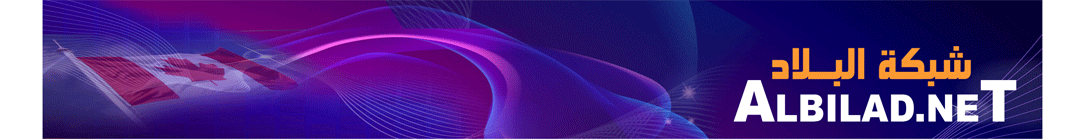
عبداللطيف السعدون
*كاتب وصحفي عراقي من جيل الرواد ، ماجستير علاقات دولية من جامعة كالجري – كندا،
شغل وظائف إعلامية ودبلوماسية. رأس تحرير مجلة "المثقف العربي"
وعمل مدرسا في كلية الاعلام، وشارك في مؤتمرات عربية ودولية. صدر من ترجمته كتاب "مذكرات أمريكيتين في مضارب شمر"
يكتب مقالا اسبوعيا في (العربي الجديد) لندن
العراق وأميركا نحو
"شراكة مستدامة"... ولكن!
عبد اللطيف السعدون
الخلاصة التي خرجنا بها من لقاء رئيس حكومة العراق محمد شيّاع السوداني برئيس الولايات المتحدة جو بايدن أن البلدين مقبلان على اتّباع صيغة "الشراكة الثنائية" في علاقتهما التي تعتمد على تفعيل "اتفاقية الإطار الاستراتيجي" في مجالات السياسة والدفاع والطاقة والصحة والاتصالات والقضاء، والتي لا تعدو أن تكون إعادة إنتاج لما هو حاصل منذ الغزو الأميركي للبلاد، وقد بشّرتنا بمردوداتها مهندسة العلاقات بين البلدين سفيرة أميركا لدى بغداد ألينا رومانوسكي، ووصفتها بأنها ستكون "شاملة" و"مُستدامة"، أي أنها ستتعامل مع كل شؤوننا، وتعالج كل مشكلاتنا، وقد تبقى معنا طول العمر. وطيّبت رومانوسكي خواطرنا، إذ أخفت عنا أن هذه الشراكة ليست متكافئة ولا عادلة، وإنما هي "شراكة" مفروضة من قوة غاشمة احتلّت بلدا، ونصّبت على حكمه من تراه يحقّق مصالحها، وحيث جعلت البلد لا حوْل له ولا طول، وليس بين حكّامه من يجرؤ على أن يعترض، أو حتى أن يناقش.
عرضت رومانوسكي علينا أيضا في سياق ما سمّتْها "مقالة رأي" جردة بأصناف ما قالت إنه يمثّل "الدعم المستدام والحيوي" الذي قدّمته بلادها إلى العراقيين على مدى الأعوام السالفة، ووثقته بأرقام عن ملايين الدولارات التي صرفتها في العراق خدمة لمواطنينا في مجالات بناء القدرات الأمنية، وتنمية المجتمعات المحلية، وإطلاق مشاريع جديدة وفرص عمل، وبناء مدارس ومستشفيات ومرافق مياه، ودعم النازحين، والتطوير التكنولوجي... إلخ.
وبالطبع، اكتشف العراقيون مبكّرين أن حصيلة هذه "الجردة" هي صفر على الشمال، ولم تدرّ عليهم لا سمنا ولا عسلا، بل ما حصل في الأعوام العشرين التي مرّت من مآس وآلام وانتهاكات ودمار شامل في كل مرافق الحياة والمجتمع يفوق ما حدَث لشعوبٍ أخرى تعرّضت لحروبٍ أوعمليات غزو أو احتلال، وما تقوله المنظمات الدولية المتخصّصة يدحض ما أشارت إليه رومانوسكي، إذ وضعت منظمة الشفافية الدولية العراق، في أحدث تقرير لها، على قائمة "الدول الأكثر فساداً، والأقل شفافية"، حيث يغذّي الفساد العنف والصراع، ويعرّض حياة المواطنين العاديين إلى مخاطر.
إلى ذلك، تعمّدت رومانوسكي أن تسرّب لنا معلومة لتذكّرنا بمنة بلادها علينا، عندما قالت إن دولا طرقت باب العراق، معلنة عن بدائل لما تعرضه الولايات المتحدة، لكن السفيرة ترى أن أيا منها لم يقدّم للشعب العراقي بقدر ما تفعله الولايات المتحدة كل يوم، ولا يمكن لأيٍّ منهم أن يقدّم للعراق شراكة متكافئة ومتساوية تربط العراق بالعالم وتعزّز ازدهاره مثل أميركا!
نفهم من "مقالة الرأي" هذه التي كتبتها رومانوسكي، السفيرة التي تريد أن تضع بصماتها على الخطوط الحمر في بلادنا، كما فعلت سابقتها "صانعة الملوك" مس بيل في زمن الإنكليز، أنها تؤكّد ما هو مؤكّد من دون أن تدري، وهو أن العراق وقع، رغما عنه، في شراك قوّتين غاشمتيْن، أميركا التي احتلته، وإيران التي هيمنت عليه. وهكذا وجد العراقيون أنفسهم في دولة مختطفة، ولا خلاص، ولا حتى أمل في انتزاعها من خاطفيها إلا من خلال مشروع وطني شامل يضمن حقوقهم في بلدهم، ويحقّق لهم طموحاتهم ورغباتهم وأحلامهم، ولكن هذا الخيار لا تزال تكتنف تحقيقه صعوبات، فلا أميركا في وارد ترك العراق لأبنائه، وهي التي خسرت في حربها آلاف الجنود، وأنفقت أكثر من تريليون دولار، وعينها على ثرواته وموارده، ولا إيران يمكنها، في ظل دولة "الولي الفقيه" أن تفكّر في التخلي عن مشروعها العرقي الطائفي الذي تعتبر بغداد، من خلاله، غنيمتها الكبرى التي سعت إلى الاستحواذ عليها منذ هزمها الإسكندر المقدوني قبل الميلاد بثلاثة قرون، وتعتبرها اليوم واحدة من عواصمها.
يبقى رهان بعضهم على إمكان إصلاح الحال وصولا إلى تغيير المآل من داخل "العملية السياسية" الماثلة، وهو رهان خاسر هو الآخر، وقد أثبتت تجربة الأعوام العشرين المرّة فشل دعوة كهذه، فحتى بعض من رفع راية التغيير من ثوار تشرين، ودخل البرلمان لم يتمكّن من التصدّي للمشكلات التي يعاني منها مواطنوه، وبعضهم أخذتهم ماكنة الفساد، وحوّلتهم إلى "مسامير" ملحقة بها.
وفي ظل كل هذه التداعيات المفروضة، نكون قد وقعنا في المحذور، وأصبحت حلول مشكلاتنا في عهدة قوى إقليمية ودولية وليست في أيدينا، ومن دون أن نجد طريقاً واضحاً للخلاص، هل نفهم من هذا أن علينا أن نستسلم، ونرضى بالقسمة الضيزى، وبما يخطّط لنا من دون مناقشة أو اعتراض؟
"التيّار الوطني الشيعي"..
. ماذا بعد؟
عبد اللطيف السعدون
لا يزال مقتدى الصدر يحظى بمكانة متقدّمة لدى فقراء الشيعة،
متدنّي الوعي، الذين يروْن فيه "خشبة الخلاص" من أوضاعهم المتردّية
يقال إنّ واحدة من مهمّات السياسي إطلاق الشعارات المُبهَمَة أو التي تحتمل أكثر من تأويل، وربما الشعارات الخالية من المعنى أيضاً، فيما تكون مهمّة الكاتب إعادة الروح إلى تلك الشعارات، وتمحيصها، وكشف ما فيها من غموض وإبهام. وقد نصحنا المعلّم الصيني كونفوشيوس، في واحدة من مأثوراته، أن نعيد المعنى إلى الكلمات وهي في مرحلة التداول.
نحن أمام مهمّة من هذا النوع، عندما يطلق مقتدى الصدر تسمية التيّار الوطني الشيعي على التيار الذي يتزعّمه، وهي التسمية التي تحتمل أكثر من معنى، الهدف الأساسي منها الاستعداد لجولة أخرى تضع الصدر وتيّاره، من جديد، في خانة العملية السياسية الماثلة، التي هجرها قبل أكثر من عام، بعدما وجّه إليها سهام نقده، ودعا إلى تغييرها. وإذا كان الصدر معروفاً بتقلّباته المزاجية المفاجئة، وعدم انضباطه، وبسعيه إلى إعادة إنتاج نفسه كلّما أحاطت به ظروف خانقة، إلا أنّ ما هو مهمّ في آخر خطواته تلك إطلاقه صفتي "الوطنية" و"الشيعية"، في آن معاً، على تيّاره، وما تحمله التسمية من تناقض، وما تثيره من ظنون، وهذا ما دعا "وزير القائد"، محمد صالح العراقي، إلى التوضيح أنّ قائده يعني وضع "المذهب" أولاً، ثم "الإسلام" ثانياً، ثم "الوطن ومكوناته"، فأعاد بهذا التوضيح، من حيث لا يعلم، التيّارَ الصدري، إلى المربّع الأول، فكرّسه "تيّاراً مذهبياً" بامتياز، ونفى عنه ضمناً صفة "الوطنية" التي أراد أن يسبغها عليه، فجاءت تغريدته بعكس ما أراد، وكنّا نتمنّى لو أنّ الأمر جرى على غير ذلك، لو أنّ خلوة الصدر المديدة أعانته على فتح الطريق أمَامَه لتأسيس تيّارٍ وطنيٍ، عراقيٍ، خالصٍ، يتعالى فوق الهويّات الثانوية، ويرقي ليمثّل كلّ العراقيين على قاعدة الانتماء إلى الوطن، عندها يكون قد تراجع عن خطاياه المعروفة، وإحداها تشكيله مليشيا جيش المهدي بعد الاحتلال، المليشيا السوداء التي أوغلت في دماء العراقيين، وفتكت بالمئات من العلماء والضبّاط، وذوي الكفاءات والمهن الراقية، وأوْدت بأسَر كثيرة.
وماذا بعد؟ ما الذي يريد مقتدى الصدر الوصول إليه؟. ... بمراجعة الحسابات السياسية القائمة، نجد أنّ الصدر، رغم كلّ ما عليه من مآخذ وملاحظات، لا يزال يحظى بمكانة متقدّمة لدى فقراء الشيعة، متدنّي الوعي، الذين يرون فيه "خشبة الخلاص" من أوضاعهم المتردّية، وأملاً في أن تمنحهم طاعتهم آل الصدر رضا الأمام المهدي عند ظهوره، وفق العقيدة "المهدوية"، وقد استطاع الصدر استثمار هذه الثقة في تجييش الأتباع والأنصار، والدفع بهم إلى الشارع متى أراد ذلك، وقد أصبح، في فترة، وربما إلى الآن، قادراً على صنع الملوك، يعكس ذلك خشية أطراف سياسية كثيرة منه، وبالأخص تيّار دولة القانون وزعيمه نوري المالكي، وكذلك زعماء المليشيات المتمركزة في الدولة العميقة، الذين أحرزوا مواقعَ متقدّمة في أثناء عزلة الصدر، تلك العزلة التي ارتضاها لنفسه على أمل أن تشكّل له نقطة قوة، لكنّها أضعفته إلى حدّ ما، وجعلته يفكر اليوم في ولوج الميدان السياسي من جديد، ومواجهة خصومه من القيادات الشيعية التقليدية الذين يتّهمهم بالفساد والتبعيّة للأجنبي، مراهناً على الحصول على غالبية نيابية في الانتخابات البرلمانية التي ستجري في وقت قريب، والإمساك بقرار إدارة شؤون البلاد، وهذا ما أدركته إيران، وفكّرت فيه عندما حاولت الجمع بينه وبين خصومِه لوضعهم جميعاً في خدمة خططها الاستراتيجية في المنطقة، لكنّها فشلت في تحقيق ذلك، إذ أصرّ الصدر على إبقاء حبل الود بينه وبين خصومه مقطوعاً. ومع ذلك، ظلّت إيران تتواصل معه، ومع كلّ الأطراف، متمسّكة بمنطق الدولة الراعية لمصالحها، ولضمان بقاء نفوذها من دون أن تخسر أحداً من اللاعبين في الساحة، الذين تنظر إليهم مجرّد "بيادق" تستخدمهم متى شاءت وارتأت مصالحها. وأدرك هو، من ناحيته، أن لا بدّ من موالاة إيران على أمل أن تساعده في الاستحواذ على "الجائزة الكبرى" التي يريدها لنفسه دوناً عن غيره من القيادات الشيعية.
وهكذا، يظلّ الصدر زمناً أطولَ مالئاً الدنيا وشاغلاً الناس، وأحد شخوص المشهد السياسي العراقي البارزين، وربما تصحّ حساباته هذه المرة أكثر من السابق، فيحقّق الغالبية البرلمانية التي يسعى إليها، وينهي سطوة خصومه ومنافسيه. لكنّ ذلك، لو حدث فعلاً، فلن يعني شيئاً بالنسبة لغالبية العراقيين الذين يريدون التغيير الجذري والشامل، وتلك هي المفارقة.
أيّ طقوس يمكن
أن ترسم الخراب العراقي؟
عبد اللطيف السعدون
ثمّة دلائل تَصفَعُنَا كلّ يوم لتؤكد لنا ما هو مُؤكّد، أنّ العراق لم يعد ذاك الذي نعرفه قبل أن يغزوه الأميركيون قبل 21 عاماً، فقد سُلبت سيادته، وانتُهِكَتْ أرضه، وامتُهِنَتْ كرامته، وصِيغَتْ أقداره على غير النحو الذي يُريدُه أهله، وأصبح القرار فيه لزعماء المليشيات التي أسّست الدولة العميقة، وقبضت على المال العام، وسعَتْ، وتسعى دائماً، إلى تحويل البلد، الذي عُمره أكثر من ستة آلاف سنة، إلى "ولاية" تابعة لدولة "ولاية الفقيه" من دون أن تجد من يردعها، ويردّها على أعقابها، ومعلومٌ أنّ مهمة الردع والردّ مهمة صعبة تحتاج أبطالاً ذوي حكمةٍ ودرايةٍ، وقدرةٍ على مواجهة التحدّيات، والبلاد التي تحتاج أبطالاً من هذا النوع دائماً لا تبدو محظوظةً.
وهكذا، ليس ثمّة في العراق من يجهل أنّ المسؤول الذي يقترن اسمُه بلافتة منصب رفيع في قمّة السلطة، رئيساً كان أو وزيراً أو عضواً في البرلمان، ليس هو صاحب الكلمة في تقرير السياسات العليا، وقد لا يستشار أو يُؤخذ برأيه في حالات كثيرة، إنما هناك من يتّخذ القرار نيابة عنه من خارج الحدود، من سدنة المرجع الإيراني الأعلى، ويفرضه من خلال "فائض القوّة" الذي توفّره له مكانته الدينية. وإذا كان بعضهم قد نسي أو تناسى خطط قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري، قاسم سليماني، في إدارة شؤون العراق نيابة عن سيّده، التي وصلت إلى حدّ تأدية مسؤولين رسميين عراقيين القسم أمامه على الالتزام والطاعة، قبل مباشرتهم مناصبهم، وكذلك توجيهات خلفه، إسماعيل قاآني، في زياراته المتتابعة إلى العراق واجتماعاته بمسؤولي البلاد، وتوجيهات سفير إيران في بغداد الذي يمارس دوراً أقرب إلى مهمّات "مندوبٍ سامٍ مفوضٍ" من حكومته. إذا كان هذا كله قد دخل في دائرة النسيان العفوي أو المتعمّد لدى بعضهم، فإنّ ثمّة كومة من وقائع طازجة تفضح الطريقة التي تُقَرَّرُ معها السياسات العليا في العراق، فها هو رئيس هيئة أركان الحشد الشعبي، عبد العزيز المحمداوي، يُؤكّد خلال مشاركته في مسيرة يوم القدس في طهران، أنّ مليشياته التي يفترض أنّها إحدى تشكيلات القوات المسلّحة العراقية وتتلقى الأوامر من قائدها العام، "تنتظر قرارات قائد الثورة (المرجع الإيراني علي خامنئي) لتقوم بواجبها في الردّ على القصف الإسرائيلي الذي استهدف قنصلية طهران في دمشق"، وأيضاً ما كشفه زعيم مليشيا حزب الله في العراق، أبو علي العسكري، أنّ مقاومته "أعدّت عدّتها لتجهيز الأشقاء من مجاهدي الأردن بما يسد حاجة 12 ألف مقاتل من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، والقاذفات ضدّ الدروع، والصواريخ التكتيكيّة، وملايين الذخائر وأطنان المتفجرات... وجاهزون للشروع في التجهيز". وكذلك ما نظّر له قائد مليشياوي آخر عن "أهمية الأردن، وضرورة إيصال المقاومة العراقية السلاح إلى هناك لينهض مقاومو الأردن بواجباتهم على الأرض الأردنية... وإحياء جبهة الأردن التي ظلّت صامتة لتكون داعمة لفصائل المقاومة".
هذا يعني أنّ اللعب أصبح اليوم على المكشوف، ولم يعد هناك من يُمارس "التِقِيَّةَ" معنا ليقنعنا أنّ مليشيات الحشد الشعبي قوّة عراقية خالصة، وأنّها لا تَأتَمِرُ إلا بأوامر القائد العام للقوات المسلّحة، وأنّ العراق بلد كامل السيادة، وحكومته هي التي تقبض بيدها على قرار السلم والحرب، وغير هذه وتلك من الأكاذيب المفضوحة. المضحك المبكي، أنّ حكومة بغداد تتصرّف وكأن لا شيء هناك، وتُمارس الخداع كي تقنع نفسها أنّها فعلاً تمثّل دولةً ذاتَ سيادةٍ، وأنّ اللعبة تُدار منها مباشرة، فيما يدرك الجميع أنّ اللعبة بكل ما فيها من سيناريوهات وسرديّات تدار من قبل طهران، وبالذات من مكتب الوليّ الفقيه، والحصيلة لن تكون سوى مزيد من سيطرة "الدولة العميقة" على مقدّرات البلاد، ومزيد من التحكم بالسلطة والمال والقرار، ومزيد من خيبة المواطنين العاديين الباحثين عن الخُبز والأمن والأمان. وبالمختصر المُفيد، فإنّ "العراق الجديد" الذي صنعه لنا الأميركيون، وهيمن عليه الإيرانيون، أضحى، بعد أكثر من 20 عاماً، بلداً مستباحاً مسلوبَ السيادةِ، ومسلوبَ الإرادةِ أيضاً، ولا نجد في تقييمنا له أفضل من السؤال التاريخي الذي طرحته مرّة الشاعرة الأميركية سيلفيا بلاث: "بعد هذا البلاء العظيم، أي طقوس يُمكن أن ترسم كل هذا الخراب؟".
السوداني في البيت الأبيض...
استضافة أم "محاكمة"؟
عبد اللطيف السعدون
قد تُشكّل استضافة البيت الأبيض رئيس الحكومة العراقية محمد شيّاع السوداني، في منتصف إبريل/ نيسان الحالي، عنواناً بارزاً في مجمل التغييرات والتحوّلات التي يمكن أن يشهدها الوضع العراقي في المرحلة المقبلة، سواء من ناحية العلاقة بين بغداد وواشنطن أو على صعيد التشكيلة الحاكمة في العراق. ومع أنّ الخطاب الرسمي في العاصمتين بشأن الزيارة يعكس وجهات نظر غير متطابقة، بل توحي بوجود خلافات واختلافات في قضايا مهمة عديدة، إلا أنّ الطرفين يحرصان على إبقاء نبرة التفاؤل ماثلةً إلى حدّ ما، والتعويل على هذه النبرة في فك الاشتباك بين ما هو حاصل وما يمكن الوصول إليه، مع اعتراف الجانبين بأنّ أمراً كهذا قد يتعذّر إنجازه بسهولة في المدى المنظور.
وإذا كانت الحقيقة تكمن في التفاصيل، كما يقال، فإنّ الشيطان قد يكمن فيها هو الآخر، ليظهر عند الحساب، وهذا ما توحي به مذكّرة السيناتور الجمهوري توم كوتون وفريقه، التي وجّهها إلى الرئيس جو بايدن، ورأى فيها أنّ "استضافة" السوداني في البيت الأبيض ينبغي أن تتحوّل إلى "محاكمة" على خلفية الارتباط الحميم بين حكومة بغداد وحكومة "الوليّ الفقيه" في طهران، إذ يستخدم العراق الدولار الأميركي لإنقاذ الاقتصاد الإيراني من سيف العقوبات، في الوقت الذي تواصل فيه إدارة بايدن إعطاء الضوء الأخضر لحكومة بغداد لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران، ولتمويل مليشيات الحشد الشعبي، ومن بينها أربع جماعات "إرهابية" بتصنيف الولايات المتّحدة، بما يزيد على ثلاثة مليارات دولار سنوياً، بحسب كوتون، الذي رأى في ذلك "استرضاءً لإيران على حساب حلفاء الولايات المتّحدة". ويدعم كوتون، في مذكّرته، مطالب حكومة إقليم كردستان من الحكومة الاتحادية بتمكين الإقليم من تصدير النفط، وإلزامها بتمويله.
تظلّ القضية الأكبر في حوار السوداني بايدن من دون أفق واضح للحل، وهي وجود 2500 عسكري أميركي على أرض العراق، بمهمّات قتالية غير معلنة تقتضيها ضرورات الأمن القومي للولايات المتّحدة، وتحدّدها لهم قيادتهم، ويسمّيهم العراق "مستشارين". هؤلاء هم من تسعى إيران إلى إخراجهم، وتدفع وكلاءها إلى المطالبة بذلك لأنّها ترى فيهم عقبةً أمام طموحاتها في السيطرة على العراق والمنطقة، وقد تأكّد أنّ الولايات المتّحدة ترى ضرورة بقاء قواتها في العراق جزءاً من استراتيجيتها في منطقة الشرق الأوسط، كما أنّ معظم القادة السنّة، وكذلك الأكراد، لا يدعمون مطلب الانسحاب، ويرون في بقاء الأميركيين ضمانةً لحمايتهم من التوغّل الإيراني في البلاد، الذي بلغ حدّاً خطيراً من الهيمنة المباشرة على القرار العراقي. كما تأكّد أنّ واشنطن أبلغت بغداد بأنها حتى في حال سحب جنودها فإنّها لن توقف الهجمات الرادعة لنشاط المليشيات التي تتعرّض للقواعد أو المنشآت الأميركية في أي مكان، وهدّدت بأنّها ستكون حرّة في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان مصالحها في العراق والمنطقة، ودعت حكومة بغداد إلى فهم التبعات المالية والاقتصادية التي ستترتب على العراق في حال الانسحاب، كما أوضحت أنّ عملية الانسحاب قد تستغرق أشهراً أو ربما أعواماً، وآخر ما صدر عن واشنطن بهذا الصدد تغريدة سفيرة الولايات المتّحدة في بغداد ألينا رومانوسكي بأن "مهمة القوات الأميركية في العراق في مكافحة الإرهاب لم تنته بعد". لم يردّ أحد من السياسيين العراقيين على التغريدة، إلا أنّ أحد قادة المليشيات أنذر بأنّ زيارة السوداني إلى واشنطن إذا لم تتكلّل بالاتفاق على سحب القوات الأميركية من البلاد، فإنّ ذلك سيفتح أبواب جهنم على مصراعيه.
نحن إذاً أمام مشهد سريالي يوضّح طبيعة الأوضاع الماثلة في العراق، والتي لا يمكن التنبّؤ بمآلاتها بسهولة، وقد تؤدّي إلى معركة "كسر عظم" بين وكلاء إيران، النافذين في حكومة السوداني، والسوداني نفسه الذي يُتّهم بأنّه يميل إلى الولايات المتحدة، ويطمح أن يحصل على "تزكية" أميركية تؤهّله للحصول على ولاية ثانية. وفي هذه الحالة، سيصطفّ معه قادة السنّة والأكراد فيما سيتفتت "الإطار التنسيقي"، وينحسر ظلّ زعيم "دولة القانون" نوري المالكي، الذي كان يردّد دائماً: "ما ننطيها"، أي أنّه لن يسمح لغيره بالاستحواذ على المشهد.
وبالمختصر المفيد، ستبقى حالة السيلان في المواقف والاتجاهات والسياسات المعلنة في العراق من دون حسم فترة أطول.
العراق... من ينهي
الشرب من الكأس المرّة؟
عبد اللطيف السعدون
كومة الفضائح التي تفجّرت في العراق، الأسبوع الماضي، وطاولت مرافق
حيوية في الدولة حملت مؤشّراً خطيراً دالّا على خلل بنيوي اكتنف نشأة
النظام السياسي الجديد الذي جاء به الأميركيون. وانعكس، طوال الأعوام
العشرين التي مرّت، على البنيان الاجتماعي والتعليمي بمقدار مهول من
الرثاثة والاهتراء في منظومة القيم والأخلاق السائدة، وجعل المواطن
العراقي العادي يتساءل عمّا إذا كان هذا كله يحدُث في ظل حكم أحزاب
تتشدّق بحمل رايات الإسلام وشعاراته، وعما إذا كانت تلك الأحزاب تمثل
الإسلام حقا؟
ليس قليلا أن تلقي سلطات الدولة القبض على عميد إحدى الكليات الجامعية
على خلفية استغلال طالبات وابتزازهن جنسياً مع أنه كان محسوباً على
فصيل "إسلاموي"، ورعى قبل بضعة أسابيع ندوة لطلبة الجامعة عن "الجوانب
المشرقة في حياة السيدة الزهراء"! وليس قليلا أن اكتشاف شبكة احتيال
وغسيل أموال من ضباط كبار يتعاملون مع "فاشنستات" لابتزاز سياسيين وذوي
مناصب عليا عن طريق الإيقاع بهم، وتصويرهم في أوضاع خادشة للحياء، ومن
ثم إجبارهم على دفع أموال مقابل عدم فضحهم، وواحد من هؤلاء الضباط كان
قد نشر كرّاسا تعليميا عنوانه "كيف تحصّن نفسك من الابتزاز الإلكتروني"!
وليس قليلاً أن يعلن نائب سابق ورئيس حزب سياسي أنه تلقّى، في وقت
سابق، تهديدا من رئيس المحكمة الاتحادية العليا يطلب منه الكفّ عن
الدخول في تحالفٍ مع تيار سياسي معين، وفي حال عدم الاستجابة للتهديد
ستعمد المحكمة لمقاضاته عن تهمةٍ ما، وطرده من البرلمان! وأيضا ليس
قليلا إعلان الشرطة السويدية القبض على وزير الدفاع العراقي السابق
الحاصل على الجنسية السويدية على خلفية "احتيال واحتيال مشدّد"، وحصوله
على مساعدات من دائرة الضمان الاجتماعي في السويد له ولأسرته، في وقتٍ
كان يتقاضى فيه رواتب من الدولة العراقية!
أضف إلى ذلك ما تكشف، في الشهور الأخيرة، عن تواطؤ ممنهج بين قوى نافذة
في لبنان، وقوى مثلها ذات حول وطول في العراق على عمليات "غسيل شهادات"
دكتوراه وماجستير من ثلاث جامعات لبنانية لم تتوفر فيها المعايير
العلمية المعروفة لمسؤولين وسياسيين وذوي مناصب عليا من العراقيين
ولأبنائهم، مقابل المال. وقدّم بعض من منحوا تلك الشهادات شهادات
مزوّرة لمراحل أدنى جرى تمريرها ومعادلتها، ثم الانضمام للدراسات
العليا، ومن دون حضور للمقرّرات الدراسية.
وبعدما أجرت السلطات اللبنانية تحقيقا في ما حصل، وتبيّن أن عمليات
"غسيل الشهادات" شملت أكثر من 1700 حالة انفضح الموضوع، وفاحت رائحة
التزوير وشراء الشهادات، وبدلاً من أن تعمد بغداد لمعاقبة من شارك في
هذه "الفضيحة" تحرّكت أطرافٌ سياسيةٌ للضغط لغلق الموضوع، ولكن الأمر
لم ينته عند هذا الحد، إذ اضطرّ العراق لإيقاف معادلة الشهادات الصادرة
من الجامعات اللبنانية الثلاث المعنية، بعدما كان قد تم الاعتراف
بشهادات مسؤولين عراقيين وأبنائهم، ومن بين من حصل على الدكتوراه من
الجامعة الإسلامية في بيروت بهذه الطريقة، وهي إحدى الجامعات الثلاث
ذات العلاقة بالفضيحة، رئيس السلطة القضائية، ووزير التعليم العالي،
فتأمل!
قمّة البؤس أن تتعرّض المرافق الثلاثة الأهم في أي دولة (التعليم
والأمن والقضاء) إلى هذه الكمية المهولة من الأعطاب، ولا تستثير همّة
القائمين على السلطة والقرار فيها، وقمّة البؤس لملمة هذه الفضائح
والتظاهر بالحزم، وتشكيل لجانٍ للتحقيق تلد لجانا، وانتظار النتائج ثم
الاسترخاء والعودة إلى المربّع الأول، وهذا ما حدث مع فضائح مماثلة
زكمت رائحتها الأنوف ثم تراجع بحثها شيئاً فشيئاً، وطويت في مراهنة على
ضعف الذاكرة الجمعية للعراقيين، وبعضها الآخر دين أبطالها، وسيقوا إلى
القضاء، وصدرت بحقّهم أحكام بالسجن، ولم يلبثوا قليلا حتى ظهروا في غير
ما عاصمة عربية أو غربية، وكأنه لم يكن هناك شيء.
وقمّة البؤس أيضا أنك لا تتوقع معالجاتٍ حقيقية لما هو مطروح من فضائح،
وفظائع، ولا حلولا جذرية للمشكلات الماثلة، وكل ما يمكن أن نتوقّعه
شرور جديدة، وفضائح تلد أخرى، كما لا تتوقّع أن يقف أحدٌ من الذين
يحكمون البلد ليفعل كما فعل المسرحي الكبير فاتسلاف هافل، الذي انتفض
بعدما شاهد ما يجري من حوله: "لقد وصل الأمر إلى قدر من الرثاثة
والاهتراء لا يمكن معه الصمت، وعليّ أن أنهي الشرب من الكاس المرّة"!
لكن من يا ترى من زعمائنا القابضين على السلطة يفكّر في أن ينشقّ لينهي
الشرب من الكأس المرّة؟
ما وراء
اجتماعات بغداد مع تركيا
عبد اللطيف السعدون
بعد عمليتي "مخلب النمر" و"مخلب النسر" اللتين نفّذتهما القوات العسكرية التركية داخل الأراضي العراقية، وكانتا مثار خلاف بين أنقرة وبغداد في السنوات الماضية، يبدو أن تركيا نجحت، على نحوٍ بدا مفاجئاً لكثيرين، في إقناع العراق بمعادلة "الأمن مقابل المياه والتنمية"، واقتربت من الاتفاق على دخول العراق شريكاً كاملاً معها في عملية "المخلب القفل"، ثالث عملية عسكرية، لاجتثاث حزب العمّال الكردستاني بي كي كي" الذي يعتبره الأميركيون والغرب "منظمّة ارهابية"، وتدمير معاقله، وستكون الخطوة التالية إنشاء "منطقة عازلة" بحدود 30- 40 كيلومترا في العمق العراقي، سيُعلَن عنها في أثناء الزيارة المرتقبة للرئيس التركي أردوغان إلى بغداد.
واللافت أن هذه الترتيبات التي جرى التوافق عليها في اجتماعات بغداد أخيراً بين البلدين، ولم تعلن كامل تفاصيلها، تجرى بعد 20 عاما من خلافات بغداد مع أنقرة على المياه وأمن الحدود التي كانت تتصاعد مرّة، وتخفُت أخرى، حيث بدا العراقيون خلالها مصرّين على طرد القوات التركية التي أقامت عشرات القواعد العسكرية عبر الجبال في شمال العراق، وحتى في مناطق متقدّمة من محافظة نينوى، ووصل الأمر إلى درجة تنظيم مليشيات مرتبطة بإيران هجمات على تلك القواعد، وسط مباركة أطراف سياسية عراقية فاعلة.
اللافت أكثر ما تردّد عن أن مليشيات "الحشد الشعبي" التي كانت تقيم علاقة تحالفٍ مع الحزب المذكور لصالح إيران ستشارك في الأعمال العسكرية، كما أن الخطوات المعلنة حظيت برضا ودعم "الإطار التنسيقي" الحاكم الذي يريد استخدام هذه الورقة للتغطية على الصراعات المحتدمة داخله.
وإذا ما اعتبرنا اتفاق بغداد - أنقرة، إذا ما حصل، محاولة من العراق لرسم علاقاته مع جيرانه على قاعدة المنافع المتبادلة، والطموح التركي لإغلاق مشكلة حادّة شغلت الحاكم التركي سنوات طويلة، فإن النظر الى الاتفاق من الزاوية الأخرى يمكن اعتباره محاولةً لاستباق ما يمكن أن تصل إليه ترتيبات ما بعد حرب غزّة على صعيد المنطقة، حيث تتحفّز القوى الدولية والإقليمية للقيام بدور، أو للحصول على مكاسب، وتظهر هنا إيران طرفاً رغم أن دورها لا يزال مُضمرا، ولم يظهر إلى العلن بعد، وهي التي كان الوجود العسكري التركي في العراق يؤرّقها دائما، ويثير قلقها في وقتٍ تعتبر فيه العراق ملعبها الذي لا يمكنها أن تتسامح مع أي طرف دولي أو إقليمي في أن يلعب فيه من دون التوافق مع أجندتها.
وهناك أميركا التي تملك القرار الاستراتيجي في المنطقة، لا بد أن تكون قد أعطت، هي الأخرى، مباركَتها الاتفاق، وهي التي تعمل ليل نهار على تبريد سخونة الأحداث من حول إسرائيل المنشغلة بحرب إبادة غزّة، وهذه النقطة توحي أيضا بتوافق أميركي- إيراني، وعلى استعداد الجانبين للتفاهم في قضايا أخرى، منها الإقرار بدور إقليمي ما لطهران يرضي إسرائيل، ويتوافق مع مخطّطاتها. هنا ينبغي أن تلفت كل هذه التداعيات انتباه الحاكم العربي الذي يعاني من قصور الرؤية، والجهل بما يدور ليس على بعد أمتارٍ من الأرض العربية إنما أيضا في داخلها، وفي عمقها الاستراتيجي.
قراءة ما لم يُذكر في محاضر اجتماعات بغداد تدفع إلى تقرير حقيقة ماثلة، أن العراق، وبعد 20 عاما من العزو الأميركي المقترن بالهيمنة الإيرانية المباشرة على قراره، لا يزال يتخبّط في مسار علاقاته الدولية، ولا يزال أسير النظرة الأحادية التي تجعلك، كما يقول الروائي التشيكي ميلان كونديرا، ترى الشجرة فقط، إنما ما هو مطلوب منك كي تجد حلّاً لمشكلة أن ترى الشجرة والغابة في وقت واحد، كي تستقيم الرؤية، ويصحّ القرار.
وما كشف عنه ليس سوى عيّنة لهذه النظرة، إذ تجاهل المفاوض العراقي الانتهاك الخطير لسيادة البلاد المتمثل في الوجود الثابت والمحتمل لآلاف الجنود الأتراك في عمق 30- 40 كيلومترا على أرض العراق. والميزة الاستثنائية التي يمنحها الاتفاق المحتمل لتركيا في التدخّل في الشأن العراقي، والعبث في الخرائط العراقية بما يخدم مخطّطاتها العرقية المعروفة التي تتذاكى بها على العراقيين كلما ضعف دور العراق، وتماهت قرارات حكّامه مع رغبات الحاكم الأجنبي.
يبقى السؤال الصعب التالي مطروحاً من دون جواب، في الوقت الحاضر على الأقل: أما كان في إمكان العراقيين حظر الحزب المذكور، وإغلاق ملفه من دون الدخول في عملية مقايضة تحمل شوائب وشكوكاً وعلامات استفهام كثيرة؟
حضر "الكرنفال"
ولم يحضر الجمهور
عبد اللطيف السعدون
ما حدث في إيران الجمعة المنصرمة عبّرت عنه شابّة إيرانية في تغريدة على منصّة إكس. قالت: "حضر الكرنفال، ولم يحضر الجمهور". والمعنى الذي استنبطته الشابة أن الانتخابات البرلمانية التي جرت لم تحظ بمشاركة جماهيرية معتبرة، بل كانت المشاركة متدنّية عكست عزوف قطاعات واسعة لم تجد في العملية الانتخابية طريقاً للتغيير، في ظل نظام مغلق تجاوز عمره أكثر من أربعة عقود، بعدما فقدت الأمل في أن يجيء تصويتها لهذا المرشّح أو ذاك بفائدة ما عليها أو على المجتمع ككل، وهذا ما توقّعته مقولة مسرّبة لممثل التيار الإصلاحي، مصطفى تاج زاده، القابع في سجن إيفن الرهيب، والذي مُنع من الترشّح للرئاسة في آخر انتخابات رئاسية، في أن بلاده تمرّ وسط مأزق صعب، دفع حكّامها الذين تتنازعهم المخاوف من ازدياد أعداد المعارضين وفقدان شرعيّة الحكم إلى إسقاط ترشيح آلافٍ من الإصلاحيين والليبراليين والمستقلين في الانتخابات الحالية.
"لن يأتي كرنفال" الجمعة، مهما كانت حصيلته، بجديد، و"المأزق الصعب" الذي أشار إليه تاج زاده سيظل ماثلاً في المشهد الإيراني إلى أمد أطول، وسيدفع إلى زيادة قبضة النظام على السلطة، والسعي لإعادة إنتاج "الشرعية" المفترضة التي اعتمد عليها منذ ولادة جمهورية ولاية الفقيه التي ما زالت تعاني من الثقوب، وقد كشفت العملية الانتخابية أخيراً تشبث النظام ببعض الأساطير والخدع لإضفاء شرعية دينية على وجوده، بهدف استمالة جماهير العامّة ودفعها إلى التصويت. وواحدة من هذه الخدع ترويج وهم إن إقدامهم على ذلك سيساعد "المهدي المنتظر" على إنهاء فترة غيابه، وسيكون لهم وحدهم شرف مرافقته والتبرّك به!
مع ذلك، لا يبدو أن النظام في إيران يعيش أيامه الأخيرة، كما قد يدور في أفهام بعضهم، فقد استطاعت طبقة "الكهنوت" الحاكمة أن تكرّس وضعاً يشكل امتداداً لها وسط القطاعات الدنيا من المجتمع التي تعيش على الأساطير وحكايات المواكب الحسينية، وأشاعت مناخاً يربط حصول تلك القطاعات على المنافع والأرزاق من خلاله طاعتها، وفتحت أمامهم، بالتنسيق مع حكّام العراق التابعين لها، أبواب زيارة المراقد المقدّسة في النجف وكربلاء، والتبرّك بها، وممارسة الطقوس الخاصة في مثل هذه الحالات، مع توفير كل متطلّبات إقامتهم في مواسم الزيارات مجاناً من حكومة بغداد، ومن ثم انتظار الفرج على يد "المهدي" الذي يجيء ولا يجيء!
استطاعت طبقة "الكهنوت" الحاكمة الإيرانية أن تكرّس وضعاً يشكل امتداداً لها وسط القطاعات الدنيا من المجتمع التي تعيش على الأساطير وحكايات المواكب الحسينية
هذه الخبطة وحدها ضمانة بقاء نظام ولاية الفقيه، وهي التي أتاحت الفرصة أمام المتشدّدين لمواصلة القبض على السلطة والمال والقرار، والسير في الطريق الذي سلكوه منذ "الثورة الإسلامية" التي أطاحت نظام الشاه. ويمكن اعتبار الشعارات التي رفعها المتشدّدون في الحملة الانتخابية أخيراً حالة "إعادة إنتاج" للمؤسّسات، وحتى للشخصيات المهيمنة اليوم على المشهد السياسي.
يبقى أن شباب العاصمة والمدن الكبيرة، وهم الذين كانوا وقود حركات الاحتجاج المعارضة للنظام، ليس من السهولة مخاطبتهم بلغة المذهب، وبأساطير التاريخ غير الموثق، وهؤلاء هم الذين يعتمد عليهم "الإصلاحيون" الساعون للتغيير بشكل أو آخر، وهذا ما ظهر في الطروحات التي قدّموها في أثناء الحملة الانتخابية، والتي ركّزت على "تعزيز الحرّيات، وخصوصاً حرّيات النساء، وحل مشكلات الشباب ومشكلات المعيشة، وتعزيز مكانة البرلمان في الحياة الداخلية". واللافت أن تلك الطروحات دعت إلى "خفض التوتر مع دول العالم"، فيما ركّز "المتشدّدون" على "التمسّك بتعاليم الشريعة، وتعزيز محور المقاومة، ومناهضة الهيمنة الأميركية"، وهي الطروحات التي قال عنها شاب معارض إنها "لا توفر الخبز، ولا تضمن الحرية".
وهكذا سيستمرّ الصراع بين المتشدّدين والإصلاحيين في المرحلة المقبلة، لكنه سيظل في إطار مناكفات محدودة تشبه ما رواه لنا صموئيل بيكيت في مسرحيته "الأيام السعيدة عن الحوار العبثي بين شخصيتي ويني المدفونة في الرمال وويلي الزاحف على يديه وقدميه حيث لا يصل الحوار إلى نتيجة". أما بالنسبة إلى العراقيين الذين يعانون من سطوة إيران وهيمنتها، فليسوا في وارد متابعة أخبار الانتخابات الإيرانية، لأنها لا تعني، بالنسبة إليهم، شيئاً، وإن كان يعتقد بعضهم أن أي تغيير في إيران سيعقبه بالضرورة تغيير في العراق، والتغيير في كلا البلدين مستبعد في الوقت الحاضر لأكثر من سبب.
أخطبوط الفساد
في العراق باقٍ ويتمدّد
عبد اللطيف السعدون
سألتُه إثر عودته من زيارته للعراق، بعد عشرين عاماً على آخر زيارة له، عن انطباعاته التي حملها من هناك. أجابني بأن ما خرج به أن العراق تحوّل، على مدى السنوات العشرين، إلى أخطبوط فساد كبير وضخم، حتى كادت كلمة الفساد تكون مرادفة تماماً لكلمة العراق، بل أصبح الفساد والعراق أشبه بوجهي العُملة الواحدة. ولكي يقرب لي صورة الأوضاع هناك على حقيقتها، كما قال، سألني ما إذا كنتُ أعرف شيئا عن حيوان الأخطبوط، ولم ينتظر أن أجيبه، بل تابع: "حيوان ذكي، له عدة أدمغة، وله مجسّات طويلة يتحسّس بها ما يواجهه، وجسمُه أقرب إلى قطعة إسفنج يمكنه ضغطها للولوج إلى داخل الشقوق الصغيرة، وله أذرعٌ تنمو مجدّداً كلما تعرّضت للإصابة، ويشهد له العلماء بحدّة ذكائه وقدرته على التلوّن والتخفّي في سعيه إلى اصطياد فريسته.
وبحسب ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز، رصد مرّة فريق من العلماء واقعة خروج أخطبوط من حوض السمك الوطني في ويلينغتون (عاصمة نيوزيلندا) متسلّلاً من سياج الحوض الذي كان يحتويه مع عشرات الأسماك والحيوانات البحرية، وأخذ طريقه منزلقاً إلى فتحة تصريف المياه الأرضية ليذهب إلى البحر، ويُنقذ نفسَه من مصيرٍ لا يرتضيه، وفسّر العلماء ذلك بأنه دليلٌ على خصيصة الذكاء التي يتمتّع بها.
استطرد محدّثي، بعد أن أدرك أنني عرفت قصده: "عليك أن تتخيّل، إذاً، أن أخطبوط الفساد في العراق بهذا القدر من الذكاء، والخبث أيضاً، وبهذه الأذرع الطويلة التي يُمكنها أن تمتد الى أي مكان، وبهذه القدرة على التلوّن والتخفّي، والأكثر من ذلك بإمكانية مجابهة كل من يجرؤ على فضحه أو محاولة النَّيْل منه. هكذا هو حال العراق اليوم، لقد امتدّ الفساد إلى كل زاويةٍ وميدان، وليس ثمّة شاردة ولا واردة إلا واصطبغت بلوْنه، وفي بغداد يندُر أن تحضر مجلساً من دون أن يكون للفساد والفاسدين في أحاديث الحضور النصيب الأوفر، وقد سمعت في مشاركتي في أكثر من مجلس وقائع لا يرقى إليها الشكّ، وصل بعضُها إلى القضاء أو إلى هيئة النزاهة، لكنها، في نهاية المطاف، طُويت، أو سوّيت على نحوٍ ما، وعفا الله عما سلف. الأنكى أن بعض أبطال فضائح الفساد جرى التحقيق معهم، وتم حجز أموالهم، وصدرت بحقّ بعضهم أحكام قضائية باتّة، وأودعوا السجن، لكنهم ما لبثوا أن تسلّلوا، بقدرة قادر، إلى خارج الحدود، تماماً كما تسلّل أخطبوط نيوزيلندا الذي روت حكايته النيويورك تايمز".
لم يترُك لي محدّثي مجالاً للتعليق، إذ واصل سرد انطباعاته، مشيراً إلى ضجيج صادم في الأوساط الإعلامية، ولدى مجموعات التواصل الاجتماعي، واجهه في أثناء زيارته، محوره حكاية عن مسؤول عام بدرجة "رئيس"، قيل إن يده امتدّت لاغتصاب بيت فخم يعود لأحد رجال صدّام حسين، وحوله إلى ملكيّته، ومن ثم أجّره لسفارة عربية مقابل آلاف الدولارات. وبدلاً من أن يتحرّك القانون لمحاسبته، عمدت السلطة إلى غلق القناة التي فضحت هذه الواقعة، مع أن نائباً برلمانياً طالب بكشف الحقيقة للرأي العام، والمُضحك المبكي أن المسؤول نفسه اعتبر فضح الواقعة من ناشطين "ممارسة غير مقبولة"، ودعا إلى محاسبتهم، فيما سانده رئيس السلطة القضائية متوعّداً باتخاذ "كافة الإجراءات القانونية اللازمة".
يضيف محدّثي أن عشرات الفضائح المشابهة تتناسل كل يوم في العراق، مُحدثةً إجماعاً في الشارع على الطعن في صدقية حكومة محمد شياع السوداني وفاعليتها في محاربة الفساد. وإذا كان ثمّة من راهن، بشيءٍ من السذاجة على هذه الحكومة لفعل ما عجزت عنه الحكومات السابقة، فقد آن لهم أن يخسروا رهانهم، بعد أن تحوّل الفساد إلى "ثقافة" عامة في ظل ترويج "فتاوى" تعتبر المال العام مالاً سائباً يجوز التصرّف به، وما دامت الطبقة الحاكمة الموسومة بالفساد والإفساد قد تعلّمت أن تتحشّد وتتحد، وإن اختلفت أطرافها، لتحمي نفسها من أية نتائج تفقدها مواقعها في السلطة ومكانتها في المجتمع، هذا يعني أن أخطبوط الفساد باقٍ ويتمدّد، ولا بد لمواجهته من عملية جراحية كبرى لا يتقنها إلا جرّاحون مهرة قد لا نعثُر على أحدٍ منهم في عراق اليوم، وتلك هي العقدة.
كفّ محدّثي عن الكلام، وراح يتأمل في البعيد، وكأنه يبحث لهذه العقدة عن حلّ!
العراق... ما عدا ممّا بدا؟
عبد اللطيف السعدون
يبدو أن الأمل قد تضاءل أمام رئيس حكومة العراق محمد شياع السوداني كي
يحظى بفرصة أن يستقبله في البيت الأبيض الرئيس الأميركي جو بايدن، في
لقاءٍ كان معقودا عليه أن يفضي إلى نتيجة يتضح من خلالها مسار العلاقة
بين العراق والولايات المتحدة التي قال العراقيون إنها ستنتقل إلى صيغة
"شراكة ثنائية"، بدلا من صيغة "التحالف" القائمة حاليا. ولكن ما يمكن
تصوّره طبيعة المواجهة التي كان يمكن أن تجري بين الزعيميْن، لو جرى
اللقاء بينهما، والتي تحتمل الدخول في مماحكاتٍ تبعا للخلفية التي
يحملها كل طرف، ففي جعبة بايدن ما حدث في الأعوام العشرين الماضية،
ابتداء من الغزو العسكري الأميركي للعراق، ومرورا بحقبة العلاقة
الذهبية بين رجال الإدارات الأميركية المتعاقبة في تلك الفترة وحكّام
بغداد، ووصولاً إلى حقبة السنوات الأخيرة التي هيمنت فيها طهران على
القرار العراقي، ودخلت في حربٍ غير معلنة مع إدارة واشنطن، وصلت إلى حد
استخدام الأرض العراقية ميدانا لصراع غير محسوب بين الطرفين، أصبحت معه
جحافل العساكر الأميركيين، والقواعد التي يقيمون فيها عرضة لضربات
المليشيات التابعة للحرس الثوري، وزاد من حدّة هذا الصراع تصاعد
التوترات الإقليمية على خلفية حرب غزّة، ودفع حكومة طهران وكلاءها في
بغداد للمطالبة بسحب القوات الأميركية التي يشعر الإيرانيون أن وجودها
على مرمى حجر منهم، يضاعف من احتمال تدخّلها في بلادهم إذا ما سمحت
الظروف بذلك.
وبالنسبة للسوداني، الذي كان سيذهب إلى واشنطن وهو محمّلٌ بأعباءٍ ما
كان عليه أن يتحمّلها لو اكتفى من الغنيمة بالاياب، فإن موقعه في إدارة
الحكم في العراق كرجل تنفيذي أول يفرض عليه أن يكون المفاوض باسم بلده
أمام الأميركيين، في وقتٍ يتيح فيه ذلك لوكلاء إيران وزعماء المليشيات
التخفّي وراءه، فإن نجح في ما هو مطلوب منه فسوف يسجّل هذا النجاح في
رصيدهم، وليس في رصيده، وإذا ما أخفق سوف يتحمّل وحدَه مسؤولية
الإخفاق، عند ذاك يركله "الإطار التنسيقي"، ويقذف به خارج السلطة غير
مأسوفٍ عليه، كما فعل مع سلفه مصطفى الكاظمي، ومع غيره من مسؤولي
الحكومة الكبار.
وما نقوله هنا عن الدور الذي طلبت إيران أداءه من السوداني ليس من قبيل
التخمين أو الرجم بالغيب، إنما هو جزء من ترتيباتٍ أُقرّت في اجتماعاتٍ
عقدها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري إسماعيل قاآني مع الزعماء
العراقيين في أثناء زيارته لبغداد بهدف احتواء الخلاف الذي نشب بين
الأطراف الحاكمة بشأن موضوع الانسحاب الأميركي الذي يطالب الفريق
المحسوب على إيران بإنجازه، فيما يرى الفريق الآخر المقرّب من الولايات
المتحدة أن ذلك سوف يجرّ إلى مخاطر أمنية واقتصادية، ليس أقلها منع
العراق من الوصول إلى أموال النفط التي يتحكّم بها البنك الفيدرالي
الأميركي، أو إثارة زوبعة أمنية داخل العراق بغطاءٍ أميركي غير معلن،
أو فرض عقوباتٍ على أركان الحكم، والتهديد بكشف سرقاتهم من المال العام
التي تحتفظ الخزانة الأميركية بأدلّتها الموثقة، وربما يؤدّي ذلك كله
إلى إطاحة العملية السياسية الماثلة التي تحوي من الثقوب ما لا يمكن
حصرُها.
وفي خضم هذه التعقيدات، وفي ضوء ما يطرحه الداخل الأميركي من معطياتٍ
تتعلق بالتنافس بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وانعكاس ما يجري على
الانتخابات المقبلة، يكون الرئيس الأميركي ملزما، لو حصل اللقاء،
بمكاشفة السوداني بالتبعات التي سيتحمّلها العراق والعراقيون إذا ما
أصرّوا على انسحاب العساكر الأميركيين، ولنا أن نتصوّر لهجة التهديد
والوعيد التي سيتحدّث بها بايدن مع السوداني، ونحن نعرف أن أميركا
نفسها هي التي جمعت حكّام بغداد بعد ما كانوا يتنقلون بين الأزقّة
والمنعطفات، وحملتهم على ظهور دبّاباتها، ووضعتهم في قمّة السلطة، فإذا
بهم يتنكّرون لها، ويمحضون الولاء لأعدائها القابعين في قم وطهران،
ويبايعونهم على السمع والطاعة، والسؤال الأكثر تعبيرا عن الحال: ما عدا
ممّا بدا؟
المؤكّد أن السوداني سيكون محتارا في الإجابة عند ذاك، وهو يعلم أن
أميركا هي التي أطعمتهم من جوع، وآمّنتهم من خوف، ولولاها لما كان
بإمكان أحد منهم أن يضع قدمه على أرض العراق، بل ولبقي صدّام حسين يحكم
العراق حتى الساعة، وهذا ما اعترف به عديدون منهم.
وفي كل الأحوال، ومع تضاؤل الأمل في عقد لقاء مكاشفةٍ بين الرئيسين،
يبدو أن لا مناص من أن يبقى العراق، وحتى إشعار آخر، أسير القبضة
الحديدية الأميركية، وهذا ما يقوله في السر أهل الحكم أنفسهم.
عن أطروحة هزيمة
الغرب بفعل أميركا
عبد اللطيف السعدون
تأبى أميركا أن تتخلّى عن إشعال الحرائق، وإذكاء الحروب والصراعات التي تروّج أبشع أنواع العنف، وأسوأ أشكال العنصرية منذ اختارت طريق فك العزلة، والدخول إلى العالم، حاملة القنبلة الذرية في يد، والدولار في يدها الأخرى، وبدأت خطواتها الأولى بصنع تراجيديا هيروشيما وناغازاكي في اليابان. ولم تتورّع بعدها عن الضرب في أكثر من مكان، لتكرّس نفسها شرطياً للعالم، ولتتحول اليوم، بفعل مخطّط تاريخي مرسوم إلى شريك مباشر مع إسرائيل في حربها على غزّة، بالسلاح والمال والدعم اللامحدود، وكذلك في استخدامها حقّ الفيتو لقطع كل فرصةٍ لوقف الحرب، وهي في أوكرانيا تجد ضالّتها في إذكاء مزيدٍ من الوقود على النار المشتعلة هناك لتزيدها اشتعالا، هكذا هي أميركا التي قال عنها مرّة المفكر الفرنسي فرانز فانون إنها تريد تحقيق مجدها الإمبراطوري فوق الأشلاء، وعلى فوّهات البراكين!
ومع أن مناطق كثيرة، ومن بينها منطقتنا، لم تشهد بعد نوعاً من التمرّد على الإرادة الأميركية لأسبابٍ كثيرة، إلا أن أصواتا عديدة شرعت تعلو، بخاصة في أوروبا، محذّرة من أن واقع الحال ينذر بهزيمة الغرب كله، بفعل السياسات والتوجهات الأميركية الموغلة في العدوانية.
نظّر لهذه الفكرة أخيراً المفكر وعالم الإنثروبولوجيا الفرنسي، إيمانويل تود، وقد كان الأكثر دقةً من بين مؤرّخين وباحثين عديدين سبقوه في هذا المنحى، وذلك في توصيفه خطوات السيناريو الجيوسياسي الذي قال إنه سيقود إلى الهزيمة النهائية للغرب، ما لم يتصدّ السياسيون وقادة الرأي العام لتدارك ما هو ماثل في الأفق بالسعي إلى تحقيق نوع من الاستقلالية في مواجهة الولايات المتحدة التي تشكّل أسّ هزيمة الغرب.
يقرّ تود بتراجع الأخلاقيات التي بشّرت بها الديانة البروتستانتية لدى شرائح المجتمع الأميركي، والتي كانت قد أنتجت، في رأيه، الانتشار العالمي للقراءة والكتابة، وصولاً إلى مستويات أكاديمية عالية في مختلف مناحي العلم، وأوصلتنا، بالتالي، إلى هذا الانفتاح المذهل للتكنولوجيا الذي نعيشه اليوم، لكن هذا التطوّر اللافت اقترن بجانبٍ سلبيٍّ تمثل في صعود أسوأ أشكال العنصرية كما وضح ذلك في معاداة السود واحتقارهم، وما نراه نحن اليوم في تماهي الإدارات الأميركية المتعاقبة مع السياسات العنصرية الصهيونية في مواجهة الفلسطينيين والعرب.
قاد هذا التراجع، يشرح تود، إلى نمو النزعة العدمية في المجتمع الأميركي، وإلى تدهور فكري، وظهور الجشع الجماعي باسم "النيوليبرالية"، وفي هذا التحليل الذي يركّز على غياب القيم الروحية لا يرى المفكر الفرنسي فيه حالة رثاءٍ لما كان، وإنما هو إنذار بالخطر المحيق، والذي بدأت طلائعه في التدهور اللافت في الميدان الصناعي- الاقتصادي الذي كان الأميركيون يتبجّحون به دائما، والذي حصل على خلفية غياب أخلاقيات العمل وانخفاض المستويات التعليمية، حيث يصبح الناتج الإجمالي مجرّد فقّاعة.
الأمر الآخر الذي يحذّر إيمانويل تود منه هو "ترويج فكرة اختيار المرء جنسه كأن يصبح الرجل امرأة، والمرأة رجلا"، يقول تود: "ذلك مستحيلٌ بيولوجيا، إنه إنكار للواقع وتأكيد للزيف، وسببه اختفاء الدين من الحياة اليومية وانهيار القيم الروحية، وشأنه شأن تمجيد العنف إلى درجة الانغماس في الجريمة المنظّمة الذي يجرّ إلى مخاطر، وربما كوارث اجتماعية، إذ يتحوّل المجتمع في ظله إلى مجتمع ضائع، ولا معنى له"، وهذا ما حدث في أوروبا بفعل التأثير الأميركي، وهو ما أشاع استفزازاتٍ وتجاذباتٍ، وصراعاتٍ في مختلف أنحاء العالم، وما نشاهده اليوم جرّاء التدخّل الأميركي في مختلف القارّات بحجّة بناء الديمقراطية أو مكافحة الإرهاب هو صورة لتلك الظواهر المضادّة للإنسانية.
وفي سياق عرضه نظريته، يعزو تود انتقال أوروبا من الديمقراطية الليبرالية نحو الأوليغارشية (الأقلية) الليبرالية إلى التأثير الأميركي الذي هدفه السيطرة على أوروبا، ودفعها إلى مواجهة روسيا والصين، وقتل أية إمكانية بخلاف ذلك، معتبراً هذا التأثير "نوعاً من الإرهاب"، لكن "أميركا سوف تفشل، والمتماهين معها سيخسرون، لأن الواقع هو الذي يفوز، وأفضل شيء يمكن أن يحدُث هو انسحاب الولايات المتحدة والعودة إلى عزلتها".
وفي النهاية، يقرر تود "أن أميركا تسير على نهج عدواني، لأن الطبقة الحاكمة فيها خالية من الأخلاق، ولم يعد لديها دين، وكل ما تبقى لها هو المال والحرب، والمتعة الزائفة التي تخلق الفوضى وعدم الاستقرار في العالم، وهذا ما تواصل فعله في كل مكان".
إنهم يشقّون
طريقهم بين الجثث
عبد اللطيف السعدون
بعد "طوفان الأقصى" جرت مياهٌ كثيرة، لكن الأميركيين ظلوا صامدين في مواقفهم، إسرائيل أولا وإسرائيل ثانيا وإسرائيل أخيرا، كرّر جو بايدن ما كان قد قاله مرّات: "لو لم تكن إسرائيل موجودة لعملنا على إيجادها"، و"دعم الولايات المتحدة إسرائيل ثابتٌ كالصخر"، قدّم دعما غير محدود لها منذ الساعات الأولى للحرب، أرسل إلى مياه الشرق الأوسط حاملتي طائرات عملاقتيْن، وسفنا وغوّاصات، وعشرة آلاف بحّار، ومفاعلا نوويا وترسانة صواريخ، كما أقام جسرا جويا للسلاح مع تل أبيب بمئات ملايين الدولارات، شمل آلاف القنابل والقذائف، وقنابل ذات رؤوس حربية خارقة للتحصينات، بموافقة الكونغرس أو من دونها، هدّد بأنه سيضرب في كل مكان يشعر أنه يشكّل خطراً على إسرائيل، أجهض عدّة محاولاتٍ لوقف الحرب، لأن "اسرائيل تدافع عن نفسها في مواجهة الارهاب"!
تعدّدت زيارات مسؤولين أميركيين وغربيين كبار إلى المنطقة لمواصلة التعبير عن دعم تل أبيب، جال وزير الخارجية أنتوني بلينكن المنطقة مكوكيا مرّات، التقى زعماءها، نقل عنهم أنهم "يتفهّمون القرارات والخيارات الصعبة التي يجب اتّخاذها"، كما تفهّموا "دعم الأميركيين ضمان عدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر"، وقال إن مسيرة التطبيع بين العرب والإسرائيليين ستتواصل بعد هزيمة "حماس"!
على الضفّة الأخرى، تنصّلت طهران التي تلقّت تهديداتٍ أميركية عن تنفيذ ما كانت روّجته أنها ستقاتل من أجل فلسطين والفلسطينيين، وأكّدت أنها غير مسؤولة عما قد يفعله "الوكلاء". وقي لحظةٍ فارقة، اختفى شعار "وحدة الساحات"، ضرب "الوكلاء" في غير ما مكانٍ في نوع من "المشاغلة" محسوبٌ ومكتوب، ولم يتوقّف الأميركيون عن اتّباع أسلوب التهدئة هنا، والضرب المحسوب والمكتوب هناك كي لا تتوسّع الدائرة. المهم القضاء على أهل غزّة اليوم قبل الغد. تنادى العالم كله من أجل وقف المجازر، حتى في الداخل الإسرائيلي هناك من يريد ذلك، لأنهم أدركوا أن استمرارها ينبئ بأيام سوداء قد تواجههم على أيدي الفلسطينيين، بنيامين نتنياهو وزمرته قرّروا المواصلة، قال الأميركيون "لا لوقف اطلاق النار"، لا كبيرة إلى أن يجهز الإسرائيليون على آخر طفل وشيخ وامرأة، هكذا شرعوا يعملون على شقّ طريقهم بين الجثث!
دولة جنوب أفريقيا "الشقيقة"، بلاد نيلسون مانديلا، تطوّعت لتقديم شكوى إلى محكمة العدل الدولية لإدانة إسرائيل نيابة عن العرب، بعدما تخلفت عن الفعل حكوماتهم وجامعتهم العتيدة الموصوفة بأنها "لا جامعة ولا عربية"، دعمت المطلب الأفريقي 13 دولة من أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية، وتقدمت غير دولة عربية، على استحياء، لدعم المطلب المذكور.
كان رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا كريما معنا، عندما قال لنا: "بلدنا صغير، واقتصادنا صغير، لكننا سنظلّ متمسّكين بمبادئنا، ولن نكون أحرارا ما لم يتحرّر الفلسطينيون". وقرّر برلمانه طرد السفير الإسرائيلي، وقطع العلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب، هل تسمع الدول العربية التي ينعم فيها سفراء تل أبيب بالأمن والأمان بخبر كهذا أم تتغافل عنه؟ وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو حرب غزّة بأنها "حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني"، وصرخ في تجمّع شعبي: "فلسطين.. قاومي، قاومي حتى ينتفض العالم من أجلك"، رفض مادورو أكثر من مرّة إعادة العلاقات مع تل أبيب التي كان قد قطَعها سلفه الراحل هوغو تشافيز.
فعل زعماء وقادة آخرون مثل ذلك، هل هم أكثر "عروبة" منا؟ ... أقر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بأنه شعر بالرعب، إذ "حتى الحرب لها قواعد"، لكن مجلس الأمن بدا عاجزا عن فعل شيء لوقف المجزرة، واستكشاف طريق لوقف النار لسبب واحد، أن الأميركيين ماضون في شقّ طريقهم بين الجثث، وقد أسقطوا بفعلهم هذا كل طروحات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان التي يتشبث بها المظلومون والمخدوعون من بني البشر.
استمرّ العداد في إحصاء حصيلة حرب الإبادة، وفي اليوم المائة سجل أزيد من مائة ألف فلسطيني بين شهيد ومُصاب ومفقود، ولم يتوقّف بعد.
لم يتزحزح الإسرائيليون والأميركيون قيد أنملة عن مسارهم الشيطاني، وإصرارهم على عدم الإصغاء لصوت الشعوب، وواصلوا المضي في شقّ طريقهم بين الجثث. لم تتمكّن الدول العربية من فعل شيء، ولو أرادت لفعلت، لكنها اكتفت بكلمات مواساة وتعاطف، وذلك أضعف الإيمان.
مائة يوم، والعدّاد لم يتوقّف، والإسرائيليون والأميركيون ماضون في شقّ طريقهم بين الجثث.
العراق بين
عبد اللطيف السعدون
ينقل الكاتب الأرجنتيني، ألبرتو مانغويل، عن صديقه الروائي، خورخي لويس بورخيس، أنه كثيرا ما كان يردّد أن "السياسة أكثر الفعاليات البشرية بؤسا"، ولعله بهذه اللمحة عكس تجارب القارّة اللاتينية التي مثّلت في حينه "الحديقة الخلفية" للولايات المتحدة التي استأثرت، في فترات تاريخية معلومة، بكل ما في هذه القارّة من أرض وثروة وبشر، وكانت تنصب لحكم بلدانها من تشاء لضمان مصالحها ونفوذها.
أما نحن فلا نجد اليوم مثالا يدلّل على صواب ما قاله بورخيس أقرب من تجربة العراق التي مثّلت قمّة البؤس في السياسة التي كنا نطمح أن تكون مصداقا لما قرأناه عن "فن إدارة شؤون الدولة". ووقائع عشرين سنة معجونة بالمرارة والمعاناة عرّفتنا بكثير مما كنا نجهل أو نتجاهل.
بعضُ هذا الكثير أن الولايات المتحدة نقلت، عند غزوها البلاد، بعض أصدقائها (اقرأ: بعض عملائها!) من العراقيين ممن اعتادوا العيش في الأزقّة الخلفية لدول الغرب والجوار، وصنعت منهم طبقة سياسية، وسلّمتهم مفاتيح بغداد، وفوّضتهم إدارة شؤون الدولة على النحو الذي تريده. ولم يكن أغلب هؤلاء يفقهون شيئا لا في الإدارة، ولا في السياسة، ولا في شؤون المجتمع، كما لم تكن لديهم أية خبرة أو تجربة تؤهلهم لقيادة بلد مثل العراق.
ولذلك، وعلى مدى أزيد من عشرين سنة، لم يتمكّنوا من تقديم منجز واحد يُحسب لهم. أكثر من ذلك أن المنجزات التي حقّقها العراقيون منذ استقلالهم الأول قبل مائة عام، وحتى الاحتلال، اختفت تدريجيا، ليس اعتباطا ولا مصادفة، وإنما جرى ذلك عن سبق إصرار وترصّد، بلغة رجال القانون. وقد خسر العراقيون من الثروة والأرض والبشر ما لم يخسره شعبٌ من الشعوب في العصر الحديث. وما كان مرسوما بعناية حدث بالفعل، إذ تحوّل العراق إلى "دولة فاشلة" فقدت السيطرة على أراضيها، وشرعنت استخدام القوّة ضد مواطنيها. وفشلت حكوماتها المتتالية في اتخاذ قراراتٍ ذات فعلٍ مؤثّر على أيّما صعيد، كما لم تتمكّن من توفير الخدمات المطلوبة منها، وارتفعت فيها معدّلات الفساد والجريمة، ما أوجد بيئة صالحة لنمو المليشيات والمافيات التي تمكّنت من النفاذ إلى قلب مؤسّسات الدولة، لتأخذ حصّة وازنة في تشكيلة الحكومات، شأنها شان أية أحزاب سياسية مهتمّة بالوصول إلى السلطة لتنفيذ برامج معيّنة. وهذا ما نراه شاخصا أمامنا في "توليفة" حكومة محمد شيّاع السوداني الحالية التي تضمّ وزراء ممثلين لمليشيات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، ومموّلة منه، وهذا يعكس أحد أوجه الهيمنة الإيرانية على القرار العراقي.
والجديد اليوم هو ما طفا على السطح، معطوفا على وجود عشرة آلاف من العساكر الأميركيين في البلاد، مقيمين في قواعد ثابتة لغايات حماية الأمن القومي الأميركي، وتطمين مصالح الولايات المتحدة في المنطقة. ومن مجريات الأحداث، نفهم أن الأميركيين يصرّون على إبقاء هؤلاء العساكر في العراق، فيما تحاول حكومة بغداد التخفيف من وقع ذلك على العراقيين، بالزعم أن ليس لهؤلاء مهمّات قتالية، وواجبهم تقديم المشورة الفنية والتدريب فحسب، وإن عددهم لا يتجاوز بضع مئات، فيما لا يتردّد الأميركيون في بياناتهم عن توصيف المسألة كما هي على أرض الواقع.
واللافت في تداعيات هذه القصة جملة مفارقاتٍ أثارت الاستغراب والسخرية معا، فعندما صعّدت الفصائل من هجماتها على القواعد الاميركية في العراق، على وقع تداعيات حرب غزّة، ظلّت بغداد تنفي علمها بمن وراء هذه الهجمات، وتعد بمتابعة الأمر ومعاقبة الفاعلين. وعندما عمدت واشنطن إلى الانتقام، واغتالت أحد قياديي الفصائل وأصابت آخرين، قالت بغداد إنها ترفض هذا الاعتداء، لكن الأخيرة جدّدت تحذيراتها بأنها ستواصل الردّ على الهجمات، إذا ما تكرّرت، وعبّرت عن تقديرها الدعم الذي قدّمته "جهاتٌ أمنية عراقية". وقد فضحت هذه الإشارة تعاونا، بدرجةٍ ما، بين الأميركيين وجهات أمنية عراقية، ما زاد من حراجة موقف السوداني الذي يبدو أن واشنطن كانت تعوّل عليه كثيرا في التجاوب معها، لكنه رضخ أخيرا لمطلب الفصائل الولائية لتفعيل قرار برلماني سابق بالعمل على إخراج القوات الأميركية. وأعلن عن مواصلة عمل لجنة للحوار مع الجانب الأميركي كانت شكّلتها حكومة عادل عبد المهدي. ومرّة أخرى، تجاهلت واشنطن ذلك، واكتفت بإطلاق تهديداتها بردود فعل أقوى، إذا ما استمرّت الهجمات، وحيث إن ايران متمسّكة بـ "الصبر الاستراتيجي" في مواجهة أميركا، فان الفصائل واصلت الهجمات نيابة عنها، وضربة من هنا، وضربة من هناك. وحكّام بغداد خائفون إلى درجة أنهم لم يسمّوا المسمّيات بأسمائها، إذ ذكروا تسمية "التحالف الدولي" مكان "الولايات المتحدة"، وظلّوا متأرجحين، لا هم قادرون على لجم الفصائل التي أخذت قرار "السلم والحرب" نيابة عن الدولة، ولا هم راغبون بمواجهة أميركا وطرد عساكرها من البلاد، واتخاذ قرار الحسم المطلوب!
ذلك كله هو صورة من صور "سياسة البؤس" و"بؤس السياسة".
تداعيات
الحرب بعيون إسرائيلية
عبد اللطيف السعدون
كيف يفكّر الإسرائيليون بعد "طوفان الأقصى" والحرب الوحشية المجنونة التي شنّها قادتهم على الفلسطينببن؟ ... دعونا نتجاوز ما يقوله أولئك "القادة"، ونتجه إلى قراءة عقل الجمهور العام، عبر ما يكتبه المحلّلون وكتّاب الأعمدة في الصحافة الإسرائيلية الذين كانوا، إلى أمد قريبن يلهجون بأوهام القوة والتفوق، فيما يرون اليوم بأم أعينهم سقوط تلك الأوهام وانهيارها في الواقع المعاش.
يعترف أوري مسغاف في "هآرتس" بتدهور مكانة إسرائيل في العالم، وينحو باللائمة على الدولة التي "تقدّس القتل بلا تمييز فتفقد تفوقها الأخلاقي وعدالة وجودها"، ما تسبّب في "الهزيمة الثانية التي تلحقها بنا حماس، وهي أسوأ من الهزيمة الأولى" في 7 أكتوبر. وفي مقالة أخرى في "هآرتس"، يكتب عاموس بولين إن "تصفية حماس هدفٌ مضلّل، وقد يستغرق سنوات، فضلا عن أنه يطرح تحدّيات جديدة أمام إسرائيل التي لن تعود إلى ما قبل 7 أكتوبر، (...)، والمطلوب تغيير الحكومة، واعتبار ذلك حاجة أمنية، والتنسيق مع الولايات المتحدة حتى تنسحب القوات من غزّة بالتوازي مع تحرير المخطوفين". يدعم هذا الرأي يوآف ليمور في "إسرائيل اليوم"، الذي يكتب: إن نزع قدرات "حماس" يحتاج بضع سنواتٍ كي يمكن أن يقوم حكم آخر في القطاع بأفقٍ مختلف، ويرى أن من الواجب اليوم إيجاد ظروف أفضل لإعادة المخطوفين، والتنسيق مع مصر "التي يهمّها، هي الأخرى، التخلص من حماس". ويقرّ المحلل العسكري في "هآرتس" عاموس هرئيل بأن إسرائيل تواجه "مصيدة استراتيجية" ليست واضحة كيفية الخروج منها، وخصوصا أن "المقاومة شديدة للغاية، وحماس لا تظهر مؤشّرات إلى الاستسلام"، ويخشى هرئيل "إمكانية ظهور منظمّات متطرّفة أخرى في المنطقة تقتدي بحركة حماس، وتتجمّع في حرب واحدة، وتحسم الصراع مع إسرائيل تدريجيا". ويرسم أيال فنتر في "هآرتس" سيناريو افتراضيا ساخرا عن الحال بعد 15 - 20 سنة، حيث يتم التوقيع على "اتفاق تاريخي" تضمنُه دول كبرى، لإقامة "دولة إبراهيم من النهر إلى البحر التي تضم مجموعتين سكانيتين، عرب ويهود، تفرق بينهما كراهية متبادلة"، مضيفا أن إسرائيل "الحالية" ستكون مضطرّة للقبول بهذا الاتفاق، بعدما أطاحت في السابق حلّ الدولتين! ويخلص فنتر إلى أن "إبقاء المشكلة الفلسطينية من دون حل يشبه وضع البطاطا في الفرن لفترة طويلة، وإذا لم يتم إخراجها في الوقت المناسب فسوف تحرق البيت كله". ويصرخ أورلي أزولاي في "يديعوت أحرونوت"، موجها كلامه إلى قادة إسرائيل: "لقد سوّينا غزة بالأرض، وخرّبنا، وجوّعنا، حتى بدت غزة مكانا غير صالح للبشر". ومع ذلك "لن تستطيعوا أن تهزموا فلسطينيا يقفز من نفق إلى آخر حافي القدمين". وفي مقابلة لصحيفة هآرتس معه، قال المؤرّخ الإسرائيلي موشي زيمارمان إن عملية طوفان الأقصى دمّرت إحساس الإسرائيليين بالأمان، كما "كشفت فشل الأيديولوجية الصهيونية"، ووصف الحال الحاضر بأنه "ميؤوس منه، حيث إننا ذاهبون إلى وضع يعيش فيه الشعب اليهودي في حالة من انعدام الأمن التام".
تعكس هذه الانطباعات الجزء الطافي من المشهد الداخلي الإسرائيلي المأزوم، والذي وراءه ما هو أدهى وأمرّ، وهي تمثّل نبض الشارع الإسرائيلي الذي يُدرك تماما أن تصفية المقاومة الفلسطينية وتفكيك حلقاتها أمر صعب، ولا يمكن إنجازه من دون خسائر. أما حكومة اليمين القائمة فتعرف أنها، بمجرّد وقف الحرب، ستتعرّض للانهيار، ورئيسها نفسه نتنياهو سيسقط من دون رحمة، ولذلك يعمد إلى تجاهل كل هذه الأصوات الرافضة للحرب، ولا يرى الحلّ إلا في الإيغال في جريمة الإبادة الموجّهة إلى الشعب الفلسطيني كله، ويعد داعميه باستمرار الحرب شهورا عدّة. وتبرز هنا حقيقة الأزمة التي يعيشها الكيان المغتصب، والتي تتعمّق يوما بعد يوم، وتفرز مضاعفات وتعقيدات على صعيد الآمال التي كان سكّان إسرائيل يلوذون بها كلما شعروا بالمخاطر تحيق بهم.
والسؤال هنا، ألا يمكن لنا، نحن العرب، أن نحوّل الأزمة الإسرائيلية الماثلة إلى "فرصة" لممارسة الضغط على إسرائيل، وعلى راعيتها الولايات المتحدة للوصول إلى حلّ عادل يضمن إنصاف الشعب الفلسطيني ونيْله حقوقه المشروعة التي لم يعد ممكنا الاستمرار في تجاهلها، خصوصا بعدما أعادت عملية طوفان الأقصى القضية الفلسطينية إلى حجمها الطبيعي، وأخذت مكانا لها في اهتمام شرائح واسعة في العالم؟
وإذا كانت الأوضاع الراهنة، إقليميا ودوليا، لا تتيح إنجاز ما يراه الفلسطينيون "حلّا عادلا وشاملا" لهم، فلا أقل أمام العرب من أن يزيدوا من ضغوطهم السياسية والاقتصادية لوقف شلال الدم الذي يتدفق على مدار الساعة، وتلك هي المهمّة الآنية المطلوبة.
في تذكّر وليد مسعود
عبد اللطيف السعدون
نتطلّع لأن تصبح حرب غزّة الماثلة أمامنا اليوم معبرا عريضا على طريق القطع بين زمنين
رحل جبرا إبراهيم جبرا عنا في مثل هذه الأيام من عام 1994، وترك لنا
"البحث عن وليد مسعود" ونحو 30 كتابا آخر بين رواية ونقد وأشعار
وتراجم، إلى جانب لوحاتٍ ورسوم، وأعمال كثيرة أخرى. وفي هذا كله وجدنا
ما يشبه بلاده الأولى فلسطين، وما لا يشبهها، وإذ سعى بعض الأدباء
والمثقفين العراقيين إلى تبني فكرة جمع آثاره في "متحف" يقام في منزله
في شارع الأميرات، شارع الطبقة البغدادية الأرستقراطية، يليق به
وبمكانته المحفوظة في الثقافة العربية، فإن المسعى لم يقدّر له أن
يكتمل لأسباب بعضها عائلي، وبعضها مرتبط بشكليات حكومية، إلى أن جاء
القصف الأميركي للمنزل ليعصف بما تركه الراحل الكبير من ثروة ثقافية
تُذكر وتستعاد.
كان جبرا قد استوحى في رواية "البحث عن وليد مسعود" تجربته الشخصية في
جوانبها الاجتماعية والثقافية والروحية والسياسية معا، وحاول تجسيدَها
في هذه الرواية وفي رواياته الأخرى، بخاصة "البئر الأولى" و"شارع
الأميرات"، وبدا كما لو أن كل رواية تُكمل الأخرى، وعرض لنا، في سردية
متنقلة بين المكان والزمان والأشخاص، تلك السيرة العريضة الحافلة
بوقائعها ومتاهاتها، منذ نزح من بيت لحم، وهو صغير، ومنذ جاب في شبابه
بلادا لم يعرفها، وعاش صراعاتٍ حادّة في فكره وقلبه. وبدت تلك التجربة،
في فرادتها وعنفوانها، موزّعة بين الحب والضياع والهجرة والسعي إلى
العمل من أجل قضية بلاده، ثم التوق لفعل شيءٍ من أجلها، وقد حصل على
فترة استقرار وطمأنينة محسوبة، عندما أقام في بغداد، وتآلف معها،
واختبر مجتمعها الذي مثّل في تلك الفترة تطوّرا مدنيا ناهضا وشفّافا.
وتعرّف، خلال إقامته التي امتدت عقودا، إلى نخبة مثقفي العراق وكتّابه
وشعرائه وفنانيه، حتى أصبح واحدا منهم، صار عراقيا صميميا، كما هو
فلسطيني صميمي.
وفي تقمّصه شخصية وليد مسعود، نجد خيار جبرا واضحا، الوقوف على المسافة
صفر بين رؤيته للمرأة الأنثى الرقيقة كوطن والوطن الأول الذي حمل طموحه
وأحلامه ومشروعه الروائي. وقد كشف لنا عبر عديد من المقاطع الرمزية في
رواياته عن عمق تعلّقه بقضيته. خذ مثلا مقطع ترك "وليد مسعود" سيارته
على طريق بغداد - دمشق الصحراوي، واختفائه في لا مكان، وعدم تمكّن أقرب
الناس إليه، من أصدقائه وحبيباته من ملاحقة أثره. وهنا تبدو رمزية
الاختفاء في الصحراء، وعلى الطريق بين عاصمتين كانتا في حينه تتجاذبان
مشروعا قوميا واحدا، ينظر إلى فلسطين أنها قضيّته المركزية ومحور
فاعليته. وقد برز لاحقا جانب آخر مثلته رمزية الاختفاء، هو رمزية
انقطاع التواصل بين بغداد ودمشق، بما يعنيه من انكفاء المشروع القومي،
وتراجع القضية التي شكّلت مركز اهتمامه ومحور فاعليته.
وثمّة كومة "رمزيات" وألغاز أخرى، عبّرت عنها التهويمات التي بثها وليد
في شريط التسجيل الذي عثر عليه الأصدقاء في سيارته، عكست شخصية
الفلسطيني التائه في الصحراء، لكنه المتمسّك بالأمل في أن يصل إلى ما
يريده يوما ما، وعينه على فلسطين، وتظلّ مدينة بيت لحم في القلب وفي
العقل، فيما تظلّ بغداد على مد النظر، وتحضر الأنثى كما تحضر فلسطين،
كلتاهما وطن. وعلى قاعدة "السرد المراوغ" لا يتردّد وليد في الاستغراق
في الذكريات، معتمدا ليس على تاريخه الشخصي، بل وعلى تاريخ وطنه الأول
أيضا، وأيضا على تاريخ وطنه الأكبر. وهنا نلحظ، في شخصية وليد، تقدّم
الفلسطيني المناضل من أجل قضيته إلى الأمام، فيما يتراجع الشاب العابث
الموسوم بالخدر.
بالحيوية نفسها، تنضح روايات جبرا الأخرى بدقائق وتفصيلات الحياة
الاجتماعية والثقافية الفلسطينية - العربية في فترة قدّر لها أن تشهد
كل إرهاصات التغيير، وأن تكتسب لاحقا وصف "الزمن الجميل" الذي عمّر بين
خمسينيات القرن الراحل ومنتصف سبعينياته، وهو الزمن الأعمق والأغنى بكل
ما فيه ومنه، قبل أن يداهمنا زمن التطبيع والتراجعات المهينة، وعبث
السياسيين، وخطط الترويض، والترهيب، والإذلال.
ولعلّنا مرّة أخرى، نحن الذين عشنا مع "وليد مسعود" آماله وأمانيه،
وصور خيباته، نتطلّع لأن تصبح حرب غزّة الماثلة أمامنا اليوم معبرا
عريضا على طريق القطع بين زمنين. وإذا كانت الميثولوجيا المهدية
تبشّرنا بظهور من "يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما"، فان
التغريبة الفلسطينية المديدة تعلمنا اليوم أن "وليد مسعود" وأشباهه
شرعوا يرجعون من غيباتهم ليحرّروا أرضهم التاريخية من دنس الصهاينة ومن
أرجاسهم، ويقيموا عليها دولتهم.
خطاب السيد...
لزوم ما لا يلزم
عبد اللطيف السعدون
سألت ناشطا فلسطينيا عن رأيه في خطاب أمين عام حزب الله، السيد حسن نصر الله، أخيرا، أجاب: "انتظرنا خطاب السيد من لبنان فجاءنا من إيران". ويبدو أن هذه "التورية" التي انتقاها الناشط، بعناية، تكفي لإعطاء انطباع موضوعي عن مضامين الخطاب الذي انتظره كثيرون على مضض، كي يعرفوا كيف يتحرّك نصر الله في هذه الأيام الصعبة، وعلى أيّ الجانبين يميل، خصوصا وقد سبق إعلام حزب الله الخطاب بجملة فيديوهات صورت مشية السيد المتئدة، والتفاتاته المحسوبة، وحركات يديه، وقلمه الأحمر، وخاتمه الأزرق اللامع، وجعل ذلك كله مريديه وخصومه، على السواء، يضربون أخماسا بأسداس!
ومع أن موقف نصر الله من أحداث غزّة الذي أعلنه في خطابه لم يرق لبعض من كان يريد سقفا أعلى، إلا أن ذلك لم يكن مستغربا من المطلعين على طبيعة العلاقة المبدئية القائمة بين حزب الله و"الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، المبنية على التزام الحزب بمرجعية ولاية الفقيه، وتماهيه مع ما تفرضه "الجمهورية الإسلامية" نفسها باعتبارها الممثلة للولاية من قيود ومواقف في التعامل إقليميا ودوليا، كما لم يكن إعلانه اتّباع سقف "متدرّج أو متدحرج"، بحسب تعبيره، في التعامل مع الحدث سوى تكريس لموقف حكومة طهران التي تمتلك، في الوقت الحاضر، عددا من أوراق اللعبة تريد استثمارها في مواجهة أميركا والغرب بما يفيد مشروعها في المنطقة، وطموحها للحصول على اعترافٍ بدورها قوة إقليمية فاعلة ومؤثرة. ولا أدل على ذلك من اتّباعها صيغة مرنة في تكييف مواقفها المعلنة أخيرا، وما كشف عن "تخادم" بينها وبين الأميركيين على قاعدة "عدم توسيع رقعة الحرب"، وعن رسائل متبادلة عبر وسطاء للتهدئة إلى أن يكتمل "السيناريو" الماثل في غزّة، ومن ذلك ما نقلته "نيوزويك" عن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن تبلّغت بمضمون خطاب نصر الله قبل إلقائه، كذلك ما تردّد عن تقديم إيران عروضا للوساطة بهدف إطلاق سراح أسرى أجانب لدى حركة حماس.
وبالطبع، ما حاول نصر الله فعله أن يجعل من خطابه "حمّال أوجه"، فهو، من ناحيةٍ، يطرح رؤية "براغماتية" للأحداث، محكومة بتداعيات الوضع اللبناني وما يعانيه من انكسارات تستدعي ضبط حركة الجبهة، وما تفرضه ضغوط الخارج العربي والدولي التي، هي الأخرى، تتطلّب نوعا من اعتماد صيغة التنقّل بين المرونة والشدّة. ومن ناحية ثانية، يطلق إشارات مضمرة وصفها هو نفسُه بأنها من قبيل "الغموض البنّاء"، توحي بأن خطواتٍ "عسكرية" في إطار نصرة غزّة قد يقدم عليها في أي وقت. وعلى أي حال، أخذ الخطاب كثيرا من صورة السيّد لدى جمهوره على الأخص، الذين كانوا يوهمون أنفسهم بأنه "صاحب قرار وصانع أحداث". وقد يحتاج في المديين القصير والمتوسط إلى صنع "ضربات" مفاجئة، هنا أو هناك، كي يرمّم تلك الصورة التي أوشكت أن تتداعى، وربما يعمَد إلى تسخين جبهة مزارع شبعا والبلدات اللبنانية المحتلة، بين الفينة والأخرى، وهذا ما لمّح إليه في خطابه. وثمّة جوانب أخرى تتعلّق بتقييمه حركة الأحداث، ومساراتها المستقبلية التي تركها مفتوحة، لأن "ليس هذا وقتها"، ولأن إضفاء نوع من الضبابية على المشهد الماثل في المنطقة قد يوجِد فرصة للبحث عن خياراتٍ أخرى، للتصرّف في حينه، واتخاذ الخطوات التي يجدها متوافقة مع خطط الحزب الاستراتيجية المرسومة وفق توجيهات دولةٍ "ولاية الفقيه".
هناك في الخطاب ما هو لافت أيضا، الرسائل التي وجّهها إلى أكثر من جهة، وسعى من خلالها إلى تبرئة إيران من أي علاقة أو معرفة مسبقة بالعملية التي أقدمت عليها "حماس" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، وتأكيده على استقلالية "فصائل المقاومة" باعتبارها تملك وحدها القرار في ما تفعله، وما تخطّط له، وعلى أن إيران "تتبنى وتدعم وتساند، لكنها لا تمارس أي نوع من الوصاية عليها".
ولافتة أيضا نظرة الإسرائيليين والأميركيين الى الخطاب، والتي اختصرها الباحث الإسرائيلي القريب من مصادر القرار في تل أبيب إيدي كوهين بتغريدته "كان الخطاب عقلانيا، ولم يعلن (نصر الله) الجهاد ضد إسرائيل، كما لم يتجرأ على الانجرار وراء الخطاب الشعبوي".
وبالمختصر المفيد، حافظ حسن نصر الله في خطابه على وتيرة "لزوم ما لا يلزم"، ومضى تاركا مريديه وخصومه في حال انتظار، ولكن ليس كحال انتظارهم قبل الخطاب.
"ادفع دولاراً تقتل عربياً"
عبد اللطيف السعدون
وراء عنوان هذا الكتاب حكاية يرويها مؤلفه الأميركي، الصحافي والباحث في المعهد الآسيوي في نيويورك، لويس غريزوولد، الذي عاش زمن الحرب العربية - الإسرائيلية الأولى عام 1948 التي أدّت إلى النكبة. يقول إن الواقعة التي أثّرت في نفسه آنذاك "أكثر ما يكون التأثير" أنه شاهد في زوايا شوارع مدينة مانهاتن في ولاية نيويورك، حيث كان يقيم، "مكبّرات الصوت، وقد نصبت على السيارات الكبيرة أو على المنابر، وراحت تخور متوسّلة إلى الأميركيين أن يعطوا دولاراً ليقتلوا عربياً. كان صوت إسرائيل قوياً جداً في الولايات الأميركية، أما صوت بلاد العرب فكان صامتاً، وكانت الأنباء والتعليقات الخاصة بحرب فلسطين متحيّزة تحيّزاً كاملاً "لصالح اليهود".
وعندما اطّلع غريزوولد على إعلان يفيد بأنه "كلما قتلت عصابة شتيرن في فلسطين عربياً أقام اليهود عيداً صغيراً في قلوبهم" طفح الكيل عنده، كما يقول، ولم يعُد يطيق صبراً. ولذلك قرّر السفر إلى الشرق الأوسط، كي ينقل إلى الأميركيين والعالم حقيقة ما يجري هناك. وسافر، كما يقول، وهو لا يكاد يعرف من الأحداث التفصيلية التي أدّت إلى اندلاع نار الحرب بين إسرائيل والدول العربية إلا قليلاً، و"فيما عدا القباحة المثيرة التي يكشف عنها الخطباء اليهود في زوايا شوارع نيويورك لم تكن تعتمل في نفسي عصبيّة خاصة".
وفّرت السفينة البطيئة، كما يصفها غريزوولد في رحلتها إلى الشرق الأوسط، الوقت له، كي يراجع ويتأمل تاريخ وجغرافية المنطقة التي هو في طريقه إليها، مستذكراً ما أورده الكتاب المقدّس عن "جنة عدن التي تحدها أربعة أنهار، هي الفرات ودجلة والنيل، ونهر رابع لا يزال مستعصياً على التحديد". ومستعيداً نقاط الإثارة والقوة في هذه المنطقة منذ نشوء المدن السومرية الزاهرة والغنية فيها حتى يصل إلى حقيقة "أن دعوى الصهيونيين بأن ذلك القطر (فلسطين) إنما تستند إلى عهد شفهي خرافي يزعم أن يهوه أعطاه لموسى (...)، وأن تاريخ فلسطين القديم ينصّ، بوضوح لا يحتمل اللبس، على أنه ليس في فلسطين أيّ آثار يهودية ترجع إلى ما قبل العهد الروماني، وأن الزعم أن حائط المبكى بقية من هيكل سليمان، زعم باطل، وأن المسجد الأقصى وقبّة الصخرة وقبّة السلسلة هي وحدها بين آثار فلسطين التي ترقى إلى ما قبل الاحتلال الصليبي للبلاد". واستناداً إلى تلك السرديات المختلقة، حاول اليهود في العصر الحديث إنشاء مستعمرة خاصة بهم في أكثر من مكان من العالم، في كندا، وفي جنوب أفريقيا، وفي جزيرة سورينام الهولندية، وفي غويانا في أميركا الجنوبية، وفي جزيرة في نهر نياغارا في أميركا الشمالية، لكنهم لم يفلحوا.
يعرض الكاتب هنا كيف أن يهودياً نمساوياً اسمه ثيودور هيرتزل قد ابتدع "الفكرة الصهيونية"، مستعيداً ما ذكره أسلافه عن حق مزعوم لليهود في أرض فلسطين، وجاءت رسالة آرثر بلفور رئيس الوزراء البريطاني في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1917 لتكون المنطلق للكارثة التي حلّت بأهل فلسطين. وفي حينها لم يكن فيها أكثر من خمسة آلاف يهودي، لكن أبواب الهجرة فتحت أمام يهود العالم لاستيطانهم في فلسطين بمخطّط مدبّر. وفي حينه، شُكِّلَت عصابات شتيرن وأرغون من اليهود القادمين، التي مارست إرهاباً وضغوطاً شتّى على السكّان العرب بهدف إخراجهم من أرضهم وإحلال جموع اليهود القادمين من أوروبا محلّهم. وقد لعبت السياسات البريطانية في المنطقة في عشرينيات القرن وثلاثينياته دورها في تكريس المزاعم الصهيونية وبلورتها، رغم تعاظم المقاومة العربية للمشاريع الصهيونية وسعيها لضمان إقامة دولة عربية في فلسطين.
ينقل غريزوولد ما شاهده في رحلته إلى المنطقة، وكيف أن "الراديو اليهودي كان يتباهى بتدمير القرى العربية، وذبْح سكانها ذبحاً جماعياً، (..) وأن هذه المجازر لم تكن عفوية، ولكن مبيتة ومدروسة"، ففي دير ياسين مثلاً "أقدمت عصابة الأرغون على ارتكاب مذبحة رهيبة لا أحد يعرف عدد ضحاياها". وفي واحدة من الوقائع "جمع الغزاة خمسة وعشرين امرأة حاملاً، ووضعوهنّ في صفٍّ طويلٍ، ثم أطلقوا عليهن النار، وبقروا بطونهنّ، وقطّعوا الأطفال إرباً إرباً أمام آبائهم، وانتُزعت الحليّ والخواتم من أجساد القتلى، وبُترت أصابع الضحايا الذين صعب انتزاع خواتمهم"!
ومع توثيق مثل هذه المشاهد المأساوية ونقلها إلى العالم، يخلص الكاتب إلى أن ما جرى من وقائع وتداعيات في الحرب العربية الإسرائيلية يؤكّد "أن إسرائيل سرطان أُقحم ظلماً وعدواناً إلى الشرق الأوسط، لكنها لا تستطيع أن تحيا إلى ما لا نهاية على حساب جيرانها، ولا بد لها من أن تموت آخر الأمر، ما دامت لا تمتلك في ذاتها مقوّمات الحياة، وإذا ما سمح لها بالبقاء على قيد الحياة سيكون ذلك أعجوبة شرّيرة".
أحدث كتاب "ادفع دولاراً تقتل عربياً" ضجّة كبيرة عند نشره في الولايات المتحدة في حينه (ترجمة منير البعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، 2000)، وقد عملت المنظّمات الصهيونية في أميركا على جمع نسخ الكتاب من المكتبات وإتلافها.
عندما يُطلب من الفلسطينيين
الخروج من الكرة الأرضية
عبد اللطيف السعدون
لماذا يطلب الإسرائيليون القتلة من الفلسطينيين الخروج من بلادهم والتخلّي عنها، ولماذا يصمت حكّام العالم "المتحضّر" عن إدانة هذا المطلب الشرير الذي يعني سقوط منطق الحضارة الذي يتباهون به، وغياب مبدأ العدالة الذي يزعمون التمسّك به، وماذا سيقول التاريخ عن هذا الذي يحدث؟
أجابنا مرّة عن سؤال كهذا شاعر فلسطين الراحل محمود درويش، قال: "إن التاريخ لن يكون حكما عادلا، لأن التاريخ ليس قاضيا، التاريخ موظّف، وهو في خدمة الأشرار الذين يتسيّدون العالم ويحكمونه". وروى لنا بلسان الفلسطيني المقيم على أرضه، والقابض عليها كما القابض على الجمر، كيف أن "الثلاثي القاتل المدجّج بالسلاح: الأول (أميركا) أباد شعباً في الماضي، كما أباد شعباً وتربة في جنوب شرق آسيا، وفجّر علامة تحضّره الكبرى (القنبلة الذرية) في شوارع العالم، وهو يطالبني بالخروج من حلبة الإنسانية، ومن الكرة الأرضية، بزعم أنني إرهابي. والثاني (أوروبا) الذي ليس من الحكمة أن نذكّره بماضيه، لقد أحرق عشرات الملايين من البشر باسم الحضارة والتمدّن، والآن يتعانق القاتل والضحية وينجبان وليداً جديداً هو الثالث، فماذا ينتج من زواج الإرهاب إلا الإرهاب". يضيف درويش: "جاء الثالث (إسرائيل) المدجّج بالتوراة والسلاح، واقتلعني من جبالي وسهولي ودحرجني من الحضارة إلى الحضيض، هذا الثلاثي يطالبني بالخروج من الكرة الأرضية لأنني إرهابي، وماذا فعل العالم المتحضّر في ساعةٍ متأخّرة من الليل؟ ذهب إلى غرفة النوم ونام!".
يُعيد التاريخ نفسه عند كل منعطفٍ حادّ يقطع زمن الصراع العربي الإسرائيلي الذي تجاوز عقودا سبعة، منذ أقام الإسرائيليون كيانهم العنصري الاستيطاني على أرضٍ ليست لهم على قاعدة "وعد من لا يملك لمن لا يستحقّ"، وها هم اليوم يكشفون عن مطلبهم الشرير مرّة أخرى، إذ يفرضون على أهالي غزّة المنكوبين بحرب إبادة شاملة قتلت منهم، حتى كتابة هذه السطور، أزيد من 2600، وجرحت وأعاقت ما يقرب من عشرة آلاف، أن يختاروا بين أمرين: الخروج أو الموت، وهم يدركون أن الوقت قد حان لبعث الحياة في مشروع "الترانسفير" الذي أطلق في خمسينيات القرن الماضي، وقوبل بالرفض المطلق منذ البداية من الفلسطينيين وكذلك مصر والعرب، والغرض منه تصفية القضية الفلسطينية، ومحوها من الأجندة السياسية الإقليمية والدولية إلى الأبد.
وفي تلافيف المشروع العمل على توطين الفلسطينيين، كل الفلسطينيين، ولو على مراحل، في شبه جزيرة سيناء، أو في أرض أخرى قد تكون صحراء الأنبار التي تفصل بين العراق وسورية والأردن، والتي تغطّي مساحتها ثلث مساحة العراق، وهذا ما كانت طرحته أيضا صفقة القرن الميّتة تاريخيا، والتي سعت إلى إنشاء "وطن بديل" حلّا دائما للصراع العربي - الإسرائيلي الذي شغل العالم طويلا.
يحاول الأميركيون اليوم، ومعهم الغربيون، ترويج فكرة إجلاء أهالي غزّة، وفتح معبر رفح لخروجهم إلى مصر، والزعم إن ذلك ينبغي أن يتحقّق لإنقاذهم وتوفير حياة إنسانية طبيعية لهم، ويقال إن هذا جرى بحثه، مع جملة قضايا أخرى، مثل السعي إلى احتواء الموقف، وعدم اتساع دائرة الصراع، وإمكانية العودة إلى مسار التطبيع، في جولة وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في المنطقة التي شملت إسرائيل وست دول عربية من بينها السعودية ومصر.
وقد تواترت تقارير صحافية عن موافقة أولية لبعض المسؤولين العرب على الأفكار الأميركية المطروحة، بخاصة أن تطبيقها قد يريح أعصابهم من صُداع الرأس الذي يسبّبه لهم استمرار صراخ الفلسطينيين في مواجهة غاصبي أرضهم، وإذا ما انجلى غبار الحرب المحتدمة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ولو بعد حين، فستكون ثمّة فرصةٌ لمناقشة أفكارٍ كهذه في الهواء الطلق، وربما يتم التوافق على "سيناريو" معيّن يضمن إنشاء "كانتون" تتوفر فيه مقوّمات الحياة لمن يوافق من أهالي غزّة على الهجرة، خطوة أولى، وهناك دول على استعدادٍ لضخّ الأموال الكفيلة بإنجاز ذلك، يطرح المحلّل الإسرائيلي القريب من مصادر القرار، إيدي كوهين، إمكانية قبول مصر بتوطين الفلسطينيين في شبه جزيرة سيناء مقابل حذف جميع ديونها الخارجية التي يقدّرها خبراء اقتصاديون بأزيد من 170 مليار دولار.
وبعد، هذه واحدة من المسائل الغائبة عنا اليوم، والتي ستُلقي بظلالها على جملة التحوّلات المتوقّعة في منطقة الشرق الأوسط بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسوف تظلّ الأوضاع الماثلة في حالة سيولة ربما إلى زمن أطول.
رسالة أخيرة إلى
رئيس الوزراء العراقي
أعرف أنك أول رئيس حكومة بعد الغزو الأميركي للعراق لم يغادر بلده، وقد عشتَ سنواته الحلوة والمرّة، وخدمت في أكثر من موقع رسمي، وهي ميزة تجعلك أكثر إدراكا لأوضاع العراق وأحوال العراقيين من أيٍّ من الذين تسنّموا منصب رئاسة الحكومة قبلك، وكانوا قد ارتضوا لأنفسهم الإقامة خارج البلاد، وعاشوا أيامهم يدورون في الأزقّة الخلفية لدول الغرب والجوار، وقد وجدت أميركا فيهم ضالّتها فنقلتهم على ظهور دبّاباتها، وفرضتهم حكّاما علينا، ثم دخلت إيران، ووضعتهم في جيبها، وأحكمت، من خلالهم، هيمنتها على السلطة والمال والقرار، وكانت حصيلة ذلك عشرين عاماً من معاناتنا، وإذلالنا، والضحك على ذقوننا. وعبر ذلك، تم اعتماد مبدأ المحاصصة الطائفية والعرقية في توزيع السلطة والموارد، واستُبيح المال العام، وسادت سلطة المليشيات والجريمة المنظمّة، وزادت أعداد من يعيشون تحت خط الفقر على نحو مريع، وتدهور مستوى التعليم، وانهار النظام الصحّي. والأهم من هذا كله سقطت منظومة القيم الأخلاقية إلى درجة أنه لم يعد هناك رادع اجتماعي يدفع إلى سلوك الطريق السليم.
ليس هذا هو بيت القصيد، ولكنني كنتُ، وغيري من العراقيين، نحتفظ في أعماقنا ببعض حسن الظن بما يجري أمام أعيننا، وإن كان حسن الظن في أيامنا هذه أقرب إلى المعجزة، والظنّ بالشر أسلم، وقد جعلنا الظن الحسن نتطلع، وبقدرٍ محسوبٍ من التفاؤل، إليك، عسى أن تمكّنك الأقدار من سلوك طريق التغيير، وأن تكون لديك القدرة على التصدّي للمشكلات الكبيرة التي ينوء تحت ثقلها شعبُنا بمختلف "مكوّناته"، وهي الكلمة التي اخترعها المهيمنون علينا لزرع الفرقة بين أبناء الشعب الواحد الموحّد الذي لم يعرف طوال عمره التاريخي ما ينال من وحدته، وقد صبر هذا الشعب على كل هذه المكائد، واحتسب الأمر مدّخراً الأجر عند الله، وهو ما دفعنا إلى أن نغضّ الطرف قليلاً عن طبيعة التشكيلة الوزارية التي ولدت معك، والتي لم تختلف لا في الجوهر ولا في المظهر عن سابقاتها.
بقية الظن الحسن، يا دولة الرئيس، تدفعني إلى الكتابة إليك عسى ولعلّ، خصوصاً وقد عبرت لنا عند تسلمك المسؤولية التنفيذية الأولى في الدولة عن "رغبة جادّة في فتح حوار حقيقي وهادف لبدء صفحة جديدة في العمل لخدمة أبناء شعبنا، وتخفيف معاناته بتعزيز الوحدة الوطنية، ونبذ الفرقة، وشطب خطاب الكراهية"، ووعدتنا بإيجاد "حلولٍ للمشكلات والأزمات المتراكمة، وفي مقدّمتها نقص الخدمات، والفقر، والتضخّم، والبطالة"، و"الشروع بحملة وطنية شاملة لمكافحة الفساد"، و"استرداد هيبة الدولة وفرض احترام القانون". ولم تنس أن تعبر لنا عن اعتقادك بأن "الدولة هي صاحبة الحق الشرعي في نشر الأمن وبسط القانون، والذود عن السيادة الوطنية عبر مؤسّساتها العسكرية والأمنية الرسمية". ورغم أننا، ومن خلال تجاربنا المريرة مع من سبقك، ومع شكوكنا في قدرتك على مواجهة سيوف الزعماء المليشياويين وسدنة الدولة العميقة وحيتان المال الكبار، إلا أن بقية الظن الحسن ظلت تحمل لنا بعض الأمل، أو قل جعلتنا "متشائلين"، وأنت تقدّم رِجلاً، وتؤخّر أخرى.
ها قد انتهى العام الأول على وجودك في السلطة، وشرعت في دخول عام ثان. لكني، وأقولها، بصراحة، واحد من المشفقين عليك من أن تفشل في تحقيق وعودك التي أطلقتها في البدء، إننا لم نلمس خطوات جادّة وجريئة باتجاه التغيير المطلوب، بل مرّ العام الأول وأنت تدور في لعبة الصراعات والمناكفات التي أتقنها من جاء قبلك، وظلّ الحال كما كان، وربما بدرجة سوء أكبر، وأمامنا حقائق ووقائع كثيرة حادّة تجعلنا نفقد بقية الظن الحسن شيئاً فشيئاً، وبدأ صبرنا ينفد، إلى درجة أننا، يا دولة الرئيس، لم نعد في وارد انتظار "غودو" الذي يبدو أنه لن يجيء في الحال الحاضر على الأقل!.
وإلا ما الذي يعنيه استمرار السير في الطريق المغلق ذاته الذي لم يأخذنا على مدى أزيد من 20 عاماً سوى إلى مزيد من المآسي والنكبات والحرائق التي حوّلت البلاد إلى "طنجرة ضغط يمكن أن تنفجر في أية لحظة"، على حد وصف باحثة فرنسية أجرت بحثاً استقصائياً عن حالنا التي لم تعد تسرّ صديقاً، ولا حتى عدوّاً.
هذه رسالة أخيرة لك، يا دولة الرئيس، وآخر دعوانا، أن حسبنا الله ونعم الوكيل.
في تذكّر الجميلات
الجزائريات الثلاث
عبد اللطيف السعدون
أمرٌ مثيرٌ حقّا أن تصل إليك صورة جميلة بوحيرد (88 عاما)، وهي راقدة على فراش المرض، وعلى شفتيها ابتسامة عريضة توحي بالأمل والطمأنينة، وكأن المرض لم يُثقل عليها لا قليلا ولا كثيرا، وكانت أتقنت الصمود وتعلّمت المواجهة من الأحداث الكبيرة التي عاشتها، فهي واحدة من جميلات جزائريات ثلاث تركن أحلام المراهقة وراءهن، ونذرْن أنفسهن للثورة، وعشن سنواتٍ طوالا في بوتقة نضال يومي لم يعرفن خلاله كَللا ولا وهنا. وحين انتصرت الثورة، فضلن الانزواء بعيدا وعدم الانخراط بشكل مباشر في عمل السلطة الجديدة، واكتفيْن بممارسة أدوار في الظل، بعدما دبّت الخلافات بين رفاق الأمس، وقد أسكرتهم نشوة النصر الذي جاوزت كلفته مليونا من الشهداء، ومليونا آخر من الجرحى وذوي الإعاقة، وكمّا ثقيلا من الأعباء والمسؤوليات، والمخاطر أيضا.
تعيدك الصورة ستين عاما إلى الوراء، لتستعيد في ذاكرتك المتعبة جميلة بوحيرد الأصل، وهي تتحدث إليك لتوحي لك بالأمل والطمأنينة، وكأن الأعوام الستين التي مرّت لم تنل لا منها ولا منك، وكأن العالم المحيط لم يغير ولم يتغير، ولا تزال كلماتها ترن في الأذن، وكأنك تسمعها لأول مرة: "أشعر وأنا في العراق أنني في بيتي وبين أهلي". كان ذلك في زيارتها بغداد قبل ستين عاما... الزيارة التي اكتسبت معنىً تاريخيا يصعب نسيانه، وكنت أدير حوارا معها لحساب إذاعة بغداد، وقد أقامت بالفعل أياما بين أهلها العراقيين الذين احتفوا بها "أيقونة" ثورة، ورمز تحرّر، وأشاد بها زعيم البلاد آنذاك عبد الكريم قاسم، وأكبر فيها شجاعتها في مواجهة محتلي بلدها.
من حكاياتها، وهي بعد صغيرة تتلقّى الدرس في صفوف مدرسة حي القصبة، وقفتها الجريئة وسط طابور الصباح، حين كان رفاقها يهتفون، كما أمرتهم سلطة المستعمر، أن "أمنا فرنسا"، شقّت جميلة بوحيرد الطابور لتصرخ: "لا... لا... أمنا الجزائر وليست فرنسا"، وكان جزاؤها الطرد من المدرسة.
ومن حكاياتها أنها انضمّت إلى صفوف الثوار، وهي لم تبلغ العشرين، وكلّفت بنقل الرسائل بين قيادة الثورة في الجبل وممثل الثورة في المدينة ياسيف السعدي الذي وضعت السلطة مائة ألف فرنك فرنسي لمن يأتي برأسه. وعندما شعر رجال الأمن بتحرّكاتها طاردوها، وفي آخر مرّة أطلقوا عليها النار فأصابوها، وألقوا القبض عليها، وتعرّضت للاعتقال والتعذيب، وحكم عليها بعقوبة الإعدام، ثم أطلق سراحها بموجب اتفاقيات إيفيان التي مهّدت لحصول الجزائر على استقلالها.
وفي تذكّر جميلة بوحيرد نتذكر معها جميلتين أخريين، جميلة بوباشا التي وهبت نفسها للثورة، فحملت القنابل بين حيّ وحي، ونجحت في تفجير مركز لجند الاحتلال، ومقهى اعتادوا ارتياده، حتى ضُبطت وهي متلبّسة بحمل قنبلة، بِنيّة وضعها في موقع آخر، وأقرّت بأنها فعلت ما فعلته لأنها تريد الحرية لبلادها، لكنها لم تُفصح عن أسماء رفاقها الناشطين معها، وعذّبت تعذيبا وحشياً، وتعرّضت للاغتصاب، ثم حكم عليها بالإعدام، ونالت حريتها بعد أن أقرّت فرنسا بحق الشعب الجزائري بالحصول على استقلاله. وجاء اعتراف الرئيس إيمانويل ماكرون بما فعله العسكر الفرنسيون معها نوعاً من الاعتذار للجزائريين لكنه لم يكن كافيا للصفح والنسيان، والتاريخ لا يطوي صفحاته على مغفرة.
الثالثة جميلة بوعزّة، نفّذت عمليات فدائية عديدة، تعرّضت بعدها للاعتقال والتعذيب، وسجلت مرّة معاناتها: "أصبحت عاجزة عن المشي لكثرة ما تحمّلته من عذاب، كانوا يلصقون الأسلاك الكهربائية على مناطق مختلفة في جسدي وأنا عارية، ومعلقة من يدي، وكنت أرتعش وأهتزّ جرّاء التعذيب الوحشي الذي عانيته". وألقي القبض عليها، وحُكمت، هي الأخرى، بالإعدام ثم أفرج عنها.
في تذكّر الجميلات الجزائريات الثلاث، نذكُر بالخير كيف وقف العالم معهن بمثقّفيه وأدبائه وقنانيه الذين نظّموا حملات احتجاج من أجل فكّ أسرهن. قال سارتر "التعذيب الوحشي الذي مارسه جنود فرنسا يكتسح العصر كله... علينا أن نؤازر الجزائريين في نضالهم من أجل تحرير بلادهم، وكي نرفع وصمة العار عن فرنسا". وكتبت رفيقة عمره سيمون دي بوفوار مندّدة، وكذلك فعلت الكاتبة والمحامية جيزيل حليمي والروائية فرانسواز ساغان وغيرهما، كما جسّد بيكاسو ما تعرضت له الجميلات الثلاث من تعذيب وحشي في لوحة له اشتهرت في ما بعد. وعبّرت قيادات عالمية، مثل الرئيس الأميركي جون كينيدي والزعيم الصيني ماو تسي تونغ، عن مشاعر مساندة وتعاطف.
في النهاية، انتصرت الجميلات الجزائريات الثلاث، وتحرّرت الجزائر، لكنّ العار ظل يلاحق فرنسا.
عن "امرأة حديدية"
تحكُم بغداد
عبد اللطيف السعدون
يصفها عارفوها بأنها "امرأة حديدية"، جريئة وصريحة، ومثيرة للجدل، تمتلك خبرات وتجارب أزيد من 40 عاما في أكثر من ميدان من ميادين الخدمة العامة قلما امتلكتها امرأة أخرى، فهي محلّلة متخصّصة في وكالة المخابرات المركزية، وخبيرة في شؤون الشرق الأوسط، ومؤسّسة لمركز الشرق الأدنى للدراسات الاستراتيجية في جامعة الدفاع الوطني، ونائبة المنسّق الرئيسي لمكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية، ومديرة قسم الشراكة الأميركية الشرق أوسطية، والمشرفة على البرنامج الأميركي لبناء القدرات لمكافحة الإرهاب في المنطقة، وسفيرة مهمّات خاصة، وقد أهّلتها تلك الخبرات والتجارب ليختارها الرئيس جو بايدن لتمثيل بلاده في بلد مثل العراق، ينام أهلُه على نار، ويصحون على نار. ومهمّتها الخاصة، هذه المرّة، مواجهة نشاط المليشيات المسلّحة المرتبطة بطهران التي تسعى إلى فرض سيطرتها على مفاصل الدولة في بغداد والتحكّم في قراراتها.
ألينا رومانوسكي، قبل ذلك وبعده، امرأة علاقات عامة، استطاعت، وفي فترة قصيرة، أن تبني علاقاتٍ متينةً مع رجال السلطة في بغداد وقادة الأحزاب والكتل، وأن تدخُل مكاتبهم متى تشاء، وأن تناقشهم في شؤون بلادهم، وحتى أن تفرض عليهم قناعاتها النابعة من مصالح بلادها، وحاجات أمنها القومي، وهي لا تتردّد في طرح آرائها في الميزانية، والانتخابات، والأوضاع الأمنية، والتشريعات المقترحة، وعلاقات العراق مع الدول. ولا يكاد يمرّ يوم من دون أن تكون لها زيارة لهذا المسؤول الكبير أو ذاك، وقد اتسعت دائرة علاقاتها لتشمل شيوخ عشائر ورجال دين وممثلي منظمات مدنيّة. وليس في وسع أحد من المسؤولين أن يرفض مقابلتها أو يعترض على تخطّيها مهمّاتها التي يقيّدها منصبها الدبلوماسي، وقد اعتادوا أن يشتموها في مجالسهم الخاصة، ويندّدوا بتدخلاتها في الشؤون العراقية، لكنهم يرحّبون بها عندما تلتقيهم، يأخذونها بالأحضان، ويتودّدون إليها، ويسعون إلى كسب رضاها دائما، لأنهم يعرفون أنها بكلمةٍ منها تستطيع أن تعيدهم كما كانوا!
ورومانوسكي، في مسلكها هذا، تذكّر العراقيين بالدور الذي لعبته "الخاتون" مس بيل، إبّان عملها مستشارة للمندوب السامي البريطاني في العراق، السير بركسي كوكس، في عشرينيات القرن الراحل، حيث ساهمت مساهمة فعالة في وضع اللبنات الأولى للدولة الوطنية العراقية، حتى وصفت بأنها "صانعة ملوك". ومع اختلاف المراحل والتفاصيل، تلعب رومانوسكي، هي الأخرى، اليوم الدور نفسه. وضمن خططها الحالية، كما يشاع في المجالس البغدادية، التحضير لتغيير في المواقع السياسية العراقية العليا بما يحقّق رحيل شخصيات سياسية انتهت صلاحية استخدامها، وإحلال شخصيات قابعة في الظلّ محلها!
ولا تتوقف رومانوسكي عن إطلاق "تغريداتها" التي توثق نشاطاتها الميدانية، ولقاءاتها بالمسؤولين، في شهر أغسطس/ آب المنصرم وحده التقت برئيس الحكومة، ورئيس القضاء، ورئيس البرلمان، ووزيري الدفاع والنفط، وكذلك نوري المالكي وهادي العامري وعمّار الحكيم، كما اجتمعت بممثلي البنك الدولي، واستضافت 80 من رجال الأعمال العراقيين، والتقت سفيري الكويت والجزائر، إضافة الى ممثلي منظمّات مدنية. وفي كل هذه اللقاءات والاجتماعات، كانت "الشراكة الأميركية العراقية" حاضرة. وهي لا تكتم عمن تقابلهم وجهات نظرها في "ضرورة إيجاد حلول لمستقبل أفضل لجميع العراقيين، وأهمية وجود عراق مستقل في مجال الطاقة غير معرض لقرارات خفض إمدادات الغاز التعسّفية (من جانب إيران) .. وستساعد التكنولوجيا الأميركية في القضاء على سرقة الكهرباء .. وأهمية إجراء انتخابات مجالس المحافظات .. وضرورة سيادة القانون" ... إلخ.
ولا تنسى رومانوسكي أن تفاخر بعلاقة بلادها بـ 270 منظمة مجتمع مدني عراقية (!)، وأن تعلمنا أن بلادها قدمت للعراق 3.4 مليار دولار خلال العقد الأخير لمعالجة واحدة من أخطر قضايانا الماثلة، وهي قضية النازحين، (لا أحد من العراقيين يعرف أين استقرّت تلك المليارات وكيف؟).
بالمختصر المفيد، لا تنبع قوة ألينا رومانوسكي، وقدرتها على التحكّم في سياسات بغداد وقراراتها فقط من الصلاحيات الممنوحة لها من حكومة بلادها، وإنما أيضا من ضعف الحكومات العراقية المتتالية، والهوان الذي يشعُر به المسؤولون العراقيون تجاهها، والإذلال الذي يتعرّضون له منها.
يخيّل لمن يتابع ما تكتبه وما تقوله أنها معنيةٌ بالشؤون العراقية، كما لو كان العراق موطنها الأول، ولا تريد لأحد أن يستأثر به غيرها، ولا ينافسها أحدٌ من السفراء الأجانب العاملين في بغداد سوى سفير إيران، محمد كاظم آل صادق، الضابط في الحرس الثوري، والمدرَج اسمُه على لائحة العقوبات الأميركية، والذي عمل مساعدا لسفير إيران السابق في بغداد أزيد من سنتين قبل أن يصبح سفيرا، وقد اعتاد صادق أن يلتقي المسؤولين العراقيين دائما لينقل إليهم "وصايا" حكومته التي هي بمثابة أوامر.
وهكذا، تخضع سياسات حكومة بغداد لإرادة سفيرين أجنبيين يعملان كما لو كانا "مندوبيْن ساميين" عن حكومتيهما، ولا يمرّ أي أمرٍ مهم من دون أن يكون لهما رأي فيه، هذا بالطبع هو حصيلة احتلالين تعرّضت لهما دولة العراق الوطنية، لا أقسى منهما ولا أمرّ!
عراقيون بين طلب
الموت أو انتظار غودو
عبد اللطيف السعدون
حاول مهندس عراقي شاب (29 عاماً)، الانتحار بتناوله كومة حبوب طبّية، وقد سقط إثر ذلك على الأرض فاقداً الوعي. ولحسن حظه عاجلته أسرته بنقله الى المستشفى وإنقاذه، وأقرّ بأنه اختار الموت بغرض إنهاء معاناته التي لم يجد لها حلاً، فقد تخرّج من الجامعة مهندساً، وكان يأمل بأن يدخل سوق العمل بعد تخرّجه، لكنّه فشل في تحقيق ما كان يأمله، واكتشف أنّ الأبواب مغلقة في وجهه، ولم يجد بداً من التفكير في الانتحار. وقد أثارتني عبارته الأخيرة: "حتى ملك الموت تخلّى عني وتركني".
تحمل هذه الحكاية قدراً مهولاً من المرارة، فهي ليست من نمط الحكايات المثيرة التي نُغمض عيوننا عنها لأنّها تكدّر صفو جلساتنا، أو نمر عليها مرور الكرام ثم ننصرف إلى اهتماماتنا اليومية وكأن شيئاً لم يكن، وهي أيضاً ليست واقعة متفرّدة معزولة، فمثل هذا المهندس الشاب في عراق اليوم آلاف الخرّيجين الشباب الذين يقفون على حافّة اليأس، باحثين عن الحدّ الأدنى من مقوّمات العيش في بلدٍ وهبته الطبيعة من الثروات ما يؤهّله لأن يكون من أسعد بلدان الله، لكنها نكبته، في المقابل، بحفنةٍ من السرّاق والأفاقين والقتلة الذين تواطأوا مع الأجنبي على سرقة ثرواته واغتيال حقّه في العيش بكرامة وإباء.
تحيلنا هذه الحكاية أيضاً إلى ما يرشح من تقارير وإحصائيات، بعضها صادر عن مراكز علمية رصينة، وحتى عن جهاتٍ حكوميةٍ معلومة، تفيد بأنّ ظاهرة طلب الموت هذه لم تعد تقتصر على هذه الفئة العمرية أو تلك، وإنما شملت نساء ورجالاً من مختلف الأعمار، وتؤكّد تصاعد أرقام طالبي الموت إلى درجة اعتبارها خطراً على المجتمع العراقي على نحو لم يكن مألوفاً. وكان تقرير رسمي قد أحصى 13 واقعة انتحار فقط في العام الذي سبق الاحتلال (2002)، فيما تصاعد العدد على نحو مريع بعد ذلك. وحسب وكيل وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، بلغ عدد وقائع الانتحار 376 في عام 2015. وظل العدد يكبر باطراد حتى بلغ 772 حالة في 2021. وينبه الخبير الأمني المختصّ رياض هاني بهار، في بحث منفصل، إلى أنّ عدد وقائع الانتحار بلغ ذروته في العام الماضي (2022)، إذ تم تسجيل 1073 واقعة، عدا تلك التي لم يجر الإبلاغ عنها لسببٍ أو لآخر.
تعترف اللجنة القانونية في البرلمان بأنّ "التدهور الأمني والاقتصادي والتفكّك الأسري وتعاطي المخدّرات عوامل ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالانتحار". وبحكم قاطع لم تشأ اللجنة أن تصل إليه، النظام السياسي الهجين الذي ولد بعد الاحتلال، وامتد أكثر من 20 عاماً، هو المسؤول الأول والأخير عن هذه الظاهرة، وسياسات هذا النظام وممارساته على مختلف الأصعدة هي التي ضاعفت حجم الظاهرة وكرّستها معلماً ثابتاً للمجتمع العراقي لا ينكره اثنان.
والذين فكّروا ويفكّرون بالانتحار كان النظام نفسه قد قتلهم مرّات قبل أن يقدموا على طلب "رصاصة الرحمة" التي تكفل إنهاء معاناتهم المديدة من الفقر، أو الجوع، أو المرض، أو بسبب حرمانهم من حقوقهم الإنسانية التي كفلتها لهم كلّ الشرائع، وإصرار حكّامهم على إذلالهم واغتيال طموحاتهم وتطلعاتهم.
على النقيض من ذلك، نرى عشرات الألوف ممن استمرأوا حياة الذلّ بعدما أغرقهم النظام بدعاوى انتظار غودو الذي يجيء ولا يجيء، وتراهم يزحفون على ركبهم خانعين كي ينالوا مرضاة مرجعياتهم القابضة على عقولهم، وهم يهتفون "هيهات منّا الذلّة"، ولا يدركون أنهم بأفعالهم هذه يشرعنون الذلّة الأبدية لنفوسهم، ويمنحون النظام الذي ظلمهم ونهب ثرواتهم وسلب حقوقهم وعمل على تجهيلهم شهادة عفو ومغفرة، ويطيلون في عمره. وقد وقع هؤلاء، بحكم وضع التديّن الزائف المحيط بهم، في خطيئة الانحناء أمام ضربات السلطة، وربما التواطؤ مع ارتكاباتها على نحو مفزع حقّق لقادة المليشيات وزعماء المافيات الهيمنة على الثروة والمال والقرار، وبما يخدم نظام "ولاية الفقيه" الذي يمنحهم السند الكفيل بحمايتهم مهما ارتكبوا من أفعال شرّيرة ضد أبناء جلدتهم.
وسط هذه التناقضات الصارخة يتسع لدى المواطنين العاديين الشعور بالإحباط وخيبة الأمل جرّاء كل الأساطير والأكاذيب والولاءات الشريرة، وتنعدم لديهم الثقة بالطبقة السياسية الحاكمة وبما تعدهم به من ديمقراطيةٍ وانتخابات ومجالس وأحزاب، حتى باتت عملية تجذير وعيهم على الظلم الذي يحيق بهم مسألة دونها خرط القتاد، وتلك هي أم المصائب التي يمكن أن تواجه بلدا ما.
عن بلاد النيجر
حيث "الأشياء تتداعى"
عبد اللطيف السعدون
ربما مثّلت رواية الكاتب النيجيري تشينوا أتشيبيي "الأشياء تتداعى"، التي نشرها قبل سبعة عقود، نبوءة لواقع حالٍ سوف يشكّل مجتمع النيجر ومجتمعات دول أفريقية أخرى خاضت صراعا بين ماضيها الموغل في الأساطير والرؤى الغيبية، وبين أنماط الحداثة التي جاء بها الغرب، وبخاصة ما تعلق بتجربة بلاده في العقود اللاحقة التي شهدت سلسلة من الانقلابات العسكرية التي بشّرت بالتغيير، وبإطلاق طاقات الشعب وإمكاناته، وتحديث بنية البلاد الاجتماعية والاقتصادية، لكن مآلاتها لم تؤدِّ سوى إلى سيطرة العسكر على السلطة والمال والقرار، كعادتهم في كل بلاد الله، وإلى إبقاء الأوضاع على ما هي عليه، إن لم يكن قد أصابها التردّي والتخلف أكثر مما كان. وقد أوقف الانقلاب الذي استجدّ أخيرا تطوّر آخر تجربة لحكم مدني شهدته النيجر على عهد الرئيس محمد بازوم الذي أسقطه العسكريون، واتهموه بالخيانة العظمى، واحتجزوه.
نالت بلاد النيجر استقلالها في مطلع ستينيات القرن الراحل، إلا أنها لم تخرُج عن دائرة الهيمنة الغربية، إذ تقيم فرنسا وبريطانيا قواعد عسكرية فيها إلى جانب قوات من أقطار غربية أخرى تعمل هناك تحت راية مواجهة الإرهاب، وبقي اقتصادها نهبا للاحتكارات الأجنبية، حيث تمتلك سادس أكبر احتياطي عالمي من اليورانيوم إلى جانب الذهب والنفط والحديد والفوسفات ومعادن أخرى، وهذا كله أوجد نوعا من التسابق والمنافسة عليها من القوى الكبرى، وحتى داخل المعسكر الغربي نفسه، كما فتح شهية روسيا والصين اللتين أدخلتا منطقة الساحل الأفريقي في أجندتهما في وقت متأخّر.
اتخذ تحرّك روسيا شكلا نشيطا، إذ عقدت في بطرسبورغ قمّة مع الزعماء الأفارقة، هي الثانية بعد قمة سوتشي عام 2019، حضرها رؤساء ووزراء من أكثر من 50 دولة أفريقية، كان اللافت فيها اهتمام الرئيس فلاديمير بوتين نفسه، رغم انشغالاته بحربه (المقدّسة) في أوكرانيا، في إطلاق سلسلة من المبادرات: إنشاء ممرّات لوجستية ومراكز للأغذية والأسمدة، وعروض في مجالات السلاح والطاقة، والوعد بتقديم مساعدات مالية، وإعادة فتح سفارات كانت قد أغلقت.
سعت الصين أيضا إلى تعزيز شراكتها مع دول القارّة، بخاصة في مجالات الغذاء والأمن والتكنولوجيا، وأقامت في بلاد النيجر بالذات مشاريع في حقول الزراعة والتعدين والنفط، وعقدت اتفاقا على المساهمة في استخراج اليورانيوم واستثماره هناك.
انطلاقا من هذه الخلفية، وجدت الدولتان (الصين وروسيا) في انقلاب النيجر ما يحقق طموحهما في توسيع نفوذهما، لكنهما تحفظتا في إبداء موقفٍ مرحّب في انتظار ما تكشف عنه الأحداث، واكتفتا بالدعوة إلى الحوار وحلّ الخلافات سلميا. وبالتأكيد، لم تغب عن عيونهما مشاهد التظاهرات الداعية إلى خروج الفرنسيين من البلاد والإشادة بروسيا. في المقابل، ليس ثمّة وضوح لمبلغ تعاطف الانقلابيين مع روسيا، أو مع الصين أيضا، لكن ما هو واضح غضبهم من القوات الفرنسية التي قالوا إنها أطلقت سراح إرهابيين متشدّدين بهدف زعزعة الاستقرار في البلاد.
هناك أيضا المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) التي قالت إنها تعمل على تفعيل القوة العسكرية الاحتياطية التابعة لها للتدخّل. ولكن لا يبدو الأمر سهلا وسط اعتراض بعض دول المجموعة التي تفضّل حلا دبلوماسيا، كما لا يبدو ثمّة خطّة لتدخل جنود القاعدة العسكرية الفرنسية في البلاد، والذين لا يملكون تفويضا من حكومتهم بالتدخّل، وقد يسبّب تدخّلهم، إن حصل، مشكلة جديدة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الغارق بالمشكلات إلى أذنيه. والأميركيون هم أيضا ليسوا في وارد اتّخاذ خطوة غير محسوبة، نظرا إلى طبيعة التداعيات التي يمكن أن تنشأ عنها على المستوى الدولي، ويفضّلون الانتظار.
يحدث هذا كله، والخوف من أن تتداعى الأشياء ليس في بلاد النيجر فحسب، إنما في بلاد الساحل الغربي، وحتى في القارّة الأفريقية كلها، والخطورة أن تسقط قطع الدومينو واحدةً بعد الأخرى بفعل فاعل من الخارج، لتغرق القارّة في لعبة الانقلابات من جديد، وثمّة قول معروف لزعيم أفريقي إن انقلابا في أي بلد من بلدان القارّة يلد انقلابا مماثلاً في بلد أفريقي آخر.
وهكذا يعود إلى الذاكرة عنوان رواية تشينوا أتشيبي "الأشياء تتداعى" الذي استوحاه من قصيدة للشاعر الإنكليزي ويليام ييتس: "الصقر يحوقل، يحوقل في الدائرة الواسعة، ولا يصغي لسيده، والأشياء تتداعى، والمركز لا يصمد". ... وسيبقى الحال كذلك في بلاد النيجر، وكذا في بلاد الساحل الأفريقي ربما إلى وقت أطول.
العراق والكويت...
إرث مزروع بالألغام
عبد اللطيف السعدون
يروي سياسي عراقي مخضرم أنّ خلافاً نشب مرّة بين مفاوضين عراقيين ومفاوضين كويتيين بشأن مسائل الحدود، وعندما احتدّ النقاش انبرى مفاوض كويتي ليقول للعراقيين: "نضع ثلاثين مليون دولار في حقيبة، وينتهي الأمر"! يضيف السياسي العراقي أنّ الكويتيين وضعوا، في مرحلة لاحقة، ملايين الدولارات في أكياس من "الورق المقوّى" إمعاناً في الإذلال، وسلموها بهدوء ودونما ضجيج، لكنّ الأمر لم ينتهِ.
صحّت هذه الرواية أو لم تصحّ، فإنّ سجالات حادّة ظهرت الأسبوع الماضي على مواقع التواصل بين عراقيين وكويتيين، تخصّ العلاقة بين البلديْن الجاريْن، وتثير وقائع وأحداثاً بعضها مرّ، والذي أطلق شرارة هذا الإرث المزروع بالألغام قول وزير خارجية الكويت، سالم عبد الله الصباح، في نهاية زيارته أخيراً العراق، إنّ بلاده ستتسلم مدينة أم قصر خلال أيام. وقدّم "الشكر بشكل خاص" إلى محافظ البصرة أسعد العيداني. والمثير هنا "الصيغة" التي حملها التصريح، والتي تفصح عن دلالات "مقصودة" على ما يبدو، إذ حدّد الوزير "أم قصر" بالاسم، وشكر المحافظ باعتباره طرفاً فاعلاً في "الصفقة"، وأطلق تصريحه هذا في ذكرى "غزوة" الكويت التي عُدّت واحدةً من أكبر خطايا النظام السابق، إذ زرعت لغماً آخر في إرث العلاقة الإشكالية بين البلدين، والتي ترجع إلى أزيد من قرنين، عندما أصبحت الكويت تحت الحكم العثماني، وتابعة لولاية البصرة في النصف الثاني من القرن الثامن عشر.
وقد سعت بريطانيا عند تأسيس الحكم الوطني في العراق في عشرينيات القرن الراحل إلى دقّ إسفين بين الدولة الجديدة والكويت، بوحي من مصالحها في السيطرة على المنطقة، وعبّر عن هذا الموقف صراحة وزير الدولة البريطاني لشؤون المستعمرات، اللورد باسفيلد، بإشارته اللافتة إلى أنّ "إبقاء الكويت ضمن العراق سيؤدّي إلى إضعاف النفوذ البريطاني في المنطقة". لكنّ العراق لم يتوقّف عن مساعيه لضم الكويت إليه، وجاءت دعوة الملك غازي انطلاقاً من ذلك. ويقال إنّ جهة ما دبّرت مقتله على خلفية موقفه هذا الذي يعني توجيه ضربة للمخطّطات البريطانية. وسنرى في ما بعد نوري السعيد يسعى إلى إدخال الكويت طرفاً في "الاتحاد العربي" الذي ضم العراق والأردن، لكنّ انقلاب/ ثورة 14 تموز 1958 في العراق أعاد العلاقة الإشكالية إلى نقطة الصفر.
وعند حصول الكويت على استقلالها في مطلع الستينيات، استجدّت حالةٌ أقرب ما تكون إلى حالة "وضع راهن" ترتّب نوعاً من الالتزامات، سواء على الدولة الجديدة أو على الدول المجاورة. ولذلك اعتبرت خطوة عبد الكريم قاسم في إعلانه الكويت قضاءً تابعاً للواء البصرة، وتعيينه أمير الكويت قائممقاماً له، خطوة غير مقبولة من المجتمع الدولي، وهدّدت بريطانيا بالتدخل العسكري لحماية استقلال الكويت، ما دفع قاسم إلى التراجع، وما لبث العراق بعد سقوط قاسم ووصول البعثيين إلى السلطة أن اعترف باستقلال الكويت، وأقام معها علاقات دبلوماسية كاملة.
عند هذا المنعطف، فرض "الوضع الراهن" حالة هدوء على جبهة الحدود بين البلدين الجارين اللذين توافقا على أسس الجيرة والأخوة والمصالح المشتركة، وهذا لا ينفي أنّ الخلافات ظلت تطل برأسها بين حين وآخر، لكنّها كانت سرعان ما تُطوى وتتراجع إلى الخلف. وسنجد في نهاية الثمانينيات أنّ صدّام حسين قرأ "الوضع الراهن" قراءة خاطئة، ولم يحسِب حساباً للمتغيرات الدولية والإقليمية. ولعلّه نسي "إعلانه القومي" في رفض استخدام السلاح بين دولة عربية وأخرى. وهكذا أنشأ بإقدامه على غزو الكويت وضعاً جديداً، وزرع لغماً آخر في إرث العلاقة بين البلدين الجارين قد لا يمكن محو آثاره من ذاكرة الكويتيين إلى أمد طويل. ويبدو أنّ الكويت أرادت، بعد استعادة سيادتها، أن تنتقم من العراق جرّاء الجرح الذي سبّبه لها، باستحواذها على أراضٍ وآبار بترول ونقاط استراتيجية عراقية، وتحويلها ملكيّتها مستعينة بقرارات ظالمة أقرّها مجلس الأمن ضد العراق في أعقاب الغزو، واتّبعت في ذلك أسلوب دفع "الرشاوى" إلى شخصيات عراقية نافذة مقابل قبولها بما تريده الكويت، وآخر ما تردّدت نية الاستحواذ عليه مدينة أم قصر العراقية.
وهكذا يكتشف العراقيون أنّ حكّامهم الذين جاء بهم الاحتلال، ولا يملكون الشرعية لعقد اتفاقات لمنح آخرين ما ليس لهم حقّ فيه، قد تواطأوا على فعل ذلك، مضيفين بأفعالهم المشبوهة هذه لغماً آخر إلى إرث العلاقة الإشكالية مع الكويت، وهو أمر لا يريده العقلاء أن يحدث.
طقوس عاشوراء
بعيون غربية
عبد اللطيف السعدون
للتاريخ سطوة غير منظورة، نلجأ إليه كلما أعيتنا الحيل في قراءة ما يدور من حولنا، وفي تشخيص ما يعتورنا من مطبّات وأخطاء. نلوذ به، نستقرئه، نتعلّم منه الدروس، ونستقي منه العبر، وقد نجسّد بعض أحداثه في طقوسٍ بهدف أن نخلق منها حياة جديدة تمنحنا الرضا عن أنفسنا، والرغبة في أن نكون كما كان عليه آباؤنا. لكن يحدُث أن تتملّكنا تلك الطقوس إلى درجة أننا نمارسها من دون أن نتفحص جدواها، وحتى أننا قد لا نجد تبريراً نقنع به أنفسنا في ممارستنا لها.
هذا ما نجده ماثلاً أمامنا في طقوس عاشوراء التي لم تعد احتفاء مهيباً يليق بواقعة استشهاد الحسين بن علي بن أبي طالب المأساوية المفعمة بالدم، بأيدي خصومه الذين واجهوه وهو على مشارف مدينة كربلاء إثر قدومه إليها من مكّة بنية مبايعته خليفة للمسلمين، وإنما تحوّلت إلى ممارسات تثير الاستهجان، مثل اللطم على الصدور، أو ضرب الرأس بآلة (الطبر) الحادّة التي تشبه الفأس، أو جلد الظهر بسلسلة حديدية، وايهام النفس بأن هذه الممارسات واجبٌ ديني، أو على الأقل اعتبارها تعبيراً عن حالة حزن وألم. ولا يقرّ عديدون من مراجع الشيعة هذه الممارسات، بل يعتبرونها خروجاً على العقيدة، لكنهم لا يحثون أتباعهم على التخلي عنها، لأنّ ذلك قد يجعلهم يخسرون ولاءهم، كما يخسرون المنافع والامتيازات التي يحصلون عليها.
يذكر توماس لييل، الضابط البريطاني الذي عمل في الإدارة المدنية التي أقامها الإنكليز في العراق بعد الحرب العالمية الأولى، أنه سأل المرجع الأعلى للشيعة في حينه، كاظم اليزدي، في جلسة خاصة جمعت بينهما عن السر في عدم توجيه المراجع أتباعهم بعدم اتباع هذه السلوكيات. أجابه المرجع بأنه يفقد السيطرة على هؤلاء الناس في مثل هذه الأمور، ولا يستطيع كبح جماحهم، مؤكّداً أنّ "الإمساك بموجات البحر أسهل من التأثير على عقول هؤلاء السذّج الذين يمتلكون قناعة ذاتية في أنّ تلك السلوكيات البدائية تمثل طاعة لله، ويصبح الكفّ عنها عصياناً له" وهذا، في ما يبدو، ما تريده "المراجع" منهم.
ويقول لييل الذي قدّر له أن يشهد تلك الطقوس إنّ كثيرين يعتقدون أنّ ممارسي تلك الطقوس إنما يبتغون الحصول على المغفرة عن الخطايا التي ارتكبوها في حياتهم، وهذا يفسّر الرغبة لدى أفراد سيئين كثيرين ليأخذوا حصتهم في عملية التعذيب الجسدي وجلد الذات تكفيراً عن خطاياهم. ومن الناحية السيكولوجية، تتصاعد مشاعر أولئك الناس حدّة إلى أعلى درجة يمكنهم بلوغها، وقد يصبحون أكثر اهتياجاً مع بلوغ هذه الطقوس قمتها في اليوم العاشر، ويظهرون حماساً وحشياً ومتعة في التسابق على ممارستها والانغماس فيها. ولاحظ لييل أنّ العاملين في دوائر الحكومة أنفسهم يسعون إلى الحصول على إجازة من العمل لتتسنى لهم المشاركة في تلك الطقوس التي تبدو للرائي أنّها تمثل القناعة لدى المشارك في أنّها ستمحو ذنوبه، وأنّه سوف ينال المغفرة عنها.
يضيف لييل الذي كرّس فصلاً خاصاً في مذكّراته "دخائل العراق .. عين بريطانية على خفايا عراقية" (دار أزمنة للنشر والتوزيع، عمّان، 2018) لهذه الطقوس أنّ الغربيين قد يتصوّرون أنّ تلك ليست سوى مشاهد مسرحية مفتعلة، لا تسبب ألماً حقيقياً، لكنهم يجهلون أو يتجاهلون أنّ عملية "التعذيب الذاتي" هذه يفعلها الفرد المشارك ليس أقل من 20 مرّة في كلّ ليلة، ولعشر ليالٍ متتابعة، وهو يضرب على صدره ليس أقلّ من مائة مرّة، ولنا أن نتصور أنه في كل مرّة تسقط يده على البقعة نفسها من جسده.
وقد توصل لييل الذي كان يراقب المشاهد الماثلة أمامه بتمعّن إلى أن ما شاهده لا يعكس تطرّفاً مصطنعاً. على العكس، كانت تلك المشاهد تتّسم بقدر كبير من العفوية والتلقائية المعبّرة عن إيمان وحماس، لو قدّر لهما أن يوجّها نحو القنوات الصحية والإيجابية لغيّرا مجرى الحياة في بلدانهم. ويظهر على هؤلاء الناس أنّهم توّاقون للتعبير عن مكنونات أنفسهم من خلال سلوكيات تبدو للمراقب الخارجي خارجة عن المألوف، وبعضها يجلب السخرية.
ما اكتشفناه نحن بعد عقود من كتابة لييل أنّ رجال الطبقة السياسية اليوم وجدوا في طقوس عاشوراء ما يحقّق سيطرتهم على عقول تابعيهم من الأميين والسذّج الذين تكون ممارسة التعذيب والجلد الذاتي عندهم أشبه بمخدّر يصرف أذهانهم عن المطالبة بحقوقهم، وقد يعزّز اعتقادهم بأنّ الذلّ الذي يقيمون فيه قدرٌ محتومٌ لا يمكن لهم ردّه، وهذا ما يريده الحاكمون، ويعملون على تجذيره.
تعدّدية قطبية
أم عالم بلا أقطاب؟
عبد اللطيف السعدون
كما توقّع كثيرون، تحوّلت حرب أوكرانيا بعد 16 شهرا على نشوبها إلى حرب بلا نهاية، وقد تؤدّي الى إعصار جيوسياسي هائل، ربما يعيد رسم خريطة العالم على غير ما نعرفه اليوم.
وكما صنعت أحداث كبرى في التاريخ، مثل الثورة الفرنسية، أو الحربين العالميتين، أو سقوط جدار برلين، أو ضرب مركز التجارة العالمي تحوّلاتٍ مفصلية على أصعدة مختلفة، فان حرب أوكرانيا مرشّحة هي الأخرى لإحداث تغييرات غير محسوبة، وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أرادها "عملية عسكرية خاصة"، يضم من خلالها أوكرانيا إلى "إمبراطوريته" باعتبارها، كما قال، "جزءا من روسيا، وبينهما قرابة مشتركة"، وقدّر لعمليته هذه بضعة أسابيع، وربما بضعة أيام، لكنها امتدّت وطالت، ولا يعرف أحدٌ متى ستنتهي. وما زاد في حيرة الباحثين خطأ حسابات بوتين قبل إقدامه على العملية، وهو الذي أهلته السنوات المديدة في جهاز المخابرات في الاتحاد السوفييتي الميّت تاريخيا ليمتلك خبرة عريضة في قراءة ما يدور من حوله، وفي فهم تحوّلات العالم وسياساته، الا أنه قد لا يكون فكّر في رد الفعل الغربي المحتمل، وقد يكون اعتقد أن الغرب الثري المرفّه لن يُخاطر بثروته ورفاهه من أجل عيون "مقاطعة" صغيرة اسمها أوكرانيا.
ويبدو أن الغرب أيضا مارس قراءة خاطئة في عدم إدراك نيات بوتين في وقت مبكّر، وتجاهل سعيه الحثيث إلى استعادة "روسيا العظيمة ذات التاريخ المجيد"، وأنه قد يضحّي في سبيل ذلك باستقرار أوروبا، وبعلاقاته المتطوّرة مع حكوماتها، والمكاسب التي تجنيها بلاده من ذلك. ولذلك احتاج الغرب لحرب قد تكون طويلة كي يدرك أن روسيا "بوتين" شيء مختلف عن روسيا زمن النظام السوفييتي. وهكذا أوقعت القراءة الخاطئة المزدوجة الطرفين في أزمةٍ امتدّت عالميا، وأصبح الخلاص منها مكلفا ومدمّرا إلى حد بعيد.
طرح الباحث الفنزويلي فيرناندو ميريس ثلاثة سيناريوهات محتملة لنهاية الأزمة، أن تنجح روسيا في ضم أوكرانيا كما نجحت في ضمّ شبه جزيرة القرم، وهذا مستبعدٌ، لأن الغرب لن يسمح به مهما طال الزمن، ومهما قدّم من سلاح أو مال لإدامة الماكنة العسكرية الأوكرانية، لأن هذا يعني انكفاء الغرب وتراجعه أمام المطامع الروسية، أو أن تصمُد أوكرانيا وتستعيد ما سلبته روسيا من أراضيها، وتوقع ضربة قاصمة بنظام موسكو، وهذا أيضا غير مسموح به، لأنه قد يجرح كبرياء الرئيس بوتين، ولا يترك له من خيارٍ سوى استعمال أسلحة نووية، وقد يؤدّي هذا الخيار إلى توسيع رقعة الحرب ومخاطرها على العالم كله.
يعرّج ميريس على سيناريو ثالث اعتبره الأقرب إلى التحقق، أن يطول أمد الحرب بفعل عوامل مختلفة، وأن تسخن جبهة الحرب في مرحلة، وتبرُد في أخرى إلى أن "تصبح تفصيلا ليس له أهمية كبيرة مقارنة بالمعضلة العالمية التي سوف تظهر واضحة عبر المواجهة المتوقّعة بين القوتين العظميين، أميركا والصين، وكلّ منهما تسعى إلى الهيمنة على العالم".
يستنبط العالم الأميركي رئيس مجموعة أوراسيا المختصة بمخاطر السياسات العالمية إيان بريمر رؤية جديدة لما يمكن أن يحدُث من تداعياتٍ تؤجّجها حرب أوكرانيا، وهو في بحثه الأخير الذي حمل عنوان "القوة العالمية القادمة لن تكون هي القوة التي تعتقدونها" يفاجئنا ببيان "أن العالم لن يكون كما هو الآن، إننا لن نعيش (بعد حرب أوكرانيا) في ظل نظام القطب الواحد، أو القطبين، أو الأقطاب المتعدّدة، بل على العكس من ذلك (يضيف بريمر)، سيكون العالم المقبل تفاعليا بطريقةٍ ما، أنظمة عالمية متعدّدة، منفصلة، ولكنها متداخلة، وسيناريوهات للهيمنة المشتركة تعتمد على التفاعل والتنافس السلمي، بدلا من الصدام العسكري والحروب".
ستظلّ الولايات المتحدة، وفقا لذلك، لاعبا مهيمنا من الناحية الأمنية، ولكن سيتعيّن عليها التنافس السلمي والتفاعل مع الصين، لأن الاقتصادين الأميركي والصيني أصبحا مترابطيْن بشكل مكثف في الفضاء العالمي، وسيصبح الاتحاد الأوروبي سوقا مطلوبا لكلا البلدين، كما ستظلّ اليابان قوة اقتصادية. وإذا ما حافظت الهند على معدّلات نموها الحالية فسوف تنضم إلى الدول المهيمنة، ولن تكون هناك حرب اقتصادية باردة، لأن لا أحد على استعداد لخوضها، وسوف يكون التفوّق التكنولوجي فاعلا مهيمنا على نحو أكبر، وقد يتم تشكيل نظام عالمي رقمي يسمح بإملاء قواعد في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي. وفي النظام العالمي الجديد يتنافس البشر تكنولوجيا واقتصاديا بعضهم مع بعض في ضربٍ من العولمة التي لا تقمع الاختلافات التي يمكن أن تبرز دينيا أو ثقافيا، أو حتى في طرق العيش.
تُرى ... أين سيكون موقعنا، نحن العرب، في ظل النظام العالمي الجديد الذي يبشّرنا به إيان بريمر؟
في تداعيات
تمرّد طبّاخ القيصر
عبد اللطيف السعدون
إذا ما فكّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يلوم أحدا على ما جرى له أخيرا، فلن يجد غير فلاديمير بوتين نفسه، فهو الذي حوّل الطباخ يفغيني بريغوجين إلى قائد عسكري، وربما مخطّط استراتيجي أيضا، وأصبح واحدا من رجال الصفّ الأول الذين يعتمد عليهم، بخاصة في "فتوحاته" الخارجية، وهو الذي كانت وظيفته الأساسية أن يعدّ بنفسه الأطباق التي يفضّلها القيصر، ويتحسّس مذاقها قبل أن تقدّم له، وكانت النتيجة أن تمرّد الطباخ على سيّده بعدما داعبت عقله خيالاتٌ مريضةٌ في أن في وسعه أن يصل إلى الكرملين، ويطيح القيصر، وينصّب نفسه مكانه.
في التاريخ القريب واقعة مماثلة ارتكبها الرئيس العراقي الراحل صدّام حسين، عندما جعل من العريف الهارب من الجيش حسين كامل واحدا من مقرّبيه وزوجه ابنته، ثم عيّنه وزيرا للدفاع ومشرفا على الصناعات العسكرية، وأعطاه رتبة فريق، وألحق بسلطته وزاراتٍ عدّة. وإذ انفتحت أمام كامل أبواب المجد تصوّر أن الدنيا دانت له إلى الأبد، وأنها خطوة واحدة فقط، ويحصل على لقب السيد الرئيس بعد إطاحته عمّه، وكان أن طار إلى الأردن ليعلن من هناك "بيانه الأول". صبر صدّام على تمرد "العريف" الهارب شهورا قبل أن يتمكّن، وبخطّة ذكية، من إعادته الى البلاد، إلا أنه لم يمهله بعد وصوله سوى ساعات معدودة، حتى كان "شباب العشيرة" قد أجهزوا عليه في منزله، وقتلوه شرّ قتلة.
ربما تذكّر الرئيس بوتين ما فعله صدّام حسين مع "العريف" المتمرّد، وقد يكون قد طلب من مساعديه تزويده بكل التفاصيل، تمهيدا لوضع خطته الخاصة به، والتي تجعل بريغوجين نسيا منسيّا، استنادا إلى خبرته العريضة في جهاز المخابرات (كي جي بي)، ولكي لا تبقى "الشوكة في الحلق" طويلا.
ولكن هل يضمن مقتل بريغوجين، إن تم، أو حتى قبوله بوضع "اللاجئ الدائم" عند رئيس بيلاروسيا لوكاشينكو، حليف الرئيس بوتين، إسدال الستار على واقعة التمرد من دون توقّع تداعياتٍ قد لا تظهر في المدى القريب، وخصوصا أن بقاء حرب أوكرانيا من دون حسم يظل يأكل من جرف الرئيس بوتين على المستوى الداخلي، وقد شرعت قياداتٌ عسكريةٌ عليا في إظهار نوع من الامتعاض والغضب مما يجري، كما أن شرائح مدنية بدأت تشعُر بثقل الحرب عليها بعدما طالت أكثر مما قدّر لها، ومن دون أن تبدو في الأفق دلائل تشير إلى قرب نهايتها.
بقاء حرب أوكرانيا من دون حسم يظل يأكل من جرف الرئيس بوتين على المستوى الداخلي
وبالعودة إلى تجربة صدّام حسين، معروفٌ أن قضاءه على حسين كامل حفّز عسكريين كبارا على تدبير مكائد ومؤامرات لإطاحة الرئيس الذي استطاع إجهاضها قبل أن تأخذ طريقها إلى التنفيذ، كما أن ما قدّمه "العريف" الهارب من أسرار ومعلوماتٍ، بعضُها كاذبٌ وملفّق، إلى "سي آي إيه" استخدمتها واشنطن في التدليل على امتلاك العراق أسلحة الدمار الشامل، وفي إقناع أطراف ودول بالمشاركة معها في إسقاط نظام بغداد لاحقا.
قد تحدُث مثل هذه التداعيات في أعقاب تمرّد بريغوجين، وخصوصا أن للأخير صلات وطيدة بعديد من القيادات العسكرية التي تُضمر عدم الرضا عن سياسات بوتين، وقد جرى بالفعل اعتقال بعضها، ومن بينهم سيرغي سوروفيكين الموصوف بأنه عضو سرّي في مليشيا فاغنر، وتردّد أنه كان على علم بنية بريغوجين التمرّد على سيّده.
وفي إطار خدمات "فاغنر" خارج روسيا، قد تحدُث تداعياتٌ من "قماشة" مختلفة، خصوصا في البلدان التي مارست فيها "فاغنر" نوعا من التغلغل لخدمة أغراض نظام بوتين، مثل سورية، وليبيا، والسودان، وأفريقيا. ومن الطبيعي أن تسود الحيرة الأوساط الحاكمة في هذه البلدان، بعد أن أصبح استمرار وجود رجال "فاغنر" فيها مشكوكا فيه، إذ قد تتعرّض المناطق التي كانت تحت حمايتهم إلى الانكشاف، وربما إلى حالة من الفوضى تلحق الضرر بالمناطق نفسها، وقد تتسبّب في ظهور عقد "جيوسياسية" تخلق مآزق صعبة لتلك البلدان، وخصوصا أن لفاغنر فيها، إضافة إلى خدماتها العسكرية، نشاطات اقتصادية وتجارية ذات تأثير مباشر على المستفيدين منها، وهذا كله قد ينشئ مأزقا للنظام الروسي نفسه الذي اعترف بتبعيّة "فاغنر" له وتمويلها منه، وإن حاول أن ينأى بنظامه عما ارتكبته هنا وهناك من أفعالٍ يرقى بعضها إلى أن يكون "جرائم حرب" وجرائم ضد الإنسانية.
يبقى سؤال في انتظار الإجابة: ما مقدار ما يمكن أن تناله التداعيات المحتملة من نظام الرئيس بوتين، ومن مكانته القيادية في داخل بلاده، ومن صورة "روسيا العظمى" التي تطوف في عقله؟
سؤال الفساد
الحاضر دائماً في العراق
عبد اللطيف السعدون
لا يكاد يمرّ يوم في العراق من دون أن يحضر سؤال "الفساد"، ليس في الصحف ووسائل التواصل فحسب، وإنما في الإدارات الحكومية، وفي الشارع العراقي، وحتى في مكاتب كبار المسؤولين الذين يضعون خططا على الورق، ويشكّلون لجانا تلد لجانا، ويدبّجون تقارير عن منجزاتهم، سرعان ما يظهر زيفها، وينهمك رجال القضاء في إصدار أحكامٍ لا تجرّم السارق، ولا تعيد ما سرق. وعلى امتداد الأعوام العشرين، كلما ولدت حكومة لعنت سابقتها، وتعهّدت بمراجعة ملفات الفساد ومعاقبة الفاسدين، لكن لا شيء يحدُث، ولا أحد يتجرّأ ويرفع الصوت. ويظل الفاسدون، بالأخص الحيتان الكبار منهم، في مأمن، وفي حرز حريز. ولا تقوى الدولة (هل هناك دولة حقّا؟) على رفع الأصابع بوجوههم مع أنهم معروفون، وبعضهم بلغت به الوقاحة حد التصريح، جهارا نهارا، أنهم شاركوا في اقتسام "الكعكة"، لأن الكل يفعل هكذا، وإذا كان أمرهم كذلك فكيف يمكن، إذن، محاسبتهم على ما اقترفوه؟
هكذا تدحرج سؤال الفساد هذا، ليصبح ظاهرة لم تتردّد ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، جينين بلاسخارت، في اعتبارها "سمة أساسية في الاقتصاد السياسي في العراق، وجزءا من المعاملات اليومية، ولا يوجد أي قائد (سياسي) في منأى عنها". وكان رئيس الجمهورية السابق، برهم صالح، قدّر حجم الأموال المنهوبة بنحو 150 مليار دولار، فيما قال خبراء اقتصاديون إنها بلغت في سنوات العقد الأخير ما يتراوح بين 350 و600 مليار دولار، ووثقت تقارير رسمية بلوغ عائدات النفط في الأعوام العشرين الأخيرة تريليونا وثلاثمائة مليار دولار، لكن لا أحد يعرف إلى أين ذهبت، واتهمت هيئة النزاهة المعنية برصد حالات الفساد في المؤسّسات والإدارات الحكومية 11 ألف مسؤول حكومي رفيع، بينهم 54 وزيرا، بالتورّط في جرائم الفساد، لكنها لم توفق في محاسبتهم، باستثناء عدد قليل جدا منهم؛ حوكموا غيابيا بعد هروبهم إلى خارج البلاد، ثم صدرت قرارات بالعفو عنهم نتيجة تدخّل جهات عليا متورّطة معهم أو لأغراض انتخابية وسياسية، وعادوا بعد ذلك سالمين غانمين، واقتحموا المعترك السياسي من جديد، وكأن شيئا لم يكن. ولم يعد المواطن العراقي في وارد الثقة بما يقال له، وهو يعرف تماما أن حصوله على خدمةٍ يفترض أن توفرها الدولة له ينبغي أن يقترن بدفع "المقسوم" كي يضمن تلبية طلبه أو إنجاز معاملته، وإلا ليس له سوى الوقوف في طابور الانتظار إلى أن يزهق ويعود خائبا وهو يلعن الساعة التي قرّر فيها البقاء في البلاد التي أذلّته وأرهقته وتحكّمت فيه، وسلبته أبسط حقوق المواطنة التي يحصل عليها الآخرون في بلاد الله.
لقد "اتّسع الخرق على الراتق"، ولم تعد الحلول المطروحة لمكافحة الفساد مجدية، بل ربما ساعدت على نمو تطلّعات غير مشروعة لدى كثيرين من صغار العاملين في الدولة للدخول في نادي "الحيتان الكبار"، ولو عن طريق إرغام المواطنين على دفع "الإتاوات" و"الرشوات" مقابل تطمين حقوقهم، أو التواطؤ مع شركات ورجال أعمال وتجار لإرساء قاعدة منافع متبادلة، أو تزوير وثائق ومستندات لإكساب معاملات معينة شكلا قانونيا يضمن الحصول على منافع شخصية.
وفي واقعة واحدة من مجموعة وقائع، أعلمتنا "هيئة النزاهة" أنها قبضت على موظف صغير يعمل في دائرة الجمارك في منفذ حدودي تضخّمت ثروته إلى 38 مليار دينار، وأصبح مالكا مستشفى خاصا وعقارات، وأرصدة في بنوك خارجية بالمليارات، لكن "الهيئة" لم تقل لنا كيف تسنّى لهذا الموظف الصغير الذي لا يتجاوز مرتبه أكثر من بضعة آلاف من الدنانير أن يقبض على هذه الثروة، ويتسلّل إلى نادي "الحيتان الكبار" من دون أن يكون له سند من "حوت" كبير ضمن له التسلّل بأمان، ومن دون خشيةٍ من عقاب؟
وقد لا تعرف "الهيئة" أيضا أن فعل القضاء في هذه الحالة لن يكون أكثر مما فعله في قضية الأمانات الضريبية التي عُرفت باسم "سرقة القرن" التي وعدنا رئيس الوزراء، محمد شيّاع السوداني، في حينه، بأن بطلها نور زهير سيعيد المبلغ المسروق كاملا (3.7 تريليونات دينار) خلال أسبوعين مقابل إطلاق سراحه، ثم مرّت سبعة أشهر على هذا الوعد، لكن المبلغ المستردّ لم يتجاوز بضعة ملايين من الدنانير، فيما سافر "البطل" إلى الخارج، ليقيم هناك آمنا مطمئنا، حتى من دون أن يكشف عن أسماء "الحيتان" المتورّطة معه، وعفا الله عما سلف!
وقد يبدو كل هذا الكلام أشبه بمزحة الروائي الفرنسي، ميلان كونديرا، التي تحوّلت إلى مصيبة، لكن حالنا الماثل يعدنا بمصائب أدهى وأمرّ.
عن صحافة احتفالية ...
وصحافيين في خبر كان
عبد اللطيف السعدون
روى زميل عربي أنه، في إحدى زياراته بغداد، صادف أن انعقد بينه وبين بائع خضار حوار في أمور شتّى، وعندما عرف البائع أن من يحاوره صحافي قال له: "إنني أيضا صحافي مثلك". هنا سأله زميلنا عما ألجأه لبيع الخضار، اعترف البائع بحقيقة أنه انضم إلى نقابة الصحافيين لضمان عيشه، مع أنه لم يمارس العمل الصحافي مطلقا، ولا يقرأ الصحف إلا نادرا، وقد فعل ذلك في الفترة التي أصدرت فيها الحكومة قرارا بتقنين حركة السيارات وفقا لأرقام لوحاتها، بحيث تعمل السيارة التي تنتهي لوحتها برقم فردي في أيام محدّدة، والسيارة التي تنتهي لوحتها برقم مزدوج في أيام أخرى، ما دفع بعض مالكي السيارات إلى الانضمام إلى نقابة الصحافيين، عبر وساطات معيّنة، وبعد دفع المقسوم، لكي يضمنوا الاستمرار في استخدام سياراتهم!
أماط أحد العاملين في إدارة النقابة اللثام في السابق عن مئات الأسماء، قال إنها لفنانين مبتدئين وموسيقيين، وحتى عمّال في قطاعات ليست لها علاقة بالعمل الصحافي انضمّوا إلى النقابة، طمعا في الحصول على مكاسب أو امتيازات توفّرها لهم العضوية.
في البال تصريح لنقيب الصحافيين، مؤيد اللامي، يشير فيه، مفاخرا، إلى أن عدد أعضاء النقابة أزيد من 25 ألفا، وهو قد لا يعلم أن عدد أعضاء نقابة الصحافيين في مصر، أمّ الصحافة العربية، 9259 عضوا فقط، بشهادة النقابة نفسها، وفي لبنان عدد أعضاء نقابة الصحافة نحو ألف، وكذا حال الصحافيين في الأقطار العربية الأخرى.
هذا يعني أن "السلطة الرابعة" في العراق تعاني من معضلة حادّة، حيث إن عدد الصحافيين العاملين في المهنة واقعيا لا يزيد على بضعة آلاف في أكثر تقدير، والباقون بالطبع لا يقرأون ولا يكتبون، ومثلهم مثل "بائع الخضار" في الواقعة التي رواها زميلنا الصحافي العربي.
في البال أن اللامي عمل في مستهل حياته العملية ضاربا على آلة الرقّ في فرقة موسيقية قبل أن يعمل مراسلا لمجلة فنية، وينضم لنقابة الصحافيين ليصبح تاليا نقيبا لها. ويقول خبثاء إن بدايات اللامي العملية هي التي دفعته إلى اعتبار العمل الصحافي "مهنة من لا مهنة له"، لكن القدر حمل له "الجائزة الكبرى"، حين التفت إليه نوري المالكي في ولايته الأولى ليرفع اسمه من قائمة "المجتثيّن"، ويؤهّله للعمل النقابي. وفي عام 2012، خصّصت حكومة المالكي لنقابة الصحافيين أربعة مليارات دينار من المال العام، مع أن أية نقابة مهنية أخرى لم تمنح دينارا واحدا. وعبر هذه الصفقة، ضمن اللامي المنصب لخمس دورات انتخابية، مع أن قانون النقابة يمنع إشغال المنصب أكثر من دورتين، حتى أصبح رئيسا لاتحاد الصحافيين العرب من خلال الدعم المالي السّخي الذي قدمته حكومة بغداد.
في البال أيضا ما نقله بعض شهود تجديد ولاية اللامي في اتحاد الصحافيين العرب عام 2022 أن عديدا من صحافيي مصر اعترضوا على التجديد، وطرحوا اسم ضياء رشوان نقيب الصحافيين لقيادة الاتحاد، إلا أن تسوية أقرت في حينه لإرضاء حكومة العراق، أبقت على اللامي رئيسا، فيما استحدث منصب جديد "رئيس فخري للاتحاد" منح لرشوان!
وبعد هذا كله، كان لا بد للنقيب العتيد أن يردّ الجميل لمن أولاه نعمته. ولذلك أنشأ "جيشا إلكترونيا" من قارعي الطبول يروّج طروحات المالكي وآراءه، ويدافع عنه مستغلّا صحفا وفضائيات ومواقع تواصل.
مناسبة هذه التداعيات التي أصبحت في ذمّة التاريخ الإعلان عن "عيد وطني" للصحافة العراقية في 15 يونيو/ حزيران الحالي الذي يصادف الذكرى الـ154 لتأسيس "الزّوراء" أول صحيفة عراقية، على عهد الوالي مدحت باشا، واقتران الإعلان بتصريحات مثيرة للنقيب ينفي فيها وجود صحافي سجين في العراق أكثر من عقد. وبالطبع، كان النقيب صادقا في قوله، فالذين اختطفوا أو اعتقلوا لم يعودوا أحياء، وأغلب الظن أنهم قتلوا وغيّبوا تماما، والحقيقة تتسلل من بين مضامين تقارير جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق التي وثّقت عشرات الانتهاكات وحالات الاغتيال والتهديد بالقتل والأحكام بالسجن والاعتداء ومصادرة معدّات والمنع من التصوير وحرق مقارّ مؤسّسات صحافية ... إلخ. وفي البال أسماء مازن لطيف وتوفيق التميمي وهشام الهاشمي وأحمد عبد الصمد وصفاء غالي، وعشرات غيرهم ليس ثمّة خبر عنهم، وما تزال أسرهم تبحث عن مصائرهم.
بعد هذا كله، أليس من حقّنا أن نتساءل عن جدوى احتفالية "عيد وطني" للصحافة العراقية، وعشرات الصحافيين العراقيين في خبر كان؟
عن التنوّع في ظلّ الوحدة
عبد اللطيف السعدون
ثمّة أمور لافتة طبعت اجتماع قمة دول أميركا الجنوبية في برازيليا أخيرا، في مقدمتها دعوة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى تخطّي الأيديولوجيا في العلاقات بين دول القارّة، والتمسّك بمبدأ "التنوّع في ظل الوحدة"، واعتماد التسامح والحوار واحترام الرأي الآخر، وقد شكّلت تلك الدعوة الصادرة عن زعيم اشتراكي معروف بتشدّده إيذانا بمرحلة انفراج في العلاقات بين دول القارّة التي عصفت بها رياح الاختلافات زمنا مديدا، وكان بعضُها لا ينأى عن بعض آخر فحسب، إنما يكايده ويخاصمه، ويعمل على تقويضه كما حصل مرارا في المشاركة في تدبير مؤامرات انقلابية أو دعم حركات مسلّحة مناهضة لهذه الحكومة أو تلك.
لم يسرق مادورو، بالتفاتته الذكية، الأضواء من خصومه الذين جاؤوا إلى القمة وفي جعبتهم كثير مما يريدون قوله ضده وضد حكومته فحسب، إنما أراد أن يؤسّس لمرحلة جديدة في العمل المشترك تنأى بدول القارّة عن النفوذ الأميركي، يشاركه في نظرته هذه الرئيس البرازيلي المضيف لويس إيناسيو لولا الذي عمَد إلى إطلاق جلسة ثانية لاجتماع القمّة بعد جلسة الكلمات البروتوكولية، عنوانها "حوار الرؤساء"، الهدف منها تكريس تقليد الحوار الذي يعتمد المواجهة والشفافية، وممارسة النقد بين الرؤساء الذين درجوا في السابق على الاكتفاء بما تقتضيه قواعد اللياقة، والتهرّب من طرح المشكلات الحقيقية التي تسود دولهم. وبالفعل، نجحت الجلسة بعدما قال الرؤساء كل ما في جعبتهم إلى درجة أنهم شتموا بعضهم بعضا قبل ان يبتسم أحدهم للآخر، بوصف صحافي فنزويلي ساخر، وقبل أن ينتهوا إلى نوع من الرضا المتبادل، والتوافق على السعي لرأب الصدوع القائمة بينهم، وتعزيز التعاون وصولا إلى التكامل الإقليمي تحت شعار "التنوّع في ظل الوحدة".
في جلسة الحوار الحرّ تلك، شنّ رئيس الأوروغواي اليميني لويس لاكال هجوما على حكومة فنزويلا، وقال إن الفنزويليين يريدون ديمقراطية كاملة واحترام حقوق الإنسان، وطالب بإطلاق سراح سجناء سياسيين، قال إن مادورو يحتجزهم. وشدّد رئيس تشيلي اليساري غابرييل بوريك، هو الآخر، على أنه لا يمكن غض الطرف عن مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في فنزويلا، لكنه أعرب عن سروره بعودتها إلى الهيئات المتعدّدة الأطراف، بعد أن كانت قد تخلت عن العمل من خلالها، مكرّرا رفضه للعقوبات المفروضة عليها من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وهو ما دعا إليه أيضا رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز (من يسار الوسط)، الذي طلب من فنزويلا العودة إلى العمل الجماعي مع دول القارّة ضمن المنظمات والمحافل الدولية، مقترحا لحلّ أزمتها اعتماد خريطة طريق مشتركة بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة لتوفير ضماناتٍ لعملية انتخابية يُفترض أن تجري العام المقبل.
لم ينس زعماء آخرون إعلان امتعاضهم من الحفاوة التي قوبل بها الرئيس الفنزويلي من البرازيل، الدولة المنظمّة للقمّة، ووجهوا اللوم للرئيس البرازيلي اليساري لويس إيناسيو لولا على وصفه ما دعا إليه بعضهم من ضرورة استجواب حكومة كاراكاس بشأن مزاعم انتهاكاتها حقوق الإنسان بأنه "مجرّد بناء سردي".
تحمّل الزعيم الفنزويلي المتشدّد كل هذا النقد بصبرٍ وأناة، وهو الذي لم تُعرف عنه قدرته على الصبر على منتقديه، لم يردّ بشكل مباشر عليهم، واكتفى بالقول إنه يحترم مبدأ الحوار والتسامح، مكرّرا شعاره الذي أطلقه لدى حضوره "التنوّع في ظل الوحدة".
وخلصت الاجتماعات إلى الموافقة الجماعية على ما سمّيت الوصايا العشر التي اقترحها الرئيس البرازيلي لولا، وجاءت، كما قال، من حقيقة "أن المنطقة لم تعد قادرةً على الانتظار أكثر مما انتظرت للتغلب على الهاوية الاجتماعية التي لا تزال قائمة منذ عهود الاستعمار، وللتوجّه نحو التكامل الإقليمي والوحدة". ومن بين "الوصايا العشر" المقرّة "وضع المدّخرات الإقليمية في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، و"تقليل الاعتماد على الدولار في تجارة أميركا الجنوبية"، و"تحديث المشاريع التي تم تصميمها منذ أكثر من عقدين، ولم تكتمل"، و"العمل على إنشاء سوق للطاقة في القارّة".
يمكن أن يقال هنا إن دول أميركا الجنوبية التي تبلغ مساحتها ضعف مساحة أوروبا، وتضم نحو نصف مليار إنسان، الغارقة في مشكلاتها، وكانت إلى حد قريب تمثل الحديقة الخلفية للولايات المتحدة، قد حدّدت في قمتها أخيرا مسار اكتمالها ووحدتها. الأهم أنها جمعت في دورتها هذه رؤساء متعدّدي الانتماءات، اشتراكيين متشددين، ويساريين معتدلين، ويمينيين محافظين، ليؤكّدوا من خلال ذلك هزيمة الأيديولوجيا، والتمسّك بمبدأ التنوع في ظل الوحدة، يحدوهم الأمل بقدرتهم على الثبات وسط عالم قلق، وقابل للتغيير والتحوّل في أي لحظة.
وصيّة كيسنجر الأخيرة
عبد اللطيف السعدون
يُنقل عن ثعلب الدبلوماسية الأميركية العجوز هنري كيسنجر أنه في زيارته السرية إلى بكين في 1971، التي مهدت للقاء التاريخي بين الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون والزعيم الصيني ماو تسي تونغ، سأل رئيس الوزراء الصيني آنذاك شو إن لاي عن رأيه في الثورة الفرنسية، فأجاب لاي بأن هذا الحدث كان قريبا جدا في وقته، بحيث لا يبدو معناه واضحا.
كان الأمر هكذا بالنسبة للصين، أمة متعدّدة الألفيات، لا شيء يوضح حدثا ما بالنسبة لها أفضل من الإحساس بالوقت والتاريخ. لذلك ينبض إحساس الصينيين بالوقت بمعدّل مختلف عن إحساس الأميركيين به، فعندما يسأل أميركي عن حدث تاريخي معيّن سرعان ما يخطر في باله يوم معين في "الروزنامة"، فيما لو سئل صيني عن الحدث نفسه، يضعه في خانة سلالة تاريخية، وقد عرفت الصين 14 سلالة إمبراطورية، استمرت عشر منها مدىً أطول من تاريخ الولايات المتحدة بأكمله.
هنا تكمن ميزة الصين في مواجهة أميركا، تضيف الأدبيات الصينية فارقا آخر، إذ تمثل الصين "حضارة دولة"، أي أن معالمها الحضارية سبقت وعيها كدولة، وضمنت لها رؤيةً تفوق رؤية دولٍ كثيرة عاصرتها، ولا ننسى أن الصين شهدت عملية هيكلة دولةٍ استمرّت في التطور في مرحلة كانت أوروبا فيها تعيش في العصور المظلمة. وفي هذا السياق، يتندّر الصينيون بحكاية إبحار كريستوفر كولومبوس من ميناءٍ في جنوب إسبانيا لاكتشاف أميركا في ثلاث سفن صغيرة، في حين كان لدى الصين أسطول يزيد على 1600 سفينة.
جعل هذا كله عيون الولايات المتحدة تركّز على الصين منذ منتصف القرن التاسع عشر، عندما دخل الأسطول الأميركي بحر اليابان، وكانت تعتقد أن عليها "مهمّة سامية وفريدة"، بتعبير الباحث الأسترالي في العلاقات الدولية، هيو وايت، تتمثل في "توجيه الصين وإحضارها إلى العالم الحديث". وبمعنى آخر، جعلها مشابهة لها على نحو أو آخر، ولم يخطر في بال الأميركيين أن للصينيين حلمهم المختلف الناتج عن تاريخ طويلٍ ممتدٍ لآلاف السنين، ويتوقون إلى استعادته، ومن ثم الدخول إلى العالم في "هجمةٍ" اقتصادية وتكنولوجية، وحتى سياسية وعسكرية، وهذا ما جسّده ، في ما بعد، طموح زعيمها شي جين بينغ إلى أن تكون بلاده قوية وفاعلة، وفي موقع المنافس للولايات المتحدة، تأهيلا وجاهزية، والعامل على إنهاء هيمنة القطب الواحد، والسعي إلى رسم مسارات حقبة عالم متعدّد الأقطاب بدأت طلائعه في التحقّق.
كان هنري كيسنجر الذي يصفه مجايلوه بأنه الدبلوماسي الأميركي الأكثر خبرةً في الشؤون الصينية أول من تنبأ بعظمة الصين وبالدور الذي تريد أن تلعبه. ولذلك طرح فكرة تعايش الولايات المتحدة معها، واعتبرت زيارته تلك بكين اختراقا دبلوماسيا لافتا ساهم بشكل مباشر في ضمان أمن العالم وسلامه، لكن ما شهدته العلاقات الصينية الأميركية في السنوات الأخيرة مثّل تراجعا عن هذا التوجّه، وأعاد أجواء الحرب الباردة، بخاصة بعد أن تحوّلت عقدة تايوان إلى بؤرة لتهديدات متبادلة بين الطرفين. وبالطبع، كان لا بد أن ينعكس ذلك سلبا على سلام العالم وأمنه.
"
وقد ظلّ كيسنجر الذي أطفأ شمعته المائة قبل أيام ملتزما بوجهة نظره عن الصين. وفي آخر حديث له دعا الأميركيين والصينيين معا إلى أن يتعلّموا كيف يتعايشون، تلك كانت وصيته الأخيرة للقوّتين العظميين محذّرا من أن أمامهما زمنا محدودا، أقل من عشر سنوات، وإلا فإنهما ستدفعان العالم إلى كارثة دونها كوارث الحربين التي عانت منها البشرية، وذكرهما بمقولة للفيلسوف الألماني إيمانويل كانط في أن السلام يحدُث من خلال أحد أمرين، إما أن يتفهم القادة المعنيون أهميته، أو أن تحدُث كارثة ما تؤسّس للسلام، وهو هنا يشبّه الوضع العالمي الماثل بلحظة ما قبل الحرب الأولى، حيث رفض أي من الطرفين المتحاربين التنازل عن بغلته، وكان لا بد من أن تحدُث الكارثة.
يبدو أن "صقور" الإدارات الأميركية المتعاقبة من ديمقراطيين أو جمهوريين لا يروق لهم التحليل الذي يصرّ عليه كيسنجر، لكن هذا لم يمنع أصواتا من أن ترتفع مجدّدا محذّرة مما قد تؤول إليه الأوضاع. وفي آخر جلسة استماع للكونغرس عن الصين، قال أعضاء برلمانيون إن على أميركا والصين التعامل بطريقة سلمية، واحتواء النزاع المحتمل بشأن تايوان، لأنه سيؤدّي إلى "تدمير العالم كله".
وهكذا لم تعد اللحظة الساخنة بين بكين وواشنطن احتمالا فحسب، فهي ماثلة في الأفق، فهل يقرأ حكماء العالم وصية كيسنجر بإمعان؟
عن محارق
الكتب ومحارق الأفكار
عبد اللطيف السعدون
لا أتذكّر اسم الحكيم الذي نصح ابنه بألّا يلتمس الحكمة من تجربته في الحياة فقط، بل عليه أن يلتمسها من تجارب الآخرين أيضاً، لكنّ تجارب الآخرين لن يجدها سوى في الكتب. وللأسف، الطغاة والدكتاتوريون عادة ما يدركون هذه النصيحة، ولذلك فإنّ واحدةً من خططهم الشريرة التي يعملون على تحقيقها هي حرق الكتب التي تحمل أفكار التمرّد والثورة، والتي تبشر بالتغيير، وتطرح ما يخالف السائد، وقد لا تكون عملية صنع المحارق وإيقاد النار هي الوسيلة الوحيدة التي قد تضمن حجب الأفكار الحرّة عن الناس إلى حينٍ معلوم، فقد تكفلت التكنولوجيا الحديثة في عصرنا بتوفير وسائل وطرق تُنجز المهمة من دون أن تترك أثراً.
ويُقال في هذا الصدد إنّ الإمبراطور شي هوانغ تي الذي حكم الصين قبل الميلاد بمئتي عام هو أول من سنّ فعلة الحرق وباركها، لتتحوّل، في ما بعد، إلى مثال تقتدي به كلّ سلطة حاكمة تخشى أن يتعلم مواطنوها الثورة من الكتب. واعتبر الفيلسوف الألماني هيغل ما فعله الإمبراطور الصيني عملية غسيل دماغ تفرض حصاراً فكرياً على عقول مواطنيه، وتعمل على هدم كل ما يذكّر بالحكام السابقين ومنجزاتهم وتدميره، وعلى محو آثارهم من الذاكرة.
وفي التاريخ ألف حكاية وحكاية عن محارق الكتب، وآلاف المؤلفات التي تعرّضت للحرق والإتلاف، لكنّ تلك العمليات الشرّيرة لم تتمكّن من حجب الفكر الحر، ولم تضمن محو أسماء المفكّرين والفلاسفة والشعراء من ذاكرة الشعوب، ومن صفحات التاريخ إلى الأبد، وواحدة من تلك الحكايات التي نستعيدها اليوم جرت في عهد الزعيم النازي أدولف هتلر، ففي لحظة عصابية مجنونة، في العاشر من مايو/ أيار، من عام 1933، عندما وقف جوزيف غوبلز؛ أقرب مساعديه وأكثرهم إخلاصاً له، في الساحة العامة في برلين، وسط حشدٍ يضمّ المئات من الطلبة والشباب، مدشّناً "مهرجان" حرق الكتب، رمى الكتاب الأول في المحرقة، وصرخ "لا للانحطاط، لا للفساد الأخلاقي"، تتابعت صرخات الحشد "لا للانحطاط، لا للفساد الأخلاقي" وشرع الجميع في إلقاء الكتب التي اصطحبوها معهم، وهم ينتشون بما يفعلونه، يرقصون ويغنّون: "ألمانيا فوق الجميع، فوق كلّ شيء في العالم، وحدة، عدالة، حرية". وفي حالة هيجان واندفاع خارق للعادة، تقدّمت صفوف أخرى لتلقي بما لديها من كتبٍ في المحرقة، فيما كان غوبلز راعي المهرجان متابعاً ما يجرى أمامه. ولعلّه كان يفكّر في سيده "الفوهرر" الذي سوف يكون ممتنّاً له على مأثرته في حرق الكتب التي تحضّ على الفساد، وفي تخليص شباب ألمانيا من شرورها!
أزيد من 25 ألف كتاب أحرقت في تلك التظاهرة الجماعية، منها كتب إرنست همنغواي وكارل ماركس وبرتولت بريخت وهاينريش مان وتوماس مان وآخرين ممن وُضعت أسماؤهم في قائمة سوداء، وقد حرصت حركة الشباب النازي على إحياء هذه المحرقة سنوياً في جامعات ومدارس ألمانيا إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية التي تعرّض فيها هتلر ونظامُه إلى الهزيمة، وأعيد الاعتبار إلى أولئك الكتّاب، وعادت كتبهم لتحتلّ مكانها في رفوف المكتبات، كما طُويت القائمة السوداء التي حملت أسماءهم.
وفي تاريخنا كثير عن وقائع كهذه، فقد حُرقت كتب ابن حزم في عهد دولة أمراء الطوائف، وكتب الإمام أبي حامد الغزالي في عهد دولة المرابطين، وكتب القاضي ابن رشد في عهد دولة الموحّدين، ولن ننسى هنا قصيدة ابن حزم التي رثى فيها كتبه التي قال إنها باقية في صدره، وسيأخذها معه إلى القبر: "فإن تحرقوا القرطاس لن تحرقوا الذي/ تضمّنه القرطاس، بل هو في صدري، يسير معي حيث استقلت كتائبي/ وينزل إن أنزل ويُدفن في قبري". واستطراداً، نذكّر بما فعله المغول في غزوتهم بغداد، إذ ألقوا في نهر دجلة ملايين الكتب، وبما فعله السلاطين العثمانيون الذين عملوا على حرق الكتب التي تتحدّث عن العرب ومفاخرهم وأمجادهم، منها كتب عبد الرحمن الكواكبي وجمال الدين الأفغاني ومحمود شكري الألوسي.
وفي عصرنا الحاضر، لم تتردّد السلطات الحاكمة في أي بلد عربي عن حرق أو إتلاف الكتب التي ترى أنها تشكّل تهديداً لها، أو لما تسمّيه السلم الاجتماعي، أو الوحدة الوطنية، أو الأديان، أو التقاليد والأعراف، وقد جرى ويجرى ذلك كله بعيداً عن الأنظار، وبإشراف أجهزة ومؤسّسات رقابية رسمية لا تصرّح بما تفعله. وفي غزوة تنظيم داعش على الموصل، حرقت آلاف الكتب الثقافية والسياسية، وحتى الدينية، بحجّة أنها تخالف التعاليم الإسلامية أو تدعو إلى الإلحاد.
ورغم كلّ ما سجّله التاريخ الإنساني من أخبار محارق الكتب ومحارق الأفكار، بقي الفكر الحر، وبقي الكتاب، حتى وإن تخلى عن صيغته الورقية، واتخذ الشكل الإلكتروني الذي فرضته التكنولوجيا، وسوف يبقى لأنّه يمثل، كما يقول خورخي لويس بورخيس، "امتداداً للذاكرة وللمخيّلة" إذ لا يمكن للإنسان أن يعيش حياته من دونهما.
العراق: عودة
النازحين ممنوعة
عبد اللطيف السعدون
يتندّر أشقاؤنا السوريون عند ذكر أوضاع بلادهم بإطلاق تسمية "حارة كلمن إيدو إلو" عليها، وفق المثل الشعبي الذي أعاده إلى أذهانهم مسلسل "صح النوم" الكوميدي الذي أنتج في مطالع سبعينيات القرن الراحل، والذي ربما يجهل كثيرون اسم كاتبه نهاد قلعي، فيما يركزون على بطله دريد لحّام. وعلى أية حال، فان ما يهمّ هنا أن العراق قد ينافس سورية في جدارته بهذه التسمية، حيث لا هيبة للقانون، ولا حضور للنظام العام، وحيث السلطة موزّعة بين أطرافٍ وشخصياتٍ بعضُها غير منظور، وكل طرفٍ يمارس سلطته من غير حسيبٍ ولا رقيب.
هل ثمّة أدلة دامغة أكثر مما حدث ويحدُث بخصوص منطقة "جرف الصخر"، على بعد عشرات الكيلومترات من العاصمة بغداد، والتي اضطرّ معظم سكّانها إلى النزوح منها في فترة سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، ولم يتمكّنوا من العودة بعد تحريرها بسبب إحكام قبضة إيران عليها من خلال "وكلائها" النافذين، ورجال مليشياتها الذين توغلوا فيها، وأقاموا متاريس وحصونا من حولها، واستولوا على مساكنها، كما أنشأوا فيها مقرّات وإدارات وسجونا، وسيطروا على معامل تابعة لهيئة التصنيع العسكري السابقة. الأكثر من ذلك، بنوا فيها معسكرات لتدريب مليشياتهم، ومستودعات ملأوها بأسلحة ثقيلة ومتوسّطة، ومسيّرات وصواريخ غنموها بعد إجبار قوات الجيش النظامي على الخروج، واستحوذوا على مزارع وبحيرات أسماك وشرعوا باستثمارها. وهناك من يؤكّد أن بعض رجال "الحرس الثوري" يقيمون هناك، وقد تحوّلت المدينة بفضلهم إلى قاعدة إيرانية متقدّمة، وتم ذلك كله بصمت حكومي عراقي مريب. وإذ فكرت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق أن تزور المدينة للاطّلاع على أوضاعها، ولتسهيل عودة أهلها إليها باعتبار أن ذلك يدخل ضمن واجبات وزارتها، فوجئت بأنها غير مسموح لها بذلك، ونصحتها "قيادات سياسية" بترك الأمر!
وفي واقعة أخرى، تجرّأ "تحالف السيادة" الذي يشكّل جزءا من "ائتلاف إدارة الدولة"، يسمّيه بعضهم "إتلاف إدارة الدولة"، على المطالبة بعودة النازحين والمهجّرين إلى أماكن سكناهم تطبيقا لمنهاج حكومة محمد شيّاع السوداني المتفق عليه، جاءه الرد من قائد مليشيا حزب الله والحاكم بأمره في المنطقة، أبو علي العسكري، أن "تحقيق هذا الحلم دونه حلم إبليس بالعودة إلى الجنة"، ووافقه في الرأي زعيم مليشيا العصائب، قيس الخزعلي، الذي أسهب في شرح مبرّرات عدم السماح بإعادتهم في الوقت الحاضر بأنه من "متطلّبات الأمن القومي". وبالطبع، يعني الخزعلي أمن إيران التي "ينتمي" إليها!
!
واستطرادا مع ما أشير إليه، يبدو أن رئيس الحكومة محمد شيّاع السوداني الذي وعد بحل المشكلة قد واجه الرد نفسه الذي عرضه زعماء المليشيات التي تحكم المنطقة، فهو لم يستطع أن يفي بوعده خلال المائة يوم الأولى من عمر حكومته، وها قد مضت المائة الثانية، وربما تجيء المئة الثالثة. والمشكلة سوف تظل في مكانها، يذكّرنا ذلك بوعد مماثل قطعه على نفسه رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي لكنه لم يستطع أن يفي به، وقد كلفه وعده هذا خسارته منصبه، وربما يكلفه أيضا عدم تسنمه منصب رئيس الحكومة مرّة أخرى، وهذا المصير قد يواجه السوداني نفسه.
ورغم أن المشكلة تبدو "عراقية" خالصة، إلا أن من يعرف أسرار ما وراء الأبواب المغلقة يكشف أن الأمر كله بيد طهران، وليس بيد بغداد. ويروي وزير سابق على "تويتر" حكاية المسؤول العراقي الرفيع الذي زار إيران، وعرض الأمر أمام مرشد الجمهورية الإسلامية علي خامنئي الذي رفض مناقشة الموضوع، وعاد المسؤول الرفيع بخفّي حنين.
في رصد مواز، ثمّة ما ساعد "وكلاء" إيران النافذين وزعماء مليشياتها الحاكمين في "جرف الصخر"، وفي غيرها من بقاع العراق المحرّرة، وهو أن ثوار تشرين الذين حملوا الأمل في عنفوان حراكهم تنكّبوا الطريق مرّة أخرى، واستسلموا سياسيا لما هو سائد، ولم يعودوا في وارد التصدّي للمشكلات المصيرية التي يعاني منها مواطنوهم، وفي المقدمة منها مشكلة وجود مليون نازح ومهجّر، التي دخلت دائرة التجاذب بين هذا الطرف وذاك، وهكذا أوشك الشر أن ينتصر، لأن "الرجال الطيبين"، بتعبير المفكر الأيرلندي أدموند بيرك، "لم يفعلوا شيئا، واكتفوا بالتفرّج على ما يحدُث والتزام الصمت".
ومع هذا كله، لا يزال اليوم ثمّة بقية صبر لدى أهالي جرف الصخر وسواها من بقاع البلاد الذين تعرّضوا لظلم مركب، وهم لا يتمنّون سوى أن يحيوا حياة طبيعية، أن يعودوا إلى مساكنهم، وأن تعاد إليهم مزارعهم وبساتينهم وبحيراتهم، لكن هناك من يأبى عليهم ذلك. ... والسؤال الذي يفرض نفسه: من يمكنه حل هذ اللغز؟ ومتى؟
عن "رئيس"
صنعته أميركا ثم خذلته
عبد اللطيف السعدون
خوان غوايدو شاب من أسرة فنزويلية متواضعة، اجتذبته السياسة مبكّرا عندما شارك في الاحتجاجات الطلابية أواخر عهد الرئيس هوغو تشافيز. وفي غمرة تصاعد الحراك الشعبي المناهض للرئيس نيكولاس مادورو، شكل حزبا معارضا مع بعض رفاقه، وسرعان ما انتُخب نائبا، ثم اختير رئيسا للبرلمان، مع تصاعد الحراك الشعبي ضد الرئيس مادورو، وبذلك يكون قد أصبح في أعلى السلم، ما جعل واشنطن تضع عيونها عليه، وتجعل منه رئيسا لحكومة مؤقتة في مواجهة مادورو الذي كان قد أعيد انتخابه في عملية وصفتها المعارضة بأنها "مزوّرة وغير شرعية"، وندّدت بها الولايات المتحدة التي وجدت في غوايدو رجلها الذي طالما بحثت عنه، رغم أن معارضي مادورو المخضرمين من رجال الأحزاب التاريخية لم يكونوا في وارد القبول بزعامته، لكنهم انصاعوا لرؤية واشنطن التي اعتقدوا أنها وحدها تملك أوراق اللعبة في فنزويلا.
هكذا رسمت واشنطن سيناريو تغيير فنزويلا، وأمام أنظارها بحيرات النفط الفنزويلية الشاسعة، (الاحتياطيات النفطية الفنزويلية أكثر من 303 مليارات برميل بحسب وحدة أبحاث الطاقة في واشنطن). وللشروع بتنفيذ هذا السيناريو، سعت إلى تهيئة إجماع دولي من حول غوايدو، وضمنت له اعتراف 60 دولة، ووضعت في يديه ملايين الدولارات من الأصول المالية الفنزويلية المجمّدة، وتعاونت المخابرات المركزية معه في التخطيط لعمليات سرّية قصد إطاحة مادورو، بينها أكثر من محاولة انقلابية كان نصيبها الفشل، كما نظّمت من أجله حملات إعلامية وسياسية عريضة في القارّتين، اللاتينية وأوروبا، وأيضا في أروقة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، لتلميع صورته وإبرازه بطلا منقذا للديمقراطية في البلد اللاتيني الواقع تحت سيطرة اليسار.
وبجهل فائض بأوضاع فنزويلا، ظلت واشنطن تراهن على دور غوايدو القيادي المفترض أربع سنوات وثلاثة أشهر، حتى اكتشفت أن حسابات الحقل غير حسابات البيدر، وأن غوايدو لم يتقن الدور الذي عهدوا به إليه، وفشل حتى في تجميع قوى المعارضة التي لفظته، في آخر المطاف، من بين صفوفها، وقبلت بالدخول في حواراتٍ مع حكومة مادورو برعاية دولية، للوصول إلى صيغة تضمن حصول حالة من الانفتاح الديمقراطي في البلاد، وساعد نشوب حرب أوكرانيا وحاجة أميركا إلى الحنفية النفطية الفنزويلية لتعوّض بعض ما تخسره على حلفائها الأوكرانيين في جعل واشنطن تركل غوايدو، وتميل نحو تطبيع العلاقة مع كراكاس ولكن تحت شروط محدّدة.
عند هذا المنعطف، أسقط في يد غوايدو، وشرع يحاول ترميم ما انكسر، وكان أن خرج من بلاده متخفّيا، هاربا، وعبر الحدود إلى كولومبيا مشيا على قدميه، بدافع إجراء اتصالات بخصوص قضية بلاده، كما قال، حيث كانت العاصمة الكولومبية بوغوتا تستضيف مؤتمرا دوليا بخصوص فنزويلا، لكن السلطات الكولومبية لم تسمح له بالبقاء، حيث تم تسفيره على متن طائرة تجارية إلى الولايات المتحدة. ولحظة هبوطه في مطار ميامي، لم تكن معه سوى حقيبة ظهر صغيرة ألقاها على كتفه، ولم يجد أمامه السجادة الحمراء التي كانت قدماه تطآنها في سفراته السابقة إلى الولايات المتحدة، ولم يكن في استقباله لا ممثل عن البيت الأبيض ولا عن وزارة الخارجية، ولا أحد من أعضاء الكونغرس الذي كانوا روّجوا قيادته مشروع تغيير. ولم يحضر أحد من رجال المعارضة المقيمين في المنفى، ولا حتى سفير حكومته المؤقتة. وحده موظف دائرة الهجرة كان في انتظاره، وأجرى معه استجوابا سريعا قبل أن يمنحه إذنا بإقامة مؤقتة، ريثما يُنظر في أمر قبوله لاجئا! وقد وصف أحد الصحافيين الشهود منظر غوايدو عند وصوله بأنه "كان مثيرا للشفقة والرثاء، إذ بدا مضطربا، حزينا، شاحب الوجه، مثل شخصٍ ربح باليانصيب جائزة المليون دولار، ثم بدّدها في بضعة أيام، قبل أن يصاب بالجنون".
سألتُ ناشطا فنزويليا عن سر نكوص الفنزويليين عن دعم غوايدو، أجابني: اكتشفنا من تجربتكم في العراق حقيقة الديمقراطية التي يريد الأميركيون صنعها في بلادنا. ألا تكفي تجربتكم المرّة لإقناعنا بنوايا الأميركيين وأفاعيلهم، نحن معارضون لمادورو، لكننا نرفض أن تتحكّم واشنطن فينا. والتغيير في فنزويلا لن يحققه سوى الفنزويليين أنفسهم إذا ما أرادوا.
السؤال الأخير: هل يتعظ من هم على شاكلة غوايدو من رجال الطبقة الحاكمة في هذا البلد العربي أو ذاك ممن صنعتهم هذه العاصمة أو تلك، وهل سيمكنهم الهرب حاملين حقائبهم على ظهورهم عندما ندقّ الساعة؟
شعب السودان محشوراً بين زعيمين
ليس أكثر استنزافا للدم من أن تعمد "العسكريتاريا" الحاكمة في أيما بلد إلى ممارسة لعبة القوة والغطرسة في مواجهة بعضها البعض الآخر. وليس غريبا أن تحدُث هذه الممارسة في السودان، البلد الذي نُكب بحكم العسكر أكثر من عشر مرّات منذ الاستقلال، وبطلا اللعبة هذه المرّة هما القائد العام للقوات المسلحة الذي تتبعه قوات الجيش النظامي، عبد الفتاح البرهان، وزعيم مليشيا الجنجويد التي تحوّلت إلى جيش موازٍ اتخذ اسم "قوات الدعم السريع" محمد حمدان دقلو (حميدتي). وكان هذان الزعيمان قد تقاسما السطوة والنفوذ والامتيازات، إذ أصبح الأول رئيسا للبلاد، والثاني نائبا له. وسيطرا على قطاعات تجارية واقتصادية لتمويل قواتهما ولمنفعتهما الخاصة، ثم كان أن اختلفا على أكثر من شأن، ووصلت العلاقة بينهما إلى مواجهة مباشرة جعلت كلا منهما يكايد صاحبه، ويحاول أن يسبقه في الفوز بالجائزة الكبرى، الهيمنة الكاملة على السلطة والمال والقرار، خصوصا بعد إعلان "الاتفاق الإطاري" مع القوى المدنية التي كانت طوال الفترة الماضية تُغالب الوقت، وتسعى إلى تشكيل حكومة انتقالية توحّد قوات الجيش والدعم السريع، وتضعهما تحت إشراف الحكومة.
وفي انتظار إنجاز ما اتُفق عليه، حدث ما لم يكن في الحسبان، إذ حرّك حميدتي قواته للسيطرة على السلطة، وشرع في تنفيذ الفصل الأكثر دمويةً في مواجهة صنوه اللدود البرهان. وساعيا، على ما يبدو، إلى إرباك الوضع وإجهاض الاتفاقات المعلنة. وردّ البرهان على حميدتي بتحرّك مضادّ رفع درجة الخطر في الشارع السوداني إلى أقصاها، فيما وجدت القوى المدنية أن خطوة قيام حكم انتقالي أصبحت في حكم المنسية، أو ربما مُلغاة، بحكم ما استجدّ على الأرض من وقائع، ولم يعد أمامها سوى الدعوة إلى وقف نزيف الدم، والطلب من الزعيمين النافذين التصالح من جديد، والعودة إلى نقطة الصفر. كذلك طالبت كومة النداءات الصادرة من الشرق والغرب بوقف القتال، والتفاوض والحوار من أجل حقن الدماء البريئة، لكن ذلك كله لم يلق استجابة مع إعلان البرهان "أن لا تفاوض، ولا حوار، قبل حل مليشيا حميدتي"، وإشارة حميدتي نفسه: "لا نعلم متى تنتهي (هذه المعركة)، وكيف ستنتهي"، يكونان بذلك قد قطعا خطّ الرجعة، وقرّرا المضي في اللعبة الماكرة، وإبقاء السلاح في اليد، ربما إلى أن يمكن لأحدهما أن ينقضّ على الآخر، ويلقي به خارج الحلبة. أما شعب السودان المغلوب على أمره، فقد وجد نفسه، وسط هذه التداعيات، محشورا بين الزعيمين، ولا حول له ولا قوّة.
ونظرة عابرة على المشاهد الأولى لتراجيديا الدم التي خرجت من الخرطوم في الأيام الأولى للصراع أفادتنا بسقوط عشرات القتلى ومئات الإصابات من الجانبين المتحاربين، ومن مدنيين كثيرين أيضا، وضعتهم أقدارهم وسط الرصاص، وأنذرتنا أن استمرار "المنازلة" على هذا النحو سوف تكون حصيلته مزيداً من الخسائر في بلدٍ منكوبٍ يعاني أصلا من انهيار اقتصاده، وتصاعد العنف بين قبائله. وقد ألحقت "العسكرتاريا" به من الشرور والخطايا ما يذكّرنا بصندوق باندورا المروي عنه في الميثولوجيا الإغريقية. ومع ذلك هي مصرّة على الإمساك بتلابيبه إلى أبد الدهر!
ومع كل ما سجّلته تلك الوقائع ومشاهد الدم، ثمّة أمل في أن تتواصل الضغوط الإقليمية والدولية لتجبر الزعيمين اللدودين اللذين يغامران بمصائر أبناء جلدتهما على وقف القتال، والقبول بالتفاوض والحوار، خصوصا إذا ما أدركا أنهما سيكونان من بين الخاسرين، وربما تدفعهما المخاوف المتبادلة إلى أن يجنحا إلى التفاهم في آخر المطاف، ويتفقا على خطّة ما لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وبالطبع، يحتاج ذلك إلى وقت لاختراع حلولٍ ذات طابع استثنائي، قد يكون من بينها القبول بوجود قوة حفظ سلام عربية تؤسّس لفرض الأمن، وتعمل على قيام حكومة انتقالية تقيّد دور العسكر، وتحدّ من تدخّلهم في السياسة. لكن، يا ترى، هل يقبل البرهان وحميدتي بحلّ من هذه "القماشة"، خصوصا أن كلا منهما يعتقد أن لديه الوقت الكافي لاستمرار اللعبة، وانتظار نتيجة لصالحه، حتى لو أدّى ذلك إلى إراقة مزيد من الدم، فيما ليست لدى الوسطاء ودعاة التفاوض والحوار قوة إلزام يمكن فرضها، وكل ما يمتلكونه هو الساعات التي يراقبون بها الوقت الذي ربما يطول إلى ما شاء الله!
بالمختصر المفيد، ليس لأشقائنا في السودان سوى أن يكابدوا أكثر، كي يصلوا إلى اليوم الذي يشبه ما قال عنه صانع التراجيديا اليوناني أسخيلوس إنه يأتي ليزيل الألم، ويفرض الحكمة، عندها يكونون قد شرعوا يتنفّسون الصعداء.
رمضان العراق بعيون غربية
يفرد توماس لييل الذي عمل في الإدارة المدنية البريطانية التي حكمت العراق في بدايات القرن المنصرم في مذكّراته فصلا خاصا عن شهر رمضان في العراق، يضمّنه انطباعاته عن صوم المسلمين والمشاهد الرمضانية التي استأثرت باهتمامه في المدن والقرى العراقية آنذاك، مشيرا الى أن صيام رمضان شكّل له ولأوروبيين كثيرين قُدّر لهم أن يقيموا زمنا في الشرق "ظاهرة مؤثّرة على مجمل حياتهم اليومية، ذلك لأن الذين يعملون بمعيتهم من المسلمين يصبحون، بحكم صيامهم، أكثر كسلا وفتورا في عملهم في هذا الشهر، وتكثر حالة الإنهاك لديهم، كما تزداد حدّة غضبهم وانفعالاتهم لدى مواجهتهم أبسط الأشياء". ويردّ على ما يراه الغربيون أن الصيام في الشرق مجرّد عملية استعراضية، إذ يُباح للصائمين تناول الطعام والشراب طوال ساعات الليل"، فيقول إنها "تهمةٌ ناشئةٌ عن الجهل بحقائق الأمور، حيث إن مجرّد ملاحظة ما يُحدثه الصوم في جسم الإنسان يُغني عن أي دليل، إذ قد يصادف مجيء رمضان في بعض السنوات في فصل الصيف الذي ترتفع فيه درجات الحرارة نهارا إلى مستوياتٍ عالية، فيما تمتدّ فترة الصوم من الفجر وحتى الغروب، من دون أن تصل إلى فم الصائم قطرة ماء. ولذلك، تعمد الحكومة إلى تقليص ساعات العمل بهدف إعطاء العاملين قدرا من الراحة.
ويصف لييل مشهد رمضان في أحياء بغداد الشعبية في عشرينيات القرن الراحل عندما يقترب موعد الإفطار، حيث تكون المقاهي قد امتلأت بالصائمين الذين يبدو عليهم الإنهاك والتعب، وهم يتجاذبون أطراف الحديث، من دون أن يسمحوا لأنفسهم بالشكوى أو التذمّر، ولو فعلوا ذلك لكانوا اقترفوا إثما، إذ إن أية علامة منهم على استعجالهم موعد الإفطار تقمع منهم بصرامة!
ويبدو المشهد أكثر إثارة عندما يسمع مدفع الإفطار أو صوت المؤذن، حيث يبدأ عمّال المقهى بإحضار "استكانات" الشاي الى زبائنهم على عجل، وحيث إن عدد العمّال عادة ما يكون محدودا، فإنهم لا يستطيعون تلبية كل الطلبات بسرعة. وهنا تبدو الطيبة لديهم، إذ قد يتأخر بعضهم عن الإفطار، ولكن من دون أي تذمّر، وغالبا ما تكون عبارة "الحمد لله" على شفاه الجميع. ورغم أن الصائم يكون متلهّفا لشرب الشاي، إلا أنه يأخذ "الاستكان" بتأنٍّ ويبقيه في يده لحظات دلالةً على عدم ضجره من الصوم، ثم يتمتم بنبرة هادئة "بسم الله الرحمن الرحيم"، قبل أن يرتشفه ببطء، ثم يلحقه بأول سيجارة أو أول ارتشافة من "النارجيلة" إذا كان من المدخّنين. ويفسّر الكاتب هذه القدرة على التحمّل بأنها "واجب على المسلم أداؤه، أما أولئك الذين يفشلون في أداء هذا الواجب فإنهم يعرضون أنفسهم لانتقاداتٍ حادّةٍ تعبر عن عدم الرضا عنهم".
وعند انتهاء شهر الصيام وحلول العيد، تظهر حالة تفجّر عفوي للحيوية والنشاط لدى أناس متصالحين مع ذواتهم إلى الحد الأقصى، وهم يجدون أنفسهم فجأة وقد تحرّروا من حالة الانضباط القاسي في كبح الملذّات الصغيرة الذي فرضوه على أنفسهم طوال شهر رمضان.
وفي واقعةٍ شهدها لييل في إحدى القرى الواقعة على ضفاف النهر، كان الناس يتجمّعون عند غروب شمس التاسع والعشرين من رمضان، ليراقبوا ظهور هلال العيد، ولم يكن في استطاعتهم كتمان لهفتهم، متطلّعين إلى السماء، وهم يجوبون المكان مجموعاتٍ، وبعضهم يصعد الى السطوح، ليكون بمقدوره الرؤية على نحو أفضل. وتمرّ دقائق قبل أن يسود صمتٌ مُطبق، تتبعه صيحةٌ مفاجئة، مفادها بأن الهلال قد ظهر. في حينها، كان الجمع يتفرّق على عجل، وعلى وجه كل واحدٍ ملامح ارتياح مكبوت. وتدافع الشيوخ المعمّرون والشباب والصبيان بالمناكب، كلّ منهم يسعى إلى أن يصل إلى مكانٍ ما، وكان وجه السماء في تلك الليلة متلبّدا بغيوم كثيفة. ولاحظت علامات اللهفة والقلق على الوجوه، وهم يأملون أن ينقشع الغيم عن بقعةٍ ما من السماء، ليظهر الهلال فيها. وأخيرا ظهر الهلال خيطا رفيعا من الضوء، كان محجوبا تحت الغيوم، وهرول عديدون ممن اعتلوا سطوح المنازل، راجعين فيما تصاعدت صيحات "الحمد لله .. الله أكبر.." من كل جانب، مع قهقهات فرح ومسرّة. وشرع بعضهم في أداء الصلاة غير عابئين بالصخب المتصاعد من حولهم، وسارع آخرون إلى تبادل القبلات، مهنئين بعضهم بعضا بحلول العيد، ومن كان يحمل بندقيته أطلق الرصاص تعبيرا عن فرحته، من دون أن يفكّر بما يمكن أن يسبّبه ذلك من خطر على المحيطين به.
لا ينسى لييل أن يؤكّد في خاتمة الفصل الذي أفرده لرمضان في مذكّراته التي حملت عنوان "المخفي والمعلن في بلاد ما بين النهرين" أن تلك الساعات التي قضاها في مشاركة العراقيين احتفاءهم بشهر الصوم كانت بالنسبة له من أجمل الأوقات التي احتفظت بها ذاكرته.
الأسئلة الصعبة وراء اتفاق بكين
عبد اللطيف السعدون
ثمّة كثير مما قيل ويقال عن الاتفاق "المفاجأة" الذي عقد بين السعودية وإيران برعاية صينية، وقد غرق بعضُهم في التفاؤل إلى درجة التوّهم أن الأمنيات التي تدور في رؤوسهم قد تحوّلت إلى حقائق، وأنّ الملفات العالقة بين العرب وإيران قد وجدت طريقها إلى الحلّ النهائي، وكلّ شيء قد تم على ما يرام، ولم يبق سوى تبادل السفراء كي تدرّ المنطقة سمناً وعسلاً!
وبغض النظر عن ذلك، لا يمكننا التقليل من إيجابيات الاتفاق وحسناته، فهو يوفّر، إذا ما خلصت النيات، جواً هادئاً للحوار الهادف بين أطرافٍ بينها ما صنع الحدّاد، وأنّ يشكّل فعلاً بادرةً لتغيير حال المنطقة، والعمل على إرساء حالة وفاق تخدم شعوبها، لكن ثمّة أسئلة صعبة ما زلنا نبحث لها عن إجابة، هل إيران مستعدة للتخلي عن منهجها في "تصدير الثورة" الذي اعتمدته منذ مولد "الجمهورية الإسلامية" قبل أكثر من أربعة عقود، وكيف ستتصرّف مع الفصائل المليشياوية المرتبطة بها والتي تشكّل درعها المهيمن على أكثر من عاصمة عربية، وبالتالي كيف سيكون موقف هذه الفصائل، هل سيرضى قادتها بحلّها وقد أصبحت مصدر رزق وهيبة لهم، أم سيحاولون التماهي مع الاتفاق والتظاهر باستقلاليتهم عن الجهة الراعية، وهم يتقنون فن "التقية" جيداً، ويتعاملون من خلاله؟
طرحت هذه الأسئلة على صحافي إيراني صديق يقيم في المنفى، أجاب: لو تخلّت إيران عن منهجها العدواني المعلن والموثق في دستورها وخططها الاستراتيجية فسوف تكون قد شربت كأس السم للمرّة الثانية، واقتربت من اعتماد منهج براغماتي يلتزم بمنطق الدولة، عند ذاك سنكون أمام إيران جديدة، إيران أخرى، عاقلة ومتآلفة مع محيطها، ومتفاهمة مع العالم، وعند ذاك لن تكون هناك مشكلة، لكن ما هو معروف أنّ إيران خميني وخامنئي وقاسم سليماني غير قادرة على فعل من هذا النوع إلا إذا حدثت معجزة، ولسنا اليوم في عصر المعجزات.
إذاً، ما الذي دفع إيران إلى القبول بالاتفاق؟ هناك ثلاثة عوامل: التكلفة المالية العالية التي تتحمّلها جرّاء تدخلاتها في دول المنطقة ورعايتها فصائل ومليشيات وتزويدها بالأسلحة والمعدّات في وقت تعاني فيه من تدهور اقتصادي واضح جرّاء العقوبات. تفجّر حركة احتجاجات شعبية مطالبة بالحرية والأمن والغذاء، وحفاظها على وتيرة متصاعدة تهدّد بقاء النظام وديمومته رغم عمليات القمع والقتل الممنهج. محاولة الظهور أمام المجتمع الدولي أنها قد تراجعت عن سياساتها المتطرفة، وأنّها حاضرة لتطبيع علاقاتها مع الجميع على قاعدة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، واستثمار هذا العامل في إيجاد جو يسمح بالعودة إلى الاتفاق النووي. أضف إلى هذا أنّ في داخل المنظومة الحاكمة فريقاً "إصلاحياً" وجد فرصته مع الانتفاضة الأخيرة للدفع باتجاه إعادة النظر في بعض ما كانت تعتبره "الجمهورية الإسلامية" من المسلّمات التي لا يمكن تجاوزها.
وكيف ترى موقف مليشياتها الموجودة في أكثر من بلد عربي في ضوء الاتفاق؟ يعطيك الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، الإجابة "هذا الاتفاق لن يكون على حسابنا، ونحن واثقون أن الطرف الثاني (إيران) لا يخلع أصحابه، وأن الجمهورية الإسلامية لا تقوم مقام الشعوب، ولا تتخذ قراراتٍ نيابة عنا". كذلك ما أكّده أحد رجال "الإطار التنسيقي" أن الفصائل غير ملزمة باتفاقاتٍ تحصل بين الدول الأخرى.
وماذا عن الملفات العالقة؟ لا أتوقع تغييراً دراماتيكياً في هذا الشأن، لكن سوف تكون هناك حالة "تبريد" وتهدئة. قد تجعل إيران من الحوثيين كبش فداء في تطوير علاقتها بالسعودية، وسوف تكون السعودية ممتنّة لتجاوب إيران معها في طيّ صفحة هذا الملف، بما يؤدّي إلى إنهاء الحرب التي كلفت الكثير. ولبنان أيضاً سوف يتحلحل الوضع فيه على نحو يتيح اعتبار حزب الله شأناً داخلياً يترك للفرقاء المحليين أمر التعامل معه. والإشارة هنا إلى أنّ الحزب بدأ يخفّف من لهجته المعادية للسعودية، مع ملاحظة أنّ السعودية نفسها فقدت اهتمامها بلبنان كما كانت في السابق، وبدأت تفكّر بقضايا أكثر أهمية بالنسبة لها. وبالنسبة لسورية أرى أنها مقبلة، في ظلّ الاتفاق السعودي - الإيراني أو من دونه، على "مقاربة" تعيدها إلى جامعة الدول العربية، ومن ثم إيجاد "توليفة" خاصة بها، تضمن بلورة صيغة تكون مقبولة لدى الأطراف المتورّطة هناك.
يبقى العراق، وهو البلد الأكثر حساسية بالنسبة لإيران التي تعتبره "قدس الأقداس" في مشروعها الذي تسعى إلى تحقيقه، ونرى من الصعب التكهن بإمكانية حدوث اختراقٍ من جهة الهيمنة الإيرانية المباشرة التي عصفت به طوال الأعوام العشرين السالفة، وتتحكّم في اقتصاده ومجتمعه، وحتى في قراراته السيادية، وقد نحتاج وقتاً أطول قبل أن نلمس تغييراً ما فيه.
بالمختصر المفيد، نحتاج مزيداً من الانتظار والترقّب، كي نرى كيف ستسير الأمور.
نهاية حقبة أم حقبة لا نهاية لها؟
عبد اللطيف السعدون
بشّرتنا سفيرة أميركا في بغداد، ألينا رومانوفسكي، بأن بلادها تتطلّع إلى حقبةٍ جديدةٍ في العلاقة مع العراقيين لـ20 سنة مقبلة أخرى، وقد رأيناها تطوف على مسؤولي البلاد من رؤساء ووزراء ووكلاء ومستشارين تبلغهم البشرى، وتراقب أداءهم، ووصل عدد زياراتها في فترة قياسية إلى 44 زبارة، ثم غيّرت وجهتها نحو المحافظات، وبدأت بمحافظة الموصل، والحبل على الجرّار.
ولم ينافس رومانوفسكي في جولاتها تلك سوى صنوها سفير إيران، إيرج مسجدي، الذي لم يترك مسؤولا نافذا لم يزره، وبعضهم كان يستدعيه إلى مكتبه ليبلغه وصايا "الولي الفقيه"، وهذه الوصايا أوامر. ويُحسَب لحكومة بلاده أنها كانت السبّاقة في إعلان تبعية العراق لها، واعتبار بغداد إحدى عواصمها!
ولكي تكتمل "البشرى" بالأعوام العشرين المقبلة، حطّ في بغداد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، ليطمئن، على ما يبدو، على حركة الإصلاحات التي شرعت بها "حكومة الخدمة الوطنية"، وسنحت له الزيارة أن يلتقي زعيمين مليشياويين موضوعين على قائمة الإرهاب، وخاضعين لعقوبات أميركية، قيس الخزعلي (عصائب أهل الحق) وريّان الكلداني (حركة بابليون)، وظهر معهما في موقفٍ لا يُحسد عليه، إذ وقف الأول إلى يمينه، والثاني الى شماله، وقيل إنه وقع ضحية مقلب دبّره رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، الذي دعاهما إلى حفل تكريم غوتيريس، بهدف إسباغ نوع من "الاعتراف الدولي" بهما، وهذا ما لمح إليه الخزعلي نفسُه!
أثارت هذه التداعيات مشاعر اليأس لدى العراقيين الذين كانوا يمنّون نفوسَهم بأن سنواتهم العشرين المقبلة ستكون أفضل، وأنهم مقبلون على حقبةٍ جديدةٍ تنسيهم الأعوام العشرين السالفة التي نخرت في جسد البلاد جروحا لا قِبل لهم بمعالجتها، لكن الوقائع الأخيرة أكّدت لهم أن لا نهاية لتلك الحقبة في الأفق، كما لا بداية منظورة لمرحلة جديدة تؤسّس لما هو أفضل.
وهكذا ازداد شعور العراقيين بأنّهم سيظلون عالقين على درب معاناتهم فترة أطول، لافتقادهم القدرة على تغيير أنفسهم، ولضعف المعارضة الشعبية المنظّمة، وكلا الأمرين يؤدّيان الى متلازمة مَرضية غاية في السوء، تنعكس اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً على مجمل الوضع في البلاد.
صحيحٌ أنّ هناك ضرباً من الضجيج والصراخ العالي الذي تمتلئ به حسابات مواقع تواصل وصحف وفضائيات يعكس حالة رفض وتحدٍّ، لكنه، في النهاية، يصبّ في خيبة أمل كبيرة، وفي استسلامٍ مهينٍ أمام السلطة المهيمنة على القرار، والتي ألفت هذا الضجيج والصراخ وتآلفت معه، بل شاركت فيه حتى تمكّنت من أن تحتويه، وهذا ما اختبرناه في "انتفاضة تشرين" التي لم تتقدّم نحو تبنّي مشروع ثوري ناجز، إنما تحوّلت إلى حركة احتجاجات ذات أفق محدود، لا تتعدّى مطالباتٍ ثانويةً بالحصول على خدمات فئوية قاصرة، كتعديل قانون أو إطلاق حزمة تعيينات أو زيادة مرتبات المتقاعدين، وهذا ما جعل "النخبة" الحاكمة تتماهى مع ما تريده حركة الاحتجاجات، وتتكيّف مع الأزمة، لغاية استعادة قدرتها على الوثوب والتمركز من جديد، وهذا ما فتّق ذهنها عن فكرة "حكومة الخدمة الوطنية" التي كانت أولى خطواتها إسقاط مطلب القضاء على المليشيات وحصر السلاح بيد الدولة، وكذا التراجع عن مطلب "الانتخابات المبكّرة" التي دعا إليها من ظن أنها تمثل نوعاً من الحل.
يزيد في الطين بلّة أنّ أحزابنا "الثورية" التي سادت زمنا ما تزال تحمل عقلية الماضي، وتعاني من قصورٍ في رؤية ما يحيط بنا، وفي إيجاد المعالجات والحلول المطلوبة لمعاناتا اليومية، وأغلب القائمين عليها إما يعيشون في منافيهم، مضطرّين أو مختارين، وهم في الحالتين يعيدون، على نحوٍ أو آخر، ما يعانيه مواطنوهم في الداخل من مظالم، أو هم داخل الوطن لكنهم في غربة عن مشكلاته وهمومه، يغالبهم الحنين إلى سلطة سالفة أكل عليها الدهر.
هذا كله يعني أنّ السنوات العشرين الماضية المشحونة بالمرارات لم تترُك أثرا كافيا عندنا للدفع باتجاه التغيير. تحضُرنا هنا مقولة الفيلسوف الفرنسي، ألكسيس دي توكفيل، في أنّ الماضي عندما يكفّ عن أن يلقي ضوءاً على المستقبل، سوف يستكين المرء لحاله، ويبقى في الظلمة أبداً.
لا طريق أمامنا، إذاً، غير السعي من أجل أن تتجذّر عندنا حالة اليقين على أننا قادرون على التغيير، وعلى إيجاد طاقة جماعية لإعطاء معنىً يُشعر المواطن العادي أنّه معنيّ بالسعي من أجل التغيير، معنيّ بالمشاركة فيه، ومعنيّ بالدفاع عنه، وطريق الألف ميل يبدأ بخطوة.
في تذكّر هوغو تشافيز
عبد اللطيف السعدون
يروي الشاعر سعدي يوسف قصة لقائه بالزعيم الفنزويلي الراحل هوغو تشافيز في مهرجان للشعر أقيم في العاصمة الفنزويلية: "كان في منتهى اللطف والمرح، محتفيا باسما، (..) مرحبا بك، أنت في بلدك، أنا أعرف المأساة التي حلّت بالعراق بعد الاحتلال، اعتبر كلامي هذا دعوة لك للإقامة في كراكاس، ليس عليك سوى إشعار سفارة فنزويلا برغبتك، أنت تعرف أن فنزويلا والعراق أسّسا أوبك، سوف يستعيد العراق حريته بنضال أبنائه، ونحن معكم في هذا النضال". .. يعقّب سعدي: "سوف يظلّ الناس يحتفون بذكراه محرّرا من الذل والفقر.. لقد فقدنا نحن العرب نصيرا لنا".
بعد عشر سنوات على رحيله، يظلّ هوغو تشافيز عندنا، نحن العرب، شخصيةً عصيّةً على النسيان على خلفية مواقفه وسياساته المناصرة لنا، لكن كثيرين منا قد لا يعرفون أنه تعرّف إلى "العرب" مبكّرا، حيث كان يشاركه العيش في موطنه الأول في مراعي الجنوب الفنزويلي الشاسعة عرب كثيرون ممن هجروا بلادهم طلبا للعيش الآمن، منهم اللبناني عدنان رضوان الذي كان صديقا لأسرة تشافيز، المعلم في مدرسة القرية التي يدرس فيها هوغو الصغير إلى جانب أولاد عدنان رضوان وأبناء عرب آخرين، وكان عدنان يمتلك متجرا صغيرا جمع فيه بين خياطة الملابس وبيع الحاجيات المنزلية الضرورية، وكثيرا ما كان هوغو يتردّد عليه مبعوثا من أسرته لشراء بعض احتياجاتها. وكانت عبارة "صديقنا العربي"، والمقصود به عدنان رضوان، تتردّد كثيرا على مسامع تشافيز الصغير، وقد أعطته الرابطة الحميمة التي ربطت بين أبيه ورضوان، وبينه وبين أقرانه العرب، انطباعا ظلّ راسخا عنده أن العرب والفنزويليين أشقاء، يواجهون ظلما مشتركا مصدره الذين يحكمونهم ويتحكمون في مواردهم، غرباء عنهم أو من أبناء جلدتهم.
منذ ذلك الوقت، تعلّم تشافيز أن "يحبّ العرب، ويحبّ ثقافتهم وتراثهم"، بحسب تعبيره هو. مرّة سأله صحافي خبيث: من أين جاءك "الانتماء العربي؟" كان جوابه أن ما يجمع الأميركيين اللاتينيين والعرب موروث ثقافي مشترك، وإحساس بالظلم والحرمان، والإيمان بالقدرة على الخلاص من نير العبودية.
وجد العرب المقيمون في فنزويلا، والذين يقترب عددهم من مليونين، في تشافيز ما افتقدوه في زعامات بلادهم
كانت شخصية تشافيز كارزمية، يسمّيها باحث أميركي "الشخصية الأوسع من الحياة"، سطع نجمُه بعد نهاية الحرب الباردة وتراجع السياسات الراديكالية، ليسجّل بدء حقبة جديدة لليسار العالمي، ولليسار في القارّة الأميركية اللاتينية على وجه الخصوص، وكان الأكثر نفوذا بين قادة هذه القارّة والأكثر تأثيرا على خطط الولايات المتحدة وسياساتها، وكان سرّ قوته الحقيقية في علاقته الحميمة بفقراء بلاده الذين احتضنوه ووقفوا خلفه، بعدما وفّر لهم برامج التعليم المجاني والخدمات الصحّية المجانية، وفرص العمل، كما أتاح لهم الانضمام إلى دائرة صنع القرار بعد عقود من الإذلال والإقصاء المتعمّد، وذلك عبر المجالس المحلية واللجان الشعبية المنتشرة في كل أرجاء البلاد.
وقد وجد العرب المقيمون في فنزويلا، والذين يقترب عددهم من مليونين، في تشافيز ما افتقدوه في زعامات بلادهم، ولذلك أعطوه أصواتهم في صناديق الاقتراع، وهتفوا له، وأكبروا فيه "عروبته"، وحزنوا لرحيله. وفاقت شعبيته في العالم العربي شعبية بعض الحكّام، وتابع أخباره الناس العاديون في فلسطين والعراق ولبنان الذين انتصر لهم ووقف معهم، وهو الذي طرد سفير إسرائيل في فنزويلا في أعقاب العدوان على غزة عام 2009، ووصف إسرائيل بأنها "دولة قاتلة وضالعة في عملية إبادة"، ودعا إلى إحالة رئيس حكومتها إلى محكمة الجنايات الدولية.
وفي سفراته إلى البلاد العربية، تعرّف عن كثب إلى تقاليد العرب وعاداتهم، ففي السعودية شارك في "رقصة العرضة" وركب الجمل وأعجبته الصحراء، حيث الأصالة والبساطة والانفتاح. وفي بغداد، سار مع صدّام حسين في شوارعها التي استقبلته جماهيرها بمحبّة وود، وكذا في الجزائر وطرابلس وغيرهما من مدن وحواضر عربية أخرى.
له أصدقاء عرب شاركوه في نشاطاته السياسية قبل وصوله إلى الحكم، وتسلموا لاحقا مناصب رسمية رفيعة: اللبناني ريمون قبشي الذي كان مستشاره للشؤون العربية، والسوري طارق العيسمي الذي شغل أكثر من منصب وزاري، آخرها وزير الداخلية والعدل، والنائب العام الحالي، طارق وليم صعب، وهو الشاعر باللغة الإسبانية الذي قال مرّة إنه يشعر بالأسى، لأنه لا يستطيع التعبير شعرا عن نفسه بلغة آبائه وأجداده، وغيرهم من ناشطين عديدين في صفوف الحزب الاشتراكي الموحد الذي يقوده اليوم خلفه نيكولاس مادورو.
لعبة القطّ والفأر
بين واشنطن وبغداد
عبد اللطيف السعدون
تذكّرنا لعبة القط والفأر الدائرة اليوم بين واشنطن وبغداد بمسلسل توم
وجيري الذي كنا نتابع حلقاته في طفولتنا بشغف ولهفة، حيث يلاحق القط
توم الفأر جيري ليصطاده، لكن الأخير يراوغ ويهرُب، ليختفي بعيدا عن
أعين توم الذي يعاود البحث عنه، وسرعان ما يجده مُختبئا في زاويةٍ ما،
هنا يحاول الانقضاض عليه، لكن جيري يهرُب ثانية، وهكذا تتواصل اللعبة
زمنا، توم يتقدّم وجيري يهرُب، إلى أن ينجح توم في الإمساك بضحيته.
الفارق بين ما شاهدناه في طفولتنا وما نشاهده على الطبيعة اليوم أن
القط توم (الولايات المتحدة) تُمسك بالفأر جيري (العراق) منذ 20 عاما،
والأخير يحاول الفكاك منها بمراوغتها تارة، ومغازلتها ثانية، والتوسّل
إليها ثالثة، لكنها تأبى أن تتركه، فهو الكنز الذي سعت للحصول عليه
مديدا حتى استحوذت عليه.
شهدنا في الأسبوع الأخير فصلا جديدا من هذا المسلسل، ترصُد العين
الأميركية مليارات الدولارات، تنقل على دفعات من بغداد إلى طهران،
خلافا لقواعد التعامل المعمول بها دوليا. ويعرف العالم كله أن معظم تلك
المليارات يصبّ، في النهاية، في خدمة المشروع الإقليمي لدولة "ولاية
الفقيه"، والبقية تدخل في عمليات غسل أموال لصالح قادة مليشيات وحيتان
فساد. تطلب واشنطن من بغداد وقف تلك التعاملات، بغداد تراوغ في
الالتزام بالطلب الأميركي، تغضب واشنطن من مراوغات بغداد وتهدّدها
بعقوبات. أول الغيث كان قرار البنك الفيدرالي الأميركي الذي يحتفظ
بواردات مبيعات النفط لديه بعدم الاستجابة للحوالات المالية الصادرة من
العراق إلا في حدود ضيقة. وبعد التأكّد من هوية المستفيد الأخير، يرتفع
سعر صرف الدولار في العراق على حساب الدينار، تلتهب الأسواق وتزداد
معاناة الشرائح الفقيرة، تتصاعد النقمة على دولة "ولاية الفقيه"
ووكلائها، تلوح بغداد بعلاقة اقتصادية أقوى مع روسيا والصين، وتتحدّث
عن خطط مع شركات غير أميركية ولا غربية، لكن هذا غير مسموح به أميركيا،
ترفع واشنطن العصا الغليظة في وجه بغداد، تضطرّ بغداد للتراجع، وتعود
إلى التوسّل بواشنطن لإمهالها، ولو عدة أشهر، لترتيب أمورها.
ترفض واشنطن وتهدّد، تتوسّط عمّان، ويسافر وفد عراقي إلى واشنطن على
عجل، يروّج رجال "الإطار التنسيقي" وزعماء المليشيات الذين صنعوا حكومة
محمد شياع السوداني أن بغداد ستعيد النظر في اتفاقية "الإطار
الاستراتيجي"، وستطلب رحيل العسكر الأميركيين. في اجتماعات واشنطن،
يملي الأميركيون شروطهم، وينصاع العراقيون لها، ويبتلع "وكلاء" إيران
ألسنتهم، وتتصاعد نغمة الحديث في بغداد عن علاقة طيبةٍ مع "الحليف
الأميركي المهم" و"الجار الإيراني المهم"، والوصف هو من وزير الخارجية،
فؤاد حسين، وتنكشف اللعبة أكثر.
يقول المنطق الأميركي: "العراق كله حصّتنا، قاتلنا من أجله، ضحّينا
بعشرات الآلاف من جنودنا، وخسرنا مليارات الدولارات كي نصل إليه، لن
نسمح لأحدٍ بأن ينافسنا في استثماره، حلفاؤنا وأصدقاؤنا فقط هم من
يمكنهم أن يمرّوا من هنا، وعلى العراقيين أن يعوا ذلك جيدا"!
ووفقا لهذا المنطق، فرضت أميركا على العراق "تعميق شراكة استراتيجية في
ظل اتفاقية الإطار الاستراتيجي"، وهذا يعني لجم أفواه "وكلاء إيران"
الذين طالبوا بإلغاء الاتفاقية أو تعديلها، وبقاء العسكر الأميركيين في
العراق إلى ما شاء الله، ولكي تضمن واشنطن غلق "الحنفية" التي تصبّ
مياهها في طهران، ألزمت بغداد بـ"تنفيذ المعايير الدولية لحماية النظام
المصرفي من الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب"!
انتهت اجتماعات واشنطن أيضا إلى دخول "40 شركة أميركية ورواد الصناعة
في مجالات الغاز والكهرباء وتحديث البنية التحتية للكهرباء ومصادر
الطاقة المتجدّدة" على الخط، و"وصول بعثات تجارية أميركية إلى بغداد
لاستكشاف فرص الاستثمار"، و"التزام العراق بمشاريع الربط الكهربائي
الإقليمي مع الأردن والسعودية ومجلس التعاون الخليجي"، هذا كله يعني
سحب البساط من تحت أقدام إيران، وقصم ظهرها وظهور وكلائها النافذين.
غير هذا، هناك من يتحدّث عن تفاهمات واتفاقات سرّية تلزم العراق بالحد
من نفوذ المليشيات، والعمل على حصر السلاح بيد الدولة، على أن يتم
تنفيذ هذ المطلب خلال فترة محدّدة قد لا تتجاوز السنة.
يبقى السؤال: هل يمرّ ذلك كله بسهولة، وهل سيكون بإمكان حكومة السوداني
تنفيذ تعهّداتها هذه في مأمن من شرور أفاعي إيران وحيتانها؟ نعرف
الجواب من تحرّك زعماء المليشيات حتى قبل أن يجفّ حبر ما تم الاتفاق
عليه مع الأميركيين. كتب أبو علي العسكري (كتائب حزب الله): "مواجهة
الأميركيين واجب شرعي لا يحتاج إلى إذن من تنظيم أو غيره".
لن تصمت إيران، إذن، ووكلاؤها في العراق سوف يقومون بالواجب، وسيدفعون
بالعراق إلى الفوضى كعادتهم، أما العراقيون الذين وضعتهم أقدار غاشمة
وسط النيران، فحسبهم الله.
قصص الجاسوسية
بين الواقع والخيال
عبد اللطيف السعدون
أسقطت واشنطن المنطاد الصيني، بعدما أخضعته للمراقبة والتتبع ومعرفة مكوناته، متهمة إياه بالتجسّس
قد يمرّ وقت طويل قبل أن ينكشف سر المنطاد الصيني الذي قطع أكثر من 5000 كيلومتر من بر الصين إلى الولايات المتحدة، والذي تريثت واشنطن في إسقاطه بضعة أيام كي لا توقع شظاياه إصاباتٍ بمواطنين أميركيين، كما قالت، ثم أسقطته بعدما أخضعته للمراقبة والتتبع ومعرفة مكوناته.
قال الأميركيون إن هدف المنطاد الذي طار فوق مواقع عسكرية أميركية حسّاسة هو التجسّس، فيما قال الصينيون إنه "منطادٌ مدنيٌّ يستخدم للبحث العلمي ولمعرفة تقلبّات الطقس، وقد انحرف عن مساره بسبب رياحٍ غير متوقعة"، قد لا نصدّق الرواية الأميركية كما قد لا نصدّق الرواية الصينية. وقد اعتدنا من الجانبين أن يقولا نصف الحقيقة في حالاتٍ تمسّ الأمن القومي لهما. ومهما يكن مبلغ الصدق في الروايتين، تسبّبت الواقعة في إجهاض حدث تاريخي كان يمكن أن يتحقّق، لو تمت زيارة كانت مقررة لكبير الدبلوماسية الأميركية أنتوني بلينكن إلى بكين، حملت الأمل في تخفيف حدّة السخونة التي طبعت العلاقة بين البلدين، ثم ألغتها واشنطن ردّا على حكاية المنطاد، وحاولت الصين أن تخفّف من ردّ الفعل الأميركي، فأقدمت على إقصاء مسؤول هيئة الأرصاد الجوي الذي حمّلته مسؤولية "الخطأ"، وفسّر محللون هذا الإجراء بأن العملية قد فعلها طرفٌ معينٌ من دون معرفة القيادة الصينية، وعلى طريقة أن اليد اليمنى قد تفعل شيئا لا تعرف به اليد اليسرى!
وعلى أية حال، قد تكون الحكاية كلها من حلقات التجسّس المتبادل بين الدولتين الكبريين، وهو أمرٌ مسلّمٌ به، خصوصا عندما يرتفع منسوب التوتر بينهما، وربما تشكّل الواقعة إغراء لكتّاب روايات الجاسوسية ومغامرات العمل السرّي للخوض فيها، والخروج بروايةٍ مثيرةٍ تستقطب القارئ كما استقطبته من قبل رواياتٌ اعتمدت على وقائع تجسّس بين أكثر من دولة ودولة.
عندنا أيضا واقعة تجسّس "طازجة" أخرى، لكنها من نمطٍ مختلف، كشفت عنها سلطات طهران، عندما اعتقلت شخصا شغل مواقع أمنية وعسكرية حسّاسة، جديدها أخيرا منصب مستشار في مجلس الأمن القومي، ومساعد وزير الدفاع، واتهمته بالتجسّس لصالح بلد جنسيته الثانية البريطانية، هو علي رضا أكبري، الذي حُكم بالإعدام ونُفّذ الحكم فيه. وقد يجد الروائي في تفصيلاتها المعلنة، وفي أسرارها الخفية، ما يغريه على إنشاء روايةٍ يمتزج فيها الخيال بالواقع، يتعرّف القارئ من خلالها إلى قدرة هذا "الجاسوس الخارق"، وبراعته في اقتناص المعلومات السرّية، وتسريبها، بهدوء ومن دونما ريبة، إلى الجهات الاستخبارية التي عمل معها حتى سقط في القفص.
وبعيدا عن قصتي "المنطاد الصيني" و"الجاسوس الخارق"، مما يُعرف عن روايات الجاسوسية أنها، في العادة، لا يمكن التنبؤ بنهاياتها بسهولة، إذ كثيرا ما تتسم أحداثها بالغموض والإبهام، وتزخر بما لا يتوقعه الذهن الذي اعتاد التعامل مع المألوف، وما يعرف أيضا أن هذا اللون من الأدب ينقل القارئ إلى عالم الدهشة والغرابة، ويمنحه متعة اكتشاف الأشياء في مواجهة الأسئلة الصعبة، كما يزوّده بجواز مرورٍ إلى ما وراء الكواليس التي قد تبقى سرّية، وتطوى مع الموت، ولا يعرف أحدٌ عنها شيئا سوى صنّاعها الحقيقيين، إذا لم يتوفر لها من يعمل على إعادة إنتاجها بمشاركةٍ من خياله الخصب.
من بين أبرز من عمل في هذا المجال البريطاني ديفيد كورنويل، الذي عُرف باسم جون لوكاريه، الذي كتب أكثر من 20 رواية، نشرت آخرها بعد رحيله، يترك بطلها منصبه الرسمي المرموق في لندن، ليعمل مديرا لمكتبةٍ في مدينةٍ صغيرةٍ تقع على الساحل، ويتعرّف خلال عمله إلى مهاجر بولندي يدخل معه في عمل استخباري محاط بعلامات استفهام كثيرة، كما اشتُهرت رواية أخرى له، أعطاها عنوان "الجاسوس الآتي من البرد"، تروي قصة عميل مزدوج يعمل بين بريطانيا وألمانيا الشرقية إبّان الصراع بين الغرب والمعسكر الاشتراكي. وفي رواية ثالثة عرضٌ لواقعة اغتيال الرئيس الأميركي جون كيندي، مفترضا أن للقاتل علاقة سابقة بالمخابرات السوفييتية (كي جي بي). ولعل خدمة لوكاريه في الاستخبارات في أثناء خدمته العسكرية أكسبته الخبرة والبراعة في كتابة رواياته التي جعلته يحصل على لقب "ملك روايات التجسّس" بجدارة.
وفي عالمنا العربي، عرف هذا اللون من أدب الرواية على نطاق واسع بعد ظهور رواية صالح مرسي "رأفت الهجان"، التي عرّفتنا على جاسوسٍ زرعته المخابرات المصرية في إسرائيل، وأقام علاقاتٍ وثيقةً مع عدد من صنّاع القرار هناك، إلى درجة أنهم عرضوا عليه دخول الكنيست. ولم يكن اسم صالح مرسي معروفا بهذه الدرجة من الشهرة، قبل أن يكتب روايته هذه، مع ملاحظة أنه كتب رواياتٍ قبلها، بعضها كان يتعلق أيضا بنشاط المخابرات.
هوامش عراقية ذات معنى
عبد اللطيف السعدون
(1)
مفارقةٌ عجيبةُ أن يملك العراق أكثر من مائة مليار دولار، ورصيدا من الذهب يتجاوز 130 طنا، وأن تسود في مدنه وأريافه مستويات الفقر الفاحشة، ويعيش ثلث سكّانه تحت خط الفقر، ولا يحصل معظمهم على الماء الصافي ولا على الكهرباء، وقد انعدم الزرع والضرع فيه بعدما كان يطلق عليه تسمية "أرض السواد"، لوفير زرعه ونخيله وأشجاره، وقد اتّسعت ظواهر الفساد فيه إلى درجة أن ما سُرق علنا في السنوات العشرين الأخيرة، وبتواطؤٍ مفضوح من الفئة الحاكمة فيه، تجاوز تريليونات الدولارات، وأحد مظاهر الفساد التي كشف عنها أخيرا شراء مافيات الدولار وتهريبه عبر الحدود المفتوحة إلى إيران من دون اتباع قواعد تحويل الأموال المعروفة دوليا، وقد سبّب ذلك ارتفاعا في أسعار الخدمات والسلع الأساسية، وانخفاضا في القدرة الشرائية للمواطن، كما وضع العملة الوطنية (الدينار) في مهبّ الريح، وبدا الجوع يضرب الملايين.
وسط هذا الخراب السياسي والاجتماعي الذي يعيشه العراقيون، جاءت تظاهرة الجياع الذين تجمّعوا أمام البنك المركزي العراقي، بعدما لم يجدوا قوت يومهم لتشكّل إنذارا لحكامهم أن لن يكون ثمّة عجب إذا ما استيقظوا يوما ليجدوا مواطنيهم شاهرين سيوفهم، كاسرين حاجز الخوف والعبودية الذي طال أمده.
هذا ما قد يحدث تاليا في العراق.
(2)
الفرنسيون عائدون الى العراق بحماس معلن يذكّرنا بحرارة العلاقة العراقية - الفرنسية إبّان عهد صدّام حسين مع الفارق بين المرحلتين، ففي عقدي السبعينيات والثمانينيات من القرن الراحل، كان هناك عراق مختلف، عراق حرّ، سيد ومستقل وصاحب قرار، فيما عراق اليوم محتلّ أميركيا ومهيمَن عليه إيرانيا، ومحكوم من مليشيات وأحزاب تابعة لقوى خارجية، وهذا ما يجعله في علاقاته مرتبطا، رغم أنفه، بمعادلةٍ ذات أطرافٍ متعدّدة، على من يتصدّى للتوافق معها أن يمتلك من الحكمة والمرونة ما يجعله قادرا على الفعل قي ظلها. وهذا، على ما يبدو، قد أدركته فرنسا جيدا، وهو ما جعل قدومها حذرا رغم الحماس المعلن، ولعل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد حسب حسابه، وحصل على ضوء أخضر من الأميركيين، وهم الطرف الأقوى في المعادلة، إذ لا يمكن لواشنطن أن توافق على إعطاء هذا الكم الهائل من "الأرباح" التي تحملها الاتفاقيات التي انتهت إليها زيارة رئيس وزراء العراق، محمد شياع السوداني، باريس، من دون أن تضمن الحصة الكبرى منها لشركاتها ومؤسّساتها المالية التي ستدخل طرفا في أعمال واستثمارات مشتركة مع الفرنسيين.
يبقى أن الإيرانيين، وهم الطرف الآخر في المعادلة، لن يكونوا راضين عما تم، والتجربة تعلمنا أنهم سوف يعمدون إلى السعي إلى تخريب هذا التوجّه، ووضع العراقيل أمامه، لأنه سينعكس عليهم بخسارة مورد مالي مهم، تعتمد عليه في دعم ميزانيتها التي تعاني من آثار العقوبات الدولية. وليس أسهل عليها من أن تحرّك "وكلاءها" ومليشياتها النافذة في العراق لإرباك الوضع الأمني، بما يوحي بعدم توفر الأمان للمستثمر الأجنبي، واعتبار العراق بيئةً غير صالحة للعيش وللعمل، وربما يصل ذلك إلى حد إسقاط حكومة السوداني، والمجيء بحكومة جديدة... وهذا ما قد نشهده في قابل الأيام.
مافيات تدير السجون تروّج المخدّرات وتُجبر السجناء على تعاطيها
(3)
بعد انحسار أخبار فضيحة "صفقة القرن" التي ابتلع أبطالها أكثر من مليارين ونصف المليار من الدولارات من المال العام، وإطلاق سراح معظمهم، وصرف النظر عن ملاحقة "الحيتان" الكبار الذين حصلوا على حصتهم من "الغنيمة" على قاعدة "عفا الله عما سلف"، وهي القاعدة "الذهبية" التي يعمل عليها القضاء العراقي، والتي كانت محصّلتها ردّ الاعتبار لكثيرين من سرّاق ومرتشين ومزوري شهادات خدمة للصالح العام (!). وبعدما أسدل الستار عليها ونسيها الناس انفجرت فضيحة أخرى، ومن "قماشةٍ" مختلفة، إذ كشفت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي عما وصفه رئيسها أرشد الصالحي "كارثة بامتياز"، مافيات تدير السجون تروّج المخدّرات وتُجبر السجناء على تعاطيها، وعندما سمعت وزارة العدل بذلك، وكانت قد صمّت أذانها من قبل، بادرت إلى عزل بعض مسؤولي السجون، قبل أن تنتشر رائحة الفضيحة، وتزكم الأنوف.
اكتشف المعنيون أيضا أن الشركة التي توفّر الطعام للسجناء تابعة لهيئة الحج والعمرة، أي أنها لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، وأن هذه الشركة "الإسلامية" تسرق ما يقرب من 170 مليار دينار سنويا من المبلغ المخصص لها عن إطعام السجناء، إذ تقدّم لهم طعاما خارج المواصفات الصحية المطلوبة. وهذا الكلام كله جزء قليل من أخبار الفضيحة الكارثة التي تفجرت.
بقي أن نقول إن عدد السجناء في العراق (الجديد) بات يشكل كارثة أخرى، إذ تجاوز المائة ألف سجين وفق ما يقوله رسميون، هذا عدا المعتقلين الذين لم يبتّ القضاء في قضاياهم بعد، وأيضا عدا من تحتجزهم المليشيات في مراكز الاحتجاز الخاصة بها، والتي لا يمكن لأحد الوصول إليها أو معرفة ما يدور فيها.
أن تخدم
سيّديْن في وقت واحد
عبد اللطيف السعدون *
في المأثورات المسيحية "لا تستطيع أن تخدم سيّديْن في وقت واحد، لأن ذلك أمر مستحيل"، لكننا في العراق استطعنا تحويل ما هو مستحيل إلى ممكن. عشرون عاما ونحن نعمل في خدمة سيّديْن في وقت واحد، إلى درجة أننا أدمنّا العبودية، وأتقنّا فلسفة الخضوع والركوع وتقبيل الأيدي وحتى الأقدام. وعلّمَنا حكّامنا الشطّار الماكرون كيف نجمع بين صداقتنا (اقرأ: تبعيتنا) للسيّد الأميركي وصداقتنا (اقرأ: تبعيتنا) للسيّد الإيراني، مع أن بينهما ما صنع الحدّاد، ولكن .. أليست السياسة فن المستحيل؟
وهكذا في كل دورةِ زمنٍ يحطّ عندنا، على نحو مفاجئ، ومن دون إخبار مسبق، مبعوثون من هذا السيّد أو ذاك، ونحن ممتنّون لكليهما بعد ما أسّسا لنا، ومن أجل سواد عيوننا، حُكما ليس له نظير على وجه الأرض، وجلبوا لتطييب خواطرنا كومةً من الأفّاقين والقراصنة واللصوص ليحكمونا ويتحكّموا فينا، وقد تفنّنوا في ترويضنا على مدى الأعوام العشرين، إلى درجة أننا أصبحنا، ورغم أنوفنا، راضين باستغلالهم لنا ولثرواتنا، قانعين بعبوديّتنا الطوعية لهم، شاكرين أفضالهم علينا وعلى بلادنا. وقد آن لنا اليوم أن نفخر أمام العالم بأننا نعيش في رحاب "دولة عميقة" أقامها سادتنا لتحرسنا ليل نهار في حماية "حشد مليشياوي" يحمل السلاح نيابة عنّا، ويرسم لنا طريق سيرنا ومصيرنا، وقد أدمنّا الحرص على أن نرضيهم ونخدمهم، وننتظر بركاتهم طول الوقت!
وقد حلّت البركة في ربوعنا الأسبوع الحالي بزيارة مبعوث البيت الأبيض، بريت ماكغورك، لنا ولقاءاته مع كبار مسؤولينا، على خلفية أن بلادنا من البقاع المهمة في العالم التي يعتبرها الأميركيون جزءا من مجالهم الاستراتيجي، والتي لا يمكنهم التخلّي عنها لأي طرف إقليمي أو دولي. وقد جاء ليذكرنا بأن بلاده أنفقت أكثر من تريليوني دولار في حربها، كما خسرت آلاف الجنود، وتريد أن نبقى تحت نفوذها إلى الأبد. وبحسب ما قاله مطّلعون على ما دار وراء الأبواب المغلقة، تحدّث المبعوث الأميركي عن استمرار وجود أكثر من 14 ألف عسكري أميركي في العراق تحت لافتة "المشورة والتدريب" سنوات، وربما لعقود. وذكّر تابعيه بما نصّت عليه مذكرة التفاهم السرية التي كان قد وقعها الطرفان في يونيو/ حزيران عام 2014، في عهد ولاية نوري المالكي الثانية، وكشف عنها رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي، في حينه، كما حذّرهم من استمرار دعمهم حكومة طهران، بخاصة في مجالات الاقتصاد والأمور المالية، وهدّد بأن استمرار ذلك سيدفع واشنطن إلى اتخاذ إجراءات من شأنها لجم عمليات غسيل الأموال ووقف الاستيلاء غير القانوني على الدولار لمصلحة إيران. وأفاد هؤلاء المطلعون بأن ماكغورك أبلغ رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، في ختام زيارته، وفي لهجة خشنة، بأنه سوف يسمع من الرئيس الأميركي، جو بايدن، في زيارته المقرّرة إلى واشنطن أكثر من ذلك!
وقبل أن تخفُت حرارة زيارة ماكغورك وسط طقس بغداد البارد، فاجأتنا زيارة لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، وهو المفوض من دولة "ولاية الفقيه" لرعاية شؤون العراق، والذي اعتاد التسلّل عبر الحدود، في جنح الليل، متخفّيا خشية أن يشعر بقدومه الأعداء فيفعلوا به مثلما فعلوا بقاسم سليماني من قبل، خصوصا وأن عيونهم لا تفوتها شاردة ولا واردة، وقد جاء ليذكّر العراقيين، هو الآخر، بما يهم إيران تنفيذه، وفي المقدمة من ذلك تفعيل القانون الذي يقضي بعدم السماح ببقاء العسكر الأميركيين في البلاد، وليطلب من قادة المليشيات الضغط على حكومة السوداني، لتحقيق ما تعتبره طهران واحدة من أولوياتها في الإقليم الذي تسعى إلى الاستئثار به من دون منافس. وطلب قاآني أيضا إيجاد طريقة للإفلات من القيود التي وضعها البنك الفيدرالي الأميركي على التحويلات المالية إلى إيران، بعد الاتفاق الذي جرى في أثناء زيارة السوداني طهران، على رفع سقف الصادرات الإيرانية إلى العراق لهذا العام إلى ما قيمته 20 مليار دولار. وبالطبع، يشمل ذلك بضائع غير أساسية، ولا يحتاجها العراقيون، والمهم توفير العملة الصعبة للميزانية الإيرانية التي أرهقتها العقوبات.
ووسط لعبة شدّ الحبل هذه، يبدو السوداني في موقعٍ لا يُحسد عليه، خصوصا وهو يريد أن يرضي "السيّديْن" معا، ولا يسعى إلى إغضاب أحدهما. ولذلك فكّر في أن يركن إلى المعادلة التي اشتغل عليها رؤساء الحكومات الذين سبقوه، والعمل مع الطرفين مع المراهنة على عنصر الزمن.
ولكن هل تسلم الجرّة هذه المرّة، كما سلمت في مرّات سابقات؟ هذا هو السؤال الذي ربما يدور في ذهن السوداني، وهو على أبواب سفرة "تاريخية" إلى البيت الأبيض لا يمكن التنبؤ بنتائجها بسهولة.
كاتب وصحفي عراقي من جيل الرواد ، ماجستير علاقات دولية من جامعة كالجري – كندا، *
يكتب مقالا اسبوعيا في (العربي الجديد) لندن
الحلم بعراقٍ مختلف
عبد اللطيف السعدون
نستطيع، نحن العراقيين، أن نمارس الحقّ في الحلم، ومع أن هذا الحقّ لم يظهر في اللائحة العالمية لحقوق الإنسان التي أقرّتها الأمم المتحدة، إلا أنه يظلّ الحق الإنساني الوحيد الذي لا يمكن لأية قوة غاشمة أن تسلبه منا. دعونا، إذن، نحلم بعراق ديمقراطي متصالح ومزدهر، هل حلم كهذا ممكنٌ حقا، أم علينا أن نكفّ عن الحلم، لأننا لم نر، على مدى عشرين عاما، ما يشير إلى أن ضوءا قد ينبثق في آخر النفق في أية لحظة، وأن أحدا قد يظهر فجأة كي يعلق الجرس؟
صحيحٌ أننا نمرّ بأوقات صعبة، ويشعر بعضُنا أن بلدهم قادم إلى ما هو أسوأ، وأن الأوضاع قد تصبح أكثر توترا وإيلاما إلى درجة أن مستقبلهم لم يعد قيد إرادتهم، إذ تم التواطؤ من الطغمة الحاكمة على سلبهم كل شيء، حرّيتهم وقرارهم وحقوقهم وثروتهم ووطنهم. ويعتقد بعضنا أيضا أن أفضل ما في حياتهم قد أصبح وراءهم، وهو شعورٌ مريض، الإقرار به يعني مزيدا من الحزن، ومزيدا من الخراب، ومزيدا من المرارة.
ولذلك علينا أن نتشبث بالحلم، خصوصا ونحن ندرك أن بداية عام جديد هي مناسبة لإطلاق الأحلام ورعايتها، والعمل الجاد لكي تصبح حقيقة أو، على الأقل، كي توفّر لنا القناعة أن كل شيء ممكن، وأن لا مستحيل أمامنا، والحلم وحده هو الذي يجعلنا نواصل البحث عن معنى لحياتنا، وأن نحلُم بعراق مختلف عن السائد، عراق بدون قمع، وبدون بؤس، وبدون نهب، بحكومة ديمقراطية منتخبة في انتخابات نزيهة وشفافة، وفي ظل دستور جديد تعدّه نخبة رجال قانون وحقوق، وقوانين تدير حركة الدولة بشفافية وعدل.
الأهم أن نعترف بأن سعينا إلى التغيير طيلة السنوات العشرين العجاف سار في طريق متعرّج، تحيط به الشكوك والأوهام، والمناكفة وحدها ليست مجدية. ومواجهة هذه الحقيقة ضرورة للبدء بعملٍ يرتكز على حلم، وأن يتحوّل هذا الحلم إلى التزام، إلى مشروع نكرّس له جهودنا ونضالاتنا، أن نضع تصميما لعراقٍ جديدٍ يتجاوز مصالحنا الأنانية ومساوماتنا العقيمة التي تمنع حل مشكلاتنا الأساسية، وتخدّر قدرتنا على التقدّم. وقبولنا حلم "عراقٍ مختلف" يعني مشاركتنا في إنشائه، وإيماننا بحقنا في التصرّف مواطنين أحرار في بلدٍ نريده أن يكون حرّا، بشرا فاعلين ومنشئين للتغييرات التي نراها ضروريةً في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة والمجتمع، وأن ندافع بحزم عن حقّنا في التغيير، عن حقّنا في بلدٍ يضمن حقوق الجميع، ويحتفي بالتنوع كثروة، أن تقوم فيه السلطة والسياسة على قيم الحرية والحقوق والواجبات والعدالة، وأن نروّض أنفسنا على البقاء صامدين، كي لا نكفّ عن الحلم المقترن بالأمل. و"نحن، على حد ما قاله مرّة الروائي الفرنسي، أناتول فرانس، "لا نستطيع أن نعطي بقدر ما يعطينا الحلم القدرة على العطاء".
وهكذا لنجعل الحلم عنصرا جوهريا وضروريا في حياتنا، ولنحلُم بدولةٍ توفر لأبنائنا تعليما عصريا، وتربّي عندهم قيم المحبة والخير والعطاء، دولةٍ توفّر الدواء للمرضى، والعناية الطبية الكافية لهم، دولةٍ توفر العيش الرغيد للجميع من دون منّة، دولةٍ توفّر فرصة عمل لكل مواطن، دولةٍ تنمّي الإحساس بالمسؤولية والعدالة، دولةٍ تضمن الأمن والأمان والراحة للجميع، دولةٍ تعترف بالتنوّع والشمول، وتحترم الحرّيات والحقوق الاجتماعية والتعايش الديمقراطي، دولة تضع مواردها في خدمة مواطنيها لرفع نوعية حياتهم وتحسين شروطها وفق خططٍ علميةٍ طموحةٍ وشفافة، دولةٍ تعطي اهتماما استثنائيا للشباب، باعتبارهم طاقة هائلة لا بد من إشراكها في صنع مستقبل حياتهم، دولةٍ توقف الهدر في المال العام، وتقتصّ من السرّاق والفاسدين، دولة لا تكون ضحية للعبة جيوسياسية يديرها لصوصٌ وأفّاقون وأمراء طوائف وزعماء مافيات. واذا كانت كذلك كما حالها اليوم، فإنها تفقد هويتها دولةً وتتحوّل إلى عصبة طائفية أو قبلية تدمر كل ما هو إنساني وخير.
ولكي لا ينالنا الإنهاك والتفكك والانهيار البطيء، دعونا نحلم بعراق مختلف، موحّد، ملتزم، منتج، حضاري، منفتح على قيم العصر. وحتى لو كان هذا الحلم صعبا وعسيرا، أو قل مستحيلا، فإن الحياة ستكون جميلة، عندما نعيشها لأجل حلم صعبٍ وعسير، وما أقسى الحياة عندما نعيشها بلا أحلام؟
عن لولا دا سيلفا
ومارغريت مينيزس
عبد اللطيف السعدون
من ماسح أحذيةٍ وبائع خضار جوّال في أحياء مدينة سيتيس الفقيرة في شمال شرقي البرازيل إلى ميكانيكي سيارات وعامل في مصنع للصلب، وإلى ناشط نقابي، ثم رئيس لاتحاد عمال الصلب، ثم مؤسّس لحزب العمّال البرازيلي ومرشّح للبرلمان وللرئاسة، ورئيس لثماني سنوات سُجن بعدها بتهمةٍ ظالمة، وخرج من السجن بعد إعلان براءته، وترشّح لانتخابات الرئاسة أخيرا ليعود إلى القصر الرئاسي، بكل هيبته وبساطته ونزاهته، رئيسا لأربع سنوات بدأها في اليوم الأول من العام الجديد.
تلك هي باختصار قصة لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (77 عاما) الذي يتمتّع بكاريزما عجيبة، ويعرف عند جيرانه وأصدقائه بأنه "صاحب اللسان الفضي"، والذي وصفه مرّة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، بأنه "السياسي الأكثر شعبية على وجه الأرض"، وقد تحوّلت قصة كفاحه هذه إلى أسطورة مثيرة، يرويها البرازيليون بكل شغفٍ وحب، إذ هو من أنقذ بلاده من أزمتها الاقتصادية الخانقة التي واجهتها بدايات الألفية الثانية، والتي وضعتها على حافّة الهاوية ودفعتها إلى استجداء القروض والهبات من البنك الدولي ومن دول العالم، لكنها، في رئاسة لولا، كان فائضها المالي يزيد على مائتي مليار دولار. وفي عهده احتلت بلادُه المرتبة السابعة في سلّم اقتصادات العالم، ويرجع إليه الفضل في نقل أكثر من 20 مليون مواطن برازيلي من تحت خطّ الفقر، بفعل برامجه الاقتصادية والاجتماعية، التي نفذها في ولايتيه الأولى والثانية، ومن بينها برنامجه "بولسا فاميليا" لإعانة الفقراء، إذ خصّص لكل أسرة فقيرة مرتبا شهريا، شرط أن تبقي أطفالها في المدارس، ولا تدفعهم إلى سوق العمل أو للاستجداء في الشارع، وهو صاحب مقترح فرض ضريبة على مبيعات السلاح في العالم تخصّص لمكافحة الفقر الذي عرضه على الأمم المتحدة في حينه.
لولا أكثر سياسي برازيلي، ربما أكثر سياسيي العالم، حظي بإعجاب النساء وحبهم. ونساء البرازيل يعتبرنه نصيرهن والمطالب بإنصافهن. وبلغت مشاركتهن في الانتخابات أخيرا 51% من أصوات من يحقّ لهن الانتخاب، وهي أعلى نسبة تصويت من النساء في أية انتخابات رئاسية، ومن أكثر ناشطي حملته الانتخابية كانت امرأة، المغنية الشعبية والناشطة في حركة السود، مارغريت مينيزس، التي غنّت في أكثر من محفل انتخابي أغنيتها "عندما تمر بجانبي أشمّ رائحة عطرك، أقاتل مطارديك، معجبة بك طول الوقت، أكاد أفقد عقلي وأنا أتبع خطواتك أينما ذهبت".
مارغريت مينيزس (يسمّونها ماغا) كانت أطلقت الأغنية قبل أكثر من عقدين، وحينها أخذت الأغنية مساحةً من الشهرة ما لم تأخذه أغنية برازيلية أخرى، وتحوّلت إلى شعار لكرنفالات الفرح التي اعتادت المدن البرازيلية إقامتها كل عام، وجعلت من مينيزيس إحدى أيقونات الموسيقى الشعبية في القارّة اللاتينية.
ردّ الرئيس لولا دا سيلفا جميل نساء البرازيل عليه، إذ أسند لهن 11 حقيبة وزارية، في خطوةٍ لم يسبق أن اعتمدها رئيس سابق، ومن بين من اختارهن مينيزس نفسها، إذ أسند إليها حقيبة وزارة الثقافة باعتبارها، كما قال، "قادرة على أن تصنع وزارة ثقافة قوية، تستجيب لرغبات الناس"، وخصّص لها ميزانية ضخمة، تصل إلى ما يقرب من ملياري دولار. وتعهّدت مينيزس، من جانبها، بالعمل على إعادة بناء الثقافة البرازيلية، وتعزيز العمليات الإبداعية وتقوية الذاكرة الجماعية والتنوع الثقافي والاهتمام بالتراث الشعبي.
ويُنظر إلى هذا الاهتمام الاستثنائي من لولا الذي لم يكن قد نال في حياته قسطا من التعليم في معالجة حقيقية لواحدة من الندوب العميقة التي تركها الرئيس الذي انتهت ولايته، جايير بولسونارو، وراءه في إلغائه وزارة الثقافة، وتحويلها إلى مكتبٍ صغيرٍ ملحق بوزارة السياحة وتقليص ميزانيتها إلى أقصى حد، وكان بولسونارو اليميني المحافظ القادم من المؤسّسة العسكرية يجاهر دائما باعتقاده أن الوزارة ليست لها ضرورة.
يبقى أن لولا دا سيلفا مقبلٌ على "ولاية شاقة" بحسب وصفها له، حيث أمامه تحدّياتٌ لن تكون مواجهتها أمرا سهلا، وأبرزها تنفيذ برامجه في مكافحة الجوع، بحيث "يمكن لكل فرد أن يحصل على ثلاث وجبات طعام في اليوم من دون عناء"، مع ملاحظة أن عدد من هم تحت خط الفقر وصل، في عهد سلفه، إلى ما يقرُب من ثلث السكان، في وقتٍ تعاني البرازيل من نقص الموارد، وثمّة شكٌّ في حصوله على دعم قطاعاتٍ واسعة في الدولة، بخاصة العسكريين الكبار ذوي النزعة اليمينية المحافطة، والذين لا يؤتمن جانبهم، كما أن سيطرة اليمين على غالبية مقاعد البرلمان سوف تشكّل عقبة أمامه.
ويظلّ الأمل معقودا على شعبيته في أوساط الشرائح الفقيرة، وقدرته على تجاوز ما يعترض طريقه من عقبات، وهو الذي قرّر أن يجعل شعب بلاده من أسعد شعوب العالم.
ماذا يخبئ العام الجديد للعراق؟
عبد اللطيف السعدون
يتردّد مثل هذا السؤال عند عراقيين كثيرين، منذ اقتيد بلدهم قبل عشرين
عاما، بفعل قوى غاشمة، إلى طريق ضيقة المخارج، أنتجت واقعا مأساويا،
كاد أن يتحوّل مع الزمن إلى مأزق تاريخي لم تعد تنفع معه المسكنات
الماثلة. وقد حملنا السؤال إلى سياسي عراقي عمل مع المنظومة الحاكمة،
ثم ارتدّ عنها، مفضّلا النأي بنفسه عما يجري، أجاب: "ما يحتاجه العراق
هو نمط من الحلول الاستثنائية الخارقة للمألوف يبتكرها قادة تاريخيون
قد لا يجود زماننا بهم. وبمراقبة ما يجري ويدور في ظلّ العملية
السياسية الحالية، لا نتوقع أن يكون العام الجديد أفضل من سابقه، بل قد
ينحدر الخط البياني أكثر فأكثر، خصوصا، وإن ما يتسرّب من الأروقة
السرية يوحي بكثيرٍ من الشر للعراق ولأهله".
"إن
أفكارا شيطانية مثل تقسيم البلاد وشرذمتها قد تطفو على السطح من جديد،
بعدما وجدت لها مناصرين من شيوخ عشائر، ومن يطلق عليهم تسمية (وجهاء
مدن)، ممن يأملون أن يحقق التقسيم لهم حصة في غنائم متوقعة. وما يطرح
في هذا المجال قد يأخذ صيغا ظاهرها بريء وباطنها فيه العذاب المقيم.
الحديث يجري عن أقاليم بميزانيات وصلاحيات مستقلة، تتّحد فدراليا،
وتضمن الأمن، وتوزع الثروة، ففي البصرة تعقد اجتماعاتٍ وتعدّ "مضابط"
للمطالبة بانشاء إقليم. وفي الأنبار حراكٌ يقوده شيوخ عشائر وناشطون
للهدف نفسه. وثمّة عودة عند برلمانيين موصليين لترويج مشروع إقامة
إقليم يضمّ، إلى جانب الموصل، محافظات ثلاثا أخرى، وتطالب حكومة
كردستان بغداد باسترجاع "الحقوق المغتصبة"، وضم كركوك إلى الإقليم. وفي
كردستان نفسها همس أخذ طريقه إلى العلن عن تفكيك الإقليم إلى إقليمين،
يتبع كل منهما واحدا من الحزبين الحاكمين هناك. وتفكّر جهات إقليمية
ودولية في إحياء مشروع بايدن سيئ الصيت الذي أطلقه قبل أكثر عقد، عندما
كان رئيسا للجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس، والذي يدعو إلى إنشاء
ثلاثة أقاليم على أسس طائفية وعرقية، وهي تجد في ذلك حلا لمعضلة العراق
التي كبرت".
"وثمّة
متغيراتٌ في الداخل تخدم هذا التوجّه، أن الناس العاديين يبدون مستائين
من الأوضاع المتدهورة، وهم يائسون إلى حد كبير في ظل عدم وجود إمكانية
في المدى القريب أو المتوسط لنهوض دولة حقيقية من ركام الغزو والاحتلال
الأميركي والهيمنة الإيرانية المباشرة، وهم يدركون أن إيران نفسها
ستجهض، عبر وكلائها المحليين ومليشياتها النافذة، أية محاولة جدّية
بهذا الاتجاه. وتعيش هذه الشريحة الكبيرة من السكان في حال أدنى من خط
الفقر، وقد أصبح اهتمامها الأساس حصولها على الخبز والأمان وخدمات
الصحة والماء الصافي والكهرباء. ولذلك تبدو مستعدّة للرضا بصيغة
التقسيم إذا ما توفرت لها القناعة أن تلك الصيغة سوف تضمن لها بعض ما
تريده".
"وربما
تشجع إيران نفسها فكرة التقسيم، بعد أن أحكمت حلقات تغيير ديموغرافي في
المدن العراقية على مدى السنين السالفة، وبمعونة وكلائها من الأحزاب
والمليشيات، وحتى تركيا التي تراودها الأحلام السلطانية لن تكون بعيدة
عن خطط كهذه".
وسخر السياسي العراقي من وعود الأحزاب الحاكمة بادّعاء تجاوز الخطايا
السابقة والعزم على أن تكون الحكومة المطلوبة "حكومة خدمة وطنية" كما
أسمتها، كما سخر من طرح بعضها فكرة "الانتخابات البرلمانية المبكّرة"
حلا للأزمة، مضيفا: "إنهم يسعون جاهدين إلى إعادة إنتاج العملية
السياسية الطائفية التي دخلت صالة الإنعاش، في حين أن معظم الناس لم
يعودوا في واقع الحال معنيين بصيغ ديكورية، مثل الانتخابات والبرلمان،
وحتى الديمقراطية التي جرّبوها عشرين عاما لم تنتج لهم سوى الخراب
والفقر.. وكل الشعارات التي أطلقها السياسيون لم تعد سوى ترّهات لا
تغني ولا تسمن، بل إن بعضهم يتمنّى لو عاد صدّام حسين ليحكمهم بدلا من
هذا النظام الهجين الذي اخترعته لهم أميركا وتابِعوها المحليون! ثم إن
ثورة تشرين فقدت الكثير من حيويتها، وإنْ بقي لها بعض الوهج، وتحتاج
وقتا أطول كي يشتدّ عودها من جديد، وتستعيد زخمها الأول، والمراهنة على
قدرتها على التغيير في الحال الحاضر أمر مشكوك فيه.
"هل
بعد هذا يمكن أن نتوقع في العام الجديد ضوءا في آخر النفق؟ وهل يمكن أن
نصحو يوما لنجد العراق مركز حياة وثقل في المنطقة؟.. لا أظن ذلك".
اتفقنا مع ما قاله السياسي العراقي المعتزل أو اختلفنا معه، فإن
قراءتنا ما يدور أمامنا ومن حولنا ترجّح أن العراق مقبل في العام
الجديد على أحداثٍ قد لا تخطر في بالنا.
عن صحوة
الشيوعيين العراقيين الناقصة
عبد اللطيف السعدون
نحن أمام صحوة جديدة للشيوعيين العراقيين، ولو جاءت ناقصةً، ومتأخرةً أيضاً كسابقاتها، وهم اعتادوا زمناً النظر إلى ما يجري في بلادهم بعين قاصرة. وحتى عندما أوقف العراق عنوة عند مفرق طريق سلبت فيه سيادته وأطيح استقلاله ظلوا متردّدين، وهم يريدون اليوم أن يستدركوا ما فات عليهم وما فاتنا منهم، وما نعرفه عنهم أنهم على امتداد عقود وهم يطرحون أنفسهم دعاة إلى التغيير الشامل، ويصطفّون يساراً، ويقارعون في أديباتهم "الاستعمار والإمبريالية والإقطاع والعنصرية والطائفية"، وقد استطاعوا في مرحلة أن يقودوا تظاهرات مليونية كانت تسرّ الأصدقاء، وتُرعب الخصوم، لكنهم، وفي غفلة من زمنهم الجميل، انعطفوا يميناً، ووضعوا أيديهم بيد المحتل الأميركي الذي غزا بلادهم، وارتضوا لأنفسهم أن يدخلوا "مجلس الحكم الانتقالي" الذي أسّسه أول حاكم للعراق بعد الاحتلال، بول بريمر، إذ قبل سكرتير الحزب، حميد مجيد موسى، أن يكون ممثلاً عن طائفته في المجلس، حتى من دون أن يضع شرطاً أو يقدّم مطلباً، وجاء قبول بريمر هذه الخطوة بناء على مقترح بريطاني، بحسب ما ذكره في مذكراته. وبذلك يكون الشيوعيون قد تشاركوا في حكم البلاد، ووافقوا على الدستور الهجين الذي وضعه الأميركيون، بزعم أنه "يوفر لكل مواطن عراقي مكاناً وظرفاً مناسبين لممارسة مواطنته". ووصفوا مجلس الحكم بأنه "وحده القادر على كسب ثقة العراقيين، والمؤهل لاستقطاب تأييد أوسع الجماهير وتحشيد إسنادهم له". كما شاركوا في الانتخابات البرلمانية أكثر من دورة، وتحوّلوا إلى ذيلٍ لأكثر من طرف من أطراف "العملية السياسية" الطائفية، وكسبوا مرّة موقعاً وزارياً، ومرّة مقعداً برلمانياً، لكنهم في المرّتين ربحوا ملوك الطوائف والإثنيات وخسروا أنفسهم. وها هم يعترفون ببؤس ما فعلوه، وجاءت صحوتهم اليوم، كما صحوات سابقات، ناقصة ومتأخّرة أيضاً، إلا أنها خطوة في اتجاه نراه ضرورياً كي تعيد للحزب بعضاً من مجده الآفل، وحتى تعطي ثمارها وتكتمل ينبغي أن تقترن بخطوات أخرى.
الصحوة الأخيرة عبّر عنها تقرير للحزب أقرّ بأن "ما بات ملحّاً
وضرورياً تدشين صفحة جديدة تحت راية التغيير الشامل تفتح آفاقاً واعدة
لغد الديمقراطية الحقّة ودولة المؤسسات والقانون والمواطنة والعدالة
الاجتماعية". ولكي يخلي الشيوعيون مسؤوليتهم عن أخطاء السنوات العشرين
المنصرمة وخطاياها، قدّموا عرضاً مسهباً لواقع الحال المتردّي. ومن بين
ما ثبتوه في تقريرهم إشارات لافتة إلى تغوّل منظومة الفساد، وتصاعد
معدلات الجريمة والانتحار، وتفشّي الفقر إلى حد أن أكثر من مليون مواطن
تحت خط الفقر، والرقم هنا رقم رسمي، إذ إن عدد الفقراء، كما يقول
التقرير، أكثر من ذلك بكثير.
يُحسب لمعدّي التقرير أيضاً اعترافهم بأن نهج المحاصصة الطائفية
والإثنية الذي شاركوا فيه منذ البداية هو "أس فشل وفساد المنظومة
الحاكمة"، وأن حكومة محمد شياع السوداني التي جاءت بعد حالة استعصاء
طويلة الأمد لم تخرُج عن هذا المنهج، وهي رهينة توافقات المصالح الضيقة
نفسها. ولذلك من غير المتوقّع أن تتمكّن من تحقيق ما يأمله بعضهم منها،
لكن الحزب، مرّة أخرى، يجد في "الانتخابات المبكّرة" الوصفة السحرية
التي قد تقود إلى حلّ، على أن تتوفر لها مقومات النجاح في قانون جديد
يضمن نزاهتها وشفافيتها، ومفوضية انتخاباتٍ غير محسوبة على حزب أو جهة.
ما هو أكثر أهمية من هذا الذي أشار إليه الحزب ثمّة ظاهرتان تجاهلهما
تشتغل إحداهما من فائض قوة الأخرى، وتشكّلان معاً العائق الأكبر أمام
أي تغيير حقيقي يصحّح المسار الحالي للعراق، ويؤسّس لمسار جديد:
الأولى، هيمنة إيران على القرار العراقي، إذ استطاعت طهران في عملها
الدؤوب على امتداد السنوات العشرين أن تبني دولة عميقة على الأرض
العراقية، تجعل من حكومة بغداد تابعة لها عملياً في صيغةٍ ليست أقل من
الاحتلال. ويعرف الشيوعيون العراقيون هذه الحقيقة، لكنهم، في تقريرهم
مرّوا عليها مرور الكرام، مكتفين بالتلميح العابر عن "انتهاكات فظّة
لسيادة العراق من جانب تركيا وإيران"، وليس أكثر من ذلك. والظاهرة
الثانية التي نأى الحزب بنفسه عنها انتشار المليشيات وتوغلها في الحياة
السياسية العراقية وفي المجتمع العراقي، على نحو بات يهدّد سلامة
المجتمع والدولة نفسها. وقد اكتفى الحزب بوصف رجالها بأنهم "ذوو
الأجندات الخاصة المدجّجون بالسلاح والمتماهون مع مشاريع خارجية"، ولم
يفصح أكثر.
وهكذا، بدون النظر إلى هاتين الظاهرتين وحسابهما تظلّ صحوة الشيوعيين
العراقيين، هذه المرة أيضاً كما سابقاتها، ناقصةً وغير مكتملة، وغير
ذات فعل.
في تذكّر فرانز فانون
و"المعذّبين في الأرض"
عبد اللطيف السعدون
يتذكّر شباب سبعينيات القرن الراحل اسم فرانز فانون، الكاتب والمناضل والفيلسوف الذي ظلت أفكاره في الثورة و"العنف الثوري" ماثلة في أذهانهم، وقد أصبحت اليوم مصدراً ثريا للباحثين في ثيمة "الكفاح المسلح" وسيلة لتغيير المجتمعات الرازحة تحت نير الظلم والاضطهاد العنصري.
وفانون الذي يوصف بأنّه "زنجي أسود" ولد في جزر المارتنيك في البحر الكاريبي، وتشرّب الثقافة الفرنسية، وعُرف بتعدّد هوياته فهو فرنسي الجنسية، جزائري الهوى، أفريقي النزعة، عالمي التوجّه، لكنّ هويته التي أرادها لنفسه هي هوية المناضل من أجل بناء عالمٍ خالٍ من الاستغلال والتبعية، وقد وجد نفسه معنياً بالدفاع عن قضايا المضطهدين، بعد تجربته المرّة التي عاشها في ظل بحثه عن هويته، وعندما حمل الجنسية الفرنسية لم يخطر في باله أنّ لونَه سوف يقيّده، مراهناً على رصيديه، المعرفي والثقافي، متوقعاً أن يخدمه هذا الرصيد في أن يأخذ مكانه في مجتمع متعدّد الألوان كما توهم، لكنّه اكتشف الحقيقة عندما أصبح جندياً في الجيش ثم دارساً للطب، وكان شاهداً على الممارسات العنصرية ضد السود، إذ ينظر المواطن الأبيض إلى صنوه الأسود على أنّه مواطن من الدرجة الثانية. ودفعه هذا الاكتشاف إلى الهجرة إلى الجزائر حيث عثر هناك على هويته "العالمية"، ليعمل طبيباً ثم كادراً ناشطاً في صفوف الثورة الجزائرية.
لم ينسَ فانون أن يؤرّخ للعنصرية الأوروبية التي لاحقته كما لاحقت غيره في كتابه "بشرة سوداء... أقنعة بيضاء" بعدما أدرك أنّ "الصمت خيانة" و"أنّ الأوروبيين الذين يتحدّثون عن الإنسانية ينكرون على السود وعلى أبناء مستعمراتهم حقوقهم كبشر". وفي هذا المنعطف أيضاً، نشر كتابه الآخر "المعذّبون في الأرض" الذي اعتبر إنجيل الثورة العالمية التي سوف تعيد هيكلة العالم كي يكون أكثر عدلاً ونزاهة، وفيه أطلق مقولته اللافتة: "لم يترك لنا الاستعمار سوى هذا الخيار، إما أن نسلك طريق العنف الثوري أو أن نموت واحداً بعد الآخر على أيدي جلادينا السابقين".
وإذا كان بعضهم قد وجد في طروحات فانون نوعاً من الفكر الطوباوي، فقد تدارك هو نفسه ذلك، بتأكيده على أنّ العنف المطلوب ليس "عنفاً وحشياً" كالذي يفعله المستعمر، إنّما هو "عنف مسالم" يعتمد إرساء العدل نوعاً من التطهير للفرد وللمجتمع، ويتقاطع مع كلّ ما يجعل المرء يعيش في رفاه وازدهار. لكنّه حذّر من أن تكون استجابة الحكام لبعض الاحتجاجات المطلبية، كالحصول على أجور أفضل أو تمثيل في المجالس البلدية أو توفير هامش لحرية الصحافة، بديلاً عن تحرير الأرض.
انتبه فانون إلى ما يمكن أن يفعله الجهل لدى شرائح واسعة من مواطني المستعمرات، وخلص إلى ضرورة إحياء الوعي لدى تلك الشرائح على الحال التي سبّبها المستعمر لها، ودفعها إلى المشاركة في العمل الكفاحي لإنجاز التغيير المطلوب، لأنّ التغيير لا يأتي هبةً من السماء، ولا يمكن للفقراء المضطهدين أن يضمنوا حياتهم إلّا على جثث مضطهديهم.
وتكتمل أطروحة داعية "العنف الثوري" بإشارته إلى دور الطبقة العاملة في الدول الاستعمارية التي قال إنّها فقدت ثوريتها، وباتت تنعم بثمرة كدح عمّال المستعمرات، وأصبحت شريكة في الامتيازات التي توفرها حكوماتها التي تمارس عمليات نهبٍ واضطهاد أبناء البلدان الأخرى، ودعا إلى إيقاظ الحافز الإنساني لديها، بما يجعلها تتخلّى عن نظرتها العنصرية تجاه شريحة مواطنيها السود الذين يعانون من التمييز، فيما نظر إلى الطبقة الفلاحية أنّها "الأكثر ثورية إذ هي لا تملك ما تخسره" مستمدّاً نظرته هذه من رصده تجربة المستعمرات الأفريقية.
ومن رصده هذا اكتشف أنّ الأحزاب الممثلة للبرجوازية الوطنية التي تسلمت السلطة بعد جلاء المستعمر سرعان ما استعارت عقلية المستعمر نفسه، وسعت إلى بسط سيطرتها على المال والقرار، ولم تفكّر في التخطيط لنهضة وطنية شاملة، إنما لجأت إلى استخدام وسائل العنف للدفاع عن بقائها في الحكم، حتى حولت حلم "الوحدة الأفريقية" إلى نوع من التعصّب العرقي.
وعن دور المثقفين في التغيير، يقول فانون إنّ المهم ليس هو تحرير الأرض فحسب، لأن تحرير الأرض لا يكتمل إلا بتحرير العقول أيضاً، و"العمل الفكري ضرورة وليس ترفا، وربطه بالعمل المسلح ضروري وواجب، إذا ما أردنا تغيير العالم".
لا يزال فرانز فانون في البال، بعد أكثر من سبعة عقود على رحيله، لكنّ أفكاره فقدت بعضاً من سحرها وبهائها، ولم يعد "العنف الثوري" الطريق الوحيد لتغيير المجتمعات، لأنّ مياهاً جرت في أكثر من اتجاه أوجدت مسالك متعدّدة جديدة للتغيير، وبما يتفق مع خصوصية كلّ بلد.
وقائع ومشاهد
برسم المونديال
عبد اللطيف السعدون
(1)
تقول الروائية الفرنسية صاحبة جائزة نوبل، آني إرنو، إن "ذاكرتنا تحتفظ بالمشاهد والوقائع التي نعيشها أو نمرّ بها، لكن رياح الزمن هي التي تقرّر ما يستحقّ أن نستدعيه منها". .. ربما يبدو الكاتب، والفنان أيضا، أكثر من غيرهما معنيين بهذه المقولة، إذ لهما حساسية النظر إلى المشاهد والوقائع على غير ما اعتاد الآخرون وألفوه، وثمّة ما يجعلهما يستدعيان بعض ما يلفت نظرهما أو يثير عندهما نوعا من الشجن أو الارتياح. وفي الحالين، ينقل الكاتب أو الفنان ما يشجنه أو يريحه الى متلقيه.
في مونديال قطر وعنه، يمكن للكاتب أن يستدعي عديد مشاهد وصور لفتت الانتباه، وحفظتها الذاكرة، منها أن سيدة ألمانية اسمها نانسي فيزر، مهنتها المعلنة وزيرة الداخلية في بلدها، أي أنها مسؤولة عن أمن المجتمع ورعاية أبنائه، هوايتها، على ما يبدو، استفزاز الآخرين بارتكاب أعمال وقحة، بقصد التباهي ولفت الأنظار إليها، وهو نوعٌ من السلوك البشري يقول علماء النفس إنه عائد لمتغيّر جيني يولَد عند بعض البشر، ويمنح صاحبَه قدرا من القوة المنفلتة، ليكون وقحا في ظرفٍ ما. هل يكفي هذا لكي نفهم ما دفع السيدة المذكورة أن تخطّط للدخول إلى ملعب مونديال قطر، وهي تخفي، عن عمدٍ وسبق إصرار، ومستغلّة صفتها الدبلوماسية، شارة المثليين تحت جاكتتها الأنيقة، ثم لا تلبث عندما تكون في مقصورة الضيافة أن تنزع جاكتتها حتى تكشف للملأ عن الشارة المرفوضة ليس لدى القطريين فحسب، إنما لدى مليارات من البشر في هذا الكون؟
تكشف فيزر، بتصرّفها هذا، عن سلوكٍ متعصّبٍ نابعٍ من نظرةٍ متعاليةٍ وشعور زائف بالتفوّق، وهي ربما لا تعلم أنها سوف تغرق وحدها في بحر الكراهية، وقديما كان الحكيم جلال الدين الرومي قد أبلغنا أن "كل من يبدي الوقاحة سوف يغرق في بحر كراهيته"، إلا أن ما كان جميلا حقا أن يقابل ذلك شباب قطر وبناتها بارتداء الكوفية الفلسطينية تعبيرا عن استهجانهم هذا التصرف، ولكي تدرك الوزيرة مبلغ الخطيئة التي ارتكبتها، وهي العارفة مقدّما بما يمكن أن يجرّه عليها وعلى بلادها ما خطّطت لفعله.
كانت فلسطين حاضرة في مونديال قطر، وبدت إسرائيل منبوذة ومكروهة
هل تسمح حكومات الغرب، حكومة ألمانيا على وجه الخصوص، بدخول وزير عربي إلى فعالية دولية تعقد هناك وهو يرتدي الكوفية الفلسطينية مثلا؟
(2)
انتفاضة نساء إيران دخلت مونديال قطر على نحو غير متوقّع. أحجم اللاعبون الإيرانيون عن ترديدهم النشيد الوطني لبلادهم قبل مباراتهم مع الفريق الإنكليزي. كان صمتهم دلالة غضب، قال كابتن الفريق، إحسان حاج صفي، إن صمتهم هو تعبير عن تعاطفهم مع الحراك الشعبي الذي يخوضه أولئك الناس الذين يعانون في مدن إيران، فيما كتبت صحيفة كيهان، التابعة لمكتب المرشد علي خامنئي، أن اللاعبين "عديمو الشرف ويفتقرون إلى الغيرة الوطنية". أطلق مئات المشجّعين الإيرانيين الذين حضروا المونديال صيحات الاستهجان عند عزف النشيد الوطني، رفع بعضهم صور الفتاة مهسا أميني التي توفيت في مركز احتجازها في طهران، كما رفعوا لافتات حملت شعار الحراك الاحتجاجي "نساء، حياة، حرية".
إلى هنا الأمر يبدو طبيعيا، لكن الغريب أن صحيفة عربية (هل هي عربية حقا؟) أنكرت أن يكون رفض المنتخب الإيراني أداء نشيد بلادهم موقف تضامن مع الاحتجاجات، وزعمت أنهم "كانوا مشغولين بتوجيه رسائل فلم يؤدّوا ما هو مطلوب منهم"!. الصحيفة نفسها برّرت خسارة إيران أمام إنكلترا بأن أعضاء الفريق "كانوا مشغولين ذهنيا بأمور خارج الملعب"!
(3)
هل كان ينبغي أن تستضيف قطر المونديال كي يعرف الإسرائيليون أن العرب يرفضون التطبيع والمصالحة معهم، وأية أوهام كانت في ذهن رازا شاشنيك وعوز معلم المحرّريْن في صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، وسواهما من رجال الإعلام الإسرائيليين، عندما جاؤوا إلى الدوحة، من قال لهم إن القطريين والعرب سيقابلونهم بالأحضان؟ وكيف اكتشفوا الحقيقة التي ربما تكون اتفاقيات التطبيع التي أبرمتها بعض الدول العربية قد حجبتها عنهم، وجعلتهم يتصوّرون أن أوراق الاتفاقيات الصفراء كافية لنزع الحقد العربي المقدّس من عقول العرب وقلوبهم بعد أن أصبح الدم العربي وساما وشارة؟
يكفي مونديال قطر أنه نقل العرب إلى العالمية في مرحلة تاريخية فارقة
هكذا كانت فلسطين حاضرة في مونديال قطر، وهكذا بدت إسرائيل منبوذة ومكروهة، وعرف العالم كله أن العرب لن يتصالحوا مع قاتليهم، ولو قيل ما قيل من كلمات السلام، ويوما سيولد الحق الفلسطيني من رحم المستحيل.
(4)
.. أما بعد، فحسبُ مونديال قطر أنه نقل العرب إلى العالمية في مرحلة تاريخية فارقة، وهذا يكفي وحده كي يتوقف المرجفون عن توجيه سهامهم إلى هذا البلد الصغير الكبير.. قطر.
عندما تغيّر
"العسكرتاريا" السودانية جلدها
عبد اللطيف السعدون
العارف بحال السودان، منذ حصوله على الاستقلال في خمسينيات القرن الراحل، يدرك أن ثمّة ثلاث حقائق مثيرة للجدل، تطفو على سطح الأحداث، أولاها أن أحزاب التيار الليبرالي والقوى الديمقراطية التقليدية ظلت مشدودةً إلى الآباء المؤسسين لها، وبعضها اعتبر ولاءه لطائفة دينية معينة مقياسا لانخراطه في صفوف الحزب الذي ينتمي إليه، ذلك واضح لدى قيادات حزب الأمة الذي لم يخرج عن عباءة طائفة المهدية وأسرة الإمام الراحل محمد أحمد المهدي، وظل محافظا على تراثها ومتمسّكا بطروحاتها من دون أن تصل إليه متغيرات العصر، وقوانينه الجديدة. وقل الشيء نفسه عن الحزب الاتحادي الديمقراطي الذي يدين بالولاء للطائفة الختمية الصوفية ومرشدها الإمام الراحل محمد عثمان الميرغني، وهذا الحزب هو الآخر ظلّ مشدودا إلى إرثه وغير مستوعب ما شهده العالم من تحوّلات.
لا ينفي هذا كله وجود من يطمح إلى تشكيل رؤية مختلفة داخل هذين الحزبين أو خارجهما من أطراف التيار الليبرالي والقوى الديمقراطية التقليدية، لكن هذه المحاولات لم يقدّر لها التقدّم لسبب أو لآخر، وظلت محصورة في إطار ضيق وغير فاعل على المستوى الشعبي.
ومع هذا كله أيضا، هذان الحزبان، ورغم ما يحملانه من تناقضاتٍ وقصور في هذا الجانب أو ذاك فقد ظلا، وعلى امتداد السنوات السبعين التي أعقبت الاستقلال، فاعلين في الحياة السياسية في السودان، مرّة في السلطة وأخرى في المعارضة، وبين هذين القطبين كانت مواقفهما تتأرجح ولا تستقرّ على حال، ولا تأخذ صفة الحسم، وهو ما نلاحظه في موقف كل منهما من صراع العسكر والقوى المدنية.
الحقيقة الثانية أن "العسكرتاريا" السودانية ظلت منذ الاستقلال في قلب السلطة، وإن بدت في بعض الفترات على مسافة منها، وهي في العديد من الحالات، كلما تصاعدت الضغوط الشعبية عليها، كانت تخرج من الباب لتدخل من الشباك، وتعلمت على مدى السنين كيف تغيّر جلدها كلما شعرت بدنوّ الخطر منها، وقد دأبت على إطلاق الوعود الكاذبة بالتخلي عن السلطة أو الاستعانة بقوى خارجية لدعمها وتمكينها من البقاء، حتى وصل بها الأمر إلى فتح قنوات اتصال مع إسرائيل، وهذا ما نرصده اليوم في تردّدها في القبول بمشروع الدستور الذي أعدّته نقابة المحامين الذي يقضي بمناصفة السلطة بين العسكر والمدنيين لمرحلة انتقالية حدّدت بسنتين على أن يفضي إلى قيام حكم مدني ديمقراطي. وعن هذه المسألة، قال قائد الانقلاب الجنرال، عبد الفتاح البرهان، أن الدستور سيدرس، ولكنه أنكر أن تكون ثمّة تسوية، و"لن نسمح لأية جهة بالعمل على تفكيك القوات المسلحة ومحاولة وضع يدها عليها". ويدلّ هذا الموقف الصريح على أن العسكر كعادتهم يراهنون على عنصر الزمن لاحتواء حركة الاحتجاجات واستيعاب الضغوط، والبقاء على كراسي الحكم، وقد يخدمهم في ذلك موقف فريق من "قوى الحرية والتغيير" وبعض الحركات الشعبية الصغيرة التي تدعو إلى التفاهم معهم، وكذا رؤية "الآلية الثلاثية" التي شكلتها الأمم المتحدة الساعية إلى تسوية ما بين المدنيين والعسكر.
ثالثة هذه الحقائق وأهمها تصاعد تأثير (وفاعلية) قوى اجتماعية جديدة نشطة على المستوى الشعبي، تتمسّك برفض أية تسوية مع العسكر، وتدعو إلى تصعيد حركة الاحتجاجات حتى سقوط التشكيلة العسكرية القابضة على السلطة ومواصلة العمل على تأسيس "سودان جديد". ويصف حكيم سوداني هذه القوى بأنها "تريد الرغيف كاملا فيما ترضى القوى التقليدية بنصف الرغيف". ويضم هذا التيار لجان المقاومة التي ولدت قبل عقد، واستطاعت تنظيم نفسها وتنشيط فاعليتها، والحزب الشيوعي الذي تمكّن من تجاوز ما شابه من ضعف وقصور في مراحل سابقة، وكذا حزب البعث الذي أعاد هو الآخر تنظيم نفسه، إلى جانب بعض أطراف "قوى التغيير" وكذلك حركات طلابية ومهنية وشخصيات فاعلة في المجتمع. وتتطلع هذه القوى إلى تشكيل ائتلاف يكون له وزنه في التأثير على مجريات الأحداث، وهي ترفع شعار "لا تفاوض (مع العسكر) ولا شراكة ولا شرعية (لهم).
تمثّل هذه الحقائق الثلاث مجتمعة واقع السودان اليوم، وتضع أمام السودانيين، في سعيهم إلى الخروج من المأزق الحالي الذي يوشك أن يتحوّل إلى "متلازمة" مستقرّة، واحدة من رؤيتين، إما تسوية مع العسكر أو تغيير شامل. وفي الحالين، ثمّة مخاطر وتعقيدات ينبغي الانتباه لها قبل التوصل إلى الخيار المناسب، لكن في نهاية المطاف لن يصحّ إلا الصحيح.
عن "بغداد التي ضاعت في بغداد"
عبد اللطيف السعدون
العنوان مستل من العبارة التي اختتم بها الناقد العراقي باسم عبد الحميد حمّودي روايته "التاريخية"، إن صح تجنيسها كذلك، والتي أعطاها عنوانا لافتا "الباشا وفيصل والزعيم"، وعاد عبرها إلى ثلاثينيات القرن الماضي، مستعرضا شخصيات تلك المرحلة من تاريخ العراق، وصولا إلى لحظة فارقة تمثلت في استحضار رجلي دين، يضع أحدهما عمامة سوداء على رأسه، والثاني يضع عمامة بيضاء، كناية عن بدء مرحلة جديدة بدأت مع وثوب الأحزاب الدينية الى الحكم بعد الغزو الأميركي للبلاد.
سعى حمودي، في روايته تلك، لأن يتملى تلك الشخصيات ويستنطقها، ويستعيد الجزء غير المكتوب من تاريخها، والذي طاولته شكوك وتأويلات كثيرة، واختلف الرواة فيه وعليه، وقد أحضر قضاة عدولا كي يحكموا عليهم، المؤرّخ الريادي عبد الرزاق الحسني والمحلل والباحث في التاريخ الاجتماعي للعراق الحديث حنا بطاطو وسواهما، كما جاء ببعض من قدّر له أن يشهد ما فعله أولئك من ارتكابات، وما صنعوه من أحداث ووقائع. ومن بين الشهود القاص عبد الملك نوري والروائي فؤاد التكرلي، وأخرون بعثهم الكاتب أحياء كي يشاركوا في إضاءة جوانب من المشهد الذي أراد أن ينقله إلى المتلقي.
حاول حمّودي أن يكون محايدا في عرضه الأحداث التي عاشها العراقيون منذ تأسيس دولتهم الوطنية من خلال حوارات أجراها على ألسنة أبطاله، لكن نظرته الشخصية إلى تلك الأحداث بدت تطغى على مقاطع عديدة من الرواية. ويظهر لنا، على نحو مكشوف، حنين الكاتب إلى عهد الملوك وتناغمه مع ما فعلوه، ورفضه ما قدّمه رجال ثورة/ انقلاب 14 تموز ( 1958)، وإدانته الدور الذي لعبته "العسكريتاريا" العراقية والأحزاب الشمولية في وقف النمو الطبيعي للتطور الديمقراطي في العراق. ونجح الروائي في صنع خيوط رفيعة بين الوقائع الحقيقية والأحداث المتخيلة، وفي توظيفه ذلك في استنطاق تاريخٍ تصعب ملاحظته بسهولة، كما نجح في إخضاع وقائع الماضي لسيناريوهات متخيّلة، تتداخل فيها الأمكنة والمسافات الزمنية، لكنها تظل تحتفظ بنكهتها التاريخية التي تعطيها قدرا من "الواقعية" القابلة للتمحيص والمراجعة.
الرواية فتحت الباب أمام تفسيراتٍ معمّقة لأحداث ووقائع أصبحت جزءا من الماضي
أدار حمّودي في روايته حواراتٍ على ألسنة أبطاله، عبرت عن أسئلة ملتبسة عكست وقائع تدهور مريع عاشه العراقيون في عهود "الجمهوريات"، بخلاف الآمال العريضة التي كانت معلقة عليها. وبعض هذه الأسئلة ظل يتردد على الشفاه عندما لم يجد جوابا شافيا: من أمر بقتل فيصل الثاني وأفراد الأسرة الملكية؟ من أطلق حمّامات الدم في هذا الاتجاه أو ذاك؟ ما هو الدور الذي لعبه العسكر في تأجيج الخلاف بين الأطراف الوطنية في العهد الجمهوري الأول؟ كيف تصارع الأميركيون والبريطانيون على العراق، وهل ثمة علاقة بين الإنكليز وانقلاب تموز؟ إلى آخر الأسئلة المستفزّة التي ما تزال تشغل أذهان الباحثين في تاريخ العراق الحديث.
وإذا كان كاتب رواية "الباشا وفيصل والزعيم" قد أراد محاكمة "التاريخ الرسمي المكتوب" باستعادته ما هو غير مكتوب عن مرحلة شائكة في تاريخ العراق، فإنه، بعمله الروائي هذا، ربما يكون قد فتح الباب أمام تفسيراتٍ معمّقة لأحداث ووقائع أصبحت جزءا من الماضي.
يحضرنا هنا، بالمناسبة، عمل روائي للتشيلي خورخي أدواردز يلتقي مع عمل باسم حمّودي في أكثر من نقطة، وبما يشكل ما يمكن أن نطلق عليها عملية "توارد حواطر" بين حمّودي وأدواردز، فقد عرض الأخير في روايته "منزل دوستويفيسكي" (أظن أنها لم تترجم إلى العربية) لتاريخ بلده تشيلي في الفترة التي استنطقها حمودي، وخلصا معا إلى النتيجة نفسها، اذ اعتبر أدواردز أن سانتياغو عاصمة بلاده ذات المعنى الحضاري والاجتماعي قد فقدت بهاءها ومجدها في عهد الديكتاتور أوغوستو بينوشيه الذي حكم بلاده بالحديد والنار، مثلما نظر باسم حمّودي إلى عاصمة بلاده بغداد التي قال عنها إنها ضاعت وتراجع دورها الحضاري الذي عُرفت به عبر التاريخ.
ما هو لافت في الروايتين أيضا أنهما تبحثان عن معنى جديد للتعلّم من التاريخ، يقول إدواردز "التاريخ يعلمنا أن تطور مجتمعاتنا كي تكون أكثر عدلا وأكثر رفاهية، (..) هذا سبب قوي للعودة إلى التاريخ، إننا نشعر بالحنبن إلى أيامنا السالفات، لكننا ينبغي أن نكون مسرورين لأننا نواصل البحث عن عالم أفضل".
يبقى أن نقول إن رواية حمودي تمثل شهادة لأديب مخضرم عاش مرحلة تدهور بلده وانهيارها، وهو هنا يقترب من تحميل نفسه وجيله مسؤولية المشاركة في صنع تلك الأحداث الساخنة، أو على الأقل، الصمت عن إدانتها في حينها.
العرب من "الوحدة" إلى
"التضامن" إلى "لمّ الشمل"
عبد اللطيف السعدون
لم تعد مفردة "الوحدة" تجد مكانا لها في الخطاب السياسي العربي، بعدما وئد المشروع القومي على أيدي دُعاته. أكثر من ذلك، أصبح ذكر تلك المفردة يقابَل بالاستخفاف والسخرية، خصوصا وقد طفت على السطح في السنوات الأخيرة خلافاتٌ واختلافاتٌ وصل بعضها إلى حد الاشتباك والتصادم بين البلدان العربية ساهمت في نمو النزعة القُطرية، وحدوث قطيعة بين بلد عربي وآخر، ولأن الناس على دين ملوكهم، لم يعد المواطن العادي في وارد الاهتمام بما يجري في بلد غير بلده.
يحدُث هذا اليوم بعكس ما كان يجري قبل عقود مديدة، عندما لم تكن معظم البلدان العربية قد حصلت على حقها في الاستقلال والسيادة. في حينه، كانت الدعوة إلى "الوحدة العربية" قد أخذت موقعا متقدّما، ليس في ثنايا الخطاب السياسي فحسب، إنما كانت لها أحزابها وحركاتها. ولم يكن الرأي العام آنذاك أقلّ اهتماما بها من تلك الأحزاب والحركات، وحتى الحكام كانوا، بدرجة أو أخرى، يحرصون على إيلاء المسألة المذكورة اهتماما ملحوظا، وظهر في تلك الفترة مفكّرون وكتّاب ينظرون إلى المشروع القومي، ويدعون إلى الدولة العربية الواحدة.
وربما غابت عن أذهان كثيرين واقعة انعقاد أول مؤتمر عربي رسمي يدعو إلى الوحدة العربية انعقد في بداية أربعينيات القرن الراحل في الإسكندرية حضرته وفود سبع دول (مصر والسعودية والعراق ولبنان وسورية والأردن واليمن). وكان مثيرا أن ينعقد ذلك المؤتمر تحت لافتة "مشاورات الوحدة العربية"، بما تحمله هذه اللافتة من معنى ودلالة، وتواصلت تلك المشاورات سنوات ثلاثا على نحو أو آخر، حتى توصلت إلى إنضاج خطّة تأسيس جامعة الدول العربية، لتكون أول منظمة عربية جماعية في العصر الحديث، وإنْ عدّت تلك الخطوة، في نظر كثيرين، تراجعا عمّا كان يمكن أن يتم باتجاه تحقيق هدف "الدولة الواحدة"، بينما رأى آخرون أن المعطيات المتوفرة آنذاك لم تكن تسمح بالتقدّم أكثر. وعلى أية حال، ظل الأمل معقودا في أن تسنح ظروفٌ لاحقة لتطوير هذه المؤسسة، لتلعب دورا أكبر في العمل العربي، وفي إعداد خطط ومشاريع قابلة للتنفيذ ضمن هذا التوجّه.
لكن على الرغم من مرور 80 عاما بعد قيام الجامعة، وانعقاد أكثر من 30 مؤتمر قمة للزعماء العرب، لم تستطع الجامعة نفسها أن تتقدّم على طريق تحقيق أهدافها، بل ظلت تتقاذفها أهواء دولة أو دول بعينها، كما تعرّضت لضغوط قوى دولية سعت إلى احتوائها والتأثير عليها لتبنّي مواقف وسياسات معينة تخدم مصالح تلك القوى في المنطقة، حتى تحوّلت في العقود الأخيرة إلى ما يشبه دائرة ملحقة بوزارة خارجية مصر (دولة المقرّ)، وانطبق عليها وصف ألسياسي الفلسطيني الراحل، أحمد الشقيري، إنها "لا جامعة ولا عربية". وهذا كله عرّضها للفشل في تنفيذ المهام القومية المنتظرة منها. وعزا بعضهم فشلها الذي لازمها إلى ما سمّاه "لعنة إيدن"، نسبة إلى وزير الخارجية البريطانية إبان الحرب العالمية الثانية، انتوني إيدن، الذي يقال إن له يدا في تأسيسها، وقد يكون الإنكليز قد دعموا الفكرة استباقا لما يمكن أن يعمل عليه الزعماء العرب في إطار وحدة بلدانهم.
وتبعا لكل هذه التداعيات، ظل الخطاب السياسي لجامعة الدول العربية يلهث وراء مفردات "العمل العربي المشترك" و"التضامن العربي"، وصولا إلى مفردة "لمّ الشمل" التي اختيرت شعارا لمؤتمر القمّة الذي انعقد أخير في الجزائر، ومعتى الشعار إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل أن يتبدّد ما كان جمعا يوما ما. وفي المؤتمر ظهرت جامعة الدول العربية أمام أنظار المراقبين وكأنها قادمة من عصرٍ ماض، وهي تحاول أن تداري الهموم العربية الحاضرة فيما يدرك القائمون عليها صعوبة التوافق على حلولٍ واقعيةٍ للمشكلات التي يعاني منها الجسد العربي، وكان لابد من اللجوء إلى اللغة القديمة، واستخدام المفردات التي حملتها بيانات مؤتمرات القمم السابقة. وفي مفارقةٍ لافتة، أكّد الزعماء الحاضرون على "مركزية القضية الفلسطينية" وعلى "مبادرة السلام العربية بكافة عناصرها وأولوياتها"، وكذلك على "حماية الأمن القومي العربي" و"رفض التدخلات الخارجية" إلخ.. وهم يعلمون قبل غيرهم أن مياها جديدة جرت في غير ما اتجاه، وإن مواقف استجدّت لدى دول عربية لم ترد إشارة إليها في البيان تتعارض مع هذه المبادئ.
وفي مفارقة أخرى، سعى الزعماء إلى إشاعة الأمل لدى مواطنيهم بالحديث عن "عصرنة العمل العربي المشترك"، والانتقال إلى "نهج جديد يؤازر الأطر التقليدية ليضع في صلب أولوياته هموم وانشغالات المواطن العربي"، من دون أن يفسّروا لنا أحجية "النهج الجديد" التي ظلّت غامضة.
تذكّرنا هاتان المفارقتان بما قاله السياسي الروسي الراحل، يفغيني بريماكوف، عنا، نحن العرب، إننا نعاني من العجز عن رؤية ما يحيط بنا، ونخلط بين الواقع والوهم، ونتصوّر الأماني التي تدور في روؤسنا حقائق قاطعة.
هل يصلح العطّار
ما أفسده الدهر؟
عبد اللطيف السعدون
يقول رئيس حكومة العراق المنصرف، مصطفى الكاظمي، إنه ترك في عهدة خلفه محمد شياع السوداني 85 ملياراً من الدولارات و134 طناً من الذهب. وفي تقدير خبراء، ستزيد هذه الثروة بمقدار 120 ملياراً على الأقل من واردات النفط في كل سنة من سنوات ولاية السوداني الأربع، فإذا ما أضيفت اليها عائدات المصادر الأخرى، وما يمكن استعادته من المال العام المنهوب في سنوات الخراب العشرين، والذي تعجز الأرقام عن تقديره، تكون أمام العراقيين ثروة خرافية تكفي لتحويل بلادهم إلى واحدةٍ من جنان الله على الأرض، ربما تقصر عقولنا عن تخيلها، فهل بإمكان السوداني أن يفعلها، وهو القادم إلينا هذه المرّة رافعاً شعار "نحو حكومة خدمة وطنية" الساحر، هل في قدرته أن ينقلب على ذاته، وأن يجعل من نفسه رجل التغيير المطلوب؟
لا نُطلق هنا السؤال على عواهنه، ولا نبغي أن نبخّس الرجل أشياءه، إنما جئنا ننقب ونستوثق بعيداً عن الرأي الذي يقول إن السوداني جرّب سابقاً في أكثر من موقع وزاري وفشل، دعونا نقرأ ما هو مستور وما هو معلن، لعلنا نصل إلى إجابةٍ واضحة ومقنعة.
في سيرته، ما يجعلنا نفترض أنه قد اكتسب خبرة عريضة من تجربة العمل في أكثر من موقع ومكان، فقد انخرط في صفوف حزب الدعوة، واقترب من زعيم الحزب نوري المالكي، وتماهى مع طروحاته، وقد كافأه المالكي بتقليده وزارة حقوق الإنسان في ولايته الثانية التي شهدت انتهاكاتٍ فظّة لحقوق الإنسان على أكثر من صعيد، تنقّل بعدها بين وزارات العمل والصناعة والتجارة في حكومة حيدر العبادي. وفي انتخابات أكتوبر 2021 تخلّى عن حزب الدعوة، مؤسّساً حزب "تيار الفراتين"، ومظهراً نوعاً من الاستقلالية المصطنعة عن حزبه السابق، وقيل إن ذلك تم بتوجيه من المالكي نفسه الذي رشّحه لرئاسة الحكومة، في صفقة مريبة جمعت ممثلين عن المليشيات ومافيات الفساد والأحزاب التي تدين بالولاء لإيران، كما ضمّت وزراء ومسؤولين سابقين متورّطين في ملفات فساد موثقة من جهات قضائية، فضلاً عن أنها لم تبتعد عن صيغة المحاصصة الطائفية التي لازمت الحكومات السابقة، بل ازدادت التصاقاً بها.
السوداني ليس سوى "عطّار" لا يعرف أكثر من أن يصنع خلطة ملفتة للأنظار، لكنها لا تلبث أن تتفتت بفعل الزمن
ولا يملك السوداني في حكومته هذه التي جاءت بعد مخاض طويل امتد أكثر من عام ما يدعم ما قاله عن سعيه إلى تقديم "خدمة وطنية" للعراقيين، وليس ثمّة ما يزكّيه في التصدّي لمعالجة الملفات العالقة الموروثة من تجربة السنوات العشرين المرّة، بل هناك أكثر من دليل على أن أداء حكومته لن يكون أفضل من أداء الحكومات التي سبقته، وقد يكون أكثر شبهة وسوءاً، إذ إن المليشيات التي حضرت رسمياً في الحكومة، مثل مليشيا جند الإمام التي مثلها زعيمها وزير العمل أحمد الأسدي ومليشيا العصائب التي مثّلها وزير التعليم العالي نعيم العبودي كانت قد أعلنت صراحة، وفي أكثر من مرّة، أنها لن تترك سلاحها، ولن تقبل بدمجها في القوات النظامية، وهذا يعني أن تجريد المليشيات من أسلحتها ووضع السلاح في يد الدولة الذي كان أحد أهداف ثورة تشرين، ليس له مكان في أجندة حكومة السوداني، وقل الشيء نفسه عن الأهداف الوطنية الأخرى.
كنا نريد أن يكون ما بعد ثورة تشرين مختلفاً عما قبلها، لكن ذلك لم يحدُث ولن يحدُث، لأن إيران لا تريد ذلك، وهي التي ترسم سياسات العراق وتوجّهاته، فيما يمحضها سياسيو بلادنا الطاعة والولاء سرّاً وجهراً، هذا يعني أن العهد الذي بدأ منذ الاحتلال باقٍ ويمتد، وأننا مقبلون على مرحلةٍ لا تقلّ خطورة عن سابقاتها، وربما أخطر بكثير، إذ ستستأسد المليشيات، وستتقوّى سلطة المافيات، وتزداد صفقات نهب المال العام، وسيخسر العراق والعراقيون ما هم جديرون بالحصول عليه من حقوقٍ ضمنتها لهم كل شرائع الأرض والسماء، وسوف ينتظرون أعواماً أخرى، بل ربما عقوداً أخرى، قبل أن يتنفسّوا الصعداء. أما الحديث عن "خدمة وطنية" تقدّمها حكومة السوداني فليست سوى كذبة كبيرة تنضم إلى أكاذيب كثيرة، قالها "سياسيون" آخرون جمعهم الأميركيون من الأزقة الخلفية لدول الغرب والجوار، ونصّبوهم حكاماً على هذي البلاد.
والمختصر المفيد لما نريد كتابته أطلقه "رجل شارع" في تغريدة على "تويتر" بأن السوداني ليس سوى "عطّار" لا يعرف أكثر من أن يصنع خلطة ملفتة للأنظار، لكنها لا تلبث أن تتفتت بفعل الزمن، ومهما بلغ من "شطارته"، فلن يقدّم لنا أي مكسب، لسبب بسيط أن "العطّار" لا يمكنه أن يصلح ما أفسده الدهر.
عودة "تشرين"
إلى الواجهة في العراق
عبد اللطيف السعدون
مرّت سنة عجفاء على الانتخابات البرلمانية المبكّرة التي خدع العراقيون بها أملاً في إصلاح خراب دهر السنوات العشرين الطويل، لكن شلة اللصوص التي حكمت البلاد منذ الاحتلال سرقت حتى بقية الأمل في أن يحدُث تغييرٌ ما، وأشاعت من جديد مناخ اليأس لدى من ظنّ أن لعبة "الصناديق" قد تدفع بتلك الشلة إلى التراجع والشعور بالذنب جرّاء الخطايا والجرائم التي اقترفتها، واكتشف من خدع أن "الانتخابات المبكرة" لم تكن سوى كذبة كبيرة أنتجت سنة أخرى من العذابات والحرمان والخراب المقيم.
أوصل ذلك كله "العملية السياسية" التي شرعنها الأميركيون بعد الاحتلال إلى طريق مسدود، لكن السياسيين من رجال الأحزاب وزعماء المليشيات ما زالوا يبحثون عن مخارج تتيح لهم إعادة إنتاجها، وهم يراهنون على الوهم، لعله يكون وسيلة إنقاذ لهم، غير مبالين بصوت الشعب "الذي قرّر أن يواجههم مرة أخرى في عقر دارهم، في المنطقة الخضراء"، بحسب بيان نشره على مواقع التواصل ناشطون اتّخذوا لأنفسهم اسم "اللجنة المركزية للحراك الشعبي"، حدّدوا الأول من أكتوبر/ تشرين الأول موعداً لانطلاقتهم السلمية الجديدة، ودعوا إلى تعبئة كل فئات الشعب في هذه الخطوة التي قالوا إنها تسعى إلى تغيير شامل، يعيد لهم حقوقهم بوصفهم مواطنين في وطن حرّ ومستقل.
هكذا يعرف "التشرينيون" أقدارهم، ويجرّبون حظوظهم مرة أخرى موجّهين نداءاتهم لكل الناس أن "اخرجوا من بيوتكم، اتركوا أعمالكم فقد دقّت ساعة الخلاص"، وقد أدركوا أن من غير الثورة لا يمكن لهم أن يستعيدوا وطنهم ويستردّوا ثرواتهم وينالوا حرّيتهم واستقلالهم، وقد خسروا سنواتٍ عديدة، وجرّبوا طرقاً شتّى للتغيير، جديدها أخيراً كذبة "الانتخابات المبكّرة"، وواكبوا مشاريع قيل لهم إنها "مشاريع وطنية" أتقن إعدادها أناس ركبوا الموجة، واندسّوا في صفوف المعارضين، ثم عقدوا اتفاقات وتفاهمات مع من هم في السلطة، وقبضوا الثمن، ودخلوا في اللعبة عن قصد وتصميم، وتحولوا إلى زعماء وقادة بفضل قوىً بعضها خفي وبعضها معلن، وأضاعوا على أبناء جلدتهم، بسلوكهم المشين هذا، فرصاً، وأهدروا إمكاناتٍ كان يمكن أن تستثمر في بناء الدولة وتحصين المجتمع.
وفي ضوء ما تشهده جبهة الحكم هذه الأيام من تحضيرات واستعدادات لمواجهة ما قد يحدُث، فإن مهمة الحراكيين/ الثوار سوف تكون هذه المرّة أكثر صعوبة مما سبق، وأقرب ما تكون إلى معركة مصير لا يتوقع أحد أن تحقق أهدافها بسهولة، وما يريده العراقيون منها أن تشكّل خطوة عملية عريضة نحو منع اغتيال الأمل بإمكانية التغيير، وهو ما تسعى إليه قوى الأمر الواقع، وتجذير الثقة في قدرة الشعب على الفعل.
من الناحية الأخرى، أخذت قوى السلطة تشعر بالرعب، وهي تدرك حجم المخاطر التي تلاحقها، ليس بسبب تصاعد المد "الحراكي" ضدها فحسب، وإنما بسبب الانقسامات الحاصلة في صفوفها أيضاً، وذلك إثر انشقاق "التيار الصدري" عنها وتضارب الآراء بين أطراف "الإطار التنسيقي" بخصوص هذه المسألة، إذ يرى زعيم حزب الدعوة، نوري المالكي، ومعه زعيم مليشيا عصائب الحق، قيس الخزعلي، ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة جديدة، وعدم أخذ موقف مقتدى الصدر المعارض بنظر الاعتبار، في حين يرى هادي العامري الممثل لتحالف الفتح أن ذلك يفضي الى الاصطدام بالصدر الذي قد يعمد إلى إثارة الشارع وإحداث المشكلات أمام الحكومة.
ونتيجة لكل هذه التداعيات، اتجه "الإطار التنسيقي" إلى مد يده إلى من هم خارجه لإقامة تحالف جديد باسم "قوى الدولة"، يضم أطراف الإطار الحاليين إلى جانب الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة اللذيْن أدارا ظهريهما للصدر، حيث كانا متحالفين معه، ما يعني محاولة لعزل الصدر الذي رفض أية تسوية مع "الإطار". .. وكخطوة استباقية، أقدمت مليشيات "الحشد الشعبي" على تنظيم حملة اعتقالات لمجموعة من الناشطين، بتهمة العمل في صفوف حزب البعث المحظور.
إيران نفسها، وهي الراعية للعملية السياسية إلى جانب الولايات المتحدة، بدأت تتحسّب لما قد يمكن أن تشهده الأيام المقبلة من تداعيات، بما قد ينعكس على نفوذها في العراق، باعتباره الحلقة الأخطر والأهم في مشروعها في المنطقة، وقد ظهرت ملامح هذا التحسّب في توجيه المليشيات المرتبطة بها، لتوخّي أقصى درجات الحذر والترقب، لما قد تؤول إليه الأوضاع، هذا إضافة الى إبقاء قوة من الحرس الثوري في بغداد، كانت قد جاءت إلى العراق تحت غطاء الإشراف على تأمين الخدمات للزوار الإيرانيين في أربعينية الحسين.
وبالمختصر المفيد، إن فصلاً جديداً في تاريخ العراق على الأبواب، وقد يتأخّر قليلاً أو كثيراً، لكنه في النهاية قادم حتماً، إنه منطق التاريخ الذي لا يعرف المساومة ولا التزييف.
عن "لعبة الكلمات المتقاطعة"
في العراق
عبد اللطيف السعدون
ثمّة ما هو جديد في "لعبة الكلمات المتقاطعة" التي يجرى تداولها بين رجال السياسة وزعماء المليشيات في العراق منذ ما يقرب من عقدين، وجديدها هذه المرّة دخول القضاة عنصرا فاعلا في إدارتها والتدخل في مسارها، إذ أفتت المحكمة الاتحادية بوجوب حل البرلمان، لأنه لم يقم بواجباته الدستورية، وتجاوز عن المدد التي حدّدها الدستور في مسألة تشكيل الحكومة، (لماذا لم تتصدّ المحكمة إياها لهذا التجاوز في حينه؟). وأضافت المحكمة أن أعضاء البرلمان لم يراعوا مصلحة الشعب، وكانوا السبب في تعطيل مصالح البلاد وفي تهديد سلامتها!.
هكذا برّرت المحكمة "الخائفة والمستسلمة"، بتعبير مقتدى الصدر، وجوب الحل، لكنها عادت لتقرّر أن الحل يجب أن تكون له مبرّراته، وكأنها تريد أن تقول إن ما طرحته ليس كافيا ولا يرقى إلى تبرير الحل. وفي التفاتة ثالثة، رأت أنه لا يحق لها دستوريا اتخاذ قرار الحل، وإنما هناك "جهة مختصة" لها سلطة اتخاذ قرار كهذا "إن توفرت المبرّرات!". وبذلك نزعت المحكمة عن نفسها مسؤولية اتخاذ القرار المطلوب، لتعيد بذلك المسألة إلى نقطة الصفر، وتضع الكرة بين أقدام رجال السياسة وزعماء المليشيات يتقاذفونها حيث يشاؤون.
يزيد من قوة موقف المالكي أن طروحاته تحظى بمباركة طهران، وإن كانت تزعم أنها تقف على مسافة واحدة من طرفي الخصومة
في هذه المرّة، بدت المحكمة مروّجة مطلب أحد طرفي الخصومة، وهو "الإطار التنسيقي"، أو قل متواطئة معه، لأجل تمرير "صفقة" سياسية، يستطيع من خلالها نوري المالكي أن يعود "رجلا أول" في المشهد السياسي، بعد أن فقد كثيرا من عناصر قوته إثر "التسريبات" الأخيرة لأحاديثه. وهدف المالكي إعادة إنتاج "العملية السياسية" الماثلة، بعد أن أوشكت على السقوط، عبر عقد جلسة للبرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية، ومن ثم تشكيل حكومة خاضعة لـ"الإطار"، تأخذ على عاتقها إجراء انتخابات برلمانية مبكّرة. هذا على خلاف مطلب خصمه اللدود مقتدى الصدر، الذي يريد حل البرلمان فورا بقرارٍ من رئيسي الجمهورية والحكومة، وتمديد عمر حكومة مصطفى الكاظمي من أجل أن تشرف على الانتخابات المبكّرة. وبالتالي، استثمار الشعبية التي حصل عليها عند نزول أنصاره إلى الشارع، لكن تراجع حلفائه، الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة السنّي، عن دعمه وتبنّيهم موقف المالكي، وجّها له ضربة قاصمة، ووضعاه من جديد في الزاوية الحرجة.
يزيد من قوة موقف المالكي أن طروحاته تحظى بمباركة طهران، وإن كانت تزعم أنها تقف على مسافة واحدة من طرفي الخصومة. أما واشنطن، وهي الداعمة الأخرى للعملية السياسية، فإنها تسعى إلى دفع العراق إلى موقعٍ أقل انحيازا لإيران، وتراهن على "تغيير" محدود يسمح بنقلة نوعية في إدارة السلطة في بغداد، من دون خسائر كبيرة لنفوذها. وهذا، في رأيها، يمكن لحكومة من الصدريين و"التشرينيين" والعناصر المستقلة أن تنهض به، لكن فرصة تحقيق هذا السيناريو تظلّ ضئيلة. وأيضا، العودة إلى الشارع غير ممكنة في الوقت الحاضر، لأسباب كثيرة.
وعلى أية حال، يسجل على المحكمة الاتحادية أنها، كما فعلت في مرّة سابقة عندما اتخذت قرارا منحازا بخصوص "الكتلة الأكبر"، فإنها، في هذه المرّة أيضا، تكون قد غادرت موقعها القانوني، وأخذت "تشتغل" سياسةً لمصلحة أطرافٍ معينة، متخلية عن صفة "الاستقلالية" التي ينبغي أن تتصف بها كي تقيم العدل، وتحكُم وفق ما يقرّره الدستور.
تكبر "لعبة الكلمات المتقاطعة"، وتزداد عقدة الاستعصاء، ويبتعد الحل، ويستمرّ تعطيل مصالح الناس
وهكذا يصبح رجال القضاء كمن يرون ضوءا في آخر النفق، ثم يسارعون إلى بناء نفق أطول، وتكبر "لعبة الكلمات المتقاطعة"، وتزداد عقدة الاستعصاء، ويبتعد الحل، ويستمرّ تعطيل مصالح الناس التي تزعم المحكمة حرصها عليها، كما يصبح التهديد بسلامة البلد الذي وضعته المحكمة على كفّ عفريت أمرا مقدّرا ولا مفر منه.
ما العمل إذن؟ مع تعدّد "السيناريوهات" المحتملة، واختلاط بعضها ببعضها الآخر، يصبح من الصعب القول إن العراق مقبلٌ على مرحلة استقرار وهدوء، بل قد يستمرّ الصدام بين القوى الفاعلة اليوم في المشهد السياسي، وقد يتطوّر الصدام إلى ما هو أعنف وأكثر حدّة، إلى درجة أن يغري ذلك قوى خارجية بالتدخل لحماية مصالحها. وثمّة تقارير تؤكد أن إيران جاهزة للتدخل في حالة حدوث فراغ في السلطة، وأنها، كما تقول تلك التقارير، أدخلت إلى العراق في الآونة الأخيرة، لهذه المهمة، فرقة خاصة من الحرس الثوري، تحت ستار تأمين حماية زوار أربعينية الحسين.
هذا يعني أن لعبة الكلمات المتقاطعة لن تمرّ بسهولة، والرابح هو الذي سوف يرفع يده في النهاية، أما الخاسر الأكبر في كل الأحوال فهو العراق.
هل وصل
العراق إلى كرة النار؟
عبد اللطيف السعدون
رجعتُ الى السياسي العراقي العتيق، أسأله: كيف يرى الحال اليوم في
بلاده... أجابني: "لم يعد العراق اليوم مركز الكون الذي تحدّثت عنه
الأساطير، فقد هشّمته السياسات الهوجاء والأقدار القاسية على مدى عقود،
حتى كادت أن تودي بكيانه الموحّد، وتجعله هشيما تذروه الرياح، وهو في
هذه الأيام يوشك أن يصل إلى كرة النار. لا أحد يعرف كيف ستؤول الأمور،
لا نعرف كيف ستسير الأمور بعد ذلك، نحن الذين اختبرنا السياسة
واختبرتنا السياسة لم يعد سهلاً علينا أن نقول كلمتنا، فالأحداث
اليومية في حالة سيولة، وتكاد تنعدم الرؤية في ملاحقة ما يجري".
واستطرد: "العراق الذي نعرف لم يعد مكاناً آمناً صالحاً للعيش، بعدما
استوطنته المليشيات، واصطبغ كلّ ما فيه بلون الدم، ولم تعد بغداد بيئةً
قابلة للتسويات أو للحلول الوسط، فقد انقطعت الخيوط بين كلّ الأطراف
الفاعلة في المشهد السياسي، كما لم يعد هناك رابطٌ بين ما يفكّر فيه
السياسيون وبين ما يريده المواطنون الذين انصرفوا عن تأمل الواقع
الماثل، وبعضهم أدمن اليأس، ولم يجد ضالّته إلّا في ارتياد مواكب اللطم
والعزاء وزيارة القطّارات التي قيل إنّ أولياء الله مرّوا بها،
والأماكن التي كانت مربط خيلهم، عساها تمنحهم البركة وتمدّهم بالعزم
على مقارعة هموم الحياة، حتى ظهور المهدي الذي يجيء ولا يجيء!".
الأميركيون غير غافلين عمّا يجري هنا، فهذه الفوضى الخلاقة هم من صنعوها لنا
تابع: "العراق الذي نعرف لم يعد كما كان، فقد تحوّل إلى بلد مستباح يغشاه تدهور مريع، لا برلمان، لا حكومة، لا قضاء، لا صحافة حرّة، لا إعلام مستقلاً، لا كهرباء، لا ماء، لا خدمات، لا صناعات، لا زرع ولا ضرع، وكلّ من فيه حكّام فاسدون، ومليشيات سوداء، وأمن مفقود، وسلاح منفلت، ومليارات الدولارات تُنهب في وضح النهار، وجوعى يموتون على الأرصفة، وأجساد تتهاوى في القاع بفعل وحشي من فاعل معلوم. الأميركيون غير غافلين عمّا يجري هنا، فهذه الفوضى الخلاقة هم من صنعوها لنا، وهم من كتبوا دستورها، وهم من جمع الأفاقين واللصوص من أزقة العالم كي يحكمونا. أما الايرانيون فقد خطفوا بلدنا، وكل همّهم أن يجعلوا منه "ضيعةً" تابعة لهم تشكّل ممرّاً استراتيجياً نحو البحر، حيث سورية ولبنان وما وراءهما، وبما يوطّد مشروعهم التاريخي الذي يعملون عليه، وهم ينتظرون ساعة توقيع صفقة الاتفاق النووي مع الأميركيين، كي تشرع الأبواب أمامهم للتغلغل أكثر فأكثر في ديارنا، وللتحكّم في مآلات شعوبنا". أردف: "أما أصدقاؤنا فقد أشاحوا بوجوههم عنا، ولم يعودوا في وارد الاهتمام بنا، ولم تعد تصل إلينا منهم سوى رسائل رثاء وتعاطف كاذب، وسوى صدقات متواضعة، لا تكاد تصل إلى أفواه الفقراء، وصداقات تأخذ منا أكثر مما تعطينا".
أقدار العراق أصبحت مفتوحة على كلّ الاحتمالات
وقال: "إنّنا نعيش أزمات حقيقية، ما إن نسعى إلى حلها حتى تلد أخرى،
والمفاتيح القديمة لم تعد تصلح لفكّ مغاليقها أو التعامل معها، والذين
يراهنون على حلول قاصرة، وإصلاحات مؤقتة من قبيل إجراء انتخابات جديدة
أو تغيير القضاة أو تعديل الدستور يكونون كمن يريد معالجة مريض السرطان
بالحبوب المخدّرة التي تأخذه إلى الموت البطيء، وهذا ما نخشاه على
بلدنا!"
سألته: ما الحلّ إذاً؟ أطلق زفرة طويلة قبل أن يجيب: "لا حلّ في الأفق،
لا ضوء في آخر النفق، ربما نحتاج زمناً أطول كي نتحسّس جراحنا، ونتلمّس
ملامح مشروعٍ ما، يمكّننا من استعادة بلدنا من أيدي خاطفيه والمهيمنين
عليه. إننا اليوم نعيش ما يشبه تلك اللحظة التي شخّصها المفكر
الإيطالي، أنطونيو غرامشي... القديم ينهار وهو في طريقه إلى الموت، لكن
الجديد لن يولد بسهولة... والطريق بين نقطتي الموت والولادة لا يسير
وفق خط مستقيم كما في علم الرياضيات، بل يبدو متعرّجاً متدحرجا على نحو
حرج، وقد تواجه السائر عليه عقبات وعراقيل قد لا تخطُر على بال. إنّنا
نوشك أن نصل إلى كرة النار، وكي لا نحترق نحتاج إلى فعل بمستوى الأخطار
التي تحيق بنا، فعل من "قماشة" مختلفة، تعيد لنا هيبتنا، وللدولة
سيادتها، ولمواطننا حريته، وكرامته، وحقوقه. وإلى أن يحين زمان هذا
الفعل، وإلى أن يظهر رجاله، علينا أن نشد على جروحنا، وأن نكظم غيظنا،
وحسبنا الله".
توقف السياسي العتيق عن الكلام، لكنّه لم يغلق الهاتف، ربما أراد أن
يُشعرني بأنّ أقدار العراق أصبحت مفتوحة على كلّ الاحتمالات.
في العراق أزمات تأبى أن تنفرج
عبد اللطيف السعدون
نذكر للزعيم الصيني الراحل ماو تسي تونغ قوله "الأوضاع يجب أن تصبح أسوأ كي تصير أفضل"، وفي مأثوراتنا الشعبية "اشتدّي أزمة تنفرجي"... في العراق، يحدث العكس، تشتدّ الأزمات، وتكبر المشكلات، لكن دائرة الحل تضيق فلا الأشياء تصير أفضل، ولا الأزمة تنفرج، ويظل مطلوباً من العراقيين أن يواجهوا قدرهم وحدهم في غياب رجال "قمم" يمكنهم أن يصنعوا لبلدهم تاريخاً جديداً بعدما أفرغته زمرة اللصوص وقطّاع الطرق والطارئين على السياسة من كل ما يؤهله لإعادة بناء دولته.
برزت في الأسبوع الأخير وقائع وتداعيات استقطبت اهتمام المعنيين في صيف العراق اللاهب، من بينها أحاديث رئيس حزب الدعوة، نوري المالكي، المسرّبة التي شكلت نقطة تحول في المشهد السياسي الماثل، ودفعت لاعبين عديدين إلى التموضع الحذر، خصوصاً بعدما أظهر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، موقفاً أكثر تصلّباً من ذي قبل، فيما يخص علاقته مع خصمه اللدود الذي نعته بأوصاف جارحة ومهينة، واتهمه بتبنّي "مشروع بريطاني يعيد العراق إلى سيطرة السنة"، ووضعت الطرفين على شفا خصومةٍ قد لا تنتهي قبل أن ينهي أحدهما الآخر سياسياً، ويقذف به خارج اللعبة.
لن ننسى أن المالكي سعى إلى درء الشر عنه بإنكاره ما تحدّث به، وتشبثه بأية صيغةٍ تمكّنه من ترميم ما انكسر، إلا أن الصدر ظل مصرّاً على موقفه، ورافضاً أي مسعى للوساطة أو للتوصل إلى تسوية، فهذه هي فرصته لتصدّر المشهد، وقيادة "العملية السياسية"، يتناغم مع هذا كله طموحه ليكون "حسن نصر الله العراق" في المرحلة التالية، وهو ما أشار إليه صراحة المالكي في أحاديثه المسرّبة، خصوصاً أن الدوائر الفاعلة في إيران جاهزة لدعم مثل هذا التوجّه، بعدما أدركت أن ورقة المالكي قد احترقت، وأن الصدر يمكنه كسب معظم أبناء الطائفة الشيعية إلى جانبه، كما أن الشعارات التي يطلقها تياره تتماهى مع ما تريده شرائح واسعة داخل المجتمع العراقي.
الدوائر الفاعلة في إيران جاهزة لدعم مقتدى الصدر، بعدما أدركت أن ورقة المالكي قد احترقت
يظل هناك من يرى أنه رغم التعقيدات الماثلة للعيان في هذا المشهد تظلّ هناك خيوط ربما تدفع إلى طي هذه الصفحة واستعادة صيغة "التخادم المتبادل" بين التيار الصدري وبعض حلفاء المالكي المنضوين حالياً في "الإطار التنسيقي"، بشكل أو بآخر، ويبدو هذا ممكناً ما دام الأمر يتم من دون المالكي الذي دخل مع الصدر في معركة "كسر عظم".
لم تتوقف تداعيات "الأحاديث المسرّبة"، بل ازدادت حدّة في الوقت نفسه الذي شبّت فيه تداعيات أخرى، ولكن من نوع مختلف، على خلفية استقالة وزير المال، علي علاوي، التي عدّها بعضهم استقالة "تاريخية"، لأنها كشفت ما يجري من عمليات نهب ولصوصية وفساد كلفت العراق أكثر من تريليوني دولار، ووضعته في قمة الدول الفاسدة، بحسب مؤشّر الشفافية العالمية.
ومع أن الوزير المستقيل أشغل أكثر من وزارة في أكثر من حكومة من الحكومات التي نصبها الأميركيون بعد الاحتلال، ولم يكن أداؤه في الوزارات التي أشغلها أفضل من أقرانه، كما لم تكن تلك الوزارات في منأى عن فضائح فساد وتجاوزات وقصور، لكنه، ربما في صحوة ضمير، وفي محاولة للقفز من السفينة التي توشك أن تغرق أقدم على تقديم استقالته، وشرع يحزم حقائبه للعودة الى بلده الثاني، مكتفياً من الغنيمة بما حمل.
تركيبة الحكم لم تتغيّر، وأخطبوط الفساد والإفساد باقٍ ويتمدّد
مع ذلك، ما يُحسب له اعترافه باستيلاء الأحزاب السياسية النافذة وجماعات المصالح الخاصة على مفاصل واسعة من الدولة، وسيطرتها على قطاعات كاملة من الاقتصاد، وسحبها مليارات الدولارات من الحزينة العامة، وهذه الشبكات محميةٌ من الأحزاب السياسية الكبرى والحصانة البرلمانية وتسليح القانون وحتى القوى الأجنبية. ويخلص الوزير المستقيل إلى لفت الانتباه إلى صعوبة مواجهة كل هذه المخاطر من دون إجراء تغييرات دستورية أو حتى تشريع دستور جديد.
على وقع هذه الاستقالة، تدحرجت كرة الفضائح أكثر، إذ نشرت مواقع التواصل "فيديو" لوزير سابق يقسم بالمصحف الشريف، متعهداً برهن وزارته لصالح شخصية سياسية، وأن يلتزم بأوامرها طوال وجوده في المنصب. كما طلب أحد المحافظين، في تغريدة له، ما سماها "حماية دولية" مقابل تعهده بكشف ما يعرفه عن شبكات فساد بالأسماء الصريحة والأرقام، كل هذا والقضاء صامت، وكأن الأمر لا يعنيه.
بالمختصر المفيد، تُشعرنا هذه الوقائع أن الأعوام العشرين السالفة لم تمُت بعد، وأن تركيبة الحكم لم تتغيّر، وأخطبوط الفساد والإفساد باقٍ ويتمدّد، ولسوف تشتدّ الأزمات، وتكثر المشكلات، ومعها سوف تضيق دائرة الحل، فلا الأشياء تصير أفضل، ولا الأزمة تنفرج!
محنة المبدع في خريف عمره
عبد اللطيف السعدون
لا شيء أكثر قسوةً على المبدع، شاعراً كان أو روائياً، مفكّراً أو
فناناً، من أن يُمتحن في صحته، في أمنه، في حريته، وفي شروط إنسانيته،
الأكثر قسوة وإيلاماً أن يتعرّض لامتحان كهذا، وهو في خريف عمره، وبعد
أن يكون قد أعطى الكثير مما يُحسب له في ميزان حسناته.
واحدة من الخطايا التي ترتكبها الأنظمة الجائرة خطيئتها في محاربة
الإبداع والمبدعين بكلّ ألوانهم وأصنافهم، أو على الأقل في تجاهلهم
وإنكار حقوقهم، أقلها الحقوق الإنسانية التي أعطتها الطبيعة لهم، وهي
في مسلكها هذا تعبّر عن خشيتها منهم، لأنهم يفضحون سوءاتها، ويسعون إلى
تغيير العالم المحيط بهم، ويطمحون لتوفير الشروط الإنسانية لمجتمعاتهم
عبر القصيدة والرواية واللوحة الفنية والموسيقى. ولذلك، يصبح همّ تلك
الأنظمة هو إما العمل على إغرائهم، وبالتالي إلحاقهم بعربة السلطة أو
ممارسة الضغوط عليهم بهذه الطريقة أو تلك، وصولاً إلى إقصائهم عن
المشهد العام وإجبارهم على العزلة والوحدة، أو دفعهم إلى الهجرة إلى
المنافي.
وفي الوجه الآخر للعملة، تسبغ تلك الأنظمة رعايتها على الأميين ودعاة
التجهيل والخرافة، وتمنحهم الحظوة والحماية، وتروّج ما يزعمونها من
أساطير، وما يبثّونه من أوهام وخرافات يختلقونها أو يعيدون إنتاجها
وتسويقها لإدامة ما يرونه ضامنا لحياتهم وللنظام الاجتماعي الشرير الذي
لا يحميهم فقط، إنما يكافئهم مالاً، وموقعاً، وجوائز، وشهادات.
تكاد تقبض على أرواح مبدعي العراق ثلة من الطارئين على السياسة والحكم "رجال جوف مملوءة رؤوسهم بالقشّ"
ليس ثمة مثال في عالمنا العربي على ما نقوله أكثر وضوحاً من حال
العراق، حيث تكاد تقبض على أرواح مبدعيه ثلة من الطارئين على السياسة
والحكم "رجال جوف مملوءة رؤوسهم بالقشّ" كلّ همّهم الحفاظ على ما
غنموه، وفي ظلهم يختبر المبدع حياته، حتى لو كانت على حد الموت،
والشواهد كثيرة، وأمامنا "عيّنات" تفضح هذا التردّي الفاجع في حال
الثقافة في بلد له ستة آلاف سنة في البناء الاجتماعي والإسهامات
الحضارية والإبداع في شتى مجالات الفنون والعلوم والآداب.
أمامنا الشاعر العراقي، سامي مهدي، صاحب "رماد الفجيعة" و"أسفار الملك
العاشق" و"الأسئلة" و"الزوال" و"مراثي الألف السابع" و"لا قمر بعد هذا
المساء" وعشرين مجموعة شعرية أخرى، منها قصائد مترجمة لجاك بريفير
وهنري ميشو، وخمسة عشر كتاباً في النقد والأدب ومسائل الثقافة، والذي
أنفق ستين عاماً من عمره في خدمة الدولة، آخرها عمله رئيساً لتحرير
أكثر من مجلة ثقافية وصحيفة، ومديراً للإذاعة والتلفزيون ومديراً
للشؤون الثقافية. وتراه قعيد بيته منذ عشرين عاماً متقاعداً بلا راتب،
بعدما أوقف المعنيون صرف راتبه الذي يستحقه قانوناً بعد تلك الخدمة
الطويلة، بدعوى أنّه من أنصار العهد السابق. وفي آخر أخباره رقوده على
سرير المرض، وحاجته إلى الرعاية الطبية بما يدعم حياته في خريف عمره.
وأمامنا عبد الرحمن مجيد الربيعي الذي قدّم لنا "السيف والسفينة"
و"وجوه من رحلة التعب" و"الأنهار" و"القمر والأسوار" وعشرين رواية
ومجموعة قصصية أخرى، ومجموعات شعرية ونثرية ودراسات نقدية، زاول
التدريس والعمل الصحافي وعمل مديراً للمركز الثقافي العراقي في كلّ من
بيروت وتونس، وخرج من رحلته الوظيفية تلك براتب تقاعدي ضئيل لا يكاد
يسد احتياجاته الشخصية، بضع مئات من الدولارات. وقد أخذته منا، هو
الآخر، غائلة المرض، ليعيش معتزلاً في منزله بمدينته الأولى، الناصرية،
من دون أن يلتفت إليه أحد.
السلاح المليشياوي الشرّير المنتشر في كلّ البلاد قادر على النّيل من المنخرطين في دروب الإبداع وإسكات أصواتهم
وأمامنا أيضاً عشرات، إن لم نقل مئات من المنخرطين في دروب الإبداع
يتعرّضون اليوم للمحنة نفسها في ظل النظام (الديمقراطي!) الذي أقامه
الأميركيون، وهيمن عليه الإيرانيون، وهم قعيدو بيوتهم لا يبارحونها،
تلاحقهم الكوابيس والمخاوف، وآخرون اختاروا المنافي بعدما شعروا بأنّهم
باتوا غير آمنين في بلدهم، وأنّ السلاح المليشياوي الشرّير المنتشر في
كلّ البلاد قادر على النّيل منهم وإسكات أصواتهم إن تجرّأوا وفتحوا
أفواههم بكلمة نقد لهذا الزعيم المليشياوي أو ذاك، أو قدّموا عملاً
يحاكم الواقع الفاسد ويبشّر بتغييره، وقد رحل بعضهم وسط مكابدتهم في
منافيهم من دون أن يتسنّى لهم أن يلقوا النظرة الأخيرة على بلادهم،
ورقدوا في مقابر الغرباء من دون أن ترتفع أصوات الأجهزة المعنية
بالثقافة، ولا حتى المنظمات التي تزعم رعايتها الإبداع وحمايتها
المبدعين بالدعوة إلى إنصافهم ورفع الحيف عنهم.
هكذا، في العراق تدور في العمق الحرب على الإبداع والمبدعين، يرافقها
سعي القوى المسيطرة جاهدة إلى تكريس الجهل والخرافة، وقد لا تبدو هذه
الحرب الشيطانية مرئيةً في عيون بعض "المثقفين!" الذين باعوا أقلامهم،
وركعوا على ركبهم يغنّون لجلاديهم "الدنيا ربيع والجو بديع" وكفى الله
المؤمنين القتال.
في إشكاليات
شخصية مقتدى الصدر
عبد اللطيف السعدون
كومة إشكاليات تستدعي النظر في شخصية زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، بعضها مكشوف ومعلن، مذ دخل الميدان السياسي بعد الغزو الأميركي للبلاد، وبعضها الآخر كان مضمرا ومستترا إلى ما قبل "صولته" التي أطلقها أخيرا في مواجهة خصمه اللدود زعيم حزب الدعوة، نوري المالكي وانسحاب نوابه من البرلمان، ثم جاءت أحاديث المالكي المسرّبة التي هاجمه فيها، ووجّه له جملة انتقادات طاولت شخصيّته ومسيرته السياسية، ولم تخلُ حتى من التهديد بتصفيته، حيث وجد الصدر عبرها الفرصة لإطلاق سلسلة مواقف تخطّت المالكي شخصا لتتجه إلى الشأن العام، وتتبلور في سلسلة خطوات مثيرة، ليس أقلها دخول أنصاره المنطقة الخضراء واقتحام البرلمان، وتمرّده على العملية السياسية الطائفية التي كان أحد أقطابها الرئيسيين إلى أشهر قليلة، وشروعه في عملية سياسية "إصلاحية"، على حد وصفه. وفي كل هذه التداعيات التي لا تزال في حالة سيولة لافتة، برز الصدر "زعيما" إشكاليا يشار إليه بالبنان إلى درجة أن خيّل لبعضهم أنه أضحى يدير اللعبة وحده من دون منافس، ومن دون اعتبار للخصوم ولا حتى للأصدقاء والمساندين، وتركّزت عيون الجميع على "تويتر" ترصد تغريداته، فيما هو ينام ملء جفونه عن شواردها، ويسهر القوم جرّاها ويختصمون!
يبلغ تضخّم الأنا عند مقتدى الصدر مداه، عندما يصنّف نفسه "حفيد الحسين" وسليل عائلة الصدر التي لها قدسية خاصة ومكانة متميزة
الملاحظ أن الصدر يقدّم نفسه زعيما "وطنيا"، لأن "الوطن أغلى من كل شيء، وهو في القلب وفي الضمير"، وهو "عراق الآباء والأجداد"، ويشرع في الفترة الأخيرة بمخاطبة الشعب "بكل طوائفه وأعراقه وأقلياته وانتماءاته وأديانه وعقائده وأفكاره وتوجّهاته مهما كانت". ويتهم خصومه بخيانة الوطن والتبعية لقوى أجنبية، لكنه يعود، في أكثر من خطاب وتغريدة، لاستدعاء "المذهب" وإعطائه مكانة متفرّدة متقدّمة على الوطن بمراحل، وبطريقةٍ تستشف منها نوعا من المغالاة والمبالغة.
يحاول أيضا تكريس نفسه زعيما "شعبويا" داعية إلى الإصلاح، ومناضلا من أجل الشعب وممثلا له ومعبرا عن تطلعاته، وهو القادر وحده على تحقيق أهدافه، لكنه أيضا منفصلٌ عنه لكونه يقف منفردا متفرّدا، "إن كنتم تريدون الإصلاح والتغيير فإنني بانتظاركم، وإن رضيتم بواقعكم مهما كانت صفاته ومساوئه فهذا أمرٌ راجع إليكم". وتحمل هذه العبارة نبرة تهديد بأنه قد "يزعل" عليهم، وقد يعتزل الناس مقيما في "الحنانة" بالنجف أو "مهاجرا" إلى إيران أو لبنان كما فعل مرّات، وعندها ربما يذهبون إلى مصير مجهول ما دام هو غير راض عنهم. يعود، في موضع آخر، طالبا رضاهم، "استغلوا وجودي لإنهاء الفساد .. لست طالبا لسلطة، ولا عندي مغنم شخصي .. ولكنني أطلب الإصلاح.. والثورة بدأت صدرية، وما الصدريون إلا جزء من الشعب والوطن".
يبلغ تضخّم الأنا عند مقتدى الصدر مداه، عندما يصنّف نفسه "حفيد الحسين" وسليل عائلة الصدر التي لها قدسية خاصة ومكانة متميزة، وهذه الميزة الاستثنائية تفرض على جمهوره واجب طاعته والالتزام بوصاياه من دون نقاش، إذ هو لا ينطق عن الهوى، ولا هدف له سوى خدمتهم وإصلاح أحوالهم.
لا يعد الصدر بزعامةٍ حقيقيةٍ يمكنها أن تقود البلاد، وتتحمّل عبء إحداث تغيير جذري في نظامها السياسي وآلياته
يبدو الصدر أيضا، وفي أكثر من موضع، نرجسيا حد النخاع، متعاليا على أنصاره، مراقبا لهم ومتابعا ما يفعلونه، وهو يستطيع، كما قال، بقصقوصة صغيرة، أن يحاسبهم إذا ما أخطأوا، ويطردهم من تياره إذا لم يعتذروا ويطلبوا العفو، بتغريدة واحدة يمكنه أن ينقلب على حاله ليتخذ موقفا مستجدّا من قضيةٍ سبق أن أعطى فيها رأيا مختلفا، وهو بذلك لا يعتبر نفسه متناقضا مع نفسه، لأنه يرى ما لا يراه الآخرون، وحده يعرف كيف يدير اللعبة.
ومع أن "التيار الصدري" ليس حزبا سياسيا له آلياته ونظامه وعلاقاته الداخلية بين قيادته والمنخرطين فيه، إلا أن الصدر يحرص دائما على وضع القواعد التي تحكُم تلك العلاقات، كأن يعين "وزيرا" له ينطق باسمه، ويشكّل مكاتب ولجانا لمهامّ معينة، ويقرّر العقوبات التي يفرضها على من يخرج على وصاياه، وهو، في كل هذه الإجراءات، لا يستشير أحدا من المقرّبين منه، وإنما يدعهم يُفاجأون بأوامره، كما يُفاجأ من هم خارج التيار. وفي تحالفه "سائرون" الذي شكله في الانتخابات السابقة مع الشيوعيين وأحزاب أخرى، كان يعطي لنفسه الحق في الإعلان عن مواقف معينة ومن دون استشارتهم، وهذا ما فعله أيضا مع شركائه في "تحالف إنقاذ وطن" في انتخابات أكتوبر الماضي، وجديد ذلك خطوة إلزام نوابه بالاستقالة من البرلمان من دون أن يتشاور معهم.
بالمختصر المفيد، كل هذه الإشكاليات لا تعدنا بزعامةٍ حقيقيةٍ يمكنها أن تقود البلاد، وتتحمّل عبء إحداث تغيير جذري في نظامها السياسي وآلياته، وتلك هي حكاية أخرى.
أبعد من قذائف دهوك..
عبد اللطيف السعدون
اللعبة الماثلة أمامنا في العراق متعدّدة الوجوه، مختلفة النيات، وقد تكون أيضاً متناقضة المسارات، لكنّها اللعبة المفروضة التي لا قبل للعراقيين بمواجهتها، واللاعبون مختلفون، دوليون وإقليميون، وعراقيون أيضا، وكل منهم يغنّي على ليلاه، وليلى العراقية مريضةٌ ولا أحد منهم يعنيه مرضها.
كان الأسبوع الماضي مليئاً بالمشاهد الصادمة، وغارقاً في سيناريوهاتٍ مخضّبة بالدم والدموع، كما هي العادة منذ عشرين عاماً، ومنذ أتاح الغزو الأميركي البلاد الفرصة أمام القوى الإقليمية لتبسط هيمنتها وتفرض نفوذها، وحتى أن تبعث جيوشها وتقيم قواعدها العسكرية، وتحوّل العراق الى موطن لصراعاتها وخلافاتها، وتسعى كل واحدةٍ منها إلى مدّ خرائطها الاستراتيجية بأمل أن تقضم هذا الجزء أو ذاك، عندما يحين وقت القسمة، وذلك كله في غياب دولة عراقية ذات سيادة تفرض هيبتها، وتمنع التدخل في شؤونها.
أكبر الرابحين في هذه اللعبة المعقدة إيران التي تعدّ العراق امتداداً ديمغرافياً لها، ورأس الحربة في مشروعها الإمبراطوري الذي تستهدف من خلاله المنطقة كلها. ولذلك هي غير مستعدّة للتخلي عن مطامعها في هذا البلد، وتعمل ما استطاعت لإبقاء القرار بيدها، وقد مدّت خرائطها الاستراتيجية عبر العراق إلى ما هو أبعد، إلى سورية ولبنان وإلى اليمن أيضاً، بل اعتبرت بغداد، في أكثر من مرة، واحدة من عواصم إمبراطوريتها، ولذلك هي حاضرة لأن توظف أي حدثٍ عراقيٍّ أو إقليمي لخدمة أغراضها، ولا تسمح بأية محاولةٍ لإفلات العراق من قبضة يدها!
وقائع الأسبوع الماضي تكرّس هذه الرؤية، إذ ما إن تناقلت النشرات العاجلة خبر سقوط قذائف على منتجع برخ السياحي في دهوك بشمال العراق، والتي تسببت في إزهاق أرواح بريئة، تردّد اتهام تركيا بتدبير الهجوم. وقبل أن يتأكد ذلك الاتهام، سارعت القوى السياسية الموالية لإيران إلى تحميل تركيا المسؤولية عن العدوان، والمطالبة باتخاذ إجراءات عقابية ضدّها من قبيل قطع العلاقات الدبلوماسية، ووقف التعامل التجاري معها، واشتغلت الماكينة الإعلامية للمليشيات الولائية لتطلب الاقتصاص من تركيا، وتحرّض على اقتحام مكاتب دبلوماسية تابعة لها في مدن عراقية، واستهدفت مليشيا مرتبطة بالحرس الثوري قواعد عسكرية تركية في محافظة نينوى بصواريخ من طائرات مسيّرة لتزيد الموقف تعقيداً، فيما سعت أنقرة إلى النأي بنفسها عن الواقعة، وألقت بها على حزب العمال الكردستاني المعادي لها، والذي يتخذ من مناطق الشمال العراقي مقرّاً له، ولقياداته التي يقال إنّ حكومة بغداد، ومن ورائها إيران، توفر الغطاء لها، وفي الوقت نفسه، دعت أنقرة إلى تحقيق دولي فني، يحدّد الجهة الفاعلة، لكنّ بغداد التي اعتادت الصمت عن أكثر من عدوان سابق من هذه الجهة أو تلك، وجدت في إحالة الأمر إلى مجلس الأمن ما يحفظ ماء وجهها، ويعفيها من مسؤولية التوجّه إلى حلّ المشكلات المزمنة في علاقتها مع أنقرة، وفي مقدمتها مشكلة المياه، ومشكلة وجود منظمة "إرهابية" على أراضيها تناصب تركيا العداء، وكذا الوجود العسكري التركي على أرضٍ عراقية. وهكذا لم تستغل بغداد الفرصة لفتح حوار موضوعي مع جارتها الشمالية لإرساء علاقات متكافئة بينهما.
توصلنا كل هذه التداعيات إلى جملة من الحقائق التي يعمد كثيرون إلى تجاهلها، أولاها أنّ العراق، ومنذ الغزو، عانى ويعاني من غياب دولةٍ ذات سيادة، ومن ضعف الحكومة وعجزها عن صد التدخلات التي تحصل من دول، أو حتى من منظومات ومليشيات تابعة لهذه الدولة أو تلك.
الثانية أنّ الطبقة السياسية الحاكمة التي نصّبها الاحتلال الأميركي، وكرّست بقاءها الهيمنة الإيرانية، ليست لها الخبرة أو الدراية في إدارة شؤون البلاد، وهي أيضا ليست في وارد التخلي عن مواقعها التي استأثرت بها بدعم أجنبي.
وثالث هذه الحقائق وأكثرها خطورةً اختطاف قرار السلم والحرب من مليشيات مرتبطة بجهات خارجية، وهو القرار الذي يفترض أن يكون بيد سلطات الدولة الوطنية حصرا، وما رأيناه في الرد المسلح من مليشيا معروفة على هجوم دهوك، وإعلان أكثر من زعيم مليشياوي أنّهم سيردّون بالسلاح على كلّ عدوان على العراق، وأنّهم غير معنيين بما تقرّره الحكومة، ما يعني أنّنا أمام ظاهرة توغل المليشيات وتغولها إلى درجة أنّها تطرح نفسها بديلاً عن الدولة.
يبقى السؤال الأخير الذي قد يظل من دون إجابة: من له القدرة على أن يعلّق الجرس في مواجهة هذه اللعبة الشريرة التي هيمنت على العراق عشرين عاماً، ومن سيكفّ أيدي اللاعبين المنغمسة بدماء العراقيين؟
عندما يقع
السياسي في شرّ أعماله
عبد اللطيف السعدون
لسان نوري المالكي السليط الذي ظهر في تسجيلاتٍ مسرّبة عكس رؤيته الطائفية القاصرة إلى مجمل الأوضاع في العراق، وكشف ضحالة تفكيره وسعيه لإثارة الفتنة عبر توجيه الاتهامات يميناً وشمالاً، والزعم أن خصومه الصدريين وحزب مسعود بارزاني وقيادات سُنية يسعون لتنفيذ "مشروع بريطاني يضع الحكم في أيدي السُّنة"، وتحذير مريديه من أن المرحلة المقبلة مرحلة قتال، "وسوف أهجم على النجف في حال هجم (علينا) مقتدى الصدر، ولدي مجاميع مستعدّة، وأنا لا أثق لا بالجيش ولا بالشرط... وقد أردت جعل الحشد الشعبي مشابهاً للحرس الثوري الإيراني"، وزاد باتهام خصومه باستباحة الدماء وسرقة أموال الدولة... إلخ.
ليس مطلوباً من المالكي الذي أوقعه لسانه في شرّ أعماله أن ينفي أو حتى أن يعتذر، فمجمل مسيرته منذ "امتهن" السياسة يشبه مسلسلاً درامياً مطوّلاً يحوي مطبّات عديدة، واختراقات عديدة، وكذا سقطاتٍ عديدة بإمكان السياسي الذكي أن يتجنّبها كي لا يقع في شرّ أعماله. وإذا كان ميكيافيلي قد وصف رجل السياسة بأنه يعمل على تحويل العقبة التي تواجهه إلى فرصة للتراجع والاعتبار، فإن المالكي كان دائماً يحوّل الفرص التي تسنح أمامه إلى عقبات ومآزق له ولمريديه، وحتى لخصومه، وهذا ما فعله من خلال أحاديثه المسرّبة.
وقد تفيدنا مراجعة سريعة لسجله في إعطاء صورة أكثر قتامةً لممارساته المريضة التي هي أكثر من كافية لأن تضعه في قفص الاتهام أمام حاكم عدل.
لم يكن جواد المالكي، وهذا هو الاسم الذي اصطنعه لنفسه إبّان العهد السابق، معروفاً في بداية نشاطه ضمن تنظيمات حزب الدعوة، باستثناء ما يعرفه القريبون منه أنه مكلف جمع التبرّعات من زوار مرقد السيدة زينب في دمشق وتحويلها إلى حزبه، متّخذاً من "دكان" صغير قرب المرقد يبيع فيه "السبح" مكاناً لترويج أفكاره الطائفية بين الشيعة العراقيين المقيمين في سورية، وقد بدأ موقعه داخل الحزب يكبر من خلال مساهمته في تنفيذ عمليات إرهابية ضد مؤسسات وشخصيات عراقية موالية للنظام السابق، ولكنه عندما عاد إلى العراق بعد الغزو لم يجد له مكاناً بين رجال الصف الأول الذين رشّحتهم أميركا لحكم العراق، وعُيّن موظفاً ثانوياً في "لجنة اجتثاث البعث"، لكن قدرته على التسلق وانتهاز الفرص أعانته على الاقتراب من إبراهيم الجعفري، الذي أصبح رئيساً لأول وزارة عراقية بعد الاحتلال، والذي رشّحه لخلافته إثر تنحّيه نتيجة عدم توافق القوى السياسية على بقائه في منصبه.
هنا يبدأ الفصل المثير في حياة المالكي الذي بدأ يتعامل باسمه الحقيقي، نوري كامل المالكي، ويضع خطواته بحذر على أرضية "العملية السياسية" التي هندسها الأميركيون. يقول سفير الولايات المتحدة الأسبق في العراق، زلماي خليل زاد، إن المالكي قدّم له ورقة مكتوبة من ثلاث عشرة نقطة، عرض فيها خدماته، مرشَّحاً لرئاسة الحكومة، ومعبّراً عن استعداده لتطبيق السياسات التي تخدم مصالح الولايات المتحدة. ووجد خليل زاد في المالكي الرجل الذي يمكن أن يحقق الاستقرار، كما قال، واتخذ قراره بالمراهنة عليه ووافق على ترشيحه. وسنعرف بعد سنوات أربع أن المالكي ينفض يده من واشنطن، ويقفز إلى طهران، ليحصل على الولاية الثانية، واعداً بتحقيق كل ما تريده إيران، ومنذ ذلك الوقت، سيصبح رجل إيران في العراق بلا منازع.
في الولاية الثانية، كشف المالكي كل أوراقه، ولم يتردّد في تأكيد ولائه المطلق لإيران، ضمن لها تمدّداً ديموغرافياً داخل بلاده، منح أكثر من نصف مليون إيراني الجنسية العراقية، خلافاً للقانون، أنشأ "مجاميع" مسلّحة تطوّرت لتشكّل النواة الأولى لمليشيات أرادها نسخةً من تجربة الحرس الثوري الإيراني، أنقذ إيران من كارثةٍ كادت تودي باقتصادها، وهي في ظل العقوبات، إذ أغدق عليها مليارات الدولارات من الخزينة العراقية، بطرقٍ أكثرها غير مشروع.
يسجّل عليه تجاهله مخطط إدخال "داعش" إلى الموصل، أو قل تماهيه مع المخطط الشرير وتسببه، وهو صاحب الحل والعقد آنذاك، بأكبر كارثة واجهها العراقيون بعد الاحتلال. وأيضا تسبّبه بمجزرة سبايكر التي أودت بحياة مئات الشباب، وكذلك استغلاله موقعه الرسمي في تبديد مليارات الدولارات، أو قل في سرقتها، وتحويلها إلى خارج البلاد بأسماء مقرّبين منه. وفي عهده وضعت منظمة الشفافية العالمية العراق على رأس قائمة الدول الأكثر فساداً.
وبعد كل هذه "الموبقات"، جاءت أحاديثه المسرّبة لتؤكّد ما هو مؤكّد، وتجهض آخر أمل له في أن يعود رئيساً للحكومة، وهو بذلك يكون قد وقع في شرّ أعماله.
السودان في
انتظار نهاية اللعبة
عبد اللطيف السعدون
ذكّرتنا "خريطة الطريق" التي رسمها رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، في خطابه أخيراً، والتي تضمنت انسحاب العسكر من حوار الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وهيئة التنمية الحكومية)، وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة يكون مسؤولا عن الأمن والدفاع وما يتعلق بهما من شؤون، وطلبه من القوى المدنية تشكيل حكومة انتقالية من بين أطرافها تعمل على إجراء انتخابات، ذكّرتنا بواقعة طريفة قيل إنها حدثت في بغداد إبّان عرس "الجبهة الوطنية" التي جمعت بين البعثيين والشيوعيين منتصف سبعينيات القرن الماضي، عندما فتح الحزب الشيوعي مقرّاً له في شارع مهم في العاصمة العراقية، ورفعت على بوابة المقرّ لوحة كبيرة تحمل اسم "الحزب الشيوعي العراقي". ويزعم مروّجو الواقعة أنّ أحد الخبثاء تسلل في عتمة الليل التالي قاصداً المقرّ، وعند وصوله، تسلق سلّماً كان قد حمله أصدقاؤه معه، وأضاف إلى اللوحة عبارة "لصاحبه حزب البعث العربي الاشتراكي" وانسلّ هارباً قبل أن يلتفت إليه الحراس. واعتبرت هذه الواقعة الطريفة، والتي لا نعلم مبلغ صدقيتها، بمثابة سخريةٍ لاذعةٍ من طبيعة التحالف بين الحزبين اللدودين، والذي لم يقدّر له أن يعمر طويلاً، إذ انفصمت عراه بعد فترة قصيرة، وجّه بعدها البعثيون ضربات قاسية للتنظيمات الشيوعية، ذهب ضحيتها مئاتٌ من أعضاء الحزب وأنصاره.
الرابط بين هذه الواقعة و"خريطة الطريق" التي رسمها البرهان أنّه يريد، كما هو واضح، إقامة حكومة مدنية ترأسها شخصية مدنية من المعارضة، على أن تكون تابعة له، باعتباره رئيس المجلس العسكري الأعلى المقترح. وبعبارة أخرى، تشكيل حكومة مدنية يكون صاحبها، أو مالكها الحقيقي، البرهان نفسه، وعلى النحو الذي قصدته الواقعة العراقية المزعومة.
السودان مقبلٌ على مرحلة قد تكون الأخطر في مسار العمل السياسي منذ انقلاب أكتوبر 2021
وفي أيّ حال، لم تنطلِ على القوى المدنية السودانية المعارضة لسلطة العسكر هذه الحيلة المكشوفة، اذ اعتبرتها بمثابة "شرعنة" لصيغة الوضع الماثل الذي صنعه البرهان نفسه، أو هي "انقلابٌ داخل الانقلاب" لن يغيّر شيئاً في واقع الحال، بحسب وصف "قوى الحرية والتغيير". ولا بد من الاعتراف بوجود خلافات داخل القوى والفعاليات المدنية نفسها، وهذا ما أتاح للبرهان التطلّع غير المشروع للقبض تماما على كل السلطات، وقد أشار إلى هذا ضمنا، في إعلانه الذي حدّد مهمات "المجلس الأعلى" المقترح بشؤون الأمن والدفاع، مضيفا الى ذلك عبارة "حمّالة أوجه" تقرّر أن صلاحيات المجلس تمتد لتشمل "الشؤون الوثيقة بالنشاط العسكري"، وهذا يعني أن للمجلس صلاحية التدخل في كل الشؤون العامة، بدعوى أنّها ترتبط بأمن البلد والدفاع عنه.
ربما ركب الوهم البرهان، وهو يرى أمامه تجربة صنوِه عبد الفتاح السيسي في مصر الذي انقضّ على الحكومة التي كانت قائمة، ونفّذ "خريطة طريق" ضمنت له الاستحواذ على السلطة. وقد يكون أيضا قد دفعه هذا الوهم لأن يفكر في اقتفاء خطوات رئيس تونس، قيس سعيّد، الذي لم يعد أمامه سوى خطوة واحدة يتنفّس بعدها الصعداء رئيسا مدى الحياة. لكن، لن يمر طويل وقت حتى يكتشف حاكم السودان أن حسابات الحقل لا تطابق حسابات البيدر، وأن السودانيين، على الرغم من خضوعهم لحكم العساكر فترات متفاوتة دامت أكثر من خمسة عقود، عانوا فيها الأمرّين، فإنّ المزاج العام للغالبية قد تغيّر، ولم يعودوا في وارد السماح باستمرار الحكم العسكري، وتجاهل مطالبهم في إرساء نظام ديمقراطي، يضمن لهم الحياة الحرّة الكريمة، خصوصا وأن مشكلات محلية وإقليمية تتطلب وجود حكومة قوية، ممثلة لشرائح الشعب الأساسية، وقادرة على التصرّف بوعي وتفهم كامل لتلك المشكلات ونتائجها المحتملة.
لا يبدو واضحاً مشهد المستقبل السوداني في ظلّ الصراع القائم بين العسكر والقوى المدنية
توحي كلّ هذه التداعيات أن السودان مقبلٌ على مرحلة قد تكون الأخطر في مسار العمل السياسي منذ انقلاب أكتوبر 2021، خصوصا بعد توقف حوار "الآلية الثلاثية" التي تشكّلت للبحث في مخرج من الأزمة. وقد تترك هذه "الآلية" الميدان نهائياً بعد خطوة البرهان أخيرا، وتراجع الاهتمام الدولي بالسودان، وتوقّع تصعيد جديد في فعاليات القوى المعارضة بإعلانها الإضراب العام والعصيان المدني حتى انتزاع الحكم من العسكر.
وهكذا، تتعرّض الخريطة الجيوسياسية للسودان لمزيدٍ من التخبّط والعبث، ولا يبدو واضحاً مشهد المستقبل في ظلّ الصراع القائم بين العسكر والقوى المدنية، وإصرار العسكر على الحصول على "الرغيف" كاملاً، حتى لو أدّى ذلك الى التفريط بمصالح البلد العليا. وفي أيّ حال، ثمة وقت أمامنا كي نعرف كيف ستنتهي اللعبة.
عندما يُناكف
السياسيون بعضهم بعضاً
عبد اللطيف السعدون
عادة ما يحظى التلاسن بين السياسيين الذي قد يصل إلى حدّ المناكفة، وحتى التنمّر، باهتمام الناس، وتحفل وسائل الإعلام ومواقع التواصل في أيامنا هذه بعيّنات من تلك الوقائع التي قد يكون القصد منها السخرية والاستهزاء، خصوصاً إذا ما جرت بين سياسيين بينهم خصومة صريحة أو مستترة. ويجد الهواة من المتابعين الفرصة لفبركة ملاسنات أو مناكفات على ألسنة سياسيين، بهدف النَّيْل منهم، أو حتى لمجرّد النكتة، كما قد يجهد بعض رسامي الكاريكاتير أنفسهم في اختلاق مناكفات بين سياسيين، وعرضها في رسوم تثير السخرية والضحك.
ومن بين مناكفات اليوم، ما جرى في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في مدريد، أخيراً، حين كان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، منهمكاً بتدوين ملاحظاته على ورقة أمامه، وفاجأه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن ربّت كتفه، ولم يرُق ذلك جونسون الذي انتفض واقفاً، وحاول تنحية ذراع الرئيس التركي عنه. ولتخفيف حدّة الموقف، ألقى بالتحية على أردوغان باللغة التركية، إلّا أنّه أخطأ اللفظ، ما دفع أردوغان إلى تصحيح اللفظ، قائلاً: "إنّه يخذلنا" في غمزةٍ تشير إلى أصول جونسون التركية. عند ذاك، تغيرت ملامح جونسون، وبدا عليه الغضب، وهو يرفع إصبعه نحو أردوغان، وكادت الواقعة أن تربك أعمال القمة لولا تدخل الرئيس الأميركي، جو بايدن، الذي سارع لاحتواء الموقف، ممسكاً بذراع جونسون قائلاً: "هذه مزحة... هذه مزحة، يا بوريس".
وفي مأدبة العشاء التي أعقبت اجتماع قادة مجموعة الدول الصناعية السبع في بافاريا بألمانيا، تساءل أحدهم عمّا إذا كان عليهم خلع ستراتهم، أجابه جونسون الذي "عادة ما يطلق نكاتاً فظّة ووقحة" بوصف أحد قراء صحيفة الديلي ميل، قائلاً: "علينا أن نظهر عضلات صدورنا لنكون أكثر برودة من بوتين". وعندما وصل خبر الواقعة إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عقّب: "لم أفهم ما يقصدونه من خلع ملابسهم، هل يقصدون فوق الخصر أم تحت الخصر، وفي كلا الحالين، سيكون المشهد مقزّزاً".
ومرة أخرى مع مناكفات جونسون وبوتين، حين صرّح الأول للصحافيين بأنّه لو كانت امرأة هي التي تحكم روسيا لما فكّرت بشنّ حرب على أوكرانيا، ووصف حرب بوتين بأنّها "تعبير عن فحولة سامّة" وردّ بوتين مذكراً إياه بأنّ مارغريت تاتشر، رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، هي التي شنّت حرباً على الأرجنتين من أجل جزر فوكلاند. ولم ينتهِ رد الفعل عند هذا الحد، إذ يبدو أنّه استفزّ أيضاً وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، التي أعربت عن اعتقادها أنّ لدى المرأة قدرة الرجل نفسها على صنع الشرّ.
في العراق أيضاً، وصلت التلاسنات والمناكفات بين أطراف "العملية السياسية" إلى حدّ جعلها تخرج عن المألوف، وتضمّن بعضها شتائم مفضوحة واتهامات بالكذب والفساد، لكنّ الملاحظ أنّ كثيراً ما كان المتناكفون يعودون إلى سابق علاقتهم من ودّ وقبول أحدهم بالآخر، بل والتحالف معه، ويعزو بعض الخبثاء سلوكاً كهذا إلى أنّه "من موجبات التفاهم على الصفقات والعقود التي تدرّ الربح على الجميع، خصوصاً بعد زيادة وارادات النفط أكثر من 11 مليار دولار شهرياً".
ومن المناكفات التي شاهدها العراقيون، دخول زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى اجتماع ضمّ أطراف "العملية السياسية"، وكان خصمه اللدود زعيم حزب الدعوة، نوري المالكي، قد سبقه في الحضور، ولم يسلّم الصدر على المالكي الذي نهض للترحيب به في ما يبدو، الأمر الذي أثار المالكي، ودفعه انفضاض الاجتماع إلى القول إنّه "لا يفقه في السياسة ولا في الدستور"، وردّ الصدر في تغريدة له بأنّ خصومه "وحوش كاسرة"، وقال عن المالكي، من دون أن يسميه: "كلامه منقوص، وعليه تدارك ما ضاع وأضاع، نصيحة مني قربة إلى الله تعالى".
وفي عهد الملوك، كثيراً ما كانت تجري بين السياسيين حالات تلاسُن ومناكفة، لكنها لم تتعدّ قواعد الاحترام والتعامل النظيف. ولا تزال بعض وقائع تلك المناكفات تتردّد كلما ذكرت مآثر رجال النخبة السياسية الذين حكموا العراق آنذاك، ومن بين ما يُروى أنّ نوري السعيد الذي ترأس رئاسة الوزراء 14 مرة فوجئ، في جلسة لمجلس الأعيان، بعضو المجلس الشيخ محمد رضا الشبيبي، وهو يصرخ بوجهه: "أنت ديكتاتور" ولم يغضب السعيد، بل ردّ عليه: "إذا أنا رحلت، وجاء من بعدي آخرون لحكم البلاد سوف تعرف من هو الديكتاتور". وأردف: "اسمع، يا شيخ، لا تتصوّر أنّني جالس على كرسي رئاسة الوزراء، إنّما أنا جالس على غطاء بالوعة كبيرة، إذا ما ذهبتُ وجاء غيري، فسترى كيف تطفح هذه البالوعة بالمياه الآسنة وتغمركم".
الشيوعيون العراقيون ولعنة بريمر
عبد اللطيف السعدون
بإمكان الشيوعيين العراقيين أن يجدوا ما يكفي لتبرير التحاقهم بركب التيار الصدري في "تحالف سائرون" الميت تاريخيا، رغم أن عديدين منهم يعترفون بأن حزبهم أصبح في ظل تلك الخطوة ذيلا للتيار الذي دأب زعيمه، مقتدى الصدر، على اتخاذ قراراتٍ مفاجئة في مسائل مهمة وأساسية، من دون استشارة أحد من حلفائه، أخيرها خطوته الدراماتيكية بخروجه من البرلمان التي يؤكد شيوعي عتيق أنه ورفاقه فوجئوا بها، كما فوجئ غيرهم. وكان الشيوعيون برّروا تحالفهم في حينه بأنه "كسر للطائفية السياسية (..)، وتحالف بين أناسٍ لم تكن لديهم، في بادئ الأمر، أي أيديولوجية مشتركة"، وهذا أمرٌ قد يفهمه بعض العراقيين في إطار النظر إلى مرحلة صعبة، لها خصوصيتها واشتراطاتها المعلومة، لكن الواضح أن هذا "التحالف" شكّل خطأ استراتيجيا، كان الجدير بالحزب تجنّبه. ومع ذلك، يظل هذا الخطأ صغيرا إذا ما قيس بالخطيئة الكبرى التي ارتكبها الحزب في الأيام الأولى للاحتلال الأميركي، عندما قبل سكرتيره العام، حميد مجيد موسى، الدخول في مجلس الحكم الذي أنشأه بول بريمر، واعتبر ممثلا عن طائفته، ووصفه بريمر آنذاك بأنه "شيعيٌّ محبوب، وله تأثير وشعبية"، وعُرف لاحقا أن ضم الحزب الشيوعي إلى المجلس جاء بنصيحةٍ بريطانية، بحسب ما أورده بريمر في كتابه "عامي في العراق". وقد دافع قادة الحزب أكثر من مرّة عن خطيئتهم تلك، ووصفوا مجلس الحكم بأنه "وحده القادر على كسب ثقة العراقيين وإشاعة الأمل في نفوسهم"، إلى آخر "المعزوفة" التي لم تثر سخرية الوطنيين العراقيين بمختلف توجهاتهم فحسب، بل أجّجت غضبهم ونقمتهم.
لم يكن معظم أفراد القاعدة الشعبية للحزب راضين عن تلك الخطوة التي رفضتها أيضا جماعاتٌ يساريةٌ عديدة، وقد التصقت تلك "الخطيئة" التي أطلق عليها بعضهم "لعنة بول بريمر" بالحزب، وأفقدته الكثير من هيبته، ومن مكانته التي عرف بها في السابق.
مناسبة التذكير بكل هذه الوقائع البيان الذي أصدره الحزب في ختام اجتماع المكتب السياسي أخيرا، والذي طرح فيه ما أسماها "رؤية ومشروعاً"، محاولاً من خلال ذلك إسدال الستار على حقبة السنوات العشرين الماضية التي تركت بصماتٍ سوداء في تاريخه الطويل، وهو لا يملك حجّة مقنعة في الدفاع عنها أو تبريرها.
ومن مكر التاريخ أن يقرّ الحزب في مشروعه بأن هناك "أزمة بنيوية في صلب نظام المحاصصة الطائفية الإثنية". وبالطبع، هذا النظام هو نفسُه الذي باركه الحزب سابقا، وعجز عن تشخيصه، بل واعتبره "مؤهلا لاستقطاب أوسع الجماهير وتحشيد إسنادهم له". وبديلا لما حصل، ولما هو ماثل، يدعو الحزب إلى "مشروع تغيير شامل يمثل الخلاص لأبناء الشعب من نظام المحاصصة"، وإلى "دولة مدنية ديمقراطية، تقوم على العدالة الاجتماعية"، يقودها "تحالف سياسي قائم على أسس وطنية غير طائفية أو إثنية، مستند إلى برنامج سياسي وتنموي متكامل (..) ومشاركة شعبية في مشروع التغيير".
مبادرة الحزب بالقطع مع المرحلة السابقة تظلّ قاصرةً، ما لم يتبعها تقديم اعتذار عن "الخطيئة" الكبرى التي ارتكبها
تُرى .. هل تمثل هذه "الرؤية" أولى الخطوات نحو رجوع الشيوعيين العراقيين إلى صباهم، بعدما فقدوا البوصلة أمدا طويلا، وبعدما فشلوا في أن يقدّموا لجمهورهم، الذي كان يوما ما فاعلا ومتفاعلا، بعض ما يجعله يعيد ثقته بهم، وفي الذاكرة تلك الفترة الذهبية في تاريخ الحزب التي أعقبت ثورة 14 تموز (1958)، والتي استطاع فيها الحزب أن تكون له قاعدة جماهيرية واسعة، شكلت ضغطا على الزعيم عبد الكريم قاسم، عندما طالبته في تظاهرة مليونية بإشراك الحزب في الحكم، وكان أن استجاب قاسم، وعيّن محسوبين على الحزب في مناصب وزارية، لكنه عاد بعد حين، ونأى بنفسه عنهم، وتلك قصةٌ أخرى.
وعلى أية حال، فإن مبادرة الحزب بالقطع مع تلك المرحلة تظلّ قاصرةً، ما لم يتبعها تقديم اعتذار عن "الخطيئة" الكبرى التي ارتكبها، وما لم يُجرِ مراجعة نقدية صارمة لمواقفه وسياساته في المراحل السابقة، وما لم يتخلّ بعض من بقايا الحرس القديم عن فرض سطوته على التنظيم. عند ذاك، يمكن للحزب أن يعيد بناء نفسه، وأن يستعيد مكانته، وأن يضع مشروعه للتغيير على السكّة.
ما الذي ينتظر العراق؟
عبد اللطيف السعدون
على مواقع التواصل، وعلى ألسنة سياسيين ومحللين، "مزاعم" متداولة عن قرار دولي قد اتُّخذ بإسقاط "العملية السياسية" الطائفية القائمة في العراق، وإنتاج عملية سياسية وطنية تضمن حالة أمن واستقرار، وتوفر الخدمات العامة، وتقضي على آفة الفساد، وتحترم الحريات الأساسية للمواطنين.
ثمّة من يذهب إلى أكثر من ذلك، ليؤكد أن من عُدَّ مسؤولاً عن خطايا السنوات العشرين المنصرمة وجرائمها، سيُحال على القضاء العادل، كي ينال جزاءه عمّا اقترفته يداه. وبينهم من يضيف: "ستُنصب للقتلة واللصوص أعواد المشانق"! ويجزم آخرون بأن إدارة الأزمة العراقية ستوكل إلى الإنكليز، باعتبارهم أصحاب تجربة عريضة في شؤون العراق ومعرفة بخباياه وأسراره استمرّت منذ الحرب العالمية الأولى وحتى العهد الجمهوري، وكانت لهم علاقات واسعة بفئات مختلفة من العراقيين، سياسيين وعسكريين ورؤساء عشائر وأكاديميين ورجال دين، وبعض أبناء هؤلاء وأحفادهم ما زالوا يحنّون للأيام السالفة، فيما يبدو الأميركيون قليلي خبرة في الشؤون العراقية، وقد كشفوا عن نقص خبرتهم وضحالة تفكيرهم في إقدامهم على غزو العراق بمبرّرات كاذبة، وكذلك في ما فعلوه فيه على مدى الأعوام الماضية، وقد حقّقوا ما يريدونه من احتلالهم له، إذ جعلوا منه كياناً هجيناً قاصراً عن أداء أي دور، ولم تعد له أية فاعلية، وقد لا يمكنه الوقوف على أقدامه مجدّداً إلا بعد حفنة سنين، وأضافوا أن ما يدفع الأميركيين إلى ذلك أيضاً انشغالهم بقضايا عالمية أخطر وأهمّ، حرب أوكرانيا والعلاقات مع روسيا، والتحدّي الصيني ومسألة تايوان.
وتستند معظم هذه التوقّعات إلى أخبار وتقارير مفبركة، تجتهد في إنشائها جيوش إلكترونية مموّلة، تتبع هذا الطرف أو ذاك، ولها غاياتها المعروفة. ومعلوم أن مثل تلك الأخبار والتقارير التي لا تحتمل قدراً من الصدقية تنتقل في الفضاء الإلكتروني ثماني مرّات أكثر مما تتنقل فيه الأخبار والتقارير الصحيحة، فضلاً عن أن متابعين يجدون فيها ما يحوّل أمانيهم إلى حقائق، ويبنون عليها قناعاتهم ويروّجون نشرها. لكن القراءة الذكية لما يحيط بنا تجعلنا نميل إلى تقرير ما نراه واقعاً ماثلاً أمام العين أن الولايات المتحدة التي كلفتها الحرب ما يقرب من تريليونين ونصف تريليون دولار، لن تترك العراق، لأنها وجدت فيه منجماً من ذهب، يعيد إليها بعض خسائرها، فضلاً عن قناعتها بأن موقعه الاستراتيجي يضمن لمظلّتها على منابع النفط القوة والمنعة، ثم إن العراق، في حساب الطموحات الصهيونية التي ترعاها واشنطن، يشكل "عقدة" خطيرة أمامها إذا ما استعاد دوره. وهذا يكفي لبقاء أميركا ساكنةً فيه مهيمنة على قراره إلى أمد قد يطول. وهذا لا يمنع دولاً أوروبية، مثل بريطانيا التي لديها تاريخ طويل مع العراقيين، من أن تعمل على مدّ نفوذها إليهم، أو حتى أن تتدخل في شؤونهم، خصوصاً أنّ العراق أصبح مفتوح الأبواب والشبابيك أمام الجميع، ومن شاء أن يدخل أو يتدخّل فليفعل، من دون أن يخشى رادعاً!
وفي بعض ما رصدناه من بعض تقارير مفبركة، اعتمادها على إشارة للثعلب الاستراتيجي العجوز، هنري كيسنجر، لم يقل فيها أكثر من أن "تغييرات مهمّة محتملة في منطقة الشرق الأوسط"، ولم يفصح عن تفاصيل، فيما أوّل البعض قصده بأنه يقصد تغيير الحكم في العراق، ومنهم من استخدم إحاطة ممثلة الأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، أمام مجلس الأمن، للتدليل على صحة تحليله، وكانت قد أنذرت الطبقة السياسية "المنشغلة بمعارك السلطة" من أن العراقيين لن ينتظروا طويلاً، ودعتها إلى أن تشمّر عن ساعدَيها لمعالجة الأولويات، خصوصاً في صراع السيطرة على الموارد ولعبة السلطة، ولوّحت لها باحتمال قيام مبادرة دولية ذات زمن محدود لمعالجة الوضع.
ومع ما يجري ويدور، تظلّ هناك "لكن" كبيرة، تطل بعنقها أمامنا، إذ إن ذلك كله لا يعني أن العراقيين مقبلون على مرحلة "سمن وعسل"، وأن استعادة العراق مكانته ودوره في العالم والمنطقة أصبحت في متناول اليد. بالعكس، كل تغيير، إن كان ثمّة تغيير في الأفق، لن يتعدّى الخطوط الحمر المرسومة للعراق من القوى الدولية والإقليمية الفاعلة. ولذلك، تبدو كل التنظيرات والتحليلات الوردية والمتفائلة غير واردة، بل قد يزداد العراق انقساماً وتفكّكاً، وعندها نخشى أن تصدق نبوءة شاعرنا الراحل، سعدي يوسف، الصادمة:
"سوف يذهب هذا العراق إلى آخر المقبرة/ سوف يدفن أبناءه جيلاً فجيلا/ ويمنح جلاده المغفرة/ لن يعود العراق المسمّى/ ولن تصدح القبّرة"!
لم تنته اللعبة في العراق بعد
عبد اللطيف السعدون
قمّة الاستعصاء السياسي في العراق هي الدوران حول المشكلة، والعجز عن القبض عليها. عشرون عاما، والعراق غارقٌ في مشكلاته، وكل مشكلة تلد أخرى، والذين يتصوّرون أن الحل كامن في قدرة هذا الطرف المحلي أو ذاك واهمون، لأن ثمة قوى دولية وإقليمية، بعضها يعمل في السر وبعضها في العلن، وكلها ليست لها مصلحة قائمة في إيجاد الحلول التي تلبي طموحات العراقيين وتطلعاتهم، بل لو توفرت هذه الحلول بقدرة قادر سوف تُجهز عليها هذه القوى وتفشلها، لأن مصلحتها هي في بقاء الوضع على حاله، وبما يتوافق مع أهدافها الاستراتيجية في المنطقة. أما الصراعات والخلافات بين الأطراف المحلية فليست سوى مناورات بائسة، وأحيانا شرسة، ويظل موضوعها "الكعكة" وكيفية اقتسامها.
هذا ما بدا جليا بعد الانتخابات البرلمانية التي توهم بعضهم أنها ستوفر لهم ما حلموا به، عندما أعطوا أصواتهم لهذا الطرف أو ذاك، وكانوا يمنّون أنفسهم أن الحال سوف يتغيّر، ومرّت ثمانية شهور، وهم يتطلعون لمن ينقذهم من ويلات العيش في ظل نظامٍ لا يوفر لهم أبسط متطلبات الحياة، الأمن والأمان، والصحة، وضمان العمل، والتعليم، وهامشا ولو صغيرا من الحرية والديمقراطية التي زعم الأميركيون أنهم جاءوا إلى العراق من أجل توفيرها لهم!
وقياسا على ما حدث في الشهور الثمانية الأخيرة، ليست صورة المستقبل، كما تبدو في عيون العراقيين اليوم، وردية، خصوصا بعد انكفاء انتفاضة تشرين وعدم قدرتها على التحوّل إلى ثورة ناجزة، تطيح كل أفراد المنظومة الحاكمة، وتؤسّس لمشروع وطني خالص، والأسباب معروفة: عدم تحديد أهدافها بوضوح، وتركيزها على مطالب خدمية محضة، وافتقارها إلى قيادة فاعلة ومتفاعلة، وضعف التنسيق بين مواقع حركتها، وطرحها أحيانا شعارات بعضها غير مدروس، ما سهّل انقضاض الخصوم عليها عبر اختراقها في حالاتٍ كثيرة، وتلك حقيقةٌ لا يمكن القفز عليها، وقد استغلت المنظومة الحاكمة هذا كله من أجل لخبطة الأمور وإشاعة الفوضى، والسعي إلى إعادة إنتاج "العملية السياسية" الماثلة، ومحاولة إلباسها ثوبا جديدا يخفي عيوبها ونقائصها، ويداري عجزها عن الفعل.
وهذا ما يريده طرفا المعادلة، إذ يصر "الإطار التنسيقي" الذي يتزعمه نوري المالكي، ويضم حزب الدعوة والمليشيات الولائية، على المطالبة بحكومة "توافقية" تجمع كل الأطراف، على أن تحفظ لمكوّن معين حقه في الاستئثار بالموقع التنفيذي الأول في الدولة، وهذا يعني العودة إلى نقطة الصفر، والحفاظ على السمة الطائفية للعملية السياسية، وهي السمة التي سبّبت للبلاد كل هذا الدمار والخراب، فيما يدعم "تحالف إنقاذ وطن" دعوة مقتدى الصدر إلى حكومة "أغلبية وطنية"، طارحا اسم أحد أفراد عائلة جدّه الصدر الأول لإشغال الموقع التنفيذي الأول في الدولة، كون العائلة، بحساب الصدر، هي القادرة على حفظ الدين والمذهب، وهو زعمٌ لا يتفق مع فكرة "الأغلبية" في المفهوم الديمقراطي، بل ويناقضها.
أخيرا، قذف الصدر حجرا كبيرا في المياه الهائجة، إذ أمر نوابه بالاستقالة من البرلمان، ملقيا بمسؤولية الانسداد السياسي على خصومه، كما أوعز بإغلاق معظم المؤسّسات التابعة لتياره، ودعا إلى تقليم أظافر "الحشد الشعبي"، وهي خطوةٌ تنذر بتداعياتٍ كثيرة قد تفضي إلى الإقدام على حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة قد لا تكون نتائجها أفضل من الانتخابات الأخيرة، أو ربما ينتقل الصراع إلى الشارع، وهو ما توقعه خصمه نوري المالكي نفسه، ما يعني المزيد من إراقة الدم، خصوصا أن ردود الأفعال لدى المواطنين العاديين في سيولةٍ لا تعرف التوقف.
على الوتيرة نفسها، ينقسم الأكراد بين فريق يدعم الإطار التنسيقي يقوده حزب الاتحاد الوطني الذي تهيمن عليه عائلة طالباني، فيما يدعم الحزب الديمقراطي الكردستاني وزعيمه مسعود البارزاني التيار الصدري، إلا أن خطوة الصدر أخيرا فاجأت حلفاءه الأكراد وأربكت حساباتهم، كما فاجأت وأربكت حسابات قادة المكون السني الذين عصفت بينهم الخلافات من قبل، وأحدثت بين بعضهم بعضا ما صنع الحداد.
هذا كله لا يصنع صورة لمستقبل وردي، إنما يزيد المشهد الماثل عتمة وسوادا، لكنه، في الوقت نفسه، يكشف لمن ما يزال يُحسن الظن أن اللعبة لم تنته بعد، وأن الحال لن يكون أفضل ربما حتى لسنين مقبلة، وقد يجرّ إلى وضع العراق على شفا التفكيك الذي بانت ملامحه في الأفق، خصوصا أن أطرافا محلية باتت مقتنعة بأن الأوفق لبلدٍ مثل العراق أن يقسّم، وأن يأخذ كل طرفٍ حصته. تغذّي هذه القناعة جهاتٌ دوليةٌ وإقليميةٌ لا تريد لهذا البلد أن يعود إلى موقعه المؤثر والفاعل على صعيد المنطقة والعالم.
لسطين.. تاريخ ما أهمله التاريخ
عبد اللطيف السعدون
ثمّة مقولة للفيلسوف اليوناني، هيراقليطس، مفادها بأنك لو قبضت على وقائع معينة، ووقفت ناظرا إليها مشدوها بها، فعليك أن تسارع إلى اقتناصها قبل أن تتسرّب من بين يديك، وهذا ما فعلته، وأنا أقلب في كتابٍ عتيق، توشك صفحاته أن تنفرط، كنت حصلتُ عليه من مكتبةٍ تتعامل بالكتب القديمة في أثناء زيارة لي إلى لندن قبل خمسين عاما. كان الكتاب بلا غلاف، وقد تهرّأت أطرافه، لكنني كنت فرحا بحصولي عليه، إذ ضم مذكّرات شخصية بريطانية، كان لها دورها في إدارة الشؤون العامة في فلسطين في أعقاب الحرب العالمية الأولى. وللأسف، لم تكن في استطاعتي معرفة اسم تلك الشخصية للوهلة الأولى، لفقدان غلاف الكتاب وبعض صفحاته، ولكنني توصلت، في ضوء مراجعتي كتباً ووثائق عديدة معنية بتاريخ فلسطين في تلك الفترة، إلى أنّ كاتب المذكرات هو الجنرال لويس بولز الحاكم العسكري لفلسطين، قبل أن تتحوّل إلى إدارة مدنية في عشرينيات القرن الماضي. وعلى أية حال، وجدتُ في الكتاب مادّة دسمة عن أوضاع فلسطين في تلك المرحلة، والأدوار التي لعبتها الحركة الصهيونية والقوى الدولية النافذة آنذاك في التأثير على سير الأحداث، وفي توجيه مسارها في غياب دور فاعل للمنظمات العربية، الفلسطينية على وجه الخصوص، وقياداتها التي بدت كأنها تقف في الظل، وليس لها فعل في إدارة الأحداث، أو على الأقل في عدم قدرتها على استثمار حركة الاحتجاجات التي كان يقوم بها العرب آنذاك في مواجهة السلطة البريطانية المتواطئة مع الحركة الصهيونية، في أكثر من منعطف.
وبحسب كاتب المذكّرات، كانت الحركة الصهيونية في تلك المرحلة تعمل في عدة اتجاهاتٍ تتكامل في ما بينها، أولها تشجيع الهجرة اليهودية إلى فلسطين، و"توطين اليهود تمهيدا لإعطائهم الاستقلال.. وإذا ما قاوم أحد العاملين في إدارة الانتداب هذا التوجّه عدّ معاديا للسامية، أو على الأقل خصما للحركة الصهيونية"، وقد لعب الاتحاد العام للعمال اليهود (الهستدروت) دورا نشيطا في تشجيع هجرة اليهود من أقطار أوروبا إلى فلسطين، ومارس شتى الضغوط على المؤسسات والشركات العاملة لاستخدام عمال يهود من القادمين إلى البلد. وثانيها "السعي إلى جعل اللغة العبرية اللغة الرسمية في فلسطين". وفي خطوة بهذا الاتجاه، استقدمت المنظمة الصهيونية، ورئيسها حاييم وايزمان، من أوروبا علماء وأكاديميين يهوداً معروفين بتخصّصهم في اللغة والدراسات العبرية والعلوم والثقافة اليهودية. وثالثها تأسيس "الجامعة العبرية"، وإقامة مركز للأبحاث العلمية. وبالفعل، وُضع الحجر الأساس في حينه، واعتبر وايزمان ذلك "بداية لعودة اليهود إلى أرضهم بعد عهود طويلة من الشتات". ورابعها النفاذ إلى البيئة الاجتماعية الفلسطينية واستقطاب السكان اليهود وزجّهم في مشاريع زراعية ونشاطات اجتماعية، وإبرازهم عنصرا سكانيا فاعلا ومتفاعلا.
والاتجاه الخامس طرح فكرة تأمين مصالح بريطانيا وأمنها في مناطق نفوذها عبر تشكيل قوة عسكرية من متطوعين يهود، على أن تكون فلسطين من هذه المناطق، وقد حصلت موافقة بريطانيا على ذلك، وتأسّست كتيبة فلسطين التي أراد الصهاينة منها أن تكون نواةً لجيش الدولة المنتظرة، وحرصت الحركة الصهيونية على أن لا يكون اسم الكتيبة معبّرا عن هويتها الحقيقية، إنما أعطيت اسم "كتيبة حاملي الغدارات الملكية"، لكنها عرفت لدى السكان باسم "الفيلق اليهودي" الذي ضم بين أفراده مشاهير وأعلاما في تاريخ الحركة الصهيونية، مثل ديفيد بن غوريون (لاحقا أول رئيس وزراء لإسرائيل)، وإسحاق بن تسفي (لاحقا ثاني رئيس للدولة)، وكذلك زئيف جابوتنسكي (زعيم الحركة التصحيحية الصهيونية فيما بعد، وصاحب نظرية "الجدار الحديدي" في العلاقات مع الفلسطينيين والعرب)، والذي عكف على وضع خطة "كومنويلث يهودي" ودستور لفترة انتقالية يضمن تغييرا ديموغرافيا يصبح اليهود في ظله الأكثرية السكانية، ويمكنهم آنذاك إعلان الدولة.
هكذا جنّدت الحركة الصهيونية كل إمكانياتها من أجل قيام الدولة الموعودة، وحصلت على الدعم البريطاني المباشر لكن كاتب المذكرات رأى أن "سياسة بريطانيا في دعم فكرة تأسيس وطن قومي لليهود في بلد تسعة أعشار سكانه عرب تبدو سياسة غير حكيمة، وسيكون من الطبيعي بالنسبة للعرب أن يكافحوا ضد سياسة تنكر عليهم حق تقرير المصير، ولن يتوقع أحد أن يساندوا إقامة وطن لليهود على هذه البقعة التي هي بالنسبة إليهم جزء مكمل لجزيرة العرب. وقد انتبه إلى هذه الحقيقة مارك سايكس (الدبلوماسي البريطاني الذي اقترن اسمه باتفاقية سايكس بيكو)، ودعا الصهاينة إلى أن ينظروا من خلال المنظار العربي، وحذّرهم من "الركون إلى الأوهام".
عندما تصبح
"الثقافة" هي الضحية
عبد اللطيف السعدون
غالبا ما يحدُث في أزمنة الحروب أن تصبح "الثقافة" هي الضحية، وأن يسعى المحاربون إلى استخدام المثقفين والأدباء والفنانين للتبشير بأهداف الحرب، وتمجيد من سقطوا وهم يرفعون راياتها، وإسباغ صفة "البطولة" عليهم، وكذا تحويل هزائم الميدان إلى انتصارات، وتوظيف كل الأشكال الفنية لترويج شعارات الحرب ومقولات قادتها، وإرغامهم على الصمت عما تقترفه الآلة العسكرية من فظائع، وما يرتكبه الجنود من أخطاء وخطايا، كما يطلب منهم طمس انتصارات الطرف الخصم والتقليل من أهميتها، والنظر إلى الأديب أو الفنان الذي يرفض منطق الحرب على أنه "خائن وطنه وخارج عن إجماع الأمة". ولذلك يعمد مثقفون عديدون معارضون فكرة الحرب إلى الهرب أو الانزواء والتخفي، كي لا ينالهم عقاب السلطة الحاكمة.
ليست حرب أوكرانيا استثناء، وقد دخلت شهرها الرابع، والأهداف التي سعى إليها الروس لم تتحقق، بل تواصلت الحرب أكثر مما قدّر لها، وهذا ما جعل العالم أكثر قلقا، خصوصا وأن مشاهد الحرب على الأرض، كما تنقلها الشاشات، توحي أن الأيام المقبلة سوف تكون حافلةً بما هو أكثر هولا، وسيجد المثقفون والأدباء الذين حاولوا تبريرها، وهم كثر، سيجدون أنفسهم أمام تصاعد وحشية الآلة العسكرية ودخول أسلحة جديدة إلى الميدان، والتهديد باستخدام السلاح النووي، واتساع نطاق العمليات العسكرية الى بلدانٍ أخرى، وما تثيره كل تلك التداعيات من مشكلات، مشكلة اللاجئين الذين تزداد أعدادهم يوميا، مشكلة العجز عن تأمين سلاسل الغذاء في العالم، مشكلة تدهور الاقتصاد في أكثر من قارّة واتساع دائرة الفقر وعدم توفر ضروريات الحياة. والمشكلة الأكثر استعصاء هي كيفية الوصول إلى نهاية قريبة للحرب، أو على الأقل تحقق إمكانية لهدنة مؤقتة في المدى القصير أو المتوسط.
في هذا العرض لا نبالغ، ولا نريد أن نتكهن، ونأمل أن يسود التعقل والحس السليم، حتى داخل الدوائر المجنونة بالحرب، سواء لدى هذا الطرف أو ذاك.
ولا تكمن حكايات الضرر الذي يحيق بالثقافة والمثقفين، وبالأدباء والفنانين في أزمنة الحروب في هذه الجوانب فحسب، إنما في جوانب أخرى أيضا، منها أن الحرب تنشئ، عند أحد طرفيها، رهابا من ثقافة الطرف الآخر. وفي حرب أوكرانيا الماثلة تظهر شواهد عديدة من رهاب ضد الثقافة الروسية من مجموعات في بلاد الغرب، وفي أماكن أخرى من العالم، وهي آخذة في الانتشار، كما يبدو، مع استمرار الحرب واتساع دائرتها، وهذا ما عانت منه آثار الروائي الروسي، فيودور دوستويفسكي، صاحب "الجريمة والعقاب"، الذي لم يشفع له أنه عاش في حقبة سابقة، وكان معارضا حكام بلاده، وحكم عليه بالإعدام في حينه ثم نفي إلى معسكرات العمل الشاق في سيبيريا. ومع ذلك، رُفع اسمه من المناهج الدراسية في جامعات عديدة في الغرب، آخرها في إيطاليا، حيث ظهرت مطالبات من أكاديميين بحذف آثاره من مناهج الدراسة.
وظهر هذا الرهاب أيضا في استعداء اتحاد كتاب دول البلطيق للكتاب الروس ودعوته الناشرين ومعارض الكتب إلى مقاطعة كتبهم وعدم ترويجها، وأيضا في إعلان الأكاديمية الأوروبية للسينما شطب الأفلام الروسية المرشّحة لجائزة السينما الأوروبية لهذا العام، وكذلك في مقاطعة مركز الأوبرا في ولاية بافاريا الألمانية مغنية الأوبرا الروسية آنا نيتريبكو، رغم دعوتها إلى وقف الحرب في أوكرانيا، ورفضها فكرة إجبار الفنانين على تبني وجهة نظر سياسية معينة.
وفي مهرجان ربيع ولاية كولورادو الأميركية، حُذف اسم يوري غاغارين الروسي، أول رائد فضاء، وذلك من البرنامج المتعلق بالفضاء، كما حدث الشيء نفسه في دوقية لوكسمبورغ، إذ أزيل تمثال نصفي له، مع أنه متوفى منذ خمسين عاما، ويعدّ من بين أعظم شخصيات التاريخ الإنساني في العصر الحديث.
المفارقة اللافتة هنا أنه حتى الجنسية يمكن أن تنحّى جانبا، إذا كان الأمر مقصودا من الناحية السياسية، وهذا ما حدث مع الفيلسوف الألماني الذي عاش ومات في إنكلترا، ولم تكن له أية علاقة بروسيا، كارل ماركس شريك فريدريك أنجلز في كتابة "البيان الشيوعي" الذي حذفت مؤلفاته إثر حرب أوكرانيا من الصفوف الدراسية في جامعة فلوريدا بالولايات المتحدة، واعتبر مفكّرا غير مرغوب فيه. حدث هذا مع أن روسيا لم تعد تعتنق الفكر الشيوعي منذ انهيار الاتحاد السوفييتي، وإن كانت لا تزال لديها بعض تقاليد الماضي الأحمر وأعرافه، والآن تسعى إلى توسيع دائرة نفوذها وأخْذ موقع لها في إدارة شؤون العالم ومقدّراته.
هكذا تتحوّل "الثقافة" في ظل الحروب إلى ضحية، وتصبح كلمات المفكرين والأدباء والفنانين خارجة عن السياق العام للأحداث.
مظفر النواب .. ما له وما عليه
عبد اللطيف السعدون
لم يترك لنا معارف (وأصدقاء) مظفر النواب، الشاعر والمناضل الملاحق معظم سنوات عمره، ما نقوله عنه، نحن الذين لم يقدّر لنا أن نقترب منه أو نلتقيه إلا لماماً، أو عبر وسائط الميديا، وقد شاهدناه من خلالها وسمعناه، وقرأنا له، وتملّكنا تجاهه مزيجٌ من مشاعر الإعجاب، والانبهار، واستفزّنا في أشعاره، ما جعل اسمه ينطبع في وجداننا منذ قرأنا أولى قصائده "للريل وحمد" قبل ستين عاماً.
جاءته الشهرة منقادة لم يسعَ إليها كما لم يفكر فيها، وتلقف الناس أشعاره في كتبٍ طبعت مرّات، منها طبعات مزورة ومستنسخة، لم يعرف ناشريها، لكنه لم يسعَ للتحري عنهم ومقاضاتهم، ولم يصل إليه منها دينار واحد.
رفض أن يكون مرتبطاً بسلطة، كما رفض أن يُحسب على سلطة، حتى في فترات اقتراب رفاقه الشيوعيين من الحكم، ورفض عروضاً عدة ليكون "مسؤولاً رسمياً". عرض عليه صدّام حسين عندما استقبله إبّان "عرس" الجبهة الوطنية موقعاً متقدماً في وزارة الثقافة، لكنه اعتذر، وطلب أن يُسمح له بالسفر إلى بيروت لطبع مجموعة شعرية له. وفي تلك المقابلة، أهداه صدّام "مسدساً"، وعندما عاد إلى بغداد بعد الاحتلال، بدعوة من الرئيس الراحل، جلال طالباني، عرض عليه الأخير منصب "مستشار في رئاسة الجمهورية"، واعتذر عن عدم قبول المنصب، مكتفياً بجواز سفر دبلوماسي، يعينه على التنقل بين العواصم من دون منغّصات.
قرأ أشعاره عراقيون من مختلف الطبقات، وأعجبوا بها كما نحن، وهو أكثر الشعراء العرب ممن كانت أشعارهم يجري تداولها سرّاً، وحتى الحكام الذين نال منهم في قصائد له، وشتمهم على نحو مقذع، كانوا يستمعون اليها بإعجاب. يُقال إن صدّام حسين كان يغالب دموعه كلما سمع شريط فيديو له، مع أنه خاصم البعثيين وتعرّض للاعتقال إبّان حكمهم، لكنه استطاع الهرب إلى إيران، بنية الوصول عبرها إلى الاتحاد السوفييتي، وألقى الإيرانيون القبض عليه، وسلموه لسلطة بغداد التي حكمت عليه بالسجن المؤبد، وطلبت منه أن يتبرّأ من حزبه، وسجّل موقفه بالرفض في قصيدةٍ على لسان أمه: "يا ابني/ لا تثلم شرفنا/ يا وليدي/ البراءة تظل مدى الأيام عفنة/ قطرة قطرة/ وبنظر عيني العميته، كلي (قل لي) ما أهدم حزب بيدي بنيته". وفي "عرس" الجبهة الوطنية، أطلق سراحه وسمح له بالسفر، ومن بيروت إلى دمشق، حيث طاب له المقام فيها بعد أن استضافته الدولة في منزلٍ خاص به، ثم ما لبث أن ترك دمشق إلى طرابلس، مستضافاً هذه المرّة عند معمّر القذافي، وتنقل بين ظفار وإريتريا والخرطوم، وأوروبا أيضاً. وبعد احتلال العراق، استجاب لدعوة صديقه جلال طالباني، للعودة إلى وطنه، لكنه لم يمكث سوى فترة قصيرة، رجع بعدها إلى بيروت وقد نال منه المرض، وانكفأ على نفسه، فلم يكتب بيتاً شعرياً واحداً ضد الاحتلال، ولم يعلن بصوته الذي كان يوماً المعبّر عن جرح وطنه الذي كان قد وصفه من قبل بأنه "جرح كبير، ما لمته ديرة ناس، ولا نامت عليه الكاع". كذلك لم ترد منه كلمةٌ واحدةٌ في رفض حكم المحاصصة الطائفية الذي شرعنته الولايات المتحدة. أكثر من ذلك، لم يتردّد في اعتبار مقاومة المحتلين "ضرباً من الخيال". ولم يقف ساخطاً أمام مشاهد وحشية المحتلين، ولم يعط من وقته ليتأمل في المرارات التي يعيشها مواطنوه، متجاهلاً ما يحدث أمام عينيه.
ومن مكر التاريخ أن يقرّر مظفّر، في أواخر أيام حياته، الالتجاء إلى الإمارات طلباً للعلاج، ولم تخيّب الإمارات ظنه، إذ استقبلته بحفاوة، ووفرت له متطلبات علاجه، حتى قدّر له أن يلفظ أنفاسه الأخيرة على أرضها، وهو القائل: "أصافح الليل مصلوباً على أمل/ أن لا أموت غريباً ميتة الشبح". ومن مكر التاريخ أيضاً أن يصل جثمانه إلى عاصمة بلده على ظهر طائرة "رئاسية" خاصة، وهو الذي كان قد جنّد نفسه في شبابه حرباً على كل الرئاسات والسلطات وممارساتها وطقوسها. والمفارقة اللافتة أن تعزي الولايات المتحدة العراقيين بوفاة النواب، وأن تصدر سفارتها في بغداد بياناً تصفه فيه بـ"المعبّر عن أصوات العراقيين وتطلعاتهم"!
وقد نال شاعرنا من المجد كما نال من السخط الكثير. وعلى أية حال، فقد غاب عنا في يوم بغدادي أغبر "مثل ما تنقطع تحت المطر شدة ياسمين"، ورحل عنا بكل ما له وبكل ما عليه.
عن ليل العراقيين الطويل
عبد اللطيف السعدون
لا يزال ليل العراق طويلا كما رآه المتنبي، وفيه "تخالف الناس حتى لا
اتفاق لهم"، لكأنما كتب على العراقيين أن تفرّقهم أسئلة السياسة كما
فرّقتهم في أكثر من زمان. وإذا كانت في زمان المتنبي دولة ورجال، ففي
زماننا لم تعد في العراق ثمّة دولة واقفة على رجليها، ولم يعد عندنا
أحد من صنف "الرجال القمم" الذين تحتفي بهم الدول، والذين وصفهم المفكر
الفرنسي، أندريه مالرو، بأنهم من تشرئبّ إليهم الأعناق إذا ما أحدقت
المحن بالناس، واستعصت عليهم الحلول، ولم يبق أمام العراقيين اليوم سوى
ممارسة الحلم، والهروب من الحاضر إلى "نوستالجيا" الزمن الجميل الذي
رحل كما رحل أهله.
ولأن الأمر كذلك، أصبحت أسئلة السياسة تدور داخل حلقة ضيقة ومفرغة
يتبادل أهلها المنافع والامتيازات، ويطلقون الوعود الكاذبة، ويتقاسمون
الحصص في "الكعكة" الكبيرة، كما اعترفت مرّة أمام الملأ برلمانية
معروفة لكن القضاء المستقل (!!) لم يستطع أن يقول لها ولا لأندادها:
"على عينك حاجب"!
وهكذا ليست هناك قضية في كل "المبادرات" التي يطرحها السياسيون،
والمناورات التي يتخفون وراءها أكبر من قضية "الكعكة" التي يختلفون
عليها تارة، ويتفقون تارة أخرى، وهدف الجميع إطالة عمر "العملية
السياسية" الطائفية التي دخلت "صالة الإنعاش"، والسعي إلى إحيائها من
جديد كي تتواصل دورة الاستحواذ والنهب واللصوصية.
تجري هذه اللعبة أمام عيون العراقيين بعد انقضاء سبعة أشهر على
انتخابات برلمانية قيل إنها ستمهد الطريق لتغيير في السلطة والسلطان،
لكنها لم تحقق ما كان مأمولا، وإن اعتبرها بعضهم خطوة على طريق
التغيير، لكن هذه الخطوة انكفأت بفعل بقاء "الحيتان" الكبار أنفسهم
ماسكين بأطراف اللعبة يشدّون حبالها ساعة، ويرخونها أخرى، ووراءهم قوى
خارجية هيمنت على البلد واستأثرت بقراره.
وقد يجد القارئ في التذكير بما يضيق به المشهد السياسي من "مبادرات"
و"مبادرات مضادّة" فرصة تسليةٍ تنسيه هموم الحياة وتصاريف الزمان، أولى
هذه المبادرات أطلقها زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، وأعطى فيها
الإطار التنسيقي الذي يرأسه خصمه اللدود، نوري المالكي، مهلة أربعين
يوما كي يشكّل حكومته "التوافقية"، لكن الإطار رد بمبادرةٍ على شاكلتها
داعيا إلى الحوار من أجل "الحفاظ على العملية الديمقراطية"، وعاد الصدر
ليتوجه إلى "النواب المستقلين" مقرّرا منحهم "جائزة مغرية"، 12 وزارة
إذا ما شكّلوا تكتلا وانضموا إلى مشروعه في حكومة "أغلبية وطنية".
والتفت المالكي هو الآخر إليهم معلنا عرضه المنافس، عدة وزارات، وترشيح
من يرونه من "الشيعة!" لرئاسة الحكومة، وفكّر "المستقلون" أن يتكتّلوا
ليمثلوا دور "بيضة القبّان" في اللعبة القائمة، لكنهم فوجئوا، كما فوجئ
غيرهم، باعتراف الصدر بفشله في تحقيق ما أراده، داعيا كل الكتل،
وبضمنها من تحالف معهم، إلى تشكيل الحكومة على أن يتحوّل هو إلى
"معارضة وطنية"!
وهكذا لم تفضِ لعبة المدد والجوائز المغرية إلى حل، إنما وصلت إلى طريق
مسدود وسط توقع بعضهم أن تتكفل قوى خارجية بتقديم "مبادرة الساعة
الأخيرة" التي يمكنها رأب الصدع والتوافق على حكومة أمر واقع، كما حدث
في أكثر من مرّة، إلا أن الظاهر أن القوى الخارجية المقصودة ليست في
وارد التدخل المباشر اليوم، فواشنطن خفّفت من اهتمامها بقضايا العراق
في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية التي نشأت بعد نشوب حرب أوكرانيا،
ولم تعد مسألة تشكيل حكومة جديدة في بغداد من أولوياتها، بل قد تكون
تلك القضايا عبئا عليها، وهذا ما لمحت إليه السفيرة الأميركية الجديدة
في بغداد، اينا رومانوسكي، في إشارتها إلى أنها ستتعامل مع الحكومة
الجديدة في إطار "تعزيز استقلال العراق وحقوق المواطن"، وإن نسبت مواقع
تواصل إلكترونية إليها وضعها خطة عمل لأزمة الانسداد السياسي في
العراق، تعتمد إعادة كتابة الدستور وفترة انتقالية وانتخابات جديدة،
وحصر السلاح بيد الدولة.. إلى آخر "المعزوفة" التي أوردها "جنود"
إلكترونيون فزعوا بآمالهم إلى الكذب.
وحتى إيران التي تعتبر قضية العراق من أولى أولوياتها، فقد اكتفت بما
مارسته من ضغوط على أطراف "العملية السياسية"، بعد أن اطمأنت إلى أن
"وكلاءها" ورجال مليشياتها ضامنون لها هيمنتها من خلال "الدولة
العميقة" التي أنشأتها ورعتها عشرين عاما، وهم جاهزون لإجراء اللازم
عند ظهور ما يشكّل خطرا عليها وعلى مصالحها.
وفي ظل استمرار هذا الليل العراقي الطويل، ليس ثمّة ما يحيي الأمل لدى
الحالمين بالتغيير، والذين ربما سيترتب عليهم أن يواصلوا الحلم أربع
سنين أخرى، وحتى تحدُث معجزة ما!
متى تبدأ
الحرب العالمية الثالثة؟
عبد اللطيف السعدون
لم يكن هذا السؤال مطروحا قبل نشوب الحرب في أوكرانيا، وكان يبدو مجرّد نبوءةٍ متشائمةٍ يتداولها كتّابٌ ومحللون ينظرون إلى العالم من وراء نظّارات سوداء، كما لم يكن في أخيلة كثيرين من صنّاع السياسة أن يتطوّر أي من النزاعات الماثلة في العالم إلى حربٍ كونيةٍ قد تقضي على البشر والحجر معا. وعندما روّج الباحث الاستراتيجي الأميركي ورئيس مؤسسة ستراتفور المعروفة في عالم الاستخبارات، جورج فريدمان، في كتبه ما أسماه "سيناريو الحرب العالمية الثالثة" التي حدّد لبدئها الساعة الخامسة مساء الرابع والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2050، رفض باحثون آخرون هذه الفكرة من الأساس، معتقدين أن العالم استطاع أن يتجاوز احتمال حصول حدثٍ مهول كهذا، بعدما تحقق نوع من السلام الكوني الشامل، وبعدما استطاع أقطاب السياسة الكبار كبح جماح الحروب الصغيرة الناشبة في هذه البقعة أو تلك من أن تتجاوز الحدود المرسومة لها، حتى لو استغرقت مدى زمنيا طويلا.
بنى فريدمان نظريته تلك متوقعا حدوث حرب عالمية على الفعل الذي تُحدثه العوامل الجيوسياسية في البيئة العالمية، وتأثير ذلك على العلاقات الدولية في هذا القرن الذي بلغت فيه التكنولوجيا العسكرية المعقدة شأوا خطيرا، ومفرداتها التي سوف تكون جاهزةً للاستخدام في أية حرب مقبلة.
ويقوم "السيناريو" المثير الذي نشره في حينه على افتراض أن اليابانيين والأتراك، وبفعل العامل الجيوسياسي، سيشعرون بأنهم مهدّدون بالآثار المرعبة التي يمكن أن تُحدثها التكنولوجيا المعقدة التي أصبح الأميركيون يمتلكونها، بخاصة في مجال المركبات الفضائية الحربية، وقد اقتنعوا بأن الخروج من هذه الدائرة هو في شنّ حربٍ استباقية تطاول التفوّق الأميركي قبل أن يبلغ مدىً أكبر. وتستهدف الضربة الأولى المركبات الفضائية الأميركية، وعندها سيتحالف الأميركيون والبولنديون (في أوروبا) لمواجهة اليابانيين والأتراك في البحر والجو، وسوف تستدرج الحرب أطرافا أخرى حتى يصعب الوصول إلى نهايةٍ لها. هنا يكتشف العالم أن انتصار من ينتصر سوف لن يكون حاسما، وهزيمة من يهزم لن تكون تامة، وتدفع هذه الرؤية لدى صناع القرار في الدول المتناحرة إلى عقد مؤتمر يؤسّس لمرحلة سلام جديدة تنتج نوعا من التوازن، تكون لأميركا فيه حقوق حصرية في عسكرة الفضاء، تحافظ من خلاله على تفوّقها وسيطرتها على العالم.
قد لا يتوافق هذا "السيناريو" مع ما دار في رأس الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وهو يطلق شرارة حربه في أوكرانيا التي ربما أوحى بها له الأميركيون على نحوٍ أو آخر، وقد يكون ابتعاد واشنطن عن القارّة الأوروبية في عهد الرئيس دونالد ترامب، ثم وصول "الديمقراطيين" إلى السلطة، شكل عامل إغراء لدى بوتين للتقدّم نحو تحقيق هدفه في كسب اعتراف الغرب والعالم بروسيا قوة لها هيبتها وهيمنتها، كما كانت عليه زمن الاتحاد السوفييتي الميت تاريخيا، ودفعه ليشرع في "عملية عسكرية خاصة" قدّر أنها لن تدوم أكثر من بضعة أيام، تكون فيها قواته قد اجتاحت أوكرانيا، وضمّتها إلى روسيا كما فعل من قبل في جزيرة القرم، لكن حسابات الحقل يبدو أنها لم تتطابق مع حسابات البيدر. وقد جرت الأمور على غير النحو الذي أراده، فقد امتدّت الحرب أياما وأسابيع، حتى تجاوزت شهرها الثالث بفعل المقاومة الأوكرانية وإمدادات السلاح الغربي المتسارعة والدعم الأميركي اللامحدود، وهذا ما جعل المخاوف تساور بعض المحللين جرّاء احتمال تطوّر الحرب وانزلاقها إلى حرب عالمية قد يستخدم فيها السلاح النووي، ولم يتورّع بعضهم عن تحديد تاريخ معين لها، وبينهم محللون روس كانوا عند إطلاق "العملية العسكرية الخاصة" يرسمون لها مسارا قصيرا ينتهي باستسلام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعودة أوكرانيا إلى أحضان روسيا لكنهم اليوم يرسمون "سيناريو" مختلفا.
يتنبأ ألكسندر نازاروف (محلل استراتيجي روسي) بأن تصعيدا خطيرا سوف يشنّه الغرب على روسيا على وقع جملة عوامل، منها وصول الاقتصاد الأميركي إلى مرحلة الانهيار، وسيصبح دخول أوروبا طرفا في معمعة الحرب أمرا لا مفرّ منه، وسوف يقترن هذا التطوّر باتساع نطاق العمليات العسكرية. وقد حدّد نازاروف تاريخ منتصف شهر مايو/ أيار الحالي موعدا لما توقعه من أحداث تزعزع استقرار العالم بأسره وأمنه. وقال محللون آخرون إن أياما قليلة قد لا تتجاوز الأسبوعين تفصلنا عن قيام حرب شاملة، فيما دقّ جرس الإنذار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الذي قال إن "خطر اندلاع حرب عالمية ثالثة جدّي وحقيقي".
هكذا إذن ليس أمامنا سوى أن نحبس أنفاسنا وننتظر.
عندما يخضع القضاء
العراقي لسلطان السياسة
عبد اللطيف السعدون
ليس لك، وأنت تتابع ما يجري في العراق في هذه الأيام، سوى أن تضحك أو تبكي، والأمر سيّان، ما دام القضاء هناك يخضع لسلطان السياسة، وما دام القانون غائباً عن كل صعيد، وما دام رجال القضاء قد ارتضوا لأنفسهم أن يكونوا أدواتٍ في أيدي "الحيتان" والأفّاقين ورجال المليشيات، وليس أكثر إيلاماً من أن يسقط هذا المرفق المهم تحت أقدام السياسيين، وفي سبيل تحقيق مآربهم الخاصة.
وإذا كان الشيء بالشيء يذكر، فلا بد من أن نذكر هنا بالخير رئيس وزراء بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية، ونستون تشرشل، الذي أصبحت مقولته مثلاً، وهو يتأمل الدمار الذي حل ببلاده: "لا تقلقوا على بريطانيا ما دام القضاء بخير"، وأيضاً الجنرال شارل ديغول الذي سأل عن حال القضاء ساعة دخوله باريس بعد تحريرها من الاحتلال النازي، وعندما قيل له إن القضاء الفرنسي لم يفقد نزاهته بعد، التفت إلى وزيره الروائي والمفكر أندريه مالرو، ليقول له "نستطيع إذن أن نبدأ الآن معركة بناء فرنسا من جديد".
ارتضى رجال القضاء لأنفسهم أن يكونوا أدواتٍ في أيدي "الحيتان" والأفّاقين ورجال المليشيات
ونستذكر تاريخ "بلاد النهرين" منذ العهد السومري، ونقرأ أن رجاله ابتكروا القوانين التي تقيم العدل وتحقق المساواة ابتداء من إصلاحات أوركاجينا وقوانين نمرود ثم قانون أشنونا الذي يعد أقدم الشرائع في تاريخ البشر، وصولاً إلى قوانين حمورابي التي شكلت البداية نحو توجّه دول العالم لإرساء نظام قانوني عادل وقضاء مستقل.
ونسترجع أيضاً عهد الملوك الذين حكموا العراق منذ عشرينيات القرن المنصرم، حيث نلمس اهتمام النخبة السياسية آنذاك بالقضاء والسعي إلى إشاعة مبدأ استقلاليته عن أية مؤثرات، وعدم التدخل في أحكامه. وفي حينه، أرسي تقليد مهم، عندما وضعت لوحة خلف مقعد القاضي، كتبت عليها الحكمة التي قال بها ابن خلدون "العدل أساس الملك"، للدلالة على أن بناء المجتمعات والدول يبدأ من القضاء الذي يقيم العدل، ويحقّ الحق، ويقتصّ من المجرمين، وإذا كانت الجمهوريات التي خلفت عهد الملوك قد شهدت، على نحو أو آخر، انتهاكات فظة في ميدان القضاء في أكثر من قضية ومحاكمة، فإن احترام القانون والسعي إلى التوعية على دوره في نهضة الشعوب وتقدّمها، كان السمة الغالبة على مؤسسة القضاء ولدى القضاة أنفسهم، لكن الطامة الكبرى التي نزلت بالعراق وأهله في السنوات العشرين التي أعقبت الغزو الأميركي، واستحواذ "وكلاء" إيران على السلطة والقرار، كانت في جنوح المحاكم العراقية نحو إصدار أحكام لا تخالف القوانين والأعراف فحسب، إنما تؤسّس للفوضى، وتعيق نهوض البلد وتطوّره جرّاء خضوع الجسد القضائي لمشيئة السياسيين ورغباتهم. ولا أدلّ على ذلك من أحكامٍ صدرت بحق عدد من كبار لصوص المال العام، ومنهم وزراء ونواب وأصحاب درجات خاصة، تفاخروا علناً أمام كاميرات التلفزيون بأنهم ارتشوا واستغلوا مواقعهم وتقاسموا "الكعكة" مع نظرائهم، (هل كانوا يستخفون بمواطنيهم الذين لا يملكون شروى نقير ويسخرون منهم؟)، لكن القضاء في النهاية غفر لهم ذنوبهم، وأسقط عنهم تبعة خطاياهم، وأوجد المبرّرات غير المعقولة للعفو عنهم، وعادوا أبرياء كما ولدتهم أمهاتهم!
أسقطت المحكمة تهماً موجهة إلى سياسيين هاربين على خلفية ما قيل في حينه عن ضلوعهم بالإرهاب، واستغلال بعضهم المال العام
وفي جديد قرارات القضاء التي ما زال العراقيون يتندّرون بها الحكم على وزير سابق مع ثلاثة من معاونيه بالسجن عاماً مع وقف التنفيذ، وغرامة مقدارها سبعمائة دولار فقط على خلفية واقعة فساد وسرقة للمال العام، بلغ الهدر فيها ثمانمائة مليون دولار، وبرّرت المحكمة قرارها بأن المدانين "لم يسبق أن حكم عليهم بجريمة من قبل"، ولقناعتها (لا أحد يعرف كيف تولدت هذه القناعة) بأنهم "لن يعودوا إلى ارتكاب جريمة مماثلة"، جرى هذا في أعقاب قرار لمحكمة أخرى بالحكم على طفل جائع لم يتجاوز الثانية عشرة من عمره اتّهم بسرقة علبة مناديل ورقية بالسجن، مثله مثل سميه جان فالجان بطل رواية فيكتور هوغو "البؤساء"، والذي حكم عليه بالسجن إثر سرقته رغيفاً من الخبز.
وفي جديد "مسلسل" القضاء العراقي المستقل (!!) أن محكمة النزاهة أسقطت تهماً موجهة إلى سياسيين هاربين على خلفية ما قيل في حينه عن ضلوعهم بالإرهاب، واستغلال بعضهم المال العام من دون أن تقدّم المحكمة تبريراً لقرارها، ويقال إن ذلك جرى بوساطة سياسيين معلومين، وضمن موجبات الصراع القائم بين أطراف "العملية السياسية" التي توشك على الموت.
هكذا في العراق، إذا سرق الوزير تركوه وأفرجوا عنه، فيما إذا سرق طفل جائع علبة مناديل ورقية كي يقايضها برغيف خبز أقاموا عليه الحد.
هذه الحملة ضد
"الصرخيين" في العراق
عبد اللطيف السعدون
لم تكن حملة أجهزة الأمن العراقية ضد جماعة المرجع الشيعي، محمود الحسني الصرخي، مفاجأة لأحد، كما لم تكن الواقعة التي استندت إليها الحملة خارج المألوف، لكنّ المعروف أنّ حالة الانسداد الصعب التي تعيشها "العملية السياسية" التي هندسها الأميركيون بعد الاحتلال تفرض عند مريديها البحث عن مخارج تعينهم على تصريف ما يحيق بها، وأيضاً لإشغال الناس في ما ينسيهم همومهم الكبرى. وقد وجد هؤلاء في واقعة دعوة أحد أتباع الصرخي إلى ترك "بناء القبور وتشييد المراقد وتخصيص طقوس ومراسم خاصة بها" باعتبارها تخالف تعاليم الإسلام ضالّتهم في تحقيق ما يبتغونه من أهداف، وفي التدليل للآخرين على أنّ هناك تيارات جانحة تُضمر الإضرار بالمذهب الشيعي والإساءة إلى أتباعه، ما يفرض ضرورة قيام توافق سياسي لحماية المذهب والدفاع عنه. وإذا ما تذكّرنا أنّ قادة المليشيات وزعماء "الإطار التنسيقي" هم أول من زعم أنّ هناك محاولات تجرى لإضعاف المكون الشيعي، وسلب حقه في السلطة والقرار، وأول من اخترع حكاية "الإضرار بالمذهب" التي ألقوها في وجوه الصدريين الذين يدعون إلى حكومة "أغلبية وطنية" ندرك أنّ ما يحدُث قد لا يخرج عن كونه "مناكفة سياسية"، القصد منها دفع الصدريين إلى التوافق مع زعماء "الإطار التنسيقي"، وتشكيل حكومة تضم الجميع تحت شعار "وحدة المكوّن الشيعي في مواجهة أعدائه". لكن، يبدو أن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اكتشف اللعبة قبل اكتمال وقائعها، فبادر إلى الإعلان عن شجبه واقعة الدعوة إلى هدم القبور، ومطالبته الصرخي بالتبرؤ من بطل الواقعة، وإلّا سيكون مضطرّاً لفرض العقاب المناسب عليه وعلى أتباعه، كما قال. وبهذا قطع حبل الوصل بين "الواقعة" المذكورة وما يجري في الميدان السياسي من مفارقات ومناكفات، مصرّاً على تمسّكه بحكومة "الأغلبية الوطنية" وتاركاً لخصومه الصيد في المياه العكرة!
هل يعني ذلك أنّ هناك من صنع واقعة الدعوة إلى هدم المراقد على نحو أو آخر، ثم رفع صوته بالصراخ؟ هنا يمكن أن يكون الجواب نعم، خصوصاً أنّ الموضوع الذي أثارته الواقعة يعكس خلافاً فقهياً عمره أكثر من ألف عام، إذ هناك بين الفقهاء من يرى رأي بطل الواقعة المحسوب على "الصرخيين" ويرى آخرون خلاف ذلك. وكان من الممكن أن تمرّ الواقعة بهدوء، ومن دون أن تنتج هذا الضجيج العالي الذي وصل إلى مديات حادّة، باعتقال عشرات من أتباع الصرخي وحرق مساجد يصلي فيها أتباعه وتدميرها. ومثل كرة الثلج، تدحرجت الواقعة لتلد سؤالاً آخر: هل يجوز شرعاً حرق مساجد ودور عبادة يذكر فيها اسم الله وتدميرها؟
أشار عارفون بأسرار ما وراء الأكمة إلى أصابع إيرانية في هذه القضية، وقرنوا ذلك بالتهديد المبطّن الذي أبلغ عبر قنوات متعدّدة، آخرها ما قاله الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في زيارة الوزير أخيراً إلى طهران من أنّ بلاده لن تسمح بنشاطات معادية لها في العراق، وإنّ واجب العراق أن يقمعها. ويضيف هؤلاء العارفون أنّ طهران أرادت الثأر من الصرخيين، على خلفية اقتحامهم القنصلية الإيرانية في كربلاء وحرق العلم الإيراني في أثناء موجة الاحتجاجات التي عمّت العراق قبل عامين، وتنديدهم بالتدخلات الإيرانية. وللصرخي مواقفه المعروفة ضد إيران، ونظرته إلى "الحشد الشعبي" وكذلك المليشيات على أنّها امتداد لنظام طهران، وانتقاداته مرجعية علي السيستاني التي يتهمها بالتبعية، وهو معروفٌ كذلك بتأكيده عروبة العراق ومناهضته الغزو الأميركي للبلاد.
وعلى ذمة المثل الإنكليزي أنّ السياسة يمكنها أكل كلّ شيء، فإنّ السياسة في العراق أكلت من كلّ هذه التداعيات، إذ تصاعدت أصوات مطالبة باجتثاث التيار الصرخي وتجريم أتباعه، فيما ندّد آخرون بالحملة المناهضة له، واعتبروها حالة قمع للرأي الآخر الذي لم يخرُج عن حدود القانون. وقد فضلت "الرئاسات الثلاث" النأي بالنفس عن هذه السجالات، وصمتت صمت القبور، ولم تتحرّك باتجاه وأد الفتنة التي كادت تشكل فصلاً جديداً في الخلافات الطائفية التي أنهكت البلاد طوال الأعوام العشرين السالفة، على أنّ بعض عقلاء القوم اختاروا الموقف الحسن، إذ دعوا إلى وقف الضجيج المتعلق بالواقعة التي أثارته، وطي صفحتها، والاحتكام إلى القضاء إذا كان هناك ما يتطلب ذلك، وإطلاق سراح الأبرياء، والكفّ عن كلّ ما يثير الفتنة ويؤجّج الخلاف.
وهكذا يتنقل الساسة العراقيون بين سيناريو وآخر بغرض شراء الوقت، من أجل إعادة إنتاج "العملية السياسية" الطائفية على نحوٍ يكفل لهم مواجهة المد الشعبي المتصاعد الذي يرفض تدخلات طهران وهيمنتها على القرار العراقي.
"المتلازمة العراقية"
حكومات ولا حكومة
عبد اللطيف السعدون
في العراق أكثر من حكومة، ولكلّ واحدة سياساتها وبرامج عملها وميزانياتها واستقلاليتها، وكل منها تسلك الطريق الذي تريده. هذا ليس مزحة ماكرة، إنه واقع ماثل أمام عيون من يتابعون أوضاع العراق وما يجري فيه. وبحساب هذا الواقع، من الطبيعي أن نرى مفارقات ومتناقضات كثيرة، وكذلك الأعراض والعلامات المرضية التي يصحّ أن يُطلق عليها صفة "المتلازمة العراقية" التي عرفناها في العقدين الماضيين، وهي تستدعي إمعان النظر والتأمل في ما آل إليه الحال بعد الاحتلال الأميركي للبلاد الذي أوجد وضعا هجينا، من الصعب مقاربته في مقالة عابرة قد يفوتها الكثير.
أولى هذه الحكومات هي حكومة "تصريف الأعمال" التي يرأسها مصطفى الكاظمي التي جاءت نتيجة توافق أطراف "العملية السياسية" على قيامها، كي تتولى مهمة إجراء انتخابات نيابية مبكّرة استجابة، كما قيل، لمطلب رفعه ثوار تشرين. وإذ أنهت حكومة الكاظمي مهمتها على النحو الذي انتهت إليه، فقد أصبح دستورياً تخليها عن السلطة لصالح حكومة جديدة تنبثق عن الانتخابات، إلّا أنّ التجاذبات السياسية والانقسامات داخل الطبقة الحاكمة فرضت بقاءها إلى حين.
عمّرت حكومة الكاظمي سنتين، وربما تعمّر أكثر، إلّا أنّها لم تقدّم منجزاً واحداً يُحسب لها، باستثناء الانتخابات البرلمانية التي قاطعتها شرائح واسعة من العراقيين، وتعرّضت للنقد على نحو واسع، بسبب مما شابها من قصور. كما أنّ جرد أفعال الحكومة على أكثر من صعيد في السنتين الماضيتين يوحي أنها فشلت في أداء المهمات التي تصوّر بعض حِسني الظن أنها يمكن أن تقوم بها، ولكن العكس هو ما حصل، فقد تحدّث رئيسها أكثر من مرة عن مشروعه لإعادة هيبة الدولة، ووضع السلاح في يدها، ولكن ذلك بقي مجرّد فكرة على الورق، فما زالت المليشيات المسلحة تطوف البلاد شرقا وغربا. كما تحدّث عن إجراءاتٍ لمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين، ولكن ذلك كان أشبه بهواء في شبك، فما زال الفساد ضاربا أطنابه في كل مرافق الدولة والمجتمع، وما زال الحيتان الكبار يصولون ويجولون وينهبون. وتحدّث رئيس الحكومة أيضاً عن نيته محاسبة قتلة أكثر من سبعمائة من ثوار تشرين، لكن هذه النية لم تُترجم إلى فعل، وظل القضاء عاجزاً عن مقاضاة أحد منهم. وفي مجال الاقتصاد، أصدرت الحكومة ما سمتها "الورقة البيضاء" لمعالجة السياسات الخاطئة وسوء الإدارة وغياب التخطيط، لكنّ هذه "الورقة" تآكلت بمرور الزمن، ولم يبق لها أثر يذكر.
ودعك من غياب الأمن، وتفاقم الجريمة المنظّمة، وانتشار تجارة المخدّرات على نطاق واسع، وظواهر أخرى تؤكّد الفشل في إدارة شؤون البلاد، وعدم القدرة حتى على تخفيف معاناة الناس اليومية وخفض جرعة الإحباط لديهم.
ثانية هذه الحكومات تستحقّ تسمية "حكومة الأمر الواقع"، بحكم سيطرتها الميدانية على مؤسسات الدولة ومرافق المجتمع، مستمدّة قوتها من ارتباطاتها الخارجية، ومن امتلاكها السلاح بمختلف أنواعه، حتى الثقيل منه، وتضم مليشيات ومافيات وأحزابا وشخصيات نافذة تتبادل الامتيازات والمنافع على نحوٍ يجعل منها "قوة قاهرة"، لا ينجو من سطوتها أحد، وهي التي زرعت الفوضى والخراب والفساد في كلّ أرجاء الوطن من دون أن يستطيع أحدٌ كفّ يدها أو التخفيف من شرورها وجرائمها، وسلطاتها مستمدّة من حكومة "الجمهورية الإسلامية الإيرانية" التي تحدّد مسارها وتعدّها من منظومات أمنها القومي!
و"ثالثة الأثافي" حكومة إقليم كردستان التي أعطتها التشريعات النافذة موقعاً دستورياً وحقوقياً، إلّا أنّها تخطت ما هو مرسوم لها، لتتحوّل إلى "دولة مستقلة" تستحوذ على 17% من الميزانية العامة، وتطالب دوماً بأكثر من ذلك وتحصل عليه. وتمتلك جيشاً خاصاً (البيشمركة) له قيادته الخاصة، ولا يخضع للقائد العام للقوات المسلحة، وتتعامل في علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع دول العالم باستقلالية كاملة عن المركز، وحتى من دون إطار قانوني، وتصدّر النفط المستخرج من آبار الشمال، بموجب اتفاقات غير شفافة وتستحوذ على عائداته.
وثمّة حكومات أخرى في هذه المحافظة أو تلك، تمارس سلطاتٍ موزّعة بين عشائر ومليشيات ومافيات وعصابات جريمة منظمة. .. وفي ظلّ هذا كله، تحولت دولة العراق إلى غابة تضم من المفارقات والتناقضات الكثير، وقد لا يمكنها أن تتجاوز واقعها الماثل، قبل أن تتخلّص تماما من هذه "المتلازمة" المرضية المستوطنة وشرورها.
هل كان ممكناً
تفادي غزو العراق؟
عبداللطيف السعدون
ليس ثمّة وجع في إبريل/ نيسان أكثر من تذكّر واقعة سقوط بغداد بيد الأميركيين قبل 19 سنة. في حينها، كانت بغداد تنوء تحت وقع الضربات الأميركية كل ساعات الليل والنهار، ولم يكن مشهد الجنود الأميركيين وهم يمشون في شوارعها وأزقتها بعد أيام من وصولهم إلى ساحة الفردوس، وسط بغداد، مثيرا للغرابة فحسب، إنما كان مشهدا مستفزّا وصادما في آن، فما لم يتوقعه المواطن العادي المغلوب على أمره الذي أرهقته شعارات المواجهة حتى النصر، أصبح ماثلا أمامه على نحوٍ لا يقبل النفي.
في تلك الساعات المغرقة في العتمة، الموغلة في الكآبة، كنت أحاور كادرا بعثيا متقدّما جاءني ببيان باسم "حزب العودة"، يدعو الناس إلى المقاومة لنشره في الصحيفة الدولية التي كنت أراسلها من بغداد، وقد صارحته برأيي في أن دلالة اختيار مفردة "العودة" واضحة، وأن رفع شعار "العودة إلى السلطة" في هذا الوقت بالذات ليس أمرا موفقا، وأن ما يجري أمام عيوننا ينبغي أن يدفع إلى تأمل الحال، للخروج برؤية نقدية صارمة توفر متطلبات الحد الأدنى للمواجهة، وابتكار سبل وصيغ غير مألوفة تعتمد على تجميع كل الوطنيين لمقاومة المحتلّين الذين لن يتركوا الغنيمة بسهولة. وأدركت، وإنْ لم يُفصح لي صراحة، أنه يشاطرني رأيي، لكنه لا يستطيع أن يفعل شيئا، ولا حتى أن يقول شيئا. وفي تلك الأيام الحرجة، بدا الإعلان عن "حزب العودة" مجرّد فكرة مهووسة لكادر بعثي اعتاد أن يرى الواقع الماثل أمامه من وراء نظّارات ملوّنة. وعلى أية حال، طويت صفحة "حزب العودة" بعد شهور قليلة، بعدما أصبحت العودة إلى السلطة أمرا دونه خرط القتاد.
تكررت "نيسانات" الوجع سنة بعد سنة، حتى تحوّل نيسان الذي عرفناه في فتوتنا وشبابنا الشهر الذي يزدهر فيه الحب، وتتفتح الأزهار، ويبدأ به الربيع، إلى غول أسود يُطبق علينا كلما فتحنا عيوننا على وهج الشمس الذي بات يصل إلينا من عوالم بعيدة. لكن مرور السنين جعلنا نستردّ بعضا من قدرتنا على المراجعة والتأمل، والتفكير في ما يمكن أن يدفعنا إلى التقدّم خطوة قد نتراجع بعدها خطوتين لأسباب ضاغطة، أو قناعات مستجدّة، أو لأن اليأس قد يدركنا ليضعنا في غير الموضع الذي نريده لأنفسنا.
وبعد كل هذه الحفنة من السنين، نقف اليوم على عتبة العقد الثالث بعد الغزو، ولا يزال ثمّة سؤال يتردّد في أذهاننا: أما كان بالإمكان تفادي الغزو وإبعاد شبح الخراب عن العراق وعن العالم العربي كله؟. الإجابة: نعم، وإن كانت هذه الإجابة قد تثير عديدين ممن يبرّرون وقوع الغزو والاحتلال وتداعياتهما على العراق والأمة بأنه كان مخطّطا له منذ عقود. ولم يكن ثمّة سبيل لتفاديه، وبتعبير مسؤول في النظام السابق، "جاء نتيجة مؤامرة كونية وراءها قوى كبرى لا تتكافأ إمكاناتنا مع إمكاناتها بغرض إسقاط نظامنا وتدمير بلدنا، وكنا ندرك أننا إذا ما نشب النزال سوف نُهزم". وبالطبع، يعبّر هذا المنطق عن عجز، ويعكس رؤية قاصرة للواقع، تتيح لصاحبها شعورا بالرضا عن النفس فحسب.
صحيحٌ أن "المؤامرة" على العراق ذات خلفية تاريخية قديمة، لكن المعروف أيضا أن دائرة الفعل ضده من القوى المعادية اتسعت بعد قرار تأميم النفط في منتصف سبعينيات القرن الذي وجه ضربة كبيرة إلى الغرب. ومنذ ذلك الوقت، كان على العراق أن يقرأ ما يدور من حوله بعناية، وأن يبتكر الحلول والمعالجات الكفيلة بصدّ الأزمات ومواجهة التحدّيات على نحوٍ يحفظ للبلاد سيادتها وسلامتها، ويرسّخ موقعها دولة إقليمية فاعلة، خصوصا وأنه يمتلك إمكانات وثروات هائلة ومئات الآلاف من البشر المؤهلين، إلا أن الانقلاب السياسي الذي قاده صدّام حسين ضد حزبه في نهاية عقد السبعينيات اتجه بالبلاد إلى نظام شمولي أفقد العراقيين فرصا كانت سانحة أمامهم لإنجاز تحوّلات تعينهم على الثبات والتقدّم، ومهّد لتكريس دور الحاكم الفرد، وجرّ إلى سلسلة من المغامرات العسكرية والتجاذبات السياسية التي أوجدت بيئةً إقليمية محتقنة وقلقة، وفسحت المجال أمام القوى المعادية لتنفيذ مخطّطها الشرير في الغزو والاحتلال تحت كومةٍ من الذرائع الكاذبة.
وهكذا، فإن عدم القدرة على إدارة الأزمة منذ البداية، وفقدان البوصلة التي تعين على ذلك، أودى بالبلاد إلى الهاوية التي نحن فيها اليوم: دولة بلا سيادة، وحكومة فاسدة، وثروة منهوبة، ومجتمع منقسم مشوّه.
وبعد.. هل كان ممكنا تفادي الغزو؟ الجواب: نعم.
أسبوع البحث عن
"رئيس" في العراق
عبداللطيف السعدون
توحي الرسائل المتبادلة بين شخصيات رواية "كرسي الرئاسة"، للمكسيكي كارلوس فوينتس، (ترجمها إلى العربية خالد الجبيلي)، أن ثمة مشاهد ووقائع منظور إليها من قبل. وفي العراق ما يشبهها، كما لو أن فوينتس عاش بيننا في العشرين سنة الأخيرة، واختبر الحياة السياسية كما اختبرناها نحن، وأيضا كما لو أن الطبقة السياسية التي تؤرّخ لها الرواية هي نفسها الطبقة التي تحكم العراق اليوم. وليس ثمّة غرابة، فالسياسيون الفاسدون في كل بلاد الله يتشابهون في ما بينهم، ويتعاطف بعضُهم مع بعضهم الآخر، في وقتٍ يدبر بعضُهم لبعض المؤامرات والمكائد، و"يلدغ أحدهم الآخر مثل العقرب". وعندما يجلسون على كراسي الحكم، يعِدون مواطنيهم المغلوبين على أمرهم بالديمقراطية وحكم القانون وفصل السلطات، لكن مكمن الخطر هنا أن المواطنين يصدّقون تلك الوعود، ويذهبون إلى صناديق الانتخاب المضلّلة واجتماعات الأحزاب، وحتى إلى الإضرابات والاحتجاجات، أملا في أن يحدث التغيير الذي يريدونه، والوصفة التي تقدّمها الرواية للداخلين إلى حلبة الحكم في دول أميركا اللاتينية هي نفسها الوصفة التي يعمل لها "سياسيو المصادفة" في العراق الذين جمعتهم أميركا من الأزقة الخلفية لدول الغرب والجوار، إذ "عليهم أن لا يكونوا منافقين ومخادعين فحسب، إنما عليهم أن يكونوا ماكرين أيضا". وأن يكون لديهم نوع من الحرص على أن يأخذ كلٌّ حصّته من الغنيمة، من دون أن يسبب أذى لصاحبه، وتظل عيونهم جميعا شاخصةً نحو موقع "الرئيس" المتقدّم الذي يحمل من الجاذبية والإغراء الشيء الكثير، وتكتمل نصيحة فوينتس للسياسي الذي يفوز بالكرسي أن يضمن منذ اليوم الأول أنه لن يكون هناك ثمّة صوت آخر سوى صوته!
سيناريوهات مثيرة كهذه ظهرت في العراق مع الغزو الأميركي للبلاد، واستوطنت على نحو مكشوف، واشتدّ أوارها مع كل أزمةٍ واجهتها "العملية السياسية" المشرعنة، وجديد ذلك ما استجدّ في الأسبوع الأخير الذي سبق يوم انعقاد جلسة البرلمان المخصّصة لانتخاب رئيس للبلاد، والذي عكس رهان كثيرين ممن سعوا إلى إحداث اختراقٍ في "العملية السياسية" التي عمّرت أكثر مما توقع مريدوها (بفتح الميم أو بضمّها). لكن إمكان حدوث اختراق كهذا لم يكن سهلا، كما لم يكن في طوع أيدي من أراده، ولذلك ستكون هناك جلسة أخرى للبرلمان اليوم (الأربعاء) للبحث عن "رئيس" من بين المرشّحين الـ 33، وهو عدد لم يشهد المكسيك ولا أي بلد آخر مثيلا له، وربما يمكن للعراق بسببه أن يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية. وما هو مثير حقا أن يكون بين كل هؤلاء المرشّحين من لا يؤمن بعراق موحّد، وصوّت في "استفتاء كردستان" الميت تاريخيا لصالح الانفصال عن العراق، وإعلان دولة كردية مستقلة!
وربما يتساءل قارئ: ما الذي دفع بكل هؤلاء إلى الطمع في المنصب المذكور، مع أن الدستور العراقي أعطى رئيس الجمهورية مهماتٍ لا تتعدى الطابع البروتوكولي الاحتفالي، إذ اعتبره "رمزا لوحدة الوطن وممثلا لسيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور والمحافظة على استقلال البلد وسيادته ووحدة وسلامة أراضيه"، من دون أن يكرّس ذلك بصلاحياتٍ واضحةٍ ومحدّدة، لكن الظاهر أن "كرسي الرئاسة" في الحالة العراقية الماثلة هو مطمح كثيرين، لأنه كما وصفته تغريدة ساخرة على موقع تواصل: "الكرسي الذي يضمن لشاغله العيش عاطلا ومن دون عمل لكن مسموح له أن ينفق من المال العام ما شاء لنفسه ولأهله وأقاربه وأصدقائه". وعلى أية حال، يظلّ هذا الكرسي في العراق، وعلى الرغم من السحر الذي يغلفه، أقرب ما يكون إلى "كعب أخيل" الذي يمثل واحدةً من نقاط ضعف "العملية السياسية" التي هي اليوم موضع خلاف واختلاف بين من يريد إعادة إنتاجها ومن يريد إنهاءها لصالح عملية سياسية يزعم أنها سوف تكون "وطنية" قد تمثل، إن صحّت النيات، خطوةً نحو المراجعة والتغيير المنشود. وهذا ما يخشاه كثيرون من رجال الطبقة السياسية الذين اعتاشوا عليها عشرين عاما، من دون أن يخطر ببال أحد منهم أن يعتزل أو يتقاعد أو ينصرف إلى ممارسة هواياته.
بقي أن يقال إن تجربة الحكم في المكسيك التي عرضها لنا كارلوس فوينتس تظل أكثر نقاءً، وحتى أقل فسادا من قرينتها في العراق، وإن أفراد الطبقة السياسية هناك يعملون على تقديم بعض ما يريده مواطنوهم لضمان كسب أصواتهم. أما عندنا فلا يأبه السياسيون لمواطنيهم، ولا يكترثون لمطالبهم.
إيران.. التمسكن ثم التمكّن
واللعب على المكشوف!
عبداللطيف السعدون
التمسكن ثم التمكّن، وصولاَ إلى اللعب على المكشوف، هذا هو جوهر "اللحظة" الإيرانية في أحدث تجلياتها، وقد حملتها تحولاتٌ إقليمية ودولية غير محسوبة، وأرست دعائمها سياسةٌ إيرانيةٌ حكيمة وصبورة. علينا الاعتراف بذلك، وقد شكّل وصول الديمقراطيين إلى مركز القرار في أميركا على أنقاض سياسات دونالد ترامب الشعبوية المعادية لإيران، واهتمام الرئيس جو بايدن بمسألة العودة إلى "الاتفاق النووي" الدعامة الأولى لهذه اللحظة التاريخية، تبعتها خطوات تخفيف الضغوط الدولية على طهران، والإفراج عن ملايين الدولارات من الأموال الإيرانية المجمّدة من دول أوروبا، وصولاً إلى تطبيع العلاقات والعودة إلى الاتفاق النووي الذي أصبح جاهزاً للتوقيع في صيغته النهائية، والذي ستجد فيه إيران ما يتيح لها إطلاق يدها في التعامل مع محيطها الإقليمي على النحو الذي رسمته استراتيجيتها الهادفة إلى تحقيق مشروعها "الثوري" في المنطقة.
وكانت تمكّنت، في الفترة السابقة، من أن تؤسّس أرضية ذات فعل للوصول إلى "اللحظة" التي تنشدُها، وسط ضباب الحصار والعقوبات، وتعاملت مع ما يدور من حولها بمزيجٍ من الدبلوماسية والقوة الخشنة معاً. واستطاعت إنجاز خطواتٍ عريضة، حقّقت من خلالها أهدافاً أساسية مرتبطة باستراتيجيتها التي لا تتورّع عن إعلانها: تقوية الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وتطويرها بما يضيف إلى قدرتها على الردع سلاحاً فعالاً، وزيادة إمكاناتها على تخصيب اليورانيوم إلى ما يقرب من 60% من الكتلة اللازمة لإنتاج سلاح نووي، مع تعهدها بالعودة إلى مستوى الـ20% إذا ما تم التوقيع على الاتفاق، وزيادة وتيرة إنتاج النفط والغاز وتصديرهما، رغم العقوبات والاستعداد لما بعد الاتفاق، وإنشاء "جيوش" قادرة على الدفاع عن مصالح "الجمهورية الإسلامية" في عواصم عربية، وتأهيل هذه "الجيوش" سياسياً وعقائدياً، والعمل على إدخالها في العملية السياسية في أماكن وجودها أذرعاً نافذة تسعى إلى بلورة أنظمة حاكمة، على غرار نظام قم، وربط هذا المنهج بالعقيدة المذهبية، وتحويل السفارات والهيئات الدبلوماسية الإيرانية القائمة في العواصم العربية إلى أدوات للتدخل في مؤسسات البلد المقيمة فيه على نحو أو آخر، والعمل على إحداث تغييراتٍ ديموغرافيةٍ وسكانيةٍ في المدن العربية عبر مليشياتها ووكلائها النافذين فيها، وبما يخدم مشروعها العرقي الطائفي المعلوم، وما يعنيه ذلك أيضاً من استهدافٍ للمشروع العربي الذي لا يزال يمتلك بعض الحياة.
تكتسب "اللحظة" الإيرانية مزيداً من الراهنية، وتشكّل اعترافاً باعتبار إي
أوكرانيا .. لزوم ما لا يلزم
عبداللطيف السعدون
"تبدأ الحرب في مكان ما، هنا أو هناك، غير أنها تمتد تماما مثل بقعة زيت على بساط من قماش الكتّان، وتتقدّم، تتقدّم أكثر حتى تقترب من مدينتك، من الحي الذي تقيم فيه، إلى أن تصل إلى باب منزلك، حينها سوف تصدّق أنها الحرب"، يمكن أن يكون رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، قد تذكّر هذه "الثيمة" التي أطلقها الأرجنتيني سيرجيو هارتمان على لسان بطل قصته اللافتة "يوم من ضمن أيام أخرى"، بعدما كان تجاهل دقات الطبول زمناً إلى أن حطّت الحرب عند باب منزله في "يوم أسود"، بوصف المستشار الألماني أولاف شولتز. عندها أدرك أن القيصر قد فعلها، ولذا قرّر أن يقاتل، ارتدى بزّة استعراضية لم يلبس مثلها سوى في السينما يوم كان ممثلا كوميدياً، جرّب أن يستنجد بحلفائه السبعة والعشرين زعيماً أوروبياً "من مستعدٌّ للقتال معنا؟"، لكنّ أيّاً منهم لم يردّ سوى بعبارات تعاطف ومواساة، والبيت الأبيض نفسه أكّد أن "بلادنا لن تدخل في حربٍ مع روسيا، ولن تذهب قواتنا لمواجهة عسكرية في أوكرانيا"، أسقط في يد زيلينسكي: "تركونا وحدنا ليشاهدوا الحرب على الشاشة". في تلك اللحظة التاريخية الفارقة، اكتشف أنّ "البيت الأبيض" لن ينفع في اليوم الأسود، وألغى متابعة تغريدات الرؤساء على "تويتر" احتجاجاً!
صحيحٌ أنّ زيلينسكي كان يخاف روسيا، ولا يثق بها، ويدرك أنّها قادمة يوماً ما لابتلاع بلاده، لكنّه لم يكن ليتصوّر أنّ خطوتها هذه سوف تتم بهذه السرعة. وكان وضع في حسابه الانضمام، عاجلاً أو آجلاً، لحلف الناتو الذي سيتكفّل بحمايته، لكنّه يشعر اليوم بالخذلان، ويريد إعادة النظر في حساباته، لكنّ وقائع الأيام الأخيرة تعلمه أنّ الوقت قد فات.
اكتشف الرئيس الأوكراني أنّ "البيت الأبيض" لن ينفع في اليوم الأسود، وألغى متابعة تغريدات الرؤساء على "تويتر" احتجاجاً!
في موسكو، على الجانب الآخر، كان القيصر يعرف جيداً أسرار اللعبة التي تمتلك جاذبيتها عليه، له خبرته العريضة فيها ابتداءً من المخابرات إلى السياسة إلى الرئاسة، عرف القانون والاقتصاد، وعرف أكثر لعبة الحرب. اختبرها في الشيشان وجورجيا، وبرع فيها عندما ضمّ شبه جزيرة القرم، وانطلق يؤسّس عملياً رهانه الاستراتيجي على إحياء دور روسيا في قيادة العالم، كما كان الاتحاد السوفييتي السابق. وقد رسم مساراً يتيح له تحقيق هدفه في الحصول على مدى جيوسياسي أوسع في أوروبا والعالم، ونجح في وضع أقدامه في "المياه الدافئة"، عبر تموضعه في سورية، ثم أمسك باللعبة في يده، طارحاً على الغرب شروطَه في طلب ضماناتٍ بمنع امتداد حلف الناتو شرقا، وعدم انضمام أوكرانيا، أو أيٍّ من الجمهوريات السابقة إلى الحلف، ومتوجّها، هذه المرّة، نحو كييف عاصمة أوكرانيا، منظّرا لما أسماها "تاريخية أوكرانيا الروسية"، ناظرا إليها أنها "دولة مصطنعة"، وأنّ ضرورات الأمن القومي لبلاده تفرض إلحاقها بروسيا أو على الأقل تنصيب حكومة موالية له فيها، وهو، في خطوته الماثلة، أعدّ كلّ الاشتراطات التي تخدمه، خصوصاً أنّ إمكانات أوكرانيا العسكرية لا يمكن أن تضاهي مثيلتها الروسية، وقد لا تصل إلى ثلث إمكاناتها، بعدما تخلت طواعيةً عن قدراتها النووية التي ربما شكلت، لو كانت باقية، عامل لجم لروسيا أو لغيرها، فضلاً عن قناعته المستجدّة بأنّ الغرب، وأميركا بالذات، لن يغامر في الدخول في مواجهةٍ عسكريةٍ مباشرة. ولعلّ هذه المعطيات تبلورت في ذهنه، حتى دفعته إلى الانخراط في مغامرته بدقة وتصميم، مظهراً عزمه على المضي بها إلى نهاية الشوط، ومتمثلاً مقولة الفيلسوف البريطاني، برتراند رسل: "إنّ أيّة حرب لا تحدّد من هو صاحب الحق فيها، لكنّها تحدّد الطرف الذي يبقى إلى النهاية"، وهو اليوم يرفع صوته عالياً إلى درجة تلويحه بتفعيل أسلحة الردع النووي ضد خصومه، فيما يبدو غريمه الرئيس الأوكراني مرتبكاً وغير قادر على تحديد أولوياته، خصوصاً بعدما صدمه الأميركيون والأوروبيون في عدم دخولهم الحرب، والاكتفاء بمدّه بحزمة مساعدات عسكرية، إلى جانب معاقبة روسيا اقتصادياً ومالياً، وقد قبل أن ينزل إلى حلبة التفاوض بأمل أن يجنب شعبه المزيد من إراقة الدم.
بقي أن نعرف أنّ كلّ هذه التداعيات تعكس في طياتها واحدةً من معضلات النظام الدولي الماثل الذي تبقى فيه القوة المعيار الأساس في حلّ المشكلات. وفي ظل هذا المعيار غير العادل، لا تملك الدول الصغيرة سوى خيار الإذعان لما يقرّره الأقوياء لها، مع التسليم باحتمال ظهور معطياتٍ غير محسوبة، قد ترغم المشاركين في اللعبة على لزوم ما لا يلزمهم.
في العراق .. سقوط
شعار "إيران أولاً"
عبداللطيف السعدون
أبرز ما يلفت نظر المرء، حين يستقرئ الأوضاع السياسية في العراق بعد الغزو الأميركي للبلاد والتوغل الإيراني فيها، بالأخص في السنوات العشر الأخيرة، تماهي رجال الطبقة الحاكمة المطلق مع نظام "ولاية الفقيه" في إيران، والتسابق بينهم على خدمته. ولا يحتاج المرء لجهد كثير كي يكتشف أنّ شعارهم العملي المضمر هو "إيران أولاً" لكنّهم يمارسون "التقية" في إخفائه لغايات معروفة، إذ يزعمون حرصهم على العراق ودفاعهم عنه، وليس في هذه اللفتة الصادمة ضربٌ من التوهم أو المغالاة، فكلّ شيء في بلاد الرافدين يوحي بأنّ بغداد تُحكم من طهران، فقد كانت لرجل إيران القوي الذي اغتاله الأميركيون، قاسم سليماني، سلطة الأمر والنهي في الشؤون العراقية، بتفويض من المرشد الأعلى علي خامنئي. وكان في زياراته المتعاقبة إلى بغداد واجتماعاته بالمسؤولين العراقيين يستفسر ويوجّه، ويأمر أيضاً، واعتاد زعماء الأحزاب الشيعية القيام بزياراتٍ، بعضها معلوم وبعضها الآخر مستتر، إلى طهران أو إلى قم، يسمعون ما يُملى عليهم مقابل إطلاق أياديهم في التحكّم بأبناء بلدهم واستباحة المال العام ونهبه، وحتى زعماء من السنة كانوا يذهبون إلى هناك طلباً للدعم، فلا تبخل عليهم طهران بشيء، ما داموا يمحضونها الولاء وهم صاغرون!
في ظلّ تلك الأوضاع الشاذّة، أصبح العراق، بمدنه ومياهه وثرواته، ونستطيع أن نقول بناسه أيضاً، في قبضة إيران، وفي خدمة مخططاتها ومشاريعها في المنطقة والعالم. ولم يكن المسؤولون الإيرانيون ينفون هذا الواقع، بل كانوا يفاخرون به، وقد تبجّحوا مرّاتٍ أنّ بغداد أصبحت إحدى عواصم إمبراطوريتهم، إذ أنشأوا فيها وفي المدن الأخرى مليشيات، وأقاموا مؤسسات ترتبط مباشرة بهم، وعملوا على إجراء تغييرات ديموغرافية واجتماعية، وشرعنوا "دولة عميقة" تحقّق لهم ما يريدونه، وتحوّل العراق، جرّاء ذلك، إلى ما يشبه ولاية إيرانية منها إلى دولةٍ تمتلك قراراً مستقلاً وسيادة نافذة، لكنّ الطبقة الحاكمة بدت متجاهلةً ما يحدث، وفي أكثر الحالات راضية ومتواطئة.
يرى بعضهم أن مقتدى الصدر نفسه، قد لا يمكنه التخلّص من القبضة الإيرانية لأكثر من سبب
وبمرور الزمن، شعر العراقيون أنّ بلدهم قد اغتُصب، وأن لا بد من وقفة جريئة يستعيدون من خلالها وطنهم. وهكذا بدأت الانتفاضة المطلبية وحركة الاحتجاجات التي انتقلت من مدينة إلى أخرى، وتحولت إلى ثورة عارمة تريد استعادة الوطن من غاصبيه، وتصاعدت أصوات الثوار أن "إيران برّه برّه". عندها أدركت طهران أنّها أصبحت في قلب العاصفة، وأنّ مشروعها الطائفي العرقي قد يتعرّض لشرخ كبير، إذا ما فلت العراق من قبضة يدها، وشرعت تستنفر مليشياتها ووكلاءها، وتسعى لأن تجعل منهم مركز قوة وتأثير عبر استخدام سلاح التهديد والتغييب والاغتيال من جهة، والاندساس داخل تجمّعات الشباب الناشطين، لحرف حراكهم والسعي إلى خطفه من أيديهم.
لكنّ جديد هذه الأيام ينبئنا بأنّ حصيلة الانتخابات البرلمانية لم تكن كما أرادها المعسكر الإيراني، إذ إنّها أعطت الأرجحية للتيار الصدري وزعيمه مقتدى الصدر الذي حاول أن ينأى بنفسه عن التركيبة الحاكمة، وأن يلتقط الخيط بذكاءٍ يُحسب له، ليدعو إلى "حكومة أغلبية وطنية، لا شرقية ولا غربية". ولاقى هذا الشعار الذي يعني السعي إلى الإفلات من قبضة إيران هوى حتى لدى الذين كانوا، إلى حد قريب، يخاصمون "التيار الصدري"، مع أنهم ما زالوا يجدون في تقلبات الصدر وتراجعاته في السابق ما يجدّد مخاوفهم من أن الصدر نفسه قد لا يمكنه التخلّص من القبضة الإيرانية لأكثر من سبب.
فشل خليفة قاسم سليماني في العراق، قائد فيلق القدس، إسماعيل قاآني، في تحقيق اختراق في علاقة الصدر بزعيم حزب الدعوة، نوري المالكي، التي يشوبها التوتر
وجديد هذه الأيام ينبئنا أيضاً بأنّ خليفة سليماني في العراق، قائد فيلق القدس، إسماعيل قاآني، فشل في تحقيق اختراق في علاقة الصدر بزعيم حزب الدعوة، نوري المالكي، التي يشوبها التوتر منذ قاد الأخير، في ولايته الأولى لرئاسته الحكومة، "صولته" الجهادية ضد أتباع الصدر بهدف اقصائهم عن الساحة السياسية وتفرّده بالدعم الإيراني له ولحزبه. كما لم تنفع وساطة قاآني في توحيد "البيت الشيعي" الذي يتنازعه في الخلفية انقسامٌ بين التيار الولائي والتيار المساند لمرجعية علي السيستاني، وبلوغ هذا الانقسام حدّه، في ضوء ما تردّد عن مرض السيستاني، وتقدّمه في السن (92 عاماً)، وسعي قم إلى تنصيب شخصية ولائية خلفاً له، الأمر الذي لا يحظى بمباركة مراجع الشيعة العرب.
وفي خضم كلّ هذه المقاربات والمفارقات، يبدو شعار "إيران أولاً" المضمر في نفوس حكام بغداد قد فقد سحره، وقد لا يمرّ زمن طويل قبل أن يسقط ويتلاشى غير مأسوف عليه!
شيء من مكر التاريخ وعبثه
عبداللطيف السعدون
لعلّ من مكر التاريخ وعبثه أن يستعيد البعثيون والشيوعيون في العراق ذكريات الصراع الدموي الذي عاشوه في أعقاب ثورة 14 تموز (يوليو 1958) التي قضت على النظام الملكي، وأن يحمّل كلّ طرف الطرف الآخر مسؤولية إطلاق عمليات تبادل الدم بالدم بينهما. ومناسبة استعادة تلك التداعيات السوداء مرور 59 عاماً على حدث الثامن من فبراير/ شباط عام 1963 الذي يسميه البعثيون "عروس الثورات" فيما يعتبره الشيوعيون انقلاباً عسكرياً أعاد العراق إلى الوراء.
ليست هذه نقطة الخلاف الوحيدة التي ظهرت في سجالات هذا العام على مواقع التواصل، إنّما تناسلت الأسئلة من قماشة: من بدأ مسيرة الدم؟ من زرع بذرة الخلاف والاختلاف بين الحزبين، وقد كانا قد ائتلفا في "جبهة وطنية" إلى جانب أحزابٍ أخرى، قبل أن يشتركا معاً في أول حكومة "جمهورية" دبّ الخلاف بين أعضائها قبل أن يجفّ الحبر الذي كتبت به مراسيم تشكيلها، ومن ثم أيضاً ما الذي جعل "الرفاق" يتنازعون أمرهم بينهم، وسرعان ما تفرّقوا أيدي سبأ، ولم يجدوا ما يحتكمون إليه سوى الدم؟
تحوّل الخصم في الرأي والفكرة إلى عدو يجب القضاء عليه
إنّه "مكر التاريخ" الذي قال هيغل إنّه يظهر عندما تكون حصيلة عمل امرئ ما غير ما فكّر فيه وسعى إلى تحقيقه، وهو ضربٌ من العبثية قد يتجسّد على وطأة مسيل الدم، وانهيار القيم، وخراب البلاد، وهذا ما شهده العراقيون منذ "سقطت المدينة" بعد "14 تموز"، وبدأت قيم التحضر والمدنية بالانحسار شيئاً فشيئاً، وتراجع دور الطبقة المتوسطة في كلّ مرافق المجتمع ومؤسساته، وأيضاً داخل الأحزاب والحركات السياسية، وترافقت مع هذا التحوّل موجة "شعبوية" حفزت كلّاً من الحزبين، الشيوعي والبعث، على الزعم إنّه مفوض، دون غيره من الأحزاب، للتعبير عن روح الشعب وحركته الصاعدة. وبهذا المنطق، كان الحزب يغادر الحوار، ويتنكّر للرأي الآخر، ويحتكر لنفسه ما يراه حقيقةً قد لا يقرّ بها الخصم، ويتطلع إلى السيطرة على الفضاء السياسي وحده، هنا تطوّرت الحكاية، تحوّل الخصم في الرأي والفكرة إلى عدو يجب القضاء عليه، ودخلت نظريات "المؤامرة" و"العمالة للأجنبي" و"التجسّس" إلى آخر "المونولوغ" لتضفي على البلاد مناخاً من التعصّب والثأر ومبادلة الدم بالدم!
وقد انزلق المثقفون والأدباء والشعراء نحو هذا المنحى، وتحوّل بعضهم إلى كتّاب "لافتات" تمجّد العنف، وتدعو إلى قتل الآخر المخالف أو المختلف. في حينها توعد الشاعر عبد الوهاب البياتي الخصوم بأن "يجعل من جماجمهم منافض للسجاير"، وكتب الشاعر الجواهري قصيدة خاطب بها حاكم العراق آنذاك، الزعيم عبد الكريم قاسم: "فضيّقِ الحبلَ واشددْ في خناقهمو/ فربما كان في إرخائه ضررُ/ تصوّرِ الأمر معكوساً وخذْ مثلاً/ في ما يجرونه لو أنّهم قدروا". وردّ البعثيون على خصومهم منذرين ومفاخرين بأنّ "وطناً تشيّده الجماجم والدمُ/ تتهدّم الدنيا ولا يتهدّمُ"!
في كلّ مرّة يتبادل فيها الجلادون والضحايا أدوارهم، يخسر العراق مئاتٍ ممن لا يمكن الشك في وطنيتهم وإخلاصهم لبلدهم
في ظلّ هذا المناخ "المبرمج" الذي ساد العراق آنذاك تفجرت مجازر الدم، بدايتها كانت في الموصل، إذ أقدم الشيوعيون، في أعقاب فشل تمرّد عسكري قاده أحد الضباط القوميين، في مارس/ آذار من عام 1959، على تشكيل "محاكم شعبية" قضت بقتل عديد من شخصيات المدينة، بدعوى تعاطفهم مع حركة التمرّد، وجرى تعليق (وسحل) جثث من وصفتهم صحيفة الحزب بأنّهم "مجرمون قتلة"، واعتبرت ذلك "درساً قاسياً للمتآمرين وضربةً في وجه دعاة القومية". وتكرر الأمر في كركوك، بعد شهور من واقعة الموصل، حيث تم قتل عشرات من أبناء المدينة التركمان وسحلهم بأيدي مناهضين لهم من الشيوعيين والأكراد. في حينها تساءل عبد الكريم قاسم: "هل فعل جنكيز خان أو هولاكو مثل فعلتهم؟".
لكنّ الأقدار لا تسير على نحو مستقيم إلى آخر الشوط، وهذا ما حدث عندما قدّر للبعثيين أن يصلوا إلى السلطة، وحانت فرصة الانتقام من خصومهم على نحو ممنهج، إذ جرت محاكمات صورية لعشرات من القادة الشيوعيين وأنصارهم، وتعرّض العديد منهم للقتل والإبادة.
وهكذا، في كلّ مرّة يتبادل فيها الجلادون والضحايا أدوارهم، يخسر العراق مئاتٍ ممن لا يمكن الشك في وطنيتهم وإخلاصهم لبلدهم. ويبقى في النهاية سؤالٌ أكبر من كلّ الأسئلة التي طرحتها سجالات مواقع التواصل: أما آن الأوان للحزبين اللذين ما زالا في الساحة، على الرغم من الضربات التي أثخنت جسديهما أن يبادرا للاعتذار بعضهما من بعض، وقبل ذلك الاعتذار من شعبهما عما ارتكباه من أخطاء وخطايا؟
العراق .. عندما
يختصم الإخوة الأعداء
عبداللطيف السعدون
العراقيون المعروفون بقدرتهم على الصبر والاحتمال بدأوا يفقدون هذه الطاقة في مواجهة أوضاع صعبة، لا قبل لهم بها، مقترنة بسيناريوهات مأساوية تطبّق عليهم على مدار الساعة، فتفقدهم احتمالهم، وتسلبهم قدرتهم على الصبر، وجديد ما يواجهونه اليوم خيبة أملهم في الانتخابات البرلمانية التي أرادوها "مبكّرة"، كي ترسم لهم طريقا آخر، على الرغم من أن النسبة العالية منهم حسمت أمرها منذ البداية، وقرّرت مقاطعة العملية الانتخابية لقناعتها أن لا شيء جديدا يمكن أن يحدُث في ظل القوانين والإجراءات الحالية التي تحكُم هذه العملية. ولا أحد من داخل "البيوت" السياسية الحاكمة يمكن أن يفكّر في قلب الطاولة على رؤوس القابضين على السلطة، ما دامت قسمة المناصب والمواقع والأموال المنهوبة تتم حسب الرؤوس. ولا أحد من خارجها يمكنه أن يعلّق الجرس في الحال الحاضر، ما دامت هناك قوى إقليمية ودولية وحدها تحدّد الرؤية وتملك القرار، وما دامت الظروف لم تنضج بعد لتشكيل قوةٍ شعبيةٍ فاعلةٍ تستطيع تحريك المسار، وليس ثمّة مشروع وطني ماثل يمكن أن يوحد ويؤثر ويغيّر. وقد انكفأت "ثورة تشرين"، وانقسم "الثوار" حول أولوياتهم، وحتى الأحزاب "الثورية" التي سادت في الماضي فقد بادت بفعل شيخوختها وعجزها عن إدراك الحال.
وإذا كان العراقيون يبحثون عن الخلاص، ولو بقشّة، فقد تنادى كثيرون منهم إلى الإمساك بالقشّة التي لوح بها لهم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الذي حصل على 75 مقعدا في البرلمان الجديد، طارحا فكرة تشكيل "حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية"، قال إنها سوف تلتزم بالإصلاح السياسي ومحاربة الفساد وحل المليشيات، وتضع السلاح بيد الدولة، وتتصدّى للتدخلات الخارجية، وتتناغم هذه "الشعارات" الوردية مع ما يطمح إليه العراقيون، وما يسعون إلى تحقيقه، لكن الشكوك تراودهم في حقيقة هذا "الانقلاب" الجديد للصدر، وقد اختبروا، أكثر من عقد، تقلباته الزئبقية، وجمعه بين مواقف بعينها وأضدادها.
لم تنضج الظروف بعد لتشكيل قوةٍ شعبيةٍ فاعلةٍ تستطيع تحريك المسار، وليس ثمّة مشروع وطني ماثل يمكن أن يوحد ويؤثر ويغيّر
وكيفما كان، أشعرت طروحات الصدر رجال "المعسكر" الإيراني الذي يسمّي نفسه "الإطار التنسيقي"، والذي يضم حزب الدعوة و"المليشيات" المرتبطة بالحرس الثوري، بخروجه عن طاعتهم، وإنه يبيت استهدافهم، كما شعرت حاضنتهم الرئيسية إيران بأن تحكّم الصدر بالقرار السياسي سوف يضعف نفوذها في العراق، وما قد يتبعه من خسارة "استراتيجية" لمشروعها في المنطقة، وهو أمرٌ تعتبر دونه "خرط القتاد". ولذلك سارعت إلى التدخل لفك الاشتباك بين "الإخوة الأعداء"، وبذل قائد فيلق القدس والمسؤول عن الملف العراقي في القيادة الإيرانية، إسماعيل قاآني، جهدا حثيثا في ذلك، لكنه عاد بخفي حنيْن. هنا رسم المرشد الإيراني، خامنئي، مسار الخطوة التالية التي أبلغت لقادة الإطار التنسيقي: "النزول إلى الشوارع، وليكن ما يكون!". وكان أن حصلت عمليات اغتيال وخطف وتفجير وتهديد من المليشيات، بغرض إرباك السلم الأهلي وإجبار الطرف الآخر على القبول بتسوية.
أدرك الصدر، عندئذ، أن خصومه سيلقون بكل ما في جعبتهم من أسلحةٍ لإفشال مشروعه الإصلاحي، أو على الأقل مطالبته بإعطاء ضماناتٍ بعدم حل المليشيات، وعدم محاسبة زعيم حزب الدعوة، نوري المالكي، عن مسؤوليته في تسليم الموصل إلى "داعش"، وهدر مئات المليارات من الدولارات في أثناء وجوده على رأس السلطة، ولم يكن أمام الصدر سوى خيار واحد، هو قلب الطاولة على الخصوم، عبر مقاطعة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، ووقف التفاوض معهم.
في هذا المنعطف، يكون الصدر قد ضيّق الخناق على مناوئيه، وفتح الباب أمام مختلف السيناريوهات، ومن بينها ذهاب البلاد إلى فراغ دستوري قد يطول. وإذا كان السياسيون قد اختصموا في ما بينهم، وأوقفوا عجلة مؤسسات الدولة عن الدوران، فما الذي يستطيع المواطنون المغلوبون على أمرهم أن يفعلوه؟
المنطق هو الذي ينبغي أن يسود، وهو ما افتقدته "ثورة تشرين" التي اضطرّت إلى الانكفاء
هنا نستعير سؤال الزعيم والمنظر السوفييتي، فلاديمير لينين، ما العمل؟ وفي الذهن إشاراته اللماحة إلى أن السياسة ليست في فهم الصراع داخل منظومة معينة فقط، إنما هي في فهم الصراعات داخل المجتمع كله، وتجذير الوعي على درء المظالم التي تحيق بالناس، وهذا لن يتحقق اعتباطا، إنما عبر تنظيم فاعل، ومن خلال نظريةٍ تواكب تطور الحياة.
ومع اختلاف الوقائع والتفاصيل، فإن هذا المنطق هو الذي ينبغي أن يسود، وهو ما افتقدته "ثورة تشرين" التي اضطرّت إلى الانكفاء، وهو أيضا ما يكمن وراء فقدان طاقة العراقيين على الصبر والاحتمال، وحتى في تراجع بعضهم عن النضال من أجل حقوقهم بوصفهم بشرا، والرضا بما تمنحه لهم السلطة من فتات.
عندما تتحوّل
أوكرانيا إلى "كلمة سر"
عبداللطيف السعدون
يقول الروائي الأميركي، وليام فوكنر، إنّ "الماضي لا يموت لأنّه ليس ماضياً". ولسوء حظ أوكرانيا، ينطبق هذا القول عليها أكثر من غيرها من دول القارة الأوروبية، إذ ما زالت مشكلات الماضي تلاحقها منذ كانت واحدة من جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق، وحتى وهي في سعيها بعد إلى بناء دولتها ومؤسساتها الدستورية. وهذا ما جعلها محط أنظار الغرب والشرق على السواء، وحلقة من حلقات المواجهة المباشرة بين أميركا وروسيا، إذ تنظر إليها الأخيرة على أنّها امتداد لأمنها القومي، بحكم موقعها الاستراتيجي في شرق أوروبا ووسطها، وإطلالتها على السواحل الشمالية للبحر الأسود وبحر آزوف. وتحاول جاهدة ضمّها إلى حظيرتها كما فعلت مع شبه جزيرة القرم من قبل. ومع أنّ أوكرانيا ثاني أكبر بلد في أوروبا لناحية المساحة، فإنّ دورها في التأثير على سياسات القارّة يظل نهبا لمشيئة الأطراف الدولية التي يرى كل طرفٍ فيها ضرورةً لمصالحه وأمنه، ويعمل على دعم قوى وحركات سياسية فيها، بهدف الاستحواذ على قرارها، بينما يطمح معظم الأوكرانيين، وإن تعددت مناشئهم العرقية في أن يكونوا "بيضة القبان" في صراعات أوروبا بين الغرب والشرق، وهو الهدف الذي لم يتمكّنوا من تحقيقه بسبب تعقيدات أوضاعهم والانقسامات القائمة في صفوف اللاعبين السياسيين عندهم، إذ فشلت "ثورتان" قاموا بهما في العقد الأخير في منع التدخلات الخارجية في بلدهم.
ويلعب الجيوبوليتيك دوره في أوكرانيا، فبينما يسيطر الانفصاليون الموالون لروسيا على نقاط ومفاصل استراتيجية في الشرق، ويسعون إلى الحصول على حكم ذاتي تتيحه لهم اتفاقية مينسك التي عقدتها أوكرانيا وروسيا ومنظمة التعاون الأوروبي، نجد تأثير الطامحين إلى التحالف مع أوروبا حاضراً في غرب البلاد، وهم يعتبرون الاتفاقية بمثابة "مسمار جحا" الروسي، وقد تستغله في أي وقت.
أخيرا، تحولت أوكرانيا الى "كلمة سر" في ظل احتدام المواجهات بين موسكو وواشنطن في أكثر من مكان، وقيام روسيا بتحرّكات عسكرية على الحدود الشرقية، رأى فيها الغرب ما يُنذر باحتمال ابتلاع أوكرانيا، وهذا الأمر غير مسموح به أميركياً ولا أوروبياً. ولذلك تصاعدت حدّة التهديدات والتهديدات المضادة بين مختلف الأطراف. وظهر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لاعباً رئيسياً يمسك بكلّ خيوط اللعبة، وهو القائل: "ليست مهمة السياسي صبّ العسل في الأكواب، بل وإعطاء الدواء المرّ في بعض الأحيان" وهو في أزمة أوكرانيا اليوم يعكف على التعامل مع سيناريوهات بعضها يحوي "دواء مرّاً" قد يسبّب مضاعفات خطيرة على صعيد أمن أوروبا والعالم.
من بين هذه السيناريوهات ما كشفته وزارة الخارجية البريطانية عن اتصالاتٍ روسية بسياسيين أوكرانيين موالين لها لتنصيب أحدهم، قد يكون النائب السابق، يفغيني موراييف، حاكماً في كييف، ومن ثم طلبه من موسكو التدخل عسكرياً لحماية بلاده في مواجهة احتمال تدخل أميركي أو أوروبي، وهذا السيناريو يشبه ما رسمه صدّام حسين في ذهنه، عندما فكّر في غزو الكويت، إذ أقدم على تنصيب ضابط كويتي على صلة بالمخابرات العراقية حاكماً على الكويت، وطلب هذا الحاكم مساعدة الجيش العراقي لحماية "ثورة" مزعومة تسعى إلى ضم الكويت إلى العراق، ومعروف طبعاً ما حدث بعد ذلك، وما جرّه هذا السيناريو الأحمق على العراق والمنطقة.
ثمّة سيناريو آخر يعدّ الأقرب الى تفكير بوتين، مستمد من نظرية "مصيدة ثيوسيديدس" التي تقوم على افتراض نشوب حرب نتيجة تنمّر قوة صاعدة بوجه قوة عظمى مهيمنة دولياً. وهنا يمكن لبوتين، وهو ما يعمل عليه، أن يضع الحرب خياراً محتملاً من باب التهديد فقط، ما يدفع الطرف الخصم إلى تلبية بعض مطالبه، وهو يدرك أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن وحلفاءه الغربيين لا يميلون إلى خيار الحرب، لأنّه يغرق كلّ الأطراف في تداعياتٍ غير محسوبة، ومطالب بوتين معروفة: "لن نقبل بأن يصل حلف الناتو إلى عتبة بيتنا" في ردٍّ على تلويح الأميركيين بنشر صواريخهم في أوكرانيا واحتمال انضمامها إلى الحلف، فيما يريد الأميركيون إعطاء الحلف جرعة حياة جديدة عبر أوكرانيا، بعد اصابته بـ"موت دماغي" بوصف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وهم يرفضون أيّ توغل روسي، ويعتبرونه "سابقة لم تحصل منذ الحرب العالمية الثانية" واللعبة الآن في أوج تصاعدها، ومن يضحك أخيراً قد لا يضحك كثيراً إذا ما سنحت الفرصة لخصمه لتغيير قواعد اللعبة!
حاشية في مناكفة فارغاس يوسّا
عبداللطيف السعدون
لهذه المقالة مناسبتها في احتجاج مجموعة من المثقفين والأكاديميين على تبوؤ الروائي البيروني، ماريو فارغاس يوسّا، الحائز على جائزة نوبل للآداب (2010)، أحد المقاعد الستة الشاغرة في "الأكاديمية الفرنسية" المعنية بحماية الآداب واللغة والثقافة الفرنسية، على خلفية مواقفه "المتطرّفة" و"المعادية للشيوعية"، وعلى دعمه زعماء اليمين في أميركا اللاتينية. ولم ينس المحتجون الإشارة الى "المشكلات الأخلاقية الخطيرة" ليوسا، وارتكابه واقعة "تهرّب ضريبي" فضحتها "أوراق باندورا". ورأوا أن دخول يوسّا إلى حرم الأكاديمية "يضفي الشرعية على مواقفه التي تضرب عرض الحائط بقيم الديمقراطية الفرنسية، ولا سيما الحق في الدفاع عن القضايا العادلة".
ومع أن دخول يوسّا إلى الأكاديمية الفرنسية ليس مكسباً شخصياً له، بقدر ما هو مكسب للأكاديمية نفسها ولفرنسا، فإن ما قاله المحتجّون عنه ليس جديداً، إذ كان بدأ حياته يسارياً وصديقاً للثورة الكوبية، إلا أنه سرعان ما انقلب على ذلك، وتحوّل إلى اليمين المتطرّف، مؤيداً السياسات الأميركية المعادية للشعوب. ومن مواقفه المعلومة تبريره غزو العراق على أساس "أن الدكتاتوريات من المستحيل أن تتغير بفعل الداخل"، لكنه قبل ذلك كان من المعارضين لفكرة الحرب. وقد زار العراق بعد الغزو بشهور، وفي "يومياته" كتب "إن الحرب الأميركية خلفت أنقاضاً وحريةً لكنها الحرية البربرية التي أدّت إلى نهب كل شيء"، و"أن خراباً ضرب بغداد جعلها مدينة شديدة القبح بعدما كانت من أجمل المدن العربية". وقريب من هذا الموقف ما كتبه بخصوص القضية الفلسطينية، واعتداده بكونه "صديقاً لإسرائيل"، لكنه دان سياساتها العنصرية ضد الفلسطينيين وممارستها القتل الانتقائي والتعذيب والسجن ومصادرة الممتلكات وهدم المنازل. ولاحقاً في زيارة له إلى الأردن طوّر موقفه: "الحل في دولتين، إسرائيل ودولة للفلسطينيين".
يعترف يوسّا بأن الخطأ الفادح الذي ارتكبه في حياته أنه أصبح شيوعياً، ولذلك تخلى عن عضويته في الحزب الشيوعي بعد عام فقط، "كنت أفكر أن الماركسية هي المخرج للبشرية من الظلم، لكنني اكتشفت في النهاية أنها أيديولوجيا مغلقة وطائفية ومتعصّبة وتقود إلى الخراب".
وفي أميركا اللاتينية، وجدت أحزاب اليمين في طروحات يوسّا نوعاً من التناغم مع رؤيتها إلى أفكار اليسار وتنظيراته. وبالطبع، كان هذا هو الدافع لأن تنظم المعارضة الفنزويلية، زمن الزعيم اليساري هوغو شافيز، ندوة يتحدّث فيها يوسّا عن "التحدّيات التي تواجه أميركا اللاتينية" كنت أحد شهودها. وفي حينها أثارت مشاركته في الندوة ضجيجاً كثيراً، خصوصاً بعد أن أطلق هجومه على التجربة الفنزويلية قبل أن يصل إلى كاراكاس، إذ وصفها بأنها "تيار شعبوي خطر يهدّد الديمقراطية في أميركا اللاتينية ويعيق تطوّرها"، ولم يستجب شافيز لطلب أنصاره منع يوسّا من دخول البلاد، لقناعته أن ذلك قد يفسّر بالعداء للديمقراطية ولمبدأ حرية التعبير، لكن يوسّا، المعروف بغرابة أطواره وعشقه المناكفات وتعمّده إثارة الضجيج في كل مكان يحلّ فيه، وهو ما أكّده لي صحافي فنزويلي صديق له، واصل إطلاق تصريحاته المعادية، حتى وهو داخل قاعة الندوة، في مناكفة منه لدفع حكومة شافيز إلى طرده من البلاد، واستثمار خطوةٍ كهذه لصالحه، لكن الرئيس الفنزويلي رد بمناكفةٍ أشدّ، عندما فاجأ يوسّا بدعوته إلى جلسة حوار في القصر الرئاسي، يحضرها مفكرون يساريون، إلا أنه اشترط أن يجرى الحوار بينه وبين الرئيس فقط من دون مشاركة آخرين، وردّ شافيز بالقول إنه رجل عسكري، وإن الحوار يمكن أن ينتظم على مستوى رجال الفكر، مشترطاً على يوسّا أن يعود الى بلاده (البيرو)، ويحصل على الرئاسة عن طريق الانتخاب أولاً، في إشارة ساخرة إلى خسارة يوسّا في الانتخابات الرئاسية التي كانت قد جرت في بلاده.
ومع كل ما قيل ويقال، يمكن الإشارة إلى أن يوسّا كان في ارتكاباته المتأرجحة يعكس فكره النقدي، بعدما أدرك أن "الماركسية" تحمل "دوغمائيتها" معها، وسوف يكتشف دعاتها، في مرحلة ما، أنها مليئة بالثقوب، وهذا ما وصل إليه لاحقاً.
وعلى أية حال، فإن يوسّا، وإن ظلّ يغترف من السياسة ويكتب فيها، إلا أنه، بوصفه روائياً كبيراً، وقد عدّ واحداً من قلة في هذا المضمار، فإن ثمّة مسافة بينه وبين النشاط السياسي المباشر تظل قائمة، وهو حتى في سعيه إلى الرئاسة في بلده لم يحاول أن يتخطّى تلك المسافة، وهو القائل "السياسة مملكة الكذب"، و"السياسي قد يضطر للسير بين الجثث"، وهو لم يكن يريد ذلك لنفسه!
هل يفلت العراق من قبضة إيران؟
عبداللطيف السعدون
كتب يسأل: "ثمّة تداعيات حاضرة على الساحتين، الدولية والإقليمية، ستكون لها مردوداتها اللاحقة على العراق وإيران. هل ترى في هذه التداعيات ما يخدم سعي العراق إلى الإفلات من قبضة إيران، وإلى أي مدى يمكن تحقيق نوع من "الاستقلالية" في القرار العراقي، خصوصاً أنّ الأميركيين لا يبدو أنّهم راحلون فعلاً، وأنّهم باقون هنا إن بهذه الصيغة أو بتلك؟".
يقول الفرنسي بول فاليري إنّ السياسة هي منع الناس من الاهتمام بما يخصّهم، وإجبارهم على تقرير ما يجهلون... ربما ينطبق علينا هذا القول أكثر من غيرنا، حيث اعتاد ساستنا أن يقرّروا نيابة عنا، ويعملوا على ترويضنا على القبول بما يقرّرونه، وهذا ما يحدث معنا اليوم. وبغضّ النظر عما يطلقونه من شعاراتٍ لا شيء يوحي بأنّ أحداً من ساستنا يفكّر، حتى مع نفسه، بالخلاص من قبضة إيران في المدى المنظور، بل ربما يعتبر بقاء هذه القبضة ضرورياً لبقاء سلطته وبناء مجده الشخصي، كما ليس ثمّة مؤشّرات عملية على أنّ حكومة بغداد القادمة، أغلبية أو توافقية، ستنهض بمهمة إنهاء أو على الأقل، تقليص سلطة الدولة العميقة التي صنعتها إيران في العراق، والتي أحد وجوهها تغوّل المليشيات في شتى ميادين الحياة العراقية، سواء منها تلك "المليشيات" التي يطلق عليها صفة "الولائية" التي ترتبط بالحرس الثوري الإيراني، وتتلقى السلاح منه وتتدرّب في معسكراته، لكنها تموّل من المال العراقي، أو التي تتخفّى تحت ستار "الحشد الشعبي"، وتزعم دفاعها عن الوطن قبل المذهب، وهي تسلك بذلك حالة ازدواجية تتيحها لها عقيدة "التقية" التي تدين بها.
اعتاد ساستنا أن يقرّروا نيابة عنا، ويعملوا على ترويضنا على القبول بما يقرّرونه
إذاً، ليس ثمّة جديد في الأفق، وهذا ما تريده طهران ووكلاؤها وتابعوها المحليون، وحتى في التداعيات الماثلة التي أفرزتها نتائج الانتخابات أخيرا، والتي قد يرى فيها بعضهم حالة انقسام في معسكر "الوكلاء"، فإنها لا تعكس تطوّرا حقيقيا في المواقف والسلوكيات باتجاه التغيير المنشود، فالكل متفقون على أن بقاء الهيمنة الإيرانية على العراق يسميها بعضهم "احتلالا"، هو الضامن الأكبر لبقاء "العملية السياسية" الحالية، ولسيطرة النفر الذي اعتمدته واشنطن، ومن بعدها طهران، لتحقيق استراتيجيات خاصة بهما، وحماية مصالحهما في المنطقة، ويجد الوكلاء والتابعون في هذا "التوافق" الشرّير طوق النجاة الدائم لهم.
وفي المقابل، ليس الأميركيون الذين كانوا المؤسّس الرئيس لهذا الوضع الهجين الذي أفرزته "العملية السياسية" الطائفية الماثلة في وارد الانسحاب الكامل من العراق، وكل ما فعلوه ويفعلونه يدخل في باب إعادة "ترتيب الأولويات"، بما تفرضه المتغيرات المتفجرة التي تسود العالم في القرن الجديد، حيث ينتقل الشغل الأساسي للماكينة الأميركية الى الصين التي شرعت تقتحم العالم اقتصاديا وسياسيا على نحوٍ غير مسبوق، وتخترق ساحات النفوذ الأميركي في أكثر من مكان، وكذلك كوريا الشمالية التي تعتبر من الدول التسع الأولى في العالم التي تمتلك قدراتٍ نوويةً فائقة، وتشكّل تهديدا لواشنطن ولحلفائها في المنطقة، ثم هناك طموح روسيا لاستعادة دورها في المشاركة في قيادة العالم، وتداعيات تحرّكاتها أخيرا تجاه أوكرانيا.
الكل متفقون على أن بقاء الهيمنة الإيرانية على العراق، هو الضامن الأكبر لبقاء "العملية السياسية" الحالية
في ضوء ذلك، ثمّة قراءة جديدة ينبغي أن يعتمدها العراقيون الذين يريدون استعادة الوطن، ومنهم فريق يمنّي نفسه بأنّ الأميركيين سيفعلونها في آخر المطاف، وسيقذفون وكلاء إيران خارج الحلبة السياسية، لتعود الأمور الى أبناء البلاد، وما يصفع هذه "الأمنية" ويردّها أنّ أميركا غزت العراق، ليس لبناء الديمقراطية فيه، كما تزعم، ولا لسواد عيوننا، وإنّما كان دفاعاً عن "إسرائيل" التي ظلّ العراق منذ استقلاله الأول عصياً عليها، كما أنّها أرادت السيطرة على بحيرات النفط وخزين المعادن الذي تتميز به بلادنا، وقد كلفتها الحرب أكثر من تريليونين من الدولارات، وخسرت فيها خمسة آلاف جندي إلى جانب جرح أكثر من اثنين وثلاثين ألفاً. وهي، من قبل ومن بعد، ليست جمعية خيرية تتصدّق على من أخنى عليهم الدهر. إنّها دولة كبرى لها مصالحها والتزاماتها ودورها في صنع العالم، والأجدى لنا، إذاً، أن نقرأ ما يدور من حولنا بعناية، وإلّا فسنبقى نراوح في مكاننا إلى ما شاء الله!
وبالمختصر المفيد، لم يجد السؤال المطروح إجابته العملية بعد، وعندي أنّ إفلات العراق من قبضة إيران كما هو إفلاته من قبضة أميركا، كلا الاحتمالين غير واردين، وواضح أنّ الظروف، وكذا المعطيات، غير جاهزةٍ لتحقيق أيّ منهما، وهو أمر مرّ ويستدعي الأسى، لكن "ظُنَّ خيراً ولا تسأل عن الخبر"!
عن "سردية"
الفساد في العراق
عبداللطيف السعدون
لافتٌ حقاً أن يتصدّى ثلاثة شبان عراقيين لركوب المركب الصعب، في محاولتهم الرائدة لفضح منظومة الفساد في بلادهم، تلك المنظومة التي اكتسبت شرعيتها المنتحلة زورا بموجب قوانين وتشريعات وأحكام صمّمت لكي تكون "حمّالة أوجه"، توافق عليها حرّاس "العملية السياسية" التي اخترعها الأميركيون لحكم العراق، وخلف أبواب تلك المنظومة المغلقة التي لا تزال عامرة بأهلها كومة أسرار وخفايا يكاد المواطن العادي يعجز عن رصدها ومتابعتها، فكيف باستقصاء مجرياتها وفك خيوطها على النحو الذي فعله العراقيون الثلاثة في "سرديةٍ" مثيرةٍ فتحت عيون كثيرين من مواطنيهم على ما يدور من حولهم، وكله حصيلة الحقبة السوداء التي استغرقتهم منذ الغزو الأميركي لبلادهم.
"المتطوعون" الثلاثة الذين تجرّأوا على كسر الأبواب وتفكيك الأسرار: محسن أحمد علي وعبد الرحمن المشهداني (أكاديميان) وعمر الجفال (باحث)، وقد نشروا بحثهم الاستقصائي، وفي خلاصته أنّ التأسيس لمنظومة الفساد بدأ في السنوات الأولى التي أعقبت الغزو الأميركي، وأنّ هذه المنظومة أرست آليات مكّنت الطبقة الحاكمة من تناقل الفساد وتحويله إلى طريقة حكم مشروعة سياسياً وقانونياً واجتماعياً. وأدّى تنامي الظاهرة إلى تعزيز قبضة الأحزاب والكيانات المشاركة في السلطة على مفاصل الدولة المختلفة، وباتت ثروات البلاد نهبا لذوي النفوذ والسيطرة، حيث بلغت قيمة الهدر المالي وحده أزيد من مائة وخمسين ملياراً من الدولارات.
في البحث حكايات تثير الشجن على ما آل إليه الوضع في العراق، تم تدمير القطاع العام بطريقة ممنهجة، جعلت الوظائف مضمونة الدخل، محتكرة لدى رجال السلطة النافذين وأحزابها التي تستخدم ورقة التوظيف في دوائر الدولة لكسب شريحةٍ واسعة من السكان إلى جانبها، واحد من كلّ خمسة عراقيين يعتمد في معيشته على الحكومة، وآلاف الموظفين "الفضائيين" يحسب لكلّ واحدٍ منهم أكثر من راتب لكنّهم، في حقيقة الأمر، وهميون لا وجود لهم. وبالطبع، تؤول رواتبهم التي تقدّر بأكثر من مائة مليار دينار شهرياً لجهات وشخصيات تابعة لمن بيده الأمر.
"المكاتب الاقتصادية" للأحزاب بدعة ابتكرتها عقول دهاقنة السلطة للسيطرة على ثروات البلاد، تسهم هذه المكاتب في إحدى أكبر عمليات غسيل الأموال في العالم. يعترف وزير سابق بأنّ هذه المكاتب تتقاضى نسبة معينة من كلّ مقاولة أو عقد. أدّت هذه العمليات إلى تضخّم الثروات الشخصية لزعماء الأحزاب وقادة المليشيات. وقد كان بعض هؤلاء، إلى ما قبل بضع سنوات، لا يملك شروى نقير، ونائب في البرلمان يقرّ بأنّ الوزارات تحوّلت إلى "دكاكين"، وأنّ مديري مكاتب الوزراء هم الذين يديرون عملياً وزاراتهم، ومحافظ يروي أنّ مدير مكتب أحد الوزراء طلب منه مبلغاً مالياً مقابل المصادقة على صرف تخصيصات مالية لمشاريع خدمية في محافظته.
الإعلام هو الآخر دخل إلى منظومة الفساد هذه، ثمّة أكثر من ثلاثمئة صحيفة ومجلة ونحو 55 قناة تلفزيونية وعشرات مواقع التواصل والجيوش الإلكترونية تابعة للأحزاب ومموّلة منها، وتعتاش على الابتزاز وإدارة الحروب بين الأحزاب والقوى السياسية نفسها.
نفهم من "سردية" الفساد العراقية أيضا أن للقيادات الدينية التي تعشّش تحت عمائمها عقارب الخداع والغش، حصتها هي أيضا في هذه اللعبة الشيطانية، وسلاحها "الفتاوى" المصنوعة على مقاسات من يحتاج لها، وواحدة من تلك "الفتاوى" تعتبر المال العام ملكاً مشاعاً للجميع.
كلّ شيء في العراق هو ضرب من ضروب الفساد التي يبدو بعضها مبتكراً، وقد لا تعرفه دول أخرى، ومن نماذج ذلك: تهريب النفط، تهريب الأموال، بيع المناصب، الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية، مزاد العملة، تجارة المخدرات، تجارة الآثار، المشاريع والعقود الوهمية، عقود النفط، عقود التسليح، أموال إعادة الإعمار .. إلخ. ولكي يتم إحكام تلك المنظومة الشريرة، تتداعى وقائع وقصص غريبة عن اغتيالات موظفين وإبعادهم وحبسهم، لأنهم فقط تحدّثوا عن ملفات فساد، أو رفضوا تمرير عقود مشبوهة.
هكذا أصبح الفساد في العراق قاعدة ثابتة في العمل الميداني الاقتصادي والاجتماعي، وليس استثناءً كما كان يحدث من قبل، ووضع ذلك العراق في أسفل قوائم الشفافية والنزاهة التي عادة ما تصدرها جهات دولية وإقليمية معتبرة.
وبعد، تحلّى الشبان العراقيون الثلاثة الذين كشفوا سوءات سلطات بلادهم بالجرأة التي أهلتهم للتفكير بصوت عال من دون خوف... هل سمعتم ببلد مثل هذا من قبل؟ يبدو أنّ هذا هو السؤال الذي أراد الباحثون الثلاثة إيصاله إلى الناس، والذي يحمل إجابته معه: ليس ثمّة بلد كهذا!
عن طائر شؤم
يأبى مغادرة العراق
عبداللطيف السعدون
يدرك العراقيون أنّ دخولهم إلى العام الجديد لا يعني خروجهم من جروح العام السابق والأعوام السابقة التي ما تزال طرية وصعبة على النسيان. وحتى جروح التاريخ المعتقة لم تبرأ بعد، وقد نُكئت وأعيد نبشها كي يتفرّق القوم أيدي سبأ يتنابزون بالألقاب، وتسيل دماؤهم أكثر فلا يجدون وسيطا يفرض حكمته، أو ناصحاً يخفّف من غلوائهم، أو حتى بطلاً مستبدّاً يقيم دولته على مبدأ "العدل أساس الملك".
ولا يملكون، وهم في مواجهة ذلك كله إلّا أن يرجعوا إلى تاريخهم يقلّبون صفحاته، يقرأونها بشغفٍ ويتسلون بها بحب، وتتملّكهم "نوستالجيا" تعينهم على استجماع قواهم، عل ذلك يفيدهم في تحمل فصول التراجيديا المديدة التي استغرقتهم عقدين، ولم تترُك لهم أملاً في خلاصٍ قريب، وقد يُمارس بعضٌ منا جلد الذات، محمّلاً نفسه نصيباً من تلك المعاناة التي طالت، فيما يلوذ آخرون بالعودة إلى الأساطير والحكايات، باحثين فيها عما يمنحهم قدراً من الأمان والحلم وراحة البال، والقناعة بأنّ شيئاً لا بد أن يحدث يوماً ما.
وإذ شئنا أن نفلسف حالنا بعيداً عن العقل، تذكّرنا أسطورة شعبية عن طائرٍ يتشاءم منه العراقيون هو طائر الطوطي (يسمّيه العراقيون الططوة)، الذي كلما مرّ في سماء قراهم، وهو يصرخ، يصيبهم الذعر والقلق، ويتوقعون كارثةً تحيق بهم. وتقول الأسطورة إنّ أصله امرأة شريرة مسخها الخالق على شكل طائرٍ ينشر الشر والخراب أينما حلّ، ويدفع أجدادنا هذا الشر بجمع الأطفال في باحة القرية، والطلب منهم ترديد عبارة "سكين وملح .. سكين وملح" كي يفر الطائر ويرحل.
ربما تتجسّد هذه الأسطورة في التراجيديا العراقية المديدة التي حملتها غزوة الأميركيين لنا قبل عقدين، الغزوة التي مكّنت عصابة من اللصوص وقطّاع الطرق وعملاء الأجنبي من الهيمنة على السلطة والمال والقرار، ونتج عنها هذا "الرصيد" الأسود الذي سجل في حساب العراقيين: أكثر من مليون مواطن بين قتيل ومعوّق، ملايين المشرّدين والنازحين واللاجئين في أصقاع الأرض، خسارة تريليون دولار بسبب عمليات الفساد وتريليون آخر بين نهب وسرقة وتبديد، سيادة السلاح المنفلت وتصاعد وتيرة الاغتيالات والخطف والاعتقال غير القانوني، توغل المليشيات في مؤسّسات الدولة ومرافقها وتغوّلها داخل المجتمع، وزيادة حالات انتهاك حقوق الإنسان العراقي وحرياته.
التراجيديا هذه لم تتم فصولاً، وطائر "الطوطي" يأبى أن يرحل، وآخر الفصول حدث في آخر العام في مدينة جبلة البابلية الوادعة، الغافية على شط الحلّة منذ أربعة آلاف عام، والموطن الأول لإبراهيم الخليل، وهذا كله لم يشفع لها في توقي شر المليشيات وأذى رجال السلطة أكثر من مرّة، لكنّها في هذه المرّة تلقت ضربة قاصمة، طاولت أسرة فقيرة تتعيّش على الزراعة، إذ أقدمت مجموعة من ضباط "المهمات الخاصة" على مداهمة المنزل البسيط الذي تقيم فيه الأسرة بدعوى وجود تاجر مخدّراتٍ يأوي إرهابيين اثنين، ونتج عن ذلك مقتل عشرين بشرياً بريئاً من بينهم رضيع في عمر أسبوعين وآخر بعمر سبعة أشهر، و18 من نساء ورجال بأعمار مختلفة.
ولم تستحِ الحكومة من أن تلفّق رواية بائسة عن هذه "الصولة الجهادية" التي استخدم فيها "أبطال المهمات الخاصة" القوة العشوائية والمفرطة، من دون مراعاة ضمانات الحماية التي يكفلها القانون، وأن تزعم أنّ ربّ الأسرة رفض تسليم نفسه، وحمل السلاح بوجه القوة المداهمة، ما دفعها إلى اقتحام المنزل، وكان أن فوجئت بجثث القتلى العشرين الذين قتلهم ثم انتحر، ولحقت بهذه الرواية رواياتٌ أخرى من هذا المسؤول أو ذاك، سعت إلى اعتبار الواقعة "حادثة فردية" داعية إلى التعقل والتهدئة. وأراد بعضها التغطية على المجرمين الحقيقيين من ضباط الدولة الذين نفذوا المجزرة بدم بارد، لصالح أحدهم الذي يرتبط بالمتهم بصلة قرابة، وقد أقدم على فعلته الإجرامية إثر خلاف عائلي، كما ظهر أنّ رجل الأسرة موضع الاتهام لم يكن تاجر مخدّرات، ولا صلة له بأيّ نشاط إرهابي.
وعرف الناس أنّ هذه الواقعة السوداء ليست سوى عينة صغيرة من ممارسات رجال المليشيات الذين تسيّدوا الأجهزة الأمنية الرسمية، وأمعنوا في الأرض فساداً مستخدمين العجلات الحكومية وأسلحة الدولة، وتحت ظلّ الحماية التي توفرها لهم مواقعهم الوظيفية.
بقي أن يعرف القارئ أنّ أحداً من المسؤولين الكبار، وزير الداخلية مثلاً، لم يتقدّم باستقالته أو يحمّل نفسه المسؤولية، ولو حدثت هذه الواقعة في أيٍّ من بلاد الله لاستقالت الحكومة كلها، وجرت إحالة بعض مسؤوليها إلى القضاء، ولكن!
الأميرة مريم ..
شخصية العام في العراق
عبداللطيف السعدون
في سيناريو تراجيدي مفعم بالمرارة بامتياز، يتسلّل خلسةً شاب أهوج إلى منزل الفتاة البغدادية مريم (16 عاما)، ويقتحم غرفة نومها، تصحو وهي في لحظة رعب لم تعش مثلها من قبل، تصرُخ في مواجهة القادم الشرّير الذي يحدّق في وجهها بلؤم، ثم سرعان ما يقذفها بمادة "الأسيد" الحارقة، ويخرج غير مبالٍ بما فعله. تنهض مريم، تحتضن مرآتها لتكتشف أن وجهها وقد تمزّق وتشوّه، وأنها فقدت ما كانت تحلم به أية فتاةٍ في سنها، جمال الخلقة المدهش الذي أكسبها صفة "الأميرة" لدى قريناتها والمعجبين بها.
لا يعكس هذا السيناريو الواقعي الذي شهدته بغداد فعلا إجراميا فحسب. إنه أكثر من ذلك، يعرض صورة مأساوية عن الواقع الذي تعيشه نساء العراق في ظل حكم الأحزاب "الإسلاموية" الذي فرضته هيمنة إيران على المشهد السياسي العراقي، واقترانه بممارساتٍ منافيةٍ لأخلاقيات الدين ولحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ليس أقلها العنف الموجّه إلى النساء، والذي غالبا ما يأخذ أفعالا لا يكفي تصدّي القوى المدنية لفضحها، وإنما المطلوب إيجاد التشريعات القانونية التي تمنع حصولها وتجرّم مرتكبيها وتعاقبهم. وتشريعات كهذه لا تنال اهتمام القوى المتسيّدة، بل إنها ترفضها بشدة، وتقاوم إقرارها بضراوة. وهذا ما فعلته في غير مناسبة وحالة، فعلى مدار أكثر من عقد، وهذه القوى تسعى إلى تمرير تعديلاتٍ على قانون الأحوال الشخصية الذي شرّعته حكومة ثورة الرابع عشر من تموز قبل ستة عقود، والذي عزّز مكانة المرأة ودورها في بناء الأسرة وتربية الأطفال، إذ حاولت فرض شروط قاسية على الأم في حالة حضانتها أطفالها، ومنعها من الزواج طوال فترة حضانتها (سبع سنوات)، وهو أمرٌ لا تقرّه لا الشرائع ولا القوانين الإنسانية، كما سعت إلى شرعنة زواج الصغيرات والزواج المؤقت، والزواج القسري، وترويج العمل على إفلات المجرمين من العقاب في ما تسميها "جرائم الشرف" التي سجّلت ارتفاعا غير مسبوق. وكذا في اتساع نطاق حالات العنف الأسري، إذ رصد تقرير لإحدى منظمات المجتمع المدني تعرّض النساء للحرق والضرب المبرح من رجال أسرهن. وثمّة أيضا حالات اتجار بالنساء والأطفال على نحو لم يعرفه المجتمع العراقي من قبل. لا شيء رادع، آخر ما وصل إلى الكاتب، وهو بصدد كتابة هذه المقالة، خبر واقعة اغتصاب جديدة ضحيتها فتاة اسمُها حوراء (سبع سنوات)، بطلها منتسبٌ لجهة أمنية، وقد جرى تهريبه كي يفلت من العقاب!
ولكي لا نغرق في التفاصيل، نذكر أن واقعة "التنمّر" التي اقترفها الشاب الأهوج الذي رفضت الأميرة الجميلة، الصغيرة عمرا، الزواج منه، لأنها تريد إكمال دراستها، جاءت عن عمدٍ وسبق إصرار، ولم تكن استثناءً من ظاهرة استخدام العنف ضد النساء، وسلبهن أبسط حقوقهن على نحوٍ يرضي توجّهات القوى المسيطرة ورغباتها. اللافت هنا صمت نساء البرلمان المنحلّ، وكذا الفائزات في الانتخابات أخيرا، اللواتي يزعمن دفاعهن عن المرأة عن إدانة ما يحيق ببنات جلدتهن من ظلم ومهانة. ومضحكٌ حقا أن تسخر إحدى النائبات (يمكن استخدام كلمة نوائب هنا بمعنى مصائب)، في معرض إجابتها عن سبب تجاهلها ما تعرّضت له مريم، بأن البرلمان ليس في حالة انعقاد بعد!
وإذا كان الشيء بالشيء يُذكر، فلا بد من رفع القبعات للذين وقفوا مع مريم وساندوها، من منظمات مجتمع مدني وناشطين سياسيين وإعلاميين وروّاد مواقع تواصل. وتُذكر بالخير قناة الشرقية التي تبنّت علاج الأميرة الصغيرة خارج البلاد. كما نسجّل بالتقدير كل مشاعر الحب التي غمرت جماهير واسعة في العراق والعالم تجاه الأميرة الصغيرة، هذه الوقفات المؤثرة تجعل نساءنا يتطلعن إلى غد أفضل وأجمل ليس لهن فحسب، إنما لنساء العالم كله.
هذا يدفعنا، وبكل حماس، إلى أن نرشّح الأميرة الجميلة إلى أن تتوج شخصية العام في العراق، كي تكون رمزا شاهدا على ما تتعرّض له المرأة العراقية من ظلم ومهانة، في ظل رجال الأحزاب الحاكمة الذين يرون في المرأة "مخلوقا" للمُتعة فحسب، لكنهم يحلّلون لأنفسهم نهب المال العام وسرقته، ويعتبرونه حقا خالصا لهم، ويحرّمون الغناء والموسيقى لأن "ثقافتنا إسلامية"، على حد تعبير أحدهم. وبعبارة عريضة، إنهم يمارسون شتى "الموبقات" من دون أن يرفّ لهم جفن.
صفقوا لمريم، إذن، اغمروها بالحب والحنان، وانتظروا عودتها من رحلة العلاج أجمل وأحلى مما كانت، انثروا الورد من أجلها وغنوا وارقصوا معها .. فهي أميرتكم الجميلة التي تستحقّ كل الحب وكل الاحتفاء، وكل الذكر الطيب.
العراق .. دعونا نتشبّث بالأمل
عبداللطيف السعدون
في جديد أخبار بغداد ثمّة جرعةٌ من أمل، قد تعيد إلينا الثقة في قدرة العراقيين على التغيير، بعد أن تجرّعوا كؤوس المرّ زمنا مديدا، اقترب من عقدين، عانوا خلاله من مشكلاتٍ وأزماتٍ لا أول لها ولا آخر، ولم تتح لهم فرصة تلمس الحلول، إذ لم تكن أمامهم سوى خيارات ضيقة ومحدودة لم تفضٍ إلى حل، ولم تضعهم على طريق التعافي، وكادت أن تُفقدهم ثقتهم بأنفسهم، في حين بات العراق "طويل الليل" كما وصفه المتنبي قبل أكثر من ألف عام، وجعلهم طول الليل هذا يفزعون بآمالهم الى الكذب، إذ يتعلقون بمشاريع إصلاح وتغيير وهمية، يطلقها لصوص وأفّاقون وحواة، يتنازعون أمرهم بينهم اقتساما للغنيمة، ثم لا يلبثون أن يتلبّسوا لباس التقوى والفضيلة عند صياح الديك.
جرعة الأمل هذه حملها لنا ثوار تشرين (أكتوبر 2019) إذ شرعوا في وضع أقدامهم على طريق استعادة الوطن، غير هيّابين من عظم المهمة التي أوكلوا أنفسهم لأدائها، ولا فزعين من تنمّر رجال "العملية السياسية" الذين التقطهم الأميركيون من الأزقة الخلفية لدول الغرب والجوار، وأوكلوهم حكم العراق. وإذا كان للثوار أكثر من موقف ووجهة نظر في التعاطي مع المتغيرات السياسية اليومية، فإن حصيلة كل تلك المواقف ووجهات النظر كانت تصبّ دائماً في مصلحة الوطن وفي خدمة أبنائه. وقد قاطع بعضُهم الانتخابات البرلمانية أخيراً على خلفية عدم توفر الاشتراطات اللازمة لجعلها عملية حرّة ونزيهة وشفافة، في حين رأى آخرون المشاركة فيها تحدّياً لطبقة الحكام الذين استأثروا بالسلطة على وفق هوى واشنطن وطهران، وبدا كما لو أنّ أحد الموقفين يكتمل مع الآخر.
الذين فازوا في الانتخابات من شباب ثورة تشرين، أو من المحسوبين عليها، شرعوا في اتخاذ خطواتٍ عمليةٍ لتكريس وجودهم في البرلمان المقبل معارضة فاعلة ونشطة
وفي جديد أخبار بغداد أنّ الذين فازوا في الانتخابات من شباب ثورة تشرين، أو من المحسوبين عليها، أو من معارضي العملية السياسية الطائفية الماثلة، شرعوا في اتخاذ خطواتٍ عمليةٍ لتكريس وجودهم في البرلمان المقبل معارضة فاعلة ونشطة، وقد أعلنوا عن تأسيس تحالف برلماني يحمل اسم "من أجل الشعب"، يضم 18 نائباً يمثلون حركة "امتداد" التشرينية و"حراك الجيل الجديد" الكردية المعارضة، كما توافقوا على إرساء مفهوم المواطنة الحقيقية، وألّا يقتربوا من كراسي السلطة، ولا يشاركوا في "اقتسام الكعكة"، وتلك أمورٌ تحسب لهم، وتضعهم في خانة العاملين على استعادة الوطن.
في جديد أخبار بغداد أيضاً ظهور حركات شبابية سياسية تجنّد نفسها لإحداث التغيير المطلوب، مثل "حركة اليسار الديمقراطي العراقي" و"المنظمة العربية للعمل من أجل الإنسان" اللتين اتحدتا، أخيراً، تحت اسم "اتحاد الطلائع اليسارية"، بهدف "بناء عراق حر ديمقراطي موحد"، ورأت هذه المنظمات في التحالف البرلماني "من أجل الشعب" خطوةً متقدّمةً على طريق تحجيم الأحزاب الفاسدة، ومحاسبتها على ما اقترفته بحق الشعب والوطن.
فشلت "الأحزاب الثورية" التي عرفها العراق في النصف الثاني من القرن الراحل، في السعي الى التغيير
قد يكون هذا "التململ الإيجابي" غير فاعلٍ بالقدر الذي يمكنه من إحداث التغيير المرجو، كما يرى بعضهم. لكن أن تشعل شمعة خير من أن تلعن الظلام، وقد يمكنه أن يشكل خطوةً أو خطواتٍ نحو نهوض عراقي طال انتظاره. وإلى ذلك، فهو يعكس فشل "الأحزاب الثورية" التي عرفها العراق في النصف الثاني من القرن الراحل، في السعي الى التغيير. راهن الشيوعيون على إقامة نظام ديمقراطي تحت الراية الأميركية، دخلوا "مجلس الحكم" الذي أقامه حاكم بغداد بول بريمر، والتحقوا في ما بعد بركب "التيار الصدري"، ولم يحصلوا على ما أرادوه، ثم قاطعوا الانتخابات البرلمانية، وفي مؤتمرهم أخيراً أعادوا قراءة "مزاميرهم" العتيقة عن "الوطن الحر" الذي لم يعد حراً و"الشعب السعيد" الذي أصبح شقياً بامتياز، وتفرّق البعثيون شيعاً وأحزاباً، وتبادلوا الاتهامات والشتائم التي وصلت إلى حد تخوين بعضهم بعضهم الآخر، وتخاصموا في ما بينهم على من له حقّ الظهور قائد ضرورة، وبقوا متمسّكين بطروحاتهم التي أدمنوها، وكأنّ الدنيا لم تتغير من حولهم. أما الباقون من قوى وشخصيات حملت يوماً راية التغيير فقد انكفأت هي الأخرى وتراجعت، ولم تعد تحمل سوى ذكرياتٍ عن زمن جميلٍ مر بسرعة البرق.
ألا يحق لنا بعد هذا أن نضع ثقتنا في شباب تشرين الذين شرعوا يضعون خطواتهم على طريق النهوض من دون منّة، ومن غير خوف، ألا يحق لنا أن نبارك خطواتهم، ونحن نشعر بالأمل في أن يحققوا لنا التغيير الذي نريده، وأن نستعيد من خلالهم وطننا الذي اغتصب؟
دعونا نتشبث بالأمل، إذاً!
حاشية في لقاء "الإخوة الأعداء"
أما وقد جمع الله الشتيتين، مقتدى الصدر ونوري المالكي، بعدما ظنّا، كلّ الظن، أن لا تلاقيا، فماذا بعد هذا اللقاء الذي أرادته إيران، كي تداري عبره بعض ما لحق بوكلائها العراقيين من خسائر أفرزتها انتخابات تشرين، ولكي تمهّد الطريق لإعادة إنتاج "العملية السياسية" الطائفية التي ضمنت لها السطوة على القرار العراقي على امتداد عقدين، وهي العملية التي تعرّضت للإنهاك الشديد والعطب، ولم يبقَ سوى تشييعها إلى نهايتها محفوفة باللعنات؟
لم يفرز لقاء "الإخوة الأعداء" هذا شيئاً ذا قيمة حقيقية يمكن البناء عليه لاحقاً، إذ خرج الطرفان، التيار الصدري والإطار التنسيقي، وكلٌّ يغنّي على ليلاه، وعرف في الأوساط السياسية أنّ اللقاء كان جافاً، ولا يحمل ملامح اتفاق، ولا حتى تقارباً في النقاط الأساسية. ولذلك، لم تزد البيانات والتصريحات التي صدرت عن شخصياتٍ محسوبةٍ على هذا الطرف أو ذاك عن أن تطرح ما تريده وتتمنّاه، وليس ما حصل اتفاقاً عليه. وبدا أنّ الصدر، وقد كان صريحاً في الإعلان بعد اللقاء مباشرة عن عدم التراجع عن موقفه، في "حكومة أغلبية وطنية، لا شرقية ولا غربية"، سعى إلى أن يُحدِث كوّةً في الجدار الصلد الذي صنعته أطراف الإطار التنسيقي، وأن "يبرئ ذمته" أمام جماهيره مما قد يُشاع عن إحداثه شرخاً داخل البيت الشيعي. وأيضاً استجابة لرغبة إيران في عقد اللقاء، وهو الذي يطمع ألّا تصل العلاقة بينه وبين طهران إلى ما صنع الحدّاد. وخوفاً من يدها الطولى التي قد تستهدفه، فيما كانت أطراف الإطار التنسيقي، ومن ضمنها المليشيات الولائية، تنطلق من "فائض ضعف" وليس من "فائض قوة" وقد أرادت، من خلال فائض الضعف هذا، تخفيف خسائرها وتزييد مكاسبها بالقدر الذي تستطيعه، خصوصاً بعد تراجعها عن التهديد باستخدام أساليب أخرى، غير الاحتجاجات السلمية. قد يكون من بين ما فكّرت فيه، في البداية، اللجوء الى حرب شوارع، ردّاً على "الغبن" الذي تزعم أنّه لحق بها جرّاء حالات تزوير حصلت في الانتخابات.
وقد فضحت صور اللقاء المنشورة على مواقع التواصل كيف ظهرت علناً الخصومة المطبوعة بالجفاء والتجاهل بين الصدر والمالكي. وعلى أية حال، لم يحقق اللقاء ما أرادته طهران التي سوف تفكّر مرة أخرى في الدخول على الخط لإصلاح ذات البين بين الأطراف المختلفة، لأنّها لا تستطيع التفريط بالمكاسب الضخمة التي حققتها في العراق على امتداد 18 عاماً، والتي قد تتأثر سلبياً إذا ما قدّر للتيار الصدري أن ينجح في تشكيل "حكومة أغلبية وطنية". وقد يأخذ هذا السيناريو من جرف "العملية السياسية الطائفية" الماثلة، وربما يطيحها على نحو كامل في المستقبل، والسيناريو الآخر الذي تبدو حظوظُه مساويةً لحظوظ السيناريو السابق، وربما أكثر، هو سيناريو "خلطة العطار" بتعبير الصدر، وهو المجيء بحكومةٍ توافقيةٍ على النحو الذي يدعو إليه الإطار التنسيقي، وتدعمه واشنطن وطهران، ولكلّ منهما حساباتها الخاصة، وثمّة سيناريوهات أخرى، محتملة الظهور في أية لحظةٍ ضمن لعبة "شدّ الحبال" بين التيار والإطار. ويتوقف اختيار أحدها على قدرة اللاعبين وإمكاناتهم ونفوذهم، وكذلك على حصيلة مباحثات الملف النووي بين الإيرانيين والأميركيين، إلى جانب عوامل إقليمية ودولية أخرى، ذات تأثير وفاعلية.
يبقى موقف الأطراف السنّية والكردية التي يمكنها أن تكون "بيضة القبّان" إذا ما تحالفت مع أيّ من الطرفين الشيعيين، لكنّها قرّرت، وبضغوط إيران أيضاً، عدم التحالف مع طرفٍ شيعيّ ضد طرفٍ شيعيٍّ آخر، وقالت إنّها تقف على مسافةٍ واحدةٍ من الجميع إلى حين تسجيل الكتلة الأكبر في البرلمان، إذ يمكنها آنذاك التباحث معها بشأن تشكيل الحكومة ومناقشة خططها. هذا يعني أنّنا سننتظر وقتاً طويلاً، قبل أن يرسو "مزاد" بيع الوزارات والمناصب العليا في الدولة على نقطة عبور، كما يعني أنّ هذه "الفوضى" التي يتّسم بها المشهد العراقي سوف تزيد من حدّة المأزق الذي يعيشه العراقيون اليوم، إذ تبقى الحلول معلقةً على ما يمكن أن يفرزه الواقع من متغيرات في الأيام والأسابيع المقبلة، وقد لا تأتي الحلول حين يحتاجها المرء، وإنما قد تتحوّل إلى مجرد أمل يظهر ويختفي. ولذلك يحدث، في أحيان كثيرة، بحسب الروائي البرتغالي الحائز على نوبل، خوزيه ساراماغو، أن يكون الانتظار هو الحلّ الوحيد الممكن.
على العراقيين، إذاً، أن يتعلّموا الانتظار والصبر!

عزيز علي .. لم يرضخ للحكام ورفض الغناء لهم
عن المونولوجست
الذي خاصم الحاكم
عبداللطيف السعدون
وسط احتدام المشهد السياسي في العراق، وتصاعد حمّى الخوف لدى الجميع مما هو قادم، تجد مجموعة من المثقفين والفنانين الفرصة سانحة لإنصاف فنان متفرّد وإعادة الاعتبار له بعد عقود من الاضطهاد والإهمال والتجاهل. ومن يكون هذا الفنان غير المونولوجست عزيز علي الذي قارع حكام بلاده على امتداد حياته، لا فرق عنده بين حاكم وآخر، سخر منهم وشتمهم، وقال فيهم ما لم يقله مالك في الخمرة. ورفض أن يقول فيهم مديحا أو إطراءً، على الرغم من أن بعضهم اقترح عليه أن يفعل ذلك فرفض، لأنه، كما قال، لا يمكن أن يكون بوقا لحاكم. وحين كان العراق في عهد الملوك يشهد هامشاً ديمقراطياً افتقدناه في عهود الجمهوريات، بدا الميدان فسيحاً أمامه، لينشط في فضح فساد الحكومات المتعاقبة، وفي الدعوة إلى الثورة على الحكام الذين اتهمهم بالعمالة للمستعمر، وذلك في مونولوجاته الشعبية الناقدة التي كان يقدّمها عبر راديو بغداد (الحكومي) في سنوات الخمسينات، والتي استقطبت جمهورا عريضا، إلى درجة أن أفراد العائلة كانوا يتحلقون حول الراديو مساء كل أربعاء لسماعه، والتعاطف مع ما يطرحه. وكان جزاؤه السجن مرات، وبتهم متناقضة لم يتوفر عليها دليل، ففي مطلع الأربعينيات، وجهت إليه تهمة اعتناق الأفكار النازية، إثر مجاهرته بمساندة حركة رشيد عالي الكيلاني ضد الإنكليز، وقد سجن إثرها سنتين. وعندما أعيدت له حريته غنّى "اسكت لا تحجي (لا تتكلم) تبتلي". عندها، وفيما كان يؤدّي نوبته الأسبوعية في استديو الإذاعة، فوجئ بحضور رئيس الوزراء آنذاك السياسي المخضرم، نوري السعيد، الذي هاله أن يهاجم عزيز السلطة في مونولوجاته. وظن أنّه "شيوعي" لكنّه حين عرف أنّه ليس كذلك اكتفى بتقريعه، وحثّه على استغلال موهبته في توعية المواطن، والتركيز على الجوانب الإيجابية وحركة الإصلاح في البلاد، وسمح له بمواصلة تقديم أغنياته.
طالما دعا عزيز علي إلى الثورة على الحكام الذين اتهمهم بالعمالة للمستعمر
لم يتراجع عزيز ولم يهادن، غنّى مونولوجات عديدة ناقدة، ومحفزة على التغيير في ظل الهامش الديمقراطي المتاح آنذاك، من ذلك مونولوج "كل حال يزول" الذي اعتبر نبوءةً بتغيير الحال. وفي اليوم الأول لقيام الجمهورية، أنشد قصيدة اشتهرت في حينه "نو.. نو.. لهنانة وبس (إلى هنا .. ويكفي)". اعتكف بعدها متمسّكاً بشعاره في ألّا يتحوّل إلى بوق للحاكم. لكن مشكلة الحاكم أنّه لا يقبل من الشاعر أو الفنان بأقل من قصيدة مديح أو نشيد في الإشادة به. ولهذا، اعتقل مرة أخرى، قرّر بعدها أن يعتزل الغناء، معلناً قراره هذا في مونولوج "ألعن أبو الفن لابو أبو الفن".
اعتقل عزيز من جديد في منتصف السبعينيات، على خلفية ما قيل عن العثور على اسمه ضمن مجموعة أسماء لشخصيات سياسية واجتماعية كانوا على صلةٍ بمحفل ماسوني قبل ربع قرن. وحكم عليه بالسجن سبع سنوات، بعد محاكمة استمرت خمس دقائق فقط، شمله عفوٌ عام بعد سنتين ليعود حرّاً.
عرضوا عليه تدبير هروبه إلى إيران، وطلبه اللجوء تحت ستار تعرّضه للاضطهاد والقمع في بلاده، والتجسّس هناك لصالح المخابرات العراقية، لكنّه رفض العرض بشدّة
لم يفارقه سوء الحظ إطلاقًا، على الرغم من اعتزاله، إذ حدث عندما نشبت الحرب بين العراق وإيران أن شرعت إذاعة الأهواز العربية في إذاعة مونولوجاته الانتقادية القديمة، وهو ما دفع سلطة بغداد آنذاك إلى التحقيق معه، لمعرفة ما إذا كانت له يد في إيصال تلك التسجيلات إلى إيران. ولمّا اكتشفوا أن لا صلة له بذلك، عرضوا عليه تدبير هروبه إلى إيران، وطلبه اللجوء تحت ستار تعرّضه للاضطهاد والقمع في بلاده، والتجسّس هناك لصالح المخابرات العراقية، لكنّه رفض العرض بشدّة. وبعدما يئسوا من استدراجه أطلقوا سراحه، ودفعه ذلك إلى حالة من اليأس، انزوى بعدها في منزله، حتى رحيله في أكتوبر/تشرين الأول 1998.
شكّل عزيز علي في مسيرته الفنية منذ منتصف ثلاثينيات القرن الماضي ظاهرة نادرة، ففي وقت ظهر عشرات المغنين والمنشدين الذين وضعوا أنفسهم تحت وصا ية الحاكم يغنون له ويغدقون عليه المديح، كان وحده النقيض لذلك، فقد رفض أن يكون بوقاً، على الرغم من كلّ ما تعرّض له من اضطهاد وإهمال وتجاهل.
وفي مواجهة ذلك، كانت مبادرة مجموعة الفنانين والمثقفين لإعادة الاعتبار له وتذكير الناس بما قدّمه من فن هادف، وباعتباره أحد رجالات العراق المبدعين، وتم تكريمه في الأسبوع الماضي بإزاحة الستار عن تمثال نصفي له من صنع الفنان موفق مكّي في مدخل مبنى مدرسة الموسيقى والباليه التي أشرف الراحل على تأسيسها في ستينيات القرن الماضي، بالتعاون مع خبراء وفنانين روس، ساهمت في صقل مواهب أطفال كثيرين، واصلوا مهاراتهم الموسيقية في ما بعد وأبدعوا فيها.
لمن الغلبة .. للصدر أم للمليشيات؟
عبداللطيف السعدون
من مؤسّس أول مليشيا طائفية في العراق بعد الاحتلال، فتكت بآلافٍ من أبناء الطائفة الأخرى، وبمئات الأكاديميين والمهنيين والعسكريين، إلى صاحب مشروع وطني مناهض للطائفية، وداع إلى حل المليشيات وتسليم سلاحها إلى الدولة، وتصفية "الحشد الشعبي" من العناصر غير المنضبطة، ومن متوافق مع طروحات "دولة الولي الفقيه"، وساع إلى ترويج العلاقة الحميمية معها، إلى ناء بنفسه عن طروحاتها، ورافض تدخلاتها في الشؤون الداخلية للعراق، ومن مشاركٍ في السلطة عبر ممثليه، وبينهم من هو متهم بممارسات فساد، إلى مناشدٍ للكيانات السياسية بعدم التستر على الفاسدين، وإحالتهم إلى القضاء للاقتصاص منهم مهما كانت مواقعهم أو ارتباطاتهم، ومن مترفّع عن طلب الولاية لنفسه إلى ساعٍ للحصول عليها بأي ثمن.
ذلك هو زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، رجل التقلبات والمتناقضات والألقاب العديدة التي يسبغها على نفسه، ومالئ الدنيا وشاغل الناس كلما عنّ له ذلك، والذي يبدو أن 18 عاما كانت كافيةً لتنقله من موقع المتمسك بالعملية السياسية الطائفية المدافع عنها إلى اللاعب المتمرّد عليها وعلى قواعدها، وقد أسعفته شعبويته بين فقراء الشيعة الذين يعتقدون فيه حاملا راية الطريق نحو دولة المهدي في إطلاق مبادرته أخيرا لتغيير المشهد السياسي بأكمله، مستمدّا حركته اللافتة هذه من "فائض قوة" جناه عبر الانتخابات النيابية أخيرا التي ضمنت له 73 مقعدا، بما يمثل ضعف المقاعد التي أحرزها خصمه اللدود زعيم حزب الدعوة، نوري المالكي، وأهلته لموقع اللاعب الأول في "العملية السياسية"، ومكّنته من تغيير "قواعد الاشتباك" وقيادة "انقلاب" سياسي، إذا ما قدّر له أن ينجح في إرساء دعائمه، فسوف يكون قد حقق إنجازا وطنيا يُحسب له، وإن كانت ثمة دلائل تفيد بأنه قد لا يكون قادرا على التقدّم بمشروعه "الوطني" الذي روّجه، وقد يتراجع عن وعوده كما فعل أكثر من مرّة. وبحسب ماكيافيلي، لا يحتاج السياسي أسبابا مشروعة ليحنث بوعده، خصوصا بعد أن أدرك خصومه من زعماء المليشيات والكيانات الخاسرة أنهم أصبحوا في دائرة الاستهداف، وأن الخطر يحيق بهم. ولذلك جمعوا أنفسهم في ما سمّوه "الإطار التنسيقي"، واستلوا سيوفهم، وهدّدوا بالإجهاز عليه وعلى مشروعه، إن لم ينصع لدعوتهم له، وينضوي معهم. وهم في ذلك يحاولون أن يداروا خسارتهم الفاضحة في الانتخابات، وتخلّي كثيرين عنهم بمزيد من الإنكار والعنجهية والاستقواء بالسلاح، وصولا إلى إخضاع خصومهم.
السؤال المطروح على أكثر من طاولة: أيهما يمكنه جرّ الحبل إلى ناحيته، مقتدى الصدر أم المليشيات، وأيهما سوف تكون له الغلبة، وقد أوشكت اللحمة بينهما أن تنفصم، بعد فشل جهود البحث عن تسويةٍ قامت بها طهران. وكان قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، قد أخذ دور "فاعل الخير"، وحاول لملمة الأمور، والدفع باتجاه إعادة إنتاج "العملية السياسية" القائمة، لكنه فشل في ذلك، ورجع إلى طهران ترافقه الخيبة. وهذا ما دفع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إلى الاتصال شخصيا برئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، والطلب منه "الوصول إلى حل قانوني وشفاف"، في عقدة نتائج الانتخابات التي ما تزال موضع خلاف.
ثمّة جزء آخر من المشهد، تتنازعه قوتان، الولايات المتحدة وإيران، يزيد الأمر تعقيدا وتأزما، حيث أعلن الأميركيون أن أكثر من ألفي جندي سوف يظلون في العراق في دور استشارة وتمكين ومساعدة، وسيقومون أيضا بأية مهمات أخرى، إذا ما طلب العراقيون منهم ذلك. وردّت المليشيات بالتهديد بأنها ستطلق عملياتها ضد الأميركيين مع نهاية العام، وهو الموعد المحدّد للانسحاب الأميركي، وزادت بدعوتها العراقيين إلى التطوع في صفوفها، استعدادا لما أسمتها "المواجهة الحاسمة" مع الأميركيين. وهذا العرض للقوة تقف وراءه إيران التي تهيمن على فصائل المليشيات، حتى تلك التي ترفع راية "الحشد الشعبي"، ما يتيح لها تحريكها في الوقت الذي تشاء، وضد أي طرفٍ خصمٍ لها.
هذا يعني أن العراق لن يتمتع بحال هدوء واستقرار لزمن أطول مما يتراءى لنا. وفي كل الأحوال، يظل المشهد محكوما بحالة سيولة متأرجحة بين دولٍ وقوى وأطرافٍ ليس بينها من يحرص على الدفاع عن العراق وحماية العراقيين، وهذه هي العقدة التي لم تجد من يحلّها بعد.
سياسيو العراق
عندما يلعبون "الشوملي"
عبداللطيف السعدون
ذكّرتني التوترات الناشبة بين أطراف "العملية السياسية" في العراق بحكاية شعبية عن خصام بين اثنين من الرعاة على ملكية عصا تستخدم في رعي البقر، يطلق عليها اسم "الشومة". وكلّ منهما يزعم أنّها ملكه، ويكرر صيحة "الشومة لي" وقد اندمجت الكلمتان بفعل تقادم الزمن لتصبحا كلمة واحدة. ومن هنا جاءت تسمية مدينة الشوملي في محافظة بابل التي يقال إنها شهدت الواقعة أيام زمان. وتضيف الحكاية أنّ كلّاً من الطرفين جمع أنصاره، وشرع يقدّم أدلته على ملكيته، حتى ضاق متابعو الخلاف ذرعاً بما يحدث أمامهم، وطلبوا من شيخ العشيرة التدخل لإيجاد حل، وعندما عجز نصح أتباعه أن يدعوا الطرفين يتخاصمان، وألّا يزجّوا أنفسهم في المشكلة، لأن النتيجة بالنسبة لهم واحدة، ربح هذا الطرف أم ذاك.
ومشكلة العراقيين مع ساستهم من زعماء المليشيات وقادة الكيانات السياسية هي مشكلة أبناء العشيرة مع طرفي الخصام في الحكاية الشعبية، إذ إنّ كلّاً من هؤلاء السياسيين يسعى إلى مواصلة الاستحواذ على السلطة والمال والقرار، فيما يتفرّج مواطنوهم على اللعبة الماثلة أمامهم، والتي ستكون نتيجتها واحدة، انتصر هذا الطرف أو ذاك، وسوف يظل العراقيون يبحثون عن شربة ماء وحبة دواء وفسحة أمن وأمان، حتى يقضي الله أمراً.
وإذ احتكم أولئك الزعماء والقادة إلى "صناديق الاقتراع" وفق ما تقتضيه اللعبة الديمقراطية التي يزعمون إيمانهم بها، فإنهم عندما شعروا، عند ظهور النتائج، أنّ حسابات الحقل لا تطابق حسابات البيدر، وأنّ الأمر قد يجرّ إلى خسارة سلطتهم، ومحاسبتهم عما جنته أيديهم عقدين، تنكّروا لما وعدوا به واستلوا سيوفهم وراحوا يضربون يميناً وشمالاً، ويتبادلون الاتهامات والتهديدات بالقتل والتصفية بعضهم لبعضهم الآخر. وفي هذا السياق، لم يتورّعوا عن تدبير محاولة لاغتيال رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، لينفضح هذا النمط من السياسيين الذين ساقتهم الولايات المتحدة من الأزقة الخلفية لدول الغرب والجوار، حيث كانوا "يجاهدون" لتقذف بهم في عاصمة الرشيد، كي يحكموا بلداً عمر حضارته أكثر من ستة آلاف سنة، وقد فقدوا الآن أعصابهم لمجرّد خسارتهم بعض المقاعد في الانتخابات البرلمانية التي أرادوا منها أن تعيد إنتاج سلطتهم على نحوٍ يرضي أحلامهم، وكشفوا عن إيمانهم المزعوم بالديمقراطية وحقوق الإنسان، وحتى عن عدم احترامهم للدستور الذي فصله على مقاسهم الأميركي نوح فيلدمان.
لحقت بكل هذه التداعيات، وكمحصلة طبيعية لها، حالة استعصاء قد تقود إلى العجز عن إنضاج عملية تشكيل حكومة فاعلة في وقت قصير، علق عليها ابعضهم ممن يُحسنون الظن بالأيام آمالهم الموؤودة.
ويدور الصراع الآن بين ما يسمّونه "الاطار التنسيقي"، وهذا يضم زعماء المليشيات والمصطفّين معهم الذي يسعون إلى إعادة انتاج "العملية السياسية" التي حكموا البلاد من خلالها طيلة السنين الماضية وقيام "حكومة توافقية" تعتمد المحاصصة الطائفية وتحافظ على امتيازاتهم وأرباحهم، و"التيار الصدري" الذي يدعو إلى تشكيل "حكومة أغلبية"، باعتباره الطرف الذي أحرز النسبة الأعلى من المقاعد في الانتخابات. ويعِد مقتدى الصدر زعيم التيار المساندين له بأنها ستكون "حكومة وطنية" لا تعتمد المحاصصة، وبأن يكون لها برنامج إصلاحي يركّز على محاربة الفساد، وتوفير الخدمات العامة، ورفض التدخلات الخارجية، ووضع السلاح بيد الدولة. ويبدو أن التوفيق بين الرؤيتين أصبح غير ممكن، في الحال الحاضر على الأقل. يُضاف إلى ذلك أن إيران، الراعية للأحزاب الشيعية، ليست في وضع يسمح لها بالانحياز المعلن لمعسكر المليشيات لأسباب عديدة، كما أنها لا تريد أن تنفض يدها من "التيار الصدري"، على الرغم من طروحاته التي لا ترتاح لها، ولأنّ قراءتها له توحي بأنّه أخذ يحتل حيزاً أكبر في الفضاء السياسي، إذ عرض التوافق مع ممثلي السنة، كما استقطب عدداً من الفائزين في الانتخابات من المستقلين، وحتى ممن يقدّمون أنفسهم من ثوار تشرين (أكتوبر 2019)، الذين لا يجدون ضيراً من التحالف مع الصدريين، على قاعدة أن "ليس بالإمكان أفضل مما كان".
ومهما يكن، سوف تكون الأيام المقبلة حبلى بالمفاجآت التي قد تعيد الوضع إلى المربع الأول، وقد تتصاعد التوترات والصراعات، لتأخذ طابعاً أكثر حدّة، ربما يفضي إلى استخدام السلاح، خصوصاً أنّ فصائل المليشيات ومعظم الكيانات السياسية تضع في أيديها مختلف أنواع السلاح، ومن ضمنه السلاح الثقيل، إلى درجة أنّ لدى بعضها طائرات مسيرة وصواريخ زودتها بها إيران، لاستخدامها عند الضرورة، وهذا ما يخشاه كثيرون.
حاشية في تداعيات
"الفرصة الأخيرة" للعراق
عبداللطيف السعدون
عندما يبارك الإيرانيون الانتخابات البرلمانية العراقية، ويعتبرونها "استمرارا للمسيرة الديمقراطية في العراق"، ويصفون ما أثير بعدها من جدل ومماحكات بين الكتل والأحزاب المشاركة فيها بأنه "شأن داخلي يخص شعب وأحزاب هذا البلد"، فهذا يعني أن العراقيين سيواجهون عواصف سياسية هوجاء، قد لا ينجو من مقاديرها أحد، وأن الإيرانيين لا يريدون أن يكونوا في الواجهة، ما دامت عقدة "الملف النووي" لم تحسم بعد. ولذلك تراهم يمارسون في طرح مواقفهم مما يجري لعبة "التقية"، تاركين لوكلائهم المحليين فعل المقتضى، بعكس ما كانوا يعلنونه في فترة سابقة، عندما كان رجلهم القوي، قاسم سليماني، يتحكّم في الملف العراقي، وفي حينها لم يتورّع عن التبجح بأنه وراء إنشاء "الحشد الشعبي" للدفاع عن بلاده. وواضح أنهم، في ظل الظروف المعقدة التي تحيط بهم، ليسوا على عجلة من الوصول الى هدفهم الأخير في إحكام هيمنتهم على العراق، وربما إعلانه ولايةً من ولايات "الولي الفقيه" كما يحلم بعضهم، إنما "رويدا رويدا وتتحوّل خيوط الصوف إلى سجادة" بحسب المثل الفارسي.
وقد رأينا مقدّمات تلك العواصف في تظاهرات "الفرصة الأخيرة" التي طوّقت "المنطقة الخضراء"، والتي نظمتها المليشيات "الولائية"، وأرادت منها إشعال النار في نتائج الانتخابات، وإسقاط حكومة مصطفى الكاظمي التي اتهمتها بتزوير نتائج الانتخابات، وسرقة أصوات الآلاف من الناخبين لصالح خصومها، وصولا إلى محاولة اغتيال الكاظمي، بعد ساعات من تهديد زعماء المليشيات علنا بتصفيته، ما يؤكّد النية السوداء لإدامة حالة عدم الاستقرار في العراق، بما يخدم توجّهات إيران في الإقليم، ويضمن لها بقاءها قوة مهيمنة على العراق، وساعية إلى توسيع هذه الهيمنة، كي تشمل دولا أخرى في محيطه.
ليس الإيرانيون على عجلة من الوصول الى هدفهم الأخير في إحكام هيمنتهم على العراق، وربما إعلانه ولايةً من ولايات "الولي الفقيه" كما يحلم بعضهم
وعبرت تظاهرات "الفرصة الأخيرة" في وجهها الآخر عن حالة إحباط ونكوص، عانى منها معسكر المليشيات، إثر خسارته المدوية في الانتخابات، وبعد أن انعقد ما يقترب أن يكون إجماعا عاما لدى العراقيين على رفض الهيمنة الإيرانية، والنظر الى "المليشيات" طابورا خامسا يخدم المشروع العرقي الفارسي، المتخفّي وراء الشعارات المذهبية. وزاد من حقدها ارتفاع صيحات ثوار تشرين أن "إيران برّه.. برّه"، ودفعها إلى الولوغ بدماء الثوار، والسعي إلى إسكات أصواتهم على النحو الذي عرفه العراقيون في العامين الماضيين.
وثمّة مفارقة برزت في هذه التظاهرات تدعم ما طرحه في السابق معنيون بالوضع العراقي، وهي اصطفاف "الحشد الشعبي" الذي يفترض أن يكون جزءا من القوات المسلحة العراقية إلى جانب "المليشيات الولائية"، ومشاركته بتظاهرات "الفرصة الأخيرة"، وتنديده بالقائد العام للقوات المسلحة، والتوعد بتصفيته، ما يشكّل خرقا للقوانين العسكرية يستوجب العقوبة، ويعزّز الانطباع القائل إن "الحشد" الذي أخذ أكبر من حجمه ليس سوى أداة في خدمة مخطّطات معادية للهوية العراقية وللأهداف الوطنية. ومفارقة ثانية، تبنّي مسؤولين في الحكومة، وفي كتل وأحزاب قائمة، تلك التظاهرات التي خرجت عن الإجماع الوطني بشعاراتها الطائفية، وبترويجها لغة العنف غير المبرّر.
وفي التداعيات أيضا محاولة بعض قيادات الجماعة السياسية الحاكمة النأي بأنفسهم عن محاولة الاغتيال، وقد كانوا إلى حد آخر ساعة يهدّدون بتصفية الكاظمي واثنين من مساعديه، لكنهم ما لبثوا أن استداروا مئة وثمانين درجة بعد فشل المحاولة، داعين إلى ضبط النفس وعدم الانجرار إلى الفتنة.
ثمّة صراعات بدأت تظهر إلى العلن بين الأطراف المختلفة في العراق، ربما تجعل الوضع العام قلقا ومفتوحا على كل الاحتمالات
وهكذا فشل "سيناريو" الإقصاء والتصفية الذي أرادته المليشيات للكاظمي، وأدّى إلى عكس ما أرادوه، فقد سجل الكاظمي نقطة لصالحه، قد تخدمه في سعيه إلى تأمين حصوله على ولاية ثانية، وإن كان زعماء المليشيات سيعملون جهدهم للوقوف بوجهه. وبقدر ما انعكس فشل "السيناريو" الماثل على حظوظ المليشيات في استئثارها بموقع القوة والنفوذ الذي اعتادت التعامل من خلاله مع الآخرين، فإنه سوف ينعكس أيضا داخل "العملية السياسية" الماثلة نفسها التي تريد الجماعة الحاكمة إعادة إنتاجها. وثمّة صراعات بدأت تظهر إلى العلن بين الأطراف المختلفة، ربما تجعل الوضع العام قلقا ومفتوحا على كل الاحتمالات، وقد يدفع قوى إقليمية ودولية إلى التدخل لتأمين موطئ قدم لها في بلدٍ يحوي من عوامل الجذب الكثير.
يبقى السؤال الذي ننتظر الإجابة العملية عنه: كيف سيتصرّف الكاظمي تجاه المليشيات هذه المرّة، وهل سيكون حازما في اتخاذ ما ينبغي بعد أن وضح الدور الشرير الذي لعبته في محاولتها إغراق العراق بالدم، وبعد أن حصل على هذا الدعم الدولي الواسع الذي لم يسبق لحكومة سابقة عليه أن تناله؟
حاشية في انقلاب السودان
عبداللطيف السعدون
حكى الحاكم العسكري للسودان، عبد الفتاح البرهان، في مقابلة له على التلفزيون ذات مرة، أن أمه كانت قد قرأت له حظه وبشّرته بأنه سيصبح يوما رئيسا للبلاد. وقد دفعته، على ما يبدو، هذه "البشرى" إلى استعجال وصوله إلى سدّة الرئاسة، منقضّاً على رفاقه في السلطة الذين جاءت بهم قوى إعلان الحرية والتغيير، وملغيا المؤسسات التي أقرّها "الإعلان الدستوري" ومتعهدا لمواطنيه بإكمال "التحوّل الديمقراطي" خلال سنتين، يعرف المجرّبون أنها ستطول إلى ما شاء الله. بذلك يكون قد جمع السلطة من أطرافها ووضعها بين يديه، بعدما استنسخ تجربة سميه رئيس مصر، عبد الفتاح السيسي، وبعدها تجربة رئيس تونس، قيس سعيّد، و"مفيش حد أحسن من حد"!
وقد يكون البرهان، وهو في غمرة استعجاله، نسي أن لبلاده خبرة في الانقلابات العسكرية، إذ شهدت، منذ الاستقلال وعلى امتداد أكثر من ستة عقود، كومة من الانقلابات، بعضها نجح وبعضها فشل، وتكاد كلها تحمل "الروزنامة" نفسها التي جاء بها البرهان. وعلى الرغم من هذه الخبرة العريضة، فإن أحدا من "العساكر" الكبار الذين خطّطوا لتلك الانقلابات أو وقفوا وراءها لم يتورّع عن التنكّر لوعوده والتنمّر على من جاء به إلى السلطة، وبقيت السودان في ظلهم تعاني من مشكلاتها المزمنة، الفقر والجوع والمرض، ولم يوفّق السودانيون في نيل حقوقهم في الحرية والديمقراطية والحكم العادل. ولذلك لم تتحقق عندهم القناعة بحكم العساكر عندهم، وهذا ما دفعهم إلى رفض انقلاب البرهان منذ يومه الأول، ونزلوا إلى الشوارع، معلنين العصيان المدني حتى رحيل الانقلابيين ووضع السلطة بيد قوى الائتلاف المدني.
رفض السودانيون انقلاب البرهان منذ يومه الأول، ونزلوا إلى الشوارع، معلنين العصيان المدني حتى رحيل الانقلابيين
الاستثناء الوحيد على تجربة "العساكر" السودانيين هي الفترة التي قضاها المشير عبد الرحمن سوار الذهب على رأس السلطة بعد "انتفاضة إبريل" منتصف الثمانينيات، ودامت سنة وافق على أن يمدّدها عشرين يوماً فقط بطلب من القادة السياسيين والنقابيين إلى حين إعلان نتائج الانتخابات وتسليم السلطة إلى حكومة منتخبة، وكان أصلا قد تردّد، في البداية، في قبول ترؤس السلطة، إلا أن الضغط الشعبي دفعه للاستجابة، ولم يشأ أن يتشبّث بالكرسي و"يبرمج" طريق البقاء رئيساً أبدياً، كما فعل آخرون في غير عاصمة عربية، ممن لم يكتفوا بما فعلوه، إنما ظلت عيونهم على أبنائهم كي يورّثوهم السلطة!
وفي ضوء هذه المعطيات، يستقرئ المرء بحذر ما يمكن أن يدور اليوم في ذهن عبد الفتاح البرهان الذي لا تخطر في باله فكرة الاقتداء بتجربة سوار الذهب، لسبب بسيط، افتقاره حنكة الرجل وحكمته، كما قد لا يفكّر في التراجع عما فعله، بعدما أوقع نفسه في مأزق، الخروج منه صعب والبقاء فيه أكثر صعوبة. لكنه في الحالين سوف يكتشف، ولو بعد حين، أنه يشبه من يضرب حائطاً صخرياً على أمل تحويله إلى باب، إذ إنّ الباب الوحيد الممكن فتحه بأمان هو في إعادة الحياة إلى التشكيلة الدستورية التي أجهز عليها، وتسليم السلطة لقوى الائتلاف، واعتزال "السياسة" التي لن تورّثه، لو أصرّ على خوض غمارها، إلّا الندم!
يدرك البرهان أنه يسير على أرضٍ رمليةٍ تهب عليها الرياح من جهاتها الأربع
وفي أيّ حال، وقع البرهان في وهمٍ ظن أنه سوف يعينه في التقدّم نحو ما يأمله، ويتوافق في هذا مع مساعده محمد حميدتي، قائد مليشيا الجنجويد التي أصبحت تعرف باسم "قوات الدعم السريع" الموازية للجيش النظامي، والذي يحظى بدعم أطراف خليجية لم تشأ أن ترمي بثقلها وراء الانقلاب في الظرف الحاضر على الأقل.
وقد يكون البرهان فكّر في أن بصمات أصابعه على اتفاق التطبيع مع إسرائيل التي ما تزال طرّية ستوفر له إمكانية البقاء في القمة. وربما فكّر أيضا أن الأميركيين سرعان ما سيعيدون النظر في موقفهم الرافض للانقلاب، عندما يطمئنون إلى استقرار سلطته وثباتها، خصوصا أن عوامل جيوبوليتيكية يتمتع بها السودان قد تخفّف من غلوائهم، وتدفعهم إلى الاقتراب من حكومة الخرطوم، وهذا ما فعلوه مع حكومة السيسي في مصر، إلى جانب استعداد البرهان لتلميع صورة انقلابه، والسعي إلى استقطاب عناصر مدنية تعينه على ذلك، وهذا ما نلاحظه في التلويح بإمكانية إعادة رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، إلى منصبه، وكذلك الوعد بإعلان تشكيلة وزارية قريباً
يبقى أن يدرك البرهان أنه يسير على أرضٍ رمليةٍ تهبّ عليها الرياح من جهاتها الأربع، وهذا ما يجعل كلّ الاحتمالات واردةً وفي أيّ وقت.
اللعبة في العراق لم تنتهِ بعد
عبداللطيف السعدون
يقود أي حدثٍ يتعلق بالانتخابات العراقية، حتى لو كان عابرا أو صغيرا،
إلى العودة الى جذور اللعبة التي بدأت مع الغزو الأميركي للبلاد
وامتدّت. وليس ثمّة أي مؤشّر على أنها سوف تنتهي في القريب، وكل
الطروحات المتفائلة التي جاء بها ناشطون سياسيون أو محللون لا تعدو أن
تكون مجرّد شطحات خائبة. وتكمن جذور اللعبة هذه في عاصمتين بينهما ما
صنع الحدّاد، واشنطن وطهران. وبالطبع، تريدان إبقاء العراق عالقا على
امتداد الطريق بينهما، ولكلّ منهما رؤيتها ومصالحها ومطامعها، كما لكل
منهما طابورها الخامس الذي يعينها ويمحضها الولاء، ويسعى إلى أن يحقّق
لها ما تبغيه.
وإذا كانت "السياسة" مثل رغيف خبزٍ مغموسٍ باللعنة، كما وصفها أحد
المفكرين، فان المواطن العراقي مضطر لازدراده ولو ببطء. هكذا هو واقع
الحال، وقد وضح أن الذين أعطوا أصواتهم في الانتخابات أخيرا، والذين
شاءوا مقاطعتها على حد سواء، تلقوا الجواب: "تريد أرنبا خذ أرنبا، تريد
غزالا خذ أرنبا". أكّدت ذلك ثيمة الاجتماعات واللقاءات التي انعقدت
بحضور قادة "العملية السياسية"، بمن فيهم "المخلصون الكذبة" الذين
ظهروا والبراءة المصطنعة في عيونهم، لكنهم كانوا في قرارة سرّهم يعضّون
على النواجذ، كي يبقى الحال على ما هو عليه، وربما يصبح أكثر سوءا.
ووضح أيضا أن "المرجعية الشيعية" التي وجّهت بعدم انتخاب من خضع
للتجربة تراجعت، وهذا ما ظهر في تسلّق "مجرَّبين" عديدين إلى مقاعد
البرلمان المقبل، وعلى حدّ ما نقله عارفون بما وراء الأكمة، فإن أسماء
"مجرّبة" طُرحت، ليكون واحدٌ منها رئيسا للحكومة المقبلة، وهذا يعني أن
لا جديد تحت الشمس في الزمن الحاضر على الأقل، والوقائع تفضح النوايا.
اتهم "وكلاء إيران" "مفوّضية الانتخابات" بتزويرها، بالتنسيق مع قوى خارجية، ونظّموا حركة احتجاجاتٍ وعصيانٍ
وكما توافقت واشنطن وطهران على دعم "العملية السياسية" وإسنادها طيلة
السنوات الماضية، وكلٌّ له حساباته، فقد توافقتا أيضا على مباركة
الانتخابات الأخيرة، والتهنئة بهذا "المنجز الديمقراطي". وذكّر
الأميركيون أصدقاءهم العراقيين بالشراكة الاستراتيجية التي جمعت بينهم،
والتي قنّنتها "اتفاقية الإطار الاستراتيجي"، فيما أكّد الإيرانيون أن
العلاقة مع جيرانهم العراقيين "قلّ نظيرها في العالم"، كما حصلت
"العملية السياسية" على جرعة دعمٍ جديدةٍ من مجلس الأمن.
وعلى النقيض مما أعطته هذه البيانات، بدا للجميع أن "وكلاء" إيران من
قادة المليشيات ذهبوا صوب توجّه معاكس، عندما اتهموا "مفوّضية
الانتخابات" بتزويرها، بالتنسيق مع قوى خارجية، ونظّموا حركة احتجاجاتٍ
وعصيانٍ في بغداد ومحافظات أخرى، معبّرين بذلك عن نزقٍ سياسيٍّ يكمن
وراءه شعور بالخطر، والخوف من فقدان سلطتهم، سرعان ما تُرجم في جملة
مطالب مرتبكة ومحدودة الأفق، تراوحت بين تنحّي مصطفي الكاظمي عن رئاسة
الحكومة ومحاكمته، (وإحلال فائق زيدان رئيس الجهاز القضائي محله، على
أن يجري انتخابات خلال ستة أشهر، بأمل إيصال أكبر عدد من مرشّحي
المليشيات الى البرلمان) والاكتفاء بمحاكمة أعضاء مفوضية الانتخابات،
المتهمين بالتزوير وإعادة الأصوات "المحجوبة" الداعمة لبعضهم. وأصاب
الخبل بعضهم حد التهديد بقصف دولة الامارات بالصواريخ، لتدخلها في
الانتخابات (!)، وقد وقفوا على أبواب "المنطقة الخضراء" لفرض تنفيذ
"السيناريو" الذي رسموه، والذي هناك من اعتبره بدايةً لإسقاط الدولة،
ووضع القرار السياسي بيد المليشيات، وهذا ما تعوّل عليه طهران كثيرا،
على الرغم من موقفها المعلن في بيان التهنئة والتبريك الذي انكشف كونه
نوعا من ممارسة "التقية" والتظاهر بعكس ما تريده. وعلى أية حال، فقد
قوبلت تلك الطروحات من المواطنين العاديين بنوع من الإهمال والتجاهل،
وربما التنديد أيضا، وهذا ما عكسه موقف زعيم التيار الصدري، مقتدى
الصدر، الذي وصفها بأنها "تجرّ البلاد إلى الفوضى وتهدّد السلم الأهلي"!
زعمت قيادة هيئة الحشد الشعبي أنه لا يتدخل في الأمور السياسية، ومهمته "حماية النظام الديمقراطي" فقط
وفي خضم موجة ردود الأفعال المتشنّجة، بدت قيادة "الحشد الشعبي" على
شيء من المكر عندما تنصلت من "السيناريوهات" المطروحة، إذ زعمت، بلسان
رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، أن الحشد لا يتدخل في الأمور
السياسية، ومهمته "حماية النظام الديمقراطي" فقط!
وهكذا تستمر اللعبة صعودا وهبوطا، ويستمرّ اللاعبون في إدارتها، وقد
اكتسبوا الخبرة في تطويع من لم يطوّع بعد، ومن ورائهم قوى خارجية تهدف
إلى حماية مصالحها، عن طريق إعادة إنتاج "العملية السياسية" الماثلة،
والعمل على تدوير الزوايا بأقل قدرٍ ممكن من الخسائر، مع تجنّب خوض
الصراعات بطريقة المواجهة المباشرة، وإن كان ما ينتج سيكلف العراق
والعراقيين خسائر أكبر وأكثر حدّة، ويمدّ في عمر التجربة الهجينة
القائمة أربع سنوات أخرى، وربما أكثر.
عندما يصبح
الصدر "صانع ملوك"
عبداللطيف السعدون
يريد زعيم تياره في العراق، مقتدى الصدر، أن يقنعنا بأن مهمة حكومته "الأبوية"، كما أسماها، هي تنفيذ البنود التي أطلقها في "خطاب النصر" عشية ظهور نتائج الانتخابات البرلمانية، ومعنى ذلك، لو صحّ، أنه سيشعل شمعةً في آخر النفق الطويل الذي عشنا في ظله عشرين عاماً. ولو فعل هذا حقاً يكون قد انتزع نفسه من غطاء إيران، ونأى بها عن "المليشيات" والأحزاب التي تدين بالولاء لولاية الفقيه، وتلتزم توجيهات طهران. لكن هل يفعلها الصدر، وهو "المجرَّب" مرّات، والمعروف بكثرة تناقضاته وسرعة تقلباته الزئبقية، والمشهور بإعلاناته الإصلاحية "الوطنية" التي يتحدّث عنها في الليل، ويتنصّل منها في النهار؟
ثم، هل يستطيع أن يطوي شعاره عن "تقوية الدين والمذهب"، وهو الشعار "الملغوم" الذي سعى إلى تكريسه عملياً منذ صنع، غداة الغزو الأميركي للبلاد، مليشيا "جيش المهدي" الطائفية التي ولغت بدماء مئاتٍ من علماء وأكاديميين ومهنيين وضباط الجيش السابق؟ ألا يحيلنا هذا الشعار إلى رؤية دينية - مذهبية ضيقة، تُنكر الآخر وتكفّره وترفض حقه في الاختيار. و"الآخر" في العراق متنوّع بحكم طبيعة البلاد التاريخية والجغرافية، وقد جمع الهويات الثانوية المختلفة وطن واحد وهوية موحِّدة (بكسر الحاء)، واختزال هذا التنوع التاريخي في دين أو مذهب يعني "اختزال" الوطن وتقسيمه وتشظيته وإلغاء المواطنة الحرّة المتساوية، ويضع في خانة الخصوم المفترضين كل من يعتقد بدين أو مذهب آخر غير ما يعتقد به الصدر؟
يعد الصدر بتصدّي حكومته للفساد وللفاسدين، وتأكيده على "أننا سنزيح الفساد بدمائنا"، ولكن ماذا عن فساد وزراء التيار الصدري؟
ولكي نوصل الصدر إلى باب الدار، كما كان يقول أجدادنا، دعونا نقرأ بعض ما ورد في "خطاب النصر"... يبلغنا الصدر أنّ أحد أهداف حكومته القادمة حل المليشيات وحصر السلاح بيد الدولة، وهو أول من حاول أن يشرعن سلطة المليشيات بدايات الغزو الأميركي، إذ أنشأ "جيش المهدي" ثم "لواء اليوم الموعود" وبعدهما "سرايا السلام"، وصولاً إلى "القبّعات الزرق" التي فتكت بثوار تشرين، وقتلت وأصابت العشرات منهم، وفي كل مرّة، يظهر الصدر لينكر ما فعلته تلك المليشيات بالناس، ويلقي المسؤولية على بعضٍ من مقرّبيه ويبعدهم عن حظيرته، لكنه سرعان ما يعفو عنهم بعد حين، ويعيدهم إليها، كيف يمكننا أن نصدّق، إذاً، وعده لنا، وفي ذاكرتنا تلك المشاهد السوداء المخضّبة بالدم، أما كان بإمكانه أولاً أن يبرهن على ذلك عملياً، فيُقدم على حل مليشياته، ويضع أسلحته بيد الدولة؟
أيضاً، يذكّرنا الصدر بحكاية "هيبة الدولة"، معبّراً عن حرصه على إعادتها، وهو واحد ممن سقطت "هيبة الدولة" على أيديهم، وباتت في خبر كان، والشواهد أكثر من أن تُحصى.
وبعد هذا يعدنا بتصدّي حكومته للفساد وللفاسدين، وتأكيده على "أننا سنزيح الفساد بدمائنا"، وماذا عن فساد وزراء التيار الصدري، الصحّة والكهرباء على وجه الخصوص، وقد انتشرت رائحة الفساد في الوزارتين، ولدى هيئة النزاهة بخصوصهما عشرات الملفّات "النائمة" التي لا يمكن لأحدٍ إيقاظها سواه، وقد دعاه مرّة برلمانيون لأن يتحمّل مسؤوليته، فيحاسب وزراءه الذين تورّطوا في عقودٍ أضرّت بمواطنيه، كعقود الكهرباء والأدوية وسواها، لكنه فضّل عدم الرد، وهو يعرف أن "الهيئة الاقتصادية" التابعة لتياره هي التي تتعاقد وتساوم وتشتري وتبيع. وبالطبع، لتياره حصة الأسد، وللآخرين حصصهم بالضرورة!
يسعى مقتدى الصدر عبر "فائض القوة" إلى فرض هيمنته على الفضاء السياسي
هذا كله غيضٌ من فيض، ولا يستطيع مقتدى الصدر أن يُنكره أو يتجاهله، لكنه يغضّ الطرف عنه، منطلقاً من "فائض القوة" الذي كسبه نتيجة اختلال موازين القوى وبروز معادلاتٍ زائفةٍ فرضتها "العملية السياسية" التي اخترعها الأميركيون بعد الغزو واستثمرها الإيرانيون، وساهمت أيضاً في ذلك "شعبويّته" المصطنعة في أوساط فقراء الشيعة الذين ما زالوا بعد عشرين عاماً على ولادة "العراق الجديد" يبحثون عن مقوّمات عيشٍ كريمٍ يليق بالبشر في بلدٍ لا يوفّر لهم سوى مواكب اللطم، والوعد بظهور المهدي الذي يجيء ولا يجيء!
عبر "فائض القوة" هذا، يسعى الصدر إلى فرض هيمنته على الفضاء السياسي، جاعلاً من حميه الصدر الأول (محمد باقر) مرجعاً مقدّساً ليس لأسرة الصدر نفسها فحسب، ولا لفريقٍ من أبناء المذهب الشيعي، لكن للناس كلهم من آمن ومن لم يؤمن، ويتوكأ الصدر على تاريخ أسرته كي يكتسب القداسة التي يريدها ممتدّة له، والتي لا تسمح بخروج أحدٍ على طاعته، كما تكرّس الإيمان به زعيماً دينياً، وأيضاً زعيماً لحركة سياسية وصانعاً للملوك، والمهمة الأخيرة هي التي جنّد نفسه لها اليوم، فهل ينجح في أدائها أم يجد لنفسه مخرجاً في خطابٍ جديدٍ ينسف ما قبله؟
انتخابات العراق ..
إيران الرابح الأكبر
عبداللطيف السعدون
لم يقف العراق، منذ الغزو الأميركي، بعيدا عن جارته اللدود إيران، بل كان، على الدوام، متماهيا مع سياساتها، مذعنا لتوجيهاتها (اقرأ: أوامرها). وكانت من جانبها تطمع بأكثر من ذلك، وتسعى إلى أن يكون العراق تابعا لها، ولم تتردّد في إعلان رغبتها هذه، بل لم تكن تُنكر خططها الشرّيرة تلك، وقد اعتبرت بغداد إحدى عواصمهان كما كشفت متبجّحة أن "الحشد الشعبي" أحد الجيوش التي أنشأتها خارج حدودها الدولية، بهدف حمايتها والدفاع عن مشروعها الامبراطوري. وقد عملت بدأبٍ على استمالة كل رجال الطبقة الحاكمة، ووضعتهم في إمرتها، بمن فيهم من حاول أن ينأى عنها، لكنها استطاعت أن توقعه بشباكها إنْ بالترغيب أو بالترهيب، كما استخدمت الورقة الطائفية، كي تخدع الآلاف من البسطاء والسذّج من العراقيين، وتلحقهم بركابها.
واليوم وقد انقضى ما يقرب من عقدين على الغزو الأميركي للبلاد الذي ترافق مع الهيمنة الإيرانية المباشرة، وإذ يجرّ الأميركيون خيولهم لينسحبوا من أرض العراق، فإن الإيرانيين ينظرون إلى هذه الخطوة أنها نقطة تسجّل لصالحهم، في وقتٍ تشهد فيه انتفاضة/ ثورة تشرين حالة انكفاءٍ، على خلفية عدم تمكّنها من الحفاظ على زخمها الأول، على الرغم من أنها أعطت مئات الضحايا من شهداء وجرحى ومعوقين، وأن هدفها في "استعادة الوطن" استقطب فئاتٍ عريضةً من مواطنيها الذين اكتشفوا فيها ما يعبّد الطريق نحو الخلاص من الاحتلال والهيمنة.
تبلغنا الانتخابات البرلمانية التي جرت الأسبوع الحالي أن ليس في الإمكان التقدّم خطوة واحدة على طريق التغيير الشامل الذي أراده الثوار
وإنه لأمرٌ لافتٌ أن تبلغنا الانتخابات البرلمانية التي جرت الأسبوع الحالي أن ليس في الإمكان التقدّم خطوة واحدة على طريق التغيير الشامل الذي أراده الثوار، وقد آن الأوان للذين راهنوا على قدرتهم على الفعل، وشاركوا في لعبة "صناديق الاقتراع"، أن يدركوا أن "وكلاء" إيران ركبوا الموجة، وحوّلوا مطلب "الانتخابات المبكّرة" الشعبي إلى خطة عمل لإعادة إنتاج "العملية السياسية" التي جاء بها الأميركيون، مع بعض التشذيب الذي تتطلبه المرحلة، وكان أن هندسوا وخطّطوا وتابعوا وأشرفوا على "الطبخة الانتخابية"، كي يضمنوا بقاء سيطرتهم على مواقع السلطة والمال والقرار أربع سنوات أخرى، وقد جنّدوا أتباعهم ومريديهم كي يحكموا الطوق. وهكذا استطاعوا، وفي غياب مشروع وطني فاعل، أن يوصلوا إلى قبة البرلمان الوجوه الكالحة نفسها التي سامت مواطنيهم سوء العذاب، وحرمتهم من أبسط مقوّمات الحياة الكريمة، وباعت سيادة البلاد لقوى خارجية، على حساب استقلال البلاد وحرية أبنائها، وحقّقت "الصناديق" لإيران ما كانت تحلم به، وقد أصبحت "الرابح الأكبر" على حساب العراق والعراقيين.
وهكذا ضاقت النازلة واستحكمت حلقاتها، ولم يأتها الفرج، لا من هذا الطرف ولا من ذاك، ولم تعد لعبة "صناديق الاقتراع" ذات جدوى لحل أزمة النظام، ولتفكيك "العملية السياسية" التي استقوت بحكم الهيمنة الإيرانية على مؤسسات الدولة ومقادير الناس، وتأكّد نفاذ بصيرة "المقاطعين" الذين رأوا أن من المحال حدوث تغييرٍ في ظل المعادلات التي فرضها نظام الاحتلال والهيمنة.
التغيير المطلوب لن يأتي من تلقاء نفسه، وحتى أشكال التغيير التقليدية التي بشّرت بها "الأيديولوجيات"، فإنها لم تعد قابلةً للرهان
هنا يتكرّر طرح السؤال التاريخي البسيط: ما العمل اذن، وهل هناك ما يوحي بأن ضوءا، ولو خافتا، سوف ينبثق في آخر النفق، بما يمكن أن يشيع الأمل بأن التغيير قادم حتما، وإن طال انتظاره؟ ثمّة حقيقة لا تقبل النقاش، أن التغيير المطلوب لن يأتي من تلقاء نفسه، وحتى أشكال التغيير التقليدية التي بشّرت بها "الأيديولوجيات"، فإنها لم تعد قابلةً للرهان، والعمل المسلّح في بلد مثل العراق، وفي ظل أوضاع دائمة السيولة على المستويين، الإقليمي والدولي، لا يمكن أن يكون خيارا عمليا بعدما اختلط بمفهوم "الإرهاب"، وتوغلت امتداداته في حروب الطوائف. ولكن لنا أن نتعلّم من المفكر الباراغواني، إدوارد غاليانو، أن الأرض واعدةٌ دائما بأشكال وصيغ جديدة للتغيير لم نألفها من قبل، ولم تعرفها مخيلتنا قط، حيث "التاريخ يتقدّم مع خطو أقدامنا، لكنه يمشي أحيانا ببطء، وقد لا يأتي التغيير من أعلى، إنما قد يأتي من الأسفل، وسوف يجد طريقه عاجلا أو آجلا، وبالسرعة التي يرتئيها. إنه يولد على خطوات أقدامنا".
هكذا، إذن، يمكن أن يتغيّر العراق بشرط أن نضع خطواتنا بثباتٍ على الأرض، فالسماء لا تمنح بركاتها جزافا، والنازلة التي حلّت بنا واستحكمت حلقاتها، ولم يأتها الفرج، لا تزول بدعائنا فقط، إنما بعملنا أيضا، ولا يساعد الله الذين لا يساعدون أنفسهم.
عن "زوبعةٍ" لم تهدأ بعد
عبداللطيف السعدون
سبع مقاربات لافتة فرضت نفسها على خلفية مؤتمر أربيل الداعي إلى التطبيع مع إسرائيل تستدعي إمعان النظر. أولاها أن اثنين راودتهما فكرة هذا المؤتمر ووضعا خطّته، حيمي بيريس، ابن الرئيس الإسرائيلي الأسبق شمعون بيريس، وهو يدير "مركز بيريس للسلام والابتكار" الذي أسسه والده بغرض "ضمان قيادة إسرائيل كقوة تكنولوجية ذات قيم (...) وبناء جسور السلام" وجوزيف برود، يهودي من أصل عراقي، يدير "مركز اتصالات السلام" ومقرّه نيويورك. طبخا فكرة المؤتمر، في ما يبدو، على نار هادئة، لم يصل دخانها سوى إلى من شارك فيه، و"أعلن بكل قوة وضمير أنه راغب في الدخول في إطار السلام الإبراهيمي، بما فيه السلام الشامل مع إسرائيل"، والتعبير لبرود نفسه. ومنطقيا، لم يعمل الرجلان وحدهما في التحضير لهذا المؤتمر، إذ من الطبيعي أن يكون هناك طرفٌ أو أطرافٌ عراقية فاعلة قد شاركت، لكنها فضّلت أن تبقى في الظل، في الوقت الحاضر على الأقل.
ومقاربة أخرى، أن المؤتمر رفع شعار "السلام والاسترداد"، وإذا كانت مقولة "السلام" معروفة المعنى والهدف، فان كلمة "الاسترداد" تشي بغموض مقصود لتغطية الدعوة الى التطبيع.
رفع المؤتمر شعار "السلام والاسترداد"، وإذا كانت مقولة "السلام" معروفة المعنى والهدف، فان كلمة "الاسترداد" تشي بغموض مقصود لتغطية الدعوة الى التطبيع
ومقاربة ثالثة، إعلان الناطقة باسم المؤتمر، سحر الطائي (باحثة في وزارة الثقافة)، وعلى نحو صارخ، أنه "لا يحق لأية قوة، سواء كانت محلية أم خارجية أن تمنعنا من إطلاق هذا النداء". والمعنى الذي يحمله هذا الصراخ أن جهة تشكّل مصدر قوة وفعل وحماية تقف وراء كل هؤلاء "المطبّعين"، وأن الأيام المقبلة ستكشف ما هو مستور الآن!
ومقاربة رابعة، ظهور أحد قادة "الصحوات" التي أنشأها الأميركيون في مواجهة المقاومة الشعبية للاحتلال في المؤتمر، وسام الحردان، ودعوته إلى "الانضمام إلى اتفاقات إبراهيم والتطبيع مع إسرائيل" وإعلانه تراجعه، في اليوم التالي، قائلا إن الكلمة التي ألقاها كتبت له، ولم يكن يعرف مضمونها، واصفا التطبيع بأنه "متروك للحكومة" وأنه يدعو فقط إلى إعادة الجنسية لليهود العراقيين التي سحبت منهم في حينه!
ومقاربة خامسة، في ظهور علامات استفهام تخصّ تورّط دولة الإمارات في دعم المؤتمر، ومشاركتها "الناعمة" في التحضير له. وبالطبع، إسرائيل هي الداعم الأكبر، ومعها الولايات المتحدة.
علامات استفهام حول تورّط دولة الإمارات في دعم المؤتمر، ومشاركتها "الناعمة" في التحضير له
والمقاربة الأخيرة التي قد تُجهض أية خطوة لاحقة يحلم بها الداعون إلى التطبيع هي ردود الأفعال على المستوى الشعبي، الرافضة والمستنكرة، والتي امتدت لتشمل مسؤولين حكوميين وسياسيين وقياديين في أحزاب السلطة وشيوخ عشائر، لكن موجة رفض "رجال السلطة" مرّت، في البداية، على استحياء، ثم تصاعدت وتيرتها بفعل الضغط الشعبي، متوعدة، وداعية إلى فرض عقوباتٍ على كل من خطّط أو شارك أو حضر. وعلى هامش موجة التنديد والشجب هذه، تبودلت الاتهامات بين هذا الطرف وذاك، ووصلت إلى حد أن نائبا سابقا فضح ما سماها "وثيقة"، قال إنها طرحت، في مؤتمر لندن السيئ الصيت الذي عقده معارضو صدّام حسين في العام 2002، تعهّد الموقعون عليها بتبنّي فكرة الصلح مع إسرائيل مقابل إقدام الولايات المتحدة على وضعهم على رأس النظام الجديد. وأورد أسماء 87 ناشطا معارضا، قال إنهم وقّعوا على الوثيقة، ومعترفا أنه كان واحدا منهم. ووجّه برلماني آخر اتهاما مباشرا لسياسيين قال إنهم زاروا إسرائيل، وبينهم من تعاقد على مشاريع استثمارية فيها، بحسبه.
وعلى أية حال، لنا أن نسجل "فضيلة" واحدة على الأقل لمؤتمر أربيل، أنه حفّز ناشطين سياسيين ومثقفين للعمل على عقد مؤتمر مضادّ يؤسّس لمنصةٍ تظل في حالة انعقاد دائم لمناهضة التطبيع، وإجهاض كلّ توجّه يهدف إلى الصلح مع العدو، والتضامن مع أبناء فلسطين الذين يناضلون من أجل تحرير أرضهم، كما كان مناسبةً لأن تستعيد الذاكرة ما سطّره العراقيون من صفحاتٍ على امتداد تاريخهم الحديث في دعم قضية فلسطين ومساندة أهلها.
وسواء أراد مرتكبو "زوبعة" التطبيع من العراقيين الحصول على رضا جهاتٍ تضمن لهم الربح "الحرام"، أو كان الهدف مجرّد جسّ نبض من بيده القرار، أو معرفة الشعور العام لدى الناس العاديين، فإنّ الجهات الفاعلة، صاحبة الفكرة والتخطيط، لن تتخلّى عما تريده بسهولة. ومن المتوقع أن تقدم على خطواتٍ أكبر وأكثر، وهذا ما أراد أن يقوله وزير التعاون الإقليمي في حكومة إسرائيل، عيساوي فريج، الذي قال، في تصريح لافت له، إنّ العراق سيكون الدولة التالية التي قد تطبّع علاقاتها مع تل أبيب.
هذا كلّه يستدعي الحذر والترقب.
عن "نكتة"
استرداد الأموال المنهوبة
عبداللطيف السعدون
ليس ثمّة غرابة في أن يثير "مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة" الذي احتضنته بغداد قبل أيام كل هذا الفيض من التعليقات الساخرة، والنكات اللاذعة الطريفة، في مواقع التواصل، وعلى ألسنة العراقيين الذين وجدوا فيه مادة للتندّر وقضاء الوقت، وسط فصل طقس حار طال مكوثه عندهم، كما ليس ثمّة غرابة في أن يتصرّف "حيتان" الفساد الكبار، وكأن الأمر لا يعنيهم، إذ يتسابقون على الترحيب بالمؤتمر، وفي إزجاء طروحات وحلول لما يرونه مناسباً لأحوالهم ولذرّ الرماد في عيون "الحسّاد" الذين يلاحقونهم، ومنهم من حضر بعض جلساته، مصغياً ومتابعاً بحرارة، ومطمئناً لما يمكن أن يسفر عنه، في حين أن "المؤتمر" لم يكن أكثر من "نكتة" موسم طازجة بامتياز، وقد لحق بسلسلة مؤتمرات "علاقات عامة"، ابتكرها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، جديدها "مؤتمر قمة بغداد لدول الجوار" الذي دخل التاريخ الميت، كما مؤتمرات قبله. ولكن فضيلة واحدة تظل لمؤتمر اليوم؛ أنه كشف حجم الأموال المنهوبة من العراق طوال عقدين، والتي قدّرها تقرير رسمي من داخل المؤتمر بثلاثمئة وستين ملياراً من الدولارات، فيما يقول خبراء ماليون معنيون إنها تصل إلى أكثر من تريليون دولار، وهو ما يساوي ميزانيات دول عديدة. ووصفت "تغريدة" ساخرة على موقع "تويتر" المؤتمر بأنه أحد إنجازين مهمين، اقترفهما الكاظمي في الأسبوع الأخير. الثاني اجتماعه المفاجئ مع المطرب حسام الرسام، حيث كلّف الأخير بإنجاز أغنية لدورة كرة القدم الخليجية التي تستضيفها البصرة العام المقبل.
أشكال مبتكرة لنهب المال العام لا يمكن رصدها أو التثبت من مجرياتها، كونها تعتمد على فتاوى "شرعية"
إشارة لافتة برزت في جلسات المؤتمر، وهي الإعلان عن نجاح هيئة النزاهة في استرداد ما يقرب من أربعين مليون دولار من الأموال المنهوبة، أي ما يساوي قطرة صغيرة في بحر هذه الأموال. ما يعني أن ما استردّ هو ما نهبته "حيتان" صغيرة لا حول لها ولا طول، أما "الحيتان" الكبيرة، وهي معروفة ومشخّصة، فقد ظلت خارج المساءلة القانونية، وإذا ما جرى الحال على هذا المنوال، وحتى لو خلصت النيات، فإننا نحتاج عقوداً، ربما قرناً، كي نسترد المال كله، وقد ألقت الحكومة بفشلها في هذا الجانب على "عدم توفر تعاون دولي"، ودعت إلى تكوين "جبهة ضاغطة على المجتمع الدولي" لاسترداد ما نهب.
إشارة لافتة أخرى من "هيئة النزاهة" أنها أصدرت ما يقرب من ثلاثمئة أمر قبض واستقدام بحق وزراء ونواب وذوي درجات وظيفية خاصة، إلا أن هذه الأوامر لم تفعّل بحكم امتلاك بعضهم "الحصانة" التي توفرها لهم مناصبهم، أو لأن بعضهم الآخر يتمتّع بحماية مليشيات أو أحزاب معينة، لا تمكّن حتى رجال القانون من الاقتراب منهم.
تظل طامة كبرى، وهي أن هناك أشكالاً مبتكرة لنهب المال العام لا يمكن رصدها أو التثبت من مجرياتها، كونها تعتمد على فتاوى "شرعية"، تضمن للفاعلين الحرية التامة في وضع اليد عليها والتصرّف بها، لأن "المال العام مجهول المالك وليس له صاحب، وشرعية التصرف به بوضع اليد عليه ودفع الخمس للمرجع". وقد استغل بعض ولاة الأمور تلك "الفتاوى" المزعومة في ترتيب عمليات مشبوهة، لتهريب كميات من النفط إلى خارج البلاد، وبيعها في السوق السوداء، أو الاستحواذ على واردات المنافذ الحدودية، وتردّدت أسماء أحزاب ومليشيات وشخصيات سياسية كونها تقف وراء تلك العمليات.
يمكن استرداد معظم ما نهب من مال، عبر تفعيل قانون الكسب غير المشروع، ورفع الحصانة عن الرؤوس التي تدير عمليات الفساد والإفساد
أما القضاء العراقي فقصته قصص، وليس قصة واحدة، فهو تابع، بحكم الأمر الواقع، لمشيئة السياسيين النافذين، ويعمل وفق مبدأ "إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد"، ألم يأتكم خبر القاضي الذي حكم على الطفل مصطفى وجدان بالسجن لسرقته أربع علب مناديل ورقية، فيما برّأ ساحة "حيتان" كبار سرقوا الملايين؟ أما سمعتم بحيتان آخرين حامت حولهم الشبهات في عقود توريد السلاح، والكهرباء، وجولات التراخيص النفطية هربوا خارج البلاد، وحكم على بعضهم غيابياً، ثم عادوا معزّزين مكرّمين بموجب قرارات عفو، وعفا الله عما سلف؟
هنا تطل الحقيقة برأسها بلا مؤتمر وبلا بطيخ، وبلا تكاذب متبادل بين اللصوص وحُماتهم من أحزاب ومليشيات ومافيات. هنا يمكن أن تدقّ الأجراس، وبخطوات بسيطة سريعة ومعلنة، يمكن استرداد معظم ما نهب من مال، عبر تفعيل قانون الكسب غير المشروع، ورفع الحصانة عن الرؤوس التي تدير عمليات الفساد والإفساد، وتشكيل هيئات قضائية مستقلة، لإنجاز هذه المهام في مدّة محدودة، ووفق ضوابط قانونية تحقق العدل، ولا تظلم أحداً.
ومن دون ذلك، سنظل نسمع جعجعةً ولا نرى طحناً!
حاشية في
انتخابات برلمان العراق
عبداللطيف السعدون
لا يختلف اثنان من العراقيين، إذا استثنينا حفنة رجال الطبقة السياسية الحاكمة ومريديهم، في إدراك أن لا شيء جذريا سوف يتغير بعد العاشر من الشهر المقبل (أكتوبر/ تشرين الأول)، موعد إجراء الانتخابات البرلمانية الموعودة، وأن "غودو" لن يجيء. وسوف يبقى الحال كما الآن، لأن الذين يعيدون إنتاج "العملية السياسية" الماثلة جاثمون على صدورنا على مدار الساعة، مثل حجارةٍ صلبةٍ لا تتعرّض للتفتيت، لمجرّد أننا نضرب عليها برفق. لكن ما دمنا في الأيام القليلة التي تسبق الحدث، فلا بأس من أن نضع أيدينا، مرة أخرى، على الجراح التي أدمت قلوبنا وعقولنا عقدين، وأن نضع بعض الأفكار والملاحظات، ليس أمام من يدرك حقائق المرحلة ويعرف أبعادها، بل أمام الرؤوس التي لا تزال تُحسن الظن بنيات رجال الطبقة الحاكمة. وحسن الظن في هذه الأيام معجزةٌ لا يمكن اجتراحها بسهولة. وقد نصحنا، في سالف الأزمان، الطغرائي صاحب "لامية العجم"، بعدما عاش أياما صعبة مثلنا، نصحنا أن لا نظن خيرا بالأيام، إنما نظن بها شرّا، ونكون منها على وجل!
وإذ تابعنا سجالات ووجهات نظر ظهرت في صحف وفضائيات ومواقع تواصل، ورصدنا ما تفوّه به من يدين بالولاء لهذا الحزب أو تلك المليشيا، أو من هو مرتبط بذاك "الزعيم" أو حتى من "ناشطين" مزعومين أو "محللين" يدارون لقمة عيشهم، لم نلمس ما يشكّل خيط أمل في أن يفكّر أحدٌ من رجال الطبقة الحاكمة أو اللائذين بها من العمل على تغيير الحال الذي يعاني منه مواطنوهم، أو أن يسعى إلى إيقاد شمعةٍ في آخر النفق الطويل، أكثر من ذلك ذكّرنا مسلكهم الشائن هذا بالمقولة السوداء التي أطلقها إبّان ولايته الأولى، نوري المالكي، زعيم حزب الدعوة، أن "ما ننطيها"، أي أننا غير مستعدّين للتراجع عن مبدأ "القبض على السلطة"، وسنعضّ عليها بالنواجذ. وقد استقرّت تلك المقولة في أذهان كل رجال الطبقة التي حكمت العراق عقدين، بمن فيهم من رفع شعارات "وطنية" أو أقام مؤتمراتٍ "تاريخية"، لتغيير الحال، ثم نراه وضع ذلك كله وراء ظهره، وكشف عن حقيقة أمره عند صياح الديك، باحثا عن بقايا موائد من كان خصما لهم.
أمرٌ محبط أن نرى الازدراء اللامتناهي من رجال الحكم للإرادة الشعبية التي طالبت بالتغيير الجذري والشامل الذي يُنقذ البلاد
وإنه لأمرٌ محبط أن نرى هذا الازدراء اللامتناهي من رجال الحكم للإرادة الشعبية التي طالبت بالتغيير الجذري والشامل الذي يُنقذ البلاد، ويستعيد الوطن الذي اغتصبه الأفّاقون واللصوص وسدنة الأجنبي، وأن يلتفّ هؤلاء حول مطلب "الانتخابات المبكرة"، ليفرغوه من معناه، ويحوّلوه إلى سلاح بأيديهم، مع أنه واحد من حزمة مطالب متكاملة، طرحها الحراك الشعبي الذي دعا إلى حكومةٍ انتقالية، تتولى محاكمة قتلة الثوار، وحصر السلاح بيد الدولة، وحل المليشيات، ومكافحة الفساد، ووقف نهب المال العام، وإطلاق سراح المعتقلين والسجناء السياسيين، وتوفير الخدمات العامة، والتحضير لانتخابات مبكّرة، نزيهة وشفافة وحرّة، لكن تلك المطالب انحسرت عن ذاكرة كثيرين. وفي مقابل ذلك، وجدنا إصرارا على ادامة الحال، والسعي إلى إعادة إنتاج "العملية السياسية" الطائفية التي شرعنها الأميركيون، واستثمرها الإيرانيون في فرض هيمنتهم. وسمعنا مزاعم متحدّية أنه إذا كان هناك من يريد إسماع صوته وعرض مطالبه، فعليه أن يشارك، وأن يعطي صوته لمن يشاء، مساهما في إرساء لبنةٍ في ما يسمونه "البناء الديمقراطي" الذي هو غير موجود أصلا. وهذا نموذجٌ لتبريرات واهية، وخدع مضللة، غرضها تكريس الوضع الحالي، وإعادة إنتاجه مع بعض الرتوش والأصباغ التي تضمن إضفاء "صدقيةٍ" كاذبةٍ قد تملأ عيون بعض من يراقب من معنيين إقليميين ودوليين، وحتى من "مواطنين" بسطاء، يقترفون معجزة حسن الظن بأيامهم التي أورثتهم النكد والمرض وسوء الحال. والمثال القريب عن انخداع معنيين "دوليين"، جينين بلاسخارت، ممثلة الأمم المتحدة في العراق التي لعبت دورا "هجينا"، عندما أعطت دعمها العملية الانتخابية، اعتمادا على وعود زائفة لمسؤولين، مع أنها كانت تحدّثت أكثر من مرّة عن اشتراطاتٍ ينبغي أن تتوفر لجعل العملية إياها "نزيهة وشفافة وعادلة"، وهي تعرف، وهذا من واجبها، أن الحد الأدنى من "النزاهة والشفافية والعدالة" لم يتوفر، ولن يتوفّر، ما دام القابضون على السلطة فيهم الخصام، وهم الخصم والحكم.
وهكذا يكتمل بناء "السيناريو" الذي سوف يبقينا في قعر الهاوية سنواتٍ أربعا أخرى، إلا إذا انقلب السحر على الساحر..، من يدري.
وزير صدّام الذي
سُجن بقرار إيراني
وضعت أميركا، عندما قرّرت غزو العراق، لطيف نصيف جاسم، الوزير الأقرب إلى صدّام حسين في التسلسل (18) في قائمة الـ55 المطلوبين لديها، ويمثلون الصف الأول من رجال صدّام، واعتبرت اعتقالهم أولوية قصوى. وأظهرت صورته على ورقة اللعب (10) لتعريف جنودها به، وقد اعتقل بعد شهرين من الغزو. وعندما هيمن الإيرانيون على القرار الأمني في عهد حكومة نوري المالكي الأولى، وكان لقاسم سليماني، المشرف على الملف العراقي في القيادة الإيرانية، الدور الرئيس في التأثير على قرارات المحاكم العراقية، بالأخص التي تتعلق برجال صدّام الذين تنظر إليهم طهران بعداء وحقد، كان نصيب لطيف نصيف جاسم أن يُحكم بالسجن مدى الحياة أمام محكمة خاصة، بتهمة "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية" مع أنه حُكم أولا بالبراءة "لعدم توفر الأدلة". وقد تعرّض لتعذيب شديد ومعاملة قاسية 18 عاما في "سجن الحوت" السيئ الصيت، وسبّب له ذلك جلطات عدة، وكذلك فقدان النطق وعدم القدرة على الحركة، ولم ينل رعاية طبية تذكر سوى في أيامه الأخيرة، إذ استجاب رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لمناشدة أبنائه بضرورة توفير رعاية له، لكنّ القدر شاء أن يرحل لطيف نصيف جاسم إلى جوار ربه، وهو في وضع مأساوي لم يفد معه نُطُس الأطباء.
ويتذكّر بعض معارفه أن أحدهم سأل مسؤولا عراقيا، في جلسة خاصة قبل أكثر من عام، عن إمكانية إطلاق سراحه بعد كل تلك المعاناة، وكان رد المسؤول أنّ "قرار بقاء لطيف نصيف جاسم في السجن ليس قرارنا"، وعُرف عندئذ أنّ القرار إيراني، وأنّ طهران ناقمة عليه، وعلى آخرين مثله من رجال صدّام، ما زالوا في السجون.
حين سأل أحدهم مسؤولا عراقيا عن إمكانية إطلاق سراحه بعد كل هذه السنوات، كان الرد أنّ "قرار بقاء لطيف نصيف جاسم في السجن ليس قرارنا"، وعُرف أنّ القرار إيراني
والسؤال هنا عن "الرمزية" التي امتلكها هذا الوزير، وجعلت الإيرانيين يضمرون له كل هذا الحقد، ولم يطيقوا بقاءه حرّا طليقا، حتى وهو في آخر أيامه، مع أنه لم يرتكب جرما يطاوله القانون، لكن ما هو معروف أن طهران تنظر إليه أنه المسؤول الأول عن قيادة "جيش" من الأدباء والفنانين والمثقفين، زجّهم في حملات إعلامية ساهمت في إشاعة الوعي لدى جماهير واسعة من العراقيين، وتعريفهم بطبيعة الصراع بين إيران والعراق، ورؤية "الثورة الإسلامية" المذهبية المتطرّفة التي ظهر مشروعها العرقي إلى العلن في مرحلة لاحقة. ويسجل هنا نجاح لطيف نصيف جاسم في إرساء منهج للإعلام العراقي في مرحلة صعبة ومعقدة، هي مرحلة الحرب التي دامت أكثر من ثماني سنين، وإنْ شابت ذلك المنهج أخطاء عديدة، وبعضها فادح، ومنها التوكؤ على مروياتٍ تاريخية مريضة، لم تسلم من الشد والجذب.
لطيف نصيف جاسم، وبغض النظر عن اعتراضات بعضهم عليه، وعلى منهجه في إدارة ماكينة الإعلام العراقي في حينه، أو حتى على تمسّكه بطروحات صدّام ودفاعه عنها، لم يكن وزيرا تقليديا بالمفهوم المتعارف عليه، فقد كان شخصية شعبية، وهو القادم من الريف، لكنه استطاع أن يتفاعل مع ما يحيط به من مؤثّرات صقلت شخصيته، وأمدّته بكثير مما يحتاجه، كي يتقدّم في إدارة المؤسسات الإعلامية والثقافية، معتمدا على مجموعة من المثقفين والأدباء الذين عملوا معه طوال سنوات الحرب، وبينهم من لم يكونوا "بعثيين". وكان نتاج تلك المرحلة مزهرا، مهرجانات شعرية، ومؤتمرات أدبية وفكرية، ومعارض فنون، وكتب ومجلات، ومسرحيات وأفلام سينمائية، وغناء وموسيقى، إلى آخر ضروب النشاط الإنساني الذي يؤسّس لمجتمع كان الجميع يحلمون به.
تنظر طهران إلى لطيف نصيف جاسم أنه المسؤول الأول عن قيادة "جيش" من الأدباء والفنانين والمثقفين، ساهموا في بلورة الوعي بطبيعة "الثورة الإسلامية" المذهبية المتطرّفة
والحديث عن مسيرة الوزير جاسم يجرّنا إلى ثبيت حقيقة أنه ليس سوى واحد من عشرات من مسؤولي نظام صدّام وعسكرييه، كتب عليهم أن يقضوا حياتهم في السجون، ومثلهم آلاف من الناشطين السياسيين المعارضين للهيمنة الإيرانية الذين حُكم عليهم بقراراتٍ جائرة، وآن لهم أن ينالوا حريتهم، وأن يشملهم عفو عام، خصوصا إذا كان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي يريد فعلا أن يؤسّس لوضع جديد، كما وعد أكثر من مرة، وأن يُجري انتخاباتٍ حرّة ونزيهة حقا، ومفتاح أيّ عملية سياسية ديمقراطية هي العفو عن الخصوم السياسيين، ومنحهم حريتهم في العيش في بلدهم بكرامة وأمان، وحتى السماح لهم بممارسة العمل السياسي. نقول هذا ونحن ندرك أن الكاظمي لا يمكنه الخروج على "الإملاءات" الإيرانية التي تفرضها هيمنة إيران الشريرة، وفق مبدأ "الأمر الواقع"، وكصفحة من صفحات مشروعها الطائفي العرقي الإمبراطوري، لكن لا شيء يدوم أبدأ.
ما قبل مؤتمر بغداد وما بعده
لم يعد سرّا أن فكرة عقد مؤتمر إقليمي في بغداد لم تكن في الأساس مبادرة شخصية من رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، كما قيل في البداية، إنما هي فكرة أميركية، أرادت واشنطن من خلالها تأهيل العراق للعب دور قيادي في المنطقة يخدم مصالحها، ويعمل على تجاوز حالة الاستعصاء في العلاقات بين دول المنطقة. وقد يفضي، في قابل الأيام، وعبر مؤتمرات أخرى، الى إقامة "منظومة" إقليمية، تقف حاجزا في مواجهة مخطّطات التغلغل الإيراني في الإقليم. وحرصت بغداد على عدم الإشارة إلى الدور الأميركي في استيلاد المؤتمر، تجنبا لما قد يثيره الخصوم ضدها، لكن "التلميحات" التي تضمنها بيان البيت الأبيض فضحت، ربما على نحو غير مقصود، أن الأميركيين هم من كانوا وراء فكرة المؤتمر التي جرى بحثها مع الكاظمي في أثناء زيارته واشنطن. ونقل البيان مباركة الرئيس الأميركي جو بايدن المؤتمر، كونه "قمة ناجحة ورائدة". كما أثنى على القيادة "التاريخية " للعراق التي توافقت مع الرؤية الأميركية في اعتماد الدبلوماسية في العلاقات الدولية، وفي تبني الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن وبغداد.
اعتبر كثيرون هذه الإشارات بمثابة "تزكية" ضمنية لشخصية الكاظمي الذي كان حريصا دوما على تمييز نفسه عن رجال الطبقة السياسية التي حكمت العراق على مدى 18 سنة، وعلى تقديم نفسه داعية إصلاح وتغيير. ونظّم أنصاره والجيوش الإلكترونية الخاضعة له، قبل المؤتمر وبعده، حملة إعلامية واسعة لترويج شخصيته رجل سلام ومصالحة، ولإشاعة قناعة لدى الآخرين في أنه استطاع، وبجهوده وحده، أن يجعل من العراق "دولة ريادية"، بعد أن كانت "دولة تابعة"، وأن يؤهل بغداد لأداء دورها القيادي المطلوب.
تعمل واشنطن من خلال القمة على تأهيل العراق للعب دور قيادي في المنطقة يخدم مصالحها
وتتوكأ مثل هذه التحليلات القاصرة على وجود رغبة أميركية في إعطاء دور أكبر للعراق في المنطقة، بعدما انحسر هذا الدور عشية الاحتلال. وربما لأن واشنطن، وفي ظل سياسة بايدن، سوف تستكمل سحب جنودها من العراق نهاية العام، وهي مطمئنة إلى أنها وجدت "وكيلا" استراتيجيا في بغداد، يشاطرها الرؤية التي تريد. وهذا "السيناريو" في حال صدقيته مشكوكٌ في جدواه وفي قدرته على الصمود، وأمامنا درس أفغانستان.
هل يمكننا القول، إذاً، من دون مواربة، إن "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة" حالة أميركية، إذا ما صحّ التعبير، وقد تكمله مؤتمراتٌ لاحقة، الهدف منها جمع الأضداد، وترويض من يظلّ ناشزا عن اتباع ما هو مخطط للمنطقة في قابل الأيام وتطويعه، وإرساء صيغةٍ لإطار أمني إقليمي، يتوافق مع مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي اشتغل عليه الأميركيون أمدا طويلا. وقد حضر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ومن ورائه أوروبا وحلف الناتو، المؤتمر ليكون "عرّاب" الصفقة الجديدة التي توفر السلام والأمن والرفاهية لشعوب المنطقة (!!). ولم يكن مصادفةً تعهد ماكرون بإبقاء قواته العسكرية في العراق، انسحبت القوات الأميركية أم بقيت. كما لم يكن مصادفةً أيضا أن يشمل برنامج زيارته الكاظمية وأربيل والموصل، وقد اختيرت هذه المدن الثلاث بعناية، لما تمتلكه كل واحدة منهن من رمزية خاصة، في إطار التنوع المذهبي والعرقي في بلاد الرافدين. وتندرج في "السيناريو" نفسه زيارة جوزيف بوريل، مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، التي ستتم خلال أيام، وهي الزيارة التي ينظر إليها كثيرون نوعا من المساندة للدور الذي يسعى العراق إلى الانخراط فيه بدعم غربي.
لا حل للعراق سوى الاعتماد على مشروع وطني يتجاوز "العملية السياسية" القائمة، ويحاسب شخوصها، ويعيد بناء الدولة
وقريبا من مخرجات المؤتمر وبعيدا عنها، بدا العراقيون غير مهتمين وغير عابئين بما زعم عن نجاحه، وهم مثقلون بهمومهم في البحث عن الأمن والأمان، وفي عدم حصولهم على الخدمات الأساسية، وتفشّي الفساد في كل المرافق العامة، وكذلك في سيطرة المليشيات، وعجز الدولة عن حصر السلاح بيدها، وأيضا في انتشار جائحة كورونا وتخبّط الدولة في مواجهتها، وهم لم يلمسوا من حكومة الكاظمي، ولا من الحكومات السابقة التي أنتجتها التوافقات الأميركية - الإيرانية حلولا واقعية، تصب في خانة إنقاذهم مما هم فيه، وقد سمعوا وعودا ومشاريع وخططا كثيرة، ما إن يعلن عنها حتى تحيلهم إلى كوميديا شكسبير المعروفة "أسمع جعجعة ولا أرى طحنا".
والخلاصة التي خرجوا بها من المؤتمر أن ليس ثمة حل لأزماتهم التي استشرت 18 سنة، غير الاعتماد على مشروع وطني يتجاوز "العملية السياسية" القائمة، ويحاسب شخوصها، ويعيد بناء الدولة، ويستعيد الوطن من مغتصبيه والمهيمنين على قراره
في تذكّر عراق فيصل الأول
قيل إن أحد المقرّبين من مؤسّس العراق، فيصل بن الحسين، اقتُرح عليه أن يبني قصرا يليق به ملكا، أجابه فيصل: "لم أجئ إلى هنا كي أبني قصرا، إنما جئت لكي أبني دولة"... تُستعاد هذه الحكاية، وغيرها من مرويات عن العراق الملكي الذي بناه فيصل بن الحسين في الذكرى المئوية ليوم التتويج، وقد انشغل عراقيون كثيرون بالاحتفاء بهذه الذكرى على مواقع التواصل، وبعضهم غرّد بمناقب عهد الملوك وفضائله، مع أن معظم المحتفين لم يحظ بالعيش في تلك الحقبة من التاريخ بحكم العمر، لكنه يكون قد استوحى مشاهد "الزمن الجميل" مما سمعه أو قرأه. وأيضا لأن الحياة في ظل الجمهوريات لم تُمطر، كما أردنا منها، أمنا وأمانا وحياة رغيدة، حتى جعلتنا نفزع بآمالنا إلى الكذب من هول ما عشناه من أهوال، وما اختبرناه من مصائب وكوارث وحروب، بخاصة في العقدين الأخيرين.
رغم التعقيدات، لم يتراجع عن صناعة الحلول وإيجاد المخرجات الضرورية لتخطي التوترات الداخلية واستيعابها
تؤشّر السيرة المستعادة لفيصل إلى أنه كان يمتلك وعيا حادّا بمشكلات العراق، وبما يحتمل أن ينشأ فيه من صراعاتٍ واختلافات، وكذا بما ينتظر أن تحقّقه الدولة الجديدة، وكان قد اكتسب خبرة ودراية بحكم وجوده في قلب العواصف التي عمّت العالم العربي في حقبة ما بعد الحرب العالمية الأولى، إذ حضر مؤتمر السوريين الأول الذي أجمع على اختياره ملكا لسورية، كما شارك في مؤتمر السلام في باريس، ورشّحه الإنكليز ممثلا للثورة العربية التي تم ترويجها لإطاحة الخلافة العثمانية، وبنى علاقاتٍ وطيدةً مع شخصياتٍ غربيةً نافذةً وناشطين عرب. وأعلن رفضه اتفاقية سايكس بيكو التي قسّمت العالم العربي، وإذ حطّ رحاله في العراق، بدا له أن الأرض العراقية ليست ممهدة على نحوٍ يسهل له فيه من بناء دولة بالشروط التي كانت ماثلةً في ذهنه، حيث واجه جملةً من المصاعب المتجذّرة التي كان عليه تفكيكها. كما وجد تركيبة عراقية ملغمة على وقع عدم توفر "الوحدة الفكرية والملية والدينية" التي تشكّل الأساس لتطور البلد ونمائه، وأدرك أنه يحتاج، في إدارته، إلى سياسيين من نوع خاص "حكماء ومدبرين، وأقوياء مادة ومعنى، وغير مجلوبين لحزازات أو أغراض شخصية أو طائفية أو متطرّفة" كما اكتشف وجود "سواد أعظم جاهل (...) وليس ثمّة شعب عراقي بعد، بل توجد تكتلات بشرية خالية من أي فكرة وطنية، ومشبعة بتقاليد وأباطيل دينية". وقد أفضى إلى وزرائه ورجال حكمه بما يجول في خاطره، واقترح عليهم خطوطا عريضة لما يمكن أن يبني دولةً قويةً ومقتدرة "إنشاء جيش قوي، واحترام تقاليد وعادات السكان والنظر إلى الطوائف بمنظار واحد، وتأسيس مجالس في الألوية والبلديات، واستحداث معاهد لتأهيل الموظفين، والعمل على مشاركة كل السكان في شؤون الدولة". وأعطى مثلا للعمل العام: "أريد أن أرى معملا لنسج القطن، بدلا من دار للحكومة، وآخر للزجاج بدلا من قصر ملكي".
كان يحمل مشروع دولةٍ حديثة، دولة مواطنة وقانون، وقد حقّق هو ومن جاء من بعده خطواتٍ جادّة على هذا الطريق
ووسط كل تلك التعقيدات، لم يتراجع عن صناعة الحلول وإيجاد المخرجات الضرورية لتخطي التوترات الداخلية واستيعابها، وهي التي أخذت كثيرا من وقته، حتى امتدت آثارها إلى عهد ابنه غازي الذي تولى العرش من بعده، ومن بين ذلك قضية الموصل، وغارات قبائل نجد على كربلاء، وتمرّد الآشوريين، واضطرابات الأكراد، ونزاعات العشائر. وعلى صعيد علاقات الدولة الخارجية، عمل فيصل على إرساء دعائم سلام وتبادل منافع بين العراق وجيرانه وأصدقائه، وعندما حاولت بريطانيا أن تبقي على ما يحقّق مصالحها، عارضة شكلا جديدا للانتداب، وقف فيصل في وجه تلك المحاولات، حتى استطاع أن يحصل على حقوق بلاده، وأن يحقق إلغاء الانتداب ودخول العراق عصبة الأمم واعتراف العالم بالعراق دولة مستقلة وذات سيادة. وإذا كان قد أبقى على تحالفه مع الإنكليز، فلأنه كان يؤمن أن العراق محاطٌ بالأعداء والخصوم من كل جانب، وحتى من الجيران الذين يُضمرون له الشر، وأن عليه، وهو في مرحلة بناء دولته، أن يحافظ على علاقته مع بريطانيا لدرء تلك المخاطر.
هذه القراءة المستعادة لسيرة فيصل الأول تظهر لنا بجلاء أنه كان يحمل مشروع دولةٍ حديثة، دولة مواطنة وقانون، وقد حقّق هو ومن جاء من بعده خطواتٍ جادّة على هذا الطريق، إلا أن الانتكاسات التي شهدها العراق في عهود الجمهوريات أعادته إلى المربّع الأول. وها نحن بعد مائة عام، نتعثر في خطواتنا، بأمل أن ننجز مشروع الدولة التي أرادها فيصل، وقد نحتاج زمنا أطول للوصول إلى ما نريد.
