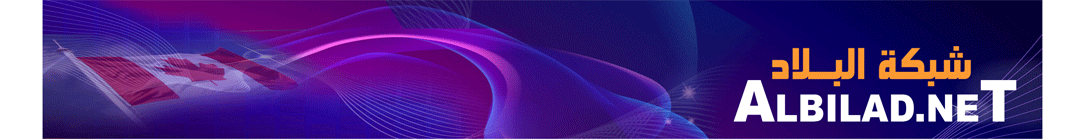

همس القش
سميرة الوردي
الترنيمة الثانية عشرة
الخيمة
الجزء الثاني
حلمٌ... كابوسٌ مضى ... سواءٌ كان ما عشناه يوماً أم دهراً... رحلت كل هذه السنين... ما تحقق لي لم يكن سهلاً... استندتُ وعائلتي على جدار المدينة غرباء... نحاول التخفي من رجال الشرطة ... أغوانا ما يشاع عن الحرية والديمقراطية التي غابت عن بلداننا...ـــــ إنها الهجرة الثانية من البلد الخليجي الجميل، بلد العبورـــــ واستقبالهم لمن يُريد اللجوء... ولكن لابد من التخلص من الجوازات كي تعجز السلطات عن ارجاع من يلجأ لبلادهم... أما نحن فلم يرتضِ الأب التخلي عن جوازاتنا.
إنها الهجرة الثانية، أغوانا البحث عن حياة هادئة مستقرة الى ترك بلد العبور الى عالم جديد يختلف كلياً عن عالمنا.
أسى تبدد من عينيَّ السارحة في وجوه الناس من شتى الملل والنحل، تجمعوا في ساحة جنب محطة القطارات، بعض افترش المصاطب وبعض يتسوقون ويأكلون من محال جميلة أحاطت بالساحة ... وقسم من الصبية تميزتْ شعورهم بقصاتٍ وألوانٍ غريبةٍ ... لو فعلوها في بلدنا لرموا بالحجارة وعوقبوا أو قتلوا... أمور تبدوا مستحيلة قبل وقوعها، رعبٌ... فرحٌ... شرٌ... خيرٌ... أملٌ...حلمٌ... حقيقةٌ... حرب ... سلمٌ، تحياه أجيالٌ وأجيال، قد يكون بينهما فسحةٌ ومتنفسٌ أو لا يكون ... هذا ما حصل بعد الحرب التي خاضتها بلادي ... ما أن أعلن عن انتهاء الحرب بين العراق وإيران، حتى عم فرحٌ لا مثيل له بين مصدقٍ ومكذب... أُطلق الكثير من العيارات النارية التي لم يأت دورها في الحرب، سقط ما تجاوز الثلاث مئة شهيد، عادة قديمة اندثرت في المدن لكنها تحت النظام القائم أُحيتْ من جديد... لم يطل السلم كثيرا ... دخلت البلاد في حرب اقتصادية ضروس، أقسى وأشد سرعةً... الأولى لم تُؤثر كثيراً على الحياة المعيشية للناس، بل فُقد فيها وأعيق الكثير من الشباب... قَتلوا بمقتلهم الحب والأمل في قلوب الناس... أما الهجمة الثانية فأحرقت الزرع والضرع ، وأدخلت البلاد في حصار وحرمان لأبسط متطلبات الحياة.
في دارنا الذي تركناه تركت معه ذكرياتي والتي لم تكن أفضل من ذكريات الطفولة بل أشد معاناةً ... الغيمة السوداء التي عشتها في صباي عندما غدر الغرباء بجدي عادت الى الظهور ، كلما ذهبت وأمي لزيارة قبر أخي الذي ــ قُتل غدراًــ تكون المقبرة قد امتلأت بألاف النسوة المئتزرات بالسواد تسد مداخلها، فلا نجد مجالاً للوصول إلى القبر... في ظروف غامضة قُتل أخي وابن عمتي الصغرى إبان حرب (البوابة الشرقية)كما يحلو لمفتعليها تسميتها ... أمي وعمتي لم تتحملا فراق ولديهما قررتا أن لا ينفصلا لا في الحياة ولا في الموت ،ولذا اشترتا قبرين متجاورين جنب ولديهما... حاولتُ ثنيهما عن مشروعهما المخيف، صعب علي تقبل فكرة موتهما وهما حيتين لكني فشلت... رائحة الموت وصمت المقابر آخر ما كنتُ أُفكر به .
الحياة بعد الحرب تغيرت كثيراً، لم يعد شراء الكتب ميسراً... لم يقتصر غلاء الأثمان على الطعام والملبس فقط، بل شمل كل مناحي الحياة... الجفاف عطل كل القدرات الإنسانية، أصبح الحصول على رغيف الخبز هو الشاغل الأهم.
متاهات زارتني في أحلامي رافقتني منذ شبابي ... أتفاجأ بأحداثٍ تحصل في الواقع صادفتها في ومضة حلم داخلني دون سابق انذار وبلا عوائق ... أطياف العسكر في أحلامي أصبح حقيقة في الحروب التي خاضتها بلادي وأحرقت الأخضر قبل اليابس، وما تلاها كان أعظم وأدهى... السلالم التي أصعد عليها الآن وصولا لشقتي في الخليج، كانت محض كوابيس فيما مضى أستيقظ بعدها لأروي عطشي من جرة ماءٍ نحاسية، احتفظت بها من جدتي، لم تفارقني، اضطررت للتخلي عنها عند هجرتي الثانية.
حياة سار فيها الموت والحياة ظلين متلازمين لم ترجح كفة أي منهما إلاّ َفي فترات متباعدة ... بعد كل تلك السنين حلمت بـ (نظيرة) صديقة طفولتي، التي لم أرها إلاَّ في بلادي عندما ذهبت الى المستشفى لعلاج ابنتي من حصبة أصابتها... التقيت (نظيرة) مسجاة على سرير منزو في زاوية إحدى الردهات ... ناديتها، بصعوبة التفتت اليّ بنظرات يائسة... مستجمعة ذاكرتها تلفظت باسمي... حضنتها، كأن زمان الفراق لم يكن، جاهدة جلست، تبادلنا الحديث، ساعدتها في شرب الماء، ممرضة جاءت ألقت نظرة غضبى عليها، عاملتها بقسوة غير مبررة، طلبت من الممرضة أن تعامل مريضتها بلين ولطف، نهرتني الممرضة ناصحة إياي أن أهتم لتصرفات اختي الرعناء إن كانت حقاً تهمني ... نظرت باستغراب لـ (نظيرة) التي غابت عني عشرين عاماً، تاركة في نفسي الكثير من الحنين ...شعرتْ (نظيرة) بنظرات الاستفهام، فانطلقت تروي لي بعيون ندية دمعها لم يجف... بعد زواجها بثلاث سنوات تدهورت صحة زوجها ولم يمهله المرض، تاركا لها ثروة لابأس بها، تزوجتْ بعد وفاته بسنتين بشاب من الجنوب رحلتْ معه الى مكان عمله، رزقت منه بطفلين، كانت سعيدة بحياتها، أرادا الخروج من المدينة عندما حدثتْ الانتفاضة فلم يستطيعا، التحق زوجها مع الثوار المحاصرين للدفاع عن المدينة، وعندما هزموا اختبأوا في المقبرة، الا أن السلطة حاصرتهم وساوت بعض القبور بالأرض وقتلتْ منهم من قتلتْ وأعدمتْ الباقين وكان هو من بين المعدومين ... صرفتْ كل ما تملك بأسرع مما توقعتْ، مما جعلها تحت وطأة الحاجة فلم تجد سوى السم ملجأ لها ... صرختُ بها : ـ
وأبناؤك ما ذنبهم!!!
انهمرت دموعها تسألني: ـ
هل مرت عليك أيام وليالٍ دون طعام وشراب؟: ـ
أجل فأولادي يقضون ليال طويلة دون طعام حتى اعتادوا على الجوع وأحيانا أقلي لهم ما يتبقى من الخبز اليابس...
سألتني ونظراتها يائسة: ـ
وإذا لم يتوفر لديك حتى هذا؟؟؟
كم من مرة سألتُ نفسي نفس السؤال!!!
وكم من ليال أرقني الخوف من ألا أجد لدي ما يسد جوعهم رغم أني موظفة ولي راتب، وأبوهم معي نحاول تدبير أمورنا، إلّا أن ما يأتينا لا يسد مصروف كم يوم من الشهر...
سألتها: ـ
أين أولادك الآن: ـ
قضوا بضع ليال مع الجيران، وبعد مدة جاء عمهم وأخذهم: ـ
وأين كان العم قبل أن تفعلي فعلتك الشنيعة؟: ـ
منعه خوفه من أن يأخذوه بجريرة أخيه، ولولا خجله من الجيران لتركهم... ومن يدري؟!
انتابتها نوبة قيءٍ حادةٍ اختلط بها الدم، سارعتُ بطلب الممرضة التي ما أن شاهدتْ (نظيرة) على تلك الحالة حتى استنجدتْ بالطاقم الطبي، نقلوها الى غرفة الإنعاش، منعوني من مرافقتها.
ماذا حدث للحياة لتكون بهذه القسوة؟!
ما ذنب الناس ليطحنوا بهذه التعسف؟!
هل لـ(نظيرة) الحق في قتل نفسها؟!
رحلتْ (نظيرة) مع أول المساء...
سألتني الممرضة معتقدة أنني أختها، أن أبعثَ على أهلي، لم أجد سوى جملة واحدة خرجتْ من فمي دون وعي مني ـــ لقد مات أهلنا تحت القصف العدواني ـــ.
الذكريات تثار وتستفز لأبسط شيء وأعظمه ... طقطقة الجمر وهسيسه في النرجيلة على شواطئ بحر الخليج... هدير الأمواج المتدفق من أعماق الخليج المتلألئ تحت ضوء القمر ... ذكرني بقصر عمتي الكبرى على ضفاف دجلة... النوم على سطح الدار في الليالي المقمرة ودجلة أمامي يمنحني شعورا بالتوحد مع الطبيعة، أنام جنب عمتي مستشعرة دفئها وحنانها.
لم أتحمل رحيلها المفاجئ قبل يوم كنت معها لم يبدُ عليها أي مظهر للمرض أو التعب، كان وداعا غير محسوب... تشتتَ شملنا بموت عمتي، وهجرة أبيهم وموته في الغربة ومقتل ابنهم الوحيد لأسباب مجهولة وبيع الدار والارتحال عنه الى الأبد ... رحلوا كما رحلتْ أمي التي قضت اليوم السابق لموتها بفرح لم الاحظه عليها منذ مقتل أخي.
ما الذي دفعني للهجرة، وترك من تبقى من الاحبة، وترك الدار الذي كونته بشق الأنفس ... متنقلة من غربة لأخرى... تداهمني الذكريات والحنين... عافني النوم منذ أن وطأت قدمي أرض الغربة ... وأنا أحدق في ظلام الغابة الدامس، التي أقرب هي للقطب الشمالي... جو متقلب يجمع كل فصول السنة في ساعة واحدة ... ما إن أغمض عيني حتى أستيقظ كأني نمت ُدهراً... لم يأتني هذا الشعور وأنا في أرض الخليج، فحياتهم وعاداتهم مثلنا، ولكنهم أكثر استقراراً وأماناً واطمئناناً... ما أن وطأت قدمي أرض السويد حتى شعرت برغبة قاهرة للرجوع الى شقتي في الخليج أمام البحر... أممكن أن أنام هنيهات تفاجئني كل هذه الذكريات أحملها في شغاف قلبي من بغداد، والتي رحلت دون عودة، ولم يتبق منها سوى عطر الهيل وكأني أشمه للتو... اعتصر قلبي لذكرى أماسي العيد وبالأخص عيد الربيع أو عيد الشجرة... وشوشة عمتي الكبرى وبناتها الأربع وعمتي الصغرى وأمي وبنات عمهن الثلاث بأزهى ملابسهن وزينتهن مجتمعات حول طست كبير يعجن فيه كميات كبيرة من الطحين لعمل (الكليجة وأنواع أخرى من المعجنات والتي نسينا مذاقها وكيفية صنعها فيما بعد)... لكل واحدة منهن هوايتها في صنع نوع معين، فأمي بارعة في صنع (الكليجة) وعماتي يتولين صنع(أُكلْ واشكر الله) أما بنات العم فكن يجدن صناعة (الشكر لمه ولقمة القاضي) ولاينسين صناعة الكيك وخبز الدهن، وعمتي الصغرى مازالت تمارس هوايتها في سرد قصص (الجان والأميرات الحسان) ... ما أن يحل اليوم الموعود حتى تكون ملابس العيد الجديدة جاهزة، تعد صينية كبيرة بأصناف المقبلات والفطائر والبيض الذي يلونونه أخوتي وأولاد عمتي، فهي مهمتهم، وتعد بقية الأطعمة، وينقضي الأسبوع الأول في تبادل الصواني المليئة بالمعجنات والمكسرات وما تشتهيه النفس بين الجيران والأقرباء، وما أن يحل الأسبوع الثاني يجتمع الأقرباء للخروج الى المتنزهات الندية، وقد بدأت أشجار البرتقال تخرج قداحها والأشجار تتبرعم أوراقها.
استيقظت من غفوتي ورائحة الهيل تملأُ كياني، فلم أسمع سوى طنين الماء الحار في الجدران، وليل دامس يبدأ في الحادية عشرة ... هم ثقيل لا يزيله سوى أمل بيومٍ مضى، وانبلاج فجر آتٍ، لا أسمع فيه خفق أجنحة نوارس برية تذكرني بأساطير عمتي عن (سُكنى الجان في جزر الواق واق).
ليال ٍأمضيها أحدق في عمق الغابة السويدية، عليّ أألفها وأتجانس معها ... ولكن هيهات فكثافة الخضرة فقدت بريقها الأول، ولحظة الاندهاش حلّ محله شعور الغربة والضيم مما عشناه ومما أجبرنا على الرحيل... بل انتابني ضجر ويأس منذ أن وطأت قدمي هذه الأرض... وددتُ الرجوع من حيت أتيت.
أمور كثيرة دفعتني للهجرة، حماية الأولاد من مصير مجهول في الوطن، ظننت أن ما فاتهم من الحياة يمكن تعويضه أو تعويض جزء منه.
أيامٌ مريرةٌ حفرت ندوباً في ذاكرتهم، لا يمر يوم في الوطن دون سماع دوي طائرات العدو وصواريخه، حتى تسبب أحدهم في احداث شروخ في جدران البيت، فسبب رعبا لدى الأولاد، بعد أن هدأت فوضى الناس الراكضين في الشارع، علا صوت ابني الصغير باكيا: ــ
أماه لماذا خلقنا الله؟
انبرى أخوه الأكبر يجيبه غير عابئ بما أنوي أن أُجيبه: ـ
ليعذبنا.
رد عليه الصغير باستنكار: ـ
وماذا فعلنا ليعذبنا؟!
الكبير: ـ
لا أدري!
وهل عند موتنا سنحرق كما تقول جدتي؟
الكبير: ـ
يقولون!
الصغير بنبرة باكية: ـ
لماذا نُحرق ألا تكفي هذه الصواريخ لحرقنا؟!
الكبير: ـ
لا تبكي يا حبيبي فنحن دائما مخطئون، قالها ناظراً اليّ بغضب وتحد وخوف... فالحروب التي نشأوا تحت ظلالها خلقت عندهم هوة نفسية لا يمكن تجاوزها.
...
صمت خيم على حوض السفن الذي يقع عبر الشارع الذي تطل عليه الشقة في العمارة التي سكناها في الخليج قبل عام مجتازة خراب الروح والمدن... بقعة جميلة على البحر، أطلُ عليها كل صباح ... تعج بالعمل منذ الساعات الأولى للفجر... النواخذة يهيؤون شباك الصيد في سفنهم الراسية ... يهدأ البحر ويخلو في الظهيرة، عند سطوع الشمس التي تحيل لون الرمل باهتاً... زوارق تنطلق الى عَرض البحر، وأُخرى واقفة ترفرف أعلامها باتجاه الريح، سيارات تقطع الشارع المحاذي للبحر تاركة سكوناً ينسجم واللهيب المتصاعد من الإسفلت، صوت مقرئٍ من جامع قريب يعيد دعاءه... هندي مهلهل الأقدام يسحب خطواته سحباً، باهتةً كهمسةٍ لم تُسمع... ابنتي الصغيرة تنام بهدوءٍ بين الحقيقة والحلم... سابحون على الشواطئ البعيدة يظهرون تارة ويختفون.
ما الذي جاء بي الى هذا المكان الذي لم أسمع به من قبل غريبة متوحدة، لا عمل لي سوى انتظار الأولاد وأبيهم عند انتهاء دوامهم... تنتعش ذاكرتي في كل لحظة وحين لا تريد تركي أحياناً تكون من الوضوح وكأني عشتها للتو ولا كأن سنوات عجاف مرت عليها ... كرنين الهاتف في ذلك المساء الذي ظلَ يرعبني سنوات طوال حتى في غربتي ... جلستُ وأمي على درج الحديقة الخلفية نتسامر، وقد بدأت تتفتح زهرات القرنفل التي زُرِعَتْ حديثاً... طائرات بعيدة جداً في السماء وكأنهما طَيْور متناهية في الصغر بصعوبة لاحظناها قصفت مكاناً بدا بعيداً لنا ورحلت ... فيما بعد عرفنا أن طائرتين إسرائيليتين استهدفت المفاعل النووي وقصفته... لم تمضِ هنيهة على القصف وإذا بأمي تنتفض وكأنها تذكرت شيئاً تحاول ألاّ تنساه:
أخوك منذ ليلة أمس لم يعد، عاد من الجبهة عصراً، وخرج مع أصدقائه كما قال لي ولم يعد؟! وليس من عادته المبيت خارج البيت!!!
: ـ
ألم يتلفن؟؟؟
: ـ
لم تأت ِمنه أي مكالمة ... لابد لي ولأبيك من العودة للدار عسى أن يكون قد عاد... خرجت أمي مسرعة وكأن مساً أصابها... إنه هاجس الأمهات... لم أتركها ترجع وحدها ذهبنا معهما...
لكنه لم يعد ...
أبلغ أبي مركز الشرطة بعد أن عجز بالاتصال به ... قرب منتصف الليل رن تلفون البيت ... كنت قرب التلفون رفعت السماعة وإذا بصوت أجش يؤنبني وكأني ارتكبت جريمة...
: ـ
أين أنتم حتى تتركوا ولدكم هكذا ...
تسلم أبي الهاتف من يدي ... شلني الرعب وكأن موجة كهربائية عاصفة سورت كل جسمي وأسقطتني أرضاً...
لقد قتلوه ...
تناول زوجي الهاتف من يده... وتركنا صارخاً وهو يردد:
لقد قتلوه وانتقموا من ماضيي... لم يكن لنا أعداء ...
بل ماضٍ سياسي ناضل ابي بشعره من أجل حرية البلد وازدهاره... ولكن حزب البعث الذي لُطِخَتْ يده بدماء العراقيين لم يترك الناس بحالهم ولم يراع عمر أبي وتِرْكَه للسياسة منذ زمن...
سُجلت القضية ضد مجهول بالرغم من معرفة القاتل وإطلاق سراحه بعد شهرين وتمشدقه امام المحكمة بأن سلاح الجريمة هدية من (القائد الدكتاتور).
بعد مقتله لم يعد البيت كما كان... كلٍ انزوى لعالمه، حتى جلسات الطعام لم تعد تجمعنا... أمي تُشغل نفسها بالزرع كي تبكي براحتها... كلما أبحث عنها أجدها منحنية تلتقط الأوراق الساقطة الاّ أن دموعها تفضحها ... ولا تجد مفراً من الاعتراف بأن قلبها لم يكف عن الخفقان منذ مقتله... خلا الدار من صوته ومن أغانيه الصاخبة، توزعت تحفه التي جمعها على أرجاء البيت... لتصبح مجرد ذكرى توجع القلب لم يتجاوز الرابعة والعشرين أُختصرت آماله وأحلامه وسنين دراسته بطلقة غادرة حاقدة.
الفزع احتل نفوس الصغار ... الموت الخاطف قد يكون نصيب أي واحدٍ منهم... لم تعد الحروب وحدها تختصر الأعمار.
الخلاص بالسفر لم يعد حلماً، بل صار هاجساً يقوي إرادة الحياة... كم مضى عليّ من الوقت وأنا أحدق في عمق الغابة... تتشكل أمامي في الظلمة وجوه تسرح عينيّ فيها... تضيع في زحمة الحياة ... وجه واحد يبقى ساخراً مني بين كل تلك الوجوه... لا تزيله حلكة الظلام، بل تزيده وضوحاً وسطوعاً... وكأنه يحملني وحدي ما نحن فيه من محن قديمة وجديدة.
ما إن نزلنا من القطار في قلب مدينة مالمو حتى اعتصرني قلبي... ازدحمت الساحة الرئيسية لشبكة القطارات بأناس من شتى الملل والنحل ... لا تربطهم ببعض أية روابط سوى الحرية المباحة للجميع وبحدود القوانين ... استراح بعضهم على المصاطب المنتشرة في الساحة... فهل سنجد خلاصنا؟!
سرنا على أرصفة المدينة... صوت دراجة مسرعة شق سكوننا... مجتمعات يسودها القانون، ولكنها لا تخلو من المارقين... مجتمع تميز بالشيخوخة والهدوء وحب الزهور لا يخلو منها دار أو شقة، في الطريق حديقة غناء خلناها متنزها زين مدخلها بتماثيل مختلفة ومتناثرة كما هي في حدائق دورهم...وإذا بها مقبرة المدينة ... للباصات مواعيد ثابتة بجداول معلقة في كابينة الانتظار... لا يبدوا على الناس ثراء فاحش، بل حياة نُظمت لخدمة الناس.
سرنا متوحدين مع أنفسنا فقد حلت الغربة محل الإلفة والمودة التي ما أن تضعفها ظروف الحياة القاسية حتى تعود ثانية...سرنا صامتين لم نتبادل سوى كلمات عابرة... كل منا تلبسه همه... لم ننظر لبعضنا وكأن هناك من يحصي أنفاسنا... صوت أطفال في الشارع بدد صمتنا... صبين في الثامنة زرق العيون يسيران، يسير خلفهم طفل أسود البشرة لا يربطهم سوى اتجاه الشارع ... الإثنين اغترفا حصى من الرصيف ورمياه على الطفل ذي البشرة الداكنة وركضا... نظرنا باستنكار لبعضنا... نظر ابني الكبير لي ساخراً...عدنا نجتر هموماً لا حل لها...لا بالبقاء ولا بالهجرة.
