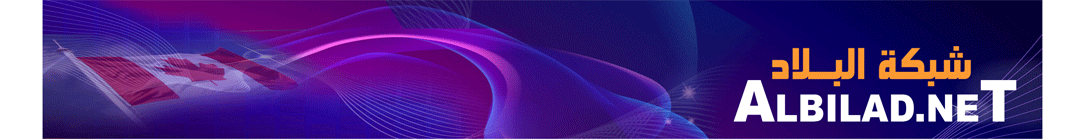
د. فيصل القاسم كاتب واعلامي سوري يكتب اسبوعيا في جريدة (القدس العربي) لندن
لماذا يتهافت الشباب
العربي على «تيك توك»؟
د. فيصل القاسم
ليس هناك شك بأن تطبيق «تيك توك» الصيني الذي يجتاح العالم العربي بشكل
مخيف، لا شك أنه يكسر كل المحرمات والمقدسات بكل أنواعها، وخاصة
الاجتماعية منها، والبعض يعتبره «مزبلة متحركة» لما يحويه من تفاهات
وترهات وسخافات مبتذلة، وهناك من يصفه بأنه أشبه بموقع إباحي لأنه يسمح
بفيديوهات لا يمكن تصنيفها إلا في خانة الإباحيات صوتاً وصورة
اجتماعياً وحتى جنسياً. ولعل الحرية المنفلتة من عقالها تجعل هذا
التطبيق يتفوق على بقية التطبيقات الغربية كفيسبوك وتويتر وانستغرام
وسواها، فبينما تعمد مواقع التواصل الغربية إلى وضع ضوابط صارمة على
متابعيها، يترك التطبيق الصيني الحبل على الغارب لرواده، وخاصة خارج
الصين، فبينما تمنع الصين تطبيق «تيك توك» بنسخته الخارجية داخل
البلاد، تسمح بتطبيق آخر منضبط ويخضع لمراقبة صارمة من الدولة، بحيث
يكون تأثيره على النشء الصاعد والمراهقين والشباب تأثيراً إيجابياً
حسبما تزعم بعض المصادر. وللأمانة العلمية، هذا بحاجة لتأكيد من مصدر
موثوق.
لكن لو بقينا في التطبيق الصيني الذي صدرته الصين للعالم منذ سنوات،
لوجدنا أنه الآن يحتل المرتبة الأولى بين الشابات والشباب العربي، وحتى
الغربي، فقد بدأت أمريكا منذ فترة تحارب ذلك التطبيق بشراسة بحجة أنه
يهدد الأمن القومي الأمريكي، ولا ندري إذا كانت الولايات المتحدة تخشى
فعلاً من التأثيرات الأمنية للمنتوجات الإلكترونية الصينية أم إنها
باتت تخشى من سيطرة التطبيق الصيني على الشباب الأمريكي ومنافسته
لمواقع التواصل الأمريكية؟ وقد لاحظنا في الآونة الأخيرة كيف بدأت
تتسابق بعض الولايات الأمريكية على حظر التطبيق، ولا ننسى أن الرئيس
الأمريكي السابق دونالد ترامب عرض على الصين شراء التطبيق، لكنها رفضت
بيعه، مما حدا بالإدارة الأمريكية إلى البدء بمحاربته على أراضيها.
وإذا كانت أمريكا صاحبة الذراع الإعلامي الأول في العالم وتهيمن على
خمسة وسبعين بالمائة من المنتوج الإعلامي العالمي تخشى من التطبيق
الصيني إعلامياً وثقافياً، فما بالك بالعرب الذين ليس لديهم أي ذراع
إعلامي في مجال التواصل الاجتماعي، وبالتالي هم عرضة لكل أنواع
الاختراقات الإعلامية والثقافية منذ عقود وعقود.
تعالوا الآن نتكلم عن اجتذاب «تيك توك» لملايين الشباب العربي من
المحيط إلى الخليج، فإذا كان الشباب الأمريكي يتسابق على تنزيل التطبيق
والاستمتاع بمواده، وهم لديهم من الرعاية والمناعة والحرية الاجتماعية
والثقافية والإعلامية أضعاف ما لدى الشباب العربي، فكيف إذاً نلوم
المراهقين واليافعين العرب على لهاثهم وراء «تيك توك»؟ ماذا بقي للجيل
العربي الصاعد غير اللجوء إلى تلك التطبيقات المنفلتة بعد أن أصبح
محاصراً في حياته من كل حدب وصوب دون وجود دول حقيقية ترعى أبناءها
اجتماعياً وثقافياً وإعلامياً واقتصادياً وتحميهم وتحافظ على هويتهم
وثقافتهم وتحقق طموحاتهم؟ فلو نظرت إلى العديد من الدول العربية اليوم
وخاصة الفاشلة منها كسوريا واليمن ولبنان والسودان وليبيا والعراق
وغيره، لوجدت أن تلك البلدان أصبحت طاردة لشعوبها وخاصة شبابها، فلو
سألت النظام السوري مثلاً: هل أنت مستعد لاستقبال أكثر من عشرة ملايين
سوري لجأوا إلى أوروبا والدول المجاورة، فبالتأكيد سيقول لك لا، فهو
غير قادر على رعاية الذين بقوا داخل سوريا معيشياً، فما بالك أن يوفر
الرعاية لملايين آخرين، ناهيك عن أنه يعتبر الجيل الصاعد خطراً على
نظامه، فلا بأس من طرده خارج البلاد ومنعه من العودة؟ إن عدد الأنظمة
الطاردة لشبابها يزداد يوماً بعد يوم، لأنها بدل أن تستغل طاقاتهم في
بناء البلد تحاول بشتى الطرق الدفع بهم خارج الحدود كي لا يشكلوا خطراً
عليها، لأن الكثير من الأنظمة اليوم وخاصة نظام الأسد لا يهمه في سوريا
غير الحفاظ على الكرسي، حتى لو باع سوريا للغزاة والمحتلين، وحتى لو
عمل على تهجير حاضنته الشعبية. وللعلم فإن عشرات الألوف من الشباب
السوري في منطقة الساحل معقل النظام بدأوا يهربون من البلد إلى أي مكان
أفضل، وقد تجد الألوف منهم اليوم في أربيل بالعراق. ولا يختلف الأمر
بالنسبة للنظام العراقي أو الليبي أو اللبناني أو التونسي أو المصري أو
اليمني، وحتى بعض دول شمال أفريقيا، فقد تخلت دول كثيرة عن مسؤولياتها
الاجتماعية والاقتصادية وتركت شعوبها عرضة لكل أنواع التأثيرات
والمغريات الخارجية. وحتى الشباب العرب الذين بقوا داخل أوطانهم، ماذا
لديهم؟ لا شيء سوى الانضمام إلى مواقع تواصل اجتماعي منفلتة من عقالها
توفر لهم عالماً اصطناعياً وحريات زائفة تعوضهم عن الحرمان السياسي
والاجتماعي الذي يعانونه داخل بلدانهم. ولا ننسى أن بعض الشباب يخاطر
بحياته في عرض البحار والمحيطات هرباً من الجحيم داخل بلده وخاصة في
دول شمال أفريقيا.
ينظر الجيل الصاعد من العرب حوله اليوم فلا يرى إلا أنظمة مهترئة فاسدة
وظروفاً اجتماعية ومعيشية واقتصادية جهنمية، وأحوالاً لا تسر الخاطر.
حكام لا يهمهم سوى البقاء على عروشهم والسمسرة لمشغليهم في الخارج على
شعوبهم وثروات بلادهم، وحكومات امتهنت السرقة والنصب والاحتيال على
شعوبها وإعلام رخيص يكذب حتى في درجات الحرارة ومؤسسات دينية لا هم لها
سوى تخدير الشعوب والكذب عليها لصالح مشغليها من الطغاة والجنرالات.
وقد تحولت الحياة كلها إلى شبه جحيم فلا عمل ولا انتاج وأسعار خيالية
لأبسط السلع، وانعدام كامل لأبسط أساسيات الحياة كالكهرباء والماء
والدواء، وهم وغم يحاصران الناس من كل حدب وصوب، فهل تلوم الشباب بعد
كل ذلك إذا نشدوا التحرر والانعتاق والاستمتاع حتى في عوالم افتراضية
مفتوحة، أو إذا تحولوا إلى متسكع ومتصعلك وصائع وضائع ولجؤوا إلى عالم
الضياع والضباع؟
كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com
الدرس الوحيد
الذي تعلمناه من التاريخ
د. فيصل القاسم
هل يا ترى زماننا الذي نعيشه اليوم مختلف عن بقية الأزمنة التي مرت عبر
التاريخ؟ هل كانت العصور القديمة أكثر عدلاً واستقراراً ووئاماً
وإنسانية؟ أم إن الإنسان هو الإنسان لا يتغير مطلقاً عبر الزمان؟ كم
خاضت البشرية من الحروب على مدى الألف سنة الماضية كي لا نقول عبر آلاف
السنين؟ لا نريد أن نذهب بعيداً، كم من الحروب خاضتها الشعوب منذ بضعة
قرون فقط؟ هل تعلم البشر من حروبهم الكارثية شيئاً؟ بالطبع لا، لا بل
إنهم طوروا أساليب القتال والتدمير والوحشية، ولو، لا سمح الله، وقعت
حرب عالمية ثالثة، سيترحم الناس على الحرب العالمية الثانية لأن
الأسلحة التي كانت متوفرة فيها أقل فعالية وخطورة على كوكبنا وسكانه من
الأسلحة المتوفرة اليوم القادرة على تدمير العالم عشرات المرات، فروسيا
لوحدها فقط لديها ترسانة نووية تستطيع تدمير العالم ثلاثا وثلاثين مرة.
تصوروا، فما بالك بالترسانات الأمريكية والأوروبية والصينية وغيرها.
وللعلم، إذا تم استخدام السلاح النووي في أي حرب قادمة، فلن تكون المرة
الأولى، فقد استخدمته أمريكا من قبل في اليابان على مدينتي هيروشيما
وناغازاكي في نهاية الحرب العالمية الثانية، ولا ننسى طبعاً أن أمريكا
وغيرها استخدمت أسلحة مشابهة في فيتنام ستبقى آثارها على الأرض والبشر
لمئات السنين، ولا بد أن نتذكر أيضاً أن السلاح النووي استخدم على نطاق
ضيق في العراق وغيره دون ضجة تُذكر. إذاً لا شيء مستبعداً في أي صرعات
قادمة، لأن البشر يكررون حروبهم ومآسيها وفظائعها حرفياً دون أن
يستفيدوا منها مطلقاً.
ولو قرأنا على سبيل المثال فقط تاريخ حرب الثلاثين عاماً بين الكاثوليك
والبروتستانت في أوروبا وما خلفته من مآس وكوارث على سكان القارة
الأوروبية خلال ثلاثة عقود لوجدناها نسخة طبق الأصل عما يحدث اليوم من
صراعات دينية ومذهبية في العالم الإسلامي وحتى المسيحي. وعندما تقرأ ما
حل بالمدن والقرى الأوروبية أثناء الصراع بين الكاثوليك والبروتستانت
فلا تحتاج أن تكتب تاريخاً جديداً لما يحدث اليوم من صراعات وحروب
أهلية، فما عليك إلا أن تحذف أسماء القرى والمدن الأوروبية أثناء حرب
الثلاثين عاماً وتستبدلها فقط بأسماء بعض القرى والمدن السورية أو
اليمنية أو اللبنانية، فالتاريخ يقدم لنا صورة لا يمكن تصورها لما
فعلته الطوائف المسيحية ببعضها البعض قبل قرون قليلة، فقد تم إحراق مدن
وقرى بأكملها وفر منها ملايين البشر، بالإضافة طبعاً إلى مقتل مئات
الألوف. هل تعلمنا منها شيئاً؟ بالطبع لا، بل كررناها بطريقتنا
الحديثة.
ولو وقعت حرب عالمية ثالثة، سيترحم الناس على الحرب العالمية الثانية لأن الأسلحة التي كانت متوفرة فيها أقل فعالية وخطورة على كوكبنا وسكانه من الأسلحة المتوفرة اليوم
ولطالما طالبنا المذاهب والملل المتناحرة في عالمنا الإسلامي بأن تتعظ
وتتعلم مما حصل في حرب الثلاثين عاماً بين المسيحيين كي تتجنب تكرار
التجربة المريرة، لكن لا حياة لمن تنادي، لأن الإنسان على ما يبدو مغرم
باستنساخ التاريخ دون أن يتعلم منه شيئاً. ولنا فيما فعلوه بسوريا مثل
معاصر مازال حياً أمامنا ونراه يومياً. نتحدث اليوم عن ملايين
الأوكرانيين الذين هربوا من بلدهم بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، ونتحدث
عن ملايين السوريين الذي تركوا بلدهم وكأن هذا الحدث الكارثي جديد على
البشرية، لا أبداً بل هو حدث معتاد وتكرر كثيراً عبر التاريخ، ومازال.
ثم هل توقفت الغزوات والتدخل في شؤون الدول بعد توقيع معاهدة
(ويستفاليا) في أعقاب حرب الثلاثين عاماً في أوروبا والتي نصت حرفياً
على مبدأ سيادة الدول وعدم التدخل؟ هل توقفت الحملات الاستعمارية، أم
اتخذت أشكالاً جديدة متطورة كالعولمة مثلاً؟
أما على الصعيد الاجتماعي، فحدث ولا حرج، فكل القضايا الاجتماعية
والإنسانية والأخلاقية التي يعانيها عصرنا الحالي عاناها من قبل
مليارات البشر عبر التاريخ، فلا عدل مطلقاً تاريخياً في توزيع الثروات
حتى قبل ظهور العصر الرأسمالي، فالعصر الزراعي مثلاً كان يسيطر فيه
الإقطاعيون أصحاب الأراضي الشاسعة، بينما كان يعمل ملايين البشر في
أراضي الإقطاعيين كعبيد وأقنان، تماماً كما يحصل اليوم في عصر العبودية
الرأسمالي حيث يملك بضعة أشخاص في العالم ثروات تفوق ما يملكه مليارات
البشر ويتحكمون بقوت البشرية وعقولها. الظلم الإنساني، أو ظلم الإنسان
للإنسان عبارة عن عملية مكررة يتوارثها البشر من عصر إلى عصر. ولا شك
أن المفكر السياسي البريطاني الشهير (توماس هوبز) كان مصيباً عندما
أطلق عبارته الشهيرة « الإنسان ذئب للإنسان». هكذا بدأ التاريخ، وهكذا
يتقدم بناء على الوحشية واستغلال الأقوياء للضعفاء وحكم القوة. ولو
قارنت مجتمع البشر بمجتمع الحيوان، لاستنتجت أن شريعة الغاب أكثر عدلاً
بكثير من شريعة الإنسان عبر التاريخ. ولو قرأت الأعمال الأدبية في
العصور القديمة قبل مئات السنين، لوجدت الأدباء والكتاب والشعراء
يكتبون عن الظلم والاضطهاد والقمع والفقر والصراع الطبقي واستغلال
البشر لبعضهم البعض، تماماً كما نكتب اليوم بحذافيره.
لا نريد هنا مطلقاً أن نغمط حقوق وتضحيات ومآثر وأفعال ومنجزات
المصلحين والكتاب والمفكرين الذين عملوا عبر التاريخ على فضح الظلم
والظالمين والدعوة إلى العدل والمساواة والإنسانية، ولا يجب أن نستهين
بما حققوه، لكن، للأسف الشديد، ففي كل عصر يتكرر الظلم والاستغلال
والوحشية نفسها التي شهدتها العصور السابقة لا بل تتطور إلى الأسوأ،
ويتكرر معها المصلحون والشعراء والأدباء والمفكرون، وحتى في عصر
الإعلام، لم يتغير شيء سوى أن الإعلاميين ينقلون ظلم الإنسان للإنسان
ووحشيته التاريخية المتكررة على الهواء مباشرة، لكن دون جدوى. هل ساهم
الإعلام مثلاً في التخفيف من مآسي بلدان ما يسمى بالربيع العربي، أم
إنه فقط نقلها لنا، وفي كثير من الأحيان زاد الطين بلة؟ صدق المفكر
الألماني الشهير جورج هيغل عندما قال: إن الدرس الوحيد الذي نتعلمه من
التاريخ أننا لا نتعلم من التاريخ».
كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com
لا فرق بين
العلمانجيين والدواعش!
د. فيصل القاسم
لا أبالغ إذا قلت إن التعصب مرض خطير، ويحتاج إلى علاج نفسي وعقلي،
وخطورته ليست فقط على صاحبه بل على الجميع، لأن المتعصب إنسان مريض
وإقصائي واستئصالي ومؤذ بامتياز قد يصل به الأمر إلى تصفية خصومه بناء
على أفكاره وتوجهاته المتعصبة المريضة المعتوهة العمياء، كما يفعل
الدواعش وأشباههم من كل الأديان. وحتى لو لم يكن المتعصبون خطرين على
البشر دائماً، فإنهم في هذا العالم الإعلامي المفتوح باتوا يشكلون
خطراً إعلامياً على الجميع، لأنهم يسممون الأجواء بأفكارهم المجنونة
والمؤذية ومواقفهم المتحجرة وقد يقنعون الكثيرين بالسير وراءهم
والاقتداء بهم، فيزداد الخطر على الجميع. ومهما كان المتعصب مثقفاً،
فإنه يبقى جاهلاً، لأن قمة الثقافة تدفعك ليس إلى معاداة البشر بل إلى
تفهم مواقفهم ومسايرتهم ومحاورتهم بالتي هي أحسن وعدم اتخاذ مواقف
إقصائية متشنجة منهم وتهديدهم أحياناً بالويل والثبور وعظائم الأمور
لمجرد أنهم لا يوافقونك في الرأي والتوجه والفكر. لكن المتعصبين
يتشبثون بآرائهم المنحرفة والجاهلة بشكل أعمى ولا يقبلون أن يناقشهم
بها أحد، حتى لو كان الكثيرون يرفضونها ويعتبرونها منحرفة ومتطرفة وغير
سوية.
تعالوا اليوم نتطرق إلى نموذجين من المتطرفين الذين يشوهون مواقع
التواصل، وهما النموذج الديني والنموذج العلمانجي، وقد استخدمت كلمة
«علمانجي» وليس علماني، لأن الأول يتغطى بالعلمانية فقط، وهو بعيد عن
العلمانية بعد الأرض عن الشمس، فالعلمانية ليست ضد الأديان مطلقاً، بل
إن الأنظمة العلمانية هي من تحمي الأديان قانونياً وتحمي أتباع
الديانات من بعضهم البعض وتسمح لهم بممارسة شعائرهم وطقوسهم وديانتهم
بكل حرية دون تدخل أو إرهاب من أحد. ولا شك أن المسلمين يستمتعون
بممارسة الدين في البلاد العلمانية أكثر مما قد يستمتعون به في بلادهم
الأصلية أحياناً لأن الأنظمة العلمانجية الديكتاتورية العسكرية
المخابراتية في العالم العربي لا تمت للعلمانية بصلة وتتعامل مع
المتدينين بشك وريبة وازدراء وتعتبرهم خطراً عليها حتى لو كانوا
مسالمين وغير خطرين أو متشددين ومتطرفين، فالديكتاتور العلمانجي العربي
يعادي الدين والمتدينين بالفطرة، ولو استطاع لكان قد منع دخول المساجد
وتأدية الفرائض، لهذا تجد أن كلاب صيده من رجال الأمن والمخابرات
يعيشون في الجوامع ويراقبون كل شاردة وواردة، ويتجسسون على المصلين،
ويدونون حتى أسماء كل من يدخل الجامع أو يؤدي الصلاة ويراقبونه. ولا
ننسى أنهم يكتبون لخطباء الجمعة أحياناً خطبة الجمعة ويحددون محتواها
ويوجهونها على هواهم وليس على هوى المصلين، بحيث يتحول الدين في
الأنظمة الديكتاتورية إلى مجرد أداة لمصلحة النظام حصراً.
وللديكتاتوريات في بلادنا «مثقفوها» العلمانجيون ، لأن المثقف
العلمانجي بعيد عن الثقافة الحقيقية بعد الشمس عن المريخ، لأنه إنسان
ذو اتجاه واحد، لا يرى إلا أمامه، وكذلك العلمانجي العربي الذي لا يريد
أن يرى إلا ما يعتقد أنه صحيح ضارباً عرض الحائط بكل الآراء الأخرى،
لهذا فيمكن أن نسميه بسهولة بالعلمانجي الداعشي، لأن الفرق الوحيد بينه
وبين الدواعش وأمثالهم أن الداعشي المتدين يربي لحية كثة طويلة، بينما
العلمانجي قد يفضل أن يكون أمرد الوجه، لكن عقله لا يختلف قيد أنملة عن
عقل الداعشي الدموي المتطرف الذي يعادي الجميع ويكفر حتى أبناء وأتباع
دينه على أتفه الأخطاء. وكما أن المتشدد دينياً يعتبر نفسه على صواب
والجميع على خطأ، فإن العلمانجي لا يؤمن بأي حوار مع المتدينين، حتى لو
كانوا معتدلين جداً وقابلين بكل أشكال وممارسات الديمقراطية الحديثة،
فهو يعاديهم ويكرههم لمجرد أنهم يتحدثون بالدين. والغريب في الأمر أن
العلمانجي الداعشي العربي لا يعادي من الأديان سوى الدين الإسلامي، ولا
تراه مطلقاً ينتقد التطرف والمغالاة في الأديان الأخرى، وكأنه مختص فقط
بمعاداة الإسلام دون غيره من الأديان، وقلما تجد مقالة واحدة لعلمانجي
عربي تهاجم المتطرفين في الأديان الأخرى.
لا أحد يمتلك الحقيقة مطلقاً، مع ذلك تجد أن القاسم المشترك بين
الداعشي والعلمانجي أن الطرفين ليسا مستعدين أن يشفعا لبعضهما البعض،
والعلمانجي يريد من الجميع أن يتخذوا موقفاً متطرفاً متشدداً من
المتدينين، حتى لو كانوا أناساً طيبين وبسطاء ومستعدين للأخذ والرد
والنقاش والحوار. كل المسلمين بالنسبة للعلمانجي خطرون ويجب ألا تتسامح
معهم أو تقبل أو تثق بهم، فليس في القنافذ أملس بالنسبة للعلمانجي
عندما يتعلق الأمر بالمتدينين، والصوفي بالنسبة له نسخة طبق الأصل عن
الداعشي، مع أن الفرق شاسع بين النموذجين.
ولا يقل خطر العلمانجي مطلقاً عن خطر الداعشي، فهما يشكلان تهديداً
للناس، لأنهما يعززان ثقافة الانغلاق والتحجر والتشدد والتطرف، ويقسمان
المجتمع إلى قسمين متناحرين، وكما أن المتطرف الديني لا يقبل بأي شخص
يخالفه عقدياً ومستعد أن يقتله كمرتد أو كافر، فإن العلمانجي لا يقبل
بأي شخص مسلم مطلقاً، وكل المسلمين بالنسبة له أعداء ولا بأس أن يتخلص
منهم جميعاً حتى يتبعوا ملته العلمانجية المتطرفة ويبدأوا بشتم الإسلام
والمسلمين ليل نهار، كما فعل العسكر في بعض الدول العربية من قبل حيث
كانت مهمتهم استئصال وإقصاء أي عنصر إسلامي عن الساحة السياسية. وكي لا
يعتقد البعض أننا هنا نروج لتسييس الدين، لا أبداً، فالدين أو رجل
الدين يبقى طاهراً أو بتولاً حتى يدخل السياسة فيتنجس، وبالتالي من
الخطأ مزج الطهارة بالنجاسة، لكن هذا لا يعني أن ندعو إلى التعامل مع
المتدينين كما لو كانوا شاذين اجتماعياً كما يفعل العلمانجيون، ولا
أدري لماذا يدافع العلمانجي العربي عن حقوق المثليين، لكنه يريد أن
يمنع النساء من ارتداء زي إسلامي ويدوس على حقوق أي شخص يريد أن يمارس
العبادة.
لعمري أنكم دواعش بدون لحى، فالداعشي يتحجج بنصوص يعتبرها مقدسة، وأنتم
جعلتم ترهاتكم مقدسات.
كاتب واعلامي سوري
ماذا ستأكل الشعوب بعد اليوم؟
د. فيصل القاسم
هناك ظاهرة مرعبة بكل المقاييس لا ينتبه لها الناس بالشكل المطلوب ولم
يعطها الإعلام التغطية الكافية للتحذير من عواقبها الرهيبة التي بدأت
تظهر شيئاً فشيئاً في العديد من بلدان العالم وخاصة العالم العربي
والعالم الثالث عموماً. إنها ظاهرة التضخم غير المسبوق تاريخياً حتى في
الدول الغربية الغنية. رواتب ثابتة ومحدودة وأسعار تحلق في أعالي
السماء ولا تقف عند حد. ما الذي يجري؟ ماذا تريد القوى التي تتلاعب
باقتصاديات وثروات المعمورة؟ كنا في الماضي نسخر مما يسمى بمؤامرة
«المليار الذهبي»، ونعتبرها من نسج خيال أصحاب نظرية المؤامرة
وتخرصاتهم السخيفة، لكن للأمانة إذا ظل الوضع المعيشي في العالم يسير
على هذا النحو غير المسبوق لا نستبعد مطلقاً أن تعم المجاعات كل دول
العالم بما فيها العالم الغربي فينخفض عدد سكان العالم إلى مليار، لأن
الذي يحصل اليوم على صعيد جنون الأسعار لا سابق له في التاريخ.
تعالوا ننظر إلى حال الشعوب في بعض البلدان العربية كسوريا مثلاً،
فراتب الموظف بعد كل الزيادات لا يتجاوز المئة ألف ليرة، وهو رقم كبير
جداً مقارنة بالرواتب القديمة التي لم تكن تتجاوز الألف ليرة قبل ثلاثة
عقود ونيّف. لكن في ذلك الوقت كانت الألف ليرة تكفي عائلة كاملة مسكناً
ومأكلاً ومشرباً. أما اليوم فالمئة ألف ليرة لا تكفي لشراء جرة غاز
صغيرة، فمن أين يأتي المواطن السوري بالمال لشراء بقية حاجاته إذا كان
راتبه لا يكفي لشراء جرة الغاز. وكي لا نطيل في الشرح، فإن الإنسان
اليوم في سوريا يحتاج أكثر من مليون ونصف المليون ليرة كي يعيش على
الكفاف، بينما راتبه لا يزيد عن مئة ألف ليرة وربما أقل، فماذا يفعل؟
لقد سمعنا قبل أيام ممثلين سوريين كبارا يستغيثون ويطالبون رئيسهم
بالتدخل لأن الوضع صار جهنمياً بامتياز وهم يعانون جوعاً حقيقياً، فإذا
كان الوضع هكذا في أوساط الفنانين والممثلين، فكيف هو في أوساط الطبقات
المسحوقة أصلاً قبل الكارثة المعيشية الحالية. وضع لا يمكن تصديقه من
شدة هوله. ما الحل؟ ليس هناك حل، فلو أرادت الدولة أن ترفع الرواتب إلى
مليون ونصف المليون ليرة ليتمكن الناس من العيش على الكفاف فقط، فهي
غير قادرة، وحتى لو زادت الرواتب فإن الأسعار بدورها ستحلق أعلى بما
يجعل الجميع يدورون في حلقة مفرغة لا يمكن السيطرة عليها.
طبعاً قد يقول لنا البعض إن سوريا ليست نموذجاً لأنها خارجة للتو من
حرب أتت على الأخضر واليابس وهي تعاني شحاً مالياً وزراعياً واقتصادياً
وغيره، لهذا فهي يمكن أن تتعافى لاحقاً وتصحح وضعها المعيشي تدريجياً
كما حصل مع بقية الدول التي عانت من الحرب وتبعاتها من قبل. لكن هذا
الكلام مردود عليه، لأن هناك بلداناً عربية وغير عربية أخرى بدأت تعاني
من النموذج السوري مع أنها لم تدخل في حرب ولم تعان ما عانته سوريا.
حتى في الغرب رغم كل الثراء والدعم الحكومي ودولة الرفاه، فإن الفجوة بين الرواتب وارتفاع الأسعار صارت خيالية بحيث صار البعض يتحدث عن مجاعات حقيقية قادمة حتى في أوروبا
خذ مثلاً مصر اليوم، فبعد انخفاض الجنيه أمام الدولار بشكل مفاجئ
ورهيب، بات الشعب المصري كله لا هم له سوى الحديث عن مواكبة التحولات
الاقتصادية الرهيبة التي بدأت تضرب البلاد بشكل غير مسبوق. فجأة ارتفعت
الأسعار مئة في المئة في بعض الأحيان، فكيف سيغطي راتب الموظف هذا
الارتفاع المرعب؟ من أين سيأتي بأضعاف راتبه كي يؤمن لقمة عيش بسيطة؟
من أين؟ لا يوجد أي مصدر، ولو زادت الدولة الرواتب فسيبتلع الزيادة
ارتفاع الأسعار الجنوني الذي لا يتوقف مع كل زيادة بسيطة في سعر
الدولار أمام الجنيه. ما الحل؟ لا حل.
ولو ذهبت إلى تونس ستجد أن الشعب هناك يعاني الحالة السورية والمصرية
بحذافيرها. ارتفاع جنوني في الأسعار وتضخم غير مسبوق ومصادر دخل محدودة
لا يمكن أن ترتفع مطلقاً لأن الدولة عاجزة عن تأمين المال الكافي لسد
العجز.
هل يختلف الوضع في السودان أو لبنان أو الأردن أو الجزائر أو المغرب أو
أي بلد عربي؟ ربما تكون بعض البلدان أفضل حالاً مثلاً من اليمن ولبنان
والسودان الذي دخل الدوامة السورية والمصرية منذ فترة طويلة، وكذلك
اليمن الذي يمر بأزمة معيشية يشيب لها الولدان، لكن لا أحد يتكلم عنها،
بينما تدهور سعر العملة اللبنانية منذ أشهر مرات ومرات بحيث بات العديد
من اللبنانيين يعتمدون على السلال الغذائية التي يتبرع بها بعض
الميسورين بشكل عابر وغير ثابت. تصوروا أن لبنان يعاني الجوع. ما الحل؟
ليس هناك أي باب أمل مطلقاً؟ فالكل بات يعاني. صحيح أن دول الخليج
تستفيد من ارتفاع أسعار النفط، لكنها بدورها تعاني في الوقت نفسه من
تضخم رهيب وارتفاع جنوني في الأسعار، بحيث تضاعفت الأسعار مرات ومرات
بينما الرواتب مازالت على حالها منذ سنوات لشرائح كبيرة. والحل طبعاً
ليس في زيادة الرواتب بشكل مستمر لمواكبة التضخم، هذا إن حصل، وهو لم
يحصل، فارتفاع الأسعار في بعض بلدان الخليج بات يقتطع الجزء الأكبر من
الرواتب للأكل والشرب والخدمات الأخرى، بحيث بات كثيرون يعملون فقط
لتأمين قوت يومهم لا أكثر ولا أقل، والوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.
وكي لا يظن البعض أن الأمر يقتصر على الدول العربية، فإن تركيا مثلاً
تواجه منذ سنوات تضخماً هائلاً خسف برواتب الطبقة الوسطى من ألفي دولار
إلى ثلاثمئة دولار، بعبارة أخرى فإن الطبيب الذي كان راتبه يعادل ألفي
دولار قبل سنوات، أصبح راتبه اليوم لا يساوي مئتي أو ثلاثمئة دولار،
لأن الليرة هبطت أمام العملات الصعبة، ولأن الأسعار باتت جنونية بكل
المقاييس، بحيث صار شراء بعض الفواكه والخضار عملاً بطولياً، فقبل
سنوات كان سعر كيلو الدراق مثلاً ثلاث ليرات تركية، بينما اليوم ثمنه
قد يصل أحياناً إلى مئة ليرة، والرواتب مع كل الزيادات التي حصلت لا
يمكن أن تغطي الفجوة التي تسبب بها الارتفاع الرهيب للأسعار. بالأمس
كنت تستطيع شراء كيلو زيتون في تركيا بخمس عشرة ليرة، واليوم هذا
المبلغ يشتري بضع حبات من الزيتون فقط، وهكذا دواليك، فكيف سيعيش
الناس؟
وحتى في الغرب رغم كل الثراء والدعم الحكومي ودولة الرفاه، فإن الفجوة
بين الرواتب وارتفاع الأسعار صارت خيالية بحيث صار البعض يتحدث عن
مجاعات حقيقية قادمة حتى في أوروبا، وبتنا نرى العجب العجاب في لندن
نفسها، بحيث يبلغ طول الطوابير على بنوك الطعام للجوعى والمحتاجين مئات
الأمتار. فمن يقف وراء هذه الكارثة، وماذا تريد القوى التي تتحكم
بثروات العالم وأرزاقه واقتصادياته وشعوبه؟
كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com
هل ما زالت كرة القدم
لعبة الفقراء والمسحوقين؟
د. فيصل القاسم
هناك اعتقاد شائع منذ عقود أن لعبة كرة القدم هي لعبة الفقراء، خاصة وأن أشهر لاعبيها بدأوا حياتهم وهم يلعبون كرة مصنوعة من بقايا القماش في الشوارع الفقيرة في أمريكا اللاتينية حفاة الأقدام، لأنهم لم يملكوا في ذلك الوقت ثمن كرة قدم حقيقية ولا أحذية رياضية، وبالتالي ارتبطت كرة القدم في أذهان العالم بالفقراء، وتحولت صورة المعدمين الذين يلعبون الكرة في أحياء البرازيل والأرجنتين المسحوقة إلى صورة رومانسية التصقت بكرة القدم، وصار الكثير منا يشجع فرق كرة القدم العالمية على أساس “بروليتاري” على اعتبار أن هذه اللعبة هي لعبة البروليتاريا العمالية المسحوقة، خاصة وأن أشهر نجومها الأوائل ظهروا في البرازيل كبيليه مثلاً، أي قبل أن تتقدم البرازيل اقتصادياً وصناعياً وتصبح من العشرة الأوائل في الاقتصاد العالمي. لكن هل يا ترى ما زالت هذه اللعبة الأولى في العالم لعبة المسحوقين فعلاً؟ أم ان الأقوياء والأثرياء في الغرب اختطفوها من شوارع الفقراء ليحولوها إلى صناعة عالمية غربية بامتياز تدر على أصحابها مليارات الدولارات سنوياً، وصارت ميزانيات بعض الأندية الغربية خرافية بكل المقاييس. لا بل إن الفقراء في هذا العالم صاروا مدمنين على متابعة الأندية الغربية، بحيث يختفي الناس من الشوارع أحياناً لمشاهدة مباراة بين منتخب ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين. وحدث ولا حرج عن متابعة الدوري الانكليزي أو الإيطالي أو الفرنسي. لا شك أن فريقي البرازيل والأرجنتين وبقية الفرق الأمريكية اللاتينية تحظى بدورها بشعبية عارمة في كل أنحاء العالم، لكنها بدأت تقلد صناعة الكرة الغربية وتحولها إلى “بزنس” عملاق بعيداً عن شوارع الفقراء في ريو دي جانيرو وبوينس آيرس. وبالتالي آن الأوان لأن ننظر إلى هذه اللعبة نظرة جديدة بعيدة عن نظرتنا الرومانسية البروليتارية القديمة التي اتسمت بالسذاجة والبساطة والطوباوية.
لقد أصبحت كرة القدم اليوم مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالتطور الانساني اقتصادياً وصناعياً وتكنولوجياً، ولم تعد لعبة الفقراء المعزولة، أي أن التطور الرياضي العام صار يتقدم يداً بيد مع التقدم في بقية المجالات الأخرى، لهذا بدأنا نرى منذ عقود أن الفرق الفائزة ببطولات كأس العالم مثلاً هي فرق تابعة لدول متقدمة علمياً وتكنولوجياً وصناعياً واقتصادياً. وقد سيطر الأوروبيون على هذه اللعبة منذ أن حولوها إلى صناعة رياضية حقيقية كما فعلوا مع كل الرياضات والهوايات الأخرى، وصارت الفرق الأوروبية هي الأقوى والأكثر خبرة وأداء وبطولة في ملاعب العالم، لأن كرة القدم الغربية واكبت التطور العام في بقية المجالات.
قد يتساءل البعض، لماذا لم تتفوق أمريكا في لعبة كرة القدم مع أنها الأقوى تكنولوجياً واقتصادياً ومالياً وعلميا وعسكرياً؟ ولماذا ننظر بعين الشفقة إلى المنتخب الأمريكي الذي يشارك في البطولات الدولية؟ والجواب على ذلك أن أمريكا لديها لعبة كرة قدم خاصة بها، وهي متقدمة ومتطورة وتعتبر صناعة رياضية بحد ذاتها تنافس كرة القدم العالمية بامتياز لكن على الصعيد الداخلي. وكذلك أيضاً هناك لعبة البيسبول والسلة الأمريكيتان اللتان تحظيان بشعبية وانتشار وقوة رهيبة على الساحة الأمريكية، وهما تدران على الأندية مليارات الدولارات لأنها أصبحت صناعة بحد ذاتها.
وماذا عن البرازيل والأرجنتين البلدين الأمريكيين اللاتينيين اللذين ينتميان عملياً إلى العالم الثالث؟ لماذا تطورت فيهما كرة القدم وأصبحت تنافس عالمياً مع الكبار، مع أن دول أمريكا اللاتينية محسوبة على نادي الفقراء والمتخلفين؟ الجواب بسيط، فالبرازيل مثلاً لم تعد محسوبة على الفقراء حتى لو كانت فيها نسبة فقر كبيرة، ولا الأرجنتين أيضاً. لمن لا يعلم، البرازيل صارت تتطور وتتقدم وتنافس على مستوى عالمي في كل المجالات، فلا تنسوا أن البرازيل قبل سنوات تقدمت على بريطانيا في إجمالي الناتج القومي، وصارت من القوى الست الأولى في العالم اقتصادياً، ولا ننسى أن صناعة السلاح تطورت بشكل رهيب في البرازيل جنباً إلى جنب مع الصناعات الأخرى، لتصبح البرازيل واحدة من أقوى عشرة اقتصاديات في العالم. هل تعلمون أيضاً أن الأرجنتين غدت عضواً في مجموعة العشرين التي تضم أقوى عشرين اقتصاداً في العالم؟ ولا ننسى أيضاً أن المكسيك التي قد يعتقد البعض أنها من العالم النامي أصبحت بدورها من مجموعة العشرين، أي أنها غدت في طليعة القوى التي باتت تقود العالم اقتصادياً وصناعياً، وبالتالي نستطيع أن نؤكد أن التطور الرياضي يمشي يداً بيد مع التطور الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي.
قد يسأل البعض أيضاً: لماذا لا تحتل الصين مرتبة متقدمة في مجال كرة القدم العالمية؟ والجواب، نعم صحيح أن الصين لم تشارك في كأس العالم سوى مرة واحدة، لكنها اليوم تشتري الكثير من الأندية الأوروبية وتستثمر المليارات للنهوض بلعبة كرة القدم وقد تحل محل بعض بلدان أمريكا اللاتينية كمنافس كروي لأوروبا. ولا ننسى أن الصين تفوز عادة بعدد هائل من الميداليات الذهبية في الألعاب الأولمبية، وهذا يؤكد أن التقدم الرياضي في الصين لا ينفصل عن التقدم العام في البلاد.
وأخيراً نقول للذين يشجعون منتخبات كرة القدم على أساس بروليتاري رومانسي عاطفي من منظور ماركسي سخيف، عليكم أن تعيدوا النظر في تشجيعكم، فمن السخف أن تشجع فريقاً هزيلاً بائساً ينتمي إلى بلد متخلف على كل الأصعدة وتظن أنه سيتفوق على فريق أوروبي هو بالنتيجة ثمرة تطور بشري عظيم على كل الأصعدة العلمية والتكنولوجية والاقتصادية الأخرى. لطالما شجعنا الفرق المستضعفة في كأس العالم لعلها تفوز على الفرق المتقدمة، وهذا طبعاً شعور عاطفي صبياني سخيف، فكيف تتوقع من فريق قادم من بلد ديكتاتوري كسوريا مثلاً يدار بعقلية عسكرية قميئة متخلفة، رجعية بائسة وقذرة، أن ينافس فريقاً قادماً من بلد متطور ومتقدم على كل المستويات؟ أليس من السخف أن تصفق لفريق مستضعف تعرف أن فرص فوزه صفر؟
أخيراً، كرة القدم أو أي رياضة أخرى يا سادة ليست مجرد لعبة بشرية، بل هي تجسيد لكل أنواع التطور البشري على كل الصعد.
فطرة الشعوب تهزم “قذارة”
الإعلام والسياسة في كأس العالم؟
د. فيصل القاسم
على الرغم من أن لعبة كرة القدم تحمل في طياتها الكثير من متفجرات
السياسة، وعلى الرغم من أنها قد تكون في أحيان كثيرة مناسبة سياسية
بامتياز إضافة إلى كونها مناسبة رياضية، إلا أن الشعوب “لو أرادت”،
تستطيع رغم كل قذارات السياسة والإعلام، أن تحافظ على الميزة الأساسية
للمناسبات الكروية الكبرى كبطولة كأس العالم وغيرها من البطولات
الرياضية، ألا وهي التلاقي الحضاري بين الشعوب وإزالة الكثير من
الانقسامات والخرافات الاصطناعية التي صنعتها قوى الشر والاستعمار
لتكريس الضغائن والأحقاد بين الأمم خدمة لمصلحة المستعمرين والقوى
الشيطانية التي تتحكم بشعوب المعمورة.
تعالوا ننظر إلى النسخة الحالية لبطولة كأس العالم في قطر وما رافقها
من ضجة إعلامية وثقافية أثارها بعض الفرق الغربية للتشويش على البطولة
في دولة قطر، وإثارة نعرات ثقافية وحضارية وسياسية لتعكير صفو البطولة
والنيل من الدولة المضيفة والثقافة التي تنتمي إليها.
صحيح أن بعض المنتخبات جاءت محملة بأحقاد تاريخية غلفتها بشعارات خاصة،
كشعار حرية الدفاع عن المثليين، كما فعل المنتخب الألماني وغيره من
المنتخبات الأوروبية. ولا ننسى الزوابع الإعلامية التي أثارها بعض
وسائل الإعلام الغربية العملاقة قبل انطلاق بطولة كأس العالم في دولة
قطر أيضاً للتشويش على البطولة وإفشالها إعلامياً ورياضياً وثقافياً
لغايات في نفس يعقوب. وكلنا تابع حملة التعكير المغرضة التي حاولت أن
تحرف الأنظار عن البطولة وتركيز الأضواء على قضايا أخرى كحقوق المثليين
ووضع العمال في الخليج، ما حدا برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)
إلى التصدي بفروسية عز نظيرها للحملات الإعلامية الغربية وفندها
تاريخياً بالأرقام والوقائع والبراهين. ولا شك أنه كان مؤسفاً جداً أن
وسائل الإعلام البريطانية تجاهلت حتى افتتاح بطولة كأس العالم في دولة
قطر في محاولة واضحة للنيل من البطولة العالمية.
لكن على الرغم من شراسة الحملة الإعلامية التشويشية على كأس العالم
ومحاولة شيطنة الدولة المضيفة، أو لنقل الثقافة العربية والإسلامية
التي تنتمي إليها، إلا أن الحملة فشلت تماماً، مع أن التي قادتها
أوروبياً كانت وسائل إعلام عملاقة، كما دخلت على خطها شخصيات سياسية
بارزة من الدول الأوروبية كوزيرة الداخلية الألمانية التي اخترقت كل
القوانين والأعراف الدولية، ودخلت إلى الملعب الذي شهد مباراة الفريق
الألماني الأولى، وهي ترتدي تحت معطفها شعار المثلية بطريقة لا تليق
بها ولا بالدولة التي تنتمي إليها. وعندما جلست على مقعدها خلعت معطفها
لتظهر الشعار بصفاقة عز نظيرها، مع أن الوزيرة من المفروض أنها تمثل
الحفاظ على القانون كونها وزيرة داخلية، وليست وزيرة شؤون المثليين.
ماذا جنت الوزيرة وفريقها جماهيرياً غير الخيبة والازدراء حتى من
الكثير من اللاعبين الألمان وملايين المتفرجين الذين جاءوا من كل أصقاع
العالم لمشاهدات مباريات البطولة.
لقد نجت الشعوب هذه المرة في إفشال الحملات الإعلامية والسياسة التي
رافقت البطولة، وتحولت شوارع دولة قطر وملاعبها وساحاتها وميادينها
وحدائقها ومطاعمها وأسواقها إلى مهرجان عالمي بامتياز انصهرت فيها
حضارات الشعوب وثقافاتها وتلاقت بانسجام ووئام عز نظيره رغماً عن أنف
القوى الشيطانية التي حاولت التشويش على البطولة وتعكير صفوها. وعندما
تمشي على طول منطقة المارينا في مدينة اللؤلؤة القطرية مثلاً، ترى كل
الجنسيات تتفاعل وتتلاقى وتستمتع بأجواء البطولة معاً بعيداً عن
الحملات الإعلامية القذرة. ولو ذهبت إلى سوق “واقف” في الدوحة لرأيت
الأمم المتحدة بأجمل صورها، مئات الألوف من البشر توافدوا على السوق
الشهير واشتروا التذكارات وتذوقوا الأطعمة العربية والدولية. لقد تحول
السوق إلى عرس حقيقي بكل المقاييس، بكل الأزياء والطقوس الدولية، وكانت
الفرحة ترتسم على وجوه الجماهير، وكأنها تقول للذين حاولوا التشويش على
البطولة: “أنت فين والحب فين”. نحن جئنا إلى هنا لنستمتع ونتلاقى
بعيداً عن قذارات الإعلام والسياسة، وها نحن نملأ شوارع قطر وأسواقها
ونزرع الوئام والانسجام بين الشعوب بعيداً عن مؤامراتكم التافهة. وقد
قالها الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورغان في إحدى مقابلاته
التلفزيونية بكل وضوح وتحد للحملات السياسية والإعلامية التي حاولت
شيطنة البطولة والدولة المضيفة، قال للإعلام الغربي ما معناه: “أنتم في
واد والبطولة والجماهير في الدوحة في واد آخر. الناس هنا جاءت لتستمتع
بكرة القدم وتتلاقى ثقافياً وحضارياً، وهي تفعل ذلك بامتياز، ولم تسمع
حتى عن ألاعيبكم وحملاتكم التخريبية التي استهدفت البطولة. لهذا العبوا
غيرها”. وقد شارك حتى لاعبون ألمان كثر الإعلامي البريطاني رأيه،
واعترفت رئيسة الدوري الألماني بعظمة لسانها بأن الحملات التي رافقت
البطولة لم تكن مناسبة، كما اعترفت أيضاً بأن العديد من أفراد المنتخب
الألماني كانوا يرفضون تحويل البطولة إلى مناسبة لصراع حضاري بين الغرب
والدولة المضيفة.
صحيح أنه مهما حاولت الشعوب والثقافات والأديان الانفتاح على بعضها بعضا والتلاقي في مناسبات جماهيرية وثقافية واجتماعية، ستواجه صعوبات في تكريس الوئام والانسجام في ما بينها، نظراً للدور الرهيب الذي تمارسه وسائل الإعلام العملاقة ومالكوها الكبار، إلا أن الشعوب أثبتت في بطولة كأس العالم الحالية بأنها تفوقت على الحملات الإعلامية التخريبية وتجاوزت أفخاخ السياسة والإعلام بنجاح منقطع النظير وحولت البطولة إلى مناسبة تلاقح حضاري وثقافي عالمية بامتياز.
كرة القدم رياضة
أم سياسة مفضوحة؟
د. فيصل القاسم
من بين كل الرياضات في العالم تتميز لعبة كرة القدم بأنها تحمل في
حركاتها وركلاتها ومناوراتها وطقوسها وعواطفها ومشاعرها وأجوائها أكبر
مخزون من المتفجرات والمكونات السياسية. المؤسسات الرياضية وعلى رأسها
الفيفا تحاول جاهدة تقديم اللعبة للعالم على أنها مادة للاستمتاع
والانبساط والتلاقي الإنساني، وتحاول كل ما بوسعها إبعاد السياسة
والدين عن بطولات كرة القدم المحلية والإقليمية والعالمية، لكنها
بالتأكيد تفشل فشلاً ذريعاً، لأن اللعبة مصممة أصلاً بشكل سياسي لا
تخطئه عين، وخاصة في البطولات الإقليمية والدولية التي تتحول في الغالب
إلى حروب سياسية، وتنتقل معها الصراعات والأحقاد والخلافات إلى ملاعب
كرة القدم والمدرجات وجماهير المشجعين، وفي بعض الأحيان تتحول
المباريات إلى ساحة وغى، ويصبح العنف المتبادل سيد الموقف، ليس فقط
بسبب خسارة أو فوز هذا الفريق أو ذاك، بل تعبيراً عن مكنونات ومواقف
سياسية مفضوحة. ويرى بول أوستر أن «البلدان اليوم تخوض حروبها في ملاعب
كرة القدم، والمفترض أن هذه لعبة، وأن التسلية هي هدفها، غير أن
الذاكرة الخفية لتناحرات الماضي تخيّم على كل مباراة، وكلما سُجّل هدف
ترددت أصداء الانتصارات والهزائم القديمة.»
حتى أعمال الشغب التي تحدث أحياناً، فهي ليست دائما نتيجة احتساء
المشجعين الكثير من الكحول وفقدان عقولهم، بل تصريفاً لمشاعر سياسية.
وقد شاهدنا كيف تصرفت بعض الجماهير العربية التي تساند منتخباتها
الوطنية بعد فوز فريقها، شاهدنا كيف تصرفت في شوارع بعض الدول
الأوروبية بطريقة عنيفة وكأنها تترجم موقفها السياسي من الفريق الخاسر
والبلد الذي ينتمي إليه في الشوارع هذه المرة. وكأنها تقول: انتصرنا
عليكم رياضياً وسننتصر عليكم سياسياً وثقافياً.
ولطالما انتقلت الصراعات السياسية بعد المباريات إلى صفوف المشجعين
خارج الملاعب صراخاً وهجوماً وعنفاً وضرباً وتكسيراً للكؤوس والرؤوس،
لأن الكرة تستفز أعمق ما في النفس البشرية من أحقاد وصراعات ومشاعر
سياسية جياشة. وتمتاز كرة القدم عن غيرها بأنها تفجر تلك الأحاسيس
السياسية المدفونة لدى الجميع. أوليست الهجمة الإعلامية الغربية على
قطر وهي تستضيف بطولة كأس العالم موقفاً سياسياً بامتياز؟ ألم يغلف
الأوروبيون مواقفهم وأحقادهم السياسية بحملات دعائية مفضوحة؟ ألم تكن
محاولة بعض الفرق الأوروبية ارتداء بعض الشعارات التي تمثل بعض
الجماعات تعبيراً عن موقف سياسي؟ ألم يكن ارتداء وزيرة الداخلية
الألمانية أحد الشعارات على ذراعها أثناء مشاهدة مباراة بلادها مع
اليابان في الدوحة موقفاً سياسياً مفضوحاً واستغلالاً وتسييساً مكشوفاً
لكرة القدم؟
بالمقابل رد ناشطون وسياسيون عرب بارتداء شارات عليها رموز فلسطينية.
ولا ننسى أن الكثير من المشجعين يستغلون المناسبات الرياضية وخاصة
المباريات الكبرى للتعبير عن مواقفهم السياسية، فتجد المعارضين لهذا
النظام أو ذاك مثلاً يحملون شعاراتهم وأعلامهم الخاصة، لا بل إن بعضهم
لا يتردد في التشويش على ترديد النشيد الوطني الذي يعتبرونه ممثلاً
للنظام الذي يعارضونه، كما فعل مثلاً بعض المعارضين الإيرانيين أثناء
مباراة إيران مع إنكلترا. وقد شاهدنا الضجة التي رافقت امتناع المنتخب
الإيراني عن ترديد النشيد الوطني الإيراني عندما عُزف قبل المباراة،
وقد اعتبره البعض موقفاً سياسياً ضد النظام الحاكم ودعماً واضحاً
للانتفاضة الشعبية التي تشهدها إيران اليوم ضد حكم الملالي.
تتميز لعبة كرة القدم بأنها تحمل في حركاتها وركلاتها ومناوراتها وطقوسها وعواطفها ومشاعرها وأجوائها أكبر مخزون من المتفجرات والمكونات السياسية
ولا شك أنكم شاهدتم ردود فعل الجماهير وحتى الإعلام والرأي العام في
بلد ما عندما يفوز فريقه على بلد آخر على خلاف معه، فيتحول الفوز في
أرض الملاعب إلى فوز سياسي بامتياز، ويشعر المنتصر بأنه سحق غريمه
سياسياً، كما يشعر الخاسر بأن خسارته على أرض الملعب هي خسارة سياسة
وطنية كبرى.
والمضحك في كرة القدم أن القائمين عليها يتناسون وهم يدعون الشعوب إلى
الاستمتاع بها وإبعادها عن السياسة والصراعات، يتناسون أن اللعبة تعبير
صارخ في كل مظاهرها عن الألاعيب والطقوس السياسية أصلاً، ففي المدرجات
يتواجه مشجعو الفريقين وكل فريق يرتدي أزياء بلده الوطنية ويبالغ في
إظهارها والتباهي بها بشكل مثير وحتى مستفز أحياناً للتأكيد على وطنيته
وبالتالي تعزيز توجهاته الوطنية السياسية في مواجهة الفريق الآخر.
وشاهدنا كيف حاول بعض المشجعين الأوروبيين دخول الملعب وهم يرتدون
أزياء الصليبيين في بلد مسلم. وتظهر أعلام البلدان المتبارية في
المدرجات بشكل فاقع لتكريس روح الصراع والمبارزة السياسية قبل
الرياضية.
ولا ننسى الهتافات الحماسية التي تشبه الهتافات والأناشيد الوطنية قبل
الحروب. ولا شك أن الجماهير في المدرجات يتدفق الدم في عروقها كالبحر
الهادر أثناء ترديد النشيد الوطني أو الشعارات الوطنية المحشوة
بالبارود السياسي.
وحتى المشاهد أو المتابع العادي لبطولات كرة القدم وخاصة العالمية منها
يشاهد المباريات عادة بموقف سياسي مسبق، فلطالما شجعنا ومازلنا نشجع
المنتخبات على أساس سياسي وليس رياضيا، وهو أمر يحدث عادة في بطولة كأس
العالم، فهناك الكثيرون الذين يقررون دعم هذا الفريق أو ذاك أثناء
المشاهدة حسب توجهاتهم ومواقفهم السياسية المتقلبة، فلو زعلوا من
سياسات بلد ما مثلاً تجدهم يشجعون أي فريق آخر يلعب ضد فريق البلد الذي
يكرهونه، كما حصل بين فريقي إسبانيا وألمانيا حيث شجع معظم العرب
الفريق الإسباني نكاية بالفريق الألماني الذي استفز مشاعرهم بارتداء
شعارات المثلية. لكن الجمهور العربي نفسه كان من قبل قد شجع الفريق
الألماني تقديراً لألمانيا على استضافة اللاجئين السوريين. وهكذا.
وغالباً ما نشجع فرقاً على أساس قومي أو ديني أو سياسي. وأحياناً نميل
إلى الفريق المستضعف ضد الفرق القوية من منطلق سياسي أيضاً. وكم من
المرات شجعنا هذا المنتخب أو ذاك بناء على طبيعة العلاقات السياسية بين
بلدنا وبلدان الفرق الأخرى. فلو كان نظامنا على علاقات طيبة مع بلد ما
ترانا بشكل أوتوماتيكي نشجع فريق ذلك البلد، لأننا مُبرمجون سياسياً.
وفي أحيان كثيرة يتوقف تشجيعنا أو عدم تشجيعنا لفرق كرة القدم بناء على
توجهاتنا السياسية، فالماركسي يشجع أي فريق يلعب ضد الفرق التابعة
للغرب لأنه اشتراكي كاره للأنظمة الرأسمالية، وهكذا دواليك. بعبارة
أخرى فإن مشاعرنا ومواقفنا الرياضية مجبولة بخلفيات سياسية.
لا شك أن هناك مشجعين رياضيين بريئين ونظيفين في العالم يشجعون
المنتخبات واللاعبين بناء على مهاراتهم الكروية، لكن نسبتهم ضئيلة
كنسبة المشجعين الأوروبيين الذين يدخلون المدرجات بدون زجاجة كحول.
كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com
لهذا السبب لا يرد بشار
على الاعتداءات الإسرائيلية
د. فيصل القاسم
ملوك الكوميديا والإضحاك اليوم هم أولئك الساسة الفاشلون الذين يشبهون
دونكيشوت، ويمارسون أعلى أشكال التهريج السياسي والكوميديا
الاستراتيجية لتبرير فشل وانهيار وإفلاس أنظمتهم واهترائها، وأحلى
القفشات تأتيك اليوم ليس من صالات السينما والمسارح والمسلسلات
التلفزيونية بل من السياسيين والمسؤولين السوريين تحديداً وهم يحاولون
تبرير وترقيع سقوط نظامهم بالوحل وتحوله لـ«ملطشة» وفرجة دولية لـ«اللي
يسوى واللي ما يسواش».
وإذا أردت فعلاً أن تضحك، و«تفرفش» و«تنعنش» و«تزهزه» وتنسى الدنيا
وهمومك كلها، و«تمزمز» وتمضي أمتع الأوقات فانس شابلن وعادل إمام وغوار
وهنيدي وتابع وزراء وأمناء فروع حزبية ومهرجين استراتيجيين وأبواق
الإعلام السوري الشهيرين، ومسؤولي النظام الكبار وهم يجترحون الأعذار،
ويختلقون الأسباب، ويدورون الزوايا، ويربّعون الدوائر لتجميل وتلميع
الموقف المهين للنظام الفاشي العائلي المستبد وهو يتلقى الصفعات
الإسرائيلية يومياً على «أم عينه»، كما يقول المصريون، دون أن يتجرأ
على رفع رأسه أمام الجبروت والقوة الإسرائيلية، فيما يكتفي «الحليف
الروسي»، الصديق وجنرالات حميميم بموقف المتفرج وهم يحتسون الفودكا
ويتمتعون بمشهد الصواريخ الإسرائيلية وهي تتهاطل على الثكنات والمواقع
العسكرية السورية مخلفة أفدح الخسائر المادية والبشرية، وأحدثها منذ
أيام، فيما عرف بمجزرة مطار الشعيرات التي لم تستدع سوى بيان تقليدي
ذليل وهزيل من الجانب السوري.
وتتوالى الضربات والصفعات والركلات الإسرائيلية اليومية على مواقع
النظام الذليل الذي يكتفي بإرسال فرق الإنقاذ، والإطفائيات وتعداد
الضحايا وإحصاء الخسائر، وكفى الله المقاومين شر الرد على العدوان،
لكن، وبالمناسبة، والشيء بالشيء يذكر، فإن هذا الجانب المسالم والطيب
والحنون والرقيق والانبطاحي مع إسرائيل، سرعان ما ينقلب للنقيض، ويتحول
فيه النظام البهرزي الفاشي العائلي وجنرالاته وجيشه «الباصل» إلى ضوار
وأسود ووحوش كاسرة وذئاب شرسة فيما لو فتح فقير جائع فمه يشكو جوعه
وألمه وفقره فيقومون بقصفه بالبراميل وخطفه ليلاً من بين أفراد أسرته
وجره لجهة مجهولة، حيث لا يعد يعلم به حتى الذباب الأزرق، ويختفي عن
وجه الأرض كما حدث مع ملايين المعتقلين، وبعد أن يكون قد كتب منشوراً
على مواقع التواصل الاجتماعي يشير فيه لسرقات «السلالات» المدللة
الحاكمة من الأقرباء والأنسباء والخليلات والحيزبونات الغواني المحظيات
والعصابات ونمور السلب والنهب واللهط الجدد من عصابة رأس النظام الحاكم
وأقربائه محدثي النعمة الذين أطاحوا الإمبراطورية المالية المخلوفية
وحلوا محلها بتواطؤ رأس النظام و«كوّشوا» حتى على حليب الأطفال وصار
سلعة للتربح والابتزاز.
ملوك الكوميديا والإضحاك اليوم هم أولئك الساسة الفاشلون الذين يشبهون دونكيشوت، ويمارسون أعلى أشكال التهريج السياسي والكوميديا الاستراتيجية لتبرير فشل وانهيار وإفلاس أنظمتهم واهترائها
ومن أطرف التبريرات التي سيقت في تبرير و«ترقيع» عدم رد النظام الفاشي
على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، وقد تحول النظام هنا، ويا حرام،
لحمامة سلام، وقط أليف، هو ما ورد على لسان فيصل المقداد، وزير خارجية
بشار، في لقاء متلفز مع الإعلام العُماني، بالقول إن «العدو»، حسب
تعبيره، يستغل مرور الطيران المدني، ويقوم بإطلاق الصواريخ من فوق،
وتحت الطائرات المدنية، كي لا يتجرأ النظام على الرد، وهنا، فالنظام
«الحنون» «الطيب» المسالم، لا يكذّب خبراً، ويحجم عن الرد على الصواريخ
الإسرائيلية، ولا يسقطها، مخافة، أن يصيب صاروخ طائش وأحمق وغير مسؤول
الطائرات المدنية التي تحلق بكثافة في الأجواء السورية، موحياً
للمتابع، بأنه في مطار دبي، أو هيثرو، أو نيويورك.
وبالمناسبة، والشيء بالشيء يذكر، فلم يكن غزو الكويت ولا حروب الخليج
ولا كل ما قيل عن تجاوزات صدام حسين، وراء القرار الدولي بإعدام صدام
والثأر منه، بتلك الطريقة، قدر ما كان تجرؤه على قصف إسرائيل بعدة
صواريخ بالستية، رغم أنها لم تحدث تلك الأضرار، وكانت رسالة إسرائيل،
وكل من يقف وراء إعدامه، واضحة وهي بأن «اليد التي ستمتد على إسرائيل
ستقطع»، وأنها خط أحمر، ويمنع إطلاق رصاصة واحدة صوبها، أما صوب شعوبكم
وصدورهم العارية، فاطلقوا ما تشاؤون من الرصاص والنابالم وقنابل الغاز
والكيماوي والبراميل والمتفجرات. وهذا هو فقط، ما يفسر إلى حد كبير
استراتيجية الاحتفاظ بحق الرد الشهيرة التي تبناها ويتبعها النظام
الأسدي، وهو الذي يوسوس بالبقاء، ولا يفكر إلا به، ويسعى للاحتفاظ
بالحكم للأبد كما يقول ويورثه لأحفاد الأحفاد، وقد تعلـّم درس صدام
جيداً وحفظه وتأدب، وحرّم الاقتراب من إسرائيل، لا بل يصدر الفرمانات
العسكرية بمنع التصدي للطيران الإسرائيلي وقتل الجنود الإسرائيليين
والحفاظ على حياتهم، والاكتفاء بإرسال رسالتين متطابقتين للأمم
المتحدة، حول شجب واستنكار العدوان، فيما تضحك إسرائيل في عبـّها من
هول وشدة وقسوة رد بشار الدبلوماسي المؤدب، وحقيقة هو هنا، وفي كل مرة،
يظهر أدباً جماً مع الإسرائيليين، وعلى غير عادته البربرية، وهو
المشهور بهمجيته والتوحش الشديد مع شعبه المنكوب الفقير، فأي طلقة تطلق
في اتجاه إسرائيل ستعني حكماً حبل المشنقة حول رقبة رأس النظام الذيل
التابع الذليل.
وطبعاً بشار رجل حصيف وذكي ولبيب، وإن اللبيب من الإشارة يفهم، وها قد
وعى الدرس العراقي، ورأى بأم عينه ما حاق بصدام الذي قصف إسرائيل، وقد
فهم الدرس، وأخذ العبرة، فصار يقول في خلده: «ما متنا، بس شفنا اللي
ماتوا. فهل عرفتم الآن السبب الحقيقي لعدم الرد الأسدي على الاعتداءات
الإسرائيلية، فلا تستغربوا ولا تدهشوا وقد قالت العرب: إذا عرف السبب
بطل العجب.
كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com
لماذا فشل العملاق
الأمريكي في كرة القدم؟
د. فيصل القاسم
أعرف الكثير من الناس، وخاصة المسيسين منهم، الذين كانوا يشجعون فرق
كرة القدم على أساس ماركسي لا رياضي، فهم غالباً ما كانوا يصفقون للفرق
المستضعفة، على اعتبار أنها مثلهم تنتمي إلى البروليتاريا، وظللت أنا
شخصياً أشجع “الحصان الأسود” في ما بعد، خاصة أنني أنظر إلى كل صراع،
بما فيه المسابقات الرياضية من منظور طبقي. وللمفارقة الكبرى، أنني،
حتى عندما يكون الفريق الرياضي منتمياً إلى بلد غربي قوي، لكنه ضعيف في
مواجهة الفرق الأخرى، كنت أشجعه طبقياً، على اعتبار أنه كما يقولون في
الإنكليزية (الكلب المستضعف) أو بالأحرى البروليتاري من حيث القوة في
مواجهة الفرق المستكبرة. لهذا السبب أتذكر أنني كنت دائماً أتضامن مع
الفريق الأمريكي وأشجعه بحرارة رغم أنه “امبريالي” فقط لأنه فريق من
الطبقة المسحوقة رياضياً. والسؤال الذي يدور في أذهان الكثيرين اليوم
مع اقتراب مباريات كأس العالم في دولة قطر: لماذا تتصدر أمريكا قيادة
العالم في السياسة والاقتصاد والسلاح والإعلام والثقافة، لكنها تبقى
قزماً في مجال كرة القدم يدعو الكثيرين للتعاطف مع فريقها المسكين في
المباريات العالمية كما فعلت أنا؟
تتنوع الحجج التي تبرر ضعف لعبة كرة القدم في بلاد العم سام، وأولها
طبعاً أن لدى أمريكا لعبة خاصة بها وتحظى بشعبية عارمة داخل الولايات
الأمريكية، ألا وهي “البيسبول”، كما أن لكرة السلة في أمريكا شعبية
كبرى أيضاً تغطي على لعبة كرة القدم وتجعل منها لعبة ثانوية في نظر
الأمريكيين. ورغم أن الدوري الأمريكي استقطب يوماً بعض الأسماء الرنانة
في عالم الكرة، مثل اللاعب الإنكليزي ديفيد بيكهام والسويدي زلاتان
إبراهيموفيتش، لكن لا تزال كرة القدم لا تحظى بشعبية كبيرة في أمريكا.
ويرى البعض أن الأمريكيين مهووسون دائماً بالأرقام الكبيرة، حيث يسجل
أقل فريق في كرة السلة سبعاً وتسعين نقطة، بينما في كرة القدم لا
يتجاوز عدد الأهداف واحداً أو اثنين وفي أحسن الحالات من ثلاثة إلى
خمسة، ويتساءل بعضهم: هل يعقل أن نخسر ساعتين من وقتنا كي نشاهد مباراة
لا يسجل فيها اللاعبون سوى هدفين أو أقل؟
وحسب موقع “سبورت 360” يبرر بعض الأمريكيين عدم شغفهم بكرة القدم بأنها
لعبة تفتقر إلى العدالة، فهم يقولون إن كرة القدم هو المكان الذي يموت
فيه العدل، ولو نظرنا لبعض الأمثلة فسنجد أنها قد تكون فعلاً معطلة
لعنصر العدالة وجمالية الإنصاف. ويرى الأمريكان أن نتيجة أي مباراة في
كرة القدم قد لا تعكس الوجه الحقيقي لمجريات تلك المباراة، فبهدف واحد
قد يقضي أي فريق عادي على آمال الفريق المجتهد الذي يسيطر على مجريات
اللعبة.
وقد يكون للحكم تأثير كبير في نتيجة المباراة، فقد تفوته حالة تسلل أو
يقوم باحتساب ركلة جزاء خاطئة فيقلب نتيجة مباراة كاملة، وربما بطولة.
ويتحدث الأمريكان عن رقم مهم هنا، وهو أن نسبة كبيرة من مجمل أهداف
بطولات كأس العالم أتت من ركلات جزاء، أي أن ركلة جزاء تحسم نتيجة أو
تأهل، وهذا ليس عدلاً.
وفي المباريات الإقصائية لا يفوز الأفضل دائماً، فقد يكون أحد الفريقين
الأفضل طوال مجريات المباراة مقابل فريق آخر مدافع يحاول الوصول إلى
ركلات الترجيح، وبالفعل قد يصل إلى مبتغاه وهو يملك القدرة الفنية
الكبيرة في تنفيذ ركلات الترجيح ليفوز الفريق المدافع والذي لا
يستحقها، ويخرج الفريق المجتهد ويذهب طي النسيان في صفحات التاريخ،
وهذا أيضاً ظلم كبير.
لهذا يجب أن تدخل تقنية إعادة مشاهدة الفيديو (فار) في حسابات الحكم
للتأكيد على صحة حتى ركلات الجزاء، ويجب أن تكون هنالك درجات في احتساب
ركلة الجزاء خلال المباراة، فليس كل لمسة يد تعني ركلة جزاء، وليس كل
عرقلة تمثل ركلة جزاء. وهنا نستذكر هدف مارادونا الشهير المثير للجدل
في شباك إنكلترا عام 1986، هل كان ليحسب مثلاً لو كانت هناك تقنية
“فار”؟
وبناء على ذلك يقترح الأمريكان إلغاء الركلات الترجيحية من قاموس
المباريات الإقصائية في كرة القدم، وأن يكون البديل أشواطٌ إضافية فقط،
في كل شوط إضافي يخرج لاعب من كل فريق، ففي الشوط الإضافي الأول تصبح
المباراة عشرة لعشرة، وفي الشوط الإضافي الثاني تصبح تسعة لتسعة ثم
ثمانية لثمانية وهكذا، حتى يتفوق فريق على آخر باللياقة البدنية
العالية.
ولدى الأمريكيين أيضاً اعتراض كبير على بطاقات العقوبة في كرة القدم، وهم يطالبون بوضع قانون ينص على خروج اللاعب لمدة خمس إلى عشر دقائق عند تلقيه البطاقة الصفراء كما في لعبة الهوكي، وذلك سيعطي إمكانية أكبر لتسجيل الأهداف ورفع مستوى الإثارة، إضافة إلى الحد من نسبة التمثيل من قبل اللاعبين خوفاً من الخروج مؤقتاً من الملعب. وفي حالة البطاقة الحمراء يجب على الحكم استخدام الإعادة التليفزيونية كما في ركلات الجزاء، وذلك يعطي مزيداً من طابع العدل المفقود.
وهناك ثلاثة أمور أساسية يعتقد الأمريكان أن تواجدها سيعطي اللعبة طعماً آخر. ألا تتوقف اللعبة عند وقوع أحد اللاعبين بسبب الإصابة (إلا إذا كانت خطيرة جداً) ويستمر اللعب بشكل طبيعي. وفي حال توقف اللعب عند الإصابة، يجب على الحكم إيقاف ساعة المباراة كما في الألعاب الأخرى، وهذا يضمن عدم التلاعب بالوقت الإضافي أو عدم ضياع الوقت على الفريق الذي يستحقه. وإذا اضطر اللاعب أن يخرج على النقالة، فيجب ألا يعود للملعب ثانيةً، ويتم استبداله، وهذا هو العدل.
هل تصدقون أن هذه التبريرات الأمريكية هي فعلاً وراء تخلف كرة القدم في أمريكا، أم إن الأمريكيين قد فشلوا في دخول هذا المضمار العالمي، وهم يحاولون التستر على هزيمتهم بأعذار واهية، وأن البروليتاريا في لعبة الفقراء قد انتصرت على البرجوازية؟
سؤال إنساني (للآلهة)
الذين يديرون العالم
د. فيصل القاسم
عندما تتحدث عن عصابات صغيرة جداً تتحكم بمقدرات العالم المالية
والاقتصادية والإعلامية والثقافية والنفسية وتتصرف كما لو أنها آلهة،
يظهر لك البعض ليتهمك بأنك من «بتوع» نظرية المؤامرة. لا عزيزي، عندما
تشغّل عقلك جيداً تستطيع بسهولة أن ترى بوضوح أكثر. قد تتساءل: أين
المؤامرة إذا كانت الدول الكبرى نفسها وقعت ضحية للعديد ممن يسميه
البعض مؤامرات، فماذا استفادت الدول مثلاً من ظهور هذا الوباء أو ذاك؟
ألم تخسر ترليونات الدولارات؟ ألم تتعثر صناعاتها وميزانياتها
واقتصادياتها؟ ألم تقع شعوبها فريسة للفقر والغلاء والمجاعة؟ الجواب
نعم صحيح، فليس هناك رابحون واضحون أبداً، فالكل يبدو خاسراً، دولاً
وشركات وشعوباً. لكن هذا لا يعني مطلقاً أن الذين يديرون العالم بعقلية
الإله هي الدول الكبرى أو الصغرى، لا أبداً، بل هناك جماعات وأفراد
خارج الدول تستغل الدول نفسها لتحقيق مشاريعها وأطماعها.
ولعلنا نتذكر الأزمة العقارية التي ضربت العالم في عام ألفين وثمانية،
والتي ألحقت الضرر بالدول الكبرى قبل الصغرى. بالطبع لا يمكن اتهام
الكبار بتلك الضربة، لا سيما وأنهم كانوا أكبر المتضررين منها. وهنا
يبرز السؤال: من الذي يقف وراء تلك الأزمة الكارثية التي هزت العالم؟
الجواب ظهر في فيلم بعنوان «القصة من الداخل» ألقى الضوء على العصابة
التي تقف وراء تلك الكارثة، لكن الفيلم اختفى من التداول بقدرة قادر
بسرعة البرق. مع ذلك عرفنا وقتها أن هناك جماعات صغيرة نافذة وقوية
للغاية قادرة على اللعب حتى بالدول الكبرى من أجل مصالحها الخاصة. وإذا
كان الأمر كذلك، فلماذا لا نضع إشارات استفهام على الأحداث الكبرى التي
تضرب العالم منذ ذلك الحين، طالما أن المتضرر منها كل الدول والشعوب؟
لماذا لا نسأل عمن يقف وراء هذه الكارثة أو تلك؟ ماذا تريد تلك
الجماعات ولماذا تفعل كل ذلك بالعالم؟ ما هي أهدافها؟ لماذا تتصرف كما
لو أنها قوة إلهية؟
وأول سؤال إنساني بسيط، وربما ساذج، أريد أن أوجهه لتلك القوى والأفراد
الذين يتلاعبون بالمعمورة كما لو كانت كرة قدم: هل تعتقدون فعلاً أنكم
آلهة؟ ألا تأكلون وتشربون مثلنا؟ ألا تمرضون مثلنا؟ ألا تموتون مثلنا
مهما أكلتم وشربتم وأخذتم من المقويات والأدوية السحرية؟ ماذا تفعلون
بالترليونات التي تكدسونها من وراء هذه الكارثة العالمية أو تلك؟ هل
ستأخذونها معكم إلى القبور؟ بالطبع لا، ولا شك أنكم قرأتم حكاية
الاسكندر المقدوني الذي أمر أن يُخرجوا له يده من الكفن أثناء تشييعه
كي يقول للعالم: أنا الاسكندر الكبير الذي فتح العالم، ها أنا أخرج من
الدنيا خالي الوفاض، لا شيء بيدي غير الهواء الذي يمر بين أصابعي.
يشعر الكثير من أولئك الكبار بحزن وأسى عندما يجمعون ثروات طائلة ويصبحون قادرين على التحكم بالبشرية ثم يجدون أنفسهم فجأة ضحية للتقدم في العمر وأمراضه ومنغصاته
ماذا تستفيدون من إخضاع البشر والتلاعب بلقمة عيشهم مثلاً وتجويعهم
وتشريدهم والتنكيل بهم على طريقة جهنم؟ من أعطاكم التفويض لتحددوا عدد
المواليد في العالم؟ من فوضكم كي تقضوا على مليارات البشر بالفيروسات
والأمراض والحروب؟ وماذا تستفيدون أنتم إذا أصبح عدد سكان العالم
ملياراً ذهبياً بدل سبعة إذا كنتم ستغادرون هذا العالم عاجلاً أو
آجلاً؟ هل أنتم مفوضون من الله عز وجل لمحاسبة البشرية ومعاقبتها؟ كيف
تفكرون؟ ما هي عقولكم؟ أرجوكم أخبرونا كيف تنظرون للعالم؟ وما الذي
يجعلكم تتصرفون بهذه الطريقة الشيطانية المريعة مع أبناء جلدتكم من
مليارات البشر؟ هل تعتقدون أن لديكم قوة وعقلية إلهية، أم إنكم تمتلكون
فقط عقلية الشياطين القذرة بامتياز؟
لا شك أننا نعلم مثلاً أن أصحاب المليارات القلائل الذين يلعبون بمصير
البشر ينفقون منذ سنوات المليارات على البحوث لتطويل أعمارهم لمئات
السنين، وفعلاً هناك شخصيات كبرى تمول مشاريع بحثية لجعلها تعيش فترة
أطول بكثير من أعمارنا العادية. ويشعر الكثير من أولئك الكبار بحزن
وأسى كبير عندما يجمعون ثروات طائلة ويصبحون قادرين على التحكم
بالبشرية ثم يجدون أنفسهم فجأة ضحية للتقدم في العمر وأمراضه ومنغصاته،
لهذا بدأوا يعملون على إيجاد طرق شيطانية لتجديد الخلايا وإطالة
الأعمار. لكن حتى لو نجحوا في ذلك، فلن يعيشوا للأبد، ولن يكونوا آلهة،
وسيكون مصيرهم كمصير أي إنسان عادي يقف بين يدي الله إذا كانوا يؤمنون
بيوم الحساب. وحتى لو لم يؤمنوا بذلك، فإن نهايتهم بكل الأحول ستكون
كنهاية أي جسد بشري بعد الموت، التحلل ومن ثم التراب. فلماذا إذاً
التصرف بهذه الطريقة الفوقية مع العالم؟
ماذا تستفيدون مثلاً إذا سيطرتم على عقول البشر من خلال امبراطورياتكم
الإعلامية من صحف ومجلات وإذاعات وتلفزيونات ومواقع تواصل وانترنت
وغيرها؟ ربما ستستمتعون بالتحكم بتفكير الشعوب لساعات وأيام وحتى عقود،
ولكن ماذا بعد أن تخرجوا من الدنيا؟ بماذا تفيدكم كل خزعبلات التحكم
والقيادة والهيمنة والجبروت الزائل؟ لماذا لم تفكروا مثلاً باستغلال
منتوجاتكم التاريخية في الإعلام والاقتصاد والتكنولوجيا لخدمة الإنسان
بدل استغلالها في إيذائه بالحروب والمجاعات والفقر والتنكيل وغسل
الأدمغة والتلاعب بالعقول؟
ربما تضحكون من أسئلتي الإنسانية الساذجة هذه. وأنا أقول لكم: اضحكوا
كما تشاؤون، لكنكم مهما سيطرتم وتجبرتم وتفوقتم وتلاعبتم بالبشرية،
فمصيركم كمصير أي مخلوق بائس في أدغال البلدان المسحوقة، فتمتعكم
بإنجازاتكم التاريخية سينتهي بانتهاء آخر نفس لكم، ولن يكون مصير
أجسادكم أفضل من مصير جسد أي إنسان معدم تلاعبتم بلقمة عيشه وعذبتموه
بالأمراض، والفقر والمجاعة والفيروسات.
هل سمعتم ببيت أبي العلاء المعري الشهير أيها الأوباش:
خَفّفِ الوَطْء ما أظُنّ أدِيم
الأرْضِ إلاّ مِنْ هَذِهِ الأجْسادِ
كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com
كفاكم تطبيلاً وتزميراً
للمستعمرين الجدد!
د. فيصل القاسم
ليس لدينا أدنى شك بأن أمريكا نفسها قامت على جماجم أكثر من مائة
وثمانية مليون هندي أحمر، ولا داعي لسرد الحروب والغزوات التي شنتها
أمريكا على بلدان عدة وأسقطت حكوماتها ونهبت ثرواتها، وآخرها طبعاً
أفغانستان والعراق. ولا ننكر أيضاً أن النظام الدولي الذي نشأ في أعقاب
سقوط الاتحاد السوفياتي بقيادة أمريكا لم يكن مطلقاً نظاماً عادلاً، بل
كان ومازال نظام هيمنة وجبروت وتسلط بامتياز. ولا يمكننا أيضاً أن ننسى
التاريخ الأوروبي الاستعماري وما فعله بالعالم الثالث لعقود وعقود. هذه
أصبحت بديهيات للجميع، ولا يتناطح فيها عنزان. لكن هل يا ترى تحاول
روسيا من خلال تصديها للغرب بناء نظام دولي جديد لتحقيق العدالة في
العالم وردع الكاوبوي الأمريكي؟ أم أنها تنافسه على أشلاء المعمورة
وثروات شعوبها لا أكثر ولا أقل؟ لماذا يحاول بعض القومجية العرب ومن لف
لفهم أن يصوروا الغزو الروسي لأوكرانيا على أنه خطوة مباركة لإعادة
التوازن للنظام الدولي ووضع حد للتسلط الأمريكي على العالم؟
هل يمكن أن تنتقم من الغزو الأمريكي للعراق مثلاً بغزو أوكرانيا وتهجير
عشرة ملايين من سكانها وتدمير مدنها والاستحواذ على خيراتها وثرواتها؟
ما الفرق إذاً بين الغزو الأمريكي للعراق والغزو الروسي لأوكرانيا؟
أمريكا دمرت البنية التحتية في العراق، وقتلت وشردت ملايين العراقيين،
ووضعت يدها على ثروات البلاد، وهذا صحيح، لكن ألم تفعل روسيا الشيء
نفسه في أوكرانيا وبنفس الوحشية والبشاعة؟ ماذا يستفيد ضحايا الغزو
الأمريكي للعراق من التنكيل الروسي بالشعب الأوكراني وتدمير وطنه
وتشريده بالملايين؟ هل خطيئتان تصنعان صواباً؟ بالطبع لا.
ألا يقتضي المنطق الإنساني أن يتعاطف العرب الذين عانوا ومازالوا يعانون شتى أنواع الاحتلالات والغزوات مع الشعب الأوكراني بغض النظر عن أي شيء آخر؟
وكي لا ننسى، ألم يقم الاتحاد السوفياتي سلف روسيا اليوم بغزو
أفغانستان عام 1979 قبل أن تغزوها أمريكا لاحقاً؟ ألم تكن نتيجة
الاحتلال السوفياتي لأفغانستان كارثية بكل المقاييس؟ كلنا اليوم يتحدث
عن ملايين العراقيين الذين قتلتهم وشردتهم وعذبتهم أمريكا، وهذه حقيقة،
لكن لماذا ننسى أن السوفيات شردوا بعد غزوهم لأفغانستان أكثر من خمسة
ملايين أفغاني، وقتلوا أكثر من مليون شخص؟ لماذا لا نسمع عن هذه
الإحصائيات في الإعلام العربي وحتى الإسلامي؟ ألم تكن أفغانستان ضحية
الوحشية السوفياتية قبل أن تقع تحت براثن الوحشية الأمريكية لاحقاً؟ هل
الاحتلال الأمريكي لأفغانستان حرام بينما الاحتلال السوفياتي كان
حلالاً زلالاً يا من تصفقون للوحشية الروسية في أوكرانيا اليوم؟
ولماذا تتناسون أيضاً أن الغزو الروسي لسوريا كان بضوء أخضر أمريكي
وغربي بشهادة مسؤولين أوربيين وأمريكيين كبار، فقد اعترف أندرو أكسوم
مساعد وزير الدفاع الأمريكي أمام الكونغرس أن الغزو الروسي لسوريا وما
تلاه من قتل وتنكيل وتشريد للسوريين كان بالتنسيق مع أمريكا. وقد أقر
رئيس وزراء فرنسا الأسبق دوفلبان بأن الغرب أخطأ خطأً فادحاً عندما
أطلق أيدي الغزاة الروس في سوريا ليعيثوا فيها قتلاً وتدميراً وتخريباً
ونهباً وسلباً. ثم جاء رئيس الوزراء اليوناني ليقول كلاماً مماثلاً ما
معناه أنه لو لم يبارك الغرب الاحتلال الروسي لسوريا لما تشجع بوتين
لفعل ما يفعله اليوم في أوكرانيا؟ بعبارة أخرى فإن الدب الروسي الذي
يعلق بعض العرب عليه آمالهم لمواجهة الكاوبوي الأمريكي يتحالف مع
الغزاة الأمريكيين هناك وهناك حسبما تقتضيه المصلحة، بدليل أنه بالرغم
من الصراع بين الروس والأمريكيين في أوكرانيا، إلا أنهم في وئام
وانسجام في سوريا لأن الطرفين مع إسرائيل تلتقي مصالحهم في تقسيم سوريا
وتهجير شعبها والتحكم بنظامها.
لا شك أن بعض العرب سيجد لروسيا الأعذار لغزو أوكرانيا، ويعتبره حقاً
مشروعاً لمواجهة الغرب بحجة أن الغرب يقترب من حدود روسيا. وهذه حجة
سخيفة جداً لا تختلف عن حجج أمريكا الواهية التي غزت بموجبها العراق
وأفغانستان أبداً.
ومما يحز في النفس أكثر أن بعض العرب الذين يصفقون للغزاة الروس في
أوكرانيا يرزحون تحت احتلالات مشابهة. ماذا تستفيد القضية الفلسطينية
إذا غزا الروسي أوكرانيا وأحرقها ونكل بشعبها وطرده خارج وطنه؟ أليس من
العبث التصفيق للغزو الروسي لأوكرانيا وأنت تعاني من الاحتلال
الإسرائيلي لفلسطين، والاحتلال الإيراني لأربع عواصم عربية بشهادة
الملالي أنفسهم؟ ألا يقتضي المنطق الإنساني أن يتعاطف العرب الذين
عانوا ومازالوا يعانون شتى أنواع الاحتلالات والغزوات مع الشعب
الأوكراني بغض النظر عن أي شيء آخر؟
لماذا يعلق البعض آمالاً على المستعمر الصيني القادم؟ ألم يروا نتائج
الاستعمار الصيني الجديد قبل فترة في سيرلانكا؟
ألم نكتشف أن كل الدول التي تساعدها الصين مرهونة للقروض الصينية وفي
أي لحظة تعجز تلك البلدان عن تسديد ديونها للصين، تصبح بشكل أوتوماتيكي
مستعمرات صينية كاملة الأوصاف. بدل الاستنجاد بوحش على آخر أيها العرب،
حاولوا أن تخرجوا من حظيرة الاستعمار. ليس هناك مستعمر طيب ومستعمر
شرير. ولا ينقذ النخاس من نخاس. كفاكم تطبيلاً وتزميراً للمستعمرين
الجدد: «شهاب الدين أسوأ من أخيه». نعتذر عن كتابة العبارة الأصلية.
كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com
(القدس العربي)
