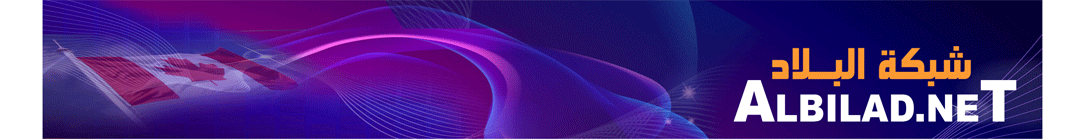
*هيفاء زنكنة كاتبة وصحفية وناشطة عراقية تقيم في بريطانيا تكتب اسبوعيا في جريدة (القدس العربي(
مقالات سابقة
المقاومة العراقية
والمُستعمر ذو النوايا الطيبة
هيفاء زنكنة
في استعراضه لمسؤوليات وزارة الدفاع البريطانية، في مجلس العموم، يوم
13 آذار/ مارس، ذكّر وزير الدفاع بَن والاس المجلس بتزايد التهديدات في
العالم حيث « يستمر الشرق الأوسط في إيواء الإرهاب» لهذا السبب «لا
تزال المملكة المتحدة تدعم حكومة العراق كجزء من التحالف العالمي ضد
داعش». مبينا، كمثال، استخدام طائرة عن بعد (درون) تابعة لسلاح الجو
الملكي البريطاني بشن غارة على عضو قيادي في داعش في شمال سوريا وإطلاق
صاروخين من طراز هلفاير. وأن استخدام الدرون القاتل كان ضروريا لأن «
نشاط الفرد كان مرتبطًا بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية… وهذه
الإجراءات حيوية لتقويض مثل هذه التهديدات الإرهابية، وحماية المواطنين
البريطانيين ودعم شركائنا الدوليين».
كيف نقرأ هذا التصريح؟ ما هي الرسالة التي يخلفها قول وزير الدفاع
«يستمر الشرق الأوسط في إيواء الإرهاب» في عقول مستمعيه في بريطانيا
وأمريكا وعموم أوروبا؟ آخذين بنظر الاعتبار أن تصريحه كان في مجلس
العموم البريطاني والذي تتم نقل جلساته مباشرة بواسطة الإعلام المرئي
والمسموع، بالإضافة إلى تناقله في الصحافة المكتوبة. تكمن خطورة هذه
التصريحات وتغطيتها إعلاميا، في تشكيلها وعي المواطن الغربي. خاصة وأن
نقل جلسات البرلمان يتم عبر قنوات البي بي سي، والذي تشير استبيانات
الرأي العام إلى أن 79 بالمئة من متابعي الأخبار البريطانيين يثقون بما
تبثه. وغالبا ما يتم بث الخطب التي يراد إيصالها إلى أكبر عدد ممكن من
المستمعين والمشاهدين في أوقات يكون فيها المتلقي على استعداد للإصغاء
والرضا. ليس مستغربا، إذن، ومن ناحية حجم الرضا، عند سؤال البريطانيين
عما إذا كانوا يعتقدون أن قرار الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بخوض
الحرب كان صائباً أم خاطئاً، قال 54 بالمئة إنه كان صائباً. وعلى
الرغم من حجم المظاهرات الكبير لمناهضي الحرب، قبل بدء الهجوم على
العراق، ما أن أعلن جورج بوش وتوني بلير بدء الغزو تحت مُسمى « عملية
حرية العراق» حتى ارتفع الدعم الشعبي للحرب مساندة للقوات. فوصل
التأييد للحرب، وفقًا لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة غالوب، إلى 72 بالمائة
في الفترة من 22 إلى 23 آذار/ مارس.
لا يمكن، بأي حال من الأحوال، اعتبار تصريح وزير الدفاع البريطاني زلة
لسان أو تصريحا شخصيا قابلا للتأويل كوجهة نظر، كما أثارت زلة لسان
الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن وصف فيها غزو العراق بأنه «وحشي
وغير مبرر» في إطار حديثه عن الحرب الروسية في أوكرانيا، بل يجب
التعامل معه كموقف سياسي حكومي مبني على أيديولوجيا عنصرية منهجية ترى
في الشرق الأوسط مأوى للإرهاب، وتقدمه إلى العالم بهذا الشكل، وتتعامل
معه وفق هذا المنظور كما نرى في فلسطين والعراق وسوريا.
لماذا؟ ما الذي يمنح ترسيخ هذه الصورة أهميتها في السياسة البريطانية،
والمستنسخة، غالبا، في التوجه السياسي والإعلامي الغربي، وفي الإعلام
العربي بمفارقة تُجسد الاحساس بالدونية؟
بينما يعمل الاستعمار، بتحويراته الناعمة/ القاتلة الجديدة، بمثابرة لا تكل على تحقيق سياسته في الاستغلال الاقتصادي والهيمنة العسكرية والأيديولوجية، لضمان وجوده، عبر الاتفاقيات ورعايته طبقة الحكام بالنيابة، وصمته المدوي عن جرائمها، سيبقى الأمل في النهوض الجماهيري
يهدف تكرار وترسيخ هذه الصورة إلى تجريد شعوب المنطقة « الأخرى» من
إنسانيتهم، فلا يثيرون أي تعاطف أو تقارب أو مسؤولية أخلاقية، إذ يتم
اختزال وجودهم في سيرورة الإقصاء الأخلاقي، إلى مصدر للتهديد والخطر،
وبالتالي تسويغ التخلص منهم. وهو ما عملت الإدارة الامريكية والمملكة
المتحدة على تسويقه في غزوها للعراق، ومنح قواتهما الضوء الأخضر
لارتكاب الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان، من التعذيب في بوكا وأبو غريب
إلى مجازر مدينة حديثة والقائم. فمن السهل ممارسة أبشع الفظائع إذا
كانت ضد « الآخر- الإرهابي» والذي لا يُثير قتله تساؤلا كما لا يُشكل
معضلة أخلاقية بل بالعكس تماما، حينئذ يُصبح القتل ضروريا لحماية
المواطنين. وهو التبرير الذي لجأ إليه وزير الدفاع البريطاني عند
استخدام الدرونز القاتلة والصواريخ لتنفيذ عمليات الاغتيال، خارج
القانون، في بلدان أخرى. كون البلدان التي يتم قصفها مأوى للإرهابيين»
الذين يشكلون تهديدا لأمن وحماية المواطنين البريطانيين ودعم شركائنا
الدوليين وهذه الإجراءات حيوية لتقويض مثل هذه التهديدات الإرهابية»
حسب قوله. وهو ذات التبرير الذي تتبناه أمريكا في عمليات القتل
المُستهدف، أي القتل العمد مع سبق الإصرار لأفراد مختارين من قبل دولة
ليسوا رهن الاحتجاز لديها، كما فعلت في باكستان واليمن، وكما يواصل
الكيان الصهيوني استهداف قادة المقاومة الفلسطينية في غزة، برعاية
الصمت الدولي.
يُعيدنا تصريح وزير الدفاع البريطاني الحالي، إلى الحملة الدعائية
المُكثفة التي حَشدّت لها الحكومة البريطانية كل السبل لتشويه صورة
المقاومة العراقية حال انطلاقها بعد أيام قليلة من الغزو عام 2003. وهي
لا تختلف كثيرا في مضمونها عما تُتهم به حركات المقاومة، في البلدان
المحتلة، في أرجاء العالم، فالعمق العنصري الاستعماري واحد. فمن إتهام
سكان أمريكا الأصليين بالهمجية إلى إطلاق ألقاب مهينة ضد المقاومة
الفيتنامية، ومن إتهام الأفغانيين بالتخلف إلى إتهام المقاومة
الفلسطينية والعراقية بالإرهاب. فحيثما يحلُ المُستعمر ويُواجه بمقاومة
أهل البلد لسياسته الإمبريالية، يجد في تشويه صورتهم أداة فاعلة لطمأنة
الرأي العام في بلده هو بأن كل ما يقوم به هو لصالحه، مهما كانت وحشية
الجرائم التي يرتكبها ولم تعد خافية على أحد.
وحين تُطلق على أهل البلد المُحتل ومقاوميه ألقابا تحط من قيمتهم،
حينئذ يكون من السهل على قوات الاحتلال أن تُبين للعالم مدى ُنبلها
وتضحيتها بنفسها لتُخلص العالم من خطر المجموعات الإرهابية. ففي
العراق، واظب المحتل والمجموعات العراقية التي استساغت التعاون معه
وتوسل دعمه، على تغييب مفردة المقاومة/ المُقاوم من معجم التداول
السياسي والإعلامي لتحل محلها مفردات تحث في مضمونها على شرعنة القتل
وتوفير الحصانة للقتلة مثل: أزلام صدام، جيش صدام، القاعدة، جهادي
إسلامي، متطوع أجنبي، متمرد سني، من مثلث الموت السني. وكلها مُلحقة
بوسم « إرهابي».
وبينما يعمل الاستعمار، بتحويراته الناعمة/ القاتلة الجديدة، بمثابرة
لا تكل على تحقيق سياسته في الاستغلال الاقتصادي والهيمنة العسكرية
والأيديولوجية، لضمان وجوده، عبر الاتفاقيات ورعايته طبقة الحكام
بالنيابة، وصمته المدوي عن جرائمها، سيبقى الأمل في النهوض الجماهيري،
ومقاومته، بكافة المستويات. وأن تبقى مقاومة الشعوب حية فليس كل من
ناضل من أجل الكرامة والعدالة والوحدة الوطنية ومواجهة خطر الهيمنة
وخطط التقسيم والتجزئة، هو إرهابي كما يحاولون تقديم صورته.
كاتبة من العراق
(تمكين) المرأة العراقية بعد
عشرين عاما من الغزو والاحتلال
هيفاء زنكنة
كما في كل عام، أعلن مكتب الأمم المتحدة في العراق، في اليوم العالمي
للمرأة «التزامه بدعم حقوق النساء والفتيات في العراق، والدعوة لتسريع
تمكينهن وكذلك تعزيز المساواة بين الجنسين» مما يأخذنا إلى محاولة
النظر في تفاصيل ما حققته إعلانات الالتزام بـ«التمكين» حتى الآن،
وخلفية أسباب التدهور المُزمن في وضع المرأة؟
يتزامن يوم المرأة العالمي، منذ عشرين عاما، مع شهر تنفيذ مشروع القرن
الأمريكي الجديد في العراق «لتشكيل قرن جديد يلائم المبادئ والمصالح
الأمريكية». وكان غزو واحتلال العراق خطوته الأولى للامتداد في بقية
البلدان العربية. وكان قدر المرأة العراقية أن يكون «تحريرها» أحد
أسباب التسويق الإعلامي لسردية الحرب العدوانية. وما كان ذلك سيحدث
لولا مشاركة «نسويات استعماريات» جمعن بين المصلحة الشخصية والرغبة
بالانتقام وكسب المناصب. جراء ذلك حصدت المرأة، عموما، انعكاسات سياسة
تجمع ما بين لا أخلاقية السياسة الخارجية المبنية على الهيمنة
والاستغلال للغزاة. بالتحالف مع العمل على بعث الحياة في تقاليد كانت
المرأة قد تجاوزت معظمها في مسيرة نضالها من أجل التحرر الوطني
والمجتمعي. حيث كادت أن تصل إلى قمة هرم توفر الاحتياجات الإنسانية
التنموية كالتعليم والصحة والعمل والانخراط في المجال العام، وما يترتب
على ذلك من مشاركة سياسية، لولا حماقة النظام السابق في غزو الكويت،
بعد حرب 8 سنوات مع إيران، وتوفير الأرضية الملائمة لفرض الحصار القاتل
بقيادة أمريكا وفتح بوابات البلد للغزاة عام 2003.
والآن بعد عشرين عاما من الغزو… ماذا عن المرأة؟ عن تحريرها أو ادعاءات
تحريرها؟
أولا: هناك حقيقة، مدعومة بالأرقام والإحصائيات، علينا ألا ننساها،
آخذين بنظر الاعتبار أن ربع سكان العراق، هم بعمر سنوات الغزو
والاحتلال. الحقيقة التي يجب أن تبقى محفورة في الذاكرة الوطنية، كما
في جزائر الشهداء، كما في فيتنام هي أن مليون رجل وامرأة وطفل كانوا
ضحايا الغزو والاحتلال أما بشكل مباشر أو غير مباشر. هذه الحقيقة، هذه
التكلفة الباهظة من حياة المواطنين، يجب أن تكون العدسة التي ننظر من
خلالها إلى واقع الحال العراقي، عموما، والمرأة خاصة، حاليا ومستقبلا.
وأن نواصل النظر والتذكير. فكل من ساهم بالتطبيل للاحتلال وادعاءات
التحرير سواء في أمريكا وبريطانيا وغيرهما من دول تحالف الغزو،
بالإضافة الى من تعاون معهم من عراقيين، يريدون مسح هذه الحقيقة، آملين
إصابة الشعب بالخرف وفقدان الذاكرة. هل رأيتم مجرما يُذكِر الناس
بجريمته؟ وهل رأيتم قاتلا يرفع يديه المغطاة بالدماء معترفا بجريمته؟
ولنا في رئيس وزراء بريطانيا السابق توني بلير والرئيس الأمريكي جورج
بوش أمثلة يتسابق على محاكاتها مسؤولو « العراق الجديد».
لا يمكن إطلاقا أن تتحرر المرأة بدون تحرر الرجل معها (شريكا الوطن) من كل أشكال الهيمنة والاستغلال الخارجية والداخلية، مهما كانت التسميات، سواء كانت احتلالا عسكريا استيطانيا أو استعماريا جديدا، بلا معسكرات على أرض البلد المُحتل، بل عبر منظومة القوة الناعمة والطائرات القاتلة
ثانيا: لا يمكن إطلاقا أن تتحرر المرأة بدون تحرر الرجل معها (شريكا
الوطن) من كل أشكال الهيمنة والاستغلال الخارجية والداخلية، مهما كانت
التسميات، سواء كانت احتلالا عسكريا استيطانيا أو استعماريا جديدا، بلا
معسكرات على أرض البلد المُحتل، بل عبر منظومة القوة الناعمة والطائرات
القاتلة عن مبعدة (الدرونز) و«معاهدات» التضليل المبنية على أن تواجد
قوى الاستغلال يتم بناء «على دعوة الحكومة المحلية» والشراكة
الاستراتيجية في محاربة الإرهاب وتقديم الاستشارة والتدريب والدعم
وتبادل الخبرة.
بطبيعة الحال، لا تغفل سيرورة القوة الناعمة وجود المرأة ولكن وفق
منظور يُعزز أيديولوجية المُستعمر (ولنتفق أن القوة الناعمة تغليف جميل
للاستعمار القديم والجديد) حيث تقدم لنا سنوات الاحتلال أمثلة صارخة
حول كيفية تطبيق ذلك كله على حساب حياة المرأة وامتهان كرامتها، في ظل
توليفة جمعت مصلحة المُستعَمر بمن تم تنصيبهم ورعايتهم أو السكوت على
جرائمهم من المسؤولين العراقيين الذين وجدوا في إحياء الممارسات
المجتمعية الموشكة على الانقراض، أو بقاياها في القوانين، خزينا وأداة
لحجب صوت المرأة وتغييب وجودها.
ثالثا: لنفترض أن ما تعيشه المرأة العراقية اليوم، مرده بالدرجة
الأولى، ليس التدهور الصحي والتعليمي والاقتصادي والأمني العام الشامل
للبلد ككل، وليس الفساد العنكبوتي الهائل وغياب القانون، وليس فشل
الدولة بمؤسساتها المتقاسمة بين أحزاب وميليشيات ترى في المواطن عبئا
لا ضرورة لوجوده في بلد ريعي، وترى المرأة سلعة للاتجار والمتعة. فما
الذي ستقدمه السردية الرسمية لتدهور وضع المرأة وماهي سبل المعالجة
المقترحة؟ تركز معظم التقارير الدولية، بضمنها الأمم المتحدة والبنك
الدولي والاتحاد الأوروبي بالإضافة الى تقارير الإدارة الأمريكية
والحكومة البريطانية، على ضرورة مشاركة المرأة في الحياة السياسية وسوق
العمل. ومنذ عشرين عاما والحل المُقترح لا يخرج عما يُطلق عليه تسمية»
إطلاق برنامج جديد لتمكين المرأة». وتحتل مفردة «التمكين» أهمية قصوى
في تقارير المنظمات الدولية وتكررها معظم منظمات المرأة المحلية لضمان
حصول الدعم المادي لبرامج مستحدثة، تُطلق في ورشات بفنادق فخمة، بحضور
عدد منتقى من نسوة، غالبا ما يكُّن جزءا من المنظومة الرسمية، ولا يجدن
ضيرا في تنفيذ سياسة أحزابهن، على حساب المرأة. وفي الوقت الذي لا يكاد
يخلو بيان أو تصريح رسمي من « العمل على تمكين» المرأة، بل وذهبت أمانة
مجلس الوزراء أبعد من ذلك وأسست مديرية تمكين المرأة. التي ستشرف على
ما أطلقت عليه «استراتيجيتها الوطنية للمرأة العراقية 2023-2030 «. وفي
الوقت الذي تُركز فيه التقارير الدولية، عند إشارتها إلى وضع المرأة
على «الهوية الجنسية والتوجه الجنسي، وقوانين الأخلاق» وهي حقوق على
المجتمع والسلطات التشريعية والتنفيذية العمل على تحقيقها، ولكن ليس
بمعزل عن بقية جوانب الحياة الكريمة للمواطنين جميعا. من الطفل إلى
المرأة والرجل، من الريف إلى المدينة. من الصحة لإعادة تأهيل البنية
التحتية لخدمات الرعاية الصحية الأولية، والتعليم والسكن والعمل. وبدون
النية السياسية الوطنية النزيهة الصادقة سيبقى العراق على ما عليه الآن
بوضعه الكارثي: وجود ما يقرب من 3 ملايين شخص (1.3 مليون طفل) في حاجة
إلى المساعدة الإنسانية. ويشمل مليون شخص من ذوي الاحتياجات الإنسانية
الحادة.
لا يزال حوالي 1.17 مليون نازح داخليًا نازحين في المخيمات والمستوطنات
خارج المخيمات والمجتمعات المضيفة. أقل من 15 بالمئة من النساء يشاركن
في سوق العمل. وتواجه النساء، خاصة، الاستغلال الجنسي والإيذاء والعنف
القائم على النوع الاجتماعي والاتجار بالبشر وانعدام الأمن الاقتصادي
وعدم كفاية الوصول إلى الصحة والتعليم والخدمات الأساسية الأخرى، أي
الافتقار إلى وسائل العيش في ظروف آمنة وكريمة. وإذا لم يتم النظر إلى
معالجة الأسباب الحقيقية وتشخيص المسؤولية ومساءلة المسؤولين، سيبقى
«تمكين» المرأة، إعلانا ترويجيا للاستهلاك السياسي المحلي برعاية
دولية.
كاتبة من العراق
العراق الجديد:
مكافحة الفساد أم تشريعه؟!
هيفاء زنكنة
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن مكافحة الفساد
والإصلاح الاقتصادي من أولويات الحكومة. وأن الفساد هو التحدي الأول
الذي تواجهه حكومته. كما كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، في العراق، عن
أوامر القبض والاستقدام الصادرة، في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2022،
التي شملت « 68 من كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا» بضمنهم وزير
الثقافة الأسبق ومدير مكتبه، بتهم فساد مختلفة، والتي تلت إصدار أوامر
بالقبض على 4 مسؤولين سابقين بينهم وزير مالية، ومقربون من رئيس
الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي، لاتهامهم بـ “تسهيل» الاستيلاء على 2,5
مليار دولار من الأمانات الضريبية، أو ما أطلق عليه « صفقة فساد
القرن».
هل تعني تصريحات رئيس الوزراء هذه، وأوامر إلقاء القبض والاستقدامات،
أن العراق مُقبل على التشافي من فيروس الفساد الذي جعله يُصنّف،
بجدارة، في العقدين الأخيرين، ضمن الدول الأكثر فساداً في العالم، حسب
مؤشرات مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية؟ وهل سيختلف
السوداني، من ناحية معالجة البلد من الفساد، عن غيره من رؤساء الوزراء
الذين تعاقبوا على حكمه، منذ غزوه واحتلاله؟
تزودنا تفاصيل خطب رؤساء الوزراء الذين سبقوا السوداني ووقائع ما تم
تنفيذه، على أرض الواقع، بصورة أبعد ما تكون عن التفاؤل. بل وتقودنا،
عند رصد الأعراض المزمنة إلى خلاصة مفادها أن فيروس الفساد، عند توفر
البيئة الملائمة، يواصل الاستشراء ولكن بتحويرات جديدة، تمنحه البقاء،
مع كل رئيس وزراء جديد.
ولنعد إلى الوراء قليلا. في مراجعة سريعة لسجل من سبق السوداني من
رؤساء الوزراء، سنجد أن تصريحاتهم، جميعا، بلا استثناء، مطلية بوعود
محاربة الفساد. وكأن الفساد لعنة آلهة مجهولة أو مادة مصدرة من أماكن
نائية في العالم أو نقمة الطبيعة وليست ممارسة ساسة يجدون في الفساد
آلة لتفكيك الدولة وإحكام هيمنتهم عبر بدائل يرون فيها مصلحتهم. ولعل
أبرز ما يميز تعامل الحكومات المتعاقبة، هو اتهام كل حكومة جديدة
سابقاتها بالفساد وإصدار أوامر اعتقال نادرا ما تُطبق أما لكون المتهم
ينتمي إلى حزب متنفذ أو هارب ليتنعم بما سرقه خارج العراق.
ولنبدأ بحكومة إبراهيم الجعفري (2005 ـ 2006). حيث استّهل خطابه الأول
مشيرا إلى « قضايا الفساد الإداري وما يفرزه هذا الفساد من معـوقـات
على صعيد التنمية والسبل الكفيلة بمعالجته وعلاقة الفساد بالوضع الأمني
المتدهور». ثم أمر بإصدار مذكرات توقيف بحق اثنين من وزراء الحكومة
السابقة «. ولم يتم ذلك بل أن الجعفري نفسه الذي تم تعيينه وزيرا
للخارجية واجه اتهامات» فساد مستشر في سفارات العراق في الخارج، وهدراً
لأموال الدولة، فضلاً عن المحسوبية والوساطات في أروقة وزارة
الخارجية». واعتبر حيدر العبادي (2014 إلى عام 2018) أن الفساد تهديد
يضاهي الإرهاب، واعدا بمكافحة هذه الآفة ولو كلفه الأمر حياته، مشيرا
إلى أن الحكومة تدفع رواتب نحو 50 ألف جندي غير موجودين.
محمد شياع السوداني في مسيرة المزايدات بمكافحة القضاء على الفساد، يكرر ذات الأسطوانة المُهينة للشعب، فيلقي الخطب ويُوجه بتشكيل هيئة عليا لمكافحة الفساد، كبديل للجنة العليا لمكافحة قضايا الفساد التي شكّلها الكاظمي، وكأن تغيير الاسم سينظف البلد من شبكة الأحزاب والميليشيات
وعند مقارنة إجراءات هيئة النزاهة اليوم بالأمس سنجد أن رئيس الوزراء
نوري المالكي (2006 ـ 2014) هو الأب الحقيقي لسيرورة الفساد تحت ستار
النزاهة، متفوقا بذلك على نهب الشركات الأمريكية وعقودها الخيالية.
ففي27 -5-2009، أعلنت هيئة النزاهة حملة «مكافحة التلاعب بالمال» العام
في المؤسسات الحكومية. وأصدرت 387 أمر اعتقال في إبريل/ نيسان وحده،
مؤكدة أن الحملة ستشمل ألف مسؤول بسبب الفساد. وأن الحكومة لن تلتزم
الصمت إزاء الفساد بعد اليوم وستلاحق جميع الفاسدين وستقدمهم للعدالة.
لكن ما لم تذكره البيانات الحكومية الصادرة من مكتب المالكي أن حملة
الاعتقالات كانت لتعزيز طائفية حكومته وحصر العقود بأنواعها بين أتباعه
لأحكام هيمنة حزبه على المؤسسات.
وفي 10 مارس 2019، لم يُشر رئيس الوزراء الذي تلاه عادل عبد المهدي (25
أكتوبر/ تشرين الأول 2018 ـ ديسمبر/ كانون الأول 2019) إلى خلطة
الطائفية والمحاصصة والفساد السامة، بل توقف عند الفساد لوحده، متحدثا
عن وجود أكثر من 40 ملفاً ضمن ما أسماه « خارطة الفساد» وتغطي كل مؤسسة
في الدولة وكل جانب من جوانب الحياة في البلد من تهريب النفط إلى
الاتاوات و «القومسيونات» والسجون ومراكز الاحتجاز والمخدرات وتجارة
الآثار إلى مزاد العملة والتحويل الخارجي وبيع المناصب
والعقود الحكومية والكهرباء والوظائف الوهمية والاتجار بالبشر.
والمفارقة أن تم مناقشة الخارطة في مجلس النواب برئاسة محمد الحلبوسي
(الذي لايزال في ذات المنصب) وحضور رئيس الجمهورية، برهم صالح «
لمناقشة توحيد جهود مكافحة الفساد الإداري والمالي الذي بلغ حجمه في
تسعة آلاف مشروع حكومي، بنحو ثلاثمئة مليار دولار أمريكي. ولم تتم
استعادة دولار واحد من تلك السرقات. أعقب ذلك تعيين مصطفى الكاظمي
رئيسا للوزراء (7 أيار 2020 حتى 13 أكتوبر 2022). حيث، وكما بات
مألوفا، تم توجيه تهم الفساد إلى حكومة المهدي حالما شرع الكاظمي
بإلقاء الخطب عن محاربة الفساد وتفعيل دور الأجهزة الرقابية المختصة
واعتقال عدد من مسؤولين صغار بدون مس الكبار، وتشكيل لجان محاسبة أصبحت
هي نفسها، عبر السنوات، جزءا من منظومة وملهاة الفساد.
وها هو محمد شياع السوداني في مسيرة المزايدات بمكافحة/ محاربة/ القضاء
على الفساد، يكرر ذات الأسطوانة المُهينة للشعب، فيلقي الخطب ويُوجه
بتشكيل هيئة عليا لمكافحة الفساد، كبديل للجنة العليا لمكافحة قضايا
الفساد التي شكّلها الكاظمي، وكأن تغيير الاسم سينظف البلد من شبكة
الأحزاب والميليشيات المتنفذة خارج نطاق القانون والمافيات القريبة
منها. وكما بات مألوفا، أيضا، أصدر الكاظمي بيانا يدين فيه اتهام
واعتقال مسؤولي حكومته ليتهم بدوره إجراءات السوداني واصفا إياها بأنها
كيد « يكشف محاولات التستر المستمرة على المجرمين الفعليين، وهروب إلى
الأمام واستهداف خصومٍ سياسيين» مضيفاً «ما جرى ليس سوى استحضار عرض
إعلامي وسياسي، ومحاولة خلطٍ للأوراق للتستر على السرّاق الحقيقيين،
بدلاً من السعي الجاد لإحقاق العدالة وكشف الحقيقة».
المضحك المبكي أن تحمل تصريحات رؤساء الوزراء كلهم الحقيقة حالما
يُتهمون بالفساد ليس لتنظيف البلد من الفيروس المستوطن ولكن لتوجيه
الأنظار بعيدا عن دورهم المنهجي في نشر الفيروس. ولعل السوداني، يتهيأ
من الآن بإعداد بيان يتهم فيه من سيليه بالكيد والتستر على السراق
الحقيقيين. فالكل يلتهمون وجبات الفساد والاختلاف الوحيد بينهم هو حجم
اللقمة.
كاتبة من العراق
«هذا ما يبدو عليه العالم يا طفلي»…
رسوم الأطفال من غزة وغيتو تيريزين
هيفاء زنكنة
لنتحدث عن معرضين لرسوم أطفال ينتمون إلى حقبتين زمنيتين مختلفتين في
مكانين مختلفين إلا أنهم يبقون أطفالا مُجبرين في عمرهم الغض أن يجدوا
معنى لما يمرون به وبضمنه الموت. ولنبدأ من الماضي لاستعادة ذكرى حدث
عاشه ورسمه أطفال يهود وقد يساعد على فهم حدث آخر مماثل تم منذ أيام
وقوعه في لندن حيث تم رفع أعمال فنية لأطفال فلسطينيين من غزة بالشراكة
مع أطفال بريطانيين. وقد يكون الربط بين المعرضين اختبارا لمقولة «
لئلا يكرر التاريخ نفسه» وألا يُصبح الضحية جلادا. فهل نجح التاريخ في
تجاوز تكرار نفسه؟
يأخذنا الحدث الأول إلى معرض «رسوم الأطفال من غيتو تيريزين 1942-1945»
المقام في متحف اليهود في براغ. يحكي المعرض، حسب التعريف به، قصة
الأطفال اليهود الذين تم ترحيلهم إلى حي تيريزين اليهودي خلال الحرب
العالمية الثانية والذي استخدمه النظام النازي كمحطة طريق إلى معسكرات
الاعتقال والموت في الشرق. ونقرأ حسب موقع المعرض الرسمي أن المعرض
يتألف من 19 قسما «تبدأ القصة بتأمل الأحداث التي تلت 15 مارس/ آذار
1939 مباشرة، عندما احتل النازيون بوهيميا ومورافيا وتحويلهما إلى
محمية. ويلي ذلك وصف لعمليات النقل إلى حي اليهود في تيريزين، والحياة
اليومية في الحي اليهودي والظروف السائدة في بيوت الأطفال. هناك أيضا
صور للاحتفالات بالأعياد والأحلام التي كان يحلم بها الأطفال المسجونون
بالعودة إلى ديارهم أو بالسفر إلى فلسطين».
يصف منظمو المعرض هذا القسم بأنه نوع من الفاصل الشعري بين الاقتلاع
الوحشي من منازلهم والترحيل إلى معسكر أوشفيتز، وهو الفصل الأخير
والأكثر مأساوية في القصة بأكملها. لأن تصوير القصة، حسب المنظمين، تم
من خلال رسومات الأطفال التي تم تنفيذها في ورشات رسم نظمتها وأشرفت
على تدريس الأطفال فيها الرسامة ومصممة المسرح وخريجة مدرسة « باوهاوس»
اليسارية النمساوية اليهودية فريدل ديكر ـ برانديز ألتي أعدمها
النازيون عام 1944.
إن تنظيم ورشات للأطفال داخل الغيتو ونوعية البرنامج الذي اتبعته فريدل
في التدريس، كما في كل الورشات الإبداعية، لابد وأن أَثر على نوعية
المُنتج أي رسومات الأطفال في هذه الحالة. يشير منظمو المعرض إلى أن
البرنامج كان في الغالب تعليميا سريا للأطفال، كانت فصول الفن محددة
جدا بطبيعتها، مما يعكس الأفكار التربوية التقدمية التي اعتمدتها فريدل
حيث كانت تنظر إلى الرسم على أنه مفتاح للفهم ووسيلة لتطوير المبادئ
الأساسية للتواصل، وكذلك وسيلة للتعبير عن الذات وطريقة لتوجيه الخيال
والعواطف. من هذا المنظور، كانت دروس الفن أيضا نوعا من العلاج،
وبطريقة ما ساعدت الأطفال على تحمل الواقع القاسي لحياة الغيتو.
من مفارقات اعتراض «منظمة محامون بريطانيون من أجل إسرائيل» على أعمال الأطفال وجود علم فلسطيني مرفوع على قبة الصخرة
كانت حصيلة ورشات فريدل حوالي 4500 رسم، قامت قبل قتلها بتجميعها
ووضعها في مكان سري حتى نهاية الحرب العالمية الثانية. لتبقى رسوم
الأطفال كتذكير مؤثر بالمصير المأساوي لحياة أطفال اليهود وجهود
الفنانة فريدل.
يلخص منظمو المعرض أهمية رسوم الأطفال قائلين «بدون الرسوم ستبقى أسماء
الأطفال منسية» و«الرسوم هي تذكير بحياتهم» مما يأخذنا إلى الحدث
الثاني أو موضوع المقارنة.
فهل هذا هو السبب الذي دفع «منظمة محامون بريطانيون من أجل إسرائيل»
إلى إجبار مستشفى، في لندن، على إلغاء عرض لمجموعة لوحات، بشكل صحون،
صممها أطفال في مدرستين للأونروا في غزة: مدرسة بيت لاهيا للبنات
ومدرسة جباليا الإعدادية للبنين، وتم تنفيذ التصميمات من قبل الأطفال
في مدرسة مستشفى تشيلسي المجتمعي، وكان عنوان العرض «عبور الحدود –
مهرجان اللوحات» حيث عُرض عند مدخل قسم العيادات الخارجية للأطفال؟ هل
هو الخوف من التذكير بوجود أطفال فلسطينيين يعيشون تفاصيل حياة يومية
مأساوية يعيد فيها تاريخ الإبادة نفسه، وقد بلغت حصيلة الشهداء من
الأطفال منذ عام 2000 حتى نهاية العام الماضي 2230 شهيدا؟ ودفعت آلة
القتل الصهيونية صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية على تكريس صفحتها
الأولى، لنشر أسماء وصور الأطفال الفلسطينيين الذين استشهدوا خلال حرب
الـ11 يوما في غزة، حيث استشهد 66 طفلا دون سن 18 عاما، وتحت عنوان «
كانوا مجرد أطفال».
ومن مفارقات اعتراض المنظمة على أعمال الأطفال وجود علم فلسطيني مرفوع
على قبة الصخرة، وينص شرح لإحدى اللوحات على أن: «الصيد بالشباك من
أقدم الصناعات في فلسطين». كما اعترضت على تعليق «غصن الزيتون هو رمز
السلام ويستخدم للتعبير عن الرغبة في دولة فلسطينية مستقلة» باعتبار
أنها لم تُنفذ من قبل أطفال بل «يبدو أن جميع الرسومات من غزة هي أعمال
فنية احترافية، بنفس الأسلوب، ونفّذها نفس الشخص».
لقد تمكنت المنظمة التي تُعّرف نفسها وهدفها « تقديم الدعم القانوني
بما في ذلك المناصرة والبحث والمشورة والحملات في مكافحة محاولات تقويض
و / أو مهاجمة و / أو نزع الشرعية عن إسرائيل والمنظمات الإسرائيلية
والإسرائيليين و / أو مؤيدي إسرائيل» من منع عرض أعمال الأطفال
الفلسطينيين والبريطانيين المشتركة بذريعة شكوى مرضى يهود عانوا من
«الإحساس بالضعف والمظلومية» لعرض الأعمال على جدار في المستشفى، ولكن
هل ستتمكن من محو وجود الأطفال الفلسطينيين وأن ينسى العالم مأساة
حياتهم وموتهم تحت احتلال يعمل يوميا على فرض مجتمع مقولب وفق مُثل
الصهيونية الاستيطانية العنصرية؟
قبل أن يقودها النازيون الى معسكر الموت عام 1944، ساعدت الفنانة فريدل
على تنظيم ورشات تعليمية سرية لـ 600 طفل من تيريزين، لأنها رأت أن
الرسم والفن وسيلة للأطفال لفهم عواطفهم وبيئتهم. وأصر زوجها التربوي
ديكر برانديز على أن كل طفل يجب أن يوقع باسمه، وألا يسمح له بأن يصبح
غير مرئي أو مجهول الهوية. فكيف ترى المنظمة التي رفعت رسوم الأطفال
الفلسطينيين بالمقارنة؟ وكيف تُفسر لوحة فريدل المعنونة «هذا ما يبدو
عليه العالم يا طفلي» التي تقدم فيها صورة طفل يعيش في ظل عالم رأسمالي
مبني على الحروب وما يرافقه من دعاية وتطهير عرقي. كتبت فريدل تعليقا
عن اللوحة يأخذنا بإنسانيته إلى تعليقات الأطفال الفلسطينيين، قائلة
«هذا ما يبدو عليه، يا طفلي، هذا العالم. هذا ما ولدت فيه. هناك من
ولدوا للتقطيع وأولئك الذين ولدوا ليُقطّعوا. هذا، يا طفلي، هو ما يبدو
عليه في عالمنا وعالم البلدان الأخرى، وإذا كنت، يا طفلي، لا تحبه،
سيكون عليك، عندئذ، تغييره». وهذا هو ما يحاول الأطفال الفلسطينيون
القيام به من خلال أعمالهم الفنية.
كاتبة من العراق
الاتحاد الأوربي وناقوس
الصراع المميت في العراق
هيفاء زنكنة
تحدد قائمة الرصد لمجموعة الأزمات الدولية، وهي منظمة تُعّرف نفسها
بأنها مستقلة تعمل على منع الحروب وتشكيل السياسات التي من شأنها بناء
عالم أكثر سلاما، 10 بلدان ومناطق تواجه صراعا مميتا أو حالة طوارئ
إنسانية أو أزمات أخرى في عام 2023، وأن بإمكان العمل المبكر، الذي
يحركه أو يدعمه الاتحاد الأوروبي، إنقاذ الأرواح وتعزيز احتمالات
الاستقرار.
وتضم قائمة الدول المعنية منطقة الخليج العربي والعراق. فما هو الوضع
الذي ترصده المجموعة داخل هذه البلدان وتوصياتها الموجهة إلى الاتحاد
الأوروبي، وكيف التعامل خاصة مع العراق بعد مرور عشرين عاما على غزوه
وفتح بواباته أمام احتلالين، وتطبيق المعاهدات والاتفاقيات مع الاتحاد
آخذين بنظر الاعتبار منظور وسياسة الاتحاد المبنية على مصالحه
الاقتصادية والعسكرية التوسعية في أرجاء العالم؟
تنبه مجموعة الأزمات الدولية أولا إلى صعوبة ما سيمر به الاتحاد
الأوروبي نفسه في العام الحالي حيث ينبغي عليه أن يعيد التفاوض على
مكانته في العالم، إزاء مجموعة من التحديات، على الرغم من كونه قد
استجاب بشكل جيد، حتى الآن، للهجوم الروسي على أوكرانيا والتوصل إلى
اتفاق عام حول توفير الدعم، بأنواعه لها.
من بين التحديات التي يواجهها الاتحاد حسب التقرير: مساعدة البلدان
الضعيفة على التعامل مع التداعيات الاقتصادية للحرب، مراقبة الآثار
الجانبية المزعزعة للاستقرار لجهود تنويع مصادر الطاقة، دعم نظام متعدد
الأطراف مرهق، إدارة العلاقات مع القوى الوسطى المؤثرة، المساعدة في
تمويل الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، وتطوير سياسة هجرة إنسانية لا
تحرف أولوياتها الإجمالية.
يستوقفنا بشكل خاص ما يُطلق عليه الاتحاد مصطلح العلاقات مع « القوى
الوسطى» التي يتم تعريفها بالقوى المؤثرة الناشطة غير الغربية، بما في
ذلك البرازيل والهند وإندونيسيا والمملكة العربية السعودية وتركيا،
باعتبارها ذات تأثير متزايد في النظام الدولي، على الرغم من عدم
تشكيلها كتلة متجانسة، حسب مقياس الاتحاد الأوروبي المستند على الوقوف
بجانب أو ضد أوكرانيا، وهو المقياس الذي لا ينطبق على العراق.
تحت عنوان «العراق: درء عدم الاستقرار في المستقبل القريب والبعيد»
يمنحنا التقرير صورة للوضع العراقي الحالي وعددا من التوصيات الموجهة
للاتحاد الأوروبي لتفعيل دوره فيه. يشير واقع الوضع السياسي والاقتصادي
إلى عجز النظام الكلي وفشله حتى في إنقاذ نفسه مما يستدعي، حسب
التوصيات المطروحة، تدخلا سريعا لوقف التدهور نحو الأسوأ أي الاقتتال
بين الجهات المتنازعة. إذ تتحكم في النظام المحاصصة العرقية والطائفية
وتوزيع الموارد وفقا لذلك. مما عزز قبضة النخبة الفاسدة على مؤسسات
الدولة بعد كل انتخابات أُجريت منذ عام 2005. ويمنع الفساد المستشري
الدولةَ من تقديم خدمات عامة، وسوء الإدارة والفساد، أكثر منه قلة
الموارد، هما السبب الرئيسي في منع البلاد من تحسين البنية التحتية
الحيوية التي تحتاجها.
يشير واقع الوضع السياسي والاقتصادي إلى عجز النظام العراقي الكلي وفشله حتى في إنقاذ نفسه مما يستدعي، حسب التوصيات المطروحة، تدخلا سريعا لوقف التدهور نحو الأسوأ، أي الاقتتال بين الجهات المتنازعة
ومع تزايد عدد سكان العراق السريع، والذي من المتوقع أن يصل إلى 50
مليون بحلول عام 2030، بزيادة قدرها عشرة ملايين في غضون عشر سنوات،
وتضاءل إمداداته المائية، فإن مزيج الضغط الديموغرافي والضغوط المناخية
ومرور إقليم كردستان بأشد أزمة سياسية منذ الحرب الأهلية الكردية في
منتصف التسعينيات، سيكون الفشل الذريع مصير أي محاولة لشراء الاستقرار
اعتمادا على عائدات النفط.
من الناحية الاقتصادية، يقترح التقرير على الاتحاد الأوروبي الدخول في
حوار صريح مع حكومة محمد شياع السوداني حول كيفية إصلاح النظام المالي
بطريقة تلبي المعايير العالمية كالإشراف على إدارة المالية العامة من
خلال البنك الدولي مبينا أن بإمكانه تنفيذ ذلك نظرا لكونه جهة فاعلة
أكثر حيادية من الولايات المتحدة. كما يتطرق إلى كيفية تحسين ثقة
العراقيين في الحكومة من خلال جعلها أكثر قابلية للمساءلة والاستجابة
للاحتياجات المحلية، وحث السياسيين العراقيين على إجراء انتخابات محلية
طال انتظارها. ويجب على الاتحاد أيضا مناقشة الإصلاح التشغيلي والمالي
للحشد الشعبي بقواته الموازية المدمجة اسميا فقط في جهاز الدولة وتتصرف
ضد المعارضين مع إفلات واضح من العقاب.
ركزت التوصيات على وجوب اهتمام الاتحاد بإصلاح مؤسسة الحشد الشعبي،
سواء عند تقديم الدعم لإصلاح قطاع الأمن في سياق البعثة الاستشارية
للاتحاد الأوروبي في العراق أو في المشاركات السياسية رفيعة المستوى،
آخذين بنظر الاعتبار أن رئيس الوزراء على الرغم من كونه القائد العام
للقوات المسلحة، لا يمارس الحد الأدنى من الإشراف على إدارة الحشد
التشغيلية والمالية. إذ طالما رفضت المجموعات التي تشكل الحشد الشعبي،
والتي لديها ميزانية كبيرة تقريبا مثل تلك الخاصة بوزارتي الداخلية
والدفاع، مرارا وتكرارا أي فكرة لتعزيز صلاحيات رئيس الوزراء باعتبارها
تهديدا لوجودها.
أثناء حضوره الجولة الثانية من مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون، الذي عقد
في عمان نهاية العام الماضي، أشار الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي
للشؤون الخارجية إلى الأهمية الذي يوليها الاتحاد لعلاقته مع العراق،
قائلا إن الاتحاد الأوروبي «مستعد لبذل المزيد وبشكل مختلف وأفضل لدعم
العراق» وضرورة البدء في مناقشة القضايا الشائكة مع حكومة السوداني،
بما في ذلك تداعيات المحاولة الفاشلة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني
للأمن الإقليمي، ومستقبل الحشد الشعبي باعتباره عنصرا أساسيا في المشهد
السياسي والأمني العراقي.
يكتسب تقرير مجموعة الأزمات أهميته، من كونه يقدم أولا صورة تكاد تكون
تفصيلية عن الوضع العراقي الحالي الذي يعيشه ويعرفه المواطنون بعيدا عن
تهويمات أجهزة الأعلام والصورة التضليلية التي تقدمها القوى المتنازعة
ضمن منظومة الفساد السائد. كما تنبع الأهمية الثانية من كونه، وهذه
حقيقة علينا ألا ننساها أثناء قراءة تقارير كهذه وإن كانت تقدم صورة
واقعية فعلا، أن التقرير موجه إلى حكومات الاتحاد الأوروبي كأداة
سياسية وهيكلية برنامج لغرض تسهيل وإنجاح دخول وبقاء الاتحاد في العراق
كقوة اقتصادية وسياسية منافسة للولايات المتحدة الأمريكية، مما يعيد
إلى الذاكرة صعود الامبريالية الأمريكية، عالميا، في أعقاب الحرب
العالمية الثانية على حساب تراجع هيمنة الإمبراطورية البريطانية.
كاتبة من العراق
لماذا يخشون روجر ووترز؟
هيفاء زنكنة
لم يكن متوقعا أن يكون حضور روجر
ووترز، أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم الأربعاء الماضي،
بمستوى حضور غيفارا أو كاسترو أو ياسر عرفات أمام الجمعية العمومية. إذ
أنه ليس رئيس دولة أو قائد حركة ثورية مناضلة معروفة في العالم أجمع بل
موسيقي من فرقة اشتهرت، في السبعينيات، بأسطوانة عنوانها « الجدار».
فكيف انتهى الحال بالموسيقي روجر أن يخاطب مجلس الأمن (عبر فيديو) الذي
أجرى مناقشات عدة حول الحرب في أوكرانيا، وتزويد الغرب أوكرانيا
بالسلاح لكنه فشل في اتخاذ أي إجراء، بسبب الفيتو الروسي؟ كيف أصبح
لموسيقي البوب من فرقة لم تعد مشهورة كما في السبعينيات، هذا الدور
البارز الذي جعله محط حملة إعلامية شرسة، تتصدرها أجهزة الاعلام
الصهيونية وتكررها الصحافة العالمية، بدرجات متفاوتة، لتصفه بالنازية
ومعاداة السامية والعمالة لروسيا وبوتين بالتحديد؟
تمت دعوة روجر ووترز، البالغ من العمر 79 عامًا، لمخاطبة مجلس الأمن من
قبل الوفد الروسي، باعتباره شخصا مؤثرا جماهيريا، إختار في العقدين
الأخيرين أن تضاف إلى سيرته والتعريف به مفردة ناشط للدلالة على مواقفه
الحقوقية والمناهضة للحرب والاحتلال، بالدرجة الأولى. أرادت روسيا،
بحضوره، القول بأنها ترغب بوقف الحرب وإحلال السلام بمواجهة الغرب
المُصر على تزويد أوكرانيا بالسلاح وهيمنة صناعة السلاح. وكان روجر قد
وقف ضد إمداد الغرب بالأسلحة إلى كييف في رسالة نشرها على موقعه على
الإنترنت في سبتمبر / أيلول.
فهل كانت إحاطة روجر، حقا، عمالة لروسيا وبوقا لبوتين وموقفا معاديا
للسامية؟ وكيف تم التوصل إلى ذلك وقد أدان في كلمته الحرب بوقائعها
الكارثية على الشعوب بقوله «أن إجتياح الاتحاد الروسي لأوكرانيا غير
قانوني. أنا أدينه بأشد العبارات. كما لم يكن الغزو الروسي لأوكرانيا
بدون استفزاز، لذلك أدين أيضًا المحرضين بأقوى العبارات الممكنة»؟ وهل
دعوة الرئيس الأمريكي والروسي والأوكراني إلى التفاوض الفوري « لوقف
القتال في أوكرانيا التي مزقتها الحرب، لا سيما في ضوء الحجم المتزايد
من الأسلحة التي تصل إلى ذلك البلد التعيس» وأن تتخلص الشعوب من السوط
المسلط عليها بعد خمسمائة عام من الإمبريالية والاستعمار والعبودية»
تستحق الوصف بالنازية؟
للإجابة على هذه التساؤلات وتمحيص حملة العداء الإعلامية والرسمية لعدد
من الدول، وعلى رأسها الكيان الصهيوني، ضد روجر، علينا أولا النظر أبعد
من كلمته عن أوكرانيا. إذ يعود أساس العداء ضده إلى موقفه المناهض
للحروب عامة وللاحتلال الصهيوني لفلسطين ومساندته للشعب الفلسطيني
المقاوم، خاصة بعد انضمامه إلى حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض
العقوبات (البي دي أس) عام 2012 والتي يعتبرها الكيان الاستعماري
تهديدا لأمنه ووجوده، بعد النجاحات التي حققتها عالميا.
أدت زيارته إلى الأراضي المحتلة إلى تهديد حياته ومنع إقامة عدد من حفلاته الموسيقية في عدة بلدان وتعرضه لأشد حملات الكراهية شراسة إثر وقوفه أمام جدار العزل العنصري
وقد أدت زيارته إلى الأراضي
المحتلة إلى تهديد حياته ومنع إقامة عدد من حفلاته الموسيقية في عدة
بلدان وتعرضه لأشد حملات الكراهية شراسة إثر وقوفه أمام جدار العزل
العنصري وكتابته جملة « لا نحتاج سيطرتكم على الأفكار» إقتباسا من
واحدة من أشهر الأغاني ألتي ألفها نهاية السبعينات لفرقة « بينك فلويد»
ورأى في الجملة تماهيا مع سياسة كيان الاحتلال، ومنددا في عشرات
المقابلات الصحافية بسياسة الإبادة وجرائم الحرب التي يرتكبها ضد الشعب
الفلسطيني.
مخاطبا الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، باسم الشعوب، والغالبية
التي بلا صوت، تساءل روجر «ما هي اهدافكم؟ أرباح أكبر للصناعات
الحربية؟ المزيد من القوة على مستوى العالم؟» معلنا بقوة أن «هذه
الحروب الدائمة ليست من اختيارنا، وأن حروبك ستدمر الكوكب الذي هو
موطننا، وجنبا إلى جنب مع كل الكائنات الحية الأخرى، ستتم التضحية بنا
على مذبح شيئين، الاستفادة من الحرب لتلائم جيوب عدد قليل جدًا جدًا،
والمسيرة المهيمنة لإمبراطورية أو أخرى نحو الهيمنة على العالم أحادي
القطب» محذرا بأن هذا الطريق سيؤدي فقط إلى كارثة.
وفي الوقت الذي اختارت فيه الحكومات والمؤسسات الغربية مسار استقبال
الرئيس الاوكراني، في كل العواصم الغربية تقريبا، وتزويده بطلبات
السلاح المتطور الذي يحتاجه، بذريعة مقاومة الاحتلال، بالإضافة إلى
الدعم الإعلامي المستمر بكل المستويات، لم يحدث يوما وأن حظيت مقاومة
الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال ولو بنسبة ضئيلة من هذا الاهتمام، بل
وغالبا ما اتُهمت، كما مقاومة الشعب العراقي ضد الاحتلال الأنكلو
أمريكي، بالإرهاب.
هذه الحقيقة المُتعامى عنها بانتقائية لا أخلاقية، تطرق إليها روجر
مُذكرا «نحن الشعب، نريد حقوق الإنسان العالمية لجميع إخوتنا وأخواتنا،
في جميع أنحاء العالم، بغض النظر عن عرقهم أو دينهم أو جنسيتهم. ولكي
نكون واضحين، أن يشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الحق في الحياة
والملكية بموجب القانون، للأوكرانيين والفلسطينيين. نعم، فكروا بذلك.
فكروا بما هو واضح لنا جميعًا. في مناطق الحروب أو في أي مكان يعيش فيه
الناس تحت الاحتلال العسكري لا يمكن اللجوء إلى القانون، ولا توجد حقوق
إنسان».
هل أراد روجر، في إشارته إلى الظلم الذي تعيشه الشعوب المُستغلة وتلك
التي تعاني من الحروب والاحتلال، أن يقول كما قال غيفارا «إنني أحس على
وجهي بألم كل صفعة تُوجّه إلى مظلوم في هذه الدنيا، فأينما وجد الظلم
فذاك هو وطني؟» ربما، لعله أراد ذلك… ولكن بأسلوب الموسيقي المختلف عن
الثوري المقاتل، مقتبسا من أغنية جون لينون المشهورة عن السلام، ليوصل
إلى مجلس الأمن رسالة من « جميع اللاجئين في المخيمات، من جميع الأحياء
العشوائية والأحياء الفقيرة، من جميع المشردين، في كل الشوارع الباردة،
ضحايا الزلازل والفيضانات.. رسالة الأغلبية التي لا صوت لها إلى قادة
الامبراطوريات العراة: نحن الذين لا نشارك في أرباح صناعة الحرب. نحن
لا نربي أبناءنا أو بناتنا مختارين لتوفير الذخيرة لمدافعكم. هذا يكفي!
نحن نطالب بالتغيير». صحيح أن رسالة روجر لم تكن بذات اللهجة التي خاطب
بها القادة الثوريين قادة العالم الاستعماري، إلا أنه بالتأكيد نجح
مثلهم في اكتساب المزيد من حملات التشويه والاتهامات النمطية الجاهزة
للتلويث رسالته الأخلاقية.
كاتبة من العراق
سردية غزو العراق
تكتبها قوات الاحتلال
هيفاء زنكنة
يوفر المرور على عتبة العام العشرين للغزو الأمريكي البريطاني للعراق،
فرصة كبيرة لدور النشر الغربية لإطلاق سراح العديد من الكتب المعنية
بالغزو والاحتلال. كتب مركونة لديها انتظار للتوقيت الصحيح للتسويق،
مهما كان نمط الكتب أو تخصصها سواء كانت موضوعاتها عسكرية أو اقتصادية
أو أدبية. أقول دور النشر الغربية لأننا نعرف جيدا مدى فقر دور النشر
العربية في نواحي التخطيط المستقبلي والتنظيم ومعرفة كيفية ترويج
الكتاب، خاصة وأن معظمها لا يختار طباعة ونشر الكتب وفق نوعيتها أو
مناسبة ألحدث بل حسب قدرة المؤلف على دفع تكاليف الطبع بدون أي التزام
من صاحب دار النشر للترويج والتوزيع. وهي من العقبات التي تحول دون
معرفتنا بحجم الاهتمام العربي الشعبي الحقيقي بذكرى الغزو العدواني وما
ترتب عليه من نتائج إجرامية بحق العراق. ففي البلاد العربية، لا يعني
غياب الكتب المُعالجة لموضوع معين غياب الاهتمام بقدر ما هي صعوبة
النشر والتوزيع على الرغم من زيادة عدد الكتب المطبوعة، كونها على حساب
المؤلفين، وبقاء مصيرها محصورا بالتوزيع على الأهل والأصدقاء.
فلا غرابة إذن، أن نلاحظ الغياب شبه الكلي للكتب الصادرة، عربيا،
بمناسبة الذكرى العشرين لغزو العراق، وهي ذكرى مهمة، عربيا وعالميا،
بكل المقاييس. فبينما يجد الباحث عن الكتب باللغات الأجنبية صدور عشرات
الكتب بالمناسبة، يفشل بالعثور إلا على كتابين إثنين أو ثلاثة، بأحسن
الأحوال، منشورة باللغة العربية من قبل أمة خرجت بملايينها احتجاجا على
الغزو ودعما للشعب العراقي الذي رأوا فيه مقاوما لعدوان همجي يمس كرامة
وسيادة الأمة العربية كلها. ولكن، هل يكفي إلقاء اللوم على دور النشر
لوحدها، لفهم أسباب خلو الساحة من الكتب العربية عن الغزو؟ لا أعتقد
ذلك فالأسباب متعددة ولعل أبرزها النجاح الذي حققته السردية الأمريكية
ـ البريطانية في تحويل الغزو إلى تحرير، والمقاومة إلى إرهاب، والعراق
الواحد إلى طوائف وقوميات متنازعة فيما بينها في محاصصة الفساد، وتحويل
البلد إلى ساحة لاستعراض القدرة العسكرية والهيمنة السياسية بين
الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيران الإسلامية. وإذا أضفنا إلى
ذلك سياسة الحكومات العربية في استهلاك عقول الناس وقدرتهم على التفكير
والعمل على التغيير لانشغالهم باللهاث وراء الأساسيات، ونسيان ما
عداها، لأدركنا كيفية تحويل واحدة من أكثر الأحداث الكارثية تأثيرا على
المنطقة العربية والإسلامية، إلى مجرد يوم عادي، بالمقارنة مع الدول
المسؤولة عن الغزو وانعكاساته.
الكتاب العربي الوحيد الذي صادف إصداره ذكرى الغزو وحظي بالاحتفاء في
معرض الكتاب في القاهرة هو كتاب الصحافي العراقي المخضرم سلام مسافر
المعنون «الهمجية.. شهادات غزو واحتلال العراق في حوارات مع سلام
مسافر» والذي يضم عددا من لقاءاته، مع عراقيين، على مدى 15 عاما، في
برنامج «قصارى القول» الذي يتم بثه على قناة آر تي (روسيا اليوم).
قد لا تكون شحة الكتب المطبوعة بمناسبة مرور عشرين عاما على غزو واحتلال العراق بالتحديد باللغة العربية دليلا مطلقا على قلة الاهتمام الأكاديمية والشعبية إلا أنه، دليل لا يمكن إهماله، بخطورة أن تكتب قوات الاحتلال سرديتنا
من خلال الحوارات يعمل سلام على تقييم ما حدث في العراق جراء الغزو على
نطاق عالمي، كاشفا عن تفاصيل، تذكر لأول مرة، عن جريمة الإعداد وتنفيذ
غزو واحتلال العراق، حيث يقوم بدحض أكذوبة واشنطن عن البرنامج النووي
العراقي وأسلحة الدمار الشامل مقابل جهود روسيا الاتحادية في التوصل
إلى تسوية، تبعد شبح الحرب. أضاءت بقية الفصول جوانب متعددة من جرائم
الاحتلال ومن بينها نهب قوات الاحتلال أموال وممتلكات البنك المركزي،
بالإضافة إلى الأخطاء العسكرية التي ارتكبتها القوات المسلحة العراقية
بمختلف أصنافها، وأفضت إلى سقوط بغداد في غضون أسبوعين، والمباحثات
السرية بين القيادة العراقية في الحبس، والسلطات العسكرية الأمريكية
المحتلة، وشهادات لكوكبة من المحامين والقضاة عن خفايا محاكمة صدام
حسين التي انتهت بإعدامه.
بالمقابل، هناك عشرات الكتب التي إما صدرت أو على وشك الصدور، تزامنا
مع ذكرى الغزو والاحتلال، باللغة الإنكليزية. تتصدرها يوميات ومذكرات
أفراد قوات الاحتلال في العراق. يقدمون خلالها سردية تتسم بالشجاعة
والصداقة الحميمة وروح التضحية والتكاتف في محاربة الإرهاب المهدد
لأمريكا والعالم، على حساب تغييب الشعب العراقي أو ذكره كملاحظة
هامشية. ففي «قلوب سوداء وبنادق مطلية: رحلة كتيبة إلى مثلث الموت في
العراق» يروي المؤلف الضابط تجربته القتالية المضنية والمروعة في «حرب
طائفية». وفي « تذكر كتيبة رامرود: أخوة في الجيش في الحرب والسلام»
يقوم المؤلف وهو الحائز الوحيد على وسام الشرف في حرب العراق بسرده
مذكراته عن مشاركته، في عام 2004، ضمن كتيبة مشاة رامرود التي « ساعدت
في الفوز بمعركة الفلوجة، أكثر الأحداث دموية في حرب العراق». مستعرضا
نجاحه « في تطهيره، بمفرده، موقعًا محصنًا للعدو». مستخدما مفردتي
العدو والإرهاب لوسم كل مقاوم للاحتلال طبعا.
ولا تخلو قائمة الإصدارات من كتب سياسية أكاديمية. من بينها “مواجهة
صدام حسين: جورج دبليو بوش وغزو العراق» لمؤرخ السياسة الخارجية
الأمريكية ملفين ب. ليفلر، يحلل فيه سبب اختيار أمريكا للحرب ومن يتحمل
المسؤولية الأكبر عن القرار. باستخدام مجموعة فريدة من المقابلات
الشخصية مع عشرات كبار المسؤولين والوثائق الأمريكية والبريطانية التي
رفعت عنها السرية، يصور ليفلر مشاعر القلق التي شكلت تفكير بوش بعد
أحداث 11 أيلول/ سبتمبر. ويُظهر كيف أثر الخوف والغطرسة والقوة على نهج
بوش ليصل إلى خلاصة مغايرة لما هو معروف عن منهجية الأعداد للغزو
مسبقا، بتأكيده على أن بوش «لم يكن متحمسا للحرب وقرار غزو العراق لم
يكن أمرا واقعيا».
بالنسبة إلى الوضع داخل العراق، يتصدر القائمة كتابان. الأول «مستقبل
قوات الحشد الشعبي العراقية: دروس من تاريخ جهود نزع السلاح والتسريح
وإعادة الإدماج» والثاني «غريب في مدينتك» للصحافي العراقي غيث عبد
الأحد، الصادر باللغة الإنكليزية أيضا، إلا أنه الكتاب الوحيد الذي
تُشكل السردية العراقية مركزه، من خلال ربط الخاص بالعام وتغطيته قصص
العراقيين، خلال سنوات الاحتلال.
قد لا تكون شحة الكتب المطبوعة بمناسبة مرور عشرين عاما على غزو
واحتلال العراق بالتحديد باللغة العربية دليلا مطلقا على قلة الاهتمام
الأكاديمية والشعبية إلا أنه، دليل لا يمكن إهماله، بخطورة أن تكتب
قوات الاحتلال سرديتنا، تاريخا وحاضرا، مرّوِجة إنسانيتها وتضحياتها
وانتصاراتها بينما تختزل وجودنا، كشعب مُحتل، بالإرهاب.
كاتبة من العراق
لنغني عراقيا للحياة
وليس الوجود فقط
هيفاء زنكنة
بعد زوال تأثير مُخدر فوز فريق كرة القدم العراقي ببطولة خليجي 25،
والاحتفاء بتنظيمه في مدينة البصرة المعطاء، وبعد رحيل الضيوف الأعزاء
من دول الخليج العربي إلى ديارهم، وبعد خفوت مشاعر الفرح الجماعي الذي
عاشه العراقيون، على مدى أسبوع، بعد طول انتظار، وعلى أمل شحن جسد
الأمة بالطاقة للعمل على استعادة العافية، وحالما تم إغلاق بوابات ملعب
جذع النخلة، تسلل الواقع العراقي، عائدا بتفاصيله المريرة، ليحتل
مكانته المعتادة.
عاد الواقع ليغرز سهامه في أجساد المواطنين، وليطّلع عليه العالم
الخارجي من خلال عدد من التقارير السنوية لمنظمات حقوقية دولية ومحلية
قامت بتوثيق الحال لعام 2021 – 2022. صدرت التقارير في الأسابيع
الأخيرة من الشهر الحالي، وبعضها صدر أثناء بطولة خليجي 25 فلم تحظ
بالتغطية الإعلامية المطلوبة إزاء التحشيد الإعلامي والترويجي الذي
رافق منافسات كرة القدم.
من بين التقارير الدولية التي صدرت تقرير «منظمة العفو الدولية»
و«هيومان رايتس ووتش» وتقرير «بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق»
(يونامي). عراقيا، أصدرت لجنة حقوق الإنسان في» هيئة علماء المسلمين»
تقريرها السنوي وكذلك «منظمة حمورابي». وقد توخت المنظمات تقسيم
تقاريرها بشكل يكاد يكون متشابها في منهجيته العلمية، للتحقيق في
الانتهاكات الجسيمة، وتوثيقها، وتحديد المسؤولين عنها، استنادا إلى
شهادات الضحايا وذويهم ومقابلات مع مسؤولين حكوميين وممثلي منظمات
المجتمع المدني بالإضافة إلى الاحصائيات المتوفرة حكوميا.
تتفق المنظمات والهيئات المذكورة صاحبة التقارير، وعلى الرغم من اختلاف
مسمياتها وتوجهاتها، حول مسؤولية الحكومة العراقية كما قوات الاحتلال
الأمريكي البريطاني عن الحالة الكارثية التي يعيشها البلد، بعد مرور
عقدين على غزوه. فتحت عنوان «التعذيب وانتهاكات المحاكمة العادلة
وعقوبة الإعدام» تذكر «هيومان رايتس ووتش» إن استخدام التعذيب لايزال
منتشرا في نظام العدالة الجنائية، لانتزاع الاعترافات. ورغم الانتهاكات
الجسيمة للإجراءات القانونية الواجبة في المحاكمات، نفذت السلطات 19
إعداما على الأقل.
وحسب بيان صادر عن وزارة العدل في سبتمبر/أيلول، تحتجز السلطات نحو 50
ألف شخص للاشتباه بصلاتهم بالإرهاب، حُكم على أكثر من نصفهم بالإعدام.
وتم اعتقال العديد من المتهمين لأن أسماءهم وردت في قوائم للمطلوبين
مشكوك في دقتها أو لأنهم أفراد من عائلات المشتبه بهم المدرجة أسماؤهم.
ليس للمنظمات المُصّدرة لهذه التقارير القدرة على التدخل المباشر لإحداث أي تغيير، مهما كانت انتهاكات حقوق الإنسان جسيمة وأبناء الشعب يعيشونها يوميا، إلا أنها توفر المعلومات الموثقة بمنهجية علمية لتكون أداة بيد المواطنين الراغبين بالتغيير
بالنسبة إلى حق التظاهر، تقاعست الحكومة عن الوفاء بوعودها بمحاسبة
المسؤولين عن الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والقتل خارج نطاق
القضاء للمتظاهرين والنشطاء والصحافيين وغيرهم ممن ينتقد الجماعات
السياسية والمسلحة في البلاد علنا. وخلص تقرير لـ «بعثة الأمم المتحدة
لمساعدة العراق» (يونامي) إلى أنه لا يبدو أن أيا من الاعتقالات
العديدة المتعلقة بعمليات القتل المستهدف قد تجاوز مرحلة التحقيق. كما
أن أيا من الاعتقالات لم يفض إلى توجيه أي تهمة.
وترى المنظمات الحقوقية أن الحكومة العراقية تمارس عقابا جماعيا ضد
النازحين قسرا من مناطق معينة. فبينما أغلقت 16 مخيما نهاية عام 2021،
تركت ما لا يقل عن 34,801 نازح دون تأكيدات بأنهم يستطيعون العودة إلى
ديارهم بأمان، أو الحصول على مأوى آمن آخر، أو الحصول على خدمات ميسورة
التكلفة. كان العديد من العائلات النازحة تعيلها نساء نزحت بسبب القتال
بين داعش والجيش العراقي بين 2014 إلى 2017، وصُنِّف العديد من هذه
العائلات على أنها منتمية إلى داعش، ليُحرم أفرادها وبضمنهم الأطفال من
الوثائق المدنية. كما منعت حكومة إقليم كردستان آلاف العرب من العودة
إلى ديارهم في قرى في ناحية ربيعة وقضاء الحمدانية، وهي مناطق طردت
قوات حكومة الإقليم داعش منها عام 2014 وفرضت سيطرتها على الأراضي،
لكنها سمحت لقرويين أكراد محليين بالعودة إلى المناطق نفسها، ضمن مخطط
التغيير الديموغرافي المتزامن مع إصرار الميليشيات على استمرار حملات
التطهير الطائفي حسب تقرير» هيئة علماء المسلمين» الذي تضمن إحصاءات
تتعلق بأحد عشر محورًا تشمل قضايا الفوضى الأمنيةِ، وارتفاعَ معدلاتِ
الجريمة، وتجذرَ الفساد في جميع الدوائر الحكومية. ويتطرق التقرير إلى
وضع المرأة والطفل المتميز باستمرار تعرض هاتين الفئتين للخطف
والاستغلال والاتجار بالبشر، وقدرت إحصاءات حجم عمالة الأطفال في
العراق بنحو مليون طفل، وعلاقته المباشرة بجرائم الاتجار بالبشر، حيث
تم تسجيل فقدان 450 طفلاً خلال العام 2022 في عمليات الاتجار بالبشر.
مع العلم أن هناك خمسة ملايين يتيم، وأربعة ملايين ونصف مليون طفل ترزح
عائلاتهم تحت خط الفقر، وسط زيادة نسب البطالة وانعدام الأمن الغذائي
وانتشار الأمية. وما يزال لدى العراق أكبر عدد من الحالات الموثقة
للاختفاء القسري في العالم، إذ تجاوز عدد ضحايا الاختفاء القسري بعد
2014 حوالي 55 ألف شخص، ما يزال مصيرهم مجهولاً من دون أي تحرك رسمي
يُذكر لمعالجة هذا الملف المعلق منذ سنين.
ماذا عن موقف الدول التي غزت العراق وأحد ذرائعها أن يتمتع الشعب بحقوق
الإنسان؟
لنترك الإجابة لمنظمة «هيومان رايتس ووتش» في تقريرها الذي يلخص الموقف
بقولها: « بعد عقدين من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة والمملكة
المتحدة للعراق في مارس / آذار 2003، استمرت الجهات الفاعلة الدولية في
التورط في انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد». ومن بين الأمثلة العديدة
التي تذكرها المنظمة اكتشاف صحيفة « نيويورك تايمز» أثناء فحصها سجلات
البنتاغون الخاصة،
في ديسمبر 2021، أن قصف الجيش الأمريكي للعراق في قتاله ضد داعش أدى
إلى «قتل آلاف المدنيين، كثير منهم أطفال «. يتطابق التقرير مع نتائج
سابقة لـ للمنظمة أثبتت «إخفاق الولايات المتحدة في اتخاذ احتياطات
كافية لتجنيب المدنيين القتل أثناء قصف أهداف داعش المزعومة».
هل من تغيير متوقع من هذه التقارير على كثرتها ومصداقيتها عن واقع
المواطنين؟ ليس للمنظمات المُصّدرة لهذه التقارير القدرة على التدخل
المباشر لإحداث أي تغيير، مهما كانت انتهاكات حقوق الإنسان جسيمة
وأبناء الشعب يعيشونها يوميا، إلا أنها توفر المعلومات الموثقة بمنهجية
علمية لتكون أداة بيد المواطنين الراغبين بالتغيير. ومن يدري، فقد
تجتمع آلاف الجماهير التي شجعت الفريق العراقي، منشدة «موطني» لتقول
نريد وطنا نتمتع فيه بحق الحياة وليس الوجود فقط.
كاتبة من العراق
ماذا حدث
للحركة المناهضة للحرب؟
هيفاء زنكنة
ماذا حدث للحركة التي ولدت
المظاهرات المناوئة للحرب على العراق وشارك فيها 36 مليون شخص، من جميع
أنحاء العالم، في حوالي 3000 احتجاج مناهض للحرب قبل وبعد الغزو في 20
آذار/ مارس 2003. وكانت مظاهرات 15 شباط/ فبراير، قبل أسابيع من شن
الحرب، هي الأكبر في تاريخ البشرية، المتميزة بأنها حدثت قبل شن الحرب
وليس اثنائها. التظاهرة التي صّورها مخرج الأفلام الوثائقية الإيراني
أمير أميراني في فيلمه «نحن كثرة». وهو عنوان مقتبس من قصيدة للشاعر
الإنكليزي بيرسي شيللي بعنوان «قناع الفوضى» واستخدمتها الروائية
الناشطة الهندية أرونداتي روي في كلمة لها أثناء الاحتجاجات المناهضة
للحرب، قائلة: «لا تنسوا! إننا كثرة وهم قلة. هم يحتاجوننا أكثر مما
نحتاجهم». وكانوا كثرة فعلا، حيث سجلت بريطانيا رقمها الأعلى في مساهمة
المتظاهرين الذين بلغ عددهم مليوني شخص، تظاهروا تحت شعار «ليس
باسمنا».
ماذا حدث للحركة المناهضة للحرب؟ قد يكون هذا هو السؤال الأكثر خطورة
في عصرنا، يقول جيفري سانت كلير محرر موقع « كاونتر بانتش» اليساري
المعروف، مركزا في تساؤله على نشاط الحركة في الولايات المتحدة
الأمريكية التي تشكل تاريخها المعاصر على الموقف الجماهيري الكبير ضد
الحرب في فيتنام ومساهمة الملايين في الاحتجاجات المناوئة
لاستمراريتها. لماذا، إذن، نرى خفوت الأصوات الآن؟ تشير الدراسات التي
تصدت لتحليل هذه الظاهرة إلى أن أحد أسباب التحشيد الكبير الذي رافق
الاحتجاجات المناوئة للحرب في فيتنام هو نظام التجنيد العسكري الإلزامي
أثناءها. حيث دخلت الحرب، بآثارها البشعة، الحياة اليومية للعائلة
الأمريكية. وصار جرحى الحرب والقتلى حقيقة لا يمكن للإدارة الأمريكية
وأجهزة الإعلام تغطيتها. وكان لانتصارات المقاومة الفيتنامية الدور
الرئيسي في إعلان الهزيمة العسكرية الأمريكية وإنهاء الحرب، في ذات
الوقت الذي ساهمت فيه حركة مناهضة الحرب بتوفير الدعم التضامني مع
الشعب الفيتنامي.
بعض هذه الأسباب وليس كلها، تمظهر في الموقف المناهض للحرب ضد العراق.
لم يعد الشاب الأمريكي مجبرا على الانخراط في الخدمة العسكرية
الإلزامية مما يؤجج المشاعر ضد الحكومة في حال الإصابة أو القتل وعدم
تحقيق النصر الموعود. بل بات توجهه إلى الخدمة العسكرية اختيارا يتحمل
مسؤوليته. ويكون انخراطه لأسباب اقتصادية أو إغراءات بتوفير الإقامة أو
مشاعر وطنية لحماية الوطن من « الإرهاب» تماشيا مع كثافة التحشيد
السياسي والإعلامي. ففي بيان رسمي، نصحت وزارة الداخلية الأمريكيين
بتخزين الأغطية البلاستيكية والأشرطة اللاصقة لحماية أنفسهم من الهجوم
الإشعاعي أو البيولوجي المتوقع من العراق الذي جاء نقلا عن تصرح لتوني
بلير، رئيس الوزراء البريطاني، بأنه سيصل بريطانيا خلال 45 دقيقة،
ناهيك عن التصريحات المدوية عن « التحرير والديمقراطية وحقوق الإنسان».
على الرغم من هذا كله خرج آلاف الناس بأمريكا احتجاجا على شن الحرب.
فلِم حل الصمت بعد ذلك ونتيجة الغزو الهمجي وانعكاساته الكارثية على
حياة الشعب العراقي ومستقبله، مرئية وموثقة للجميع؟ أين الاحتجاج من
قبل التقدميين والليبراليين والمدافعين عن الحقوق المدنية ورجال الدين
والأكاديميين والفنانين والمتطوعين المجتمعيين وغيرهم ممن شاركوا في
الحركة سابقا والذين يجب أن يُواصلوا العمل تذكيرا بمسؤولية أمريكا
وبريطانيا؟ هل هو اهتمام الشباب المُنصب على البيئة والجنسوية؟
ماذا حدث للحركة المناهضة للحرب؟ قد يكون هذا هو السؤال الأكثر خطورة في عصرنا، يقول جيفري سانت كلير مركزا في تساؤله على نشاط الحركة في الولايات المتحدة الأمريكية التي تشكل تاريخها المعاصر على الموقف الجماهيري الكبير ضد الحرب في فيتنام
يقول ديفيد بواز، نائب الرئيس
التنفيذي لمعهد كاتو التحرري، على موقع بريتانيكا الإلكتروني، أن
الاحتجاجات الأمريكية ضد الحروب بدت وكأنها توقفت لحظة انتخاب باراك
أوباما رئيسًا في عام 2008. «ربما افترض المنظمون المناهضون للحرب أنهم
انتخبوا الرجل الذي سيوقف الحرب». وما حدث، كما نعلم هو أنه كان مهووسا
باستخدام الطائرات بل طيار القاتلة. السبب الآخر هو استمرار تسويق
سياسة «الحرب على الإرهاب» بذكاء، والسيطرة على الأخبار الواردة من
الجبهة عن طريق تحديد حركة الصحافيين، وتلويث سمعة المقاومة العراقية
بسمة الإرهاب وتصوير الجندي الأمريكي باعتباره منقذا للمواطن العراقي
من الإرهابيين. ولا يمكن إغفال الدور الاعلامي الذي لعبته «المعارضة
العراقية» في مرحلتي الترويج للحرب وأثناء الاحتلال، واستفادت منه
الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية، بشكل كبير. وهل هناك ما هو
أكثر نجاحا في التسويق من استخدام معارضين يدعون الى التحرير وبقاء
القوات الأجنبية لتوفير الحماية لهم؟
بالإضافة إلى الأسباب المعروفة، تطرقت جوان رويلوفس، أستاذة العلوم
السياسية والناشطة المناهضة للحرب ومؤلفة عدة كتب، في كتابها
الاستقصائي الجديد المعنّون «كاتم صوت بتريليون دولار» إلى النقص
المذهل للاحتجاج الشعبي على الموت والدمار الذي يُلحقه المجّمع الصناعي
العسكري بالناس والأمم والبيئة. ركزت المؤلفة على كيفية تغلغل الإنفاق
العسكري في الاقتصاد الوطني، ومدى امتداد تمويله، ليشمل الآن، إلى حد
كبير، حتى الحركات المناهضة للحرب. إذ تمتلك مؤسسة – جيش الولايات
المتحدة – آلاف الوظائف وأوجه الاستثمار الاقتصادي الحربي، وميزانية
تصل حوالي ألف مليار دولار كل عام لدعم دورها في التحضير للحرب وشنّها
في جميع أنحاء العالم. وتجيب المؤلفة على سؤال جوهري يُطرح غالبا وهو
كيفية نجاح المجّمع الصناعي العسكري بالحصول على الرضا الشعبي؟ بتفاصيل
الميزانية والمُنح والجداول، تبين المؤلفة أوجه التغلغل العسكري في
المجتمع الأمريكي اقتصاديا وثقافيا. حيث يُعتبر المقاولون والقواعد
بمثابة محاور اقتصادية في مناطقهم. تشمل المشاريع المشتركة مع وزارة
الدفاع مساعدة الإدارات البيئية بالولاية، وفرق المنظمات الحكومية
والبيئية لإنشاء مناطق عازلة لميادين القصف. تعد مستشفيات إدارة
المحاربين القدامى نعمة لمجتمعاتهم.
ويتسلل التأثير الأخطر عبر حصول الجامعات والكليات وأعضاء هيئة التدريس
على عقود ومنح من وزارة الدفاع ووكالاتها، مثل وكالة مشاريع الأبحاث
الدفاعية المتقدمة. وتوفر الوظائف المدنية في وزارة الدفاع فرصًا
للعلماء والمهندسين ومحللي السياسات وغيرهم. يتغذى كل نوع من الأعمال
التجارية وغير الربحية، بما في ذلك المنظمات البيئية والخيرية على
مائدة وزارة الدفاع من خلال العقود والمنح. إذ تتبرع وزارة الدفاع
بمعدات للمنظمات، وخاصة منظمات الشباب، وتقرض كتائب مجهزة لهوليوود.
وتقدم شركات الأسلحة منحا سخية للفنون والجمعيات الخيرية، خاصة للشباب
والأقليات.
تنطبق هذه التفاصيل على أمريكا أكثر من المملكة المتحدة التي لاتزال
منظمات مناهضة الحرب فاعلة فيها إلى حد ما، وإن كان النموذج الأمريكي
في الهيمنة عن طريق التمويل العسكري يتسلل ويتوسع بسرعة كبيرة. مما
يستدعي، كخطوة أولى، لإعادة نصب الحدود بينه وبين المجتمع المدني، أن
نرى كيف يؤدي الإنفاق العسكري إلى تواطؤ المجتمع المدني في نتائجه
الوخيمة.
كاتبة من العراق
خليجي 25:
حبات لتسكين أوجاع بصرة العراق
هيفاء زنكنة
كم هو مفرح رؤية ناس يبتسمون في بلادنا! فمن النادر، منذ عقود الحرب
والحصار والاحتلال، أن نرى جمهورا عراقيا، يرتدي أفراده الفرح. أن نرى
النساء والرجال يضحكون ويغنون سوية مسرورين، في مكان يوحدهم. يتنفسون
فيه معنى أن يكون المرء عراقيا بألوان ساطعة مثل شمس بلاده بعيدا عن
العزاء الأسود الذي بات وجبة يومية يتناولها الجميع على مضض. هكذا
إجتمع آلاف العراقيين والعرب بمناسبة إفتتاح الألعاب حين إستضاف العراق
البطولة للمرة الثانية، بعد مرور 44 عاما على إقامتها في بغداد عام
1979.
لخصّت احتفالية الافتتاح تاريخ البلد الحضاري ووحدة المشاعر العابرة
للطائفية الدينية والنعرات القومية وكل ما لوث إسم العراق منذ غزوه
واحتلاله عام 2003. فكانت ليلة أُريد لها أن يستمتع زوار مدينة البصرة،
بجنوب العراق، التي يقطنها أكثر من خمسة ملايين نسمة، بضيافة أهلها
المعروفين بطيبتهم وسخاء مشاعرهم، بافتتاح البطولة في ملعب «جذع
النخلة» تذكيرا ببصرة كانت تفتخر، يوما، باحتضانها 16 مليون نخلة، إلا
أن غالبيتها تلفت جراء الحروب بين أعوام 1980 و2003.
كان الافتتاح مبهرا بالأضواء. أشار التعليق الأكثر تداولا عن الافتتاح.
وأكدت الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب أنها عملت على إضاءة الطرق
المؤدية إلى المدينة الرياضية ومحيطها وأبوابها بالإنارة الحديثة
والتراكيب الجديدة. كما أطلقت الشركة حملة تحت وسم ترشيد الكهرباء،
وأشرف وكيـل مديـر توزيـع كهربـاء البصـرة ميدانيـاً على استنـفار
ملاكـات كهربـاء البصـرة لبطـولة الخليج. هذه التأكيدات التي وفرت
للحاضرين والمشاهدين المحبين لكرة القدم الضوء خلال أيام البطولة تثير
عديد التساؤلات. لماذا هذا التحشيد الإعلامي عن التجهيز « الضوئي»؟ ما
هو الغريب في إضاءة ملعب دولي لكرة القدم والشوارع المحيطة به؟ ولماذا
لا يحدث الإشراف الميداني لتزويد عموم أهل البصرة بالكهرباء في كل
الاوقات؟ هل ستقتصرإضاءة الشوارع على أسبوع البطولة فقط لتستعيد
المنطقة بعدها ما تعودت عليه من ظلام؟ وإذا كان بإمكان الجهات الحكومية
المسؤولة توفير مستلزمات وشروط استضافة البطولة، المطلوبة من قبل اتحاد
الكرة الدولي (الفيفا) بشكل جيد، وخلال فترة قياسية، كما لاحظنا، فلم
لا تعمل بنفس الجهد على توفير مستلزمات الحياة الأساسية المطلوبة من
قبل المواطنين، منذ عشرين عاما، والتي هي حق من حقوق المواطنين وليست
منة يتفضل بها المسؤولون على المواطن؟ أم أن تبييض الوجوه أمام العالم
الخارجي، ضروري لاستثمار الأموال المنهوبة، بأرقام مذهلة، التي لم يعد
بالإمكان استثمارها كما كان المسؤولون يطمعون بعد أن فاحت رائحة
الفضائح في أرجاء العالم ؟ وهل هناك ما هو أكثر قدرة على تبييض الوجوه
والأموال والتعتيم على واقع الحياة اليومي البائس للمواطنين ورسم
الابتسامة على وجوههم من إقامة بطولة لكرة القدم التي يصفها البعض
بأنها دين العصر الحديث، محاججين بأنه إذا كانت المسيحية، أكبر ديانة
في العالم، لديها 2.2 مليار متابع، فإن لكرة القدم أكثر من 3 مليارات
متابع؟
لا يقتصر سوء الحال على الكهرباء والماء وتلوث البيئة بل يشمل تدهور الحالة الأمنية. إذ تعيش محافظة البصرة، كما غيرها من المحافظات، حالات التوتر الأمني وصراعات الميليشيات التابعة للأحزاب الحكومية والنزاعات العشائرية وتعرض المحتجين على هذه الأوضاع المزرية للعنف بأنواعه
من حق الناس، بطبيعة الحال، تسكين الوجع ولكن بشرط ألا يتم على حساب
تغطية الأسباب الحقيقية للمرض ومنع الشفاء الكلي. ولننظر إلى واقع
مدينة البصرة، فقط، من هذه الناحية، لتفكيك صورة الاحتفال المضيء،
ولندفع جانبا واقع المحافظات والمدن الأخرى، بضمنها العاصمة بغداد،
لئلا نُتهم بالتشاؤم. يُخبرنا أهل البصرة أن شوارعهم مظلمة، تتراكم
فيها الزبالة، وأنهم يتوسلون زيارة أحد المسؤولين ليرى بعينيه ويفهم أن
انقطاع التيار الكهربائي، مهما كانت الأسباب، لا يعني عدم الإضاءة فحسب
بل هو شلل للحياة اليومية والخدمات الطبية والتنمية الاقتصادية.
ويطالب آخرون بدفع رواتب قُراء المقاييس ومُستحقات المشاريع التي لم
تُدفع، بينما يعتصم أصحاب الشهادات التي ألغيت ولم تحتسب عند التثبيت
أمام وزارة الكهرباء. ويعيش أهل البصرة أزمة نقص المياه الصالحة للشرب
بسبب الملوحة وتاثير الجفاف وارتفاع درجات الحرارة الأعلى عالمياً،
بالإضافة إلى التلوث المزمن الذي يهدد حياة السكان، وخاصة الأطفال،
بأمراض من السهل القضاء عليها إذا ما توفرت النية المخلصة لايجاد
الحلول ووضع حد لجشع الساسة الفاسدين. الجشع الذي ابتلع التخصيصات
المالية مما عرقل إكمال أكثر من 90 مشروعاً لتصفيه المياه وتحليته. كل
هذا يحدث في مدينة غنية بالنفط والمهندسين والعمال من ذوي الكفاءة
وتساهم بتمويل ميزانية العراق بنحو ثمانين بالمائة من مبيعات النفط
والغاز.
ولايقتصر سوء الحال على الكهرباء والماء وتلوث البيئة بل يشمل تدهور
الحالة الأمنية. إذ تعيش محافظة البصرة، كما غيرها من المحافظات، حالات
التوتر الأمني وصراعات الميليشيات التابعة للأحزاب الحكومية والنزاعات
العشائرية وتعرض المحتجين على هذه الأوضاع المزرية للعنف بأنواعه. تؤكد
تقارير منظمة الأمم المتحدة بالعراق فشل لجان التحقيق المُعلن عنها
رسميا للتحقيق في تعرض المتظاهرين للعنف والاختطاف والقتل، وإهمالها
محاسبة المسؤولين وإيصالهم مرحلة المحاكمة والإدانة، وباستثناء قضيتين
فقط ركزت فيهما على أفراد من رتب صغيرة في قوات الشرطة، بقيت الجرائم
ملصقة «بعناصر مسلحة مجهولة الهوية». وما يمنح المجرمين الحصانة من
العقاب هو تعرض عدد من المحققين الذين عملوا في قضايا حساسة للانتقام.
حيث يعطينا تقرير لليونامي، على سبيل المثال، تفاصيل قتل ضابط
استخبارات كلفّته محكمة تحقيق البصرة بالتحقيق في قضايا «فرق الموت»
بدعم من ضباط الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية. وسُجلت الجريمة ضد
« عناصر مسلحة مجهولة». وفي 7 كانون ألاول 2021، انفجرت، في البصرة،
عبوة ناسفة كانت موضوعة في دراجة نارية مما أسفر عن مقتل مدنيين وإصابة
أربعة آخرين بعد فترة وجيزة من مرور ضابط تحقيق في سيارة. كان ولايزال
للبصرة المعطاء نصيبها من الظلم الجاثم على الصدور، بعموم العراق والذي
لن يشفيه تناول مسكن الآلام لمدة إسبوع، بل إيجاد حل علاج جذري لانتشار
فايروس الفساد والطائفية وكل ما تم استحداثه لديمومتهما.
كاتبة من العراق
لِم الاحتفال بالعام الجديد؟
هيفاء زنكنة
ما الذي يدفع الناس لتبادل التمنيات والتهاني في لحظة واحدة من منتصف
ليلة محددة في العام وكأنهم منشدون في فرقة تعزف لهم لحنا جماعيا لا
يُعزف في وقت آخر؟
لماذا: كل عام وأنتم بخير. ولنبدأ بسنة جديدة ملؤها الحب والوفاء
والتسامح. سنة سعيدة وهانئة للجميع. تمنيات نتلقاها ونسمعها من ملايين
الناس في أرجاء المعمورة في يوم محدد من العام. يتبادلها الكل ، جامعة
ما بين التمنيات الفردية والجماعية سواء ضمن الأسرة أو الملتقيات
العامة أو ، وهو الأكثر انتشارا هذه الأيام، مواقع التواصل الاجتماعي.
لننطلق نحو فضاء جديد. لتتحقق آمالنا المشتركة. لا تدع الخيبات الصغيرة
تُنسيك بأنكَ لستَ شخصًا عاديًا. ستكون أقوى وأفضل حالا. هكذا تعدُنا
الرسائل المتبادلة بداية العام الجديد بفحواها الإيجابي ومتعة
المشاركة. «لا نستمتع بالمتعة ما لم نشاركها»، تُذّكرنا الكاتبة
الإنكليزية فيرجينيا وولف التي كانت تعاني من الاكتئاب ورضخت أخيرا
للمرض فوضعت حدا لحياتها، على الرغم من مقاومتها الإبداعية المتمثلة
بالروايات والمؤلفات النقدية. فهل مشاركة التمنيات بالسعادة والهناء،
ولو ليوم واحد، هو محاولة لإبعاد شبح القلق والكآبة الجماعية التي تحيط
بنا ونحن نعيش في خضم دورة إخبارية على مدار الساعة، طيلة أيام العام،
تهيمن عليها قصص العنف والحرب والكوارث الطبيعية والفساد؟ وما الذي
يمنح التلويح مودعين لعام واستقبال عام آخر، في دقيقة محددة، خصوصيته،
على الرغم من إدراكنا الواعي بأنه ليست هناك عصا سحرية ستحيل، في تلك
اللحظة المحددة، ظلمة الليل إلى نهار مشرق يحتضن فيه الناس أنفسهم
والآخرين؟ هل هو التشبث بتعويذة الأمل والحلم باحتفالات طالما مورست
عبر التاريخ ولسنا ، أبناء العصر الحالي أبناءها؟
السعادة ليست فردية بل هي ظاهرة جماعية. وأن علاقاتنا بالآخرين ، قد تكون هي الأكثر أهمية. وهو مفهوم ينطبق على أسلافنا الذين عاشوا في الكهوف، والذين شكلوا هياكل اجتماعية لزيادة احتمالات بقائهم على قيد الحياة
في بابل، احتفل البابليون، قبل حوالي 4000 عام، بشرف وصول العام الجديد
بظهور أول قمر في أواخر شهر آذار/ مارس احتفاء بلحظة شروق الشمس ترحيبا
بمجيء النور بعد الظلام. أقاموا بهذه المناسبة مهرجانا دينيا كبيرا
يسمى أكيتو (مشتقة من الكلمة السومرية للشعير ، الذي يُحصد في الربيع).
تستمر احتفالاته كما هي الاحتفالات الحالية عدة أيام كما في بعض
البلدان. إلا أن الرومان اختاروا تغيير ذلك فأصبح الأول من يناير/
كانون الثاني بداية العام ، لتكريم الشهر الذي يحمل الاسم نفسه: يانوس
، وهو إله البدايات الروماني ، الذي يسمح له وجهاه بالنظر إلى الماضي
وإلى الأمام في المستقبل، تتويجا لتلك اللحظة المُحتفى بها حاليا.
وللطقوس الرومانية يعود الكثير مما نشهده اليوم. فقد احتفل الرومان
بتقديم التضحيات إلى يانوس ، وتبادل الهدايا مع بعضهم البعض ، وتزيين
منازلهم بفروع الغار وحضور الحفلات الصاخبة. أما أوروبا العصور الوسطى
، فقد شهدت تغيرا جمع بين الاختيار البابلي والروماني حين استبدلت
الكنيسة، مؤقتًا الأول من يناير باعتباره الأول من العام بأيام تحمل
أهمية دينية مسيحية، مثل 25 ديسمبر/ كانون الأول (ذكرى ميلاد المسيح) و
25 آذار/ مارس (عيد البشارة) ؛ إلى أن أعاد البابا غريغوري الثالث عشر
تأسيس يوم 1 يناير كيوم رأس السنة الجديدة في عام 1582 .
ولكن، كيف استطاعت طقوس ما قبل آلاف السنين التسلل إلى عصر مابعد
الحداثة وما بعد الحقيقة وأوجه التواصل الاجتماعي المتسعة عبر
التغريدات والواتس آب والانستغرام، لتصبح هذه المستجدات كلها أدوات
للاحتفال وتبادل التهاني والسعادة بعام جديد عابر للقارات؟ وهل يمتد
السؤال ليضم لم الاحتفال بالعام الجديد؟ لم السعادة؟ لم الضحك؟ الضحك
ألذي أثار خوف الكنيسة في القرون الوسطى وجعل الإمام الحسن عند مروره
بشاب يضحك إلى تقريعه قائلا: هل مررت على الصراط؟ قال: لا، قال: وهل
تدري إلى الجنة تصير أم إلى النار؟ قال: لا، قال: فما هذا الضحك؟ فما
رؤي هذا الشاب بعد ضاحكا.
بعيدا عن الحفر التاريخي الذي قد نحمله في دواخلنا، يخبرنا علماء النفس
بأننا بحاجة ماسة لسماع أخبار جيدة، وتبادل التهاني والتمنيات بالصحة
والسعادة هو نوع من مشاركة الأخبار المفرحة التي تؤثر بشكل إيجابي على
الآخرين، وأننا نستخدم وسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة لخلقها ونشرها.
فمن خلال مشاركة إيجابية واحدة، يمكنك إضفاء البهجة أوالتفاؤل أو
الراحة أو الامتنان على يوم شخص حتى لو لم تلتق به من قبل.
ولأن البداية في كل المشاريع المغموسة بالأحلام توحي بالتفاؤل، فإن ما
نتمناه ونطمح اليه لأنفسنا والآخرين هو شحن للأحلام في أن تكون تلك
الدقيقة الفاصلة بين ليلة وليلة، هي محطة النهاية والبداية، والانتقال
من حال إلى آخر، على ايقاع أصوات تُردد العد التنازلي من العشرة إلى
الصفر، وممارسة طقوس تنشد السعادة . السعادة التي أصبحت في عصر التواصل
الاجتماعي، كما تُشير الدراسات، شديدة العدوى مثل الفيروسات والأمر
ذاته ينطبق على المشاعر السلبية. فالكتابات ألتي تُستخدم فيها كلمات
مثل «فرح ، وحب ، ورائع، وجميل» أو تبادل قطعة موسيقية أو أغنية مشحونة
بالعواطف أو ذكريات « الزمن الجميل» تتم مشاركتها بنسبة 70 بالمئة أكثر
من الكتابات ألتي تضم مفردات « قلق ، ومؤلم ، وحزين، وقبيح». ووجد
علماء تتبعوا الاستجابات العاطفية لمستخدمي الفيسبوك في ألمانيا
والولايات المتحدة أن قراءة المشاركات الإيجابية لأشخاص آخرين تثير
السعادة في 64 بالمئة من الناس. كما أن مشاركة الأخبار الإيجابية لها
مزايا مباشرة على كاتبها أو موزّعها. إذ يزيد إيصال التجربة الإيجابية
التي يمر بها الشخص إلى آخر من تأثير التجربة الإيجابية نفسها لأنه
سيعيشها ويستمتع بها من جديد. وإذا كان من المعروف أن الضحك مُعد، فقد
اتضح، الآن، أن السعادة كذلك. وأظهرت دراسة نُشرت في المجلة الطبية
البريطانية ، أن السعادة ليست فردية بل هي ظاهرة جماعية. وأن علاقاتنا
بالآخرين ، قد تكون هي الأكثر أهمية. وهو مفهوم ينطبق على أسلافنا
الذين عاشوا في الكهوف، والذين شكلوا هياكل اجتماعية لزيادة احتمالات
بقائهم على قيد الحياة. فهل هذا هو السبب الذي يجعلنا نتبادل التهاني
والتمنيات بالخير والسعادة كطوق نجاة، ولو لبضع ساعات، في بحر الحروب
والمآسي المحيط بنا؟
الاتجار بالبشر بين
المهربين والحكومة البريطانية
هيفاء زنكنة
في خضم الاحتفالات بعيد الميلاد وفرحة الناس باستقبال عام جديد وتغني
المحتفلين بالتواصل الإنساني، تواصل الحكومات الغربية بناء الجدران
العالية حول حدودها لمنع المهاجرين الهاربين من الحروب والنزاعات
والكوارث البيئية من الوصول إلى بر الأمان، بذريعة حماية مصالح
مواطنيها بل وحماية حياة المهاجرين أنفسهم من وحشية المهربين. فما إنْ
تنشر وكالات الأنباء أخبار مهاجرين يلقون حتفهم أثناء محاولتهم عبور
بحر المانش (القناة الإنكليزية) على متن قوارب طلباً للجوء في المملكة
المتحدة، مثلا، حتى يُسارع السياسيون في جميع أنحاء أوروبا، وليس في
بريطانيا وفرنسا فقط، للتعبيرعن صدمتهم وحزنهم، في ذات الوقت الذي
يعملون فيه على منع اللاجئين من الوصول بمختلف الطرق ومنها استحداث
تغييرات في قوانين الهجرة وإصدار تشريعات تفرض العقوبات على طالبي
اللجوء بل وتجريمهم، ليسقط المهاجرون ضحايا محترفي الإتجار بالبشر من
جهة والساسة الغربيين، محترفي الزيف والمعايير المزدوجة من جهة أخرى.
تحتل بريطانيا مركز الصدارة في إبداء الأسى حول محنة المهاجرين ظاهريا
ومعاقبتهم عمليا. فبينما وقفت وزيرة الداخلية البريطانية، سولا
بريفرمان، في البرلمان، لتُعبر عن أساها العميق لمقتل أربعة مهاجرين
بعد انقلاب قاربهم في القناة الإنكليزية في الساعات الأولى من صباح 20
ديسمبر/كانون الأول، ملقية اللوم على معاملة المهربين الوحشية
للمهاجرين، تعهدت بتسريع تنفيذ القوانين الجديدة عن كيفية التعامل معهم
بعد أن وصفتهم بأنهم غير قانونيين ويغشّون النظام، ووضع القيود الصارمة
على طالبي اللجوء، المؤجلة قضاياهم، منذ سنوات أحيانا، مع استمرار
احتجازهم في ظروف وصفها المتحدث باسم منظمة العفو الدولية بأنها «غير
إنسانية، بما في ذلك احتجازهم في ثكنات عسكرية سابقة تفشت فيها حالات
الإصابة بفيروس كوفيد».
وقد أثارت سياسة الحكومة البريطانية الداعية إلى ترحيل طالبي اللجوء
إلى رواندا، خاصة بعد إصدار المحكمة العليا قرارها بأن خطة حكومة حزب
المحافظين لإرسال الأشخاص الذين يسعون للحصول على الحماية في المملكة
المتحدة إلى رواندا، في وسط إفريقيا، قانونية، غضب الناشطين والمنظمات
الحقوقية والإنسانية. كما دفع قرار رئيس الوزراء ريشي سوناك عقد صفقة
بقيمة 140 مليون جنيه إسترليني مع فرنسا، لمنع وصول المهاجرين إلى
بريطانيا، فولكر تورك مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى التصريح
لصحيفة الغارديان بأنه قرار يثير مخاوف خطيرة للغاية سواء من منظور
حقوق الإنسان الدولية أو من منظور قانون اللاجئين الدولي مستخلصا بأنه
من غير المرجح أن ينجح. وحث الحكومة البريطانية على إعادة النظر في
خططها لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، محذرا من أن مخططات «النقل إلى
الخارج» المماثلة في الماضي أدت إلى معاملة «غير إنسانية للغاية»
للاجئين.
اقتراح حزب المحافظين ترحيل طالبي اللجوء من بريطانيا إلى رواندا جاء تلبية لما تريد تحقيقَه الغالبيةُ العظمى من الشعب البريطاني
في المقابل يقول ريشي سوناك إنه يستند في قراراته عن الهجرة إلى
«الأولوية المطلقة للشعب البريطاني وهي السيطرة على الهجرة غير
الشرعية». وتقول وزيرة الداخلية إن اقتراح حزب المحافظين ترحيل طالبي
اللجوء من بريطانيا إلى رواندا جاء تلبية لما تريد تحقيقه الغالبية
العظمى من الشعب البريطاني، لذلك ستعمل على تنفيذه «على نطاق واسع
وبأسرع وقت ممكن».
هل صحيح أن قرار حكومة المحافظين جاء تلبية لرغبة الشعب البريطاني؟
تقدم معطيات مؤسسة «أبسوس الدولية» لسبر الرأي، وهي واحدة من عدة، صورة
مختلفة عما يدّعيه رئيس الوزراء البريطاني ووزيرة الداخلية حول رغبة
الشعب في تقليل عدد اللاجئين القادمين إلى بريطانيا. إذ يبين الاستبيان
أن دعم تقليل الهجرة في أدنى مستوى له منذ إجراء مسح التتبع لأول مرة
في شباط/فبراير 2015، وأن عددا أكبر من الناس يشعرون أن الهجرة كان لها
تأثير إيجابي على بريطانيا (46 في المئة) من تأثيرها السلبي (29 في
المئة) وأن 42 في المئة فقط يؤيدون تخفيض الهجرة، فيما يفضل 26 في
المئة بقاءها كما هي، و 24 في المئة يرغبون بزيادتها. ويعتقد 52 في
المئة من عموم الشعب البريطاني و 43 في المئة من مؤيدي حكومة حزب
المحافظين أن «خطة رواندا» لن تنجح في تقليل عدد الأشخاص القادمين إلى
المملكة المتحدة لطلب اللجوء دون إذن. كما يعتقد 34 في المئة من
الجمهور أنه من المرجح أن البرنامج سيثني اللاجئين الحقيقيين عن التقدم
بطلب اللجوء وهي نتيجة مأساوية لمن يعانون ويلات الحرب والتعذيب
وانتهاكات حقوق الإنسان ومن حقهم اللجوء إلى مكان آمن وليس الترحيل إلى
مكان يعاني سكانه، أنفسهم، من انتهاكات حقوق الإنسان.
وإذا كانت الحكومات الاوربية تطبل وتزّمر لإنسانيتها في استقبال
اللاجئين وتشرع القوانين المنتهكة للقوانين الدولية والإنسانية لمنع
وصولهم إلى أراضيها فإن واقع الحال المدعوم بإحصائيات الأمم المتحدة
يبين أن ألمانيا هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي استقبلت 1.2 مليون
لاجئ من بين 12 دولة أخرى، استقبلت ملايين اللاجئين في الأعوام
الأخيرة. حيث يوجد في تركيا مثلا 3.6 مليون سوري وعراقي، وفي باكستان
1.5 أفغاني، و3.6 مليون في أوغندا ومعظمهم من جنوب السودان، ومليون في
لبنان وما يعادله في السودان ومليون في أثيوبيا من مهاجري السودان
وأرتيريا والصومال. هذه الأرقام المليونية من المهاجرين إلى بلدان
تعاني هي نفسها من الفقر، في تزايد مستمر، كونها مجاورة لبلدان نشبت
فيها حروب، غالبا ما تغذيها صناعة السلاح والحروب الأمريكية ـ
الأوروبية ـ الإسرائيلية، بشكل لامثيل له، والتي تشكل العمود الفقري في
تحالفاتها السياسية والاقتصادية مهما كان الثمن البشري.
إن أي مراجعة سريعة لأسباب الحروب والاحتلال في أرجاء العالم ستأخذنا
إلى الدول الرافضة لاستقبال اللاجئين ذاتها. فمن هو المسؤول عن إقامة
الكيان الصهيوني وتهجير الشعب الفلسطيني؟ ومن هو المسؤول عن الحرب في
أفغانستان؟ ماذا عن غزو واحتلال العراق ونهب ثروته وتشريد أهله؟ هذا هو
بالضبط ما تحاول الحكومة البريطانية ممثلة برئيس وزرائها ووزيرة
الداخلية (المفارقة أن كليهما من عوائل مهاجرة) والحكومات الأوروبية
وأمريكا، تزويره والتظاهر بالإنسانية ومعارضة الإتجار بالبشر بينما
يثبت حاضرهم، كما هو تاريخهم، أن ما يقومون به هو الإتجار بالبشر.
كاتبة من العراق
هستيريا التشويه الصهيوني
لفوز الفريق المغربي
هيفاء زنكنة
منح الفريق المغربي متابعي بطولة كرة القدم، في أرجاء العالم، ساعات
فرح نقية قلما يحظى بها الكثيرون، خاصة من (الشعوب العربية والافريقية
والمسلمة والأمازيغية). مع ملاحظة أن هذه التوصيفات ليست من عندي بل
أنها خلطة مُسميات أُطلقت على الفريق المغربي، من قبل المشجعين والنقاد
والمعلقين، كل حسب إنتمائه القومي والديني، إما اعتزازا بالانتماء أو
مشاركة بالفوز أو «النصر»، المعروف بندرته في عالمنا.
كما نجح الفريق في توحيد مشاعر الفخر والاعتزاز بالانتماء والهوية بين
المشجعين المماثل، الى حد كبير، بما ساد حول تنظيم البطولة، بالإضافة
الى التعبير الجماهيري الرمزي، برفع الأعلام، الدال على حضور وتجذر
عدالة القضية الفلسطينية. وهو إنجاز لم يغب عن أنظار أجهزة الإعلام
الصهيونية، داخل كيان الاحتلال الصهيوني وخارجه، فشنت حملة مكثفة تجمع،
بشكل مباشر وغير مباشر، وعلى مختلف المستويات، بين التشويه والتلفيق و
«مظلومية الضحية الأبدية» المتناسلة عبر الأجيال.
وقد وجدت، عند قراءتي، عددا من المقالات المنشورة ضمن الحملة، خاصة تلك
المنشورة على المواقع الصهيونية الأمريكية، التي تقدم نفسها كمؤسسات
فكرية ومراكز سياسات « تفتخر بتحدي الأكاذيب والتحريفات السائدة عن
إسرائيل في سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط»، تركيزها على «
المظلومية» وكونها ضحية عداء مستديم. وهو مفهوم استطاعت الحركة
الصهيونية تسويقه عالميا قبل تأسيس الكيان الصهيوني ولاتزال بعد تأسيس
الكيان بمسميات مختلفة، لعل مثالها الأبرز، أخيرا، ما وصفه مركز أمريكي
صهيوني بأنه «الواقع الإسرائيلي للعيش وسط بحر من الرفض والعداء
المطلق»، مشيرا بذلك إلى «مشاعر العداء والغضب التي تعرض لها المراسلون
والصحافيون الإسرائيليون، في قطر، مما أجبر الكثيرين منهم على العودة
إلى إسرائيل»، ومتباكيا بأن «جميع المراسلين والصحافيين الإسرائيليين
تعرضوا تقريبًا للإذلال والعداء والتهديدات العلنية».
وتزخر الحملة الصهيونية بأمثلة ردود الفعل الجماهيرية ضد مراسلي الكيان
الصهيوني أثناء «مهرجان الكراهية»، حسب التسمية الصهيونية لبطولة كأس
العالم.
من بين الأمثلة التي نشرت، عبر الفيديو، استخدام الجمهور تعابير غاضبة
على غرار : «أنتم غير مرحب بكم هنا. لا إسرائيل، فقط فلسطين!» و
«لايوجد شيء اسمه إسرائيل». وكيف اضطر أحد المراسلين إلى القول بأنه من
البرتغال وسارع مذيع إلى القول بأنه من الأكوادور إزاء استهجان الجمهور
لوجودهم. واعتبرت «مؤسسات الفكر» الصهيونية حمل المشجعين للأعلام
الفلسطينية ترويعا وترهيبا ضد المراسلين، في ذات الوقت الذي ترى فيه أن
قتل الأطفال الفلسطينيين، وقصف وتهديم البيوت، والاستيلاء على الأراضي
الفلسطينية لبناء مستوطنات الاحتلال ومنع الفلسطيني من العودة إلى
وطنه، فعلا ضروريا للقضاء على الإرهاب وبيع بضاعة «السلام».
كان من الطبيعي أن ترتفع درجة الهستيريا الصهيونية في حملة التزوير والتشويه، إزاء الحماس الجماهيري العارم لفوز الفريق المغربي، وإصرار الفريق على الربط بين الفوز الكروي الآني والأمل بالنصر الفلسطيني متمثلا برفع العلم
ولم تسلم قطر التي وافقت، حسب موقع «منتدى الشرق الأوسط» الصهيوني
الأمريكي الذي يترأسه دانيال بايبس، على «استضافة المراسلين والمشجعين
الإسرائيليين مؤقتا» من رذاذ الهجوم، فكان الاستطراد بأن الاستضافة تمت
«على الرغم من موقف قطر المعروف المتمثل في الترويج للكراهية المعادية
لإسرائيل ومعاداة السامية ودعم منظمة حماس الإرهابية»، وكيف أن
الموافقة تمت بناء على طلب «غير قابل للتفاوض من قبل الاتحاد الدولي
لكرة القدم ( الفيفا) المنظّم للبطولة»، خاصة وأن قطر حصلت على دعم
الاتحاد فيما يخص منع حضور المثليين. ويخلص موقع المنتدى إلى «أن
الكراهية التي يعيشها الإسرائيليون في قطر هي عينة تمثيلية للدول ذات
أسوأ أنواع الالتزام الثقافي والديني بمعاداة الصهيونية. ومع ذلك، ليس
هناك شك في أن مثل هذا العداء لم يكن ليحدث لولا السياسة والمناخ
الرسميان المناهضان لإسرائيل الذي تصر قطر على الحفاظ عليه وتمويله
محليًا وإقليميًا». يتعامى الموقع هنا في خلاصته عن ذكر أن شعوب الكثير
من دول العالم، من بينها بريطانيا صاحبة وعد بلفور، وأمريكا الراعية
الأولى للكيان، باتت، في العقود الأخيرة، جراء وحشية وعنصرية النظام
الصهيوني، متهمة هي الأخرى، كما العرب والمسلمين، بمعاداة الصهيونية
حينا والسامية حينا آخر وذلك لوقوفها بجانب نضال ومقاومة الشعب
الفلسطيني. لم تعد القضية الفلسطينية تقتصر على الشعوب العربية
والإسلامية، كما يدّعي الصهاينة لتبرير جرائمهم، بل امتدت ليتم تبنيها
كرمز عالمي لتحقيق العدالة، في أرجاء العالم، خاصة بعد نجاح وشعبية
حركة المقاطعة الاقتصادية والثقافية.
لذلك كان من الطبيعي أن ترتفع درجة الهستيريا الصهيونية في حملة
التزوير والتشويه، إزاء الحماس الجماهيري العارم لفوز الفريق المغربي،
وإصرار الفريق على الربط بين الفوز الكروي الآني والأمل بالنصر
الفلسطيني متمثلا برفع العلم واحتضانه عند كل فوز. ومن الطبيعي أن
تزداد الهستيريا شراسة، فكل «ألف مبروك لأسود الأطلس»، « ومبارك لكم
الفوز» على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الاتصالات الهاتفية واللقاءات
العائلية والبرامج التلفزيونية والاحتفالات في الأماكن العامة، تحول
تدريجيا إلى «مبارك لنا الفوز». صار عنوانا ونشيدا وأغنية واستعادة
للأمل في الوحدة الجماهيرية والتحرر من عبودية الاحتلال الصهيوني في
وقت تحاول فيه حكومات عربية إقناع الشعوب بأنها ضعيفة، بلا قدرة على
التغيير، وأن الحل الوحيد هو التطبيع وتناول ما يرميه الغرب إليها من
فتات «اتفاق أبراهام» بمباركة أمريكا.
هل صحيح أن ما عبر عنه لاعبو الفريق المغربي ومن قبله التونسي من حب
للشعب الفلسطيني وإيمان بقضيته، عبر رفع العلم، ما كان سيحدث لولا
«السياسة والمناخ الرسميان المناهضان لإسرائيل في قطر» كما يدّعي دعاة
الحملة الصهيونية؟ لا أظن ذلك، فتحرير فلسطين مطلب يمتد عميقا في وعي
الشعوب، كان قبل المونديال وسيبقى بعده، ثم أن مساندة القضية
الفلسطينية ومناهضة الكيان الاستيطاني الصهيوني ليست جريمة تُشعر المرء
أو الحكومات بالعار. إنها موقف مبدئي أخلاقي وانساني وقانوني يرفع
الرأس فخرا واعتزازا ويُفرح القلوب كما فعل فريق أسود الأطلس، ونأمل أن
يفعل دوما.
كاتبة من العراق
(في مثل هذا اليوم) من اسكتلندا:
يوميات تصنيع كيان ومقاومة شعب
هيفاء زنكنة
هل بإمكاننا أن نُحدثُ تغييرا، في أي مجال عام، ونحن نعيش في عصر تزخ
فيه الأخبار السيئة على رؤوسنا بشكل يومي؟
هل من قيمة للمبادرة الفردية وأنشطة التضامن إزاء أنظمة تقتات على
تجارة السلاح وهدفها الأول والأخير الهيمنة على الشعوب بمساعدة حكام
محليين يديرون التضليل والقمع بالوكالة؟ ماذا عن الأنشطة الجامعة بين
التوعية والتوثيق والحفاظ على الذاكرة، في عصر يتميز بكثافة التضليل
الأعلامي وفبركة الأخبار؟
عشرات الأسئلة يثيرها يوم 29 تشرين الثاني/ نوفمبر، وقرار الجمعية
العامة للأمم المتحدة، المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر1977 للاحتفال به من
كل عام باعتباره اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وهو ذات
اليوم من عام 1947 الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة قرار تقسيم فلسطين.
تأخذنا محاولة العثور على أجوبة إلى النظر في نوعية النشاطات المنظّمة
بمناسبة «اليوم». حيث تقام، في كل عام، نشاطات كثيرة، في أرجاء العالم،
من بينها نشاطات رسمية لحكومات تساهم، عمليا، في ديمومة الاحتلال
وتبرير جرائم وانتهاكات المحتل اليومية ضد الشعب الفلسطيني، بينما
تدّعي العكس لتتجنب أما إغضاب شعوبها كما في البلدان العربية أو إغضاب
الكيان الصهيوني شاهر سلاح «معاداة السامية» في البلدان الغربية. هناك،
أيضا، فعاليات تحييها منظمات الأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية
الدولية ومنظمات المجتمع المدني في عديد البلدان، ويتبنى معظمها خطاب
الأمم المتحدة الرسمي «للتوعية بمحنة الشعب الفلسطيني وحشد الدعم
لنضاله في سبيل نيل حقوقه غير القابلة للتصرّف». ما يميز هذه النشاطات،
بالدرجة الأولى، كونها مرتبطة بـ «اليوم» الذي دعت إليه الأمم المتحدة،
بينما يعيش الشعب الفلسطيني في سجن الاحتلال في كل دقيقة من دقائق
يومه، بسنوات الاحتلال حيث «جدران بيتك تحفظ عن ظهر قلب وجوه القذائف،
وأنت بباب المشيئة واقف، وصوتك نازف، وصمتك نازف، تلم الرصاص من الصور
العائلية، وتتبع مسرى الصواريخ في لحم أشيائك المنزلية، وتحصي ثقوب
شظايا القنابل في جسد الطفلة النائمة»، كما صورّها الشاعر الراحل سميح
القاسم، ولا تزال متمثلة في معاناة الفلسطيني ومقاومته ألتي تُعري قتلة
الاحتلال وهم ينفذون جرائمهم وإعداماتهم في الشوارع العامة.
من هنا، من ديمومة المقاومة الفلسطينية التي يدفع الفلسطيني حياته ثمنا
لها، تنبع ضرورة استمرار التضامن العالمي، بشكل يومي، مهما كان حجمه،
ليكون جزءا لايتجزأ من إثبات الإنسان لإنسانيته وتعطشه لتحقيق العدالة،
وألا يقتصر على يوم واحد في السنة وألا يختزل النضال لتحرير فلسطين
التاريخية ووصف الاستعمار الصهيوني الاستيطاني بأنه نزاع.
إن مبادرة « في مثل هذا اليوم»، التي يشارك في إعدادها ونشرها قلة من الناشطين المؤمنين بعدالة القضية الفلسطينية، تؤكد أهمية مبادرات التضامن العالمية
من بين المنظمات الناشطة في تطبيق هذا الموقف المبدئي، على الرغم من
حملات التشويه التي تتعرض لها تحت مزاعم «معاداة السامية»، هي «حملة
التضامن الاسكتلندية مع فلسطين»، التي أسسها الناشط الحقوقي ميك
نابيار، عام 2000، وتديرها الناشطة صوفيا ماكلاود. تهدف الحملة إلى
التوعية، وتحشيد المعارضة العامة لمشروع الاستعمار الاستيطاني
الصهيوني، وتواطؤ حكومة المملكة المتحدة لدعم إسرائيل، وإرسال رسالة
تضامن قوية مع مقاومة الشعب الفلسطيني، من خلال عديد النشاطات ومن
بينها المشاركة العملية في حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض
العقوبات على إسرائيل حتى تنهي احتلال الأراضي الفلسطينية.
لمواجهة الحملات المحمومة لمحو الذاكرة وكتابة التاريخ وفق الأجندة
الصهيونية الاستعمارية، شرعت الحملة، قبل عامين، باستحداث «في مثل هذا
اليوم» باللغتين الانكليزية والعربية. مستفيدة من التطور التقني في
أسلوب التواصل، وفرت الحملة «في مثل هذا اليوم» للاستلام عبر الواتس
آب، بالإضافة إلى موقع الحملة الرسمي وصفحتها على الفيسبوك. وهي خدمة
مجانية، يصفها محمد عيسى، أستاذ الفيزياء المتقاعد، ومترجمها إلى
العربية، بأنها «فكرة بسيطة لمذكرات باتت تجذب جمهورًا متزايدًا من
جميع أنحاء العالم. « في مثل هذا اليوم»، ليس مجرد سجل جاف للحقائق
التاريخية، بل أكثر من ذلك بكثير… في وقت يتم فيه إسكات أصوات
الفلسطينيين ومحو روايتهم وتاريخهم».
ويستطرد قائلا «عندما طُلب مني إجراء الترجمة العربية لليوميات، أدركت
فجأة مدى ضآلة تعرضنا للتاريخ الفلسطيني بشكل يسهل الوصول إليه». وهو
ذات الاحساس الذي انتابني وأنا أتابع ما أستلمه، يوميا، منذ عامين على
هاتفي المحمول، من يوميات موثقة، كان بعضها أما مدفونا في ملفات سرية
أو لعلها ضائعة في زخم المتوفر من غث وسمين. فإذا كان هذا احساسنا، نحن
الذين درسنا تاريخ فلسطين ونحمل فلسطين بدواخلنا، فكيف بالغربي الذي لم
يكن حتى فترة قصيرة يرفض حتى لفظ اسم فلسطين ناهيك معرفته بتاريخ
الاحتلال وما قاد إلى تصنيع الكيان الصهيوني؟
من بين اليوميات، مثلا، تذكير بما حدث في 24 نوفمبر من عام 1940، حين
قامت المجموعتان الصهيونيتان الإرهابيتان الهاغاناه بالتنسيق مع
الإرغون بتهريب قنبلة ضخمة على متن سفينة في ميناء حيفا. كانت السفينه
باتريا س س تنقل آخر 1800 لاجئ يهودي من ألمانيا النازية متجهين إلى
موريشيوس، حيث توجد منشآت لتوفير ملاذ آمن للاجئين. تم تفجير القنبلة
في الساعة التاسعة من صباح اليوم التالي، مما أسفر عن مقتل 267 وإصابة
172 آخرين.
كان هدف الاعتداء منع مغادرة أي يهودي من فلسطين. أما في 4 ديسمبر، عام
1948، فقد نشر ألبرت أينشتاين وعدد من اليهود الأمريكيين البارزين
رسالة في صحيفة « نيويورك تايمز» تدين حزب حيروت، سلف حزب الليكود
برئاسة نتنياهو حاليا، باعتباره «قريبًا جدًا في تنظيمه وأساليبه
وفلسفته السياسية وجاذبيته الاجتماعية من الأحزاب النازية والفاشية «.
استخدم حيروت «أساليب العصابات» و«افتتح عهد الإرهاب ضد الجالية
اليهودية في فلسطين» وكذلك ضد الفلسطينيين. مُنح مؤسس حيروت مناحيم
بيغن على جائزة نوبل للسلام بعد 30 عامًا.
إن مبادرة « في مثل هذا اليوم»، التي يشارك في إعدادها ونشرها قلة من
الناشطين المؤمنين بعدالة القضية الفلسطينية، تؤكد أهمية مبادرات
التضامن العالمية، وما توفره للقراء، سهلة القراءة، عميقة وقصيرة،
بعيدة عن رطانة الخطب، مما يجعلها أقرب إلى ومضة نور في محيط مظلم أو
مفتاح باب يقود إلى فضاء معرفة أوسع.
كاتبة من العراق
السيادة العراقية المنتهكة
هيفاء زنكنة
أعلنت الحكومة العراقية، يوم الأربعاء الماضي، عن اتخاذ قرارات لوضع
خطة لإعادة نشر قوات عراقية على طول الحدود مع إيران وتركيا لتأمين
الحدود في إطار العمل على وقف الاعتداءات والخروقات التركية
والإيرانية، التي شهدتها الحدود العراقية مؤخرا. وهو إعلان تشي تركيبته
«اتخاذ قرارات لوضع خطة» بأنه قد لا يزيد عن كونه إعلانا مجانيا آخر
مقابل التوغل التركي ـ الإيراني داخل العراق والكولونيالية الأمريكية
الجديدة بمستوياتها المتعددة.
كما هو معروف، لم يتوقف سيل الاجتماعات الرسمية، يوما في العراق،
للتأكيد على « أهمية الحفاظ على سيادة العراق وما تحقق من منجزات
أمنية»، ومن بينها ما أخبرنا عنه مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي،
في تغريدة له بأنه التقى رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي، يوم السبت
الماضي وبحثا موضوع سيادة العراق، في ذات اليوم الذي التقى فيه رئيس
مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، مع رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني
بافل طالباني، وبحثا «ملف تأمين الحدود العراقية».
تهدف اجتماعات « التباحث» كلها إلى التصريح بأن «سيادة العراق» هي محط
اهتمام الساسة العراقيين، من مختلف الأحزاب، وعلى رأسهم المسؤولون
الحكوميون، بالإضافة إلى كونها «مصدر قلق» دولي. وعلى مدى العشرين عاما
الأخيرة، بات موضوع «السيادة»، مصدر رزق لباعة الورق واستديوهات
الأخبار التلفزيونية، ومزايدات الساسة في مجلس النواب، وأطنان البيانات
والتصريحات الرسمية. فالسيادة، كما هو كل شيء آخر في «العراق الجديد»،
من الإنسان إلى البيئة، لا تزيد عن كونها بضاعة مُغلّفة بورق صقيل
للاستهلاك المحلي والدولي. بضاعة لم يعد بالامكان التعرف عليها لفرط
تبادلها في سوق المزايدات السياسية. وإلا ما معنى أن يجد من يراجع عدد
عمليات القصف والتوغل التركي / الإيراني، في الأراضي العراقية، أنه
إزاء قائمة طويلة من الانتهاكات المارة مرور الكرام على الرغم من أنها
تسبب في كل مرة، تقريبا، سقوط الضحايا وترويع السكان وتهديم البيوت
بالإضافة إلى خرق الاتفاقيات بين العراق وتركيا من جهة والعراق وإيران
من جهة أخرى ناهيك عن المواثيق الدولية؟
تبلغ مفارقة الاستهانة بمعنى السيادة الوطنية وحياة المواطنين ذروتها حين تغطي كل دولة انتهاكاتها بذريعة «الحفاظ على الأمن القومي» ومكافحة الإرهاب، في ذات الوقت الذي تدين فيه ما تراه اعتداء او جريمة الآخرين
في مراجعة سريعة لوضع «السيادة العراقية»، المنتهكة، باستمرار، سنجد أن
تصريحات الساسة العراقيين للانتهاكات تتماشى مع ولائهم لهذه الجهة أو
تلك أكثر منها لصالح موقف وطني عراقي. ففي الوقت الذي يقف فيه فريق من
الساسة للتاكيد بأن استمرار انتهاك تركيا للسيادة العراقية أمر خطير،
ومع تندّيد رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي، بارتكاب
«القوات التركية انتهاكا صريحا وسافرا للسيادة العراقية»، كان الصمت هو
اللغة السائدة إزاء توغل القوات الإيرانية في الأراضي العراقية منذ
أبريل 2006، وقصفها داخل الحدود بالمدفعية الثقيلة. ويصادفه، في الوقت
نفسه، ترحيب بقصف أمريكي مهما كان عدد الضحايا.
وتبلغ مفارقة الاستهانة بمعنى السيادة الوطنية وحياة المواطنين ذروتها
حين تغطي كل دولة انتهاكاتها بذريعة «الحفاظ على الأمن القومي» ومكافحة
الإرهاب، في ذات الوقت الذي تدين فيه ما تراه اعتداء او جريمة الآخرين.
فقد برّرت إيران قصفها كردستان العراق، في رسالة إلى مجلس الأمن
الدولي، بعدم وجود «خيار آخر» لديها لحماية نفسها من «جماعات إرهابية»
وأنها استخدمت «حقها المبدئي في الدفاع عن نفسها في إطار القانون
الدولي من أجل حماية أمنها القومي والدفاع عن شعبها». ولرش الملح على
الجروح، صرح السفير الإيراني إيراج مسجدي بأن بلاده لا تقبل وجود أي
قوات أجنبية في العراق ولا التدخل العسكري فيه، مطالباً القوات التركية
بالانسحاب وألا تشكل أي تهديد للأراضي العراقية.
بالمقابل قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في خطاب أمام البرلمان:
«عملياتنا بواسطة الطائرات والمدافع والمسيّرات ليست سوى البداية،
سنواصل العمليات الجوية بدون توقف وسندخل أراضي الإرهابيين في الوقت
الذي يبدو لنا مناسبًا». أما الموقف الأمريكي فقد تضمن، بلسان المتحدث
باسم وزارة الخارجية نيد برايس إدانة إيران لارتكابها « الانتهاكات
المتكررة وغير المسؤولة لوحدة الأراضي العراقية»، مبينا أن الولايات
المتحدة تقف مع شركائها في بغداد وأربيل وتشارك الحكومة العراقية هدفها
في الحفاظ على أمن البلاد واستقراره وسيادته. ماذا عن العمليات
التركية؟ اقتصر تصريحه حول الهجوم التركي على «معارضة أي عمل عسكري غير
منسق في العراق ينتهك سيادته». مؤكدا بذلك ضرورة التنسيق مع أمريكا حول
أي عمل عسكري في العراق، باعتبارها شرطي العالم المقاتل ضد الإرهاب،
متعاميا عن حقيقة أن من بذر الارهاب في العراق، ويواصل رعايته، هو
أمريكا نفسها.
تدل متابعة الادعاءات العراقية والإيرانية والتركية والأمريكية حول
انتهاك السيادة العراقية على مدى العقدين الأخيرين، تقريبا، أنها
متشابهة الفحوى والخطاب. وأن لكل دولة تساهم بارتكاب الانتهاكات،
بالاشتراك مع الساسة العراقيين الموالين لها، حاجتها الماسة لوجود
العدو الخارجي. وهو واحد من أقدم الاساليب للهيمنة على الشعوب، فما أن
يواجه القادة السياسيون تحديات محلية لقيادتهم، حتى يميلون إلى بدء
الصراع بين الدول، وتحويل الانتباه المحلي إلى الشؤون الخارجية. وهذا
ما يحدث حاليا في إيران وتركيا، وهو سيناريو قابل للنجاح، خاصة مع توفر
الأراضي والحدود العراقية المفتوحة لكل من هب ودب من خارجها، والمتنازع
عليها داخليا، بالإضافة إلى أنه لم يعد من الصعب على أية دولة شن حرب
ضد دولة أخرى أو حملة قمع وترويع داخل البلد، بإسم «مكافحة الإرهاب»،
منذ أن صاغت امريكا تعريف الإرهاب وفق أجندتها الخاصة وباتت تفرضه على
العالم في اتفاقياتها « الأمنية المشتركة». من هذا المنطلق، وفي ظل هذه
الظروف الخارجية، سيبقى العراق رهينة كل دولة تريد تحويل النظر عن
أزماتها السياسية والاقتصادية ومشاكلها الحقيقية مع شعوبها، مهما كانت
ادعاءات النظام العراقي عن « تأمين السيادة».
كاتبة من العراق
وجبة
ماكدونالد للمرأة العراقية
هيفاء زنكنة
منذ احتلال العراق، عام 2003، والذي تم تسويقه تحريرا، ومنظمة الأمم
المتحدة ناشطة، بمثابرة تثير الإعجاب، في عقد المؤتمرات وورشات التدريب
وتوقيع اتفاقيات الشراكة حول وضع المرأة مع النظام.
آخر الاتفاقات، وقعَّه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم
المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في 31 أكتوبر / تشرين
الأول، بقيمة مليون دولار لدعم المشاركة السياسية للمرأة وتمثيلها في
العراق. يهدف المشروع المشترك، حسب بيان المنظمة على «معالجة القيود
المفروضة على صوت المرأة السياسي، وتعزيز صنع القرار والقيادة للمرأة
في الأماكن المنتخبة، وزيادة القيادة في الفضاءات المدنية».
وكان قد سبق ذلك بأيام توقيع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق
الأمم المتحدة للسكان اتفاقية لدعم حكومة العراق في تقييم حالة تنمية
الشباب في العراق «من أجل تعزيز السياسات والبرامج والميزانيات التي
تركز على الشباب».
هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها منظمات الأمم المتحدة بتوقيع
اتفاقيات مع جهات ومؤسسات حكومية عراقية تحاول من خلالها معالجة محنة
النساء خاصة والشباب، عموما، وتنفيذ التوصيات أو بعض التوصيات المطروحة
في مئات التقارير الأممية والمحلية الموثقة بالإحصائيات والشهادات
لتحسين الأوضاع. ضمن قائمة المؤتمرات، عُقد في حزيران/ يونيو من العام
الحالي، ما تمت تسميته بلغة دبلوماسية مهذبة «تسليط الضوء على الوضع
المقلق للزواج المبكر» بدلا من جريمة زواج القاصرات، إذا ما أردنا
تطبيق القانون الذي يحدد سن الزواج 18 عاما.
تثير مواظبة الأمم المتحدة على عقد المؤتمرات وتوقيع الاتفاقيات مع
النظام، ومعظمها بمباركة أمريكية (الولايات المتحدة هي الممول الرئيسي
للمنظمة)، تساؤلا حول جدواها مع تجنب إطلاق حكم بسوء النية الدائمة أو
منهجية إلحاق الضرر أو التبعية المطلقة لسياسة الدول العظمى. ومنبع
التساؤل مبعثه التردي المتزايد لوضع المرأة. وقلما يوجد ما يثير الأمل
بالتحسن ولو لبضع خطوات خارج نفق المآسي الاقتصادية والسياسية
والمجتمعية المظلم والمتبدية في تفاصيل العنف الأسري بالإضافة إلى
العنف الذي تتعرض له في الفضاء العام. فتزويج القاصرات، مثلا، ارتفع من
21.7 إلى 25.5 خلال السنوات العشر الماضية.
لا يقتصر وضع المرأة المزري على ارتفاع حالات تزويج القاصرات بل تشير كل التقارير إلى إزدياد نسبة زواج المتعة والعنف الأسري ونسبة دعاوى الطلاق، بل وصل الانحدار إلى القاع مع تجارة الجنس، وما تتعرض له النساء من استغلال ومعاملة لا إنسانية
ولا يقتصر وضع المرأة المزري على ارتفاع حالات تزويج القاصرات بل تشير
كل التقارير إلى إزدياد نسبة زواج المتعة (الدعارة الدينية) والعنف
الأسري ونسبة دعاوى الطلاق، بل وصل الانحدار إلى القاع مع تجارة الجنس،
وما تتعرض له النساء من استغلال ومعاملة لا إنسانية. فما هو سبب هذا
التردي والتدهور العام على الرغم من كثرة المؤتمرات وتوقيع الاتفاقيات
ووجود منظمات المرأة؟
هناك عدة أسباب. أولها، عدم تطبيق القانون والاتفاقيات. فمعظم حالات
تزويج القاصرات تتم خارج المحاكم وبعقد زواج في مكاتب رجال الدين
المنتشرة كالبثور على وجه مراهق، ويغض النظام النظر عن وجودها، كما
انتشار الدعارة، إذ من المعروف أن أطرافاً سياسيةً وجهات حكومية
وحزبيةً، تسيطر على المكاتب والبيوت أو تتجاهل وجودها لأنها توفر لها
مصدر ربح بشكل أتاوات يجنبها التجريم. فهل من مصلحة نظام كهذا تنفيذ
الاتفاقيات الموقعة لصالح المرأة بعد أن باتت سلعة تُحقق الربح؟
يتعلق السبب الثاني بالوضع الاقتصادي وضحيته الأولى هي المرأة. إذ يحتل
العراق المرتبة 123 من أصل 188 دولة على مؤشر التنمية البشرية للأمم
المتحدة. وتدل آخر الإحصاءات الصادرة عن البنك الدولي إلى أن مستوى
البطالة بلغ 13.7 في المئة، وهو المعدل الأعلى منذ عام 1991، على الرغم
من ثروة البلاد النفطية الضخمة التي لو لم يلتهمها الفساد وسوء الإدارة
لأحدثت نقلة نوعية في مستوى المعيشة وتوفير الخدمات الأساسية، خاصة في
مجالات التعليم والصحة والغذاء، وهي أساس تحقيق المساواة المواطنية /
وبين الجنسين التي يحتل العراق أحد أدنى تصنيفاتها في منطقة الشرق
الأوسط وشمال إفريقيا.
تحت هذه الظروف، من الطبيعي، أن يتدهور مستوى وعي النساء بحقوقهن. ومن
أبسط الأمثلة، أن نسبة 59 بالمئة من النساء اللاتي بين سن 15 و49
يعتقدن أن ضرب الرجل لزوجته هو أمر مقبول، وترتفع هذه النسبة في
المناطق الريفية إذ تبلغ 70 بالمئة وتبلغ بين من لم يلتحقن بالتعليم
الرسمي 71 بالمئة. وتحتمل النساء في الفئة العمرية من 15 إلى 24 التعرض
للعنف حالهن حال النساء الأكبر منهن سنا. ورغم أن الزواج بالإكراه
محظور، حسب القانون، إلا أن ثلث الشابات يعتقدن أنه على الفتاة أن
تقترن بالشخص الذي يختاره الوصي عليها.
ما هو الحل والمرأة تعيش العنف على مستويين. الأول خاص بسبب جنسها
والثاني عام في ظل التدهور الاقتصادي والمحاصصة السياسية الطائفية
ووجود 63 ميليشيا ترتكب ما ترتكب بحق المواطنين، نساء ورجالا، بلا
مساءلة، فضلا عن استحضار ممارسة عادات وتقاليد كان المجتمع قد تخلص
منها؟ تقول الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيدة
زينة علي أحمد «نحن بحاجة إلى المزيد من القيادات النسائية في العراق».
في ذات الوقت الذي تشغل فيه النساء 96 مقعداً في مجلس النواب، أي حوالي
ثلث أعضائه وفوق الحد الأدنى للكوتا البالغة 25 بالمائة. وهي نسبة
مشاركة سياسية أعلى من عديد البلدان التي تعيش فيها المرأة بأمان. مما
يعيدنا إلى بديهية أن كثرة العدد لا تعني النوعية وأن فشل نساء
البرلمان مرده ولاؤهن المطلق لأحزابهن وليس لقضايا المرأة بل ووقوفهن
ضد قضايا المرأة والأسرة إذا ما اختار الحزب موقفا مناوئا. تدل الأمثلة
المذكورة، أن القوانين التي تحمي معظم حقوق المرأة موجودة إلا أنها
تبقى حبرا على ورق يوقع عليها النظام لتبييض وجهه دوليا.
أما الخلل الآخر الذي قلما يتم التطرق اليه هو طبيعة عمل منظمات الأمم
المتحدة، في رؤيتها لمعالجة قضايا المرأة وفق ذات البرامج المستنسخة
تماما لفرط تشابهها، في كل البلدان، في أرجاء العالم. متحاشية بذلك مس
الجذور الحقيقية للمشاكل بحكم عملها مع الأنظمة، وغالبا، بمواصفات وجبة
ماكدونالد، على حساب التطور العضوي النابع من داخل المجتمع نفسه.
كاتبة من العراق
هل نصدق الرئيس الأمريكي؟
هيفاء زنكنة
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مؤتمر الأمم المتحدة السابع
والعشرين للمناخ، عن «مبادرات جديدة لتعزيز القيادة الأمريكية في
معالجة أزمة المناخ وتحفيز العمل والالتزامات العالمية». مؤكدا أن
الولايات المتحدة « تتابع التزاماتها ومبادراتها الحالية»، لدعم
«الشركاء في البلدان النامية الضعيفة لمواجهة التغيرات البيئية،
ومساعدتهم على التعامل مع مشكلة لم يخلقوها».
ويأتي الإعلان عن المبادرات الجديدة في وقت حذر فيه الأمين العام للأمم
المتحدة أنطونيو غوتيريش، البشرية من «انتحار جماعي». مما يضفي على
المبادرات الأمريكية أهمية قصوى تستوجب الترحيب الرسمي والشعبي، معا،
باعتبارها ستنقذ البشرية من الانتحار. فلِمَ، إذن، بقي الترحيب محصورا
في محيط رؤساء الدول الذين حضروا المؤتمر، مقابل أصوات المحتجين من
ناشطي المنظمات والعلماء والحركات المعنية بالتغير المناخي والبيئي،
المتنامية في أرجاء العالم؟
هناك أسباب عدة لتردد هذه المنظمات في الإسراع للترحيب بالمبادرات
الأمريكية على الرغم من سخاء الخطاب الأمريكي والأصح هو أن الخطاب نفسه
سبب رئيسي للتردد. إذ يبين تحليل اللغة المستخدمة في الخطاب وما سبقه
من تصريحات رئاسية «سخية» تُطلق في مؤتمرات المناخ الدولية، تناقضا
هائلا، عند مقارنتها بمدى الإنجازات الحقيقية للوعود في العالم، كونها
مرتبطة ارتباطا وثيقا باستثمار وأرباح شركات النفط والغاز الرئيسية في
أمريكا، والتي تُشكل، بجانب صناعة السلاح والدواء، العمود الفقري
للواقع الاقتصادي والسياسي الأمريكي ويُشكل جوهر السياسة الخارجية.
أفادت دراسة نشرتها دورية « بلوس وان» العلمية أن كبرى شركات النفط
والغاز الأمريكية والبريطانية، وهي شفرون وأكسون موبايل وبي بي وشل،
فشلت في دعم أقوالها وتعهداتها بشأن تغير المناخ بإجراءات واستثمارات
حقيقية بينما تضاعفت إشاراتها إلى تغير المناخ والطاقة منخفضة الكربون
ثلاث مرات تقريبًا في تقاريرها السنوية المنشورة في العقد الماضي. مما
يجعل هذه الشركات لا تختلف كثيرا عن الرئاسة الأمريكية في إطلاق وحتى
توقيع التعهدات بخفض الانبعاثات والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة
بينما لا يحدث أي تغير. إذ تواصل جميع الشركات الأربع التركيز بشكل
أساسي على إنتاج الوقود الأحفوري لتجني أرباحا قياسية، بغض النظر عما
تحدثه عملياتها من أضرار تنوء تحت تأثيرها الأكبر بلدان الجنوب التي
يسميها بايدن « البلدان النامية الفقيرة» والتي يتصارع الغرب على
استغلال مواردها الطبيعية وتنفيذ مشاريع استخراج النفط والغاز من
الصخور الزيتية فيها.
أمريكا توقع أكثر من مائتي معاهدة كل عام حول مجموعة من القضايا الدولية، بما في ذلك السلام والدفاع وحقوق الإنسان والبيئة، إلا أن هذا لا يعني التزامها بالتنفيذ
تلاقي هذه المشاريع معارضة كبيرة، تصل إلى حد العنف، وتستقطب الشباب
والعلماء في البلدان الغربية، كما في حركة «علماء متمردون» الذين يرون
أن التنقيب عن النفط والغاز من الصخور الزيتية في مناطق غير مستغلة
سابقًا هو «جريمة ضد الإنسانية» بسبب الضرر البيئي الذي يلحقه ويطالبون
بوضع حد فوري لمشاريع الحفر الجديدة.
الملاحظ امتداد المعارضة، في الأعوام الأخيرة، إلى البلدان العربية.
حيث برز ناشطون يجمعون بين العدالة البيئية والمناخية والسيادة،
ويقودون حملات توعية بأضرار مشاريع الحفر التي تتم بواسطة تكسير الصخور
الزيتية وتحرير الغاز المنحبس بضخ كميات كبيرة من الماء المخلوط بالرمل
والمواد الكيمياوية مما يسبب بالنتيجة تلويث المياه الجوفية. وإذا كانت
المياه الجوفية هي المصدر الرئيسي لديمومة الزراعة والحياة عموما في
العديد من بلداننا فإن وقود الصخور الزيتية هو المصدر الرئيسي لعدد من
شركات النفط الكبرى ومن بينها توتال أنيرجيز الفرنسية (توتال سابقا)،
التي يشكل 91 من إنتاجها و71 بالمئة من استثماراتها الحالية ويبلغ
إجمالي مبيعاتها 184.7 مليار دولار لعام 2021.
لم يعد هناك أي شك في تحمل الغرب، مسؤولية الانحباس الحراري وتغير
المناخ. وتقع المسؤولية الأكبر على أمريكا لأنها أكبر منتج للغاز في
العالم من الصخور الزيتية منذ عام 2009، وأكبر مستهلك له أيضًا،
بالإضافة إلى كونه مصدر ربح ترحب به الشركات والحكومة وسبب للازدهار
الاقتصادي. بين عامي 2015 و2020، وصل مردود الوقود الأحفوري ما يقرب من
138 مليار دولار سنويًا. في ذات الوقت الذي أثبتت فيه البحوث العلمية
تسببها في تغيير النظم الإيكولوجية للمحيطات وتلوث مصادر مياه الشرب
بواسطة المواد الكيمياوية السامة المستخدمة لاستخلاص الوقود من الصخور
الزيتية، وهي حقيقة لم تكشفها وكالة حماية البيئة الأمريكية للعموم
لأنها كانت قد منحت عملية الاستخلاص والسوائل المستخدمة فيها، حتى إذا
وُجدت في مياه الشرب، إعفاءً من قانون مياه الشرب الآمنة في عام 2005،
وذلك حين شرعت شركة هاليبرتون بالعمل في مجال الاستخلاص وكان ديك
تشيني، نائب الرئيس الأمريكي، رئيسا لها.
من الطبيعي إذن، ألا تعمل الإدارة الأمريكية، متمثلة برئيسها، خارج
شبكة الشركات الكبرى بل إن تماشيها في إطلاق المبادرات بشكل تصريحات
ووعود حرصا على أمنها الاقتصادي والسياسي، لأن تزايد تطور الطاقة
النظيفة، سيؤدي إلى انحسار تدفق الإيرادات وما يترتب على ذلك من
تأثيرات كبيرة داخليا. وما يستحق الذكر هنا أن أمريكا توقع أكثر من
مائتي معاهدة كل عام حول مجموعة من القضايا الدولية، بما في ذلك السلام
والدفاع وحقوق الإنسان والبيئة، إلا أن هذا لا يعني التزامها بالتنفيذ
بالإضافة إلى امتناعها عن التوقيع أو التصديق على المعاهدات التي
يدعمها بقية العالم. بل أن أمريكا تمتلك أحد أسوأ السجلات في التصديق
على معاهدات حقوق الإنسان والمعاهدات البيئية.
إزاء ترسانة المصلحة المشتركة بين مجموعات المصالح الخاصة ورغبة
السياسيين في الحفاظ على سلطة الحزب الذي ينتمون إليه، بالإضافة إلى
المخاوف القائمة بشأن السيادة، وحماية حقوق الشركات الأمريكية ونفوذ
شركات النفط الكبرى وامتداداتها، سواء في أمريكا أو الغرب عموما، لا
يبقى أمام شعوب الجنوب، المحكومة بأنظمة فاسدة، إلا توسيع شبكات
تعاونها مع منظمات وحركات العدالة البيئية والسيادة، خاصة في بلدان
الترسانة، والعمل على إحداث التغيير بنفسها، إذا أرادت وضع حد لمأساة
التلوث والجفاف والتجويع ألتي باتت واقعا وليس فيلم خيال علمي يتصارع
فيه الناجون من الخراب على بضع قطرات من الماء.
كاتبة من العراق
الفلوجة 19…
الجنرالات يحبون النابالم
هيفاء زنكنة
تمر هذا الأسبوع، الذكرى 19 على معركة الفلوجة الثانية (7 تشرين
الثاني/ نوفمبر – 23 كانون الأول/ ديسمبر 2004)، في محافظة الأنبار،
التي شنها المحتل الأمريكي باسم عملية «الفجر» وعملية «غضب الشبح»، بعد
فشله في إخضاع المدينة في معركة الفلوجة الأولى (4 نيسان/ أبريل ـ 1
أيار/ مايو 2004). ومن سخرية القدر، مقابل الصمت الرسمي العراقي، أن
يُعيد الغزو الروسي لأوكرانيا إلى الواجهة تفاصيل طالما عملت أمريكا
وبريطانيا على طمرها بصدد جرائمها في العراق، وأكثرها وضوحا استخدام
الأسلحة المحرمة في الأماكن المأهولة بالسكان، كاليورانيوم المنضب
والفسفور الأبيض والنابالم، مما عرَّض حياة المدنيين، أكثر من
المقاتلين، للموت.
وتُشكل مدينة الفلوجة المثال الأكثر بشاعة لما ارتكبته قوات الاحتلال
بالتعاون مع ساسة عراقيين. وهي حقيقة تُذَّكرنا بها تقارير شبكة
الأنباء الإنسانية (إيرين): « لقد عاش العراق كله عنفا كبيرا منذ
إحتلاله إلا أن ما تعرضت له الفلوجة يساوي أربعة أضعاف ما عانته بقية
المدن «. وذلك بعد أن وثقت العثور على أكثر من 700جثة، من بينها 550
امرأة وطفلا. وفي عام 2012، أظهرت دراسة صادرة عن المجلة الدولية
للبحوث البيئية والصحة العامة، بسويسرا، وهي واحدة من عديد الدراسات،
أنه في السنوات التي أعقبت عملية غضب الشبح، كانت هناك زيادة بمقدار 4
أضعاف في جميع أنواع السرطان، بما في ذلك 12 ضعفًا في سرطان الأطفال
الذين تتراوح أعمارهم بين 0-14.
وإذا كانت الدراسات والبحوث العلمية العراقية والأجنبية قد وفرت لنا
المعلومات حول استخدام اليورانيوم المنضب في عدة مدن عراقية ووثقت
مضاره الآنية وبعيدة المدى المتبدية بأشكال تراوح ما بين التشوهات
الخلقية وأنواع السرطان، خاصة في الفلوجة، فإن استخدام الفسفور الأبيض،
بقي في الظل، مصنفا كمادة يمكن استخدامها في الحروب بلا مساءلة
باعتباره مجرد دخان يوفر الحماية لمستخدميه. مع أنه مادة كيميائية
تشتعل ذاتيًا في الهواء. تحترق فورًا عند ملامستها الأوكسجين، مما ينتج
عنها دخان أبيض كثيف. ويستخدم عادة بشكل قذائف يحجب وابل الدخان
المتصاعد بسرعة كبيرة منطقة واسعة.
ولا يهتم مستخدموه، بكونه سلاحا قاتلا للأشخاص، يتميز بالالتصاق بالجلد
ويستمر في الاحتراق حتى يذوب جسد الضحية.
تُشكل مدينة الفلوجة المثال الأكثر بشاعة لما ارتكبته قوات الاحتلال بالتعاون مع ساسة عراقيين. وهي حقيقة تُذَّكرنا بها تقارير شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)
وصورة الرجل، من الفلوجة، المُحتَضن لطفلته بجسدها المحترق شبه الذائب،
باتت رمزا لجريمة الإبادة الأمريكية كما هي صورة الطفلة الفيتنامية
الهاربة بجسدها المحترق العاري من النابالم الأمريكي. ولاحظت منظمة
«هيومن رايتس ووتش» الدولية، أن الفسفور الأبيض مشهور بالإضافة إلى عمق
وشدة الحروق التي يسببها أنها سامة، لذلك قد يموت الضحايا بفشل الأعضاء
حتى لو نجوا من حروقهم.
وكانت « مجموعة تحليل العراق» البريطانية قد نشرت تقريرا في آذار/ مارس
2005، أكدت فيه استمرار استخدام الجيش الأمريكي للأسلحة الحارقة
بأنواعها من الفسفور الأبيض إلى النابالم. وبينما حاولت الحكومة
البريطانية التقليل من أهمية أو إنكار استخدام المواد الحارقة، أُجبر
المسؤولون الأمريكيون على الاعتراف باستخدام
MK
ـ 77 الحارقة، وهو شكل حديث من النابالم، وصفه قائد فرقة مارينز بأن
الاصابة به « ليست طريقة رائعة للموت. إلا أن الجنرالات يحبون
النابالم. له تأثير نفسي كبير»، وهو تصريح يحمل جزءا من الحقيقة وليس
كلها. فاستخدام هذا النوع من الأسلحة يهدف، أيضا، إلى إنزال العقوبة
الجماعية بالسكان وإضعاف المعنويات وتقويض إرادتهم في المقاومة.
عراقيا، لا تزال الحكومة تتعامل مع الجرائم البشعة التي ارتكبتها قوات
الاحتلال الأمريكية والبريطانية والتي سيحمل العراقيون آثارها لأجيال
مقبلة، باستهانة مزرية مرددة ذات التعابير والمصطلحات ألتي يبرر بها
الاحتلال جرائمه وبالتالي غسل يديه من المسؤولية التاريخية. حيث صارت
مقاومة المحتل إرهابا والغزو تحريرا وقتل المدنيين دفاعا عن النفس
واغتصاب النساء هفوة « تفاحة فاسدة»؟ وباتت سردية المقاومة في المدينة
بأقلام المتعاونين مع المحتل ملوثة بالطائفية وعزو سبب نشوئها إلى
إرهاب القاعدة بينما كانت الحقيقة الصارخة هي تجمع نحو 200 رجل وطفل
خارج مدرسة القائد الابتدائية في الفلوجة، يوم الثالث والعشرين من
إبريل 2004، احتجاجاً على احتلالها من قبل القوات الأمريكية، وطالبوا
بإخلائها وإعادة افتتاحها للدراسة، فأطلقت القوات الأمريكية النار على
المتظاهرين وقتلت 17 شخصاً، بينهم 3 أطفال أعمارهم أقل من 11 سنة،
وجرحت أكثر من 70، وأطلقت النار كذلك على طواقم الإسعاف الذين حاولوا
معالجة المصابين وإجلاء القتلى. كانت هذه هي البداية التي عوقبت
الفلوجة بسببها، فقُصفت بقذائف اليورانيوم المنضب ورُشت بالفسفور
الأبيض والنابالم.
إن من واجب الحكومات الوطنية حماية كرامة مواطنيها وحقوقهم الإنسانية
وأولها حق الحياة وتحقيق العدالة مهما طال الزمن. ولنا في الحكومة
الجزائرية مثال يجب أن يُحتذى.
فبعد مضي ستين عاما على توقيع اتفاقيات إيفيان التي مهدت لاستقلال
الجزائر، لا تزال العلاقات الجزائرية الفرنسية محكومة بملف الذاكرة
والتاريخ. وقد كتب الرئيس عبد المجيد تبون رسالة، بمناسبة عيد النصر في
مارس 2022، مشيدا بقوة الشعب الجزائري وعزيمته، لمجابهة آثار دمار
واسِع مَهُول.. وخَرابٍ شَامِلٍ فَظِيع، يَشْهد على جرائمِ الاستعمارِ
البشعةِ، مؤكدا بأن جرائم الاستعمار الفرنسي «لن يَطالَها النسيان، ولن
تسقطَ بالتقادم». وذكّر بمطلب بلاده «استرجاعِ الأرشيف، واستجلاءِ مصير
الـمفقودين أثناء حرب التحرير الـمجيدة، وتعويضِ ضحايا التجارب
النووية» التي بدأت في 1960 واستمرت حتى 1966، أي أربع سنوات بعد
استقلال الجزائر.
لم يحدث أي شيء مماثل في العراق. فضحايا الغزو والاحتلال والمتظاهرين
وذويهم، لايزالون، مجرد أرقام في تقارير تطفو بين الحين والآخر في سوق
المزايدات الطائفية والعرقية. وتبقى حياة العراقي فيها رقم بلا حياة.
ولم يحدث ذلك في الفلوجة مدينة المقاومة الأبية. وإذا كان الرئيس
الجزائري قد أكد على وجوب المعالجة المسؤولة المُنصفة والنزيهة لملف
الذاكرة والتاريخ فإن ساسة العراق يبذلون أقصى جهودهم لمسح الذاكرة
وتلويث التاريخ. لماذا؟ لأنهم يعرفون جيدا أنهما يشكلان خطرا حقيقيا
على وجودهم وفضح مشاركتهم في ارتكاب الجرائم.
كاتبة من العراق
سرقة الأموال في العراق
مقابل القرض التونسي
هيفاء زنكنة
أعلن صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، عن توصله إلى اتفاق مع
الحكومة التونسية لمنحها قرضا بقيمة 1.9 مليار دولار لمدة 48 شهرا،
بشرط موافقة المجلس التنفيذي للصندوق الذي سيناقش الطلب في شهر كانون
الأول/ ديسمبر القادم، مقابل تعهد الحكومة بتنفيذ حزمة من الإصلاحات
الاقتصادية من بينها تقليص دعم المواد الغذائية الأساسية والطاقة
المعمول بها حاليا، وتجميد التوظيف في القطاع الحكومي، وإعادة هيكلة
المؤسسات الحكومية. يهدف القرض، حسب صندوق النقد الدولي، إلى مساعدة
تونس لتجاوز الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها و«استعادة
الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي وتعزيز الأمن الاجتماعي والعدالة
الجبائية وتكثيف الإصلاحات لإرساء مناخ ملائم لتحقيق النمو الشامل وفرص
العمل المستدامة.»
تطلب الوصول إلى هذه الاتفاقية عدة مراحل من مفاوضات استغرقت شهورا،
التقى خلالها وفد حكومي تونسي مع صندوق النقد الدولي. ضم الوفد وزيرة
المالية ووزير الاقتصاد ومحافظ البنك المركزي لمناقشة الشروط.
تعطينا هذه التفاصيل صورة عامة عن معنى مرور بلد ما بأزمة اقتصادية
وكيفية قيام الحكومة بأداء واجبها في إيجاد الحلول ولو بشكل قروض
مشروطة عبر مفاوضات يُشارك وزراء كل في مجاله. هذا ما تعيشه تونس
للحصول على قرض قيمته 1.9 مليار دولار، فقط، أملا في تحسين الأوضاع.
تأخذنا تفاصيل الصورة إلى العراق حيث تم في ذات الوقت الإعلان عن سرقة
2.2 مليار دولار في ظل الحكومة العراقية ومع وجود وزراء للمالية
والاقتصاد ومحافظ للبنك المركزي. وهو حدث غطى على ظاهرة «المظاهرات
المليونية» والتطبيل لها عن معجم التداول اليومي للساسة، لتبرز على
السطح عناوين السرقة الترليونية الكبرى، وسرقة القرن الأسطورية، وأكبر
سرقة في التاريخ، وأكبر قضية فساد، وتريليونات الضرائب. فكيف يتم
اختفاء مبلغ كهذا بينما تقضي دول أخرى شهورا من المفاوضات تحت قائمة من
الشروط وبدعم دول عظمى للحصول على مبلغ أقل؟ ما هو دور الحكومة؟ ومن هي
الجهات المسؤولة وكيف سيتم التعامل معها؟ وهل سيكون بالإمكان استعادة
المبلغ الخيالي المسروق؟
طفت حكاية سرقة المليارين ونصف مليار دولار من أموال الضريبة في مصرف
الرافدين الحكومي في بيان أصدره وزير المالية بالوكالة، متهما ما أسماه
«مجموعة محددة» قبل أن يطلب إعفاءه من المنصب. اضطر مجلس القضاء، إزاء
حجم السرقة الذي تجاوز عديد الاختلاسات السابقة، إلى إصدار مذكرات
استدعاء بحق عدد من المدراء في المجال الضريبي والرقابي للتحقيق معهم
بالإضافة إلى « تشكيل لجنة تدقيقية مشتركة من وزارة المالية والهيئة
العامة للضرائب ومصرف الرافدين وهيئة النزاهة لتدقيق المبالغ
المصروفة».
كيف يتم اختفاء مبلغ كهذا بينما تقضي دول أخرى شهورا من المفاوضات تحت قائمة من الشروط وبدعم دول عظمى للحصول على مبلغ أقل؟ ما هو دور الحكومة؟ ومن هي الجهات المسؤولة وكيف سيتم التعامل معها؟ وهل سيكون بالإمكان استعادة المبلغ الخيالي المسروق؟
وهي خطوة أثارت الكثير من التعليقات الساخرة مثل «حاميها حراميها» وأن
الإعلان الرسمي عن اختفاء المليارين ونصف مليار، هو محاولة لتغطية بركة
الفساد المالي – السياسي الآسنة بغشاء من زيت «النزاهة» المُعّطر ليضمن
استمراريتها. لا تنبع هذه التعليقات الساخرة المريرة من فراغ بل من
انعدام الثقة بجدوى اللجان والتحقيقات الرسمية، على مدى العقدين
الأخيرين، والتي غالبا ما تعمل على دفن الحقائق أو تمويهها، لسبب بسيط
وهو استشراء الفساد في كل ركن من الحكومة بدءا من الرأس إلى أصغر
مستخدم فيها، وتمكُن المسؤولين من الافلات من العقاب. وتشير سردية
الكشف عن الفضائح المتكررة أنه إذا ما حدث وكشف أحد المسؤولين
الحكوميين عن فضيحة اختلاس أو جريمة أثناء تبوئه أحد المناصب، فإنه
غالبا ما يقوم بذلك أما لأنه أُقيل من منصبه أو أنه التهم ما يكفي
لإطفاء جشعه فيُفضل مغادرة البلد إلى بلد يحمل جنسيته، أو لأنه تعرض
للابتزاز من جهة سياسية مغايرة تشعر بأن منصبه من حقها فيشعر بتهديد
حياته، لفهم هذه الأجواء الغرائبية هناك أمثلة عدة لعل أكثرها تفصيلا
وعلاقة بالاختلاس الأخير هي رسالة استقالة وزير المالية السابق علي
علاوي التي تحدث فيها عن تفاصيل عمله وأسباب استقالته وما تعرض له من
ضغوطات، ولم ينس تعداد، ما أنجزه من نجاحات، بإسهاب. مع العلم أن ما
وصفها بـ «بواحدة من أكبر الفضائح المالية في العصر الحديث» تمت أثناء
تبوئه منصب وزير المالية.
مع انتشار رائحة السرقة وتفاصيل الفضيحة عاد علاوي للتصريح حول العوامل
التي مكنت حدوث السرقة ومنها، حسب تعبيره، تأخر وزارة المالية في مجال
«اعتماد أنظمة المعلومات والمحاسبة وإعداد التقارير الآلیة»، و«عدم
انصياع بعض المدراء العامين وموظفي الدولة الى الأنظمة والقوانین
الحاكمة في مهامهم، وعدم اتباعهم الأوامر الوزارية وتوجيهات الوزير،
واخفائهم المعلومات، ومنع الدوائر الرقابية القيام بدورها والإبلاغ
عنها»، ملقيا اللوم على ولاء الموظفين « لجهات سیاسیة متنفذة تسترزق من
حیتان الفساد وتوفر الحصانة إلى الفاسدين». وهي أسباب كانت معروفة قبل
قبوله تسنم منصب الوزير، وما كان بحاجة إلى أن يُصبح جزءا منها، وهو
السياسي الذي خاض غمار «العملية السياسية» منذ أعوام الاحتلال الأولى
ليكتشف ويكشف، بعد استقالته، يومياتها. فمن المعروف أن العراق يحتل
واحدة من المواقع الأدنى بين الدول في مؤشر منظمة الشفافية الدولية
للفساد. ولا يكاد يمر أسبوع بدون الكشف عن فضيحة مالية أو الاحتيال في
العقود الحكومية عن طريق استخدام شركات صورية، أو تعيين موظفين وهميين،
وسرعان ما يتم تشكيل لجنة تحقيق تؤدي، غالبا، إلى التغاضي عن هرب
المتهمين إلى الخارج، خاصة إذا كان المسؤول الفاسد من حملة جنسية أحد
البلدان الأوروبية أو حاصلا على الإقامة الخاصة برجال الأعمال.
وإذا كان صندوق النقد الدولي لا يقدم القروض التسهيلية للحكومات التي
تمر بأزمات اقتصادية إلا بعد فرض شروط قاسية، كما في تعامله مع تونس،
فإن الدول الرئيسية في الصندوق، لا تكيل بنفس المكيال لغسيل الأموال
لديها. حيث يجد الساسة الهاربون أو من يقدمون أنفسهم كرجال أعمال ملاذا
اقتصاديا آمنا للأموال المُهرّبة في الدول الرئيسية بأقل الشروط.
وجوابا على سؤال عما إذا كان بإمكان العراق استرداد المليارات المنهوبة
فان إلقاء نظرة واحدة على المتصارعين على المناصب الحكومية، حاليا،
وتدوير ذات الوجوه التي رعت الفساد على مدى عشرين عاما الأخيرة،
سيعطينا الجواب.
كاتبة من العراق
كيف أصبح غير المرغوب
فيه مرغوبا في العراق؟
هيفاء زنكنة
لو أتيحت لنا مستقبلا قراءة أحد كتب سلسلة الكتب التجارية الصادرة تحت
عنوان» كيف»، كما في كيف تتعلم الإنكليزية في أسبوع أو تربح مليون
دولار في شهر، هل سيكون لاختيار رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف
رشيد، أخيرا حظا في الاستئثار بعنوان «كيف تؤجل تنفيذ نتائج الانتخابات
لمدة عام؟ « تشير كثرة التهاني التي تلقاها العراق بمناسبة اختيار رئيس
للجمهورية وتكليفه رئيسا للوزراء، بعد مخاض عام من إعلان نتائج
الانتخابات، إلى أن كتابا كهذا، كونه يستند على تجربة حقيقية متميزة،
سيحقق نجاحا كبيرا، خاصة، في الدول التي تُفرض على شعوبها طبخة
«الديمقراطية» والانتخابات ويتم تطبيقها من قبل أتباع محليين بإشراف
«دولي».
في خلاصة الكتاب سيتوصل لاعبو الأدوار الرئيسية إلى التوافق فيما
بينهم، حول بعض النقاط لعل أهمها وأكثرها وضوحا هو الاستغناء عن الشعب
بمختلف الأساليب الممكنة والمجربة تاريخيا من الترويع إلى السجون إلى
التهجير القسري أو التجاهل وتركه ضحية الجوع والعطش وانعدام الخدمات
الصحية والتعليم. وسيصادف القارئ، لا محالة، أثناء تصفحه سطور التجربة
العراقية المُنتهِكَة للمواطن فصولا مغموسة بالتجاهل الدولي المنهجي
لحقوق الشعب، على الرغم من العزف المتواصل على طبول حقوق الإنسان
والقوانين الدولية.
أما بقية الفصول فستحفل بالتهاني والتبريكات بنجاح الانتخابات أولا على
الرغم من أن سنبة المشاركين فيها لم تزد عن 30 بالمئة، كما التهاني
بتمكن البرلمان أخيرا، من تجميع أعضائه في المنطقة الخضراء، والتصويت
مرتين لأن المرة الأولى قوطعت بسبب قصف المنطقة الخضراء، لانتخاب رئيس
للجمهورية كلّف بدوره رئيسا للوزراء. مما يُشكل واحدة من مفارقات الوضع
العراقي إذ تم تكليف، ذات الشخص الذي رُشّح، قبل عام، وأثار ترشيحه
تبادل الاتهامات واستقالة 73 من أعضاء البرلمان، من أتباع مقتدى الصدر،
بالإضافة الى الاحتجاجات والاعتصامات والقصف والاعتقالات وغيرها من
يوميات التفاصيل « المألوفة» في حياة العراق الديمقراطي الجديد.
فما الذي حدث إذن ليُصبح غير المرغوب فيه مرغوبا؟ ما الذي تغير ليعود
إلى الواجهة من أشعل ترشيحه نار النزاع والاقتتال بين «أهل البيت»
وأظهر الى العلن ملفات الابتزاز، بأنواعه، من التعيينات الحكومية إلى
المقاولات إلى إدارة شبكات التهريب والدعارة، والتهديد بفضح الفساد،
والإرهاب العام بإطلاق يد ميليشيات الاختطاف والقتل، وأن يجري هذا كله
في أجواء صمت المرجعية الدينية التي يُفترض أن معظم الساسة العراقيين
يتبعونها ويطيعون إرشاداتها على الأقل؟
الاستغناء عن الشعب بمختلف الأساليب الممكنة والمجربة تاريخيا
من الترويع إلى السجون إلى التهجير القسري أو التجاهل وتركه ضحية الجوع والعطش وانعدام الخدمات الصحية والتعليم
يحتاج تفكيك الصورة إلى وضع مماحكات ومهاترات الساسة المناهضين لعملية
الاختيار وما سبق العملية وما سيليها من قصف وتفجيرات، جانبا. لا لقلة
أهميتها، فهي العنصر المحّرك للواقع المشوه، ولكن لإضاءة دور التدخل
الخارجي وحجمه وكيفية فرضه أو عدم فرضه، الأجندة الداخلية. لعل أهم
تغيير حدث، منذ انتهاء الانتخابات ومباركتها دوليا وإقليميا وتبنيها
الكلي من قبل منظمة الأمم المتحدة، هو تراجع المنظمة عن « اللغة
الناعمة» التي تلجأ أليها عادة في مخاطبتها الساسة العراقيين. فكان
تصريح ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس ـ
بلاسخارت، خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن حول الحالة بالعراق، في 4 تشرين
الأول/أكتوبر، قويا في نقده النظام ومتضمنا يأس المنظمة من دعم الساسة
المنخرطين في «الشقاق ولعبة النفوذ السياسي على حساب الشعور بالواجب
المشترك… حيث كان العراقيون رهينة لوضع لا يمكن التنبؤ به ولا يمكن
احتماله، ليتحول إلى اشتباكات مسلحة». محذرة بلهجة صارمة أن «خيبة أمل
الشعب قد وصلت إلى عنان السماء… وفقدان العديد من العراقيين الثقة في
قدرة الطبقة السياسية في العراق على العمل لصالح البلد وشعبه… وإن
النظام السياسي ومنظومة الحكم في العراق يتجاهلان احتياجات الشعب
العراقي». مشخصة بأن السبب الجذري الرئيسي للاختلال الوظيفي في البلد
هو الفساد المستشري. وهي إن لم تكشف، بتقريرها، سرا لا يعرفه
العراقيون، إلا أنها أكدت بؤس الحالة المتردية التي وصل إليها العراق.
وكان لإحاطتها قوة العصا المُشّرعة بوجوه الساسة. وهي، مع الأسف
الشديد، أكثر تأثيرا من دماء الشهداء المحتجين المطالبين بحقهم في
الوطن ومن كل ما كُتب وقيل بصدق ووطنية عن التدهور الكارثي، بمختلف
المجالات، في البلد، وعن المسؤولية الكبيرة التي تتحملها دول الاحتلال.
وجاء عامل الضغط الثاني متمثلا بموقف المملكة المتحدة. حيث سارع السفير
البريطاني مارك برايسون ريتشاردسون، لتأييد إحاطة بلاسخارت، مضيفا بما
يقترب من التهديد أن أعمال العنف التي يشهدها العراق «غير مقبولة» و
«لا يمكن السماح بتكرارها». وجاءت الضربة التالية من السفير الأمريكي
الذي أخذ على عاتقه تذكير الساسة بمرور عام على الانتخابات «ذات
المصداقية» وعدم تمكنهم من حل خلافاتهم السياسية مما يتطلب «إجراء حوار
واسع لشق طريق سلمي وشامل للخروج من المأزق السياسي الحال». كما ذكرهم
بوجود اتفاقية «شراكة» بين أمريكا والعراق لاتزال أمريكا، في الوقت
الراهن ملتزمة بها».
ولا يمكن، عند التذكير بدور القوى الخارجية، إهمال دور الكيان الصهيوني
بمستويين المباشر وغير المباشر، سواء بشكل فردي أو مؤسساتي. أما التدخل
الإيراني فهو متغلغل في عمق الحكومة والميليشيات ولا يجد النظام
الإيراني حرجا في قصف العراق بذريعة استهداف مواقع لأحزاب كردية ـ
إيرانية معارضة، منافسا بذلك تركيا التي تستخدم ذات الذريعة للتوغل
وقصف الأراضي العراقية، وكان آخرها قصف منتجع، بمحافظة دهوك، في
كردستان العراق في تموز/ يوليو.
جراء هذه الضغوط والتحذيرات المختلطة بالتهديد من الدول التي عملت بجد
على تحطيم العراق ومن منظمة دولية لم تعد قادرة على تغطية عري
الامبراطور، كان لابد وأن يتوصل المتنازعون على السلطة إلى حل يعرفون
جيدا أنه ليس علاجا حقيقيا إلا أنه يضمن لهم إبقاء العراق ضعيفا، تحت
طائلة عنف مستدام، لتسهل السيطرة عليه كمصدر للطاقة وتحجيمه كواحد من
آخر الدول العربية الرافضة للاعتراف بالكيان الصهيوني.
كاتبة من العراق
كانت آخر
مرة رأيت فيها أخي
هيفاء زنكنة
ما هو المشترك بين ليبيا والعراق؟ بين ليبيا وإيران وسوريا وقائمة
الدول التي حظيت بمسمى «الشرق الأوسط» بالتحديد؟
هناك الكثير مما يجمع بين شعوب هذه البلدان تاريخا وحضارة فيما بينها
إلى حد التداخل في اللغة والأديان. إلا أن خارطة الشعوب الإنسانية هذه،
تلوثت بحكومات ذات مصالح لا تجمعها بشعوبها، بل وتفصلها عنها فجوة هوس
الاستحواذ على السلطة المؤدلجة وفرضها بالقوة، سواء كانت دينية أو
علمانية متمددة في تطرفها بين اليمين واليسار. أدت الهيمنة السلطوية
وتوفر أدوات تكريسها والتحالفات الداخلية ـ الخارجية، أي توليفة
الاستعمار الجديد في تحالفه مع الحكومات المحلية المستبدة، بحيث صارت
الشعوب بمواجهة استعمارين وهي تقاوم على مستويين. الأول هو لمواصلة
الحياة اليومية بأدنى ما يمكن الحصول عليه من الحاجات الأساسية وما
يتطلب من جهد وانشغالات مستهلكة نفسيا وجسديا والثاني المحافظة على
البقية الباقية من روح المقاومة في مرحلة ما بعد التحرر الوطني وتحول
من كان وطنيا مقاوما للاستعمار إلى مستبد قامع لشعبه باسم الوطنية
والمقاومة.
هذه الصورة، بتفاصيلها المريرة، أدت إلى ما يمكن توصيفه بمصطلح
الشيزوفرينيا العامة التي تعيش في ظلها شعوب المنطقة، وتمارسها الأنظمة
إلى حد دفع الشعوب، بحثا عن الخلاص، إلى الاستنجاد بذات الدول التي
سببت مأساتها. وتتبدى بأكثر تفاصيلها الصادمة في التقارير الحقوقية
المحلية والدولية، الموثقة لجرائم الحرب وانتهاكات الحقوق الإنسانية من
حق الحياة الى التعذيب.
عن ليبيا، مثلا، أصدرت المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، بجنيف، تقريرا
بعنوان «كانت آخر مرة رأيت فيها أخي»، يوثق مقتل 581 من المواطنين
والمهاجرين من قبل قوات حكومية وميليشيات خلال العامين الأخيرين فقط.
ويشمل هذا العدد الأشخاص الذين أُعدموا في مراكز الاحتجاز أو تعرضوا
للتعذيب حتى الموت وخسائر بشرية في هجمات عشوائية على مناطق سكنية. مع
التأكيد في أكثر من مكان في التقرير بأن هذا العدد لا يمثل سوى غيض من
فيض. وأن عمليات القتل خارج نطاق القضاء ضد المدنيين العزل غالبا ما
تكون مسبوقة بعمليات تعذيب مروعة، والتي أصبحت ظاهرة عادية متوطنة في
ليبيا هذه الأيام، حيث تمارس القوات الحكومية والميليشيات المسلحة
العنف والتمتع بالإفلات التام من العقاب.
يستند التقرير إلى مقابلات مباشرة مع شهود وناجين، أجريت في جميع أنحاء
البلاد من قبل الشبكة الليبية لمناهضة التعذيب، المكونة من منظمات
المجتمع المدني. لاقى العمل على إكمال التحقيق الكثير من العراقيل جراء
الوضع الأمني الخطر والخوف من الانتقام في بلد تتواجد فيه «حكومتان
متنازعتان وعدد لا يحصى من الميليشيات المسلحة التي يمارس أفرادها
التعذيب وطلب الفدية والقتل في ظل إفلات تام من العقاب. ما يسمى «حكم
الميليشيات» يغرس الخوف في نفوس السكان. بالإضافة إلى ذلك، فإن حقيقة
أن نسبة كبيرة من عمليات القتل نفذت من قبل مجموعات تابعة للدولة تقلل
من أي فرص للمحاكمة».
عمليات القتل خارج نطاق القضاء ضد المدنيين العزل غالبا ما تكون مسبوقة بعمليات تعذيب مروعة، والتي أصبحت ظاهرة عادية متوطنة في ليبيا هذه الأيام، حيث تمارس القوات الحكومية والميليشيات المسلحة العنف
يكاد هذا الوضع المأساوي، ينطبق على الوضع العراقي. ومن يقارن التقارير
الدولية والمحلية بصدد الجرائم اللاإنسانية المرتكبة بالعراق على مدى
العقدين الأخيرين، تقريبا، مع التقرير الأخير في ليبيا (ولا تُستثنى من
ذلك حكومات عربية وإقليمية أخرى) سيجد أن بالإمكان استبدال ليبيا
بالعراق أو العكس بالعكس عند مراجعة تفاصيلها.
فكما في ليبيا، يسود حكم الميليشيات، زارعة الخوف والإرهاب، في أرجاء
البلد بالإضافة إلى القوات الحكومية الأمنية. كلاهما محم من المساءلة
القانونية على الرغم من معرفة مرتكبي جرائم القتل والاختطاف والتعذيب.
وعى الرغم من توثيق الجرائم من قبل منظمات حقوقية عراقية ودولية كما هو
الحال بليبيا. وقد قام المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب بتوثيق
عمليات قتل خارج القانون واحتجاز عشرات الآلاف من المعتقلين في ظروف
غير إنسانية، بوضعهم في زنازين مكتظة لسنوات بدوافع انتقامية وطائفية.
فمنذ بداية 2022 وحتى شهر آب/ أغسطس، وثّق المركز وفاة أكثر من 49
معتقلًا تحت التعذيب والإهمال الطبي، مع وجود حالات وفيات أخرى في
السجون الحكومية التابعة لوزارة العدل والداخلية والدفاع، فضلًا عن
السجون السرية التابعة للميليشيات. وكانت اللجنة المعنية بحالات
الاختفاء القسري بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة قد أعربت عن قلقها
إزاء مزاعم وجود حوالي 420 مكانًا للاحتجاز السري في العراق.
أنجزت مجموعة منظمات عراقية ودولية تقريرا مهما نشرته نهاية آب/ أغسطس
من العام الحالي، حول تقييم عمل المفوضية العليا لحقوق الإنسان في
العراق التي تم تأسيسها كجهة مستقلة. بداية لم يجب أعضاء المفوضية على
أسئلة المنظمات باستثناء علي أكرم البياتي، مدير مؤسسة الإنقاذ
التركمانية، ورئيس المفوضية السامية لحقوق الإنسان، السيد عقيل جاسم
علي. والمفارقة أن يتم الغاء تعيين علي البياتي فيما بعد وتهديد حياته
لأنه تحدث عن تعرض المعتقلين للتعذيب. وقامت المنظمة الدولية لمناهضة
التعذيب بإصدار بيان إدانة لما يتعرض له والمطالبة بحماية حياته. يناقش
التقرير عمل المفوضية والأسس القانونية التي تستند اليها وقدرتها على
الاضطلاع بالأنشطة المخولة بها، بالإضافة الى مدى استقلاليتها وكيفية
تعيين أعضائها، خاصة، وأن معظمهم ينتمون إلى أحزاب ذات ميليشيات تمارس
القتل والتعذيب وإرهاب المواطنين.
ومن الأمثلة التي تناولها التقييم حالات التعذيب والاختفاء القسري، لا
سيما بعد احتجاجات أكتوبر / تشرين الأول 2019. ووفقًا للعديد من
المنظمات غير الحكومية، لم تقم المفوضية العليا لحقوق الإنسان بمتابعة
هذه القضايا، وعلى الرغم من أنها تنشر الآراء والتوصيات والتقارير، إلا
أنها تقترب فقط من توثيق انتهاكات حقوق الإنسان بطريقة شاملة وعامة،
دون تحديد السلطات المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان، على الرغم من
حقيقة أن المسؤولين وغالبا ما تكون السلطات والجناة معروفين.
تؤكد هذه الحقيقة المريرة أن التقارير الموثقة لانتهاكات حقوق الإنسان،
على أهميتها، لا تشكل ضمانا لتحقيق العدالة للضحايا وذويهم، ولا رادعا
لارتكاب المزيد من الجرائم، ما لم يتم تحديد المسؤولية ومقاضاة
المجرمين ومعاقبتهم. وهذا لن يتم إلا إذا تم تطبيق القوانين الدولية
والوطنية والإنسانية بشكل حقيقي وليس كمكياج لتزويق وجوه الحكومات ذات
المصلحة في ديمومة انتهاك كرامة الانسان والسيطرة عليه.
كاتبة من العراق
ما الذي حل بإبداع
انتفاضة تشرين العراقية؟
هيفاء زنكنة
من الصعب تصور انتفاضة
أكتوبر/تشرين الأول 2019، التي تمر ذكراها الثالثة هذه الأيام، بدون
الجوانب الإيجابية لتي نبعت من صميمها، على الرغم من إجهاضها من قبل
ذات القوى التي أراد المساهمون فيها التحرر منها. وكانت تكلفتها
البشرية باهظة، بكل المقاييس، إذ قُتل خلالها 600 شخص وجُرح 30 ألفا
آخرين، ولا توجد إحصائيات دقيقة حول أعداد المختطفين والمعتقلين.
لعل الجانب الإيجابي الأول هو أنها فتحت المجال خصبا حول قدرة فعل
المقاومة على التغيير وإلغاء ما تم تصنيعه وتسويقه، بنجاح أحيانا، من
الطائفية والفروق العرقية والجنسية. فتجسدت في ساحة التحرير، قلب بغداد
النابض، ومنها الى بقية المحافظات، خلال شهور الانتفاضة، رغبة الجميع
في هدم جدران التمييز الكونكريتية وامتلاك وطن مستقل، يتمتع فيه
المواطنون، جميعا، بلا استثناء، بالحرية والكرامة والعدالة. أما الجانب
الثاني الذي أثمرته الانتفاضة وسيبقى على مر السنين، وثيقة للحرية
والكرامة الإنسانية الرافضة للقمع والتمييز، فهو الجانب الفني الإبداعي
المتمثل بالرسم والموسيقى والشعارات والنكات والمسرحيات والقصائد
والتصوير والجداريات والفيديوهات واستخدام التقنية الرقمية وحتى
الشعارات الجامعة بين المطالبة بالحقوق والسخرية من الساسة.
كل هذا تم في ظل جدارية الحرية للفنان الراحل جواد سليم والتي تُشكل
جزءا لا يتجزأ من الذاكرة الجماعية العراقية الرافضة لعبودية الاستعمار
والسلطة بالنيابة، والايمان بأن الفنون الحاملة للأصالة المحلية، هي في
ذات الوقت لغة عالمية مشتركة، تُبعد مُبدعيها ومُتلقيها في آن واحد، عن
الاحساس بأن ما يتعرضون له فريد من نوعه ولا مثيل له في العالم وهو
منبع الشر الراسخ في أهل هذه البقعة المحددة من العالم.
وإذا كان بالإمكان، من هذا المنطلق، النظر إلى ما أفرزته ساحات انتفاضة
تشرين 2019 من فنون باعتبارها، على المدى البعيد، عاملا رئيسيا لإعادة
بناء الإنسان والشفاء من جروح الماضي وما يحمله من خوف من «الآخر»، فإن
معظم ما قدمته الفنون، على اختلاف مستوياتها وأنماطها، ارتبط ارتباطا
وثيقا بحس الشارع ومطالب المتظاهرين الممثلة لعموم الشعب.
ولئلا تضيع هذه الثروة المعنوية في خضم تسارع الأحداث السياسية
ومحاولات كتابة التاريخ كل على هواه على حساب تغييب « الآخر»، ومع غياب
المؤسسات الوطنية المعنية بالتوثيق، وقع عبء الحفاظ على مُنتج
الانتفاضة على عاتق قلة من الأفراد والمبادرات الذاتية والمواقع
الإلكترونية. من بينها الأكاديمي د. هيثم هادي نعمان الهيتي الذي قام
بتوثيق أحد مستويات الأبداع في ساحة التحرير ببغداد، بالتحديد، والذي
شكّل الواجهة الأمامية الغنية للانتفاضة. فأنكّب على تجميع 2113 من صور
اللافتات المتضمنة شعارات وتخطيطات وصور، بالإضافة إلى الرموز ونصوص
استخدمها المتظاهرون خلال الانتفاضة، وتم نشرها لاحقا على وسائل
التواصل الاجتماعي من فيسبوك وتويتر وإنستغرام باعتبارها بيانات مادّية
لإكمال دراسة أكاديمية قام بتقديمها، أخيرا، في منتدى « إنسانيات»
الدولي الذي أقيم بتونس (20 ـ 24 أيلول/ سبتمبر) وساهمت فيه الهيئة
الدولية لدراسات لشرق الأوسط، كما سيتم نشر الدراسة في دورية أكاديمية.
خلال شهور الانتفاضة، رغبة الجميع في هدم جدران التمييز الكونكريتية وامتلاك وطن مستقل، يتمتع فيه المواطنون، جميعا، بلا استثناء، بالحرية والكرامة والعدالة
تتناول الدراسة الموضوعات التي تطرق إليها أو طالب بها المحتجون عبر
اللافتات ونصوصها، حيث تبين من التحليل أن هناك أربعة موضوعات ورسائل
رئيسية قصدها المحتجون وهي: الاستعداد للتضحية في سبيل الأمة، والوحدة
الوطنية، ودور المرأة، والمطالب، بالإضافة إلى 14 رسالة فرعية منها على
سبيل المثال، إنهاء الميليشيات والفصل بين الدين والدولة ورفض
الطائفية.
وبيّن التحليل العلمي للمعطيات أن كان الطلب الأساسي الذي تم رفعه
ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي هو تغيير النظام، بنسبة 20.39
بالمئة من إجمالي الطلبات. أما المطلب الثاني فهو الحرية بمعدل
14.29بالمئة ثم المطالبة بإنهاء الفساد، بمعدل12.91 بالمئة، والقضاء
على الميليشيات، بمعدل 12.11بالمئة. ومن بين المطالب الأولية جاء
المطلب الخامس، وهو فصل الدولة عن التأثيرات الدينية بمعدل 12.02
بالمئة. وبالنسبة إلى المطالب التسعة الأخرى، كان المطلب الرئيسي هو
القضاء على التأثيرات الإيرانية بمعدل 49 بالمئة.
هناك، أيضا، مقالات متناثرة في الصحافة والمواقع العربية والأجنبية غطت
جوانب أخرى. من بينها موقع « ألترا عراق»، في سلسلة مقالات، رافقتها
صور رائعة، أبرزها مساهمة أحمد هادي عن الغرافيتي والجداريات التي
حولّت نفق ساحة التحرير الكونكريتي إلى سلسلة لوحات مضاءة بالأمل، « و
حتى لو تم تدميرها أو حذفها، ستكون عالقة بأذهان الناس، وأنا متأكد
أنها ستطبع وتُعّلق في بيوت العراقيين، لأنها رمز من رموز الثورة».
واحتل الشعر مساحة متميزة، إذ جمع الثوار بين كتابة الشعر ومواصلة
الاحتجاج وهم يتعرضون للرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع ويقومون
بنقل الجرحى والمصابين وتجنب الاختطاف. كانت الانتفاضة، كما كتب علي
فائز، ولا تزال واحدة من « أكثر الانتفاضات العراقية التي ألهمت هذا
العدد الكبير من الشعراء لكتابة قصائدهم، مؤسسةً لجيل جديد يشبه وطنه
ويعيش همومه.» وفي مجال الغناء « أبدع شباب الانتفاضة في مدينة الموصل،
مثلا، في تحويل الأغنية الثورية الإيطالية «بيلا تشاو» إلى اللهجة
المحلية فباتت «بلا جارة»، أي لا حل يرجى، مع مشاهد مستوحاة من مسلسل
إسباني يروي قصة «انتقام من السلطة»، حملت طابعًا عراقيًا سلط الضوء
على معاناة الشباب في ظل البطالة والإهمال الحكومي»، كما كتب عثمان
الشلش مضيفا مساهمات عدد من المغنين الكبار والشباب، معتبرا أغنية رحمة
رياض أحمد «نازل أخذ حقي» من بين أشهر الأغاني التي جسدت الاحتجاجات.
ولئلا تصبح حياة شهداء الانتفاضة بضاعة لمقايضات السياسيين المبتذلة،
أعد الصحافي الاستقصائي حسن نديم كتابا يوثق بالتفصيل أسماء وحياة
ورحيل الشهداء وجعله متوفرا للجميع على الإنترنت.
باللغة الإنكليزية، صدر « طوباويو ساحة التحرير»، متضمنا قصائد 28
شاعرًا شابا (لا تتجاوز أعمار عدد منهم 19عاما) ممن شاركوا « في احتجاج
ساحة التحرير أو شهدوه»، جمعتها الشاعرة الشابة سما حسين عام 2021
وترجمتها وحررتها د. أنباء جاوي وكاثرين ديفيدسون.
أثبت الخزين الفني الهائل الذي أبدعته ساحات انتفاضة تشرين أن الفنون
لا تقتصر على النخبة فحسب بل أنها أرضية خصبة يملكها الجميع لبذر
الأحلام والتطلعات وإمكانية تحقيق البدائل. وللحفاظ على هذا الإرث
الثمين، كذاكرة شعب، تقع علينا مسؤولية تجميعه وصيانته، ربما كمتحف
وطني حي يليق بحياة وإبداع المشاركين بالانتفاضة وشهدائها، تُجمع فيه
حتى القنابل الحارقة التي استخدمت لقمع الأصوات الحرة. وقد يكون تجسيدا
لغرافيتي « يا بلد… في الحلم رأيت الموتى ينظفون أسلحة الجنود من
دمائهم» الذي خلّده زياد متي، مصور يوميات الانتفاضة.
كاتبة من العراق
العراق يُسبب
الصداع للحكومة البريطانية
هيفاء زنكنة
إذا كانت الإدارة الأمريكية تكتفي، بين الحين والآخر، بالتعبير عن
قلقها إزاء ما يجري في العراق من أحداث تكاد تفكك البلد، فإن الحكومة
البريطانية لا تختلف عنها كثيرا بل تسايرها، كتفا بكتف، حسب تعبير رئيس
وزرائها السابق أثناء الإعداد لشن الحرب العدوانية عام 2003.
ويلازم تعبير القلق، وما يلازمه من صداع، الحكومة البريطانية مهما كان
الحزب الحاكم وعلى الرغم من الضجة الإعلامية الكبيرة التي صاحبت
توقيعها اتفاقية التعاون الاستراتيجي، منتصف العام الماضي، الملزمة
للجانب البريطاني بما هو أكثر من إبداء القلق إن لم تعمل على تطبيق
بنود معينة على حساب بنود أخرى وفق مصلحتها، بناء على منظور طرحه تقرير
أخير للبنك الدولي يشخص فيه «الخصائص الثلاث التي تكمن وراء مآزق
العراق: حكمه السيئ، والاعتماد على الثروة النفطية، والتنوع العرقي
والإقليمي».
ويفترض أن مزيج الثروة النفطية و«التفتت العرقي والديني» أدى إلى
الصراع والعنف والهشاشة. وهو منظور يوفر للحكومة البريطانية صك الغفران
عما ارتكبته والإدارة الامريكية من جرائم وتخريب متعمد ومأسسة الفساد
بالإضافة إلى المحاصصة الطائفية والعرقية، ومن خلال إلقاء اللوم الكلي
على أهل البلد أنفسهم وكأنهم يعيشون في ظروف مختبرية نموذجية بلا
مؤثرات ومصالح خارجية مهما كان حجمها، فكيف إذا كان المؤثر الخارجي
غزوا واحتلالا تم التخطيط له على مدى عقود؟
أبدت الحكومة البريطانية «قلقها» أخيرا، في إجابة لسؤال طرحه وزير
الدولة للدفاع في حكومة الظل على وزير الخارجية للدفاع، نهاية الشهر
الماضي، عن ماهية المناقشات التي أجراها مع نظيره العراقي حول المصالح
الأمنية للمملكة المتحدة في العراق منذ يونيو/ حزيران 2022، مشيرا بذلك
إلى أحد جوانب الاتفاقية. وهو جواب يستحق المتابعة لأنه يساعدنا على
الفهم بعيدا عن آنية التصريحات المتبادلة بين ساسة ما بعد الانتخابات
العراقية. أجاب الوزير أن الحكومة البريطانية تُبقي الاستقرار الداخلي
العراقي قيد المراجعة المنتظمة، وأن الأجواء وإن هدأت قليلا إلا أنها
لاتزال متوترة في وسط وجنوب العراق ويمكن أن تُسبب مزيدا من
الاحتجاجات.
مكتفيا بذلك، لجأ الوزير إلى المشجب الذي يتم تعليق كل ما يجري من
أحداث وجرائم عليه، وهو مكافحة الإرهاب المتمثل، منذ عام 2014، بمنظمة
داعش ومن قبله بتنظيم القاعدة أو كل ما ترغب أمريكا بوصمه بالإرهاب.
إذ بقي وسم «الإرهاب» مطاطيا وصالحا لكل تبريرات التدخل في شؤون الدول
الداخلية وتصفية الخصوم بمختلف الطرق. وأكثر أسلحة التصفيات شيوعا
حاليا هو الطائرات بلا طيار. لذلك كان من الطبيعي أن يؤكد الوزير
التزام المملكة بمهمة مكافحة داعش «والعمل جنبًا إلى جنب مع التحالف
الدولي» بناءً على الطلب المستمر من حكومة العراق، آملين « أن يجد
العراق حلاً سلميًا ومستدامًا للمأزق السياسي الحالي وأن تستمر الحكومة
العراقية في دعم هذا العمل الحيوي لضمان الهزيمة الدائمة لداعش».
أمان واستقرار الشعب العراقي ليس استراتيجية بريطانية أو أمريكية، بل هو الاستراتيجية التي يجب أن نعمل على تحقيقها بأنفسنا ونحن ننظف دارنا من الفساد
وتأتي إجابة الوزير متماشية مع البيان الذي ألقته نائبة المنسق السياسي
للمملكة المتحدة في الأمم المتحدة، في جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن
مكافحة الإرهاب في 9 أغسطس 2022. دعمت فيه النائبة السياسة الأمريكية
في التدخل الإمبريالي والاستهانة بمفهوم السيادة في كل مكان في العالم،
بضمنه العراق قائلة «لدينا جميعًا مصلحة مشتركة في استخدام كل رافعة في
حوزتنا لمواجهة تنظيم القاعدة وداعش والجماعات الإرهابية الأخرى. وعلى
الرغم من هزيمته على الأرض والعمليات الناجحة الأخيرة ضد قيادته، لا
يزال تنظيم داعش يمثل تهديدًا خطيرًا في العراق وسوريا، معقله
الاستراتيجي».
يتفق الساسة العراقيون مع الخطاب البريطاني في محاربة داعش، فهم أيضا
بحاجة إلى عدو مستديم.
إلا أن تصريحاتهم الإعلامية تمنح معاهدة التعاون الاستراتيجي وجها
برتوش تجميلية تُساعد على تمرير الادعاءات البريطانية حول تغطية
الاتفاقية جوانب أخرى مثل «الاقتصاد والتعليم والثقافة وتنفيذ القانون
والتعاون القضائي وحقوق الإنسان» حسب وزارة الخارجية العراقية. كما تضم
الاتفاقية، في ديباجتها، رسالة لو تم تطبيقها لاحتل الشعب العراقي
المرتبة الأولى في مقاييس الاستقرار والنزاهة والعدالة والديمقراطية،
ولما كان منحدرا إلى أسفل القوائم الدولية. حيث تنص الديباجة على أن
السبب الرئيسي لتوقيع الاتفاقية هو «الأهمية التي يوليها الطرفان
لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، واحترام حقوق الإنسان، والمبادئ
الديمقراطية والحريات السياسية والاقتصادية التي تشكل أساس الشراكة بين
البلدين».
ولم تهمل ذكر « دعم جهود العراق لمواصلة الإصلاحات السياسية
والاقتصادية، وكذلك في تحسين الظروف المعيشية للفئات الفقيرة والمحرومة
من السكان». وهي إصلاحات لو تم تطبيقها فعلا بين (الشركاء) لتمكنت
بريطانيا وأمريكا من معالجة « قلقها» والقضاء على الإرهاب، مهما كانت
طبيعته، فضلا عن تخلصها من عقدة الرجل الأبيض تجاه دمقرطة «السكان
المحليين». وهذا ما لن يحدث فالعلاقة بين بريطانيا والعراق، في السنوات
الأخيرة التالية لتقليص الوجود العسكري، وغايته تقليل التكلفة المادية
وحماية حياة القوات البريطانية، ستبقى عند إزاحة غطاء « مكافحة داعش»
عن السطح، كما كانت في العقود السابقة للغزو. هدفها إبقاء العراق،
بوضعه الحالي، بكل مآسيه وتناقضاته وحالة الاقتتال المستهلكة لقوى
شعبه، لأنه الوضع الأفضل للسيطرة على مصدر الطاقة.
«بالطبع يتعلق الأمر بالنفط؛ لا يمكننا إنكار ذلك حقًا»، كما قال
الجنرال جون أبي زيد، الرئيس السابق للقيادة المركزية الأمريكية
والعمليات العسكرية في العراق، في عام 2007. وليس النفط هو السبب
الوحيد لشن الحرب، فقد شملت طبخة « التحرير وبناء الديمقراطية» تأمين
سلامة الكيان الصهيوني، وانعكست بقوة على فتح الأبواب أمام تهافت
الحكومات العربية على توقيع الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني فضلا عن
صفقات السلاح وعقود الفساد الخيالية لـ «إعمار» ما قامت بريطانيا
وأمريكا بتهديمه. هذه الحقائق قد يُنسينا إياها الانخراط اليومي في
تفاصيل الوضع السياسي بكل صراعاته الحقيقية والمفتعلة، ومن مختلف القوى
والدول بضمنها « الشركاء». ولعل اقترابنا من الذكرى السنوية الثالثة
لانتفاضة تشرين/ أكتوبر وتكلفتها الغالية من حياة الشهداء، سيُذكرنا
بأن أمان واستقرار الشعب العراقي ليس استراتيجية بريطانية أو أمريكية،
بل هو الاستراتيجية التي يجب أن نعمل على تحقيقها بأنفسنا ونحن ننظف
دارنا من الفساد.
كاتبة من العراق
مستقبل العراق بين الرادود
وزراعة الرقائق في الدماغ
هيفاء زنكنة
على هامش الحياة اليومية لسكان كوكب الفيسبوك من العراقيين، ومن بين
ركام التعليقات بكل تفاصيلها الغنية والمبتذلة، برز في الأيام الأخيرة
خبر حظي بعدد كبير من التعليقات المؤيدة والمستنكرة وإشارات الرضا
والاحتضان على حساب خبر آخر لم ينجح، على أهميته، من الحصول إلا على
بعض الإيماءات الخجولة. فهل لهذا دلالة على حجم الوعي لدى سكان الموقع،
سواء كان شخصيا أو جماعيا، على تنوع خلفياتهم الثقافية عموما، أم إننا
نمنح الفيسبوك وسكانه أهمية أكبر من هدفه الأصلي، وهو تمضية الوقت
والتواصل وتبادل شذرات الاخبار أو تسويق النفس، في فضاء مشترك مريح؟
يتضمن الخبر الأول الذي شغل الكثيرين من سكان الفيسبوك واستقطب عديد
التعليقات وصفا يُسيء للصحابة، أطلقه شاب عنوان وظيفته «رادود» أي
حكواتي يسرد مقتل الأمام الحسين، ويعتمد مقياس نجاحه وارتفاع أجره على
قدرته في استدرار الدموع الغزيرة والبكاء واللطم. بتعليقه، سواء كان
ساذجا أو مخططا له، نبش الرادود جرحا بات ينزف على صفحات الفيسبوك،
وشغَل المعلقين حتى كادت الأصوات الناقمة تتساءل «هل تستطيع مياه
المحيطات غسل هذه الأيدي الملطخة بالدماء؟» كما تساءل الملك ماكبث في
مسرحية شكسبير الشهيرة، بعد ارتكابه جريمة قتل، لتجيبه زوجته قائلة
ببرود أن قليلا من الماء سيزيل الدماء.
أما الخبر الثاني وهو الذي رماه عراقيو الفيسبوك جانبا، فبدايته إعلان:
«احصل على شريحة الدفع الخاصة بك الآن لتخطو نحو المستقبل». ونقرأ من
خلاله كيف روجت الشركة البريطانية – البولندية «ووليتمور» أول دفعة من
شرائح الدفع الدقيقة القابلة للزرع في جسد المستهلك. فبتكلفة لا تزيد
على 199 يورو، صار بالإمكان التخلص من حمل النقود وبطاقات الإئتمان
مقابل زرع شريحة لا يزيد حجمها على حبة الرز لتكون الوسيلة الأكثر
أمانا للدفع، المقبولة عالميا، والآمنة بيولوجيًا بعد أن أكدت إدارة
الغذاء والدواء الفيدرالية الأمريكية صلاحيتها البيولوجية.
يوضح موقع الشركة كيفية غرز هذه الشرائح المعروفة تقنيًا باسم «شرائح
تحديد التردد اللاسلكي» تحت الجلد، وسلامتها. وقد اختار أكثر من 50 ألف
شخص، في أنحاء العالم، غرز الرقائق، لتحل محل المفاتيح وتذاكر السفر
الإلكترونية، وحتى تخزين معلومات الاتصال في حالات الطوارئ وملفات
تعريف الوسائط الاجتماعية.
تؤكد الشركة المنتجة في إعلاناتها على أنه من غير الممكن التجسس أو
تتبع أو مراقبة أو جمع أية معلومات عن مستخدم الشريحة. وهي النقطة
الأكثر إثارة للجدل والشك والخوف المتداخل مع الاحساس بعدم الأمان إزاء
فكرة غرز الشرائح مهما كان نوعها ومصدرها.
التطور الحالي وهو حصيلة عقود طويلة من تطبيق ما كان يتخيله رواد الخيال العلمي ويهدف بشكله البريء إلى توسيع قدرات وقوى البشر وتمكينهم من جعل أداء مهام معينة بشكل أسهل وأسرع، هو سيرورة، تحمل أيضًا إمكانية التدخل بشكل خاص لأغراض الرقابة
هل صحيح أن وجود شريحة مبرمجة داخل الجسم لن يؤدي بالنتيجة إلى أما
السيطرة عليه أو تسهيل عملية السيطرة عليه ما دام التحكم بها يتم من
خارج الجسم؟ وإذا كان هذا صحيحا فكيف يتم التوصل إلى تكوين صورة شبه
متكاملة عن الانسان بدءا من مواصفاته الجسدية إلى ما يرغب فيه ويحبه،
عبر تجميع المعلومات عنه ومتابعته وملاحقته بواسطة الطائرات بدون طيار
بمجرد استخدامه بطاقة الائتمان أو الهاتف المحمول وبقية التقنيات
الرقمية المحيطة بنا؟ مما يقودنا إلى التساؤل، أيضا، عما إذا كان
التطور الحالي وهو حصيلة عقود طويلة من تطبيق ما كان يتخيله رواد
الخيال العلمي ويهدف بشكله البريء إلى توسيع قدرات وقوى البشر وتمكينهم
من جعل أداء مهام معينة بشكل أسهل وأسرع، هو سيرورة، تحمل أيضًا
إمكانية التدخل بشكل خاص لأغراض الرقابة وتسهيل عمليات الرصد، ليضاف
إلى ما تقوم به السلطات، في عديد الدول، من تجميع الحامض النووي
والبيانات البيولوجية، بما في ذلك عينات الدم وبصمات الأصابع
والتسجيلات الصوتية ومسح قزحية العين وغيرها من المُعّرفات الفريدة –
من مواطنيها، في عملية تضعهم تحت رادار السلطة بشكل شبه دائم.
ويتمثل أحد المخاوف الأمنية العامة في تقنية غرس الشرائح عموما في أنها
قد تسمح لأطراف ثالثة بالتنصت على اتصالات الجهاز أو تزويد بيانات
مشوهة. فمثل أي جهاز آخر، كما يُحذر باحثون في هذا المجال، تحتوي هذه
الشرائح الشخصية على ثغرات أمنية ويمكن اختراقها، حتى لو كانت مضمنة
تحت الجلد.
وإذا كانت روايات الخيال العلمي هي أساس الكثير مما وفره التقدم العلمي
والتكنولوجيا لنا، فما الذي يمكن أن يحمله المستقبل؟ يجيب كتاب الخيال
العلمي ويوافقهم العلماء: إنه زرع الشريحة في الدماغ. وهناك أمثلة
ناجحة طبيا. فقد ساعدت إحداها مريضا أمريكيا على استعادة السيطرة على
يده وأصابعه بعد إصابته بالشلل من الرقبة إلى أسفل. وطور أستاذ من جنوب
كاليفورنيا غرسة دماغية للمساعدة في تحسين الذاكرة القصيرة والطويلة
المدى. وبدأت شركته إجراء تجارب تبشر بنتائج إيجابية مع مرضى الصرع.
وأطلق إيلون ماسك، مالك شركة تسلا الأمريكية العملاقة، شركة جديدة يأمل
أن تعمل على «دمج الدماغ البشري مع الذكاء الاصطناعي» بهدف علاج أمراض
الدماغ الخطيرة.
هذا هو الجانب الإيجابي الذي سيقود إليه زرع الشرائح في الدماغ.
الملاحظ أن كل الأمثلة الإنسانية الناجحة حتى الآن تم تنفيذها في
الغرب، بينما تلقى العراق، مثلا، التطبيق القاتل للتطور العلمي ـ
التكنولوجي فمن قذائف اليورانيوم المنضب والفسفور الحارق إلى أجهزة
استشعار الحركة المحمولة على الطائرات، والأقمار الصناعية وكاشفات
الحرارة وأجهزة تنصت الصور والاتصالات بالإضافة الى تقنية تصوير قزحية
العين الذي استخدم لتحديد هوية الداخلين إلى مدينة الفلوجة بعد تهديم
70 بالمئة منها.
فما الذي يحمله المستقبل إذن بصدد غرز الشرائح، ولدينا ما يدل على أن
تطبيقها سيميل أكثر نحو إحكام السيطرة على الافراد والمجتمع في البلدان
العربية وبقية الدول الخاضعة لحكومات تحرم مواطنيها من حرية الاختيار؟
وهل سنكون قادرين على التوعية بهذه المسارات الخطرة المُستهدفة لوجودنا
بينما ننشغل بالنظر الدائم الى الوراء، لا لاستخلاص العبرة وتفادي
الأخطاء ولكن، كما نرى في عراقنا اليوم، لتكرار الأخطاء؟ إذا كان ما
يُنشر على الفيسبوك إشارة، مهما كان حجمها، تساعدنا على إستشراف
المستقبل، فإنه يُبلغنا رسالة مفادها أنه إذا ما استمر تدهورنا الحالي،
سيكون من الصعب رؤية ما سيحمله المستقبل لنا بتطوره العلمي الهائل، إلا
من منظور فئران التجارب.
كاتبة من العراق
رحيل ملكة… قلب
الإمبراطورية الأسود بوجه أبيض
هيفاء زنكنة
أبعدت وفاة الملكة إليزابيث الثانية الحرب الأوكرانية عن عدسة الإعلام
ومع التعازي ومظاهر الحزن، والتغطية الإعلامية المتواصلة، تدفق التبجيل
والذكريات السعيدة عن الراحلة ممتدا من المنظور العائلي الخاص إلى
السياسي العام. وتحدث كل من التقى بها من الساسة عن إلمامها السياسي
الكبير بما يدور في أرجاء العالم وتفاعلها الإنساني مع الأحداث مع
التزامها برمزية منصبها. وهي نقطة تثير الكثير من التساؤلات عند
الاستماع إلى ذكريات الساسة البريطانيين، بضمنهم كبار المسؤولين ورؤساء
الوزراء، التي تؤكد أنها كانت تتخطى حدود رمزية المنصب، بشكل غير
مباشر، وغالبا عبر الثقل الذي يحمله رأيها واستنادا إلى مكانتها كممثلة
لسلطة مركزية متوارثة منذ عام 827 ميلادي.
ففي مجلس اللوردات الذي كرس جلسته الأخيرة لتأبين الملكة، تحدث لورد
ستيراب، عضو لجنة العلاقات الدولية والدفاع، مذكرا إيانا بأن الملكة
كانت قائدة القوات المسلحة، وهو منصب قلما يتم ذكره. وأنها طالما أولت
اهتمامًا كبيرًا لأنشطة القوات من الصعوبات والتحديات إلى النجاحات.
مستطردا بأنه أراد التركيز على حادثة واحدة فقط جرت منذ عدة سنوات. حين
كان مسؤولا عن قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، الذي قاد حرب
الخليج الأولى، قائلا: « عندما بدأنا نفقد الطائرات فوق العراق، كانت
الملكة على اتصال على الفور، وأرادت معرفة كيف يمكنها المساعدة، وعلى
وجه الخصوص كيف يمكنها دعم العائلات. جاءت وعقدت اجتماعات خاصة مع أقرب
أقارب المفقودين في العمل… وجعلتهم يفهمون مدى اهتمامها.» وهو موقف
مفهوم لأي قائد عسكري يدرك مسؤوليته تجاه قواته، لكنه لا يعني وصف ما
يقوم به القائد بالإنسانية الشاملة، تجاه الشعوب، أيا كانت، كما تدل
رسائل التعزية المرسلة إلى المملكة ومن بينها رسائل الملوك والرؤساء
العرب. فالملكة الراحلة لم تهتم إطلاقا بالعوائل العراقية التي قُتل
أفرادها كانت بقصف سلاح الجو الملكي البريطاني بل بالبريطانيين فقط.
الجانب الآخر المعني أكثر بتوضيح موقفها «الإنساني» من الشعوب في أرجاء
العالم، هو تنصيبها توني بلير، رئيس وزراء حزب العمال السابق، كعضو في
حملة «وسام الجارتر»، وهو أقدم وأعلى رتبة في منزلة الفرسان المُقربة
من الملكة والمؤثرة في إنكلترا، ولا يزيد عددهم عن 24 عضوًا على قيد
الحياة. وقد تأسس هذا النظام المتجذر في فكرة الفروسية في العصور
الوسطى عام 1348، عندما كان الملوك يحيطون أنفسهم بأقوى حلفائهم من
الطبقة الأرستقراطية. ولمن يحاجج بأن تعيين توني بلير جاء كقرار
مؤسساتي لأن دور الملكة رمزي، أُذكر بأن التعيينات تتم وفقا للاختيار
الشخصي للملكة ومشيئتها والأكثر من ذلك إنها تتم دون مشورة رئيس
الوزراء بعد تعليبها بأنها «اعتراف بمساهمة وطنية أو خدمة عامة أو خدمة
شخصية للملك»، بشكل يُراد له تجاوز مفهوم القرون الوسطى وإن بقي، في
جوهره كما هو.
أبعدت وفاة الملكة إليزابيث الثانية الحرب الأوكرانية عن عدسة الإعلام ومع التعازي ومظاهر الحزن، والتغطية الإعلامية المتواصلة، تدفق التبجيل والذكريات السعيدة عن الراحلة ممتدا من المنظور العائلي الخاص إلى السياسي العام
كيف يتماشى اختيار توني بلير مع صورة الملكة الإنسانية الهائلة التي
يتم تدويرها حاليا في أرجاء الكون؟ وكيف بالإمكان هضم الحزن الجماعي
الشامل الذي تُرّوج له أجهزة الإعلام والمؤسسات الرسمية لشعوب ذاقت
الأمرين من سياسة بريطانيا الخارجية الاستعمارية ويُنكس لها الحكام
العرب الإعلام لعدة أيام؟
« تكريم توني بلير؟! يجب أن يُحاكم بسبب الكارثة في العراق». لم يكن
هذا صوت العراقيين المناهضين لشن الحرب ضد العراق لتقوم الملكة بتجاهله
بل واحدا من عدة عناوين رئيسية نشرتها الصحافة البريطانية عندما أعلنت
الملكة عن تكريمها توني بلير. كما تجاهلت عريضة وقعها ما يزيد على
المليون مواطن بريطاني (بضمنهم من أصول عربية وإسلامية) تطالب بسحب
تكريمه لأنه «مجرم حرب» أدانته محاكم الضمير في حوالي 12 دولة،
لمسؤوليته عن قتل مليون عراقي بشكل مباشر وغير مباشر. وكان في تقرير
تشيلكوت الذي أجرته الحكومة البريطانية نفسها ما يدينه، لو تم الأخذ
به، كمسؤول عن شن حرب عدوانية بالشراكة مع الرئيس الأمريكي جورج بوش.
وعلى المستوى الشعبي، طالما تمتعت الملكة بحضور وصراخ الحشود حول قصرها
احتفالا بالمناسبات الملكية، فكيف لم تسمع صرخة الاحتجاج العالمية
المناهضة للحرب التي شارك فيها مليونا مواطن بريطاني في أكبر مسيرة
احتجاجية شهدتها بريطانيا على الإطلاق، وهي الأولى من نوعها التي
يتظاهر فيها الناس على حرب قبل شنها؟ ألم يُطلعها أحد على تجاهل توني
بلير لصوت رعاياها المخلصين للمملكة وسلامة وأمن شعبها المناهضين، في
الوقت نفسه، للحروب الإمبريالية لمعرفتهم بحجم تهديدها للسلام الداخلي
والخارجي معا؟ لم اختارت الملكة ضّم توني بلير إلى حلقة النخبة من
«فرسانها» متجاهلة أصوات المحتجين ضد التكريم، كما تجاهل بلير أصوات
المحتجين ضد الحرب ليعيد التاريخ نفسه متعجرفا إزاء رعايا الإمبراطورية
كما الشعوب التي استعمرتها الإمبراطورية؟
هل يكمن الجواب في أن ما حققه توني بلير كرئيس للوزراء من التقارب
السياسي الوثيق مع أمريكا وخوضه الحرب العدوانية لتثبيت القدم الأنكلو
أمريكية على الأراضي والموارد العراقية، وتحطيم الدولة وتحييد الموقف
العراقي المبدئي من القضية الفلسطينية، هو في صلب الحلم الملكي
باستعادة ما كان؟
وإذا كان مقياس نجاح أي حكومة هو ما تحققه من رفاه اقتصادي، فهل هناك
ما هو أكثر ربحا من الصناعات المرتبطة بالحروب والاستيلاء على موارد
الدول التي تنهشها الحروب والنزاعات، بأنواعها، أي ما أنجزه بلير؟
ولا يمكن استبعاد فهم تقدير الملكة لتوني بلير وتكريمه على الرغم من
كونه متهما كمجرم حرب إلا بالنظر إلى نشأتها كابنة وفية لإمبراطورية
انتزعت رفاهيتها من دماء الشعوب. ألم تُعّرب في بداية تنصيبها كملكة عن
تقديرها «لخبرة رئيس الوزراء تشرشل وحكمته وبلاغته وكيف تتطلع إليه
كدليل يساعدها على كيفية التصرف كملكة»، وهو من أكثر المتحمسين
لاستخدام «أسلحة الدمار الشامل» قائلا «أنا أؤيد بشدة استخدام الغازات
السامة ضد القبائل غير المتحضرة» بضمنهم الكرد في شمال العراق، ومبررا
القتل الجماعي بحس نكتة إنكليزي متسائلا: «لماذا ليس من العدل أن يطلق
مدفعي بريطاني قذيفة تجعل المواطن المذكور يعطس؟» واصفا موقف المعترضين
«إنه حقًا سخيف للغاية».
كاتبة من العراق
هل انتهت صلاحية الصراع
السني ـ الشيعي في العراق؟
هيفاء زنكنة
وأخيرا عاد العراق ليحتل، بعد غياب، مكانا في نشرات الأخبار الدولية.
لا لفوزه في ألعاب الساحة والميدان أو كرة القدم أو أي تقدم علمي أو
حضاري يليق بتاريخه وسمعته التي طالما تغنى بها أبناؤه والعالم العربي
والإسلامي، بل جاءت عودته بعد تغييب لأنه ساحة للاقتتال الداخلي وغياب
العقلانية في تسيير الأمور، في داخل الداخل. مما جعل خارطة العراق، كما
نعرفه، مقسمة إلى أجزاء من الصعب تجميعها إذا ما استمر الوضع على حاله.
ففي الأسابيع الأخيرة، وهنا تكمن جاذبية التغطية الإعلامية الدولية، لم
يعد القتلى من العراقيين ضحايا الحرب العراقية الإيرانية، أو نظام صدام
حسين، أو قصف تحالف ثلاثين دولة بقيادة أمريكا، أو الحصار، أو المليون
من ضحايا الغزو والاحتلال، وما تلاه من إرهاب بمسميات مختلفة من بينها
تنظيم داعش. بل صار العراق، في وضعه الأكثر انحدارا في ظل حكومات
الاحتلال « الديمقراطية» ساحة للمنافسة للفوز بجائزة من الذي يحصد
أرواحا أكثر؟ من الذي يختطف ويعذب ويقتل أكثر؟ من هو الحائز على
الميدالية الذهبية لرفع راية الحزب الذي تقوده ميليشيا تتلذذ بطعم
الموت؟
« في الحروب ليس هناك فائزون» مقولة قد تكون صحيحة في مكان ما في
العالم إلا أنها غير صحيحة إزاء كثرة ضحايا سباق القتل المتعمد في
العراق وكثرة المستفيدين منه. فكل الدول التي ساهمت ولاتزال بتحطيم
البلد فائزة وكذلك من تقاطعت مصالحهم معها من العراقيين. وإذا كانت
الخسارة الحقيقية مُجسّدة بالضحايا وعوائلهم من نساء وأطفال، فإن
الضحايا لا يسلمون حتى بعد قتلهم، من قبل قاتليهم. إذ تسارع الأحزاب و«
التيارات» و«المكونات» للمتاجرة بهم في ساحة منافسة أخرى ولكن باسم
وتعليب جديدين.
من بين مسميات الضحايا الجديدة التي شاعت في الأسابيع الأخيرة، أثر
إقتتال يوم الاثنين الماضي، الذي خّلف 45 قتيلاً وعشرات الجرحى، بعد
ساعة من إعلان مقتدى الصدر، قائد التيار الصدري اعتزاله، واقتحام
أنصاره المباني الحكومية في المنطقة الخضراء، ولأغراض التسويق السياسي
والمنافسة على المناصب والفساد، تم تداول المسميات التالية: «شهداء
فتنة الخضراء»، «ضحايا الاشتباكات»، « شهداء الحشد الشعبي»، « شهداء
الثورة السلمية». كل هذا قبل وقوع الاشتباكات المسلحة بين مليشيا سرايا
السلام التابعة للصدر من جهة، وعصائب أهل الحق التابعة لقيس الخزعلي من
جهة اخرى، في مدينة البصرة، ليلة الأربعاء الماضي.
للتغطية على سقوط الضحايا، سارع الساسة وقادة الميليشيات ورئيس
البرلمان وكل المسؤولين بشكل مباشر أو غير مباشر، وعلى رأسهم مقتدى
الصدر ونوري المالكي، إلى الإعلان عن إقامة مجالس عزاء وحداد « على
أحداث المنطقة الخضراء». ففي سباق المتاجرة بأرواح الضحايا بات إعلان
الحداد هو العملة الرائجة لغسل الأيادي من دماء الضحايا.
جوهر الخلاف الحقيقي هو المنافسة على السلطة لصالح هذه الجهة أو تلك بالتوافق مع المصلحة الذاتية وكيفية توزيع عائدات النفط الباذخة
حيث أعلن رئيس البرلمان الحداد لمدة 3 أيام في مجلس النواب على «أرواح
ضحايا العراق»، مع العلم أن البرلمان لم يكن منعقدا بل محتلا سوية مع
المنطقة الخضراء، وسط بغداد، من قبل أنصار الصدر. وأعلن «الإطار
التنسيقي» وهو تجمع أحزاب شيعية بقيادة رئيس الوزراء الأسبق نوري
المالكي، عن إقامة مجلس عزاء على» أرواح ضحايا الاشتباكات». وأقامت
ميليشيا الحشد الشعبي، المدعومة إيرانيا، مجلس عزاء على «أرواح ضحايا
أحداث المنطقة الخضراء» بحضور معتمد المرجع الديني السيد علي
السيستاني. أما مقتدى الصدر، فقد أعلن وزيره (ولعل الصدر هو رجل الدين
الوحيد في العالم الذي لديه وزير) عن إضرابه عن الطعام وحل ميليشيا
سرايا السلام التابعة له (وهي ليست المرة الأولى)، طالبا من أنصاره «أن
يُكثروا من الاستغفار وأن لا يعودوا لمثل هذا العمل مستقبلا حيا كنت أم
ميتا». عازفا بذلك على نغمة الاستشهاد التاريخية.
وكأن أيام حداد العراقيين المتشحة بالسواد، وممارسة اللطم والجلد
وتطبير الرؤوس ومجالس العزاء من أول شهر محرم حتّى العشرين من صفر،
بمناسبة مقتل الحسين، لم تعد كافية. لم يعد تكاثر الأيام السود، في
العقدين الأخيرين، بسرعة باتت تنافس مجموع ما عاشه العراقيون من ظلمة
حالكة على مدى تأسيس الدولة العراقية، كافيا. والمفارقة المُهينة لعموم
العراقيين أن تأتي الزيادة المتسارعة في ظل حكومات كان أفرادها، ولا
يزالون، يتباكون على مظلوميتهم، والتمييز ضدهم في عصور الخوف والقتل
والمطاردة، وعلى مر الظروف التاريخية. وإذا كان الحزن الجماعي على
استشهاد الحسين الذي يمثل خط الثورة والتضحية والمتبدي في إقامة الطقوس
والشعائر والمواكب (تم تسجيل تسعة آلاف موكب للمشاركة في إحياء مراسم
الأربعين حتى يوم السبت) فإنه، في ترجمته ضمن واقع النظام العراقي
الحالي لا يزيد، سياسيا واقتصاديا، عن كونه سوقا للمزايدة الشعبوية
والابتزاز العاطفي ومحاصصة الفساد الطائفي. وظهرت ذروة الانحطاط
(ولنأمل أنها وصلت القاع فعلا ولا مجال للانحدار أكثر) في الشهور
الأخيرة حين انتهت صلاحية استخدام مبرر «الإرهاب السني» ليطفو على
السطح جوهر الخلاف الحقيقي وهو المنافسة على السلطة لصالح هذه الجهة أو
تلك بالتوافق مع المصلحة الذاتية وكيفية توزيع عائدات النفط الباذخة.
فكما أن الارهاب لا يميز بين الناس، أثبت اقتتال «أهل البيت» أن هوس
السلطة، مهما كانت أهدافه، وبتعدد مستوياته الشخصية والعامة، هو
الأساس. كما أجهض إقتتال «أهل البيت» الدموي الأخير، وتبادل الاتهامات
بين «الفصائل المسلحة»، وتبادل إطلاق النار بالرشاشات والصواريخ
واستهداف القوات الأمنية من كل جانب، الفبركة الاستعمارية (القديمة –
الجديدة) التي روّج لها المحتل الأمريكي بأن عدم نجاحه في العراق، على
الرغم من حسن نيته، سببه الصراع السني الشيعي والمظلومية التاريخية بكل
أثقالها وتمظهراتها!
ولعل هذه الحصيلة، رغم ثمنها الغالي، هي الجانب الإيجابي الوحيد الذي
يلوح من فوضى الصراع الذي لا يمكن التحرر منه ما لم يتم التعامل،
وطنيا، مع مخلفات الاحتلال الأمريكي، بضمنها تحويل العراق إلى ساحة
لاستعراض العضلات مع إيران، وهدفه في الهيمنة على مصادر الطاقة
بالإضافة إلى الأحزاب والميليشيات والعشائر، الممولة إقليميا، ذات
المصلحة في إدامة الصراع الطائفي القومي لتسهيل سيطرتها على موارد
النفط وتوزيعها حسب المحاصصة.
كاتبة من العراق
الحرب الأوكرانية بريئة
من تُقزّم خمس العراقيين
هيفاء زنكنة
يعاني واحد من كل خمسة أطفال من التقزم في العراق. هذه حقيقة يحاول
الصراع السياسي المفتعل دفنها، سوية، مع تبادل الاتهامات بالفساد، على
الرغم من إختلاف الإثنين. فبينما بالإمكان إجراء الإصلاحات، وبعضها
فوري، لتجاوز الفساد، سيحتاج علاج ما يصيب الأطفال من أضرار،
وانعكاساته على حياتهم ومستقبلهم، بمختلف النواحي، إلى ما هو أكثر من
جيل.
من المعروف أن السبب الرئيسي للتقزم، أي عندما لا ينمو الأطفال كما
يُفترض ويكونون أقصر وأقل وزنا، بالنسبة لسنهم، هو «نقص التغذية» لأنهم
لا يحصلون على ما يكفي من الغذاء. وقد برزت هذه الظاهرة، في سنوات
الحصار الذي فُرض على العراق ( 1990 – 2003). حين عاش الشعب فترة تدهور
اقتصادي لا مثيل له، وعانت النساء، كأمهات بشكل خاص، من عدم الحصول على
ما يكفي من الطعام قبل الحمل وأثناءه، كما تشير تقارير منظمة اليونسيف،
فازداد خطر الإصابة بالتقزم. وتؤكد تقارير المنظمة، كما منظمة «أنقذوا
الأطفال» الدولية، وبقية المنظمات المعنية بنمو الأطفال وتنمية قدراتهم
العقلية، أهمية ما تسميه «نافذة الألف يوم» أي من بداية حمل المرأة حتى
بلوغ الطفل عامه الثاني، وهي الفترة الأكثر تأثيرا على إمكانيات الطفل
وتطوره المعرفي في المستقبل، لأنها الفترة الحرجة لتكوين وتطور الدماغ،
والتغذية الجيدة للأم ضرورية كما تستمر في لعب دور رئيسي في ضمان نمو
الدماغ بشكل صحيح. وإذا كان الحصار قد ألحق الضرر بجيل من أطفالنا، فإن
تراكم عوامل أخرى زادت من حجم المأساة وألحقت الضرر بالأجيال التالية.
من بينها الحروب، والاحتلال، والنزوح القسري، وتعرض العديد من المرافق
الصحية للضرر أو النهب أو فقدان موظفيها بسبب النزوح القسري، ونقص
الإمدادات الطبية جراء تضخم حجم الفساد المالي والإداري.
في دراسة اجراها خمسة من الباحثين العراقيين بعنوان «سوء التغذية بين
الأطفال بعمر 3 – 5 سنوات في بغداد» ونُشرت في دورية علمية عام 2013،
أن معدل الانتشار الإجمالي للأطفال ناقصي الوزن في بغداد هو 18.2
بالمئة وأن النسبة أعلى بقليل بين الإناث مقارنة بالذكور. خلُص
الباحثون إلى عدم وجود علاقة بين المستوى التعليمي للوالدين أو الحالة
الوظيفية وسوء تغذية الأطفال، متوصلين إلى أن سوء التغذية يرتبط بشكل
كبير، خاصة بعد حرب عام 2003 «بالعيش في أحياء غير آمنة ومقتل فرد واحد
على الأقل من الأسرة خلال السنوات الخمس الماضية». كما اهتمت دراسات
أخرى بالعلاقة بين العوامل البيئية والتغذية والصحة، ومن بينها ظروف
الحرب، وتأثيرها على النمو البدني للأطفال.
بانتظار التغيير الحقيقي النابع من صميم الشعب، سيبقى خمس العراقيين يعانون من التقزم وانعكاساته الجسدية والنفسية والاقتصادية المُدّمرة على مستقبل البلد كله
تستند معظم الدراسات ذات العلاقة على أن الاحتياجات الأساسية المحددة
للسلوك البشري والضرورية بالتالي لمستقبل البلد هي الصحة، التعليم،
المساواة، العمل، والاقتصاد. وكلها، حسب منظمة الغذاء الدولية، تقريبا،
في تدهور مستمر في العراق الذي يبلغ عدد سكانه 39 مليونا، من بينهم 1.2
مليون نازح و 2.4 مليون شخص في أمس الحاجة إلى الغذاء ومساعدات سبل
العيش مع استشراء البطالة. مع وصول معدل الفقر إلى 31.7 بالمئة، في عام
2020. ويحتل العراق المرتبة 123 من بين 189 دولة في مؤشر التنمية
البشرية للعام نفسه. وهي نتيجة متوقعة جراء سوء التغذية المزمن، الذي
بقي مهملا وبلا حل، على الرغم من رفع الحصار، منذ عشرين عاما، وإرتفاع
ميزانية الدولة ارتفاعا لم يشهد له العراق مثيلا. ويُظهر العديد من
الدراسات طويلة المدى، من بينها دراسة لسوزان ووكر، أستاذة التغذية في
معهد أبحاث طب المناطق الحارة بجامعة ويست إنديز، أن سوء التغذية لا
يقلل من فرص بقاء الأطفال على قيد الحياة، ويعيق صحتهم ونموهم فحسب، بل
أن الأطفال الذين يعانون من التقزم لديهم مستويات أقل من القدرة
المعرفية، وضعف الإنجاز المدرسي. ويظهر الكثير منهم اللامبالاة وأنماط
السلوك المشوهة الأخرى. وأن هذه الآثار تستمر حتى مرحلة البلوغ مع
انخفاض معدل الذكاء، ومستويات أقل من التحصيل الدراسي، ومشاكل صحية
عقلية أكثر تواترًا حين تمتد تأثيرات التقزم لتتعدى الأضرار الجسدية
والعقلية المباشرة إلى الأضرار النفسية، مسببة شرخا عميقا في احترام
الذات والثقة بالنفس والطموح لتغيير الوضع الذي كانوا عليه.
يأخذنا الرصد الأوسع والأبعد لهذه الكارثة في مرحلة ما بعد الغزو ورفع
الحصار، إلى فشل حكومات الاحتلال المتعاقبة في توفير الاحتياجات الصحية
الأساسية، من مبان وكوادر إلى الأمن الغذائي والإنساني. ويتبدى الفشل
في إهمال الأراضي الزراعية والمحاصيل والاعتماد على استيراد المواد
الغذائية بدلا من تصنيعها وعدم ايجاد الحلول لمشكلة الجفاف الناتجة عن
تحكم دول الجوار بمصادر المياه والفساد وسوء إدارة موارد الدولة. وإذا
كانت محاججة الحكومة بصدد كل المشاكل، خاصة توفير المحاصيل الغذائية،
هي الغزو الروسي لأوكرانيا منذ ستة أشهر، فإن هذه المحاججة واهية تماما
لأن ما يعانيه العراق من مشاكل ومن بينها سوء تغذية الأطفال وظاهرة
التقزم يعود إلى عدة عقود وليس ستة أشهر من الحرب في أوكرانيا التي
باتت المشجب الذي تُعلق عليه الحكومات الفاشلة، في أرجاء العالم،
إخفاقاتها.
وإذا كان العراق يعاني من نقص الغذاء إلا أنه بالتأكيد لا يخلو من
الافكار البّناءة والحلول وخطط التنفيذ من قبل عراقيين متمرسين في هذا
المجال، فضلا عن البرامج المقترحة من قبل منظمات حماية الأطفال
الدولية، وعدد منها فاعل بزخم معقول داخل البلد، إلا أن إصلاح السياسات
والمؤسسات، لا سيما في القطاعَين الزراعي والغذائي، ناهيك عن الصحة
والتعليم، لا يحظى بالأولوية لأن تفكيك الدولة بعد الاحتلال جعل
الحكومات عاجزة عن تمويل هذه البرامج، ولا يمكنها تطبيقها لغياب نية
البناء البشري والوطني من قبل الساسة المنشغلين بالصراعات المذهبية
والعرقية والعشائرية والفساد المستشري. وبانتظار التغيير الحقيقي
النابع من صميم الشعب، سيبقى خمس العراقيين يعانون من التقزم
وانعكاساته الجسدية والنفسية والاقتصادية المُدّمرة على مستقبل البلد
كله.
كاتبة من العراق
الفوزالأوكراني في السعودية
هيفاء زنكنة
فاز، يوم السبت الماضي، الأوكراني أولكسندر أوسيك ببطولة العالم
للملاكمة للوزن الثقيل، على البريطاني أنتوني جوشوا، في النزال الذي
أُقيم في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة. أهدى أوسيك، من أرض
المملكة العربية السعودية فوزه إلى بلده الذي يواجه غزواً روسياً منذ
شباط/ فبراير الماضي، وإلى عائلته و” كل الجنود الذين يدافعون عن
وطني”. احتفى الجمهور، وبحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بفوز
الملاكم الأوكراني وألوان علم أوكرانيا وكلمات “ألوان الحرية” المكتوبة
على ملابسه. وهو أمر قد لا يثير الانتباه لولا ما يستحضره في الذاكرة
ويدعو، كما هي عادة الاستعادة للأحداث، إلى المقارنة ومحاولة تعلم
الدروس، ربما لأننا لا نزال نؤمن، حتى ونحن نرى العالم يكرر نفسه في
استنساخ همجي، بما قاله الكاتب السعودي عبد الرحمن منيف، بأن ” من يقرأ
الماضي بطريقة خاطئة سوف يرى الحاضر والمستقبل بطريقة خاطئة أيضا، لذلك
لابد أن نعرف ما حصل لكي نتجنّب وقوع الأخطاء مرة أخرى. فمن الغباء أن
يدفع الإنسان ثمن الخطأ الواحد مرتين” يقول الكاتب السعودي عبد الرحمن
منيف لئلا نعيش الخطأ مرتين”.
إن الحدث الذي احتضنته السعودية رياضي، والملاكمة رياضة معترف بها
دوليا وأولمبيا، والرياضة كما هو متعارف عليه في المواثيق الرياضية،
وباتفاق إجماعي بين النوادي والمنظمات الرياضية وحتى الدول، يجب أن
تبقى حيادية بعيدة عن السياسة. وتحظر المادة 51 من الميثاق الأولمبي
وقانون الاتحاد الدولي لكرة القدم) الفيفا) أي شكل من أشكال التعبير
السياسي أو الديني على أرض الألعاب الرياضية. إنها فسحة الهواء التي
يتنفس من خلالها الجمهور هواياته وشغفه بالألعاب والتعبير عن مشاعره عن
طريق المشاهدة بشكل جماعي. تحييد الرياضة، إذن، كما يدافع مؤيدو وجهة
النظر هذه، ضروري. وهناك أمثلة كثيرة عن رياضيين تم إبعادهم أو
معاقبتهم لأنهم عبروا عن مواقف سياسية. من هذا المنطلق، يستوقفنا
النزال في السعودية وما صاحبه من تصريحات من قبل الفائز، وكيفية التقبل
الرسمي المحلي والعالمي لموقفه السياسي المُرحب به بينما، يتم في الوقت
نفسه، منع الرياضيين الروس من المشاركة في أي مسابقة رياضية دولية فقط
لكونهم مواطنين روسا. فالملاكم أوسيك مقاتل متطوع في القوات الخاصة
الأوكرانية. نُشرت له صور وهو يحمل السلاح. تفاخر مدير فريق الملاكمة
لشبكة ( سي أن أن) قائلا أن مهمّة أوسيك “كانت التنقل بحثاً عن أشخاص
غرباء. ونصب حواجز لمراقبة من يدخل ومن يخرج. وللتأكد من عدم عبور
أشخاص غرباء أو يشكلون خطراً”.
أجبرت الحرب في أوكرانيا عالم الرياضة على اختيار جانب، وهي تعني ذلك حقًا”. وهو موقف سليم تماما، ويبقى السؤال: هل سيُطبق على جميع الرياضيين في كل الدول أم أن ازدواجية المعايير لغة وممارسة ستبقى هي العملة المتداولة كما هو الموقف الحالي من أوكرانيا؟
فأُضيف إلى لقب أوسيك الملاكم بطل العالم، لقب المقاوم، مقاتل الغزاة
الروس، المدافع عن بلده ضد الاحتلال. الأمر الذي يجعلنا بمواجهة تساؤل
مهم، كيف يتم السماح لمقاتل غير نظامي يحيط مهامه على أرض المعركة
الغموض المشاركة بحدث رياضي عالمي؟ هل لأنه أوكراني وطبول دعم
أوكرانيا، إعلاميا وحربيا واقتصاديا، من قبل دول الناتو، وحاجة
السعودية إلى تغيير إطار صورتها، أمام العالم، أعلى من أي منطق؟ وكيف
بات لقب الأوكراني، مهما كانت طبيعة العمليات التي يُنفذها، مُقاوما،
في اللغة اليومية الشائعة للسياسيين وأجهزة الإعلام العالمية، بينما تم
وسم العربي والمسلم المقاوم بالإرهاب وبتنويعات أخرى كما رأينا بعد
الغزو الأنكلو أمريكي للعراق في عام 2003، وكما يواصل الاحتلال
الصهيوني وصف مقاومة الشعب الفلسطيني ويكررها من بعده العالم؟
لغويا ولغرض ترسيخ صورة معينة، ولنأخذ العراقي نموذجا، استحدث المحتل
الأمريكي نعوتا مهينة للحط من قيمة العراقي المقاوم وإنسانيته، لتبرير
قتله من جهة وتماشيا مع سياسة أمريكا بأن من الممكن كسب الحرب في ساحة
الرأي العام دعائيا وإعلاميا. بداية، كان وصف المقاوم: صداميا، فاشيا،
ثم أصبح إسلاميا، سنيا، وقاعدة. وخلافا لما يحدث بأوكرانيا، من تشجيع
للمتطوعين الأجانب للقتال ضد الاحتلال الروسي، وُصف المتطوع العربي
المتوجه إلى العراق للدفاع عن البلد ضد الغزاة بأنه إرهابي، من
المرتزقة، ذهب للدفاع عن الطاغية صدام، وفي أحسن الأحوال متمردا أو من
العصاة. وتم تعليب ذلك كله بمصطلحات، انتشرت بين قوات الاحتلال، تسللت
إلى وعي العالم أما من خلال التصريحات العسكرية الرسمية أو شهادات
الجنود الأمريكيين.
ومن سخرية القدر أن يأتي إجراء النزال بالسعودية، ليذكرنا بالاهتمام
الكبير الذي حظي به لقب “الحاج” لدى قوات الاحتلال عموما ومن بينها
القوات الأوكرانية التي اشتهرت بشراستها ضد العراقيين. حيث اُستخدم وسم
” الحاج” ليس للدلالة على من يتوجه إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج،
ولكن لإهانة ” العدو”، أي العراقي أو أي شخص من أصل عربي أو حتى من ذوي
البشرة السمراء. من بين الاستخدامات ” درع الحاج” وهو درع مرتجل نصبه
جنود يستأجرون عراقيين لتحديث المركبات عن طريق تركيب أي معدن متوفر
على جوانب عربات الهمفي. و “حاجي مارت” أو متجر حاجي: أي المحل الصغير
الذي يديره عراقيون لبيع الأشياء للقوات الأمريكية. أما ” دورية الحاج”
فهي الدورية العراقية المرافقة للأمريكية. وحسب المنظور العسكري
الأمريكي يُعتبر العراقي المُقاوم ” علي بابا ” بمعنى اللص والمجرم،
بينما تستخدم تسمية ” الملاك” للجندي الأمريكي القتيل.
في مقالة نشرتها صحيفة ” الغارديان ” بعنوان ” الحرب في أوكرانيا أنهت
خرافة حيادية الرياضة” ، كتب تم هاربر، رئيس مؤسسة ” المساواة في
الرياضة”، متهما رؤساء الاتحادات الدولية الرياضية بإدارة رؤوسهم بعيدا
عن محنة الناس بالتوافق مع الأنظمة الاستبدادية والديكتاتورية وطغيان
المصلحة التجارية على المصلحة المشتركة. مستدركا بقوة “لكن هذه المرة،
أجبرت الحرب في أوكرانيا عالم الرياضة على اختيار جانب، وهي تعني ذلك
حقًا”. وهو موقف سليم تماما، ويبقى السؤال: هل سيُطبق على جميع
الرياضيين في كل الدول أم أن ازدواجية المعايير لغة وممارسة ستبقى هي
العملة المتداولة كما هو الموقف الحالي من أوكرانيا؟
٭ كاتبة من العراق
( كصديقة لإسرائيل)…
الحكومة البريطانية ترد
هيفاء زنكنة
وقَع أكثر من مائة ألف شخص التماسا طالبوا فيه أن تقوم المملكة المتحدة
بمراجعة سياستها الخارجية «في ضوء التقارير عن الفصل العنصري
الإسرائيلي». تم إرسال الالتماس، بعد الحصول على عدد التوقيعات
المطلوبة للنظر فيه، إلى لجنة الالتماسات البريطانية المكونة من 11
نائبا من الأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة والمعارضة معا، وهي
لجنة تُعّرف نفسها بأنها مستقلة تماما.
جاء الالتماس الذي جُمعت توقيعاته بسرعة كبيرة أثناء هجوم الكيان
الصهيوني الأخير على غزة الذي أسفر عن مقتل 48 شهيدًا – 17 منهم من
الأطفال – وجرح حوالي 360 ، من بينهم ما لا يقل عن 151 طفلاً، والهجوم
على مدينة نابلس حيث اغتيل ثلاثة من المقاومين هم إبراهيم النابلسي
وإسلام صبح وحسين طه. خلال هجوم الكيان الصهيوني المسعور، استقبلت
مستشفيات غزة المُحاصرة، أعدادا كبيرة من الإصابات الناجمة عن
الانفجارات المباشرة وشظايا الصواريخ وتساقط الأنقاض من المباني
المنهارة، وهي التي تعاني أساسا من قلة الأدوية والمعدات والعلاج
الطبي، وإعادة التأهيل، والحاجة الماسة لدعم الصحة العقلية للأشخاص
الذين يعانون من صدمات نفسية أما بسبب إصاباتهم أو فقدان أحبائهم.
والمعروف أن أكثر من 40 ألفا من سكان غزة أصيبوا بجروح جراء القصف
والهجوم الصهيوني خلال الأربع سنوات الأخيرة.
استند موقعو الالتماس في مطالبتهم إعادة النظر في السياسة الخارجية على
تقارير منظمات حقوقية دولية وثقّت سياسة التمييز العنصري التي يمارسها
الكيان بشكل يومي بحق المواطنين الفلسطينيين والانتهاكات التي يتعرضون
لها جراء الاحتلال.
وقَع أكثر من مائة ألف شخص التماسا طالبوا فيه أن تقوم المملكة المتحدة بمراجعة سياستها الخارجية «في ضوء التقارير عن الفصل العنصري الإسرائيلي»
ثبّت اعتراف المنظمات بممارسات الكيان العنصرية، ما كان الفلسطينيون
يعيشونه ويوثقونه بأنفسهم على مدى سنين، وهو مطابق لممارسات نظام
التمييز العنصري «الأبارتهايد» في جنوب أفريقيا.
تلقت لجنة الالتماسات الالتماس. وحسب السيرورة المرسومة في النظام
«الديمقراطي»، ألقت نظرة عليه، وجاء الرد الحكومي باسم حكومة وبرلمان
المملكة المتحدة ليضع حدا لأي أمل خالج الموقعين في أن يكون الالتماس،
كما هي العادة الجارية، أداة ضغط على الحكومة لاتخاذ إجراء معين وجمع
الأدلة.
فما الذي تضمنه الرد؟ لا شيء جديدا وإن كان من الضروري قراءته من باب
التذكير بموقف حكومة كانت ولاتزال تمارس ازدواجية المعايير بلا مقياس
أخلاقي. جاء في الرد أن «المملكة المتحدة ملتزمة بدفع عملية السلام في
الشرق الأوسط إلى الأمام … وأن استئناف المفاوضات الثنائية الهادفة،
بدعم دولي، هو أفضل طريقة للتوصل إلى اتفاق»، وأنها مُطلعة على
التقارير الدولية (تعني تلك التي تُثبت أن النظام الإسرائيلي هو نظام
تمييز عنصري) إلا أنها لا تتفق مع المصطلحات المستخدمة فيها، مكتفية
بذلك بدون التطرق إلى تفاصيل التقارير أو محاججتها.
يلجأ الرد بمجمله إلى الموقف المعتاد في المساواة بين الجلاد والضحية
بل ويتعداه ، غالبا، بلغة صريحة أو مبطنة إلى إلقاء اللوم على الضحية
وبالتالي استحقاقها ما يقع عليها. هذا هو الملمح العام للرد مغلفا
بمفردات «عملية السلام» و»التسوية التفاوضية» و»الالتزام بالقانون
الإنساني الدولي وتعزيز السلام والاستقرار والأمن»، وأن تُجرى مفاوضات
بإشراف دولي، يضم بالتأكيد الحكومة البريطانية التي لا تخاطب نظام
التمييز العنصري إلا «كصديق». مرتان تكررت مخاطبة الكيان الصهيوني
كصديق . الأولى بالقول « كأصدقاء لإسرائيل ، لدينا حوار منتظم مع حكومة
إسرائيل» والثانية في معرض الغزل بـ» التزام إسرائيل طويل الأمد بالقيم
الديمقراطية» وكيف أن إلتزامها «هو أحد نقاط قوتها العظيمة كديمقراطية
زميلة … كصديق لإسرائيل ، نشعر بالقلق من أي تطورات قد تقوض هذا
الالتزام».
ويتضح من قراءة الرد، بوضوح لم تنجح اللغة الدبلوماسية بتمويهه، أن
هناك موقفين مختلفين تماما من النظام العنصري والشعب الفلسطيني: الأول
هو موقف الصديق القلق على أمن وسلامة صديقه مما يستدعي «الاعتراف بحاجة
إسرائيل المشروعة لاتخاذ تدابير أمنية» و»تظل المملكة المتحدة حازمة في
التزامها بأمن إسرائيل». كما «يستحق شعب إسرائيل أن يعيش في مأمن من
ويلات الإرهاب والتحريض اللاسامي الذي يقوض بشكل خطير احتمالات حل
الدولتين. لقد أذهلتنا الهجمات الإرهابية الأخيرة ضد المواطنين
الإسرائيليين. لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لأعمال العنف هذه». وإذا
حدث و»وُجهت اتهامات بالاستخدام المفرط للقوة، تدعو المملكة إلى إجراء
تحقيقات سريعة وشفافة».
وكأن كاتب الرد خشى أن يٌتهم بـ «معاداة السامية»، وهي التهمة الجاهزة
فورا ضد أي شخص يحاول الإشارة من قريب أو بعيد إلى احتلال فلسطين
وجرائم المحتل، فقام بتدوين سرد لقائمة مواقف بريطانيا الداعمة للكيان.
ومن بينها وقوف «المملكة المتحدة إلى جانب إسرائيل عندما تواجه تحيزًا
وانتقادًا غير معقول» مع ذكر أمثلة عن منع تمرير قرارات للأمم المتحدة
مؤيدة للشعب الفلسطيني. وفي الوقت الذي لعبت فيه الحكومة البريطانية
دورا رئيسيا في فرض العقوبات والحصار الشامل على الشعب العراقي على مدى
13 عاما، وبينما لا تجد ضيرا في حصار الإبادة المفروض ضد سكان غزة،
نجدها تصرح «نحن نعارض بشدة المقاطعات / العقوبات في حالة إسرائيل «.
لماذا؟ لأنها ترى أن المقاطعة ستعيق جهودها « للتقدم في عملية السلام»!
أما الموقف من معاناة الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال والممارسات
العنصرية فإنه لا يعدو كونه ناتجا طبيعيا لما يوصف بأنه « نزاع» أو
«صدام» . أما مقاومة الاحتلال فإنها إرهاب يُسّوغ اعتقال وسجن وإغتيال
المقاومين. ولا يأتي ذكر ما يتعرض له الشعب الفلسطيني إلا كهامش في جمل
فضفاضة مبتذلة لفرط عُريها، على غرار: « لكل إسرائيلي وفلسطيني الحق في
العيش بسلام وأمن». وإن كانت بريطانيا لا تغفل عن ذكر كرمها في «تحسين
حياة الفلسطينيين» مركزة بشكل خاص على تزويق «المساعدات الإنسانية
لغزة»، لتغطية بثور النظام الصهيوني العنصري الذي جعل من غزة سجنا
لمليوني فلسطيني.
ما هي، إذن، أهمية المشاركة في توزيع وتوقيع الالتماس، وواقع الحال
يشير إلى معرفة الجميع بما سيكون عليه الرد الحكومي؟ إن استمرارية
النشاطات المناهضة للاحتلال، بكافة المستويات، ضرورية لا من أجل تحقيق
غايتها النهائية فحسب بل في سيرورتها وكونها أداة توعية وتضامن عالمي
مع المقاومة التي يتحمل الفلسطينيون عبأها الأكبر، ويدفعون ثمنها غاليا
من حياة الناس اليومية ودماء الشهداء والجرحى والمصابين.
كاتبة من العراق
استقبال نتائج الانتخابات الديمقراطية
في الجزائر وفلسطين والعراق
هيفاء زنكنة
في تطور لعملية إقتحام مبنى البرلمان العراقي، بعد أسبوع من النوم
والأكل وإقامة الشعائر الحسينية، صار مطلب المقتحمين، إجراء انتخابات
جديدة بدلا من المطلب الذي دعاهم أساسا إلى اقتحام البرلمان وهو
الاحتجاج على ترشيح محمد السوداني المنتمي إلى جهة سياسية منافسة لقائد
المقتحمين مقتدى الصدر، رئيسا للوزراء. يأتي مطلب إعادة الانتخابات
ليتصدر الأجواء المشحونة بالتهديد والتُهم المتبادلة بعد أن برز على
السطح سؤال لم يخطر على بال المقتحمين الذين كان جُل ما فعلوه هو تلبية
أمر قائدهم، وهو: ما هي الخطوة التالية بعد نجاح الاقتحام؟ وهل من
برنامج لما بعد الاقتحام أو هل هناك برنامج أساسا للتيار الصدري الناشط
تحت قيادة زئبقية؟
ردا على السؤال، ظهرت دعوة مقتدى الصدر لحل البرلمان الحالي وإجراء
انتخابات مبكرة، حاثّاً المتظاهرين المعتصمين إلى الاستمرار باعتصامهم
لحين تحقيق المطالب. الأمر الذي وفر للساسة المنخرطين بالعملية
السياسية الموسومة بالفساد والطائفية وتفتيت العراق، بضمنها ساسة
التيار الصدري، فرصة الجلوس في استديوهات الفضائيات لساعات وساعات
والادعاء بأن هذا هو ما « يريده الشعب»، بل أن ما يأمر به السيد (وهو
لقب ديني لمقتدى) هو ما يريده «الشعب»، وأمره باقتحام البرلمان أكبر
دليل على ذلك.
ولنفترض أن الشعب لا يعاني من هيمنة الفساد المؤسساتي وانعكاساته على
تفاصيل التعامل اليومي، وأنه لا يعيش أجواء الارهاب وهيمنة الميليشيات،
وأنه لا يهتم بانقطاع الكهرباء وقلة مياه الشرب والتصحر وانتشار
الامراض السرطانية، والنزوح القسري، وانخفاض مستوى التعليم والصحة،
ومخاطر الاختطاف والاعتقال والتعذيب، ومعاناته من الفقر وهو في بلد غني
جدا، ولنفترض بأن ما يريده ويطمح إلى تحقيقه، هو إجراء إنتخابات جديدة
لا غير لأنه كما قال الصدر في 3 آب/ أغسطس، قد سئم الطبقة السياسية
الحاكمة، مخاطبا الشعب «استغلوا وجودي لانهاء الفساد، ولن يكون للوجوه
القديمة وجود بعد الآن من خلال عملية ديمقراطية ثورية سلمية، وعملية
انتخابية مبكرة». ولنفترض صدق الصدر هذه المرة ونسيان كونه قد شارك في
الانتخابات السابقة، كما كان شريكا دائما في كل الحكومات الفاسدة
المتعاقبة منذ احتلال البلد عام 2003، ليبقى السؤال عن ماهية
الانتخابات التي يدعو إليها؟ سيرورة تنظيمها وتكلفتها، والأهم من ذلك
ما الذي ستحققه بالمقارنة مع الانتخابات السابقة؟
كان فوز التيار الصدري، ضربة لم يتحملها منافسوه من الأحزاب الإسلاموية المنتمية إلى ذات المذهب، وإن كانت نسبة المشاركة حوالي 20 بالمئة فقط. فبرزت على السطح، منذ ما يزيد على العشرة أشهر، الخلافات والتهديدات بين الفائزين والخاسرين، مدعومة باستعراض سلاح الميليشيات والتحشيد الشعبوي وتقزيم دور الشعب
قد تساعدنا العودة إلى مجريات الانتخابات السابقة للاجابة على الأسئلة.
من الضروري، بداية، التذكير بحجم الثناء الذي أٌهيل على الانتخابات
التي أُجريت في العاشر من أكتوبر 2022. إنها انتخابات «مفصليةٌ مصيريةٌ
وتأسيسية» و«واحدةٌ من أهم العمليات الانتخابية في تاريخ العراق
الحديث» قال برهم صالح رئيس الجمهورية. «بها يتفادى خطر الوقوع في
مهاوي الفوضى والانسداد السياسي» قالت المرجعية الدينية. إنه «طريق
نأمل أن يؤدي إلى عراق أكثر ازدهارًا وأمناً وعدالة» قالت جينين هينيس-
بلاسخارت مسؤولة بعثة الامم المتحدة بالعراق. وهنأت السفارة الإيرانية
ووزارة الخارجية الروسية الحكومة والشعب بالنجاح، وأشادت بريطانيا
«بالتسيير السلس» للانتخابات. وأرسلت جامعة الدول العربية، برقية تهنئة
الى الحكومة والشعب. وردد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي «لقد أتممنا
واجبنا بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة». وأكدت المفوضية المستقلة
للانتخابات أنها «كانت مفخرة لنا، وسُررنا بالمؤسسات الداعمة التي
أمّنتها».
اتفق، إذن، كل المشاركين، بضمنهم التيار الصدري المشارك بقوة، أن عملية
الاقتراع، سارت «بشكل انسيابي» وهي «مختلفة عما جرى عام 2018». حيث تمت
بحضور أكبر بعثة انتخابية للأمم المتحدة في جميع أنحاء العالم، وبعد
إجراء أربع عمليات محاكاة انتخابية، وصرف مبالغ خيالية، وبعد توقيع كل
الأحزاب المشاركة على «مدّونة قواعد السلــوك الانتخابي» التي تعهدت
بموجبها «بنبذ التعصب والعنف وخطاب الكراهية».
إلا أن هذا كله تهاوى حالما أُعلنت نتائج الانتخابات، وفيها الخاسر
والرابح، كما هو متوقع من الانتخابات الديمقراطية، باستثناءات عربية
ودولية قليلة. من بينها قرار المجلس الأعلى للأمن الجزائري إلغاء نتائج
الانتخابات التشريعية، التي فازت فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ
(الفيس) بالأغلبية، عام 1992، بذريعة إنقاذ الدولة من وصول إسلاميين
متطرفين إلى الحكم. فكانت النتيجة الاقتتال لمدة عشر سنوات أُطلق عليها
اسم « العشرية السوداء». وفي فلسطين، رفض الكيان الصهيوني والولايات
المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، الإعتراف بنتائج الانتخابات
التشريعية لعام 2006، بعد فوز حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بحصولها
على 76 مقعدا من أصل مقاعد المجلس التشريعي البالغة 132. كما رفضت حركة
فتح (الخصم السياسي لحماس) وبقية الفصائل، المشاركة في الحكومة التي
شكلتها حماس، مما أدى عام 2007 إلى الاقتتال الذي انتهى بإدارة حماس
لقطاع غزة فقط وفرض الكيان الصهيوني الحصار الشامل على غزة وإخضاع
اهلها لأسوأ الظروف المعيشية واستهداف قيادات المقاومة المسلحة. أما
النموذج العالمي فيمثله رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنتائج
الانتخابات الرئاسية وتشجيع أنصاره على إحتلال مبنى الكونغرس في حدث لم
تشهد له أمريكا مثيلا سابقا.
على ذات المنوال، كان فوز التيار الصدري، ضربة لم يتحملها منافسوه من
الأحزاب الإسلاموية المنتمية إلى ذات المذهب، وإن كانت نسبة المشاركة
حوالي 20 بالمئة فقط. فبرزت على السطح، منذ ما يزيد على العشرة أشهر،
الخلافات والتهديدات بين الفائزين والخاسرين، مدعومة باستعراض سلاح
الميليشيات والتحشيد الشعبوي وتقزيم دور الشعب باسم الشعب. وهاهو
الصدر، يطالب باستحقاقه الانتخابي في تشكيل الحكومة بطريقة خَلقت، حتى
الآن، بين المواطنين جوا من الخوف والرعب من نشوب القتال مع ذات القوى
السياسية المنافسة له والتي ستشاركه الانتخابات المقبلة، إن حدثت،
لأنها لا تقل عن تياره تغلغلا وفسادا في مؤسسات الدولة فضلا عن كونها
لا تختلف عن تياره بقوتها القتالية وتعطشها للدماء. ويبقى الأمل
المنشود، وهنا المفارقة، أن يقرر الصدر فجأة، كعادته أثناء الأزمات
التي يلعب دورا في إثارتها، الانسحاب والانكفاء في صومعته أما لكتابة
الشعر أو إنهاء دراسته.
كاتبة من العراق
اقتحام البرلمان…
كوميديا العراق السوداء
هيفاء زنكنة
لماذا لا يثير إحتلال مبنى البرلمان العراقي، في المنطقة الخضراء في
بغداد، مشاعر الحماس كما أثار إحتلال المحتجين القصر الرئاسي في
سريلانكا والذي وصل الحماس له إلى الشعوب العربية ليمنحها بعض التفاؤل؟
هل لأن محتلي المبنى، ببغداد، لا يمثلون الشعب على الرغم من إدعائهم
بأنهم الشعب المسحوق؟ أم لعلها الطائفية التي بعد أن حققت نجاح استقطاب
السلطة لصالح الأحزاب والميليشيات الإسلامية ذات المذهب الواحد، في
السنوات العشرين الأخيرة ومنذ غزو العراق عام 2003، وفي غياب العدو
المشترك الموحد لها، أوصلت دودة الأرضة / الفساد إلى أرض «أهل البيت»
لتنخر «البيت» من الداخل؟ ولكن… ماذا عن راية الإصلاح التي رفعها
المقتحمون داخل المبنى وهم يتقافزون على الكراسي، وداخل المكاتب
ويصورون أنفسهم داخل المرافق الصحية متحدثين عن توفر الماء والكهرباء
للبرلمانيين بينما يُحرم الشعب منها؟
أليست هذه هي روح الشعب المسحوق المُنتفض ضد الفساد، ومن حقه استعادة
ملكية المبنى وتحويله، إلى ما يشاء، ولو كان ما يريده ساحة إضافية أخرى
لأداء طقوس النواح واللطم؟ أم أن غياب الحماس باقتحام مبنى هو رمز
للفساد، الموجود في منطقة محصنة هي رمز للاحتلال، سببه اليأس من
إسطوانة مشروخة، لكثرة التكرار، من قبل قائد التيار الصدري، حتى بات
تجسيدا لبيضة لن يخرج منها عصفور، كما يقول الشاعر الراحل مظفر النواب؟
هناك أسباب كثيرة تدعو إلى عدم التفاؤل باقتحام البرلمان ليس من بينها
عدم الإيمان بضرورة التغيير وقدرة الشعوب على التغيير والعيش الكريم في
وطن يتسع للجميع. إلا أن اقتحام البرلمان العراقي يختلف عن اقتحام
المتظاهرين للقصر الرئاسي في سريلانكا، الذي وقع بعد احتجاجات جماهيرية
ومظاهرات عارمة، استمرت لفترة طويلة وعّمت أرجاء البلاد، مطالبة
باستقالة رئيس الدولة ورئيس الوزراء، بعد أن أعلن الأخير انهيار اقتصاد
البلد بالكامل، في أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلال البلاد عام 1948،
بالإضافة إلى معاناة الناس من نقص حاد في الغذاء والوقود والأدوية.
وعلى الرغم من معاناة العراقيين من نقص الأساسيات، وهي نقطة تشابه مع
سريلانكا، إلا أن حيثيات اقتحام البرلمان تختلف من عدة نواح لعل أبرزها
أولا: أن العراق واحد من الدول الغنية في العالم، وقد وصل دخله من
النفط، حاليا، أعلى نسبة في تاريخه. ثانيا أن عملية الاقتحام اقتصرت
على أتباع مقتدى الصدر، قائد التيار الصدري وميليشيا سرايا السلام
الشيعية.
ثالثا: جاء الاقتحام احتجاجا على ترشيح منافس للتيار الصدري، من قبل
تكتل شيعي آخر يُدعى الإطار، لمنصب رئيس الوزراء، بناء على مناورات
سابقة أرادها الصدر استعراضا لشعبوية قيادته للتيار والميليشيا. من بين
المناورات التي شغلت البلد وعطلت حياة الناس: الأمر بانسحاب
البرلمانيين الصدريين، صلاة الجمعة الموحدة، والإعلان عن مؤامرات تهدف
إلى اغتيال الصدر بعد أن قام الناشط الحقوقي علي فاضل بتسريب أشرطة
لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي احتوت لخطورة تحريضها على العنف، ما
كان يجب أن يُقدم على أثرها المالكي للمحاكمة. رابعا: أن قائد مقتحمي
البرلمان لا يمثل الشعب ولا حتى الأغلبية، بل غالبا ما يتم تضخيم دوره
حسب الحاجة لإثارة العنف والفوضى.
لماذا لا يثير احتلال مبنى البرلمان العراقي، في المنطقة الخضراء في بغداد، مشاعر الحماس كما أثار إحتلال المحتجين القصر الرئاسي في سريلانكا والذي وصل الحماس له إلى الشعوب العربية ليمنحها بعض التفاؤل؟
وما يزيد من محدودية «التيار الصدري»، تقّلب سلوك زعيمه من أقصى اليمين
إلى أقصى اليسار بسبب حالة الصعود والهبوط النفسي الحاد الذي يعاني منه
منذ طفولته ويتبدى بشكل واضح في خطبه ولغته وسلوكه. خامسا: أن عدد
المرات التي ساند فيها الصدر الفاسدين ومجرمي الحرب وأبرزهم عدوه
الحالي نوري المالكي تجاوزت اصابع اليد الواحدة، بل والأدهى من ذلك أنه
كان أحد الاسباب الرئيسية التي لعبت دورا حاسما في القضاء على مظاهرات
تشرين/ أكتوبر 2019 لأنها مثّلت صوت الشعب العراقي فعلا، وأحيت الأمل
باسترداد الوطن إلى أن أدرك الصدر وأتباعه أنها ستُحدث تغييرا سياسيا
حقيقيا مما يهدد شعبويته، فأرسل أتباعه وميليشياته لتفريقها.
ومقتدى الصدر ليس فريدا من نوعه في مزاجيته المرضية المنعكسة بقوة على
الوضع السياسي، فالفضل الأول يعود الى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الذي حفّز بخطبه وتلفيقاته مشاعر العنصرية و«الوطنية» الزائفة. حتى
يكاد اقتحام البرلمان العراقي مطابقا للهجوم على مبنى الكونغرس بواشنطن
وأحتلاله من قبل أتباع ترامب، المطالبين بإيقاف التصديق على فوز جو
بايدن في الانتخابات الرئاسية، وبقوا في المبنى لأكثر من ثلاث ساعات
قبل أن يطلب منهم ترامب، الذي كان متمتعا بمراقبتهم عبر شاشة
التلفزيون، العودة إلى ديارهم. بذات الايقاع، بقي أتباع الصدر في
البرلمان، في الاقتحام الأول، مدة ثلاث ساعات، إلى أن وصلهم أمر مقتدى،
مغردا «وصلت رسالتكم… أيها الأحبة فقد أرعبتم الفاسدين عودوا لمنازلكم
سالمين».
في ذات الوقت، سرّب نوري المالكي، منافس الصدر الأقوى في احتلال
المناصب الوزارية والمؤسساتية من «البيت الشيعي»، صورا له وهو يحمل
سلاحا وسط مجموعة من حراسه داخل المنطقة الخضراء. كانت رسالة الصور
المُسرّبة واضحة. أنها تُعبرعن جدية المالكي في تطبيق ما صرح به ذات
يوم بأنه «لن يعطي» السلطة لغيره، وإن كانت رسالته حينئذ موجهة كتهديد
لمن يتجرأ على معارضته من السنة وليس الشيعة كما يحدث الآن، مما يُثبت
أن كوكتيل التشبث بالسُلطة والفساد أقوى من الولاء المذهبي. فأيقن
الصدر أن الاقتحام الأول لم يُحدث التأثير المطلوب بل جاء لصالح
منافسيه، فكان الاقتحام الثاني مدعوما هذه المرة بحضور المسؤول العام
لميليشيا «سرايا السلام» لاستعراض قوة السلاح بمباركة الصدر الذي نُشرت
له صورة وهو يقرأ القرآن ومخاطبا المقتحمين «داعياً الله.. لكم أيها
الأحبة بالحفظ والسلامة والنجاح». ليواصل وأتباعه التظاهر بالنزاهة
والتدين والوطنية بينما، كانوا ولايزالون، يتحكمون بأكثر إدارات الدولة
ومؤسساتها فسادا وإرهابا، وما يقومون به الآن من اعتصام هو مجرد
استمرارية لكوميديا سوداء يدفع العراق ثمنها غاليا تحت مٌسميات مُتغيرة
حسب جهة التسويق.
كاتبة من العراق
لماذا تختار الشعوب الغربية مسايرة
السياسة الخارجية لحكوماتها؟
هيفاء زنكنة
صحيح أن روسيا وقعت إتفاقية مع أوكرانيا تتيح لأوكرانيا إعادة فتح
موانئها على البحر الأسود لتصدير أطنان الحبوب العالقة في فيها بسبب
الحرب، وقد يكون هذا الاتفاق على الرغم من إمكانية خرقه، خطوة، نحو
تبني دبلوماسية لتخفيف الاقتتال بين الدولتين، ولكن… هل سيكون لهذا
التقارب، الذي تم عبر وسطاء، وستكون له نتائج اقتصادية إيجابية عالمية،
انعكاسات نفسية ومجتمعية إيجابية، أيضا، على الشعوب الغربية التي تمت
تغذيتها بحملات سياسية وإعلامية مكثفة، ضد روسيا، منذ الغزو الروسي
وتبني حلف الناتو بقيادة أمريكا وبريطانيا لأوكرانيا؟
سبب التساؤل هو أن الآثار المجتمعية، خاصة المبنية على التمييز، أبعد
وأعمق بكثير من التغيرات الآنية المتسارعة الناتجة عن التحشيد الدعائي
السياسي والإعلامي، المؤجج لنار ليست خامدة تماما. إذ لم يقتصر احتضان
قضية الدفاع عن أوكرانيا ضد الغزو الروسي على الحكومات وأجهزة الإعلام
والمنظمات الدولية والمثقفين، سواء كانوا أوكرانيين ( من داخل وخارج
أوكرانيا) أو من المثقفين الروس المعارضين للغزو، بل امتد متجذرا في
حياة الناس اليومية، بأدق تفاصيلها، في البلدان الغربية. وهو ما لم
يحدث عند غزو العراق أو حصار غزة وتحويلها إلى سجن لما يزيد على
المليوني شخص.
فالصحف المحلية المجانية ببريطانيا، مثلا، وهي التي تقتصر عادة على
أخبار سكان « محلة / حي» معين، وتراوح في تغطيتها بين أخبار سرقة دراجة
أو كلب ضائع والإعلانات عن دور العجزة وعمال التظيف وألشكاوى من
الإدارة المحلية، باتت تتصدرها أخبار تأليف قطعة موسيقية مهداة يتم
التبرع بواردها لأوكرانيا أو سفر ناشطين إنكليز، للمرة الرابعة، إلى
أوكرانيا « لايصال تبرعات إلى ضحايا الغزو الروسي». قارنوا ذلك بالحكم
على رافل ظافر، الطبيب الأمريكي من أصل عراقي، بالسجن 22 عاما، في 28
أكتوبر 2005، لأنه أرسل أموالا إلى المحتاجين من ضحايا الحصار في
العراق. وماذا عن خبر فوز فرقة أوكرانية في مسابقة «يوروفيجن» 2022،
وبيعها الكأس الذي حصلت عليه لشراء طائرات بدون طيار لـ «مقاومة»
المحتل الروسي، بينما وُسم كل من قاوم احتلال العراق بالإرهاب ويُسجن
كل فلسطيني يقاوم الاحتلال الإستيطاني متهما بالإرهاب؟
لقد لعبت، ولاتزال، بلا شك، التغطية الإعلامية لغزو أوكرانيا دورا
كبيرا في تشكيل الوعي الجماعي للشعوب الغربية. فهي أكبر وأكثر تعاطفاً
من تغطيتها للبلدان «غير البيضاء» وتنضح بالعنصرية أحيانا، مما وفر
لأوكرانيا فرصة الاستفادة من الامتياز الأبيض في العلاقات الدولية، كما
وفرت لها حليفتها أمريكا، وهي القوة الإمبريالية الأكثر هيمنة في
العالم، الدعم العسكري والمساعدات بكافة أنواعها ومستوياتها. لهذه
العوامل مجتمعة دور أساسي في منظومة تسيير الحياة اليومية الغربية
وتشكيل ما يطلق عليه المفكر اليساري الأمريكي نعوم تشومسكي مصطلح
«صناعة الرضا» إلا أنه من الصعب إلقاء اللوم الكلي عليها في انجذاب
معظم الناس، في الغرب، إلى دعم أوكرانيا وحلفائها بينما لم يحدث الأمر
ذاته في أفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط.
أما الشعوب الُمُستعمِرة فإن ما بقي متجذرا في صُلب تكوينها، هو المنطق العنصري، الأبوي، والتفوق الأبيض المشترك الذي وفر الأسس الأيديولوجية للاستعمار الأوروبي
فهل هي روح المُستعمِر الأوروبي بعنجهيته وعنصريته، الذي كانت الغالبية
العظمى من دول العالم مُستعمَرة من قبله، لا تزال متجذرة عميقا في نفوس
السكان، حتى بعد زوال الامبراطوريات الاستعمارية وتحرر البلدان من
سطوتها ؟ وهل انتهت العلاقات القديمة المبنية على الاستغلال بعد تخلص
الشعوب من قيودها لتحل محلها علاقات جديدة مبنية على الاحترام المتبادل
والمساواة الإنسانية بعيدا عن عنصرية اللون والدين والعرق؟ وماذا عن
أمريكا التي لا يحمل سكانها، وهم خليط من جميع أنحاء العالم، الإرث
الامبراطوري؟ أم أن ما يتحكم بالنفوس، الآن، هو تزاوج المصالح
الأقتصادية مع السياسة الخارجية والتي يتم تقديمها مُعلبة بتسمية
«المساعدات الإنسانية» على مستوى الحكومات و«الإحسان» والتبرعات
الخيرية على مستوى الأفراد، وهو ما يتيح للحكومات تسويق الادعاءات
بأنها إنما تدافع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، والانسانية بشكل عام؟
ان حجم التعاطف الشعبي الغربي اليومي العام الكبير المستمر مع ضحايا
الغزو الروسي بالمقارنة مع مستوى ما شهدناه إزاء محنة الشعب العراقي،
ضحية الغزو الانكلو أمريكي، بعد حصار قاتل دام 13 عاما، ومأساة الشعب
الفلسطيني الذي يعيش احتلال ما يزيد على السبعين عاما، يبين أن تحطم
الشكل الاستعماري المباشر لا يعني بالضرورة وضع حد لتأثيرها سواء على
الشعوب المُستعمَرة أو المُستعمِرة. وتتبدى تأثيرات الامبريالية طويلة
المدى على الشعب المُستعمَر بتنصيب حكومات وفق قالب جاهز يعكس المصالح
الأوروبية، والتغيرات الاقتصادية التي تساعد على ديمومة الديناميكية
الرأسمالية وأعباء الديون، والتغيرات الثقافية المُهّمِشة لدين لصالح
دين آخر.
أما الشعوب الُمُستعمِرة فإن ما بقي متجذرا في صُلب تكوينها، وإن حاول
البعض تحديه، هو المنطق العنصري، الأبوي، والتفوق الأبيض المشترك الذي
وفر الأسس الأيديولوجية للاستعمار الأوروبي. وإذا حدث ونجح ( غير
الأبيض) في تسلق سلم النجاح السياسي، بريطانيا نموذجا، فإن سبب القبول
به هو كونه قيصريا أكثر من قيصر، بإيمانه بأن الثقافة والحكومة
البريطانية هما من أسمى أشكال الحياة والحكم. توارث هذه العنجهية،
لخصته وزيرة خارجية بريطانيا ليز تروس، في خطاب لها عن دعم بريطانيا
المطلق لأوكرانيا بقولها إن بريطانيا مستعدة «لفعل الأشياء بشكل مختلف،
والتفكير بشكل مختلف والعمل بشكل مختلف… لإنجاز الأمور». بذات الوقت
الذي سلط فيه تقرير « تشاتام هاوس» عن الفساد، الضوء على مدى استفادة
السياسيين في المملكة المتحدة – وخاصة المحافظين الحاكمين – من الأموال
الروسية، وكيف بُذلت جهود مضنية لتأخير ثم التقليل من شأن تقريرين
برلمانيين حاسمين عن فضيحة أطلق عليها أسم «لندن غراد».
إزاء توفر هذه المعلومات كلها، المُحّفزة للتفكير الواعي، لماذا تختار
الشعوب الغربية، إذن، مسايرة السياسة الخارجية لحكوماتها؟ هل يكمن
التوضيح في ما كتبه الرئيس الأمريكي أيزنهاور في 20 كانون الثاني 1953
معترفا بصراحة « نحن نعلم… بأن الذي يربطنا بكل الشعوب الحرة، ليس فقط
مثالا شريفا أعلى، ولكن أيضا، وبكل بساطة، الحاجة. فعلى الرغم من كل
قدرتنا المادية، نحتاج في العالم لأسواق لتصريف الفائض من إنتاجنا
الزراعي والصناعي، ونحتاج كذلك لزراعتنا وصناعتنا لمواد أولية ومنتوجات
حيوية توجد في اماكن بعيدة»؟
كاتبة من العراق
هل صلاة الصدر
الموحدة عبادة خالصة فعلا؟
هيفاء زنكنة
اذا كان التساؤل الشكسبيري « أن تكون أو لا تكون هو السؤال» قد أصبح
جزءا من الثقافة الشعبية البريطانية، فإن الشعارات والمفردات «الصدرية»
التي يطلقها (سماحة السيد) مقتدى الصدر، منذ بروزه على سطح الحياة
العراقية بعد غزو وإحتلال البلد عام 2003، باتت جزءا من الثقافة
الشعبية العراقية بجانبيها المبكي والمُضحك. فهو القائد الذي منح مفردة
(حبيبي) نكهة التداول اليومي، وأدخل شعار « شلع قلع» قاموس السياسة،
وأصبحت « مليونية» التظاهرات مرتبطة به، وتغيير اسم الميليشيا/ الكتلة/
التيار يتم حسب مزاجه وحاجة السوق السياسي ـ الطائفي.
من هذا المنطلق، قال الصدر، يوم الجمعة، إن العراق يعيش «ملحمة عبادية
وطنية مليونية إصلاحية». وهو توصيف بحاجة إلى توضيح. بداية، علينا
الاعتراف بأن للصدر مخيلة وقدرة على إطلاق تعابير غير مألوفة سياسيا
واقتصاديا ودينيا، في مخاطبته الحشود من أتباعه. ثانيا، أن هناك من
يترجم ويُنظم ما يريده بشكل تفوق على قدرة الحزب الشيوعي التنظيمية
التقليدية. وقد تبدت هذه القدرة، يوم الجمعة، عند إقامة ما أطلق عليه
مقتدى اسم «صلاة الجمعة الموحدة» إحتفاء بذكرى إقامة والده الراحل صلاة
الجمعة في مسجد الكوفة أثناء حكم صدام حسين. أمر مقتدى بجمع أتباعه
لأداء الصلاة، في المدينة المسماة باسمه، أي مدينة الصدر، الواقعة شرق
بغداد. سبب الدعوة الظاهري، كما جاء في تغريدة له على تويتر لأن صلاة
الجمعة «عبادة خالصة لله» وأن «صوت الجمعة أعلى من أي احتجاج آخر»
ليبين أنه يحتج ضد السيرورة السياسية للبرلمان الحالي، متعاميا عن
حقيقة أنه، بواسطة الميليشيا التابعة له، قد ساهم في إجهاض احتجاجات
المتظاهرين في تشرين الأول / أكتوبر 2019، حالما أدرك أنها تشكل خطوة
للتغيير الحقيقي بالبلد، بعد أن قدمت الانتفاضة مئات الضحايا وعشرات
الآلاف من الجرحى والمُقعدين.
وكما أمر مقتدى الصدر أتباعه من أعضاء البرلمان العراقي، قبل أسابيع،
وعددهم 73 بالانسحاب الجماعي من البرلمان فلبوا النداء، لبى الأتباع
أوامر السيد للتجمع وأداء الصلاة. مُدّعيا، مثل بقية الساسة على اختلاف
أعراقهم وطوائفهم، بأن ما يقوم به هو باسم الشعب « والخيار للشعب» وأن
دوره يقتصر على دعم الشعب « إن أراد الشعب الوقوف من أجل مناصرة
الإصلاح».
فقام الشعب المعني، ملبيا النداء، وتوجه يوم الجمعة، إلى شارع حددته
لجنة أوصى الصدر بتشكيلها للإشراف على تحشيد الأتباع وتنفيذ الأوامر.
أشرفت اللجنة بالتعاون مع فروع مكتب الصدر بمختلف المحافظات على ترتيب
حافلات لنقل الأتباع إلى بغداد، وتوفير احتياجاتهم، وشراء وتفصيل
وتوزيع الأكفان البيضاء ليرتدونها جميعا، مثل الصدر، أثناء الصلاة،
دلالة على استعدادهم للاستشهاد. وشملت التحضيرات «تكثيف الاجتماعات مع
القيادات الأمنية… لاستكمال جميع الاستعدادات مع بدء توافد المصلين وسط
إجراءات أمنية مشددة ودعم لوجستي ومعنوي وشعبي».
إبقاء العراق مقادا بمنظومة طائفية تأتمر بتقلبات شخص يساعد، في الواقع، من يدّعي محاربتهم، على تلهية الناس بمشاغل مختلقة، تعيق القدرة على التفكير بما هو أبعد من التحشيد الغرائزي وتأجيج مشاعر الخوف والانتقام
وكأن القوم سيتوجهون لخوض معركة تحرير شرسة، وليس لأداء الصلاة
والاستماع الى خطيب كما يفعل المسلمون في أرجاء المعمورة كل يوم جمعة،
في كل فصول العام، بلا أكفان أو إجراءات أمنية مشددة. ولم ينس المنظمون
تكرار مفردة السيد المفضلة في وصف كل تظاهرة يقودها أو يدعو اليها
بأنها «مليونية» وهو رقم حاول النائب باسم الخشان تفنيده عن طريق ذكر
قياسات شارع الفلاح الذي تمت فيه الصلاة، متوصلا بالنتيجة إلى استحالة
جمع هذا العدد الهائل من الناس في مكان واحد. وأن العدد الذي يدًّعيه
الصدريون يساوي أضعاف العدد الحقيقي.
ما تجدر الإشارة اليه أن تكرار أجهزة الأعلام لأي خطاب سياسي أو حدث
بدون تمحيص، يجعله حقيقة واقعة، ويترسخ في الأذهان بصيغته الأولى حتى
لو تم تكذيبه فيما بعد، فكيف إذا كان التكرار والاستنساخ مستمرا على
مدى أسابيع من قبل قنوات تستهدف جمهورا معينا، يحمل عقيدة جاهزة بل
وتأسيس قناة تلفزيونية خاصة للتحشيد للصلاة ومن ثم بثها بشكل حي؟
بهذه الطريقة، تُصبح الحقيقة غير مهمة إزاء خلق واقع يسود فيه التلفيق
السياسي – الديني، ويرتبط بصعود الشعبوية الطائفية في مجتمع، مهيأ
لاستقبال ما يُقدم اليه، حيث يتم إيهامه بأنه مُهدد بالأخطار، فيتجاذبه
الخوف من « الآخر» ليتشبث بمن يوفر له الحماية الجسدية، مُغّلفة بطقوس
«الجماعة» والعصمة من المسؤولية، والتدريب المسلح الدائم إستعدادا
للدفاع عن النفس، بالاضافة إلى الدخل المادي.
حيث يُشكل توفير الدخل، سواء عن طريق التوظيف بلا كفاءة أو ُمنح
الدراسة في الحوزة أو توزيع النقود بشكل مباشر وتعزيز الانطباع بقوة
التيار الشيعي الصدري، جانبا رئيسيا في تنامي شعبوية مقتدى الصدر، خاصة
مع ازدياد نسبة الفقر وتدهور الخدمات الأساسية. ولا يهتم أتباع الصدر
بمصدر ثروته سواء كانت عن طريق السيطرة على الوزارات والمناصب، وفساد
العقود التجارية وتهريب النفط والسرقة والنقد مقابل الخدمات – بما في
ذلك الحماية المسلحة للتجار والشركات، أو عن طريق إيران.
تحت هذه الظروف، تصبح تعبيرات القائد/ الرمز اللغوية المعبرة، عن قدرته
العقلية المحدودة، ميّزة ذات فائدة لتسهيل التلاعب به من جهة وتسويقه
شعبويا. فالشعبوية، مرغوب بها لتسهيل وتمرير سياسات وأجندات خارجية
تتقاطع مع مصالح عدد من الساسة المحليين، لا ضرر إطلاقا من إلقائهم
الخطب عن مقاومة الاحتلال. وهنا تكمن أحد أوجه قوة المحتل في تأسيسه
منظومة تتشابك فيها المصلحة المشتركة مع قوى محلية لخلق هويات مفتعلة
ومزورة، للتغطية على هيمنتها، خاصة مع ضعف أو غياب البدائل الوطنية.
ليس مهما، إذن، غياب البرنامج السياسي والاقتصادي لما تسمى « الكتلة/
التيار/ الحركة الصدرية». المهم هو ترويج الصلاة كمليونية إستعراضا
للعضلات ضد منافسي مقتدى في «البيت الشيعي». والأكثر أهمية من ذلك،
إبقاء العراق مقادا بمنظومة طائفية تأتمر بتقلبات شخص يساعد، في
الواقع، من يدّعي محاربتهم، على تلهية الناس بمشاغل مختلقة، تعيق
القدرة على التفكير بما هو أبعد من التحشيد الغرائزي وتأجيج مشاعر
الخوف والانتقام، ما لم يعمل الجميع من أجل دولة مواطنة في عراق يتسع
للجميع بلا إستثناء.
كاتبة من العراق
عاجل… نشرات
الأخبار مضرة بالصحة!
هيفاء زنكنة
« أنقذ رجال المطافئ قطة تسلقت شجرة عالية ولم تتمكن من النزول لساعات»
صاحبت الخبر لقطات أظهرت ثلاثة من رجال المطافئ المبتسمين وهم يحيطون
بصاحبة القطة محتضنة قطتها بحب. كان هذا آخر خبر في نشرة أخبار عالمية
غربية يراقبها ملايين الناس، قدمته الصحافية متمنية للمشاهدين أمسية
سعيدة وهي تبتسم. الملاحظ، أن معظم مقدمي نشرات الأخبار، في العالم،
باتوا، في العقد الأخير على الأقل، يُنهون النشرات بخبر مُفرح ومٌسل.
قد يكون الخبر عن إنقاذ حيوان أو العثور على طفل ضائع أو نجاح عجوز
مٌقعد بالسير مائة خطوة لجمع التبرعات لهدف إنساني. وفي نشرة للأخبار
في القناة الوطنية التونسية الأولى، مثلا، وفي موسم إعلان نتائج
امتحانات البكالوريا، كان خبر نجاح أم عاودت الدراسة مع بناتها هو لحظة
الختام. وهناك ما يشير إلى استنساخ النسق نفسه في قنوات عربية أخرى،
مما يثير التساؤل عن الأسباب التي تدفع القنوات التلفزيونية، واجهزة
الأعلام، عموما، إلى تكريس وقت ثمين، قد يُكلف عشرات الآلاف من
الدولارات، ومساحة إعلانية مُكلفة في الصحف العالمية، لأخبار تبدو،
أحيانا، لفرط هامشيتها، وعدم تماشيها مع بقية الأخبار الرئيسية المؤثرة
في العالم، بلا معنى؟
تشير أحدث الأبحاث العلمية إلى أن الأخبار يمكن أن تؤثر بمتابعيها
الدائمين بطرق مختلفة، بدءا من التماهي مع ذات الأخطار إلى التسلل إلى
محتوى الأحلام إلى إحتمال الإصابة بنوبة قلبية. ففي دراسة أجراها علماء
في جامعة كاليفورنيا ونشرتها البي بي سي، تبين أن متابعة الأخبار
السيئة، وتكرار بث الصور واللقطات المأساوية كما في الزلازل والفيضانات
والتفجيرات وضحاياها بأجسادهم الدامية والشوارع الملطخة بالدماء،
يُعّرض أولئك الذين لم يروا الانفجار بأنفسهم، لكنهم استهلكوا ست ساعات
أو أكثر من التغطية الإخبارية يوميًا في الأسبوع الذي تلاه، لضغوط
نفسية شديدة تؤثر على صحتهم العقلية.
كما تُثبت الدراسة أن التغطية الإخبارية هي أكثر بكثير من مجرد مصدر
جيد للحقائق. أنها عامل أساسي في تشكيل وعينا ومواقفنا تجاه الواقع. إذ
أن بإمكانها، من خلال تسللها إلى العقل الباطن، التدخل في تفاصيل
الحياة بشكل مذهل، يمكن أن يؤدي إلى سوء تقدير بعض المخاطر، وتشكيل
وجهات النظر بشأن الدول الأجنبية، وربما التأثير على صحة الاقتصاد
بأكمله، مما يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بحالات القلق والاكتئاب.
وتؤكد الدراسة، وهي واحدة من عدة دراسات نُشرت في السنوات الأخيرة، أن
هناك ما يدل على أن التداعيات العاطفية للتغطية الإخبارية يمكن أن تؤثر
حتى على الصحة الجسدية، مما يزيد من فرص الإصابة بنوبة قلبية أو
الإصابة بمشاكل صحية على المدى البعيد. ترتبط هذه التأثيرات، بطبيعة
الحال، بعدد الساعات المكرسة أسبوعيا لمتابعة الأخبار ونوعيتها.
برز نهج جديد في في عالم الإعلام، أطلق عليه مصطلح «الصحافة البناءة» يُعنى بتقديم الأخبار الإيجابية ذات المصداقية مع التركيز على التقدم الإنساني وتوفير الإمكانيات والحلول
وإذا كانت الأخبار السيئة هي المصدر الرئيسي للتأثيرات المؤذية فأنه
لايمكن تبرئة المتابع من المسؤولية إزاء مواصلة متابعتها، بلهفة كبيرة.
فمن الحقائق المعروفة أن معظم الناس يولون إهتماما أكبر للأخبار
المأساوية أو الدرامية من الأحداث العادية التي قد تثير الضجر، وكما
قال كاتب الخيال العلمي آرثر سي كلارك «إن صحف المدينة الفاضلة ستكون
مملة بشكل رهيب».
وهو أحد الأسباب التي تدفع أجهزة الإعلام، المتنافسة على جذب
المشاهدين، والتي تعتمد على عائدات الإعلانات، ومذيعو أخبارها من متلقي
أعلى الرواتب، على زيادة الإحساس بالدراما والتوتر لجذب المشاهدين
وإبقائهم ملتصقين بمقاعدهم أمام الشاشة حتى عند الإبلاغ عن حوادث صادمة
بالفعل. حيث غالبا ما تتم سيرورة بناء الترقب لما هو آت من تفاصيل قد
تكون أكثر دموية عن طريق إضافة شريط أحمر أو كلمة «عاجل» أو «تفاصيل
جديدة» كما تفعل القنوات الإخبارية العربية.
إزاء هذه التأثيرات السلبية جراء متابعة الأخبار المشوهة لتصور الناس
للواقع، وليس بالضرورة إلى الأفضل، برز نهج جديد في في عالم الإعلام،
أطلق عليه مصطلح «الصحافة البناءة» يُعنى بتقديم الأخبار الإيجابية ذات
المصداقية مع التركيز على التقدم الإنساني وتوفير الإمكانيات والحلول.
فبادرت بعض المؤسسات الإعلامية الكبيرة، إلى تكريس صفحات للأخبار
الجيدة الايجابية، كما تم تأسيس صحف ومجلات ومواقع ألكترونية، في أرجاء
العالم، خاصة بهذا النوع من الأخبار. مثالها «صحيفة الأخبار السعيدة»
الفصلية المليئة بالقصص المتفائلة من جميع أنحاء العالم، و « بوزتيف
نيوز» أي الأخبار الإيجابية، التي أسستها الصحافية شونا كريكيت بوروز
عام 1993 كصحيفة تهدف إلى تغيير كيفية إختيار الأخبار ونشرها. حققت
الصحيفة نجاحا كبيرا وسرعان ما تطورت إلى « أول مؤسسة إعلامية في
العالم مكرسة لتقديم تقارير عالية الجودة ومستقلة حول ما يجري بشكل
صحيح حين تمتلئ معظم وسائل الإعلام بالحزن والكآبة «.
هل يناقض نجاح مواقع وتداول الأخبار الإيجابية ما توصلت إليه دراسة
جامعة كاليفورنيا وغيرها حول تأثير الأخبار السيئة على متابعيها
واستغلال أجهزة الإعلام لعامل الشد الدرامي بالكوارث والفواجع، كطريقة
لاغواء اكبر عدد ممكن من المشاهدين يساعدها على تحقيق مردود مالي أكبر،
بعيدا عن إيصال الاخبار كما هي؟ لا يوجد ما يدل على التناقض، إذ تمكنت
أجهزة الإعلام الكبيرة من إحتواء نتائج البحوث الدالة على أن الأخبار
المأساوية مضرة بالصحة وأن الأخبار الجيدة توفر طريقًا إيجابيًا للمضي
قدمًا في الحياة لأنها تجعل الناس سعداء مما يشيع التفاؤل وبالتالي
تحسن الصحة العقلية والجسدية، احتوتها عن طريق تضمين فقرة في نهاية
نشرات الأخبار أو صفحة في جريدة لقصص إنسانية إيجابية تتعلق بانجازات
فردية أو جماعية، مهما كانت صغيرة، كإنقاذ قطة أو النجاح في زراعة
طماطم على سطح مبنى، أو أي شيء مماثل لمنح المتابعين الثقة والأمل في
الجنس البشري، بعيدا عن «عاجل» الأخبار الدموية.
كاتبة من العراق
إعترف وإلا…
ثقافة التعذيب في العراق
هيفاء زنكنة
يُصر المسؤولون العراقيون في لقاءاتهم الدورية مع ممثلي المنظمات
الحقوقية الدولية على إنكار ممارسة التعذيب في أماكن الاحتجاز. وحالما
يواجهون بشهادات ووثائق تثبت العكس يلجأون إلى القول بأنها حالات
منعزلة وليست ممارسة منهجية أو واسعة النطاق. وهو ذات التبرير الذي
طالما قدمته إدارة الاحتلال الأمريكي حين كانت قواتها تمارس الانتهاكات
والتعذيب ضد المعتقلين العراقيين، أو حتى القتل، ملقية اللوم على « بضع
تفاحات فاسدة». ولا تختلف صيغ الانكار من وزارة إلى أخرى، ومثالها
النفي المطلق لحدوث حالات تعذيب في السجون كما فعل المتحدث باسم وزارة
العدل، قائلا إن «السجون التابعة لوزارة العدل تخلو من التعذيب» حين
جوبه بتقرير للأمم المتحدة أوضح أن أساليب التعذيب تشمل «الضرب المبرح،
والصعق بالكهرباء، والوضعيات المجهدة، والخنق» بالإضافة إلى العنف
الجنسي وما وصفه بعض المحتجزين، خجلا، بأنه معاملة «لا يستطيعون التحدث
عنها».
ولنفترض صحة التصريحات الحكومية العراقية عن الحالات الفردية المنعزلة
لبعض الجلادين المصابين بعُقد سادية، وأن التعذيب هو الاستثناء، فلِم
لَم يتم تنظيف السلة من التفاح الفاسد في السنوات العشرين الأخيرة في
ظل النظام الحالي؟ ولِم تواصل المنظمات الدولية والمحلية إصدار التقرير
تلو التقرير موِثِقة حالات تعذيب مرعبة، بلا توقف، على مر السنين، من
بينها سبعة تقارير أصدرها مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم
المتحدة لمساعدة العراق ( يونامي)؟
يكمن الجواب البسيط لمثل هذه التساؤلات في أن ممارسة التعذيب في العراق
ثقافة شائعة ومبررة ومستساغة لدى القوات الأمنية وأجهزة الشرطة
والمليشيات، بكافة مستوياتها، وبكل مواقع الاحتجاز والسجون، يعززها
مناخ الإفلات من العقاب، والايمان بأن التعذيب هو الوسيلة الأفضل
والأسرع لاستخلاص الاعتراف، أيا كانت طبيعته. كما أن الإعدام هو الحل
الأفضل للتخلص من المتهمين الذين، غالبا، ما يعترفون بارتكاب كل
الجرائم المطلوب منهم الاعتراف بها، جراء التعذيب حتى يقال أن متهما
اعترف بتفجير نفسه مرتين!
وزاد التعذيب إنتشارا دور المحتل الأنكلو أمريكي في إبداع أساليب
معاملة مبتكرة بحق المعتقلين، رجالا ونساء، كما شاهدنا في أبو غريب
والمعسكرات الأمريكية والبريطانية. وحين زكمت الأنوف رائحة الانتهاكات
والاعتداءات الفاضحة قررت إدارة الاحتلال غسل يديها من دماء المعتقلين
فقامت بتسليمهم إلى جلادين محليين متواطئين معها، مانحة الضوء الأخضر
باستمرارية الاستخدام الممنهج للتعذيب والتغاضي عنه. فلم يعد السؤال
بصدد معاملة المعتقلين جراء كثرة الانتهاكات هو هل هناك تعذيب أم لا بل
أصبح السؤال عن مدى منهجية التعذيب وشموليته وأنواعه، حيث أصبح التعذيب
حقيقة واقعة لا تقبل الانكار مهما كانت تبريرات الساسة العراقيين.
حسب بيان صادر عن وزارة العدل، فإن السلطات تحتجز ما يقرب من 50 ألف شخص للاشتباه بصلاتهم بالإرهاب، وحُكم على أكثر من نصفهم بالإعدام
من مفارقات الوضع المأساوي أن العراق وقع على اتفاقية الأمم المتحدة
لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو
اللاإنسانية أو المهينة (UNCAT)
في عام 2011. من هذا المنطلق، بحثت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم
المتحدة، في 26 نيسان/ أبريل 2022، التقرير الدوري الثاني للعراق،
والذي تشرح فيه السلطات العراقية الخطوات المتخذة لتنفيذ اتفاقية الأمم
المتحدة لمناهضة التعذيب. أثناء الحوار التفاعلي مع اللجنة، وكالعادة،
أنكر ممثلو العراق وجود التعذيب على الرغم من تلقي اللجنة «تقارير تشير
إلى أن الأشخاص المحتجزين، بما في ذلك في المنشآت الخاضعة لسلطة القوات
الأمنية والمرافق التي يُقال إنها غير معروفة للمحتجزين، يتعرضون
للتعذيب أو سوء المعاملة «.
كما فنّدت اللجنة عديد الادعاءات الرسمية ومن بينها إدعاء السلطات أن
«الأحكام الصادرة عن المحاكم العراقية لا تعتمد على الاعترافات وحدها
بل على مجموعة شاملة من الأدلة» حيث وجد أعضاء اللجنة أن الاستجوابات
التي تجريها قوات الأمن، في الممارسة العملية، تهدف بشكل عام إلى
انتزاع الاعترافات، مما يساهم في إجراءات قسرية. وأن الآليات القائمة
لتلقي شكاوى التعذيب والتحقيق فيها «لا تؤدي عملياً إلى مساءلة جادة
لمرتكبي التعذيب».
بعد مناقشة الإطار القانوني العراقي لمكافحة التعذيب وعدم مراعاة
الضمانات القانونية، أعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم إزاء مزاعم
التعذيب أو سوء المعاملة على نطاق واسع وعدم المساءلة عن مثل هذه
الأفعال. كما تم أيضًا التطرق إلى معاملة السجناء المحكوم عليهم
بالإعدام وكذلك الانتهاكات التي حدثت في سياق احتجاجات 2019-2020.
فتوصلت اللجنة إلى حصيلة مفادها أن العراق لم يحرز أي تقدم، في هذا
المجال، منذ آخر مراجعة في عام 2015.
استوقفت اللجنة، كما في كل التقارير الدولية الأخرى، سرعة إصدار أحكام
الأعدام وكثرتها وتنفيذها. فعلى الرغم من حقيقة أن نظام العدالة
الجنائية معروف بالاستخدام الواسع النطاق للتعذيب والإكراه على
الاعترافات، وعلى الرغم من الانتهاكات الجسيمة للإجراءات القانونية
الواجبة، نفذت السلطات العديد من عمليات الإعدام.
وحسب بيان صادر عن وزارة العدل في سبتمبر / أيلول، فإن السلطات تحتجز
ما يقرب من 50 ألف شخص للاشتباه بصلاتهم بالإرهاب، وحُكم على أكثر من
نصفهم بالإعدام.
وهو رقم مذهل بكافة المقاييس، مما يضع العراق بين الدول الست الأولى في
العالم المسؤولة عن 85 بالمئة من تنفيذ أحكام الإعدام بمتهمين، غالبا،
ما يعترفون بالجرائم نتيجة تعرضهم للتعذيب، مما يعني أن السلطات نفسها
تنتهك القانون بحجة محاربة الإرهاب واستتاب الأمن. وهو ما يدحضه الواقع
الأمني العراقي، إذ لم تؤد ممارسة التعذيب وتنفيذ الإعدام إلى استتاب
الأمن أو ما تدّعيه السلطات من وضع حد للإرهاب، خاصة مع تفشي انتهاكات
وجرائم الميليشيات الداعمة لأحزاب فاعلة ضمن السلطة. وستبقى نافذة
الأمل مغلقة أمام المعتقلين وذويهم، مهما كانت التهم الموجهة إليهم، ما
لم يتم تطبيق القوانين والالتزام بها بالإضافة إلى العمل الجاد على
تغيير القبول المجتمعي لثقافة التعذيب. وكما يُذّكرنا رئيس جنوب
أفريقيا الرحل نلسون مانديلا أن بالإمكان منع العنف لأنه خلافا لافتراض
العديد من الناس الذين يعيشون مع العنف يومًا بعد يوم ليس جزءا من
الحالة الإنسانية. وبالإمكان قلب الثقافات العنيفة… وبإمكان الحكومات
والمجتمعات والأفراد إحداث التغيير، إذا كنت النية صادقة.
كاتبة من العراق
قراءة في خطاب
سماحة السيد القائد
هيفاء زنكنة
هل صحيح ما يقال إنه لم يعد هناك
ما يثير الدهشة في « العراق الجديد»؟
الأسابيع الأخيرة تُثبت بما لايقبل الشك أن بإمكان ساسة العراق دحض حتى
ما قاله أب الحركة السوريالية أندريه بريتون حين وصف خيبته بالعالم،
ذات مرة، قائلا بأنه لم يعد هناك ما يثير الدهشة. ففي فترة قياسية أضيف
إلى قائمة المصطلحات المستحدثة في العراق الجديد مثل «العملية
السياسية» و»البيت الشيعي» و»المكونات» و»أذرع إيران»، مصطلح
«الإطاريون» و»النواب البدلاء». بدأ وسم العراق بمصطلح «النواب
البدلاء» بعد إلقاء خطاب يترك المرء بين منزلتي الضحك والبكاء، وعدم
التصديق إلى حد ما، حيث أمر مقتدى الصدر (سماحة السيد القائد أعزه
الله)، أتباعه من أعضاء البرلمان العراقي، بالاستقالة الجماعية،
مُستَّهلا خطابه بأبيات « شعرية» من نظمه قائلا: « أنا ابن النجف
والحنانة/ أنا ابن محمد الصدر الذي رفض الظــلم والمهانة/ أنا الذي
واجه الاحتـلال فأذلهُ وأهـانه/ أنا للإصلاح إستل سيـفه وأظهر أسنانه».
وفعلا، لبى النواب البالغ عددهم 73 نائبا، النداء بلا تردد هاتفين «
نعم… نعم يا سيد». متجاهلين في فورة حماسهم الشعب الذي طالما كرروا أنه
انتخبهم، وليس (القائد أعزه الله).
هل بإمكان نواب انتخبهم الشعب (مهما كانت نسبة المصَّوتين) بانتخابات وُصفت بالنزيهة، الانسحاب جماعيا أو حتى فرديا بناء على أمر أصدره قائد الحزب؟
ليست هذه هي المرة الأولى أو
الثانية أو الثالثة (أو … لنتوقف هنا فالقائمة طويلة) التي ينسحب فيها
الصدر من العملية السياسية، التي أسسها الاحتلال الأنكلو أمريكي بعد
غزو العراق، منذ عشرين عاما تقريبا. إلا أن سبب إثارة الدهشة، هذه
المرة، على الرغم من تعّود العراقيين على صعود وهبوط مزاج السيد القائد
وكثرة انسحابه وعودته وإنكفائه إما في العراق أو إيران أو لبنان، بحجج
تراوح بين إكمال الدراسة، حينا، وكتابة الشعر حينا آخر، كلما واجه أزمة
لا يعرف كيف يتعامل معها، ما يثير الاستغراب، هذه المرة، قراره ألا
ينسحب لوحده، إلى شرنقته، بل أن يأخذ معه 73 من نواب يُشكلون كتلة
فائزة في الانتخابات. انتخابات وُصفت محليا وعالميا، بأنها الأكثر
سلاسة ونزاهة، وأن شارك فيها 20 بالمئة فقط من المصّوتين، وكلّفت
العراقيين ثروة كانوا بأمس الحاجة لها للتزود بأساسيات الحياة. وكما
كان متوقعا، عززت الانتخابات بقاء معظم الوجوه، تقريبا، التي اعتلت
السلطة في عقدي الغزو والاحتلال. ذات الوجوه المهيمنة بقوة الدعم
الخارجي والفساد المالي والإداري الكبير، بضمنهم أتباع الكتلة الصدرية
بلا استثناء. وكما كان متوقعا باتت نتائج الانتخابات أداة فعالة لصالح
تمديد عمر منظومة الفساد بهامش تغيير بسيط لإعادة توزيع أدوارها،
انسجاما مع التوازنات الإقليمية. ولم يُغّير الخلاف الحالي حول منصبي
رئيس الوزراء والجمهورية، بعد مرور ثمانية أشهر على انتهاء التصويت
وإعلان النتائج، من جوهر الهيكلة الأصلية. وأقصى ما حدث هو تغيير أسماء
بعض الأحزاب والتحالفات، فتصاعدت على سطح المياه الراكدة فقاعات
بمسميات على غرار الإطار التنسيقي، ومن هنا منشأ مصطلح إطاريون (قيادة
ميليشيات الحشد الشعبي الموالية لإيران مع أحزاب وتكتلات مما يسمى
البيت الشيعي) مقابل الكتلة الصدرية التي يتزعمها مقتدى الصدر وراثة عن
أبيه الراحل، وبشكل غير مباشر عن « المهدي المنتظر»، ليسود النزاع
المسرحي في أستوديوهات التلفزيون، كبديل للبرلمان، حول بأي شكل سيتم
التهام ثروة العراق، وبأي واسطة؟ هل هي «الأغلبية» أم «التوافقية»؟
هذا الحال المضحك المبكي، ومع تدوير أسطوانة الانسحاب الجماعي إعلاميا،
ومن ثم صعود «نواب بدلاء»، يستدعي سؤالا إفتراضيا، قد لا يقل عبثية عن
إصدار الصدر أمر الانسحاب وكيفيته، وهو: هل بإمكان نواب انتخبهم الشعب
(مهما كانت نسبة المصَّوتين) بانتخابات وُصفت بالنزيهة، الانسحاب
جماعيا أو حتى فرديا بناء على أمر أصدره قائد الحزب؟ وكيف يُقارن هذا
الوضع مع انسحاب/ استقالة نواب منتخبين في بلدان أخرى؟ لو نظرنا إلى
الوضع ببريطانيا لوجدنا أنه، تاريخيا، لم يُسمح أبدًا بالاستقالة من
مجلس العموم، وأن سُمح لخمسة نواب بالاستقالة في أوائل القرن السابع
عشر بسبب اعتلال صحتهم. وفي 2 آذار/ مارس 1624، قام البرلمان بإضفاء
الطابع الرسمي على الحظر من خلال إصدار قرار مفاده « لا يمكن للنائب،
بعد أن يتم اختياره على النحو الواجب، التنازل عنه». إلا أن الاستقالة
ممكنة لأسباب كالمرض والموت والتسبب بفضيحة أو اتخاذ موقف سياسي يتناقض
تماما مع الموقف الحكومي. كما حدث عندما استقال روبن كوك، وزير خارجية
المملكة المتحدة الأسبق، استنكارا لوقوف الحكومة برئاسة توني بلير
بجانب أمريكا في غزوها العراق. ويترتب على الاستقالة الفردية إيجاد
البديل عبر انتخابات في المنطقة التي يُمثلها النائب المستقيل.
هناك، أيضا، أمثلة لاستقالة مجموعة نواب من أحزابهم بسبب خلافات حول
سياسات أحزابهم. ففي 18 فبراير 2019، استقال سبعة نواب من حزب العمال،
وشكّلوا جمعية سياسية، إلا أنهم واصلوا عملهم كنواب. مما دفع الصحافة
إلى مطالبة النواب المغادرين أن يستقيلوا أيضًا من مقاعدهم. بل وجادل
البعض بضرورة الدعوة إلى انتخابات عامة كوسيلة لتصحيح الانحراف، وإلا
أدت إلى تقويض المبادئ الديمقراطية الأساسية، لأن التغييرات لم تتم
المصادقة عليها من قبل الناخبين في صندوق الاقتراع. وتشير أمثلة أخرى
من عديد البلدان، حول العالم، أنه في حال استقالة جميع أعضاء المعارضة
في البرلمان، فإن الحل الوحيد هو إجراء انتخابات جديدة. ويكاد لا يوجد
نموذج يطابق ما يجري في العراق إذ لم ترد مفردة «استقالة» بل انسحاب،
مما يبقي مجال العودة مفتوحا، وإن هدد الصدر بالانسحاب من العملية
السياسية كي لا يشترك « مع الفاسدين بأي صورة من الصور لا في الدنيا
ولا في الآخرة». وكأنه كان مشتركا مع الأنقياء الطاهرين منذ مأسسة
العملية السياسية وحتى اليوم، متسائلا لدعم دعوته إلى إنهاء الفساد
والتوافق « الى متى يبقى البعير على التل». وهي جملة يرددها الأطفال،
بمستوى الصفوف الأولى في المدرسة الابتدائية، في «القراءة الخلدونية»،
لتعلم قراءة الحروف. وتأخذنا الجملة المقتبسة إلى تساؤل تثيره خطابات
الصدر وسلوكه، عما إذا كان قائد أكبر كتلة سياسية في العراق لايزال،
عقليا ونفسيا، بمستوى تلميذ بمدرسة إبتدائية أم أن من يأمرهم ويخاطبهم
ويلبون أوامره هم الذين لا يزالون هناك؟
كاتبة من العراق
عقدة وزيرة الداخلية
البريطانية وشيطنة طالبي اللجوء
هيفاء زنكنة
للمرة الأولى، منذ فترة طويلة، احتل بلدان عربيان حيزا في النقاشات
الدائرة بحرارة في مجلس العموم البريطاني ومجلس اللوردات.
جاء ذكر البلدين أثناء إدلاء وزيرة الداخلية بريتي باتيل في 15 حزيران
/ يونيو ببيان حول ما أسمته «شراكة الحكومة الرائدة عالميًا في مجال
الهجرة والتنمية الاقتصادية مع رواندا». بعيدا عن العنوان «الحضاري»،
تهدف هذه «الشراكة» إلى وضع حل لمنح حق اللجوء لمن تصفهم باللاجئين غير
القانونيين، وإرسالهم بدلا من ذلك إلى رواندا. وقد تكرر ذكر العراق
وسوريا باعتبارهما من البلدان المُصّدرة للاجئين، فقط لا غير. كالعادة،
بدون التطرق إلى الأسباب ومن هو المسؤول عن المأساة.
تبرر باتيل إصرارها على تنفيذ خطة الترحيل، على الرغم من كل الاعتراضات
القانونية والإنسانية، بأنها إنما تُنفذ بذلك ما «صِّوت له الشعب
البريطاني مرارًا وتكرارًا» وأن ما تقوم به هو الاصغاء لما يريده
الشعب. وادعاء الاصغاء للشعب، خدعة قديمة، معروفة إلى حد الابتذال، إلا
أنها لا تزال سارية المفعول، يمارسها عديد السياسيين حين يواجهون
معارضة قوية لقراراتهم. وهو التبرير الذي تُفضل باتيل التعكز عليه،
خاصة بعد صدور قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ،
بإيقاف مغادرة الطائرة الأولى المغادرة إلى رواندا وعلى متنها عدد من
طالبي اللجوء، ومنع عملية ترحيلهم. من بين الذين كانوا على وشك الترحيل
إلى رواندا سوري وعراقي، لم يُثر وجودهما أكثر من ذكر عابر.
أثار الحكم غضب باتيل فوقفت في مجلس العموم لإلقاء بيانها المكتظ
بالتضليل والعنصرية. وكما يقول عالم الاجتماع الأمريكي دي شان ستوكس
«عندما تتعامل مع محتالين وكذابين، أصغي إلى ما لا يقولونه أكثر مما
تصغي إلى ما يقولونه». فما الذي لم تقله باتيل وهي تحاول إقناع
البرلمان والشعب البريطاني، فضلا عن العالم، بصحة موقفها تجاه واحدة من
أكثر المشاكل الإنسانية حاجة للتعامل بشكل إنساني وأخلاقي؟ وما هو الرد
على تسويغها بأنها إنما تحاول إنقاذ الناس من الغرق والتهريب وأن طالبي
اللجوء «يجعلوننا أقل أمانا كأمة» ويكلفون دافعي الضرائب البريطانيين
فاتورة مصاريف كبيرة؟
معظم طالبي اللجوء هم من شعوب، ذاقت الأمرين من الدول الاستعمارية، المُغذية للحروب والصراعات، والعمل بجد على تنصيب حكام محليين، ينفذون سياستها وربط البلدان بعقود وقروض بأكثر الأساليب «الديمقراطية» قمعية
إن ما لم تذكره باتيل هو أن معظم طالبي اللجوء هم من شعوب، ذاقت
الأمرين من الدول الاستعمارية، المُغذية للحروب والصراعات، والعمل بجد
على تنصيب حكام محليين، ينفذون سياستها وربط البلدان بعقود وقروض بأكثر
الأساليب «الديمقراطية» قمعية، وبكافة الطرق من الغزو والاحتلال إلى
تغيير الأنظمة. مما يجعل سبب مغادرة البلدان الأصلية ليس بالضرورة
اقتصاديا فقط، كما تقول باتيل، بل وسيلة يخاطر فيها اللاجئون بحياتهم
هربا من القمع والاضطهاد، السياسي المدعوم غربيا، حفاظا على حياتهم.
في تفنيد ادعاءاتها، لخّص ستيوارت ماكدونالد شادو، المتحدث الرسمي
للحزب الوطني الأسكتلندي، موقف عديد النواب واصفا الخطوة، بمفردات
غاضبة، بأنها غير عملية وغير قانونية وغير أخلاقية. لن توقف المهربين
بل ستلحق ضررًا جسيمًا بالضحايا. وبحساب بسيط سيتضح أن الأموال التي
ستدفع لحكومة رواندا هي إهدار طائش لأموال دافعي الضرائب. وتُعد الخطوة
انتهاكا لشرعية اتفاقية اللاجئين الموقعة مع المفوضية السامية للأمم
المتحدة لشؤون اللاجئين بالإضافة إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق
الإنسان، التي ساعدت بريطانيا في صياغتها والمصادقة عليها منذ عقود.
من ناحية رواندا، المعروف أنها غير مهيأة للتعامل مع اللاجئين بشكل
عادل، كما صرح مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين. إذ لديها
ضابط أهلية واحد فقط يقوم بالتحضير للحالات، وهناك نقص في المترجمين
الفوريين والمستشارين القانونيين. ومن المفارقات أن هناك حاليا 50
روانديا تقدموا بطلب اللجوء إلى بريطانيا جراء تعرضهم للقمع السياسي،
وحقيقة أن السلطات أطلقت النار على 12 لاجئًا في عام 2018 للاحتجاج على
قطع وجبات الطعام عنهم. أما طالبو اللجوء الأفغان والسوريين فقد
أعادتهم رواندا إلى بلدانهم ليواجهوا الموت. وأثار الأسقف كريستوفر
شيسون، الانتباه في مجلس اللوردات، حول حقيقة أنه «لا يوجد شيء في
القانون يسمى «طالب لجوء غير قانوني» بل فقط طالب لجوء».
إزاء هذه المعارضة الكبيرة، حتى بين عدد من أعضاء حزبها، حزب المحافظين
الحاكم، لماذا تُصر باتيل على الترحيل اللاإنساني لطالبي اللجوء،
وتمديد محنتهم، وهي نفسها ابنة عائلة هندية مهاجرة إلى بريطانيا، عمل
والدها في محل للبقالة ليوفر العيش لأسرته، والمفترض أن تكون متفهمة
لوضع اللاجئين أكثر من غيرها؟
في كتابه «بشرة سوداء.. أقنعة بيضاء»، يقدم الكاتب والطبيب النفسي
فرانز فانون، تحليلا عن نفسية أبناء المُستعمَرات وإحساسهم بعقدة النقص
(الدونية)، من ناحية اللون واللغة والثقافة، تجاه الشعوب المُستعمِرة.
يحمل التحليل مُقاربة معقولة لفهم سلوك باتيل، وهي من عائلة عاشت في ظل
الاستعمار، حيث اختارت الانضمام إلى حزب المحافظين الذي يشكل أتباع
الكنيسة الإنكليزية واليهود غالبية أعضائه. وسياسة الحزب مبنية على
تعزيز الملكية الخاصة، والحفاظ على القيم والمؤسسات الثقافية التقليدية
للمجتمع البريطاني (غالبا الإنكليزي)، واستمرارية تسليح جيش قوي كذراع
للهيمنة الاستعمارية والتوسع الإمبريالي. وهي من الناحية الأيديولوجية
من الجناح اليميني في حزب المحافظين، وترى في السيدة ثاتشر، رئيسة
الوزراء الملقبة « السيدة الحديدية» النموذج الذي تقتديه. ولباتيل
علاقة حميمة بكيان الاستيطان الصهيوني. من بينها زيارتها إلى إسرائيل،
عام 2017، وإجرائها اجتماعات غير مصرح بها مع مسؤولين حكوميين مما
أجبرها على الاستقالة من منصبها كوزيرة للتنمية الدولية.
قد تشكل هذه السيرة تجسيدا لنظرية فانون عن عقلية ووعي ونفسية المثقف
المُستعمَر، خاصة حين يترعرع ويتعلم في بلد المُستعمِر، حيث يتوجب عليه
مواجهة عنصرية المجتمع والتهميش وأن يثبت، بمختلف الطرق، أنه لكي تكون
إنسانا عليك ان تكون أبيض. وهو ما تابعه الصحافي والباحث الهندي أشوين
فينكاتاكريشنان، الذي ترعرع مثل باتيل في بريطانيا بعد هجرة عائلته
اليها، سيرة باتيل وطموحها في أن تكون كالسيدة ثاتشر في قوتها وقسوتها،
ليتوصل للإجابة على السؤال حول مواقف باتيل، بأنه «قد تكمن الإجابة في
خلفيتها عندما كانت طفلة تواجه التمييز العنصري، ورغبتها في محاربة
ذلك. فسَعّت إلى محاربة الاتهامات بأنها ليست إنجليزية من خلال كونها
إنكليزية».
كاتبة من العراق
وأخيرا… زيارة دولية لبحث
الاختفاء القسري في العراق
هيفاء زنكنة
ما أن يُعقد مؤتمر دولي لبحث انتهاكات حقوق الإنسان إلا وكان العراق
على قائمة الدول التي يتعرض فيها المواطن لكافة أنواع الانتهاكات،
بدرجات مختلفة. فمن استهداف الصحافيين إلى نقص الخدمات الأساسية
والحرمان من حق الحياة. ومن الجوع إلى الفساد وتخريب البيئة. ومن
الاعتقال والتعذيب إلى الاختطاف والاختفاء القسري. وها نحن على مشارف
اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، لترتفع الأصوات دوليا، من جديد،
مطالبة بالتقصي عن مصير المختفين، في أرجاء العالم ومن بينها العراق
الذي، حسب «اللجنة الدولية للصليب الأحمر» يوجد فيه واحد من أكبر أعداد
الأشخاص المفقودين في العالم.
وتقدّر «اللجنة الدولية للمفقودين» أن العدد قد يتراوح بين 250 ألف
ومليون شخص. ويؤكد مركز جنيف الدولي للعدالة أن العدد يقارب المليون.
وتوثّق منظمة «هيومن رايتس ووتش» منذ عام 2016، عمليات الإخفاء القسري
المستمرة على أيدي قوات الأمن العراقية، لتخلص في تقريرها الجديد لهذا
العام بأن السلطات، في بغداد وإقليم كردستان، لم تفعل ما يكفي لمعاقبة
الضباط والعناصر المتورطين في حالات الإختفاء، وفي كل حالة راجعتها
المنظمة، لم ينجح أقارب ضحايا الإختفاء القسري في الحصول على معلومات
من السلطات حول مكان المفقودين.
ليس تقرير المنظمة فريدا من نوعه. فاستمرار المضايقات التي يتعرض لها
المدافعون عن حقوق الإنسان، وأقارب الضحايا، والشهود، والمحامون الذين
يعنون بقضايا الاختفاء القسري؛ واستغلال الدول أنشطة مكافحة الإرهاب
كذريعة لانتهاك التزاماتها؛ واستمرار مرتكبي أعمال الاختفاء القسري في
الإفلات من العقاب على نطاق واسع، جزءا من ظاهرة عالمية، فبعدما كانت
هذه الظاهرة في وقت مضى نتاج دكتاتوريات عسكرية أساساً، فإنه يستُخدم،
حاليا، كاستراتيجية لبث الرعب داخل المجتمع، حسب منظمة الأمم المتحدة
التي تبين أيضا الشعور بانعدام الأمن الذي يتولد عن هذه الممارسة لا
يقتصر على أقارب المختفي، بل يصيب أيضا مجموعاتهم السكانية المحلية
ومجتمعهم ككل.
وتتجلى خصوصية الوضع العراقي في جانبين هما أولا: ازدياد عدد الضحايا
بشكل مستمر وعلى اختلاف الحقب الزمنية وثانيا: تجزئة القضية حسب
الأجندة السياسية لتلك الحقبة. ففي حزيران/ يونيو 2020، أصدرت بعثة
الأمم المتحدة بالعراق ( يونامي) تقريرا موثقا عن المفقودين بالعراق.
كانت صورة الغلاف: لقطة ثابتة من مقطع فیدیو للمفوضیة العراقیة العلیا
لحقوق الإنسان يظهر فيها أطفال من محافظة الأنبار یحملون صورا ووثائق
ثبوتیة لأقارب مفقودین. وتكاد الصورة تتكرر في معظم التقارير الدولية،
السابقة واللاحقة، مع تغيير بسيط. كأن يُستبدل الاطفال بمجموعة من
النساء، يلتحفن السواد، وهن يرفعن صور أقارب مفقودين، أو تغيير عنوان
التقرير لتتراوح العناوين بين مفقودين ومغيّبين ومختفين قسرا. ويبقى
الوضع المأساوي، كما هو بلا تغيير، على مر السنين.
يتعرض المواطن في العراق لكافة أنواع الانتهاكات، بدرجات مختلفة. فمن استهداف الصحافيين إلى نقص الخدمات الأساسية والحرمان من حق الحياة. ومن الجوع إلى الفساد وتخريب البيئة. ومن الاعتقال والتعذيب إلى الاختطاف والاختفاء القسري
وتواصل العوائل، أو النساء في معظم الاحيان، لأن المغيبين هم غالبا من
الرجال، ملء استمارات بيانات بالمفقود: عمره، شكله، تاريخ الاختفاء،
مكان الاختفاء، تاريخ آخر مشاهدة، وظروف الاختفاء. ثم ينتظرن وضع حد
لانتظارهن الذي، كما تشير شهادات العديد من النساءـ يمتد لسنوات، يبقين
فيه معلقات بين الحياة والموت، بلا شهادة وفاة أو ما يمنح الأمل
بالحياة.
وتصبح المأساة مضاعفة إذا كان الرجل هو معيل الأسرة. واذا إفترضنا أن
عدد المفقودين هو نصف مليون، وليس مليونا، وبما أن معدل أفراد الاسرة
العراقية هو (5.7) حسب نتائج المسح لعام 2021 الذي نفذه الجهاز المركزي
للاحصاء بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، فهذا يعني أن اختفاء
النصف مليون رجل يمتد سيؤثر على حياة ما يقارب الثلاثة ملايين شخص
أُسريا وعاطفيا واقتصاديا.
يتبدى رد الفعل الحكومي ـ السياسي على المأساة الموثقة دوليا ومن قبل
منظمات المجتمع المدني، بشكل يراوح ما بين الاقرار والانكار، وفقا
لأجندة النظام السياسية وطائفية الأحزاب والميليشيات. فبينما يركز
النظام على المُغيّبين والمفقودين في حقبة ما قبل الاحتلال عام 2003،
ولا يذكر ضحايا سنوات الاحتلال، ينبري آخرون لتوثيق ضحايا داعش، وبينما
تتبنى أحزاب ضحايا جريمة داعش في سبايكر منكّرة وجود ضحايا في
المحافظات الغربية، يُهمل ضحايا الميليشيات والقوات الأمنية المحتمية
بالإفلات من العقاب. وكان مصطفى الكاظمي، قد أعلن منذ توليه منصبه في
مايو/أيار 2020، أن حكومته ستعمل على إنشاء آلية جديدة لتحديد مكان
ضحايا الاختفاء القسري، متعهدا بالعمل بجدية لمتابعة ملف المفقودين في
البلاد، إلا أن الوعود بقيت، كما هي، مجرد ألفاظ تلاشت مع سابقاتها.
مما دفع اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري بالأمم المتحدة، وهي
هيئة تتألّف من عدد من الخبراء المستقلين، وترصد أعمال الاتفاقية
الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري من جانب الدول
الأطراف، إلى مطالبة الحكومة العراقية، وبضغط مستمر، على مدى سنوات، من
منظمات حقوقية محلية ودولية، للسماح لها بزيارة العراق وتنظيم لقاءات
مع أهل الضحايا ومنظمات المجتمع المدني والتجمعات والجهات الفاعلة
الأخرى ذات الصلة. وحصلت اللجنة على الموافقة، أخيرا، وستتم الزيارة في
تشرين الثاني / نوفمبر 2022.
قد لا تكون هذه الزيارة الدواء السحري لمحنة الاختفاء القسري، إلا أنها
خطوة إيجابية وبالاتجاه الصحيح، إذا ما نشطت منظمات المجتمع المدني
والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والأوساط الأكاديمية من تقديم طلباتها
للاجتماع باللجنة أثناء زيارتها وتوفير بيانات الضحايا. وبإمكان
اللجنة، في حال تلقت معلومات تستند إلى أدلة صحيحة بأن ممارسة الاختفاء
القسري جارية على نطاق واسع وبصورة منهجية، أن تعرض المسألة على
الجمعية العامة. حيث ينص عمل اللجنة على أن الاختفاء القسري جريمة، إذا
ما تمَّت ممارسته بطريقة «واسعة النطاق» أو «ممنهجة» فإنها قد ترقى إلى
مستوى الجرائم ضد الإنسانية.
كاتبة من العراق
شكرا لعلماء البيئة
والدكتور العّشاب
هيفاء زنكنة
في واحدة من أكبر الحفلات العامة التي شهدتها لندن، يوم السبت الماضي،
احتفالا بمرور 70 عاما على تنصيب إليزابيث الثانية ملكة على المملكة
المتحدة ودول الكومنولث، ومن بين المساهمات الغنائية والراقصة ورسائل
التهنئة من قبل شخصيات سياسية وثقافية بارزة، كانت هناك رسالة واحدة
اختلفت عن البقية، التي ركزت كلها على شكر الملكة لتفانيها في أداء
واجبها ولبقائها كـ « أم» راعية على رأس المملكة والكنيسة أطول من أي
ملك آخر ورث الحكم.
استغرقت الرسالة بضع دقائق إلا انها كانت مختلفة في مضمونها عن بقية
البرنامج الحافل. كان صاحبها سير ديفيد آتينبارا وكانت موجهة، وهنا سبب
فرادتها، ليس إلى الملكة لشكرها فحسب، وليس لتسلية أفراد العائلة
المالكة الجالسين في الصفوف الأمامية للحفل، وليس إلى المحتفلين
بالشوارع المحيطة بقصر الملكة، فقط، بل إلى العالم كله.
تضمنت رسالته تحذيرا عالميا عن مسؤولية الناس في تدمير الأرض. وهي
استمرارية لأفلامه الوثائقية التي استهلها عام 1979 في برنامج « الحياة
على الأرض» وما تلاه من سلسلة برامج، حملت عناوين مثل « الكوكب الحي»
جعل محورها علم البيئة وتكّيف المخلوقات الحية مع بيئاتها. حققت
البرامج والأفلام نجاحا كبيرا إذ إستقطبت جمهورا واسعا لم يقتصر على
القلة من العلماء والمتابعين، وفتحت الأبواب أمام معرفة جماهيرية أكثر
تخصصاً عن الطبيعة مثل حياة النباتات الخاصة وإصدار أفلام عن مناطق
قلما تمكن أحد من الاطلاع على مجرى الحياة فيها سابقا. وجاء تحذيره في
حفل الملكة تكرارا لما ذكره في خطاب ألقاه أمام مجلس الأمن في الأمم
المتحدة أثناء نظر المجلس في المخاطر الأمنية التي تشكلها حالة الطوارئ
المناخية، قائلا « بغض النظر عما نفعله الآن، فقد فات الأوان لتجنب
تغير المناخ، ومن المؤكد أن الأشخاص الأشد فقرًا وضعفًا – أولئك الذين
لديهم أقل مستوى من الأمان – سيعانون الآن». ولم يكتف بذلك، بل عاد الى
الثيمة نفسها، عند استلامه جائزة برنامج الأمم المتحدة للبيئة لتفانيه
في البحث والتوثيق والدعوة لحماية الطبيعة واستعادتها، تساهم دعوته
للحفاظ على التنوع البيولوجي وإصلاحه، والانتقال إلى الطاقة المتجددة،
والتخفيف من تغير المناخ وتعزيز النظم الغذائية الغنية بالنباتات في
تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة. مُذكرا بالمسؤولية الدولية،
بقوله « على العالم أن يجتمع. هذه المشاكل لا يمكن حلها من قبل أمة
واحدة، بغض النظر عن حجم تلك الأمة الواحدة، نحن نعلم ما هي المشاكل
ونعرف كيفية حلها. كل ما نفتقر إليه هو العمل الموحد».
لا يمكن، بطبيعة الحال، التقليل من أهمية عمل ديفيد آتينبارا واستمراره
بأداء العمل وهو بعمر 96، إلا أن دعوته للعمل الموحد لحل مشاكل البيئة،
ينقصها البحث في بعض جذور الكارثة التي قلما يتم التطرق اليها في
أمريكا وعموم العالم الغربي مما يعيق تحقيقها.
على العالم أن يجتمع. هذه المشاكل لا يمكن حلها من قبل أمة واحدة، بغض النظر عن حجم تلك الأمة الواحدة، نحن نعلم ما هي المشاكل ونعرف كيفية حلها. كل ما نفتقر إليه هو العمل الموحد
من بين ما يتم التعامي عنه الكوارث التي تسببها الحروب الامبريالية
وعسكرة المجتمعات والاستخدام المنهجي للأسلحة وإحتلال البلدان وما
يترتب عليه من تدمير للبنية التحتية، بكافة المستويات، وتلويث البيئة
وإغتيال العلماء وتهديم المشاريع الوطنية ومنع المبادرات الفردية
الحامية للبيئة والإنسان. وهي مسؤولية جسيمة لا يمكن ان تُعزى بأي شكل
من الاشكال، كما يُشاع عادة، إلى تخلف العالم الثالث.
ففي فلسطين، مثلا، قام العالم والمؤلف مازن بطرس قُمصية، بتأسيس متحف
فلسطين للتاريخ الطبيعي ومعهد فلسطين للتنوع البيولوجي والاستدامة في
جامعة بيت لحم، بمبادرة شخصية. ولان قُمصية يعيش يوميات الاحتلال
الاستيطاني الصهيوني، فإنه يُشخص بوضوح أسباب التدهور البيئي، متجنبا
الفصل المتعمد، غالبا « ويربط بين الأضرار السابقة والتهديدات الراهنة
وطاقات الاستدامة الكامنة، بتأثير السياسات والممارسات الاستعمارية
والنيوليبرالية من جهة، ودور الفرد والمجتمع في الحفاظ على الانسجام مع
بيئتهم وطبيعتهم، من جهة أخرى». ويذكر قُمصية، في مقابلة صحافية مع
صحيفة الاتحاد، أن مشاريع الحفاظ على البيئة والاستدامة مشاريع مقاومة
لأنها تساعد في بقاء الإنسان على أرضه « في ظل إصرار الاستعمار
الإسرائيلي على اقتلاعنا من أرضنا، وتهويد تراثنا الطبيعي».
وإذا كانت المحافظة على النباتات جزءا لا يتجزأ من ديمومة الحياة على
الأرض، كما يُرينا آتينبارا في أفلامه الوثائقية، فإن محاولات علماء
النبات بالعراق لتوثيق الموجود منها وتكثيرها وإغناء استخداماتها،
واجهت من العوائق ما جعل استمرار العمل، جراء تعرض العلماء أنفسهم
للمخاطر، مستحيلا. وهو وجه مُهمل آخر للنظر في سيرورة تدمير الارض.
من بين العلماء الذين خسرهم العراق، في ظل الاحتلال الأنكلو أمريكي، هو
عبد الجليل إبراهيم القره غولي، الذي كان يطلق عليه تحببا « الدكتور
العّشاب». وقد قام عبد الجليل، خلال فترتي الحرب والحصار وندرة الأدوية
االمسموح باستيرادها، بتوثيق النباتات واستخداماتها الطبية. كما افتتح
عيادة محلية في عام 1990، ولمدة ست سنوات قام بتوزيع الأدوية العشبية
عندما كان المرضى في أمس الحاجة إليها. كانت حصيلة عمله الدؤوب توثيق
النباتات الطبية من أرجاء البلاد في ثلاثة مجلدات تحتوي على ثروة من
المعلومات عن 834 نباتًا واستخداماتها التقليدية. وتوقف عمله حين قُتل
في هجوم إرهابي عام 2009.
إلا أن وثائقه ونتائج بحوثه التي تشكل ثروة معرفية وتراثا ثقافيا، نجت،
لحسن حظ العراق والعالم، من التخريب، فقامت إبنته رنا، من متحف تاريخ
العلوم بجامعة أكسفورد، بالمحافظة عليها وإصدار نماذج منها في كتاب صدر
أخيرا باللغتين العربية والانكليزية بعنوان « عشبة العراق».
قام بتحريره خبراء من جامعة أكسفورد والحدائق النباتية الملكية ( كيو).
يصف الكتاب خمسين نباتًا واستخداماتها في طب الأعشاب التقليدي في
المنطقة. وبالإضافة إلى ثروة المعلومات، تم توضيح الأعشاب برسوم رائعة
الجمال، مما يجعل الكتاب مصدرا ثمينا للمعلومة البيئية ولوحة للجمال.
أملا، كما جاء في الكتاب « أن يساعد نشره في الحفاظ على استمرار الطب
الإسلامي التقليدي، وأهميته العميقة في علاج الأمراض، في المناطق التي
فُقدت فيها معرفة الأجيال بسبب الحرب».
كاتبة من العراق
العراقي لا يفهم ما يقرأ!
هيفاءزنكنة
هل تشكل معرفة أن 90 في المئة من التلاميذ العراقيين لايفهمون ما
يقرأون صدمة لمن يفتخر، عراقيا وعربيا، بالتعليم العراقي والعقول
العراقية؟ وهل ما يذكره البنك الدولي في آخر تقاريره عن الوضع التعليمي
في العراق وموافقته على مشروع بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي «لدعم
الابتكارات من أجل التعلم في ثلاث من المحافظات العراقية المتعثرة «،
سيساعد فعلا على تعزيز ممارسات التدريس لمعلمي اللغة العربية
والرياضيات، وتحسين مهارات القراءة والكتابة والحساب لدى طلاب المرحلة
الابتدائية في المحافظات المنتقاة؟
لايثير تقرير البنك الدولي الصدمة لأنه لا يكشف شيئا جديدا. فالحقائق
المؤلمة التي يشير اليها معروفة لكل من يتابع إزدهار التعليم ومن ثم
تدهوره، بكافة مراحله، بدءا من سنوات الحصار الجائر (1991 – 2003) وحتى
الانهيار شبه الكلي منذ احتلال البلد. والحقيقة التي لا يشير اليها
التقرير هي أن التدهور يشمل جميع المحافظات، بضمنها بغداد التي طالما
افتخر عديد المثقفين والعلماء العرب بكونهم من خريجي جامعاتها، مما أدى
إلى إضعاف رأس المال البشري، وهو أساس تحقيق النمو الاقتصادي المستدام،
ليشكل 15 في المئة فقط من إجمالي الثروة، وهو أحد أدنى المعدلات في
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يخلص التقرير إلى أن النظام
التعليمي عاجز عن تقديم المهارات الأساسية إلى الطلاب والتي تشكل أساس
التعلم وتنمية المهارات. ويعزو أسباب القصور وتفاقمها إلى ما يسميه «
فترة الصراع» بالاضافة إلى جائحة كورونا وإغلاق المدارس. وأن مبلغ
العشرة ملايين دولار الممنوحة، على مدى عامين، سيساعد على « تحسين
نواتج تعلم القراءة والرياضيات لتلاميذ ومُدرسي مادتي الرياضيات واللغة
العربية في محافظات العراق الثلاث الأشد فقراً». حسب ساروج كومار جاه،
المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي.
يثير التقرير، بتفاصيله، والمبلغ الضئيل نسبيا المخصص له، ومدى تطبيقه،
عديد التساؤلات. إذ يكتفي، عند التطرق إلى أسباب التدهور، وهي نقطة
مهمة جدا لأيجاد الحلول، بلمس السطح تاركا الأسباب الحقيقية جانبا. وهي
أسباب طالما تناولها باحثون وأكاديميون عراقيون، قبل صدور هذا التقرير
بسنوات عديدة، في محاولاتهم الوطنية لأنقاذ التعليم وتطويره. ففي ورقة
بحثية نُشرت عام 2009، مثلا، بعنوان «أولويات التعليم العراقي في
المرحلة الراهنة» للأكاديمي منذر الأعظمي، المختص في مجال تطوير
القدرات الذهنية والمهارات الأساسية التعليمية، عالج المقترح ذاته في
مشروع البنك الدولي، مع فارق السنوات المهدورة وتخصيص «مساعدة» بإمكان
العراق، وهو من دول العالم الغنية، توفيرها بسهولة لو توفرت النية
الصادقة لإنقاذ التعليم، وإنقاذ 3.2 مليون طفل عراقي في سنّ الدراسة
خارج المدرسة، حسب تقرير لليونسيف.
يعزو التقرير سبب تزايد تدهور مستوى التلاميذ إلى جائحة كورونا وإغلاق
المدارس أثناءها، والحقيقة هي أن الكثير من مباني المدارس أما تدهورت
أثناء حقبة الحصار أو أستولت عليها القوات الأمريكية في بداية الاحتلال
للتمركز داخل كل مدينة وحي، ومنع تجمع السكان في تلك المراكز. ولم تعبأ
الإدارة الأمريكية لا باتفاقيات جنيف، التي تمنع قوات الإحتلال من
تغييرالمعالم المدنية للمناطق التي تحتلها، ولا بقواعد القانون
الإنساني ولا للوعود التي رافقت الحرب من تطوير الحياة المدنية. ثم
استلمتها منها الميليشيات والجهات السياسية، لكون أغلبها في وسط المدن.
وهي مشكلة تناولها منذر الأعظمي، في دراسته، كواحدة من ثلاثة مستويات
تتوجب معالجتها في مجال التعليم. «المستوى الأول هو خراب المدارس
كأبنية، وتهميشها كمراكز حضارية في حياة المدن. والمستوى الثاني هو
تدهور الإدارة التعليمية في المدارس والمحافظات والامتحانات والسياسات
التعليمية للدولة. والمستوى الثالث هو في المحتوى، أي تدهور المستوى
المعرفي في التعليم، طلابا ومعلمين» مبينا أن هناك عملية مستمرة لإفراغ
التعليم من أهم محتوياته في تطوير قدرات الطلبة على التفكير، ونمو
كفاءاتهم ومواهبهم المتعددة في أطر المسؤولية العامة».
واستند الباحث إلى آخر الدراسات موثقا أن من لا يدخل المدارس يتراجع
مستواه العقلي سنويا بنسبة 3 – 5 في المئة عمن يدخلونها في المعدل، أي
أن من المحتمل أن مستوى الذكاء لمن تسرب من المدارس لعشر سنوات هو
حوالي 70 في المئة من المعدل وهو ما يمكن اعتباره تخلفا عقليا لهم في
المعارف العامة، إن لم يكن في الأمور الحياتية العملية الروتينية. وهي
الصورة المؤسفة ذاتها التي يذكرها البنك الدولي في تقريره، ولكن بعد 13
عاما من التأخر في اتخاذ خطوات العلاج التي يعرف الجميع، من عراقيين
وأجانب، أنها ليست مستحيلة.
هناك، أيضا، علامة استفهام حول مناهج التدريس التي يبين الأعظمي أنها
أما أستورثت من الغرب أو تُرجمت من اللغة الانكليزية في الغالب، حسب
الارتباطات بدول كنا إحدى مستعمراتها. وهذه المناهج، غالبا، هي الأكثر
شيوعا في البلدان العربية، أي أنها قُررت أما بدون صياغتها وطنيا أو
اعتباطيا أو بدون تمحيص لمناهج أخرى في البلدان نفسها وخصوصا البرامج
الحديثة والتجريبية هناك والتي، على أهميتها، لن تحقق النجاح كما في
البلدان المتقدمة، لأن هذه البلدان مع كونها تتخذ مناهج عامة غالبا فهي
تسمح بالإضافة اليها بالعديد من المناهج التجريبية التي تُغني بمرور
الزمن المناهج الأصلية.
تكمن أهمية صدور تقرير البنك الدولي والمشروع، بعد عشرين عاما من
الأحتلال تقريبا، تأكيد صحة موقف التعليميين العراقيين الوطنيين، كما
يؤكد أن تآكل الوضع التعليمي وتأثيره على تدهور القدرة العقلية لما
يقارب 13 مليون عراقي وُلدوا وعاشوا فترات الحصار والاحتلال، وصل حدا
لم يعد بالامكان التستر عليه، بحيث بات إطلاق أي مبادرة، وإن كانت من
قبل ذات الدول والجهات التي عملت على تحطيمه، يُنظر اليها كمساعدة
إنسانية تستحق الشكر، وهو ما سيستمر ما لم، كما يخلص الأعظمي في بحثه،
يعمل أهل العراق، أنفسهم، على التطوير التدريجي للبدائل الحضارية التي
تخدم جميع فئات الشعب وتطور مواهب أبنائه لخدمة الأمة والبلد، فتحرير
البلد من الاحتلال المباشر لا يعفي من الصراع مع مخلفاته، ومع ما
استنفره من ردود فعل مرضية أو صحية، ومع امتداداته التعليمية والثقافية
والاجتماعية.
كاتبة من العراق
مذبحة الزفاف والمرصد الأمريكي
لجرائم الحرب في أوكرانيا
هيفاء زنكنة
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في 18 أيار/
مايو الحالي، عن إنشاء مرصد لتوثيق الجرائم التي ترتكبها روسيا
بأوكرانيا، واستخدام المعطيات « لمحاسبة المسؤولين عن الفظائع
وانتهاكات حقوق الإنسان والضرر الذي يلحق بالبنية التحتية المدنية، بما
في ذلك التراث الثقافي الأوكراني «. مبينا أن ذلك لن يقتصر على المحاكم
المحلية بأوكرانيا بل المحاكم الأمريكية وغيرها من دول العالم.
وهي خطوة ضرورية. فغزو واحتلال البلدان، أمر مرفوض حسب القوانين
الدولية والإنسانية، وتطبيقاتهما في حماية حياة الناس والبنية التحتية
والتراث الثقافي في البلدان الخاضعة للاحتلال. وإدانة الاحتلال، وتوثيق
جرائمه، ومحاسبة المسؤولين أمر مفروغ منه ويجب أن يتم بلا تردد،
عالميا، لئلا يُمنح البلد المعتدي مساحة لتبرير عدوانه غير الشرعي وطمس
جرائمه. وهو ما يُفترض القيام به، عالميا أيضا، مهما كانت طبيعة وقوة
الدولة المُعتدية، منعا لإعطاء الضوء الأخضر للدول القوية عسكريا في حق
غزو واحتلال الدول الأضعف للاستيلاء على مواردها الطبيعية أو لدوافع
جيوسياسية.
ولكن، هل هذا ما يحدث فعلا إزاء كل البلدان أم أن مقولة « كل الحيوانات
متساوية لكن بعضها أكثر مساواة من غيرها» حسب الكاتب الانكليزي جورج
أورويل، هي السائدة، مهما كان إقتناعنا بأهمية القانون الدولي وما
يتمخض عن تطبيقه من عدالة تطمح الشعوب إلى تحقيقها؟ فزيف ما يُعاش،
أوصل معظم الشعوب إلى القناعة بأن الإيمان بالقانون الدولي يماثل
محاولة الإمساك بسراب. مادامت آلية تطبيقه تمر عبر المنظمات الدولية،
الخاضعة في النهاية، وإن بدرجات متفاوتة، للولايات المتحدة الأمريكية
وقوتها العسكرية. مما يوفر لأمريكا حصانة من المساءلة، تكاد تكون
مطلقة، بينما تستقوي ذات المنظمات على دول أخرى تُصنف بأنها مارقة أو
إرهابية، ويجب محاسبتها لارتكابها انتهاكات جسيمة ترقى الى مستوى جرائم
حرب. الأمر الذي أدى، تدريجيا، إلى خلق نظام عنصري في مجال تطبيق
القانون الدولي، يتناسب مع القوة العسكرية والهيمنة الاقتصادية للدولة
أو الدول التي تروم تفعيله.
من هذا المنطلق، تقودنا المفارقة السوداء في توقيت الإعلان الأمريكي،
عن تأسيس مرصد لتوثيق جرائم روسيا في أوكرانيا ومحاسبة المسؤولين، بعد
إحتلال ثلاثة أشهر فقط، إلى الغزو والاحتلال الانكلو أمريكي للعراق،
الذي سيبقى مع الاحتلال الصهيوني لفلسطين، حيا في وجدان وذاكرة الشعوب
عن الزيف والعنصرية. ليس لأن أمريكا تعامت عن غزو واحتلال العراق، كما
تفعل بعض الدول حماية لنفسها عادة بل لكونها البلد الذي هدم البنية
التحتية، وحبس مئات الآلاف بشكل غير قانوني، في ظروف لاإنسانية مهينة (
ولنتذكر أبو غريب كمثال) وسبّب قتل مايقارب المليون عراقي، أما بشكل
مباشر أو غير مباشر، ونهب الآثار وحرق الموروث الثقافي فضلا عن مأسسة
الفساد والارهاب على مدى عشرين عاما.
غزو واحتلال البلدان، أمر مرفوض حسب القوانين الدولية والإنسانية، وتطبيقاتهما في حماية حياة الناس والبنية التحتية والتراث الثقافي في البلدان الخاضعة للاحتلال. وإدانة الاحتلال، وتوثيق جرائمه، ومحاسبة المسؤولين أمر مفروغ منه
ولا يمكن المرور على توقيت الإعلان الأمريكي عن إنشاء مرصد للجرائم
الروسية بدون التوقف عند مجزرة حفل الزفاف التي إرتكبتها قوات الاحتلال
الأمريكي بذات التاريخ، تقريبا، أي يوم 19 أيار/ مايو من عام 2004. حيث
قامت مروحية أمريكية باطلاق النار على حفل زفاف في قرية مقر الذيب، قرب
بلدة القائم، غربي العراق. مما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصًا، من
بينهم العديد من الأطفال. خلال ساعات أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية
(البنتاغون) بيانا إدّعت فيه بأنه لم يكن هناك حفل زفاف بل « مخبأ
مقاتلين أجانب» وأنهم « كانوا معادين لقوات التحالف وأطلقوا النار
أولاً، وأن القوات الأمريكية ردت على النيران ودمرت عدة سيارات وقتلت
عددًا منها». تثير قراءة هذه البيانات الأمريكية لتسويغ جرائم قتل
المدنيين الغثيان لفرط تكرارها وشبهها، إلى حد أدق التفاصيل، تبرير
الكيان الصهيوني لجرائمه بفلسطين بحجة «حق الدفاع عن نفسه وأمنه». حيث
يبرر الجنرال الأمريكي المذبحة بلا لحظة تفكير أو ندم. وهو يرى أن قتل
العراقيين ضروري وهم يستحقون الموت. ولا يجد في المذبحة ما يدعوه إلى
التشكيك بصحة قراره وأخلاقيته على الرغم من وجود شهود عيان، أكدوا أن
الضيوف كانوا يطلقون النيران في الهواء وهو تقليد محلي إحتفالا
بالزفاف، حين هجمت المروحية الأمريكية فهدمت دارين وقتلت الموجودين.
وأكد نائب رئيس شرطة الرمادي، لوكالة « أسوشيتد برس» أن القتلى بينهم
15 طفلاً و10 نساء. وقال صلاح العاني، الطبيب في مستشفى الرمادي، أن
عدد القتلى كان 45 شخصا.
وإذا اخذنا في الحسبان نظرة المحتل الدونية لشهود العيان العراقيين،
ماذا عن وكالة « أسوشيتد برس» وروري مكارثي، مراسل صحيفة « الغارديان»
البريطانية، الذي كتب بالتفصيل عن المجزرة يوم 20 أيار/ مايو، أثناء
وجوده ببغداد؟ قائلا « وأظهرت لقطات تلفزيونية شاحنة تحمل جثث القتلى
وهي تصل إلى الرمادي أقرب بلدة كبيرة. من الواضح أن العديد من القتلى
كانوا من الأطفال». مذكرا بأن للهجوم « بصمات حادثة مماثلة في
أفغانستان، قبل عامين، أطلقت خلالها طائرة أمريكية النار على حفل زفاف
في إقليم أوروزغان في الجنوب، مما أسفر عن مقتل 48 مدنيا أفغانيا
وإصابة أكثر من 100 آخرين. تم استهداف حفل الزفاف لأن الضيوف كانوا
يطلقون النار في الهواء كتقليد احتفالي».
أليس هذا كله توثيقا لجريمة يجب أن تستخدم معطياتها لمحاكمة المسؤولين
عن إرتكابها كما تفعل أمريكا، حاليا، في رصدها الجرائم الروسية ضد
الأوكرانيين؟ لا يبدو ذلك. ففي حالتي العراق وأفغانستان، أعلنت القوات
الأمريكية عن إجراء تحقيق، على غرار أن يقوم المتهم بالتحقيق في
الجريمة التي إرتكبها. فكانت النتيجة تبرئة الطيارين تماشيا مع شهادة
جنود أمريكيين قالوا إنهم تعرضوا لإطلاق النار. مما يترجم على أرض
الواقع أن قتلهم المدنيين، وبينهم عشرات الأطفال، في العراق
وأفغانستان، فعل ضروري للدفاع عن النفس في معركة بدأها إرهابيون ضد
الحضارة. وهو منظور « يشمل كل من يطالب الغرب بالنظر في ماضيه» بكلمات
المفكر الفلسطيني ادوارد سعيد.
كاتبة من العراق
شيرين فلسطين
تكتب تاريخها بنفسها
هيفاء زنكنة
من بين الاسئلة التي نواجهها، ونحن نعيش حقبة تزوير وتضليل سياسي ـ
إعلامي مذهل، فضلا عن إزدواجية المعايير، بعد جريمة إغتيال الصحافية
الفلسطينية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، تحت أنظار العالم، مع استمرارية
حرب أُريد لها ان تكون عالمية، هو كيف تتم عملية تقطير الأحداث
المعاصرة لتصبح الخلاصة، ملائمة للمنتصرين أو أصحاب القوة؟ وكيف تُدّرس
على هذا الأساس وإن كان من عايشها، من أفراد وحتى شعوب، لايزال على قيد
الحياة؟
في عديد الكتابات والنقاشات والآراء المتبادلة اليوم، في حلقات
المثقفين العرب، خاصة العراقيين والفلسطينيين، يحضر التاريخ بقوة تنافس
الحاضر، بمستوياته من التاريخ الشخصي والعام، وعلى إختلاف مستوياته
المتعددة، من كتابة المذكرات إلى البحوث والدراسات، لتنشر أما بشكل كتب
أو على صفحات التواصل الاجتماعي. الحاضر، في معظم الحالات تائه بين
محاولات فهم التاريخ والأدلجة وإثبات الهوية وتجزئة القضايا. مما ينعكس
بقوة على توثيق الحقيقة وجهود إثبات المصداقية.
فلسطينيا، يعتبر التوثيق الآني الفردي والعام والتاريخي المتضمن، أيضا،
كتابة اليوميات والمذكرات وتسجيل الشهادات المحكية، أداة مقاومة
للسردية الصهيونية المختلقة، ولعل آخرها المُختلق الصهيوني لتغطية
جريمة إغتيال شيرين. لذلك نجد اهتماما جديا، يتنامى بشكل متزايد، خاصة
في المجالات الأكاديمية، بدراسة التاريخ وتوثيق كل ما يرتبط بفلسطين،
بشكل علمي يتوخى المحافظة على المصداقية بمواجهة «الأسطورة» والأكاذيب
الصهيونية والتركيز على حفريات «الذاكرة» المصطنعة. ويمتد الاهتمام
ليشمل كيفية دراسة وتدريس التاريخ، وهي حقول معرفية تغتني بالبحث
والتحليل والمقارنة، والربط الموضوعي بين الأحداث.
عراقيا، لدينا فقر حقيقي في مجال كتابة التاريخ. ينعكس في البحوث
والدراسات الأكاديمية كما نراها، بأوضح صورها، في الكتابات المنشورة
كأوراق بحثية أو المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي وهي تحمل توقيع
« مؤرخ» أو «مفكر». إذ قلما نجد من يكتب عن حدث ما بدون السقوط في فخ
الأديولوجية بقوالبها الجاهزة، وانتقائية الحدث حسب الظرف الاجتماعي
والسياسي الذي يمر به الشخص/ البلد، وطغيان نفي كل ما لايتماشى مع ما
يراد إنتقائه. لتصبح كتابة التاريخ المعاصر، تحديدا، عملية شخصنة تمر
عبر مراحل تجميل أو تشويه، كل حسب وجهة نظره وخلفيته السياسية
والاجتماعي، والدور الذي تلعبه الذاكرة الشخصية في إضفاء المديح
والوطنية أو التشكيك والتخوين. في بحث له، يذكر حيدر لشكري هو أستاذ
مساعد للتاریخ الإسلامي الوسیط في جامعة کویه ـ إقليم کردستان العراق:
« يقع الباحثون، بسبب تكوينهم الإيديولوجي، في دوامة المسائل المنهجية،
لأنهم يتجاهلون كيفية تكوّن النص التاريخي، ويأخذون من هذه الروايات ما
يساعدهم على تجميل الصورة التاريخية لهويتهم وما يؤكد فاعلية جماعتهم
في الذاكرة العراقية».
يعتبر التوثيق الآني الفردي والعام والتاريخي المتضمن، أيضا، كتابة اليوميات والمذكرات وتسجيل الشهادات المحكية، أداة مقاومة للسردية الصهيونية المختلقة
تقودنا هذه الملاحظات إلى التساؤل عن كيفية تكوين المؤرخ العراقي،
بالمقارنة مع نظرائه في العالم، هل هو وليد تدريس التاريخ في الجامعات
العراقية أم أنه عصامي التكوين؟ وماهي منهجية إعداد «المؤرخ» جامعيا؟
تطغى الانتقادات الموجهة بشكل كبير على كيفية ومنهجية تدريس التاريخ،
وإن كان النظر إلى أهمية دور المؤرخ لايشوبه الشك. من بين الانتقادات
التي تكاد تنطبق على عموم التدريس بالعراق «أن تدريس التاريخ يتم
بالطريقة اللفظية الاستظهارية» ويُنظر الى التاريخ «باعتباره مادة
تقريرية تتألف من مجموعة نصوص وأحداث مسطرة في الكتاب المدرسي» بدون
مراعاة ضرورة» تنمية القدرة على التعامل مع المفاهيم الزمنية وادراكها
واكتساب القدرة على تمحيص الأحداث والقراءة النقدية للتاريخ». وتلخص
إطروحة دكتوراه أحمد هاشم محمد، في فلسفة التربية، المعنونة «طرق تدريس
التاريخ» بعض مشاكل تدريس مادة تاريخ العراق المعاصر من وجهة نظر 247
من طلاب وطالبات السنة الأخيرة، بقسم التاريخ بجامعة بغداد. توصّلَ
الباحث إلى نتائج تساعد على إلقاء الضوء على كيفية إعداد ونوعية مدرسي
التاريخ و« مؤرخينا» مستقبلا.
ففي مجال الأهداف العامة للمادة كانت المشكلة الأولى ضعف تنمية التفكير
النقدي عند الطلبة. وشكلت أساليب التدريس كإعتماد الطريقة الالقائية
عند تناول الموضوعات التاريخية، وافتقار مدرسي المادة إلى مهارة
التمهيد للدرس، وقلة زيارة الطلبة إلى المتاحف التاريخية، وقلة اللجوء
إلى استخدام الوسائل التعليمية والتقنيات التربوية المتمثلة بالمصورات
والخرائط والأفلام ذات العلاقة بمضمون التدريس، بالاضافة إلى غموض
الأهداف الداعية إلى دراسة تاريخ العراق المعاصر، تشكل هذه العوامل
عائقا في عدم تنمية رغبة الطلبة في فهم المادة وأحداثها بشكل عام، مما
إنعكس، على عدم رغبة الطلاب في التخصص بتاريخ العراق المعاصر، وبالتالي
على كتابتنا لتاريخنا المعاصر بأنفسنا.
إن عدم كتابتنا لتاريخنا لا يعني فقط عجزنا عن فهم الحاضر والمستقبل
معا، فالتاريخ كما يذكر أستاذ التاريخ البريطاني جي كورفيلد « لا مفر
منه». وهو خلافا لما يشاع في مدارس ما بعد الحداثة الفكرية، ليس
موضوعًا ميتًا، لذلك يشكل قرار طلاب التاريخ العراقيين عدم جدوى دراسة
تاريخ بلدهم المعاصر كارثة حقيقية، لا من ناحية عدم الدراسة والتدريس
فقط وإنما لفسحه المجال واسعا أمام الآخرين لكتابة تاريخنا، وفق ما
يريدون، بشكل انتقائي، يُبرز أحداثا تُحفر في الذاكرة الجماعية بينما
يتم حذف أحداثا أخرى. ويتم ذلك كله وفق ميزان القوى الخارجية والجهات
المتحكمة بالسلطة داخليا المتزامن مع غياب المؤرخين.
وهذا ما نواجهه في بلداننا، عموما، وهو منبع القصور في فهم الأسئلة
والمعضلات الحالية وتوليفة العلاقات العالمية والوطنية والمحلية بين
المجتمعات والأفراد وكيفية التعامل معها. إذ لانزال خاضعين بشكل مباشر
أو غير مباشر، لكتابة الاحداث وتحليلها وصياغتها وحتى تدريسها لنا،
إنتقائيا، كما أراد المستعمر، على حساب مسح الذاكرة الجماعية.
كان الاستعمار ولايزال، بتركيبته الاستيطانية العنصرية في فلسطين،
يتغذى على تدمير الثقافة وطرق فهم العالم وإبادة الانسان. وكلما ينتهي
من إرتكاب واحدة من جرائمه يشرع بعملية محو جرائمه من الذاكرة العامة
واستبدال الحقائق الآنية لئلا تُصبح تاريخا كما يشاء. وهو ما نشهده،
الآن، بعد اغتيال الشهيدة شيرين. وسينجح في تحويلها إلى صورة تضاف إلى
قائمة صور الشهداء المرسومة على جدران المخيمات، ما لم تواصل الاصوات
الغاضبة المستنكرة مسار شيرين / فلسطين في كتابة تاريخها بنفسها.
كاتبة من العراق
من المسؤول عن صبغ
العراق بالغبار الأحمر؟
هيفاء زنكنة
سببت
عاصفة ترابية، غطت سبع محافظات عراقية، من بينها بغداد، أكثر من 5 آلاف
حالة اختناق ووفاة شخص واحد. تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورا
مذهلة، عن الغبار الأحمر الذي غّلف الجو والناس والأماكن، للمرة
السابعة، خلال شهر. رافقت الصور، تحليلات ونظريات، جمعت ما بين العلمي
والتهويلي والرسمي الدعائي المُطّعم بالتبريرات بدرجات مختلفة.
ركزت التصريحات الرسمية على التغير المناخي وقلة الأمطار والتصحر، وهي
أسباب حقيقية على مستوى العالم، إذ لم يعد الدمار الذي ألحقه الإنسان
بالبيئة خافيا على أحد، ومن أعراضه المتزايدة، الأعاصير والفيضانات
وإرتفاع درجات الحرارة، والتصحر، وجفاف الأراضي الزراعية، والحرائق
المهددة للغابات، وتزايد الغازات وتلوث الهواء. وهي ظواهر طالما حذر
علماء البيئة من حدوثها ووجوب إيجاد حلول جذرية لها. حلول أكد العلماء
ونشطاء البيئة على ضرورة أن تُلزم جميع الدول بلا إستثناء بشكل عام وأن
نبهوا، في الوقت نفسه، إلى مراعاة خصوصية كل بلد على حدة، أيضا، تسريعا
لإصلاح الأضرار.
عند النظر إلى الوضع البيئي في العراق بالاضافة إلى قبولنا بحقيقة
الضرر العالمي العام، سنجد تميزه بخصوصية تميزه عن أمريكا و أوروبا
وحتى عديد البلدان الإقليمية، مثلا، مهما حاولت التصريحات الرسمية
العراقية والدولية تعليبه في ذات العلبة، مع إضافة بعض التحذيرات، على
غرار تصنيف العراق من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في
العالم خصوصا بسبب تزايد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز
لأيام من فصل الصيف خمسين درجة مئوية. وتحذير البنك الدولي في تشرين
الثاني/نوفمبر الماضي من انخفاض بنسبة 20 في المئة في الموارد المائية
للعراق بحلول عام 2050 بسبب التغير المناخي.
نلاحظ، عند متابعة التصريحات الرسمية المحلية وقراءة التقارير الدولية
والتحذيرات من مستقبل قريب مظلم، خاصة بعد إرتفاع عدد الأيام المغبرة
إلى 272 يوماً في السنة، في العقدين الأخيرين، أنها، باستثناء النادر
منها، لا يمس جذور الكارثة البيئية بالعراق ومسؤولية السياسة الغربية
الاستعمارية بل يكتفي بخدش السطح، وإقتراح تشكيل لجان، لا يعرف أحد
مصيرها بعد غياب الضجة الإعلامية، مما يعيق إيجاد حلول حقيقية تساعد
على إيقاف التدهور أولا وتحسين الوضع ثانيا.
إن خصوصية الوضع الكارثي نابعة من كون الكارثة البيئية، بالإضافة إلى
الخراب العام، ناتجة عن صناعة الحرب والاحتلال والسياسات الاستعمارية
الجديدة، الدولية والإقليمية المستقوية بنظام اللادولة بالعراق،
المؤدية إلى تقويض الأساس الاقتصادي للحياة في المنطقة. تظهر آثار هذه
الحروب والسياسة الاستعمارية فضلا عن تجاهل النظام الكلي لمسؤوليته
الوطنية في تغير المناخ المدمر، واستنفاد الموارد الطبيعية، وندرة
المياه، وتلوث الهواء والتربة جراء استخدام الذخيرة الحديثة،
كاليورانيوم المنضب.
تشير التقديرات إلى أن الحرب ضد العراق سببت إطلاق 141 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون، بين عامي 2003 و2007، أي أكثر من 60 بالمئة من جميع دول العالم
وتشير التقديرات إلى أن الحرب ضد العراق سببت إطلاق 141 مليون طن متري
من ثاني أكسيد الكربون، بين عامي 2003 و2007، أي أكثر من 60 بالمئة من
جميع دول العالم. وكانت العالمة العراقية د. سعاد العزاوي والدكتورة
المصرية بياتريس بقطر قد وثقتا في عديد بحوثهما انتهاك الولايات
المتحدة للقوانين الدولية أثناء حرب الخليج، وفي وقت مبكر، عن طريق
إستخدام أسلحة ذات قابلية للتأثير على المدى البعيد مما يسبب تدميرا
دائما للبيئة الطبيعية حتى بعد إنتفاء الحاجة العسكرية لها، وهو ما
أثبتت الأيام صحته، خاصة بعد أن واصلت أمريكا خرقها لقوانين الحروب
والقوانين الإنسانية في السنوات التالية وحتى غزوها العراق عام 2003.
ومن بين الأسباب المدمرة للبيئة العراقية، المسكوت عنها بشكل متعمد، هو
كيفية تخلص القوات الأمريكية من النفايات العسكرية، وذلك عن طريق حرقها
في حفر كبيرة في الأرض.
احتوت النفايات، باعتراف الجنود، الإمدادات الطبية المستعملة، والطلاء،
وزجاجات المياه البلاستيكية، والبطاريات، وحتى عربات همفي بأكملها. أدى
الحرق إلى إصابة الجنود بأمراض خطيرة. يقول الضابط المتقاعد بروير «كان
الدخان سامًا، إنه قاتل صامت، وقد لا يقتلك في ساحة المعركة غدًا، إلا
أنه سيتسبب في أضرار صحية طويلة المدى. ونحن نرى ذلك الآن، نرى ذلك
كثيرًا». وقد أدى تزايد ظهور الأعراض المرضية على الجنود إلى تأسيس
جمعية للمطالبة بالرعاية الخاصة وتعويض المصابين من الجنود، بينما لم
يحدث إطلاقا أن طالب أحد سواء من الساسة العراقيين أو الأجانب أو حتى
أعضاء منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية بالتحقيق في الأعراض
المرضية التي تعرض لها المواطن العراقي جراء حرق النفايات السامة،
ناهيك عن المطالبة بالتعويضات. لتبقى إزدواجية المعايير هي اللغة
السائدة خاصة مع غياب المطالبة بالحقوق.
وفي الوقت الذي لا يختلف فيه إثنان حول تعقيد الوضع البيئي العراقي
وكونه حصيلة عقود من التخريب، إلا أن التغاضي عن تحميل الغرب المسؤولية
الاولى وطرح حلول لا تحيد عن صراط ذات الأنظمة التي سببت الخراب لن
يؤدي إلى تنظيف البلد وإيقاف التدهور نحو الحضيض. وتشكل قلة المياه في
نهري دجلة والفرات، جراء بناء إيران وتركيا السدود، خلافا للاتفاقيات
الدولية، مشكلة جسيمة، تناولتها د. سعاد العزاوي في بحث أخير لها منبهة
إلى حتمية جفاف النهرين. هذه الكارثة، لن توقف ما دام النظام الحاكم
عبارة عن أحزاب وميليشيات، تتنازع إلى حد الاقتتال فيما بينها، مما جرد
الدولة من أية قوة وسلطة مركزية. وبقيت الحلول، حتى البسيطة منها، على
غرار تشريع قانون يمنع عمليات الحفر غير المنظمة، وتجريف البساتين
وتحويلها إلى مبان، ومنع قلع الأشجار، بل العمل على تشجيع زراعة
الأشجار الكثيفة وعودة المزارعين إلى أراضيهم التي تركوها بسبب موجات
الجفاف والعواصف، معلقا بلا تنفيذ. ليبقى العلاج الحقيقي مرتبطا بتوفر
الإرادة السياسية الصادقة، النابعة من صميم المجتمع والممثلة لمصالحه
والمفروضة فرضا من قبل أبناء الشعب أنفسهم.
كاتبة من العراق
الإعلام الغربي:
من غزة وملجأ العامرية إلى أوكرانيا
هيفاءزنكنة
ما هو طول الفترة الزمنية التي تكرسها أجهزة الإعلام الغربية لتغطية ما
يدور من أحداث كارثية في فلسطين والعراق بالمقارنة مع تغطيتها لما يدور
حاليا في أوكرانيا؟ ليست هناك دراسات وإحصائيات دقيقة توفر الإجابة
العلمية بعد، لكن متابعة نشرات الأخبارواللقاءات والبرامج الإذاعية
والتلفزيونية البريطانية، مثلا ناهيك عن الأمريكية والدول الأوروبية،
توضح، بما لا يقبل الشك، أن هناك تحيزا إعلاميا فاضحا لصالح تغطية
الغزو الروسي لأوكرانيا بالمقارنة مع تغطية ممارسات وجرائم الكيان
الصهيوني اليومية بفلسطين، والغزو الانكلو أمريكي للعراق وما سببه من
تخريب ينوء تحت آثاره الشعب العراقي حتى اليوم.
مثل زخات من المطر، تُبث البرامج « الإنسانية»، البريطانية والأمريكية،
متسللة إلى عقول المشاهدين والمستمعين، منذ لحظات الغزو الروسي الأولى.
يتم خلالها سرد تفاصيل معاناة الأوكرانيين بالدقائق، جراء القصف الروسي
وتهديم المباني وتهجير السكان، وبطولة مقاتلي المقاومة الأوكرانية ومن
ثم «صعوبة» وصول المهاجرين الى بلدان اللجوء وتأخر قبولهم مدة أسبوع أو
أسبوعين، متجاهلين المشروع البريطاني بإرسال اللاجئين إلى رواندا.
تصاحب هذه التغطية المكثفة المستمرة، على مدى 24 ساعة يوميا تقريبا،
حملة شيطنة منهجية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وإغلاق لكافة المنافذ
الإعلامية الروسية، وحتى منع المشاركات الرياضية والفنية والأدبية،
وحجب المحاضرات الأكاديمية الروسية.
تغطية مكثفة مستمرة، على مدى 24 ساعة يوميا تقريبا، تصاحبها حملة شيطنة منهجية للرئيس الروسي
التساؤل الذي تثيره هذه السيرورة الإعلامية، بعيدا عن أحقية روسيا
باحتلال أوكرانيا وهو فعل مدان، خاصة، لما سببه من معاناة للشعب
الأوكراني، هو لماذا لا نشهد ذات التغطية والمتابعة ومشاركة الاحاسيس
الإنسانية عن الفلسطيني الذي يعيش إحتلال أرضه صهيونيا منذ عام 1948 ،
ويقاوم بكل السبل الممكنة عنصرية المحتل وانتهاكاته وجرائمه وتهجير أهل
البلد في مخيمات، استحدثت كحل مؤقت تحول إلى واقع دائم، ولايحق له
العودة إلى أرضه، بينما يمنح المحتل أرضا اغتصبها لحثالات العالم؟
لماذا لا نشهد ذات التغطية عن النظام الإسرائيلي الصهيوني الذي صنفته
التقارير الحقوقية الدولية بأنه نظام فصل عنصري بعد رصد دقيق لممارساته
التي ، كما ذكر كينيث روث، المدير التنفيذي لمنظمة « هيومان رايتس
ووتش» في مقابلة له مع البي بي سي، منذ أيام، مؤكدا « أن إسرائيل لم
تتمكن من دحض أي من الوثائق التي استندنا إليها في تقريرنا». وكان
تقرير منظمة « العفو الدولية» قد ثبت الحقيقة نفسها قبل ذلك بأشهر.
لماذا باتت الإشارة الى جرائم الكيان الصهيوني، من بينها جرف البيوت
وقتل المدنيين وتدنيس الاماكن الدينية، وآخرها إقتحام المسجد الأقصى،
وإطلاق الرصاص الحيّ والغاز المسيّل للدموع وإلاعتداء على المصلّين، في
إنتهاكٍ صارخ لكلّ القواعد والأعراف الدولية، لا تذكر الا في حيز
أخباري عابر وبيانات تخلص، عادة، إلى مساواة المجرم بالضحية؟
لماذا باتت الإشارة الى جرائم الكيان الصهيوني، لا تذكر الا في حيز أخباري عابر وبيانات تخلص، عادة، إلى مساواة المجرم بالضحية؟
وفي الوقت الذي سارع فيه المجتمع الدولي، خلال دقائق، لإدانة روسيا
ودعم أوكرانيا، فانه لايزال صامتاً، بعد مرور 19 عاما، إزاء الغزو
الأنكلو أمريكي للعراق ونتائجه الكارثية المتبدية في تخريب البنية
التحتية للبلد، ودعم نظام طائفي فاسد، وانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة.
ولايزال المسؤولون عن التخطيط للغزو وتنفيذه والمتعاونون معهم يتمتعون
بغنائم الثروة النفطية، بلا محاسبة في بلد يعيش ثلث سكانه تحت خط
الفقر، بلا حماية قانونية في ظل انتشار السلاح بيد ميليشيات ترتدي
أقنعة أحزاب ومنظمات سياسية.
وإذا كان للفترة الزمنية المكرسة للتغطية الإعلامية قيمتها وتأثيرها،
ما الذي تعنيه تغطية أجهزة الإعلام البريطانية ، البي بي سي خاصة ،
الموسومة بـ « حياديتها «، المتعاطفة ، كلية، مع الأوكرانيين ، ضحايا
الغزو الروسي، منذ 68 يوما فقط ، ومعاناتهم من حالات الاكتئاب والصدمة
النفسية، بالمقارنة مع حرمان الفلسطيني من أرضه وبلده ومعاقبته بعدم
العودة الممتدة من الأجداد إلى الابناء والاحفاد منذ ما يزيد على
السبعين عاما؟ وكيف يُفسر رفض البي بي سي بث النداء الموجه من لجنة
طوارئ الكوارث البريطانية لصالح أهل غزة لعد تعرضهم للعدوان الإسرائيلي
عام 2009؟
وتبرز المساحة الزمنية التي كُرست لدعم الغزو الانكلو أمريكي للعراق
حجم التأثير الإعلامي لتحشيد العواطف تأييدا لايديولوجيا الخطاب.
فبينما لا تكف اجهزة الإعلام الغربية عن وصف مناهضة الاحتلال الروسي
بالمقاومة مُنعت / إختارت اجهزة الإعلام ذاتها وصف مناهضة العراقيين
للاحتلال الانجلو امريكي عام 2003 بالإرهاب، بل واكتفت القنوات
البريطانية مثلا، على مصادر الحكومة أو الائتلاف العسكري ، في أسابيع
الغزو الاولى . وحسب دراسة أكاديمية أجرتها جامعة كارديف شكل ذلك 11
بالمئة من التغطية وهي أعلى نسبة من بين جميع المذيعين التلفزيونيين
الرئيسيين. وكانت البي بي سي الأقل نسبة في اقتباس مصادر عراقية رسمية
، وأقل في استخدام مصادر مستقلة (وغالبا متشككة) مثل الصليب الأحمر.
ووجدت الدراسة أن هيئة الإذاعة البريطانية ركزت بشكل أقل على الضحايا
العراقيين ، الذين ورد ذكرهم في 22٪ من قصصها عن الشعب العراقي، كما
كانت الأقل احتمالاً للإبلاغ عن استياء العراقيين من الغزو.
وقام الباحث الاستقصائي المستقل توم ميلز بتوثيق تركيز البي بي سي، على
أسلحة «الدقة» عالية التقنية التي إستخدمتها القوات الامريكية ضد
العراق في حرب الخليج ، مما يوحي بأن كل ما أستخدم كان دقيقا . بينما
تبين، فيما بعد، أنها شكلت نسبة 9 بالمئة فقط من القنابل التي ألقيت
خلال الحرب. بل وحتى القنابل «الذكية» أخطأت أهدافها في 40 بالمئة من
الحالات. وكان الهجوم الأكثر دموية هو الذي تعرض له المدنيون العراقيون
دون سابق إنذار في الصباح الباكر من يوم 13 فبراير / شباط 1991، إذ
قصفت مقاتلتان أمريكيتان ملجأ العامرية، وسط بغداد. تم القصف بقنابل «
ذكية»، راح ضحيتها نحو 408 أشخاص، بينهم 52 طفلًا، عمر أصغرهم سبعة
أيام. لقد أدى تركيز أجهزة الإعلام على استخدام « الاسلحة الذكية» على
إضفاء النقاء على حرب دموية، حسب تعبير ميلز. بهذا المقياس، قد تُبرز
لنا الأيام المقبلة، بعيدا عن التضليل الإعلامي، مدى دموية كل الجهات
المشاركة في الحرب الروسية الأوكرانية وليست جهة واحدة.
كاتبة من العراق
بعيدا عن أوكرانيا… مبادرة
جديدة تتحدى شرطي العالم
هيفاء زنكنة
لتحدي سياسة فرض العقوبات الاقتصادية التي ترتكبها الولايات المتحدة من
خلال استخدام القانون، ولتسليط الضوء على الطبيعة غير القانونية،
والظالمة، والاستعمارية للتدابير الاقتصادية القسرية، أعلنت مجموعة من
المنظمات عن تأسيس ” المحكمة الشّعبية الدوليّة حول العقوبات
الإمبرياليّة الأمريكيّة”. من بين المنظمات الدولية : “معهد سيمون
بوليفار للسلام والتضامن بين الشعوب”، و”جمعية المحامين الوطنية”،
و”الجمعية الدولية للمحامين الديمقراطيين”، و”تحالف حقّ العودة
الفلسطيني في الولايات المتحدة”، و”صامدون” شبكة التضامن مع الأسرى
السياسيين الفلسطينيين، و”تحالف السود من أجل السلام”، و”مؤسسة فرانز
فانون”، وحركة “المسار الثوري الفلسطيني البديل”، و”التحالف من أجل
العدالة العالمية”.
تأتي المبادرة بناء على واقع تزايد فرض العقوبات، أمريكيا، على الدول
والحكومات والأفراد، آخرها منذ الغزو الروسي لأوكرانيا. وهي عقوبات
تهدف إلى إلحاق الضرر، بأقصى درجة ممكنة، على النظام المعتدي في ذات
الوقت الذي يضمن عدم إلحاق الضرر بالدولة أو الدول المشاركة في فرض
العقوبات، كما يتوخى قانونيا، عدم إلحاق الضرر بالشعوب. وهو ما لم
يحدث، وغالبا، كما يدل تاريخ فرض العقوبات، على أنظمة توصف بأنها
مارقة، لتعيش الشعوب عبء ضنك العيش وهدر الكرامة. حتى ولو كانت الأنظمة
لا تمثلها والمراد من فرض العقوبات استهداف رؤساء الأنظمة، في حقبة
زمنية معينة، بعد انتهاء صلاحيتهم، ومع تسارع عملية شيطنتهم. الأمر
المهم في هذه السيرورة المبنية على الضخ الإعلامي المؤدلج، والتزوير
وفبركة الأخبار والتلفيق المنهجي، من كل الجهات المتحاربة، هو تجاهل
وجود الشعوب المعرضة ليوميات العقوبات كشكل جديد من أشكال الحصار،
بتفاصيله المريرة، والذي لا يختلف إلا بالتسمية عن حصار التجويع
وانتشار الأمراض في القرون الوسطى. مما يجعل فرض العقوبات الاقتصادية
حربا من نوع آخر أو سلاحا لأخضاع الشعوب.
الأمر المهم في هذه السيرورة المبنية على الضخ الإعلامي المؤدلج، والتزوير وفبركة الأخبار والتلفيق المنهجي، من كل الجهات المتحاربة، هو تجاهل وجود الشعوب المعرضة ليوميات العقوبات كشكل جديد من أشكال الحصار، بتفاصيله المريرة
حاليًا، تقوم الولايات المتحدة الأمريكية، بدعم من الأمم المتحدة
والاتحاد الأوروبي، بفرض عقوبات وتدابير اقتصادية قسرية أخرى على أكثر
من 30 بالمئة من سكان العالم، معظمهم في آسيا وأفريقيا وأمريكا
اللاتينية، على الرغم من فشل العقوبات في تغيير سلوك أنظمة البلدان
الخاضعة للعقوبات؛ لكنها نجحت بالحاق الأذى بأفقر الناس في تلك
البلدان.
المعروف، أيضا، أن ثلثي العقوبات الـ 104 التي فُرضت في جميع أنحاء
العالم من عام 1945 إلى عام 1990، كانت من قبل أمريكا، وأحادية الجانب
دون مشاركة دول أخرى. وتشمل قائمة البلدان التي فرضت عليها عقوبات
طويلة الأمد كل من كوبا وإيران وكوريا الشمالية وسوريا.
ولا يمكن الحديث عن تأثير تطبيق العقوبات أو التدابير القسرية
الانفرادية على تمتع السكان المتضررين بحقوق الإنسان، ولا سيما تأثيرها
الاجتماعي والاقتصادي على النساء والأطفال، في الدول المستهدفة، إلا
ويأخذنا المسار إلى العراق. حيث عاش الشعب العراقي 12 عامًا و8 أشهر من
“الحصار”، بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 661 الصادر في 6 أغسطس / آب
1990. أثر الحصار على كل جانب من جوانب الحياة العراقية، مما تسبب في
تدهور اقتصادي سريع أدى إلى تدهور عموم الأوضاع. من التعليم والصحة
والخدمات العامة الأخرى، إلى البطالة الهائلة، والوفيات الزائدة
وتقريبا نهاية أي نوع من التنمية البشرية. إن دراسة آثار الحصار في ضوء
إعلان حقوق الإنسان، يبين بوضوح حجم وكيفية انتهاك حقوق الإنسان لجميع
العراقيين، النساء والأطفال على وجه الخصوص.
وقد قدرت منظمة ” اليونيسف” أن السنوات الخمس الأولى من العقوبات ضد
العراق أسفرت عن مقتل نصف مليون طفل دون سن الخامسة. كان ذلك في عام
1996، أي أقل من نصف الطريق خلال سنوات العقوبات، عندما كانت مادلين
أولبرايت، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة آنذاك، التي صرحت،
عند مواجهتها بهذه الحقيقة، قائلة أن “الثمن يستحق” تغيير نظام صدام
حسين.
ويأخذنا المثال الصارخ الآخر إلى فلسطين المحتلة التي تعيش حصارا
شاملا، يتبدى خاصة في قطاع غزة، الذي تحول منذعام 1994 من معسكر لاجئين
كبير إلى أكبر سجنٍ مفتوحٍ على سطح الكرة الأرضيّة يتعرض فيه السكان
للعدوان المستمر على كافة جوانب الحياة، حيث تتفاقم الآثار الاقتصادية
والصحية وارتفاع معدلات البطالة وانهيار المنظومة الصحية أمام الاصابات
والضحايا، فلم تعد المستشفيات ولا الأدوية ولا الأطباء قادرين على
مواجهة الكارثة الإنسانية. وتحولت حياة الناس إلى جحيم لا يطاق مُغّلف
بصمت المجتمع الدولي أما بقيادة أو مباركة أمريكية، لسياسة الإبادة
التي يمارسها كيان الاستيطان الصهيوني.
لذلك، يبدو تأسيس ” المحكمة الشّعبية الدوليّة حول العقوبات
الإمبرياليّة الأمريكيّة”، ضروريا. حيث ستستضيف المحكمة الشعبية، على
مدى ستة أشهر، من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران 2023، شهودا
خبراء، وقانونيين دوليين، ومقررين من 13 دولة مستهدفة حاليا بالعقوبات
والإجراءات القسرية، باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية لهيمنة
الإمبريالية الأمريكية، وكونها تسبب مجاعات ومعاناة جماعية للشعوب في
الجنوب العالمي، بينما تفتح الأسواق للشركات الأمريكية والأوروبية.
يُدرك منظمو المحكمة من محامين ونشطاء وعلماء، محدودية قدرة المحكمة
الشعبية القانونية على تحدي ما ترتكبه الولايات المتحدة من انتهاكات
وجرائم من خلال إجراءات قسرية متعددة الأطراف أو أحادية الجانب، إلا
انهم يؤمنون، بأن “المحكمة ليست مجرد تكتيك قانوني بل إنها أيضا أداة
تنظيمية”. قد تدفع مستقبلا إلى تطبيق القانون الدولي والإنساني بشكل
ينطبق على جميع الدول بلا استثناء، وألا يُستغل فرض العقوبات كأداة
لمعاقبة دول وحكومات وشعوب تحيد عن صراط أمريكا كشرطي للعالم، مهما
كانت طبيعة الحكومات، كما يجب عدم السكوت على انتهاكات حقوق وحياة
السكان لأن حكوماتهم في صراع مع دول قوية أو مؤسسات متعددة الملكية،
ووفق إنتقائية مخالفة للقوانين الدولية والإنسانية.
٭ كاتبة من العراق
نزيف العقل العراقي…
رحيل العلماء في الشتات
هيفاء زنكنة
كم من العلماء والأكاديميين وعموم المثقفين أجبروا على الرحيل من
العراق، على مدى العقود؟ يُجبر على الرحيل إما قمعا أو إهانة وإهمالا
أو لتلقيه طلقة في مظروف تستهدف حياته. في كل حقبة، يُنتزع من جسد
الوطن عقل ومحظوظ من بقي حيا تحت سياط القمع والغزو وتصفيات الاحتلال.
في المنفى، الذي غالبا ما يمتد ليشمل سنوات العمر كله، إما أن تتاح
للمنفي فرصة أن يترعرع ويزدهر في البلد الثاني، أو يذوي بعيدا عن
منبعه، يُدفن في أرض غريبة ملتفا بوجع القلب، حنينا إلى بلده. كم من
العقول العراقية ترجلت من قطار الحياة في محطات الشتات؟ قائمة الأسماء
طويلة لخسارة كبيرة كأشخاص وثروة وطنية. أليس الأنسان هو أغلى رأسمال،
فكيف به إذا كان عقلا منتجا للمعرفة؟
آخر الراحلين العراقيين في الشتات هو الأكاديمي منذر نعمان الأعظمي،
المتخصص في حقل تعليم الرياضيات إستنادا إلى علم النفس المعرفي
والابستيمولوجيا وعلم النفس الاجتماعي. رحل وهو يعمل، آخر أيامه، مع
أساتذة من جنوب أفريقيا لتطوير فهم وتعليم الرياضيات هناك، استمرارا
لما قام به طوال حياته في مجال الرياضيات وتطوير الذكاء.
في رثائه، كتبت بروفسورة مارغريت براون، رئيسة جامعة « كينغز كوليدج
للتعليم» – بجامعة لندن، لصحيفة « الغارديان» البريطانية « كان زميلي
وصديقي منذر الأعظمي، رائدا في مجال تعليم الرياضيات وناشطا سياسيا،
ركز على دعم المدرسين وحثهم على تنمية قدرة التلاميذ على التفكير،
وإعداد الدروس التي تشجع على المشاركة النشطة في التفكير الرياضي لجميع
الأطفال وتطوير الذكاء… كان منذر ناشطًا فكريًا، يحاول بلا كلل فهم
العالم وينخرط في نشاطات لتحسينه، سواء في التعليم أو السياسة. لقد كان
سخيا بوقته وتعاونه مع الآخرين، وكانت شراكته في العمل محفزة دائما،
وإن كانت مرهقة في بعض الأحيان».
وكان منذر قد عمل مع بروفسورة براون في الثمانينيات وحتى 1993، في
برنامج « التقييم المتدرج في الرياضيات» الذي أصدر 11 مجلدا يجمع بين
النظرية والتطبيق. وكان الباحث الرئيسي لبرنامج « التسريع الفكري عبر
الرياضيات» الذي أصدر مجلدات تعليمية، اعتُمِدَت رسميا من قبل وزارة
التربية البريطانية.
وحتى رحيله، كان منذر مديرا لـ« هيئة التنمية الفكرية» وهي مؤسسة خيرية
بريطانية مقرها لندن، تهدف إلى الاستثمار الكامل للإمكانات المعرفية
لدى التلاميذ من خلال إغناء المناهج الدراسية، وطرق التدريس والتطوير
المهني للمدرسين في المواد الدراسية الأساسية في المدارس الابتدائية
والثانوية.
كم من العلماء والأكاديميين وعموم المثقفين أجبروا على الرحيل من العراق، على مدى العقود؟ يُجبر على الرحيل إما قمعا أو إهانة وإهمالا أو لتلقيه طلقة في مظروف تستهدف حياته
من التعليم إلى السياسة، عمل منذر على صياغة برنامج « التدرج في
المساهمة الديمقراطية» مركزا على مجالات الخدمات غير السياسية التي
يمكن لمؤسسات المجتمع المدني تقديمها فيما أطلق عليه مصطلح « الاستثمار
الاجتماعي». وعن دور التعليم في البناء الديمقراطي في بلداننا، كان
سؤاله الأبرز: « من يُعلم المعلمين؟». هل بإمكانهم نقل قيم لم يتربوا
هم أنفسهم عليها، إلى طلابهم؟ وكيف يمكن حل هذه المعضلة في غياب النشاط
الصفي المحفز لصياغة أسئلة من قبل الطلاب أنفسهم، حيث تجري غربلتها
وبلورتها؟ هل يمكن الاعتماد على معلمين من بلدان وثقافات ولغات أخرى أم
علينا ابتداع طريق تجريبي يساهم فيه المعلمون والطلاب سوية يجمع بين
التفكير النقدي والتحليلي والتفكير الإبداعي التركيبي، مما يقود ضمنيا
إلى تقبل الاختلاف وبالتالي المواطنة والديمقراطية؟
من هذا المنطلق، ولأنه أراد نقل خبرته الى العالم العربي، حاول تقديم
دروسا نموذجية لتطبيق برنامج التسريع الذهني، مع أمثلة للرياضيات
الاستكشافية والتدرجية، بمدارس في تونس العاصمة، كما تمكن من إقناع
زملاء بريطانيين بالمجيء إلى تونس لإدارة ورشات تعليم دورية، الا أن
اهتمام المعلمين وأهالي التلاميذ بالنتائج السريعة لم يساعد على
استمرار المشروع أو الحلم الذي أراد من خلاله التعويض عما كان بالإمكان
إنجازه في العراق، كمبادرة فردية ـ تطوعية تحث وتحفز بمواجهة غياب
الإرادة السياسية للإصلاح التربوي،الذي يكاد يكون في إهماله « عاديا»
ومقبولا في معظم البلدان العربية. حاول منذر طوال مسيرته المهنية إيجاد
السبل لعلاج ظاهرة الخوف والنفور من الرياضيات الشائعة بين التلاميذ
وحتى المهنيين. استنادا الى قناعته « بأن سبب القلق والنفور هو أسلوب
التعليم نفسه، بحيث يتم إعادة إنتاج أو بث هذا القلق بين الأجيال
الجديدة من المعلمين أنفسهم دون قصد منهم».
وقد جعله شغفه وفضوله الفكري بالتساؤل في كل المجالات، وعمله على إيجاد
السبل لكي يسترد العراق عافيته، أقرب ما يكون الى رجل عصر النهضة في
اهتماماته الممتدة من ترجمة الشعر والكتابة الصحافية إلى الموسيقى
وكتابة مسرحية عن عائلة لا تلتقي، والرسم بمهارة وروح تليق بفنان.
أراه حاضرا، كما لو كان واقفا أمام مرآة، في ملاحظات سريعة كتبها عن
معرض حضره، بلندن، للوحة واحدة من لوحات ليوناردو دافنشي «اهتمامات هذا
الرجل متعددة بدءاً بالجيولوجي وانتهاء بالفن والمعاني الرمزية وتجاوز
زمانه. أعتقد أن دافنشي أقرب الفنانين للعلم كما هو للفن. لقد نجح فعلا
في تصوير البعد الثالث عبر الظلال وتقنيات اخرى يصعب فهمها».
في تونس، أغمض منذر عينيه للمرة الأخيرة. « في أرض الله الواسعة بعد
تشتت العراقيين. لا ضير في ذلك غير أن أجسادنا لن تزيد من خصوبة أرض
العراق». هو الذي غادر العراق ولم يغادره أبدا، حاملا فلسطين في قلبه،
مرددا أنها قضية ألعالم أجمع إذا أراد العالم أن يحافظ على إنسانيته.
على ضريحه، حُفرت ترنيمة تجمع بينه وبين رفيقه مظفر النواب والشاعر
التشيلي بابلو نيرودا وبدر شاكر السياب. « عراق… عراق… قلنا: يا هذا
الضالعُ بالهجرات / هل يوصلك البحر إلى العراق؟ / قال: أحمل كلَ البحر
وأوصِلُ نفسي».
كاتبة من العراق
يوم وطأ الغزاة أرض بغداد
هيفاء زنكنة
في التاسع من نيسان/ أبريل 2003، تسلق أحد جنود الغزو الأمريكي تمثالا
ضخما لرئيس العراق السابق صدام حسين، في ساحة بوسط بغداد، ليرفع العلم
الأمريكي، فوقه. معلنا الانتصار الأمريكي في لحظة إنتشاء، عاشها الرئيس
الأمريكي جورج بوش فيما بعد على ظهر باخرة عسكرية، قائلا «معركة العراق
انتصار واحد في الحرب على الإرهاب التي بدأت في 11 سبتمبر 2001 وما
زالت مستمرة» وأن قتال أمريكا هو «من أجل الحرية والسلام في العالم».
لخص بوش بذلك جوهر السياسة الأمبريالية تجاه العراق ودول الجنوب، مثيرا
في تلك اللحظة نفسها تساؤلا لا يزال حيا في ذاكرة الشعوب العربية
والإسلامية ومناهضي الحرب العدوانية في أرجاء العالم، مفاده الانتصار
على من؟
هل هو انتصار على رئيس دولة تم تضخيم خطره بواسطة آلة إعلامية باتت منذ
منتصف التسعينات سمة عصر ما بعد الحقيقة؟ أم على شعب أنهكته الحروب
والحصار الأشمل في التاريخ على مدى 13 عاما، بحيث تم إجبار مواطني
واحدة من الدول الأغنى في المنطقة على بيع كل ما يملكون فقط للبقاء على
قيد الحياة، وصار رفع العقاب الجماعي عن الشعب مشروطا بتغيير النظام؟
ويبقى السؤال الأهم، بعد مرور 19 عاما، من الغزو والاحتلال، عما تم
تحقيقه عراقيا وعربيا وغربيا، معلقا بارتفاعات وثقل غير متساو، على
رؤوس الشعوب، في مختلف المجالات. تم خلالها نشر آلاف الكتب والدراسات،
وإنتاج مئات الأفلام والمسرحيات، وإقامة المعارض. معظمها يحلل ويبرر
ويتغنى، في حالة الأفلام الامريكية، ببطولة وتضحيات القوات الامريكية
في محاولتها نشر «الديمقراطية» وإنقاذ العالم من خطر عراقي إرهابي
محتم. وفي مجال الغناء وتأليف الموسيقى، تراوح الإنتاج ما بين أغنية
الجندي الأمريكي الذي يتباهى بقتله مواطنين عراقيين والتي تطلق على
العراقيين نعوتا تسلخهم من إنسانيتهم ، ليسهل قتلهم، إلى الحفل
الموسيقى، وهو الأكثر شهرة، الذي أقيم في كانون الأول/ ديسمبر 2003 ،
بواشنطن إحتفاء بـ»الانتصار» الأمريكي بحضور مهندسي ومنفذي غزو العراق
من الرئيس بوش، والسيدة الأولى لورا بوش ، ووزير الدفاع دونالد
رامسفيلد ، ومستشارة الأمن القومي كوندوليزا رايس، إلى رند رحيم فرانكي
التي كوفئت على تعاونها مع الاحتلال بتعيينها سفيرة لدى الولايات
المتحدة. حضرت الحفل، أيضا، « النخبة» العراقية التي مهدت للغزاة طريق
الوصول إلى بغداد وفتحت أبواب الجحيم على العراقيين. هذه « النخبة»،
التي كان يجب إخضاعها للمساءلة والعقاب، جراء « خيانتها» والتعاون مع
العدو، كما فعلت فرنسا، مثلا، تجاه المتعاونين مع الاحتلال النازي،
صارت هي الرحم الخصب الذي أنجب للغزاة وكلاء يتكاثرون حتى الآن لتخريب
العراق وتركيع أهله.
لقد سقط الكثير من العراقيين ضحايا التضليل السيكولوجي الإعلامي الذي
مهد للغزو باعتباره خلاصا من الدكتاتورية وتحقيقا لحلم الديمقراطية،
و»مذاق الحرية الحلو» كما وعد كولن باول. واختارت غالبية الشعوب
الغربية أما تأييد حكوماتها المدافعة عنها ضد «أسلحة الدمار الشامل» أو
إنتظار جني الغنيمة الاقتصادية أو الصمت لأن ما يحدث في أماكن نائية لا
يعنيها. كان هذا واقع عام 2003، عام اعلان « الانتصار الأمريكي»، فما
الذي تغير حاليا؟ عراقيا وعالميا؟ ما هي سردية الشعب الذي ذاق يوميات
الاحتلال ونتائجه من القضاء على الدولة، وتنصيب وكلاء متعددين معززين
بالميليشيات إلى نثر بذور الإرهاب ونمو أعشاب الطائفية والمحاصصة
الضارة؟
فرض مسار التدهور الداخلي العام، بكل المستويات، من السياسي الى
الاقتصادي وكل ما له علاقة بتوفير اساسيات الحياة بكرامة، ومع نمو جيل
جديد من الشباب ( ربع سكان العراق لم يكونوا مولودين في عام الغزو) ،
تغيرا محسوسا في الموقف من النظام السابق والحالي والأحزاب القديمة
المتآكلة والجديدة المولودة حسب الطلب. تبدى التغير بأوضح صوره في
إنتفاضة تشرين الأول/ أكتوبر 2019، التي طالبت بوطن خال من «الوكلاء»
المعتمدين خارجيا، الذين لا يمثلون أبناء الشعب وإن أجادوا رطانة
الادعاء بذلك بلغة تجمع ما بين التستر بالدين وممارسات الفساد المادي
والأخلاقي. وهي وليدة تجذر الهيمنة الامبريالية بشكل عقود و»استثمارات»
في بلد بات مقسما، عمليا، بين ثلاث حكومات يُطلق عليها تسميات: حكومة
بغداد وحكومة إقليم كردستان بفرعيها في أربيل والسليمانية. ينخرها كلها
التهافت على السلطة والوقوف متفرجة على تحويل البلد الى ساحة للتفاوض
واستعراض العضلات بين أمريكا وإيران.
أمريكيا، يلخص أنتوني كوردسمان الذي شغل مناصب عليا في الإدارة
الأمريكية كمختص بالأمن الأمريكي، وسياسات الطاقة، وسياسة الشرق الأوسط
المنظور السائد في التقييم الغربي لما يطلقون عليه مصطلح حرب العراق،
تزويرا لحقيقة إنها حرب ضد العراق، قائلا: «منذ سقوط صدام حسين في عام
2003 وحتى الوقت الحاضر، لم يكن لدى الولايات المتحدة مطلقًا
استراتيجية كبيرة قابلة للتطبيق للعراق أو أي خطط وإجراءات متسقة
تجاوزت الأحداث الجارية.» وهو منظور لا يتماشى إطلاقا مع وجهة النظر
السائدة، عموما، في العراق وكل البلدان التي تعيش محنة تغيير أنظمتها،
مهما كانت طبيعتها، أو احتلالها، أو معاقبتها بفرض العقوبات
الاقتصادية.
هناك بالتأكيد استراتيجية أمريكية تجاه العراق. وهي التي صاغها
المحافظون الجدد في مشروع القرن الأمريكي الجديد ونفذها مسؤولو الإدارة
الامريكية برئاسة بوش وواصل العمل بها من تلاه من رؤساء. إنها
استراتيجية شاملة تهدف الى إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط. كان العراق
نقطة البداية فيها، وصاحب المصلحة الأولى فيها، بعد أمريكا، هو كيان
الاحتلال الصهيوني. فحركة توقيع الاتفاقيات والتطبيع مع المحتل
الصهيوني وتسارع الهيمنة الامبريالية وفرض السياسات الاقتصادية
الاستغلالية هو وجه من أوجه تلك الاستراتيجية خاصة بعد تفكيك الدولة
العراقية وما تلاها من خراب في ليبيا واليمن ولبنان وسوريا.
وإذا كانت الاستراتيجية قد تعثرت جراء مقاومة الشعب العراقي فإن هذا لا
ينفي وجودها. وتتطلب مواجهتها وجود مقاومة تجمع بين المقاومة المحلية
وحركات التضامن العالمية النابعة من بطن الوحش نفسه.
كاتبة من العراق
في الغزو الأمريكي للعراق
كانت مفردة “المقاومة” ممنوعة
هيفاء زنكنة
هل نقول شكرا لبوتين لأنه جراء غزوه لأوكرانيا، أيقظ العالم ربما
للحظات، على مآس تُسّطرتها آلة الناتو، بقيادة أمريكا، الواحدة تلو
الأخرى، من غزو وإحتلال وتغيير أنظمة، وكأن التاريخ يكرر نفسه لا لشيء
إلا لأنه يكرر نفسه أو ربما لأن العالم لا يتعلم؟
هل ما يتم تداوله، الآن، بغضب وألم يماثل آلام من تلقى ضربة قوية على
رأسه، جديد؟ أعني التصريحات العنصرية، من معلقين وصحافيين، يرون في غزو
أوكرانيا وتهجير أهلها موقفا غير حضاري لأن الأوكرانيين ليسوا مثل
العراقيين والأفغان وعموم سكان الشرق الأوسط، لأنهم من جنس ” منا”
وليسوا من ذلك الجنس غير الحضاري ” منهم”؟ لأنهم من مواطني العالم
الأول وليسوا من العالم الثالث؟
هل طفت التعليقات العنصرية في لحظات تأثر إنساني بما يجري في أوكرانيا
حقا أم أنها العنصرية المستدامة، مثل فايروس يستوطن الجسد، قد يركن
للسبات حينا إلا انه سرعان ما يعود إلى الظهور بقوة حين تكون الظروف
ملائمة؟
إن جذور العنصرية حية على الرغم من قدمها والادعاءات التي يتم تسويقها
بأنها على وشك الانقراض. ويكفينا إلقاء نظرة واحدة على موقف العالم ”
الحضاري” من الشعب الفلسطيني، وكيف أنه يمد المستعمر الصهيوني
الاستيطاني بمليارات الدولارات شهريا ليواصل إبادة الشعب الفلسطيني
باسم حق إسرائيل في الوجود ومواجهة الإرهاب الفلسطيني، لندرك أن كل ما
حدث، في العقود الأخيرة، هو منح العنصرية أسماء جديدة وتعليبا مغايرا
يبيعها بشكل ” إنساني”. ربما ما نحتاجه الآن للتعرف على وجه العنصرية –
الحضاري” الأبيض”، العاري الآن، العودة إلى حقبة استعمار الجزائر
وأفريقيا، والنظر أبعد من السطح الإعلامي الذي يحجب الرؤية، وقراءة
كتابات المفكر فرانز فانون، المعروف بنضاله من أجل الحرية ومناهضة
الاستعمار والعنصرية. كما سيساعدنا تذكر (إن حدث ونسينا) تفاصيل غزو
واحتلال العراق من قبل ذات التحالف الأمريكي البريطاني – الدولي، الذي
يتباكى حاليا على غزو أوكرانيا.
لا تختلف التغطية الإعلامية الشاملة لصالح أمريكا ودول الناتو، هذه الأيام، عن التغطية التي تم تصنيعها قبل وأثناء وبعد غزو العراق عام 2003
لاحظت وأنا اتابع البث المباشر لما يجري في أوكرانيا، محاولة القنوات
الغربية نقل عدة أحداث في آن واحد من خلال تقسيم الشاشة إلى أربعة
أقسام. يبين أحدها حجم الخراب الذي يسببه القصف الروسي والثاني هرب
السكان مع إبراز صور النساء والأطفال خاصة، والثالث تصريحات الرئيس
الاوكراني البطولية. والرابع مكرس لشباب وصبيان يتدربون على السلاح تحت
عنوان ” المقاومة”. أعادني هذا التدريب على السلاح وبضمنه تصنيع قنابل
المولوتوف الحارقة بعنوان المقاومة، إلى الاعوام التالية للغزو
الأمريكي للعراق وكيف طُلب مني، حين كنت أكتب لصحيفة “الغارديان”
البريطانية، كتابة رأي لصحيفة ” لوس أنجلوس تايمز” الأمريكية، عن الوضع
في العراق، فعلمت بأن إدارة الصحيفة كانت قد أصدرت توجيها داخليا لكل
الصحافيين بعدم استخدام مفردة ” المقاومة” عند وصف مقاومة العراقيين
للاحتلال الأمريكي بل: “تمرد” أو ” عصيان” أو ” إرهاب”. بررت الصحيفة
موقفها بأن مفردة المقاومة مرتبطة في أذهان الناس بمقاومة الشعب
الفرنسي للغزو النازي وهي مفردة إيجابية، وهذا ما لا يراد بالنسبة الى
العراق. وتحدث الإعلامي والكاتب التروتسكي المعروف كريستوفر هتشنغ عن
شعوره بالغثيان عند استخدام البعض” المصطلح الوصفي “المقاومة العراقية”
لوصف المسؤولين عن مهاجمة القوات الأمريكية… لأن العديد من أولئك الذين
يقاتلون هم إما جزء من الشرطة السرية السابقة للنظام أو تم استيرادهم
من الجماعات الجهادية خارج البلاد”!
أما في المقابلات التلفزيونية الأمريكية والبريطانية، فإن أي ذكر
لأسباب الغزو الحقيقية، وأي إشارة إلى تصنيع الأكاذيب المبررة للغزو
كأسلحة الدمار الشامل، والتشكيك بوجود علاقة بين النظام العراقي
والقاعدة، كان غالبا ما يقود، أما إلى إنهاء المقابلة بشكل سريع أو
مطالبتي بالجواب بصيغة نعم أو لا، أو وضعي في قفص الاتهام الجاهز
كمساندة لنظام صدام حسين.
ولا تختلف التغطية الإعلامية الشاملة لصالح أمريكا ودول الناتو، هذه
الأيام، عن التغطية التي تم تصنيعها قبل وأثناء وبعد غزو العراق عام
2003، مع فارق أساسي، وهو أن القوات الغازية لم تكن روسية بل أمريكية –
بريطانية ومعها الأوكرانية. أيامها أُطلق على الغزو، وحملة” الصدمة
والترويع”، وقصف البنية التحتية، وقتل المدنيين أسم يليق بحضارة الغزاة
وهو ” عملية حرية العراق”.
وحين قاوم العراقيون الغزاة لم تُكتب المقالات، ولم تُعرض الأفلام
الإنسانية المؤثرة عن استعداد وتهيئة الشباب وتدريبهم للانضمام الى
المقاومة. لم تُنشر صورهم أو يُكتب عن حبهم للوطن ودفاعهم عنه. كانت
معظم القصص المنشورة والمتلفزة عن شجاعة الجنود الأمريكيين
والبريطانيين أثناء مواجهتهم ” الإرهابيين العراقيين”. ولم يتم ذلك
اعتباطا بل جاء جراء تدريب مكثف لحوالي 600 صحافي وإعلامي، قامت وزارة
الدفاع الامريكية بتدريبهم في برنامج خاص للتعايش، بشكل كامل، مع قوات
كانت تتهيأ للقتال في العراق. حيث خلقت المعايشة حالة تماهي بين الجنود
والصحافيين الذين سُمح لهم بالبقاء مع القوات اثناء الغزو الفعلي وفي
المعسكرات داخل العراق، بعد أن وقع المراسلون عقدا ينص على “القواعد
الأساسية”، أي السماح بمراجعة تقاريرهم من قبل المسؤولين العسكريين،
وأن تتم مرافقتهم في جميع الأوقات من قبل عسكريين، والسماح بطردهم في
أي وقت ولأي سبب. فكان من الطبيعي أن يقوم المراسل المتعايش مع القوات،
بسرد قصة الحرب من وجهة نظر الجنود والتأكيد على النجاحات العسكرية
وبطولات جنود الاحتلال، وليس على عواقب الغزو على الشعب العراقي. وقد
بينت دراسة أجراها الأكاديمي الأمريكي أندرو لندنر عن السيطرة على
الاعلام في العراق، أن رصد 742 مقالاً بقلم 156 صحافياً بينت أن 93
بالمئة من المقالات التي كتبها صحافيون متعايشون مع قوات الاحتلال
استخدموا جنودا كمصادر لأخبارهم، بينما أشارت 12 في المائة فقط من
المقالات إلى الخسائر البشرية التي سببتها الحرب على الشعب العراقي.
أن عملية خداع الجماهير التي هندّستها أمريكا ودول الناتو لأنجاح غزوها
العراق، تلاقي هذه الأيام، وفي ذات الشهر، انعكاس صورتها في الغزو
الروسي لأوكرانيا. وسترينا الأيام المقبلة، في خضم الاحداث المتسارعة،
إذا كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيقف كما وقف جورج بوش، على دماء
الضحايا ليعلن الانتصار الأمريكي.
٭ كاتبة من العراق
غزو أوكرانيا
بتعليقات عراقية
هيفاء زنكنة
إذا كانت مؤسسات سبر الرأي العربية والعالمية غير قادرة على تزويدنا
بوجهة نظر الشعوب إزاء حدث دولي بسرعة توازي وقائع الحدث نفسه، كما
يحدث حاليا حول مجريات الأمور في أوكرانيا، فإن صفحات التواصل
الاجتماعي بأنواعها، استلمت عجلة القيادة، لتصبح فضاء مفتوحا لكل من لا
تستهدفه مؤسسات سبر الآراء، عادة، لأبداء الرأي. حيث تُلزم مؤسسات سبر
الآراء المشاركين بالإجابة على أسئلة تحددها المؤسسة لتُشكل الخلاصة
جزءا من صناعة الرأي المقنن، وهذا ما لا يلتزم به كتاب التعليق
والتحليل على صفحات التواصل، المفتوحة لكل أنواع الكتابة، وإبداء الرأي
بحرية وعفوية وشاعرية وتوليفة مشاعر متأججة تراوح بين الصدق والابتذال،
بين المديح والهجاء، بين اللغة الجادة والسطحية، بين نقل الخبر المتميز
بموضوعية الرصد وتدقيق فحوى ما يتم والخبر الملفق مع إضافة الصور
المزورة.
من هذا المنطلق، في العالم الفيسبوكي المتسع لكل البلدان، الغني
المتأجج بديناميكية سرعة الأحداث حول العالم، وما تحفزه من تحليلات
عميقة لدى البعض، وما تثيره من شحنات عاطفية قد تطغي، أحيانا، لفرط
سرعتها، على التأمل وحتى القدرة على التفكير الموضوعي، لدى البعض
الآخر، يُسطّر العراقيون، وجهات نظرهم عما يجري في العالم. آخر ما
استحوذ على اهتمامهم، سيرورة الاستعداد لشن الحرب في أوكرانيا وتفاصيل
وقوعها. وهل هناك من هو أكثر فهما لأسباب الحروب وما تُسببه من العراقي
الذي عاش، عبر أجيال، حروبا وُصفت الأولى منها، أي الحرب العراقية
الإيرانية، بأنها الأطول في التاريخ المعاصر، وتم تعبيد الثانية، أي
حرب الخليج الأولى، بطريق الموت وفرض الحصار ورش المواطنين باليورانيوم
المنضب (1991 ـ 2003) وتلاها حملة « الصدمة والترويع» ـ الغزو
والاحتلال (2003) ليواصل العراقي رحلة بقائه وفي داخله جرح لم يلتئم في
بيئة مُدمِرة بتأثير أكثر ضررا من آثار القاء القنبلة الذرية على
هيروشيما وناكازاكي؟
من واقع الحروب المضني، وسياسة بذر الشقاق تحت الاحتلال، كُتبت
التعليقات العراقية. منها ما هو مؤيد للرئيس الروسي بوتين في إحتلاله
أوكرانيا. لا حبا ببوتين وسياسته ولكن « هكذا يتم تأديب الإمبريالية
والصهيونية والرجعية» خاصة وأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي/
الذي يعرفه أحد المعلقين بأنه «نازي صغير، عميل لأمريكا والغرب، مغرر
به» معروف بمساندته للمحتل الصهيوني، وجاء إعلان «الكيان الصهيوني
الغاصب موقفه بجانب أوكرانيا» ليؤكد صحة موقف الرئيس بوتين. ولأن ذاكرة
الشعوب، خلافا لما يعتقده الساسة، طويلة وجرائم الإبادة لا تُنسى بل
تبقى بوحشتيها ولا عدالتها متجذرة من جيل إلى آخر، استعادت التعليقات
مشاركة أوكرانيا في غزو العراق عام 2003 وكانت القوات الأوكرانية
متمركزة في محافظة واسط. ونشرت صور دبابات تحمل العلم الأوكراني أثناء
الغزو مع تعليق شامت» الحياة تدور. ذُق ما صنعت يداك في حرب العراق».
ورأى عدد من المعلقين في خطوة بوتين «هل أشعلت روسيا النيران في البيت
الأمريكي باجتياحها أوكرانيا ليبدأ العد التنازلي بانهيار امبراطورية
الشر والجماجم؟».
من قلوب عراقية ذاقت معنى الحرب وما تسببه من خوف وجوع وحصار وموت، وتعرف جيدا حجم الخراب البشري والعمراني الذي يستمر زمنا طويلا بعد انتهائها، انطلقت الأصوات داعية «أن ترتفع راية الأمن والسلام في العالم كله
وكان للرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، حصة الأسد في التعليقات المفككة
لازدواجية المعايير في إعلان التضامن الأمريكي «الإنساني» مع الشعب
الأوكراني، حيث وصف احتلال أوكرانيا بالبلطجة داعيا الى حل الأمور
بالتفاهم والسلام، بينما سجل له التاريخ إصراره المسعور، سوية مع رئيس
وزراء بريطانيا توني بلير، على شن الحرب على العراق، التي لايزال
العراقيون يعيشون آثارها وانعكاساتها. تشارك الإدارة الأمريكية في
تباكيها على استقلال وسيادة أوكرانيا ذات الدول الأوروبية «التي شاركت
في غزو العراق وكأن مشاركتهم كانت قانونية وضمن الشرعية الدولية. كم هم
منافقون ولاأخلاقيون».
استرجعت بعض التعليقات شجاعة الجيش العراقي بمواجهة الغزو الأمريكي
بالمقارنة مع انهيار الجيش الأوكراني أمام الهجوم الروسي، على الرغم من
ضعف تسليحه خلال سنوات الحصار والتفوق الجوي لقوات التحالف بقيادة
أمريكا. وفي الوقت الذي رحب فيه معلقون بخروج تظاهرات في قلب سان
بطرسبرغ في روسيا ضد الحرب ونشر أحدهم مخاطبا المتظاهرين «تتظاهر في
قلب سلطة ديكتاتور مجنون قاتل في يوم إعلانه للغزو؟ أنت شجاع» رأى آخر
أن ما قام به بوتين « مقدمة لولادة بلاشفة جدد وحركات ثورية في وسط
أوروبا، وفي العالم، تكنس اليسار المتهالك الحالي والعاجز لمواجهة
عدوان إمبريالي أمريكي غربي صهيوني مستمر لا ينتهي إلا بالإطاحة بهذا
الغول الإمبريالي».
ولم تخل التعليقات من روح النكتة والسخرية السوداء والتهكم الذي برع
فيه العراقيون في العقدين الأخيرين كأداة لمداواة جروحهم ومقاومة
لامعقولية الواقع. من بين التعليقات ومعظمها يتناول الرئيس الأمريكي جو
بايدن وأمريكا: « حكمة تعلمتها من أوكرانيا أن البيت الأبيض لا ينفع في
اليوم الأسود». وفي تصريح لبايدن: بوتين بدأ غزو الأراضي الأوكرانية
والعراق سيدفع ثمنا باهظا! وخبر عاجل: بايدن يحذر الجيش الروسي من دخول
أوكرانيا بدون فحص بي سي آر! أما بوتين فقد نشرت عدة مواقع صورته
مرتديا الزي العراقي العشائري تأكيدا لقوة مكانته وقدرته على مواجهة
التحديات وعدم تنازله عن حقه. أثناء ذلك كله علق مهندس عراقي يعيش في
كييف، عن حاله تحت القصف الجوي: استيقظت وكأنني في بغداد.
عموما، أجمعت التعليقات على شجب الغزو الروسي وتصعيد دول الناتو، خاصة
أمريكا «ذات السجل الدامي في استهانتها باستقلال وسيادة الدول وغطرستها
العسكرية». واقتصرت التعليقات الساخرة على الرؤساء، مستهدفة الرئيس
الأمريكي والروسي، وإن بدرجة أقل، وكأن هناك إتفاقا عاما على التمييز
بين تطلعات الشعوب في العيش بلا حروب وسياسة الحكومات التي لم يعد
أغلبها ممثلا حقيقيا للشعب، على الرغم من كل ادعاءات الديمقراطية وحقوق
الإنسان.
ومن قلوب عراقية ذاقت معنى الحرب وما تسببه من خوف وجوع وحصار وموت،
وتعرف جيدا حجم الخراب البشري والعمراني الذي يستمر زمنا طويلا بعد
انتهائها، انطلقت الأصوات داعية «أن ترتفع راية الأمن والسلام في
العالم كله» ووضع حد لحرب مجنونة، أخرى، لن يخرج أحد منها منتصرا.
كاتبة من العراق
دفع التعويضات… حين تكون
أمريكا هي القاضي والجلاد
هيفاء زنكنة
في الوقت الذي أعلنت فيه الأمم المتحدة حاجتها إلى 5 مليارات دولار
لتجنب كارثة إنسانية في أفغانستان، أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن،
قرارا برفع الحجز عن 7 مليارات دولار من الأصول التابعة للبنك المركزي
الأفغاني، وتخصيص 3.5 مليار دولار منها لعائلات ضحايا اعتداءات 11
سبتمبر. ومن باب المفارقة السوداء يتزامن هذا القرار مع إصدار مجلس
إدارة لجنة التعويضات في الأمم المتحدة تقريرا يبين أن «حكومة العراق
قد أنجزت كامل التزاماتها الدولية لتعويض كل المطالبين الذين منحت لهم
التعويضات من قبل اللجنة للخسائر والأضرار التي عانوا منها في نتيجة
مباشرة لغزو العراق غير القانوني للكويت». وقد دفع العراق تعويضات
قدرها 52.4 مليار دولار لقرابة 2.7 مليون مطالبة من أفراد وشركات
وحكومات ومنظمات دولية، بعد إصدار مجلس الأمن برئاسة الولايات المتحدة
الأمريكية قرارا بوجوب دفع التعويضات من نسبة مئوية من العائدات
المتأتية من مبيعات تصدير النفط والمنتجات النفطية العراقية. وقد
حُدِّدت هذه النسبة المئوية في الأصل بنسبة 30 في المائة وتم تخفيضها
على مر السنين. ولم يُحسم القرار النهائي بعد، بانتظار تقديم إحاطة إلى
مجلس الأمن في 22 شباط/ فبراير.
وما يجعل المفارقة أشد إسودادا، أن تكون أمريكا هي التي اخترعت فكرة
دفع التعويضات والديون المترتبة على بلدان متحاربة بعد أن كانت السياسة
العامة، وحتى نهاية الحرب العالمية الأولى، هي إلغاء ديون كل الأطراف
المساهمة في أي حرب كانت، استمرارا لما سنته شريعة حمورابي، في بابل
(العراق) حوالي 1800 سنة قبل الميلاد. وقضت تلك الشريعة بأن الحروب تضر
الجميع ولا بد من بدء صفحة جديدة بدون ديون وانتقام. إلا أن إصرار
أمريكا على استعادة ديونها المترتبة على بريطانيا وفرنسا بعد الانتصار
على ألمانيا، دفع بريطانيا إلى إجبار ألمانيا على دفع تعويض لكل
الخسائر التي سببتها الحرب حتى تتمكن بريطانيا من دفع ديونها لأمريكا.
وكان إجبار المانيا ذلك أهم أسباب صعود النازية والحرب العالمية
الثانية. ومع مأسسة سياسة التعويضات جاءت سياسة العقوبات الاقتصادية
وحجز الأموال. كانت هذه بذرة تأسيس مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع
لوزارة الخزانة الأمريكية، لإدارة وتنفيذ العقوبات الاقتصادية
والتجارية « بناءً على السياسة الخارجية وأهداف الأمن القومي ضد الدول
والأنظمة الأجنبية المستهدفة والإرهابيين ومهربي المخدرات الدوليين
والمتورطين في الأنشطة المتعلقة بانتشار أسلحة الدمار الشامل
والتهديدات الأخرى للأمن القومي أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد
للولايات المتحدة». ومن يراجع تفاصيل تطبيق هذا القانون سيجد أن الوجه
الآخر لسياسة الردع المعلنة هو حصول أمريكا على مورد مادي جراء ما
تسميه « الانتهاكات» يساعد مهما كان صغيرا، على تعزيز مكانتها كشرطي
عالمي لا يقبل الاخلال بسلطته على « الآخرين» سواء كانوا افرادا أو
حكومات.
فقد فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية غرامة قدرها 20 ألف دولار على
منظمة «أصوات في البرية» المؤلفة من متطوعين شبان رائعين في بريطانيا،
لتبرعها بأدوية للعراقيين في الفترة التي فُرض فيها الحصار (1991-
2003).
إن القرار الأمريكي بتجميد الأرصدة الأفغانية، ومنح نصفها كتعويضات لضحايا 11 أيلول/ سبتمبر، بينما يعيش الشعب الأفغاني مأساة الحاجة الإنسانية والكفاح للحصول على أبسط مقومات الحياة
كما فرض المكتب قدرها 10 آلاف دولار بالإضافة إلى الفائدة، ضد ناشط
السلام بيرت ساكس لأخذه أدوية لسكان البصرة؛ وأسقطت المحكمة التهم
الموجهة إليه في ديسمبر / كانون الأول 2012، بعد أن قضى سنوات من عمره
مفندا القرار بل ورفع دعوى ضد المكتب، متهما الحكومة الأمريكية
بالإرهاب استنادا الى تعريف القانون الأمريكي للإرهاب، والذي ينص بأنه
« فعل يشكل خطرًا على حياة الإنسان أو يُحتمل أن يدمر البنية التحتية
أو الموارد، ويبدو أنه يهدف إلى تخويف أو إكراه السكان المدنيين ؛
للتأثير على سياسة الحكومة بالترهيب أو الإكراه ؛ أو للتأثير على سلوك
الحكومة بالدمار الشامل أو الاغتيال أو الاختطاف». قدم بيرت دعما
لقضيته مئات التقارير الطبية والأدلة التي تُثبت مسؤولية أمريكا عن موت
مئات آلاف الأطفال العراقيين واستهداف المدنيين عمدا، وتدمير البنية
التحتية، وفرض الحصار الاقتصادي، الذي وصفه عدد من مسؤولي الأمم
المتحدة بأنه إبادة جماعية، مستشهدا بتقرير كشف ان هدف أمريكا هو « من
خلال جعل الحياة غير مريحة للشعب العراقي، ستشجعهم العقوبات في النهاية
على إزاحة الرئيس صدام حسين من السلطة».
ولتحقيق ذات الغرض، تواصل أمريكا سياستها الخارجية المستهدفة، في
حقيقتها، للشعوب وليس الأنظمة، من خلال فرض العقوبات الاقتصادية وتجميد
الأرصدة ودفع التعويضات. بينما تواصل سياستها الخارجية نفسها، على
إختلاف الرؤساء، في شن الحروب وإسقاط أي نظام يبادر لتحقيق الاستقلال
الحقيقي وتمثيل مصالح شعبه. فمنذ عام 1947 حتى 1989، مثلا، حاولت
أمريكا 72 مرة تغيير حكومات دول أخرى. سبقها قصف جماعي لمدن يابانية
وألمانية خلال الحرب العالمية الثانية، وقصف نووي لهيروشيما وناغازاكي،
وتلاها رش فيتنام بالعامل البرتقالي السام، وذخائر اليورانيوم المنضب
على العراق، والعقوبات الاقتصادية على كوبا وإيران وسوريا. كل هذا ولم
يحدث ودفعت أمريكا تعويضا لضحاياها في البلدان التي عملت على تدميرها.
وكما فُرض على الشعب العراقي دفع تعويضات خيالية، حيث تم، مثلا، تسعير
رأس الخس الذي تناوله الجندي الأمريكي بـ35 دولارا، تواجه كوبا حاليًا
5911 دعوى قضائية أقامتها شركات وأفراد فيما يتعلق بمصادرة ممتلكات
وأصول أخرى في الجزيرة بعد عام 1959، وتسعى معًا للحصول على تعويض
يقارب 7 مليارات دولار، بعد أن جمدت أمريكا 253 مليون دولار من الأصول
الكوبية في عام 2012.
إن القرار الأمريكي بتجميد الأرصدة الأفغانية، ومنح نصفها كتعويضات
لضحايا 11 أيلول/ سبتمبر، بينما يعيش الشعب الأفغاني مأساة الحاجة
الإنسانية والكفاح للحصول على أبسط مقومات الحياة، هي عملية نهب تماثل
نهب العراق المتواصل سواء عن طريق العقوبات الاقتصادية ودفع التعويضات
أو الغزو وتحطيم البنية التحتية وتنصيب حكومات فساد بالنيابة.
كلاهما استمرار لسياسة استعمارية قديمة ولكن بتبريرات جديدة تُسوغ
الإبادة الجماعية، بشعارات نبيلة مثل التدخل الإنساني وحماية حقوق
الانسان، خاصة المرأة. وستبقى أمريكا تتصرف باعتبارها القاضي والجلاد
ضد من تشاء، حتى تتمكن الشعوب وحكوماتها الوطنية المستقلة الممثلة لها
بشكل حقيقي، من تطبيق القانون الدولي ومساءلة أمريكا على جرائمها ودفع
التعويضات لضحاياها.
كاتبة من العراق
هل من جدوى لليوم
العالمي للعدالة الاجتماعية؟
هيفاء زنكنة
في ظل وضع يُهان فيه المواطن، في معظم بلدان العالم، على مدى أيام
السنة، تبّنت منظمة الأمم المتحدة، في عام 2007، تخصيص يوم 20
شباط/فبراير، من كل عام، للاحتفال باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية،
تحت شعار « العدالة الاجتماعية والحياة الكريمة للجميع». وهو شعار
اقترحه اتحاد العمال الروسي. عرَّفت منظمة الأمم المتحدة العدالة
الاجتماعية بأنها « المساواة في الحقوق بين جميع الشعوب، وإتاحة الفرصة
لجميع البشر، من دون تمييز، للاستفادة من التقدم الاقتصادي والاجتماعي
في جميع أنحاء العالم». مؤكدة في بياناتها وبالاتفاق مع مائة من رؤساء
الدول، بـأن لا غنى عن التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية لتحقيق
السلام والأمن وصونهما داخل الدول وفيما بينها. وهو ما لن يتم بدون أن
تضع الحكومات خططا تسعى من خلالها للقضاء على الفقر والبطالة،
والتمييز، بسبب الجنس أو السن أو العرق أو الدين أو الثقافة أو العجز.
واعتمدت منظمة العمل الدولية، الإعلان تحت شعار « عولمة عادلة « للجمع
بين مسؤولية الحكومات المحلية والعالمية، بعد أن تسللت العولمة إلى كل
الدول في جميع أرجاء العالم، ومع تزايد حجم الفجوة الاقتصادية بين
الدول المتقدمة والنامية.
ومثل كل المواثيق والإعلانات الصادرة عن الأمم المتحدة، سارعت
الحكومات، بضمنها حكومات عربية، إلى الترحيب بالإعلان (وهو بالتأكيد
نبيل المضمون) ومن ثم استخدامه كواجهة لتزيين واقع لا تتوفر الإرادة
السياسية لتغييره، أو لا قدرة للنخبة الحاكمة على تغييره، جراء انتشار
وباء الفساد من جهة وقدرة الرأسمال الاحتكاري الدولي على إجهاض أية
خطوة تتجه نحو القضاء على التفاوت أو اللامساواة الاقتصادية من جهة
أخرى. فكما هو معروف يرتبط مفهوم العدالة (أو الإنصاف) بشكل رئيسي
باللامساواة الاقتصادية، وغالبا ما يكون التوزيع العادل للثروة وما
يترتب على ذلك من تكافؤ في الفرص هو الأساس الذي تُبنى عليه المساواة
السياسية والتمتع بحقوق الإنسان وتعزيز التنمية والكرامة الإنسانية.
ولأن لمفهوم العدالة الاجتماعية، بنوعيها القانوني المفترض معاملة
الفرد كمواطن، والعادات والتقاليد المتجذرة في المجتمع المتجاوزة
للقوانين، تعريفات تجمع ما بين الحرية الفردية وتكافؤ الفرص بالإضافة
إلى الاستغلال الاقتصادي من قبل البلدان الرأسمالية للأيدي العاملة في
البلدان النامية، ولأن تعريف الأمم المتحدة لا يغطي كافة الجوانب من
ناحيتي الأسباب وطرق العلاج، خاصة بالنسبة إلى اللامساواة، قد تحمل
الإجابة على سؤال « لماذا تعتبر اللامساواة مهمة» إضاءة للجوانب
والنتائج غير المتطرق اليها، وهو ما يناقشه الفيلسوف الأمريكي تي أم
سكانلون المتخصص بنظريات العدالة والمساواة والنظرية الأخلاقية، في
كتابه عن اللامساواة. حيث حدد سكانلون ستة أسباب تدفع إلى الاعتراض على
الأشكال المختلفة لعدم المساواة والسعي إلى القضاء عليها أو الحد منها.
عدم المساواة يُمكن أن تُحدث فوارق مهينة في المكانة الاجتماعية والأنظمة الطبقية، لأنه يمنح الأغنياء أشكالا غير مقبولة للسلطة على أولئك الأقل حظا
ويمكن تلخيص أسباب الاعتراض بما يلي: لأن عدم المساواة يُمكن أن تُحدث
فوارق مهينة في المكانة الاجتماعية والأنظمة الطبقية، لأنه يمنح
الأغنياء أشكالا غير مقبولة للسلطة على أولئك الأقل حظا، لأنه يُضعف
تكافؤ الفرص الاقتصادية، لأنه يُقوّض نزاهة المؤسسات السياسية، لأنه
ينتج عن انتهاك مطلب المساواة في الاهتمام بمصالح أولئك الذين تلتزم
الحكومة بتقديم منفعة ما لهم. لأنه ينشأ عن المؤسسات الاقتصادية غير
المُنصفة. وإذا كان التفاوت على أساس الطبقة أو العِرق أو الجندر، فإن
للقوانين أو العادات والمواقف الاجتماعية الراسخة تأثيراتها، مما يدفع
إلى النظر في المساواة المجتمعية الأخلاقية. ولعل المثال الأفضل عن
اللامساواة الأخلاقية ضمن منظومة العدالة الاجتماعية والذي لا يتطرق
اليه إعلان الأمم المتحدة هو التمييز العنصري المفروض من الخارج، وهو
الوجه الأكثر وضوحا للسياسة الاستعمارية والاحتلال، حين يُنظر إلى سكان
البلد الأصليين بأنهم أدنى منزلة من المُستَعمِرين وحرمانهم من الحقوق
الأساسية أو حتى إحالتهم إلى مهن يُنظر اليها بأنها حقيرة ولا تليق
بمكانة المُستعمِر، كما كان الحال في جنوب أفريقيا سابقا وفي فلسطين
حاليا.
بالنسبة إلى إعاقة تحقيق العدالة في مجتمع بلد واحد وبلدان أخرى، يحتل
الفساد مكانة متميزة. وبالإمكان اعتبار العراق نموذجا تضمحل فيه حقوق
الإنسان الأساسية كالتعليم والصحة والسكن والعمل، ناهيك عن تأمين
الضمان الاجتماعي لكل أفراد المجتمع، وتأمين ظروف عمل صحية وآمنة،
كخطوة ضرورية للقضاء على الفقر، إزاء شراهة النظام الفاسد اقتصاديا
وسياسيا، فضلا عن استغلال وجشع المنظومة الاحتكارية الدولية، وتشجيع
الشقاق. وهو وضع يتنافى، تماما، مع مفهوم العدالة الاجتماعية كمبدأ
أساسي من مبادئ التعايش السلمي والاستقلال الاقتصادي والاجتماعي
والسياسي داخل الأمم وفيما بينها.
ينص العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على إمكانية
تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إعادة توزيع الثروة وتنفيذها من قبل
الهيئات العامة في الدولة، مما يثير تساؤلا عن الآليات التي يتوجب
تطبيقها لتحقيق ذلك فعلا. يظهر على السطح هنا مفهوم المساءلة
الاجتماعية أي إخضاع المسؤولين الحكوميين للمساءلة عن أفعالهم، سيما
المتعلقة بإدارة الموارد العامة، والقيام بدور المحاسب والمُسائل في
القضايا التي تدور حولها شبهات الفساد، من قبل منظمات المجتمع المدني
والمجتمع الأهلي ومشاركة المواطنين وفق آليات مراقبة.
هل سيؤدي الاحتفال بيوم واحد للعدالة الاجتماعية إلى تحقيقها عالميا،
آخذين بنظر الاعتبار أنه مطلب قديم، ذكره للمرة الأولى في شهر كانون
الأول/ديسمبر عام 1784، الملك الفرنسي لويس السادس عشر عندما قال:
«هناك حقوق مقدسة للبشرية، ومن بينها العدالة الاجتماعية»؟ آخذين بنظر
الاعتبار، أيضا، عراقيا، أن انتفاضة تشرين / أكتوبر 2019 في العراق
ألتي قام بها شباب رفعوا شعارات طالبوا فيها بحقوقهم في وطن بلا فساد
وقمع، وهي من صلب العدالة الاجتماعية، جنت ثمارها قوى حزب الفساد محليا
وعالميا؟
الجواب المباشر هو كلا. إلا أن استمرارية المطالبة بالعدالة
الاجتماعية، على مر العصور، ومع كل التغيرات السياسية والاقتصادية،
يعني أنها مطلب أساسي لحفظ كرامة الإنسان، وتكريس المواطنة والمساواة
الفعلية، ولايزال الكثيرون، حول العالم، يعملون على تحقيقه، مما يعني
أنه قد يكون صعب المنال إلا انه ليس مستحيلا.
كاتبة من العراق
ديكتاتورية الحزب الواحد…
«حزب الفساد» العراقي
هيفاء زنكنة
بلمسة تكاد تكون سحرية، أصبحت مشكلة العراق الوحيدة هي اختيار رئيس
الجمهورية. سبقتها مشكلة الخلاف، صحبة التهديد والتفجير، بين الفائزين
والخاسرين بالانتخابات. الانتخابات التي كان يفترض أن تكون حلا لمشاكل
الطائفية والعرقية والفساد، تلبية لمطالب متظاهرين دفعوا ثمنها أرواح
مئات الشهداء، أصبحت هي المشكلة. شهور من النزاعات الشرسة بين
المشاركين في انتخابات لم يتجاوز المصوتون فيها العشرين بالمئة.
أُختزلت العملية بمنصب رئيس الجمهورية والمنافسة بين اثنين هما وزير
المالية السابق هوشيار زيباري (الحزب الديمقراطي الكردستاني) والرئيس
الحالي برهم صالح (الاتحاد الوطني الكردستاني) تكريسا لمحاصصة أسسها
الاحتلال ووكلاؤه، منحت منصب رئاسة الجمهورية للكرد. إلا أن دعوى
قضائية رُفعت ضد زيباري أمام المحكمة الاتحادية أدت إلى تعليق ترشيحه
«مؤقتا» الى حين البت بتهم تتعلق بالفساد، مع إبقاء المحاصصة حية ترزق،
وهي أحد أوجه الفساد الكبير الذي يغمر العراق.
ذات الوجوه، تقريبا، التي اعتلت السلطة منذ ما يقارب العشرين عاما من
الغزو والاحتلال بقيت ملتصقة بغراء الفساد الداخلي ودعمه الخارجي. من
هو الفائز ومن هو الخاسر؟ من الذي يقرر وكيف؟ هل هي «الأغلبية» أم
«التوافقية»؟ هل هي ما يسمى بالإطار التنسيقي (قيادة ميليشيات الحشد
الشعبي الموالية لإيران مع حزب الدعوة) أم الكتلة الصدرية التي يتزعمها
مقتدى الصدر وراثة عن أبيه الراحل، وبشكل غير مباشر عن «المهدي
المنتظر»؟ «البيت الشيعي» أو نصف البيت الشيعي (ومفردة البيت بتونس
تعني الغرفة وليس الدار كلها، ولعلها الأصح في الواقع السياسي
العراقي)؟ التحالف السني والكردي مع نصف البيت الشيعي؟ لماذا يُصّنف
الكردي كرديا وليس سنيا بينما السنة والشيعة ليسوا عربا كلهم؟ أسئلة
ستبقى معلقة، بلا أجوبة، في فوضى استنباط المفردات والمصطلحات
التجميلية التي يراد منها إخفاء الصديد المتفشي في جسد منظومة الحكم،
وأساسه هو الفساد الحكومي، المؤسساتي، الممنهج، المُهدد لبنية المجتمع
والعلاقات الإنسانية في البلد.
الملاحظ أن العراق لم يشهد، عبر تاريخه، انتشار مفردة كما « الفساد»
مقابل تراجع مفردة « الوطن» باستثناء فترة مقاومة المحتل الأمريكي
وأثناء انتفاضة تشرين/ أكتوبر 2019 التي كان شعارها «نريد وطن». الكل
يتهم الكل بالفساد. الكل لديه ملفات، سرية، لفضح فساد الكل.
الساسة، الوزراء، رجال الدين، المرجعية الدينية (التي شرعنت نهب المال
العام دينيا باعتباره «مجهول المالك» ما دام خُمسه يدفع لها ومشاريعها)
التكنوقراط، وأجهزة الإعلام، الكل يُدين الفساد والكل منغمس فيه من
أعلى راسه حتى أخمص قدميه. من أعلى سلطة سياسية إلى أصغر موظف في
الدولة.
تمتع أعضاء «حزب الفساد» العراقي، بإثراء أنفسهم بمختلف الطرق: من الرشوة، وتوقيع العقود الزائفة، والابتزاز، والمحسوبية والمنسوبية، إلى الدعم السياسي
لعل أفضل مثال يُقّرب حجم الفساد بالعراق للأذهان، ومدى هيمنته على
حياة الناس اليومية وبالتالي المستقبلية، هو اعتباره نظام حزب واحد، ذي
تراتبية هرمية، تُجبر الكل على الانخراط في عضويته، كما في كل الأنظمة
الشمولية، تقريبا، عن طريق استخدام سياسة الجزرة والعصا. حيث يُكافأ من
ينضم اليه ويُروج له، ويعاقب من يرفض وينأى بنفسه رافضا المشاركة عن
طريق الاختطاف والاعتقال والقتل. بهذه السياسة المنهجية، ازداد عدد
أعضاء « حزب الفساد» اتسعت مظلته، تدريجيا، وانغرزت أكثر فأكثر في جسد
المجتمع، وفق علاقة ديناميكية بين الفساد الأعلى وانخفاض الثقة
الاجتماعية، وبالتالي زيادة الميل للانخراط في أنشطة فاسدة، خاصة في
مجتمع كان منهكا أساسا، وليس لديه ما يكفي من القوة لمواجهة طبقة
سياسية / دينية تتحكم بالمورد الاقتصادي الريعي أو ما بات يُسمى « لعنة
الموارد الطبيعية» وفي حالة العراق «لعنة النفط». وكما هو معروف، يقلل
الاقتصاد الريعي من حاجة النظام الى الشعب بشكل حقيقي مكتفيا بادعاء
تمثيله تزويقيا، وترسيخ تصور، شائع، بأن الخدمات العامة هي خدمة من
الدولة بدلاً من كونها حقا يمكن المطالبة به.
تمتع أعضاء «حزب الفساد» العراقي، بإثراء أنفسهم بمختلف الطرق: من
الرشوة، وتوقيع العقود الزائفة، والابتزاز، والمحسوبية والمنسوبية، إلى
الدعم السياسي. ساعدهم في ذلك، تمتعهم بالإفلات من المساءلة والعقاب،
على مدى ما يقارب العشرين عاما الأخيرة. وما كان ذلك سيتم لولا توفر
الدعم من منظمات ودول أجنبية، أما ساهمت بشكل فعال يتماشى مع أجندتها
السياسية لإبقاء «حزب الفساد» في السلطة أو عن طريق غض الطرف عن
ممارسات الفساد وتشجيع استمراره.
وعلى الرغم من إصدار المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، مئات
التقارير عن تأثير الفساد السلبي المدمر على العراق، من عدة نواح من
بينها عدم المساواة وتوفير الخدمات الأساسية، مما يؤثر على الفقراء
بشكل غير متناسب، وكون الفقراء هم الأكثر عرضة لدفع الرشاوى لتسيير
شؤون حياتهم اليومية وتوفير الضروريات، حيث أظهرت العديد من الدراسات،
على مر السنين، ارتباطًا واضحًا بين زيادة الجريمة مع ارتفاع عدم
المساواة الاقتصادية، وعلى الرغم من توثيق قائمة انعكاسات الفساد،
الآنية وبعيدة المدى مثل انتشار شبكات الدعارة، والمخدرات، الجرائم
بأنواعها، المتاجرة بالفتيات والأعضاء البشرية، تزوير الشهادات ( تم
اكتشاف 40 ألف موظف حكومي، من بينهم وزراء، بشهادات مزورة) والانضمام
إلى الميليشيات وأنواع المنظمات الإرهابية الأخرى، لا يزال عدد من
الدول، على رأسها أمريكا وبريطانيا، يمد النظام بالدعم السياسي
والإعلامي، مما يساعد على إستدامة وإعادة خلق، وتدوير الفساد، وترسيخ
قوة الفاسدين. وهذا هو ما حصل أثناء اجراء الانتخابات ويستمر حاليا.
إن هذا الطابع المنهجي للفساد وحاجة النظام المتزايدة له، على اختلاف
مكوناته، هو ما يجعله مترسخًا أكثر من بقية العوامل المؤثرة على
المجتمع. أما المنافسة بين مكونات النظام، من أحزاب وميليشيات، عرب أو
كرد، سنة أو شيعة، فإن جوهرها هو شراهة كل جهة منها لالتهام أقصى ما
تستطيع من ثروة البلد، وبذلها كل الجهود الممكنة لنشر ثقافة الفساد.
وغالبا، ما تتدفق ثقافة الفساد المنسوجة بالإجرام، سواء كانت مؤسساتية
أو سياسية، من أعلى إلى أسفل. وخلافا لما يُشاع، لا تضع الديمقراطية،
حدا للفساد، مهما كان حجم الترويج لانتخاباتها. وعلينا الاعتراف بأن
«حزب الفساد» الذي استطاع نهب360 ملياردولار من ثروة البلد، للترويج
لحملته الانتخابية، واستهداف النسيج المجتمعي على مستوى البقاء والحقوق
الأساسية، سيُتّوج إنجازاته برئيس جمهورية يليق به، كما الحكومة ورئاسة
البرلمان.
كاتبة من العراق
بذر الشقاق في العالم…
هل تحصد أمريكا ما زرعته؟
هيفاء زنكنة
هل ما يجري في الولايات المتحدة الأمريكية، منذ خسارة الرئيس دونالد
ترامب الانتخابات الرئاسية، هو شكل من أشكال الشقاق المجتمعي (تصدع
وانهيار العلاقات) الذي طالما اقتصر على بلدان العالم الثالث؟
وإذا كان سبب الشقاق في العالم الثالث، خاصة في البلدان العربية، هو
أمريكا، فمن هي الجهة المسؤولة عن بوادر ما يُسمى بالشقاق الأمريكي
المستمر حتى بعد التخلص من ترامب؟ أم أن أمريكا باتت تحصد ما زرعته من
في بلدان أخرى، كما نرى من انعكاس سياستها في العراق؟
هناك، طبعا، أجوبة جاهزة تواجهنا عند النظر في بروز الانقسامات،
المفاجئ، أحيانا، في البلدان العربية، ومن بينها أن الانقسامات
الطائفية والعرقية والمناطقية، موجودة ومتجذرة في المجتمعات، إلا أنها
حبيسة الأنظمة الدكتاتورية التي نجحت في قمعها، أو أحكمت تغطيتها وما
أن أزيح الغطاء، بسقوط الدكتاتورية، حتى برزت إلى السطح بقوة كبيرة.
لا تقتصر هذه الأجوبة على القوى الاستعمارية لتبرير سياستها بل
تتجاوزها الى النخبة في البلدان المُحتلة بعد تسللها، جراء عدم الفهم
أو الكسل العقلي، إلى وعيهم أو لا وعيهم. حيث يصبح المثقف أو الباحث
الأكاديمي أداة جلد للذات وإقناع بأن الشعب المُستَعمَر هو مُرتكب
الخطيئة الأصلية، والسياسة الاستعمارية، فعل اُريد منه، تحرير الناس من
خطاياهم بحسن نية. ولا يُشار، إطلاقا، ولو من باب التحفيز العقلي
للنقاش، إلى أن هذه الانقسامات المجتمعية، إن وجدت حقا، كانت في طريقها
الى الاضمحلال.
لكن السنوات الأخيرة، تزامنا مع تزايد الأسئلة عن الشقاق في داخل
أمريكا وتصاعد أصوات التحذير من التدخل الروسي والصيني، كما لاحظنا في
فترة الانتخابات الرئاسية، طفا على سطح البحوث الأكاديمية ومنها إلى
أجهزة الإعلام، مصطلح قديم كان قد دُفع جانبا بعد أن بات واقعا يوميا
في عديد البلدان، في أرجاء العالم، ومنها البلدان العربية. المصطلح
باللغة الإنكليزية هو « شيزموجَنسيس» وأصله يوناني. تم تطويره من قبل
عالم الأنثروبولوجيا الموسوعي غريغوري بَيتسون، في ثلاثينيات القرن
الماضي، لتفسير أشكال معينة من السلوك الاجتماعي بين المجموعات. معنى
المصطلح هو « الانشقاق» وما يتمظهر بشكل انهيار علاقة أو نظام جراء زرع
الانقسامات. وللتوضيح أكثر، أنه ببساطة خلق الانقسام أو سياسة «فّرق
تسُد» المتعارف عليها عند توصيف السياسة الاستعمارية في البلدان
المُستَعمَرة.
طوّر بَيتسون مفهوم الشقاق/ الانقسام، لأول مرة أثناء مراقبة التفاعلات
الاجتماعية لقبيلة في غينيا الجديدة. وسرعان ما تحول ما بدا في ظاهره
خلاصة أنثروبولوجية بريئة، لدراسة ميدانية عن قبيلة نائية وشبه معزولة
عن العالم الخارجي، إلى سياسة قام بَيتسون، فيما بعد، بتطبيقها أثناء
عمله في مكتب الخدمات الاستراتيجية، التابع لوكالة المخابرات المركزية
الأمريكية (السي آي أي) في الأربعينيات. ولا يهمنا هنا أن بَيتسون ندم
بشدة فيما بعد على هذا المسار في عمله وهاجم انخراط العلماء في سياسات
الدول، مثلما فعل الكثيرون من علماء الذرة بعد إلقاء القنبلة الذرية
على هيروشيما.
إن رصد انعكاسات سياسة زرع الانقسام في العراق، لا يترك شكا في قدرة هذه السياسة على استهلاك طاقة الشعب، وإدخاله في دائرة مغلقة، السبيل الوحيد للخروج منها هو قدرة الشعب على البحث عن جذور الخلافات المزعومة داخل الدائرة
وجد بَيتسون أن بعض السلوكيات الطقوسية أما تثبط أو تحّفز العلاقة
الانشقاقية في أشكالها المختلفة. وبالإمكان رؤية تطبيق ذلك، في العراق
منذ التسعينيات تهيئة لغزوه عام 2003. وتطور ذلك تحت الاحتلال، حيث تم
التركيز على تحفيز الانقسام بين السنة والشيعة، مثلا، مع تقليص الرغبة،
بشكل تدريجي، من كل الجوانب، لاتخاذ خطوات قد تساعد على تخفيف التوتر
في العلاقة المتأزمة، بشكل متزايد، خاصة، مع قيام أحد الطرفين أو
كليهما بإرتكاب أعمال انتقامية، تُضّخم تأثيرات التفاعلات السلبية
السابقة، والتذكير المستمر بها. لتصبح آلية التعامل اليومي مبنية على
هوس « نحن» الأخيار و «هم» الأشرار، وتجريد «الآخر» من إنسانيته لتسهيل
عملية « إجتثاثه».
قد لا تكون أبحاث بَيتسون الأنثروبولوجية العلمية نقطة الانطلاق الأولى
لسياسة فرق تسد القديمة، إلا أنها ساعدت على أن يكون المفهوم ونجاحاته
الاستراتيجية في مجالات متعددة، في أنحاء العالم، مادة تُدرس في
الدوائر الاستخبارية والوكالات الحكومية والكليات العسكرية، سوية مع
مادة التحليل النفسي المجتمعي كأداة فاعلة في خلق الانقسامات، تؤدي
بالنتيجة إلى توليد سلوكيات مدمرة للذات والرضوخ للهيمنة في آن واحد.
وتبين الدراسات أن المذابح البشعة، بين قبائل الكونغو ومحيطها، قبل
سنوات، كانت نتيجة مباشرة لسياسة فرنسية مدروسة للسيطرة على المنطقة.
ولا يخلو المنهج التدريسي من استمرارية تلقي نتائج الأبحاث الميدانية
لعلماء أنثروبولوجيا متعاونين مع السي آي أي، كما فعل بَيتسون. فأثناء
التهيئة لغزو العراق وما بعده، جنّدت الوكالة علماء في برنامج يساعدهم
على فهم نفسية من يسمونهم «سكان البلد المُضيّف» وكيفية التعامل معهم
لـ «محاربة التمرد» أي مقاومة الاحتلال، متجاهلين بذلك العهد المهني
الأخلاقي حول عدم إلحاق الضرر بأحد. وتلعب وحدات الحروب النفسية للكيان
الصهيوني، بشتى مسمياتها، دوراً كبيراً هنا، بتوظيف كبار علماء النفس
من بينهم من حصل على جائزة نوبل، عندما ترك عمله في جيش الكيان، ليختص
بالاقتصاد مثل دانييل كانيمان.
هل تحصد أمريكا، الآن، ما بذرته من شقاق في أرجاء العالم؟ تؤكد
الدراسات والمقالات الصحافية، أن هناك ما يشير إلى تطبيق ذات السياسة
التي كانت أمريكا تنتهجها ولكن، هذه المرة، من قبل أعدائها. حيث يُعزى
صعود السياسات المتطرفة في أمريكا وأوروبا الغربية إلى «سياسة مدفوعة
من قبل روسيا والصين والعديد من الجهات العدائية الأخرى التي يمكن أن
تستفيد من الطريقة الفعالة، من حيث التكلفة، لإضعاف الأنظمة بدون
مواجهة الغرب مباشرة «. وكان الاقتصادي الأمريكي المعروف جيمس غالبريث
قد حذر في عام 2011 من سقوط أمريكا قائلا: «يمكن للدول الكبيرة أن
تفشل، لقد تم ذلك في عصرنا». إلا أنه لم يوجه اللوم إلى «الأعداء» بل
إلى سياسة أمريكا الخارجية، خاصة شن الحرب العدوانية ضد العراق، موضحا
أن «هناك سببا لضعف الإمبراطوريات. فالحفاظ على الإمبراطورية يتطلب
حربًا دائمة بلا نهاية. والحرب مدمرة، من وجهة نظر قانونية وأخلاقية
واقتصادية».
سواء كان الشقاق المتهمة روسيا والصين بتجذيره في أمريكا أو الحروب
التي شنتها وتشنها أمريكا ضد عشرات الدول منذ نهاية الحرب العالمية
الثانية السبب الرئيسي لضعفها، فإن رصد انعكاسات سياسة زرع الانقسام في
العراق، مثلا، لا يترك شكا في قدرة هذه السياسة على استهلاك طاقة
الشعب، وإدخاله في دائرة مغلقة، السبيل الوحيد للخروج منها هو قدرة
الشعب على البحث عن جذور الخلافات المزعومة داخل الدائرة، والوعي
بسيرورة وكيفية التحكم بالعلاقات المجتمعية من خارج الدائرة، وإلا
انتهى الشعب بتدمير نفسه.
كاتبة من العراق
ثورة الوحش على خالقه…
عودة تنظيم داعش
هيفاءزنكنة
كانت صباحات الأيام الماضية، مغطاة لا بتساقط الثلوج في بلدان قلما
عرفت اللون الأبيض سابقا، ولكن بصوت موحد معلنا عن» عودة داعش». شاركته
التصريحات وأجهزة الإعلام الأجنبية بعناوين مختلفة من ناحية الاسم. حيث
استمرت باطلاق تسمية «الدولة الإسلامية» بدلا من داعش. هل لهذا مغزى
عميق أم أنه مجرد الصعوبة في لفظ الحروف العربية أو كون داعش مختصرا
للحروف العربية؟ هل من احتمال للسذاجة البريئة في زمن الخطيئة المتبدية
في إعادة رسم الخرائط وتفكيك الوطن وصناعة الهويات؟
«عودة داعش» هو العنوان الرئيسي في الصحافة واستوديوهات الأخبار
المفتوحة على مدى 24 ساعة، لجمهور يلتهم « عاجل» الأخبار. جمهور لم يعد
قادرا على هضم التحليل وتمحيص ما يُقدم إليه وبالتالي التساؤل،
باستثناء ما هو جاهز، غالبا، لفرط تعوده على استهلاك وجبات الأكل
السريعة وما تخلقه من حالة خدر جسدي وفكري.
عراقيا، وإلى حد كبير، عربيا وعالميا، طُمر سؤال مهم: هل غادرنا تنظيم
داعش (الدولة الإسلامية) فعلا؟
إذا بقينا في العراق، نموذجا، سنجد عند إزالة طبقات الفساد السياسي
والإداري الذي نجح في التسرب إلى مختلف شرائح المجتمع، تدريجيا، ووصوله
الذروة المستدامة منذ احتلال العراق عام 2003، جواب هذا السؤال مدفونا،
عميقا، في خضم تلاعب ومناورات طبقة سُراق تبنتها قوى الاحتلال لتحكم
بالنيابة. ولا تخلو الساحة من إعلاميين عملوا على أدلجة التغييب
والاستحضار، عند الضرورة، وفق المتغيرات السياسية في الداخل والخارج.
الحقيقة التي عمل الساسة العراقيون، بدعم المتنازعين على غنيمة العراق،
على طمرها، هي أن تنظيم داعش (الدولة الإسلامية) هو وليد الاحتلال
الانكلو أمريكي، بإجماع عربي قلما حظيت به قضية فلسطين، ضد الاحتلال
الصهيوني، طوال عقود المقاومة. كانت فترة الحمل قد بدأت مع حملة
التهيئة للغزو وشرعنتها قانونيا. هكذا جلس كولن باول، وزير الخارجية
الأمريكية، في شباط/ فبراير 2003، في الأمم المتحدة، ليقدم سردية خطر
أسلحة الدمار الشامل وإرهاب القاعدة في العراق، التي وصفها فيما بعد
بأنها كانت أحد أكثر إخفاقاته جسامة وكان لها تأثير واسع النطاق. هز
الحاضرون، من ممثلي الحكومات، يومها، رؤوسهم موافقين. فصارت الكذبة
حقيقة لا يمكن التشكيك بها. وشهادة ميلاد لتنظيم مستقبلي، ستنمو الحاجة
إليه بمرور الوقت، ومع تصاعد نشاط المقاومة ضد الاحتلال. وهل هناك ما
هو أفضل من تأطير وتقديم المقاومة بشكل مشوه، يجمع ما بين منظمات تم
صرف ملايين الدولارات على تغطية وجودها وإرهابها، إعلاميا ومخابراتيا،
بمسميات القاعدة ـ الإرهاب السني، في العقد الأول من الاحتلال، ومن ثم
داعش عند إعلان ميلاده الرسمي في 2014.
ظهور واختفاء التنظيمات، لا يعني أنها وليدة حاجة القوى الخارجية فحسب بل إنها، أيضا، وليدة عوامل أساسية أخرى يتم تجاهلها أو تغييبها، عموما، ومن بينها الظلم، والغضب الشعبي
في الوقت الذي قد تبدو فيه توليفة خلق وصناعة «التنظيمات الإرهابية» من
قبل قوى خارجية (السي آي أي مثلا) منطقية، لأنها تتماشى مع العقلية
والسياسة الاستعمارية، إلا أنها تحمل، في الوقت نفسه، ما يلقي بظلال
الشك على صحتها المطلقة. إذ لا يكف التاريخ عن تذكيرنا بأن ظهور
واختفاء التنظيمات، على اختلاف أنواعها، في مناطق الحروب والاحتلال، لا
يعني أنها وليدة حاجة القوى الخارجية/ الاحتلال، وصناعتها فحسب بل
أنها، أيضا، وليدة عوامل أساسية أخرى يتم تجاهلها أو تغييبها، عموما،
ومن بينها الظلم، والغضب الشعبي، وعدم الاستقرار، وهيمنة نزعة
الانتقام، والبيئة غير الصحية للحياة الإنسانية بشكل عام، وتنامي طبقة
تحترف الاستغلال المادي والبشري. كما يجدر التذكر، أيضا، أن إصدار حكم
مطلق، بقدرة أمريكا مثلا على إنجاز كل ما تطمح إليه، يعني في الواقع
إلغاء دور الشعب، وحتى وجوده، بتاريخه وحاضره وتناقضاته وتعدد مستويات
نضاله. وهو موقف يؤدي الايمان به، ونشره إلى ترسيخ مفهوم العبودية
والإحباط والعجز عن اتخاذ أية بادرة فردية أو جماعية في مسيرة النضال
من أجل الحرية. فيكون البديل، لدى البعض، ومع تهيؤ الأرضية لاستقبال
أية بذرة، هو الانصياع إلى قوى، قد تكون من داخل المجتمع او خارجه،
تُقدم للمرء ما يفتقده في حياته اليومية بل وتعده بمغفرة وفردوس،
يمتدان أبعد من الحياة نفسها، مهما فعل. تجّسد البديل، المُستثمر في
العراق لـ « العودة» وتنفيذ العمليات، بين الحين والآخر، بعد إستنزاف
كرنفال النصر عليه، بتنظيم داعش ووجهه الآخر المُسمى الحشد الشعبي.
كانت تكلفة إعلان تأسيس الدولة الإسلامية وما ارتكبته من جرائم ضد
المدنيين، وتكلفة دحرها، خاصة بواسطة الهجمات الجوية الأمريكية، التي
بلغت 50 ألف طلعة جوية عام 2016 على مدينة الموصل لوحدها، بالإضافة إلى
حملات انتقام الحشد الشعبي، خسارة فادحة في الأرواح والتخريب العمراني،
يبين مدى قدرة الإنسان على السلوك الوحشي والتدمير بمواجهة « الآخر».
إن « عودة داعش» المُعلن عنه حاليا، كما خلال الأعوام الماضية، ضروري
لعديد الحكومات العربية والعالمية. فهو الغطاء الجاهز الذي طالما
استخدم في العراق لتبرير آلاف الاعتقالات وحالات التهجير والاختفاء
القسري، ناهيك عن التعذيب في معتقلات متناثرة على وجه العراق كالدمامل
الصديدية، المُهددة بالانفجار. وهو الجدار العازل الذي تستخدمه الدول
الأوروبية للحد من وصول المهاجرين إليها، وفرض قوانين عنصرية ضد
المسلمين، بينما تواصل الولايات المتحدة الأمريكية إما تنفيذ عمليات
خاصة يُعلن عنها باسم داعش أو خلق أزمات سياسية تستدعي تمديد بقائها،
في البلدان المتواجدة قواتها العسكرية فيها، بذريعة التدريب والاستشارة
والتعاون.
وإذا تغاضينا عن الأسباب الأساسية التي تؤدي إلى بقاء تنظيم داعش حيا
سواء تحت هذا الاسم أو غيره، ورضينا بأن جهاز الاستخبارات الأمريكية
صنّعَه، كما الوحش في المختبرات، لإعطاء الخوف وجهاً، وإرهاب الشعوب
فإن علينا أن نتقبل، أيضا، حقيقة أن أول ما يفعله الوحش المخلوق في
فضاء مختبري، هو الثورة على خالقه.
كاتبة من العراق
هل يوقف مليون
توقيع تكريم مجرم حرب؟
هيفاءزنكنة
يقول رئيس حزب العمال سير كير ستارمر أن السيد بلير يستحق أن ينال وسام
الفروسية، ولقب «سير» الذي منحته إياه الملكة، أخيرا، وهو الأعلى
تكريما في المملكة المتحدة، لأنه «جعل بريطانيا دولة أفضل». بالمقابل،
يقول ما يزيد على المليون مواطن بريطاني (بضمنهم من أصول عربية
وإسلامية) وقعوا على عريضة تطالب بسحب تكريمه من قبل الملكة، أنه «مجرم
حرب». يوافقهم الرأي عدد من الصحف التي تصدرتها عناوين على غرار «تكريم
توني بلير؟! يجب أن يُحاكم بسبب الكارثة في العراق». تساهم منظمة
«أوقفوا الحرب» البريطانية، وهي الأكثر شهرة في مناهضتها سياسة الحكومة
البريطانية الخارجية في شن الحروب والتوسع الإمبريالي، منذ إعلان
أمريكا « الحرب على الإرهاب» وغزوها أفغانستان والعراق، في حث الناس
على الاحتجاج ضد التكريم.
ما نعرفه جميعا، هو أنه وعلى الرغم من صرخة الاحتجاج العالمية المناهضة
للحرب، وعلى الرغم من مشاركة مليوني مواطن بريطاني في أكبر مسيرة
احتجاجية شهدتها بريطانيا على الإطلاق، وهي الأولى من نوعها التي
يتظاهر فيها الناس على حرب قبل شنها، اختار بلير تجاهل المحتجين وبدأ
الحرب. بتهم مفبركة، تم فضحها للعموم بعد الغزو، وتثبيت القدم الأنكلو
أمريكية على الأراضي والموارد العراقية، وتحطيم الدولة وتحييد الموقف
العراقي المبدئي من القضية الفلسطينية. مما يضعنا أمام أسئلة مهمة حول
أهمية المبادرات الشعبية للضغط على الحكومات أو الجهات المتنفذة لتغيير
سياستها تجاه قضية معينة. فهل سينجح الموقعون على العريضة الآن في
الضغط على رئيس الوزراء، وهو من حزب المحافظين، لكي يحاول إقناع الملكة
سحب تكريمها لتوني بلير؟ وما هو عدد المواطنين الذين يجب أن يوقعوا
ليكون لصوتهم تأثير حقيقي؟ وهل من أمل بتغيير القرار الملكي؟ وإن لم
يحدث ذلك، يواجهنا السؤال الأهم وهو ما جدوى توقيع العرائض؟
يبدو الأمر مستحيلا من ناحية الضغط على الملكة لتغيير قرارها بتكريم
بلير فهو متعلق، أساسا، بتقليد ملكي بريطاني مفاده أن يحصل رؤساء
الوزراء السابقون على وسام الفروسية، مهما كان حزبهم أو سياستهم
الداخلية أو الخارجية. بل غالبا، ما يُقاس نجاح رئيس الوزراء وحكومته
بمقياس السياسة الخارجية المبنية على ما تحققه من رفاه اقتصادي للبلد،
وهل هناك ما هو أكثر ربحا من الصناعات المرتبطة بالحروب والاستيلاء على
موارد الدول التي تنهشها الحروب والنزاعات، بأنواعها، أي ما أنجزه
بلير؟
على الرغم من صرخة الاحتجاج العالمية المناهضة للحرب، وعلى الرغم من مشاركة مليوني مواطن بريطاني في أكبر مسيرة احتجاجية شهدتها بريطانيا على الإطلاق، اختار بلير تجاهل المحتجين
من هذا المنظور التوسعي الإمبريالي، من غير المعقول قيام الملكة بسحب
التكريم، خاصة، وأن هذا سيعني، بالضرورة، الاعتراف بأن توني بلير مجرم
حرب أو على الأقل محاكمته، لأنه قرر شن حرب ألحقت الضرر ببريطانيا
نفسها وليس العراق. ومن الصعب، أيضا، إثبات إلحاقه الضرر ببريطانيا
كدولة لأن الشعب البريطاني أعاد انتخابه في الفترة التالية لغزو
واحتلال العراق، في الوقت الذي كانت جيوش الاحتلال تتلقى الضربات من
المقاومة العراقية. مما يمكن ترجمته، على أرض الواقع، أن توني بلير نجح
في استقطاب المشاعر «الوطنية» للدفاع عن جنود بريطانيا المدافعين عن
«القيم الديمقراطية» وحماية بريطانيا من خطر سيستهدفها خلال 45 دقيقة،
حسب تعبير بلير.
توصل تقرير اللورد تشيلكوت حول حرب العراق، بعد تحقيق دام سبع سنوات،
إلى استنتاجات شككت بمصداقية ادعاءات بلير، خاصة حول الخطر المهدد
للشعب البريطاني، إلا أنه توقف عند ذلك الحد، ولم يتجاوزه ليتم تقديم
بلير للمحاكمة لمساهمته في شن حرب سببت مقتل مليون عراقي و179 جنديًا
بريطانيًا، وأدت إلى تأسيس تنظيم الدولة الإسلامية وديمومة العنف
المستدام في العراق اليوم. من بين الاستنتاجات التي توصل إليها التقرير
أن الرئيس العراقي لم يشكل تهديدًا عاجلاً للمصالح البريطانية، في وقت
غزو العراق عام 2003، ولم تثبت المعلومات الاستخباراتية، بلا شك، وجود
أسلحة دمار شامل، وكانت هناك بدائل للحرب لم يُستنفد النظر فيها مما
سبَّب قتل جنود بريطانيين ومئات الآلاف من العراقيين.
لم، إذن، لا يُحاكم توني بلير كمجرم حرب، أو على الأقل لم لا يتم سحب
تكريمه الملكي؟ جوابا على السؤال الثاني الذي يصح على السؤال الأول
أيضا، يقول الصحافي ومقدم البرامج البريطاني جيريمي كلاركسون أن توقيع
مليون شخص على عريضة للمطالبة بسحب وسام التكريم من بلير، في بلد مجموع
سكانه 70مليونا، يعني أن 69 مليونًا لم يفعلوا، على الرغم من أن توقيع
العريضة، إلكترونيا، لا يتطلب جهدا. بمعنى آخر أنهم إما لا يرغبون بذلك
أو أنهم لا يهتمون بالمسألة كلها. ويوضح كلاركسون بأن الطريقة الواقعية
الوحيدة لمنع بلير من الحصول على التكريم هي إجراء استفتاء رسمي عام
حول هذه المسألة. ولكن بعد كارثة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي،
لا يبدو في الأفق ما يشير إلى حدوث ذلك.
هل يقودنا هذا الاحساس المسبق بالفشل إلى عدم المشاركة في أية مبادرة
جماعية للتغيير؟ هناك من النجاحات، على قلتها، ما يدحض « قدرية» الفشل.
ففي 10 أكتوبر / تشرين الأول 1998، مثلا، أُلقي القبض على الدكتاتور
التشيلي بينوشيه بتهمة «الإبادة الجماعية والإرهاب التي تشمل القتل»
أثناء زيارته للندن بالذات، بموجب مذكرة توقيف نجح ناشطون حقوقيون في
تفعيلها، مستفيدين من مبدأ سلطة القضاء العالمية، الذي يسمح للدول
بمتابعة القضايا التي تنطوي على أعمال تعذيب وإبادة جماعية وغيرها من
الجرائم ضد الإنسانية دون النظر إلى المكان الذي تم ارتكاب الجريمة
فيه، وبغض النظر عن جنسية مرتكبي تلك الجرائم أو جنسيات ضحاياهم. وألغى
موشيه يعالون، نائب رئيس وزراء الكيان الصهيوني، في تشرين الأول/
أكتوبر 2009، رحلة إلى بريطانيا خشية اعتقاله بتهمة ارتكاب جرائم حرب
ضد الفلسطينيين. وفي كانون الثاني 2010، ألغت الوزيرة الإسرائيلية
السابقة تسيبي ليفني زيارتها إلى بريطانيا بعد صدور مذكرة توقيف بحقها.
والمعروف أن توني بلير لم يعد يجرؤ على السير في شوارع بلده بريطانيا
تفاديا لغضب الناس. ومن يدري، مع تغير موازين القوى العالمية والمحلية،
قد تتمكن مجموعة حقوقية عراقية بريطانية مثابرة من تقديمه للمحاكمة، في
المستقبل القريب، كمجرم حرب مهما كان لقبه.
كاتبة من العراق
جدوى عرائض الاحتجاج
من الغارديان إلى أسانج
هيفاء زنكنة
عريضتان تم تداولهما في الأسبوع الماضي عبر كل أنواع التواصل
الاجتماعي. رافقهما طلب التوقيع بسرعة لتحقيق الغرض من العريضتين. كانت
العريضة الأولى احتجاجا على موقف صحيفة «الغارديان» البريطانية التي
نشرت نعي رئيس أساقفة جنوب أفريقيا ديزموند توتو (في 26/12/2021)
المعروف بنضاله الدؤوب ضد الاضطهاد والعنصرية بجميع أنواعها، وضد
ممارسة الفصل العنصري على وجه الخصوص. ومع ذلك، اختارت الصحيفة حذف
انتقادات توتو المتكررة لسياسات الفصل العنصري الإسرائيلية التي شبهها
بسياسة النظام العنصري في جنوب أفريقيا سابقا. ذكرت العريضة أن الحذف
لم يكن سهوا بل سياسة متعمدة. مما يفتح الباب أمام افتراض أن صحيفة «
الغارديان» ترى الآن أن أي إشارة إلى طابع الفصل العنصري للسياسات
الإسرائيلية معاد للسامية. ويقود إلى خلاصة منطقية تنص على «أن وجهة
نظر الصحيفة الآن هي أن ديزموند توتو، الذي رأى أن القمع الإسرائيلي
للفلسطينيين كان أسوأ من الفصل العنصري في جنوب إفريقيا (كما كتب
لصحيفتك في عام 2002) كان معاديًا للسامية». طالبت العريضة بتصحيح
التحريف وتقديم اعتذار لعائلة توتو ولقراء الصحيفة. فهل نجحت العريضة
التي وقعها آلاف الناس وممثلو منظمات حقوقية، بضمنها يهودية مناهضة
للنظام الصهيوني العنصري، وأخرى تمثل اليهود داخل حزب العمال، تزامنا
مع رسالة وجهتها منظمة «حملة التضامن الفلسطينية» إلى الغارديان، في
تحقيق ما هدفت إليه؟ وهل لأسلوب توقيع العرائض أو الالتماس العام،
كأسلوب ضغط مجتمعي لتغيير سياسة ما، فائدة تُرجى أم أنه مضيعة للوقت
وامتصاص للنقمة والغضب؟
كان رد فعل الصحيفة سريعا إذ قامت بنشر مقال يتناول دعم توتو لحقوق
الفلسطينيين كما أعادت نشر التعليقات المحذوفة على مقالها، واعترفت
بشكل خاص بأنه ما كان ينبغي حذفها، إلا أنها لم تعتذر، كما لم تنشر
الرسالة الموقعة من قبل أكثر من 30 شخصية بارزة بما في ذلك العديد من
الذين كانوا نشطين في النضال ضد الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. رحبت «
حملة تضامن فلسطين» بنشر المقال وتنفيذ طلبها الرئيسي وهو إعادة نشر
التعليقات، وفي الوقت نفسه كتبت الى الصحيفة ثانية مطالبة إياها بتجنب
ما حدث مستقبلا جراء الخضوع للوبي الصهيوني. يدل تراجع الصحيفة، وهي من
الصحف المؤثرة عالميا، أن استخدام مستويات متعددة، من ضمنها توقيع
العرائض وكتابة الرسائل والتعليقات، يضمن حراكا شعبيا مؤثرا وقوة ضغط
لا يستهان بها سياسيا، إن تم إجراؤها بشكل صحيح. صحيح أنها قد لا تؤدي
دائما إلى تحقيق النتائج المتوخاة كلها بل جزء منها أو لا تحقق شيئا
أحيانا، إلا أن مجرد الاطلاع على فحواها ومتابعتها وحث الآخرين على
المشاركة هو سيرورة توعية وتنظيم، في داخل البلد الواحد أو عابرة
للحدود، للتعبير عن حق الفرد في التغيير السياسي والمجتمعي.
استخدام مستويات متعددة، من ضمنها توقيع العرائض وكتابة الرسائل والتعليقات، يضمن حراكا شعبيا مؤثرا وقوة ضغط لا يستهان بها سياسيا، إن تم إجراؤها بشكل صحيح
العريضة الثانية ألتي تستحق وصفها بأنها عابرة للقارات، هي الداعية إلى
إطلاق سراح الصحافي جوليان أسانج. والمعنونة «حرروا جوليان أسانج قبل
فوات الأوان. قم بالتوقيع على وقف تسليم المطلوبين للولايات المتحدة
الأمريكية». تهدف العريضة إلى منع مأسسة سابقة قانونية ستؤدي إلى تسليم
صحافي غير أمريكي فضح جرائم الحرب الأمريكية إلى الحكومة الأمريكية.
والمعروف أن أسانج، مؤسس ويكيليكس، قد نشر ملايين الوثائق السرية ألتي
كشفت جرائم أمريكا أثناء غزو واحتلال أفغانستان والعراق، وبعدها. وهو
معتقل ببريطانيا، حاليا، إلا أن أمريكا تطالب بتسليمه إليها ليواجه
عقوبة السجن 175 عامًا وإعدامًا محتملًا. وكانت المحكمة العليا في لندن
قد حكمت في 10 ديسمبر/ كانون الثاني 2021 لصالح الإدارة الأمريكية
بتسليم أسانج بناء على تأكيدات تلقتها من أمريكا حول ضمان سلامته.
استأنف فريق الدفاع عن أسانج الحكم استنادا إلى هذه النقطة هذه المرة.
إلى جانب كل تصريحات المنظمات الحقوقية الدولية، والشخصيات العالمية،
ومنتديات الصحافة المتضامنة مع أسانج، باعتباره صحافيا لم يرتكب أية
جريمة بل مارس عمله، وفق حرية التعبير، في إطلاع الرأي العام على جرائم
حرب ارتكبتها الحكومات المضللة له، بات للعريضة الملتمسة إطلاق سراحه
مكانتها. إذ وقعها حتى العاشر من آب (أغسطس) 2021، حين تم تقديمها إلى
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية 619،900 توقيع، جنبًا إلى جنب
مع أكثر من 570.000 موقع على الالتماس للمحكمة الجنائية الدولية (ICC)
في 15 يناير 2021. وهي أكبر عريضة قُدمت إلى المحكمة الجنائية الدولية
على الإطلاق منذ إنشائها، هادفة إلى إطلاق سراح أسانج والتحقيق في
حالات التعذيب النفسي التي تعرض لها. وكانت المحكمة الجنائية الدولية
قد حددت التعذيب النفسي بأنه يشكل «جريمة ضد الإنسانية». وتدفع
العريضة، أيضا، بمقاضاة «الموظفين الحكوميين» من المملكة المتحدة
والسويد والإكوادور وأستراليا، الذين يُزعم مشاركتهم في خلق وضع أخضع
أسانج عن عمد للتعذيب النفسي، على الرغم من التصريحات العلنية التي
أدلى بها المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب والتي خلصت إلى
أن جوليان أسانج قد تعرض لمعاملة قاسية ومهينة، أدت إلى حالة تعذيب
نفسي تم التحقق منه على النحو المحدد في تنفيذ الاتفاق المعترف به
دوليًا.
يُحذر كُتاب العريضة من أن السماح بتسليم جوليان أسانج، بسبب نشره
وثائق من أجل الصالح العام، «من شأنه أن يضع كل امرأة وطفل ورجل في
المجتمع الغربي تحت حكم استبدادي خارج الحدود الإقليمية للولايات
المتحدة. يثبت التاريخ أن هذا يؤدي دائمًا إلى الديكتاتورية الوحشية
التالية التي ستغتال أو تَعدم أو تُسكِت بشكل دائم أي شخص ينشر
دليلايفضح إجرام «السلطات».
لقد أثبتت الأيام الأخيرة أن لحملات الضغط، بضمنها توقيع العرائض، حظها
من النجاح كما في حملة التضامن مع فلسطين، فهل ستنجح أصوات مئات الآلاف
من الموقعين على عريضة الصحافي أسانج، في إيقاف تسليمه إلى شرطي العالم
أمريكا؟ سترينا الأسابيع المقبلة النتيجة، وهي وإن لن تحقق المطالب،
ستؤكد أن أسانج ليس إنسانا فريدا من نوعه في الدول الامبريالية، بل
هناك المزيد من أمثاله يتكاثرون في بطن الوحش، خصوصاً وأن أمثاله
يتمتعون بدعم عابر للأوطان والتيارات السياسية على إختلافها.
كاتبة من العراق
ترنيمة حب للصديق
الراحل ديزموند توتو
هيفاء زنكنة
حين اجتمعنا في تضامن المرأة العراقية، لاطلاق مبادرة « شهر التضامن مع
العراق» بعد مرور 15 عاما على احتلال وطننا، لم نتردد كثيرا في اختيار
ما نستهل به ديباجة المبادرة.
كانت صورة ديزموند توتو، رئيس أساقفة جنوب إفريقيا وناشط السلام
المخضرم الذي فاز بجائزة نوبل للسلام عام 1984 تقديراً لحملته ضد الفصل
العنصري، ماثلة أمام أعيننا، صديقا رافقنا في رحلة استغرقت سنوات فرض
الحصار الهمجي على العراق (كما غزة اليوم) مدة 13 عاما، وفي مناهضة
الغزو والاحتلال الأنكلو أمريكي. رافقنا، أيضا، في تعرية نظام الاحتلال
الصهيوني لفلسطين، بعد زيارته للأراضي المقدسة في عام 2002، في مقاربة
قلما تجرأ أحد على استخدامها أمام اللوبي الصهيوني في أمريكا، واصفا
إياه بأنه نظام فصل عنصري، وكيف إنه رأى «إذلال الفلسطينيين عند نقاط
التفتيش وحواجز الطرق» كما كانت معاناة السود، في بلادهم، عندما كان
ضباط شرطة شباب من البيض يمنعونهم من التحرك. مضيفا « أن إسرائيل لن
تنال أبدًا الأمن والسلامة الحقيقيين من خلال قمع شعب آخر». وتفنيدا
لتهمة معاداة السامية الجاهزة، قال إن انتقاده للحكومة الإسرائيلية لا
يعني أنه معاد للسامية. كما أنه ليس معاديا للبيض» على الرغم من جنون
تلك المجموعة».
أردنا، في مبادرتنا الهادفة إلى التذكير بالظلم الذي سببه غزو العراق،
شخصا يجمع بين الإنسانية وحب الحياة، يتحدث لغتنا، لغة التضامن
والمساواة، لا على المستوى الفردي أو مستوى البلد الواحد الذي ينتمي
إليه الشخص فقط، فهذه ميزة شائعة بين السياسيين بحجة التأهل للمنصب
«السياسي الجيد» بل من يحتضن كل البلدان المقهورة ليحقق حرية بلده،
لأنه يعرف جيدا معنى القهر والظلم والتمييز، لأنه ناضل طوال حياته
ليتخلص من طعم العبودية والتمييز العنصريين، واثقا من إشراقة الشمس بعد
ليل طويل. وهل هناك ما هو أكثر إنسانية من أن ترى نفسك في روح إنسان.
لهذا اخترنا كلمات ديزموند توتو لتكون في المقدمة. لا لأنها عبرت عن
موقفه المناهض لغزو واحتلال العراق فقط، بل لأنه تمكن، ببصيرته
الأخلاقية أن يرى أبعد من كثير من القادة والحكام وحتى المثقفين (ضمنهم
عراقيون) وأن يستشف اكذوبة القوة العظمى المتمثلة بتصريحات الساسة
والتزوير الإعلامي، وخطرهما على العالم كله، قائلا: « إن لا أخلاقية
قرار الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى بغزو العراق في عام 2003، على
أساس كذبة أن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل، قد أدت إلى زعزعة استقرار
العالم واستقطابه إلى حد أكبر من أي صراع آخر في التاريخ «. أيامها،
شارك ملايين الناس، من جميع أنحاء العالم، ديزموند توتو إدانته لشن
الحرب على العراق، متظاهرين ولأول مرة في التاريخ، ضد حرب قبل وقوعها.
ديزموند توتو يعرف جيدا معنى القهر والظلم والتمييز، لأنه ناضل طوال حياته ليتخلص من طعم العبودية والتمييز العنصريين، واثقا من إشراقة الشمس بعد ليل طويل
ولم يكتف بتصريحاته وتحذيره بريطانيا وأمريكا في الفترة التي سبقت شن
الحرب العدوانية بل واصل نشاطاته المناهضة للسياسة الامبريالية وهو
يرصد عمق الخراب الذي سببه الاحتلال، وتزايد عدد الضحايا الأبرياء.
صارخا بلغة تُذكرنا بأنه رجل دين» أين الرحمة، أين الأخلاق، متى تأتي
الرعاية؟».
ويأتي موقف توتو كناشط حقوقي ورجل دين، في آن واحد، مماثلا لعدد كبير
من رجال الدين المنتمين إلى الكنيسة الكاثوليكية في أمريكا اللاتينية
(على الرغم من أنه لم يكن كاثوليكيا) الذين لعبوا دورا رئيسيا في حركات
التحرير والنضال من أجل حقوق سكان الريف والفقراء، والضغط على الكنيسة
لمواجهة دورها في انتهاكات حقوق الإنسان ألتي ارتكبت أثناء حقبة
الاستعمار. ففي سنوات الحكم العسكري الدموي للجنرال بينوشيه في تشيلي،
مثلا، كان الكهنة الناشطون أعلى صوت للمعارضة ومن قادوا الجهود للبحث
عن الأشخاص المختفين قسراً. وانضم القس كاميلو توريس ريستريبو، رائد
لاهوت التحرير في كولومبيا، إلى جيش التحرير الوطني اليساري، حيث ساهم
في حرب العصابات وقُتل في عملية خاصة وصادر الجيش جثته، ولايزال موقع
دفنه مجهولا حتى اليوم. وقد ألهم فكره أجيالامن الحركات والمنظمات
الاجتماعية.
في أغسطس/ آب 2012، إنتقل ديزموند توتو إلى مستوى آخر من النشاط، حين
رفض مشاركة توني بلير المنصة في قمة قادة للاستثمار، في جوهانسبورغ،
محاججا بأن قرار بلير دعم الغزو العسكري للولايات المتحدة للعراق، على
أساس مزاعم غير مثبتة بوجود أسلحة دمار شامل فيه، أمر لا يمكن الدفاع
عنه أخلاقيا. وبما أن محور القمة هو القيادة، فإن الأخلاق والقيادة غير
قابلين للتجزئة. وسيكون من غير المناسب ولا يمكن الدفاع عن رئيس
الأساقفة مشاركة منصة مع السيد بلير، حسب بيان لمكتب توتو.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2012، رافعا إصبعه محذرا من غضب الشعوب،
المتطلعة للحرية، أينما كانت، وواقفا بصلابة من أجل العدالة مهما كانت
سلطة الظالم وقوته العسكرية، أو جنسه أو لونه، إلتفت رئيس الأساقفة إلى
الجانب القانوني، مطالبا بتقديم الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس
الوزراء البريطاني توني بلير للمحاكمة كمجرمي حرب في لاهاي. «لأنهما
قاما باختلاق الأسباب للتصرف مثل المتنمرين في الملعب لتفريقنا. لقد
دفعونا إلى حافة الهاوية حيث نقف الآن – مع شبح سوريا وإيران امامنا.
بالإضافة إلى عدد القتلى نتيجة العمليات العسكرية منذ عام 2003… على
هذه الأسس، في عالم متوازن، يجب أن يسلك المسؤولون الغربيون نفس المسار
الذي سلكه بعض أقرانهم الأفارقة والآسيويين الذين أجبروا على تحمل
مسؤولية أفعالهم في لاهاي».
بقي ديزموند توتو، طوال حياته، مؤمنا بقدرة الشعوب على تحقيق العدالة
المنشودة التي تليق بنضالها، في جميع أنحاء العالم، بضمنها فلسطين
والعراق، مذكرا من يشكك بالأمر أن «حكومة الفصل العنصري كانت قوية
للغاية، لكنها لم تعد موجودة اليوم… وأن هتلر وموسوليني وستالين
وبينوشيه وميلوسيفيتش وعيدي أمين كانوا جميعًا أقوياء، لكنهم في
النهاية سقطوا وأكلوا التراب «.
كاتبة من العراق
لماذا يتصدّر العراق
قوائم الدول «الأسوأ» في العالم؟
هيفاءزنكنة
لم يعد الدمار الذي ألحقه الإنسان بالبيئة خافيا على أحد، بعد أن بدأت
الطبيعة توجه ضرباتها الموجعة إليه، بعد عقود من تحذيرات العلماء
بالمستقبل الكارثي الذي يستوجب حلولا جذرية سريعة. لم يعد هناك مجال
للمماطلة والتسويف إزاء الأعاصير والفيضانات وإرتفاع درجات الحرارة،
والتصحر، وجفاف الأراضي الزراعية، والحرائق المهددة للغابات، وتزايد
الغازات وتلوث الهواء.
وصلت أخطار التغير المناخي، في الأعوام الأخيرة، إلى قمة المشاكل
والشغل الشاغل لمعظم الدول، سواء في العالم الأول أو الثاني أو الثالث.
فأمام غضب الطبيعة تشهد الحدود الفاصلة بين البلدان انهيارا، تزداد
سرعته في بلدان العالم الثالث بشكل خاص. صحيح أن الانعكاسات الكارثية
باتت تمس الجميع إلا أن دول العالم الثالث، الدول العربية من بينها،
تتحمل عبأها الأكبر. لا لأن غضب الطبيعة ينتقيها دون أمريكا وأوروبا
مثلا، ولكن لأسباب داخلية وخارجية متراكمة، تتفاعل من خلالها الكوارث،
طبيعية كانت أو من صنع الإنسان، لتزيد من تأثير وحجم أية أزمة تصيب أهل
البلد.
ويشكل العراق، مع فلسطين، نموذجا واضحا للأزمة البيئية الناتجة عن
صناعة الحرب والاحتلال والسياسات الاستعمارية الجديدة في العالم
العربي، المؤدية إلى تقويض الأساس الاجتماعي والاقتصادي للحياة في
المنطقة. تظهر آثار هذه الأزمة البيئية في تغير المناخ المدمر، وتلوث
الصناعات الاستخراجية، واستنفاد الموارد الطبيعية، وندرة المياه، وتلوث
الهواء والتربة جراء استخدام الذخيرة الحديثة، كاليورانيوم المنضب،
والفوسفور الأبيض، كما في العراق وغزة. وتشير التقديرات إلى أن الحرب
ضد العراق سببت إطلاق 141 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون، بين
عامي 2003 و2007، أي أكثر من 60 بالمئة من جميع دول العالم.
على الرغم من توفر هذه المعطيات وتوثيقها من قبل منظمات حقوقية دولية،
وكون الوضع البيئي الداخلي مرتبطا، إلى حد كبير، بالعالم الخارجي، بقي
العراق، حتى الأشهر الأخيرة، في أسفل الاهتمامات الحكومية والشعبية.
ولا يكاد يُذكر إلا كهامش في المؤتمرات الدولية أو ضمن قوائم الدول «
الأسوأ» في التقارير والاحصائيات الصادرة عن منظمات الأمم المتحدة
وغيرها من المنظمات المعنية بالبيئة وانعكاساتها الاقتصادية
والمجتمعية. حينئذ فقط، والحق يقال، غالبا ما ينجح في إحراز مكانة
متقدمة لا يضاهيه فيها أحد.
فالعراق مستقر في موقع متقدم في قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم،
ويتصدر قائمة الدول العربية الأكثر فسادًا. مما جعل حتى الرئيس العراقي
برهم صالح، عاجزا عن تغطية حجم الخسارة المالية التي تسبب بها الفساد
في البلاد على مدى سنوات. وأعترف بأن العراق خسر عشرات، او مئات
مليارات الدولارات، إضافة إلى 150 مليار دولار هُرِّبت من الصفقات إلى
الخارج منذ 2003، وهو رقم يبدو أصغر من أرقام تختلط فيها التريليونات
مع المليارات والملايين، كما يختلط الدينار والدولار.
لفهم الكارثة البيئية الحالية في العراق، من الضروري النظر في الوضع السياسي وخاصة تجزئة الدولة بين تكتلات سياسية، تتنازع إلى حد الاقتتال فيما بينها، مما جرد الدولة من أية قوة وسلطة مركزية
ويُعد العراق من بين الدول الأكثر خطورة حسب مؤشر المخاطر الأمنية،
متنافسا مع ليبيا وسوريا واليمن والصومال ومالي وأفغانستان. استنادا
إلى جدولة حالة الحرب والمعلومات عن الإرهاب والاقتتال المجتمعي وحركات
التمرد والاضطرابات ذات الدوافع السياسية. وفاز العراق بلقب ثاني أكثر
دول العالم فتكًا بالصحافيين في عام 2020، حسب منظمة «مراسلون بلا
حدود» ولم تسلم بغداد الجميلة، ذات الحضارة العريقة، من ضمها الى قائمة
المدن الأقل نظافة في العالم لما تعيشه من إهمال في إعمار ما خرّبه
الاحتلال من مبان والبنية التحتية من المجاري والطرق وتصريف المياه
ومحطات تزويد الكهرباء.
وفي تقرير، أخير، لبرنامج البيئة التابع لمنظمة الأمم المتحدة، إحتل
العراق المرتبة الخامسة لأكثر دول العالم تأثرا بظاهرة تغير المناخ
والاحتباس الحراري في العالم. ويمكن تلخيص انعكاساته بنقص المياه
الصالحة للشرب والري، والتوظيف العشوائي للمياه الجوفية، وقلة المياه
في نهري دجلة والفرات جراء بناء إيران وتركيا السدود، خلافا للاتفاقيات
الدولية. مما سبّب ترك الزراعة والنزوح إلى المدن غير المهيأة أساسا
لاستقبال النازحين.
على الرغم من هذه التقارير، المرتبطة بالتغير المناخي والبيئي العالمي،
وانعكاساته على الحياة، بكافة جوانبها، في العراق، والتي دفعت منظمة
«المجلس النرويجي للاجئين» إلى التصريح، في الأسبوع الماضي، بأن نصف
سكان العراق تقريبا في حاجة إلى مساعدة غذائية في المناطق المتضررة من
الجفاف، لاتزال الحكومة أو بقاياها تتأرجح بين الفساد والاقتتال حول
نتائج الانتخابات الأخيرة، مستفيدة في الوقت نفسه من فرصة تزويق موقعها
إعلاميا، والانضمام إلى جوقة المنادين بتحسين البيئة، في المؤتمرات
الدولية، بدون إتخاذ أي إجراء حقيقي. كما فعل وزير البيئة العراقي عشية
انعقاد قمة غلاسكو المناخية والمعروفة بمؤتمر منظمة الأمم المتحدة
لتغير المناخ، حين اختار الحديث عن التداعيات الكارثية لتغير المناخ
على الأمنين الغذائي والمائي. ولم يشر الى القصور في تنفيذ البرامج
الإصلاحية والتنموية التي قلما يتم تنفيذها.
ولفهم الكارثة البيئية الحالية في العراق، من الضروري النظر في الوضع
السياسي وخاصة تجزئة الدولة بين تكتلات سياسية، تتنازع إلى حد الاقتتال
فيما بينها، مما جرد الدولة من أية قوة وسلطة مركزية تؤهلها لاعمار
البنية التحتية ووضع حد لنزاعات المحاصصة الطائفية والعرقية المنعكسة
على توزيع الموارد فضلا عن الفشل في إجبار الدول المجاورة على إحترام
حقوق العراق. وفي الوقت الذي صنّفت فيه « منظمة الأغذية والزراعة للأمم
المتحدة» العراق ضمن 44 بلدًا في حاجة لمساعدات خارجية مُلحة من
الغذاء.
هذه الحالة المأساوية معروفة الأسباب محليا وعالميا، فعدم تطبيق سبل
العلاج الناجعة (وما أكثر ما كُتب عنها) وبناء البدائل، بالإضافة إلى
تواطؤ الحكام المحليين سياسيا واقتصاديا مع منظومة الدول الامبريالية،
وتشجيع سياسة السكوت والاستسلام والرضا بالواقع المأساوي، بدلا من
الرفض والمقاومة، وتنامي الاحساس بالهوية الفرعية بديلا للوطنية، مسؤول
عن خلق مناطق النزاع حتى بين الضحايا، حيث تحتل النزاعات الاجتماعية
البيئية حول الأراضي والموارد وسبل العيش مركز الصدارة.
كاتبة من العراق
عن غيفارا وانسحاب
القوات الأمريكية من العراق
هيفاء زنكنة
ثلاثة أحداث تستحق التوقف عندها هذا الأسبوع، على الرغم من عشرات
السنين وآلاف الأميال التي تفصل بينها. الحدث الأول هو الإعلان العراقي
الرسمي عن «انتهاء المهمة القتالية لقوات التحالف وانسحابها من
العراق».
أثار الإعلان بدلا من الفرحة الشعبية العارمة بالتخلص النهائي من قوات
الاحتلال، ردود أفعال متباينة، إقتصرت على الأحزاب والميليشيات، مع
بقاء الشعب المُدرك لزيف ما يجري متفرجا، خاصة بعد أن صرح جون كيربي،
المتحدث باسم البنتاغون، بأن انتهاء المهمة القتالية في العراق لا يعني
انسحاب القوات الأمريكية من البلاد. وأنه «لن يكون هناك تحول
دراماتيكي» متمنيا للشعب العراقي « استمرار كفاءة وثقة قواتهم الأمنية
في ميدان القتال ضد داعش».
يشكل الحدث الثاني أو الأصح مناسبة ذكراه، الخلفية التي لم تفقد قدرتها
على إضاءة ما يجري، حاليا، من وقائع لتساعد على التحليل والفهم العميق،
من خلال ربطها مع بعضها البعض، بعيدا عن عقلية « الغيتو» السائدة، في
التحليل السياسي والاجتماعي والاقتصادي، عند النظر في واقع بلداننا.
وإذا ما حدث الربط فإنه لا يخرج عن محيط الربط ببلدان الاستعمار القديم
واستمراريتها بالنيوكولونيالية، والهيمنة الاقتصادية العالمية. فكل ما
يحدث، يُربط فورا بأمريكا وبريطانيا وفرنسا، مثلا، أما أفريقيا وأمريكا
اللاتينية وجنوب شرق آسيا والهند وحتى الصين، فإنها مجرد أماكن قلما
تُذكر إلا إذا حدث وانطلق منها، حسب وجهة نظر شرطة العالم، ما يُهدد «
أمنها».
الحدث الثاني هو الذكرى السنوية لخطاب تشي غيفارا، أمام الجمعية العامة
للأمم المتحدة في نيويورك – 11 ديسمبر/ كانون الأول 1964. الخطاب الذي
بات معروفا بجملته الأخيرة « الوطن أو الموت». الجملة التي لا يزال
الشباب يرددونها في فلسطين والعراق وبقية البلدان العربية وفي أرجاء
العالم، بمواجهة الاحتلال والقمع والاستغلال والهيمنة الإمبريالية.
شباب قد لا يعرفون شيئا عن خطاب غيفارا إلا أنهم يُدركون جيدا معنى
النضال من أجل الحرية والكرامة، الذي يتجاوز حدود الزمان والمكان،
للتمتع « بحياة جديدة والمطالبة بحقهم المطلق في تقرير المصير والتنمية
المستقلة لدولهم». وهنا تكمن قوة خطاب غيفارا وقدرته الساحرة على رؤية
ما هو أبعد من الآني في مختلف البلدان، بضمنها الدول الرأسمالية.
« كيف ننسى خيانة الأمل؟ «، جاء هذا التساؤل المرير في خطاب غيفارا عن
جريمة إغتيال القائد الأفريقي باتريس لومومبا، الذي وضع ثقته بالأمم
المتحدة. وهو تساؤل لا يزال يُطرح حول دور الأمم المتحدة الذي تريد
الإمبريالية تحويله « إلى بطولة خطابية لا طائل من ورائها، بدلاً من حل
مشاكل العالم الخطيرة».
للحركات الشعبية أدوات نضالية استحدثتها الأجيال الجديدة مع الإبقاء على ذات القيم الإنسانية التي بقيت منغرزة بالوجود الإنساني عبر تاريخه، بشرط الحفاظ على الوحدة الداخلية ، والإيمان بالعدالة، وذلك التوق المستدام للحرية والكرامة والمساواة
يُضيء التساؤل الحدث الثالث الذي تصادف ذكراه هذه الفترة أيضا. ففي عام
2004، عاشت الفلوجة، مدينة المقاومة، وحشية قوات الغزو الامبريالي،
بأبشع صورها من القصف باليورانيوم المُنضَب وتدمير حوالي 70 بالمئة من
المدينة إلى قتل وجرح وتهجير الآلاف من السكان. ولم تكن قوات الاحتلال
لوحدها مسؤولة عن الجرائم بل شاركتها طبقة من المتعاونين العراقيين، من
« العبيد الاستعماريين». طبقة يُعرفّها غيفارا، بأنها تساهم في تجميل
صورة « الحضارة الغربية» المكونة في حقيقتها، من الضباع وابن آوى. « من
حيوان يتغذى على لحوم الشعوب العزّل. هذا ما تفعله الإمبريالية
بالرجال.» موضحا بأنه « ربما يعتقد العديد من هؤلاء الجنود، الذين
حولتهم الآلة الإمبريالية إلى أقل من البشر، بحسن نية أنهم يدافعون عن
حقوق جنس متفوق».
وتكاد الصورة التي رسمها غيفارا عن إستخدام المرتزقة في منطقة البحر
الكاريبي، في حقبة الستينيات من القرن الماضي، تنطبق بحذافيرها على
توظيفهم في العراق « يجب أن نلاحظ أن أخبار تدريب المرتزقة في أجزاء
مختلفة من منطقة البحر الكاريبي ومشاركة حكومة الولايات المتحدة في مثل
هذه الأعمال يتم تقديمها على أنها طبيعية تمامًا في الصحف في الولايات
المتحدة». كما تنطبق على ارتكابهم الجرائم بحق المدنيين بموافقة أو صمت
الساسة العراقيين، ومن قبلهم حكام أمريكا اللاتينية، مما يدل، تاريخيا
وحاليا، على « مدى الاستهانة التي تحرك بها حكومة الولايات المتحدة
بيادقها.»
هل صحيح أن التاريخ يُعيد نفسه بشكل كوميدي؟ أي تعريف للتاريخ ينطبق
على العراق؟ تُبين مراجعة حقبة الستينيات، بتعقيداتها السياسية
والاقتصادية، وما صاحبها من آمال كبيرة بإمكانية التغيير، عند مقارنتها
بالأوضاع الحالية، أن التاريخ مكون من صفحات / حقب، قد تكون منفردة الا
ان تراكمها كما التلة المكونة من طبقات أثرية، متراكمة على مر العصور،
تجعله يتشكل من خلال التراكم والتواصل المعرفي للمجموعات البشرية
والأجيال المتعاقبة. فلا غرابة أن تنقلنا مقولة الرئيس الكوبي الراحل
فيدل كاسترو «ضعوا حداً لفلسفة النهب وستنتهي فلسفة الحرب أيضاً « إلى
القرن الواحد والعشرين، لنجد ان فلسفة النهب لم تنته وخطاب الرأسمالية
الاحتكارية، المُشّجع لفساد الحكومات المحلية، أقوى من أي وقت مضى. كما
أنها لاتزال تتعامل مع التعايش السلمي كأنه « حق حصري لقوى الأرض
العظمى» يُفرض، وفق إرادتها، وبقوانين دولية تُطبق بشكل انتقائي. أما
الانتخابات « الديمقراطية» فهي « وهمية دائمًا تقريبًا ويديرها ملاك
الأراضي الأثرياء والسياسيون المحترفون» بالإضافة إلى كونها وسيلة
للمراوغة وكسب الوقت لضمان إنقياد الشعب لحكومة جديدة تم إختيارها سرا
« من أجل حرية مخصية للبلد».
لمواجهة هذا الواقع المحبط، بل ومتحدية إياه، هناك حركات شعبية عديدة
تنمو وتتكاثر، ليس في البلدان التي كانت خاضعة للاستعمار القديم،
ولاتزال بأشكاله الجديدة، بل وفي بطون ذات البلدان التي ولدت
الإمبريالية، خاصة، أمريكا. لهذه الحركات، أدوات نضالية استحدثتها
الأجيال الجديدة مع الإبقاء على ذات القيم الإنسانية التي بقيت منغرزة
بالوجود الإنساني عبر تاريخه، بشرط الحفاظ على الوحدة الداخلية ،
والإيمان بالعدالة، وذلك التوق المستدام للحرية والكرامة والمساواة
للجميع بلا تمييز.
كاتبة من العراق
اليوم العالمي لمناهضة العنف
ضد المرأة… جعجعة بلا طحين!
هيفاء زنكنة
بين اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة في 25 نوفمبر / تشرين
الثاني واليوم العالمي لحقوق الانسان في 10 ديسمبر/ كانون الأول، ولدت
حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، حيث تقام في عديد البلدان، في
أرجاء العالم، ندوات وفعاليات تجمع بين الاستنكار والمطالبة، أما بشكل
رسمي أو من قبل منظمات المرأة خاصة. وإذا كانت مشاركة منظمات المرأة
مفهومة، إلا أن الخطاب الرسمي، دخل على الخط في السنوات الأخيرة، جراء
ضغوط دولية سياسية واقتصادية. فلا يكاد يخلو بلد، خلال حملة 16 يوما،
من خطاب لرئيس دولة أو رئيس وزراء أو مسؤول كبير، لا يندد فيه بالعنف
ضد المرأة مستنكرا إستهدافها، لأنها « تشكل نصف المجتمع ولولاها لما
كانت للأمة قيمة» وتأكيدا « على دور المرأة ومكانتها الرفيعة». بل وصار
المسؤولون الذين ينظرون إلى المرأة، طوال أيام السنة، باستثناء أيام
حملة 16، بشكل دوني، يوجهون منظمات المجتمع المدني لتنفيذ « أنشطة
وفعاليات خلال فترة حملة الـ 16 يوما يرتكز على إدراك عميق بالدور
المتميز لها».
أشير هنا الى دور الحكومات في البلدان العربية، حيث تتبدى الهوة بين
النص والتطبيق بأوضح تفاصيلها. وتمتد إزدواجية المعايير والاستخدام
المزور لنضالات المرأة التاريخي لتشمل كل البلدان العربية من شمال
أفريقيا إلى الخليج. فمن يتابع فعاليات حملة 16 يوما سيجد أن أكثرها
جذبا للتغطية الإعلامية هو تصريحات المسؤولين وحضورهم هذه الفعالية أو
تلك. وكلهم يستنكرون العنف ضد المرأة. مما يستحضر، في الاذهان، صور
الاستنكار الرسمي العربي بالاحتلال الصهيوني لفلسطين.
ما نراه اليوم يتكرر منذ سنوات. يُردد المسؤولون خطبهم العام تلو العام
في قاعات كبيرة تغص بالرجال وعدد من النساء اللواتي يحظين بمقاعد الصف
الأمامي، ربما لأول مرة، لأغراض العرض والتزويق، في ذات الوقت الذي
تشير فيه الاحصائيات إلى تزايد مستوى العنف ضدها أضعافا. وتكاد الصورة
أن تتطابق، في معظم البلدان العربية، مع إختلاف بسيط في التفاصيل حول
تعريف العنف وما ينص عليه الدستور، ومجلة الأحوال الشخصية، وما وقعته
الحكومات من قوانين واتفاقيات دولية، باتت تتناول موضوع العنف من عديد
الجوانب، والتي لم يعد تعريف العنف فيها يقتصر على الاعتداء الجسدي، بل
تعداه إلى المادي والفكري والسياسي. لا أحد ينكر، بطبيعة الحال، أهمية
التشريعات والقوانين المحلية وما تنص عليه الدساتير في حماية حقوق
المواطنين، كما لا يمكن إنكار دور القوانين الدولية المناهضة للعنف.
إلا ان إبقاء عنف الدول والأنظمة على الهامش، وهو الأكثر شمولية ضد
المرأة كمواطنة في مجتمع يضمها مع الرجل سوية، وعلى قدم المساواة، هو
جوهر إشكالية قراءة القوانين والاتفاقيات من منظور محلي، خصوصا حين لا
تجد الدول العظمى، المؤطرة للقوانين، حرجا أما في ممارسة « العنف»
بنفسها، بشكل غزو وإحتلال لشعوب بكاملها، كما في العراق، أو المساهمة
بارتكابها، بالتعاون مع حكومات محلية، أو النظر جانبا، مع توفير الدعم
الاقتصادي والسياسي للأنظمة القمعية، حين يتم خرق وانتهاك حقوق الشعب،
بضمنه المرأة. والتعامل مع المرأة وكأنها كائن، منعزل تماما عن بقية
الشعب. لكل هذا، طبعا، تبريراته الرسمية الجاهزة، المتسربلة بلغة
الأقناع، ما دامت تحدث في بلدان « أخرى» غير بلدانها ومن قبل حكومات
تقدم نفسها كممثلة للشعب.
تمتد إزدواجية المعايير والاستخدام المزور لنضالات المرأة التاريخي لتشمل كل البلدان العربية من شمال أفريقيا إلى الخليج
يُقدم لنا العراق، عند مراجعة الفعاليات الرسمية والمنظماتية، نموذجا
لفهم التردد وقلة الاقتناع في الاحتفال المناسباتي، بحملة 16 يوما. كما
تقدم لنا نوعية الفعاليات المقامة، حتى الآن، بعض الأجوبة المحددة،
بعيدا عن العموميات. إذ تعكس فعاليات المناسبة أولا كون العراق مقسما،
فعليا، الى نظامين وعاصمتين هما بغداد وأربيل (عاصمة كردستان
الجنوبية). كما تعكس، عمليا، تجزؤ هوية المرأة كمواطنة عراقية. حيث
تقدمت الهوية الفرعية، القومية، الدينية، المذهبية، تدريجيا (المفترض
فيها ان تُكمل وتُغني الهوية العراقية الجامعة) لتصبح لدى عديد منظمات
المجتمع المدني، بوابة شاسعة للحصول على الدعم المادي من قبل منظمات
وأنظمة أجنبية، وتسويق بديل للهوية العراقية. مما أدى بدوره، جراء
التهافت على الدعم المادي، حتى بين المنظمات نفسها، إلى مأسسة حالة لا
مبالاة بقضايا المرأة ككل والتركيز على المتجزأ، حسب قاعدة « معاناتي
هي الأكبر وما أتعرض له هو الأخطر».
أما على مستوى الاحتفال الرسمي، فقد أصدر رئيس حكومة إقليم كردستان
مسرور بارزاني، بياناً غَيّبَ فيه العراق والمرأة العراقية. آملا أن
يغدو إقليم كردستان، مثالاً ناصعاً عن حماية حقوق الإنسان، وإنهاء جميع
أشكال العنف. ويأتي بيانه، بذات الوقت الذي تعامل فيه قوات الشرطة
الطلاب والطالبات الجامعيين في السليمانية المطالبين بحقوقهم بالعنف
والاعتقال. وكان نائب رئيس المفوضية الأوروبية قد اتصل بالبارزاني، قبل
يوم، لمناقشة أوضاع « المهاجرين الكرد» المأساوية على الحدود بين
بولندا وبيلاروسيا. فَحَثَ بارزاني النائب على حشد الدعم من الاتحاد
الأوروبي لتأمين الإغاثة الإنسانية العاجلة للعائلات التي تقطعت بها
السبل!
وفي بغداد، سارع رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي إلى إصدار بيان عن وجوب
العمل الجاد على مناهضة العنف ضد المرأة، بينما لا تزال قضايا آلاف
الشهداء والمختطفين والمعوقين من الشباب/ الشابات، المتظاهرين في
انتفاضة تشرين 2019، بلا مساءلة.
وتعطينا عناوين نشاطات بعض المنظمات النسوية، مثل «حول دور الناجيات
الأيزيديات والشبك» وندوة « نساء كردستان» فكرة عن تقسيم المرأة، في
البلد الواحد، إلى جزئيات ولكل جزئية مظلوميتها الخاصة. كما يعطينا
بيان منظمة « رابطة المرأة» التابعة للحزب الشيوعي، نموذجا لأختيار
المنظمات النسوية عدم التطرق الى عنف الدولة وماجره غزو البلد
واحتلاله، وإلقاء اللوم، غالبا، على «العنف الأسري والمجتمعي». وكأن
ضحايا الاحتلال، الذين يُقدر عددهم بما يقارب المليون، ولنفترض أنهم
جميعا من الرجال، لم يكونوا ينتمون الى عائلة، تُركت بعد قتلهم، في
رعاية إمرأة. هذه المرأة، مهما كانت هويتها الفرعية، عراقية تستحق أن
تعامل كمواطنة في بلد يحترم حقوق مواطنيه إناثا وذكورا، ولن يتم ذلك من
خلال تفتيت القضايا، والعزل الجنسوي، وتسكين الآلام آنيا، بل من خلال
النضال المشترك لإيجاد الحلول الجذرية النابعة، عضويا، من داخل
المجتمع، وبالتضامن مع شعوب تلتزم، فعلا، بحقوق الإنسان والقوانين
الدولية، لها وللآخرين.
كاتبة من العراق
العراق… الشعب يريد
وطنا والميليشيات تريد وطنا
هيفاء زنكنة
هل بالإمكان «إختطاف» ما يريده الشعب من حقوق وطموحات بواقع ومستقبل
أفضل مما يعيشه؟ بمعنى الاستحواذ على ما يطالب به الناس وتعابيرهم عما
يريدون؟ تعاني أغلب البلدان في لحظتنا التاريخية هذه، ومنها حتى دول
متقدمة كأمريكا منذ انتهاء الحرب الباردة، مرورا بولاية دونالد ترامب
وحتى الان، من اختلال في وعي المجتمع المنقسم على نفسه، والانجرار الى
ما يحشد له الإعلام السياسي المتطرف إستخداما للعواطف والاكاذيب
والتخويف والترغيب، حتى بما هو واضح أذاه للناس مباشرة او في المنظور
القريب. فهل نجح نظام ما بعد الاحتلال في تحقيق ذلك عبر إختطاف روح ما
يريده الشعب فعلا؟
من يراجع إنجازات النظام العراقي الحالي، منذ غزو البلد وتركه عرضة
للنهب وساحة للصراعات الخارجية، سيجد أن ذلك ممكن وأنه تجاوز حدود
الاختطاف الجسدي للمواطنين. حيث بينت مظاهرات ميليشيات الأحزاب،
المتربعة على السلطة، في أسابيع ما بعد إجراء الانتخابات بأن من بين
مهاراتها متعددة المستويات، قدرتها على إختطاف أساليب النضال الجماهيري
والتلاعب بها إلى حد يصعب فيه، أحيانا، التمييز ما بين الحقيقي
والزائف. فالانتخابات التي تم الترويج لها بقوة إعلاميا وماديا، بدعم
دولي لا مثيل له، ناهيك عن تشجيع المرجعية الشيعية الداعية الى
المساهمة في الانتخابات، بعد أن اختارت غالبية الجماهير مقاطعتها،
والتي تم وصفها بأنها من أكثر الانتخابات التي شهدها العراق نزاهة
وشفافية وسلاسة، سرعان ما تحولت، حال إعلان النتائج بخسارة عدد من
ميليشيات الاحزاب، الى انتخابات زائفة ومزورة ولا يمكن القبول بها
إطلاقا.
وكما هو واضح من نزول متظاهرين من الميليشيات الحزبية الخاسرة إلى
الشوارع والاشتباك مع قوات أمنية، والتهديد باقتحام المنطقة الخضراء،
رمز المحتل الأمريكي والحكومة العراقية بالنيابة معا، بأن خبرة ما
يقارب العشرين عاما من إستلام الأحزاب المليشياوية السلطة، قد أثمرت من
ناحية سرقة جوانب من آلية النضال الجماهيري الذي عاشه العراق، بشكل
متواصل، منذ أيام الاحتلال الأولى عام 2003، في النزول الى الشوارع
والاعتصام ومقاومة المحتل بكل السبل الممكنة وتحرير الوطن. وحقق النظام
نجاحا معقولا، في استغلال المطالب والحقوق، وإعادة تدويرها وتقديمها
بشكل شعارات شعبوية، مغلفة بقدسية ذات بعد مذهبي، تُساعد على تقبلها
وكأنها من صلب حقوقها التاريخية.
فالانتخابات المبكرة ألتي نادى بها المتظاهرون والمعتصمون على مدى عام،
للتخلص من الفساد والطائفية والإصلاح العام والتحرر من الأحتلالين
الأمريكي والإيراني، خلال إنتفاضة تشرين/ أكتوبر 2019، مثلا، سرعان ما
إستولت عليها واحتوتها أحزاب الميليشيات، من خلال تعبئة وتحشيد وتخويف
أفرادها من « الآخر» وتجريدهم من إنسانيتهم. وتحول الثمن الغالي الذي
دفعته الجماهير، متمثلا باستشهاد وإصابات واعتقالات وتعذيب تجاوز عشرات
الآلاف من المحتجين، تحول الى عملة مقايضة لصالح الأحزاب ذاتها التي
ساهمت بارتكاب الجرائم بلا مساءلة. وهي المشاركة في ماسسة العملية
السياسية ومتقاسمة للحكومة، بدءا من تيار الصدر وحزب الدعوة والحزب
الأسلامي إلى كتائب حزب الله والحشد الشعبي. كما استولت أحزاب
الميليشيات على أهم شعار جَسّد الانتفاضة وهو « نريد وطنا». فصار
لمفردة « الوطن» معاني تم تطويعها وفق استخداماتها الحزبية.
كان بإمكان هذه الأحزاب، تمرير أجندتها الزائفة، على نسبة من السكان، خاصة بعد إختطاف وإعادة تدوير مطالب منتفضي تشرين، لولا لجوئهم إلى ما يجيدون ممارسته، فعلا، وهو استخدام العنف بأشكاله المتعددة
وأخذت معنى جديدًا لتثير ردود افعال مختلفة تمامًا عما إعتبره
المتظاهرون حقا من حقوقهم الأساسية ويجب إستعادته. بينما حملت المفردة،
بعد تدويرها حزبيا ومليشياويا، معنى هلاميا يخلط ما بين الوطن والسلطة.
الوطن إذن موجود، ونحن مالكوه، ما دمنا نتحكم بالسلطة. ويجب الدفاع
عنها بأي ثمن ولن نتخلى عنها، كما صرح رئيس الوزراء السابق نوري
المالكي قائلا بطائفيته المقيتة وعباراته عن أبناء الحسين مقابل أبناء
يزيد، التي يستحق عليها العقاب لتأجيجه خطاب العنصرية والكراهية
والتحريض على القتل.
تم تحوير صوت الشعب الحقيقي المطالب باستعادة الوطن الى صيغ جاهزة،
مبتذلة لفرط التكرار من قبل ساسة فاسدين، لصالح أجندة سياسية لهذا
الحزب المدعوم أمريكيا، الذي لا برنامج لديه غير مهاجمة إيران، ضد
الحزب المدعوم إيرانيا والذي لا يملك برنامجا غير مهاجمة أمريكا.
كلاهما يدعيان تمثيل الشعب العراقي بينما، هما في الحقيقة، يعملان وفق
أجندات ومصالح فئوية لا علاقة لها بمصلحة الشعب على المدى القريب أو
البعيد، وإبقاء حياة العراقيين مؤجلة ومحكوم عليها بالمخاوف والقلق
وعدم الاستقرار، في أجواء دعائية غايتها « أن تخلق مستوى القلق الأمثل»
حسب مهندس الإعلام النازي غوبلز.
فحين يصرح هادي العامري، المسؤول الفعلي لميليشيا الحشد الشعبي، قائلا
« سندافع عن اصوات مرشحينا وناخبينا بكل قوة» و « اننا لا نقبل بهذه
النتائج المفبركة مهما كان الثمن». فأنه لا يأتي بجديد بل ان صوته صدى
لما قاله المالكي قبل سنوات بصدد عدم التخلي عن السلطة. وهو يعمل على
تعبئة العواطف المتمثلة بشخصه « الرافض» أكثر منه طرح برنامج للإصلاح
والبناء، أو بديلا للانتخابات التي تأرجح ما بين دعوة أتباعه للمشاركة
فيها بقوة أولا ورفضها بقوة أكبر حين خسرها. وإذا كان العامري، خلافا
لمقتدى الصدر، لا يملك القدسية المحيطة بالصدر كوريث للصدر الأول،
وتصنيمه من قبل اتباعه، كمرجع ديني واجب الطاعة، فانه بتجسيده لشخصية
المقاتل من أجل « الإمام « الخميني ومن حكم بعده، وباستغلال دعائي ناجح
لإعلان الانتصار على داعش، جراء القصف الجوي المستمر للتحالف الدولي
والقوات العراقية على الأرض، نجح العامري في إضفاء صفة القدسية على
مليشيا الحشد الشعبي ليتمتع بوسم الإفلات من العقاب مهما إرتكب.
ولم تقتصرعملية إختطاف حقوق ومطالب متظاهري إنتفاضة تشرين على الشعارات
واللافتات، والنزول الى الشوارع ونصب الخيام، والاعتصام، بل إمتدت إلى
جوانب ثقافية ذات خصوصية دينية وتأثير يحفز عواطف الشباب كالرادود
المعتاد في مجالس العزاء وزيارات مراقد الأئمة ومناسبات الاستشهاد
التاريخية. ومع توفر الدعم المادي الكبير ووجود التغطية الإعلامية عبر
قنوات تملكها الأحزاب أو مدفوعة الأجر، كان بإمكان هذه الأحزاب، تمرير
أجندتها الزائفة، على نسبة من السكان، خاصة بعد إختطاف وإعادة تدوير
مطالب منتفضي تشرين، لولا لجوئهم إلى ما يجيدون ممارسته، فعلا، وهو
استخدام العنف بأشكاله المتعددة، من اختطاف وتعذيب وحملات الاغتيال
بشكل علني.
كاتبة من العراق
لا صديق للكرد
المهاجرين على حدود بولندا
هيفاء زنكنة
الرئيس الأمريكي جو بايدن قلق هذه الأيام، يشاركه القلق الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين، ليس بسبب «محاولة اغتيال» رئيس وزراء حكومة تصريف
الأعمال، في العراق، مصطفى الكاظمي، في الأسبوع الماضي. فمشاعرهما،
ومعهما كل من هب ودب من المسؤولين الأمريكيين والأوربيين والشرق
أوسطيين، كانت أعمق من مجرد القلق ولغة الإدانة والاستنكار ونعوت
الإرهاب. بل ووصل رذاذها مجلس الأمن المعروف بصمته، عادة، تجاه جرائم
الإبادة الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني أو حتى إدانة سياسة الاستيطان
على الرغم من كونها مخالفة للقانون الدولي، وإذا ما أخذنا حالة العراق،
مثالا، فإن صمت مجلس الأمن مُدّوٍ إزاء جرائم التطهير المذهبي والتهجير
القسري في محافظة ديالى، شرق العراق، في الأسابيع الأخيرة، بمشاركة
«الحشد الشعبي» المنخرط في القوات الأمنية الحكومية.
مصدر قلق الرئيس بايدن وبوتين هو أن «وضع الأطفال مؤسف وخطير» عند
الحدود بين بيلاروسيا وبولندا حسب تعبير بوتين، على الرغم من أن وضع
الأطفال المؤسف على حدود البلدين ليس وليد الأسبوع الماضي. بل بدأ، في
العام الماضي، حين سمحت حكومة بيلاروسيا بدخول العراقيين أراضيها بلا
تأشيرة. وهي مسألة نادرة الحدوث للعراقيين الذين يعانون الأمّرين
للحصول على أي فيزا، باستثناء ما تمنحه قلة من دول تُعد على أصابع اليد
الواحدة. وبتسهيلات غير عادية، قامت شركات بتنظيم «رحلات سياحية»
بالمئات. فكان من الطبيعي أن تصبح هذه السفرات فرصة عمر لمن يريد
مغادرة العراق، والهجرة مرورا من بيلاروسيا الى بولندا ومنها الى
ألمانيا أو أي بلد أوروبي آخر. فكانت النتيجة، بعد نجاح عبور الآلاف،
إغلاق بولندا حدودها مع بيلاروسيا واتخاذ قرار بأطلاق النار على كل من
يحاول العبور. فبقيت أعداد كبيرة من المهاجرين، بينهم عوائل بكاملها،
معلقة على الحدود بين البلدين. أصبح المهاجرون بيادق تتلاعب بحياتهم
حكومتا بيلاروسيا وبولندا ضمن أجندة الخلافات السياسية. حيث يتهم
الأوروبيون، وهم يسرعون بإصدار القوانين ومد الأسلاك وحشد الحراس للحد
من أعداد المهاجرين إليها، الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بمنح
تأشيرات للمهاجرين ووضعهم على الحدود، كرد فعل على العقوبات الأوروبية
التي فرضت على بلده، لقمعه حركة معارضة بعد الانتخابات الرئاسية في
2020.
يُشكل العراقيون، غالبية المهاجرين المحصورين، حاليا، في وضع لا
أنساني، في درجات حرارة وصلت الصفر مئوي، مما دفع مفوضة الأمم المتحدة
السامية لحقوق الإنسان إلى توجيه نداء إلى الدولتين والعالم مشددة على
ضرورة ألا يقضي اللاجئون ليلة أخرى عالقين بين البلدين. كان ذلك يوم
الأربعاء الماضي، ولم تتجاوز الإجراءات المتخذة توزيع الخشب للتدفئة
ووجبات طعام رُميت على المهاجرين بشكل مهين. وإعلان حكومة الكاظمي
تبرعها ببضعة دولارات للمساعدة. ولا يزال نحو أربعة آلاف شخص عالقين
هناك في برزخ البرد واليأس والانتظار، بعيدا عن أوطان تُعامل أبناءها
بقسوة تجعلهم، يُفضلون الموت على الحياة فيها أو كما يقول المثل
الجزائري الذي يكرره الشباب المهاجرون في قوارب الموت «يأكلني الحوت
ولا يأكلني الدود» وهو ما ينطبق أيضا على الشباب التونسي ألذي تجاوزت
ظاهرة «الحرقة» كونها حلم أبناء الطبقة الفقيرة لتصبح طموحا يسعى إليه
الخريجون من أبناء الطبقة المتوسطة، بحثا عن فرص العمل.
هربا من واقع يجرده من إنسانيته ويُجّمده في قاع مظلم بلا أفق يخاطر المهاجر بحياته وحياة أطفاله
ولا يكف الشباب عن محاولات الهجرة، على الرغم من كل المخاطر والصعوبات
الجسيمة. وهو ما يُجمع الشباب على تنفيذه في العراق بأعداد مذهلة. حيث
غادره نحو 28 ألف مهاجر، منذ مطلع عام 2021، تم إلقاء القبض على 803
منهم وإعادتهم إلى العراق، ووفاة 33 منهم، في طرق الهجرة، حسب جمعية
اللاجئين في إقليم كردستان العراق.
تُبين متابعة تفاصيل مأساة المهاجرين على الحدود البيلاروسية البولندية
إن إلقاء اللوم على الصراع الدولي وحده ليس كافيا. فجذر المأساة يمتد،
في عمقه، إلى بلدانهم ومسؤولية حكوماتهم، مهما كانت طبيعتها. بالنسبة
إلى المهاجرين العراقيين، تشير تقارير المنظمات الحقوقية إلى أن معظم
المهاجرين هم من الكرد الهاربين من إقليم كردستان العراق الأمر الذي
يثير عديد التساؤلات حول صورة الإقليم الديمقراطية المزدهرة، غير
الملوثة بفساد بقية العراق، التي تروّجها أجهزة إعلام رئاسة الإقليم.
الإقليم المتقاسم سياسيا واقتصاديا بين عائلتين هما البارزاني ومقرها
أربيل، وعائلة طالباني ومقرها السليمانية. تتصرف العائلتان بكل ما هو
موجود في الإقليم ولا يمكن تجاوز أفرادهما المستحوذين على مراكز
السلطة، بأي شأن كان، خاصة عقود النفط. نجحت العائلتان بتكوين طبقة
ملياردية، في فترة قياسية، على حساب العاطلين عن العمل، فقط لكونهم،
غالبا، لا ينتمون الى أي من العائلتين ـ الحزبين. وهو السبب ذاته الذي
يعاني منه الخريجون، الذين لا ينتمون لأحزاب الحكم الفاسدة في بقية
أنحاء العراق. إذا أضفنا الى واقع الإقليم ثالوث الطائفية والتهجير
القسري والإرهاب، المستشري في بقية البلد، لفهمنا نفسية الشباب
والعوائل في محاولاتها الهرب بحثا عن المستقبل وإن كان محفوفا
بالمخاطر، ومع كل هرب ينكشف زيف إدعاءات الحكومات المحلية بأنها تمثل
أبناء الشعب وتحمي مصالحهم. وهي إدعاءات حكومات تستمد مرجعيتها من
الاستقواء بدول مَكَنّتها من السلطة أولا وباتت درعا لحمايتها من غضب
شعوبها ثانيا. وهذا الغضب هو منبع قلق جو بايدن وبوتين الحقيقي. أما
الخوف على أطفال المهاجرين فهو لا يزيد عن كونه تعبيرا جاهزا وجزءا لا
يتجزأ، من عالم السياسة، بمناوراتها ومصالحها وتحالفاتها الظاهرة
والخفية. وضحايا هذه اللغة الناعمة ـ المغموسة بالإنسانية الزائفة،
المتأخرة، غالبا، التي لا يَطّلع عليها العالم، ما لم تصل حد الكارثة
والموت، هم الأطفال وعوائلهم، المُجبرة على الهجرة من بلدانهم إلى
بلدان يرون فيها مستقبلا أفضل من واقعهم اليومي بتفاصيل الحروب،
والصراعات والفساد والبطالة، وتردي كل أساسيات الحياة التي يجب أن
يتمتع بها كل مواطن في بلده. هربا من واقع يجرده من إنسانيته ويُجّمده
في قاع مظلم، بلا أفق، يخاطر المهاجر بحياته وحياة أطفاله، المرة تلو
المرة، كي يتشبث بما يراه المنفذ الوحيد للحياة، ويبقى البديل، واحدا
على مر تاريخ الشعوب وحاضرها، وهو استمرارية النضال، بأشكاله المتعددة،
لاستعادة الأمل المتمثل بوطن يتسع للجميع بلا استثناء.
كاتبة من العراق
الصراع على السلطة بين
العوائل الحاكمة في العراق
هيفاء زنكنة
كيف يمكن فهم ما يجري حاليا في العراق من عنف تجسد بالتخريب والاقتتال
بالرصاص الحي أو بالطائرات المسيرة المفخخة، في أعقاب انتخابات تم
تسويقها باعتبارها من أكثر الانتخابات التي عرفها العراق نزاهة
وشفافية، منذ غزوه عام 2003، ورُحب بها، عالميا، كأعلى مراحل «العملية
السياسية الديمقراطية» التي أسستها الولايات المتحدة الأمريكية
وبريطانيا، بمساهمة أحزاب وشخصيات عراقية، وباركتها عشرات الدول
والمنظمات الحقوقية من أرجاء العالم؟ ماذا عن الأحزاب التي حشّدت
للانتخابات كما لو كانت الحل السحري لكل المشاكل ثم عادت ورفضتها
بكليتها، باحتجاجات وهجوم على القوات الأمنية، حالما دلت النتائج على
عدم فوزها بها؟ هل هي العنجهية الناجمة عن الاستقواء بالخارج؟ أم أنه
السياق الطبيعي لنمو بذرة هجينة، زُرعت في غير تربتها، بمساعدة هرمونات
اصطناعية؟ وها هو الحصاد: محصول لا يتعرف عليه، لفرط تشوهه، حتى من
زرعه، ولا علاقة للحقل الذي نُثرت فيه بذور الغزاة بالنمو العضوي
المتعارف عليه للطبيعة.
لينأى بنفسه عن الفساد ومن يمثله، اختار أغلب العراقيين مقاطعة
الانتخابات، باستثناء نسبة من المحتجين في انتفاضة تشرين الأول/اكتوبر،
تاركين الساحة للمتقاتلين على المحاصصة الطائفية، والعرقية، والفساد
المالي والإداري، بالإمكان تقسيمهم إلى نوعين. يضم النوع الأول أحزابا
صار لديها باع طويل، يقارب العشرين عاما، في تمثيل أما السياسة
الأمريكية أو الإيرانية بالنيابة، بالإضافة إلى تجذير مصالحها
وطموحاتها الخاصة. من بين هذه الأحزاب: حزب الدعوة والحزب الإسلامي
والحكمة والاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني. ويضم
النوع الثاني الميليشيات المسلحة التي تمت شرعنتها كأحزاب، بعد أن
تكاثرت بسرعة الفايروس، مع تزايد الولاء لهذه الجهة أو تلك ومع تنوع
مصادر سلاحها، فأصبحت أكثر قوة وسيطرة على الشارع من الحكومة. وحازت
على دعم الأحزاب (الأم) التي احتاجتها للقضاء على أي مقاومة للاحتلال،
فضلا عن القضاء على الجيل الجديد من أبناء انتفاضة تشرين المطالبين
بوطن.
من بين أبرز أحزاب الميليشيات: سائرون (وجه سرايا السلام وما يسمى
بالتيار الصدري) و«الحشد الشعبي» المكون من 45 فصيلا، أبرزها حزب الله/
العراق، وعصائب أهل الحق. وكلها، بلا استثناء، مسؤولة عن جرائم
وانتهاكات مذهبية وحملات تطهير، موثقة بالأرقام والتواريخ، في عديد
التقارير الحقوقية المحلية والدولية، بضمنها مجلس حقوق الإنسان التابع
للأمم المتحدة.
وبينما يتظاهر المحتجون على خسارتهم الانتخابات ويهددون باقتحام
«المنطقة الخضراء» ومع تصاعد العنف بينهم والقوات الأمنية، قام مقتدى
الصدر، زعيم التيار الصدري، الفائز بأقل مما توقعه من المقاعد (73 بدلا
من 120 من مجموع 329) وإن أكثر من الكتل الأخرى، باتخاذ خطوة تتماشى مع
سيرته المضحكة المبكية، المعتادة، في معالجة الأزمات. حيث «قَطعَ
سماحته زيارته للعاصمة بغداد، استنكاراً لِما يحدث من عُنف غير
مُبَـرَّر، ومن إضعاف الدولة المُتَعَمَّـد» كما جاء في بيان لمكتبه.
اختار أغلب العراقيين مقاطعة الانتخابات، باستثناء نسبة من المحتجين في انتفاضة تشرين الأول تاركين الساحة للمتقاتلين على المحاصصة الطائفية، والعرقية، والفساد المالي والإداري
لعل أفضل مقاربة لفهم الصراع الدائر، حاليا، بسِمَته التراجو كوميدية،
بما في ذلك اللجوء إلى التصفيات الجسدية والابتزاز وتأجير الحماية، بين
عوائل تنتمي الى المذهب ذاته، وتتبع أو تَدّعي إتباع المرجعية ذاتها،
هي الموجودة في فيلم «العراب».
الفيلم الذي يُبين صراع عوائل المافيا واقتتالها الشرس وترويعها
الآخرين، للاستحواذ على المال، مهما كان مصدره، والسلطة مهما كانت
السبل، واستكشاف طبيعة القوة، والاختلاف بين ما يمكن تسميته بالسلطة
المشروعة وغير المشروعة، بين سلطة الدولة والمؤسسات الشرعية وسلطة
المافيا. ولا يخلو صراع عوائل المافيا، كما في أحزاب عراق اليوم، التي
هي في حقيقتها عوائل تتصرف كأحزاب بقيم عشائرية، من مفهوم الشرف
المتوارث ضمن أفراد عائلة واحدة، بموازاة التحالفات السرية والتكتلات
مع بقية العوائل، وما قد تجلبه من صفقات تجارية وسياسية لهذه العائلة
أو تلك.
ولنأخذ كمثال على المناورات واللقاءات الدائرة، الآن، في بغداد بين
أحزاب النظام وميليشياته لتقاسم المراكز السياسية وما تدره من أموال،
الاجتماع المشهور الذي تم عام 1948، بين رؤساء عوائل المافيا، في
نيويورك، بعد مقتل ابن عراب المافيا فيتو كورليوني. عُقد الاجتماع
للتوسط وإحلال السلام بين عائلتي كورليوني وتاتاغليا المتحاربتين. ترأس
الاجتماع وسيط، سرعان ما أدرك فيتو أن العوائل الأخرى تحالفت معه سراً،
لإجبار عائلة كورليوني على مشاركتهم الحماية السياسية، التي حصلت عليها
العائلة بالاتفاق مع أعضاء في الكونغرس ورجال الأمن والشرطة.
وكان الخلاف الرئيسي بين العوائل حول تجارة المخدرات المزدهرة التي
عارضها فيتو. وافق فيتو على مضض على مشاركة نفوذه السياسي لحماية تجارة
المخدرات، لإنهاء حرب العائلات الخمس. وإذا كان كورليوني قد فشل في
إضفاء الشرعية على المافيا فان ابنه الأصغر نجح، بعد استيراثه، في
تحقيق ذلك من خلال تصفية معارضيه بطريقة وحشية. مما يأخذنا إلى نقطة
تشابه مع خصومات ونزاع أحزاب العوائل التي يقودها، الآن، أبناء جيل
المؤسسين الأوائل كعائلة الصدر والحكيم والخوئي وبدرجة أقل البارزاني
وطالباني، بحماية سياسية وعسكرية من أمريكا وإيران.
وكأن اقتتال الانتخابات ليس كافيا، أضيفت إلى محنة الشعب العراقي جعجعة
محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، التي جعلته، كما أُريد
للانتخابات، محط أنظار العالم، بردود أفعال استنكارية تربع على رأسها
البلدان اللذان يمارسان الإرهاب على أرض العراق. حيث سارعت إيران إلى
تحميل «جهات أجنبية» المسؤولية، في الوقت ذاته، الذي ادانتها الولايات
المتحدة كفعل إرهابي يستهدف الدولة العراقية، مما يثير تساؤلا عن أي
دولة يتحدثون؟ ولم محاولة الاغتيال وقد انتهى الكاظمي من تنفيذ مهمته،
ومن المفترض أن يكون قد أعد حقيبته ليلتحق بعائلته المقيمة خارج
العراق، كما فعل عادل عبد المهدي، رئيس الوزراء الذي سبقه؟
والحل؟ أقتبس هنا جملة للمؤرخ الفلسطيني سلمان أبو ستة، مؤلف «أطلس
فلسطين» التوثيقي لمدن وقرى فلسطينيّة، هدمها المحتل الصهيوني، في
إجابة عن سؤال حول المستقبل، وتكاد تنطبق مقولته على العراق بحذافيرها،
حيث يقول: «بدأت العمليّة تتم للقضاء علينا باستخدام أناس من الشعب
الفلسطيني، يدّعون أنهم يمثِّلوننا وهذه هي الكارثة الكبرى.. ليس لنا
غير الشباب الذين يستشهدون كل يوم، ويُقتلون بدم بارد… إن الوقت قد حان
لتنظيف البيت الفلسطيني بمكنسة ديمقراطية؛ لإزالة كل الفساد، فشعبنا
يستحق الأفضل بكثير مما هو عليه الآن».
كاتبة من العراق
العراق والتطبيع
في مجلس العموم البريطاني
هيفاء زنكنة
في الوقت ذاته الذي يعيش فيه سكان مدينة المقدادية، في محافظة ديالى،
شرق العراق، حملة قتل وتهجير وتطهير عرقي، من قبل ميليشيات حكومية أو
داعش (وجهان لعملة واحدة) وبمرأى القوات الأمنية والحكومة، أبدى مجلس
العموم البريطاني، اهتماما كبيرا، بالعراق، ولكن بطريقة انتقائية،
تجاهل فيها النواب الإشارة إلى يوميات القتل. حيث تم تناول الوضع
السياسي والاقتصادي والأمني، بالإضافة إلى سياسة العراق الخارجية،
بنعومة تتماشى مع مصلحة الحكومة البريطانية في دعم النظام القائم
الراعي لمصالحها بينما تقترح حلولا للصعوبات والعراقيل بأسلوب سياسي
مُغّر يتميز بنُبل مسعاها ووحشية المتقاتلين فيما بينهم من أهل البلد.
قام عدد من أعضاء البرلمان، من حزب العمال المعارض، بمساءلة الحكومة،
ممثلة بوزارة الخارجية ووزارة الدفاع، أولا: عن التقييم الذي أجرته
بشأن الآثار المترتبة على سياساتها للانتخابات البرلمانية الأخيرة،
وثانيا: العلاقات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية. كما
طُرحت أسئلة حول « النصائح» التي قدمتها الحكومة لنظرائها في حكومة
الإقليم والحكومة الفيدرالية، بشأن معالجة الفساد وتعزيز حقوق الإنسان
والسماح بحرية التعبير.
بالنسبة إلى سيرورة الانتخابات، كانت بريطانيا من أوائل الدول التي
أثنت على «الانتخابات السلسة» وكيف أنها، من الناحية الفنية و«انعدام
أي حوادث أمنية كبيرة» تُشكل تحسناً واضحاً مقارنة بالانتخابات
السابقة. وتفادى وزير الدولة للشؤون الخارجية في جوابه أي ذكر لعدم
إعلان النتائج النهائية، حتى الآن، ومظاهرات الخاسرين من أبناء النظام،
وإعادة توزيع المقاعد وفقا لقوة سلاح الميليشيات. كما لم يتطرق إلى
المقاطعة الكبيرة التي وسمت الانتخابات على الرغم من حملة الترغيب
والترهيب الكبيرة التي صاحبتها، وبذخ الميزانية «التشجيعية».
وجاءت الأجوبة بصدد معالجة الفساد وحرية التعبير مماثلة للموقف من
الانتخابات من ناحية « نُبل» الموقف البريطاني. «سأستمر في إثارة أهمية
معالجة الفساد وتعزيز حقوق الإنسان، والسماح بحرية التعبير، خلال
ارتباطاتي مع القادة السياسيين العراقيين» حسب وزير الدولة المُصّر على
تنفيذ مهمة بريطانيا «الإنسانية النبيلة» وحمل عبء نشر الديمقراطية مع
السفير البريطاني ببغداد والقنصل العام في أربيل، اللذين « يناقشان
بانتظام هذه القضايا مع محاوريهما في كلا الحكومتين».
ينص الخطاب العام للسياسة البريطانية، المتمثل بكل الأجوبة، على تكرار
الصيغة الاستعمارية، الجاهزة، التي تمنحها بالدرجة الأولى صك البراءة
من مسؤولية غزو البلد وتخريبه، مع الإبقاء على هيكلية النظام الضامن
لمصالح بريطانيا الاقتصادية.
«سنواصل العمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين لتشجيع
حكومة جديدة في العراق وحكومة إقليم كردستان على حل مشاكلهما، بما في
ذلك الميزانية المستدامة والحدود الداخلية المتنازع عليها».
ولأن السياسة البريطانية مختلفة عن الأمريكية بكونها أقل عنجهية وأكثر
ميلاً لأن تُغّلف السُم بالعسل، وأنها كما يُصرح مسؤولوها أدرى
بـ«الثقافة العربية» وكيفية التعامل مع الحكام العرب، تم، أخيرا، طرح
السؤال الأهم في مجرى الاهتمام بالعراق. « ما هي الخطوات التي تتخذها
وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية لتشجيع التطبيع الدبلوماسي بين
إسرائيل والعراق؟» طرحت السؤال نائبة تمثل حزب العمال، الذي بات أقرب
الى المنظمات الصهيونية والمحتل العنصري الاستيطاني، منذ إبعاد رئيسه
السابق جيريمي كوربن المعروف بمناصرته الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل
التحرير.
ينص الخطاب العام للسياسة البريطانية، المتمثل بكل الأجوبة، على تكرار الصيغة الاستعمارية، الجاهزة، التي تمنحها بالدرجة الأولى صك البراءة من مسؤولية غزو البلد وتخريبه
أجابها الوزير موضحا ترحيب المملكة المتحدة «بحرارة» باتفاقيات التطبيع
بين إسرائيل والبحرين والإمارات العربية المتحدة والمغرب والسودان.
لأنها «خطوات تاريخية تشهد تطبيع العلاقات بين أصدقاء المملكة
المتحدة». مؤكدا بأن المملكة المتحدة « ستواصل تشجيع المزيد من الحوار
بين إسرائيل والدول الأخرى في المنطقة». وهو الجواب الأكثر وضوحا
ومطابقة للحقيقة والواقع تجاه العراق. وهي المرة الأولى التي يتم فيها
طرح سؤال مباشر وصريح، في البرلمان، عن موقف بريطانيا من العراق الذي
يواجه ضغوطا أمريكية – بريطانية كبيرة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، منذ
غزوه واحتلاله عام 2003.
وقد جرت محاولات سابقة لسبر الروح العراقية الشعبية تجاه التطبيع،
وخطوات عملية من بينها قيام ثلاثة وفود عراقية مكونة من 15 شخصية
سياسية ودينية، بزيارة الكيان الصهيوني، عام 2019، والتقت بمسؤولين
حكوميين وأكاديميين يهود. والمعروف أن علاقة حكومة إقليم كردستان
بالكيان الصهيوني حميمة على عدة مستويات. وقدمت الحكومة الأمريكية
لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اثناء زيارته واشنطن، منتصف العام
الحالي، حزمة إغراءات تضم معالجة المشاكل الاقتصادية المثيرة للنقمة
الاجتماعية، إذ تفاقم الفقر عام 2020 مقارنة بعام 2019، بحيث يعيش ثلث
سكان العراق الآن تحت خط الفقر، حسب الأمم المتحدة، وفتح أبواب
الاستثمار، وتعويض أي انخفاض بأسعار النفط، وتخفيض أعداد القوات
الأمريكية الى حد الغاء وجودها، كل ذلك مقابل الاعتراف بإسرائيل
والمساهمة بعزل إيران.
وتساهم بريطانيا، في حملة الضغط من خلال تقديمها التطبيع، باعتباره
دواء لعلاج المشاكل السياسية والاقتصادية وما تصفه بـ «السخط الشعبي».
إلا ان المحاولات الأمريكية – البريطانية، باءت بالفشل الذريع حين عُقد
في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، يوم الجمعة 24 أيلول /
سبتمبر، مؤتمر بعنوان «السلام والاسترداد» نظمه مركز يدعى «اتصالات
السلام الأمريكي» بحضور عدد من عراقيين تم وصفهم بأنهم « شيوخ عشائر
وكتاب ومثقفون». تزامن عقد المؤتمر الداعي إلى اعتراف العراق بكيان
الاستيطان الصهيوني مع الذكرى السنوية الأولى لـ ( إتفاقات إبراهيم)
التي تواصل الإدارة الأمريكية دعمها على حساب إبادة الشعب الفلسطيني.
كانت ردة الفعل الشعبية العراقية الغاضبة على عقد المؤتمر كبيرة إلى حد
أنكرت فيه قيادة الأقليم علمها بها وسارعت كل الأحزاب والجهات الرسمية
إلى إدانته وإعلان تمسكها التاريخي بالقضية الفلسطينية.
تبين أسئلة المعارضة والأجوبة الرسمية، في البرلمان البريطاني عن
العراق، حول الوضع الاقتصادي المنخور بالفساد والأمني المتهالك، الناتج
بالدرجة الأولى، جراء غزو واحتلال العراق الذي شاركت بريطانيا بقيادته،
استمرارية العقلية الاستعمارية المستهينة، والمحتقرة، لشعوب يختار بعض
أفرادها أما خدمته أو مشاركته النظرة حول إتهام بقية السكان بالجهل
والتخلف وعدم القدرة على إدارة شؤونهم، تبريرا لاستغلالهم وسرقة ثروات
البلد. وهو ما كذبّته إنتفاضة تشرين في 2019 ومقاطعة الانتخابات،
والرفض القاطع لضم العراق الى قائمة موقعي « إتفاقات إبراهيم».
كاتبة من العراق
لماذا تنتخب الشعوب
قادة غير مؤهلين؟
هيفاء زنكنة
ما
الذي يجعل الشعوب، سواء كانت عريقة الديمقراطية كبريطانيا وأمريكا أو
مستحدثة الديمقراطية كالعراق، تختار لقيادتها، في العقد الأخير، خاصة،
حكاما يتميزون بأنهم غير مؤهلين أما سياسيا أو أخلاقيا أو عقليا، أو
كلها معا؟ هل هناك حاجة لقراءة التاريخ البعيد لمعرفة أسباب فوزهم في
عملية باتت تُقدم باعتبارها الخيار الوحيد للشعوب لتفادي الدكتاتورية؟
وهل صحيح أن المصوتين يتماهون، بدرجة أو أخرى، مع شخصيات من يختارونهم
من الفائزين؟
لندع « الفائزين» في بلداننا جانبا. فمفهوم «الديمقراطية» كما بات
معروفا لشعوبنا، يتخذ أشكالا متعددة، ومواصفات تختلف من بلد الى آخر،
عند التطبيق، وان قيل غير ذلك. ثم أن لدينا من النماذج الحاكمة في
البلدان راعية الديمقراطية ما يكفي. ولعل الرئيس الأمريكي السابق
دونالد ترامب هو المثال الأبرز، الذي وفر لآخرين، في جميع أنحاء
العالم، نموذجا يُحتذى به لتخفيض مستوى المطلوب من القيادة.
لقد كُتبت عن شخصية ترامب وفوزه وأسلوب أو لا أسلوب حكمه، كرئيس لأقوى
دولة في العالم، ملايين المقالات، بالإمكان اختزالها، إذا أردنا
استعادة ملامح شخصيته للمقارنة مع آخرين، بالقول بأنه لم يكن مؤهلا
سياسيا أو اقتصاديا. كان يتحرش بالنساء، يسخر من المعاقين، يحتقر السود
والأقليات واللاجئين. شعبوي يغازل رغبات الحشود. يشجع العنصرية كغذاء
روحي للمتعصبين البيض. وحين تقتضي الضرورة، لاستقطاب المتطرفين دينيا،
يتفاخر بقوله «لا أحد يقرأ الكتاب المقدس أكثر مني».
تم وصفه بأنه خطر على العالم، جراء استجاباته السريعة المبنية على
غروره وعنجهيته، وسرعته في إتخاذ القرارات بلا تفكير جدي، وانه خطر على
أمريكا بسبب سرعته في توبيخ الناس، وإهانتهم والانتقام من منتقديه،
بضمنهم مستشاريه. بعض ملامح هذه الصورة كانت معروفة قبل إنتخابه والبعض
الآخر كان بالإمكان الاطلاع عليه عند مراجعة محطات حياته الشخصية
والعامة، خاصة وانه كان معروفا بصيته السيئ في الأوساط المالية
والإعلامية. فلم انتخبه الناس؟
والسؤال ذاته يستحق أن يُطرح لفهم « فوز» تيار سياسي بـ« قيادة» شخص
مثل (سماحة حجة الإسلام والمسلمين القائد السيد أعزه الله) مقتدى الصدر
في انتخابات العراق، على الرغم من تاريخه الشخصي والسياسي المتخبط بين
القرارات الارتجالية، والقفزات السريعة، من موقف الى آخر، المتناقض بين
الخطاب الموعظي ـ التحشيدي ـ الشعبوي بعنوان الاستشهاد والمقاومة
والانكفاء التوحدي. والمراوحة بين الغضب على أحد أتباعه وإنزال العقاب
به أو تسريح الميليشيا التي يقودها باسم والده، أو إعادة تشكيلها تحت
اسم جديد. ويمتد انكفاؤه، أحيانا، شهورا طويلة، في مدينة قم الإيرانية،
بذريعة محاولة إكمال الدراسة الفقهية التي تؤهله، كما ذكر في آخر بيان
له، لإصدار الفتاوى الدينية، أو كتابة الشعر، بالإضافة إلى إرساله
تغريدات تضاهي تغريدات ترامب في نزقها وتدني المستوى العقلي لمرسلها.
إن بروز هذه النماذج، بعيوبها وهذيانها، وأضرارها الآنية وبعيدة المدى، سيستمر إلى أن تتخلص الشعوب من حقبة الأكاذيب المُغلّفة بالزيف الدعائي، لتعيش آمالها في الحرية والعدالة والكرامة
هناك، طبعا، أسباب عديدة ومتشابكة الى حد التعقيد لظاهرة انتخاب «
قادة» غير مؤهلين. يأخذنا بعضها إلى دوافع المشاركة في الانتخابات
أساسا لتحقيق فوز مرشح معين. من بينها الانتماء الحزبي أو الديني أو
العائلي. وقد يكون الاعتقاد بأن التصويت هو الطريق الأسلم للتغيير، أو
الدعم المالي والوظيفي الذي يوفره حزب لأتباعه، أو نتيجة الانصياع
لضغوط إعلامية مكثفة تهدف الى «صناعة» موقف. كما يرى علماء الاجتماع
والنفس أن فعل التصويت هو تعبير عن الانتماء إلى مجموعة أو التعبير
«عمن أكون» فضلا عن الأحاسيس المثالية بأن من يُصوت هو مواطن صالح.
مقابل ذلك، توصل عدد من علماء النفس، الى أن العقلانيين الذين يهتمون
بأنفسهم، لا يعيرون الانتخابات أية أهمية ويرونها مضيعة للوقت.
جوابا عن سؤال عدم الأهلية، وصعود اشخاص لا يستحقون موقع القيادة،
يذكرنا من لم يصوت لهم، بأنه لم يتم انتخاب الشخص غير المؤهل من قبل كل
الشعب، وأن أقلية متنفذة تملك المال والاعلام والسلاح استحوذت على
الأصوات. وأن الناخبين يفضلون، عمومًا، السياسات ذات الحلول الآنية
السريعة التي تساعدهم على حل مشاكلهم المعيشية وتعزز رفاهيتهم على حساب
الحلول الاستراتيجية. بينما يذكرنا آخرون بأن للديمقراطية، أمراضها
ومساوئها حتى في « أمهات الديمقراطية». ثم قد يكون الشخص غير المؤهل هو
الأقل ضررا في حالة الفراغ الأخلاقي، وكما أشار أحد المعلقين أثناء
الحملة الانتخابية الرئاسية التي خاضها ترامب مقابل هيلاري كلينتون عام
2016 «لا يوجد مرشح رئاسي جيد أخلاقيا في هذه الانتخابات» وأن ترامب
«مرشح جيد وإن كانت لديه عيوب». في تلك الحالة، حُسمت الانتخابات، من
وجهة نظرهم، باختيار السيئ من الأسوأ أو أهون الشرين. ولا تخلو عملية
الاختيار الديمقراطي من الانتقام العام. حيث يلجأ المواطن للتصويت ضد
مرشح حزبه الذي طالما ناصره حين يُصاب بخيبة أمل في سياسة الحزب تجاه
مسألة أو قضية يعتبرها مبدئية. أو تلجأ الجماهير للتصويت لصالح شخص لا
ينتمي لأي حزب كان وغير معروف نسبيا انتقاما من الأحزاب المنشغلة
بالفساد والمصالح الشخصية، وهو ما حدث في تونس، حين أُنتخب قيس سعيد
رئيسا للجمهورية وبأعلى نسبة من الأصوات.
وإذا كانت الديمقراطية قد وضعت حدا لديمومة حكم الرئيس، مهما كانت
أهليته، فإنها أسقطت، في الوقت نفسه، وهم الرئيس – القائد بما يحمله من
مواصفات تاريخية وبطولية تغذي مخيلة الجماهير على مدى عقود. وظهر رعيل
جديد من الرؤساء، بمواصفات مغايرة لما كان مألوفا. فرئيس الوزراء
البريطاني بوريس جونسون المتقلب المواقف، الذي يتفوه بما يخطر بباله
بلا تفكير، مهما كانت العواقب، لا يجد غضاضة في التراجع عما تلفظ به
ضاحكا، مازحا. مرسخا صورته، وبالتالي دوره، كشخص يعيش اللحظة، بروح
شبابية مرحة، وتسريحة شعر متطايرة، بعيدا عن كوابيس التاريخ الثقيلة
التي طالما غلّفت حزبه، وبعيدا، بالتأكيد عن شخصية منافسه في
الانتخابات جيريمي كوربن، رئيس حزب العمال، المبدئي الجاد. كان فوز
جونسون نجاحا كبيرا للاستنساخ الأول لترامب.
ولن تتوقف عملية الاستنساخ عند هذه النماذج بل تشير نتائج الانتخابات
في عديد البلدان، العراق مثالا، إن بروز هذه النماذج، بعيوبها
وهذيانها، وأضرارها الآنية وبعيدة المدى، سيستمر إلى أن تتخلص الشعوب
من حقبة الأكاذيب المُغلّفة بالزيف الدعائي، لتعيش آمالها في الحرية
والعدالة والكرامة التي طالما ناضلت من أجلها.
كاتبة من العراق
ما وراء نزاهة وشفافية
الانتخابات العراقية؟
هيفاء زنكنة
كان هناك سخاء مذهل في الثناء على مجريات انتخابات العاشر من تشرين
الاول/ أكتوبر، في العراق. إختلطت العبارات والشعارات السياسية
بالدينية وحتى التخويفية. لجأ المرشحون وقادة الأحزاب والميليشيات
ومبعوثو الأمم المتحدة وسفراء دول إلى استخدامها كسلاح للتأثير
والأقناع الجماعي بضرورة المشاركة في الانتخابات. إنها انتخابات
«مفصليةٌ مصيريةٌ وتأسيسية» و«واحدةٌ من أهم العمليات الانتخابية في
تاريخ العراق الحديث» قال برهم صالح رئيس الجمهورية. « بها يتفادى خطر
الوقوع في مهاوي الفوضى والانسداد السياسي» قالت المرجعية الدينية. إنه
« طريق نأمل أن يؤدي إلى عراق أكثر ازدهارًا وأمناً وعدالة» قالت جينين
هينيس- بلاسخارت مسؤولة بعثة الامم المتحدة بالعراق.
استمر المديح والثناء في يوم التصويت نفسه، وحتى الساعات القليلة التي
تلته. تزكية، أسرعت منظمات دولية ودول وجامعة الدول العربية، بإرسال
برقيات التهاني والتبريكات الى الحكومة والشعب. هنأت السفارة الإيرانية
ووزارة الخارجية الروسية الحكومة والشعب بالنجاح، وأشادت بريطانيا
«بالتسيير السلس» للانتخابات. إتفقت الرواية الرسمية في داخل العراق
وخارجه أن عملية الاقتراع، سارت «بشكل انسيابي» وهي « مختلفة عما جرى
عام 2018 «. ولم تبق صيغة تفضيل لم تستخدم لوصف الانتخابات «النزيهة
الشفافة» أو « الكرنفال» الذي دعت اليه المرجعية الدينية العليا، كما
صرح المتحدّث العسكري باسم كتائب حزب الله العراق، وردد رئيس الوزراء
مصطفى الكاظمي «لقد أتممنا واجبنا بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة».
هذه اللغة الناعمة الرقيقة عن النزاهة، والشفافية، والمصداقية، وصوتك
هو مستقبلك، سرعان ما بدأت بالتبخر، تدريجيا، بعد إغلاق صناديق
الاقتراع، وإعلان مفوضية الانتخابات أنها ستعلن النتائج بعد ساعات.
تبخرت آخر قطرة من التلاعب بلغة التحشيد السياسي. حل محلها خطاب سياسي
يجمع ما بين الترهيب من العواقب والتشكيك بسيرورة الانتخابات التي تمت
بحضور أكبر بعثة انتخابية للأمم المتحدة في جميع أنحاء العالم، وبعد
إجراء أربع عمليات محاكاة انتخابية، وصرف مبالغ خيالية، وبعد توقيع كل
الأحزاب المشاركة على «مدّونة قواعد السلــوك الانتخابي» التي تعهدت
بموجبها « بنبذ التعصب والعنف وخطاب الكراهية». كل هذا تهاوى لغة
وتنظيما وسلوكا، إنزاح السراب سريعا وباسرع مما توقع المراقبون
«الأمميون» حال بدء المفوضية بإعلان النتائج «الأولية «، الدالة أولا:
على أقل نسبة مشاركة منذ تأسيس « ديمقراطية العملية السياسية» إثر
الغزو الأنكلو أمريكي للعراق عام 2003. مما يعني أن التكرار الآلي لنفس
المفردات والعبارات، وإن تمت صياغتها بعناية، أصبح أقل فاعلية خاصة مع
تنامي الوعي العام وعدم الثقة بالخطاب السياسي.
تشير قراءة مجريات الانتخابات وإعلان نتائجها وردود الأفعال عليها، على الرغم من تدني نسبة المشاركة فيها، إلى نجاحها الكبير كمسرحية مأساوية ـ كوميدية بعدة فصول
والدالة ثانيا: على فوز التيار الصدري على منافسيه من الأحزاب
الإسلاموية المنتمية إلى ذات المذهب، ومن أهل ذات البيت. إذ دل التخطيط
الأولي لمرحلة ما بعد إعلان النتائج أن التيار الصدري، برئاسة مقتدى
الصدر، حل بالمركز الأول وتلاه ائتلاف دولة القانون برئاسة رئيس
الوزراء الأسبق نوري المالكي.
وبينما بقيت المفوضية مصممة، لفظيا، على أن الانتخابات «كانت مفخرة
لنا، وسُررنا بالمؤسسات الداعمة التي أمّنتها» بات تاجيلها لإعلان
النتائج النهائية واعادة الفرز جراء الطعونات المتزايدة، محط سخرية
شعبية عامة، أثارت الشك بعملها وأزالت البقية الباقية من وهم مصداقية
الانتخابات. حيث صارت مقاعد البرلمانيين تزداد لهذا الحزب وتنقص لذلك،
كما لو كانت في مزاد علني للمقاعد. فما أن يقف ممثل حزب خاسر مهددا
متوعدا بنشر «صور وفيديوهات» التزييف حتى يتم، خلال ساعات، إعلان فوزه
بمقاعد إضافية. وفي خضم الشكوك والتهديدات والضغوط والابتزاز، وبكائية
الخسارة، طفت على السطح مفردات وعبارات جديدة أبعد ما تكون عن عبارات
المديح الأولية التي كانت تُرش على رؤوس المواطنين كما حلوى الأعراس.
تراوحت المفردات والعبارات لتقييم النتائج بين «اللامنطقية» و« الحيف»
و «التزوير». أما عمل المفوضية فهو «تلاعب» و«احتيال». وأعتبر المتحدث
باسم كتائب حزب الله، أن «ما حصل في الانتخابات يمثل أكبر عملية احتيال
والتفاف على الشعب العراقي في التاريخ الحديث». وصرح المتحدث بأسم
تحالف فتح، بعد يومين من الانتخابات : « النتائج لن تبقى» و«أعلنا بشكل
واضح اننا لن نقبل النتائج لأنه لدينا أدلة وأشرطة حول خلل في جميع
المحطات» وقال مذكرا بضرورة ضمان حصته من المقاعد « نحن أمة الحشد الذي
ضحى بحياته ودافع عن الديمقراطية». وكان لأقليم كردستان دوره في إغناء
لغة التراشق بإتهامات التزوير. حيث صرح متحدث باسم الاتحاد الوطني
الكردستاني بأن «أيادي خارجية تدخلت للتلاعب في النتائج». وأتسعت، في
اليومين الأخيرين، أرضية التهديد بما لا تحمد عقباه، مستقبلا، إذا لم
يحصل التوافق على المقاعد والمراكز بين الأحزاب المشاركة بالانتخابات،
وهي نفسها المهيمنة على الوضع السياسي ومحاصصة الطائفية والفساد منذ
غزو البلد. فحذّر مقتدى الصدر من «استفحال الإرهاب» وأن عدم القبول
بالنتائج « يهدد السلم الأهلي».
تشير قراءة مجريات الانتخابات وإعلان نتائجها وردود الأفعال عليها، على
الرغم من تدني نسبة المشاركة فيها، إلى نجاحها الكبير كمسرحية مأساوية
– كوميدية بعدة فصول، باخراج دولي مشترك وتمثيل محلي. مسرحية تم التهيؤ
لها إعدادا وتنسيقا ومحاكاة على مدى عام تقريبا، مع توفير التغطية
الإعلامية المكثفة لكل خطوة. ويكمن نجاحها الحقيقي في أنها أعادت تدوير
ذات الاحزاب بساستها ومليشياتها وفسادها. فمقتدى الصدر القائل في
خطابه، منذ يومين «لا مكان للفساد والفاسدين بعد اليوم» تعامى عن حقيقة
ان تياره كان في نفس البرلمان الذي يتهمه بالفساد الآن، كما أن تياره،
كما البقية، كان فاعلا في ارتكاب المجازر الطائفية، بل وأمتاز
بابداعاته الخارقة في التمثيل بالجثث واستخدام المثقاب في التعذيب.
وهذه حقيقة لا يتطرق اليها فريق إعداد المسرحية و أجهزة الإعلام، كما
لا تُذكر أوضاعه النفسية والعقلية المضطربة، فالكل منشغل بتقديمه
كشخصية «غير موالية لإيران» مقابل « الموالين لإيران» والتخويف من
إقتتال وسفك دماء بين أحزاب «البيت الشيعي». وهو ما لن يحدث. فقد حققت
مسرحية الانتخابات المرجو منها، وهو تمديد عمر النظام الحالي، بأحزابه،
على حساب دماء شهداء البلد، على مدى 18 عاما الأخيرة، ومن بينهم محتجو
إنتفاضة تشرين، لقاء دية، وقدرها عشرة مقاعد من بين 329 مقعدا.
كاتبة من العراق
المحكمة العليا الأمريكية…
بعيدا عن الانتخابات العراقية
هيفاء زنكنة
بعيدا عن الانتخابات العراقية، المماثلة في ترتيبها ونتائجها، من
يستأجر قاعة للاحتفال بعيد ميلاده، ويُزّينها، ويرتدي أجمل ما لديه
إنتظارا للمدعوين فلا يحضر أحد، بعيدا عنها، ثمة حدث تم ركنه في زاوية
لا تصل إليها أضواء أجهزة الإعلام الساطعة. ربما لأنه لا يتماشى مع
السردية الشائعة عن الأحداث التي عاشها العالم في العقدين الأخيرين،
جراء الاحتلال الأمريكي لأفغانستان والعراق. حيث نظرت المحكمة العليا
الأمريكية، الأسبوع الماضي، وللمرة الأولى، في قضية مواقع الاعتقال
السرية التابعة لوكالة المخابرات المركزية وكان أول شخص تم احتجازه
فيها، هو زين العابدين محمد حسين المعروف بإسم أبو زبيدة. هذه الخطوة
قد تساعد، إذا نجحت القضية، في منح الأمل للعراقيين الذين عاشوا
الاعتقال والتعذيب في سجون الاحتلال وحكامه بالنيابة. فهل هي الخطوة
الاولى في مراجعة تلك الأحداث من منظور يقترب من تحقيق العدالة
الأنسانية، قانونيا؟
تنبع أهمية إنعقاد المحكمة من كونها إشارة ضوء، قد تستمر مستقبليا،
لمعالجة قضايا إنتهاك حقوق الإنسان، بشكل قانوني، مهما كانت قوة
الحكومات التي تمارسها، كسياسة خارجية أو داخلية، بحجة « الحفاظ على
أمن الدولة». كما يؤكد إنعقاد المحكمة، وهو الأهم، بالنسبة إلى الأشخاص
والشعوب التي تعاني من الانتهاكات، إن محاسبة الانتهاكات والجرائم لا
تسقط بالتقادم. فقد مر على قضية أبو زبيدة، مثلا، حوالي العشرين عاما ،
متزامنة مع مرور 20 عاما على أحداث 11 أيلول/ سبتمبر، ومرور 20 عامًا
على الغزو الأمريكي لأفغانستان، و 19 عامًا على إنشاء سجن خليج
غوانتانامو، و 18 عامًا على غزو العراق، وبعد مرور 15 عامًا منذ أن تم
الكشف عن قيام وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بإستخدام مواقع
اعتقال سرية في أوروبا. دعم رفع الدعوى وتزويد المحامين بالوثائق مكتب
الصحافة الأستقصائية، بلندن، بالتعاون مع «مشروع التسليم الاستثنائي».
وفحوى القضية هي تفنيد إدعاء حكومة الولايات المتحدة بأن مواقع السجون،
التي تعرض فيها عشرات الأشخاص للتعذيب في سنوات الحرب على الإرهاب، غير
معروفة لديها ولا علاقة لها بها. وهو إدعاء مماثل لنفي قيادة الاحتلال
الأمريكي للعراق قيامها بتعذيب المعتقلين العراقيين في « أبو غريب»
وإصرارها على الرغم من معرفة الكل بذلك، بإنها أفعال «بضع تفاحات
فاسدة» كذلك إدعاء الجيش الأمريكي الذي وصفته الأمم المتحدة رسمياً
بالجهة المحتلة، أنه لا يعرف عدد الضحايا في بلد تحت أمرته لأنه «لا
يقوم بتعدادهم».
أول الدلائل المفندة لادعاء الحكومة الأمريكية بعدم معرفتها بالسجون
والتعذيب، كما يشير ملف محامي الدفاع، المكون من 53 صفحة من الوثائق،
هو تصريح الرئيس جورج بوش، في 6 سبتمبر 2006: « بالإضافة إلى
الإرهابيين المحتجزين في غوانتانامو، هناك عدد من قادة الإرهابيين،
المشتبه بهم، تم احتجازهم واستجوابهم خارج الولايات المتحدة، في برنامج
منفصل تديره وكالة الاستخبارات المركزية».
تحتل ذريعة المحافظة على الأمن، أولوية تكاد تكون مقدسة، لدى الدول الامبريالية، والحكومات القمعية، لتعمي الشعوب عن المطالبة بحقوقها
كان هذا أول اعتراف رسمي بأن وكالة المخابرات المركزية قامت بتشغيل
برنامج يتم من خلاله احتجاز « الإرهابيين» المشتبه بهم الذين تم القبض
عليهم في الخارج، بمعزل عن العالم الخارجي، في مواقع سرية، خارج
الولايات المتحدة، تسمى «مواقع سوداء». في البداية، اقتصرت المواقع على
بلدان محددة أهمها بولندا ورومانيا وليتوانيا وأفغانستان والمغرب.
ومع تزايد الوعي العام بوجودها، وقيام صحافيين مستقلين بنشر مقالات
تكشف عن الطائرات المرتبطة بالبرنامج، وربطها بسجلات معتقلين أو
مختطفين، كرس د. كروفتون بلاك، من منظمة « ريبريف» (الاعفاء)، وهي
منظمة غير حكومية، جهده بالتعاون مع أستاذين آخرين لجمع وتحليل كل
المعلومات المتاحة عن البرنامج. نُشرت قاعدة البيانات والمواقع، لأول
مرة، في 2013، ثم واصل الثلاثة التعاون لتطوير تحليلهم للسجل العام
ونشروا ملخصا تنفيذيا عام 2014. ليتم نشر النتائج التي توصلوا إليها،
عام 2019، في دراسة مشتركة مكونة من 400 صفحة. من بين الوثائق التي
قدمها الدفاع في قضية أبو زبيدة : وثائق حكومية أمريكية رُفعت عنها
السرية، وسجلات رحلات نقل السجناء إلى وخارج المواقع السوداء، وسجلات
هبوط الطائرات. حيث يُظهر السجل العام تاريخ وصول أبو زبيدة، مثلا، إلى
الموقع الأسود البولندي ثم نقله الى خارج بولندا، والمواقع التي احتُجز
فيها لاحقًا وهي غوانتانامو، المغرب، ليتوانيا وأفغانستان. كما يُظهر
تقرير لمجلس الشيوخ الأمريكي أن استجوابات زبيدة تضمنت 83 حالة من
الإيهام بالغرق، والحرمان من النوم وحبسه لمدة 11 يومًا في صندوق يشبه
النعش. وأثناء احتجازه، فقد أبو زبيدة عينه اليسرى.
وأدى توفر المعلومات عن سلسلة التعاقدات الخاصة بالطائرات المشاركة في
نقل المتهمين إلى رفع عدة دعاوي قضائية ضد مدير وكالة المخابرات
المركزية جورج تينيت، وأصدر المدعي العام الإيطالي مذكرات توقيف بحق 22
عضوًا من فريق الترحيل السري التابع لوكالة المخابرات، وتكرر الشيء
ذاته في إسبانيا. ونشرت صحيفة « الواشنطن بوست» في نوفمبر / تشرين
الثاني عام 2005، تحقيقا عن الدول المتعاونة مع المخابرات الأمريكية،
مقابل ملايين الدولارات. وبيّن تقرير لمنظمة « المجتمع المفتوح «
المشاركة العالمية المذهلة في البرنامج حيث وصل عدد الحكومات المشاركة
إلى 54، من بينها حكومات عربية، شاركت بطرق مختلفة. وكان للمثابرة على
التوثيق وعدم اليأس نجاحه في ثلاث دعاوى قضائية في المحكمة الأوروبية
لحقوق الإنسان.
على الرغم من ذلك، تدّعي الحكومة الأمريكية بأن الدعوى الحالية،
لاتستند الى حقائق بل مجرد تكهنات، وتصريحات غير رسمية من قبل مسؤولين
سابقين وأجانب. والمفارقة أنها تقدمت بطلب الى المحكمة ينص على أن «
أضرارا جسيمة ستلحق بالأمن القومي إذا تأكدت التكهنات العامة حول مكان
وجود المواقع السوداء لوكالة المخابرات المركزية»!
تحتل ذريعة المحافظة على الأمن، أولوية تكاد تكون مقدسة، لدى الدول
الامبريالية، والحكومات القمعية، لتعمي الشعوب عن المطالبة بحقوقها.
وهي الأداة التي بررت بها الولايات المتحدة إحتلالها أفغانستان والعراق
تحت مسمى» الحرب على الارهاب». فكانت النتيجة إزدهار صناعة الإرهاب في
ظل حكومات تُخّرب وتنهب بالنيابة. لذلك قد لا تنجح الدعوى في تحقيق
العدالة للمدعي إلا انه سيكون للحكم تداعيات كبيرة لتحديد حدود حق
الحكومة الأمريكية في السرية. وهو ما يجب التمسك به، كأحد مستويات
النضال، لتحقيق العدالة قانونيا.
كاتبة من العراق
هل نشارك في
الانتخابات العراقية أو نقاطعها؟
هيفاء زنكنة
في تغريدة باللغة الانكليزية خاطب مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء حكومة
بغداد، الشعب العراقي بمناسبة إجراء الانتخابات المبكرة، في العاشر من
أكتوبر، قائلا : « أحثكم على الحصول على بطاقات تسجيل الناخبين الخاصة
بكم… أولئك الذين يريدون الإصلاح والتغيير يجب أن يهدفوا إلى إقبال
كبير على التصويت». وهي رسالة، تبدو بفحواها المرتب، وكأنها موجهة الى
شعب يعيش رفاهية التمتع بوجود حكومة أنتخبت ديمقراطيا وعلى وشك تسليم
السلطة لمن سيتم انتخابه ديمقراطيا فعلا. أي إنها موجهة أما لمن لا
يعرف واقع الحال المُعاش سياسيا وإقتصاديا في العراق أو لمن يتظاهر
بأنه لايعرف ومن مصلحته إستمرار الحال على ما هو عليه.
هناك مستويان للنظر إلى مجرى الانتخابات الموسومة بالمبكرة، لأن قرار
إجرائها أُتخذ بعد إنتفاضة تشرين/ أكتوبر 2019 التي أسقطت حكومة عادل
عبد المهدي بتكلفة عالية من حياة مئات المتظاهرين وآلاف الجرحى
والمُقعدين. المستوى الأول هو ما يُقدم كصورة إعلامية مزوقة عن الإعداد
لانتخابات توحي، للعالم الخارجي، بأنها لا تختلف عن عديد البلدان في
أرجاء العالم الديمقراطي. هناك اسطوانة يومية، مثلا، عن مفوضية عليا «
مستقلّة» للانتخابات، وإحصائيات وقانون انتخابات ومراقبة دولية لضمان
النزاهة. إلا أن تفكيك هذه الصورة، وهو المستوى الثاني للنظر، يبين ما
هو مخفي ورائها من تزوير وتزييف للواقع المٌعاش، المؤثر على سيرورة
الانتخابات وإنقسام مواقف أحزاب وميليشيات ومرجعيات دينية أرتبطت
بالاحتلال وحركات ومنظمات وُلدت من رحم إنتفاضة تشرين.
قبل أشهر، أعلنت مفوضية الانتخابات أن عدد الذين يحق لهم التصويت في
الانتخابات البرلمانية، يبلغ ما يقارب 25 مليون شخص. إلا أنها عادت،
بعد طفو ملامح التزوير إلى السطح، إلى حصر عدد من يحق لهم التصويت بمن
يمتلكون البطاقة البايومترية، مع زيادة عدد المراقبين الخارجيين. ومع
اقتراب موعد الانتخابات وزيادة عدد الخروقات في الإعلانات والترويج،
وإطلاق المرشحين (ومعظمهم من ممثلي الأحزاب الفاسدة الموجودين في
البرلمان حاليا) وعودا خيالية زائفة لمداعبة حاجات المواطنين، من الصحة
والتعليم، إلى البناء والإعمار والكهرباء والماء الصالح للشرب، وتعيين
الخريجين، ومع تصاعد أصوات الداعين إلى مقاطعة الانتخابات، ازدهر موسم
إصدار التصريحات والبيانات الداعية إلى إلمشاركة.
حكوميا، صرّح الكاظمي، مثلا، بأنه سيشرف شخصيا على الأمن الانتخابي
وأنه لن يسمح « بأي خرق، أو تجاوز يمكن أن يؤثر على سير العملية
الانتخابية أو نتائجها» متعاميا عن حقيقة إطلاقه الوعود بالأطنان حول
تقديم قتلة المتظاهرين الى القضاء وتقليم أظافر الميليشيات، بداية
تسنمه المنصب. ولم يُنفذ أيا منها. وأصدرت المرجعية الدينية، متمثلة
بمكتب المرجع الديني علي السيستاني، المُصر على أنه لا يتدخل بالشأن
السياسي، بيانا يوم 29 أيلول/ سبتمبر، لتشجيع «الجميع» على المشاركة في
الانتخابات لكي يتفادى البلد خطر الوقوع بـ «مهاوي الفوضى والانسداد
السياسي» مفترضا أن ما يعيشه البلد، حاليا، هو قمة النظام والانفتاح
السياسي. وهو بيان يستحق أن يُقرأ بتأن لسببين. الأول لتوقيت إصداره
قبل أيام من إجراء الانتخابات، وبعد أن بات تغلغل الفساد في كل تفاصيل
التهيؤ لها مكشوفا، فجاء البيان أما من باب رفع العتب أو محاولة إنقاذ،
لنظام فاسد، ما أن يوشك على الغرق حتى يمد مكتب المرجعية له يد
الانقاذ.
كيف يمكن للناخب «أن يكون واعيا ومسؤولا» من أجل «إحداث تغيير حقيقي في إدارة الدولة» وهو الذي ما إن خرج إلى الشارع مطالبا بوطنه حتى جوبه «بالاستخدام المفرط للقوة المميتة؟
القراءة الثانية للبيان تبين مهارة «الواعظ» في صياغة خطاب، بلا محتوى
حقيقي، باستثناء دغدغة المشاعر. فكيف يمكن للناخب «أن يكون واعيا
ومسؤولا» من أجل «إحداث تغيير حقيقي في إدارة الدولة» وهو الذي ما إن
خرج إلى الشارع مطالبا بوطنه حتى جوبه «بالاستخدام المفرط للقوة
المميتة، من طرف قوات الأمن لتفريق المحتجين، بما في ذلك القنابل
المسيلة للدموع ذات الاستخدام العسكري، والذخيرة الحية والهجمات
المميتة التي يشنها القناصة» حسب منظمة العفو الدولية التي وثَّقت،
أيضا « حالات الاختفاء القسرية للناشطين». وتنصح المرجعية بانتخاب
المرشح « الصالح النزيه، الحريص على سيادة العراق وأمنه وازدهاره،
المؤتمن على قيمه الأصيلة ومصالحه العليا، الكفوء، غير المتورط
بالفساد، المؤمن بثوابت الشعب العراقي «. وهي مواصفات بضاعة، يعرف مكتب
المرجعية جيدا كما أبناء الشعب، إنها غير متوفرة بين المرشحين،
المغموسين بالفساد، مما يلقي ظلال الشك حول النية من إصدار البيان.
الملاحظ أنه ليس هناك موقف موحد بين المرجعيات بصدد المشاركة. حيث أوضح
المسؤول الإعلامي لمكتب المرجع الديني جواد الخالصي، في مقابلة مع
وكالة ( روداو) بأن البيان لم يصدر باسم السيد السيستاني بل من مكتبه
وهو ليس فتوى، بل بيان تشجيعي، مما يعني أن الالتزام به ليس فرضا. وترى
مدرسة الامام الخالصي أن الاحتلال الأمريكي لايزال موجوداً « وهو
المتحكم والمسيطر والمهيمن على كل تفاصيل العملية السياسية، ومن ضمنها
الانتخابات». و«أن نتائج الانتخابات محسومة والاصوات مفروزة والمقاعد
موزعة».
بعيدا عن المرجعية، أيد «تجمع قوى المعارضة» الذي تأسس من مجموعات
شاركت في انتفاضة تشرين، المقاطعة لأنها «تفتقر إلى النزاهة وتكافؤ
الفرص». وكان الحزب الشيوعي قد إنسحب من المشاركة يوم 24 تموز/ يوليو،
بعد مناورة الانسحاب المؤقت لشريكه « التيار الصدري» يوم 15 تموز/
يوليو. إلا أن الصدر أعلن، بعد أسابيع، عدوله عن قراره السابق وألزم
مرشحي تياره بالتوقيع على تعهد من 28 نقطة أُستهل بشرط « الطاعة
والولاء» للصدر، تاركا حليفه الحزب الشيوعي في عراء اللا مشاركة مع
كونه بعيدا عن تجمع قوى المعارضة التي التزمت منذ البداية برفض العملية
السياسية برمتها.
هل ستؤدي المشاركة في الانتخابات أو مقاطعتها إلى إحداث أي تغيير في
هيكلة منظومة الحكم الحالية؟ نعم، سنرى تغييرا ما إلا أنه في الأغلب،
لن يكون لصالح الشعب المتطلع إلى التخلص من النظام الطائفي الفاسد
وإقامة نظام ديمقراطي حقيقي، بل سيكون لصالح تمديد عمر منظومة الفساد
مع إعادة توزيع لتوازناتها، انسجاما مع التوازنات الاقليمية الجديدة
بين دول الجوار والتحالف الدولي وصفقاتها الداخلية.
كاتبة من العراق
عن التطبيع والكرد
وحسرة القائد الأمريكي
هيفاء زنكنة
عُقد في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، يوم الجمعة 24 أيلول
/ سبتمبر، مؤتمر بعنوان «السلام والاسترداد». حضر المؤتمر الذي نظمه
مركز يدعى « اتصالات السلام الأمريكي» عدد من عراقيين تم وصفهم بأنهم «
شيوخ عشائر وكتاب ومثففون».
تزامن عقد المؤتمر الداعي إلى اعتراف العراق بكيان الاستيطان الصهيوني
مع الذكرى السنوية الأولى لـ ( إتفاقات إبراهيم) التي أبرمتها الإمارات
والبحرين والمغرب والسودان، بمباركة الرئيس الأمريكي السابق دونالد
ترامب. وتواصل الولايات المتحدة برئاسة الديمقراطي جو بايدن سياسة
الجمهوري ترامب الداعمة للاحتلال الصهيوني على حساب إبادة الشعب
الفلسطيني. حيث أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، يوم
الجمعة، في أجتماعه مع وزراء خارجية دول « إتفاق إبراهيم» الدعم
الأمريكي المستمر للاحتلال من خلالهم. وإذ يتغنى بلينكن بفائدة
الاتفاقات لشعوب المنطقة، فإنه لاينسى تهديد الحكام بنعومة شرطي العالم
بأنه» من مصلحة دول المنطقة والعالم أن يتم التعامل مع إسرائيل كسائر
الدول». لا غرابة، إذن، أن ينعقد، في اليوم، نفسه، مؤتمر يدعو بلسان
متحدثته الرئيسية المدعوة سحر الطائي « لابد للعراق اليوم أن يغير
سياسته. بات أمرا ضروريا ولابد منه الاعتراف بإسرائيل كدولة صديقة «.
تدل التقارير ألتي نُشرت عن المؤتمر وأشرطة الفيديو، بالاضافة إلى خطب
المتحدثين، إلى أن الحاضرين الذين تفادوا إظهار وجوههم أمام الكاميرا،
لا يمثلون، كما ادعى منظمو المؤتمر، الشرائح المجتمعية والدينية أو
المراكز أو المنظمات، أو العشائر العراقية، التي يدّعي منظم المؤتمر
انهم يمثلونها. فالسيدة سحر الطائي القائلة « لا يحق لأي قوة، سواء
كانت محلية أم خارجية، أن تمنعنا من إطلاق مثل هذا النداء» والتي تم
تقديمها وكأنها ناطقة رسمية بإسم وزارة الثقافة، مثلا، دفعت وزارة
الثقافة إلى إصدار بيان تكذيب سريع نفت فيه «صلتها بالتصريحات ألتي
صدرت عن إحدى الموظفات تدعِّي شَغلِها لمنصب في وزارة الثقافة».
وأوضحت الوزارة إنها « ترفض انعقاد مؤتمرٍ للتطبيع مع إسرائيل على أرض
أربيل في كردستان العراق، معتبرة أن انعقاد هذا المؤتمر سابقةٌ خطيرةٌ
تتعدى على الدستور ورأي الشعب العراقي، وتمسّ كرامة القضية الفلسطينية
وحقوق شعبها، وهو ما لايرضى به العراقيون حكومةً وشعباً، مؤكدة وقوفها
المنيع مع أبناء الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة «.
أكد البيان موقف الشعب العراقي، التاريخي والحاضر، ألذي يرى في فلسطين
قضيته العادلة، التي لا تسقط بالتقادم. وأن فلسطين هي البوصلة
الأخلاقية بالأضافة الى القانونية الدولية والأنسانية. وسارعت، عديد
الجهات الشعبية، والمسؤولين الحكوميين، وحتى قيادة الجيش، إلى إستنكار
إنعقاد المؤتمر. وهو موقف جماعي غاضب، قلما توصل اليه العراقيون حول
قضية ما، منذ غزو العراق، بقيادة أمريكا، في 2003، ومأسسة محاصصة
الطائفية والعرقية. وجاء موقف حكومة إقليم كردستان التي إدّعت أن
الاجتماع تم دون علمها وموافقتها ومشاركتها، مثيرا للتهكم، فالمعروف
للجميع أن أي إجتماع، مهما كان حجمه، لا يتم بدون موافقة الجهات
الأمنية، فكيف إذا كان مؤتمرا كهذا، وهو يتماشى مع موقف قادة الإقليم
من الكيان الصهيوني وزياراتهم وحجم توسع المصالح الإسرائيلية المؤيدة
لأنفصال الإقليم عن العراق.
تزامن عقد المؤتمر الداعي إلى إعتراف العراق بكيان الاستيطان الصهيوني مع الذكرى السنوية الأولى لـ ( إتفاقات إبراهيم)
مع هذا، إذا كان الغرض من إقامة المؤتمر، كما يبدو، هو جس نبض الحكومة
العراقية، بناء على الارتباط بأمريكا، وفق إتفاقية الاطار الاستراتيجي،
فان النتيجة جاءت معاكسة تماما لما كان متوقعا من قبل المنظمين، حيث
استردت القضية الفلسطينية أولويتها، بقوة الأرادة الشعبية وعمق العلاقة
بين الشعبين الفلسطيني والعراقي، خلافا لعنوان « السلام والاسترداد».
كما كانت النتيجة، إفراغ المؤتمر من هدفه، بفضل المتحدثين، أنفسهم، حين
فشلوا في تقديم خطاب موحد يتماشى مع سياسة المركز الذي تكفل بدعوتهم
ودفع إجورهم. إذ إختلط، في خطبهم الركيكة، التأجيج الطائفي ( بين السنة
والشيعة) وأهمية الفيدرالية وتقسيم العراق، والخلط ما بين الدين
اليهودي والصهيونية، ومهاجمة إيران إلى حد تناسوا فيه، أحيانا، التركيز
على «السلام الإسرائيلي».
« السلام» الذي بات مفردة كريهة لحدة تناقضه مع واقع الاحتلال، وسياسة
الاستيطان، والتمييز العنصري، ومنع حق العودة لأهل البلد الشرعيين. وهو
واقع رافق الكيان الصهيوني منذ لحظات تأسيسه الأولى وأصاب رشاشه
العراقيين كما الفلسطينيين. ففي لقاء بين رئيس أركان جيش الدفاع
الإسرائيلي يغئيل يادين والقيادة العليا للجيش الإسرائيلي، عام 1950،
كما جاء في كتاب «عزيزتي فلسطين» لشاي هازكاني، أعرب يادين عن قلقه من
أن معظم الجنود اليهود الذين كانوا مهاجرين حديثًا من العراق، لم
يُظهروا مستوى العداء الذي توقعه تجاه العرب. وحث الاجتماع قائلا:
«علينا أن نحفز مشاعر الكراهية ضد العراقي العربي حتى في أوقات السلام.
ليس لدينا أوقات سلام. بل وعلينا تشجيع روح الانتقام ضد العراقيين».
نظّم مؤتمر أربيل المدعو جوزيف براود، رئيس مركز « إتصالات السلام
الأمريكي» في نيويورك، الذي « طّور لغته العربية خلال عمله مدة سبع
سنوات في الإذاعة الوطنية المغربية وتعلم الفارسية كطالب دراسات عليا
في جامعة طهران» ويهدف في نشاطاته مع آخرين، بينهم صحافية لبنانية ومغن
تونسي، وناشط مدني عراقي كردي، على مكافحة «معاداة السامية» وعلى تطوير
«استراتيجية حول كيفية دحر أجيال من الرسائل المعادية للسامية والرفض
في وسائل الإعلام والمساجد والمدارس العربية» حسب كتاب لبراود.
وقد حاول براود، عبثا، والحق يقال، تلميع صور المساهمين من العراقيين
وإضفاء أهمية كبيرة على مراكزهم ودورهم، أثناء مقابلاته مع أجهزة
الأعلام، تبريرا لالتقاطه إياهم، إلا أن تخبطهم في إيصال دعوته الى
العراقيين لتشجيع التطبيع مع الكيان الصهيوني، لا بد وأن ذكّره بما
قاله قائد إحدى فرق جيش الاحتلال الأمريكي، عام 2006، حين سأله صحافي
عن فشل القوات الأمريكية، بالقضاء على «المتمردين العراقيين» على الرغم
من التفوق العسكري الأمريكي وتجنيد عملاء عراقيين، فأجابه القائد
متحسرا : «المشكلة هي أن أفضل الناس يقاتلون في الجانب الآخر».
كاتبة من العراق
استيزار المرأة في العراق
وأفغانستان… هل هذا هو السؤال؟
هيفاء زنكنة
في الوقت الذي تتعالى فيه أصوات
المسؤولين الأمريكيين والبريطانيين، وأجهزة الإعلام الرسمية في الغرب،
عموما، إستنكارا لعدم إستيزار المرأة الأفغانية في حكومة طالبان، التي
تم تشكيلها مؤخرا، وعدم تخصيص نسبة تمثيل سياسي لها، في أي موقع آخر،
تعيش المرأة العراقية المُغّيبة مثل نظيرتها الأفغانية، في ظل صمت مطبق
من قبل ذات الجهات. وإذا كانت حركة طالبان معروفة، بموقفها من المرأة،
وهناك خوف عام من عدم تغير موقفها، حاليا، على الرغم من تصريحاتها، فان
محنة المرأة العراقية أكبر وأعمق من ذلك. فهي، تعيش، منذ إحتلال
العراق، بقيادة أمريكا في عام 2003، تراجعا مستمرا في ذات الحقوق التي
يُفترض من حركة طالبان تطبيقها بعد توليها الحكم. وهي حقوق لا خلاف
إطلاقا حول وجوب أن تتمتع بها المرأة. فمن المُسّلمات أن حقوق المرأة
هي حقوق الإنسان، وضمانها مسؤولية أخلاقية وقانونية، في عالم يُفترض
فيه العمل على تطبيق حقوق الإنسان، في جميع البلدان، في أرجاء العالم،
بلا تمييز.
إلا أن تجربة 18 عاما في العراق، تجعل من الصعب على أي متابع لوضع
المرأة، ناهيك عن المرأة نفسها، ألا يقارن بين التصريحات والممارسات
الفعلية على الأرض، فيما يخص مدى تطبيق حقوق الإنسان، خاصة المرأة. ومن
الصعب ألا يخلُص المرء إلى الضرر الكبير الذي تسببه سياسة إزدواجية
المعايير التي تمارسها أمريكا وبريطانيا، خاصة، تجاه قضية المرأة في
البلدان المحتلة، وبعد أن بات مفهوم « حقوق الإنسان» مرتبطا بالغرب،
واستغلال ما تتعرض له المرأة، كورقة لعب سياسي لفترة معينة، سرعان ما
تنتهي حال إنتفاء الحاجة اليها، لتنتهي المرأة كخاسرة أولى، في كافة
المجالات من التعليم والصحة إلى العمل وحرية الحركة إلى المساواة في
التمثيل السياسي، بكافة المستويات، كما يبين حال المرأة العراقية بوضوح
شديد. وإذا كانت خسارة العراقيين، نساء ورجالا، فادحة في سنوات
الاحتلال، جراء التخريب المنهجي المتبدي بالطائفية والفساد والاعتقالات
والقتل وانتشار الأرهاب بكافة أنواعه، فأن خسارة المرأة مضاعفة لأنها
باتت المعيل الأول للعائلة، في بلد تحتد فيه المنافسة على العمل، حسب
المحاصصة الطائفية والحزبية، مما أبعدها عن النضال العام.
ويقودنا الجدل الدائر حول عدم إستيزار نساء أفغانيات، إلى متابعة
سيرورة إستيزار المرأة العراقية وتفكيك إدعاءات « تحرير» المرأة
والوعود المبذولة لها بالأطنان عن المساواة، في ظل العملية السياسية
التي أسسها الاحتلال، والتزمت بها الحكومات العراقية المتعاقبة. حيث
تميزت الفترة التي تلت الغزو، مباشرة، بنشاط «نسوة استعماريات» اخترن
أن يكن وجها للاحتلال بخطاب غالبا ما يستبدل أو يعارض القضايا الوطنية
والاجتماعية والطبقية الأساسية، بقضايا التمايزات الأخرى مما أنتج نخبة
تحترف العمل «النسوي» على حساب النشاطات النسائية والنضال الشعبي
المتنامي عضويا من داخل المجتمع نفسه. وما يجعل وضع المرأة العراقية
نموذجا لتفكيك إدعاءات تحسين مشاركتها السياسية مقابل حرمان الأفغانية
أن العراق « شريك» لأمريكا حسب «اتفاقية الإطار الاستراتيجي لعلاقة
الصداقة والتعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية العراق».
هل استيزار المرأة، كما يُطرح عالميا ومحليا، أحيانا، هو الحل لوضع المرأة المتدهور، تعرضها للعنف، وحرمانها من حقوقها الأساسية في التعليم والصحة والعمل؟
وحسب بيان للادارة الأمريكية في
نيسان/ أبريل من العام الحالي « جدّد الجانبان التأكيد على علاقتهما
الثنائية الوطيدة، والتي تعود بالنفع على الشعبين الأمريكي والعراقي.
في قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب، والاقتصاد والطاقة والبيئة، والمسائل
السياسية، والعلاقات الثقافية». مع ملاحظة تفادي ذكر حقوق الإنسان،
خاصة المرأة التي أستخدمت قضيتها لتسويق الغزو، لتُركن جانبا ولم يعد
وجودها في الحكومة ومراكز اتخاذ القرار السياسي، أمرا يستدعي الاهتمام.
بالنسبة الى عدد الوزيرات، ضمت الحكومة الانتقالية برئاسة إياد علاوي
(2004 ـ 2005) ست وزيرات. لينخفض العدد تدريجيا، حتى اختفى تماما، في
حكومة عادل عبد المهدي، في عام 2018. وكان عبد المهدي قد أُجبِر على
الاستقالة تحت ضغوط المتظاهرين في إنتفاضة تشرين/ أكتوبر 2019 التي
ساهمت فيها المرأة بقوة أعادت الأمل بإستعادة المرأة موقعها الطبيعي في
النضال الشعبي العام. وكانت وزارة المرأة قد ألغيت في حكومة حيدر
العبادي (2014 ـ 2018). أما الحكومة الحالية، برئاسة مصطفى الكاظمي،
فتضم وزيرة واحدة من أصل 22 وزارة. وإذا اضفنا الى الإقصاء الوزاري،
فرض رجال الدين السياسي تفسيراتهم الطائفية المتماشية لا مع التدين
كمعتقد شخصي، بل مع سياسة الأحزاب المتبنية لهم، وغالبا ميليشياتها،
على عضوات البرلمان والمرأة عموما، لوجدنا أنفسنا أمام تساؤلات لم تفقد
أهميتها رغم قدمها.
هل استيزار المرأة، كما يُطرح عالميا ومحليا، أحيانا، هو الحل لوضع
المرأة المتدهور، تعرضها للعنف، وحرمانها من حقوقها الأساسية في
التعليم والصحة والعمل؟ كيف يمكن الفصل بين العنف الشخصي والعام حيث
تختلط العائلة، والعشيرة، والتقاليد المجتمعية بعنف الدولة والميليشيات
والمنظمات الإرهابية؟ كيف الفصل ما بين الخاص والعام ؟ وما هو الفرق
بين الوزير والوزيرة اذا كانت العملة اليومية المتداولة، سياسيا
ومجتمعيا، هي الفساد بأنواعه المتمثل بالاحزاب التي ينتمون اليها؟ وهل
يكفي الحصول على المناصب وترداد الشعارات، بدون الأصغاء الى أصوات
النساء على الارض، وعزل النضال النسوي عن الشعبي التحرري العام، لمسح
الحيف الذي تتعرض له المرأة؟ ان متابعة نضال المرأة العراقية
والفلسطينية وكل البلدان التي عاشت أو تعيش الاحتلال والهيمنة
الامبريالية تبين ان تجربة المرأة في بيئتها، ونضالها العضوي المشترك
مع الرجل لترسيخ حق المواطنة، قد يحمل الإجابة على عديد التساؤلات، كما
تُذكرنا الأكاديمية الأيرانية إلهي روستامي بوفي في دراسة لها عن
مقاومة النساء الأفغانيات ونضالهن في أفغانستان ومجتمع الشتات، قائلة :
« مع استمرار العنف ضد النساء والتمييز الجنسي وعلاقات الجندر
التقليدية، تبنت الدول العظمى والمؤسسات المالية والعسكرية لغة النسوية
وخطابها. وقد أُعيد تعريف هذه المفاهيم لتعني ان الغرب، وبالاخص
الولايات المتحدة، متحضر، بينما الثقافات الأخرى تقع على هامش
البربرية. جرى التلاعب بهذه المسائل بنجاح منقطع النظير، لتبرير الحرب
والسيطرة الامبريالية».
كاتبة من العراق
عشرون عاما من الإبداع
الفني في مناهضة الحرب
هيفاء زنكنة
بعيدا عن نيويورك وأفغانستان، عن سنوية الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر،
وما جره التفجير من مصائب على العالم، كان هناك، في لندن، حضور من نوع
آخر. ليس إحتفالا بل تذكيرا بمناسبة، غير رسمية، تقف على الجانب الآخر
من إعلان إدارة بوش « الحرب على الإرهاب» واحتلال أفغانستان والعراق.
في قاعة، بشرق لندن، بدلا من أصوات القنابل والصواريخ ووقع أحذية
القوات العسكرية وصراخ الضحايا، تعالت أصوات المحتجين ضد الحرب ممزوجة
بالفن. بالألوان والموسيقى، والأفلام، والتصوير، والمطبوعات، واللوحات،
واللافتات الخشبية واللافتات المنسوجة باليد. شعارات وملصقات فنية تمثل
بشاعة الحروب التوسعية الإمبريالية، وأخرى يتحدى فيها الفنانون
المشاركون الموقف السياسي الخارجي الذي قاد بريطانيا، على مدى عشرين
عاما الأخيرة إلى حرب مستمرة، ويعطون صوتًا للحركة المناهضة للحرب،
منسوجا بتحقيق العدالة، عبر موقف مبدئي واضح ضد الحرب والأحتلال في
أفغانستان والعراق ونظام الفصل العنصري في فلسطين. كانت الحركة المسماة
«أوقفوا الحرب» قد تأسست في عام 2001، إثر المظاهرات ضد غزو أفغانستان،
ونجحت في تحشيد الملايين ضد الحرب على العراق عام 2003، ولاتزال مثابرة
على تنظيم المظاهرات المطالبة بانهاء إحتلال فلسطين وسياسة الاستيطان
الصهيونية، مساهمة بتشكيل الوعي السياسي لجيل كامل.
في تحشيدها ملايين المواطنين البريطانيين، ضد الحروب الخارجية، ألهمت
حركة « أوقفوا الحرب» عددا كبيرا من الفنانين والمصممين وصانعي الأفلام
والمصورين والموسيقيين الذين ساعدوا الحركة على إبراز رسالتها، لإنشاء
سجل نابض بالحياة لأنشطتها وإنتاج مجموعة من الفنون المناهضة للحرب
التي خاطبت الملايين. حيث وضع المساهمون، جميعا، بأعمالهم، حدا للتساؤل
الذي لاتزال بعض الدوائر الثقافية تجتره وهو: هل بامكان الفن، بأنماطه،
أن يؤدي دورا في التغيير المجتمعي والسياسي؟ وهل بإمكانه تقديم شيء،
مهما كان، في فترات الصراع والحروب خاصة؟
إن سردية عشرين عاما من الإنتاج الفني في الحركة المناهضة للحرب، تقول
نعم لدور الفن في الحث والمساهمة في سيرورة التغيير. إذ تنتفي المسافة
بين العمل الفني والنشاط في الحياة العامة، وهو ما جعل الحركة المناهضة
للحرب تنبض بالحياة وزّودها بالقدرة على التعبئة الجماهيرية غير
المباشرة. فبالاضافة الى العمل السياسي التعبوي المباشر، هناك العديد
من مستويات العمل التي يجب اتخاذها عند السعي من أجل التغيير، وأحدها
هو التعبير الفني. وهو شكل من أشكال النشاط العام، له بحد ذاته القدرة
على مواجهة الظلم، وتجاوزه من خلال تقديم وجهات نظر مغايرة للسائدة
والمتحكمة بالمجتمع. وغالبًا ما تكمن قيمته في تزويد الناس بمنظور وطرق
جديدة لتصور العالم. فالنشاط الفني أداة مهمة لتشكيل الوعي الاجتماعي،
وممارسة ديناميكية تجمع بين القوة الإبداعية للفنون، للتحريك عاطفياً،
مع التخطيط الاستراتيجي للنشاط الضروري لإحداث التغيير الاجتماعي. وهنا
تكمن قوة الفنان الناشط في حركة تدعو وتعمل من أجل التغيير.
من المعروف أن حركات الاحتجاج والانتفاضات الشعبية تُلهم الفنانين والأدباء. وهذا ما رأيناه بوضوح في إنتفاضة تشرين 2019 في العراق
من هذا المنطلق، تمكن الفنانون الناشطون في الحركة المناهضة للحرب من
إنتاج أعمال أصبحت جزءا من ذاكرة جيل بريطاني يرنو الى تحقيق العدالة
وينأى بنفسه عن تاريخ بريطانيا الاستعماري. من بين الأعمال المعروضة
لافتات مبقعة بالدم ولوحة للفنان بانكسي المعروف بلوحاته وجدارياته ضد
النظام الصهيوني العنصري. في مجال الأفلام، وثق المخرج أمير أميراني
بفيلم « نحن كثرة» واحدة من أكبر المظاهرات بتاريخ بريطانيا، حين خرجت
الجماهير احتجاجا على وقوف حكومة رئيس الوزراء توني بلير الى جانب جورج
بوش في شن الحرب العدوانية ضد العراق. وساهم الموسيقي والمفكر براين
إينو بمقطوعة موسيقية لم تُقدم سابقا، وكان إينو واحدا من أوائل من
كتبوا ونشطوا ضد الحرب متطرقا إلى مستويات مناهضة الحرب المتعددة ومنها
الموسيقى كسلاح قوي له إستخداماته المتناقضة، كما حدث حين أُستخدم
المحققون الأمريكيون أغاني البوب للتعذيب في المعتقلات بالعراق. ولا
يمكن نسيان فوتومونتاج كينارد فيلبس الذي أصبح رمزا للدور البريطاني في
الحرب، المتمثل بتوني بلير المبتسم إبتسامة المنتصر، وهو يحمل هاتفه
الذكي لالتقاط صورة ذاتية، فرحا بنفسه وما فعله، بينما يتصاعد خلفه
دخان حقول النفط المحترقة، مغطيا الأفق كله.
ضم المعرض بطاقات لمصممة الأزياء العالمية فيفيان ويستوود ( عمرها 79
عاما) التي قامت، أخيرا، بتعليق نفسها داخل قفص طيور موضوع على إرتفاع
عشرة أقدام في الهواء، أمام محكمة بوسط لندن، وهي ترتدي بدلة صفراء
كاملة وقبعة بيسبول، صارخة بأعلى صوتها « أنا جوليان أسانج. أنا طير
كناري. إنني نصف مسمومة من الفساد الحكومي وتلاعب الحكومات بالنظام
القانوني، بينما لا يعرف سكان العالم البالغ عددهم 7 مليارات ما كان
يحدث». بعملها الجريء صّورت ويستوود ما قام به أسانج في كشف حقيقة
السياسة الأمريكية من خلال نشره وثائق « ويكيليكس» بأنه مثل طائر
الكناري الكاشف عن السموم في المناجم.
ولم تقتصر نشاطات « أوقفوا الحرب» على تنظيم الندوات والمظاهرات
والتوعية بأطماع الحرب الامبريالية المبنية على الاستغلال وتسويق
السلاح، بل تعدتها إلى إصدار الكتب وإقامة الأمسيات الأدبية، لتجذب
بذلك جمهورا من المهتمين بالادب والشعر. وكان من أهم إصداراتها التي
ساهمتُ فيها، شخصيا، كتاب « حرب بلا نهاية» و« لامزيد من الموت».
من المعروف أن حركات الاحتجاج والانتفاضات الشعبية تُلهم الفنانين
والأدباء. وهذا ما رأيناه بوضوح في إنتفاضة تشرين/ أكتوبر 2019 في
العراق. حيث بلغ المُنتج الإبداعي، من جداريات ولوحات وموسيقى وأغان
ومسرحيات وشعارات ورسوم كاريكاتير، خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا، ما
يعادل المُنتج خلال عقد من الزمن. وهذا ما عاشته الحركة المناهضة
للحرب، إذ أبدعت على مدى العشرين عاما الماضية، أعمالا، لم تنجح في
إيقاف الحروب، إلا إنها نجحت في أن تكون العدسة التي يرى من خلالها
الجيل الجديد من البريطانيين والعالم كيف تُشن الحروب، وممارسات
الهيمنة الامبريالية، والعولمة الوحشية، وسياسة تفتيت الشعوب المبنية
على العنصرية والنظرة الفوقية.
كاتبة من العراق
لنأمل ألا تقلد طالبان
سياسة أمريكا في العراق
هيفاء زنكنة
من الصعب، عند متابعة ما يجري في أفغانستان، ألا يستعيد المرء الأحداث
التي عاشها العراق في الأسابيع والشهور الأولى التي تلت الغزو الأمريكي
– البريطاني في عام 2003.
تحضر المقارنة، بقوة، عن الفترة الأولى فقط، وليس سنوات الاحتلال كلها،
بين الممارسات الأمريكية بالعراق وتاريخ السياسة الأمريكية بالعالم،
وممارسات طالبان، الآن، وسياستها الحكومية السابقة. فالعالم كله يرصد
بدقة ما ستفعله طالبان. أما المقارنة ما بين انعكاسات الغزو والاحتلال
الأجنبي على حياة الشعب العراقي خلال 18 عاما، وهي المتوفرة للعيان
والموثقة محليا ودوليا ( بضمنها وثائق دول الاحتلال) وبين ما سيحل
بالشعب الأفغاني في الشهور والسنوات المقبلة، جراء سياسة طالبان أو
التدخلات الأجنبية أو إستحداث منظمات إرهابية وفق الحاجة أو كلها معا،
فهي متروكة للمستقبل، وليد الماضي والحاضر معا.
« نحن لا نأخذ بكلامهم فقط، ولكن من خلال أفعالهم» هكذا لخص الرئيس
الأمريكي جو بايدن، في 31 آب/ أغسطس، الموقف الأمريكي من نظام طالبان.
وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد علق على تصريحات طالبان
بشأن العفو عن الموظفين وإعطاء المرأة الحق في العمل، في 18 آب/ أغسطس
قائلا « إن بريطانيا ستحكم على نظام طالبان بناء على أفعاله وليس على
أقواله». الأفعال، إذن، وفق التصريحات الامريكية – البريطانية، هي
المحك في التعامل مع طالبان. ويفترض هنا، لكي تؤخذ القوى العالمية جديا
من قبل الشعوب، ولئلا تفقد الشعوب إيمانها بمصداقية « القيم « التي يتم
تسويقها من قبل هذه الدول، وإذا كانت تريد أن تؤكد على سمو مبدأ سيادة
القانون الدولي، أن تطبق هي نفسها ذات السياسة التي تريد للآخرين
إتباعها.. فهل تحترم أمريكا وبريطانيا معيار القيم هذا، فعليا، أم انها
تتوج حضورها الاستعماري بتكرار الأقوال والمصطلحات عن القيم، العراق
نموذجا؟
أطلقت أمريكا وبريطانيا على غزو العراق إسم «عملية الحرية من أجل
العراق» تأكيدا لما أعلنه الرئيس الامريكي السابق جورج بوش في
يناير/كانون الثاني 2003، أن أمريكا « لا تريد غزو العراق وإنما تحرير
الشعب العراقي». فكيف حررت أمريكا الشعب العراقي؟ في 20 آذار/ مارس، تم
رش بغداد بالصواريخ والقنابل في حملة «الصدمة والترويع» مما أدى الى
تدمير البنية التحتية التي قدّر بول بريمر، رئيس الإدارة الأمريكية في
العراق، أن البلاد في حاجة لمليارات الدولارات لإعادة بنائها. بهذه
الطريقة حصدت الشركات الأمريكية عقود بناء ما هدمه القصف الأمريكي
بأموال عراقية. لاحظوا أن طالبان لم تقصف أفغانستان. في 28 آب / أغسطس،
قال ويسلي كلارك، قائد قوات الناتو، إن السياسة الأمريكية خلقت الفوضى
في العراق، وإن المشكلة الرئيسية هي أن الولايات المتحدة تميل إلى
محاربة الدول للقضاء على «الإرهابيين» بدلا من محاربة «الإرهابيين»
أنفسهم.
لم ينفذ الجرائم الوحشية المهينة، في العراق، أمريكيون مختلون عقليا أو مجرد « تفاحات فاسدة» كما تدعي الإدارة الامريكية، بل كانت من صلب السياسة الخارجية
في 9 نيسان/ أبريل ساد النهب والتخريب في بغداد وغيرها من المدن. تعرضت
المتاحف وأهمها متحف بغداد الذي يضم كنوزا أثرية، من أولى الحضارات
التي عرفها العالم، الى سرقة الآثار. بعد ثلاثة أيام بدأ تخريب
المكتبات ومنها المكتبة الوطنية ومكتبة الأوقاف الاسلامية وحرق ما فيها
من كتب قديمة نادرة ومخطوطات ثمينة من الحقبتين العثمانية والعباسية،
في فعل لا يمكن وصفه إلا بأنه جريمة محو ثقافي متعمد. تم ذلك كله تحت
أنظار القوات الامريكية التي لم تتدخل لحماية المتحف أو أي موقع آخر
باستثناء وزارة النفط، خلافا لمسؤوليتها القانونية كقوة إحتلال. يومها،
قال ريتشارد لانيير، مستشار بوش للشؤون الثقافية « إن الولايات المتحدة
تعرف ثمن النفط ولكنها لا تعرف قيمة الآثار التاريخية». برر مسؤولون
أمريكيون عدم التدخل بأنهم « فوجئوا» بمدى ما حصل من أعمال سلب ونهب.
فهل أصبح أستخدام مفردة « المفاجأة» مبررا شرعيا للافلات من العقاب
سواء في العراق أو أفغانستان؟ من يقرأ تصريحات وزير الخارجية دونالد
رامسفيلد، سيجد أنه كان مدركا تمام الإدراك لما يجري وتبريره أن «هذه
أشياء تحدث» و« أن الناس أحرار في ارتكاب الأخطاء وارتكاب الجرائم
والقيام بأشياء سيئة.. وأن النهب ليس غريبا في البلدان التي تعاني من
اضطرابات اجتماعية كبيرة». لاحظوا أن أيا من هذا لم يحدث في كابول الآن
والتخريب الوحيد كان في المطار الذي يديره الأمريكيون. ولكن، هل يحق
لطالبان اليوم إستخدام تبرير رامسفيلد ذاته اذا ما ساد النهب والتخريب
بوجودهم؟ ماذا عن الدولة ومؤسساتها؟
في 16 مايو، صرح بول بريمر أن التحالف مصمم على محو مراكز القوى
القديمة من الوجود. فقام بحل الجيش العراقي واصدار أكثر من 100 أمر
وقرار تشريعي تفصيلي للتحكم بكل مجريات تسيير الحياة. كان من جرائها
تفكيك الدولة وجعل نحو أربعمائة ألف شخص عاطلين عن العمل. ومن ثم تطبيق
سياسة « إجتثاث البعث» التي شجعت على القتل خارج القانون، ومنح المخبر
السري دورا كبيرا في الاتهامات الكيدية، بالاضافة الى حملة الاغتيالات
التي طالت العلماء والأكاديميين والطيارين والفنانين. وكان لأمريكا،
بمساعدة مترجمين عراقيين وعرب، الفضل الكبير في إبداع أساليب تعذيب في
أبو غريب، أدت إلى مساواة المرأة بالرجل تعذيبا.
لم ينفذ الجرائم الوحشية المهينة، في العراق، أمريكيون مختلون عقليا أو
مجرد « تفاحات فاسدة» كما تدعي الإدارة الامريكية، بل كانت من صلب
السياسة الخارجية، حين صاغت إدارة بوش عمليات محاربة الإرهاب في
العالم. ومعظمها يخرق قوانين الحرب والقانون الدولي لحقوق الإنسان، إذ
تشمل تقنيات طالما تدينها أمريكا عندما تمارسها أطراف أخرى.
وفي الوقت الذي لا يمكن فيه الحكم مستقبلا على سياسة أية دولة أو حركة
إلا من خلال قراءة الماضي، فلنأمل أن تتفادى حركة طالبان، بعد تحريرها
أفغانستان من قوات الاحتلال، ما قامت به أمريكا في العراق، وأن تتعامل
مع خروقات حقوق الإنسان كجرائم وليست «خيارات سياسية» أو عقابا جماعيا،
تفاديا لدورات الانتقام.
كاتبة من العراق
قمة بغداد في بورصة
التخويف من الإرهاب
هيفاء زنكنة
احتلت بغداد، يوم 28 آب/ أغسطس، حيزا إعلاميا، يعيد إلى الذاكرة أيام
المؤتمرات الكبيرة الحاضنة للدول العربية والأجنبية في حقبة ما قبل
الاحتلال الأنجلو أمريكي عام 2003. ففي توقيت، تدّعي الحكومات الغربية،
بأنه مفاجئ، فيما يخص استعادة حركة طالبان لأفغانستان والانسحاب المهين
لقوات الاحتلال الأمريكي ـ البريطاني، انعقدت « قمة بغداد للتعاون
والشراكة» بحضور تسع دول جوار وفرنسا بالإضافة إلى الجامعة العربية
ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي.
ألقى ممثلو الحكومات من رؤساء ووزراء خارجية خطبا تكاد تكون في
تشابهها، مثل وجبات مكدونالد. الوجبة نفسها بتعليب مختلف مع إضافة قطعة
مخلل هنا أو شريحة طماطم هناك. حفلت الخطب المعنونة «دعم ومساندة
العراق» بمفردات: الأمن والاستقرار والسلام، مواجهة الإرهاب والتطرف،
إعادة البناء، بناء الجسور والحوار.
وكالعادة، كانت اجتماعات « الحوار» بين ممثلي الدول والمنظمات مغلقة،
واقتصر البيان الختامي على العموميات، لتبقى الشعوب، كما هي، مجرد
هامش، لا يستحق التضمين إلا في حالات ادعاء الحديث باسمها أو مخاطبتها
باسلوب مبطن بالنظرة الفوقية واللوم على التقاعس، كما فعل الرئيس
المصري عبد الفتاح السيسي قائلا «أيها العراقيون أنتم أمة عريقة. ابنوا
مستقبلكم ومستقبل أبنائكم».
وفي الوقت الذي تحدث فيه الخطباء عن « عدم التدخل في الشؤون الداخلية
للعراق» كان التدخل في الشأن العراقي الداخلي هو سيد الموقف، على
مستويين. الأول حول الانتخابات العامة المفترض إجراؤها بداية تشرين
الأول/ أكتوبر المقبل، وهو التاريخ ذاته الذي انبثقت فيه انتفاضة تشرين
الأول/ أكتوبر 2019. وكان المستوى الثاني حول العلاقة بـ «محاربة
الأرهاب».
بالنسبة إلى الانتخابات، كان لمصر والكويت وفرنسا الدور الأبرز في
الدفع باجراء الانتخابات. ذكر الرئيس الفرنسي ماكرون أن بعثات من
الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ستراقب الانتخابات، متجاهلا حقيقة أن
الانتخابات السابقة تمت بإشراف البعثات ذاتها، وكانت النتيجة كارثية.
أما السيسي فقد أطلق موعظة «شاركوا في اختيار من يقودكم إلى الأمان»
متغافلا عن مساره الفاشي في إرساء «الأمان» في مصر منذ أعوام، فضلا عن
قيامه بدور الحارس، بالنيابة عن الكيان الصهيوني، على أهل غزة، في واحد
من أكبر السجون في العالم. ولم يشر أحد المتحدثين إلى سبب مشاركة 18 في
المئة، فقط، من العراقيين في الانتخابات السابقة، على الرغم من قرع كل
طبول الديمقراطية، وكيف أجبر المتظاهرون رئيس الوزراء عادل عبد المهدي
على الاستقالة، وكيف أغرق من حل محله، أي مصطفى الكاظمي، الشعب بفيضان
من وعود بمعاقبة قتلة المتظاهرين.
تفكيك الانتخابات سيُظهرعقود نهب ومشاريع ووظائف وهمية وأموال رشاوى يتم غسلها في بنوك الغرب
وكانت الحصيلة المزيد من المختطفين والمعتقلين والتعذيب والقتلى.
وإلقاء نظرة سريعة على تقارير مجلس حقوق الأنسان في الأمم المتحدة،
ومفوضية حقوق الانسان في العراق، بالاضافة إلى منظمة العفو الدولية
وهيومن رايتس ووتش ( في حال عدم ثقة ممثلي الدول بالتقارير المحلية)
كانت ستبين لهم أن كراسيهم الفخمة، في قاعة الاجتماع، غارقة بدماء
العراقيين، وأن خطاب الكاظمي وتصريحات وزير الخارجية يدلان بوضوح، كما
شمس العراق، إلى ما ستتمخض عنه الانتخابات المقبلة: إعادة تدوير الوجوه
نفسها، ربما بأقنعة مغايرة. لا لأن العراقيين لن يختاروا «الأمناء» كما
نصحهم السيسي، بل لأن لغة الانتخابات الأولى والأخيرة هي الفساد. وألف
باء لغة الفساد في العراق الغني هي مليارات الدولارات. وتفكيك
الانتخابات سيُظهرعقود نهب ومشاريع ووظائف وهمية وأموال رشاوى باذخة
يتم غسلها في بنوك الغرب. فالدول التي تُخّرب البلدان غير المطيعة
صباحا، تتظاهر بمد يد الإحسان والمساعدة والبناء مساء.
بالنسبة إلى «مكافحة الأرهاب» وهو المشروع الذي صّنعته وسوّقته
الولايات المتحدة، وتبناه الحكام العرب لكي لا يحيدوا عن الصراط
الأمريكي، قدمه المشاركون في القمة بعنوان «دعم العراق في مواجهة
الإرهاب» لتحقيق الأمن والاستقرار. هنا يتبدى التدخل في الشأن الداخلي
بشكل أوضح. إذ تحدث كل مشارك باستفاضة عن الجهة التي يراها مصدرا
للإرهاب، الذي يستهدف بلده هو، من داخل العراق، وحسب تعريفه هو
للإرهاب. يرى الرئيس الفرنسي إنه الإرهاب العالمي، ويجب مساعدة العراق
للتخلص منه. وصرح وزير الخارجية التركي «لا مكان للإرهاب في مستقبل
العراق» والأرهاب بالنسبة إلى تركيا هو «أي وجود لحزب العمال
الكردستاني على الأراضي العراقية» بينما يتعامى عن عسكرة القوات
التركية على أراض عراقية. وكالصدى كرر وزير الخارجية الإيراني «أن
العراق تضرر كثيرا بفعل الإرهاب» والإرهاب بالنسبة إلى إيران هو «
لتدخلات الأجنبية» على رأسها أمريكا، وكأن تدخل إيران وميليشياتها شأن
عراقي داخلي وطني بحت، مما يذكرنا بتصريح مماثل لوزير الدفاع الأمريكي
دونالد رامسفيلد في واحدة من خطبه، عقب غزو العراق، قائلا بأن مشكلة
العراق هي التدخل الخارجي. وكأن قوات الاحتلال الأمريكية عراقية وطنية
أبا عن جد. وترى السعودية أن محاربة الإرهاب تتم بالتعاون مع قوات
التحالف برئاسة أمريكا.
إن متابعة الخطب والتصريحات والبيان الختامي للقمة، لا يضيف شيئا جديدا
لما سمعناه في خطب وتصريحات سابقة، باستثناء كونها صادرة عن أشخاص
موجودين في قاعة واحدة قاسمهم المشترك، المعلن، هو التخويف من «
الإرهاب «. الإرهاب الذي يقدم كل واحد منهم تعريفه الخاص به، وعجنه
بالخوف واحد من أكثر طرق سيطرة الأنظمة على عقول الشعوب نجاحا.
تم تصوير « قمة بغداد» بأنها ستمنح شعوب الدول المجتمعة الأمل بتحقيق
الأمن والاستقرار. إلا أن ما لم يتم التطرق إليه إطلاقا سواء من قبل
المجتمعين أو إعلاميا هو أن معظم شعوب هذه الدول، وليس العراق وحده،
تعيش خارج قاعات الاجتماعات الباذخة واقعا يراوح ما بين المزري واللا
إنساني، وأن وجود المضاربين، ممثلي شركات المتنافسة بشراسة، في مبنى
البورصة لايعني اتفاقهم حول توحيد الأسعار في الأسواق لصالح
المستهلكين.
كاتبة من العراق
إذا كانت أفعال طالبان هي المقياس …
ماذا عن أمريكا في العراق؟
هيفاء زنكنة
هل تفاجأت أمريكا، فعلا، بعودة
طالبان السريعة الى أفغانستان؟ وهل الحقيقة لا تحمل اموراً مخفية بل كل
ما في الأمر هو « أن هذا حدث أسرع بكثير من تقديراتنا»، كما ذكر الرئيس
الأمريكي جو بايدن في خطابه، بعد أيام، من استعادة طالبان للعاصمة
كابول في 15 آب / أغسطس؟ وهل « ما حدث» هو اندحار، استسلام ، انسحاب،
تراجع ؟ أم هو مغادرة، أو عودة، أو إتفاق ؟
وما مدى صدق الطرفين المتفاوضين في تنفيذ الاتفاقية المبرمة،
وانعكاساتها على الشعب الأفغاني، عموما، في الأيام والشهور المقبلة،
بالمقارنة مع الوضع العراقي؟
إذا ما تابعنا مسار المفاوضات في الدوحة، بين الوفدين الأمريكي
وطالبان، سنجد صعوبة في تصديق عنصر المفاجأة وما ترتب عليها من فوضى
بخصوص ترحيل الأمريكيين والبريطانيين، انفسهم، وغيرهم من قوات الناتو
والمتعاونين معهم، ثم انتقلت الى المتعاونين مع الاحتلال ثم عامة
الناس، النساء خاصة، المذعورين من صيت طالبان وما قد يتعرضون له من
انتقام. وأصبحت هذه الأخيرة الصورة الأبرز إعلاميا. وسبب صعوبة تصديق «
المفاجأة» هو أولا الصورة الخارقة في الامكانيات والتنظيم التي ترسمها
الولايات المتحدة الأمريكية عن نفسها وتوزعها على العالم إعلاميا . كما
أن بحث عملية انسحاب القوات الأمريكية لم يكن وليد العامين الأخيرين،
بل عشرة أعوام من المفاوضات المستمرة، على كل المستويات، وإن القرار
الرسمي قد حمل توقيع الرئيس السابق دونالد ترامب الذي حدد موعد
الانسحاب هذا العام، والرئيس الحالي جو بايدن الذي أقره بتعديلات
بسيطة.
لقد بدأت مفاوضات الانسحاب نهاية عام 2013 ، بعد مرور عشر سنوات على
الإحتلال الامريكي لأفغانستان، بعد أن أدركت أمريكا ، حسب روبرت غرينير
« لم ننجز الكثير بعد مرور عشر سنوات… وكان تدخلنا في البداية رمزيا
واعتمدنا على تنظيم « التحالف الشمالي» لمقاتلة طالبان. الا ان
عنجهيتنا دفعتنا الى سياسة مختلفة عام 2005» . كان غرينير رئيس محطة
وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ( السي آي أي) في إسلام أباد، في
أخطر مرحلة ، في أعقاب 11 سبتمبر 2001. كان مسؤولا عن تخطيط وإدارة
عمليات سرية لدعم غزو أفغانستان. ثم مدير مهمة العراق في الوكالة ،
لتنسيق العمليات السرية لدعم غزو العراق عام 2003. وترأس مدرسة
«المزرعة» لإعداد الجواسيس التابعة للسي آي أي، وأخيرا مدير مركز
مكافحة الإرهاب في أرجاء العالم.
تصادف اني حضرت أثناء وجودي في مؤتمر ثقافي عالمي عُقد في جزيرة غوا،
بالهند في تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، مقابلة مهمة جمعت غرينير بالملا
عبد السلام ضعيف، أحد مؤسسي طالبان، وسفير طالبان في باكستان، الذي
اعتقلته المخابرات الباكستانية بعد الغزو الأمريكي وباعته ( كما
الكثيرين ممن اتهموا بالإرهاب) الى المخابرات الأمريكية مقابل خمسة
آلاف دولار، فسُجن في معتقل غوانتانامو، مدة اربع سنوات ونصف. وكان
الرئيس الأفغاني السابق حميد كرزاي قد أعلن عفوا عاما عن طالبان، كخطوة
نحو استتباب الأمن، إلا أن الادارة الأمريكية جمّدت القرار بعد أسبوع
لتجهض بذلك إمكانية المصالحة بين مختلف القوى الأفغانية.
بحث عملية انسحاب القوات الأمريكية لم يكن وليد العامين الأخيرين، بل عشرة أعوام من المفاوضات المستمرة، على كل المستويات، وإن القرار الرسمي قد حمل توقيع الرئيس السابق دونالد ترامب الذي حدد موعد الانسحاب هذا العام
أدارت المقابلة شوما جاودري، رئيسة
تحرير صحيفة « تهلكا» الاستقصائية الهندية، وأثارت مشاركة ملا عبد
السلام ضجة لأنها المرة الاولى التي يٌسمح فيها لشخص مثله بزيارة الهند
والحديث أمام جمهور واسع. تحدث غرينيرعن نية أمريكا سحب قواتها
والتفاوض مع طالبان. واستفاض ملا عبد السلام بالحديث عن أهمية
الاستقرار الأمني والسياسي في افغانستان وضرورة اللجوء الى التفاوض
الدبلوماسي لتحقيق ذلك ، مركزا على فشل الديمقراطية التي تحاول أمريكا
فرضها عسكريا والتي لم يُسمح بنموها عضويا من داخل المجتمع ، أي
«ديمقراطية إسلامية». خلال المقابلة المتوفرة ألكترونيا، والتي عدت الى
مشاهدتها مجددا، أجوبة على أسئلة تُطرح ، اليوم، وبعد مرور عشرة أعوام
على اجرائها، ومطابقة بتفاصيلها مع التساؤلات الحالية عن تغير طالبان
او قدرة طالبان على التغير، وبالتحديد السؤال الأكثر شيوعا عن الموقف
من المرأة . أكد ملا سلام، المرة تلو المرة، أهمية تعليم المرأة لأنها
نصف المجتمع وأدان ، بعد إلحاح من مديرة اللقاء، تفجير ومهاجمة
المدارس. منبها الى وجود « جهات أخرى» تحاول تشويه صورة طالبان. أما عن
مستقبل أفغانستان ، فتحدث عن الانسحاب الحتمي لقوات الاحتلال الامريكي
مع التنبيه الى تعقيدات الوضع بسبب الموقع الجغرافي للبلد المحصور بين
الصين وروسيا وإيران وباكستان من جهة، والتدخل الأمريكي الذي سيتخذ
أشكالا أخرى كتأسيس المليشيات، كما في العراق.
والمفارقة أن نسمع، حاليا، وبعد الانسحاب العسكري المهين، اطلاق
تصريحات رسمية على غرار « التزامنا تجاه أفغانستان دائم» ، لرئيس
الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بدون أن يبين كيف، ومتغافلا عن
الجريمة الكبرى التي ارتكبتها بريطانيا وأمريكا، في شنها حربا عدوانية
لا يزال العراق يعيش تفاصيلها الدامية. وتبلغ ازدواجية المعايير ذروتها
حين تركز كافة أجهزة الإعلام الغربية ، تقريبا، وتجترها الصحافة
العربية ومواقع الفيسبوك، أما تعمدا أو سذاجة، على تقديم صور
كاريكاتيرية عن أشكال مقاتلي طالبان ومظهرهم الخارجي، واستخدام لغة
مبتذلة تحقيرا لهم ، مما يُذكرنا باللغة التي استخدمتها قوات الغزو
الامريكي للعراق لوصف العراقيين بـ»علي بابا « و»حاجي» و»رؤوس الخرقة»
اشارة الى الغترة الشعبية العراقية، ليصبح من السهل تجريدهم من
إنسانيتهم وبالتالي تعذيبهم وقتلهم. ولا يقتصر الحط من القيمة
الانسانية عبر الانتقاص من الشكل، على الصحف الصفراء واجهزة الإعلام
الرخيصة، بل سقطت البي بي سي عربي، أخيرا، في ذات الهوة، مستخدمة
عنوانا بمثابة حكم مسبق وتصنيف جاهز، هو «لم يغيروا ملابسهم أو شعرهم
أو لحاهم، فكيف يمكنهم تغيير أفكارهم؟».
أمام أعضاء البرلمان قال بوريس جونسون « سنحكم على نظام طالبان على
أفعاله وليس أقواله ، وعلى سلوكه حيال الإرهاب والجريمة والمخدرات،
وحقوق الفتيات في الحصول على التعليم»، أليس هذا هو المقياس الذي فشلت
الحكومة البريطانية والإدارة الامريكية، في تحقيقه بالتحديد في عملية
«تحريرالعراق »؟
كاتبة من العراق
إذا كانت أمريكا لم تتغير…
هل تغيرت طالبان؟
هيفاء زنكنة
في ظل إرسال الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا قوات إلى كابول
لترحيل موظفي الدولتين والمتعاونين معها بسرعة بعد دخول قوات طالبان
العاصمة، وفي ظل استعادة العالم، صورة الهرب الأمريكي الكبير من
فيتنام، نقضت إحدى المحاكم البريطانية حكما سابقا بوقف ترحيل مؤسس
«ويكيليكس» جوليان أسانج، إلى الولايات المتحدة. قررت المحكمة منح
الحكومة الأمريكية مجالا أكبر لاستئناف القرار الأول الذي كان يستند
على تدهورالوضع النفسي الذي يعانيه أسانج وقد يدفعه إلى الانتحار، اذا
ما تم ترحيله الى أمريكا، حيث سيواجه فيها 18 تهمة، عن نشر آلاف
الوثائق السرية في عامي 2010 و2011، تصل عقوبتها إلى 175 سنة.
واذا كان الانشغال العالمي بالبحث عن أسباب التغيرات العسكرية المذهلة،
أو ما بات يُعرف بالاندحار الأمريكي ـ البريطاني في أفغانستان، ومحاولة
الإجابة في لحظات الهزيمة المريرة عن تساؤلات كان يجب طرحها، منذ عشرين
عاما، حول طبيعة الغزو، فان التاريخ ينقلنا إلى ذات اللحظات، تقريبا،
إلى فيتنام ولكن من خلال التطابق شبه الكلي مع حياة وجهود أشخاص،
ساهموا في مساءلة ما هو وراء التصريحات الحكومية وكشف الحقيقة معرضين
حياتهم للسجن في أمريكا.
قد لا يكون للصحافي جوليان أسانج دور مباشر في الهزيمة المدوية لأمريكا
وبريطانيا في أفغانستان، وإلى حد أقل في فشلهما السياسي بالعراق، إلا
أنه وآخرين ساعدوا في فضح المخفي والمزيف في غزوها وإحتلالها البلدين.
حيث أسس أسانج مع عدد من الباحثين موقع ويكيليكس لتسريب المعلومات، من
بينها نشر ما يقارب الاربعمائة ألف سجل عسكري سري، من بين سجلات جيش
الاحتلال الأمريكي للعراق، بالاضافة الى نشر وثائق عسكرية أمريكية سرية
عن احتلال العراق وأفغانستان، ولم يشمل ذلك هويات المخبرين الذين كانوا
يساعدون وكالات الاستخبارات في أفغانستان والعراق وأماكن أخرى، وهو
الإدعاء الذي تستخدمه الولايات المتحدة باعتباره فعلا يهدد حياتهم.
كل هذه الوثائق موجودة، الآن، في أرشيف الصحف العالمية مثل
«الغارديان». ولعل ما رسخ في الأذهان وأثار ضجة أكثر من غيره، عن
العراق، هو تسريب شريط فيديو التقطته مروحية أمريكية، في 2007،
يُظهراستهداف طاقم المروحية لمدنيين عراقيين وقتلهم 11 شخصا من بينهم
طفلان وموظفان في شبكة «رويترز» بحجة أنهم إرهابيون.
هل سنحتاج لفهم ما يجري فعلا والكشف عن الحقيقة أشخاصا مثل إلسبيرغ وأسانج لتسريب «أوراق طالبان» مثلا؟
من سبق أسانج و«ويكيليكس» أثناء الحرب الأمريكية ضد فيتنام، هو دانيال
إلسبيرغ، المحلل الاستراتيجي المتخصص في الاستراتيجية النووية والقيادة
والسيطرة على الأسلحة النووية، الذي ساهم عام 1967، بتكليف من وزير
الدفاع روبرت ماكنمارا، في دراسة سرية، للغاية، لوثائق سرية حول تاريخ
التدخل السياسي والعسكري للولايات المتحدة في فيتنام من عام 1945 إلى
عام 1967. أصبحت هذه الوثائق تُعرف باسم «أوراق البنتاغون». كشفت أوراق
البنتاغون أن أربع إدارات (برئاسة ترومان وأيزنهاور وكينيدي وجونسون)
قد ضللت الجمهور فيما يتعلق بالحرب ضد فيتنام، وأنها كذبت بشكل منهجي
لتضمن استمرارها عن طريق توسيع الحرب، بقصف كمبوديا ولاوس والتي لم يتم
الإعلان عنها اعلاميا. وفي الوقت الذي أعلن فيه الرئيس جونسون أن الهدف
من حرب فيتنام كان تأمين «فيتنام الجنوبية المستقلة وغير الشيوعية»
ووضع حد «لحرب أهلية» إلا أن أوراق البنتاغون كشفت أن السبب الأساسي
«ليس مساعدة صديق، ولكن احتواء الصين «. مما يدفع المرء الى مقارنة هذه
الادعاءات بما أطلقته ادارة جورج بوش بصدد غزو افغانستان والعراق،
وحقيقة الديمقراطية وحقوق الإنسان مقابل السيطرة على مصادر الطاقة
وإنهاء الحظر الذي فرضته حكومة طالبان، عام 2000، على إنتاج الهيرويين،
وأدى إلى إنخفاض ما يقرب من ثلاثة أرباع إمدادات العالم منه.
توصل إلسبيرغ، من خلال دراسة سجلات الحكومة، إلى أن حرب فيتنام لم تكن
«حربًا أهلية» بل حرباً استعمارية. وإن «الحرب التي يتم فيها تجهيز أحد
الأطراف بالكامل ودفع ثمنه من قبل قوة أجنبية ـ والتي فرضت طبيعة
النظام المحلي لمصلحته ـ لم تكن حربًا أهلية… بل عدوانًا خارجيًا،
عدوانا أمريكيا». مثل أسانج، قرر إلسبيرغ أن من حق الشعوب أن تطلع على
حقيقة ما تقوم به الحكومات باسمها. فقام بتسريب نسخ من الأوراق الى
صحيفة «نيويورك تايمز» فنشرت مقتطفات من مجموع الصفحات البالغ عددها
7000. وحين مُنعت الصحيفة من نشر المزيد، سرب إلسبيرج الوثائق إلى
صحيفة «واشنطن بوست» ومن ثم إلى 17 صحيفة أخرى. ألقي القبض على إلسبيرغ
وقُدم للمحاكمة في مايو 1973، إلا أن القاضي رفض إدانته بسبب السلوك
الحكومي المنافي للقوانين وجمع الأدلة غير القانوني.
هل أدى الدور الذي لعبه إلسبيرغ في تسريب أوراق البنتاغون السرية الى
الصحافة والرأي العام الى هزيمة أمريكا العسكرية المتمثلة بالهروب
الكبير؟ كلا. إلا انه ومن خلال الكشف عن أكاذيب التصريحات الحكومية حول
الوضع العسكري في فيتنام، بما في ذلك إختلاق عمليات لم تحدث أبدا، على
غرار قصف زوارق البحرية الأمريكية في خليج تونكين، ساهم تسريبه الوثائق
في تعميق فجوة المصداقية بين الحقيقة وما تقول الحكومة إنه حقيقي، في
تحويل موقف الكثير من الأمريكيين من مؤيدين الى مناهضين للحرب.
واذا كانت تفاصيل الأحداث المتسارعة في افغانستان، اليوم، حبلى بهزيمة
السياسة الأمريكية والبريطانية وقوات الناتو مجتمعة، وهي الأقوى عسكريا
في العالم، فان ظروف ولادة الوضع الجديد المتمثل باستعادة طالبان
الحكم، وتأثيرات ذلك على الدول المجاورة والعلاقة، كما كانت أيام
فيتنام، مع الصين، محاطة بغموض ما اتفقت أو لم تتفق عليه الجهات
المتفاوضة. واذا كانت أمريكا لم تتغير، هل تغيرت طالبان؟ كيف؟ وهل
سنحتاج لفهم ما يجري فعلا والكشف عن الحقيقة أشخاصا مثل إلسبيرغ وأسانج
لتسريب « أوراق طالبان» مثلا؟
كاتبة من العراق
هل هناك 11 ألف
محكوم بالاعدام في العراق؟
هيفاء زنكنة
«كان نفس الروتين، كل يوم يعلقونني ويضربونني. هناك أشياء فعلوها بي
هناك أشعر بالخجل من التحدث عنها، ولكن هناك شيئا واحدا يمكنني أن
أخبرك به هو أنهم جعلوني أجلس على قنينة زجاجية مرتين». هذا بعض ماجاء
في المقابلة رقم 106. ويخبرنا المعتقل في المقابلة رقم 107 «لقد قيدوا
يدي وراء ظهري وعلقوا الأصفاد بخطاف في سلسلة متدلية من السقف. لم
يطرحوا على أية أسئلة، فقط استمروا بالصراخ لأعترف».
في غياهب المعتقلات العراقية، أجريت مقابلات مع 235 محتجزا، تم تضمينها
في تقرير «حقوق الإنسان في تطبيق العدالة في العراق: الشروط القانونية
والضمانات الإجرائية لمنع التعذيب والمعاملة السيئة» الذي أعدّته بعثة
الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق (يونامي) ومفوضيّة الأمم
المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، الصادر في 3 آب/ أغسطس. ويغطي التقرير
من 1 تموز/يوليو 2019 إلى 30 نيسان/أبريل 2020.
«التعذيب حقيقة واقعية في جميع أنحاء العراق» أُسْتُهل التقرير بهذه
الجملة الصارخة في إدانتها للممارسات اللاإنسانية في أماكن الاحتجاز
التي لا تقتصر على وزارتي العدل والداخلية بل، أيضا، وزارة الدفاع،
وجهاز مكافحة الارهاب، وقيادة عمليات بغداد، وجهاز الأمن الوطني، وجهاز
المخابرات الوطني، وقوات الحشد الشعبي، بالاضافة الى أماكن اعتقال أخرى
لم يعرف المحتجزون مكانها. ويحيط الغموض أعداد المحتجزين، فباستثناء
وزارتي العدل التي افادت بوجود 39518 محتجزا عام 2020. من بينهم 2115
إمرأة و11 ألفا و595 مدانا محكوما عليهم بالإعدام، بضمنهم 25 امرأة،
و24853 في منشآت تحت سلطة وزارة الداخلية، لم يتم التحقق من أعداد
المحتجزين في المعتقلات الأخرى، مما يشير إلى أن الأعداد أكبر بكثير.
كما لا تشمل الأرقام إقليم كردستان.
من بين أشكال التعذيب التي يذكرها التقرير: الضرب المبرح، والصعق
بالصدمات الكهربائية، والتعليق من السقف، والتعرض للعنف الجنسي، لاسيما
الصدمات الكهربائية على اعضائهم التناسلية وحشر العصي والقناني
الزجاجية في فتحة الشرج. ولاحظت البعثة أن الكثير من الاشخاص الذين تمت
مقابلتهم تحدثوا عن «أشياء فعلوها بي هناك أشعر بالخجل من التحدث
عنها». ولم يُضمن التقرير اوضاع السجون كفقر الخدمات، والاكتظاظ. فقد
تلقت البعثة معلومات عن وفاة 62 معتقلا في «سجن الحوت» بالناصرية، جنوب
العراق، و355 حالة وفاة في مرافق تابعة لوزارة العدل. يؤكد التقرير
قبول التعذيب وسوء المعاملة مقبولا رسميا كوسيلة لانتزاع «اعتراف». وهي
سياسة منهجية تمارس على نطاق واسع حيث قدم أكثر من نصف المحتجزين الذين
قابلتهم البعثة، روايات موثوقة وذات مصداقية عن تعرضهم للتعذيب.
وللمتظاهرين السلميين حصتهم في سوء المعاملة والتعذيب. حيث وثّق
التقرير شهادات 38 معتقلا بعد اختطافهم. كان من بين ما تعرضوا له «
الصدمات الكهربائية، الضرب الشديد، والتعليق من السقف، والتهديد
بالقتل، والعنف الجنسي ضدهم وضد عوائلهم، والتبول عليهم وتصويرهم
عراة». ويخلص التقرير الى» أن روايات الضحايا لا تترك مجالا للشك في أن
التعذيب وسوء المعاملة متفشيان في جميع أنحاء البلاد على الرغم من أنّ
الإطار القانوني العراقي يجرّم صراحةً التعذيب ويحدّد الضمانات
الإجرائية لمنعه» في اشارة الى انضمام العراق الى اتفاقية مناهضة
التعذيب عام 2011.
في غياهب المعتقلات العراقية، أجريت مقابلات مع 235 محتجزا، تم تضمينها في تقرير»حقوق الإنسان في تطبيق العدالة في العراق: الشروط القانونية والضمانات الإجرائية لمنع التعذيب والمعاملة السيئة»
ان الاعلان المباشر والصريح بأن التعذيب في العراق حقيقة لم يعد
بالامكان السكوت عليها، أمر يُحسب لصالح التقرير. ولعلها من المرات
النادرة التي لا يُغلف فيها موظفو الامم المتحدة، تقاريرهم بمفردات
مبهمة تتحمل التأويل المتناقض، والشك في الحقيقة، لتفادي التعرض
المباشر الى الحكومات القمعية. مفردات على غرار «مزاعم» و«ادعاءات»
تقود، في نهاية التقرير، الى خلاصة تُعبر فيها اللجنة عن « القلق»
و«الاستنكار». ولعل موظفي الأمم المتحدة تعبوا من القلق والاستنكار
أمام الواقع المرير الذي يرونه.
صحيح أن التقرير لم يخلُ من الاشارة الى ان الحكومة أجرت بعض التغييرات
القانونية ضد التعذيب الا أن المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل
باشيليت نبهت الى إن «السلطات في حاجة إلى التنفيذ الفعال للأحكام
المكتوبة في القانون في كل مركز احتجاز. وإلا فإنها تظل حبرا على ورق».
وهذا هو أساس استمرار الممارسات الهمجية المرعبة في لا انسانيتها. ومن
بينها وجود 11 ألفا و 585 مدانا محكوما بالإعدام، حسب كتاب صادر من
وزارة العدل وموجه الى البعثة. وهو رقم هائل بكل المقاييس، دفعني الى
قراءة التقرير عدة مرات وباللغتين العربية والانكليزية، لأتأكد من
صحته، والعثور على إجابة منطقية لمرور التقرير، بشكل عابر، على هذا
العدد الذي يجعل العراق مسلخا بشريا أو نسخة من المحرقة النازية، في ظل
نظام «تنتهك فيه اغلب الشروط القانونية الاساسية والضمانات الاجرائية
المنصوص عليها في الاطار القانوني العراقي والدولي بشكل منتظم» وحيث
«لا يخشى الجناة حقاً عواقب قيامهم بالتعذيب لأنهم يعلمون أن النظام
الرسمي لن يعاقبهم» برعاية قضاء مهمته شرعنة الأكاذيب الحكومية.
ما لم يتطرق اليه التقرير، على أهميته، هو حجم الضرر الجسدي والنفسي
الذي سيرافق المحتجز المتعرض للتعذيب مدى الحياة أحيانا. فما يهدف اليه
الجلاد هو ليس انتزاع الاعتراف بجريمة ما فحسب بل سلبه إنسانية الشخص
وكرامته والسيطرة عليه بشكل يمتد الى الابتزاز الاجتماعي والسياسي.
فصور المتظاهر السلمي المختطف عاريا، باسلوب مماثل لسياسة التعذيب
الأمريكية في أبو غريب، أداة فاعلة للتخويف والتهديد ومنع المتظاهر،
وآخرين، من المشاركة في اي نشاط كان مستقبلا. من هنا تنبع ضرورة فضح
هذه الاساليب بكل الطرق الممكنة. فالتعذيب فعل اجرامي، والجلاد هو الذي
يجب ان يشعر بالعار وليس الضحية. ومن يكشف عن تفاصيل ما يتعرض له
«هناك» يستحق الاحترام والتقدير. لأنه يساهم بتوثيق جرائم، نأمل أن
تؤدي، مستقبلا، الى محاسبة مرتكبيها ووضع حد لممارستها.
كاتبة من العراق
من الذي يحتضن
مليارات العراق المهربة؟
هيفاء زنكنة
حين سألت كارولاين لوكاس، النائبة البريطانية عن حزب الخضر، وزير
الدولة للشؤون الخارجية والتنمية، عما إذا كانت الحكومة البريطانية
تدعم، ماديا، مشاريع متعلقة بالطاقة الغازية في بلدان أخرى، أجابها
الوزير أن الحكومة مستمرة في دعم مشروع شركة جنرال إلكتريك للطاقة في
العراق. مما يتماشى مع سياسة بريطانيا في العراق. مع العلم أن شركة
جنرال إلكتريك، أمريكية متعددة الجنسيات صُنفت كواحدة من 300 أكبر شركة
في الولايات المتحدة من حيث إجمالي الإيرادات. تمكنت الشركة، بضغوط من
الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب، عام 2017 من الفوز بعقد قيمته
أكثر من 1.2 مليار دولار «لتنفيذ مشاريع قطاع الطاقة التي ستؤمن
إمدادات طاقة موثوقة في جميع أنحاء البلاد». كما اتفقت الحكومة
البريطانية على توفير ضمان للشركة مع أخرى بريطانية بقيمة 155 مليون
دولار «لتعزيز قطاع الطاقة في العراق. كما يوفر إنشاء المشاريع أيضًا
فرصًا ضخمة ـ ومثيرة للغاية ـ للمُصدرين في المملكة المتحدة» حسب وزير
التجارة الدولية الذي تجاهل، وهو يعلن سروره بالاتفاقيات، أن يذكر نسبة
الربح الذي ستحصل عليه بريطانيا مقابل توفير الضمان.
إعتبرت لوكاس جواب وزير الدولة وافيا. فالمهم، من وجهة نظر السياسي
البريطاني، سواء كان يساريا أو محافظا، هو استمرار الإعلان أن الحكومة
البريطانية تتعاون مع الحكومة العراقية في توفير الخدمات والاستقرار
للشعب العراقي، أما الهيمنة الاقتصادية ومن خلالها السياسية، إثر الغزو
والاحتلال، فأمر غالبا ما يتم تجنب الاشارة اليه علنيا. لذلك كان من
الطبيعي ألا تطرح لوكاس، رغم كونها يسارية، سؤالا آخر عن مدى نجاح
المشاريع المدعومة بتحسين وضع الشعب العراقي، فعلا، والذي تتحمل
بريطانيا جزءا كبيرا من انهياره. فاذا كانت الحكومة تدعم مشاريع الطاقة
منذ اسقاط نظام صدام عام 2003 وتوقيع العقود يتجدد مع زيارة كل وزير
كهرباء عراقي إلى لندن، لماذا، إذن، يتظاهر العراقيون، خاصة في الصيف،
وهم يحملون تابوتا يدعى الكهرباء؟ لماذا يُضحي المتظاهرون بحياتهم،
ويسقط الآلاف منهم قتلى وجرحى، في كل المواسم؟ ما مدى استفادة بريطانيا
من دعمها الشركات البريطانية والأمريكية وغيرها ومعظمها يحظى بعقود
خيالية تحت شعار إصلاح وتجديد وزيادة القدرة على تزويد العراقيين
بالكهرباء؟ وكيف بات ما يحصل عليه المواطن من الكهرباء، يوميا، لا يزيد
على الخمس ساعات في بيئة، تصل فيها درجة الحرارة أكثر من 52؟ ولم، مع
كل المشاريع المعلن عنها، لا يزال العراق المستورد الأول للكهرباء من
إيران؟ لماذا لم يتم، حتى الآن، العمل على معالجة حوالي 16 مليار متر
مكعب من الغاز المشتعل لاستخدامه في محطات الطاقة، مما يوفر 5.2 مليار
دولار ويلغي الحاجة للاستيراد من إيران؟ أم أن ذلك هو بالضبط ما يجب أن
يحدث؟
في سردية أسباب انقطاع الكهرباء، على الرغم من صرف ما يزيد على 50
مليار دولار منذ احتلال البلد، تبرر التصريحات الرسمية، العراقية
والبريطانية والامريكية، فضلا عن التقارير ذات الاختصاص، الانقطاع بأنه
ناتج عن أسباب تقنية عدة يعود بعضها الى تسعينيات القرن الماضي، ومن ثم
التخريب الذي لحق البلاد جراء الغزو الأمريكي البريطاني أولا ثم تنظيم
الدولة الاسلامية ثانيا. ومن بين الأسباب التي يُشار اليها، غالبا، هو
زيادة عدد السكان، واستخدام المكيفات وزيادة الاستهلاك وعدم دفع قوائم
الكهرباء والغاز. وهي أسباب، تشير الى واقع سياسي واقتصادي متدهور، بكل
المستويات، يتطلب حلولا آنية سريعة واستراتيجية، لضمان المحافظة على
حياة وكرامة المواطن وليس توجيه اللوم اليه. ولن يتحقق هذا ما لم تتوفر
الإرادة السياسية المستقلة للحكومة، وتمتع البلد بالسيادة، وتنظيفه من
فيروس الفساد.
تحويل أموال الفساد والتهريب من بلدان العالم المضطربة، الغنية منها والفقيرة، ينتهي في بورصات وبنوك وعقارات بلدان حروب التدخل والغزو
إذ يبقى السبب الرئيسي لعدم تنفيذ أي من المشاريع هو الفساد، كعملة
صعبة، سارية المفعول، في حقل التزود بالكهرباء وعلى مستويين، بواسطة
الاحتيال في العقود الحكومية مع جهات خارجية من جهة ومافيا المّولدات
على المستوى المحلي من جهة أخرى.
محليا، تتحكم مافيا المّولدات، بكل ما له علاقة بالكهرباء من تكلفة
وتوزيع، وللسياسيين والميليشيات حصص فيها. لذلك لايزال معدل تلبية
حاجات الفرد من الكهرباء واحدا من أدنى المعدلات في الشرق الأوسط.
أما العقود الخارجية، فان في تقرير حديث لتشاتام هاوس، بعنوان «الفساد
المقبول سياسياً وعوائق الإصلاح في العراق» أمثلة عن الاحتيال في
العقود الحكومية عن طريق استخدام شركات صورية. أحدها «العقد الذي وقعته
وزارة الكهرباء العراقية مع شركة «باور أنجنز» البريطانية، لبناء 29
محطة كهرباء، في مدينة الناصرية، جنوب العراق. وقد دفعت الحكومة مبلغ
العقد وقدره 21 مليون دولار لتجد أن الشركة مزورة. ومع ذلك لم تقم
الحكومة بفصل أو معاقبة المتورطين في صياغة العقد أو رفع دعوى قضائية.
وكشفت وثيقة رسمية أخرى عن خسارة 8 ملايين دولار من المديرية العامة
لإنتاج الطاقة الشمالية».
ومن يتابع مقابلات الساسة العراقيين التلفزيونية، سيجد أن اتهامات
الفساد المتبادلة حول العقود الخارجية، مع عديد البلدان، تكاد تكون
خيالية، ومع ذلك تمر بلا محاسبة.
ولايقتصر إفلات العراقيين الفاسدين من المحاسبة والعقاب على داخل
العراق لوحده، بل يمتد إلى بريطانيا وأمريكا إذا كان المسؤول الفاسد من
حملة جنسية أحد البلدين أو حاصلا على الاقامة الخاصة برجال الاعمال.
وباستثناء نوفل حمادي السلطان، محافظ نينوى السابق، الذي فرضت عليه
الحكومة البريطانية العقوبات، في الشهر الماضي، لأنه «حّول الأموال
العامة المخصصة لجهود إعادة الإعمار، ومنح العقود وغيرها من ممتلكات
الدولة، بشكل غير صحيح الى بريطانيا» فان «رجال الأعمال» العراقيين
يجدون في بريطانيا وأمريكا ملاذا آمنا إلى حد كبير. ولم لا وقد تم
تهريب 150 مليار دولار من أموال النفط العراقي في صفقات فاسدة منذ
غزوه؟ وهل هناك من هو أكثر احتضانا لهذه الأموال من الغزاة؟ مما يعني
أن تحويل أموال الفساد والتهريب من بلدان العالم المضطربة، الغنية منها
والفقيرة، ينتهي في بورصات وبنوك وعقارات بلدان حروب التدخل والغزو،
مؤشرا إلى أن العالم يعيش مرحلة جديدة من النهب الامبريالي، غير
المباشر، بامتياز. حيث تتنصل هذه الدول من تكلفة الاحتلال أو ضرورات
تأهيل أنظمة تابعة مستقرة، مستبدلة إياها باستمرار الفوضى والتمزق
والنهب، من قبل أنظمة محلية فاسدة، ليست تحت مسؤليتها العسكرية
المباشرة، مع ضمان انتهاء ما يُنهب إلى «الملاذ الاقتصادي الآمن».
كاتبة من العراق
انسحاب القوات الأمريكية
من العراق وتقطيع الأذن
هيفاء زنكنة
« نقول إن العراقيين يستحقون حياة أفضل، ولدينا خيرات نريد أن ينعم بها
أبناء شعبنا، إلا أن الصراع السياسي يكبّل أي تقدم». لنفترض ان هذا
التصريح قد تم تقديمه في برنامج حزورات، يتساءل فيه مقدم البرنامج: «من
قال هذا ؟» وهل هو رئيس اتحاد طلبة أو رئيسة منظمة مجتمع مدني أو مديرة
جمعية خيرية، ما الذي سيكون عليه الجواب؟
هل سيتبادر إلى أذهان المتسابقين وجمهور البرنامج أن قائل التصريح
المتباكي الذي يلقي اللوم في بؤس حياة العراقيين على «الصراع السياسي»
هو رئيس وزراء العراق الذي يُعدّ، وفق شروط وظيفته، وحسب الدستور، وبكل
المعايير، المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للحكومة والقائد
العام للقوات المسلحة العراقية ؟ مما يعني انه المسؤول الأول عن الوضع
العام في البلد، بكافة مستوياته الاقتصادية والصحية والتعليمية ناهيك
عن الامنية والعسكرية. وهل هناك حاجة الى تذكيره بأنه مسؤول عن تنظيم
عمل الوزارات بما يتماشى والوضع العام من اجل وضع الحلول المناسبة وحل
القضايا العالقة؟ وهل هناك ما هو أكثر الحاحا من القضايا ذات العلاقة
باستمرار الحياة، بشكل طبيعي، ووضع حد لسقوط الضحايا المتزايد إغتيالا،
كما مئات المتظاهرين والناشطين، وحرقا كما في مستشفيات المصابين
بالكورونا، وتفجيرا كما في ضحايا مدينة الصدر، ببغداد، أخيرا؟ وكيف
انتهى العراق برئيس وزراء إما لا يعرف معنى مسؤوليته الوظيفية، ويعتقد
إنها تقتصر على زيارة أهالي الضحايا والتقاط الصور مع أطفالهم، أو يعرف
تماما حجم المسؤولية إلا أنه يتجاهلها، لأنه عاجز عن القيام بها أو
لأنه يستهين بالعراقيين ويجد انهم يستحقون الموت؟
واذا ما نظرنا الى صورة العراق الأكبر وعلاقته بقوات الاحتلال والعالم،
المتشابكة والمتغلغلة بمآسي الحياة اليومية، كيف انتهى العراق برئيس
وزراء، يتعامل مع الأحداث وكأنه رئيس منظمة غير حكومية، ومع ذلك سيفاوض
باسم العراق حول واحدة من أهم الاتفاقيات، وهي الاتفاقية الاستراتيجية
وانسحاب قوات الاحتلال الأمريكي، مما يستدعي المقارنة النوعية مع
شخصيات الوفد الفيتنامي المفاوض للغزاة الأمريكان والجزائري المفاوض
للمستعمر الفرنسي، في ظل الغموض المحيط بتفاصيل الأتفاقية ولا سياسة
حكومة مصطفى الكاظمي.
أعلن الكاظمي أن مهمته هي مناقشة جدولة انسحاب القوات الأمريكية
القتالية ( التعبير الرسمي لقوات الاحتلال) من العراق، إذ لايزال هناك
2500 جندي أمريكي في البلد. والتفاوض حول انسحاب أية قوات أحتلال هو
موقف وطني لا خلاف عليه. باستثناء ان واقع الحال، مغاير تماما، كما تدل
تصريحات الكاظمي ووزير خارجيته المتناقضة مع بيانات قادة الميليشيات
والعشائر وتصريحات مسؤولي الادارة الأمريكية، مما يثير الشكوك
والألتباس حول أبسط المفاهيم كالوطنية والاحتلال والمصالح المشتركة
بالاضافة الى حقيقة ما يتم الاتفاق عليه.
تحت مسمى الشراكة «الناعم» سيبقى، اذن، الوضع كما هو تقريبا، إلى أجل غير مسمى، تحت الوصاية الأمريكية الإيرانية، مع تعديلات في نسب ومجالات المشاركة والصراع
فمن جهة أكد وزير الخارجية فؤاد حسين أن القوات الأمنيّة ما تزال في
حاجة إلى البرامج التي تقدمها أمريكا في مجالات التدريب، والتسليح،
والتجهيز، وتقديم المشورة في المجال الاستخباري، وبناء القدرات، وأهمية
ديمومة الجهود الأمريكية العسكرية لمحاربة الأرهاب. وأن العراق يجدد
تأكيده والتزامه بتعزيز شراكته الاستراتيجية مع الولايات المتحدة
الأمريكية بوصفها شريكاً أساسياً في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم
داعش. وشكر أمريكا لدعمها إجراءات مُراقبة الانتخابات المقبلة وضمان
نزاهتها، موضحا بأنه، بالاضافة الى ذلك كله، قد تم إبرام العديد من
مُذكرات التفاهم في قطاعات مُتعددة من بينها الاقتصادية والصحية ومجال
الطاقة والاستثمار فضلا عن السياسة الأقليمية. كرر فؤاد حسين في
تصريحاته ومقابلاته أن اتفاقية الإطار الاستراتيجي مبنية على « العمل
المشترك» بين البلدين.
ولكن بدون ان يتطرق الى تفاصيل الفائدة التي سيجنيها « الشريك»
الأمريكي. بل ترك التفاصيل مغيبة ساردا بتفصيل كبير ما سيجنيه العراق،
مستبعدا واقع الهيمنة الكلية الممنوحة لأمريكا بكافة النواحي. مما يوحي
وكأن ما يحصل عليه العراق هبة مجانية من قبل جمعية احسان تدعى الولايات
المتحدة وليس، كما هو معروف تاريخيا، تعزيز لعنصرية المحتل وسيطرته
وأخطرها رعاية التفرقة وتشجيع التمايز في المظلومية والظهور بمظهر حامي
حقوق الانسان وبناء الديمقراطية.
اذا كان الكاظمي، يحاول استغلال مشاعر الميليشيات المدعومة إيرانيا،
الأقوى من القوات الأمنية والجيش، والتي هددته احدى فصائلها بان «الوقت
مناسب جدا لتقطيع أذنيه كما تقطع آذان الماعز» فان لمحاولته حدودا لا
يستطيع تجاوزها. إذ ان الادارة الأمريكية لن تتخلى بسهولة عن بلد لديه
ثاني أكبر احتياطي نفط في العالم، ويمكن الوصول إليه بسهولة، ويقع في
المنطقة الرئيسية المنتجة للطاقة في العالم، وحلبة للمساومة مع إيران
بصدد السلاح النووي. وكما نّوه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن،
في مؤتمر صحافي، إن الشراكة مع العراق أكبر بكثير من الحرب ضد داعش.
تحت مسمى الشراكة «الناعم» سيبقى، اذن، الوضع كما هو تقريبا، إلى أجل
غير مسمى، تحت الوصاية الأمريكية الإيرانية، مع تعديلات في نسب ومجالات
المشاركة والصراع كما هو حاصل منذ احتلال العراق عام 2003. وسيواصل
المسؤولون الأمريكيون والعراقيون اطلاق التصريحات عن تحول دور القوات
الأمريكية من العسكري القتالي إلى الاستشاري، وهو عمليا ما تقوم به،
حاليا، باستثناء القصف الجوي واستخدام الدرونز، الذي يدار كله من قواعد
موجودة خارج العراق ولن يطرأ تغيير عليه وعلى دور قوات الناتو. وكل ما
سيحدث هو التلاعب ببعض المفردات لأغراض اعلامية. بينما ستبقى الحقيقة
مُغَيبة باتفاق الطرفين الأمريكي والحكومي العراقي على طمس مسؤولية
أمريكا في غزو العراق الذي يشكل جريمة حرب، إذ لم يكن الغزو دفاعًا عن
النفس ضد هجوم مسلح، ولم يقره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي
يجيز استخدام القوة من قبل الدول الأعضاء، وفقًا للجنة الحقوقيين
الدولية في جنيف. مما يجعل توقيع أي مادة ضمن الاتفاقية الاستراتيجية
شرعنة لجريمة الحرب وتمديدا لهيمنة المحتل والغاء لحق الشعب العراقي في
اي تعويض قد يطالب به جراء الغزو والتخريب وخسارة الحياة الإنسانية.
وكل هذا بموافقة حكومة تدّعي الوطنية.
كاتبة من العراق
تشييع الإمام التاسع
في بغداد في ظل كوفيد 19
هيفاء زنكنة *
مشهد آخر يضاف إلى غرائبية الوضع العام في العراق. يشي المشهد،
بتفاصيله، بالأزمة العميقة ألتي يعيشها البلد على إختلاف المستويات
الدينية والسياسية والاقتصادية، وما يتمخض عنها من تشكيل للوعي
المجتمعي.
ضمن هذه التشكيلة المشهدية إحتشد آلاف الرجال، يوم السبت الماضي،
العاشر من تموز/ يوليو، في بغداد. أجسادهم تكاد تلتصق لفرط الزحام
والتدافع، وجوههم مبللة بالدموع، وهم يحملون تابوتا خشبيا ضخما مغطى
براية خضراء، متجهين نحو صحن الكاظمية ( شمال بغداد) في تشييع رمزي
للأمام محمد الجواد، التاسع من أئمة الشيعة الإثني عشرية، والحادي عشر
من المعصومين الأربعة عشر، في ذكرى استشهاده. المعروف أن الإمام الجواد
كان قد تولى الإمامة بعد أستشهاد أبيه علي الرضا وعمره إما سبعة أو
ثمانية أعوام. وقد أدى صغر سنه إلى الاختلاف في مدى أحقيته بالإمامة
حينذاك. استشهد الإمام الجواد ببغداد، وعمره 25 عاما، ودُفن في
الكاظمية. وتشير الرواية الشيعية الى أن زوجته أم الفضل، ابنة الخليفة
المأمون، دست له السم بتأثير من أخيها المعتصم، بعد توليه الخلافة
أثناء الدولة العباسية.
تحفل أيام العراق، منذ احتلاله عام 2003، بعديد المناسبات الدينية،
الحافلة بالطقوس الجماعية، بعد رفع الحظر عنها. لا شك في أن للطقوس،
بأشكالها، من الدينية الى المناسباتية كالولادة والزواج والموت الى
حضور مباراة لكرة القدم، ومعظمها تعود بداياته الى الطقوس الدينية،
أهمية بالغة، في حياة الأفراد والشعوب. فمن خلالها يؤكد الفرد انتماءه
الجماعي و«نقاء» أو مصداقية رحلته الحياتية حتى اللحظة، وإعادة التأكيد
على أن المسار الذي يسلكه هو الطريق الصحيح، كما تربطه بالأجداد
والتراث، وتمكنه من التواصل مع هويته وتقويتها.
من هذا المنطلق، يمكن إعتبار هذه المسيرة واحدة من الطقوس العادية ألتي
يختار أبناء شعب ما ممارستها. إلا أن الواقع الحالي، الاستثنائي، في
العراق، يضع هذه المسيرة خارج حدود «العادي المألوف «. لتثير عديد
التساؤلات حول توقيتها، وكيفية الإعداد لها، بالإضافة إلى أهميتها
والموقف الحكومي الرسمي منها.
من ناحية التوقيت تم تنظيم المسيرة الحاشدة والبلد يعيش كارثة إنتشار
وباء الكوفيد، التي جعلته يحتل المكانة الاولى في قائمة الدول العربية،
بأعداد المصابين والموتى. ومن أوليات الإجراءات التي يجب اتخاذها
للوقاية من الوباء هو التلقيح والتباعد الاجتماعي وإعلان الحظر العام
عند الضرورة. وهذا ما كان يجب إجراؤه للمحافظة على حياة الناس والتعافي
من الوباء. الا أن ما حدث هو العكس تماما إذ تم تنظيم المسيرة ( وهي
واحدة من عدة) في وقت لا يزال فيه التطعيم دون المستوى المطلوب بكثير.
وإذا كان ما يميز الشعب هو قلة الوعي، وغسل الدماغ، كما يُشاع، فماهو
الدور الحكومي والمراجع الدينية في هذه الحالة؟
بدلا من شن حملة توعية بمخاطر التجمعات، سبقت المسيرة حملة تحشيد منظمة
لحث «الموالين» على المساهمة بل وإقناعهم بوجوب الحضور لتجديد « عهدهم
للأمام «، لكي يضمن لهم الثواب و«الأجر». ساهم في الحملة سياسيون ورجال
دين، ومراكز ومجمعات دينية، وأمناء مجالس العزاء. أُعدّوا خلالها
«منهاجاً خاصاً وحافلاً بالنشاطات الدينية.
إن حماية حياة أبناء الشعب، من جميع المخاطر، مسؤولية الحكومة، بالدرجة الأولى، وعليها إيجاد أفضل الطرق وصيغ التعاون مع رجال الدين والمنظمات الدينية لمنع التجمعات الحاشدة
ويشمل إقامة مجالس العزاء الحسيني في رحاب الصحن الكاظمي الشريف على
مدى خمسة أيام بالاضافة الى مشاركة الرواديد الحسينيين «. والرادود هو
الحكواتي الشيعي، المتمرس في تقديم سردية البطولة والشهادة، بلغة يزداد
سحرها بتوظيف المخيلة، لإعادة تمثيل رمزيتها، بأسلوب يستدر التعاطف
والتماهي، إلى حد البكاء واللطم على الإمام الشهيد ومأساته. تُخرج هذه
الطقوس المشارك فيها من واقعه اليومي، ليكون خارج عالم المكان والزمان
العاديين. ويزداد إقترابا من الأئمة وما يحيطهم من قدسية، خاصة إذا كان
واقعه بائسا (اقتصاديا ومجتمعيا) كحال الشريحة الأكبر من الهامشيين
والمسحوقين في العراق، وهو بأمس الحاجة إلى الارتقاء بواقعه، كما
الحالم بالفردوس.
لاضرر في ممارسة الطقوس، عموما، في الظروف العادية للبلد، بل ويتطلع
الناس للمشاركة فيها، كما يحدث في أرجاء العالم، وتتحول بمرور الزمن
إلى احتفالات رمزية تجمعهم، وهو ما وصل العراق اليه، في خمسينيات القرن
الماضي، مع أيام عاشوراء. فاصبحت فضاء مشتركا للاحتفاء بالذاكرة
الجماعية وإبداع المخيلة في أعمال تجمع بين المسرح والطقوس، ولا تٌستغل
لأغراض سياسية واقتصادية وعنصرية.
ان التناول المتوازن للروايات التي تستند عليها الطقوس القديمة، في
خلفية الاحتفالات، جزء من التطور الثقافي التدريجي للأمم. فلا بد من
تمييز التاريخ عن الأسطورة والتزييف المتعمد، وخصوصا ما يمنع تشكل
التكوين النفسي المشترك للشعب، وأخطرها تجريم حقب كاملة من تاريخه، كما
يحدث مع الخلافة العباسية اليوم، مثلا، واسقاطها على الحاضر، بشعبوية
سياسية، هدفها تأجيج العواطف.
لا يمكن، اذن، انكار أهمية الطقوس الدينية الشعبية حتى مع انتشار
الوباء، ما لم يتم من خلالها إيهام المشاركين بأن زيارة المراقد
الدينية والمساهمة في مسيرات طقوسية حاشدة، ستزودهم بالمناعة ضد الوباء
فلا حاجة للتباعد الاجتماعي واللقاح.
إن حماية حياة أبناء الشعب، من جميع المخاطر، مسؤولية الحكومة، بالدرجة
الأولى، وعليها إيجاد أفضل الطرق وصيغ التعاون مع رجال الدين والمنظمات
الدينية لمنع التجمعات الحاشدة، مهما كانت قدسية المناسبة. وهذا ما
فعلته الحكومات والمؤسسات الدينية، في جميع أرجاء العالم. فأغلقت أماكن
العبادة وألغت الشعائر الدينية وحددت التجمعات العامة. وقدمت الكنائس
المسيحية، والكُنُس اليهودية، والمساجد، والمعابد، الشعائر الدينية عبر
البث المباشر أثناء الجائحة. كما ألغت المساجد صلاة الجمعة. وتم إلغاء
احتفالات رأس السنة البوذية، التي غالبا ما تجمع الآلاف من الناس معا،
ليمارسوا طقوسهم في جميع أنحاء جنوب آسيا. بل وأصدرت الحكومات قرارات
تقضي بمنع تشييع الموتى واتمام الدفن بحضور شخصين فقط.
وإذا كان من المفترض أن تقوم الحكومة أما بمنع مسيرة التشييع أو
تأجيلها، حماية للأرواح، وباعتبار إن الإمام الجواد قد استشهد قبل 1186
عاما، ولن يضر الانتظار عاما آخر، إلا أن أيا من ساسة الحكومة لم يتجرأ
على إتخاذ قرار كهذا، ليس إيمانا بضرورة تشييع الإمام الجواد، ولكن
خشية اتخاذ قرار قد يمس مصالحهم إذا ما تعرضوا، باي شكل من الاشكال،
للمؤسسة الدينية وأتباعها، والبلد مقبل على الانتخابات، فالحصول على
مقعد، في انتخابات أكتوبر المقبلة، بالنسبة إلى ساسة عراق اليوم، أعلى
قيمة من حياة الإنسان.
كاتبة وصحفية وناشطة عراقية تقيم في بريطانيا
تكتب اسبوعيا في جريدة (القدس العربي)
العراق يضحك… القيظ من
ورائكم والكورونا من أمامكم
هيفاء زنكنة
أيام العراق حافلة بانجازات بلا حدود. آخرها فوزه بالمركز الأول،
عربيا، بانتشار فيروس كورونا. فبينما أظهر إحصاء لوكالة «رويترز» أن
أكثر من 183 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى
العالم، وأن عدد الوفيات تجاوز الأربعة ملايين، سجل العراق رقمه
القياسي بين الدول العربية: 17256 وفاة وأكثر من مليون وربع المليون
إصابة. وتشير الزيادة في عدد الإصابات، بين فئة الشباب، وارتفاع عدد
الراقدين بردهات العناية المركزة في المستشفيات، إلى وصول متحورة
«دلتا» إلى البلاد.
وإذا كانت حالات الإصابة والوفيات هي التي تحتل الصدارة، بلغة
الاحصائيات المجردة، للدلالة على وضع آني فإن إنعكاسات الجائحة، الآنية
منها وبعيدة المدى، وامتدادها بشكل سريع، يضيف إلى الوضع العام
الكارثي، «بيئة مثالية» لتفشي أمراض من نوع آخر. أمراض بالإمكان
معالجتها لو توفرت الإرادة السياسية الوطنية وتم تعقيم البلد من
ميكروبات الفساد. فالعراق بلد يتمتع بثروة لا تتوفر للدول العربية
الأخرى التي تليه في قائمة الإصابة بالفيروس مثل الأردن ولبنان
والمغرب. شبح الفقر بعيد إذن والتحجج بقلة الموارد المادية أكذوبة
مفضوحة. خاصة وإن تعافي أسعار النفط، عالميا، عزز الإيرادات من مبيعات
النفط في شهر حزيران/ يونيو لتتجاوز ستة مليارات دولار للشهر.
إلا أن هذه الثروة سرعان ما تُصبح سرابا، عند الحديث عن مقايضتها
بتوفيرالخدمات للمواطنين. وهنا تأتي انعكاسات إنتشار الكورونا
المضاعفة، الممتدة أبعد من الحاضر، حين تتزاوج مع التدهور الكلي إلى
الحضيض، منذ غزو البلد عام 2003، وتسليم السلطة إلى عراقيين يحكمون
بالنيابة.
من ناحية توفير اللقاح وتوزيعه، يأتي العراق في مستوى متدن للغاية. إذ
لم يتلق اللقاح بجرعتيه، حتى الآن، غير أربعة بالمئة من المواطنين
(مقارنة بدول تقترب من 70 بالمئة من البالغين كتشيلي). مما يعني، إذا
ما استمر الوضع على هذا الحال، ستصل نسبة 70 بالمئة من مجموع أربعين
مليون من السكان عام 2075.
ويعيش المهجرون والنازحون قسريا (من العراقيين والسوريين ومن بلدان
أخرى) البالغ عددهم ستة ملايين ونصف، حسب المفوضية السامية لشؤون
اللاجئين في شهر حزيران، مأساة مضاعفة. إذ يعانون من عدم القدرة على
العمل وكسب العيش بسبب القيود المفروضة على الحركة. مما يعرضهم لقبول
أي عمل كان مهما كانت نتائجه، ومعاناة الأكثرية من الصدمات النفسية،
والتوتر والقلق، ووقف الأنشطة التعليمية، وتصاعد العنف المنزلي،
والاستغلال الجنسي. وقد دفع الاستغلال الجنسي المفوضية إلى إضافة
تحذير، بالخط العريض، عند التسجيل للحصول على اللقاح، يبين إنه في حال
طلب أي موظف يتبع لجهات فاعلة في العمل الإنساني الاغاثي أو التنموي ـ
بما في ذلك وكالات وبعثات الأمم المتحدة أو المنظمات غير الحكومية
الوطنية أو الدولية بأي خدمة أو نشاط جنسي مقابل الوعد بتوفير لقاح
جائحة كوفيد 19، فإن ذلك يعد ارتكابا لجريمتي الاستغلال والانتهاك
الجنسيين.
حققت الحكومات العراقية المتعاقبة نجاحا مذهلا في تلاشي الثقة، حتى بين مؤيديها، جراء إطلاق الوعود الكاذبة، والقرارات التخديرية، وسياسة التزييف المنهجية
من الجانب الحكومي، تُلقي معظم التصريحات مسؤولية انتشار الوباء على
قلة وعي المواطنين، وخوفهم من اللقاح وتجاهلهم الإجراءات الحكومية. إلا
أنها قلما تتطرق إلى الأسباب الحقيقية وأهمها انعدام الثقة، عموما،
بالإجراءات الحكومية، أيا كانت. فمن المعروف إن التحدي الذي تواجهه
الحكومات ( حتى الديمقراطية فعلا) لا يقتصر فقط على معرفة السياسات
التي يختارونها، ولكن أيضًا في كيفية تنفيذ السياسات، وتعتمد القدرة
على التنفيذ بشكل رئيسي على الثقة. بدونها لا أمل في تطبيق أي اجراء
حكومي ولو كان لصالح الناس أنفسهم. وقد حققت الحكومات العراقية
المتعاقبة نجاحا مذهلا في تلاشي الثقة، حتى بين مؤيديها، جراء إطلاق
الوعود الكاذبة، والقرارات التخديرية، وسياسة التزييف المنهجية المبنية
على الاستهانة بعقول الناس، فضلا عن اللجوء الى العنف بأشكاله.
وإذا كان التعامل مع الوباء مشكلة عالمية، فإن انقطاع التيار الكهربائي
يشكل نموذجا متميزا يُحسب للحكومة العراقية دون غيرها. تجثم المشكلة،
القابلة للحل، بثقلها على صدور الناس فتمنعهم من التنفس، وأحيانا الموت
من شدة الحرارة، بعد مرور 18 عاما على إطلاق الوعود بالأطنان عن تحسين
الوضع. وهناك من الدلائل العلمية ما يؤكد إن عدم توفير الكهرباء وتعريض
حياة المواطن للخطر القاتل هو جريمة بحد ذاتها، في بلد ترتفع فيه درجة
الحرارة، على مدى ثلاثة شهور كل عام، إلى ما يزيد على الخمسين درجة
مئوية. حيث يؤكد العلماء أن درجة حرارة الجسم التي من المفترض ثباتها،
ترتفع إذا كانت درجة الحرارة الخارجية مرتفعة للغاية. فيصاب المرء
أولاً بالإرهاق الحراري، الذي يتسم بالصداع والغثيان أو الدوار إلى أن
يصل نقطة تحول تختلف باختلاف الاشخاص، لكنها تدور حول 42 درجة مئوية إذ
يتوقف جدوى التعرق ويمكن أن ترتفع درجة حرارة الجسم، لتصل أحيانا فوق
44 درجة مئوية. مما يسبب الوفاة. ويتضاعف الخطر في محافظة البصرة
وحواليها باضافة درجة الرطوبة العالية التي توقف التعرق في منطقة
الخليج العربي.
تتجاهل الحكومة هذه الحقائق الواضحة، بدون أن تتخذ أي إجراء فعال،
لانقاذ حياة الناس، بل تكتفي باطلاق التصريحات وبعض الإجراءات
الترقيعية. ولعل أكثرها إهانة للمواطنين هو الإعلان المبتذل عن تشكيل
لجان التحقيق. على هذا المنوال شكل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لجنة
«لفتح تحقيق في حالات التقصير والإهمال في بعض مفاصل وزارة الكهرباء».
ونشر تغريدة عن «التحقيق لمعرفة اسباب الانقطاع بالمنظومة الكهربائية
للوصول إلى اجابات عن حقيقة ما حصل. هل سببه خلل فني أم عمل إرهابي أم
سياسي». وكأن المشكلة طارئة والصيف يحل بالعراق للمرة الأولى، مما
يستدعي تشكيل لجنة حكومية للتحقيق في الاسباب، وكأن انتفاضة تشرين /
أكتوبر 2019، التي راح ضحيتها مئات المحتجين وجرح مئات الآلاف، حدثت في
بلد آخر غير العراق. ولأن كثرة الهم والأسى تدفع الناس إلى السخرية
وتبادل النكات دفعا للجنون، كثرت النكات حول الكورونا وانقطاع الكهرباء
إلا أن مواقع التواصل الاجتماعي شهدت في الايام الأخيرة إضافة نوعية،
برزت مع لجوء الكاظمي الى اطلاق التغريدات تشبها بالرئيس الأمريكي
السابق دونالد ترامب. الاضافة الجديدة هي الاكتفاء بتوزيع التغريدات
الغرائبية بلا تعليق. فهل تحتاج تغريدة مثل «العراق مستعد لتعزيز
التعاون مع إيطاليا، في مجال التدريب وتطوير العمل في مكافحة الفساد
وغسيل الأموال والجريمة المنظمة والمافيات» لأي تعليق لاثارة الضحك؟
كاتبة من العراق
مبادرة جمعيات
أمهات الضحايا في العراق
هيفاء زنكنة
داخل خيمة صغيرة، في مدينة توسم بالقدسية، اعتصمت أمرأة نحيفة، منهكة
الملامح، مجللة بالسواد، تتجمع دموعها في قلبها غضبا ينذر بالانفجار.
انفجار أم عراقية ثكلى بابنها.
اسم المرأة المعتصمة هو سميرة. ينادونها أم ايهاب، تكريما للآصرة
الأبدية بين الأم والابن/ البنت، في عراق يحترم الأم ويكاد يقدسها.
أزالت القوات الأمنية الخيمة، عدة مرات، لأنها باتت مزارا للمطالبين
بمعرفة قتل المتظاهرين. صارت أم ايهاب وخيمتها، تجسيدا حيا لشعار «من
قتلني» الذي يستمر المحتجون، في عدة مدن، برفعه بصوت واحد لستمائة
قتيل، تخضبت أيدي مسؤولي الحكومة بدمائهم، منذ انطلاق انتفاضة تشرين /
اكتوبر 2019.
ولايزال المحتجون يتساقطون بينما يتمتع القتلة بالحماية والتكريم. حيث
بات كتم الأصوات، اغتيالا، نسغا يمد الميليشيات وأحزابها بمواصلة
البقاء والهيمنة. وهذا هو أحد أسباب أغتيال ايهاب الوزني، رئيس تنسيقية
الاحتجاجات في كربلاء، جنوب بغداد، من الأصوات المناهضة للفساد وسوء
الإدارة، المطالب بوطن يُحترم فيه المواطن ولا يهان، بوطن لا تتنعم فيه
فئة لصوص ومجرمين على حساب أبناء الشعب، والحد من نفوذ الميليشيات.
صورت كاميرات مراقبة قريبة من منزله لحظة اغتياله، في 9 مايو، كما وثقت
أشرطة فيديو عمليات اغتيال ناشطين غيره من قبله. ووعدت القوات الأمنية
بمحاسبة القتلة، كما وعدت سابقا، وكما وعد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي
شخصيا، لتبقى الجريمة بلا محاسبة، مسجلة ضد مسلحين مجهولين. وإذا كان
رئيس الوزراء قد نجح سابقا في طمر الجرائم تحت غطاء وعوده وزيارته لذوي
الضحايا، واحتضانه أطفال الضحايا أمام عدسات الكاميرات، واستنكار
الجرائم خطابيا، كأنه مسؤول منظمة غير حكومية، وكأن القتلة نزلوا من
المريخ، فان مثابرة أم ايهاب على المطالبة بمحاسبة قتلة ابنها، وفق
القانون، وعدم رضوخها للضغوط والتهديدات، والقبول بالوعود المعسولة،
وزيارة ممثلة الأمم المتحدة جينين هينيس بلاسخارت، يوم الخميس الماضي،
يشير الى أن جسد الامبراطور، وليست ملابسه الوهمية فقط، قد تهرأ.
إن موقف أم ايهاب على المستوى العام هو استمرار للحركة الاحتجاجية
ومشاركة النساء منذ احتلال العراق عام 2003. نساء العراق اللواتي يقفن
أمام المعتقلات والدوائر الأمنية بحثا عن أحبائهن المختفين قسرا
والمفقودين، مطالبات بحقوقهن كأمهات وزوجات، منذ عقود. يقفن أيام البرد
والحر القائظ انتظارا. فقد يعطف عليهن شرطي أو رجل أمن « شريف» فيهمس
لهن بخبر ما يمنحهن الأمل بوجود أحبتهن في أحد المعتقلات أو حتى
امكانية العثور على جثة في ثلاجة إحدى المستشفيات. لتبدأ رحلة من نوع
آخر. رحلة تقتضي، إذا كان الشخص حيا، ارضاء المرتشين والمبتزين وتحمل
إهانات وتهديدات الشرطة وقوات الأمن. وبيع ما يملكن (الجسد أحيانا)
لإشباع جشع المجرمين من دعاة حماية الأمن.
استنادا الى تجارب مماثلة في المغرب والجزائر وكولومبيا والمكسيك وتشيلي، من المفيد لأية مبادرة على غرار جمعيات العوائل التعاون مع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، لتحقيق رؤية أوضح واكتساب مصداقية أكبر
أما على المستوى الشخصي، فان موقف أم ايهاب انعكاس لموقف ابنها الذي
أقسم حين قيل له إن أعداد المتظاهرين بدأت بالتناقص مع ازدياد حملة
الاغتيالات، بأنه سيواصل التظاهر وحده، في بلد الحكومة فيه ظل شاحب
لميليشيات تستعرض أسلحتها وقوتها حيثما وأينما شاءت في قلب البلد في
العاصمة. وكأنه رسم بذلك مسار حياة أمه بعد اغتياله، أن تعيش حياته.
لتعكس بذلك الصورة المتعارف عليها: أن يحمل الأبناء عبء مواصلة طريق
الآباء ونقل الإرث من جيل إلى جيل.
وكما اجتمع عدد من الأمهات في ساحة مايو، أمام قصر الرئاسة في وسط
بوينس آيرس، عاصمة الأرجنتين، للمطالبة بمعلومات عن مكان وجود أبنائهن
المختفين، في ظل النظام القمعي وما سمي «الحرب القذرة» عام 1977، وازاء
ازدياد الضغوط الأمنية ومنعها من مواصلة الاعتصام أمام مقر القضاء في
مدينتها، دعت أم إيهاب عوائل ضحايا الاحتجاج، خاصة النساء، من أمهات
وشقيقات وزوجات، الى مشاركتها الاعتصام. ولبى الدعوة عدد من النساء في
محافظات ذي قار وبابل وبغداد. مما يشكل نقطة تحول نوعية أبعد من
المطالبة الفردية. فهل بتنا نشهد بذرة إنشاء جمعية أو جمعيات عائلات
الضحايا، كما في عديد البلدان المحتلة أو الخاضعة لنظام قمعي، أو تعيش
مرحلة العدالة الانتقالية ما بعد انتهاء النزاع او الحرب؟ جمعيات،
غالباً، ما يتم تأسيسها من قبل أقارب اشخاص أغتيلوا أو اختفوا خلال
بحثهم عن أحبائهم. فبسبب تجاهل المطالب الفردية للعائلات من قبل
السلطات، يتكاتف الأهالي معاً للبحث عن أحبائهم وللتحرك من أجل قضيتهم
أو محاسبة الجناة.
بالإضافة الى العمل على تشكيل شبكة وطنية للتوعية بخصوص حقوق الضحايا
على الصعيدين الوطني والدولي والدفاع عن حقوق عائلات الضحايا في
الحقيقة والعدالة. هل من الممكن تأسيس جمعيات كهذه في ظل حكومة تديرها،
عمليا، ميليشيات مسلحة مسؤولة عن جرائم قتل وتهديد واختطاف موثقة محليا
ودوليا؟ كيف يضمن أفراد الجمعيات سلامتهم وقد عاشوا أنفسهم مأساة
اغتيال احبائهم، ومسؤولي الحكومة الذين يفترض اللجوء اليهم لتحقيق
العدالة هم أما طرف فعلي في الجرائم أو متفرجون صامتون؟
كيف يمكن لمجموعة نساء التغلب على مشاعر الخوف وهو من أكثر المشاعر
تجذرا في الطبيعة الإنسانية وهن يدركن أنه تحذير من خطر حقيقي يهدد
حياتهن؟ قد يكون تواجد الأمهات معًا، ووجود محتجين آخرين، مصدر قوة
لمواجهة العنف والقمع. عن الخوف تقول إحدى « أمهات ساحة مايو: «في كل
مرة وأنا في طريقي إلى الساحة كنت أشعر بالخوف مما قد يحدث، كنت أسمع
صوت قلبي وهو يخفق بشدة حتى يكاد أن ينخلع من مكانه، لكن ما أن أصل إلى
الساحة وأنضم للأخريات حتى يزول خوفي بل أزداد قوة وإصرارًا على مواصلة
النضال».
استنادا الى تجارب مماثلة في المغرب والجزائر وكولومبيا والمكسيك
وتشيلي، ومع مراعاة خصوصية وخطورة الوضع في العراق، من المفيد لأية
مبادرة على غرار جمعيات العوائل التعاون مع المنظمات الحقوقية المحلية
والدولية، لتحقيق رؤية أوضح واكتساب مصداقية أكبر، بالاضافة الى
التنسيق حول توثيق الجرائم والعمل على أعداد قاعدة بيانات، توضع على
شبكة الإنترنت، من قبل ناشطين مقيمين في الخارج وذلك لأنهم لا يتعرضون
للمخاطر الأمنية التي يتعرض لها الناشطون داخل البلد، آخذين بنظر
الاعتبار تجنب مطب انتقائية الضحايا والشهداء الذي يعمل وفقه النظام
الحالي، بل متابعة قضايا جميع أنواع الضحايا، مهما كانت خلفيتهم
القومية أو الدينية، سواء كانوا ضحايا الدولة أو الجماعات الإرهابية أو
الميليشيات بأنواعها. وأن يكون الهدف الأساسي هو تحقيق العدالة للجميع
والعمل على عدم تكرار الجرائم مستقبلا.
كاتبة من العراق
كيف أصبح العراق
جزءا من طريق البلقان؟
هيفاء زنكنة
بشكل شبه يومي تعلن الجهات الأمنية بالعراق عن القاء القبض على مهربي
ومتعاطي المخدرات، خاصة، في بغداد والبصرة جنوبا وديالى على الحدود
العراقية الايرانية. ففي يوم 20 حزيران/ يونيو ألقت قيادة عمليات بغداد
القبض على ستة متهمين بتعاطي المواد المخدرة وضبطت بحوزتهم مادة
الكرستال. وهو الاسم الشائع للميثامفيتامين، المنشط القوي والمسبب
للإدمان بسرعة. وفي يوم 19 حزيران تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات
والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على مهربين
للمخدرات بحوزتهما 10 كيلوغرامات من مادة الحشيشة في البصرة. كما أعلنت
وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، القبض على تاجر وناقل
للمواد المخدرة من إحدى دول الجوار في البصرة. نستخلص من إعلانات
القوات الأمنية أن هناك مشكلة متفاقمة يقومون برصدها ومحاولة القضاء
عليها، وأن المهربين والمتعاطين تتم معاملتهم بشكل متساو وأن لدول
الجوار دورا في انتشار هذه الآفة التي يتم التعامل معها كمشكلة «
أمنية».
تثير كيفية التعامل العديد من التساؤلات التي لم يتم الالتفات اليها
على الرغم من كثرة التقارير والتغطية الصحافية المحلية والدولية،
تساؤلات عن الجهات المستفيدة من زرع وانتشار هذه الآفة بالاضافة الى
أسباب سرعة انتشارها في بلد كان نظيفا تماما حتى غزوه عام 2003. وإذا
كان العراق معبرا لتمرير المخدرات، في السنوات الأولى من الاحتلال،
جراء غياب القانون وتفكيك الدولة، فكيف تطور ليصبح، بالاضافة الى ذلك،
الى مستهلك ومصّنع للمخدرات الكيمياوية؟
تشير البيانات في التقرير العلمي « تعاطي المخدرات والكحول في العراق:
نتائج مجموعة العمل لدراسة المجتمع العراقي» الصادر 2014، إلى أن
المواد الأكثر استخدامًا هي الكحول والحشيش والعقاقير الموصوفة. وتشمل
المخدرات الجديدة من نوع الأمفيتامين «كبتاغون» والكريستال
ميثامفيتامين، ومسكن الآلام ترامادول مع زيادة استخدام الأفيون
الأفغاني والترياك (شكل خام من الأفيون) والهيروين. مما يدل على زيادة
حجم الكارثة بمرور الوقت على الرغم من اعلانات القوات ألامنية عن
عملياتها الناجحة. فأين مكمن الخلل اذن؟
هناك أسباب عديدة لانتشار استهلاك وتجارة المخدرات من بينها أن مناطق
النزاع والحروب مفتوحة أكثر من غيرها لتجارة توازي في مردودها
الاقتصادي صناعة السلاح. واستشراء الفساد بين المسؤولين هو عمودها
الفقري. الملاحظ اهمال هذا الجانب عند التطرق الى الفساد المنهجي
المؤسساتي بالعراق، حيث يتم التركيز على الفساد الاقتصادي الشاسع في
مجال النفط، واذا ما أشير الى المخدرات فمن باب كونها مشكلة « مستوردة»
بدون ذكر المسؤولين عن استيرادها وكيفية محافظتهم على ديمومتها كأداة
للسيطرة على الشعب والتحكم بمستقبل البلد. وقلما ينظر اليها من زاوية
دور الاقتصاد غير المشروع في تأجيج الصراعات الطائفية والقومية
وتعزيزها، داخل البلد، كما يُهمل النظر الى تجارب شعوب أخرى أثبتت
الاقتصادات غير المشروعة فيها والجماعات التي تمكّنها أنها متماسكة
للغاية، وقادرة على التكيف، وعرضة لتوسيع نشاطاتها.
استمرار الصراع بين الأحزاب المتنازعة على السلطة وسياسة قمع الأصوات المعارضة، كما نرى في العراق، يعني استمرار الربح من المخدرات وتوفير الحجج لعسكرة قوات الشرطة المحلية
صحيح أن ارتفاع معدلات البطالة وحالة اليأس وانخفاض الفرص، والنزوح
وعدم الاستقرار، وما عاشه البلد من حروب واحتلال واستمرار النزاع
المسلح والارهاب، يجعل السكان، الشباب والفئات المهمشة خاصة، أكثر
تقبلا لتعاطي المخدرات وكذلك لتهريبها والاتجار بها وتصنيعها من أجل
كسب المال، إلا أن الترويج الحقيقي وتجذير المشكلة، غالبا ما يتم إما
بمساهمة المسؤولين الحكوميين الفعلية أو التغاضي عنها لأسباب يرون فيها
تقوية لنفوذهم.
في دراسته المعنونة «في صنع الحرب: مناطق الصراع وانعكاساتها على سياسة
المخدرات،» يتناول الباحث تيوزداي ريتانو ما يسميه « نموذج الحكم
العنيف» خلال فترة النزاع والصراع المسلح « اذ يتم تحقيق النفوذ
السياسي من خلال الوصول إلى الموارد ذات القيمة أو يمكن تحقيق الدخل
منها؛ حيث تشتري الموارد دعم المجتمعات المحلية من خلال توفير سبل
العيش والوصول إلى النفوذ السياسي الحالي (من خلال الفساد) ؛ وحيث
تشتري الموارد أيضا امكانية الحصول على الأسلحة والجنود المشاة
(الميليشيات أو الجيوش أو الأمن المدفوع أو «الجيوش»)، والتي يمكن
استخدامها بدورها للضغط على المعارضة أو مهاجمتها، وتقويض احتكار
العنف، وتأمين السيطرة على الأراضي والأصول، أو ابتزاز الدعم من السكان
المحليين».
ولا تقتصر الاستفادة من تجارة المخدرات على الجهات الحكومية بل تتعداها
الى الميليشيات بأنواعها المتكاثرة والمنظمات الإرهابية، ويُقدر المركز
النرويجي للتحليل العالمي أن عائدات الاتجار بالمخدرات تمثل 28 في
المائة من دخلها في مناطق الصراع. معظم هذه الإيرادات لا تأتي من إنتاج
أو توزيع المخدرات، أو من وسائل مباشرة أخرى للمشاركة في تجارة
المخدرات، ولكن من فرض الضرائب على المخدرات التي تمر عبر الأراضي التي
تسيطر عليها الجماعات. هنا تبرز أهمية العراق كمعبر أضيف الى ما يسمى
بطريق البلقان المشهورمع وجود حدود طويلة ومفتوحة مع إيران بالاضافة
الى تركيا وسوريا من جهة ودول الخليج من جهة ثانية. وحسب مكتب الأمم
المتحدة للمخدرات والجريمة يتم تهريب الهيروين ومصدره أفغانستان الى
إيران إما مباشرة أو عبر باكستان ومن ثم الى العراق، عبر البصرة
وأربيل، ومنه الى تركيا والأردن.
يساعد انضمام العراق الى طريق البلقان إيران، بشكل خاص، لكسر طوق
الحصار الاقتصادي المفروض عليها أمريكيا، كما يوفر مردودا ماليا كبيرا
للميليشيات والقوات الأمنية التي تدير المعابر الحدودية، آخذين بنظر
الاعتبار ان مردود تجارة المخدرات تزيد على المليار دولار سنويا، وان
أفراد الميليشيات، أنفسهم، وخمسين بالمائة من القوات الأمنية ( صحيفة
نيويورك تايمز – 25 أكتوبر 2010) يدمنون شرب الكحول والمخدرات كالترياك
والكريستال وحبوب الكبتاغون، لأنها تمنحهم الشجاعة والاندفاع وتجاوز
الكوابح الأخلاقية. ولعل هذا يفسر نوعية الجرائم الوحشية المرتكبة بلا
مبرر احيانا. وكانت الحكومة النازية قد وفرت لجنودها حبوبا تماثل
الكريستال، وفقًا لنورمان أوهلر، مؤلف « المخدرات في المانيا النازية»
التي ساعدت « الجندي أن يصبح روبوتًا مقاتلًا «. ومعروف ان استخدام
المخدرات منتشر بين القوات الأمريكية في كل حروبها، خصوصا منذ حرب
الفيتنام، كما يستخدمها المرتزقة او المتعاقدون الأمنيون كما حدث في
العراق وأفغانستان.
إن الصراع الممول من المخدرات ليس جديدا فالمخدرات سلع ذات قيمة عالية
ومربحة للغاية وقابلة للنقل بطرق سهلة نسبيا في بلد حدوده مفتوحة أو
مدارة من قبل جهات مستفيدة من التجارة. واستمرار الصراع بين الأحزاب
المتنازعة على السلطة وسياسة قمع الأصوات المعارضة، كما نرى في العراق،
يعني استمرار الربح من المخدرات وتوفير الحجج لعسكرة قوات الشرطة
المحلية. ولن تتمكن الحكومة الحالية، مهما نشرت من بيانات حول إلقاء
القبض على المدمنين والتجار، من وضع حد للمشكلة لأنها سبب المشكلة.
كاتبة من العراق
يوم صارت أصوات
الضحايا العراقيين حجارة
هيفاء زنكنة
خلال أسبوع واحد، أصدرت أربع منظمات دولية تقارير وبيانات عن استمرار
النظام العراقي بقمع واستهداف المتظاهرين. واجه النظام التقارير
الموثقة بطريقتين، الأولى هي الصمت والتجاهل والثانية اطلاق رئيس
الوزراء مصطفى الكاظمي وعودا جديدة الى أن زار مدينة الناصرية، جنوب
العراق، يوم السبت الماضي.
لابد أن الكاظمي توقع أن يستقبل بالهوسات الشعبية، وربما اطلاق النار
في الهواء، ترحيبا بزيارته الناصرية، جنوب العراق، خاصة وأن غرض
الزيارة هو تدشين جسر. وهو حدث نادر، إذا ما تحقق فعلا، في زمن
المشاريع «الفضائية» أي الافتراضية، والفساد المستدام. الا أن المحتجين
من سكان المنطقة الذين عانوا الأمرين من عدم الاستماع لمطالبهم فيما
يخص الخدمات الأساسية، والارهاب الحكومي المتمثل بالتهديد والاختطاف
والقتل، حاصروا الكاظمي مطالبين بالكشف عن قتلة النشطاء السياسيين
والمحتجين في الحراك الشعبي الموحد، الذي تجدد يوم 25 أيار/ مايو،
تضامنا مع بغداد وبقية المدن، تحت شعار « من قتلني؟». هاتفين بأصوات
565 متظاهر قتل منذ انطلاق انتفاضة تشرين/ أكتوبر 2019، بالاضافة الى
عشرات النشطاء الذين أغتيلوا « على يد مجهولين».
هرب الكاظمي، محاطا بحراسه الأمنيين، بعد أن بدأ عدد من المحتجين رشق
موكبه بالحجارة وليس الرصاص الحي الذي تستخدمه «القوات الامنية» ضد
المحتجين، بأمرة القائد العام للقوات المسلحة، أي الكاظمي، الذي كان
على رأس قائمة وعوده، عند تسلمه السلطة، تشكيل لجنة للتحقيق بمحاكمة
المتورطين في قتل المتظاهرين والناشطين. كالمعتاد، دُفنت اللجنة تحت
ركام المآسي اليومية التي يعيشها المواطن. ولم يتم تقديم أي متهم
للقضاء حتى الآن. واضيف قتل المتظاهرين الى سلسلة الجرائم والانتهاكات
التي تعاود المنظمات الحقوقية العراقية والدولية التذكير بتاريخ حدوثها
والمطالبة بمعرفة نتائج التحقيق فيها.
فمنذ أيام أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا بمناسبة مرور خمس سنوات
على ما حدث في الصقلاوية. استهلت المنظمة التقرير بصورة لصبي، في وثيقة
نجد فيها المعلومات التالية « محل وتاريخ ولادة حامل الشهادة :
الصقلاوية ـ الفلوجة. الدين : مسلم «. وعند مواصلة القراءة سنجد ان هذا
الصبي هو واحد من 1300 رجل وصبي، اقتادتهم ميليشيا» الحشد الشعبي»
المسلحة، وهي جزء من القوات المسلحة العراقية، تعمل بأمرة الكاظمي،
قانونيا، صباح الثالث من يونيو/حزيران 2016 بعيدا عن عوائلهم في منطقة
الصقلاوية في محافظة الأنبار. وعند غروب الشمس، صعد ما لا يقل عن 643
رجلاً وصبياً إلى حافلات وشاحنة كبيرة.
أثار الاختطاف ضجة كبيرة أجبرت رئيس الوزراء آنذاك، حيدر العبادي، على
تشكيل لجنة للتحقيق في حالات الاختفاء والانتهاكات المرتكبة في سياق
العمليات العسكرية لاستعادة السيطرة على الفلوجة. كان ذلك في 5
يونيو/حزيران 2016، ولم يتم الإعلان عن النتائج التي توصلت إليها
اللجنة. ولم ترد السلطات العراقية على طلب منظمة العفو الدولية للحصول
على معلومات في ذاك الوقت. ولم يسمع ذوو الـ 643 رجلا وصبيا أي خبر
عنهم على الرغم من مرور خمس سنوات على اختطافهم وتشكيل اللجنة
التحقيقية بأمر رئيس الوزراء.
إذا كان عام 2020 قد تميز بقتل واختطاف المتظاهرين، فان بقية الانتهاكات الصارخة لم تنته بل تجذرت أعمق فأعمق في ممارسات النظام، ومن بينها تفشي استخدام التعذيب
وتلاقي منظمة « هيومن رايتس ووتش» الدولية، التي توثق حالات الاختفاء
القسري في جميع أنحاء العراق منذ عقود، جدار الصمت ذاته الذي تصطدم به
منظمة العفو الدولية عند تعاطيها مع النظام فيما يخص حقوق الإنسان. ففي
عام 2018، اصدرت تقريرا موثقاعن 78 رجلا وصبيا تم إخفاؤهم قسرا بين
أبريل/نيسان 2014 وأكتوبر/تشرين الأول 2017. وفي يونيو/حزيران 2018،
أرسلت المنظمة استفسارا يتضمن قائمة بأسماء عشرات الأشخاص المخفيين،
بالإضافة إلى التواريخ والمواقع التقريبية التي شوهدوا فيها آخر مرة،
إلى حيدر العكيلي، مستشار حقوق الإنسان في المجلس الاستشاري لرئيس
الوزراء، لكنها لم تتلق قط أي رد رسمي.
وفي تقريرها الأخير المعنون « العراق احداث 2020» أشارت المنظمة الى
ظاهرة اطلاق الوعود الصوتية من قبل مسؤولي النظام خاصة رئيس الوزراء،
مستهلة التقرير بالقول «رغم تكرار الوعود بمعالجة بعض التحديات
الحقوقية في العراق، لم تتمكن حكومة مصطفى الكاظمي، التي استلمت الحكم
في مايو/أيار 2020، من إنهاء الانتهاكات بحق المتظاهرين، حيث تستمر
الجماعات المسلحة بالإفلات من العقاب لممارسة الاعتقال التعسفي
والإخفاء القسري والقتل خارج نطاق القانون بحق منظمي المظاهرات ومنتقدي
النخبة السياسية في العلن». وإذا كان عام 2020 قد تميز بقتل واختطاف
المتظاهرين، فان بقية الانتهاكات الصارخة لم تنته بل تجذرت أعمق فأعمق
في ممارسات النظام، ومن بينها تفشي استخدام التعذيب والاعترافات
القسرية في نظام العدالة الجنائية. ويواصل النظام تنفيذ الإعدامات
القضائية رغم الانتهاكات الجسيمة للإجراءات القانونية الواجبة. اذ ينفذ
العراق أحد أعلى معدلات الإعدام في العالم، إلى جانب الصين وإيران
والسعودية. في أغسطس/آب 2019 أصدرت وزارة العدل بيانات أظهرت أن 8.022
محتجزا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام.
وغالبا ما لايعرف أهل المعتقلين الجهات المسؤولة عن الاعتقال التعسفي
على الرغم من مطالبة المنظمات المحلية والدولية بالكشف عن الهياكل
الأمنية والعسكرية التي لديها تفويض قانوني لاحتجاز الأشخاص، وفي أي
منشآت.
وبينما طالبت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) الحكومة بتقديم
معلومات عن التحقيق والملاحقة القضائية في الجرائم المرتكبة ضد
المتظاهرين والمنسوبة، غالبا، الى «مجهولين» أصدر مركز جنيف الدولي
للعدالة تقريرا حول تلقيه فيديوهات توثق إنتهاكاتٍ بشعة لفصائل الحشد
الشعبي، وتحديداً منها ميليشيا عصائب أهل الحقّ، يقوم أفرادها بعملياتٍ
قتلٍ جماعية لعددٍ من المدنيين. ويؤكدّ المركز إنّ الإنتهاكات المصوّرة
ترقى إلى جرائم ضدّ الإنسانيّة، مما يتوجب على مجلس حقوق الانسان،
بالامم المتحدة، إرسال بعثة تحقيق دوليّة للتحقيق في هذه الجرائم
والضغط على السلطات لحلّ الميليشيات وتقديم قادتها الى القضاء الجنائي
الدولي. بالاضافة الى تعيين مقرّر خاص لحالة حقوق الإنسان في العراق،
يكلّف بالكشف عن كل الانتهاكات المُرتكبة منذ الغزو الأمريكي عام 2003
ولحد الآن.
هل ستغير هذه التقارير المعززة باسماء الضحايا وفيديوهات القتل البشع
للمدنيين، من الوضع اللاإنساني الذي يغلفه النظام العراقي بالصمت؟ لهذه
التقارير أهمية بالغة من ناحيتين. الاولى توثيقية ستساعد على تحقيق
العدالة للضحايا وذويهم مستقبلا. والثانية توعوية لأيصال الصورة الى
شعوب العالم، خاصة شعوب الدول التي نفذت غزو واحتلال البلد، ومهدت
الارضية لنمو الفساد والارهاب، لحثها على التضامن مع الشعب الذي تم
غزوه باسمها. أما التغيير، فان منبعه سيبقى هو الشعب العراقي نفسه
بوحدته وايمانه بالعدالة والاستقلال والعيش الكريم للجميع.
كاتبة من العراق
إزار أم محمد ومعنى
تمكين المرأة العراقية
هيفاء زنكنة
اذا كان المفترض من انتشار وباء فيروس كورونا هو اقامة الجدران
الكونكريتية حول الأفراد والمجتمعات، بين الدول، في أرجاء العالم،
بذريعة «التباعد الاجتماعي» فان الإنسان الذي طالما عُّرِف بأنه حيوان
اجتماعي، نجح بحفر ثقوب في الجدران، ليتواصل مع أبناء جنسه، تأكيدا
لهويته الاجتماعية. فصار بامكانه، وهو جالس في بيته، زيارة أبعد
الأماكن في أقصى الكرة الأرضية ويلتقي بأشخاص ما كان يحلم بلقائهم،
سابقا، جراء البعد الجغرافي أو التكلفة المادية أو الحظر السياسي. صار
الـ«زوم» وآليات التواصل الاجتماعي الإلكترونية الاخرى نافذة مفتوحة
للجميع، يطلون منها على عوالم، كانت في غرف مغلقة تسمى الدول، لا تُفتح
ابوابها الا للنخبة ممن يتحكمون بنقاط التفتيش والحدود والرقابة.
عبر الزوم، كثرت اللقاءات والاجتماعات، بأنواعها. من الفردية الى
العامة. فاتسع الفضاء العام، إيجابيا، للناشطين لتبادل الآراء وتشجيع
المبادرات. لم يعد اطلاق كتاب من تأليف أسيرة فلسطينية محررة مقتصرا
على دار النشر في مدينتها المحاصرة من قبل الصهيوني الاستيطاني، أو
متابعة مبادرة إنسانية أو فنية محصورا في بقعة جغرافية لا يسمع بها
أحد.
هذه الإمكانية الهائلة بالانفتاح وعبور حدود البلدان، وتجاوز قيود
السفر ومخاوف نقل العدوى، نقلت مجموعة من المهتمين بالفنون اليدوية
التقليدية، المنتمين الى بلدان مختلفة، الى مدينة البصرة، جنوب العراق.
حيث أقامت كلية الفنون الجميلة، بجامعة البصرة أمسية للتعريف بـ (إزار
أم محمد) أدارها الاستاذ ياسين يامي. والإزار أو «الشف» هو نوع من
السجاد المنسوج، يدويا، ليستخدم اما للفرش على الارض أو الأسرة أو
الارائك. وأم محمد (التفات خريجان) هي مديرة مشغل لإنتاج السجاد والبسط
والأُزر في مدينة السماوة، جنوب العراق. تحدث في الامسية الفنان رشاد
سليم وهو من اوائل مشجعي المشغل ومنتجاته.
يمثل المنتج الرائع للمشغل، بألوانه الزاهية المميزة للمنطقة، إحياء
لموروث حرفي أصيل برسوم عفوية تماثل رسوم الاطفال وتصنيع يدوي بالغ
الدقة. لا تتدخل فيه الآلة اطلاقا من لحظة تجميع صوف الغنم وغزله، الى
تلوينه ونسجه.
مبادرات الأفراد في المؤسسات الحكومية، ومبادرات أصحاب الأعمال او العقارات، كما مبادرات الجامعات والمدارس، قد تكون أفضل ما يستطيعه البلد في ظروف خراب الدولة وسياسييها
ويستغرق العمل في السجادة الواحدة أكثر من ثلاثة أو أربعة أشهر. يعاني
المشغل، على الرغم من حرارة الاعجاب بالتجربة والمنتوج، عدة مشاكل.
أهمها قلة الرعاية والاهتمام، وضعف التسويق وتراكم الانتاج. مما يؤثر
بشكل سلبي على حياة النسّاجات ومستوى العيش الكريم، اذ ان أغلبهن من
الأرامل والمطلقات والمعوزات اللواتي يعتمدن، بشكل أساسي، على ما يدره
عملهن، الذي لا يختلف اثنان في قيمته الجمالية والتراثية وصعوبة
انجازه. فاذا كان المنتج، بهذه الأهمية، كما تحدث عنه منظمو الأمسية
والمشاركون فيها باعجاب وحماس، فلم لا يتم تبني المشروع حكوميا، وتوفير
الدعم له من ناحيتي الترويج والتسويق؟ خاصة وأنه مشغل تديره وتعمل فيه
مجموعة من النساء، كما تتلقى فيه نساء أخريات التدريب العملي، لما قد
يكون سلسلة من ورشات تدريب وتوفير فرص العمل للنساء في مدن أخرى؟ وهي
نقطة مهمة جدا. اذ أن معدل البطالة مرتفع في العراق، ومازال معدل
المشاركة في قوة العمل متدنيا، لاسيما بين النساء والشباب. فحسب تقرير
للبنك الدولي لا يشارك في قوة العمل سوى 15 بالمئة، فقط، من النساء، في
سن العمل. وهذه النسبة أقل من النسبة المتدنية، بالفعل، على مستوى
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغة 22 بالمئة. وبالنسبة للشباب
في الشريحة العمرية 15 – 29 سنة، نجد أن 72 بالمئة من النساء و18
بالمئة من الرجال إما خارج المدرسة أو لا يعملون. ويلخص البنك الدولي
وضع المواطن المعيشي في البلد بأنه «تراجع التنمية البشرية ومؤشرات
الخدمات العامة، ومعايير الرعاية الصحية، ومتوسط العمر، وجهود محو
الأمية، وزيادة مؤشرات الفقر».
ولأن للمرأة النصيب الأكبر في التدهور التعليمي والصحي العام ووقوعها
في براثن الفقر المدقع، وحاجتها الماسة الى العمل، أيا كان، في العراق
اليوم، قد يتبادر الى الأذهان أن الجهات الرسمية والأحزاب ومنظمات
المجتمع المدني الممولة دوليا، ستسارع الى تبني ودعم اي فرصة توفر
للنساء التدريب والعمل، خاصة وأنها تصرف مبالغ خيالية على ادارة لقاءات
وندوات في فنادق فخمة لمناقشة «تمكين المرأة».
ويكاد لا يخلو أي تقرير عن المرأة في الريف، التي تشكل حوالي ثلث نساء
العراق، عن التوصية «بدعم المرأة الريفية من خلال منح القروض الصغيرة
وتسويق الانتاج ودعم المنتجات الريفية والاعمال اليدوية». فما هو معنى
«تمكين المرأة» إن لم يبدأ في مكان تجد فيه المرأة عملا تحقق فيه
ذاتها، وتعبر فيه عن مشاعرها؟ هل هناك ما هو أكثر تمكينا للمرأة من عمل
يهبها الافتخار بجمالية المنجز بالاضافة الى تحسين وضعها المادي؟ أليس
من المفترض، في هذه الحالة، أن تحظى ورشة « إزار أم محمد « المعنية
بتدريب نساء ريفيات على انجاز منتج فني تراثي، يدرأ الفقر، بالاضافة
الى تعليمهن القراءة والكتابة، ويجدن فيه متنفسا للقاء والتواصل
والتطور، بأولوية الدعم والتشجيع، وأن تكون الورشة نموذجا عمليا، نابعا
من صميم المجتمع، يحتذى به في أرجاء البلد؟ أم ان هذا هو، بالضبط، ما
لا يراد تحقيقه؟
أثناء أمسية الزوم تبرع علي الكناني، رئيس كلية الفنون الجميلة
بالبصرة، بتوفير مكان لعرض منتجات الورشة في مجمع تجاري وتكريم أم محمد
في الجامعة. وهي مبادرة مشجعة ستمد فنانات الورشة بالدعم المعنوي.
وتبقى مشكلة الترويج والتسويق ازاء انتشار السجاد المستورد الأرخص سعرا
لأنه مصنوع آليا. معالجة هذه المشكلة تحتاج حملة وطنية لدعم المنتوج
الوطني وقبل ذلك رعايته وتدريب الجيل الجديد حرصا على استمراريته
والتأكد من نوعيته. والى أن يتم ذلك، بامكان المسؤولين الافراد في
الجهات الحكومية بما لديهم من مجال للقرار، في عديد الدوائر المحلية
وفروع الوزارات والمديريات، اتخاذ خطوات بسيطة لن تكلفهم الكثير لكنها
ستساهم بانقاذ ورشة الإزار واستمراريتها. تتلخص هذه الخطوة بشراء
منتجات الورشة التي لا تضاهى بجمالها ودقة نسجها، وعفوية رسومها،
وتوزيعها كهدايا لضيوف المؤتمرات الأجانب ( وما أكثر المؤتمرات الخاصة
بالمرأة) بالاضافة الى توفير فرص عرضها في الاماكن السياحية والمطارات،
او في تأثيث غرف ضيافتها كما نرى في بلدان المغرب العربي.
والموضوع الأوسع هنا أن مبادرات الأفراد في المؤسسات الحكومية،
ومبادرات اصحاب الأعمال او العقارات، كما مبادرات الجامعات والمدارس،
قد تكون أفضل ما يستطيعه البلد في ظروف خراب الدولة وسياسييها. فطاقات
العراق في جميع ابنائه وبناته. وقد تكون المبادرات المحلية في كل مجال،
من الاقتصاد الى الثقافة والخدمات، إذا انتشرت، من أهم مسارات تعافينا.
كاتبة من العراق
أي عراق يريده المتظاهرون؟
هيفاء زنكنة
في ظل جريمة الاحتلال الصهيوني الاستيطاني ضد الشعب الفلسطيني، يواصل
عدد من الأنظمة العربية، من بينها سوريا والعراق، ارتكاب الجرائم ضد
شعوبها بشكل مستديم، لكنه أقل ضجيجا، وأكثر استفادة من ورشات تغليف
الممارسات الإجرامية بالديمقراطية. وبينما تنشغل الشعوب العربية
بالنزول الى الشوارع تضامنا مع الشعب الفلسطيني، والهتاف بصوت عال أن
حكومات التطبيع مع الكيان الصهيوني لا تمثلها، تلتقط الأنظمة القمعية
كل من ترى فيه نبلا إنسانيا لتغتاله. ولعل واحدة من أقسى الصور الدالة
على لا إنسانية نظام ما، هي تلك التي صاحبت آخر المظاهرات والاحتجاجات
العراقية، يوم 25 مايو، ومطلبها الرئيسي هو الكشف عن قتلة المتظاهرين.
يومها رفع المتظاهرون السلميون صورة متظاهر شاب يحمل صورة متظاهر قُتل
في تظاهرة سابقة. يومها، قُتل ثلاثة متظاهرين وجرح المئات، حين أطلقت
القوات الحكومية الرصاص على المتظاهرين العُزل، لتضاف الى قائمة
الضحايا أسماء جديدة، في بلد بات فيه القتل سلاحا حكوميا – ميليشياويا
مشروعا.
في العراق، بوجود النظام الحالي، لم يعد لهوة الحضيض الأخلاقي
والإنساني قاع. حيث تتفكك أكذوبة الديمقراطية وانتخاباتها، يوميا، مع
تزايد ضحايا المظاهرات والاعتصامات في أرجاء البلد، ومع استشراء الفساد
المُهدد لبنية المجتمع وسيولة الولاء. وصل الانحدار حدا تلاشت فيه «
العصمة» الانتقائية التي يقدمها ساسة النظام لمتظاهري هذه المدينة
لأنها «مقدسة» أو شرعنة للقتل في تلك المدينة لأنها «إرهابية». إذ نجح
النظام الفاسد في تحقيق المساواة للمواطنين، جميعا، بلا استثناء، في حق
السقوط ضحية للاغتيال. ليس هناك ما يحمي المتظاهر المطالب بالكشف عن
قتلة المتظاهرين في بلد بلا حكومة وبلا قانون. واستديوهات أجهزة
الإعلام مفتوحة على سعتها لاستقبال ساسة يعرف الكل مدى انخراطهم
بالفساد وجرائم الاغتيال، ان لم يكن بشكل مباشر فصمتا وتسترا.
والمفارقة التي يدفع ضحايا الاحتجاجات ثمنها، غاليا، أن ينجو القتلة
بجرائمهم، أمام الملأ، لأنهم يتمتعون بحماية أقوى بكثيرممن يقدمون
أنفسهم كرؤساء للحكومة وحماة للقانون.
كما حدث في اليوم التالي لمظاهرات 25 مايو الحالي، حين أصدر رئيس
الوزراء مصطفى الكاظمي أمرا بالقاء القبض على المدعو قاسم مصلح، بتهمة
اغتيال الناشط إيهاب الوزني، رئيس تنسيقية الحراك الشعبي، قرب منزله في
محافظة كربلاء جنوبي العراق. كان القتيل معروفا بموقفه من الميليشيات
المدعومة إيرانيا. أعتقل قاسم مصلح، القيادي في ميليشيا الحشد الشعبي،
وهو قائد سابق للواء «علي الأكبر» التابع لحشد العتبات الذي تديره
المرجعية الشيعية مباشرة، بعد أن أقامت عائلة الوزني، الدعوى ضده ويبدو
أن القتيل كان قد أودع لدى عائلته قائمة بأسماء الأشخاص الذين هددوه
سابقاً. تأكيدا للأمر، أصدر الكاظمي بيانا جاء فيه أن إلقاء القبض تم
بأمر القائد العام للقوات المسلحة مذكرة قبض قضائية وفق المادة 4 إرهاب
وبناء على شكاوى بحقه. إلا أن بقاء المتهم رهن التحقيق لم يدم غير
ساعات إذ « قامت سلطات عراقية بإطلاق سراحه» ونقله سالما آمنا الى منزل
رئيس هيئة الحشد الشعبي. مما أوضح من هو مالك السلطة الحقيقية في
البلد.
الهوية الوطنية وتآخي قوميات وأديان العراق وعمق ثقافته وتاريخه، أقوى من أن تمحى. إنه جيل إستعادة العيش سوية، كمواطنين متساوين، بغض النظر عن الجنس والعرق والدين
هذه «السلطات العراقية» عاملت المطالبين بمساءلة قتلة المتظاهرين
بطريقة مختلفة تماما. حيث لم تتوان عن إطلاق الرصاص الحي عليهم،
والاعتداء عليهم، وترى انتهاكاتها ضرورية في سيرورة بدأت منذ انتفاضة
تشرين / اكتوبر 2019 وحتى اليوم، ليزداد عدد الضحايا، بشكل طردي، مع
تهرؤ قناع الاصلاحات الموعودة، ومع استبدال وجه رئيس وزراء بآخر، في
حكومات احتلال متعاقبة موسومة بأنها» منتخبة». وكان أحد اعضاء المفوضية
العليا لحقوق الإنسان قد تحدث عن وجود 89 محاولة اغتيال لنشطاء
وإعلاميين بالإضافة الى التهديدات. ويأتي توقيت ارتكاب هذه الجرائم مع
تكسر الاسطوانة المشروخة عن «محاربة الإرهاب» و «خطر داعش» و«القاعدة»
و«أزلام النظام السابق». لتحل محلها، بشكل تدريجي، بين عامة الناس،
توصيفات « الفساد» و«الطائفية» و« الميليشيات» و«العمليات الخاصة» و«
الفصائل الولائية».
ليس هذا ما يريده المواطنون. لم يكن مطلبهم، لا في الماضي ولا الحاضر،
تبديل الإرهاب بإرهاب آخر أو المسميات والتصنيفات بأخرى. ما يريده
المواطن هو أساسيات بناء الحياة الكريمة من صحة وتعليم، وحقوق توفر له
ولأبنائه مستقبلا آمنا في ظل قوانين تطبق على الجميع بلا استثناء. فكيف
يحقق ذلك وهو يكاد يختنق في وضع تتحكم به عصابات تتنازع فيما بينها على
المكاسب وتتوحد في احتقارها واستهانتها للشعب. هناك مشاريع وبرامج
ومبادرات تحت شعارات مشجعة يتم تقديمها، بين الحين والآخر، من مجموعات
وحركات ومنظمات، كحل للوضع الكارثي في البلد. هناك قوائم من احزاب
جديدة أو قديمة بمسميات جديدة. المظاهرات والاحتجاجات والاعتصامات
مستمرة في ساحات المدن المختلفة. يحاول كل منها طرح مشروعه ومطالبه وفق
منظوره. في ذات الوقت الذي لم يبرز فيه مشروع وطني موحد يهدف الى تحرير
أرض الوطن من الاحتلال، بأنواعه، والكفاح ضد أشكال الاستغلال وسلبه
كرامته وحقه في الحرية. علينا أن نواجه حقيقة أن عملية استبدال رؤساء
الوزراء كما في استبدال عادل عبد المهدي برئيس المخابرات الكاظمي لم
يكن نصرا للمعتصمين، بل مناورة حلول نجح ساسة النظام في تمريرها لتمديد
حياة النظام.
هذا لا يعني أن انتفاضة تشرين لم تحقق شيئا. فقائمة انجازاتها
الإيجابية طويلة ولعل أهمها أنها منحتنا لمحة ( بالمعنى التاريخي
للمحة) لما يجب أن يكون عليه العراق، بجيل جديد طليعته شباب مثقف يُدرك
خطورة الطائفيين، يسعى لأن يرى العراق متشافيا متعافيا من الفساد
والولاءات الخارجية وسياسات التجهيل، وبقية الأمراض التي زرعها المحتل
في تربة أجهدتها سنوات الاستبداد والحصار. جيل ينهض لأنه يحمل روح نضال
التحرير من الاستعمار وقادر، في الوقت نفسه، على غربلة خطايا وأخطاء
الفترة اللاحقة. ليثبت أن الهوية الوطنية وتآخي قوميات وأديان العراق
وعمق ثقافته وتاريخه، أقوى من أن تمحى حتى لو تعاون المحتل والمستبد
المحلي سوية. إنه جيل إستعادة العيش سوية، كمواطنين متساوين، بغض النظر
عن الجنس والعرق والدين.
كاتبة من العراق
استحضار الوضع العراقي
حين نقرأ النصر الفلسطيني
هيفاء زنكنة
لقد حققت فلسطين القلب والروح، خلال 11 يوما، انجازا هائلا، كلل مواصلة
النضال، بتكلفة نعرف جيدا أنها باهظة.
أراد العدو، خلالها، أن تكون حياة الأطفال والكبار حجرا يُثقل الاحساس
بالكرامة والحرية، فيجّر الشعب الذي قارع الاحتلال والظلم والاستهانة
على مدى 73 عاما، الى قاع الاحباط واليأس والاستسلام، ففشل. استخدم
العدو، بالإضافة إلى القوة العسكرية، كل آليات الخداع والتزييف. من
تصنيف الفلسطيني إرهابيا الى اختزال الاحتلال وارهابه الى « نزاع» بين
إسرائيل الأوروبية الديمقراطية وحماس الإرهابية، الى التذكير المستمر
بمعاداة السامية ومظلومية المحرقة. وكأن الفلسطيني هو الذي قاد
الأوروبي اليهودي الى المحرقة، وليس الاوروبي النازي، فتوّجب لتحقيق
العدالة، وفق منظور الكيان الصهيوني، تجميع الحطب لحرق الفلسطيني.
أثبتت مجزرة 11 يوما الأخيرة هشاشة هذه المحاججة، وليس محوها تماما.
فهي معين ضروري لاستمرارية الوجود الصهيوني. دٌفن بعضها تحت ركام
المباني التي هدمها القصف المنهجي ومعه ملامح الهالة الإعلامية التي
نسجها الصهاينة عن «حق الدفاع عن النفس» وانتقائية حق الحياة لكيان
بُني على أغتصاب أرض وتهجير شعب وسياسة الإبادة. أوقفت ايام القتل
الوحشي الكيان الصهيوني عاريا أمام العالم : قوة استعمارية عنصرية،
بدعم من امبريالية تتغذى على الاستغلال والحكام المستبدين.
إزاء ذلك العري، تعالت الأصوات المطالبة بالعدالة. بمختلف الأساليب
والإمكانيات. من النزول الى الشارع الى الهاشتاغ وكل مواقع التواصل
الاجتماعي. من الكتابة واجراء المقابلات والندوات مع المحاصرين في غزة
وشيخ جراح عبر الزوم الى الغناء وأناشيد الاطفال الى الابتسامة والضحكة
بوجه من يريد قتل الابتسامة والضحكة. لم تعد المقاومة المسلحة ومن جهة
واحدة هي السلاح الوحيد. اتفق الجميع في فلسطين اولا وفي أرجاء العالم
ثانيا، على دفع الخلافات جانبا، وأن يعيدوا لجوهر النضال ألقه: لكي
تصبح فلسطين حرة، كما تهتف الأصوات وتُرفع الشعارات، فلسطين بحاجة الى
كل مستويات المقاومة.
لقد حققت فلسطين القلب والروح انجازا هائلا تبدى بخروج مئات الآلاف من
الناشطين والمؤيدين، من جميع أرجاء العالم الى الشوارع تضامنا مع الحق
الفلسطيني بالتحرير. جمعهم تكبير «فلسطين حرة». من البلاد العربية الى
اوروبا وأمريكا اللاتينية الى أمريكا. مع كل صوت وكل فعل تضامني مع
نضال الشعب داخل فلسطين، يترهل خطاب «معاداة السامية» و«الإسلاموفوبيا»
الذي يصب العرب والمسلمين عموماً في قالب الإرهاب والهمجية. وتتعرى
السردية الصهيونية. هذا ما عشناه، في الاسبوعين الأخيرين، فكيف البناء
على هذه الأرضية الخصبة من التضامن مع الصامدين؟ كيف نسقي النبتة لتنمو
وتتبرعم وتزدهر ؟ كيف نجنبها الجفاف؟
يأتي التساؤل مشوبا بالمخاوف والحرص على ما أُنجز واستعادة تفاصيل،
تحمل بعض الشبه من الماضي القريب. تفاصيل ايام الاحتجاجات المليونية
المناهضة لغزو العراق، والتضامن العالمي المذهل الذي سبق الاحتلال في
آذار/ مارس 2003.
مع كل صوت وكل فعل تضامني مع نضال الشعب داخل فلسطين، يترهل خطاب «معاداة السامية» و«الإسلاموفوبيا» الذي يصب العرب والمسلمين عموماً في قالب الإرهاب والهمجية، وتتعرى السردية الصهيونية
أيامها، خرج الى الشوارع 35 مليون مواطن عربي وعالمي احتجاجا وغضبا ضد
مخطط الإدارة الأمريكية لغزو العراق وتضامنا مع الشعب العراقي. احتل
المتظاهرون الشوارع بعدة مدن عربية من بينها ليبيا ومصر ولبنان والأردن
وسوريا وتونس والمغرب. ووقعت اشتباكات بين المتظاهرين و«قوات مكافحة
الشغب» في القاهرة والأردن. هدفت المظاهرات الى محاصرة السفارتين
الأمريكية والبريطانية، وقام المتظاهرون بحرق العلم الأمريكي. كما
طالبوا، في عدد من الدول، من بينها مصر، بطرد سفراء الولايات المتحدة
وبريطانيا وإسرائيل. ووحدت ادانة «الصمت العربي» المحتجين، باستثناء
مدن الدول الخليجية التي خلت من المتظاهرين. عالميا، احتشد في شوارع
أثينا أكثر من مئتي ألف متظاهر، كان من بينهم ( كما في مظاهرات التضامن
مع فلسطين) عدد كبير من الطلاب وصفوا الرئيس الأمريكي جورج بوش
«بالقاتل» ( كما يتم وصف نتنياهو حاليا). في اليوم نفسه كانت هناك
مظاهرات في باكستان، ومدن أستراليا، وإندونيسيا وأنقرة، وموسكو وباريس
وعديد المدن الألمانية. وتظاهر آلاف الطلاب الذين أضربوا عن الدراسة في
الدنمارك وسويسرا وإسبانيا ونيويورك، وأعلنت النقابات العمالية الاضراب
في إيطاليا. وتم تشديد إجراءات الأمن المفروضة على السفارات والقنصليات
الأمريكية حول العالم ( كما سفارات الكيان الصهيوني المخندقة حاليا).
استمدت الحركة التضامنية العربية ـ العالمية قوتها من المقاومة
العراقية، المعادل الموضوعي للاحتلال. كانت التكلفة، كما في فلسطين،
باهظة الثمن. واتهمت المقاومة، كما في فلسطين، بالإرهاب. وتسلل الى
النسغ الوطني داء التمزيق الاستعماري الجديد: الطائفي – العرقي المعجون
بالفساد والعملاء المحليين.
وعلى الرغم من نجاح المقاومة في وقف توسع المد الامبريالي الى دول أخرى
وحققت ما تنبأ به النائب البريطاني جورج غالاوي، أثناء المظاهرات،
قائلا: «إذا بعث بوش نصف مليون جندي إلى العراق، جميعهم من الأمريكيين،
لا يسانده غير رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون، فسينتهي به الأمر
في الجحيم وسيعود الكثير من الأمريكيين إلى بلادهم في حقائب بلاستيكية»
الا أن المقاومة لم تنتصر. وكانت نقطة الضعف الكبرى هي عدم توصل فصائل
المقاومة الى اتفاق للعمل سوية من أجل التحرر الوطني. استغل العدو نقطة
الضعف هذه، مع تنصيب ودعم حكومات تدين بولائها له. فأدى غياب الاتفاق
الوطني، وتوسع حلقة المستفيدين من النظام الطائفي الفاسد، الى تفريخ
احتلالين بدلا من احتلال واحد. وتحولت أرض العراق الى ساحة لاستعراض
القوة والتفاوض بينهما، بينما يلوك ساسة النظام علكة « الديمقراطية» في
البرلمان، وأجهزة الإعلام، ومؤتمرات الدول المانحة، وبرامج الإعمار،
وورشات اعداد القياديين، والدفاع عن حقوق الإنسان، ومحاربة الارهاب.
دفع العراقيون ثمن هذه التوليفة السامة ما يزيد على المليون مواطن خلال
18 عاما، ولم تُسدد فاتورة الحساب بعد، اعتقالا وتعذيبا واختطافا
وقتلا، غالبا، ما يتم تصويره ونشره ترويعا لكل من يحاول رفع كمامة
الاختناق عن فمه.
إن استحضار الوضع العراقي بنقاط قوته وضعفه، بمقاومته وعملائه، بما
أحاطه من تزييف وأكاذيب لتبرير غزوه واحتلاله، واستقطابه حملات التضامن
الشعبي العربي والعالمي، لا يعني بالضرورة تطابقه مع الوضع الفلسطيني،
إلا أن هناك بعض الملامح العامة التي قد يكون من المفيد القاء نظرة
عليها، اذا ما أردنا ديمومة الانجاز الفلسطيني حتى النصر وتحويل
ايماننا بالعدالة والحرية الى واقع بلا احتلال.
كاتبة من العراق
النكبة هي ألا نقاوم
هيفاء زنكنة *
خرج يوم الأحد، يوم النكبة، 15 أيار/ مايو، مئات الآلاف من المتظاهرين،
الى الشوارع، في جميع أنحاء العالم، من كل القارات، مطالبين بتحرير
فلسطين من احتلال الكيان العنصري، وانهاء قصف غزة، وانقاذ «شيخ جراح»
من المستوطنين الصهاينة. حمل المتظاهرون، وأغلبهم من الشباب، شعارات
كتبوها ورسموها بلغات بسعة العالم، وبالألوان التي تُخيف المحتل.
الأحمر والأسود والأخضر والأبيض. رمز الوجود الفلسطيني بألوانها التي
يخشاها المحتل بأسلحته وتقنيته العسكرية المتقدمة.
لماذا يخشى المحتل الألوان؟ في رواية «الدرس الألماني» لزيغفريد لينز،
يسأل الشرطي النازي صديقه عن سبب تلقيه أمرا بالقاء القبض عليه، وهو
مجرد رسام تجريدي، فيجيبه الرسام «إنه اللون. الألوان لديها دائما ما
تقوله. حتى أنها، في بعض الأحيان، تصدر تصريحات محددة. من يدري ما الذي
يقود اليه اللون؟». وفي سيرتها الروائية «حجر الفسيفساء» تخبرنا
الأسيرة المحررة مي الغصين كيف أنها صنعت مسبحة من نوى الزيتون، هدية
لأمها. لوّنتها بستة ألوان إلا أن مدير السجن الصهيوني لم ير غير ما
يرعبه، صادرها قائلا « أحمر أسود أخضر أبيض ممنوع. ممنوع يعني ممنوع».
السجان الصهيوني ـ المحتل ـ لص مذعور غير قادر على رؤية كل ما يحيط به.
تبدت في حضور المتظاهرين وشعاراتهم، وحدة المقاومة الفلسطينية. الأرض
واحدة والشعب واحد. من القدس وغزة الى الضفة الى اللد. الفلسطينيون،
أصحاب الأرض، باقون والمحتل طارئ. هذا ما تعلمته كل الشعوب، وليس
العربية فقط، من نضال الشعوب المُستَعمَرَة مثالها حرب التحرير
الجزائرية. درس تاريخي لا ينسى مهما حاول حكام الخنوع والاستبداد تسويق
خدعة «السلام».
تحررت الجزائر بعد 140 عاما من الاستيطان العنصري الفرنسي. وكلما بدا
للعالم أن المعركة على وشك الفشل، نهض الشعب بعزيمة متجددة. كما يحدث
اليوم في فلسطين المحتلة. حيث حاول المحتل، منذ تأسيس كيانه
الاستيطاني، عام 1948، تدريجيا، تهجير السكان، وتوسيع مستوطناته،
وتقسيم أهل البلد ديموغرافيا، وبذر تفتيت الهوية ورعاية الفساد، واطلاق
تسميات تجزيئية، وحصار غزة. لم تبق وسيلة همجية على وجه الأرض لم
يستعملها لبتر غزة عن الجسد الفلسطيني، فجاءت ساعات الأيام الاخيرة
شاهدة على فشله. على الرغم من جراحه، تماهى ابن الوطن مع ذاته. لا يعود
فيه ذلك الـ «هنا وهناك» الذي مّيز ايام الاشتباكات مع العدو عبر
الأسلاك الشائكة، كما يذكرنا الأكاديمي حيدرعيد من غزة. « في كل مرة
كنت اذهب للمشاركة في مسيرة العودة الكبرى بالقرب من السلك الشائك الذي
يفصل قطاع غزة المحاصر عن باقي فلسطين المحتلة، كان ظلي يتركني ويذهب
الى الطرف الآخر من السلك، و يعود لي صامتا حزينا بعد اسبوع وكأنه ظل
رجل اخر، الى أن ذهب ولم يعد! منذ تلك اللحظه وأنا أعيش بلا ظل! انا
هنا وهو هناك». هذه الايام استرد المناضل ظله ليمتد واقفا على تراب
الوطن كله.
أهمية دور الجيل الجديد من اللاجئين والمهاجرين من الدول العربية الذين يتقنون مختلف اللغات مما يشكل قوة في مجالات النّشر وصناعة المحتوى عالميا
«حالة الانبعاث التي تسري في روح الفلسطينيين على مساحة كل فلسطين بفضل
المقاومة» التي يصفها الأسير المحرر عصمت منصور، امتدت كذلك الى كل
البلاد العربية وارجاء العالم. في العراق المعجون بفلسطين، تستعيد
الصحافية نرمين المفتي لحظة من الذاكرة الجمعية ملخصة معنى ممارسة
الابادة المنهجية ضد المدنيين «سياسة الابادة نفسها، أكيد تتذكرون
اولبرايت في 1995 حين سألها مقدم برنامج 60 دقيقة «هل تعتقدين أن موت
نصف مليون طفل عراقي نتيجة العقوبات الاقتصادية هو ثمن يستحق أن يدفع؟»
وأجابت اولبرايت «لقد كان خيارا صعبا امامنا، لكننا نعتقد أن الثمن
يستحق أن يدفع». اليوم، لا يذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي
قتل مدنيين، معظمهم من الاطفال والنساء، بل يقول انهم قضوا على 85
عنصرا من حماس والجهاد الإسلامي.
انعدام الوازع الإنساني والأخلاقي، هو ما يجمع الغزاة والمستعمرين، وما
يزيد على ذلك عند المحتل الصهيوني هو مهارته في التباكي حول مظلوميته
التاريخية واضطهاده. وهذا ما شهدناه، يوم السبت الماضي، حين حوصرت
سفارته، بلندن، بعشرات الآلاف من المتظاهرين ضد القصف الوحشي لغزة،
فلجأت السفارة الى مشجبها التقليدي وتباكيها عن معاداة السامية واتهام
المتظاهرين بالدفاع عن «تنظيم ارهابي» يطلق الصواريخ!
بالمقابل، لم يكف الفلسطينيون يوما عن البحث، حتى وهم يتعرضون للاعتقال
والتعذيب واغتصاب الارض والقصف والقتل، عن سبل جديدة ومتنوعة للمقاومة
السلمية. حملة المقاطعة الدولية (البي دي أس) واحدة منها. وها هو علي
مواسي، رئيس تحرير فُسْحَة ـ ثقافيّة فلسطينيّة، يثمن تفوق
الفلسطينيّين ومناصريهم في مخاطبة الرأي العامّ العالميّ وتوجيهه. «ليس
بسبب الإعلام الرسميّ، وإنّما صبايانا وشبابنا الرائعين في وسائل
التواصل الاجتماعيّ: تويتر، إنستغرام، سناب تشات، تيك توك، فيسبوك،
وغيرها». مؤكدا على أهمية دور الجيل الجديد من اللاجئين والمهاجرين من
الدول العربية الذين يتقنون مختلف اللغات مما يشكل قوة في مجالات
النّشر وصناعة المحتوى عالميا. مشيرا الى أن « أكثر من باحث ومحلّل
إسرائيليّ تحدّث عن تعثّر مشروع «الهسباراه» عن إخفاقه، رغم صرف مئات
ملايين الدولارات عليه». ويهدف مشروع «الهسباراه» الى الترويج لاعتبار
إسرائيل دولة مسالمة، محبة للسلام، وتساهم بالخير العام حول العالم،
حتى تتمكن من التصدي، وإخفاء الأخبار الواردة من فلسطين حول الانتهاكات
ضد الإنسانية التي تنفذها سلطات الاحتلال.
إن ما يدفعه الفلسطينيون ثمنا للحرية لايقدر بثمن. إنهم يدفعونها
بالحياة الإنسانية وهذا ما لايفهمه الكيان العنصري المؤسس على الإبادة.
واذا كان منبع انبعاثة المقاومة سيبقى فلسطينيا أولا وهو الأهم، فان
تضامن الشعوب، في جميع انحاء العالم، ضروري، وبمختلف الأساليب التي يجب
أن تضم، بالاضافة الى المظاهرات والاعتصامات، تفعيل وتقوية حملات الضغط
( اللوبي) على الحكومات الغربية والإدارة الأمريكية، خاصة، لوقف تغذية
الكيان العنصري بالمال والسلاح والتكنولوجيا العسكرية.
ماذا عن الأنظمة العربية التي يرتكز معظمها على الاستبداد المحلي
واستجداء الحماية الخارجية ضد شعوبها؟ في رسالته المفتوحة الى «الزعماء
العرب الحلوين الحبابين العاقلين الخوافين المساكين» يعيد الكاتب
العراقي علي السوداني طرح الحل الذي طالما اقترحته الشعوب العربية،
ولاتزال، وهو أضعف الايمان، قائلا: «قاطعوا إسرائيل اللقيطة اقتصادياً
على الأقل، وسترون كيف ستنمو الكدمات على جسد هذه الدويلة المفبركة.
افعلوها وستجدون شعبكم هو حاميكم من الفك الأمريكي المفترس».
· كاتبة من العراق
صمت إدارة بايدن حول العراق
هيفاء زنكنة
أعلن الجيش العراقي أن «طائرة مسيرة مفخخة» سقطت السبت الماضي على
قاعدة « عين الأسد» الجوية، في محافظة الأنبار، غرب العراق. يوجد في
القاعدة، حالياً، نحو ألفي جندي أمريكي إلى جانب قوات من الدول
المشاركة في « التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية». تسبب
الهجوم «بأضرار في مستودع» حسب تصريح التحالف الدولي. وهو الهجوم
الثاني على القاعدة، هذا الشهر. سبقه هجوم على قواعد تستخدمها القوات
في مطار بغداد ومطار أربيل بالإضافة الى هجمات أخرى في الشهور الماضية.
كل هذا يحدث تحت انظار الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن وهو يحتفل
بمرور 100 يوم على تسلمه الرئاسة من دونالد ترامب الذي أمر بتقليص عدد
القوات في العراق. وكان ترامب قد زار قاعدة «عين الاسد» مع زوجته، في
26 ديسمبر/ كانون الأول 2018، بدون إعلام الحكومة العراقية، دعما
للجنود «المتمركزين في قاعدة الأسد الذين لعبوا دورا حيويا في هزيمة
تنظيم داعش عسكريا في العراق وسوريا».
الآن، بعد مرور اربع سنوات على اعلان هزيمة داعش، ما سبب بقاء القوات
في العراق، خاصة، بعد اعلان بايدن سحب القوات من على الارض في
افغانستان؟ ومن وراء عمليات الهجوم المتناوبة على القواعد والمتميزة
بأنها لا تسبب ضررا لأي من القوات؟ وما هو موقف الحكومة العراقية
والمنظور الشعبي لهذه العمليات؟
في مقابلة بثتها إذاعة بي بي سي 4، في 6 مايو الحالي، قدم أنطوني
بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي الجديد، صورة تفصيلية عن السياسة
الخارجية الأمريكية برئاسة بايدن. تحدث بالتفصيل عن العلاقة مع روسيا
من عدة جوانب بضمنها معاملة المعارض أليكسي نافالني، منتقلا الى
العلاقة مع الصين، وصفقة تجارية محتملة مع المملكة المتحدة، وضرورة
المحافظة على السلام وتوفير الرفاه الاقتصادي في أيرلندا الشمالية.
تطرق الى الانسحاب التدريجي للقوات الأمريكية من أفغانستان، مع بقاء
أمريكا باشكال أخرى. وأسهب بتوضيح الموقف من إيران والعودة إلى
المباحثات، حول اتفاقية الاسلحة النووية عبر وسطاء في فيينا، وأمله في
ان تصغي إيران للمقترح الأمريكي.
ما يسترعي الانتباه في هذه المقابلة التفصيلية، هو عدم تطرقه، بأي شكل
كان، للوضع في العراق. غياب العراق بشكل كلي، عن الأجندة السياسية
المعلنة، صارخ حتى عند تناول الاوضاع ذات العلاقة الوثيقة به وبأمريكا
وإيران وحتى افغانستان. فهل السبب هو الرغبة الأمريكية بحسم ملف الخلاف
مع إيران، لأنه الأهم بالنسبة اليها، واعتبار العراق ورقة مقايضة، ذات
صلاحية غير محدودة، من اجل التوصل الى اتفاق يوفر لها ولحلفائها،
كالسعودية وإسرائيل، السلام؟ أو لعل اهمال ذكر العراق نابع من الرغبة
بنسيان « خطأ» لا تريد الارادة الجديدة التذكير به، باعتباره من
الماضي، والماضي بالنسبة الى أمريكا، زمن غير موجود، تجنبا للمساءلة
وما يصاحبها من التزامات قانونية وانسانية؟
يبقى الحل الوحيد للتخلص من وجود النيوكولونيالية الأمريكية والنفوذ الميليشياوي الإيراني هو في اتخاذ موقف مقاوم واضح من كلا الاحتلالين، وعدم تحويل العراق الى ساحة تصفية حسابات
هذه السيناريوهات واقعية الى حد كبير، لأنها توفر للادارة غطاء زمنيا
الى حين الاتفاق مع إيران ذات العلاقات والمصالح المتشعبة مع عديد
الدول من بينها الصين. لذلك من الطبيعي الابقاء على الوضع الحالي
بالعراق، بحكومته الفاشلة أو اللا حكومة، بأحزابها منقسمة الولاء،
وبالعنف المستدام فيه. ولا ضرر من التغاضي عن اسقاط بضعة صواريخ وتفجير
طائرة مسيرة على القواعد الأمريكية مادامت، مثل العاب الكمبيوتر، لا
تؤدي الى خسارة بشرية. وما دام ذلك سيبقي العراق متهالكا، ضعيفا،
منقسما على نفسه، منخورا بالفساد والقمع، عاجزا عن مواجهة النزاع
الأمريكي – الإيراني على ارضه، واستخدامه ساحة مفتوحة لتصفية الحساب من
خلال المليشيات والقوات الخاصة والمرتزقة وما يسمى « العمليات القذرة».
لذلك، ستبقى قوات الاحتلال الأمريكي بالعراق المُغيّب في خطاب السياسة
الخارجية لأن بايدن لا يريد أن يبدو وكأنه يواصل سياسة ترامب بالعراق.
وتُركت مهمة تأكيد بقاء القوات لمتحدثي وزارة الدفاع لأنهم الاقل ظهورا
ونجومية اعلاميا من سياسيي وزارة الخارجية. ففي تقرير نُشر في أبريل /
نيسان قال الجنرال في مشاة البحرية فرانك ماكنزي لمجلة « مليتيري
تايمز» ان الولايات المتحدة اختارت ابقاء قواتها بالعراق، خلافا
لافغانستان «مع شركائنا في الناتو لإنهاء معركة داعش». مما يمكن ترجمته
على ارض الواقع بتبرير البقاء بلا أمد محدد، في العراق، فمهمة استعادة
الأراضي من داعش انتهت منذ سنوات، حسب التصريحات الرسمية الأمريكية
والعراقية معا، وامكانية بروز تنظيم إرهابي آخر، يهدد أمن أمريكا، وان
كان محتملا سواء في العراق أو اي بلد آخر في العالم، الا ان هذا لا
يسوغ احتلال كل البلدان التي تظهر فيها تنظيمات إرهابية، هذا اذا تركنا
جانبا تعريف « الإرهاب» المبرر للاحتلال.
بالمقابل، يبين الوضع العراقي الداخلي، أنه ليس هناك موقف شعبي وطني
عام وموحد يرفض بقاء قوات الاحتلال الأمريكية أو الميليشيات الإيرانية.
الانقسام واضح. وهو انقسام أسس له المحتل منذ 18 عاما وعززته الاحزاب
المستفيدة ليتحول تدريجيا الى موقف دفاعي عن النفس ضد « الآخر». حيث
صار مقياس تحديد الموقف الوطني هو إما الانتماء الديني – الطائفي
أوالقومي أو عضوية الاحزاب الطائفية / القومية أو عضوية الميليشيات.
وهي مواقف هشة وسائلة تسللت الى المجتمع الواحد لتقسمه مع مرور الوقت.
كما نمت، في ظل التمزق السياسي والفساد الإداري والمالي، طبقة من
المستفيدين الذين يرون في عملهم كسماسرة لأي احتلال كان، فرصة للثراء
والنفوذ. وغالبا ما تتداخل الانتماءات أو الهويات، حديثة الصنع، حتى
يصعب التمييز بين حامليها المستشرسين بتقديمها كقيمة متجذرة في عمق
تاريخ المجتمع العراقي.
ويبقى الحل الوحيد للتخلص من وجود النيوكولونيالية الأمريكية والنفوذ
الميليشياوي الإيراني هو في اتخاذ موقف مقاوم واضح من كلا الاحتلالين،
وعدم تحويل العراق الى ساحة تصفية حسابات، والحفاظ بكل السبل على
الهوية الوطنية لعراق مستقل موحد والتي تتعرض للتكميم والاعتقال
والقتل، كما لاحظنا في مراحل مختلفة من مقاومة الاحتلال، منذ 2003،
وكما يدفع ثمنها غاليا الجيل الجديد من ابناء انتفاضة تشرين/ اكتوبر
2019.
كاتبة من العراق
من العراق إلى الهند…
الفساد القاتل واحد!
هيفاء زنكنة
قد لايكون وضع العراق الصحي والبيئي، خاصة، مع تفشي فايروس كوفيد 19،
بذات الصورة الكارثية التي نراها، يوميا، في الهند أو بيرو والبرازيل،
إلا أن الوضع سيئ جدا بالمقارنة مع العديد من دول المنطقة والعالم من
ناحية عدد السكان والإمكانيات المادية والتخطيط لمواجهة الأزمات
والكوارث البيئية سواء كانت طبيعية أو من صنع الإنسان. كما أن هناك
أوجه شبه متعددة. فالعراقي الذي يرى صورة اثنين من المرضى الهنود
مرميين على سرير واحد في المستشفى، أو اشتراك النساء والرجال في ردهة
واحدة، لا يستغرب كثيرا، لأنه رأى أو عاش الحالة نفسها في مستشفيات
العراق حتى قبل انتشار الوباء.
بالنسبة إلى تفشي الكورونا، تجاوز عدد المصابين، بالعراق، حتى الآن،
حسب منظمة الصحة العالمية، ما يقارب المليونين، والوفيات 15,498.
وسجلت، قبل يومين، 5167 حالة جديدة و33 وفاة. أما الحالات النشطة فهي
108 آلاف. وهي حالات إصابة مرتفعة بالمقارنة مع إيران وتركيا فضلا عن
لبنان وتونس والإمارات، اذا ما اخذنا بنظر الاعتبار اجمالي عدد السكان
ونسبة الاصابات لكل 100 ألف شخص. حيث وصلت النسبة، بالعراق، الى 114
إصابة لكل 100 ألف شخص استنادا الى احصائيات وزارة الصحة التي لا تسجل
عدد الموتى في البيوت بل في المستشفيات فقط. لا يمكن الثقة إذن بهذه
الأرقام كأي ارقام رسمية أخرى ولكننا نستخدمها كمؤشر.
اتخذت الحكومة، في بداية انتشار الوباء، في العام الماضي، اجراءات
لتقليل الانتشار على غرار منع التجول وتقليل ساعات الدوام وإغلاق
المدارس، إلا أن انزال العقوبات المشددة بالمخالفين التي وصلت حد
الاعتقال وسوء المعاملة، وعدم توفير المساعدة الحكومية للعاطلين
والشريحة الأفقر، وتخوف المسؤولين من رجال الدين إذا ما تجرأوا على منع
الزيارات الدينية من داخل وخارج البلد الى الأماكن المقدسة حيث
الاكتظاظ والتقارب البشري بأقصى أشكاله، ناهيك عن تكذيب رجال الدين
الذين يروجون أن زيارة المراقد الدينية هي الكفيلة بمنع الاصابة
بالوباء بل وحث المريدين على الزيارة لأنها توفر الشفاء منه في حال
الاصابة مما جعل الأماكن الدينية بؤرا للانتشار الأسرع للوباء. ومع
انعدام ثقة الناس بالحكومة الموصوفة بأنها حكومة لصوص وفساد، وانهيار
الجهاز الصحي الذي تسارع تهالكه منذ الاحتلال عام 2003، بعد أن كان
واحدا من أفضل الأنظمة الصحية في المنطقة، بات الناس يفضلون البقاء في
بيوتهم على التوجه الى المستشفيات التي اقترنت بالموت، جراء قلة
المعدات والأدوية والكادر الصحي.
لايبشر الوضع الحالي بالخير. فوزارة الصحة المسؤولة عن الرعاية الصحية
لا تتواصل مع اللجان المستحدثة للرعاية الصحية. اذ صرح مدير دائرة
الصحة العامة نافيا أن تكون وزارة الصحة قد رفعت أية توصية إلى اللجنة
العليا للصحة والسلامة الوطنية بشأن الحظر في الأيام المقبلة، مضيفا ما
يؤكد حالة التخبط في اتخاذ القرارات «وربما لا تتوافق اللجنة العليا مع
توصيات وزارة الصحة «. وعن إغلاق المدارس، ألقى عضو لجنة التربية
البرلمانية صفاء الغانم، مسؤولية ارتفاع الإصابات بين صفوف الطلبة
والكوادر التدريسية على لجنة الصحة والسلامة الوطنية لاصرارهم على عدم
إيقاف التعليم الحضوري، محذرا من كارثة سيذهب اليها البلد نتيجة لهذا
الإصرار.
آخر مستشفى بُني في العراق كان عام 1986، وأن عقودا بمبالغ خيالية وُقعت لبناء 51 مستشفى منذ عام 2009، وصُرفت الأموال ولم يتم بناء أي منها
واذا افترضنا ان الحكومة تبنت فكرة أن اللقاح هو الحل الأفضل لانقاذ
الشعب من الوباء، فان حملة التلقيح تشي بالعكس تماما. اذ تم توزيع ما
لا يقل عن 298377 جرعة حتى الآن. بافتراض أن كل شخص يحتاج إلى جرعتين،
فهذا يكفي لتطعيم واحد من كل 1300 من السكان البالغ عددهم 38.3 مليون
نسمة. وخلال الأسبوع الماضي، بلغ متوسط الجرعات حوالي 12766 جرعة كل
يوم. وبهذا المعدل، سيستغرق الأمر 616 يوما آخر لإعطاء جرعات كافية
لـنسبة 10 بالمئة من السكان. وتكمن المأساة خلف هذه الصورة والتأخير
القاتل في تزويد المواطنين بما يحمي الحياة، في الفساد المتخلل بكل
الحكومة والمؤسسات.
في الوقت الذي أعلن فيه أن ميزانية عام 2021 تبلغ 89.65 مليار دولار،
بعد مساومات أشهر بين الأحزاب حول من يلتهم ماذا، وحصة هذا الحزب أو
ذاك تبعا للوزارة التي يراها ملكا له، واذا كان من المفترض، ولو من باب
تبييض الوجوه، تخصيص نسبة صغيرة من الميزانية لتوفير حاجة الشعب من
اللقاح، إلا أن واقع الحال أثبت أن استهانة الحكومة بحياة الناس
وكرامتهم، بلا حدود. إذ أنها تفضل انتظار تبرع المجتمع الدولي باللقاح
واستجداء المساعدات الانسانية لئلا تمس محاصصة الاحزاب في الميزانية.
إن اهمال حق الرعاية الصحية لا يقتصر على ضحايا الفايروس. بل يمتد
ويتسع ليشمل، بدرجات متفاوتة، اهمال الأطفال والأمهات الحوامل
والمصابين بالاعاقة وضحايا الأمراض النفسية والعقلية. وأشار تقرير حديث
لمنظمة الصحة العالمية الى ازدياد حالات الانتحار، خاصة بين النساء،
بشكل كبير. ولايزال ضحايا اليورانيوم المنضب وحرق مخلفات قوات الاحتلال
يعانون من مختلف التشوهات والامراض الخطيرة، في مختلف مدن العراق. وكان
مركز الوقاية من الإشعاع التابع لوزارة الصحة، قد أعلن في الاول من
مايو الحالي عن وجود 8 مواقع جديدة للتلوث الإشعاعي في محافظة البصرة.
وإن اهمال هذه الوضعية الكارثية التي تنتهك واحدا من أساسيات حقوق
الانشغال، والانشغال بالمحاصصة السياسية والمساومات المالية، وتقاسم
المؤسسات وميزانياتها، وما يترتب على ذلك من موت يومي اما بشكل وباء او
اعتقال أواختفاء قسري هو ممارسة ارهابية، وكونها حكومية لا يجعلها
تختلف عن ممارسة المنظمات الارهابية.
ولابد أن من عاش من ساسة العراق الحاليين في الدول الأوروبية وأمريكا،
وعرفوا بتجربتهم الشخصية، معنى الكرامة المصاحبة لاحترام حقوق الإنسان،
وان ما يحتاجه العراقيون هو نفسه ما يحتاجه جميع البشر من الحقوق
الأساسية كالوظائف والتعليم الجيد والرعاية الصحية والعدالة. وأن هناك
بعد سنوات من الحرب والخراب، حاجة ماسة إلى الاستثمار في الأطفال
والشباب والدعم النفسي لمساعدة الناس على التغلب على الصدمات التي
واجهوها.
إن هذا الأمر هو الذي يُحملً السياسيين العراقيين في السلطة مسؤولية
الخراب الانساني، على مدى 18 عاما الاخيرة، بشكل مضاعف ويجعل مسؤوليتهم
القانونية، ناهيك عن الأخلاقية، أعظم. ويكفي للدلالة على حجم تخريبهم
المنهجي للبلد وأهله ان نُذكر أن آخر مستشفى بُني في العراق كان عام
1986، وأن عقودا بمبالغ خيالية وُقعت لبناء 51 مستشفى منذ عام 2009،
وصُرفت الأموال ولم يتم بناء أي منها.
كاتبة من العراق
حرق المرضى في المستشفى
في بغداد ليس حادثا
هيفاء زنكنة
وكأن العراق في حاجة الى كارثة إنسانية أخرى تضاف الى الموجود لنصل الى
حضيض قتل المرضى حرقا.
في 23 نيسان/ أبريل، أدى انفجار قنينة أوكسجين الى حريق في مستشفى ابن
الخطيب المخصص لعلاج مرضى فيروس كورونا، في بغداد، الى قتل 91 مريضا،
واصابة العشرات. ليضاف عدد الضحايا الجدد الى قائمة تضم ما يقارب 16
ألف وفاة ومليون و250 ألف مصاب بالفايروس، وهو الأعلى بين الدول
العربية. وكان العراق قد حصل على ما يقرب من 650 ألف جرعة من اللقاحات
المختلفة – معظمها عن طريق التبرع أو من خلال برنامج كوفاكس، الذي
يساعد الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط على شراء اللقاحات. وهي
مفارقة توجع القلب غضبا أن ينافس بلد هو من أكثر دول العالم ثراءً
بالنفط، البلدان الفقيرة للحصول على ما يتم التبرع به من اللقاح.
بينما تثير الفاجعة الأخيرة التساؤلات حول سبب حدوثها وكيفية التعامل
معها، يثير عدم توفير اللقاح والرعاية الصحية للمواطنين تساؤلات أكثر.
بالنسبة الى الفاجعة، قد يكون انفجار قنينة الأوكسجين هو السبب الأولي
الا أن شهادة خبراء تداولتها وكالات الأنباء العالمية تدل على ان
المستشفى لم تكن في تصميمها وبنائها وتجهيزها وصيانتها وتشغيلها
مستوفية لتوفير وسائل خروج مناسبة، لتجنب الخطر غير الضروري، على حياة
وسلامة شاغليها من الحريق أو الدخان أو الأبخرة أو الذعر خلال الفترة
اللازمة للهروب. وتبدى النقص الأوضح في عدم تثبيت الأبواب الثقيلة
الخاصة بين الردهات منعا لانتشار الحريق. مما أدى الى الانتشار السريع
للنار والدخان والغازات القاتلة قبل وصول رجال الإطفاء الذين يعانون،
أساسا، من النقص في الإمكانية لمواجهة كارثة كهذه.
أما بالنسبة الى توفير اللقاح ومراكز الرعاية الصحية العامة
والمستشفيات ذات الأقسام المهيأة، بشكل خاص، لعلاج المصابين بالفايروس،
فان أسباب الفشل مرتبطة بانهيار النظام الصحي، بمجمله، وصعوبة الحصول
على الماء الصالح للشرب وانخفاض الصرف الصحي، خاصة بعد غزو البلد عام
2003. حيث انتشر وباء الفساد المالي والإداري بشكل مبكر وسريع. وبدأ
المسؤولون يتحدثون عنه بصيغة استنكار وإدانة منذ ذلك الحين. ففي عام
2005، مثلا، تحدث د. شاكر العيناجي، رئيس العمليات في وزارة الصحة، عن
تخصيص الوزارة مبلغ 518 مليون دولار لشراء 831 قطعة من المعدات الطبية
في النصف الثاني من عام 2004، إلا أنها اما لم تكن صالحة للاستخدام أو
أختلست. وقال د. شاكر إن الفساد منتشر لدرجة أنه يجب إعادة بناء القطاع
بمساعدة المجتمع الدولي. كان هذا قبل أن يصبح الفساد أخطر من الإرهاب
والكورونا معا، في تكلفته البشرية والمادية حاليا، وإعاقته مشاريع
البناء والتنمية الاقتصادية مستقبلا. فمؤشر التنمية البشرية للعراق
أدنى من معدلات الدول العربية وغيرها من البلدان المتوسطة التنمية.
تبدى تجذر الفساد في عقود بناء المستشفيات الوهمية أو غير المكتملة أو غير المستوفية لشروط السلامة، وعقود شراء المعدات والأجهزة والدواء والامدادات الطبية وانعدام صيانة وتأهيل المستشفيات
وقد تبدى تجذر الفساد في عقود بناء المستشفيات الوهمية أو غير المكتملة
أو غير المستوفية لشروط السلامة، وعقود شراء المعدات والأجهزة والدواء
والامدادات الطبية وانعدام صيانة وتأهيل المستشفيات. فقد تم تشييد أكثر
من نصف المستشفيات الموجودة في البلد في سبعينيات وثمانينيات القرن
الماضي. ويبلغ عدد الموجود حاليا 229 مستشفى، بما في ذلك 61 مستشفى
تعليميا و92 مستشفى خاصا و 2504 مستوصف، معظمها بلا طبيب. ومنذ عام
2012، وعلى الرغم من وصول ميزانية العراق رقما لم يسبق الوصول اليه
سابقا، ويعادل ميزانية عدة دول مجتمعة، إلا أن عدد الاسرة وفقًا للبنك
الدولي، لم يزد عن 1.3 سرير في المستشفيات لكل 1000 عراقي، انخفاضًا من
1.9 في عام 1980، و0.8 طبيب، وهو انخفاض كبير من 1.0 في عام 2014. وهذا
أقل بكثير من مصر والاردن. وخصص 154 دولارًا فقط للفرد للخدمات الصحية
في عام 2015، مقارنةً بإيران 366 دولارًا والأردن 257 دولارًا. تشير
هذه الارقام الموثقة الى استمرار التدهور الصحي بينما تواصل الحكومة
الإعلان عن مشاريع وتحسينات وإصلاحات بمبالغ خيالية. فتتلاشى المبالغ
ولا يبقى للمواطنين غير السراب.
ويشكل تناقص عدد الأطباء مشكلة حقيقية. فقبل الغزو، كان هناك حوالي 32
ألف طبيب في المستشفيات العامة والهيئات التعليمية. إلا أن الكثيرين
غادروا البلد بعد تعرضهم للتهديد والاعتداء والاختطاف بالإضافة الى من
تعرض للاغتيال، وازداد الأمر سوءا مع تعرض الاطباء للاعتداء من قبل
عناصر أمنية وأعضاء ميليشيات تعتبرهم مسؤولين عن وفاة احد المرضى.
ومع تدهور المستوى التعليمي، والتعيين حسب الانتماء الحزبي – الطائفي،
وانعدام النزاهة، لاغرابة أن تحصل وزارة الصحة على لقب « أكثر الوزارات
فسادا». حيث فاقت قيمة الفساد في وزارة الصحة 10 مليار دولار منذ 2003.
لعل أكثر صفقات الفساد إثارة للضحك المبكي هي صفقة «النعال الطبية»
باشراف وزيرة الصحة السابقة عديلة حمود، حيث تم شراء 26 ألف نعال طبي
بمبلغ 900 مليون دولار، في الوقت الذي تفتقد فيه المستشفيات لأبسط
أجهزة الفحص والأدوية الاساسية.
أدى انعدام الثقة بالحكومة، الى عدم اتباع تعليماتها وفيما يخص الاصابة
بالفايروس الى تفضيل المرضى البقاء في بيوتهم الا في حالات قليلة. حيث
باتت المستشفيات مكانا للموت وليس العلاج. ويفضل المصابون بكوفيد في
الكثير من الأحيان، الحصول على اسطوانات الأوكسجين لتلقي العلاج في
المنزل، بدلاً من الذهاب إلى المستشفى.
ولابد أن مقتل المصابين في مستشفى الخطيب سيزيد من عمق الفجوة بين
المواطنين وساسة الحكومة المبنية على الفساد بأنواعه، ويقلل من امكانية
اية إصلاح يدعيه المنخرطون في هذه الحكومة وأحزاب الميليشيات. فالإصلاح
الحقيقي يتطلب توفر الارادة السياسية والدعم الشعبي، وهو ما لن يتحقق
ضمن منظومة الفساد المستشري أو بالاعلان الحكومي المبتذل عن تشكيل لجنة
تحقيق لمعرفة اسباب الحريق، وكأنهم لا يعلمون انهم هم السبب، أو توجيه
رئيس الوزراء «بنقل جرحى حادثة حريق ابن الخطيب ممن يحتاجون للعلاج إلى
خارج العراق» مستخدما، باستهانة لا تغتفر، وصف جريمة قتل 91 مريضا،
لجأوا الى المستشفى للعلاج، بأنها «حادث».
كاتبة من العراق
هل انسحاب أمريكا من
افغانستان استعادة لإنسانيتها؟
هيفاء زنكنة
للمرة الثانية، منذ عشرة أعوام، يقوم رئيس أمريكي بتنفيذ قرار انسحاب
القوات الأمريكية من بلد تم غزوه واحتلاله بقرار من رئيس أمريكي سابق
له. كانت المرة الاولى حين أعلن الرئيس باراك أوباما الانسحاب من
العراق عام 2011، وحلت الثانية حين أعلن الرئيس جو بايدن، في 14 نيسان/
أبريل، عن جدول زمني لانسحاب كل القوات الأمريكية من افغانستان، في
موعد أقصاه 11 سبتمبر/ أيلول، الذكرى العشرين لهجوم القاعدة وما تلاه
من غزو قادته الولايات المتحدة. في كلا الحالتين، كان الرئيس جورج بوش
هو الذي اصدر قرار غزو البلدين، تحت شعار» محاربة الإرهاب». الشعار
الذي بات، عمليا، الاستراتيجية الأمريكية التي تم تطبيقها في أرجاء
العالم على مدى العشرين عاما الأخيرة. وكان من بين نتائجها الخسارة
البشرية الهائلة والخراب على مستوى البنية التحتية ومد الحكومات
المحلية بمغذي الفساد وقمع الانتفاضات الشعبية السلمية. وكان ابرز تلك
النتائج تصفية انتفاضات الربيع العربي سواء بإختراقها وتجنيدها من
الخارج في الصراع الدولي، أو باتهامها داخليا بالإرهاب واستغلال
الإسلاموفوبيا، لتحييد النخب المدنية وعزلها عن الجماهير الكادحة
والمهمشة.
أثار قرار بايدن حماس البعض الى حد القول بوجوب عدم التشكيك بخطوته بل
ووصفها بأنها تقترب من الراديكالية. فما هي مصداقية هذا المنظور ؟ ليس
بالامكان قراءة خطاب جو بايدن دون العودة الى خطاب أوباما. فنقاط
التشابه كثيرة ومهمة لمعرفة ما تحقق وما سوف يتحقق حول الانسحاب،
واقتراح البدائل، والرؤيا الأمريكية المستقبلية سياسيا وعسكريا. فمن
ناحية التوقيت، أعلن الرئيسان قرار الانسحاب بعد الفوز بالانتخابات،
كما يؤكد أوباما: « كما وعدت، ستعود بقية قواتنا في العراق إلى الوطن
بحلول نهاية العام… ستنتهي حرب أمريكا في العراق». كما يفتخر الرئيسان
بانجازات القوات الأمريكية واستحقاقهم العودة الى وطنهم. يقول أوباما «
سوف يعبر آخر جندي أمريكي الحدود إلى خارج العراق ورؤوسهم مرفوعة،
فخورون بنجاحهم». كما قال بايدن: «حان وقت عودة القوات الأمريكية إلى
الوطن». «حان الوقت لإنهاء الحرب الأبدية».
وفي الوقت الذي تجاهل فيه أوباما سبب وجود القوات الأمريكية بالعراق،
وما هي المهمة التي نفذتها هناك وجعلتهم فخورين بنجاحهم، ربما لمعرفته
أن معظم المسؤولين عن الغزو، اعترفوا في فترات متفاوتة بأنهم كانوا «
ضحية أكاذيب» اختار بايدن تكرار سبب الغزو وتحقيق النصر، اكثر من مرة،
قائلا : « ذهبنا إلى أفغانستان لاجتثاث القاعدة، لمنع الهجمات
الإرهابية المستقبلية ضد الولايات المتحدة المخطط لها من أفغانستان.
كان هدفنا واضحا. كان السبب عادلاً. لقد فعلنا ذلك. لقد حققنا هذا
الهدف».
ماذا عن العلاقة مستقبلا مع البلد المحتل بعد سحب القوات العسكرية؟ عن
العراق أخبرنا أوباما: «ستكون هناك شراكة قوية ودائمة. بوجود
دبلوماسيينا ومستشارينا المدنيين في المقدمة، سنساعد العراقيين على
تقوية المؤسسات التي تكون عادلة وتمثيلية وخاضعة للمساءلة. سنبني روابط
تجارية جديدة، وتجارة، وثقافة، وتعليم يحرر إمكانات الشعب العراقي. سوف
نتشارك مع عراق يساهم في الأمن والسلام الإقليميين، تمامًا كما نصر على
أن تحترم الدول الأخرى سيادة العراق». وهي صورة مشرقة، بإمكاننا القول،
الآن، أن أيا من جوانبها لم يتحقق بل وشُرعت أبواب العراق لكل انواع
الإرهاب، بضمنها الأمريكي. وبنفس الألوان يصبغ جو بايدن، حاليا، مستقبل
العلاقة مع أفغانستان، مؤكدا: «سنواصل دعم حكومة أفغانستان. وسنواصل
تقديم المساعدة لقوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية».
قرار الانسحاب من العراق كان بوش قد شرع بهندسته قبل أوباما، ونتيجة اتفاق في «لجنة بيكر» التي جمعت الحزبين لاسترجاع التوافق في السياسة الخارجية من المحافظين الجدد و»مشروع القرن الأمريكي الجديد»
إذا كان قرار جو بايدن قد استقبل بالترحيب، باعتباره خطوة نحو انهاء
عنصرية اليمين الترامبي فان علينا أن نتذكر ان قرار أوباما لقي ذات
الترحيب، سابقا، وكانت النتيجة ابقاء المطلوب من القواعد العسكرية مع
زيادة مستخدمي الشركات الأمنية والمرتزقة والعمليات الخاصة بالاضافة
الى استخدام الطائرات بلا طيار عشرة اضعاف ما كان مستخدما قبله. وتضاعف
الاستخدام خلال رئاسة ترامب بالاضافة الى اصداره قرارا ألغى فيه
التصريح بعدد الاستخدامات ايضا. مما منح الجيش والسي آي أيه الحرية
المطلقة في عمليات القتل والاغتيالات. كما نُذكر بأن قرار الانسحاب من
العراق كان بوش قد شرع بهندسته قبل أوباما، ونتيجة اتفاق في « لجنة
بيكر» التي جمعت الحزبين لاسترجاع التوافق في السياسة الخارجية من
المحافظين الجدد و«مشروع القرن الأمريكي الجديد» الذي أفشلته المقاومة
العراقية. كما أن قرار بايدن، استمرار لقرار كان ترامب قد اعلنه.
باعتبار ان استخدام القوات العسكرية، يشكل استنزافا اقتصاديا لأمريكا،
وليس من مصلحة أمريكا التضحية بجنودها، مجانا، لصالح دول اخرى، وضرورة
اعادة هيكلة الجيش الأمريكي.
هذه الحقائق، اشار اليها بايدن في خطابه ولكن بشكل ناعم مغلف بمفردات
«نبيلة» حول وجوب إعادة الجنود الى الوطن بعد أدائهم « مهمتهم
الإنسانية» بعيدا عن اهلهم. وبعنصرية تليق بالغزاة وصف كيف انه يحمل
منذ 12 عاما «بطاقة تذكرني بالعدد الدقيق للجنود الأمريكيين الذين
قتلوا في العراق وأفغانستان. هذا الرقم الدقيق، وليس رقمًا تقريبيًا أو
تقريبًا – لأن كل شخص من القتلى هم بشر مقدسون تركوا وراءهم عائلات
بأكملها». متعاميا عن حقيقة أن القوات الأمريكية بالعراق رفضت بشكل
مطلق ان تسجل عدد الضحايا العراقيين، وأن سبب غزو أفغانستان كان مقتل
2977 أمريكيا، بعملية ارهابية نفذها 19 قتلوا اثناء تنفيذ العملية،
بينما قدرت أبحاث جامعة براون الأمريكية، في عام 2019، عدد الضحايا بين
الجيش الوطني والشرطة في أفغانستان بأكثر من 64100 منذ أكتوبر 2001.
ووفقًا لبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (أوناما)، فقد قُتل
أو جُرح ما يقرب من 111000 مدني منذ أن بدأت في تسجيل الخسائر المدنية
في عام 2009.
تثير هذه الأرقام المخيفة تساؤلات مشحونة بالغضب: لماذا تقتصر
«القدسية» على حياة الأمريكي؟ ولم يعاقب بلد، تخريبا وقتلا، كعقاب
جماعي جراء عمل إرهابي ارتكبه 19 شخصا فقط؟ أليس الغزو واستمراره، لهذا
السبب، عملا إرهابيا، يجب محاكمة المسؤولين عنه وفق القانون الدولي ؟
وما الذي سيجلبه المستقبل من تغيير في العلاقة بين أمريكا وافغانستان
بعد الانسحاب ؟ يقول بايدن في ختام خطابه بأن فريقه العسكري يعمل على «
تنقيح الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الإرهاب الذي يستهدف أمريكا واعادة
تنظيم القدرات في مكافحة الإرهاب في المنطقة لرصد التهديدات الإرهابية
الكبيرة وانهائها ليس فقط في أفغانستان، ولكن في أي مكان قد تظهر فيه.
الإرهابيون موجودون في إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط وأماكن أخرى».
مما يعني أن سياسة « محاربة الإرهاب» ستبقى كاستراتيجية بعيدة المدى
لتطويع الشعوب والدول، اذا ما فكرت برفع رأسها للتنفس بعيدا عن بسطال
الشرطي الامريكي. الا انه يعني، أيضا، ان أمريكا لن تتمتع بالامان الذي
تنشده لنفسها ما لم، سواء في العراق أو أفغانستان، تعتذر عما ارتكبته
بحق الشعوب، وتعويضها والعمل على بناء علاقة مشتركة على قدم المساواة،
ووضع حد لدعمها الأنظمة الاستبدادية الفاسدة التي جعلت من بلدانها سوقا
للسلاح.
كاتبة من العراق
كيف لبغداد
لم تستسلم أن تسقط؟
هيفاء زنكنة
هل سقطت بغداد، فعلا، يوم التاسع من نيسان/ إبريل 2003؟ وما معنى
السقوط؟ للفعل « سقط» ومصادره عشرات المعاني التي تمتد من المكان الى
الإنسان. سقَطتِ المدينةُ : تم احتلالها من العدو. سقَط الشَّيءُ من
كذا : وقَع من أعلى إلى أسفل. سَقَطُ المتاع: ما لا خير فيه من كلِّ
شيء. السَّقْطُ :السَّاقِطُ من الناس، لئيم، حقير. أسقاط النَّاس:
أوباشهم وأسافلهم. أي تعريف ينطبق على بغداد؟ بغداد المدينة، بغداد
العاصمة؟ لماذا سقوط بغداد وليس الاستسلام أو الدحر أو الهزيمة أو
الاستيلاء أو الانتصار عليها؟
هل هو المكان أم الإنسان؟
من يبحث عن «سقوط بغداد» سيجد ثلاث صفحات من تاريخ يقودهم الى ما هو
أقدم وأعرق، الى موقع ومدينة وعاصمة، لكل واحد منها خصوصيته المذهلة،
وتماهيه مع العالم في آن واحد. لأنه، على خصوصيته لم يكن استثناء بل
امتدادا لحضارة إنسانية تتجه الى الأمام لولا «السقوط».
في الصفحة الاولى، دخل القائد المغولي هولاكو خان، حفيد جنكيز خان،
بغداد عام 1258، منتصرا، فنهبها وهدم مبانيها التي كانت آية من آيات
الفن الإسلامي وحرق كتبها. فتك بأهلها فلم يبق غير القليل. وكانت أعظم
الأعمال التهديمية التي ارتكبت هي تخريب البنية التحتية كالسدود ونواظم
الإسقاء. أليس هذا ما يفعله الغزاة حين يدخلون مدنا يعرفون جيدا انهم
لا يستطيعون إزالتها، كما رأينا، بأنفسنا، في العصر الحديث؟
كانت بغداد عاصمة الدولة العباسية ورمزالإمبراطورية الإسلامية. أرادها
الغزاة ان تبقى خربة، ضعيفة، متهالكة لتكون عبرة لمن قد يفكر
بمقاومتهم. فكانت بغداد بوابة السقوط لما تلاها. لتأجيل الحياة
والاكتفاء بالبقاء.
في الصفحة الثانية، عاشت بغداد بين كانون الأول/ ديسمبر 1916 و آذار/
مارس 2017، صراعا دمويا للاستحواذ عليها. كانت جزءا من الامبراطورية
العثمانية المحتضرة التي يتنافس على استيراثها الانكليز. فكان القتال
المرير على الارض العراقية وكان «سقوط» بغداد غنيمة غزاة جدد. وكان
العراقيون، كما بقية العرب، الذين عاشوا في ظل الامبراطورية العثمانية،
يظنون أن التعاون مع قوات التحالف ومن بينهم الانكليز، والتخلص من
العثمانيين، سيمنحهم الاستقلال. فكان الترحيب الاولي بالحاكم الانكليزي
الذي كان قد أدرك ضرورة دغدغة روح المرحبين وتطلعاتهم، فأصدر الجنرال
مود بيانا خاطبهم فيه قائلا : «لم تأت جيوشنا إلى مدينتكم وأرضكم كغزاة
أو أعداء ولكن كمحررين». ولم يطل الوقت لتزول اوهام من بنوا الآمال على
المحتل الجديد. فأجبروا على الانضمام الى ثورة الشعب حين وضع العراق
تحت الانتداب واعتمد البريطانيون تدابير لحماية مصالحهم فاندلعت الثورة
العراقية الكبرى أو ثورة العشرين، عام 1920.
بغداد الموسومة بأنها الأكثر قذارة في العالم على الرغم من ثروة البلد الهائلة، بغداد التي يجوب الموت شوارعها متمثلا بميليشيات ومرتزقة ولصوص يتحكمون ببرلمان ينطق باسمهم
وجلبت لنا صفحة التاريخ الثالثة تكرارا يجمع في ممارساته ما بين المغول
والبريطانيين. ليعيد تاريخ الغزاة نفسه كما هو وحشيا، مدمرا، مستغلا،
مع بعض التجميل الطفيف . فكان يوم 9 نيسان/ أبريل 2003. ومثل كل
احتلال، سبق الدخول الى بغداد عقود من التهيئة. ولكن بشكل تحديثي.
فكانت خطة الطريق لاحتلال بغداد، سياسية ـ إعلامية، منسوجة بالاكاذيب
وحصار اقتصادي انهك الناس وجعل أولوية التفكير محصورة بالحصول على
الاولويات. ومثل الغزو الاول والثاني، تبرع عراقيون بمساعدة الغزاة.
خلطوا بين التخلص من نظام عارضوه واحتلال الوطن. فشرعنوا الغزو وقتل
الأهل واحتفلوا بسماع صراخ الضحايا واصفين اياه بانه موسيقى. وتطلب
منهم اقناع الناس باحتلال بغداد، عاصمة العراق الأبي، ان يحتالوا حتى
على انفسهم، مخاطبين الشعب بأن الاحتلال هو الطريق الوحيد الى الحرية،
وديمقراطية المحتل هي النموذج الذي يجب ان يُحتذى إذا أرادوا أن
يتجاوزوا تخلفهم ليكونوا حضاريين. فكان تهديم المباني ونهب المتاحف
وحرق الوثائق.
وكانت الاعتقالات الجماعية. وكان التعذيب في أبو غريب والمساواة بين
النساء والرجال اغتصابا. وكان استهداف المدنيين قتلا تسلية للمحتلين
حين يشعرون بالضجر. وكان التقسيم الطائفي والعرقي، وصار صباح بغداد
جثثا مرمية في الشوارع. وشُرعت ابواب الوطن لكل من يستبيح كرامه أهله،
احتقارا واستهانة. والمواطن المنغمر بالخوف من الآخر. ولايزال مستخدمو
الاحتلال يقتاتون، على أكذوبة تحرير العراقي من الخوف.
واذا كانت اعوام الاحتلال قد هدمت الكثير، الا انها لم تنجح وبعد مرور
18 عاما، في دفع العراق الى الاستسلام والقبول بالخضوع عنوانا للحياة.
فبقي الغزاة غزاة والاحتلال احتلالا. ولم تنهر بغداد او تستسلم، لا
«رسميا» ولا شعبيا. بل بقيت عزيزة النفس، مقاومة. أطلقت طلقتها الاولى
برأس المحتل في اليوم الاول للاحتلال. وكان يوم 10 نيسان/ أبريل نقطة
انطلاق المقاومة العراقية من بغداد الى بقية المدن. من الموصل وكربلاء
والنجف الى الفلوجة. ضد قوات غزو بلغ عددها 147 ألف أمريكي و 15 ألف
بريطاني، مدججين بأحدث الأسلحة والتقنيات العسكرية وتغطية اعلامية
بملايين الدولارات. ولم تسقط بغداد.
هذه المدينة التي تصفها منظمات الرصد بأنها مركز حكومة من بين الأكثر
فسادا في العالم، حيث يشرب سكانها، يوميا، مياه غير صالحة للشرب وناقلة
للأمراض الخطيرة وحتى الموت. بغداد الموسومة بأنها الأكثر قذارة في
العالم على الرغم من ثروة البلد الهائلة، بغداد التي يجوب الموت
شوارعها متمثلا بميليشيات ومرتزقة ولصوص يتحكمون ببرلمان ينطق باسمهم.
هذه البغداد لم تتوقف يوما عن اثارة دهشة العالم بمقاومتها للخنوع
والانحناء امام الغزاة والمستبدين. تدهش العالم بنهوضها المرة تلو
المرة. تنبع من بين أحجار شوارعها ودرابينها أزهار لاتقل نضارة عن زهور
هيروشيما بعد رشها بالسلاح النووي الأمريكي.
ولم تسقط بغداد. رفعت رأسها عاليا، في قلبها النابض، في ساحة التحرير.
عام 2011 وتلتها انتفاضة تشرين / أكتوبر في 2019. توسع قلب المدينة،
سرت دماؤه في شرايين المدن فتكاثرت ساحات التحرير. من البصرة والناصرية
الى الكوت وبابل. يقيم فيها مواطنون يطالبون بوطن ( هل سمعتم قبل هذا
بمواطنين يطالبون بوطن؟). فبلغت تكلفة الوطن للسنة الواحدة 600 شهيد و
مئات الآف الجرحى وآلاف المعاقين. ثم يأتي من يقول لك أن الاحتلال كان
تحريرا أو تغييرا وان بغداد سقطت. أيمكن لـ«بغدادُ المحروسةُ بالاسمِ
الأعظمِ: بغداد» كما يصفها سعدي يوسف، أن تسقط؟
كاتبة من العراق
تطبيق العدالة الانتقالية
أو الانتقائية في العراق؟
هيفاء زنكنة
للمرة الثانية، منذ الاحتلال في عام 2003، يبرز بعض الاهتمام التوثيقي
بالعدالة الانتقالية بالعراق، من خلال اطلاق تقرير «العدالة الانتقالية
في العراق الذاكرة وأفق المستقبل» من قبل منظمة أفق للتنمية البشرية
ومؤسسة فريدريش ايربت الالمانية.
كانت المرة الاولى حين شرع المركز الدولي للعدالة الانتقالية،
بنيويورك، بالعمل داخل العراق، مباشرة بعد الاحتلال. حيث قام باصدار
اربعة تقارير، متوفرة باللغتين العربية والانكليزية، عن محاكمة
الأنفال، والدجيل المحاكمة والخطأ، وأصوات عراقية: مواقف من العدالة
الانتقالية وإعادة البناء الإجتماعي، وأرث مُر: دروس من عملية اجتثاث
البعث في العراق 2004 – 2012. استند التقرير الاخير، إلى أبحاث ميدانية
ومقابلات مع مسؤولين في الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث، مركزا
على « عملية تطهير المؤسسات من أعضاء حزب البعث» وهي، حسب التقرير،
أكبر وأشهر عملية عزل موظفين لأسباب سياسية في منطقة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا. وتضمن دروسا مستقاة من دول اخرى عاشت تجربة العدالة
الانتقالية بالاضافة الى توصيات اساسية لصانعي القرار لتلافي الأخطاء.
أكد المركز دائما بان فحوى عمله هو تقديم المشورة، خاصة في مجالات فحص
أهلية الموظفين المسؤولين عن تنفيذ العدالة. فقد راقب المركز، مثلا،
عملية اجتثاث البعث، مبينا عيوبها « مع التأكيد على أنه يجب تقييم
الأفراد بناءً على الأعمال السابقة، وليس على أساس العضوية في الحزب».
وبصدد الملاحقات القضائية، أثار المركز قضية التدخل السياسي والخلل
الوظيفي أثناء المحاكمات. كما قدم معلومات وتحليلات للمساعدة في
تصميم وتنفيذ برامج جبر الضرر الفعالة بعد أن التقى موظفو المركز
بأعضاء المجلس الأعلى لتعويض الضحايا لمناقشة طرق التعويض وصياغة
التشريعات. وقد شجع المركز العراقيين المعنيين على التعرّف على تجارب
البلدان الأخرى في عمليات البحث عن الحقيقة قبل اتخاذ أي قرار لإنشاء
مثل هذه الآلية. وأوصى بزيادة مشاركة الضحايا ومنظمات المجتمع المدني
في أية هيئة تهدف للبحث عن الحقيقة. ملخصا فكرة العدالة الانتقالية
بأنها العمل على تحقيق العدالة، واظهار الحقيقة، وجبر الضرر، والعمل
على عدم تكرار الممارسات المهينة وانتهاكات حقوق الإنسان مستقبلا.
فما هو الجديد الذي استدعى اصدار التقرير الأخير وما هي الإضافة الى
تقارير المركز السابقة، التي كان يجب الاستفادة منها تجنبا للتكرار
ولاستمرارية توثيق التجربة بجوانبها المتعددة ؟
لا اعتقد أن هناك إضافة جديدة في النصف الاول من التقرير، المكرس
للتعريف بآليات العدالة الانتقالية في القانون الدولي وأمثلة لتجاربها
في عدد من الدول. إلا أن هناك بعض الجوانب التي تم التطرق اليها للمرة
الأولى في النصف الثاني من التقرير المسمى « تجربة العدالة الانتقالية
في العراق في سياقها التاريخي والقانوني وآليات التطبيق وأثرها
الاجتماعي» والذي كان الأصح تسميته «فشل تجربة العدالة الانتقالية في
العراق» بناء على التفاصيل المذكورة فيه. وهو ما أكده استبيان، أنجزه
مؤلفو التقرير، شارك فيه 200 شخص، معظمهم كما تدل الاجابات مسؤولو
منظمات المجتمع المدني. عند سؤالهم عن الثقة بقدرة المنظومة القانونية
والإجرائية المتعلقة بمسارات العدالة الانتقالية ومدى نجاعتها لمنع
تكرار وقوع الانتهاكات التي اقرت من اجلها، أقر 70 بالمئة عن عدم
اعتقادهم بذلك، ولم يؤيده سوى 3.5 بالمئة فقط.
غياب الإرادة السياسية الصادقة، وهيمنة روح الانتقام، والطائفية، والإفلات من العقاب، والأكثر من ذلك هو استشراء منظومة فساد مالي وسياسي وإداري، اختزلت تحقيق العدالة بدفع التعويضات فقط
من بين الأسباب التي أعاقت تنفيذ العدالة الانتقالية بالشكل السليم،
حسب التقرير، أولا: مأسسة العملية والبلد تحت الاحتلال الانكلو –
أمريكي «، المسيطرعلى سلطة القرار التنفيذي والتشريعي فيه، دون مشاورة
مسبقة مع الشعب العراقي بل اقتصر عملها على التنسيق مع قوى المعارضة
التي تغيرت موازين القوة لصالحها بعد إسقاط النظام السابق».
ثانيا: اقتصار المجال الزمني للانتهاكات على حقبة حكم حزب البعث 1968 –
2003، والتي تشكلت عليها أسس العدالة الانتقالية، ولا يزال كما هو رغم
مرور 18 عاما على نهاية حكم البعث. يقترح مؤلفو التقرير، ان تشمل
العدالة الانتقالية الانتهاكات منذ ثلاثينيات القرن الماضي « وأبرزها
مذبحة سميل عام 1933 التي قامت بها الحكومة العراقية بحق أبناء الأقلية
الآشورية. وتهجير يهود العراق عام 1950… ثم انتهاكات حقوق الإنسان بعد
تغيير النظام 2003 – 2020، والتي تجسدت من خلال ضحايا الحرب الطائفية
في العراق 2008 – 2006، يسبقها ضحايا عمليات الاحتلال ومابعد الاحتلال،
ثم ضحايا الحركات المتطرفة ضد أبناء المناطق الغربية والجنوبية
والوسطى.. وضحايا داعش». ويذكر التقرير أن الأقليات الدينية والقومية
هي المتضرر الأكبر، بكل المستويات، وان مسلسل الانتهاكات الجسيمة مستمر
وبأشكال مختلفة كما في تظاهرات تشرين الأول 2019 باعتبارها «واحدة من
اهم ملامح انهيار منظومة حقوق الإنسان في العراق حيث قتل اكثر من 800
متظاهر، وجرح وإعاقة الآلاف منهم، بالإضافة الى خطف واختفاء المئات
منهم.. ويبقى استهداف الناشطين مستمراً، دون اي كشف للحقيقة». ويضمن
التقرير في مراجعته مسار التطبيق في إقليم كردستان قائمة انتهاكات ضمت
ضحايا الاقتتال بين الحزبين الكرديين الرئيسيين وضحايا مجزرة بشتا شان
من الشيوعيين.
إن توسيع حقب الانتهاكات، وهي مهمة ليست سهلة، تستدعي تقييم كيفية
تطبيق العدالة الانتقالية لضحايا الحقبة الحالية الممتدة بلا تحديد
زمني قانوني. مما يتطلب الإجابة على السؤال الاهم أولا، وهو هل ما تم
العمل به هو عدالة انتقالية فعلا؟ تدل مراجعة عمل المؤسسات التي
استحدثت وآليات التطبيق على ان العدالة الانتقالية تحولت ضمن التجربة
العراقية الى عدالة انتقائية – انتقامية. تمركزت حول احتكار الحقيقة من
قبل السلطة والجهات الرسمية وانتقائية « الضحايا» وكتم انفاس الحقيقة
بما يسمى جبر الضرر، حيث أسست اللجان والمؤسسات بدون تشريع قانوني او
مشاركة الشعب عبر منظمات المجتمع الاهلي والمدني او تشكيل لجان حقيقة
بامكانها توثيق سردية الانتهاكات، من اعتقال وتعذيب وقتل، بشكل محايد
بعيدا عن التضخيم والتخيل وروح الانتقام، لئلا يتم تكرارها مستقبلا.
ينتهي التقرير بقائمة تشخيص وتوصيات طويلة، توحي للقارئ بانها محاولة
لضخ الحياة في تجربة أخفقت بقوة من ناحية تطبيق المفهوم الحقيقي
للعدالة. وأسباب الاخفاق معروفة للجميع مهما كان نبل التعابير
والمصطلحات المستخدمة. وهي غياب الإرادة السياسية الصادقة، وهيمنة روح
الانتقام، والطائفية، والافلات من العقاب، والأكثر من ذلك هو استشراء
منظومة فساد مالي وسياسي وإداري، اختزلت تحقيق العدالة بدفع التعويضات،
فقط، ضمن سياسة منهجية لاستقطاب المؤيدين.
بينما يتطلب تطبيق العدالة الانتقالية، استقلال البلد، والارادة
السياسية الصادقة وان تبنى العملية على مشاورة ومساهمة أبناء البلد،
أنفسهم، في اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان حق الضحايا في معرفة
الحقيقة، والعدالة، وجبر الضرر، وعدم التكرار، لضمان مصالحة ماضي
العراق مع حاضره أملا بحماية مستقبله.
جائزة كتاب فلسطين
ومقاومة تزييف التاريخ
هيفاء زنكنة
لم تكن الهوة بين الشعوب العربية
وحكوماتها أكبر وأعمق منها، مما نعيشه، حاليا، حول فلسطين. ففي الوقت
الذي سارعت فيه حكومات عربية، الى إعلان التطبيع الرسمي مع الكيان
الاستعماري العنصري، تزداد مقاومة الشعب الفلسطيني تجذرا، ونشاطات
مناهضة التطبيع الشعبية العربية انتشارا، وحملات التضامن العالمي
والانضمام الى حملة المقاطعة تزايدا حول العالم.
لم يعد تبرير استخذاء الحكومات وخضوعها لابتزاز وضغوط شرطي العالم من
جهة وتبريرها بأنها تفعل ذلك من أجل « السلام» وانهاء « النزاع
الفلسطيني الاسرائيلي» ، من جهة أخرى، ساري المفعول. كما انتهت صلاحية
ادعائها بأنها تحقق ما يصبو اليه الجيل الفلسطيني والعربي الجديد. فيوم
الأرض، مثلا، لايزال جزءا من الذاكرة التي يحاولون طمسها. وتنوعت
مستويات المقاومة، بفضل مبادرات الجيل الجديد الذي يواصل نضال آبائه
واجداده ، سواء كان داخل أو خارج فلسطين. يحملون شعلة المقاومة،
بأشكالها وتنوعاتها، لوحدهم أو مع المتضامنين مع عدالة القضية
الفلسطينية عالميا.
يركز عدد من المبادرات الفلسطينية العالمية على الجانب الثقافي لمقاومة
الاحتلال، وأن تكون السردية الفلسطينية أداة حفظ الذاكرة ومواجهة
عمليات التزوير. ولنقل الرواية الفلسطينية إلى أوسع جمهور ممكن أطلقت
منظمة (ميدل إيست مونيتور) جائزة كتاب فلسطين عام 2011. احتفاء
بإنجازات الكُتاب ، أينما كانوا، في الكتابة عن فلسطين ولتشجيع
الناشرين على نشر الكتب المعنية بفلسطين ، كما يذكر د. داود عبد الله،
رئيس المنظمة. واذا كانت فكرة الجائزة قد بدأت كفكرة بسيطة فانها نمت
وتطورت خلال العشر سنوات، نتيجة العمل الدؤوب لفريق مؤمن بفلسطين
وأهمية الكتب، وعلى رأسهم الصحافية الناشطة فكتوريا بريتن، والزميل
د.ابراهيم درويش، وكان لي شرف الانضمام الى الكادر في العام الثاني
للجائزة.
كيف نقيم عمل الجائزة بعد عشر سنوات على تأسيسها ؟ تمكنت الجائزة ،
تدريجيا، من جذب انتباه دور النشر والجامعات والمؤلفين المستقلين، في
ارجاء العالم ، حيث باتت تتقدم بكتبها الصادرة عن فلسطين ، المستوفية
لشروط الجائزة الرئيسية بأن يكون الكتاب عن فلسطين وباللغة الانكليزية
وتمت طباعته خلال العام السابق لمنح الجائزة. واذا كان عدد الكتب
مقياسا للنجاح فتجدر الاشارة الى ان العام الاول شهد استلام 20 كتابا
ووصل العدد في الاعوام الاخيرة الى خمسين كتابا، تغطي موضوعات واسعة،
من السياسة والاقتصاد وحقوق الانسان الى القصة والرواية والشعر
والمذكرات وكتب الأطفال والرسم والتصوير والطبخ. أما المؤلفون فانهم من
جنسيات ودول مختلفة بالاضافة الى الجيل الجديد من الفلسطينيين داخل
فلسطين بالاضافة الى المهجرين في ارجاء المعمورة. ما يجمعهم هو
التزامهم المبدئي بحقوق الشعب الفلسطيني وايمانهم، ككتاب وأكاديميين
وشعراء وفنانين، بمقاومة الاحتلال عن طريق نشر المعرفة عن فلسطين
وشعبها وتحدي الصورة النمطية لمظلومية المُستَعمر، مع بقاء معيارها هو
الأصالة والإبداع في البحث.
قضية الشعب الفلسطيني ليست قضية خلاف أو نزاع بل قضية مقاومة استعمار استيطاني عنصري
وقد تطورت الجائزة لتصبح حدثا
سنويا له مكانته ، في الساحة الادبية البريطانية. حيث يتطلع الجمهور
المهتم ، الى حضور الامسية المقامة عادة في اليوم السابق لاعلان
الفائزين، بلندن، للاستماع ومناقشة مؤلفي الكتب المرشحة للقائمة
القصيرة. وكان الاستثناء الوحيد لهذا التقليد، هو ما تم في نوفمبر، من
العام الماضي، حيث نوقشت الكتب المرشحة وتم الإعلان عن الفائزين،
بواسطة تطبيق زوم على الانترنت ، بسبب الحظر المفروض على الاجتماعات
لانتشار كوفيد 19.
في تلك الامسية، كانت د. ريما خلف ضيفة الشرف. والمعروف ان د. ريما
كانت قد استقالت من منصب وكيل الأمين العام والأمين التنفيذي للجنة
الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) عام 2017،
عندما رفضت سحب تقرير مؤثر عن معاناة الفلسطينيين تحت الحكم الإسرائيلي
؛ خلص التقرير إلى أدلة دامغة على أن إسرائيل أقامت نظام فصل عنصري
يضطهد ويسيطر على الشعب الفلسطيني ككل ، وفي أي مكان يقطنه. وهي،
حاليا، عضو مؤسس ورئيس «المنظمة العالمية لمناهضة التمييز العنصري
والفصل العنصري»
لخصت د. ريما ، في كلمتها اثناء الأمسية، الأسباب التي جعلت الجائزة
متميزة، ومن بينها «تركيزها على موضوع كان حتى وقت قريب تحت الحصار في
معظم دول العالم الغربي. كانت محاولة نشر كتاب عن فلسطين هناك ، ولا
سيما كتابًا ينتقد إسرائيل ، بالنسبة للكثيرين، مهمة محبطة، إن لم تكن
غير مجدية».
وأعطت أمثلة تبين مدى خوف الناشرين في المملكة المتحدة من نشر كتب قد
تسيء ، بنظرهم للصهيونية ، ويتعرضون جراء ذلك لمقاطعة منظمة لجميع
كتبهم، حيث « اضطر المؤلف آلان هارت أن يؤسس شركته الخاصة لنشر الطبعة
الأولى من كتابه: «الصهيونية: العدو الحقيقي لليهود». كما كانت ترجمة
الكتاب إلى اللغة الإنكليزية صعبة بنفس القدر إذا تضمن أي شيء قد يبدو
أنه يشوه صورة إسرائيل».
وقد تم ترتيب برنامج يمتد على مدى الشهور المقبلة على موقع المنظمة
للاحتفال بمرور العشر سنوات. يضم البرنامج مقابلات مع مؤلفين حازوا على
الجائزة وناشرين وشخصيات فلسطينية واجنبية ساهمت بدعم المشروع.
بالاضافة الى انتاج فيديو يحكي قصة الجائزة. وسيصدر خلال العام كتاب
يضم كلمات ضيوف الشرف بالاضافة الى لوحات فنية وقصائد مختارة.
ان استلام ما يقارب 400 كتاب عن فلسطين ( وهو ليس كل المنشور) على مدى
عشر سنوات، دليل مادي على مدى الاهتمام المتزايد بفلسطين كقضية عادلة
غير قابلة ، كما يدحض زيف دعاة التطبيع مع المحتل بحجة اقامة «
السلام». فقضية الشعب الفلسطيني ليست قضية خلاف أو نزاع بل قضية مقاومة
استعمار استيطاني عنصري، وما التطبيع غير تنفيذ المخطط الامبريالي من
قبل حكومات عربية مستبدة.
والكتب المؤلفة عن فلسطين ، كأداة انتاج ثقافي معرفي وحفظ للذاكرة،
سواء كانت ضمن القائمة المختصرة أم لا ، هي جزء من سيرورة النضال
للوصول الى الحل الحقيقي وهو انهاء الاحتلال وتحقيق العدالة كمفهوم
للعيش بكرامة ومساواة.
والدرس الأوسع من النجاح النسبي في تجربة جائزة كتاب فلسطين هو امكانية
تغيير السردية التي تفرضها الهيمنة السياسية الاستعمارية والصهيونية في
المجال الفكري والثقافي، عبر جهد مثابر، ومتواصل يشترك فيه الناشطون من
جميع الثقافات. وهو أمر ينطبق على مقاومة تزييف تاريخ الحروب التي شنت
تحت لافتة محاربة الإرهاب واهمها جريمة غزو وتدمير العراق، كما على
تاريخ الكولونيالية في بلدان العالم الثالث عموما.
كاتبة من العراق
عن النصر والحرية بعد
18 عاما من غزو العراق
هيفاء زنكنة
«في معركة العراق، انتصرت الولايات المتحدة وحلفاؤنا». أعلن الرئيس
الأمريكي جورج دبليو بوش من على متن حاملة طائرات، في الأول من مايو /
أيار 2003، واقفاً مباشرة تحت لافتة، كُتب عليها « أنجزت المهمة». وكان
قد دَشَن، قبلها، حملة « الصدمة والترويع» على العراق، في 19 آذار/
مارس. حينها أكد الرئيس بوش لشعبه والعالم «إن تحرير العراق تقدم حاسم
في الحملة ضد الإرهاب. لقد أزلنا حليفًا للقاعدة، وقطعنا مصدر تمويل
الإرهاب». مؤكدا « لن تحصل أي شبكة إرهابية على أسلحة دمار شامل من
النظام العراقي، لأن النظام لم يعد موجودًا».
لم يدم النصر طويلا، حتى بمفهوم الادارة الأمريكية للنصر. فقد فككت
أحداث الايام والسنوات التالية كل ما قامت أمريكا وبريطانيا، مع
متعاونين عراقيين، بتصنيعه من أكاذيب لتسويق الحرب ضد العراق. وقد
أظهرت كل المراجعات والوثائق وحتى شهادات المسؤولين المشاركين في
«المهمة» عمق الخدعة التي استخدمت لصناعة الرضا حول حرب عدوانية ضد شعب
قاسى من حصار لا إنساني على مدى 13 عاما. وتحول النصر الموعود، المزجج
بألوان «التحرير» و«الديمقراطية» إلى مفرخة لإرهاب منظمات ودول على
حساب تخريب بلد واستباحة حقوق وحياة مواطنيه. مما دفع هانز فون سبونيك،
ممثل الأمين العام للامم المتحدة السابق، الى القول «لم يبق بند في
ميثاق حقوق الإنسان لم ينتهك بالعراق بعد احتلاله». ودفعت كثرة
الاعدامات نافي بيلاى، المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم
المتحدة، الى وصفه بأنه «مسلخ بشري».
يأخذنا حال العراق اليوم، ونحن نقف على عتبة مرور 18 عاما على «انجاز
المهمة» الأمريكية ـ البريطانية، الى مستويات المقاومة التي واجه بها
المواطنون قوات الاحتلال وما أسست له من مشاريع تقسيم طائفية وعرقية
ونهب اقتصادي. حيث كانت المقاومة المسلحة، اولى مستويات النضال. فكانت
الفلوجة رمزا أراد المحتل والمتعاونون المحليون ابادته بكل الطرق
الممكنة. من القصف بأسلحة محرمة دوليا الى تشويه المقاومة وتهديم 70
بالمئة من المدينة. كان الثمن غاليا. ولم تتح للمقاومين فرصة الاحتفال
بفعل المقاومة والاستبسال، اذ تمت سربلتهم، في حملة إعلامية مكثفة،
محليا خاصة، بالإرهاب. التهمة الجاهزة التي لم يعد بامكان أي معارض
يرفع صوته احتجاجا للدفاع عن نفسه ازائها. تدريجيا، تعمقت قدرة توليفة
الحكم (الطائفية + الفساد) على كتم انفاس شعب، محكوم عليه بالمادة 4
مكافحة الإرهاب، وشهادة المخبر السري، والقضاء الفاسد، بعد تعريضه
للتعذيب والاغتصاب الذي امتد الى الرجال كما النساء. الأمر الذي دفع
منظمة العدالة الانتقالية الدولية الى كتابة تقرير خاص حول الموضوع،
احتل فيه العراق مركز الصدارة.
جددت الانتفاضة الأمل بإمكانية التغيير الحقيقي وليس مجرد تدوير الوجوه والمناصب بشكل تزويقي، وكانت ستحقق أهدافها فعلا لولا انتشار الكوفيد وما صاحبه من حظر صحي. ومع ذلك، لم تنطفئ الشرارة
إعلاميا، لم يعد عراق اليوم موضوعا «مثيرا» تستثمره اجهزة الإعلام لجذب
القراء. انه، على الاغلب، محاط بالصمت. واذا ما حدث وأشير اليه
لارتباطه بحدث « مثير» كما في زيارة البابا الاخيرة، فانه يُصنف تحت
الصورة النمطية المعتادة لبلدان العالم الثالث، من الشرق الاوسط
وافريقيا الى امريكا اللاتينية. كواحد من بلدان لديها حكومة وطنية،
منتخبة، وجيش وقوانين ودستور. أما مشاكله من فساد ورشوة واقتتال داخلي،
فهي، أيضا، جزء من الثقافة السائدة في تلك البلدان. تتقبل فيها الشعوب،
باستسلام قدري، قادتها غير الأخلاقيين والفاسدين الذين يمارسون السلطة
من خلال المحسوبية.
بتقديم هذه الصورة، يُنفى واقع الاحتلال وجرائمه وما سببه من فتح
الأبواب أمام التدخل الإيراني، ومأسسة ميليشيات يزيد عددها على
الاربعين، وزرع بذرة الانتقام المتمثلة بالمنظمات الإرهابية. في ذات
الوقت الذي تمكن فيه المحتل الأمريكي/ البريطاني من تغيير دوره من محتل
الى متدخل بمهمة انسانية، لتقديم المساعدة والاستشارة والتدريب للحكومة
«الديمقراطية» حديثة الولادة، مع التأكيد المستمر أن وجودهم، مهما كان
شكله وحجمه، انما يتم بناء على دعوة الحكومة العراقية.
الا ان سياسة وصم المقاومة بالإرهاب التي نجحت، الى حد ما، في بعض
المحافظات، وصورة الاستسلام القدري في محافظات اخرى، والتخويف من (
الآخر) أسقطتها انتفاضة تشرين/ اكتوبر 2019 ز فكانت صرخة «نريد وطنا» و
« وكلا للاحتلال الأمريكي والإيراني» جماعية. وجاء رد فعل النظام
والقوى التي يستقوي بها وحشيا. فعوقب المحتجون السلميون باستخدام قوات
الأمن الذخيرة الحية ضدهم. وحين عادت المرأة الى ساحات التحرير
لاستعادة دورها النضالي، جوبهت بالاختطاف والاعتقال والانتهاكات
الجسدية. سلب النظام حياة 600 متظاهر وجرح الآلاف.
جددت الانتفاضة الأمل بإمكانية التغيير الحقيقي وليس مجرد تدوير الوجوه
والمناصب بشكل تزويقي، وكانت ستحقق أهدافها فعلا لولا انتشار الكوفيد
وما صاحبه من حظر صحي. ومع ذلك، لم تنطفئ الشرارة. بقيت متوقدة في مدن
متعددة من بينها الناصرية (محافظة ذي قار) على الرغم من كل اساليب
القمع والقتل وتصاعد ظاهرة الاختطاف والاختفاء القسري. حيث كشفت مفوضية
حقوق الإنسان في العراق، في الاسبوع الماضي، عن تلقيها 8 آلاف بلاغ عن
حالات اختفاء قسري للمواطنين خلال السنوات الأربع الأخيرة. وشهدت
الايام الاخيرة تصاعد وتيرة التظاهرات في مدينة النجف، حيث بيت المرجع
الشيعي الأعلى علي السيستاني الذي زاره البابا فرانسيس، يوم 6 مارس/
آذار. والمفارقة أن يؤكد المرجع للبابا «اهتمامه بأن يعيش المواطنون
المسيحيون كسائر العراقيين في أمن وسلام وبكامل حقوقهم الدستورية»
وهاهي القوات الأمنية تواصل عنفها المعتاد واطلاق قنابل الغاز والرصاص
ضد المتظاهرين ومنع إسعاف المصابين منهم، على مقربة من بيته. فهل هذا
ما يعنيه بتمتع سائر العراقيين بالامن والسلام والحقوق الدستورية؟
«الخائفون لا يستحقون الحرية» واحد من شعارات المنتفضين التي بقيت
ترفرف عاليا في ساحة التحرير، ببغداد، وساحة الحبوبي في الناصرية، وهو
شعار يعبر، في عمقه، عن روح مقاومة المحتل، المتمثلة بالفلوجة رمزا،
والنضال ضد الطائفية والفساد، من اجل الحرية والكرامة والعدالة، في
ارجاء العراق. وهي روح لاتزال تنبض بالتحدي وعدم الخضوع، على الرغم من
مرور 18 عاما على محاولة دحرها.
كاتبة من العراق
نحن والغرب… النساء
لسن أخوات كما يقال لنا
هيفاء زنكنة
لم تحظ المرأة، في أرجاء العالم، على مدى قرون، بالاهتمام الإعلامي
الذي حظيت به في الشهور الأخيرة، ولأسباب مختلفة. من بين أسباب هذا
الاهتمام المتأخر نجاح المرأة في تحقيق انجاز مؤثر، في مجالها الذي
تعمل فيه، وهناك ما يدل على انه سيؤدي الى تغيير حياة آخرين مستقبلا
بالاضافة الى تأثيره الحالي، بالإضافة الى النجاح في تطبيق القوانين
المشرعنة لحماية حقوق المرأة، وأولها حق الحياة، في بعض الدول.
هناك، ايضا، الاهتمام الإعلامي المرتبط بـ« نجومية» عدد من النساء، على
مستوى كوني، وكونهن محط متابعة شعبية لأسباب فنية او تجارية، أو ضحية
اعتداء أو جريمة تهز المجتمع أو تأسيس مشروع بحاجة الى التسويق
الإعلامي التجاري من خلال تسويق نفسها. واذا كانت هذه الموضوعات لا
تختلف كثيرا عما يحظى به الرجل، الا ان منبع الاختلاف هو التركيز
والتكثيف الذي نالته، أخيرا، وساعدت مناسبة اليوم العالمي للمرأة في
الثامن من الشهر الحالي، على زيادته، خاصة وقد أصبح اليوم، مثل عديد
الايام المناسباتية، عابرا للحدود ويكاد يكون جسرا يوصل بين نساء
العالم. أو هذا ما تحاول شعارات الاحتفالات التي تقيمها الحكومات
والمنظمات الدولية والمحلية، ارتدائه للاحتفاء بـ « نخبة» من نساء يتم
انتقائهن من قبلهم. ونادرا ما تكون عملية الاختيار واقعية بمعنى تمثيل
غالبية النساء، بل تخضع لحسابات سياسية وإيديولوجية أو دينية. مما يؤدي
الى اقصاء المبدعات والمؤثرات الحقيقيات، وتهميش أدوارهن، وطمس امكانية
ان يصبحن نموذجا يحتذى من قبل الأخريات.
ويتبدى هذا بشكل واضح، أكثر من غيره، في بلداننا الخاضعة لأنظمة يعيش
ساستها حالة انفصام الشخصية (شيزوفرينيا) أسمها « وجود المرأة». حيث
يحبذون توقيع الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق المرأة كمواطنة،
ويتباهون بها، ولا مانع لديهم من سن القوانين التي تدين وتعاقب مرتكبي
العنف ضدها، الا انهم نادرا ما يعملون على تفعيلها، لتصبح القوانين
مجرد بودرة مكياج لتجميل وجه قبيح. فهم بحاجة دائمة الى تبييض وجوههم
أمام العالم الخارجي/ الغربي، والتصريح الدائم بانهم يعملون على تحقيق
المساواة وردم هوة التمييز بين المرأة والرجل.
كشف الاهتمام الإعلامي المكثف، اخيرا، المستويات المتعددة للعنف ضد
المرأة، من خلال مقارنة وضعها بين دولة وأخرى، ومدى التقدم الذي احرزته
في الغرب، حتى على مستوى الاستخدام اللغوي للتعابير والمصطلحات،
بالمقارنة مع بلداننا. مما يضيف الى شيزوفرينيا ساسة الانظمة لدينا،
ازدواجية المعايير في الدول الغربية، والتلاعب الذكي بالقوانين
والاتفاقيات الدولية.
فالعنف الذي يستهدف امرأة واحدة في الغرب، مهما كانت درجته، يطرح
للنقاش العام، والمساءلة، ومحاسبة مرتكبه، واحتمال اجراء تغيير لصالح
المرأة ضمن القوانين المرعية. فجريمة قتل الشابة البريطانية سارة
إيفرارد، وهي في طريق عودتها الى دارها بلندن، صار حدثا شغل المسؤولين
والقانونيين والمنظمات النسائية حول حرية المرأة في الأماكن العامة
وكيفية حماية حقها هذا. كما أثار ظهور الممثلة الأمريكية ميغان، زوجة
الامير هاري، في مقابلة تلفزيونية، أشارت فيها ألمها، اثناء حملها، حين
سأل احد اعضاء عائلة زوجها، عن لون بشرة ابنها، ضجة كبيرة حول العنصرية
داخل العائلة المالكة والمجتمع عموما، باستقطاب لم تشهده بريطانيا من
قبل، مع تدخل سياسي وشعبي أمريكي، فاكتسب الحدث الشخصي، بعدا تجاوز
الخاص الى العام، بسبب نجومية ميغان وانتماء الزوج الطبقي والتسويق
الإعلامي المثير للمقابلة.
إن العمل المشترك، بكل السبل الممكنة، لترسيخ حق المواطنة في بلد حر ومستقل، هو المسار الذي سيُنّمي ثقافة مجتمعية تعيد تنظيم العلاقات بين مواطني البلد الواحد وتمتد للتواصل مع بقية البشر، على قدم المساواة
في ذات الوقت، تمر معاناة ملايين النساء في بلداننا، كحاشية في مقالة
قلما يقرأها أحد. حيث تعيش المرأة أوضاعا وانتهاكات مرعبة في معسكرات
تضم ملايين النازحين. أرقام واحصائيات من الصعب جدا استيعابها. اربعة
ملايين ونصف المليون نازح ومهجر سوري في معسكرات ببلدان مختلفة. ووصل
الاحساس بالخوف وعدم الأمان والفقر المدقع بالعوائل العراقية النازحة،
منذ سنوات، في المخيمات الى توسل العوائل البقاء في المخيمات. فما بدأ
مؤقتا صار دائميا في بلد يعتبر من الدول الغنية بالعالم. وتعيش المرأة
اليمنية لحظات احتضار ابنائها بسبب سوء التغذية بينما تقف مع بقية
النساء في طوابير طويلة، بانتظار استلام «المساعدات الإنسانية» من
بلدان يقوم معظمها ببيع السلاح لتغذية الحرب في ذات البلد. فأي مستقبل
تحمله الايام المقبلة لأبناء هذه العوائل سواء كانوا اناثا أو ذكورا،
في ظل مفارقة مبكية يصبح فيها الموت، جوعا وقصفا، هو من يحقق المساواة
بين الجنسين؟
كيف يمكن للمرأة، في بلداننا، تحقيق ما تصبو اليه من كرامة وعدالة
وحرية؟ وكيف تتمكن من تحسين وضعها وهي تواجه زيف ادعاءات الأنظمة
القمعية بتحقيق المساواة بالتعاون مع نساء يدرن منظمات «نسوية» وورشات
تنتهي، غالبا، بتخريج نساء، يحفظن ويكررن عن ظهر قلب شعارات جاهزة عن «
تمكين المرأة» و« تعزيز مشاركة المرأة في القيادة وعملية صنع القرار»
و«الديمقراطية والنوع الاجتماعي» بينما لايتم التطرق الى الأسباب
الحقيقية لتدهور وضع المرأة، على كافة المستويات، كما نرى في وضع
المرأة العراقية، بسبب الاحتلال وانعكاساته وتنصيب حكومات فاسدة يجمع
افرادها ما بين التخلف الديني والمجتمعي واحتقار المواطنين بلا
استثناء؟
لقد أثبتت لنا سنوات الاحتلال الصهيوني لفلسطين والاحتلال الانكلو
أمريكي للعراق، مثلا، ان تجزئة القضايا يساعد على تجذير الاختلاف، بشكل
مَرَضي، وتمديد بقاء الاحتلال ولكن تحت مسميات جديدة. وان هذه التجزئة
لا ترتقي بالعلاقات الانسانية بل تبين ان مفهوم نضال المرأة ليس واحدا،
وان النساء لسن « أخوات» كما يقال لنا.
مما يجعل جوهر الحل هو الإيمان بان قضية المرأة هي قضية الرجل. وليس
كافيا جلب امرأة للجلوس على منصة الخطب بين عشرة رجال يحتكرون الحديث
عن السياسة والاقتصاد والسيادة، تاركين مساهمة زميلتهم على المنصة « عن
المرأة» فقط وليس عن السياسة والاقتصاد والسيادة، وكانها امور لا
تعنيها. الأمر الذي يدفعها، فورا، خارج خريطة الحياة العامة التي يرون
أنفسهم معماريها. بينما المطلوب ان تكون حاضرة ومساهمة فاعلة في كل
الجوانب، وجنبا الى جنب مع الرجل الذي هو نفسه بحاجة الى التحرير. إن
العمل المشترك، بكل السبل الممكنة، لترسيخ حق المواطنة في بلد حر
ومستقل، هو المسار الذي سيُنّمي ثقافة مجتمعية تعيد تنظيم العلاقات بين
مواطني البلد الواحد وتمتد للتواصل مع بقية البشر، على قدم المساواة.
كاتبة من العراق
كانت زيارة البابا
إلى العراق تاريخية فعلا؟
هيفاء زنكنة
«جئت، رأيت، انتصرت». هل لهذه العبارة الشائعة باللغة اللاتينية،
المنسوبة إلى يوليوس قيصر، وكان قد استخدمها في رسالة إلى مجلس الشيوخ
الروماني، عام 47 قبل الميلاد، لابلاغهم عن انتصاره السريع ضد عدوه،
علاقة بزيارة البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، الى العراق في 5 مارس/
آذار، والانتصار هنا بمعنى تحقيق هدف ما، أم ان الاقتباس الاصح هو
«جئت. رأيت. غادرت» ولم يتحقق شيء؟ وهل كانت الزيارة، كما وصفت من قبل
آلاف المواقع واجهزة الإعلام والناطقين الرسميين، في جميع انحاء
العالم، بأنها «حدث تاريخي» فعلا؟
ان وصف حدث ما بأنه «تاريخي» يعني بأنه حدث مهم للمستقبل، أو من
المحتمل أن يكون مهما، مستقبلا، أي أنه يؤدي إلى تغيير كبير، على مدى
فترات زمنية طويلة، لأعداد كبيرة من الناس. بهذا المعنى، يمكن القول إن
الحرب العالمية الثانية هي حدث تاريخي كما هو الغزو الانكلو أمريكي
للعراق. حيث تعتمد تاريخية الحدث على ربطه بتغيرات تتكشف بسردية أكبر
من «اهميته» في اللحظة الآنية، ولا تعتمد على المنظور الشخصي أو
لاستيفائه الغرض منه في الوقت الراهن. فالتاريخ، كما هو معروف، ليس
سلسلة من احداث بل استمرارية وتغيير. من هنا، سيكون مدى التغيير،
بمقياس التقدم والتراجع، الذي ستؤدي اليه زيارة البابا فرانسيس هو
المحك الحقيقي لتاريخية الحدث. لا ان يلتقي بالمرجع الديني السيستاني،
وان كان يحظى بالاحترام والتقدير، أو يزور موقعا أثريا لاداء صلاة
جماعية، مع عدد من رجال الدين العراقيين والتقاط الصور معهم، والقاء
الخطب، واطلاق التصريحات عن «السلام والوحدة والتآخي والتسامح بين جميع
مكونات الطيف العراقي الملون والجميل».
كما ان علاقة الحدث بالإعلام وتغطيته، مهما كانت مكثفة، وصبه قطرة
قطرة، تدريجيا، في دماغ الجمهور، لا يعني انه حدث تاريخي. فمقابلة
لزوجين ميغان ماركل والأمير هاري مع الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري
استقطبت ملايين الناس من جميع انحاء العالم لأن التسويق الناجح وبشكل
مقتطفات يومية وبمهارة في صياغة وكيفية تقديم الحبكة جعلت المقابلة
«حدثا» يترقبه الكثيرون لكنه ليس حدثا تاريخيا. فالحدث التاريخي هو ما
سيغير حياة الناس في المدى البعيد وبعد غربلته من البهرجة والتلوينات
المزركشة وكثير منها نفسي وذكي إعلاميا. فاضراب العمال، في منطقة نائية
بالهند، مطالبين بحقوقهم، لا اهمية له جماهيريا ما لم يغط إعلاميا
بطريقة توصله الى بقية الناس، كما تقول الكاتبة والناشطة الهندية
أرونداتي راي.
بعيدا عن البهرجة الإعلامية المبتذلة التي استهلها النظام العراقي بسير
البابا ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بين صفين من رجال البادية الذين
أشهروا سيوفهم عاليا في الهواء، برمزية مقلقة، أقرب ما تكون الى وحشية
داعش، لم يلتق البابا الا بقلة من الناس العاديين، وان كان قد خاطب
الكل قبل مجيئه، قائلا «لقد فكرت فيكم كثيرا منذ عدة سنين» إذ كان
محاطا، طوال الوقت، بفرق الحماية والساسة الفاسدين. ساسة جعلوا من
مقايضة الوطن والشعب، عملة لبقائهم الطائفي والعرقي، وادخلوا بتعاونهم
مع قوى الاحتلال الارهاب، بابشع صوره، ضد كل المواطنين، وأولهم
الأقليات، ثم وقفوا يتباكون استجداء للدعم المادي الدولي لانقاذ البلد
المهدد بالارهاب، من جهة، ويتشدقون بالسلام والمحبة من جهة أخرى.
أما مدى «تاريخية» الزيارة فلنترك الحكم عليها للشهورالمقبلة، أن ترينا فيما لو نجح البابا في إحداث تغيير في حياة من أعلن حبه لهم
«لتصمت الأسلحة! ولنضع حدا لانتشارها هنا وفي كل مكان! ولتتوقف المصالح
الخاصة، المصالح الخارجية التي لا تهتم بالسكان المحليين. ولنستمع لمن
يبني ويصنع السلام!» قال البابا. لعله أراد بذلك انقاذ حياة البقية
الباقية من المسيحيين الذين تراجع عددهم من مليون ونصف قبل الاحتلال
عام 2003 إلى 400 ألف أو أقل من ذلك اليوم (لأن العراق بدون تعداد
سكاني منذ ربع قرن) واقناعهم بالبقاء في بلد هو بلدهم. وهو خيار صعب
جدا اذا ما ادركنا حجم التهديد والخطر الذي يتعرضون له، يوميا، من كل
الجهات الهادفة الى تفتيت العراق، خاصة مع عدم وجود ما يشير إلى أي
تغيير ايجابي، ولو بشكل الارتفاع درجة واحدة من الحضيض الذي انحدر اليه
البلد جراء الاحتلال والفساد والطائفية والميليشيات المسلحة.
في كلمته المذاعة قبل وصوله العراق، قال البابا ان هدف زيارته هو «لكي
التمس من الرب المغفرة. والمصالحة بعد سنين الحرب والإرهاب. ولاسال
الله عزاء القلوب وشفاء الجراح». وهي أهداف انسانية فعلا لولا أنه كان
بالامكان تحقيقها وهو موجود في دولة الفاتيكان بدون ان يتكلف، وهو
المسن، عناء السفر، ويعرض حياة الآخرين لخطر الوباء المنتشر في بلد
يعيش خراب الاحتلال والفساد المنعكس على خدماته الصحية المنهارة. كان
بامكانه الاطلاع على حجم الظلم الذي يعيشه العراق وأهله منذ عام 2003
وان يطلع، في آلاف التقارير الحقوقية المحلية والدولية، بضمنها تقارير
الأمم المتحدة، على المسؤول الحقيقي عن الانتهاكات والجرائم التي
استهدفت المسيحيين والإيزيديين وكل من يرفع صوته احتجاجا، وآخرها حملة
التهديد والاختطاف والقتل العلني للمتظاهرين السلميين. صحيح انه أشار
الى ضرورة «التصدي لآفة الفساد» و«سوء استعمال السلطة» ولكن هذا هو
بالضبط ما يكرره الساسة اللصوص. وكما كتب احد المعلقين على الفيسبوك: «
لسنا بحاجة لأن يخبرنا البابا بذلك. بارك الله فيه».
إلا ان البابا نفذ مهمة ما كان بامكانه تنفيذها عن مبعدة وهي زيارة
المرجع الديني الشيعي علي السيستاني في داره، بالنجف. وفي الوقت الذي
لم يكف فيه البابا عن الصلاة والقاء الخطب طوال ايام زيارته، وبضمنها
رأيه باللقاء، اطلعنا على رأي السيستاني من خلال بيان أصدره مكتبه. وهو
أمر معهود اذ لم يُسمع السيستاني يوما وهو يخطب او ينطق او يتواصل حتى
مع أتباعه. جاء في البيان ان سماحة السيد تحدث عن معاناة « شعوب
منطقتنا… ولا سيما الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة». وبصدد معاناة
المسيحيين «أكّد اهتمامه بأن يعيش المواطنون المسيحيون كسائر العراقيين
في أمن وسلام وبكامل حقوقهم الدستورية». وكما نعلم أن هناك فرقا كبيرا
بين «الاهتمام» و«التنفيذ».
اختتم البابا زيارته بالتجول في مدينة الموصل المهدمة ووقف متأملا بحزن
الخراب الذي ألحقه تنظيم داعش باحدى الكنائس القديمة، كما التقى بعدد
من اهل الضحايا الإيزيديين والمسيحيين والكرد. ولا ندري إن كان أحدا ما
قد اخبره عن الخراب والموت الذي سببه القصف الأمريكي للموصل. ولعله
اختار أن يتجاهل توقيت زيارته المصادف في الأيام السابقة لشن الحرب
العدوانية ضد العراق التي سببت قتل مليون شخص.
أما مدى «تاريخية» الزيارة فلنترك الحكم عليها للشهورالمقبلة، أن ترينا
فيما لو نجح البابا في إحداث تغيير في حياة من أعلن حبه لهم أو أن
زيارته لا تزيد عن كونها « جئت. رأيت. غادرت».
كاتبة من العراق
هل مظاهرات العراقيين
ضد إيران أو أمريكا؟
هيفاء زنكنة
تحمل أيام هذا الشهر، حدثا كارثيا تحاول الذاكرة، عبثا، مسحه. إنه
الشهر الذي ارتفعت فيه حمى التهيئة وتقديم «الأدلة» المبررة لغزو
العراق، ومن ثم غزوه واحتلاله، من قبل امريكا وبريطانيا، بمساعدة
«معارضين» عراقيين.
نلاحظ هذه الايام، انحسار تحميل البلدين مسؤولية التخريب الذي حل
بالبلد والقائها، من قبل ساسة ومتظاهرين وبشكل كلي على إيران، التي لا
ينكر أحد دورها التخريبي المتبدئ بأحزاب وعصائب وميليشيات ارهابية. الا
أن محاولة فهم الخراب الاقتصادي والسياسي والمجتمعي لن تكتمل ما لم نعد
خطوات الى الوراء لتعقب بداية المسار ومسؤولية امريكا وبريطانيا في
الوضع المأساوي الحالي.
تم خلال شهر آذار/ مارس 2003، تسريع الترويج لكذبة، وتضخيمها بشكل مذهل
ومبتذل في آن واحد، عن خطر عراقي يدعى أسلحة الدمار الشامل. أسلحة قيل
ان بامكانها محو الشعب الأمريكي من على وجه الارض خلال ايام، وبامكانها
استهداف الشعب البريطاني بيولوجيًا أو كيماويًا خلال 45 دقيقة، حسب
رئيس الوزراء البريطاني توني بلير. كذبة تلقفتها الادارة الأمريكية،
وقدمها الرئيس جورج بوش في عديد الخطب والتصريحات. « النظام العراقي
يمتلك أسلحة بيولوجية وكيميائية، ويعيد بناء المنشآت لصنع المزيد،
ووفقًا للحكومة البريطانية، يمكن أن يشن هجومًا بيولوجيًا أو كيميائيًا
في أقل من 45 دقيقة بعد إصدار الأمر «، كرر بوش ما قاله بلير ثم أعاد
المسؤولون في أمريكا وبريطانيا تدوير الأكذوبة. « ليس هناك شك في أن
صدام حسين يمتلك الآن أسلحة دمار شامل. ليس هناك شك في أنه يحشدها
لاستخدامها ضد أصدقائنا… وضدنا «، قال ديك تشيني، نائب الرئيس
الأمريكي. الخيار الوحيد هو الحرب « لإظهار أننا سوف ندافع عن ما نعرف
أنه على حق، لإظهار أننا سنواجه أنظمة الاستبداد والديكتاتوريات
والإرهابيين الذين يعرضون أسلوب حياتنا للخطر»، صرح توني بلير.
مع ازدياد قرع طبول الحرب، انتشر الخوف من الآخر، من العراق، ومن
اسلحته المبيدة للحياة. تعميم دفع وزارة الداخلية الى ان تنصح
الأمريكيين بتخزين الأغطية البلاستيكية والأشرطة اللاصقة لحماية أنفسهم
من الهجوم الإشعاعي أو البيولوجي المتوقع. بهذه الطريقة الدعائية
الإعلامية تم تجريد عموم العراقيين، وليس صدام حسين لوحده كما يدّعون،
من انسانيتهم. لم يعد العراقي إنسانا يستحق الحياة بل إرهابيا يستحق
الموت وبأي طريقة ممكنة حتى اذا خرقت القانون الدولي والإنساني، وحتى
اذا أدى الى « التمرد ضد الولايات المتحدة و زيادة التعاطف الشعبي مع
الحركات الإرهابية» كما حذر مجلس الاستخبارات القومي بوش في يناير
2003. ويشير سجل الاجتماع بين بوش وبلير في 31 يناير/ كانون الثاني
2003، أن بوش كان يعتزم غزو العراق حتى لو لم يعثر مفتشو الأمم المتحدة
على دليل يثبت وجود أسلحة دمار شامل. بل كان مستعدا حسب قوله لتوني
بلير أن يرسل « طائرات استطلاع يو 2، للتحليق فوق العراق وهي مطلية
بألوان الأمم المتحدة لإغراء القوات العراقية بإطلاق النار عليها،
الأمر الذي من شأنه أن يشكل خرقا لقرارات الأمم المتحدة» وبالتالي يدفع
الأمم المتحدة الى اصدار قرار يشرعن الحرب العدوانية ضد العراق.
لم يعد العراقي إنسانا يستحق الحياة بل إرهابيا يستحق الموت وبأي طريقة ممكنة حتى إذا خرقت القانون الدولي والإنساني
اعلاميا، استفادت الادارة الأمريكية والحكومة البريطانية، من «المعارضة
العراقية»، خاصة في مرحلة الترويج للحرب. وهل هناك ما هو أكثر نجاحا في
التسويق من استخدام عراقيين يدعون الى « تحرير» العراق؟ وكان الكونغرس
الأمريكي قد ضاعف تمويل جماعات المعارضة إلى أكثر من 25 مليون دولار في
عام 2000. تم تخصيص 18 مليون دولار منها للمؤتمر الوطني العراقي الذي
يتزعمه أحمد الجلبي، فقام الجلبي بتأسيس صحيفة «المؤتمر» وتوظيف مجموعة
من الكتاب والشعراء الذين وجدوا أنفسهم في توجه «ليبرالي» يدعو الى
بناء « الديمقراطية» ولو عن طريق شن الحرب والاحتلال. وكان الشخص
الاقرب الى الجلبي والاكثر نشاطا في دعم الغزو الأمريكي هو كنعان مكية،
الاستاذ الجامعي المقيم بامريكا، الذي رأى في الجلبي قائدا « مختلفا عن
السياسيين العرب. لم يكن لديه أية مشكلة حول التعامل مع إسرائيل،
والمسألة العربية الإسرائيلية، كما لم يكن لديه أي عظم قومي عربي في
جسده». ومكية، كما هو معروف، الشخص الذي أخبر الرئيس بوش، قبل شهرين من
بدء الحرب، في اجتماع في البيت الأبيض، أن العراقيين سيرحبون بقوات
الغزو الأمريكي بـ «الحلوى والزهور». في مكية وجد الغزاة ضآلتهم.
«أعتقد حقًا أنه سيتم الترحيب بنا كمحررين» كرر تشيني. «ما من شك أننا
سنكون موضع ترحيب» قال وزير الدفاع رامسفيلد.
لم تكتف الادارة الأمريكية باستخدام المعارضة واستضافة « نسويات»
عراقيات لالتقاط الصور مع بوش وكوندليزا رايس وباقي طاقم المحافظين
الجدد، وهن يتحدثن عن أملهن بالتحرير، بل سبقت ذلك حملة قصف مكثفة
وطلعات جوية بلغ عددها حوالي 22 ألف طلعة وقصف 349 موقعا. عاش الشعب
العراقي خلالها يوميات خوف ورعب وحصار. مخاوف ناس عاديين وثقتها
الفنانة الراحلة نهى الراضي، في كتابها الرائع « يوميات بغدادية».
في خطابه المشهور أمام الأمم المتحدة، الذي قدم فيه « أدلة» تثبت
امتلاك العراق اسلحة الدمار الشامل، قال وزير الخارجية كولن باول: «كل
تصريح أدلي به اليوم مدعوم بمصادر، مصادر قوية. هذه ليست تأكيدات. ما
نقدمه لك هو حقائق واستنتاجات تستند إلى معلومات استخبارية قوية «.
تبين، بعد الغزو، ان مصدر الحقائق التي استندت اليها أمريكا في غزوها
العراق، هو مهندس عراقي لاجئ في المانيا، يدعى رافد أحمد علوان
الجنابي. اعترف في 15 فبراير 2011، لصحيفة الغارديان، إنه لفّق حكايات
عن شاحنات أسلحة بيولوجية متحركة ومصانع سرية بعد استنطاقه من قبل
المخابرات الالمانية والبريطانية. واضاف «لقد منحوني هذه الفرصة. سنحت
لي الفرصة لابتكار شيء لاسقاط النظام. كانوا يعلمون انني كاذب منذ
منتصف 2000 ».
إن مراجعة سيرورة صناعة الاكاذيب التي أدت الى تخريب البلد، وقتل ما
يزيد على المليون مواطن، اما بشكل مباشر أو غير مباشر، وانعكاسات
الخراب على البنية الاجتماعية، وفتح الأبواب امام ارهاب الدول
والمنظمات، يؤكد مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا
والمتعاونين معهما من العراقيين أولا، ومن الضروري التذكير بذلك لئلا
ننسى، ولكي تقودنا الاحتجاجات والاعتصامات، بتكلفتها البشرية العالية،
الى الاستقلال الحقيقي وليس التدمير الذاتي الناتج عن تفتيت الأدوار.
كاتبة من العراق
المعلن والمستور في تقرير
بلاسخارت عن العراق
هيفاء زنكنة
ما هو الانطباع الذي يتركه الاصغاء أو قراءة تقرير يطرحه مسؤول أممي
امام مجلس الأمن الدولي وهو مشحون بالعبارات التالية: «وكما سمعتموني
أؤكد من قبل. واليوم، لا يسعني إلا أن أكرر ما قلته. وكما قلت سابقا.
وأقول مرة أخرى»؟
هذا ما كررته السيدة جنين بلاسخارت، رئيسة بعثة الأمم المتحدة في
العراق ( اليونامي) مرارا، في تقريرها أمام مجلس الأمن، في 18 شباط /
فبراير، الذي تناولت فيه « ما يأمل العراقيون تحققه عام 2021، في عديد
الجبهات وأهمها الانتخابات والإصلاح الاقتصادي وتعزيز سيادة القانون
وتوفير بيئة أكثر أمناً للجميع» حسب تعبيرها. والمعروف أن السيدة
بلاسخارت حظيت منذ تعيينها، بالعراق، بضجة، لم تثرها أمرأة أخرى تحتل
منصبا رسميا فيه. فأخبارها، بما فيها صور من تلتقي بهم وتفاصيل
تصريحاتها وحتى ما ترتديه، نظرا للظرف العام المحيط بعملها وتوقعات
الناس منه، محط اهتمام، يمنحها، ظاهريا، سلطة أكبر بكثير من صلاحياتها
وطبيعة موقعها.
وفي ظل أجواء الاحباط العام وكثرة التقارير، غير المجدية، المستهلكة
للورق، والتصريحات « التوافقية» للأمم المتحدة، باتت بلاسخارت الوجه
الذي تركزت عليه النقمة، والتعليقات الغاضبة، والساخرة، وحملات
المطالبة بطردها، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى نكاد ننسى
بأنها ممثلة منظمة لا يمكن ان تمارس عملها، ما لم تحصل على موافقة
الحكومات والدول التي تفتح مكاتبها فيها، وان تقاريرها وتصريحاتها
محكومة باحتمال سحب الموافقة او حتى المحاربة اذا ما تجاوزت حدودها.
فاليونامي، مثلا، تأسست اثر الاحتلال، عام 2003، بناء على طلب حكومة
العراق. وأنها لا تملك صلاحية تنفيذ القرارات بل يقتصر عملها على تقديم
المشورة والمساعدة في مجالات شاملة، بالإضافة الى العمل مع الشركاء
الحكوميين والمجتمع المدني لتنسيق الجهود الإنسانية والإنمائية لوكالات
الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها.
ضمن هذه الهيكلية، استهلت بلاسخارت تقريرها بتقديم صورة عن الجانب
الاقتصادي. فأشارت الى تخفيض قيمة الدينار العراقي بما يزيد عن 20
بالمئة في نهاية العام الماضي، وتزامنه مع ارتفاع 40 بالمئة من عوائد
النفط، مما أدى إلى التخفيف من أزمة السيولة، وتوفير متنفس للحكومة،
للمضي قدماً فيما اعتبرته قضايا ملحة مثل تقديم الخدمات العامة ورواتب
الموظفين الحكوميين. الجانب الثاني الذي تناولته، هو عدم اقرار قانون
ميزانية العام الحالي حتى الآن، منتقلة بعده إلى الموعد الجديد
للانتخابات العامة وهو العاشر من تشرين الأول/ اكتوبر 2021، واصدار
البرلمان التشريع اللازم لتمويل الانتخابات، وبداية تسجيل المرشحين
والتحالفات، وتحديثات سجلات الناخبين. وحثت المجلس على الموافقة على
طلب الحكومة العراقية بخصوص المراقبة الانتخابية لأهميته البالغة. وكما
هو متوقع، أكدت أن منظمة الدولة الاسلامية «داعش» لاتزال نشطة في
البلاد مما يقتضي استمرار الدعم ضد الإرهاب. عن الوضع الانساني
للاجئين، بينت بلاسخارت ان الحكومة جددت جهودها لإغلاق مخيمات النازحين
العراقيين- العديد منهم نساء وأطفال.
لا يمكن الخروج من الوضع المأساوي المتدهور أكثر فأكثر بدون ايجاد الحل لها، من بينها وجود الميليشيات وارتكابها الجرائم بلا مساءلة وإرهابها المواطنين وسيطرتها على مقدّرات الدولة
قد تبين قراءة الخطوط العامة للتقرير أن بلاسخارت تستحق، فعلا، حملة
التسقيط التي تشن ضدها الا ان القراءة المتأنية تشير الى انها استخدمت
لهجة، كشفت فيها مدى تدهور الوضع في العراق، بكافة الجوانب التي
تناولتها، وان حاولت عدم تجاوز الحدود المرسومة لعمل منظمة الأمم
المتحدة. حيث أبدت أسفها لعدم تنفيذ تدابير الاصلاح الاقتصادي وذلك
لعدم مصاحبته « المعركة ضد الفساد الاقتصادي والسياسي وتعزيز الحوكمة
القوية والشفافية والمساءلة». وعادت لابداء الاسف ازاء « الحقيقة
المُرة» بأن التوصل إلى اتفاق نهائي ودائم بين العراق الاتحادي وإقليم
كردستان بشأن المسائل المتعلقة بالميزانية وقضايا أخرى أكبر، لا يزال
أمراً بعيد المنال. وان المفاوضات « تتسم بطابع سياسي متأصل وتعكس
استفحالاً للهواجس وانعدام الثقة». وباختصار شديد « أن الوضع الراهن
مخيب للآمال بشكل خاص» وينعكس على استقرار البلد بكامله.
ولم يتوقف احساس بلاسخارت بالأسف عند هذا الحد بل امتد ليشمل قرار
الحكومة باغلاق مخيمات النازحين وعدم الاصغاء لتوصيات البعثة بتوفير
تدابير آمنة وكريمة لحل مشكلة النزوح بدلا من التسرع والتعتيم، مما أدى
الى نتائج كارثية، مثل النزوح الثانوي أو عودة الناس إلى مناطق تفتقر
إلى المأوى والخدمات الأساسية. كما ذكّرت بأن هناك ما يقرب من 30 ألف
عراقي يقيمون في مخيم «الهول» بسوريا، بمن في ذلك عراقيون لا ينتمون
لتنظيم داعش، وعلى العراق مسؤولية استعادة مواطنيه، ابتداءً بالحالات
الإنسانية. «وأقول مرة أخرى: يتوجب التعامل على نحو عاجل، وبلا مزيد من
التأخير، مع الحالات الإنسانية لمن لا ينتمون لتنظيم داعش».
وقدمت، عند تطرقها الى ما يتعرض له المتظاهرون من قمع، معنى
الديمقراطية الغائب في البلد، قائلة : « اسمحوا لي أن أعلن بوضوح أن
القمع وانتهاكات الحريات الأساسية – بما في ذلك حرية التعبير والتجمع
السلمي – والاختفاء القسري والقتل المستهدف، كل ذلك لا مكان له في
الديمقراطية. ولسوء الحظ، لا تزال الشفافية والعدالة والمساءلة غائبة
إلى حد كبير – لا سيما عندما يتعلق الأمر بقمع الاحتجاجات الشعبية في
جميع أنحاء العراق، بما في ذلك في إقليم كردستان» محذرة بأن الغضب
العارم سيندلع مرة أخرى عاجلاً أم آجلاً، إذا لم يتغير الوضع. واختتمت
بلاسخارت تقريرها بالتأكيد على اهمية الانتخابات المقبلة وأملها في ان»
تكون الانتخابات موضع ثقة، وأن تحل المساءلة محل الترهيب، وأن تسود
الشفافية، وألا يكون الولاء معروضا للبيع».
لقد تناولت بلاسخارت، كما أشارت في بداية تقريرها، جوانب عدة من الوضع
العراقي، الا أنها تفادت طرح مسائل مهمة جدا، لا يمكن الخروج من الوضع
المأساوي المتدهور أكثر فأكثر بدون ايجاد الحل لها، من بينها وجود
الميليشيات وارتكابها الجرائم بلا مساءلة وإرهابها المواطنين وسيطرتها
على مقدّرات الدولة. كما لم تشر الى التدخلات الخارجية، خاصة الإيرانية
والتركية، الا بجملة غامضة، مفادها « يواصل القادة العراقيون الحفاظ
على علاقات مفتوحة خدمة للسياسة الخارجية التي تؤكد على سيادة العراق»؟
في الوقت الذي قدمت فيه الانتخابات كما لو كانت الأمل المرجو بدون
التطرق الى ان الميليشيات المهيمنة بأحزابها الحاكمة هي ذاتها التي
ستخوض الانتخابات، وهي ذاتها التي قدمت لها بلاسخارت توصياتها سابقا،
ولم يؤخذ بها اطلاقا. ولعل هذا هو مبعث « أسفها» و«سوء حظها» ويأسها من
تكرار توصياتها، الذي يُستشف بوضوح في كافة الجوانب التي تطرقت اليها،
وان كانت لا تريد الاعتراف به بحكم منصبها.
كاتبة من العراق
نافذة للأمل
من فيتنام إلى العراق
هيفاء زنكنة
من بين الأخبار القليلة المفرحة التي تناقلتها وكالات الأنباء، أخيرا،
نجاح الصحافية والناشطة فان تران تو نيجازاده، الفيتنامية الأصل
والفرنسية الجنسية المولودة عام 1942، في رفع دعوى قضائية ضد 14 شركة
متورطة في تصنيع وبيع المادة الكيميائية المسماة «العامل البرتقالي»
إلى الحكومة الأمريكية، المنخرطة حينها في الحرب ضد فيتنام.
من بين الشركات التي رفعت الدعوى ضدها شركة مونسانتو (المعروفة
بانتاجها وتسويقها البذور المعدلة وراثيا) التي تملكها، حاليا، شركة
باير الألمانية المعروفة، عالميا، بانتاجها الأدوية أيضا. وكانت فان
تران قد عانت هي نفسها من أمراض نادرة جراء التعرض لآثار العامل
البرتقالي.
«العامل البرتقالي» هو مبيد أعشاب ونازع لأوراق الأشجار، وهو أكثر
فاعلية بنحو 13 مرة من مبيدات الأعشاب العادية. قامت القوات الأمريكية
برش 80 مليون ليتر من هذه المادة السامة فوق جنوب فيتنام في الفترة بين
1962 و1971، محاولة بذلك حرمان مقاتلي فيتنام الشمالية ( الفيتكونغ) من
الغطاء الذي توفره لهم الغابات ضد القصف الجوي الأمريكي، بالإضافة الى
حرمانهم وحاضنتهم الاجتماعية من مصادر الغذاء. أدى الاستخدام الأمريكي
للمبيد القاتل الى إصابة ملايين الفيتناميين بأعراض لم يشهدوا لها
مثيلا ولحقبة زمنية تجاوزت سنوات الحرب الى أيامنا هذه. اذ أدى تسرب
المبيد من التربة الى المياه الجوفية والأنهار الى تعريض الفيتناميين،
من اجيال تالية، الى إعاقات عقلية وجسدية وهاجمة مناعة الجسم. ولا تزال
تتسبب في ولادة أطفال برؤوس متضخمة أو أطراف مشوهة، وانتشار الإصابة
بالسرطان، بالاضافة الى الأضرار التي لحقت بالبيئة. من بين الضحايا ،
عوائل قررت عدم انجاب الأطفال بسبب انجابها اطفالا مشوهين، وأخرى أنجبت
خمسة عشر طفلا لم يعش منهم غير ثلاثة. وتشير احصائيات فيتنام الحكومية
الى إن نحو ثلاثة ملايين فيتنامي تعرضوا للعامل البرتقالي وأن مليون
شخص يعانون من تأثيرات خطيرة على الصحة من بينهم 150 ألف طفل على الأقل
يعانون من عيوب خلقية.
حتى تاريخ النظر الحالي في الدعوى، كانت الحكومة الأمريكية قد قامت
بتعويض جنود في الجيش الأمريكي والأسترالي والكوري عانوا من عواقب
استخدام المادة الكيميائية في الحرب. إلا أن ذلك لم يشمل المواطنين
الفيتناميين على الرغم من محاولات الضحايا المستمرة، وتنامي التعاون
الأمريكي مع فيتنام كدولة ضمن الصراعات الإقليمية المتغيرة، اذ لم
تعترف الحكومة الأمريكية أو الجهة المصنعة لهذه المادة الكيميائية
بمسؤوليتها.
مما دفع الناشطة فان تران الى اقامة الدعوى ضد الشركات المنتجة في
فرنسا. تتحجج الشركات، متعددة الجنسيات، بأنه لا يمكن تحميلها
المسؤولية عن استخدام الجيش الأمريكي لمنتجاتها التي انتجتها، وان
الشركات ، كما ذكر محامي مونسانتو، «تصرفت بأوامر من الحكومة ونيابة
عنها».
سببت القذائف أضرارا صحية متعددة، ومنها السرطانية والجينية والتشوهات الخَلقية. حيث سجلت ارتفاعا ملحوظا في مستويات التشوهات الخلقية، وارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان، وظهور أمراض وتغيرات غير عادية في نسبة الجنس عند الولادة
إن سبب اعتبار خبر رفع الدعوى مفرحا لا يعود، فقط، الى مشاعر التضامن
مع ضحايا الجريمة الأمريكية بل، ايضا، الى اقترابهم من تحقيق العدالة،
ومحاسبة المسؤولين، قانونيا، عن جريمة حطمت حياة الملايين، على مدى
عقود. وهو يماثل ما نطمح الى تحقيقه لضحايا قذائف اليورانيوم المنضب
المستخدمة ضد العراق. اذ استخدمت القوات المسلحة الأمريكية والبريطانية
ذخائر اليورانيوم المنضّب في مناطق مأهولة بالسكان، خاصة في جنوب
العراق؛ طوال العمليات العسكرية لاحتلال العراق في عام 2003، ما أدى
إلى تلوث المنطقة بالمواد المشعة، بالاضافة الى استخدامها في حرب
الخليج الاولى، عام 1991، وهي الفترات التي يقدم تفاصيلها بدقة علمية
رصينة بحث د. سعاد العزاوي المعنون « تقدير مخاطر استخدام أسلحة
اليورانيوم المنضّب في العراق».
سببت القذائف، كما تؤكد عشرات الدراسات والبحوث العلمية ، أضرارا صحية
متعددة، ومنها السرطانية والجينية والتشوهات الخَلقية. حيث سجلت
ارتفاعا ملحوظا في مستويات التشوهات الخلقية عند الولادة، وارتفاع
معدلات الإصابة بالسرطان، وظهور أمراض وتغيرات غير عادية في نسبة الجنس
عند الولادة، خاصة في أعقاب الهجمات التي قادتها أمريكا على مدينة
الفلوجة، غرب العراق، في عام 2004. وهو الهجوم الذي يوصف بأنه الأكبر
الذي خاضته قوات المارينز (البحرية الأمريكية) منذ حرب فيتنام 1968.
وقام فيه الجيش الأمريكي بالتعاون مع قوات بريطانية وعراقية، بأمرة
إياد علاوي، رئيس الوزراء حينئذ، باستخدام اسلحة اليورانيوم بالاضافة
الى الفسفور الابيض.
تختلف حالات ولادة الأطفال المشوهين خلقيا وانتشار الأمراض السرطانية
بين النساء والأطفال في المدن التي تعرضت الى اشعاع اليورانيوم المنضب
، عن بقية جرائم الاحتلال من ناحيتين، الاولى انها تشكل جريمة حرب
تتنافى مع قوانين الحرب الإنسانية لأنها تستخدم اسلحة يبقى تأثيرها
القاتل على المدنيين بعد انتهاء الحرب واسبابها. الثاني، لأنها وبسبب
تأثيرها القاتل ببطء على الأطفال والنساء، جميعا بلا استثناء وبمساواة
مخيفة، انما تشكل جريمة ابادة لمستقبل العراق كله وتؤثر بدرجة او أخرى
على المنطقة كلها بسبب هبوب غبار الموت عليها وتلوث المياه والبيئة
بشكل عام.
تكرر الحكومة الأمريكية في العراق ما فعلته في فيتنام، اذ ترفض،
الاعتراف بأنها استخدمت مواد مشعة يبقى تأثيرها القاتل على السكان بعد
انتهاء الحرب، وتهربا من المسؤولية القانونية وما يترتب على الاقرار
بذلك من تبعات تعويض الضحايا المتضررين وتنظيف للأماكن بعد تزويد
الجهات المعنية باحداثياتها، تنفي ومعها بريطانيا الاعتراف بتأثير
اليوراينوم المنضب. وحتى الآن، ترفض الولايات المتحدة تقديم المعلومات
الضرورية، الأمر الذي يعيق تنفيذ عمليات تقييم وإدارة التطهير
اللازمتين، بل هناك ما يدل على ممارسة الضغوط على الجهات الرسمية
العراقية لغض الطرف عن فتح هذا الملف الذي سيمنحها حق المقاضاة وأن
تكون، كما هو مفروض، صوتا للضحايا وممثلة لمواطنيها.
إن رفع الدعوى ضد الشركات المنتجة للمادة السامة التي استخدمها الجيش
الأمريكي ضد الشعب الفيتنامي يمنحنا الأمل، مهما كان صغيرا، في تحقيق
العدالة، مستقبلا، لضحايا جريمة استخدام الولايات المتحدة الأمريكية
قذائف اليورانيوم المنضب ضد الشعب العراقي. وهو أمل تقع مسؤوليته لنقله
من مستوى التمني الى التحقيق الفعلي، في غياب العمل الحكومي الرسمي،
العمل المكثف المثابر من قبل الناشطين في مجال حقوق الإنسان، والمنظمات
الإنسانية المحلية والعالمية، بالتعاون بطبيعة الحال مع العلماء
والباحثين.
كاتبة من العراق
8 شباط والصور المحفورة
في ذاكرة العراق الجماعية
هيفاء زنكنة
في 8 شباط / فبراير 1963، استيقظ العراقيون، في بغداد، على أصوات أعيرة
نارية. كان ذلك انقلاب البعث الاول أو ما أطلق عليه البعث « ثورة
رمضان». ومن يقرأ ما يتم تبادله على صفحات التواصل الاجتماعي، هذه
الايام، من استعادة لأحداث الأيام والسنوات التي تلت هذه التاريخ،
سيدرك أن العراقيين، من ذلك الجيل الذي عاصر تلك الفترة، وابناء ذلك
الجيل الى حد ما، لايزالون يعيشون آثار ونتائج ذلك اليوم. فالمشاعر
مشحونة بجروح عميقة لم تندمل على الرغم من مرور عشرات السنين، تغذيها
ذاكرة تحتشد بالاعتقالات ودماء الضحايا. « إنه يوم مشؤوم في شهر مشؤوم»
تقول سيدة ترفض أن تحتفل بأعياد ميلاد أفراد من عائلتها ولدوا في ذلك
الشهر، معربة بذلك عن رغبتها في ألا ينسى أبناؤها ما حدث. يومها، شهد
العراق اقتتال من ساهموا، سوية، في جبهة وطنية للاطاحة بالحكم الملكي
واعلان الجمهورية المستقلة في 14 تموز/ يوليو 1958.
ما الذي تستعيده ذاكرة الشعب الجماعية عن تلك الحقبة التي استمرت تسعة
شهور فقط؟ ماذا عن الجمهورية الاولى ( 1958 – 1963) والحكم الملكي الذي
سبقها؟ هل هناك ذاكرة جماعية واحدة للشعب كله؟ لايمكن القول إن
للعراقيين ذاكرة جماعية واحدة . بل تشير كل الدلائل التاريخية
والشهادات الشخصية ومتابعة كتب المذكرات والبحوث الى أن هناك عدة
مستويات للذاكرة، أو ذاكرات. ما يفرقها هو أكثر، احيانا، مما يجمعها،
خاصة عند النظر الى مآسي تلك الحقبة ومن هو مرتكبها وانعكاساتها على
الحاضر. ويدل اختلاف التسميات والمصطلحات المستخدمة للتحقيب على عمق
الشروخ في الذاكرة والحاضر. فثورة 14 تموز، لدى البعض هي انقلاب دموي
لدى البعض الآخر. وانقلاب شباط 63 الدموي لدى البعض هو عروس الثورات
لدى البعض الآخر. ويقودنا الاختلاف بين الثورة والانتفاضة، حتى عند
مراجعة معطيات الحدث الواحد، الى مسار يزيد من تعقيد قراءة التاريخ.
على الرغم من ذلك، وعلى اتساع اختلافات الأحداث المفككة للذاكرة
الجماعية، ومعظمها اختلافات سياسية، بالمعنى السياسي الشامل للاقتصاد
والبنية المجتمعية، هناك كوارث- مآس محددة رسخت في ذاكرة من عاصرها،
بشكل صور دموية مرعبة لايزالون يعيشون دقائقها. ولا يزالون يستعيدونها
ويقومون، في عصر التواصل الاجتماعي، بتناقل تفاصيلها وصورها.
من بين هذه الصور، أجساد العقداء الاربعة، قادة انتفاضة مايو 1941 ضد
الحكم الملكي، الذين أعدموا وعلقت جثثهم أمام مبنى وزارة الدفاع، وسط
بغداد، ليكونوا عبرة للجميع. «كنت في السادسة، سائرة بجانب والدي، حين
رأيت الجثث المعلقة. أسرع والدي الخطى، ساحبا إياي بقوة، وركضنا
خائفين. حتى اليوم، كلما أمر على المكان نفسه، استحضر ذلك المشهد كأنه
يحدث اليوم» تقول مدرسة في الثمانين من عمرها. الصورة الثانية التي
خلفها العهد الملكي هي إعدام قادة الحزب الشيوعي، يوسف سلمان يوسف
(فهد) سكرتير عام الحزب، وعضوي المكتب السياسي زكي بسيم وحسين الشبيبي،
فجر يوم 14 شباط 1949، وعلق الثلاثة، بعد اعدامهم، في ساحات متفرقة من
بغداد. مما زرع بذرة اشاعة الترويع والإرهاب في الاماكن العامة.
خرج الشباب، وكلهم لم يكونوا قد ولدوا في حقب المآسي السياسية السابقة، مطالبين بوطن يوفر، للجميع بلا استثناء، حق الحياة والعمل والكرامة. على أمل ألا تكون أيام الاستذكار شحنا وتأجيجا للانتقام بل درسا جماعيا لوضع حد للاعتقالات والتعذيب والمجازر
وحصدت بعنفها حياة العائلة المالكة وعدد من سياسي العهد الملكي، بشكل
أدخل على حياة العراقيين مفردات وممارسات عنف جديدة مثل السحل. واذا
كانت رغبة ثوار 1958 هي تشكيل «حكومة تنبثق من الشعب وتعمل بوحي منه
وهذا لا يتم إلا بتأليف جمهورية شعبية تتمسك بالوحدة العراقية الكاملة»
كما جاء في البيان الاول، فان السنوات التالية جذرت خلافات، حفرت
عميقا، في الجسد العراقي، مسببة من الجروح ما لم يكن في الحسبان، إذا
ما افترضنا حسن النية ووطنية الأحزاب التي ذلقت طعم العمل الجماهيري
العلني للمرة الاولى. فكانت الصراعات الشيوعية البعثية القومية التي
أضافت الى بشاعة الماضي ودموية القتل والسحل وتعليق الجثث، غرز نواة
المليشيات (تشكيل المقاومة الشعبية) وشعبوية الزعامة (سيادة الزعيم
الأوحد الزعيم المنقذ ابن الشعب) وغوغائية الحشود المرتكبة للمجازر كما
في مدينتي الموصل وكركوك.
هذه الصراعات المتراكمة عادت لتغرق بدمويتها، وروح الانتقام، العراق في
الشهور التالية لشباط 63، حيث نجح البعثيون في حفر صور أخرى للقتل في
ذاكرة المواطنين، أولها صورة رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم بعد
اغتياله.
لم تقتصر رؤية الصورة على المارة في الأماكن العامة، كما كان يحدث في
اعدامات النظام الملكي، مثلا، بل نجح النظام الجديد في ادخال الصورة
الى كل البيوت، ليراها كل الناس، عن طريق البث التلفزيوني. وهو، الفعل
الذي كررته قوات الاحتلال الانكلو أمريكي، بأيدي مستخدميها المحليين،
باعدامها رئيس الجمهورية العراقية الرابع صدام حسين، عام 2006 وبث شريط
إعدامه تلفزيونيا.
أشهر ما بعد 8 شباط، جلبت معها، أيضا، ميليشيا «الحرس القومي»
والاعتقالات والتعذيب والإعدامات المستهدفة للشيوعيين، خاصة بعد أن
أصدر الحزب الشيوعي نداء الى المواطنين يدعوهم فيه» الى حمل السلاح
لسحق المؤامرة الاستعمارية الرجعية» . وكان للمرأة حصتها في التعذيب
والاغتصاب، ليصبح جسد المناضلة مشاعا للجلادين.
ان استذكار 8 شباط، ضروري باعتباره جزءا من الذاكرة الجماعية أو كيف
نتذكر تاريخنا. آخذين بنظر الاعتبار ان تكّونها يتأثر بعوامل عديدة، قد
يطغى فيها احد الجوانب على أخرى، خاصة حين تتعلق بالهوية الوطنية كموقف
أساسي، وما تتعرض له من تقليل او تضخيم او حتى صناعة، كما نلاحظ حاليا
في البلد، مع وجود التدخل الخارجي بأنواعه. ولكن غالبًا ما تكون هناك
مواضيع مشتركة. فكل العراقيين، مثلا، يتغنون بتاريخ العراق البعيد
وحضارته، كما أن معظمهم يرى أن الخلافات والصراعات في عراق ما قبل
الغزو الانجلو امريكي، عام 2003، كانت سياسية بالدرجة الاولى ولم تكن
دينية طائفية. الاعتقاد الذي استعاد قوته، تدريجيا، عبر مقاومة المحتل
والاعتصامات والتظاهرات التي سادت سنوات الاحتلال، وجاء تأكيده الواضح
في انتفاضة تشرين الأول / اكتوبر 2019، حين خرج الشباب، وكلهم لم
يكونوا قد ولدوا في حقب المآسي السياسية السابقة، مطالبين بوطن يوفر،
للجميع بلا استثناء، حق الحياة والعمل والكرامة. على أمل ألا تكون أيام
الاستذكار شحنا وتأجيجا للانتقام بل درسا جماعيا لوضع حد للاعتقالات
والتعذيب والمجازر الجماعية والاستهانة بالإنسان.
كاتبة من العراق
لا تقترب لا تلمس…
حقول الموت في العراق
هيفاء زنكنة
إذا كان إجراء دراسة عن احصائيات الألغام الأرضية والقذائف غير
المنفلقة، يقود الباحثين، عادة، الى كمبوديا التي زرع فيها ما بين 4
ملايين و6 ملايين لغم أرضي، خلال الحروب الأهلية بين 1975 و1998، مما
تسبب في سقوط أكثر من 64 ألف ضحية، أو الى فيتنام التي تسببت بقايا
الألغام الأرضية والمتفجرات التي ألقتها الولايات المتحدة عليها بمقتل
40 ألف شخص، منذ نهاية الحرب، فان العراق بات ينافس البلدين بل ويتغلب
عليهما في كونه البلد الأكثر تلوثا في العالم من حيث حجم المنطقة
الملغومة، حسب «مرصد الألغام الأرضية والذخائر العنقودية» في سويسرا.
مناطق العراق الملغومة ناتجة عن الحرب العراقية الإيرانية (
1980-1988)، وحرب الخليج عام 1991، والغزو الانكلو أمريكي عام 2003.
حيث ألقت قوات التحالف، بقيادة أمريكا 61 ألف قنبلة عنقودية، تحتوي على
حوالي 20 مليون ذخيرة صغيرة على العراق والكويت في عام 1991. أما أثناء
غزو العراق عام 2003، فقد استخدمت أمريكا وبريطانيا ما يقرب من 13 ألف
ذخيرة عنقودية تحتوي على ما يقدر بنحو 1.8 مليون إلى 2 مليون من
الذخائر الصغيرة. كما زرعت أمريكا 120 ألف لغم، منها 28 ألف لغم مضاد
للأفراد و 90 لغماً مضاداً للمركبات، بالاضافة الى قنابل كانت قد رمتها
القوات الأمريكية أثناء تقدمها البري باتجاه بغداد. وتشمل حقول الألغام
حدود العراق مع إيران والمملكة العربية السعودية.
أما احتلال الدولة الإسلامية ( داعش)، لمساحات كبيرة بعد عام 2014، فقد
أدى إلى زيادة التلوث بالألغام المرتجلة والعبوات الناسفة المزروعة في
مختلف الأماكن المأهولة. وهي نقلة نوعية من ناحية استخدام السلاح
المحظور في المدن وحتى داخل البيوت. فألالغام المضادة للأفراد محظورة
بموجب معاهدة حظر الألغام التي وقعتها 155 دولة، باستثناء أمريكا، لحظر
تصنيع واستخدام الألغام الأرضية، لأنها تهدد حياة المدنيين بعد فترة
طويلة من انتهاء الحروب، وكونها لا تفرق بين المدني والعسكري، وأكثر من
نصف ضحاياها هم من الأطفال الذين يلتقطونها كلعبة.
تشير تقارير مرصد الألغام الى أرقام مخيفة. تخبرنا أن الأراضي العراقية
ملوثة بـ 25 مليون لغم ومليون طن من المقذوفات غير المنفجرة بعد، التي
تشكل بمجموعها تهديداً مباشراً لقرابة 2117 تجمعاً مدنياً يعيش فيه
قرابة 2.7 مليون مواطن عراقي. وتعتبر محافظتا البصرة والموصل من أكثر
المحافظات تلوثا بالألغام والذخائر الحربية، ويقدر مدير التوعية
ومساعدة ضحايا الألغام في المؤسسة العامة لشؤون الألغام في إقليم
كردستان، في تصريح لموقع (درج) أن عدد ضحايا الألغام في كردستان يزيد
عن 13 ألف مواطن. ويكثر عدد الضحايا والمصابين خاصة بين الفلاحين
والرعاة. واذا كانت الألغام والقنابل غير المنفلقة سببا للموت الفوري،
فانها، ايضا، مدمرة لحياة من يتعرضون للانفجارات فينتهون بإعاقات دائمة
ليضافوا، وهنا المأساة، الى قائمة ضحايا الحروب الفعلية. يتراوح عدد
مبتوري الأطراف بسبب الألغام في العراق بين 80 و100 ألف شخص.
الأراضي العراقية ملوثة بـ 25 مليون لغم ومليون طن من المقذوفات غير المنفجرة بعد، التي تشكل بمجموعها تهديداً مباشراً لقرابة 2117 تجمعاً مدنياً يعيش فيه قرابة 2.7 مليون مواطن عراقي
وتشكل الخسارة البشرية جانبا من جوانب تهديد حياة البلد المتعددة. من
بينها اعاقة التنمية واستحالة استثمار الأراضي والاعمار في حال عدم
تطهير الاراضي والاماكن السكنية. وهذا ما يتبدى بوضوح في الجانب الغربي
من مدينة الموصل والأنبار وبقية المدن. فعلى الرغم من مضي سنوات على
«التحرير» لاتزال عديد الأحياء، حقول موت اكثر منها مناطق صالحة للسكن
وعودة الأهالي. وعلى الرغم من توقيع العراق، على اتفاقية أوتاوا
الدولية الملزمة له بتنظيف البلد من الألغام المزروعة مع نهاية عام
2018، لكنه فشل في تحقيق ذلك ومدد الفترة عشرة أعوام أخرى، إلى عام
2028.
يبرر المسؤولون الحكوميون فشلهم بقلة الكادر المدرب على تطهير الأراضي
الملغومة، وقلة المعدات الكاشفة، وعدم توفر المسح الميداني، وعدم
حصولهم على خرائط توضح مكان انتشار حقول الألغام بالاضافة الى
تصريحاتهم المستمرة عن قلة التمويل باعتباره السبب الرئيسي. متناسين ان
العراق بلد غني بثروته وكفاءاته لو أتيحت فرص التعليم والتدريب،
وبامكانه، ان لم تتحكم به حكومة اللصوص والفساد، ان يمد يد المساعدة
الى بلدان العالم بدلا من استجداء المعونة المادية والقروض لزيادة
محاصصة النهب.
إن كل لغم موجود في الأرض يمكن أن يعني فقدان حياة أو طرف آخر، ما لم
يتم العمل على إزالته، والى أن يتحقق ذلك وجوب احاطة الأماكن الملغومة
بالاسلاك الشائكة ووضع اشارات التحذير الواضحة والتوعية بوجودها في
المدارس والندوات العامة واجهزة الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
والعمل على دعم وزيادة عدد مراكز التأهيل ومساعدة الضحايا الناجين من
حوادث المخاطر المتفجرة وأفراد أسرهم. وهو، أحد الركائز الخمس التي
تقوم عليها الأعمال المتعلقة بالألغام، والذي يعتبر قطاعا ناقص التمويل
في العراق، حسب منظمة دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام
(أونماس). ففي 2013، أقر العراق قانون رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي
الاحتياجات الخاصة، والذي حل محل جميع التشريعات الأخرى المتعلقة
بالإعاقة إلا أنه لا يضم، على إشارة محددة للناجين من حوادث المخاطر
المتفجرة.
إن تطهير الأراضي والأماكن من الالغام والمتفجرات ليس مهمة مستحيلة في
بلد غني كالعراق. وخلافا لكارثة اليورانيوم المنضب الذي استخدمته
أمريكا وبريطانيا ضد البلد، والذي يمتلك خاصية التسرب بين دقائق التربة
ومدة تأثيره السام، تصل مئات السنين، بالامكان تنظيف الأراضي من
الالغام الأرضية والمقذوفات غير المنفلقة اذا ما توفرت النية الحقيقية
لحماية السكان المعرضين للخطر، وتوفير الدعم لهم. الدعم الذين هم بأشد
الحاجة إليه لتخفيف معاناتهم الإنسانية. هناك، مثلا، بريطانيا التي
أعلنت اخيرا تنظيف جزيرة الفولكلاند. ولأثبات عدم استحالة المهمة
وتفكيك الادعاء بعدم قدرة العراق على تمويل منظمات عراقية ودولية
متخصصة بتطهير الأراضي، تكفينا المقارنة ما بين سرقة مليارات الدولارات
من قبل المتحاصصين في النظام، والمبلغ المطلوب لتمويل برنامج التطهير
والذي تبلغ قيمته 265 مليون دولار، حسب آخر تصريح لدائرة الأمم المتحدة
للأعمال المتعلقة بالألغام. وهو مبلغ سيدفع تكلفته، بحياتهم، أشخاص لم
يكونوا قد ولدوا بعد.
كاتبة من العراق
إقالة ومقاضاة
رئيس الوزراء العراقي
هيفاء زنكنة
الى قائمة ضحايا التفجيرات، بالعراق، أضيف يوم الخميس 21 يونيو/ كانون
الثاني، 32 قتيلا، وأكثر من 110 جرحى. السبب: انتحاريان بحزامين ناسفين
في سوق للملابس المستعملة، في ساحة الطيران، وسط بغداد.
ما الذي نعرفه عن الضحايا؟ إنهم باعة ملابس مستعملة ومشتروها. بينهم
عمال يعرضون خدماتهم بأرخص الأسعار، وبسطات فقراء يبيعون ما لا يحتاجه
المرء بأسعار لا تقيهم الجوع، إلا أنهم يثابرون على الجلوس في الساحة
كبائعين حفاظا على كرامتهم، لئلا يتهمون بالاستجداء، باستثناء شابين
هما علي وعمر، الضحايا أرقام بلا أسماء. اختزلت حياتهم إلى أرقام
ستضاف، ان وجد من يوثق، الى قوائم ضحايا آخرين في ساحة الطيران، التي
شهدت تفجيرات سابقة في عام 2018 و تشرين الثاني / نوفمبر 2019 والى
بقية الضحايا في ارجاء العاصمة ومدن العراق الأخرى، والذين يزيد عددهم
على المليون منذ عام 2003 ثمنا للتغيير او التحرير او سقوط بغداد. ليست
هناك صحافة استقصائية مستقلة تتابع حياة الضحايا وتنشر تفاصيلها لتترسخ
بالذاكرة. الصحافيون أنفسهم ضحايا جرائم من نوع آخر.
ما الذي نعرفه عن الانتحاريين؟ باستثناء التفجير المرعب واستخدامهما
جسديهما المفخخين لنشر الموت، لا شيء تقريبا. وان كان هناك عدو جاهز
واشاعات ونظريات مؤامرة يساعد على انتشارها عدم الثقة بالتصرحات
الأمنية والحكومية. فبعد ساعة من المجزرة، وقف مسؤول امني، في الساحة،
امام عدسات التصوير، قائلا : « نفذ التفجير انتحاريان. ربما… بالتأكيد
داعش». بلا تحقيق أو جمع للأدلة أو إحاطة المكان بما يمنع تلويث الأدلة
أو دوس بقايا الضحايا المتناثرة في ارجاء المكان. وبسرعة مذهلة، وصل
الساحة فريق من عمال تنظيف الشوارع، نظفوا الأرضية بشكل لم تعرفه
الساحة من قبل، وبدلا من انتظار وصول فريق التحقيق، غسلت الساحة من
دماء وأشلاء الضحايا المختلطة ببقايا الانتحاريين، بلا دليل مادي وعلمي
يماثل عمليات التمشيط التي تقوم بها اجهزة الشرطة والأمن في ارجاء
الكون للتعرف على هوية المجرمين، بدأ المسؤولون « الأمنيون» ببث
تصريحات صار الشعب العراقي يحفظها عن ظهر قلب. تصريحات جاهزة تتماشى مع
أجندة الجهات المصدرة لها سياسيا وإعلاميا. ففي تصريح خاص لقناة
«الحرة» المؤسسة من قبل السي آي أي، ومقرها واشنطن، قال المتحدث باسم
قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، وهو إن «تنظيم داعش هو
المسؤول عن التفجيرين الانتحاريين اللذين وقعا في بغداد اليوم» مضيفا
أن «الأجهزة الأمنية مستمرة في ملاحقة الجناة ومن قدم العون لهم
وساعدهم» وهو ما تريد الادارة الأمريكية، أو مقررو سياستها الراهنون،
سماعه تبريرا لاستمرارية عملياتها الخاصة تحت شعار «محاربة الإرهاب».
ما صرح به اللواء الخفاجي هو انعكاس لتصريحات مصطفى الكاظمي والاجراءات
التي أعلن عن نيته اتخاذها، باعتباره رئيسا للوزراء والقائد العام
لقوات المسلحة. وهي تصريحات بحاجة الى التمحيص لتبيان مدى صدقها
وفاعليتها. حيث ترأس الكاظمي اجتماعا لقادة الأجهزة الأمنية
والاستخبارية « لمناقشة الهجوم وعواقبه» وأمر بتشكيل لجنة تحقيق،
أضيفت، كالعادة، الى مئات لجان التحقيق التي شكلت، سابقا، ودفنت في
مخازن الفساد. كما أمر بإجراء تغييرات في «مفاصل الأجهزة الأمنية
المسؤولة عن حادث ساحة الطيران». وهو اجراء، يبدو مشجعا ظاهريا، الى أن
يتبين بأنه، في حقيقته، لعبة كراس موسيقية.
حكومة فاشلة، بلا مصداقية، مكونة من ميليشيات وعصابات بواجهات حزبية تتغذى على الفساد والعنف والجريمة والفقر والأمية والبنية التحتية المتداعية
اذ تم تدوير نفس الأشخاص في مناصب مغايرة بلا مساءلة أو محاسبة على
إهمال وظيفي قاتل. ثم ما الذي يعنيه بوصفه المجزرة بأنها « حادث في
ساحة الطيران»؟ كيف يمكن وصف قتل 32 شخصا وجرح 110 بأنه « حادث»؟ اليست
هذه لغة المحتل التي طالما وصف بها جرائمه وانتهاكاته ومنهجية قتله
للعراقيين بأنها « حادث»؟
ولا يتوقف الكاظمي في تصريحاته عند ذلك بل يسترسل بلغة اراد منها طمأنة
أمريكا في « الحرب على الإرهاب» وخلق حالة من عدم الاستقرار التي
تستدعي التدخل الخارجي، قائلا: «أن معركتنا ضد الإرهاب مستمرة وطويلة
الأمد، وأنه لا تراجع ولا تهاون في محاربته». أما وعوده للاستهلاك
المحلي فقد جاءت مضخمة بادعاءات السيطرة وامتلاك القوة والقدرة على
الانجاز، بقوله « لقد وضعنا كل إمكانات الدولة وجهود قطاعاتنا الأمنية
والاستخبارية، في حالة استنفار قصوى، للاقتصاص من المخططين لهذا الهجوم
الجبان وكل داعم لهم وسنقوم بواجبنا لتصحيح أي حالة تهاون أو تراخٍ أو
ضعف في صفوف القوات الأمنية» ملمحا بأنه يقف الى جانب الشعب في سعيه
إلى « انتخابات نزيهة وعادلة». وهو فخ سقط فيه عديد المحللين
السياسيين، حين اعتبروا ان مجزرة ساحة الطيران، محاولة أرهابية لاعاقة
سيرورة الانتخابات التي ستجري في اكتوبر القادم، وليست، كما هو معروف،
من سردية التفجيرات السابقة والحالية المتتالية، واحدة من أوجه الصراع
الأمريكي الإيراني الإرهابي وامتدادتها في عصابات الجريمة المنظمة، في
تسقيط بعضها البعض، وهو الحال الذي يعيشه العراق منذ غزوه عام 2003،
ولن تكون المجزرة الحالية آخرها.
ولنعد الى شهر تموز/ يوليو الماضي، لتمحيص صدق تصريحات وانجازات
الكاظمي ووعوده المبذولة، حين تسارعت حملة اغتيال الناشطين، خاصة
اغتيال المحلل السياسي المعروف هشام الهاشمي الذي صورت كاميرات
المراقبة تفاصيل اغتياله ونشرتها اجهزة الإعلام محليا ودوليا. أيامها،
صرح الكاظمي، في 7 تموز/ يوليو، بأنه « لن ينام قبل أن يخضع قتلة
الهاشمي للقضاء بما ارتكبوا من جرائم» متوعدا « من تورّط بالدم العراقي
سيواجه العدالة ولن نسمح بالفوضى وسياسة المافيا أبدا… ولن نسمح لأحد
أن يحول العراق إلى دولة للعصابات» معلنا تحمله المسؤولية «إننا
مسؤولون والإجابة الوحيدة التي يتقبلها منا الشعب هي الإنجاز والإنجاز
فقط» وأن الدولة هي المرشد والمعيار وقانون الدولة السقف ولا أحد فوق
القانون. وكما فعل منذ أيام أمر بتشكيل هيئة تحقيقية قضائية وإعفاء
القائد الأمني المسؤول عن منطقة اغتيال الهاشمي، من منصبه وأحاله
للتحقيق. وكانت النتيجة؟ لاشيء. لم يتم الإعلان عن نتيجة اية تحقيق كما
لم يتم اعتقال المجرمين. وسجلت الجريمة، كما الآلاف من قبلها، ضد «
جهات مسلحة».
إن توثيق تصريحات الكاظمي وادعاءاته، خاصة التي يعلن فيها مسؤوليته
أمام الشعب، كرئيس للوزراء وقائد للقوات المسلحة، وفشله المستمر، في
تحقيق وعوده وواجباته، وأهمها مسؤوليته في حماية أمن المواطنين وتنفيذ
القانون وتحقيق العدالة والاستقرار الاقتصادي والسياسي، ضروري ومن واجب
اجهزة الإعلام المستقلة والعاملين في المجالات الحقوقية والأحزاب
الوطنية تقديم الحكومة كما هي: حكومة فاشلة، بلا مصداقية، مكونة من
ميليشيات وعصابات بواجهات حزبية تتغذى على الفساد والعنف والجريمة
والفقر والأمية والبنية التحتية المتداعية، مما يستدعي وجوب إقالة
الكاظمي وتقديمه الى القضاء. ولدينا في اقالة رئيس الولايات المتحدة
الأمريكية دونالد ترامب، بتهمة تكاد تكون مضحكة بالمقارنة مع فشل
الكاظمي، في القيام بمسؤوليته، ودوره في استمرارية حصانة المجرمين من
العقاب، درس يستحق التقليد.
كاتبة من العراق
سارقو حليب
الأطفال في النظام العراقي
هيفاء زنكنة
بينما كان المسؤولون في الحكومة العراقية يبررون، كل الكوارث التي تحل
بأبناء الشعب، حتى فترة قريبة، بأنها نتيجة « الإرهاب» و «القوى
الخارجية» و«الطرف الثالث» برزت على السطح، في الآونة الأخيرة، تصريحات
ذات وقع مختلف، تلقي اللوم أما على المواطنين أنفسهم أو تقلل من
تأثيرها، باعتبارها أحداثا « عادية» مشابهة لما يجري في بقية انحاء
العالم، خاصة بعد انتشار فايروس كورونا. ولعل أكثر الامثلة وضوحا هو
مقارنة حالة الفقر وجوع الأطفال بين بريطانيا والعراق.
عاشت بريطانيا، في الأسابيع الاخيرة، أجواء حملة نافست بما أثارته من
اهتمام انتشار الفايروس، وازدياد عدد المصابين، والضغط المتزايد على
المستشفيات بالإضافة الى حملة التلقيح ضد الفايروس، التي يتابعها
الجميع بلهفة ورصد دقيق. قاد الحملة نجم كرة القدم ماركوس راشفورد بعد
أن رفضت حكومة حزب المحافظين تقديم وجبات طعام مجانية للأطفال الفقراء،
خلال فترات العطل المدرسية أو وهم يدرسون في دورهم، في فترات الحظر
للحد من انتشار الفايروس. أعاد القرار الحكومي الى الاذهان ما قامت به
السيدة ثاتشر، رئيسة وزراء بريطانيا) 1979 – 1990)، حين ألغت حصة
الحليب التي توزع لأطفال المدارس تقليصا للميزانية، فاطلق عليها الناس
لقبا لاحقها حتى وفاتها وهو «ثاتشر سارقة الحليب». شارك في حملة اطعام
الأطفال، ايضا، المجتمع الأهلي (الأفراد والكنائس والجوامع) وعموم
منظمات حماية الأطفال، ووقع اكثر من 2000 طبيب أطفال رسالة عبروا فيها
عن صدمتهم من القرار. مذكرين بأن ضمان حصول الأطفال على ما يكفيهم من
الطعام هو مسؤولية انسانية أساسية. ووصف حزب العمال المعارض القرار
بأنه عار على الحكومة وأمر مخجل ان يتم تجويع الأطفال في بريطانيا
الغنية في القرن الحادي والعشرين. إزاء هذه الضغوط الأهلية والمدنية،
تراجعت الحكومة البريطانية عن قرارها.
عراقيا، يصرح المسؤولون بأن الحالة المعيشية المتردية في العراق،
بضمنها وضع الأطفال، هي نتيجة الوضع الاقتصادي المتأزم، عالميا، جراء
انتشار وباء الكورونا. ويذهب عدد من المسؤولين أبعد من ذلك بذكرهم
بريطانيا وأمريكا كأمثلة، لدعم تصريحاتهم، متعامين عن حقائق عديدة
اولها اختلاف مفهوم الفقر ودرجاته بين العراق والدول التي يستشهدون
بها. ففي بريطانيا يعتبر عدم تناول الأطفال وجبة الطعام المجانية، خلال
العطل، مثلا، تجويعا للأطفال وعارا على الحكومة. بالمقابل، ما هو وضع
الأطفال في العراق الغني، في القرن الواحد والعشرين؟
بلغ حجم الأموال المهربة خارج العراق حوالي 239 مليار دولار، أي ما يزيد على موازنة البلاد لأكثر من عامين
في العراق، بات الجوع رفيقا دائما للطفل، يمتد على مدى الأيام
والأعوام، ويتبدى لا في نقص وجبات الطعام فحسب، ولكن في أبعاد أخرى
تجعله محصورا مع فئات السكان الهشة البالغة 42 بالمئة من السكان ممن
يواجهون مخاطر أعلى، كونهم يعانون من الحرمان من عديد الأبعاد، وليس من
بُعد واحد مما يلي: التعليم، والصحة، والظروف المعيشية، والأمن المالي.
بالنسبة إلى الأطفال، هناك طفل من بين كل اثنين تقريبا (48.8 بالمئة
كرقم منشور) أكثر عرضة للمعاناة من الحرمان في أكثر من بعد واحد من هذه
الأبعاد الأربعة، حسب تقرير منظمة « يونسيف» لعام 2020. أما تأثير
جائحة كورونا على الوضع الاجتماعي الاقتصادي، فقد قامت وزارة التخطيط،
بدعم من اليونيسف، والبنك الدولي، ومبادرة أكسفورد للفقر والتنمية
البشرية، بتقييمه، وُجد أن 4.5 مليون شخص (11.7 بالمئة من السكان، أو
ما يقارب واحدا من كل ثمانية أو تسعة مواطنين، أغلبهم أطفال) يواجهون
خطر الوقوع تحت خط الفقر إضافة لمن سبقهم. ستسبب هذه الزيادة رفع معدل
الفقر الوطني إلى حوالي الثلث (31.7 بالمئة ) بالمقارنة مع حوالي الخمس
( 20 بالمئة ) لعام 2018، وزيادة العدد الإجمالي للفقراء إلى 11.4
مليون.
وبتعبير آخر، كان واحد من بين كل خمسة أطفال ويافعين فقيراً قبل تفشي
الكورونا،، ليرتفع الى أكثر من إثنين من بين كل خمسة أطفال. هذه
الحقائق المخيفة دفعت اليونسيف الى إطلاق تحذير للحكومة من حالة الفقر
التي انحدر فيها البلد ووضع الأطفال وفقدانهم حقوقهم الأساسية، كما
أصدرت مجموعة توصيات الى الحكومة حول ايجاد حلول آنية سريعة لمعالجة
الفقر الغذائي وأخرى استراتيجية لمعالجة جذور الفقر، حتى لا يحرم الطفل
من حقوقه في الصحة والأمن والحرية والتعليم والماء النظيف واللعب. وهي
حقوق على الحكومة ضمانها إذ أن العراق عضو في اتفاقية الأمم المتحدة
لحقوق الطفل وملزم بما يضمن حقوقهم آنيا ومستقبلا.
الحقيقة الثانية المتعامى عنها، تعمدا، من قبل المسؤولين، هو حجم
الفساد الذي ينخر المؤسسات، في حكومة تديرها مجموعة لصوص تتقاسم
المغانم، وفق محاصصة سياسية طائفية وعرقية. وإن اللائمة لا تقع كلية
على فايروس الكورونا الذي يعتبر تأثيره ضئيلا بالمقارنة مع حجم مأسسة
الفساد الحكومي ومليشيات الاحزاب المنخرطة بالنظام. حيث بلغ حجم
الأموال المهربة خارج العراق حوالي 239 مليار دولار، أي ما يزيد على
موازنة البلاد لأكثر من عامين، حسب تصريح لجنة النزاهة النيابية في 4
كانون الثاني/ يناير. وتزداد الصورة قتامة حين نراجع ما نعرفه ويعرفه
العالم من حقائق عن تجذر وتطويرالفساد منذ احتلال البلد عام 2003.
فالعراق من بين أكثر الدول فسادا في العالم. الفساد يعني التدمير
المنهجي والمنظم للانتاج والتعليم والصحة، واضطرار المواطنين جميعا
للتعامل ضمن منظومة الفساد، وما يعنيه من انعدام الحدود الدنيا من
الصدق والنزاهة في التعامل اليومي بين الناس ضمن هيمنة طبقة تتحكم
بالعقود والعمولات والرشاوى وتهريب العملة، الموظفون الوهميون. شراء
ذمم النواب والمسؤولين الحكوميين. تحويل السجون ومراكز الاحتجاز الى
مصادر للابتزاز، وتمويل الإرهاب بأنواعه.
وتأتي تصريحات المسؤولين الحكوميين والنواب لإدانة الفساد لترش الملح
على الجروح. فهم، جميعا، بلا استثناء يدينون الفساد وكأنه هطل عليهم من
الفضاء الخارجي، متحدثين، دوما، عن امتلاكهم ملفات فساد سيظهرونها
للعيان ذات يوم، لإثبات نظافتهم، وأن الفساد هو فساد « الآخر» محاولين
بقولهم إن الامبراطور بلا ملابس أن يغطوا عُريهم. أما محاولتهم تقليل
التأثير المدمر لفسادهم على البلد وأهله ومستقبله المتمثل بمستقبل
أطفاله، فلن تمر مرورا عابرا، كما يتصورون. فالتاريخ قد يغفر للساسة
أخطاءهم وقد يبرر جرائمهم، إلا أنه لا يغفر لهم سرقة حليب الأطفال.
كاتبة من العراق
هاشتاغ المبادرة
العراقية لتحرير أمريكا
هيفاء زنكنة
شهدنا، منذ ايام، غزو مقر المجلس التشريعي لحكومة الولايات المتحدة
الأمريكية (الكونغرس) من قبل « أنصار اليمين المتطرف» للرئيس دونالد
ترامب. جاء الهجوم بعد شهور من نشر الرئيس على وسائل التواصل الاجتماعي
أن الانتخابات مسروقة.
أثار الغزو والهجوم على واحد من أهم رموز الديمقراطية بالعالم، بل
ويشار إليه باعتباره « مهد الديمقراطية» مشاعر متناقضة تراوح بين
الدهشة، والاستغراب، والذهول، والتنديد، والاستنكار بالإضافة الى
الشماتة والسخرية السوداء. من ركام المشاعر التي غذاها ( ولايزال ) سيل
الصور والفيديوهات التفصيلية للغزو عبر أجهزة الإعلام ومواقع التواصل
الاجتماعي، تبرز تساؤلات أساسية مهمة حول عمق الحدث، ومدى فجائيته. وهل
هو فعل آني يتعلق بتحريض الرئيس ترامب عبر التويتر أم انه أكثر من مجرد
غزوة يمينية شعبوية؟ وهل صحيح وصف مرتكبيها بأنهم «غوغاء» يدل سلوكهم
على فاشية زرعها ورعاها ترامب في تغريداته وأكاذيبه وسلوكه غير
المتوازن؟
ولعل السؤال الأقرب إلينا هو كيف ترى شعوبنا هذا الحدث وتحلله و
تقّيمه، آخذين بنظر الاعتبار أن نصف الشعب الامريكي، تقريبا، أي ما
يساوي بحدود 75 مليون ناخب، صوتوا فعلا لترامب الذي يصفه معارضوه
وأجهزة اعلامهم بأنه راعي اليمين الأبيض المتطرف؟ وكيف تُقيم عملية نشر
الديمقراطية، في العالم، اذا كان حرمها المقدس، أي أمريكا، يضم هذا
العدد الهائل من اليمين المتطرف الذي وجد نفسه في مهاجمة قلب
الديمقراطية وتعطيله وتعريض حياة ممثليه لخطر القتل؟ كيف تنظر الشعوب
التي امتدت الذراع الأمريكية اليها لتغيير الأنظمة فيها، إما عبر
المؤامرات واغتيال الرؤساء أو غزوا بذريعة التحرير، كما في 84 دولة من
أصل 193 دولة معترف بها من قبل الأمم المتحدة، حسب المؤرخ الأمريكي
كريستوفر كيلي والمؤرخ البريطاني ستيوارت لايكوك، مؤلفا كتاب «غزوات
أمريكا: كيف غزونا أو تورطنا عسكريًا مع كل بلد تقريبًا على وجه
الأرض»؟
ولنقترب أكثر من الواقع. من وجهة نظرة شعب يعيش آثار وانعكاسات الغزو
والاحتلال الامريكي وتسويقهما تحت مسمى « عملية تحرير العراق». واستعين
هنا بنعمة توفر مواقع التواصل الاجتماعي، التي على نقائصها، تمكننا من
الاطلاع على المشاعر الحقيقية للمتواصلين بلا رقيب او تشذيب وظيفي او
رسمي او ايديولوجي. استعاد معظم متابعي حدث غزو واحتلال الكابيتول من
العراقيين أحداث الايام الاولى للغزو الأمريكي لبغداد. استعادوا، وهم
يشاهدون تخريب المكاتب وتكسير الأبواب ونهب الأثاث، وتعليقات الساسة
واجهزة الإعلام المشمئزة الغاضبة المتبرئة من الغوغاء، تصريحات وزير
الدفاع دونالد رامسفيلد يوم 12 نيسان/ ابريل حول نهب الدوائر الحكومية
العامة تحت انظار القوات الأمريكية، قائلا: « ان النهب فى العراق جاء
نتيجة مشاعر مكبوتة من القمع» كما أكد « أن النهب لم يكن بالسوء الذي
أشارت إليه بعض التقارير التلفزيونية والصحافية وأن النهب جزء من
الثمن، من تحرير العراق. «. ولعل أفضل اقتباس استخدمه عدد من العراقيين
لوصف سلوك من غزوا وحطموا مكاتب الكونغرس ونهبوها، بالمقارنة مع ما حدث
بالعراق، هو قول رامسفيلد: «إن الأحرار أحرار في ارتكاب الأخطاء
والجرائم والقيام بأشياء سيئة». لماذا اذن يتم وصف مهاجمي الكابيتول
بالغوغائية والفاشية واليمين المتطرف؟ لم لا ينطبق عليهم منظور وزير
خارجية بلد الحرية؟ وهل صحيح أن ترامب، بأكاذيبه، هو المسؤول الوحيد عن
وجود خمسين مليون أمريكي من هذا النوع، أم أن الأكاذيب الكبرى سبقت
ترامب بعقود وأنها جزء لايتجزأ من السياسة الخارجية والداخلية
الأمريكية، مهما حاول ساسة اليوم وأجهزة الإعلام الادعاء بأن المهاجمين
« ليسوا منا»؟
هل صحيح أن ترامب، بأكاذيبه، هو المسؤول الوحيد عن وجود خمسين مليون أمريكي من هذا النوع، أم أن الأكاذيب الكبرى سبقت ترامب بعقود وأنها جزء لايتجزأ من السياسة الخارجية والداخلية الأمريكية؟
في مقال « الجحيم الامريكي» المنشور في الصفحة الاولى من « نيويورك
تايمز «، يقول تيموثي سنايدر، المؤرخ المتخصص بالفاشية، إن أكاذيب
ترامب الكبرى هي مقدمات الفاشية. فيحاججه الاكاديمي العراقي منذر
الأعظمي مذكرا: « لكن النخب الليبرالية ( ومنها الجريدة نفسها) هي التي
بدأت او تواطأت مع الأكاذيب الكبرى. لنتذكر الحرب على العراق، وقبلها
حادث مضيق تونكين الذي بدأ حرب فيتنام. وهناك أكاذيب الكيان الصهيوني
وخيوط التآمر الرسمي المحتملة في إغتيالات الستينيات وأبرزها كندي
ومارتن لوثر كنغ. أما ترامب نفسه فانه يشكل مجيء شخصية نرجسية فظة الى
قمة السلطة وهو ما ابرز خطورة هذا الطريق». وكيف يمكن نسيان أكذوبة
العصر التي أطلقها وزير الخارجية كولن باول، يوم 5 فبراير 2003، عن
امتلاك العراق اسلحة دمار شامل تهدد أمن العالم كله، مخاطبا مجلس الأمن
الدولي: « زملائي، كل معلومة أدلي بها اليوم مدعومة بمصادر. مصادر
راسخة. هذه ليست تأكيدات. ما نقدمه لكم هو حقائق واستنتاجات مبنية على
استخبارات لا يتطرق اليها الشك».
هذه الأكاذيب التي شرعنت غزو العراق وتخريبه المستمر حتى اليوم قبل
وصول ترامب الى الحكم، دفعت المحامية العراقية سجى رؤوف الى اطلاق
هاشتاغ تحرير أمريكا على نهج عملية تحرير العراق. وما تكتبه سجى ليس
عاديا. فهي تكتب مشاعرها، بشكل يوميات، بجملة واحدة او اثنتين، مكثفة
بالسخرية المريرة والغضب والمخيال التراجو كوميدي. هل هي الشماتة؟ لا
أعتقد ذلك. فهي، كما الكثير من العراقيين، لاتزال تعيش أيام دق طبول
الحرب وغزوه أمريكيا. وما تكتبه مستوحى من لحظات الهجوم على الكابيتول،
وما استحضرته من مشاهد مماثلة بقيت محفورة في ذاكرتها. في سيناريو نزف
المشاعر واحاطتها بالسخرية لكي لا يموت المرء كمدا من شدة الظلم، تكتب
سجى، بالانكليزية، عن ضرورة تدخل العراق عسكريا لتحرير أمريكا وإعادة
الديمقراطية اليها، على الرغم من انها كانت، طوال حياتها مناهضة للحرب.
ويضع السيناريو خطوات ومستلزمات التحرير التي لن تكلف العراقيين فلسا
مادامت أموال النفط مستغلة مجانا على اية حال. إلا أنها تربط عملية
التحرير، كما فعل « محرر» العراق الامريكي بتشريعات، تفرضها على الشعب
بعد تحريره. « عليكم تعلم اللغة العربية. استبدال الدولار بالدينار.
وافرشوا السجادة الحمراء لاستقبال محرريكم العراقيين. انه تحرير وليس
احتلالا. هاشتاغ العراق يحرر أمريكا 2021». والى الجنود العراقيين
الذين نراهم على ظهور الدبابات المتقدمة نحو الكابيتول لتحريره وهم
يحملون علم العراق عاليا، بينما يرحب بهم عدد من المتظاهرين بالأزهار
والحلوى، توجيهات اخرى: « خلافا لعام 2003، علينا حماية المتاحف.
يمكننا إعادة اعمار متاحفنا بمحتويات سميثسونيان. لن نضعهم في أبو
غريب».
أتساءل ثانية: هل هي الشماته؟ لا أظن ذلك. انه استحضار للغة حرب ظالمة
بنيت على الأكاذيب وازدواج المعايير، وهو استحضار ضروري للتذكير. لئلا
ننسى. فاذا كانت أمريكا، ومعها دول الديمقراطية مصدومة، كما يقال لنا
إعلاميا، لما أصاب « مهد الديمقراطية» فكيف تواصل قلوبنا النبض،
وعقولنا التفكير بشكل منطقي، نحن الذين رأينا قصف وتهديم « مهد
الحضارة»؟
كاتبة من العراق
عالم الإنترنت
يتحدى النظام العراقي
هيفاء زنكنة
غالبا ما يلجأ الصحافيون في نهاية العام او بداية العام الجديد الى جرد
أهم الأحداث في بلدانهم والعالم. خطوة يرونها ضرورية لاستشراف المستقبل
واستخلاص الدروس . خطوة تساعد، احيانا، وحسب موقع الصحافي ، على الدفع
لتغيير مسار سياسي حكومي أو اتجاه عام . يؤثر على عملية الجرد ، وهي
عملية انتقائية بالضرورة، مدى أهمية الخبر على بلد الصحافي اولا. ففي
بريطانيا ، مثلا، اختار عديد الصحافيين ، على اختلاف توجهاتهم
وايديولوجية الصحف التي يتعاملون معها، البريكست ، اي مغادرة اوروبا ،
وانتشار كوفيد 19 كأهم حدثين أثرا وسيؤثران على مستقبل بريطانيا
بالاضافة الى ما يسمونه التوسع والهيمنة الصينية الاقتصادية.
بالنسبة الى البلاد العربية ، من الصعب استشراف المستقبل استنادا الى
حدث او حدثين. فاختيار الصحافي الغربي للأحداث يتم وهو يتمتع بالأمان
الفردي والعام وحرية التعبير والاختيار. هذه الحرية والاستقلالية ،
رفاهية يفتقدها ويحلم بها الصحافي في بلداننا. فكل ما يقوم به او يبحث
عنه استقصائيا او يقوم بالتنبيه اليه خاضع للرصد والمراقبة ويعرض حياته
للخطر. واذا حدث ولم يكن الرقيب جالسا في الصحيفة التي يعمل فيها أو
يرصده عن مبعدة في إحدى الدوائر الوزارية – الأمنية ، فانه جالس حتما
في عقل الصحافي. حيث بات حضوره، بمرور الوقت، أمرا مألوفا. كما الورقة
والقلم والحاسوب، يحمله معه الصحافي، اينما كان. السبب الآخر لصعوبة
انتقاء ما هو مهم، فعلا، خلال العام وبالتالي تمكين الصحافي من الكتابة
عن انعكاساته المستقبلية هو كثرة الأحداث ( أو لعل الأصح القول بأنها
كوارث) التي تمر بها بلداننا ، وتداخلها بحيث من الصعب تفكيك الاساسي
من السطحي والاقتصادي من السياسي، والاجتماعي من القانوني، وحقوق
الإنسان من الثقافي / الديني. الكل متداخل بشكل مربك تُسّيره الجهات
الرسمية وفق أجندة حماية مصالحها الذاتية وديمومة بقائها. تضاف الى ذلك
صعوبة تفكيك الأحداث المحلية المرتبطة بالوجود الأجنبي سواء بشكل
احتلال استيطاني كما في فلسطين او هيمنة امبريالية تتصارع مع ميليشيات
طائفية، مدعومة اقليميا، كما في العراق. واذا كان الحدث الاول المتفق
على اختياره عربيا ، لعام 2020، هو وباء الكورونا ، وهو اختيار آمن،
فان الاختيار الثاني وهو اعلان الإمارات والبحرين والسودان وسلطنة عمان
والمغرب، الكشف عن علاقاتها، شبه السرية، مع الكيان الصهيوني واضفاء
الصبغة الرسمية عليها، لم يحظ بالاجماع، لا لكونه حدثا لا يهم الشعوب،
ولكن لاستشراس الأنظمة العربية المتزايد ، وتنويعها اساليب التخويف
والترهيب.
ويشكل النظام العراقي « الجديد – الديمقراطي» ، بعيدا عن الدخول فيما
يسمى منافسة الضحايا حول من هو الأكثر تعرضا للقمع، نموذجا جيدا يؤهله
لاحتلال مكانة متميزة، توازي مكانته المتقدمة في قائمة الفساد، بين
أنظمة الدول العربية المستشرسة في معاقبة شعوبها. وخلافا لما يجري
الترويج له عن حرية التعبير في « العراق الجديد» ، تؤكد كل التقارير
الحقوقية الدولية والمحلية ، أن الصحافي المستقل، والناشط الحقوقي، وكل
مواطن يرفض التزام الصمت ازاء جرائم النظام، معرض للعقاب بأشكال ودرجات
مختلفة. تبدأ بالتهديد والاعتداء الجسدي وتنتهي بالخطف أو الاغتيال .
فكل الطرق مفتوحة والأبواب مشرعة حين يتمتع القتلة بالحصانة من
المسؤولية والمقاضاة. مما يجعل العراق واحدا من البلدان الأكثر خطرا
على الصحافيين والناشطين المستقلين، حسب عشرات التقارير الحقوقية. من
بينها مركز الخليج لحقوق الإنسان، الذي وثق قائمة تضم 43 ناشطاً تعرضوا
للتهديد بالقتل المباشر جنوب العراق عام 2020، مما اضطرهم جميعاً إلى
مغادرة مدنهم. كما وثّق مرصد الحريات الصحفية (JFO)
انتهاكات 2019، وقد بلغت» 477 انتهاكاً، منها 87 حالة احتجاز واعتقال،
و98 حالة منع وتضييق، و32 حالة اعتداء بالضرب، و4 هجمات مسلَّحة، و243
ملاحقة قضائية، و4 حالات إغلاق ومصادرة، وإغلاق 4 قنوات فضائية. ولم
تسلم هذه القنوات وغيرها من اقتحام الجهات المسلحة وتكسير معداتها
والاعتداء على كوادرها بالضرب. كما سجّل العام مقتل تسعة صحافيين».
أثبت عالم الإنترنت أنه، بعبوره حدود البلدان، أكبر وأوسع من أن تحده قضبان السجن، وأن المواطن العادي لم يعد مجرد متلق للأخبار الجاهزة المؤدلجة
ان حجم ما يعيشه الصحافيون والناشطون، منذ عام 2003، وحتى اليوم، سواء
تحت الاحتلال الأمريكي المباشر او غير المباشر بالتزامن مع « انتخاب»
الحكومات، وتحكم المليشيات المدعومة ايرانيا بها وبالشارع، يجعلهم
معاقين في أداء عملهم، وتحديد الأهم من المهم وفرز المهم من غير المهم،
ونشر المعلومة الموثقة واضاءة المستور من الممارسات الحكومية
والمجتمعية، أي المساهمة في نشر التوعية حول كل ما يدور في البلد . وهي
مهمة تتطلب، بالاضافة الى الوقت والجهد الجسدي، تركيزا وتفرغا لايتاح
لمعظم الصحافيين، وهم يعيشون دوامة انعدام حرية الحركة والتهديد أما
بقطع الرزق أو الرأس.
وما يزيد من سوء الوضع هو استحداث النظام قوانين تشرعن ممارساته أمام
العالم الخارجي، وتغطي حملة الاغتيالات المستهدفة للصحافيين والناشطين
المستمرة من قبل القوات الأمنية والميليشيات، المسجلة دائما ضد
مجهولين. آخرها مشروع قانون الجرائم الإلكترونية أو تقنية المعلومات،
الذي جوبه بحملة معارضة شعبية وتضامنية من قبل منظمات عالمية من بينها
« هيومان رايتس ووتش». اذ يتضمن القانون « مواد غامضة تسمح للسلطات بأن
تعاقب بشدة أي شخص يكتب على الإنترنت تعبيرا ترى أنه يشكل تهديدا
للمصالح الحكومية أو الاجتماعية أو الدينية». مما يعني ان القانون
يماثل الى حد كبير، في تفسيراته المفتوحة، حسب الطلب، قانون 4 لمكافحة
الإرهاب الذي يستخدم للادانة بالارهاب مرتكبي 42 فعلا ، مهما كانت صحة
أو درجة خطورتها. ومن الواضح من قراءة مشروع القانون الجديد انه يستهدف
من ينتقدون الأوضاع أو يتناولون الشؤون العامة للبلاد، او الذين ينشرون
معلومات بغرض كشف ملفات الفساد، مما يعني إغلاق المتنفس الأخير لكل
المواطنين ونصب قضبان السجون حول مواقع التواصل والرغبة بالحصول على
المعلومة بعيدا عن الاعلام الدعائي الرسمي. وهي خطوة تتسم بالغباء حتى
من منظور الأنظمة القمعية المستهينة، بلا حياء، بمواطنيها. فقد أثبت
عالم الإنترنت أنه، بعبوره حدود البلدان، أكبر وأوسع من أن تحده قضبان
السجن، وأن المواطن العادي لم يعد مجرد متلق للأخبار الجاهزة المؤدلجة.
إن تضييق حرية الحركة والتعبير الفعلي داخل العراق، وشرعنة العقاب
قانونيا، ومقصلة التهديد المعيقة للبحث والاستقصاء لكشف الحقائق، تتطلب
اللجوء الى الإنترنت أكثر فأكثر بوصفه ، اضافة الى فوائده، مساحة
مفتوحة للتضامن العالمي ودعم قدرة الناشطين والصحافيين وكل المواطنين
على النضال لإزالة « الرقيب» المنغرز، داخل العقول. ولتكن ردود الافعال
على منظومة القمع ، عبر التضامن العالمي الشعبي، بالاضافة الى
المظاهرات والاعتصامات، الحدث الأهم للسنوات المقبلة.
كاتبة عراقية
هل بإمكان المثقف
العراقي إشاعة التفاؤل؟
هيفاء زنكنة
ارتدت الشابة العراقية شيماء العباسي (23 عاماً) معطف بابا نويل
الأحمر، ثم تجولت، بدراجتها، وسط أنقاض وحطام المدينة القديمة،
بالموصل، شمال العراق، وهي توزع الهدايا لأطفال المدينة المنكوبة،
بمناسبة عيد الميلاد.
وانطلقت يوم الأحد الماضي، بطولة أندية العراق للسيدات بالمصارعة الحرة
في محافظة الديوانية، في منطقة الفرات الاوسط . استمرت البطولة مدة
ثلاثة ايام بمشاركة أكثر من 15 ناديا، من اغلب المحافظات وبجميع الفئات
العمرية. في اليوم نفسه، تم نصب شجرة عيد ميلاد تضيئها المصابيح
الملونة و 2021 ، استعدادا للاحتفاء بالعام الجديد ، في ساحة التحرير،
وسط بغداد. وهي الساحة التي شهدت ، منذ الاحتلال عام 2003، مظاهرات
واعتصامات توجت بانتفاضة تشرين الأول / اكتوبر 2019 ، بشهدائها وجرحاها
ومعتقليها وفنونها وأغانيها وتغيراتها السياسية والاجتماعية. قبل ذلك،
بادر مواطنون في مدينة السماوة، جنوب غرب بغداد، إلى تغليف أعمدة
الكهرباء بمادة النايلون لحماية المارة وخصوصا الأطفال من الصعقات في
فترة هطول الامطار وبعد أن يئسوا من قيام المسؤولين باتخاذ اية خطوة
لوقاية الأهالي من الموت. تشكل هذه المبادرات ، واستعادة ذكرى عام
الانتفاضة ، نفحة أمل، يستدعيها العد التنازلي لأيام العام الحالي
المغرق بالعتمة.
كيف التعامل مع طبقة سياسية تتغذى على ريع النفط بمليارات الدولارات وتنتعش على الفساد، وتسكت من يعارضها أو يخالفها، بإرهاب الميليشيات وقدسية المرجعيات الدينية؟
فمن الحقائق التي نكاد نتقبلها، بلا نقاش، أن إطلالة كل عام جديد تحمل
في طياتها الأمل، مهما كان الواقع سوداويا مريرا. واذا ما تلاحمت دقائق
الايام المقبلة بما يقال حول دور المثقف في اشاعة الامل او على الاقل
عدم إشاعة اليأس والاحباط، لئلا يموت الناس كمدا ، تصبح للكتابة ،
نهاية العام وبداية عام آخر، نكهة مختلفة .هذه بديهية عامة، تنطبق على
كل الاعوام، تقريبا، فكيف اذا كان العام الذي نتحدث عن مغادرته هو 2020
، بكل ما جلبه من وباء وازمات اقتصادية وانهيار المناخ، على مستوى
العالم، وتأثير ذلك كله على العلاقات السياسية والاجتماعية، في بلداننا
؟ واذا كان العام الذي سنستقبله متسربلا بما كشفه الوباء عن أوجه
اللامساواة والظلم ، والاستغلال ، والفساد المنهجي، والتقسيم العنصري
الواضح بين إنسان العالم الاول وانسان العالم الثاني، كما يؤكده فشل
قضايا المساءلة القانونية الدولية، متمثلا بالنسبة الى العراق بقرار
وفجوة العلاقات بين الدول العسكرية الكبرى والدول المحتلة التي يتنازع
أهلها على رمال الهوية والوطنية المتحركة؟
وهل بإمكان المثقف ، فعلا ، تجاوز هذا الواقع بما يطرحه من تحديات
ليركز على زرع الأمل ( بما يحمله من تلفيق وتضخيم أحيانا) متجاوزا دوره
وما يجب عليه القيام به ، كما يلخصه الكاتب فاسلاف هافيل، الذي عاش
تجربة تقسيم بلده الى بلدين وتسنم منصبين في ظروف استثنائية نادرة حيث
شغل منصب آخر رئيس لبلده تشيكوسلوفاكيا ثم أصبح أول رئيس لجمهورية
التشيك بعد التقسيم . «يجب على المثقف أن يزعج باستمرار ، يجب أن يشهد
على بؤس العالم ، يجب أن يكون استفزازيًا من خلال كونه مستقلاً ، يجب
أن يتمرد على جميع الضغوط والتلاعبات الخفية والمفتوحة، يجب أن يكون
المشكك الرئيسي في الأنظمة … ولهذا السبب، لا يمكن للمثقف أن يتناسب مع
أي دور قد يتم تكليفه به … ولا ينتمي بشكل أساسي إلى أي مكان: فهو يبرز
على أنه مصدر إزعاج أينما كان». يطرح تعريف فاسلاف الكثير من الاسئلة
من بينها التناقض أو الشرخ ما بين أفكار الكاتب وممارساته. وهو شرخ
عاشه فاسلاف نفسه ، كما يعيشه، في بلادنا العربية، الكثيرون من كتابنا
ومثقفينا.
عراقيا، يمتد الشرخ، ليطفو ما هو مغمور فيه، على سطح ضحل لايتحمل ثقل
الأسئلة الأساسية. ما هو برنامجنا؟ وكيف نتحمل كأفراد (فنحن أفراد..
قبل أن نكون أمما) إذا أردنا البقاء على قيد الحياة؟ ما هي أوجه التكيف
التي يجب أن نتوصل اليها مع صعود الأنظمة الاستبدادية والصراعات
الأهلية، ومع استمرار الاستعمار القديم بالهيمنة على منطقتنا بأوجه
جديدة ؟ هل لدينا، لمواجهة القتلة والحكام الفاسدين والميليشيات وقوى
الاحتلالين العسكري والناعم، سيناريو ثان اذا ما فشل السيناريو ألاول؟
سيناريو مواصلة الحياة بعد رحيل الشهداء، والنضال السلمي بعد المقاومة
المسلحة، وكيفية تحقيق التحولات المجتمعية التقدمية، وبناء التضامن مع
العالم الخارجي، ونحن نعلم جيدا أن نصفه، على الأقل، يرى أن الخنوع
والاستسلام هو السلام وان صناعة الموت دفاع عن الامن القومي؟ كيف
نتعامل مع المجتمع الدولي الذي أقنع الناس بأن القانون الدولي هو بديل
الموقف الأخلاقي بينما يطبق درجات مختلفة من القانون / القيم الاخلاقية
حسب قوة الدول العسكرية، ومثالها اعلان المحكمة الجنائية الدولية أنها
لن تتخذ أي إجراء ضد المملكة المتحدة رغم عثورها على أدلّة على تورّط
قوات من الجيش البريطاني بارتكاب جرائم حرب في العراق؟ كيف التعامل مع
دول يمارس رؤساؤها الإرهاب «قانونيا» ، ويصنفون « الارهاب» حسب
مصالحهم، كما فعل الرئيس الأمريكي ترامب اخيرا حين أصدر عفواً عن أربعة
مرتزقة من شركة «بلاك ووتر» للخدمات الأمنية الخاصة كانوا يقضون عقوبات
بالسجن لقتلهم 14 مدنيا عراقيا، بينهم طفلان، في بغداد؟
محليا ، كيف التعامل مع طبقة سياسية تتغذى على ريع النفط بمليارات
الدولارات وتنتعش على الفساد، وتسكت من يعارضها أو يخالفها، ولو كان من
بين صفوفها، بإرهاب الميليشيات وقدسية المرجعيات الدينية؟ مثال ذلك
التهديد الذي أطلقه أبو علي العسكري، المسؤول الأمني لميليشيا « كتائب
حزب الله» في تغريدة له يوم السبت الماضي ، ضد رئيس الوزراء مصطفى
الكاظمي، قائلا بأن « الوقت مناسب جداً لقطع أذنيه».
هل هذه لحظة صالحة لبعض التفاؤل – كيف تبدو وكيف يمكن المضي قدمًا؟
ليست لدي اجابة جاهزة . بل اقتبس من الفنان الفلسطيني الراحل ناجي
العلي، الذي دفع حياته ثمنا لما يؤمن به، قوله إن دور المثقف هو شرح
الحال وليس توفير الحل. مما يعني ان الحل بيد الشعوب. ماذا عن التفاؤل
؟ « التفاؤل هو استراتيجية لبناء مستقبل أفضل. لأنه ما لم تعتقد أن
المستقبل يمكن أن يكون أفضل ، فمن غير المرجح أن تتقدم وتتحمل مسؤولية
تحقيق ذلك. إذا افترضت أنه لا أمل ، فأنت تضمن أنه لن يكون هناك أمل.
إذا افترضت أن هناك غريزة للحرية ، فهناك فرص لتغيير الأشياء ، فهناك
فرصة قد تساهم في صنع عالم أفضل. الخيار لك» كما يذكر المفكر الأمريكي
نعوم تشومسكي.
كاتبة من العراق
مهندسو النفط
عاطلون في عراق النفط
هيفاء زنكنة
عاد خريجو كليات الهندسة للتجمع يوم الأحد الماضي، احتجاجا، أمام مقر
مصفى الشعيبة، غرب مدينة البصرة، جنوب العراق. سبب العودة هو عدم
استجابة الحكومة لمطالبهم في التعيين بشركات النفط. وكانوا قد تظاهروا
قبل ذلك بايام، وقطعوا الطريق المؤدي الى المصفى، بعد أن شكّلوا حاجزا
لمنع الموظفين من الدخول. وتعتبر مصفاة الشعيبة واحدة من اهم وحدات
تكرير النفط في الجنوب.
هذه ليست المرة الأولى أو الثانية التي يحتج فيها خريجو كليات الهندسة
سواء في محافظة البصرة أو بقية أرجاء العراق. فقد سبقها عديد
الاحتجاجات، في السنوات الاخيرة، حيث كان الخريجون في واجهة المتظاهرين
في انتفاضة تشرين/ اكتوبر 2019، المطالبين بوطن يتمتعون فيه بحقوقهم
الأساسية ومن بينها حق العمل. وشهدت الشهور الاخيرة، مع زيادة انتشار
فايروس كورونا ونسبة العاطلين عن العمل، تكثيفا في الاحتجاجات.
ففي يوم 4 تشرين الثاني/ نوفمبر، خرج مئات الخريجين المعتصمين منذ 120
يوماً في مسيرة احتجاجية سلمية راجلة، جابت الشوارع المحيطة بشركة نفط
البصرة للمطالبة بتوفير العمل لهم. إلا أن التجاهل الحكومي أدى الى
تطوير الاحتجاج وفي يوم 19 تشرين الثاني/ نوفمبر، قام عدد من الخريجين
باغلاق مدخل البئر النفطي 20 ومدخل بوابة شركة نفط البصرة، في خطوة
تصعيدية عسى أن يجلب ذلك الانتباه الى وضعهم المتأزم إلا أنهم قوبلوا
بالصمت الحكومي المطبق. فأصدروا بيانا يوم 9 كانون الاول/ ديسمبر
خاطبوا فيه رئيس الوزراء ووزير النفط ونواب المحافظة ومدير الشركة
بالإضافة إلى الشركات النفطية كافة بخصوص وضعهم ومطالبتهم بتصديق
الوعود التي قطعوها لهم بشأن التعيين.
ساهم الخريجون، على اختلاف اختصاصاتهم، في المظاهرات والاعتصامات
المطالبة بالعمل، منذ احتلال البلد وتسنم الفاسدين المناصب في محاصصة
تُجّذر وجودهم. ويقدر البنك الدولي أن نسبة البطالة بين الشباب في
العراق تبلغ 36 بالمئة، مقارنة بمعدل البطالة الوطني البالغ 16 بالمئة.
ومن بين هؤلاء الشابات والشباب العاطلين وغير القادرين على تكوين
أنفسهم ودعم عوائلهم، هناك أكثر من مليون ونصف المليون ممن تخرجوا منذ
الاحتلال من الجامعات والمعاهد العالية بجميع الاختصاصات. وبصرف النظر
عن تدني المستوى التعليمي فهم أعلى فهما وقدرة وجدوى ممن تجندهم او
توظفهم الكتل الحاكمة وميليشياتها من الأميين أو ذوي الشهادات المزيفة.
مما يثير تساؤلا حول أهمية خريجي كليات الهندسة بالتحديد؟
والجواب هو أن لمطالبهم خصوصيتها، كونهم أبناء بلد يحتل المرتبة
السادسة عالميا كأكبر منتج للنفط خلال عام 2019، بعد أمريكا والسعودية
وروسيا وكندا والصين، اضافة الى أن بلدهم يملك خامس أكبر احتياطي للخام
في العالم، يمثل 18 بالمئة من احتياطيات الشرق الاوسط وتقريبا 9 بالمئة
من الاحتياطيات العالمية للنفط. إلا أن القاء نظرة واحدة على أوضاع
شعوب البلدان الخمسة، عموما، من الناحية الاقتصادية والرعاية الصحية
والاجتماعية وفرص العمل، بالمقارنة مع العراق، والاستهانة بالمواطن
ومحاربته في لقمة عيشه، أكثر من كاف لفهم سبب المظاهرات والاعتصامات
المستمرة فيه والتي يدفع الشباب ثمنها بتكلفة باهظة الثمن.
أدى سوء تقديم الخدمات والفساد المستشري إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة والفقر في العراق إلى مظالم عامة حتى قبل انتشار الوباء العالمي
إن ما يطالب به خريجو الهندسة بسيط بساطة استنشاق الهواء وهو حقهم
بالعمل في حقولهم النفطية، أي في حقول يفترض أن تكون ملكهم كمواطنين
عراقيين، مؤهلين للعمل في مجال اختصاصهم الذي قضوا سنوات وهم يستعدون
له ولهم الأولوية في العمل وهو حق من حقوقهم وليس منة تتفضل بها شركات
النفط الأجنبية مثل أكسون موبيل الأمريكية وبي بي البريطانية ورويال
دتش شل البريطانية الهولندية، فضلا عن الشركات الصينية والروسية
المهيمنة على حقول النفط والتي تفرض تعيين المهندسين والأيدي العاملة
الأجنبية بجنسيات باكستانية وبنغلاديشية وفليبينية بالاضافة الى
البريطانية والأمريكية، بينما ينظر الى توظيف العراقي كنسبة تقع ضمن
تصنيف استخدام « السكان المحليين» وليس أصحاب البلد ومالكيه. لذلك، من
الطبيعي، أن يكون المهندس والتقني والعامل والحارس العراقي من أوائل من
تنهى خدماتهم حالما تتعرض الشركات لانخفاض نسبة الأرباح أو تقليص
الميزانية. مثال ذلك، ما تم في الآونة الاخيرة حين تم ارسال 15 ألف
عامل عراقي الى بيوتهم عند انخفاض اسعار النفط.
يبرر النظام العراقي عدم قدرته على تعيين عموم الخريجين وتدهور الوضع
الاقتصادي وازدياد الفقر المهدد 5.5 مليون عراقي ( حسب المرصد
الاقتصادي للعراق التابع للبنك الدولي) بانهيار اسعار النفط وانتشار
وباء كوفيد 19. الا ان هذا ليس صحيحا بل إنه فبركة مفضوحة لستر
الحقيقة، وهي محاصصة الفساد النهمة بين أحزاب النظام ومؤسساته التي
انتشرت قبل الوباء وحتى قبل ظهور داعش. وهذا ما يؤكده البنك الدولي في
تقرير له في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، جاء فيه «أدى سوء تقديم
الخدمات والفساد المستشري إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة والفقر إلى
مظالم عامة حتى قبل انتشار الوباء العالمي». اذ ليس خافيا على أحد تبوؤ
العراق مركزا متقدما في قائمة الدول الفاسدة بالعالم، كما أن حكومات
الاحتلال المتعاقبة لم تؤسس لأية صناعة وطنية بل قامت بتحطيم ما هو
موجود منها. اختفت الصادرات الوطنية مثل الرز، والفواكه المجففة،
والمصابيح الكهربائية، ونواتج قطران الفحم، والإسمنت، والصوف، وجلود
الحيوانات، والمنتجات النحاسية، والمواد الكيميائية المبلمرة،
والشاحنات، وأجزاء السيارات، مما جعل العراق « من أقل الدول تنويعاً في
الصادرات في العالم. في عام 2018، لم يكن سوى 4.1 بالمئة فقط من صادرات
العراق يشتمل على أي شيء آخر غير النفط الخام، منخفضة عما كانت عليه
عام 2004 عندما بلغت 8.5 بالمئة. وأدى التخلي عن المزارع والمصانع خلال
سنوات الصراع إلى إضعاف القدرة الإنتاجية للعراق بشكل كبير. ونتيجة
لذلك، فإن الحصة المشتركة للزراعة والتصنيع في الناتج المحلي الإجمالي
للعراق انخفضت بنحو ثلاثة أرباع منذ أواخر الثمانينيات» حسب البنك
الدولي.
بلا صناعة وبلا زراعة، ومع استخدام التعيينات الحكومية كأداة لتقوية
الأحزاب الفاسدة على حساب الكفاءات والتنمية استنادا الى الانتاج
والصناعة الوطنية، تؤكد يوميات الاحتجاجات في العراق كله، خاصة من قبل
الخريجين، أنها باقية ولن تنتهي ما لم يحدث تغيير حقيقي على مستوى
الوطن كله.
كاتبة من العراق
مظاهرات عرب وكرد
العراق غير مجدية
هيفاء زنكنة
منذ الثاني من كانون الأول/ ديسمبر والمظاهرات مستمرة وإطلاق النار على
المتظاهرين السلميين مستمر، وأعداد الشهداء والجرحى في تزايد بالعراق.
توثق الفيديوهات مطاردة القوات الأمنية للمتظاهرين واستهدافهم بالرصاص
الحي. خلال أسبوع واحد استشهد تسعة شباب وجرح 59. كلا، هذه ليست ساحة
التحرير، ببغداد، أو ساحة الحبوبي، في مدينة الناصرية، جنوب بغداد. كما
أنها ليست مدينة الفلوجة أو الموصل. إنها ليست الساحات والمدن التي
باتت المظاهرات والاعتصامات ملمحا من ملامحها العمرانية ومسيرات وداع
الشهداء جزءا من شوارعها. كما أن المحتجين ليسوا، هذه المرة، ممن يمكن
قولبتهم ضمن التوصيفات الجاهزة: سنة أو شيعة أو دواعش أو قاعدة.
المتظاهرون المستهدفون بالاعتداء والاعتقال والقتل هم من مدينة
السليمانية، شمال العراق، في إقليم كردستان. الإقليم الموسوم من قبل
الإعلام الغربي بنموذج الديمقراطية وحقوق الإنسان.
خرج المتظاهرون، كما في بقية محافظات العراق، احتجاجا على عدم دفع
الرواتب والبطالة والفساد. ما يميزهم عن المتظاهرين في بقية أرجاء
البلاد، هو أن رواتبهم تدفع من قبل حكومة الإقليم التي تقبض ميزانيتها
من الحكومة المركزية ببغداد. بين الحكومتين ضاعت الرواتب على الرغم من
ميزانيتيهما الخيالية، وحيازتهما على مليارات الدولارات النفطية،
بالقياس إلى ما كانتا عليه قبل الاحتلال عام 2003، غير أن شراهة فساد
الحكومتين تزداد يوما بعد يوم.
امتدت المظاهرات، بسرعة، لينضم إليها سكان بلدات وقرى في ضواحي محافظة
السليمانية الواقعة تحت سلطة الاتحاد الوطني الكردستاني، وليصب غضب
الناس على رئاسة الحكومة المتمثلة بالحزب الديمقراطي الكردستاني والذي
ينتمي إليه رئيس الإقليم ورئيس الوزراء. فإقليم كردستان، خلافا للتسمية
التي قد تدل على وحدة الكرد، مقسم عمليا، سياسيا وإداريا ومؤسساتيا بين
الحزبين، أو الأصح سلالة العائلتين الحاكمتين وهما عائلة / عشيرة
البارزاني (مقرها الرئيسي أربيل) وعائلة الطالباني (مقرها الرئيسي
السليمانية). وإذا كانت خلفية المتظاهرين في السليمانية وما حولها،
بضمنها مدينة حلبجة، الوجه الإعلامي المعروف عالميا بضحايا السلاح
الكيمياوي، مختلفة من الناحية الإثنية عن بقية المدن العراقية
المنتفضة، إلا أن الطريقة التي ووجهت بها واحدة. إذ سرعان ما اتهم
المتظاهرون بتهديد الأمن القومي وتدخل قوى خارجية مما شرعن شراسة
القوات الأمنية والاعتداءات الجسدية والاعتقالات والغاز المسيل للدموع
والاستهداف بالرصاص الحي، لتثبت وحشية التعامل مع المتظاهرين أن الحاكم
المستبد واحد والنظام القمعي واحد، مهما كان الدين أو المذهب أو العرق.
وأن الفساد الذي يغذي وجودهم واحد، والخوف من أبناء الشعب المستهان
بكرامته واحد.
تبين الفيديوهات المتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي، بوضوح، حجم
الخوف الذي تعيشه السلطة الفاسدة من أبناء الشعب المحروم من حقوقه. حيث
تم إنزال الدبابات والمدرعات إلى الشوارع، وأغلقت ساحات معروفة
للمظاهرات، ليحتلها مسلحون مقنّعون مدججو السلاح إزاء شباب تكاد
تبتلعهم الفجوة الهائلة بين الثراء المليارديري السريع، المبتذل،
لساكني المجمعات السكنية المحمية بحراسات شركات أمنية خاصة وبين الشباب
العاطل الهارب إلى أوروبا في قوارب الموت.
المنافسة بين الحكومتين لتصدر قائمة النهب والفساد والمحسوبية والمنسوبية محمومة، ومثقلة بدماء ضحايا الاحتجاجات من أبناء العراق كله، بلا استثناء
تبرر سلطة الإقليم فشلها في دفع الرواتب وقلة الخدمات بـ« عدم وفاء
حكومة بغداد بالتزاماتها المالية». والحقيقة هي أن المنافسة بين
الحكومتين لتصدر قائمة النهب والفساد والمحسوبية والمنسوبية محمومة،
ومثقلة بدماء ضحايا الاحتجاجات من أبناء العراق كله، بلا استثناء. فهذه
ليست المرة الأولى التي يتظاهر فيها الكرد في محافظات الإقليم، كما
أنها ليست المرة الأولى التي يٌستهدف فيها المتظاهرون والصحافيون
بالعنف وقمع الحريات. بل إن ما يجري، حاليا، هو استمرارية لعقود من
الاقتتال على محاصصة الفساد، بأنواعه، بين الحزبين، تتخللها الاحتجاجات
والاعتصامات الجماهيرية المطالبة بوضع حد لامتهان كرامة المواطن وحقوقه
الأساسية. ففي 19 فبراير/ شباط 2011، مثلا، تظاهر نحو ثلاثة آلاف من
طلاب جامعة السليمانية مطالبين رئيس الإقليم مسعود بارزاني بالاعتذار
عن قيام حراس مقر حزبه بإطلاق النار على متظاهرين مما أسفر عن مقتل
اثنين وإصابة 57 جريحا. وفي 12 أغسطس/آب، من العام الحالي، خرج
المحتجون للمطالبة بتحسين التعليم وفرص العمل وتدابير مكافحة الفساد.
وحين قامت قناة إن آر تي، بتغطية الاحتجاجات، أغلقت السلطات الكردية
مكتبي القناة في أربيل ودهوك بذريعة « تشجيع تكدير الأمن العام
والإضرار بالانسجام الوطني».
على مستوى حرية التعبير، مارست السلطات أنواع التضييق والتهديد وحتى
الاغتيال. إذ تم اختطاف الصحافي الشاب سردشت عثمان (23 عاما) في 4
أيار/ مايو 2010 من أمام كلية اللغات، بجامعة صلاح الدين، بأربيل. وعثر
على جثته بعد يومين وعليها آثار ضرب وهي مصابة بإطلاقات نارية في منطقة
الرأس. وكان السبب كتابته أربعة مقالات ساخرة من السلطة والرئيس
بارزاني. أشار في أحداها إلى « كلاب أمريكا البوليسية وحراس
إسرائيليين» مستخدمين لحراسة الأغنياء.
كما كتب عن بعض نواحي فساد إدارة الإقليم، قائلا: «هنا بلدٌ لا يسمح لك
أن تسأل الرئيس لماذا أعطيت كل هذه المناصب الحكومية والعسكرية لأبنائك
وأحفادك وأقاربك؟ من أين أتى أحفادك بكل هذه الثروة؟» مشيرا إلى مصيره
«إذا استطاع أحد أن يطرح هذه الأسئلة فإنه قد اخترق حدود الأمن القومي
وعرّض نفسه لرحمة بنادقهم وأقلامهم». ولا تقل تهديدات وملاحقة الاتحاد
الوطني عن الحزب الديمقراطي، حيث هدد هالو إبراهيم أحمد (شقيق زوجة
الطالباني الرئيس الراحل) الصحافي ناباز كوران في 28-2-2008 قائلا
«سأقتلك ياكوران حتى لو بقي يوم واحد من عمري». وذلك لمجرد كتابة كوران
مقالة نشرت في صحيفة «هولاتي» المستقلة، انتقد فيها قلة الكهرباء في
الإقليم بينما يبقى قبر إبراهيم أحمد المشيد بشكل مزار، في أطراف
السليمانية، لا تنقطع عنه الكهرباء على مدار اليوم.
إن بقاء الإقليم مقسما، من ناحية توزيع النفوذ والمناصب والعقود، بين
الحزبين، بالإضافة إلى استشراء الفساد العام، المغلف بالسياسة
والشعبوية القومية، بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية، ولجوئهما،
سوية، إلى استغلال حملات التخويف والترويع من «الآخر» تتطلب نضالا
موحدا من أجل الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية لكل العراقيين على
تنوع قومياتهم وأديانهم ومذاهبهم. لم تعد المطالب الخدماتية المتفرقة
لشرائح وطبقات سكانية في مدن ومحافظات، كل على حدة، بلا تنسيق موحد
جامع، مجدية بمواجهة أنظمة وسلطات قمعية مستعدة للتضحية بكل المواطنين
لتبقى. إن التغيير الحقيقي يتطلب توحيد القوى المؤمنة فعلا بكرامة
الإنسان. الإنسان بالمعنى العميق الشامل للإنسانية. وإن العراق بلد
يتسع للجميع، ولعل هذا ما عناه سردشت حين كتب قبل اغتياله «وأينما
انتهت حياتي فليضع أصدقائي نقطة السطر، وليبدأوا هم بسطر جديد».
كاتبة من العراق
سويسرا الحيادية تستثمر
أموالها في صناعة الحروب
هيفاء زنكنة
قام الشعب السويسري بالتصويت، الشهر الماضي، على مبادرتين لهما أبعاد
اقتصادية دولية وانعكاسات أخلاقية وانسانية. لم يتم تمرير أي منهما.
تدعو المبادرة الأولى المسماة «من أجل شركات مسؤولة» الى محاسبة
الشركات السويسرية، متعددة الجنسيات، على انتهاكات حقوق الإنسان أو
انتهاكاتها للمعايير البيئية التي ترتكبها في الخارج، في زمن بات فيه
نفوذ هذه الشركات يفوق غالباً نفوذ البلدان التي تعمل فيها. وتدعو
المبادرة الثانية المسماة «مناهضة تجارة السلاح» إلى إضافة مادة إلى
الدستور السويسري تحرّم تمويل صناعة الأسلحة. وهذا يعني أن البنك
الوطني السويسري ومؤسسات التمويل والادخار لن تستطيع منح قروض أو
استثمارات للشركات التي يولّد إنتاج المواد الحربية أكثر من 5 بالمئة
من عائداتها السنوية. وسيتوجب على سويسرا أيضاً أن تلتزم على المستوى
الوطني والدولي بتوسيع هذا الحظر ليشمل البنوك وشركات التأمين.
تثير نتيجة التصويت عديد التساؤلات حول حضارة الأمم والمستوى الأخلاقي
لمواطني دول يتمتعون فيها بحرية الاختيار.
وهل بامكان العالم التطلع الى مستقبل خال من صناعة الحروب وتحقيق
السلام، فعلا، أم انها أضغاث احلام « يسارية» لأشخاص ومنظمات، تعيش
بعيدا عن الواقع، مستنزفة، ببيعها الأحلام، قوى الناس في نشاطات يعرفون
جيدا أنها غير مجدية؟ هل هناك شعب محب للسلام تخلى عن صناعة الحرب
المربحة بامكاننا استحضاره كنموذج، لشحن طاقة الأمل بالسلام في ارجاء
الكرة الارضية، مستقبلا، وخاصة في منطقتنا التي تعيش 40 بالمئة من
الحروب بالعالم؟
إن القاء نظرة على حجم تصنيع وانتاج العتاد الحربي وتصديره، وأهميته
الأساسية في اقتصاد الدول المنتجة، وبالتالي انعكاسه على ارتفاع مستوى
معيشة الفرد، يبين أن هذه الصناعة المربحة لن تكون مهددة بالانقراض
قريبا. بل هناك ما يؤكد، أنها ستبقى، لاسباب سياسية بالاضافة الى
الاقتصادية، بمنأى عن التخلي الرسمي والشعبي معا، مهما كانت الدول
المصدرة حيادية وتشدّد على تقاليدها الإنسانية واحترامها لحقوق
الإنسان، كما هي سويسرا.
تأتي مبادرة « مناهضة تجار السلاح» في سياق ازدياد تصدير السلاح
السويسري. واذا كانت الفكرة السائدة عن سويسرا أنها البلد المحايد،
المضيف، لأهم المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية والمصّنعة للأدوية
والساعات الراقية، فقط، فان الواقع يؤشر الى ما هو أكثر من ذلك. حيث
تُصدر سويسرا السلاح وعلى رأسها أنظمة الدفاع الجوي والمدرعات، إلى خمس
وخمسين دولة، من بينها دول في حالة حرب بما في ذلك الكيان الصهيوني
والسعودية والإمارات.
تكتسب متابعة ما يجري في سويسرا أهمية بالغة بالنسبة إلينا، نحن أبناء البلدان التي يتغذى حكامها ومستبدوها على شراء السلاح ولا مانع لديهم من دفع المليارات ثمنا لأسلحة تستخدم، غالبا، ضد شعوبهم
وتواصل سويسرا تغذية الحرب ضد اليمن بالسلاح منذ أكثر من خمسة أعوام،
بالاضافة الى وجود تقارير تؤكد وصول اسلحتها الى سوريا وليبيا، على
الرغم من كونها محظورة. اذ من المفترض خضوع صادرات الأسلحة السويسرية
إلى مناطق النزاع الى قانون العتاد الحربي، الذي تنص المادة 5 منه على
أنه لا ينبغي منح ترخيص تصدير إذا كان بلد المقصد متورطًا في نزاع مسلح
داخلي أو دولي؛ وإذا كان ينتهك حقوق الإنسان «بطريقة منهجية وخطيرة»؛
وإذا بدا أن هناك احتمالا لاستخدام الأسلحة المصدرة ضد المدنيين؛ أو
إذا كان هناك «خطر كبير في أن تتم إعادة تصدير هذه الأسلحة إلى مستلم
نهائي غير مرغوب فيه». الا ان هذه النصوص القانونية المقيدة لم تمنع
وصول الاسلحة الى بلداننا، مما دفع حزب الخضر و«مجموعة من أجل سويسرا
بدون جيش» والأحزاب اليسارية والمنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال
تعزيز السلام الى طرح المبادرة الثانية، المستهدفة للشركات التي تحقق
أكثر من 5 بالمئة من ربحها السنوي من إنتاج السلاح. مع العلم أن
الاستثمار والإتجار بالأسلحة البيولوجية والكيميائية والنووية وكذلك
الألغام المضادة للأفراد والذخائر العنقودية محظور في سويسرا.
أثارت هذه المبادرة، النقاش ما بين المؤيدين والمعارضين، لارتباطها
بالوضع الاقتصادي العام والمعاشي للمتقاعدين. شكّل معارضو المبادرة
لجنة مؤلفة من مسؤولين منتخبين من جميع الأحزاب اليمينية والوسطية
وكذلك النقابات المهنية لمحاربتها. فقبولها يعني اعادة النظر في
استثمار ما قيمته 1.93 تريليون دولار، يدار من قبل المصرف الوطني
السويسري، ومنظومة التأمين ضد الشيخوخة والعجز التي تديرها الدولة،
بالإضافة إلى أكثر من ألف وخمسمائة صندوق معاشات مهنية. وأي مس بهذه
الاستثمارات يُشعر المواطن بالقلق لما قد يصاحب ذلك من تدهور في وضعه
الاقتصادي، بالاضافة الى تقليل فرص العمل المرتبطة بتصنيع السلاح. فحسب
تقرير منظمة «لا تستثمر في القنبلة» استثمر المصرف الوطني السويسري و
«كريدي سويس» و«يو بي إس» حوالي 9 مليارات دولار في شركات منتجة للمواد
الحربية المحظورة في عام 2019، ومنها شركات أيرباص وبوينغ.
يرى مؤيدو المبادرة أن الاستثمار في صناعة السلاح وتصدير المعدات
الحربية يُساعد على تأجيج النزاعات المسلحة في جميع أنحاء العالم، مما
يتعارض مع صورة سويسرا كوسيط دبلوماسي محايد، ودولة تروّج وتدعم الجهود
الإنسانية. كما يقترحون ان هناك صناعات واستثمارات بديلة لتجارة
الحروب. «هناك قطاعات أخرى صالحة للاستثمار مستقرة ومُربحة مثل تجارة
الحرب» تقول المتحدثة باسم حزب الخضر. هذا صحيح، طبعا، وليس من
المستحيل تحقيقه.
الا أن حملة رفض المبادرة المكثفة التي ضمت غالبية مجلس النواب
السويسري والأحزاب اليمينية بالاضافة الى النقابات المهنية ( وهي نقطة
تستحق الدراسة) وحثهم الناخبين على رفضها، أدت الى عدم تمريرها وان
حازت على نسبة عالية من الاصوات.
تكتسب متابعة ما يجري في سويسرا أهمية بالغة بالنسبة إلينا، نحن أبناء
البلدان التي يتغذى حكامها ومستبدوها على شراء السلاح ولا مانع لديهم
من دفع المليارات ثمنا لأسلحة تستخدم، غالبا، ضد شعوبهم، وبإمكان مصدر
السلاح فرض شروط استخدامها عليهم ومنعهم إذا ما عاشوا صحوة ضمير
وأرادوا استخدامها ضد أعدائهم الحقيقيين، والأمثلة في فلسطين واليمن
وسوريا كثيرة. كما تثير متابعة التصويت في سويسرا تساؤلا بالغ الأهمية
وهو اذا كان هذا هو الوضع بالبلد المحايد غير التوسعي فكيف يمكن تحجيم
صناعة السلاح والحروب في أمريكا وهي من اكبر الدول المصدرة للسلاح
وسياستها تهدف الى الهيمنة على العالم؟
تعتمد صناعة السلاح، في مفهوم السوق التجاري الرأسمالي، على الربح وما
يوفره من رفاهية لشعوب الدول المصدرة.
وتنبع مناهضتها، من قبل شرائح مجتمعية دون غيرها، لأسباب أخلاقية
وانسانية تخوفا من استغلال الشركات والدول لفرص الربح على حساب حياة
الناس. هنا تكمن مسؤولية الحكومات في بلداننا الموبوءة بالاستبداد
والقمع والنزاعات المختلقة والحروب في وضع حد لصفقات السلاح المربحة
القاتلة، ولأن قدرة حكوماتنا على تنفيذ ذلك مشكوك بها، لعل الضوء الذي
يمنحنا الأمل هو العمل سوية مع مناهضي انتاج السلاح وحركات السلام في
البلدان المنتجة للسلاح نفسها.
كاتبة من العراق
اقتتال المجموعات العرقية والمذهبية
في ساحة الحبوبي في العراق!
هيفاء زنكنة
إلى قائمة شهداء انتفاضة تشرين الأول/اكتوبر 2019 البالغ عددهم 600
شخص، وجرحاها الذين تجاوز عددهم عشرات الآلاف، أضافت مدينة الناصرية،
في محافظة ذي قار، جنوب العراق، في الايام الثلاثة الاخيرة، ضحايا جددا
من شباب لم تتح لهم فرصة التمتع بشبابهم وتحقيق طموحاتهم وأحلام ذويهم.
سبعة شهداء و85 جريحا.
لماذا؟ لماذا يقتل شبابنا ومعهم تدفن آمالنا ومستقبل بلادنا؟ يتساءل
الأهالي المخضبة وجوههم بالدموع وهم يرون أبناءهم يقتلون بلا سبب غير
مطالبتهم بحق الحياة بكرامة، وألا يهانوا في بلدهم، على أرضهم، وأن
يعيشوا أيامهم كما الآخرون في بلدان أقل ثراء. وأن تتوفر للجميع
اساسيات الحياة والمواطنة، وأن يُحترم حقهم بالتظاهر السلمي والاحتجاج
اذا ما أساء المسؤولون استخدام سلطتهم ونسوا، أو تناسوا، أن مواصفات
وظيفتهم تنص، بوضوح، على أن واجبهم هو خدمة الشعب وليس العكس.
هل هذا صعب التحقيق في بلد ثري بميزانية سنوية تعادل عدة بلدان مجاورة
يعيش أهلها ظروفا حياتية تليق بالإنسان؟ هل من الصعب ايجاد اشخاص غير
فاسدين ينتمون الى الشعب ويعرفون معنى الحرية والكرامة والوطنية؟ هل
الصورة معقدة، فعلا «لأننا بلد متعدد القوميات والمذاهب» كما يحاول
الساسة إقناعنا ويروج له إعلاميا، وكان واحدا من تبريرات المحتل «
الإنسانية»؟ واذا كان هذا صحيحا في بلد لا يزيد عدد المذاهب والقوميات
فيه عن العشرة، واللغات عن اربع، ماذا عن في أندونيسيا حيث تتعايش 1300
مجموعة عرقية تتحدث 652 لغة بسلام؟ ماذا عن الفلبين وبين سكانه 180
مجموعة عرقية؟ و تشاد، في شمال وسط إفريقيا، حيث ينتمي 8.6 مليون نسمة،
أي ربع سكان العراق تقريبا، إلى أكثر من 100 مجموعة عرقية؟
تبين مراجعة الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق المواطنين، في ارجاء
العراق، على مدى 17 عاما الأخيرة، أنها بدأت بشكل طائفي وعرقي تزامنا
مع احتلال البلد وعودة أحزاب المعارضة المتعاونة مع المحتل للاستحواذ
على السلطة وهي بلا جذور حقيقية في المجتمع. فكانت بحاجة ماسة الى
تجذير وجودها عن طريق التخويف والترهيب واختلاق هويات مصطنعة وادعاء
حماية مجموعة سكانية ضد أخرى. إلا أن تصنيع هذه السيرورة الطائفية /
العرقية، تلقى ضربة قوية مع انطلاق انتفاضة تشرين، التي أكدت للجميع،
على اختلاف الأديان والمذاهب والأعمار والطبقات، من ضمنهم المتضررون
حقا من سياسة النظام السابق، وضحايا طائفية نظام الاحتلال والارهاب، ان
فساد النظام ولا وطنيته واحتقاره للمواطن هو أساس المشكلة الحقيقية.
فكان صوت المحتجين واحدا، بلا تصنيف مسبق، في كربلاء والنجف وبغداد
والبصرة والديوانية، مطالبا بوطن وانهاء الفساد المنتشر في كل مؤسسات
الدولة والحكومة، وتقديم قتلة المنتفضين للقضاء، والكشف عن مصير
الناشطين المخطوفين.
وكادت الانتفاضة أن تحقق ما هو أكثر من هذا، بعد نجاحها باسقاط حكومة
عادل عبد المهدي، لولا انتشار فايروس كورونا وميل البعض الى اعطاء
الكاظمي فرصة لتحقيق قائمة وعوده الطويلة، والتي تمخضت عن استمرار خطف
واعتقال وقتل الناشطين، بالاضافة الى بقاء الوضع الاقتصادي متدهورا،
والخدمات الاساسية معدومة، وانتشار السلاح بأيدي الميليشيات المسيطرة
بإرهابها على الشارع وحياة المواطنين.
لماذا يقتل شبابنا ومعهم تدفن آمالنا ومستقبل بلادنا؟ يتساءل الأهالي المخضبة وجوههم بالدموع وهم يرون أبناءهم يقتلون بلا سبب غير مطالبتهم بحق الحياة بكرامة، وألا يهانوا في بلدهم، على أرضهم، وأن يعيشوا أيامهم كما الآخرون
عدم الوفاء بالوعود، أعاد المتظاهرين السلميين الى ساحة الحبوبي، وسط
مدينة الناصرية، جنوب العراق، وهي ساحة مدينة لا توجد فيها عشرات
المجموعات العرقية والطائفية بل تعتز بتاريخها وشعرائها ومغنيها
ويتوسطها تمثال الشاعر ورجل الدين المقاوم للاحتلال البريطاني، عام
1915، محمد سعيد الحبوبي. شهدت الساحة، يومي الجمعة والسبت الماضيين،
هجوما وحشيا شنه أتباع مقتدى الصدر المسلحين على المحتجين السلميين
وحرق خيامهم المنصوبة وسط الساحة، بينما وقفت القوات الامنية متفرجة
على ما يجري وبضمنه سيطرة مليشيا الصدر على مركز المحافظة والاستيلاء
على الاسلحة الموجودة، حسب بيان للمنتفضين طالبوا فيه استقالة حكومة
مصطفى الكاظمي لفشلها « بحفظ هيبة الدولة وحماية أرواح الشعب وحماية حق
الاحتجاج والرفض والتعبير».
تراوحت ردود الأفعال حول هجوم أتباع الصدر وقتل المتظاهرين بين الصمت
المطبق، خاصة، من قبل الحزب الشيوعي، حليف مقتدى الصدر في قائمة «
سائرون» والغضب الشعبي المتبدي في احتجاجات التضامن في مدن أخرى،
بالاضافة الى التبادل السريع لأخبار الاحتجاج ونشر صور واسماء الضحايا
من الشهداء والجرحى على صفحات التواصل الاجتماعي، والسخرية والتعريض
بمقتدى الصدر وتقلبات مواقفه المماثلة لحركة بندول يتأرجح ما بين أقصى
اليمين وأقصى اليسار، فضلا عن حالات انزوائه المفاجئة واختفائه أما
خارج العراق أو داخله بذريعة اكمال الدراسة أو كتابة الشعر. وغالبا ما
تنعكس تقلباته النفسية والعقلية، على قادة تياره وأتباعه، فهو يدعو الى
تظاهرة مليونية يوما ثم داعيا إلى «تصفية ساحات التظاهر» يوما آخر،
ويطالب الحكومة بالاصلاح بينما هو في صلب الحكومة. تؤدي تقلبات الصدر
الى خلق انواع السلوك المختل بين اتباعه مما يجبره، حين يتذكر انه «
سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد القائد المجاهد مقتدى الصدر أعزه
الله» الى « تصفية» التيار الصدري لتنقيته من « الشوائب» فيصدر أوامره،
على موقعه الرسمي وبتغريداته، بطرد هذا المسيء او تجميد نشاط ذاك «
و«عليهم التفرغ للعبادة».
تمثل رد فعل رئيس الوزراء الكاظمي، الأساسي، بتشكيل لجنة تحقيق و« خلية
ادارة الأزمة». وهو رد فعل مألوف ومتوقع، تعّود عليه المواطنون الذين
يعرفون جيدا ان لجنة التحقيق هي مجرد اضافة جديدة الى قائمة تضم مئات
لجان التحقيق، التي تمر بلا تحقيق، وهدفها الوحيد هو طمس الانتهاكات
والجرائم والتسترعلى القتلة، خاصة، اذا كانوا منتمين الى إحدى
الميليشيات. وبينما تُصدر «خلية ادارة الازمة» صورا واخبارا عن مواعيد
اجتماعاتها، لا يكف أتباع الصدر، حالما يعطيهم الصدر الاشارة، عن
الانطلاق نحو الساحات وهم يحملون السلاح بانواعه، خلافا لبقية
المتظاهرين، لاستعراض قوتهم والتأكيد على انهم القوة الحقيقية في
البلد، متهمين المتظاهرين بانهم ينفذون أجندات خارجية مشبوهة.
اذا كان هناك ما يستخلص من انتفاضة تشرين، بساحاتها الممتدة في عديد
المدن، وعودة المنتفضين اليها على الرغم من وحشية رد فعل الميليشيات
ودعم او صمت جهات النظام الأمنية، فهو أن النظام المبني على الفساد
والمكون من مجموعات لصوص أكثر منها عرقية أو طائفية، تستطيع، مهما
احتربت، في ظروف توفر الريع النفطي وحده، أن تعيد توزيع اسلابها، وهي
لا تحتاج الشعب، ما دامت قادرة على التشبيك مع القوى الاقليمية
والدولية، تحت مظلة « تقاطع المصالح». وهو درس استوعبه جيل الانتفاضة
التشرينية جيدا، وسيعيدهم الى ساحات مدنهم مطالبين بالتغيير المرة بعد
المرة.
كاتبة من العراق
العراق:
الإعدام ثقافة شعبية؟
هيفاء زنكنة
في الوقت الذي تراجع فيه تنفيذ الإعدام في العالم، وانخفضت الأعداد الى
حد أدنى، حيث أبطلت نحو 170 دولة عقوبة الإعدام أو أوقفت تنفيذها سواء
بالقانون أو الممارسة، للسنة الرابعة على التوالي ضاعف النظام العراقي
عدد عمليات الإعدام المسجلة تقريباً بين عامي 2018 و2019 فوصل إلى 100
في 2019 مقارنةً بـ 52 في 2018 محافظا بذلك على مركزه الرابع بين الدول
الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام. ولعله يتطلع الى احتلال مركز اعلى، خلال
هذا العام، اذ أعدم 21 سجيناً في أكتوبر، ثم 21 سجينا آخر الأسبوع
الماضي، في سجن الناصرية المركزي، المعروف باسم سجن الحوت، أدينوا
بتهمة الإرهاب والانتماء إلى تنظيم «الدولة الإسلامية».
تباينت ردود الافعال حول حملة الإعدامات ما بين الاستنكار والترحيب.
حيث أجمعت منظمات حقوقية عراقية ودولية على استنكار وادانة حملة
الإعدامات الجماعية ومن بينها منظمة العفو الدولية ومجلس حقوق الإنسان
في الامم المتحدة ومركزجنيف الدولي للعدالة بالاضافة الى عدد من خبراء
الأمم المتحدة. وصفت منظمة العفو الدولية الإعدام الجماعي بأنه عمل
مشين، حاثة السلطات العراقية على ان تضع حداً لإعدام الناس. إذ ان
عمليات الإعدام الانتقامية لا تحقق العدالة للضحايا ولأسرهم، بل إنها
تعمل على تعزيز صورة العدالة الجزئية، في الوقت الذي تكون فيه السلطات
صامتة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة الأخرى التي لا تزال ترتكب في
جميع أنحاء البلاد، كالتعذيب، والاختفاء القسري.
واذا كانت ذريعة اللجوء الى تنفيذ الإعدام بهذه الاعداد الكبيرة ( وهي
المعلن عنها فقط) بالمقارنة مع بقية الدول في جميع انحاء العالم هي ان
من نفذ بهم الحكم هم من الدواعش الإرهابيين، على الرغم من فساد القضاء
وإجراء محاكمات جائرة، تستند في احكامها إلى ما يسمى «الاعترافات» التي
انتزعت تحت وطأة التعذيب أو المخبر السري والتهم الكيدية، فان بقاء
العراق في مركزه العالي، الذي تبوأه قبل ظهور داعش بسنين، وبالتحديد
منذ احتلاله، يدل على ان تنفيذ الإعدام سياسة حكومية منهجية لقمع
الأصوات المعارضة أو لبث الخوف في قلوب الأقليات أو الجماعات التي لا
تتمتع بالحظوة فضلا عن محاولة النظام اثبات سيطرته وقدرته على الدفاع
عن اتباعه.
النظام الذي تم تسويقه والترويج له كنموذج شرق أوسطي للديمقراطية وحقوق
الانسان، اصبح أداة لسلب الحياة والوجه الثاني للإرهاب الذي يدّعي
محاربته حتى حين تكون المعارضة سلمية، كما رأينا اثناء انتفاضة تشرين
الأول / اكتوبر 2019 حين تم اغتيال 600 مواطن واعاقة الآلآف. ولم يحدث
وتم اعتقال أو محاسبة اي مسؤول عن هذه الجرائم الموثقة بالصور
والفيديوهات. انتقائية تطبيق العقاب هذه، واللجوء الى الإعدام رغم عدم
وجود ما يؤكد فاعليته في وضع حد للجرائم والإرهاب، هو ما يدفع المنظمات
الحقوقية الى اصدار التقرير تلو التقرير حول انتهاكات وجرائم النظام
العراقي، وهو ما يدفعنا الى عدم السكوت.
إن إعدام شخص بلا محاكمة عادلة هو إعدام للعدالة وللقضاء النزيه وتشجيع للخروج على القانون وإشاعة ثقافة القتل خارجه
«أظهر تقييمنا لإقامة العدالة في القضايا التي تتعلّق بالإرهاب في
العراق، وقوع انتهاكات متكرّرة للحقّ في المحاكمة العادلة، في سياق
التمثيل القانوني غير الفعال، والاعتماد المفرط على الاعترافات،
والادعاءات المتكررة بالتعذيب وسوء المعاملة. وفي مثل هذه الظروف،
يشكّل تنفيذ عقوبة الإعدام مصدر قلق بالغ، وقد يرقى إلى حدّ الحرمان
التعسفي من الحياة تمارسه الدولة نفسها».أفادت مفوّضة الأمم المتّحدة
السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، بعد تلقيها خبر الإعدامات، وما
قد تحمله الايام المقبلة لمئات السجناء الآخرين. بالاضافة إلى المفوضة
السامية أصدر مركز جنيف الدولي للعدالة بيانا أدان فيه المحاكمات
الجائرة والإعدامات الجماعية وحث على تطبيق الإجراءات القانونية
الواجبة. اذ يجب على العراق الإلتزام بالقوانين الدولية المتعلّقة
بعقوبة الإعدام والمعاملة اللاإنسانية أثناء الاستجواب ويجب إحترام حقّ
جميع المتهمين في محاكمة عادلة. كما ضمّنه رأي ثلاثة من خبراء الأمم
المتّحدة في مجال حقوق الإنسان عن الإعدامات ووجوب وقف جميع عمليات
الإعدام الجماعية فورًا، قائلين: «نحث الحكومة العراقية على ضرورة
احترام التزاماتها القانونية الدولية ووضع حدّ فوري لخطط إعدام
السجناء».
مقابل هذه المواقف والتقارير الحقوقية الانسانية المطالبة، كلها،
بانهاء اصدار وتنفيذ احكام الإعدام الجائرة، هناك منظور سياسي شعبوي
للاعدام يروج له الساسة باعتباره الحل الوحيد «لأخذ حقوق ضحايا الهجمات
الإرهابية» وانه يجب العمل به لأنه «جزء من ثقافة وقيم المنطقة» كما
دافع عبد الفتاح السيسي، في 2019 عن تنفيذ الإعدامات بمصر، وإن «الشعب
عندما يسمع عن عدم تطبيق عقوبة الإعدام، لا يمكن أن يقبلوا منا أن نبقي
هذا المجرم الذي مزق أشلاء آبائهم أو أبنائهم أو نسائهم، لأن لا قيمة
للحياة إذا كان يعيش فيها هؤلاء، في نظر أهالي الشهداء» كما برر نوري
المالكي، رئيس الوزراء العراقي السابق، رفضه ايقاف تنفيذ إعدام 129
سجينا في عام 2012 وما لايقل عن 169 خلال العام 2013 ملقيا المسؤولية
على اهالي الشهداء وان توقيعه على تنفيذ الإعدامات هو لتحقيق رغبة
الشعب، متعاميا عن حقيقة إن إعدام شخص بلا محاكمة عادلة هو إعدام
للعدالة وللقضاء النزيه وتشجيع للخروج على القانون وإشاعة ثقافة القتل
خارجه. وما اعتبره قصاصا رادعا لم يجعل العراق أكثر أمنا وطمأنينة بل
ساعد على تنمية الاحساس بالظلم واشاعة روح الانتقام. ومايزيد من بشاعة
الوضع بالنسبة الى السجناء وذويهم هو غياب التمثيل القانوني الفعلي
(محام أو محامية) للمتهمين أثناء التوقيف، والتحقيق، والمحاكمة وما بعد
المحاكمة في القضايا المسماة « إرهاب» أي التهمة الجاهزة المستخدمة منذ
عام 2005 مع تزايد حالات اختطاف المواطنين، كرهائن لابتزاز العوائل من
قبل ضباط أمن اشتروا مواقعهم بغية استرجاع ما دفعوا واثراء لانفسهم،
أوميليشيات تبحث عن تمويل. في حالات كهذه قد يطلق سراح الإرهابي
المدعوم من جهة قادرة على دفع الاتاوة كما حدث للكثيرين، بينما يعدم
المواطن البريء او المتهم بارتكاب جرم غير خطير، فقط لأن اهله لا
يملكون ما يطلبه الخاطفون من مال.
إن ادعاء الساسة أن اصدار أحكام الإعدام التي تحول البلد الى مسلخ بشري
هو جزء من ثقافة وقيم المنطقة ادعاء مبتذل. فشعوبنا لا تختلف عن بقية
شعوب العالم في رغبتها بأن يعامل كل شخص على قدم المساواة أمام
القانون. ومن يرتكب اية جريمة سواء كانت ضد شخص أو مجموعة اشخاص يجب
تقديمه للقضاء، وان يحاكم وفق القانون بدون تمييز كما يجب توفير
الحماية المواطنين على قدم المساواة. وهذا ما لا يحدث في العراق تحت
النظام الحالي حيث غالبا ما يعدم الأبرياء ويكافأ المجرمون.
كاتبة من العراق
ضرورة إبقاء
أطفال العراق متخلفين
تواصل
الهيئات الحكومية البريطانية والدولية المعنية بحماية ورعاية الأطفال،
اصدار التقارير حول تأثير اغلاق المدارس على الأطفال جراء انتشار
فايروس كوفيد 19 ومدى امتداد ذلك التأثير على المجتمع ككل مستقبلا.
تُحذر التقارير كلها من التأخر في القدرة على التعلم بالإضافة الى
المعاناة النفسية والجسدية كالاحساس بالعزلة والقلق وقلة الحركة. لذلك
اتخذت الحكومة البريطانية وعديد الدول الغربية المتقدمة قرارات واجراءت
فعالة لابقاء المدارس مفتوحة ومواصلة التعليم، عن بعد، عند الضرورة
القصوى. اذ تؤكد دراسات علمية اجريت حول تأثير إغلاق المدارس كما حدث
عام 2005، حين اسفر إعصار كاترينا الذي اصاب ساحل الخليج، عن نزوح 370
ألف طفل وتدمير أكثر من 100 مدرسة عامة، ان آثار الكارثة ظلت قائمة بعد
عودة الأطفال الى المدارس. أظهر بعض الأطفال اعراضا متزايدة من القلق
والاكتئاب وضغط ما بعد الصدمة لفترة طويلة بعد الحدث؛ ووجدت دراسة بعد
خمس سنوات أن أكثر من ثلث هؤلاء الأطفال النازحين ما زالوا متخلفين
بسنة على الأقل عن أقرانهم أكاديميًا، وانهم غير منضبطين في سلوكهم
وعواطفهم.
كما بينت دراسة اجريت عام 2019، أن الطلاب في الأرجنتين الذين فاتهم ما
يصل إلى 90 يومًا من المدرسة في الثمانينيات والتسعينيات بسبب إضراب
المعلمين كانوا أقل من غيرهم امكانية للحصول على درجة علمية، وأكثر
عرضة للبطالة، وحصلوا على حوالي ثلاثة بالمائة أقل في المتوسط من
المناطق الأقل تأثراً. تعطينا هذه الدراسات والبحوث صورة عامة عن
العوامل المؤثرة كالأعاصير والفيضانات وانتشار الأوبئة على توفير
التعليم المدرسي للأطفال وانعكاسات القطيعة التعليمية، مهما كانت
مدتها، على الأطفال عقليا وجسديا. أما في مناطق النزاع، فتدل البحوث
على ان العبء الأكبر يقع دائمًا على الأطفال الذين فقدوا أسرهم، أو
الذين يعاني أحد والديهما من صدمة نفسية. مما يأخذنا الى وضع اطفالنا،
في البلدان العربية، التي تعيش اما في ظل احتلال مباشر (فلسطين) أو غير
مباشر في ظل حروب ونزاعات كالعراق وسوريا واليمن ولبنان، بالاضافة الى
خطر وباء كوفيد. هنا، تستوقفنا أسئلة تنعكس على الأطفال والمجتمع ككل.
ترى كيف ستكون شخصية الطفل الذي يعيش هذه الظروف بتفاصيلها البائسة
يوميا؟ بعيدا عن التعليم أو بتعليم متقطع، وفقدان احد الوالدين، وعدم
الاحساس بالأمان، والخوف من فقدان من تبقى من عائلته، أي مستقبل يتوقعه
الطفل، وكيف يتخلص من المخاوف وعدم الثقة بالآخر التي ترسبت، مبكرا،
على انسانيته؟
أطفال العراق يعيشون هذه التفاصيل وغيرها. بعد ثلاث سنوات من إعلان
النظام النصر ضد تنظيم الدولة الإسلامية، لا يزال هناك 1.3 مليون نازح،
موزعين في مخيمات نُصبت، منذ ما يقارب العقد، لتكون مؤقتة الا انها
باتت دائمية. وبدلا من العمل على اعادة التوطين بشكل مستدام واتفاق
مسبق يحفظ كرامة المواطنين وتأمين الضروريات، شرع النظام، الشهر
الماضي، باغلاق المخيمات دون انذار مسبق ومشاورات مع ممثلي النازحين
ووكالات الإغاثة العاملة في المخيمات للانتقال «الطوعي» الذي يصفه 60
بالمئة من النازحين الذين عادوا الى مناطقهم، بانه اجباري، بينما نزح
44 بالمئة منهم الى مخيمات أخرى ستغلق أيضاً أو منازل شبه مهدّمة، ولم
يعد نحو نصف سكان تلك المخيمات إلى مناطقهم الاصلية، اما لأن بيوتهم في
مناطق مدمرة أو لانعدام الخدمات او لتعرضهم، وفق منظمة الهجرة الدولية،
التي تفادت التحديد، مثل استملاك الميليشيات لمناطق مثل جرف الصخر.
هناك اليوم ما يقارب من 3.2 مليون طفل عراقي في سنّ الدراسة خارج المدرسة، وأن الوضع في عدد من المحافظات سيئ جدا، حيث أنّ ما يزيد عن 90 في المئة من الأطفال في سنّ الدراسة خارج النظام التعليمي
في تلخيصه للحال، يقول فلاح حسن حسين على موقع المجلس النرويجي
للاجئين: «لقد سجلنا العودة قبل أكثر من عام من مخيم السلامية الأول
/محافظة نينوى، ولم نتلق اي مساعدة لا من وزارة الهجرة والمهجرين، ولا
اية منظمة. والمنطقة الي نسكن فيها خالية من الخدمات، ولا يوجد ماء
صالح للشرب. نشتري خزان الماء بثمانية الاف دينار، ولا توجد فرص عمل.
لو باقين بالمخيم أحسن من هاي الحالة».
ماذا عن التعليم؟ عن الدوام المدرسي الذي يؤدي الى أضرار نفسية وعقلية
كبيرة قد تمتد مدى العمر، كما تحذر الدراسات العلمية وتخشاها الدول
الغربية؟ يشير تقرير حديث لليونسيف أنّ هناك اليوم ما يقارب من 3.2
مليون طفل عراقي في سنّ الدراسة خارج المدرسة، وأن الوضع في عدد من
المحافظات مثل ديالى وصلاح الدين سيئ جدا، حيث أنّ ما يزيد عن 90٪ من
الأطفال في سنّ الدراسة خارج النظام التعليمي، وما يقرب من نصف الأطفال
النازحين في سنّ المدرسة، أي حوالي 355.000 طفل وطفلة، ليسوا في
المدرسة. والوضع أسوأ بالنسبة للفتيات في المدارس الابتدائية
والثانوية. حيث ارتفعت معدلات التسرب، فضلا عن ارتفاع عدد المدارس
المزدوجة التي تعمل بدوامين أو ثلاثة في اليوم الواحد، وبصفوف مكتظة
يصل فيها عدد الطلبة إلى 60 طالبا في الصف الواحد.
يعزي التقرير الاسباب الى « عقود من الصراع، وغياب الاستثمارات في
النظام التعليمي الذي كان يُعدّ فيما مضى أفضل نظامٍ تعليمي في
المنطقة». مبينا ان حصول الأطفال على التعليم الجيد، يتوقف على معالجة
عوائق رئيسية وتشمل « التمويل غير المنصف، وعدم كفاية البنية التحتية
التعليمية لا سيما في المدارس في المناطق الريفية والمناطق المتضرّرة
من الأزمة، والنقص في المواد التعليمية الضرروية الذي يحدّ من التعليم
الفعّال، والافتقار إلى مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الملائمة
والمواتية للفتيان والفتيات، والتوزيع غير العادل للمدرّسين المؤهلين».
وستتبدى بوضوح مدى جدية النظام في ايجاد حلول للعوائق حين نعلم ان
الميزانية الوطنية للبلد، خصصت في السنوات الماضية، أقل من 6 بالمئة
للقطاع التعليمي، ممّا يضع العراق في أسفل الترتيب لدول الشرق الأوسط،
في الوقت الذي تتزايد فيه تخصيصات الفساد المالي لتصل المليارات.
لاتوفر المدارس مكانا للتعلم فقط بل أماكن لحماية الأطفال من الأذى
والمحافظة على سلامتهم من خلال التعرف على التهديدات التي قد يتعرضون
لها في المنزل والمجتمع. ووجود الأطفال خارج المدارس يعني حرمانهم من
الاحساس بالأمان وجعلهم أكثر عرضة للاستغلال وسوء المعاملة، بما في ذلك
عمالة الأطفال والاستغلال الجنسي والزواج المبكر، والأخطر على انفسهم
والمجتمع هو التجنيد من قبل جهات مسلحة أيا كانت. واذا اخذنا بنظر
الاعتبار أبحاثا أمريكية توصلت الى ان فقدان عام دراسي واحد يعادل
تخلفا ذهنيا عاما بمعدل نصف عام، هل من المستغرب اقتناع الكثيرين بأن
سياسة النظام العراقي التعليمية هي تكريس التجهيل وتدمير الأجيال
الجديدة، عقليا وجسديا، وابقاء البلد ضعيفا قابلا للاستغلال والهيمنة،
وهو هدف الاحتلال عام 2003، والتوافقات الاقليمية التي تلته.
كاتبة من العراق
بايدن في العراق: علينا الحذر!
هيفاء زنكنة
باستثناء مواجهة أحد الجنود الأمريكيين الذين خدموا في العراق، للرئيس
الأمريكي الجديد جو بايدن، واتهامه بأنه، بمساندته غزو واحتلال العراق
برئاسة جورج بوش، كان قد سبب قتل الابرياء من الأمريكيين والعراقيين،
صارخا أن « دماء الابرياء تلطخ يديك» لم يثر احتلال العراق وما سببه من
خراب وقتل ما يزيد على المليون مواطن، أي اهتمام اثناء الحملة
الانتخابية الرئاسية. ولم يوضع العراق المحتل على أجندة النقاش من قبل
أي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري على الرغم من الحملة الانتخابية
المكثفة على مدى شهور.
جاء تغييب العراق وبقية الحروب والنزاعات التي تنخرط فيها أمريكا،
تأكيدا، لسياسة الحزبين المتماثلة في تجنب التطرق الى السياسة الخارجية
عموما. ومن الأفضل ابقاء السياسة الخارجية، كما هي «خارجية» تُعنى بناس
«آخرين» ضبابيين، يعيشون بعيدا في أماكن نائية تصلح للاستغلال عن
مبعدة. لا قيمة انتخابية لهم ولا رأي بما سيحل بهم وبلدانهم جراء سياسة
الإدارة الأمريكية التي ينتخبها الشعب الأمريكي.
هذه نقطة تستحق التذكير، لا من باب وضع الشعب الأمريكي كله في سلة
واحدة مؤيدة للسياسة الامبريالية، ولكن لئلا نسقط في فخ الفصل بين
سياسة الادارة الأمريكية والشعب الذي انتخبها. فالمحاججات التي يلجأ
اليها البعض للتمييز بين ممارسات الحكومات القمعية المستبدة والشعب
بسبب غياب الديمقراطية أو ان الديمقراطية حديثة الولادة أو ان الشعب
بحاجة الى تعلم ثقافة الديمقراطية، لا تنطبق على الشعب الأمريكي الذي
يرى نفسه حاضنة للحرية والديمقراطية، وناشرا لها بكل الأساليب الممكنة
بضمنها، غالبا، الغزو والاحتلال، ويتم غرزها في نفوس المواطنين منذ
طفولتهم وفي مناهج تعليمهم.
عموم الشعب الأمريكي يؤمن، اذن، بأن حكومته تمثله، مهما كان الحزب
المنتخب أو شخصية رئيسه. فالرئيس ترامب الذي يتهمه معارضوه بأنه يمثل
نفسه استطاع ان يحقق للحزب الجمهوري نجاحات مذهلة على مستوى جذب شرائح
مجتمعية، كالعمال، كانت محسوبة للحزب الديمقراطي. مما يعني أن سياسة
الحكومة الخارجية، وهذا ما يعنينا بالدرجة الاولى، هي وليدة رضا الشعب
المتمتع ككل، وان بدرجات، بالرفاه الاقتصادي الذي يشكل الأرضية الاكثر
خصبا لصناعة الرضا الشعبي. يليها، في الاهمية، الهيمنة الإعلامية
والدعائية، المواظبة على ابعاد المواطن عن العالم الخارجي وحصره،
عقليا، في قوقعة تُغذى بشعارات بسيطة سهلة الهضم.
من هذا المنطلق، في معركة تم، مسبقا، مسح انعكاساتها على العالم
الخارجي، أختزل برنامج الانتخابات الاخيرة بشعار « اما ان تكون مع
ترامب أو ضده». وهو شعار يماثل شعار الرئيس بوش في اعقاب الحادي عشر من
أيلول/ سبتمبر « أما ان تكون معنا أو ضدنا» باستثناء أن بوش أطلق
شعاره، المدجج بالتفوق العسكري، بوجه العالم كله. العالم الذي يعيش
مصائب الحروب والنزاعات المستمرة التي شنتها وتشنها أمريكا. فمن فلسطين
والعراق الى اليمن وسوريا وافغانستان وأمريكا اللاتينية، تعيش شعوب هذه
البلدان، في ظل ارهاب امبراطورية عسكرية، تشكل 5 بالمئة فقط من سكان
العالم، لديها حوالي ألف قاعدة عسكرية متناثرة كالبثور على وجه العالم،
وتعتمد في تنمية اقتصادها على مجمع التصنيع العسكري والحربي، وصفقات
السلاح، واشعال الحروب والاحتلال وفرض « الأتاوة» على حكومات محلية
مستبدة لحمايتها من شعوبها.
هل سيعيد الرئيس بايدن تفعيل خطة السناتور الديمقراطي جوزيف بايدن لتقسيم العراق، أم انه سيترك للحكام بالنيابة تنفيذ ذلك مع بعض التدخل «الناعم» من جهته؟
أكدت التغطية الإعلامية للانتخابات، على مدى 24 ساعة يوميا، أن
الامبراطورية العسكرية، بوجهها السياسي، لا يمكن أن تحقق النجاح بدون
آلة التسويق الدعائية الاعلامية. «الهدف من الإعلام الدعائي الحديث ليس
فقط التضليل أو الدفع بجدول أعمال محدد. إنه استنفاد التفكير النقدي،
لإبادة الحقيقة» يقول لاعب الشطرنج الروسي العبقري غاري كاسباروف الذي
يعرف اكثر من غيره معنى انتقائية « الديمقراطية» حين تجرأ على تحدي
بوتين في الانتخابات الرئاسية عام 2007، فتم استبعاده في ظروف غامضة،
واضطر الى مغادرة بلده بعد تعرضه الى عدد من «الحوادث».
واذا كان بوتين متهما باللاديمقراطية واستبعاد خصومه واغتيالهم اذا
تطلب الأمر، فان الادارات الأمريكية المختلفة، لا تجد حرجا في ممارسات
مماثلة باسم الديمقراطية. من بينها تغيير الحكومات التي لا تتماشى مع
سياستها، أينما كانت، اما بانقلابات عسكرية مدبرة أو الاحتلال المباشر
أو التدخل في تغيير نتائج الانتخابات حتى في الدول التي قاموا «
بتحريرها» وأمطروها بوعود الديمقراطية. وافضل مثال على ذلك هو العراق
الذي تم غزوه واحتلاله لتغيير نظامه أولا، ومن ثم، وبعد أن أعلنوا عن
اقامة « عراق ديمقراطي جديد» واجراء انتخابات فيه، تدخلوا بشكل مباشر،
في تغيير نتيجة انتخابات عام 2010. المفارقة المضحكة ان يتم التدخل في
تغيير النتائج حين كان جو بايدن، الذي يعاني حاليا من اتهامات ترامب له
بتزوير الانتخابات، نائبا للرئيس باراك اوباما ومشرفا على ملف العراق.
يومها تم الاعلان عن فوز قائمة « العراقية» برئاسة إياد علاوي بفارق
ضئيل مقابل ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء آنذاك نوري
المالكي. الا أن المالكي، المعروف بطائفيته وفساده وانتهاكات حقوق
الإنسان، قال « ما ننطيها» أي لن نعطي السلطة، رافضا النتيجة. مما أدى
إلى مواجهة استمرت ستة أشهر احتفظ خلالها المالكي، بدعم من إيران،
بالسلطة لكنه لم يتمكن من تشكيل حكومة ائتلافية. حينئذ تدخل جو بايدن
لصالح ابقاء المالكي، راميا نتائج الانتخابات في سلة المهملات، لأن
مصلحة أمريكا اقتضت عدم استفزاز إيران أثناء اجراء مفاوضات توقيع
اتفاقية السلاح النووي.
الجانب الثاني المهم لاستشراف سياسة بايدن الخارجية تجاه العراق، هو
ارتباط اسمه بمشروعه، الداعي عام 2006 الى تقسيم العراق الى ثلاث مناطق
على أسس عرقية وطائفية، وهي منطقة كردية في الشمال، وللشيعة في الجنوب
والسنة في الغرب. وُصف المشروع بأنه خطة للتقسيم الناعم وانها تشجع على
التطهير العرقي، وستؤدي الى تغذية الانقسامات الطائفية في جميع دول
المنطقة. على الرغم من ذلك، عمل بايدن على الدفع باتجاه تحقيق مشروعه،
بتأييد من اللوبي الصهيوني، لعدة سنوات الا أنه، دفعه جانبا، بسبب عدم
تلقيه التأييد الذي كان يأمله من العراقيين خاصة. مما يثير تساؤلا مهما
حول سياسته تجاه العراق خاصة مع تغييب العراق عن الأجندة الانتخابية
اولا ومع ملاحظة عودة عدد من الصحف الى الكتابة عن «خطة بايدن»
والتساؤل عما اذا كانت الحل لـ « الصراع» في العراق وكيفية التعامل مع
إيران. فهل سيعيد الرئيس بايدن تفعيل خطة السناتور الديمقراطي جوزيف
بايدن لتقسيم العراق، أم انه سيترك للحكام بالنيابة تنفيذ ذلك مع بعض
التدخل «الناعم» من جهته؟
كاتبة من العراق
عليهم التطبيع وإلا…
هيفاء زنكنة
كل شيء متوقف، تقريبا، في أوروبا، وعديد الدول في العالم، من بينها
الدول العربية، بانتظار نتيجة الانتخابات الرئاسية بأمريكا في الاسبوع
المقبل. إلا أن حالة الركود السياسي والاقتصادي والعسكري لم تشمل حمى «
التطبيع» برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المتلهف لتقديم نفسه
كعراب «سلام» بين المحتل الصهيوني العنصري، وانظمة عربية هشة، ينخرها
الفساد. فالرئيس الأمريكي، بحاجة ماسة الى ما يوفر له رصيدا انتخابيا
ضد مناوئه الديمقراطي جو بايدن. والأنظمة العربية بحاجة الى حماية
نفسها ومصالحها ضد شعوبها بواسطة شرطي بتكلفة لا تقبل التأجيل، كما
بلغها الرئيس ترامب المرة تلو المرة، محذرا بأن « اتعاب الدفاع»
مُستحقة.
«عليهم أن يدفعوا لنا» قالها، عام 2015 اثناء حملته الانتخابية، موجها
كلامه الى السعودية مباشرة، ثم عاد ليكرر طلب « اتعاب الدفاع» بعد
انتخابه، ليشمل أنظمة اخرى، يتوجب عليها دفع المال لأمريكا لأنها «توفر
خدمة هائلة وتخسر الثروات» مؤكدا «لقد تكبدنا الكثير من المصاريف دون
أن نحصل على شيء بالمقابل.. عليهم أن يدفعوا لنا».
كان تهديد ترامب، من ناحية استخلاص التكلفة، جديا. وجاءت استجابة
الأنظمة العربية الغنية سريعا، اذ ان فقدان الحماية مسألة بالغة
الخطورة ولا تتحمل التأجيل. فقامت الأنظمة بدفع « الاتاوة» أما فورا
بشكل سيولة نقدية بمليارات الدولارات، حسب غنى الدولة، أو بشكل عمولات
أو مقابل صفقات أسلحة بأثمان عالية جداً أو بكل الاشكال مع استثمارات
تكاد تكون مجانية لشركات استغلال النفط والغاز، بالتزامن مع دفع تكاليف
القواعد العسكرية الموجودة في أكثر من سبع دول عربية في الخليج والدول
المحيطة بها، العراق من بينها.
التهديد الحاسم الثاني الذي أطلقه ترامب بوجوه حكام الأنظمة العربية هو
وجوب الاعتراف بالمحتل الإسرائيلي واقامة العلاقات، بمختلف المستويات،
باتفاقيات رسمية، معه. لم يعد التطبيع المستور، من تحت الطاولة، كما هو
متعارف عليه تحت رئاسات أمريكية سابقة، مقبولا لدى أمريكا والمحتل
الاسرائيلي معا. فالرئيس ترامب، رغم جهله العام المفضوح وتناقضات
تصريحاته العنجهية، يعرف جيدا كرجل أعمال أن افضل وقت لشراء الشركات
المنافسة هو حين تنخفض قيمة اسهمها في الاسواق الى أدنى حد وتكاد تشرف
على الافلاس. حينئذ يتقدم بالعرض الذي يعرف جيدا بأنه سيقبل بابخس ثمن.
وهذا هو بالضبط ما لمسه بعد تحليل المعطيات الشاملة للانظمة العربية.
انها تعاني من حالة انهيار، بكل المستويات وأكثره خطرا الغضب الشعبي.
حالة تماثل الافلاس الكلي، وقد حان الوقت لتقديم عرض طالما تم تأجيله.
عرض مهين ستقبله الأنظمة العربية بشكل صفقة تدعى « السلام» ستمنح ترامب
تمايزا سياسيا، كما ستخفف اعباء الدعم المالي الأمريكي للمحتل
الاسرائيلي البالغ 3.8 مليار دولار من المساعدات الأمنية و 500 مليون
دولار للتعاون الدفاعي الصاروخي بين البلدين، حسب ميزانية 2020.
إن المخطط خطير، لكنّه ليس قدراً محتوماً على شعبنا، فالمعركة مفتوحةٌ بين شعبنا وأنصاره من أحرار العالم، وبين الاحتلال وداعميه الاستعماريين، والتي لا يُمكن أن تحسم نتائجها سلفاً. فقد حالت مقاومة وصمود شعبنا والشعوب العربية الشقيقة، بدعم من أصحاب الضمائر الحية
يأتي التخفيف عن طريق تنشيط علاقات الاستثمار والتجارة والصناعة بين
كيان الاحتلال وأنظمة التطبيع الغنية، التي ستوفر للمحتل دخلا اضافيا
يساعده على التخلص بسرعة من اهل البلد الاصليين الموسومة مقاومتهم
بالارهاب. هكذا ستكون انظمة التطبيع حزام الامان للمحتل، والضامن
لوجوده، ليتفرغ أكثر فأكثر في مشروع الاستيطان الاخطبوطي لإجلاء
الفلسطينيين. باعتبار ان أمريكا نفسها مبنية على فكرة ابادة السكان
الاصليين فلم لا يبني الكيان الصهيوني نفسه على ذات الاساس؟
خلال شهرين وقعت الإمارات والبحرين، وتلاهما السودان على اتفاقات تطبيع
العلاقات مع المحتل الإسرائيلي. ويشكل وضع السودان نموذجا للشركات التي
يتم شراؤها بعد العمل المتعمد على افلاسها. حيث عاقب شرطي العالم
السودان وحاصره الى حد التجويع عن طريق وضعه على قائمة الارهاب. وها هو
يمد له يد الانقاذ « الإنساني» ورفع وسم « الارهاب» بشرط الاعتراف
باحتلال يمارس ابشع الانتهاكات ضد اهل البلد الفلسطينيين. حال الموافقة
على التطبيع المذل، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن حزمة
« مساعدات إنسانية» تقدمها الولايات المتحدة لصالح المنكوبين في
السودان بقيمة 81 مليون
دولار.
بمواجهة الغضب الشعبي، اعتبر المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة
بالسودان، العميد الطاهر أبو هاجة، أن الانفراج في العلاقات الخارجية
«ليس بيعاً للقضية الفلسطينية».
ويشير جواب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (واشنطن بوست – 22 آب/
أغسطس 2020) عند سؤاله عن تطبيع الإمارات مع المحتل، إنه «قرار
إماراتي، ولا ينبغي لنا التدخل» وتصريح وزير االخارجية فؤاد حسين « أن
العراق ملتزم بقرارات الجامعة العربية بخصوص العلاقات مع إسرائيل
والقضية الفلسطينية» بأن ما يجمع الأنظمة المحلية الفاسدة مع التوسع
الامبريالي واحد، ونموهما كالاعشاب الضارة، الا أن ايقاف انتشاره، مهما
كانت الصورة قاتمة، ليس مستحيلا. والقاء نظرة سريعة على التاريخ البعيد
والقريب يبين ان الاستعمار، بأشكاله، لا يمكن ان يدوم مهما اتكأ على
عكاز خدمه المحليين. ويبقى المحك هو مواصلة الشعوب غضبها ورفضها
الاستسلام المتمثل بالمقاومة الفعلية ضد المحتل والأنظمة القمعية
المتعاونة معه في آن واحد، بالاضافة الى حملات التضامن العالمية مع حق
الشعب الفلسطيني غير القابل للتجزئة.
إن «المخطط خطير، لكنّه ليس قدراً محتوماً على شعبنا، فالمعركة مفتوحةٌ
بين شعبنا وأنصاره من أحرار العالم، وبين الاحتلال وداعميه
الاستعماريين، والتي لا يُمكن أن تحسم نتائجها سلفاً. فقد حالت مقاومة
وصمود شعبنا والشعوب العربية الشقيقة، بدعم من أصحاب الضمائر الحية
عالمياً، دون حسم هذا الصراع الممتدّ منذ عقود» كما جاء في بيان حركة
مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (بي دي أس)
عن اعلانات التطبيع الاخيرة.
«فلسطين ستبقى البوصلة» أعلن فنانون عرب عن مقاطعة النظام الإماراتي «
رافضين المشاركة في تلميع جرائم نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل
العنصري الإسرائيلي، وبقرارهم الالتزام بواجبهم الأخلاقي». وسارع نشطاء
إماراتيون لرفض تطبيع حكومة الإمارات مع العدو الصهيوني، ودعا عمانيون
الأنظمة العربية إلى العودة إلى رشدها واحترام إرادة شعوبها، واعلنت
تونس شعبا وحكومة التزامها بالقضية الفلسطينية. واذا كان الشعب
الفلسطيني قد واصل مقاومته لاحتلال بلده أبا عن جد، مع تصميم الأبناء
على الاستمرار، بكافة الطرق، فان مناهضة التطبيع والضغط على الأنظمة
العربية الاستبدادية والقمعية من أجل وقف كلّ العلاقات التطبيعية مع
دولة الاحتلال ومن يمثلها، مسؤولية أخلاقية وان تحرير فلسطين هو تحرير
للانسان، اينما كان. وهو مبدأ غير قابل للمقايضة، مهما كان رئيس
الولايات المتحدة الأمريكية المقبل.
كاتبة من العراق
الحصانة البريطانية والأمريكية
تذكرة مفتوحة لارتكاب جرائم الحرب
هيفاء زنكنة
من المتوقع أن يتم تمرير قانون العمليات الخارجية (موظفو الخدمة
والمحاربون القدامى) المقترح من قبل حكومة حزب المحافظين البريطانية
برئاسة بوريس جونسون، بعد أن تم تمرير القراءة الثانية ومناقشة
التعديلات يوم 14 تشرين الثاني/ اكتوبر الحالي. وجاء توقيت اقتراح
القانون مناسبا لتمريره «تحت الرادار» أي دون أن يحظى باهتمام كبير
وذلك للانشغال العام بانتشار فايروس كورونا، ومتابعة الاجراءات
الحكومية، المتناقضة، المحيطة بكيفية الوقاية منه او الحد من انتشاره.
من المؤكد ان لهذا القانون تأثير هائل على وضع العسكري البريطاني، ولكن
ما هو تأثيره على مواطني البلدان التي تحتلها أو احتلتها بريطانيا،
كالعراق، مثلا؟ وهل من تشابه مع القوانين الأمريكية بذات الصدد؟
ينص القانون المقترح على تقييد الملاحقات القضائية ضد الجنود
البريطانيين، على جرائم يرتكبونها اثناء خدمتهم أو قيامهم بعمليات في
الخارج، من خلال منحهم الحصانة بعد مرور خمس سنوات، على ارتكابهم اية
جريمة كانت، بما في ذلك التعذيب وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية،
باستثناء الجرائم الجنسية. يطبق القانون على كل العسكريين، كما ستقدم
مهلة مدتها ست سنوات، فقط، للدعاوى المدنية ضد وزارة الدفاع.
صوّت معظم نواب البرلمان لصالح القراءة الثانية، وتنص محاججة مقترحي
القانون بأن العسكري يقوم باداء مهامه المطلوبة وواجبه والتضحية بحياته
للدفاع عن الجميع، واذا ما حدث وارتكب ما يمسّ حياة الاخرين اثناء
ادائه واجبه، فان صلاحية مقاضاته يجب ان تسقط بعد مرور خمس سنوات.
وتؤكد الحكومة أن هذا سيحمي القوات البريطانية من الملاحقات القضائية
«الكيدية». أحد اسباب هذه المحاججة هو رفع مواطنين عراقيين مئات
القضايا ضد عسكريين بريطانيين، أثناء مشاركة القوات البريطانية في
احتلال العراق. ففي غضون 15 عامًا، قامت وزارة الدفاع بتسوية 300
مطالبة بإجمالي 20 مليون جنيه إسترليني لضحايا عراقيين عانوا من
انتهاكات وتعذيب على ايدي القوات البريطانية.
تطلب اصدار الحكم بقضية الشاب بهاء موسى، الذي توفي جراء تعذيبه أثناء
احتجازه في معتقل بريطاني، في مدينة البصرة، في أيلول/ سبتمبر 2003 عدة
سنوات الى ان وافقت وزارة الدفاع في 10 يوليو / تموز 2008 على دفع 5.6
مليون دولار، كتعويض لأقاربه وتسعة رجال آخرين عانوا من التعذيب على يد
جنود الاحتلال. وقالت وزارة الدفاع في بيان «التسوية مع اعتراف وزارة
الدفاع بالمسؤولية… عن الانتهاكات الجوهرية للمادة 2 (الحق في الحياة)
و 3 (حظر التعذيب) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان». ودق ناقوس
الخطر بالنسبة الى مقاضاة الجنود واعتراف وزارة الدفاع بالمسؤولية،
وانعكاسات ذلك على « سمعة « القوات البريطانية، حين استمرت الدعاوي ضد
القوات في السنوات التالية.
هذه التجاوزات للقوانين الدولية ستمس، بشكل مباشر، حقوق المواطن العراقي، إذ سيضع حدا لأية مطالبة بالعدالة وتعويض الضرر لانتهاكات حدثت منذ عام 2003
ففي عام 2009، مثلا، وحسب قاعدة ان مساءلة المجرمين لا تسقط بالتقادم،
رفع عراقيون من ضحايا التعذيب قضايا أخرى. « زعم أحد المطالبين أنه
تعرض للاغتصاب من قبل جنديين بريطانيين أثناء وجوده في مركز احتجاز،
بينما يدعي صبي يبلغ من العمر 14 عامًا أنه أُجبر على ممارسة الجنس مع
جندي بريطاني. ويزعم آخرون أنهم جُردوا من ملابسهم وتم تصويرهم وتعرضوا
للإساءة. في حادثة أخرى، تكدس المحتجزون فوق بعضهم البعض وصُعقوا
بالكهرباء». أثارت هذه القضايا ضجة كبيرة لأنها بدأت تشوه سمعة القوات
البريطانية التي حاولت النأي بنفسها من فضيحة التعذيب في أبو غريب،
باعتبارها فضيحة أمريكية وان الجندي البريطاني « متميزاً» بانضباطه
وأخلاقيته.
أثار القانون المقترح استنكار منظمات حقوقية بريطانية ودولية من بينها
منظمة العفو الدولية و«هيومان رايتس ووتش» لأنه سيزيد من إفلات الجنود
البريطانيين الذين يرتكبون جرائم خطيرة من العدالة. حيث وصف مدير منظمة
العفو الدولية، في المملكة المتحدة، القانون بأنه سيضع تصرفات الجنود
فوق القانون، ويشير اقتراح الحكومة إلى أن القوات المسلحة بحاجة إلى
الإفلات من العقاب من ممارسة التعذيب وجرائم الحرب، و« ترى الحكومة أنه
من المقبول منحهم ذلك. مثل هذه الخطوة ترسل رسائل متضاربة على الصعيد
الدولي. كيف يمكننا دعوة دول مثل سريلانكا إلى تطبيق العدالة على جرائم
الحرب منذ عام 2009، عندما وضعنا قانونًا محددا للتقادم؟»
وحذر النائب العمالي دان جارفس من أن القانون، اذا تم سنه، ستكون له
عواقب وخيمة لأنه يضر بمكانة بريطانيا في العالم وبسمعة القوات
المسلحة، قائلا: « خذ التعذيب كمثال. حظر التعذيب مطلق. لا توجد
استثناءات. استخدامه غير قانوني بموجب العديد من المعاهدات الدولية
التي وقعت عليها المملكة المتحدة، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة
لمناهضة التعذيب، واتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي».
هذه التجاوزات للقوانين الدولية ستمس، بشكل مباشر، حقوق المواطن
العراقي، إذ سيضع حدا لأية مطالبة بالعدالة وتعويض الضرر لانتهاكات
حدثت منذ عام 2003. كما ستنعكس على المستقبل، مع وجود حوالي 1400 عسكري
حاليا. وبامكان الجهات المعنية ووزارة الدفاع اعاقة وتأخير اجراءات
التحقيق الجنائية لحين سقوط حق الضحية، كما يتبين من التدخل السياسي
لوقف المساءلة، ومثالها إغلاق « التحقيق الجنائي البريطاني في الجرائم
المزعومة في العراق» قبل أن يكمل عمله.
أما قوات الاحتلال الأمريكي فانها تمتعت بالحصانة من المساءلة والعقاب
حتى انسحابها الجزئي عام 2011. الا ان حكومة نوري المالكي منحتها
الحصانة من الملاحقة القضائية، عام 2014، إذا ارتكب هؤلاء الجنود
الأمريكيون أي جرائم أو واجهوا أي مشاكل قانونية أثناء « تقديم المشورة
« للعراقيين. ويبلغ عدد القوات الأمريكية، المعلن عنه رسميا، اليوم،
5200، وقد أكدت حكومة مصطفى الكاظمي، على استمرار الحصانة، وفق الاتفاق
الموقع في حزيران 2020، استمرارا « للمبادئ التي اتفق عليها الجانبان
في اتفاقية الإطار الاستراتيجي، وكذلك مبادئ تبادل المذكرات
الدبلوماسية وخطابات جمهورية العراق إلى مجلس الأمن التابع للأمم
المتحدة بتاريخ 25 يونيو 2014».
أن مواجهة هذا المسار، كما المسارات الاخرى في المد اليميني العالمي،
في منح الحصانة للسلطات عند انتهاك حقوق الناس، يستدعي جهدا وطنيا
جادا، مشفوعاً بجهود تضامنية عالمية، لاستعادة الشرعية الدولية عامة.
أنه امر يخص العراقيين لمواجهة سياسة حكومات الاحتلال المتعاقبة التي
ترى في قوات الاحتلال، المسّوقة تحت مسميات مختلفة، حماية ضرورية
لوجودها، كما يخص شعوب بلدان الاحتلال نفسها، إذا ما أرادت استرجاع
القيم الحضارية العامة، ودفاعا عن القيم الديمقراطية التي اصبحت تعاني
من هجمة تسلطية تماثل صعود الفاشية والنازية في القرن الماضي.
كاتبة من العراق
انتحار أطفال
«التحرير» في العراق
هيفاء زنكنة
تم الاعلان، في الشهور الاخيرة، عن حالات انتحار في الولايات المتحدة
الأمريكية والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا جراء انتشار فايروس
كورونا، والاجراءات المتخذة لتفادي الاصابة به التي سببت آثارا نفسية
واجتماعية عميقة كالاحساس « بالضيق والقلق والخوف من العدوى والاكتئاب
والأرق بين عامة السكان.
وتؤدي العزلة الاجتماعية وعدم اليقين والتوتر المزمن والصعوبات
الاقتصادية إلى تطور أو تفاقم الاكتئاب والقلق».
ولاتقف الاعراض عند هذا الحد بل تتجاوزها الى «إلى زيادة معدلات
الانتحار أثناء الجائحة وبعدها» حسب البحث العلمي الذي اجراه بروفسور
ليو شير ونُشر في دورية الطب الدولية بنيويورك. ويأتي الاهتمام بهذه
الجوانب تزامنا مع اليوم العالمي للصحة العقلية المصادف 10 أكتوبر/
تشرين الاول.
يُلاحظ، في الوقت نفسه، ما نشرته الصحافة العراقية والعربية، عن ازدياد
حالات الانتحار في العراق، ووصفها بأنها مرعبة، اذ بلغت 293 حالة، خلال
الستة اشهر الاولى من 2020، فقط، وتتميز بانتحار الذكور أكثر من
الاناث. فهل سبب ذلك، كما في الدول الغربية، هو انتشار الفايروس وما
يصاحبه من « عدم اليقين بشأن المستقبل» والاضطرابات النفسية جراء
الحرمان الاقتصادي، كما تخبرنا الدراسات العلمية، أم ان ما يتعرض له
المواطن العراقي مختلف تماما او متعدد المستويات مما يُسّرع برغبته في
الانتحار؟
ليس بالامكان انكار تأثير الجائحة على نفسية وحياة المواطنين، خاصة مع
تجاوز عدد الاصابات اليومية الآلاف نتيجة انهيار الجهاز الصحي وتخوف
الناس من التوجه الى المستشفيات. الا ان فهم الارقام الحالية لحالات
الانتحار ومدى ارتباطها بالجائحة، يحتاج الى مراجعة الحالات في الاعوام
الماضية. ففي عام 2006، نقل موقع « رليف وب» التابع للأمم المتحدة، في
مقال « ضغوطات العنف تقود الى الانتحار» تصريحا لوزارة الصحة، بناء على
إحصاءات من مشرحة ومستشفيات بغداد في خمس مناطق، إن نحو 20 شخصا
ينتحرون كل شهر. وقال أحمد فتاح، عضو إدارة التحقيق في الانتحار بوزارة
الصحة، إن «الأرقام مرتفعة بالمقارنة مع تلك التي كانت موجودة قبل عام
2003، عندما كان لدينا حالة انتحار واحدة أو اثنتين في الشهر». وتشير
ورقة بحثية بعنوان « الدراسة الوطنية العراقية لطرق الانتحار: تقرير عن
معطيات الانتحار في 2015 و 2016» المنشورة في دورية « الاضطرابات
النفسية» عام 2017، الى 647 حالة انتحار في 13 محافظة من مجموع 18.
معظم الحالات لشباب تحت سن 29 وأغلبهم من الذكور. مع ازدياد ملحوظ في
عام 2016 بالمقارنة مع 2015. ربع الحالات سببها اضطرابات نفسية، أكثره
شيوعا هو الاكتئاب، مع أقلية تعاني من صدمة نفسية (15.5٪)ومشاكل مالية
(12.4٪) أو إساءة معاملة اثناء الطفولة (2.2٪).
ونشرت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية تقريرها لعام 2018 بينت فيه ارتفاع
عدد الحالات من 383 خلال عام 2016 إلى 519 في 2018. تدل هذه المراجعة
على ان الزيادة مستمرة، تدريجيا، منذ عام الغزو الانكلو أمريكي، أي قبل
غزو جائحة الكورونا بـ 17 عاما، وانها ليست، كما في الغرب، السبب
الوحيد لحالات الانتحار.
إن ايجاد حل للصحة النفسية والعقلية، بالعراق، يتطلب ليس معالجة انعكاسات الجائحة، في الشهور الأخيرة، فحسب، ولكن التعامل معها، باعتبارها عمّقت بحلولها الخراب السياسي والاقتصادي والمجتمعي الموجود أساسا
ما هي الاسباب الرئيسية اذن؟ في عام 2006، صرّح د. أحمد فتاح بسوداوية
موجعة: «اليوم ينتحر الكبار، لكن لن يمر وقت طويل قبل أن يبدأ الأطفال
أيضًا في الانتحار». فهل ما نشهده اليوم، اذن، هو انتحار اطفال الامس؟
هل هم الذين كبروا تحت الاحتلال، واستمرارية العنف والتهديد اليومي
بالقتل، والخراب الاقتصادي، والتمييز الطائفي والعرقي، والنزوح القسري
والتشرد، والفساد الناخر للبنية الاجتماعية؟ هل هم ابناء المليون مواطن
ممن قتلوا اما بشكل مباشر او غير مباشر جراء الاحتلال؟ هل هم الخريجون
العاطلون عن العمل أو النساء المعيلات للأيتام بعد قتل او سجن ازواجهن؟
اليست هذه الاسباب كافية لجعل العراقيين يعيشون تأثيرات نفسية وعقلية
وجسدية لا تقل ضررا عن تأثيرات جائحة كوفيد؟
« أربعون في المائة من الأطفال العراقيين يعانون من أمراض عقلية». تقول
الاخصائية النفسية د. الهام الدوري « كذلك الحال بالنسبة إلى 17 في
المائة من الشباب، مما يجعل عدد الشباب المصابين بمستويات متباينة من
الأمراض النفسية والعقلية يساوي خمسة ملايين وسبعة أعشار المليون،
بالمقابل هناك 100 طبيب مختص، فقط، داخل العراق». لامفر للعراقي، اذن،
من الضرر النفسي نتيجة العنف والنزوح والبطالة، حين يشعر الرجل بالعجز
عن تأمين المعيشة لنفسه وعائلته، ويصيب النساء رشاش العنف المجتمعي
والاسري بالاضافة الى كوابيس الحرب والتشرد والقلق الدائم على تعليم
وصحة وحياة الاطفال. أن تدهور العلاقات العائلية الممتدة القديمة،
وتدهور علاقات الجيرة التي تميز المجتمع الشرقي التقليدي ( وهما
الجانبان اللذان كانا يؤمنان درجة من الرعاية النفسية للجميع من
الطفولة الى الشيخوخة ) لم تعوضه اي خدمات من الدولة التي دمرت عمداً،
وانهار معها التعليم المدرسي والقانون، ولم يعوضه أيضاً صعود التدين
بما رافقه من خزعبلات وجهل، ومن تجارة وفساد أخلاقي ومالي.
في مقال مشترك لوزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية
سيغريد كاج والعراقية د.هالة صباح جميل، نُشرت، أخيرا وصف الاثنان نظام
الصحة العقلية الذي يعمل فيه مقدمو الرعاية العقلية في العراق « فيه
فجوات كبيرة مثل حفر القنابل». وجه الاثنان الى وجوب الاهتمام بهذا
الجانب، بالغ الاهمية، للأفراد والأسر والمجتمعات وصانعي القرار « حتى
يتمكنوا من التعافي وإعادة البناء واستئناف سبل العيش وتعزيز المصالحة
«. محذرين بانه ما دامت هذه الفجوات موجودة، تزداد معاناة النازحين
والمصابين بصدمات نفسية لأن «الصدمات تتراكم، بمرور الوقت، ويصبح
العلاج أكثر صعوبة». ومعروف أن الصدمات النفسية والكآبة من مقدمات
العديد من الامراض المزمنة التي تستنزف قوة المجتمع وحيويته عموما.
المشكلة الاساسية التي نتلمسها بقوة اثناء قراءة هذه التصريحات
والتقارير المتتالية، وهي تقارير انسانية نبيلة، كما تركيز يوم في
السنة للوقاية من الانتحار، وهو ضروري للتنبيه الى جانب مُعاش ومهمل،
ان هذه النشاطات، غالبا، ما تتجاهل، وهذا واضح جدا في حالة العراق،
الاسباب الاعمق المؤدية الى فقدان الشباب الرغبة بالحياة أو التطلع الى
ما هو أبعد من اليوم الذي يعيشونه. ويكمن سبب التغاضي عن التغيير
الفعال، كون عمل المنظمات المحلية والدولية يرتبط بموافقة الحكومات
ونظامها السياسي. مما يجعل نشاط المنظمات دواء مُسٌكنا للاوجاع وليس
علاجا. وهي خطوة تحمل آثارا جانبية خطرة، حين لايعالج الوضع ككل بل يتم
تفتيت القضايا دون المس بالاسباب الحقيقية. وإن ايجاد حل للصحة النفسية
والعقلية، بالعراق، يتطلب ليس معالجة انعكاسات الجائحة، في الشهور
الأخيرة، فحسب، ولكن التعامل معها، باعتبارها عمّقت بحلولها الخراب
السياسي والاقتصادي والمجتمعي الموجود أساسا.
كاتبة من العراق
هل يتوجب علينا الاهتمام
بمصير الرئيس ترامب ؟
هيفاء زنكنة
حتى أقل الناس اهتماما بالسياسة، وأكثرهم عزلة وابتعادا عن اجهزة الإعلام، سمع او شاهد أو قرأ خبر اصابة الرئيس الامريكي دونالد ترامب والسيدة زوجته بفايروس كورونا. فقد تصدر الخبر مواقع التواصل الاجتماعي وتسلل الى المكالمات الهاتفية، ناهيك عن اجهزة الإعلام، ليتم فرز كل حركة أو اشارة صدرت عن الرئيس، منذ اعلان اصابته، بالاضافة الى تدوير تصريحاته عما نطق به حول كيفية الوقاية من الاصابة بالفايروس، مثل شرب الكلورين، ونصائحه عن ارتداء او عدم ارتداء الكمامة، التي باتت تضاهي في شهرتها، الآن، المقولة الشكسبيرية « أن تكون أو لا تكون» .
حققت متابعة تفاصيل علاج الرئيس ترامب، نجاحها أو انتكاستها، نجاحا مليونيا ، في أعداد المتابعين يتجاوز أكثر افلام هوليوود ومسلسلات نفلكس نجاحا، وأكثر من المسلسلات التركية التي احتلت مكان السورية، في العالم العربي، بعد تراجع انتاج الاخيرة. تحيط التغطية الإعلامية ، الممتدة على مدار الساعة، الكرة الارضية، في ذات الوقت الذي تُمرر فيه مئات آلاف الاصابات والوفيات، في جميع انحاء العالم، كارقام واحصائيات وخطوط بيانية، تُبث أو توضع على المواقع ، بألوان مختلفة، توحي للناظر بانها تمثل الفرق بين الحياة والموت، بين فترة ما قبل الكورونا وخلالها. الاحصائيات والخطوط البيانية، غالبا، لا تعني شيئا للقارئ. انها مجرد أرقام. من السهل على الناظر أن يدير وجهه جانبا لئلا يراها او يختار الا يعرف لأنه وصل حد الاشباع في التعامل مع الارقام ومحو الانسان، الا اذا كان وزيرا أو نجما او رئيس دولة. حينئذ تطالعنا تفاصيل حياة المصاب اليومية، ومسار العلاج والفحوصات التي تجرى عليه بادق التفاصيل، وسيرورة تعافيه وانتصاره على الفايروس، الذي يحصد حياة الفرد العادي الذي قلما تتاح له فرصة الرعاية والعلاج. تبدت هذه المفارقة بوضوح حين أصيب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالفايروس . وها هي أصابة دونالد ترامب لتدحض، مرة اخرى، حقيقة المساواة بين البشر ورعاية الحياة الانسانية. الحقيقة هي « كل الحيوانات متساوية لكن بعض الحيوانات متساوية اكثر من غيرها» كما كتب جورج اوريل في مزرعة الحيوان، وهو ما يأخذنا الى انتقائية تطبيق القوانين الدولية من قبل الدول الكبرى مقابل الشعوب المستضعفة ، والتي تماثل الفروق بين القبو المظلم والطابق العلوي بشرفاته، وان كان المبنى واحدا.
السياسة الخارجية ، مهما كان الحزب الحاكم ، جمهوريا أو ديمقراطيا، تكاد تكون واحدة مع بعض التغييرات الطفيفة الناتجة عن شخصية الرئيس
بعيدا عن نظرة اللامساواة السوداوية، التي تبلورت بأوضح صورها في عام الكورونا، يبدو الاهتمام الإعلامي والشعبي، بمتابعة صحة الرئيس ترامب، مبررا. فهو، من الناحية الدولية، رئيس اقوى دولة عسكرية في العالم ، قد يصفه البعض بانه شرطي العالم، الا ان هذا غير مهم بالنسبة للحكومات، المرتبطة مع أمريكا، بمعاهدات واتفاقيات عسكرية وأمنية واقتصادية، تتحكم بدرجات متفاوتة، بشعوب تلك الدول. وهو رئيس الدولة المانحة والداعمة لآلاف المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية، الممتدة كاذرع الاخطبوط، في طول وعرض الكرة الارضية. أما في داخل أمريكا، فتتمحور درجة الاهتمام بصحة الرئيس ، بيمينها العنصري الابيض وحركات الحقوق المدنية واليسار المتظاهر الغاضب، حول العد التنازلي لاقتراب يوم الانتخابات الرئاسية، ومحاولة الحزب الجمهوري المستميتة ، المتمثلة بمرشحه ترامب، للفوز بدورة ثانية.
عربيا، تشكل سياسة ادارة ترامب من فلسطين والعراق وإيران والسعودية، أحد أسباب الاهتمام الحكومي والشعبي بمتابعة صحة الرئيس. حكوميا، لأن معظم الحكومات العربية بحاجة الى الحماية الأمريكية بأي شكل من الاشكال. وتخلخل الوضع داخل أمريكا سيؤدي الى انعكاسات غير مرغوب بها. أما سبب الاهتمام الشعبي، وهو أقل من الحكومي، فيغلب عليه عدم التصديق واعتبار مرض ترامب جزءا من عرض مهيأ لالهاء الناس عن جرائم أمريكا وسياستها، خاصة في فلسطين. هناك ، ايضا، جانب السخرية المريرة، والشماتة، وتبادل النكات عن الرئيس الذي أوصل الفضائح الجنسية والسياسية وتزوير الانتخابات مستوى فاز فيه على الرئيس الديمقراطي السابق بيل كلينتون ، المشهوربعلاقته الجنسية مع المتدربة في البيت الابيض مونيكا لوينسكي. وقد صرح، أخيرا ، في فيلم وثائقي جديد، يتناول حياة زوجته هيلاري المرشحة الرئاسية لعام 2016 ، قائلا إنّ علاقته بمونيكا كانت وسيلة للتغلب على مخاوفه وقلقه. وسجل ترامب فوزا ساحقا على الرئيس الجمهوري ريتشارد نيكسون، صاحب فضيحة « ووترغيت» الذي استقال بعد ان حوكم وسحبت الثقة منه، بتهم عرقلة عمل العدالة، وسوء استخدام السلطة، وازدراء الكونغرس.
هذه الممارسات « الرئاسية» منحت ترامب الاحساس بنوع من الحصانة المعجونة بعنجهيته الشخصية كرجل أعمال يعمل بقوة من اجل الرجل الابيض. وكونه قد حقق كل الوعود، تقريبا، التي أطلقها اثناء حملته الانتخابية مهما كانت قسوتها وتحريضها على العنصرية والعنف. فقد نجح في رفع المستوى الاقتصادي، ومنع دخول المزيد من المهاجرين الى امريكا، والعمل على سحب القوات العسكرية من البلدان المتواجدة فيها، كافغانستان والعراق، واجراء المباحثات مع طالبان. وجعل وجود القوات، لحماية الحكام المحليين، مشروطا بدفع تكاليفها، كما فرض على السعودية. فالحماية العسكرية الامريكية ضرورة اساسية لحكام يخشون شعوبهم. وكان لنجاحه في تحقيق الوعد للكيان الصهيوني بجعل القدس عاصمة للمحتل، والجمع بين المحتل الصهيوني العنصري والمستخذين من ممثلي دول عربية، تأثير غطى على جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وضحايا القصف، بحجة محاربة الارهاب، في العراق وسوريا واليمن.
« الأيام القليلة المقبلة ستكون الاختبار الحقيقي» غرّد ترامب بعدما دخل المستشفى. وهي تغريدة نادرة في صدقها. فما الذي ستحمله نتيجة الاختبار الحقيقي الايام المقبلة لأمريكا وبقية العالم ؟ لا شيء مغاير تماما. فالسياسة الخارجية ، مهما كان الحزب الحاكم ، جمهوريا أو ديمقراطيا، تكاد تكون واحدة مع بعض التغييرات الطفيفة الناتجة عن شخصية الرئيس . وهو ما تلخصه عضوة الكونغرس الشابة الاشتراكية الديمقراطية ألكساندريا أوكاسيو- كورتيز ، بقولها: « بامكانه البقاء ، بامكانه الذهاب. يمكن عزله، أو التصويت لصالحه في عام 2020 ، لكن إزالة ترامب لن تؤدي إلى إزالة البنية التحتية لحزب أحتضنه؛ والأموال السوداء التي مّولته ، والتطرف عبر الإنترنت الذي طّبل له جيشه ، ولا العنصرية التي قام بتضخيمها وإعادة إحيائها» . لتجيب عند سؤالها عن احتمالات تغيير الواقع الحالي الذي تتحكم فيه الرأسمالية « «الرأسمالية لم تكن موجودة دائمًا في العالم ولن توجد دائمًا في العالم.»
كاتبة من العراق
عن زمن الحب والمقاومة
في فلسطين ولبنان
هيفاء زنكنة
هل صحيح أن سمة الشعوب العربية هي التأرجح المدمر بين الغرور الدافع
الى التمرد البدوي والمثالية الفجة من جهة، واحتقار الذات الدافع الى
الاستخذاء والخنوع للعدو من جهة أخرى، مما يجعل تسليم امرنا الى القضاء
والقدر والقبول بالأمر الواقع على هناته حلا وحيدا لوضعهم المصنف
سياسيا بالتعقيد؟
هل بات اليأس هو الكفاف اليومي للشعوب العربية، كما كتبت الشاعرة
والاستاذة اللبنانية نادين عطو، مشيرة في اعقاب صدمة تفجير لبنان التي
أذهلتنا جميعا، الى شعب « نزلت عليه الويلات كلها في وقت واحد. وقد لا
تكفي كلمة «محزن» لوصف الوضع فيه؟ فما يحصل يدمي القلب، والقصص التي
تصلني تشعرني بالانهزام والالم. ورغم أنني أقضي معظم الوقت في المساعدة
ولو عن بعد، ادعو الله ان يزيل الغمة».
ونحن نخطو متعثرين، مثقلين بحمل صخرة الأسى، يصاحبها الاحساس بالذنب
لأننا لا نفعل ما يكفي، في ليل توحي ساعاته المتمددة باللانهاية ، يتخذ
دعاؤنا أشكالا متعددة. تشير اليها علامات طرق، نراها على الرغم من
الظلام وصعوبة المسار لكي نواصل السير. قد تكون علامات الطرق أحداثا
نستخلصها من الذاكرة فتشحننا بقوة الارادة أو كتبا عن شخصيات تاريخية
توحي لنا بديمومة الأمل أو شخصيات تعيش معنا، في ذات الليل المظلم،
لكنها قادرة على الصمود والرؤية بضياء القلب، فيتسلل الينا الضوء من
خلالها. المخرجة مي مصري هي واحدة من تلك الشخصيات. وإحدى العلامات
التي استوقفتني، أخيرا، في طريق القلب الى لبنان وفلسطين، كتاب يلخص
ويوثق ثلاثين عاما من انجازاتها وهو بقلم امرأة تضاهيها نضالا. « الحب
والمقاومة في افلام مي مصري» عنوان كتاب الصحافية والناشطة البريطانية
المعروفة فكتوريا بريتن.
كيف نقرأ السينما؟ كيف يتم تحويل المرئي الى التدوين؟ كيف يحافظ
المدّون، ناقل الصورة الى الورق، على فرادة وتمايز الفن الجامع لكل
الفنون، بالاضافة الى التجربة الحياتية، اذا كان صانع الفيلم ، يتوخى،
كما تفعل مي في افلامها الوثائقية، الجمع بين الفن والسياسة معا ؟ ليست
مهمة سهلة. الا ان فكتوريا تمكنت من توثيق الأفلام بموضوعاتها، وخلفيات
اخراجها، واسماء المشاركين فيها وفي الوقت نفسه اضاءة الجوانب الفنية
والابداعية المميزة لأعمال مي التي يراها المشاهد خيطا ملونا في نسيج
الحياة اليومية للبلدين . نسيج تغزله بحرص وشغف وحماس من يحب الحياة.
وحب الحياة والتشبث بالامل هو الذي يرافقنا طوال صفحات الكتاب وطوال
افلام مي سواء التي أخرجتها لوحدها ، او صحبة زوجها ورفيق حياتها
الراحل جان شمعون ، ولعل هذا واحد من الاسباب التي تجعلنا نلتقي
بالشاعر الفلسطيني محمود درويش ونحن نتصفح فصول الكتاب التي نتعرف من
خلالها لا على افلام وحياة مي فحسب ولكن على حقبة نضال بكل تحدياتها:
تحت الأنقاض، زهرة القندول، بيروت: جيل الحرب، أطفال جبل النار، أحلام
معلقة، حنان عشراوي: أمران في زمن التحدي، يوميات بيروت، 3000 ليلة. مع
اصوات الأسيرات المتحديات في معتقلات الكيان الصهيوني، والأطفال رافعي
اشارة النصر، وعلى ايقاع روح النضال والمقاومة في فلسطين ولبنان ، نسمع
درويش وهو يردد « على هذه الأرض ما يستحقّ الحياةْ: على هذه الأرض
سيدةُ الأرض، أم البدايات أم النهايات. كانت تسمى فلسطين. صارتْ تسمى
فلسطين. سيدتي: أستحق، لأنك سيدتي، أستحق الحياة».
تُبدع مي مصري في زرع الأمل، وتوثيق مقاومة الفرد العادي وإنسانيته مقابل لا إنسانية المحتل ووحشية الطغاة
ان رواية مي مصري السينمائية عن الإنسان من خلال النساء والاطفال، عن
القضية الفلسطينية، عن الحرب ومعنى السلام المرتبط بالعدالة ، عن حفظ
الذاكرة و» خوف الغزاة من الذكريات» وتوثيق حالات التعذيب لئلا تتكرر،
والبحث عن المختفين ، وأحلام وطموحات الأسيرات في سجون الاحتلال
الصهيوني، بحثا عن الحرية واسترداد الارض، عن علاقة الفلسطيني بالارض،
ارضه التي يحملها في وجدانه اينما كان. في سرديتها السينمائية ، بهدوء
الراوي الواثق من نفسه وايمانه بقضيته، بابرازها انسانية نضال
الفلسطيني ومقاومته، متعددة المستويات، وقدرتها على تقديم الواقع الحي
بتفاصيله الصغيرة، تفكك مي مصري سينما المحتل العنصري المبنية على
التزوير التاريخي، وتشويه صورة الفلسطيني ومحو وجوده. بهذه الطريقة ،
وهي تروي قصص الحب والحيرة والتشتت وحكايات الطفولة والسجون والتعذيب ،
تُبدع مي مصري في زرع الأمل، وتوثيق مقاومة الفرد العادي وإنسانيته
مقابل لا إنسانية المحتل ووحشية الطغاة.
وتنبع أهمية الكتاب، أيضا، بذات الطريقة غير المباشرة، التي تبدع فيها
مي أفلامها، من كون فكتوريا بريتن هي المؤلفة. حيث تشكل تقاريرها
كصحافية مختصة بالشأن الافريقي والشرق الأوسطي، على مدى عقود، وكتبها ،
وآخرها « النساء المنسيات في الحرب على الإرهاب» وكونها من مؤسسي
واللجنة التنفيذية لجائزة افضل كتاب عن فلسطين باللغة الانكليزية، محطة
تزخر بالتضامن اليومي الدؤوب للشعب الفلسطيني لاستعادة وطنه المحتل.
ويأتي اختيارها الكتابة عن سينما وحياة المخرجة الفلسطينية مي مصري
امتدادا طبيعيا لإنسانية ما تؤمن به ، ورغبتها في توثيق الواقع اليومي
والنضال من أجل العدالة الذي ميز حياة جيل بأكمله، والاكثر الحاحا هو
ضرورة عدم السكوت ، خاصة في هذا الوقت المُهدد باليأس، والظلام السياسي
الحالي وتقدمه في خلاصة الكتاب بأن شعرية وغنى سينما مي يكتسب اهمية
قصوى ونحن نراقب ما يحدث في فلسطين بعيدا عن القانون الدولي والانساني،
حيث استهداف الشباب وتشويههم لمشاركتهم في مظاهرات غزة، وسنوات الحصار
الجائر عليها، ووحشية المستوطنين المتسعة في ارجاء فلسطين وعنفهم ،
خاصة ، ضد النساء والاطفال. ولا ننسى جدار الفصل العنصري ، واعلان
الولايات المتحدة الامريكية القدس عاصمة للكيان الصهيوني، والاعتراف
بالجولان جزءا منه، واستقطاع الدعم لمنظمة الاونروا مما يعني العقاب
الجماعي لجيل المستقبل من خلال حرمانه من حق التعليم. وهي تلخص لنا ما
يعانيه الفلسطيني ، يوميا، تحفر فكتوريا ، في أذهاننا، الصورة
الإعلامية التي تركز عليها اجهزة الإعلام لتغطي آلة القتل اليومي
المستهدف للفلسطينيين ، ولترسخ صورة القوة الامريكية – الاسرائيلية
متجسدة بايفانكا ترامب وزوجها جارد كوشنر، وهما بأبهى حلة، مبتسمان
اثناء افتتاح السفارة الامريكية الجديدة في القدس المحتلة.
كاتبة من العراق
جاذبية استخدام
المظلومية في العراق
هيفاء زنكنة
أيام العراق كما هي. الاحتجاجات مستمرة للمطالبة بالحقوق. اختطاف
الناشطين واكتظاظ المعتقلات مستمر. أيام العراق عادية للمواطن العادي.
على مواقع التواصل الاجتماعي تبادل الاتهامات ما بين المثقفين مستمرة،
اكثرها انتشارا هي الموجعة، الغاضبة، المشحونة بالشتائم، المنصبة على
المقارنة بين ممارسات النظام العراقي السابق والحالي حول حقوق الانسان.
هل بإمكاننا المقارنة، بعيدا عن الالم الشخصي واستنادا الى ذاكرتنا
التي عانت الكثير عبر العقود الكارثية المحملة بالحروب والحصار
والاحتلال؟ ماذا عن مراجعة عدد من تقارير المنظمات الحقوقية الدولية
لتمنحنا تخطيطا جافا، بلا عواطف، عن الموضوع؟
عند مراجعة تقارير منظمة العفو الدولية عن انتهاكات حقوق الانسان في
العراق، في ثمانينات القرن الماضي، أثناء الحرب العراقية الإيرانية،
سنلاحظ ان التعذيب و الاختفاء والاعدام، يطغى على التقارير. حيث تم
تمريرها بذريعة المحافظة على «أمن الدولة» في فترة الحرب، واتهام
الاحزاب المعارضة بالخيانة والإرهاب. وهي ذات الاحزاب المشاركة بالحكم
حاليا. يوثق تقرير المنظمة لعام 1983، مثلا، اعتقال 38 «معارض رأي» و
اعتقال اربعة من مساعدي آية الله الخوئي، واختفاء اربعة من اعضاء الحزب
الشيوعي، واعتقال اعداد كبيرة منهم، بالإضافة الى اعضاء من حزب الدعوة
الإسلامي المحظور، واطلاق النار على متظاهرين في مختلف المدن الكردية
واعتقال عدد منهم. يؤكد التقرير ان الاعدامات تتم بعد اصدار احكام
سريعة غير مستوفية للشروط القانونية. الا ان المنظمة رحبت بقرار مجلس
قيادة الثورة الصادر في 16 تموز/ يوليو 1982 بالعفو «عن كل الاكراد
المتهمين بحمل السلاح ضد الحكومة العراقية». كما صرح نائب رئيس الوزراء
طارق عزيز، يوم 10 آب/ اغسطس، ان العفو يشمل كافة اعضاء الحزب الشيوعي.
حول مدى صحة تنفيذ قرارات العفو، ذكرت المنظمة انها كتبت الى «الرئيس
صدام حسين ملتمسة تفاصيل العفو، إلا انها لم تتلق اي جواب. كما لم يصدر
أي تصريح رسمي حول أعداد المعتقلين الذين استفادوا من العفو».
من المفيد مراجعة سجل إيران، لذات الفترة، ايضا، لأن عددا من الاحزاب
والميليشيات التي دخلت العراق بعد الاحتلال أسست في إيران، وكونها
البلد الثاني المؤثر، بعد أمريكا، في البلد، منذ الاحتلال الانجلو
أمريكي عام 2003، الى حد ترك بصمة كبيرة في تشكيل الهوية الفردية.
يتبين عند المراجعة ان التعذيب والاختفاء والإعدام، يطغى على التقارير.
حيث وثقت المنظمة، اعدام 624 شخصا، عام 1982 فقط، بينما بلغ العدد 4605
منذ الثورة عام 1979، حسب الارقام المعلن عنها رسميا. تم تمرير
الانتهاكات والاعدامات بذريعة التخريب ومعاداة الثورة والقيام بمحاولة
انقلاب. في كانون الثاني 1982، كتبت المنظمة الى رئيس الوزراء حسين
موسوي بصدد عدد الاعدامات الكبير واصدارها في محاكمات سريعة جراء
اعترافات مستخلصة نتيجة التعذيب، الا انها لم تتلق أي جواب. وطالت
الاعتقالات سجناء الرأي، من بينهم اربعة محامين اعضاء في نقابة
المحامين، استهدفتهم مع آخرين آلة الاعتقال، بعد اعلان آية الله خميني،
في 23 اغسطس 1982، تطبيق الشريعة والغاء القوانين المدنية.
استخدمت قوات الأمن وفصائل من قوات « الحشد الشعبي» القوة المفرطة ضد المحتجين المشاركين في مظاهرات عمت أنحاء البلاد بدءا من أكتوبر/تشرين الاول، فقتلت أكثر من 500 منهم وأصابت آلافا آخرين
يقول هانز فون سبونيك، ممثل الامم المتحدة في العراق المستقيل بسبب
الحصار الجائر «لم تبق أية مادة في ميثاق حقوق الانسان لم تنتهك في
العراق منذ غزوه». ولنراجع تقرير منظمة العفو لعام 2019: «استخدمت قوات
الأمن وفصائل من قوات «الحشد الشعبي» القوة المفرطة ضد المحتجين
المشاركين في مظاهرات عمت أنحاء البلاد بدءا من أكتوبر/تشرين الاول،
فقتلت أكثر من 500 منهم وأصابت آلافا آخرين، وتوفي الكثير نتيجة
إصابتهم بالذخيرة الحية أو بعبوات من الغاز المسيل للدموع لم تشاهد من
قبل. وتعرض النشطاء، وكذلك المحامون الذين يمثلون المحتجين، والمسعفون
الذين يتولون علاج الجرحى، والصحافيون الذين يغطون الاحتجاجات للقبض،
والاختفاء القسري، وغير ذلك من أشكال الترهيب على أيدي أجهزة
الاستخبارات والأمن.. وظل آلاف الرجال والصبية مفقودين بعد اختفائهم
قسريا على أيدي قوات الامن العراقية، بما في ذلك وحدات الحشد الشعبي».
كل هذا، بدون القاء القبض على مرتكبي الانتهاكات والجرائم، بل وغالبا
ما تتم مكافأة المسؤولين على الرغم من توفر الادلة والشهود. ترينا هذه
المراجعة السريعة ان هناك ممارسات وانتهاكات تكاد تكون متماثلة في
تطبيقها وتبريرها بين النظامين العراقي والإيراني، في الثمانينيات، الا
انها تعمقت وانتشرت وتطورت بشكل كبير، وهنا المفارقة، على أيدى الساسة
الذين طالما قدموا انفسهم كضحايا للنظام السابق. حيث اصبحت «المظلومية»
ذريعة للتعاون مع الاحتلال اولا ولتكريس نظام المحاصصة والتمييز
الطائفي والعرقي ثانيا. ما يجمع الساسة «الضحايا» بالإضافة الى الفساد،
هو ارتكاب أو غض النظر عن الانتهاكات والتعذيب والاختفاء وتنفيذ احكام
الاعدام، بشكل جماعي شبهته مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان
بـ«ذبح الحيوانات في المسلخ».
ومن استخدام المثقب وشوي الضحايا واغتصاب الرجال الى تصوير أشرطة فيديو
التعذيب والانتهاكات الجنسية وتوزيعها. كل هذا بحجة «ليس الوقت ملائما»
لانشغال الحكومة بمحاربة الإرهاب!،
ويعود سؤال «من هو الاسوأ» أو «الاحسن» من الحكام، ليتكرر وينتشر
بتنويعات تبريرية، مبتذلة، تختزل حياة الإنسان الى رقم في قوائم تضم
الآلاف. تُنسينا بديهية ان حماية الفرد هي مسؤولية الحكومة، خاصة، اذا
كانت تدّعي الديمقراطية الانتخابية وتُزّين وجودها بحقوق الإنسان. وإلا
من يتحمل، مثلا، مسؤولية عوائل آلاف القتلى والمغيبين تحت لافتة مكافحة
الإرهاب، وملايين المهجرين، في عدة مدن، جراء قصف قوات التحالف الدولي
«الستيني» والميليشيات الطائفية؟ ألن تكون هذه مبررا لمظلومية مستقبلية
تبرر الافعال الانتقامية كما يفعل ضحايا تهجير تهمة «التبعية
الإيرانية» من قبل النظام السابق واستغلالها سياسيا من قبل النظام
الحالي؟
لا يمكن تقليل المسؤولية عن الحكومة حيث اثبتت السنوات الاخيرة، في
حياة العراقيين، ان بامكان مُدّعي المظلومية ان يكون جلادا بينما يبقي
الضحايا الحقيقيين مظلومين. وحين توفر الحكومة التمويل لصالح «التظلم»
فانها تعمل على تقسيم الناس وإقناع الضحايا بأن المجتمع يقف ضدهم بلا
هوادة، مما يقضي على امكانية التفكير بايجاد حلول حقيقية للمعاناة
والقمع. وهو ما وصفه المفكر الإنساني البريطاني برتراند راسل، عام
1950، في مقالته المعنونة «الفضيلة الفائقة للمضطهدين» التي بيّن فيها
«ميل الناس إلى تخيل أن أولئك المضطهدين يتمتعون بجودة اخلاقية فائقة».
كاتبة من العراق
« الدرونز»…
عقوبة إعدام بلا محاكمة
هيفاء زنكنة
جاء في بيان لوزارة الدفاع البريطانية أن سلاح الجو الملكي البريطاني
نفذ عمليتين ضد تنظيم «داعش» في شمال العراق خلال شهر آب/ أغسطس.
كلاهما بواسطة طائرة بدون طيار ( درون) من صنف ريبر، موضحا بأن
العمليتين هما جزء من مساهمة بريطانيا في التحالف الدولي في الحرب ضد
«داعش» في سوريا والعراق. حيث تقوم الطائرات بشن ضربات على «أهداف
إرهابية عند الحاجة». تبين تفاصيل العملية الاولى، أن الدرون تعرف على
«إرهابيين عند مدخل كهف لداعش، على بعد 85 ميلاً غرب كركوك. وبقي
الدرون يراقب الموقع عن كثب ثم نفذ طاقم الدرون، في 20 آب، هجومًا
بصاروخ « هيلفاير» بعد أن تاكد من عدم وجود مدنيين قد يكونون معرضين
للخطر. «أصاب الصاروخ الهدف بدقة، ولوحظ أن الانفجار يخرج من جزء آخر
من شبكة الكهوف، مما يشير إلى أن تأثير السلاح قد وصل إلى عمق الكهوف».
الملاحظ أن البيان لا يذكر عدد القتلى، تماشيا مع سياسة أمريكا والكيان
الصهيوني، في إهمال ذكر الضحايا، أيا كانوا، بل يركز على إثبات دقة
تصويب الدرونز، والحرص على سلامة المدنيين، وشرعية وقانونية استخدامه
كسلاح للقتل، في بلد، ليس في حالة حرب مع بريطانيا. مما يثيرعدة نقاط
مثيرة للجدل. من بينها زعم صناع السلاح ودعاة حرب الطائرات بدون طيار
أنها الأسلم بالنسبة الى الجنود، لأنها تقلل من الحاجة الى وجودهم على
الأرض وبالتالي تعرضهم للخطر، متعامين عن حقيقة أن ثمن سلامة الجنود في
أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني يدفعه المدنيون على الأرض. اذ ليس
من الممكن معرفة ما يحدث على الأرض بدقة من على بعد آلاف الأميال. صحيح
أنها تسمح للجنرالات والسياسيين بمشاهدة الحرب التي يشنونها على الجانب
الآخر من العالم، على الهواء مباشرة، بواسطة شاشة من أي مكان في
العالم، والانتشاء لتحقيق «الانتصار» إلا أن هذا لا يعني سلامة
المدنيين بل سهولة شن الحروب عن مبعدة. فبينما تدعي بريطانيا، مثلا، أن
مدنيًا واحدًا فقط قُتل في آلاف الضربات الجوية والدرونز البريطانية في
العراق وسوريا، أعلنت منظمات تسجيل الضحايا والصحافيين عن آلاف القتلى
في غارات جوية للتحالف.
وقد عاشت أربعة بلدان هي افغانستان وسوريا وليبيا وغزة جحيم «الأمان»
الذي توفره الدرونز، في شهر نوفمبر / تشرين الثاني 2019، حيث قُتل جراء
«دقة» استخدامها 41 مدنيا بينهم 11 طفلا. ففي أفغانستان، قُتل 6 قرويين
كانوا يرعون الماشية ويجمعون الأخشاب. وفي سوريا تم ضرب مجموعة من خمسة
مدنيين كانوا يقطفون القطن، مما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة خمسة. وفي
ليبيا قتل 10 عمال مهاجرين في مصنع بسكويت وبعد عشرة أيام، قُتلت عائلة
من العمال المهاجرين النازحين بما في ذلك 6 أطفال مع عاملين يقومان
بتوصيل المياه للأسر النازحة. واعترفت قوات الكيان الصهيوني بقتل
ثمانية أفراد من عائلة رسمي السواركة ( 45 عاما) في غزة.
وليس صحيحا ما تدعيه البيانات الرسمية بأن استخدام الدرونز، في العراق
وبقية الدول، يتم لتوجيه ضربات ضد تنظيم داعش. ففي 12 آب، من العام
الماضي مثلا، هاجمت ثلاث طائرات درون تابعة للكيان الصهيوني إحدى قواعد
«الحشد الشعبي» في بغداد، ما أدى إلى انفجار 50 طنا من الأسلحة بذريعة
ضرب صواريخ إيرانية كانت في طريقها إلى سوريا ولبنان.
هناك عدة منظمات أوروبية وأمريكية مستقلة، تقوم برصد استخدام الدرونز للتجسس والاغتيال وآثارها على حياة المدنيين
الجانب الآخر الأكثر اثارة للجدل هو استخدامها من قبل أمريكا وبريطانيا
والكيان الصهيوني في عمليات القتل المستهدف، أي القتل العمد مع سبق
الإصرار لأفراد مختارين من قبل دولة ليسوا رهن الاحتجاز لديها، كما
فعلت أمريكا في باكستان واليمن، ويواصل الكيان الصهيوني استهداف قادة
المقاومة الفلسطينية في غزة. واذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،
هو من أصدر تعليمات تنفيذ عملية قتل سليماني، قائد فيلق القدس التابع
للحرس الثوري الإيراني، أثناء وجوده بالعراق، بداية كانون الثاني/
يناير 2020، دلالة ازدياد الاعتماد على الدرونز لتنفيذ عمليات الاغتيال
الحكومية، فان التوسع الكبير لحرب الدرونز كان قد بدأ في عهد الرئيس
باراك أوباما الذي أمر بضربات لـ «مكافحة الإرهاب» ونفذتها وكالة
المخابرات المركزية وقيادة العمليات الخاصة المشتركة في البنتاغون،
أكثر بعشر مرات من سلفه جورج بوش.
هناك، بالتأكيد، جوانب ايجابية متعددة للتطور التكنولوجي السريع
للدرونز، إلا أن الجانب الأكبر الذي نتلقاه في العالم العربي، منذ
اختراع الدرونز، هو الاستخدام العسكري القاتل حيث تعيش شعوب لبنان
والعراق وسوريا وفلسطين واليمن وليبيا، تحت أزيز وصواريخ حرب الدرونز
البريطانية والأمريكية والكيان الصهيوني. مما يقودنا إلى التساؤل عن
مدى معرفتنا، كشعوب، بهذا السلاح المهيمن، حاليا، على جانب مهم من
حياتنا ويوشك، نتيجة تطوره وسياسة الدول المنتجة له وسهولة الادعاء
بدقتهس؟ باستثناء عدد من المقالات والمتابعات الصحافية، لم أعثر على
موقع عربي متخصص بهذه الآلية التي غيّرت هيكيلية الجيش الأمريكي وشكل
الحروب.
الا أن هناك عدة منظمات أوروبية وأمريكية مستقلة، تقوم برصد استخدام
الدرونز للتجسس والاغتيال وآثارها على حياة المدنيين. من بينها منظمة
Drone wars.
وموقعها الالكتروني غني بالمعلومات والوثائق وتحيين المتابعات لكل ما
له علاقة بالاستخدام العسكري للدرونز في جميع انحاء العالم، وقد أصدرت
المنظمة بمناسبة احتفالية تأسيسها العاشر، كتيبات وتقارير التقارير
ورقية متوفرة لمن يرغب. وفي تلخيصه لعمل المنظمة، يقول مدير المنظمة
كريس دول «أحد الجوانب الرئيسية لعملنا هو تحدي السرية التي تحيط
باستخدام الدرونز»، محذرا من عدم وجود قوانين محلية أو دولية تمنع
استخدام الدرونز في عمليات القتل مما سيؤدي الى توفيرها لأي شخص كان
يود استهداف مسؤول او قائد متهما اياه بانه إرهابي، خاصة «و أن أي شخص
منا معّرض للاتهام بالإرهاب».
المنظمة الاخرى هي «ريبريف» التي تصف برنامج الدرونز القاتلة لوكالة
المخابرات الأمريكية المركزية بأنه «عقوبة إعدام بدون محاكمة» معلنة
معارضتها للاستخدام غير المشروع للدرونز المسلحة خارج ساحة المعركة في
أي مكان في العالم. قائلة «لقد قتل هذا البرنامج أكثر من 4000 شخص، حتى
الآن، معظمهم لا يزالون بلا أسماء». بالنسبة الينا، هناك حاجة ملحة
للتوعية بنوعية الحرب التي تخاض باسمنا وبتكنولوجيا واستخدامات نتلقى
الجانب القاتل منها، ونظرا لغياب أي جهد حكومي في هذا المجال، قد يكون
العمل سوية مع المنظمات والنشطاء الفاعلين هو الحل الأفضل، حاليا. ولأن
مسيرة ألف ميل تبدأ بخطوة واحدة قد تكون مبادرة ترجمة عمل احد المواقع
حلا يجنبنا جهد وتكلفة اعادة اختراع الجاجيك « اللبن بالثوم».
كاتبة من العراق
مقالات سابقة للكاتبة
فرنسا: الضلع الثالث
في اقتسام كيكة العراق؟
هيفاء زنكنة
مصطلح جديد نزل الى الأسواق الإعلامية ـ السياسية في الاسبوع الماضي
وبالتحديد يوم الثاني من ايلول/ سبتمبر. المصطلح هو «مبادرة السيادة»
أو «مسيرة السيادة» وقد أطلقه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اثناء
زيارة قصيرة الى بغداد احيطت بالكتمان. مما تذكرنا بزيارات المسؤولين
الأمريكيين الذين يكتفون، عادة، بلقاء رئيس الوزراء العراقي اما في
المنطقة الخضراء المحصنة او احد المعسكرات الامريكية الأكثر حصانة، حيث
يتناول رئيس الوزراء وجبة طعام مع قوات الاحتلال ليبين، كما فعل نوري
المالكي، مقدار اعتزازه بتضحياتهم بحياتهم على أيدي «الإرهابيين
العراقيين».
بعد ساعات من زيارته بيروت وقيامه بواحد من أكثر الأفعال ذكاء اعلاميا،
أي منحه أرفع وسام فرنسي لفيروز التي لايختلف أحد حول قيمتها الوطنية
وما تمثله للبنان والبلاد العربية، وبعد احتضانه المطربة ماجدة الرومي
وطمأنتها بأن لبنان سيكون بخير، (لماذا يحتضن الرؤساء والساسة الاطفال
والنساء ويذرفون الدموع اثناء احتضانهم أمام كاميرات أجهزة الإعلام؟)
وقبل ان تجف عبراته التي بللت شعر المطربة، سارع الرئيس الفرنسي بارسال
تغريدة له عن البلد الثاني الذي يريد أن يشمله برعايته وان يضمه، مع
بيروت، الى حضنه الكبير: «أؤكد لكم أنني سأكون غداً صباحاً في العراق
لكي أطلق، بالتعاون مع الأمم المتحدة، مبادرة لدعم مسيرة السيادة في
هذا البلد». أثارت الزيارة، الدهشة، خاصة بين العراقيين. فالعراق،
خلافا للبنان، ليس مستعمرة سابقة تحاول فرنسا استعادة مكانتها فيها
بنعومة فنية او عبر ترتيب حملة مساعدات «إنسانية». صحيح أن فرنسا لم
تشارك في غزو العراق واحتلاله بأمرة أمريكا كما فعلت بريطانيا، مثلا،
الا أنها شاركت في التحالف الذي قادته امريكا تحت راية محاربة تنظيم
الدولة الإسلامية «داعش» عام 2014، وبقيت قواتها في العراق حتى فترة
قصيرة. ما أثار الدهشة، أيضا، لجوء ماكرون الى اسلوب «التغريدة» لاعلان
الزيارة، فهذا اسلوب متوقع من الرئيس الامريكي دونالد ترامب الذي باتت
تغريداته، بكل مفارقاتها، بديلا للبيانات الصحافية، الا انه ليس اسلوبا
شائعا بين بقية الرؤساء، في انحاء العالم. فهل أراد ماكرون بتغريدته أن
يثبت لنفسه والعالم أن فرنسا لاتقل مواكبة لحداثة «التغريد» من الرئيس
الأمريكي، أو انه لايقل عنه اهتماما بالشرق الأوسط، خاصة، بعد ان جعل
ترامب من اعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني وتوقيع اتفاقية تطبيع
العلاقات مع الإمارات، انجازات لامثيل لها يستند اليها في حملته
الانتخابية؟ أو لعل ما ابتغاه ماكرون هو تفنيد النظرة الأمريكية التي
عبر عنها وزير الدفاع الامريكي السابق دونالد رامسفيلد، قبل غزو العراق
بشهرين، متهما فرنسا والمانيا، بأنهما «أوروبا العجوز» غير القادرة على
مجاراة امريكا في «انقاذها» الشعب العراقي من نظام جائر وبناء
الديمقراطية، فشٌمر عن ذراعيه، هو الآخر، هاتفا « اريد ان اساند الشعب
العراقي»!
ليس من قبيل الصدف ألا يتطرق ماكرون، في حديثه عن « مساندة الشعب العراقي» إلى الشعب العراقي، المحتج، المتظاهر، المعرض للاغتيالات والخطف، النائم في ساحات مدنه منذ تشرين / اكتوبر 2019، مطالبا باستعادة وطنه وسيادة وطنه
ضمن هذه الخطوط العامة، بالامكان تلمس بعض الملامح الدالة على اهداف
الزيارة، مع بقاء السبب الرئيسي حتى المعلن منه غامضا وخاضعا
للتفسيرات. وأعني بذلك اعلان « مبادرة السيادة» كسبب رئيسي للزيارة
وابقائه كما هو مصطلحا كرره ماكرون، بتنويعات ملونة تليق باللغة
الفرنسية، في خطابه ومقابلاته الصحافية ولقاءاته الرسمية مع المسؤولين
ببغداد، حاملا اياه بحميمية كما راقص الباليه حين يحمل البطلة، لأكثر
من ساعة، وهو واقف على رؤوس اصابعه.
«امامنا تحديات عديدة، وأنني أريد أن اساند الشعب العراقي. لكم ان
تعتمدوا على التزامي معكم، وسنعمل مع شركائنا على تحشيد المجتمع
الدولي». انهمرت وعود المساندة بسخاء صحبة التحذير. في اطلاقه صيحات
التحذير، استنسخ ماكرون تحذيرات الخطاب الأمريكي والإيراني، حول خطرين
هما اولا: تداعيات «التدخلات الخارجية» في الشأن العراقي. لينفي عن
فرنسا، كونها قوة خارجية تتدخل بالشأن الداخلي. بل وليقدمها كقوة
ضرورية لحماية السيادة من « قوى خارجية» ملمحا على الاغلب الى تركيا،
التي تخوض معها الصراع في ليبيا. الخطر الثاني الذي حذر منه ماكرون
وذكره نقلا بالحرف الواحد من الخطاب الامريكي هو ان «الحرب على داعش لم
تنتهِ بعد». مما يعني، بالضرورة، ان العراق بحاجة الى « المساندة»
الفرنسية و« التحشيد الدولي».
عند جلاء الغبار الإعلامي وتنظيف التصريحات الفرنسية من طابعها الودي
حول « دعم ومساندة الشعب العراقي» سنجد ان ما يود ماكرون انجازه هو ليس
« مسيرة سيادة» مبهمة، بقدر ما هو تحقيق هدف استعماري قديم مُغلف
بتغريدة منمقة: ان تحصل فرنسا على قطعة من كعكة دسمة تتهافت على
التهامها دول اخرى، بينما لا تحصل هي على اي «مكافأة» على الرغم من
انها «قدمت الدعم للعراق في حربه ضد داعش» كما قال رئيس الوزراء مصطفى
الكاظمي شاكرا ماكرون. فلم لا تنال نصيبا من عقود السلاح والنفط
والعقود التجارية كما هي أمريكا وإيران؟ واذا كانت ارض البلد مباحة من
قبل الدولتين، بينما تنتهك تركيا حدوده، قصفا وتوغلا، فلم لا تكون
فرنسا الضلع الثالث في قوى الاحتلال، العسكري والناعم، في بلد يملك
رابع أعلى مخزون للنفط بالعالم، ويحتل، في الوقت نفسه، بساسته السابقين
والحاليين، مركزا مرموقا في قائمة اكثر الدول فسادا في العالم؟ أليس في
هذا ما يكفي من الغواية لأية جهة او دولة، تود الانتفاع؟ حيث تتوفر كل
الشروط الملائمة لتوسيع رقعة الاستغلال، فالنظام الفاسد بحاجة الى
الحماية الخارجية، أيا كانت، والقوى الاستعمارية الجديدة، ترى في ابقاء
البلد ضعيفا، منهكا، تنخره النزاعات والحروب، وتسليط سيف تهمة
«الإرهاب» الجاهزة على كل مقاوم. لذلك ليس من قبيل الصدف الا يتطرق
ماكرون، في حديثه عن «مساندة الشعب العراقي» الى الشعب العراقي،
المحتج، المتظاهر، المعرض للاغتيالات والخطف، النائم في ساحات مدنه منذ
تشرين / اكتوبر 2019، مطالبا باستعادة وطنه وسيادة وطنه، التي يعرف
معناها جيدا، وسيحققها ان آجلا أم عاجلا .
كاتبة من العراق
مواكب العزاء في العراق
عن الشهداء والميليشيات والتمويل
هيفاء زنكنة
أضيفت الى طقوس أيام عاشوراء، هذا العام، مواكب جديدة يقوم الشباب
المشاركون فيها بالسير صفوفا طويلة، وهم يحملون صور شهداء انتفاضة
تشرين التي انبثقت في تشرين/ اكتوبر 2019 واستشهد فيها 560 متظاهرا.
ردد المشاركون في مواكب العزاء شعارات الانتفاضة بذات الاسلوب، كما
تعودوا، من مرددي أو قراء العزاء، وكأنهم يُعزون انفسهم والعالم
باستشهاد المتظاهرين المطالبين بحقوقهم، كما استشهد الحسين. ويحتمون،
في الوقت نفسه، بجموع مواكب العزاء آملين ان تردع قدسية الايام العشرة
ميليشيات القتل وقناصة الموت عن مواصلة حملة الاغتيالات التي طالت
شبابا يعرفونهم.
في ذات الوقت الذي واظب فيه شباب مواكب العزاء على حمل صور شهداء
الانتفاضة تذكيرا بتضحيتهم والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن اغتيالهم،
أصدرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومفوضية الأمم
المتحدة السامية لحقوق الإنسان، تقريرا بعنوان « العراق: مختفون ولكنهم
لن يغيبوا عن الذاكرة» بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري،
دعت فيه الحكومة العراقية إلى إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة لتحديد مصير
نحو ألف مدني من الرجال والفتيان، أغلبهم من العرب السنة، الذين اختفوا
قسراً اثناء العمليات العسكرية التي قامت بها قوات الأمن بمشاركة
ميليشيا «الحشد الشعبي» في محافظة الأنبار، غرب العراق، عامي 2015
و2016 « وما ارتكبته من انتهاكات بما في ذلك الإعدام خارج نطاق القضاء
والتعذيب” في اطار محاربة داعش بدعم من قوات التحالف بقيادة امريكا.
لقد بات من بديهيات الأمور، في يوميات الحياة العراقية، ان آلة
الاغتيالات والعنف ستستمر بالتهام حياة المحتجين وكل صوت معارض أو
مطالب بالتغيير الحقيقي وتنظيف البلد من منظومة الفساد، بغض النظر عن
ادعاءات الحكومة والساسة بإجراء التحقيقات وتصريحات وفود الحكومات
الغربية «المدافعة عن حقوق الانسان» بالعراق. وستبقى أمهات وزوجات
المفقودين، يتنقلن بين الدوائر الحكومية، متوسلات الاخبار، بحثا عن
احبائهن، وهن يحملن صورهم المبللة بالدموع كما صور شهداء تشرين، كما
صور الشهيد الحسين واهله.
ما يعزز بديهية استمرار الاغتيالات ويزيد من حالة اللا استقرار وقلة
الأمان والخوف مما تحمله الايام المقبلة، بالإضافة الى شحن آليات
الانتقام كمنفذ وحيد للعدالة، هو تغوّل ميليشيات القتل وتمكنها من
التحكم بالحكومة ومؤسسات الدولة، عبر أذرعها الحزبية المنخرطة بدورها
في البرلمان، وهنا تكمن المفارقة. فالأحزاب العراقية التي غزت الساحة
السياسية منذ غزو واحتلال البلد عام 2003، هي أداة بيد الميليشيات
وواجهة لها وليس العكس كما هو معروف عادة. بل أن أغلب العناوين
العشائرية ومنظمات المجتمع المدني قد أصبحت بنفس حال الأحزاب، إذ أفرغت
من محتواها أو أصطنعت كجزء من شبكات الفساد، ولم تعد ذات جدوى في لعب
أي دور اجتماعي مستقل. وتتصدر هذه الواجهة ميليشيات « الحشد الشعبي»
التي تم ضمها الى القوات المسلحة في نوفمبر/تشرين الثاني 2016ّ، ووضعت
بأمرة رئيس الوزراء، بصفته قائدا أعلى للقوات المسلحة، كسلطة وحيدة
مسؤولة عن نشر هذه الميليشيات وإدارة عملياتها. الا ان هذه التغييرات
بقيت حبرا على ورق وواصلت ميليشيات «الحشد الشعبي» نشاطاتها خارج نطاق
القانون والسيطرة للدولة. وإذا ما أعلنت الحكومة عن اجراء تحقيقات فانه
لم يحدث وقدم اي عضو في الميليشيات لينال جزاءه القانوني.
لقد بات من بديهيات الأمور، في يوميات الحياة العراقية، ان آلة الاغتيالات والعنف ستستمر بالتهام حياة المحتجين وكل صوت معارض أو مطالب بالتغيير الحقيقي وتنظيف البلد من منظومة الفساد
ضمن هذه السيرورة تعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم السبت
الماضي، ردا على تقرير يونامي حول اختفاء الالف شخص بـ« العمل بجدية
لمتابعة ملف المفقودين قسريا في البلاد، والكشف عن مصيرهم». وهو يعرف
جيدا أن تعهده لا يزيد عن كونه محض هراء كما الوعود والتعهدات الكثيرة
التي اطلقها هو أو من سبقه من رؤساء الوزراء. فما يُسَير الأمور، هو
صراع الميليشيات فيما بينها، احيانا، كل حسب ولائها المحلي او الخارجي
وضد غيرها من قوى مسلحة احيانا اخرى. وإذا كانت كل الاطراف مسلحة في «
العراق الجديد» فان الميليشيات تتصدر القائمة بأسلحتها وسبل تمويلها
وإرهابها المماثل لداعش. وابسط مثال على حجم تمويلها هو سيطرتها على 20
رصيفا في ميناء الفاو، المنفذ المائي الوحيد للعراق، من بين 21 رصيفا
وينطبق الأمر ذاته على كل المنافذ الحدودية. فالميليشيات التي يزيد
عددها على الستين، أكثر هيمنة على الشارع بحكم تدريبها وتمويلها
واسلحتها. فهي تملك أنواعا من الأسلحة تراوح ما بين الخفيفة والثقيلة
والذخائر المصنوعة في ما لا يقل عن 16 بلدا، بما فيها صواريخ وأنظمة
مدفعية ومركبات مصفحة صينية وأوروبية وعراقية وإيرانية وروسية
وأمريكية. ففي ديسمبر/كانون الأول 2014، قرر الكونغرس الأمريكي تخصيص
6.1 مليار دولار أمريكي لصندوق التدريب والتجهيز الخاص بالعراق لدعم
الحملة العسكرية ضد تنظيم «الدولة الإسلامية». وقد أظهرت الأدلة
المصورة لدى منظمة العفو الدولية أن طيفا من المعدات المصنوعة في
الولايات المتحدة، بما في ذلك عربات «همفي» العسكرية وحاملات جنود
مصفحة من طراز «M113
«وأسلحة صغيرة زود بها الجيش العراقي، باتت تحت تصرف قوات «الحشد
الشعبي» بما في ذلك بين يدي بعض الميليشيات المتهمة بارتكاب انتهاكات
خطيرة لحقوق الإنسان. كما تحصل الميليشيات على قسط من أسلحتها وذخائرها
مباشرة من إيران، إما على شكل هدايا أو في صيغة مبيعات، بالإضافة الى
قيام اجهزة حكومية عراقية بتزويدها بأسلحة تحصل عليها من دول اخرى بحجة
محاربة داعش. ولا تجد الدول الكبرى حرجا في بيع الاسلحة لأي كان اما
مباشرة او عبر الشركات الخاصة، بدون التدقيق او التغاضي عن مصيرها أو
سبل استخدامها. كل التفاصيل موثقة في تقرير منظمة العفو الدولية»
العراق: غض الطرف عن تسليح ميليشيات الحشد الشعبي». ففي حال بريطانيا،
مثلا، تتضمن قائمة وزارة الخارجية والكومنولث البريطانية ثلاثين دولة
مدرجة في قائمة الدول التي تعتبرها لندن مدعاة للقلق الشديد بشأن سجلها
في حقوق الإنسان والديمقراطية. ومع ذلك، فقد صادقت الحكومة – خلال
العامين الماضيين وحدهما ـ على بيع أسلحة إلى 22 دولة من تلك الدول.
ان وجود الميليشيات المتناسلة كالأرانب على ارض العراق جراء الفشل
الحكومي، وغياب القانون، وهيمنة القوى الخارجية المتغلغلة ضمن الاحزاب
والبرلمان، بشكل كبير، ولأسباب مالية مربحة او ولائية او عن طريق اشاعة
التخويف من « الآخر» سيبقى سيفا مسلطا على رؤوس المواطنين للترهيب
والقمع والانتقام و توفير «الحماية» ما لم تتوحد القوى الوطنية
المبعثرة لوضع برنامج انقاذ وبناء موحد يخلص البلد من دستور « العملية
السياسية» ونظام المحاصصة الذي رعاه المحتل تفتيتا للمجتمع واغتيالا
لأبنائه وابقائه ضعيفا يستهلكه الاقتتال.
كاتبة من العراق
«مجهولون»
يغتالون العراق
هيفاء زنكنة
هل هناك بيت لم يزره الموت مبُكرا في العراق؟ هل من عائلة لم تفقد أحد
افرادها تغييبا وقتلا منذ «تحرير» البلد، لتضيف الى قائمة ضحايا القمع
والحرب والحصار اسماء جديدة لشباب لم يعرفوا غير خطيئة وحيدة عبر عنها
شعارهم «نريد وطنا» فرفعوا رؤوسهم محتجين على الأوضاع المهينة، حالمين
بالحرية و الحياة الكريمة، فبات حرمانهم من الحياة حكما لا يقبل
الاستئناف والنقض.
في كل يوم، بدلا من الاحتفال بالحياة، بجيل يواصل حمل شعلة البناء
والتطور والحضارة التي نفتخر بها، تطالعنا وجوه شباب شوهتها الاطلاقات
النارية وأخرستها كواتم الصوت.
نرى صورا وفيديوهات لقتلة يرتكبون جرائمهم ويهربون. القتلة دائما
«مجهولون» هكذا تخبرنا التصريحات الرسمية.
ما هو غير مجهول: جثث ومقاعد سيارات مغطاة بالدماء. تغُّيب الملامح
الفتية فتبقى عيون الضحايا مفتوحة على سعتها، متساءلة بأي ذنب قتلت!
في الاسابيع الأخيرة، رأينا مقاعد سيارة أخرى، تغطيها الدماء. على أحد
المقاعد حقيبة يد نسائية لم يعد بالإمكان تمييز لونها.
غاب عن مدينة البصرة، وجه ترتسم على ملامحه النضرة طيبة سكانها وكرمهم
وعزة أنفسهم. بعد عامين من مشاركتها في الاحتجاجات وقيادتها لمسيرات
نسائية، لم تعد الكاميرات تتوقف عند رهام يعقوب، الناشطة وخبيرة الصحة
والتغذية، لنسمعها وهي تلخص بعاطفة متأججة وصوت غاضب، مأساة مدينتها،
المعاقبة بوجود الميليشيات في ظل حكومات يتقاسمها الاحتلال الأمريكي ـ
الإيراني. مدينتها البصرة ذات الثروة النفطية التي لولا الفساد لأصبحت
فردوسا أرضيا غير أن أهلها يقفون منذ «تحريرهم» على هامش الحياة
انتظارا لقطرات ماء نظيفة تحت حرارة منحت العراق لقب البلد الأشد قيظا
في العالم، والأكثر اصابة بالامراض نتيجة تلوث المياه وقلة التزود
بالكهرباء وتجمد الخدمات الصحية في الحضيض.
منذ يوم الاربعاء، 19 آب/ أغسطس، لم نعد نسمع صوت رهام وهي تتقدم
الشباب والشابات مخاطرة بحياتها، معهم، قائلة مرة ردا على أحد
التصريحات الرسمية الكاذبة حول تحسن الأوضاع في البصرة «كنت أتمنى أن
تشرب وزيرة الصحة من ماء البصرة لتعرف معاناتنا».
منذ يوم الاربعاء، لم يعد بامكان رهام أن تكًّذب التصريح الرسمي حول
اغتيالها القائل بأنه «نُفذ برصاص بندقية هجومية كان يلوح بها مسلحان
مجهولان يستقلان دراجة نارية وسط المدينة حيث لاذا بالفرار بعد إطلاق
النار على السيارة».
من واجبات الحكومة، صيانة حياة مواطنيها، أيا كانوا وليس برمجة زيارات لتعزية أهالي الضحايا أو احتضان أطفالهم وتقبيلهم في لقطات تلفزيونية دعائية، كما يفعل الكاظمي
إن اغتيال رهام حلقة في سلسلة اغتيالات استهدفت عديد الناشطين. فقد
سبقها بايام قليلة اغتيال تحسين أسامة الخفاجي الذي كانت ابنته قد
حذرته من الخروج مع المتظاهرين فأجابها قائلا بأن هذه هي فرصة التغيير.
وكان حسين العابدي وزوجته، والمراسل أحمد عبد الصمد، قد اغتيلوا قبلهم
وكذلك الخبير الأمني هشام الهاشمي.
وفي يوم 17 آب نجا اربعة هم عباس صبحي ولوديان ريمون وفهد الزبيدي
ورقية الموسوى من محاولة اغتيال بعد اصابتهم بجروح ونقلهم الى مستشفى
البصرة. كما نجا ثلاثة ناشطين من مدينة الحلة وهم محمد جابر وعدنان
الكهار ومحمد المنصوري، ومحسن الزيدي بينما استشهد ياسر كاظم ببغداد.
كل الاغتيالات ومحاولات الاغتيال وصفتها المصادر الرسمية بأنها تمت «
بأيدي مسلحين مجهولين».
حين تم تعيين رئيس المخابرات مصطفى الكاظمي رئيسا للوزراء، في 7 أيار-
مايو، كان أحد مطالب منتفضي تشرين/ أكتوبر 2019، الرئيسية هو محاسبة
قتلة المتظاهرين واطلاق سراح المختطفين ووضع حد لآلام ومعاناة أهالي
المختفين.
كان مطلبا ملحا لا لكثرة أعداد الضحايا الذين بلغ عددهم 560، اعترف بهم
في 30 تموز/ يوليو، رسميا، كشهداء، بالإضافة الى 30 ألف جريح ومعوق
بشكل دائم جراء الاستهداف بواسطة القناصة واستخدام الرصاص الحي
وبندقيات الصيد والغازات المسيلة للدموع. ولا لأنهم الضحايا الوحيدون
من قتلى ومختطفين منذ الاحتلال عام 2003 وحتى الانتفاضة، حيث تجاوز
العدد المليون، بل نبعت أهمية المطلب من كونه حقا عاما، وحَّدَ ابناء
الشعب بكل اديانه ومذاهبه، ووضع رئيس الوزراء أمام اختبار يبين صحة
وعوده حول تطبيق القانون على الجميع بلا استثناء، ولا طائفية الحكومة،
وسياستها في تمثيل ابناء الشعب كلهم، بدون تصنيف « الآخر» إرهابيا.
إلا أن أيا من المسؤولين عن جرائم الاغتيالات والخطف والتغييب لم يتم
القاء القبض عليه، واكتفى الكاظمي، كما فعل من سبقه من رؤساء الوزراء،
بتشكيل لجان لم يتم الاعلان عن نتائجها. مما يعني إبقاء الجهات
المسؤولة عن الاغتيالات سواء كانت أجهزة الدولة الأمنية والعسكرية، أو
الميليشيات، ذات الدعم والولاء الإيراني والتي يتجاوز عددها الخمسين،
أو فرق الموت والعمليات الخاصة التابعة لأمريكا، أو أي جهة مخططة لهذه
الاغتيالات، حرة طليقة، بالإضافة الى بقاء المنفذين « المجهولين» على
أهبة الاستعداد لتنفيذ أية عملية اغتيال أخرى حسب الطلب.
كما بقيت اجراءات الكاظمي لمحاسبة القتلة مقتصرة على تصريحاته المغلفة
بسين المستقبل مثل « سنقوم بكل ما يلزم لتضطلع القوى الأمنية
بواجباتها» و«سنقوم بكل ما يلزم لتقوم أجهزة وزارة الداخلية والامن
بمهمة حماية أمن المجتمع» كما فعل عند عودته، منذ يومين، من واشنطن.
عمليا، ليس هناك ما يشير الى وضع حد للعنف والتصفية الجسدية ضد
المحتجين والناشطين وكل من يجرؤ على السباحة عكس تيار الفساد مطالبا
بوطن. ومع تجذر الفساد المؤسساتي والاداري، وتوفر السلاح بانواعه خارج
سيطرة الدولة، يشكل الناشطون الذين تمكنوا من افراغ الاستغلال السياسي
للدين والمذهب من قدسيتهما المصّنعة خطرا حقيقيا لا على الميليشيات
والحشد فحسب بل وعلى الأحزاب التي ازدهرت تحت توليفة الفساد الطائفي في
« العراق الجديد». من واجبات الحكومة، صيانة حياة مواطنيها، أيا كانوا
وليس برمجة زيارات لتعزية أهالي الضحايا أو احتضان أطفالهم وتقبيلهم في
لقطات تلفزيونية دعائية، كما يفعل الكاظمي.
إن اعلان هوية مخططي الاغتيالات ومنفذيها وتقديمهم للقضاء مسؤولية رئيس
الوزراء وقائد القوات المسلحة خاصة وأنه كان، حتى أشهر قليلة مضت،
رئيسا للمخابرات. مما يجعل مسؤوليته مضاعفة لأنه أدرى من غيره بكل من
يمس أمن واستقرار البلد ويستهدف معارضيهم او من يعتبرهم اعدائه عن طريق
التصفية الجسدية.
هذا، طبعا، اذا لم يساهم هو أو يسكت، لأسباب يعرفها، على تغطية دور
المجرمين والمخططين والممولين، من خلال الإجراءات الشكلية الهادفة إلى
دفن القضية وتسجيلها، كالعادة، ضد « مجهول».
كاتبة من العراق
من الفلوجة وحلب الى
بيروت… نحن أطفال هيروشيما
هيفاء زنكنة
كنا نتهيأ لاستقبال يوم الخميس، يوم 6 آب/ أغسطس، ذكرى مرور 75 عاما
على القاء القنبلة الذرية على مدينة هيروشيما اليابانية. إلا أن يوم
الأربعاء فاجأنا بحضور هيروشيما بيننا، مبكرة، في بيروت، لتمتزج رمزية
الدمار بين الماضي والحاضر، بين مدن بعيدة وقريبة في آن واحد. نار
حارقة تتسلل الى مدن عربية، بأشكال متغيرة، تظهر حينا وتختفي حينا آخر
كالغيوم، كصاعقة تحفر عميقا، تاركة وراءها أجساد أهل المدن شظايا
يلتقطها الاحياء. ماذا عن الغد؟ يتساءل الباقون وهم في طريق عودتهم الى
الحياة، كما كانوا يعرفونها، ثم يعاودون السؤال عما سيجلبه ما بعد
الغد. فالغد ضبابي يلتحف بسماء من غبار.
بيروت الجميلة باتت مدينة منكوبة. مدينة يدّعي ملكيتها الجميع ولا
يرعاها أحد. كيف نميز بين المدن المنكوبة؟ في بلدان لم تعد بلدانا؟
هياكل مبان ومساحات مثل صورة متآكلة الحواف، انمحت ألوانها فلم يبق غير
لون الرماد. مدن متناثرة على وجه أرض كنا نراها واحدة، بجبالها وسهولها
وانهارها. في العراق واليمن وسوريا وليبيا. لقطات الخراب واحدة والصور
واحدة، وأهل المدن في غربتهم المكانية، ما عادوا يميزون الأماكن التي
ولدوا فيها أو شيّدوها بأنفسهم. مبان قد يبقى جزء منها منتصبا، بلا
جدران بلا أبواب بلا نوافذ، مثل جوف فارغ، فقط ليتحدى قوة الانفجار من
مادة كيمياوية أو قنبلة ذرية أو صاروخ أو قصف جوي بمئات الاطنان. كم من
هيروشيما سنعيش؟
كل مدينة منها تستحضر برماديتها، اليوم، بعض هيروشيما. كانت (لهذا
الفعل الناقص في ذاكرتنا جذور) متألقة بلون الشمس والسماء والأرض
الخضراء ذات يوم أو لعله الأمس. في بيروت والعراق، يوم خرج الناس الى
الشوارع صارخين. « نريد وطن» في الأول من تشرين الاول / أكتوبر في
العراق، و«كلن يعني كلن» في 17 تشرين في بيروت. ورفع المتظاهرون علم
البلدين سوية.
في سوريا تحضر هيروشيما في 13 مدينة. أكل القصف في حلب 36 ألف مبنى،
وفي مدينة حمص 13778 بناء، ثم الرقة 12781، ومن ثم حماة 6405، ودير
الزور 6405، إضافة إلى 5489 في مخيم اليرموك (معهد الأمم المتحدة
للتدريب والبحث في 18 مارس 2019). ومع كل مبنى تغيب حياة عائلة، تتشرد
في بلدان تضيف الى مأساتها محنة الاستغلال السياسي والاقتصادي.
استحضر الانفجار القاتل ببيروت هيروشيما، بفارق 75 عاما. واستحضر رش
مدينة الفلوجة العراقية باليورانيوم المنضب والفسفور الأبيض هيروشيما
بفارق 59 عاما. غاب التمييز بين البشر، ألغيت الحدود. تماهت بيروت في
كارثتها مع هيروشيما وصارت الفلوجة هيروشيما « العراق الجديد».
في كل يوم يغادرنا فيه جرحى بيروت، يولد في الفلوجة أطفال برأسين ويموت
آباء وامهات بالسرطان. أي أطفال سيولدون في بيروت نتيجة التلوث ومخلفات
التفجير؟ المخلفات الأمريكية لا تزال تغتال الأطفال ببطء في الفلوجة.
القاتل معروف إلا أن العدالة مفقوءة العينين، تائهة في دروب المدن
الخربة. يقول المفكر الامريكي نعوم تشومسكي «ما يتعلق بالفلوجة، لم تقم
الولايات المتحدة بنقل النساء والأطفال إلى خارج المنطقة، لقد قصفتهم.
أيها الصغار، لا تصمتوا، تكلموا، قاوموا الكبار في العالم كله، أرباب الحرب، اصرخوا فيهم، بأصوات ناصعة، وعيون تلمع، افتحوا أذرعكم، حرروها لتعانقوا الجميع، امنحوا الجميع عناقًا، يعيد دموع الطيبة للقلوب
كان هناك ما يقرب من شهرٍ كاملٍ من القصف، كان قصفاً شاملاً للمدينة،
إذا كان هناك من تمكَّن من الخروج بطريقة ما، فهم ليسوا أكثر من مائتي
ألف شخص فرّوا، أو خرجوا بطريقة ما… فالرجال تم الاحتفاظ بهم في الداخل
ونحن لا نعرف ماذا حصل بعد ذلك، نحن أنفسنا لم نقدّم تقديرات عن عدد
الضحايا الذين كنّا مسؤولين عن قتلهم»..
الانفجار القاتل في بيروت اختزل الزمن بين مدن نائية ما ابعدها.
هيروشيما ـ الفلوجة – بيروت. رمزية الرعب في كيفية الموت: أسرع كما في
القصف وهدم البيوت على رؤوس ساكنيها ودفنهم تحت الأنقاض أو بطيء يمتد
على مدى عقود كما في المواد الكيميائية واليورانيوم المنضب؟ وينشج
القلب… « أن نسبة حالات السرطان والتشوهات الخلقية في مدينة الفلوجة
التي تعرضت لقصف أمريكي عام 2004 تفوق النسبة في مدينتي هيروشيما
وناغازاكي اليابانيتين اللتين ألقيت عليهما قنابل ذرية في الحرب
العالمية الثانية».
«في أقل من لحظة، التهم ثقب أسود من الدمار والموت كل شيء. لا نزال من
هوة الصمت هذه نسمع صراخ أولئك الذين رحلوا»، قال البابا قرب «نصب
السلام» في هيروشيما. هل من نصب للسلام لمحو مشاهد الجحيم في بلداننا،
ودفاتر نسجل فيها أسماء من سقطوا ضحايا جرائم البشر ضد البشر، وليس
تسونامي الطبيعة، لئلا يكونوا أرقاما واحصائيات تجردهم من انسانيتهم؟
في الموصل وثّق موقع «ايروور»، البريطاني المختص، الحرب الجوية، في
العراق وسوريا، واصفا عدد ضحايا القصف الجوي الأمريكي، بالعراق «بأنه
الأعلى منذ حرب فيتنام، ومع ذلك لا تبدي الحكومات الغربية والعراقية أي
اهتمام بتوثيق اعداد الضحايا».
استخدمت أمريكا لقصف الموصل، القاذفة الجوية بي 52، التي تم تحديثها
لتُزود بالصواريخ والقنابل الموجهة بالليزر، وطائرات أف 16 وأف-أي 18،
وطائرات ريبر بدون طيار، بالإضافة الى مروحيات الأباتشي قاذفة القنابل.
وإذا كان تنظيم داعش الإرهابي قد زرع الألغام، ولا يزال الكثير منها
مدفونا تحت الركام، فان قوات التحالف رمت على المدينة « قنابل تزن
الواحدة 500 رطل، تخترق الأرض لمسافة 15 مترا أو أكثر»، حسب مدير
برنامج الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام.
ما الذي سيجلبه المستقبل لبيروت التي احتضنتنا جميعا بكل صراعاتنا
ومآزقنا وندواتنا وكتبنا وطموحات واحلام شبابنا؟ لبلداننا التي ينخرها
الاستبداد والفساد والطائفية؟ هل ستلملم زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون
جراحها ويعيد لها ألقها واعتدادها بنفسها؟ متى تحولت الدول الاستعمارية
الى منظمات إنسانية، أم انها إنسانية فعلا بالمقارنة مع حكام/ حيتان
الفساد المحليين؟ هل لملمت زيارة الرئيس الأمريكي ترامب جراح العراق
النازفة؟ كيف وهو يمنح الأوسمة لقتلة العراقيين ويبارك حكام الفساد؟ هل
وصلنا حقبة نستجدي فيها، كشعوب ذاقت الأمرين من حكامها، العودة الى حضن
« المُحرر» الذي وسمنا، على مدى قرون، بالدونية البشرية؟ هل سنكون آخر
الباقين؟ أم سنرحل كما الياباني شاعر القنبلة سانكيشي توغي، ابن
هيروشيما، مرددين مثله في نصب تذكاري: « أيها الصغار، لا تصمتوا،
تكلموا، قاوموا الكبار في العالم كله، أرباب الحرب، اصرخوا فيهم،
بأصوات ناصعة، وعيون تلمع، افتحوا أذرعكم، حرروها لتعانقوا الجميع،
امنحوا الجميع عناقًا، يعيد دموع الطيبة للقلوب، وغنوا لهم: نحن أطفال
هيروشيما».
كاتبة من العراق
عن أفلام رئيس الوزراء
العراقي وفيديو الطفل العاري
هيفاءزنكنة
وزع المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم 30
تموز/ يوليو، فيلما قصيرا تداولته أجهزة الاعلام العراقية والعربية، عن
زيارته الى سجن مطار المثنى، وسط بغداد. وُصفت الزيارة بأنها «ليلية
تفقدية مفاجئة». تأكد الكاظمي، خلالها «بنفسه من عدم وجود سجناء من
المتظاهرين، وأصحاب الرأي». وسجن المثنى واحد من سجون نظام «العراق
الجديد» ينافس في سمعته السيئة سجني «أبو غريب» و«التاجي». اذ لا يكاد
أي تقرير حقوقي عالمي أو محلي يُنشر حول انتهاكات حقوق الإنسان بالعراق
الا ويذكر فيه سجن المثنى، مرة كمركز للتحقيقات وأخرى كسجن «سري» تسيطر
عليه الميليشيات وتُخضع المعتقلين «لكافة أنواع التعذيب، تبدأ بالضرب
والخنق والصعق بالتيار الكهربائي في كافة أنحاء الجسم والحرق ونزع
الأظافر والأسنان ومحاكاة الغرق، بهدف انتزاع اعترافات بتنفيذهم عمليات
إرهابية لم يرتكبونها». ولا تخلو التقارير من توثيق حالات تهديد أو
انتهاك واعتداء جنسي ضد المعتقلين من الذكور.
يأتي توقيت الزيارة مع عودة المظاهرات الغاضبة في عديد المحافظات، في
ارجاء البلد، احتجاجا على انقطاع الكهرباء مع ارتفاع حرارة الصيف الى
ما يزيد على الخمسين درجة مئوية، وأزمة المياه الصالحة للشرب بالإضافة
الى المطالبة بالقبض على قتلة المتظاهرين في انتفاضة تشرين/ أكتوبر
2019، الذين بلغ عددهم 560، اعترف بهم في 30 تموز، رسميا، كشهداء،
بالإضافة الى 30 ألف جريح ومعوق بشكل دائم جراء الاستهداف بواسطة
القناصة واستخدام الرصاص الحي وبندقيات الصيد والغازات المسيلة للدموع.
عاد المتظاهرون الى الشوارع على الرغم من قساوة الجو، ومخاطر انتشار
وباء الكورونا، احتجاجا، أيضا، على حملة الخطف والاغتيالات المنهجية
المترصدة بالمتظاهرين وكل ذي فكر حر، وكان آخرهم المحلل السياسي هشام
الهاشمي. تلاه اغتيال خمسة متظاهرين وسقوط عشرات الجرحى، والبلد تحت
قيادة الكاظمي الذي لاتزال وعوده ترن في آذان المواطنين. حين تعهد بأن
الحكومة ستحقق في مقتل المتظاهرين. وذّكره المتظاهرون بأن وعود تشكيل
اللجان بات مزحة سمجة، وكما اكدت منظمة هيومان رايتس ووتش «يجب على
الحكومة، أن تحدد وتعلن عن الجماعات وقوات الأمن التي شاركت في عمليات
القتل هذه أو نسقتها ومحاسبة المسؤولين. وبذل الجهود لتحديد مكان
المتظاهرين الذين اختطفوا وما زالوا مفقودين، مع المساءلة الكاملة».
بالنسبة الى المفقودين، تقول اللجنة الدولية للصليب الأحمر « أن في
العراق أكبر عدد من المفقودين في العالم. البعض منهم يتعرضون للاختفاء
القسري، بما في ذلك، مؤخرا، بعض المشاركين في حركة الاحتجاج التي بدأت
في تشرين/ أكتوبر 2019».
إزاء هذا كله، ما هي الاجراءات التي اتخذها الكاظمي؟ رأينا فيلمين
وصورة. لابد وأن تكون حصيلة نصيحة أسداها له أحد مستشاريه حول أهمية
الصورة / اللقطة المستخدمة إعلاميا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي،
لتُصبح هي الواقع والحقيقة، مهما كانت «اللقطة ـ الصورة» مفبركة لتبين
بأنه يقوم فعلا بإنجازات مغايرة لمن سبقه.
يأتي هذا الفيديو بوحشيته، ليكشف الحقيقة عن زيف ادعاء حماية الشعب من قبل القوات الأمنية والشرطة، في بلد بلا قوانين، تحكمه مؤسسات تُسيّرها الميليشيات وعصابات الفساد
تناول الفيلم الأول زيارته « التفقدية المفاجئة» الى سجن المثنى. حيث
نراه واقفا يتصفح بضع ورقات في مكتب أنيق مرتب ثم ينتقل للوقوف امام
قضبان لردهة واسعة تتألق نظافة. نرى فيها عددا من المعتقلين الذين
لايقلون نظافة وترتيبا عن المكان والكاظمي نفسه باستثناء انه يرتدي
بدلة وكمامة. في رحلته للعثور على المتظاهرين المفقودين والمختطفين،
نسمعه قائلا: « منو منكم صار له أسبوع؟ شهر؟ أكو (ثمة) واحد صار له
أسبوع؟ أسبوعين؟ شهر؟ «. حين يهز المعتقلون رؤوسهم نفيا، يعيد صياغة
أسئلته « منو أجدد واحد؟ أكو واحد من المتظاهرين؟». هكذا تأكد الكاظمي
من عدم وجود متظاهرين معتقلين، وخرج فرحا بتفنيده التقارير الحقوقية
الموثقة لاعتقال آلاف المحتجين. فهل من المعقول ان الكاظمي، الذي كان
حتى 9 حزيران/ يونيو، رئيسا للمخابرات، ومن قبله صحافيا، لا يعرف أين
يُحتجز المعتقلون من المتظاهرين؟
وإذا كانت الميليشيات هي المسؤولة وهو لا يعرف، فكيف استطاع تحرير
المُختطفة الألمانية، قبل أيام، بسرعة قياسية، بينما تدور أمهات الشباب
العراقي المُختطف باحثات عن ابنائهن وبناتهن في أكثر المعتقلات والسجون
لا إنسانية، على مدى شهور وسنوات، ويواجهن الاهانات والاساءات ودفع
الرشوات بلا جدوى.
الفيلم الثاني عن القاء القبض على جندي متهم مع اثنين آخرين، لا نراهما
في الفيلم، برتبتي رائد وملازم. يعترف الجندي بانه والآخرين استهدفوا
المتظاهرين الثلاثة، قبل أيام، ببنادق صيد. ويأخذنا الجندي المرعوب الى
سيارة ليرينا وجود الرصاص فيها. المتهمون الثلاثة، كانوا ضمن القوة
الأمنية المنتشرة في خطوط مواجهة المتظاهرين والممنوع عليهم، كما صرح
وزير الداخلية، حمل السلاح. فكيف أخفى الثلاثة بنادق الصيد، وكيف
اغتالوا المتظاهرين ولم تثر العملية التي تمت امام القوات الأمنية،
اعتراضا؟ وإذا كان الثلاثة مسؤولين فعلا عن اغتيال اثنين من
المتظاهرين، من المسؤول عن قتل الخمسمائة وثمانية وخمسين الآخرين؟
أجمعت التعليقات الغاضبة والساخرة على «الفيلم» أنه « حتى أفلام الدرجة
العاشرة أحسن منه».
ولمعالجة أزمة الكهرباء القاتلة، وزع الكاظمي صورته بكامل قيافته
بالبدلة والرباط جالسا خلف مكتب في غرفة شبه مظلمة وهو محاط بالشموع
وهو يواصل الكتابة بكل همة وبلا قطرة عرق واحدة تدل على صحة الرسالة
التي أراد ايصالها الى أبناء الشعب وهي أنه مثلهم، يعاني من انقطاع
الكهرباء، الا انه ليس مثلهم لأنه يواصل العمل غير مبال بالحر!
هذه الحملة الإعلامية المبرمجة سقطت إزاء فيديو لم يتم تصويره من قبل
محترفين ولم يشارك فيه الكاظمي بشكل شخصي. الفيديو الذي اشير اليه لم
أستطع اكمال رؤيته. فمن منا يريد مشاهدة ضعف طفل عار أمام سادية جلادين
يلتذون بما يقومون به الى حد تصويره ونشره، ليكون نسخة مما نفذه جلادو
الاحتلال الأمريكي في أبو غريب؟ فيديو بلقطات مقززة يبين الاعتداء
الوحشي على طفل يتوسل الرحمة من مجموعة من منتسبي قيادة قوات حفظ
القانون، يتباهون بما هو اوطأ ما يمكن ان تصل اليه خسة « قوات الامن»،
التي طالما وُثقت جرائمها وممارساتها في عديد السجون والمعتقلات، وقامت
الحكومات بالتستر عليها.
خلافا لفيديوهات الكاظمي ذات السيناريو المُعد مسبقا، لتغطية الحقائق،
يأتي هذا الفيديو بوحشيته وبذاءته، ليكشف الحقيقة عن زيف ادعاء حماية
الشعب من قبل القوات الأمنية والشرطة، في بلد بلا قوانين، تحكمه مؤسسات
تُسيّرها الميليشيات وعصابات الفساد. ولن يأتي الحل من قبل المنظومة
الموجودة، فالعراق، يعيش « أزمة وطن، لا يحلها من يقف ضد الوطن»، كما
يقول الكاتب أحمد الناصري.
كاتبة من العراق
سيبقى العراق
دولة مارقة!
هيفاء زنكنة
بذلت الحكومات البريطانية التي تلت حكومة رئيس الوزراء توني بلير، التي
شنت مع أمريكا الحرب ضد العراق، عام 2003، ان تنسحب تدريجيا من كل ما
له علاقة بالبلد الذي ساهمت بتخريبه.
تُركز سياستها على طمس كل ما يجذب الانتباه إعلاميا وسياسيا الى ما
يجري فيه، حاليا، كنتيجة مباشرة وغير مباشرة لاحتلاله، حتى يكاد يكون
العراق سرابا انحسر، خاصة بعد انسحاب قوات الاحتلال البريطانية، ونجاح
الحكومة في تسقيط القضايا التي رفعت ضد الجيش البريطاني وما ارتكبه من
جرائم. وكللت نجاحها بتشريع قانون يحمي القوات العسكرية من المسؤولية
تجاه اية جريمة او « انتهاك» يرتكب في العراق وغيره.
هذه المعطيات، مكّنت الحكومة البريطانية من حماية صورتها من أي حدث قد
يلوثها في مجالات تعتبرها، ظاهريا على الأقل، تمس حقوق الإنسان ووضع
القوات العسكرية العاملة خارج بريطانيا في مهام تُعّلب، غالبا،
باعتبارها « مساعدات إنسانية « أو « مُنح تنموية». هكذا تنشط آلة
الإعلام والدعاية الرسمية على تغييب العراق، ومسح شن الحرب العدوانية
وانعكاساتها من ذاكرة الشعب البريطاني، الذي تظاهر بملايينه ضدها،
باستثناء استحضاره، عند الحاجة، كساحة « حرب ضد داعش».
من هذا المنطلق وللإجابة على عدد من الأسئلة المكتوبة لنواب بريطانيين،
وضح وزير الدفاع بن واليس، في مجلس العموم، بتاريخ 22 تموز / يوليو،
موقف الحكومة استهله بالقول بانه سيتحدث عن « مكافحة داعش»، مهمشا
بذلك، منذ البداية، بقية الأسئلة التي قد تحرج الحكومة، خاصة، وما يشير
الى مسؤولية الحكومة فيما يحدث اليوم، في العراق، كنتيجة للغزو
والاحتلال.
أكد الوزير، عدة مرات، على ان وجود القوات المسلحة في بلدان مثل العراق
وسوريا ضروري بسبب وجود صراع مستمر « حيث الأخطار التي تفرضها أمثال
داعش والدول المارقة موجودة دائمًا» ومحاربة هذه القوى تجعل
البريطانيين ينامون بشكل أفضل في أسرتهم. وهو ذات الموقف الذي طالما
تبنته الحكومات البريطانية المتعاقبة، سواء كان الحزب الحاكم هو حزب
العمال أو المحافظين، لستر تدخلها الامبريالي واستعمارها في عديد
البلدان، مستغلة تخويف المواطن من «الآخر / الإرهابي»، وتحت مسميات
مختلفة تناسب الحقبة الزمنية والمصلحة الاقتصادية المتوخاة.
فالإمبريالية تحتاج الإرهاب، دائماً. وإن لم يستدعَ الإرهاب استفزازا
عبر منع الاحتجاج السلمي وجره للعنف المتصاعد، فهو سهل الصناعة
بالتوريط وباختراق التنظيمات السياسية العادية.
وفق هذه السيرورة، يُحذر وزير الدفاع، من “احتمال عودة ظهور داعش هناك»
وأنها « يمكن أن تضرب مواطنينا هنا» ويستطرد الوزير لتحيين وتعميق خطر
داعش التي « تواصل نيتها في تنفيذ وإلهام الهجمات ضدنا، وتظل أهم تهديد
إرهابي للمملكة المتحدة ومصالحنا». وهو ذات الخطاب، تقريبا، الذي
استخدمه توني بلير عشية إعلانه الحرب يوم 20 آذار/ مارس 2003. قائلا
انه أمر القوات بالمشاركة في “العمل العسكري بالعراق.» حينها لم تكن «
داعش» قد صُنعَت بعد، فكانت «مهمتهم: إزاحة صدام حسين ونزع أسلحة
الدمار الشامل». لأن « العالم يواجه تهديدا جديدا من فوضى ولدت إما من
دول مارقة كالعراق أو من الجماعات الإرهابية المتطرفة… كلاهما يكره
أسلوب حياتنا وحريتنا وديمقراطيتنا». وتتوقف « طمأنينة العديد من الدول
على شجاعة وتصميم قواتنا». وإذا ما حدث وتساءل البعض عن هذه الدول التي
ستوفر لها الطمأنينة، يرد بلير « لقد التزمنا أنا والرئيس بوش للعمل من
اجل السلام في الشرق الأوسط على أساس دولة إسرائيل الآمنة ودولة
فلسطينية قابلة للحياة».
الإمبريالية تحتاج الإرهاب، دائماً. وإن لم يستدعَ الإرهاب استفزازا عبر منع الاحتجاج السلمي وجره للعنف المتصاعد، فهو سهل الصناعة بالتوريط وباختراق التنظيمات السياسية العادية
الخطاب، اذن، واحد لتبرير « تدخل» القوات البريطانية. «العدو « جاهز
للاستخدام سواء كان صدام حسين أو أسلحة الدمار الشامل او القاعدة أو
داعش. وهل هناك أنبل من مهمة الدفاع عن أمن، ليس البريطانيين فحسب بل
والعالم كله، وتوخي، في الوقت نفسه، تحقيق « السلام» بل وحماية أهل
البلد المُحتل سواء من قبلهم او ممن غرزوه كما في فلسطين؟
لتحقيق هذا الهدف الانساني، يُخبرنا الوزير: « تواصل طائرات سلاح الجو
الملكي البريطاني القيام بدوريات في سماء العراق، بشكل شبه يومي» وكانت
قد شنت 16 هجوما، وضربت 40 هدفًا إرهابيًا منذ تموز/ يوليو 2019.
وبفضلها و« بفضل قوات التحالف والقوات الشريكة المكونة من 82 عضوًا في
العراق وسوريا»، تحقق النصر. ولئلا يتبادر الى الاذهان ان تحقيق النصر
على داعش سيؤدي الى انهاء ضرورة سيطرة القوات الأجنبية على العراق،
يقول الوزير متداركا « لكن القتال الصعب ضد داعش لم ينته».
لذلك يؤكد الوزير استمرار دور المملكة المتحدة « القيادي في الائتلاف
العالمي» كما هو. فعلى الرغم من تقدير المملكة لقوات الأمن العراقية
وتضحياتها في القتال ضد داعش، وعلى الرغم من اكمال أكثر من 50.000 فرد
من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية وحرس الحدود وقوات الأمن
الكردستانية وكتائب الاستجابة للطوارئ التدريب الذي قدمته الدول
المساهمة بقوات التحالف. الا انها « لا تزال بحاجة إلى المساعدة
الدائمة لإزالة التهديد»، من خلال التدريب والتوجيه والتعليم العسكري
المهني من قبل التحالف ومهمة الناتو في العراق والمبادرات الثنائية،
بالإضافة الى تقديم الدعم الجوي الأساسي.»
ولم ينس الوزير اضافة الكليشيه الضرورية التي يجيدها المستعمِر عن
رعايته للشعوب المُستَعمَرة وعبء الرجل الأبيض متحدثا عن « التزام
المملكة المتحدة باستقرار العراق وسيادته»، متناسيا حقيقة مساهمته في
تخريب كل ما له صلة بالاستقرار وسيادة البلد، ومنوها بتوقيع « مذكرة
تفاهم حول العلاقة الدفاعية المستقبلية» في آب/ أغسطس 2019. وهي في
الحقيقة اتفاقية ستسمح لبريطانيا بإبقاء قواتها في العراق. آخذين بنظر
الاعتبار، بقائها مادامت مصلحتها تقتضي ذلك، بموافقة الحكومة المكونة
من ساسة مُدجنين مهمتهم الأساسية حماية مصالحهم الخاصة ومصالح القوى
الخارجية، وهذا ما يذكرهم به الوزير، بوضوح وقوة يصلان الى درجة
التهديد، حين يقول « على الحكومة حماية قوات التحالف والبعثات الأجنبية
ومحاكمة المسؤولين عن الهجمات. التحالف موجود في العراق بناء على طلب
الحكومة العراقية، للمساعدة في الدفاع عن العراقيين وغيرهم، مكررا،
ربما للمرة العاشرة في تصريحه، ضرورة وجودهم « ضد التهديد المشترك
الحقيقي للغاية من داعش. بدون جهودهم، سيتم تشجيع داعش فقط».
ان اتخاذ أية حكومة قرار توقيع اتفاقية أو معاهدة مع جهة خارجية، يتطلب
البحث والتمحيص وقراءة مدى قانونية الاتفاق وحجم الفائدة والضرر من قبل
فريق خبراء في المجال المعني، فكيف اذا كانت الاتفاقية او المعاهدة تمس
استقلال البلد وسيادته، مع دول احتلت البلد وسببت قتل ما يزيد على
المليون مواطن، خلال فترة قياسية في قسوتها وهمجيتها، استنادا الى
أكاذيب وتلفيقات بات مسؤولو دول الاحتلال انفسهم يعترفون بها؟ وهل
طُرحت هذه الاتفاقيات المصيرية سواء مع بريطانيا أو أمريكا للاستفتاء؟
أم ان الاستفتاء الوحيد الذي سيتم، كما لاحظنا في الأسابيع الأخيرة،
عبر التفجيرات والاغتيالات والصواريخ، التي ستبقى اللغة السائدة في «
العراق الجديد»؟
كاتبة من العراق
حكومة الكاظمي وتوفير
«إستكانات» الشاي للعراقيين
هيفاء زنكنة
لعل واحدا من « إنجازات « حكومات الاحتلال منذ غزو واحتلال العراق في
2003، هو منح عديد المفاهيم والمصطلحات والأمثال المتعارف عليها معاني
جديدة تتماشى مع مصالح الفئة المختارة لدحرجة البلد من حضيض الى آخر.
فمن التحرير الى الديمقراطية ومن النزاهة والشفافية الى القضاء على
الفساد والفاسدين، يتنقلون بتكرار مبتذل واستهانة منهجية بعقول الناس.
فاستمراء الساسة في اتهام بعضهم البعض بالفساد، مثلا، أفرغ الفساد من
معناه وجعله عملة رائجة لاتهام وتسقيط « الآخر» والإعلان عن نظافة
ونزاهة صاحب الاتهام.
وإذا كان تكرار شعار « القضاء على الفساد» بعد 17 عاما من تنميته
وتجذيره في كل مؤسسات البلد، ومن كبير مسؤوليها الى صغيرهم، قد يوحي
بانه أسطوانة مشروخة الا ان الفاسدين، والحق يقال، يدهشوننا، يوميا،
بإبداعاتهم في هذا المجال، حيث نجحوا في استثمار الأسطوانة المشروخة،
المراد منها التكرار الممل، الى مجالس نقاش لا تنتهي في أستوديوهات (ما
أكثرها!) تتناوب على استضافتهم على مدى 24 ساعة في اليوم. كلها، بلا
استثناء، تدّعي انها تعمل من اجل مصلحة المواطن وكيفية توفير الأفضل
للمواطنين، من الخدمات الأساسية الى الامن وحقوق الانسان وأحسن الأجواء
لأداء الشعائر الدينية.
ولأننا في فصل الصيف، والعراق مشهور بلهيب حرارته، خاصة شهري تموز /
يوليو وآب/ أغسطس، المعروف بانه اللَّهاب الذي يحرق المسمار بالباب،
فان الأستوديوهات معبأة بالمتحدثين عما يسمونه « أزمة الكهرباء» وكيفية
حلها عن طريق القضاء على الفساد. وهم أنفسهم سبب الفساد. وهي معالجة لا
تهدف الى إيجاد حل ولو جزئي بل الى تحويل مأساة البلد الى مفردات مجردة
لا تعني شيئا مهما كانت حقيقتها. لم يعد هناك من يتحدث عن معنى انقطاع
الكهرباء لساعات وساعات يوميا ودفع المبالغ الكبيرة للحصول على التيار
الكهربائي من أصحاب المّولدات الكهربائية الخاصة. الفاسدون المسؤولون
عن انقطاع الكهرباء لا يتحدثون عن المرضى الذين يموتون في المستشفيات
او المعامل المتوقفة عن العمل او طلاب وتلاميذ المدارس او حالات الكآبة
وحتى الجنون الذي يمكن أن يصاب به الإنسان وهو يعيش تحت درجة حرارة
تزيد على نصف درجة الغليان.
إنهم لا يتحدثون عن نزول العباد الى الشوارع مطالبين بحقهم في وطن
يتوفر فيه، كما بقية بلدان العالم الأقل ثراء وامكانيات، بالكهرباء.
متناسين حقيقة ان أكثر القرى بعدا في العراق كانت مزودة بالكهرباء فكيف
بالعاصمة بغداد؟ ما يتحدثون عنه، على مدار الساعة هو الوعود البراقة
وتشكيل اللجان والشفافية والنزاهة وهم يعرفون جيدا أنها علكة يلوكونها
لطمس روائح الفساد الكريهة.
لم يغير تعيين مصطفى الكاظمي رئيسا للوزراء الكثير. فمنظومة الفساد
أعمق من تغيير الوجوه، ان حدث. وهو ما لم يحدث. ما حدث هو تدوير الوجوه
وتبادل المواقع، حسب العلاقة اما مع الولايات المتحدة الامريكية أو
إيران. الانتظار والارتفاع والانحسار في علاقة البلدين المُحتلين هو ما
يُشكل يوميات المواطن ومعه تتزايد وتتكرر الوعود.
الفاسدون المسؤولون عن انقطاع الكهرباء لا يتحدثون عن المرضى الذين يموتون في المستشفيات أو المعامل المتوقفة عن العمل أو طلاب وتلاميذ المدارس أو حالات الكآبة وحتى الجنون
تكرار الوعود هذا العام، لم ينخفض ولو درجة مئوية واحدة منذ تعيين
مصطفى الكاظمي، بل ازداد لينافس وعود العام الماضي، والعام الذي سبقه،
وكل عام منذ غزو البلد، يوم وعدوا بتحويل العراق الى فردوس لا مثيل له.
ولم لا، كما تنص المحاججة، ما دام البلد يزخر بعقوله وثروته النفطية،
وكل ما يحتاجه هو التخلص من النظام الدكتاتوري واحلال الديمقراطية!
بالإضافة الى الادعاءات الأولية التي بررت الغزو وهي كثيرة، باتت كل
حكومة جديدة تنافس سابقتها في إطلاق التصريحات، حول القضاء على الفساد،
بل وصلت البلاغة برئيس الوزراء حيدر العبادي الى القول إن الفساد أخطر
من الإرهاب في ذات الوقت الذي كانت فيه حكومته منقوعة بالفساد. ولا
يكاد كل رئيس وزراء جديد يعتلي كرسي منصبه حتى يلقي خطابا مغلفا
بالنزاهة والشفافية، غير غافل عن القاء اللائمة على من سبقه، متهما
الحكومات السابقة كلها بالفساد، مجندا الوزراء الجدد لتدوير ذات
الأسطوانة حتى لو كانوا هم أنفسهم وزراء في الحكومات السابقة. كما هو
علي علاوي، وزير المالية الحالي الذي كان وزيرا في حكومات فاسدة سابقة،
والذي لم يخرج على الطور المعتاد يوم 16 تموز/ يوليو حين صرح «نحارب
الفساد بكل قوة في كافة مؤسسات الدولة». كما لم يخرج على الطور حين
حاول تبرئة الحكومة الحالية من اية مسؤولية سابقة او لاحقة، قائلا: «لا
يمكن تحميل حكومة الكاظمي ما يمر به العراق من مشاكل مالية»، مضيفا «
أن أكثر من 10 في المئة من الموظفين «فضائيون» ومزدوجو رواتب ». يشكل
هذا التصريح المراد منه اثبات فساد الحكومات السابقة بودرة لتزويق وجه
الحكومة الحالية. ومثل كل بودرة تتناثر بسرعة حالما يراجع المرء
تصريحات مسؤولي الحكومات السابقة ويقارنها بالحالية فيجد انها ذات
الأسطوانة المشروخة. فمن منا لا يتذكر تصريح وزير الكهرباء حسين
الشهرستاني، وهو بالمناسبة عالم ذرة يُفترض فيه التحقق العلمي، بان
العراق سيصدر الكهرباء عام 2013؟ وفي ظل حكومة حيدر العبادي، بتاريخ 30
أكتوبر 2018، ومع تزايد الاحتجاجات، تم ابلاغ المواطن بإنجازات مذهلة
لحل ما يسمى بأزمة الكهرباء، مثلا، ومن بينها اعلان وزارة الكهرباء
أنها أبرمت اتفاقيتين بشكل منفصل مع شركتي جنرال إلكتريك الأمريكية
وسيمنز الألمانية لتطوير قطاع الطاقة الكهربائية. وان شركة «جنرال
إلكتريك»، سلّمت الحكومة العراقية إستراتيجية لتطوير القطاع في البلاد
ورفع قدرة المنظومة الوطنية وتشغيل المزيد من الأيدي العاملة. وأُبلغ
المواطن المنتظر لأية بادرة تريحه من القيظ ان دول الخليج ستصدّر فائض
الكهرباء إلى العراق. وتماشيا مع هذه الجهود الجبارة لعديد الدول
والشركات ولكي يثبت العبادي انه معماري هذه « الإنجازات « العظيمة،
بادر بإصدار أمر بتجميد عمل وصلاحيات وزير الكهرباء قاسم الفهداوي «
على خلفية تردي خدمات الكهرباء وإلى حين استكمال التحقيقات». وتحولت
التحقيقات، كالعادة، الى طُرفة غير مضحكة، يتبادلها المواطنون وهم
يحتسون إستكانات الشاي الساخنة، أملا في احياء نظرية التبريد داخل
أجسادهم عن طريق تبخر العرق.
وكي لا يُتهم الكاظمي بأنه ضد الشركات المزودة لشاي العراقيين أو أنه
تخلف عن سلفه في تشكيل لجان التحقيق، ها هو يتصدر أستوديوهات الأخبار
بمباركته « تشكيل لجنة نيابية تحقيقية بملف الكهرباء ويبدي استعداده
للتعاون معها بهدف القضاء على الفساد». وهو فساد وصفه عضو اللجنة
القانونية في مجلس النواب، في 14 تموز/ يوليو بانه «لا مثيل له في كل
العالم، وهناك حيتان وجهات سياسية اعتاشت على عقود الوزارة». فكم
«استكان» شاي سيشرب العراقيون انتظارا لصيد هذه الحيتان؟ ومن هو
الصياد؟
كاتبة من العراق
هل العراقي أقل اعتزازا
بكرامته من الجزائري؟
هيفاء زنكنة
نصَّ البيان المشترك عن جلسة الحوار الاستراتيجي العراقي الأمريكي،
المنعقدة في 10 حزيران / يونيو، على تجديد البلدين «تأكيدهما على
المبادئ المتفق عليها في اتفاقية الإطار الاستراتيجي، لعام 2008، في
مجالات الأمن، ومكافحة الإرهاب، والاقتصاد، والطاقة، والقضايا
السياسية، والعلاقات الثقافية.» بمعنى آخر، لا جديد اطلاقا في
الاتفاقية التي عاش في ظلها العراق خلل 12 عاما الأخيرة والتي سيواصل
العمل بها بين الإدارة الأمريكية، أيا كان الرئيس المنتخب، والنظام
العراقي، مستقبلا، وبلا تحديد زمني، وهي نقطة مهمة جدا لم تتم الإشارة
اليها. وهي واحدة من عديد القضايا التي تم التغافل عنها عن طريق حذفها
أي عدم تضمين ما كان يجب تضمينه لو كانت الاتفاقية لصالح العراق حقا.
اعتبر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن الحوار حقق إنجازاً عراقياً
كبيراً، من ناحيتين اعتبرهما من الأولويات وهما انسحاب القوات
الأمريكية من البلاد وعدم بقاء أي قواعد لها بالإضافة الى وضع أسس
لتعاون اقتصادي بين البلدين. ومن تتح له فرصة قراءة الاتفاقية بكاملها
والتي تم التوقيع عليها عام 2008 ومن ثم البيان الصادر حديثا عن الحوار
الذي اعتبره الكاظمي إنجازا كبيرا لوجد أن تصريح الكاظمي مبني على
مغالطات واضحة حول سيادة العراق ووضع القوات الامريكية.
تبين مراجعة التفاصيل أن القوات باقية ولكن، وكما حدث في السنوات
الماضية، تحت مسميات مختلفة يتم ابتكارها وفقا للحاجة. مستشارون،
مدربون، قوات أمنية مساعدة لاستتباب الامن، جمع المعلومات، محاربة
الإرهاب، عمليات خاصة، القصف الجوي ولا ننسى السيطرة الجوية عن طريق
الطائرات بلا طيار. هذا هو المعنى الحقيقي للسيادة كما تنص عليه
الاتفاقية، ويؤكدها البيان بوضوح يناقض تصريح الكاظمي تماما حيث ينص
البيان « تعهدت حكومة العراق بحماية العسكريين التابعين للتحالف الدولي
والمنشآت العراقية التي تستضيفهم بما يتماشى مع القانون الدولي
والترتيبات المحددة لوجودهم كما يقرر البلدان».
ستثبت السنوات المقبلة أن اتفاقيات التبعية لا تمسح ذاكرة العراقيين مهما تم تزويقها، وأن الشعب العراقي ليس أقل اعتدادا بهويته الوطنية وكرامته من أشقائه في الجزائر
وبينما تتكرر في الاتفاقية والبيان مفردات « الصداقة» و «التعاون» و»
الشراكة» و « تعزيز مصالح كلا البلدين» فان قراءة بنود الاتفاقية تدل
على خلاف ذلك، وان المفردات مصاغة لتبرير وتكريس الهيمنة على بلد ضعيف
ومنهك جراء الغزو والاحتلال من قبل ذات البلد الذي يدّعي الصداقة
والشراكة. ففي مجال الاقتصاد والطاقة، ستزود أمريكا « المستشارين
الاقتصاديين للعمل بشكل مباشر مع حكومة العراق»، وتحقيق « مشاريع
الاستثمار المحتملة التي تنخرط فيها الشركات الأمريكية العالمية في
قطاع الطاقة والمجالات الأخرى». سياسيا، أكد البيان على « أهمية مساعدة
العراق في تطبيق برنامجه الحكومي والإصلاحي بالشكل الذي يلبي طموحات
الشعب العراقي، بما في ذلك مواصلة الجهود الإنسانية، واستعادة
الاستقرار، وإعادة إعمار البلد، وتنظيم انتخابات حرة وعادلة ونزيهة».
وهي اهداف قد تبدو نبيلة، حقا، لولا أن أمريكا بغزوها واحتلالها وقائمة
جرائمها المادية والبشرية التي ارتكبتها على مدى 17 عاما، وتهيئتها
الأرضية لزرع الإرهاب ومأسسة الميليشيات الإيرانية، هي آخر بلد في
العالم تهمه مصلحة الشعب العراقي او أي شعب آخر في المنطقة خاصة. بل ان
ما يميز الإدارة الأمريكية هو سياستها العلنية والسرية لتغيير النظام
الذي تلجأ اليه ضد الحكومات التي يُعتقد أنها تعمل ضد المصالح
الاستراتيجية والأمنية والاقتصادية للولايات المتحدة. حيث قامت، مثلا،
بـ 72 محاولة لتغيير النظام، أي الانقلاب العسكري او التمرد المسلح،
اثناء العقود الأربعة للحرب الباردة حتى حوالي 1990 فقط. وهي تشمل 66
عملية سرية وست عمليات علنية، حسب صحيفة « الواشنطن بوست»، وهي من داخل
المؤسسة الحاكمة الأمريكية، في 26 كانون الأول-ديسمبر 2016.
ثقافيا، كان مرور البيان سريعا. اذ اقتصرت الإشارة الى إعادة الأرشيف
السياسي والقطع الاثرية المسروقة. الا ان الاتفاقية نفسها تُبين وجود
«المستشارين الثقافيين»، في عديد المؤسسات الثقافية. ويوضح موقع
السفارة الأمريكية، ببغداد، معنى « التبادل الثقافي» و « التفاهم
المتبادل»، بشكل أفضل. فالمعنى الحقيقي للتبادل هو عدم وجود تبادل. اذ
يتم من طرف واحد هو الأمريكي لتنظيم «ورش العمل والمحاضرات والعروض…
تغطي البرامج مجموعة واسعة من المصالح بما في ذلك الاقتصاد والعلاقات
الدولية وبناء الديمقراطية والدراسات الأميركية». انه، اذن، ضخ للثقافة
من جانب واحد. اذ لا يحدث ويزور أمريكيون العراق ليتعرفوا على البلد
الذي تم غزوه وتخريبه باسمهم أو « لإقامة علاقات إنسانية متينة والتي
تبني جسورا من التعاون والتفاهم بين الشعوب»، كما تدّعي برامج «
التبادل الثقافي»، لأن السفارة الأمريكية، أساسا، تحذر من زيارة العراق
بل و» تحث المواطنين الأمريكيين ان يغادروا العراق فورا»، فكيف يمكن
بناء « جسور التفاهم» بين مواطني البلدين في هذه الحالة؟
من المتوقع زيارة الكاظمي الى واشنطن، في الشهر المقبل، لتوقيع
الاتفاقية. فهل هي لصالح الشعب العراقي كما يدّعي؟ وهل يجب القبول
بالتبعية التي تنص عليها الاتفاقية، في كافة المجالات، لقاء إضعاف
الميليشيات المدعومة إيرانيا، إذا كان هذا فعلا ما يريده الكاظمي من
اجل بناء « العراق الجديد» وهو مصطلح أدخله الاحتلال عقب الغزو وتلاشى
ليعود، اليوم، ليطفو من جديد؟ وهل اطّلع الشعب على تفاصيل ما سيتم ربطه
به، لأمد غير محدد، في اتفاقية تتميز بالتضليل والتزييف؟ ماذا عن جرائم
الاعتقال والتعذيب والاغتصاب والقتل التي ارتكبتها أمريكا منذ اليوم
للاحتلال وسببت مقتل حوالي مليون مواطن؟ ماذا عن الحصانة من العقاب
المتوفرة للقتلة من القوات الامريكية؟ هل سيقوم الكاظمي بتضمين
الاتفاقية هذه القضايا قبل توقيعها؟
على الرغم من مرور 66 عاما على اندلاع الثورة الجزائرية ضد الحكم
الاستعماري الفرنسي، لا يزال الجزائريون يتذكرون جرائم الحقبة
الاستعمارية الفرنسية، ويطالبون فرنسا الاعتراف بما ارتكبته من جرائم
نهب وتعذيب وقتل وتهجير واختفاء ومحو الهوية والاعتذار عنه. إن ما
ارتكبته أمريكا في العراق، خلال فترة قياسية، يكاد يماثل، الى حد
التطابق، ما قامت به فرنسا. وستثبت السنوات المقبلة أن اتفاقيات
التبعية لا تمسح ذاكرة العراقيين مهما تم تزويقها، وأن الشعب العراقي
ليس أقل اعتدادا بهويته الوطنية وكرامته من أشقائه في الجزائر.
كاتبة من العراق
ويسألونك عن طعم
الصداقة مع أمريكا!
هيفاء زنكنة
لا تزال المظاهرات المناوئة للتمييز العنصري في الولايات المتحدة الامريكية مستمرة. قد تؤدي هذه الاحتجاجات وما صاحبها من دعم في بلدان أخرى الى تغييرات سياسية وقانونية داخلية، إلا أن المؤكد هو أنها لن تمس السياسية الأمريكية الخارجية. كما لاتزال السياسة الخارجية كما هي توحد الحزبين الرئيسيين ولا يتطرق اليها غير قلة أما من الموسومين باليسار أو الذين يقسمون الأنظمة والدول في ارجاء العالم الى صنفين هما حلفاء الولايات المتحدة وأعدائها.
لا يخضع التصنيف الأمريكي للحلفاء والأعداء لمقياس أخلاقي أو إنساني او حتى القوانين الدولية في معظم الأحيان اذ ترتبط أمريكا بعلاقات وثيقة مع العديد من الأنظمة التي تتعارض قيمها وسياساتها مع الضمانات الدستورية الأمريكية للديمقراطية وحرية التعبير والحق في الإجراءات القانونية الواجبة والعديد من الأنظمة الأخرى.
ينعكس هذا التصنيف، بشكل كارثي، على علاقتها كقوة عسكرية كبرى مع شعوب دول الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية من بين الدول الأخرى التي تذوقت ولاتزال معنى «الصداقة» و«التحالف» و«التعاون» مع أمريكا، أو ما هو متعارف عليه بتسميات الاستعمار والاحتلال والغزو، أي الوجه الحقيقي للعلاقة.
ويوفر لنا «الحوار» الذي تم في الأسابيع الأخيرة بين الإدارة الامريكية والنظام العراقي، حول اتفاقية الإطار الاستراتيجي، والزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الى واشنطن، نموذجا عمليا وآنيا لكيفية انتقاء وتثبيت آلية «التعاون» الأمريكي مع «الحلفاء» بالإضافة الى القاء الضوء على مفهوم الانتقائية الأخلاقية والترويج الإعلامي.
لتوضيح نوعية «التحالف» الذي تأمل جهات عراقية أن تحصده من توقيع المعاهدات مع أمريكا، وما ستتمخض عنه زيارة الكاظمي، يجدر التذكير بأن أمريكا لا تقيم علاقاتها مع الشعوب حسب ما تصبو إليه الشعوب وتقاتل من اجله. من البديهيات أن أمريكا تعمل بالدرجة الأولى والوحيدة لمصلحتها وتعاونها مع الآخرين، سواء كانوا دولا ام حكومات ام حركات وتيارات مختلفة، يٌقاس بمدى الفائدة المستخلصة منهم. لذلك تُقيم أمريكا علاقات وثيقة مع خمسين نظاما قمعيا في العالم، من بينها عديد الأنظمة العربية التي توفر لحكامها الحماية ضد شعوبها مقابل استحقاقات تدفع لها عاجلا ام آجلا. ولا تجد أمريكا حرجا في استبدال الحليف بمن كان عدوا أو العدو بمن كان حليفا أو وحسب استراتيجية مكافحة التمرد ان تدعم « تمردا» ضد من كان حتى الأمس حليفا، بغية تغيير النظام.
الأمثلة من التاريخ القريب متعددة. كما التعامل مع حليف الأمس شاه إيران، واللعب على الحبلين بين العراق وإيران (1980 ـ 1988)، وبينما كانت سوريا مدرجة في قائمة وزارة الخارجية الامريكية للدول الراعية للإرهاب منذ عام 1979، الا ان هذا لم يمنع الرئيسين بوش وبيل كلينتون من توكيل الرئيس الراحل حافظ الأسد على لبنان، مثلاً، (حكم الأسد من عام 1971 حتى وفاته في 2000)
يتخذ الدعم الأمريكي للأنظمة القمعية مستويات متعددة. حيث تسمح، أو ترتب، أو حتى في بعض الحالات توفر التمويل لمبيعات الأسلحة الأمريكية إلى 41 من البلدان الخمسين ذات الأنظمة القمعية
يتخذ الدعم الأمريكي للأنظمة القمعية مستويات متعددة. حيث تسمح، أو ترتب، أو حتى في بعض الحالات توفر التمويل لمبيعات الأسلحة الأمريكية إلى 41 من البلدان الخمسين ذات الأنظمة القمعية، أي بنسبة 82 في المئة. في حالات أخرى، تقوم أمريكا بمهام «التدريب» و «الاستشارة العسكرية» إلى 44 من أصل 50، أو 88 في المائة، لأنه بالإضافة إلى بيعها (أو منحها) الأسلحة وتدريبها، توفر الحكومة الأمريكية أيضًا تمويلًا مباشرًا للجيوش الأجنبية. من بين الحكومات القمعية الخمسين، تتلقى 32 منها «تمويلا عسكريًا أجنبيًا» أو تمويلًا آخر للأنشطة العسكرية من حكومة الولايات المتحدة. بل وتمضي ابعد من ذلك في علاقتها ودعمها عن طريق انشاء القواعد العسكرية، هذه الأوجه المتعددة وثّقها الكاتب والصحافي الأمريكي دافيد سوانسون في بحث له حول درجات تعاون ودعم الولايات المتحدة للأنظمة القمعية، والتي يتطرق فيها أيضا الى تفاصيل التدخل العسكري ودرجاته من الحرب بالشراكة، الى الغزو والاحتلال وتأسيس حكومات قمعية، من مصلحة أمريكا المحافظة عليه، كما في العراق.
سياسة أمريكا الخارجية اذن ثابتة وواضحة. ما هو متغير هو شخصية الرئيس، فنعومة خطاب الرئيس باراك أوباما تختلف عن عنجهية وابتذال ترامب غير ان كليهما حافظا على جوهر السياسة الخارجية، خاصة فيما يتعلق بمقدار وحدود الحماية التي توفرها أمريكا للحكام، الذين يتم انتقاؤهم كحلفاء، ومتى يصبح من الضروري التخلي عنهم واستبدالهم بحكام آخرين.
«الحليف»، اذن، من البلدان التي كانت مستعمرة او محتلة او المُستَغلة أو الخاضعة لحكومات قمعية بحاجة الى الحماية، هو المُتغير لا بالنسبة الى أمريكا، فقط، بل وبقية الدول العظمى ضمن تحالفات وصراعات ونزاعات متسارعة، بشكل مذهل، وخارج القوالب الكلاسيكية المتعارف عليها سياسيا وعسكريا. تُقاد بشكل حرب أهلية/ دولية متعددة الأطراف (يطلق عليها مصطلح نزاع او صراع تزييفا) في بلد واحد كما في سوريا وليبيا واليمن. وهي حروب أهلية بمعنى ان وقودها هم أبناء الشعب وثروة البلد، وهدفها إبقاء البلد ضعيفا من الناحيتين البشرية والمادية لتسهل السيطرة عليه، لأغراض استراتيجية، سواء من القوى الخارجية او النظام القمعي أو كليهما تحت مظلة «تحالف دولي». هي حرب دولية لمشاركة عديد الدول فيها وان لم تعد بالشكل التقليدي. حيث فتحت التكنولوجيا الحديثة والتقدم العلمي السريع في مجال تطوير السلاح والعتاد ابوابا واسعة لتقليل الخسارة البشرية في الجيوش الحديثة. فالطائرات بلا طيار والاستهداف الجوي والصواريخ المتطورة، بالإضافة الى العمليات الخاصة المرتزقة، بل واستخدام جنود وقوات «البلدان الحليفة» للقتال على ارض بلدهم، يشكل دافعا أساسيا في إصرار الإدارة الامريكية على سحب معظم القوات العسكرية واغلاق المعسكرات ذات التكلفة المادية والبشرية العالية، ما لم تقم الأنظمة الراغبة بحمايتها من دفع التكلفة بنفسها. مما يحول القوات الامريكية، مثلا، بهذا المعنى، أو فرقا منها، الى قوات مرتزقة مهيأة للاستئجار من أي نظام أو جهة في العالم. وهي قفزة نوعية في تغير معنى التواجد العسكري الأمريكي أو غيره من الدول العظمى في «البلدان الحليفة»، تثير سؤالا جوهريا يعيدنا الى ألف باء العلاقة بين المُستَعمِر والمُستَعمَر، في مرحلة التحرر الوطني، وهو ما هو الثمن الذي ستدفعه الشعوب حين تقوم الأنظمة القمعية بالاستجارة بمرتزقة الدول العظمى لحمايتها، وهل بإمكانها أن تنهض، من جديد، لتخوض حرب تحرير وطنية أخرى؟
كاتبة من العراق
في العراق صرنا
كلنا ندفع الجزية!
هيفاء زنكنة
إذا كان هناك من تفاؤل باقتراب فترة هدوء وأمان بعد التوافق الأمريكي ـ الإيراني على تنصيب رئيس المخابرات مصطفى الكاظمي رئيسا للوزراء بالعراق، فان وقائع الأسابيع الماضية أعادت المتفائلين، الى ارض الواقع المتدهور على كافة المستويات، سواء كانوا من الساسة المتهافتين على النهب والمتمرسين فيه أو أبناء الشعب المنهك الذي بات ينشد الأمان وأساسيات الحياة وحدها، أحيانا، في اية بادرة تمنحه فرصة للتنفس والتفكير، مهما كان مصدرها.
اذ تنشط، حاليا، في تجاذب أطراف البلد الى حد تمزيقه أربع قوى خارجية، وهي وباء كورونا والولايات المتحدة الامريكية وجمهورية إيران الإسلامية بالإضافة الى دخول وجه جديد/ قديم هو تركيا. يتداخل مع هذه القوى، كل على حدة، غالبا، وبشكل من الصعب تفكيكه، ساسة محليون تذوقوا طعم الفريسة، واكتسبوا خبرة لا تضاهى في نهش ثروة البلد، ومد جذورهم في مؤسساته من خلال ثلاثة محاور هي: التخويف من « الآخر»، والاغواء المادي والتعيين الوظيفي، بالإضافة الى التعكز على المرجعية الدينية وما يحيطها من طقوس تمتد على مدى العام.
تكّفل انتشار فايروس كورونا بتكذيب التصريحات الحكومية السابقة حول النجاح في احتواء الوباء ومعاقبة وكالة الأنباء « رويترز» التي اشارت الى ان عدد المصابين أكبر مما يعلن عنه. وصل معدل الإصابات، حاليا، بحدود ألف وخمسمائة يوميا وأبدت الأمم المتحدة قلقها لارتفاع عدد الوفيات، بينما دعت مفوضية حقوق الإنسان الحكومة الى اتخاذ إجراءات سريعة للحد من ارتفاعها المخيف. وفي الوقت الذي تستحق فيه الطواقم الطبية الثناء الا ان تردي وضع المستشفيات واهمالها دفع النائبة وحدة الجميلي الى وصفها بأنها « مقبرة للفقراء». ونرى في فيديو انتشر على صفحات التواصل الاجتماعي، وتم التحقق من صحته، جثامين ضحايا الكورونا مرمية خارج احدى المستشفيات. الأمر الذي أكده النائب جاسم البخاتي، قائلا « ان جثث المتوفين بفيروس كورونا تفوق الطاقة الاستيعابية للمستشفيات». مبينا « وصلتنا مناشدات من مؤسسات صحية وخاصة مستشفى الكندي بأن هناك مجموعة من الجثث وهناك تباطؤ في عملية نقلها ودفنها». وجاء الرد الحكومي متمثلا بعرض أفلام في القناة الحكومية الرسمية تبين حشدا من رجال برُتب عسكرية عالية وهم إما يسيرون أو يلتفون حول سيارة رش المعقمات. وتأتي وفاة النجم الرياضي أحمد راضي، وكان قد غادر المستشفى على مسؤوليته، قبل يومين من وفاته، احتجاجا، لتلقي الضوء على الإهمال الذي يعيشه المصابون بالفايروس في نظام صحي منهار.
في هذه الأجواء الكافكوية، المخيفة وغير القابلة للفهم في آن واحد، التي تتطلب أولوية التركيز على انقاذ حياة الناس، وتوفير الرعاية للمصابين وحملات التوعية، واتخاذ الإجراءات الضرورية للحجر الكلي للبلد، واكرام الموتى، وإلغاء كل ما هو غير مُلح، كما فعلت معظم دول العالم، سارعت حكومة الكاظمي، كالسراق تحت جنح الظلام، الى تنفيذ ما أطلق عليه اصطلاحا « اجراء حوار» مع الإدارة الامريكية. أي التباحث حول تعديل «اتفاقية الإطار الاستراتيجي»، المُوقـَّعة مع الولايات المتحدة الأمريكيَّة عام 2008، لغرض تنّظيم «العلاقة طويلة الأمد في المجالات الاقتصادية والدبلوماسية والثقافية والأمنية بين البلدين». وهي الاتفاقية الأكثر أهمية منذ احتلال البلد عام 2003، لا من ناحية بقاء القوات الأمريكية، كما يشاع، ولكن من ناحية الهيمنة على الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهي الجوانب التي قلما يشار اليها علنا. وتنبع أهمية الاتفاقية من رغبة الإدارة الامريكية بتقليص عدد قواتها على الأرض، في أثر إعادة هيكلة الجيش الأمريكي، لتقليل تكلفة الخسائر البشرية والمادية في صفوفه، والاستعاضة عن القوات بزيادة الاعتماد على الطائرات بدون طيار، والقوة الجوية، والعمليات الخاصة بواسطة المرتزقة والشركات الأمنية بالإضافة الى الحكومات المحلية أو « الدول المُضّيفة» بالنيابة.
تبقى مسيرة البلد للتعافي مشروعاً طويل المدى بمراحل متعددة ومتكاملة بدءا من انقاذ وحماية حياة المواطنين وتوفير العيش الكريم الى إنضاج البدائل الوطنية والتنموية لاستعادة النسيج الاجتماعي في البلد
وموقف الرئيس الأمريكي ترامب واضح من مسألة طلب الحماية الأمريكية. فمن يرغب بالحماية عليه دفع التكلفة. وأكد يوم السبت الفائت، في خطاب له في الأكاديمية العسكرية الأمريكية ما ذكره في خطب سابقة، قائلا: «إننا نستعيد المبدأ الأساسي القائل بأن مهمة الجندي الأمريكي ليست إعادة بناء دول أجنبية ولكن الدفاع عن أمتنا والدفاع عنها بقوة من الأعداء الأجانب»، وتابع قائلا: «نحن ننهي حقبة الحروب التي لا نهاية لها». هذا من الناحية العسكرية، أما «الثقافية» وهي الأعمق والأكثر تأثيرا على بنية المجتمع في المدى البعيد، فيمكن تصنيفها ضمن اساسيات» القوة الناعمة». لتمرير الاتفاقية، أو الهيمنة النيو كولونيالية، تكثر في تصريحات الإدارة الأمريكية، عموما، مفردات تثير الاطمئنان وتساعد على تسويق الاتفاقية باعتبارها بين حليفين متكافئين أو بلدين صديقين. مفردات على غرار «شراكة، اتفاقية، تعاون». اما مضمون الاتفاقية فهو «استشارة، تدريب، مساعدة». وهي ذات التسميات التي تستخدمها إيران لتسويغ جرائم ميليشياتها المسلحة وتسخير الساسة الموالين لها داخل البلد.
وبينما يتواصل قصف المنطقة الخضراء بالصواريخ، والتي تبدو «رمزية» أكثر منها فعلية، شهدنا، في الأسبوع الأخير، سباقا من نوع مختلف نسبيا. اذ قصفت إيران قرى حدودية سببت خسائر مادية، وأضرارا بالممتلكات، علاوة على بث الخوف بين الآمنين من سكان تلك المناطق، حسب تصريح عراقي، في ذات الوقت الذي نفذت فيه تركيا عمليتين ضد «حزب العمال الكردستاني». الأولى جوية باسم «مخلب النسر»، والثانية برية باسم «مخلب النمر»، وتشير مصادر تركية الى رغبة الحكومة بإقامة قاعدة عسكرية لم يحدد موقعها بعد، لتضع حدا «لازدياد هجمات المقاتلين الأكراد على قواعد الجيش التركي على الحدود بين البلدين».
ان سياسة تمزيق العراق كبلد ذو سيادة وتفتيت شعبه الى طوائف وأقليات وعشائر وميليشيات تتصارع فيما بينها مستمر منذ احتلاله عام 2003، وإذا كانت « الرقعة صغيرة والشق كبير» و « صرنا كلنا ندفع جزية»، كما يقول منشدنا الراحل عزيز علي، فان تعيين الكاظمي لم يحد من سياسة القوى المتصارعة على الغنيمة. اذ لم يتخذ، حتى الآن، أية خطوة عملية تطمئن الناس وأولها مساءلة المسؤولين عن قتل 700 متظاهر واختطاف آخرين. والأدهى من ذلك أن عمليات الاغتيال مستمرة، من قبل « مجهولين»، آخرها اغتيال أستاذ جامعي في مدينة الناصرية، والمحامي طارق هلال من شمال بغداد. وإذا كان هناك انجاز للكاظمي يستحق الذكر فإنه مواصلة سياسة من سبقه من رؤساء وزراء، في إطلاق التصريحات بلا تنفيذ. وتبقى مسيرة البلد للتعافي مشروعاً طويل المدى بمراحل متعددة ومتكاملة بدءا من انقاذ وحماية حياة المواطنين وتوفير العيش الكريم الى إنضاج البدائل الوطنية والتنموية لاستعادة النسيج الاجتماعي في البلد. ومن هناك تحقيق التوازنات الإقليمية والعلاقات الدولية المتكافئة.
كاتبة من العراق
ألا يمثل ترامب
الشعب الأمريكي؟
هيفاء زنكنة
لم يعد فايروس كورونا القاتل هو الشاغل الأول للناس في أرجاء الكرة الأرضية. تغيرت الأولويات، فالعالم مشغول بالمظاهرات في أمريكا. انتقل غضب المتظاهرين، من ولاية أمريكية الى أخرى، ومنها الى بريطانيا وألمانيا وكوريا وفرنسا ومنها الى مدرج المسرح البلدي، بشارع الحبيب بورقيبة، وسط العاصمة التونسية.
اختلفت ردود الأفعال من بلد الى آخر. ففي تونس، وجّه حمة الهمامي، الأمين العام لحزب العمال، نداء « إلى شباب تونس، إلى نسائها وكادحيها ومثقّفيها ومبدعيها: انتصروا إلى أخواتكم وإخوتكم في أمريكا» مبينا فيه « إنّ تحرّك الشعب الأمريكي اليوم يعطي فرصة غير مسبوقة للقوى التقدمية في العالم لكي تعبّر عن مساندتها له وتشدّ أزره في مواجهته الوحش الرأسمالي الامبريالي الأمريكي» وإن « الشعب الأمريكي يقدّم خدمة كبيرة لشعوب العالم لأنه يفضح هذا الوحش الذي آذاها ويؤذيها ويضعفه ممّا يوفّر فرصة لهذه الشعوب حتّى تتمرّد عليه وتتحرّر من أغلاله».
ونشط في بقية البلدان العربية والإقليمية المجاورة، متحدثون باسم حكومات قمعية لاستنكار أسلوب مواجهة المتظاهرين « غير الديمقراطي» من قبل الإدارة الامريكية. في ذات الوقت الذي لا يجدون فيه حرجا باتباع أسلوب أكثر وحشية لقمع مظاهرات مواطنيهم. الكل يبررون ذلك بأنه ضرورة أمنية.
خلال أيام قليلة، ظهرت قراءات وتفسيرات متعددة للمظاهرات التي أججها مقتل جورج فلويد الأمريكي الأسود اختناقا تحت شرطي أبيض (لا أدري لم يوصف فلويد بأنه من أصول افريقية ويصفون الرئيس السابق أوباما بأنه من اصل كيني، وكأن بقية سكان أمريكا كلهم لا ينحدرون من أصول هي غير سكان البلد الأصليين، الذين تمت ابادتهم وبناء البلد الحالي على جماجمهم). تحولت صرخة فلويد الأخيرة « لا أستطيع أن أتنفس»، الى شعار سرعان ما تم تداوله ضد العنصرية وتكميم الأفواه وكل أنواع التمييز، بل وربطه متظاهرون في عواصم أوروبية بفرض الحكومات سياسة ارتداء الكمامات. خُلعت الكمامات التي باتت رمزا للهيمنة والسيطرة بدلا من الوقاية والحذر، واحتلت أخبار إيجاد لقاح سريع لمنع انتشار الوباء بوجبة ثانية المرتبة الدنيا في قوائم أكثر الأخبار قراءة او اطلاعا إعلاميا.
احتلت صورة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واقفا امام كنيسة وهو يحمل الإنجيل، مساحة مساوية وموازية لصورة جورج فلويد والمتظاهرين، لتبين، مدى انقسام الشعب الأمريكي لا من ناحية لون البشرة فقط ولكن ما هو ابعد من ذلك، أي الناحيتين الاقتصادية والطبقية، المتداخلتين مع درجات الاستحواذ على مراكز السلطة، وكيفية الوصول اليها ومن ثم المهارة في صناعة الرضا الشعبي.
إن تأثير المظاهرات الامريكية سيبقى، محصورا بما سيفرض من تغيير على الوضع الداخلي، ولن يمس السياسة الخارجية التي هي في المحصلة سياسة دولة
ومن يراجع مسيرة ترامب سيجد أنه منذ ترشيحه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، البلد الأقوى في العالم عسكريا وتكنولوجيا، كممثل للحزب الجمهوري، عمل على استقطاب شرائح مجتمعية يعرف جيدا أنها من ستوفر له فرصة البقاء في منصبه دورة أخرى. وانه، خلافا، لعديد الرؤساء الأمريكيين ممن سبقوه، نفذ فعلا معظم وعوده التي أطلقها اثناء الحملة الانتخابية، بغض النظر عن درجة استهجان نسبة من الشعب الأمريكي لبرنامجه ولا إنسانية أسلوبه في التطبيق البرنامج، بالإضافة الى كراهيتنا، نحن الذين نعيش نتائج عنجهية السياسة الأمريكية الخارجية وحروبها المدمرة.
صحيح أن سلوك الرئيس الأمريكي اتسم بالشعبوية التحريضية، واقترن خطابه بخلق المهاترات والعنصرية بواسطة تغريدات لم يعهدها العالم من قبل أي رئيس سبقه، وصحيح أنه تميز بسرعة إصدار الأحكام وتعيين المستشارين او طردهم أو إقامة علاقات دولية او وضع حد لها بسرعة، خلال ساعات أحيانا، قد جعلته محط سخرية ومصدرا لا ينضب لرسامي الكاريكاتير، الا انه نجح في تحقيق ما أراده جمهوره من الشعب الأمريكي، الذي صّوت له وفق نظام ديمقراطي يُعتبر أساس الوجود الأمريكي، تبعا لدستور يكاد يكون مقدسا. وهذه نقطة بالغة الأهمية، غالبا، ما يتم تجاهلها أو التعامل معها من قبلنا. اذ نُسقط على الديمقراطية الامريكية واختيار الشعب لحكامه عبر الانتخابات مواقفنا نحو الديمقراطية والدساتير في بلداننا في ظل أنظمة استبدادية ـ تابعة ومتوارثة. حيث لم تنم الديمقراطية بشكل عضوي، ونادرا ما كان الدستور مكتوبا من قبل أبناء البلد أنفسهم في معظم البلدان العربية بل والأدهى من ذلك، غالبا ما نجدهما اما مستوردين أو مفروضين من « الخارج» وفي حالة العراق من قبل قوات الاحتلال الأمريكي
هذه الأرضية تستحق الانتباه عند الكتابة عن المظاهرات الامريكية الحالية والدعوة الى مساندتها باعتبارها « ثورة»، وكأنها نبعت من شعب أجبرته قوات الغزو والحكام بالنيابة، على خوض انتخابات مفروضة عليه قسرا. المفارقة (أو لعله الإحساس بالمرارة)، هي اننا لم نقرأ أي نداء من قبل أي حزب أو تنظيم عربي أو عالمي يدعو الى دعم المعتصمين العراقيين في انتفاضة تشرين/ أكتوبر بتكلفتها العالية بحياة 700 شهيد ومئات المختطفين وآلاف الجرحى، خلال أربعة أشهر فقط. ولا يزال الصمت القاتل سائدا على الرغم من استمرار الاحتجاجات في عشر مدن عراقية للمطالبة بمحاسبة قتلة المتظاهرين والتخلص من الاحتلالين الأمريكي والإيراني.
بعيدا عن الصحافة العربية التي يبدو كتابها إما مصدومين لأن «الكلام المنمق الذي تستخدمه الإدارات الأمريكية للحديث عن وجوه المساواة والعدالة المتحققة في المجتمع الأمريكي، ليس حقيقة»، أو كأنهم اكتشفوا العجلة حين يصفون قتل فلويد بأنه يبين « ممارسات التمييز العنصري في دولة تدعي أنها زعيمة المساواة والحرية في العالم»، نجد أن ترامب استطاع، الحصول على رضا المصوتين له، اذ حقق لهم تحسنا اقتصاديا ملموسا وتخفيض نسبة البطالة، وبناء جدار عازل مع المكسيك، ومعاملة المهاجرين بطريقة تثير رعب كل من يحاول اللجوء الى أمريكا، وطرد من لا تحتاجهم، والعمل على تقليل القواعد العسكرية وتكاليف نفقاتها الكبيرة، وإجبار الحكام الراغبين بالحماية الأمريكية ضد شعوبهم، على دفع تكاليف القوات، كما فعل مع المملكة العربية السعودية. كما لم ينكث بوعوده السخية للكيان الصهيوني، بل اُعتبرت « صفقة القرن» إنجازا له، والاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني هو «الشيء الصحيح الذي ينبغي فعله». لتليها الموافقة على مد المستوطنات أينما أراد المحتل. كل هذا بموافقة أو صمت الخانعين من الحكام العرب.
إن تأثير المظاهرات الامريكية سيبقى، محصورا بما سيفرض من تغيير على الوضع الداخلي، ولن يمس السياسة الخارجية التي هي في المحصلة سياسة دولة، كما أن معظم مواطني الولايات المتحدة وأوروبا لا يهتمون كثيرا بالسياسة الخارجية إلا إذا مست وضعهم الاقتصادي بشكل مباشر. ولنتذكر أن معظم الشعب الأمريكي والبريطاني أنتخب الرئيس جورج بوش ورئيس الوزراء توني بلير على الرغم من المظاهرات المناوئة للحرب على العراق في كلا البلدين وفي أرجاء العالم.
كاتبة من العراق
ألا يمثل ترامب
الشعب الأمريكي؟
هيفاء زنكنة
لم يعد فايروس كورونا القاتل هو الشاغل الأول للناس في أرجاء الكرة الأرضية. تغيرت الأولويات، فالعالم مشغول بالمظاهرات في أمريكا. انتقل غضب المتظاهرين، من ولاية أمريكية الى أخرى، ومنها الى بريطانيا وألمانيا وكوريا وفرنسا ومنها الى مدرج المسرح البلدي، بشارع الحبيب بورقيبة، وسط العاصمة التونسية.
اختلفت ردود الأفعال من بلد الى آخر. ففي تونس، وجّه حمة الهمامي، الأمين العام لحزب العمال، نداء « إلى شباب تونس، إلى نسائها وكادحيها ومثقّفيها ومبدعيها: انتصروا إلى أخواتكم وإخوتكم في أمريكا» مبينا فيه « إنّ تحرّك الشعب الأمريكي اليوم يعطي فرصة غير مسبوقة للقوى التقدمية في العالم لكي تعبّر عن مساندتها له وتشدّ أزره في مواجهته الوحش الرأسمالي الامبريالي الأمريكي» وإن « الشعب الأمريكي يقدّم خدمة كبيرة لشعوب العالم لأنه يفضح هذا الوحش الذي آذاها ويؤذيها ويضعفه ممّا يوفّر فرصة لهذه الشعوب حتّى تتمرّد عليه وتتحرّر من أغلاله».
ونشط في بقية البلدان العربية والإقليمية المجاورة، متحدثون باسم حكومات قمعية لاستنكار أسلوب مواجهة المتظاهرين « غير الديمقراطي» من قبل الإدارة الامريكية. في ذات الوقت الذي لا يجدون فيه حرجا باتباع أسلوب أكثر وحشية لقمع مظاهرات مواطنيهم. الكل يبررون ذلك بأنه ضرورة أمنية.
خلال أيام قليلة، ظهرت قراءات وتفسيرات متعددة للمظاهرات التي أججها مقتل جورج فلويد الأمريكي الأسود اختناقا تحت شرطي أبيض (لا أدري لم يوصف فلويد بأنه من أصول افريقية ويصفون الرئيس السابق أوباما بأنه من اصل كيني، وكأن بقية سكان أمريكا كلهم لا ينحدرون من أصول هي غير سكان البلد الأصليين، الذين تمت ابادتهم وبناء البلد الحالي على جماجمهم). تحولت صرخة فلويد الأخيرة « لا أستطيع أن أتنفس»، الى شعار سرعان ما تم تداوله ضد العنصرية وتكميم الأفواه وكل أنواع التمييز، بل وربطه متظاهرون في عواصم أوروبية بفرض الحكومات سياسة ارتداء الكمامات. خُلعت الكمامات التي باتت رمزا للهيمنة والسيطرة بدلا من الوقاية والحذر، واحتلت أخبار إيجاد لقاح سريع لمنع انتشار الوباء بوجبة ثانية المرتبة الدنيا في قوائم أكثر الأخبار قراءة او اطلاعا إعلاميا.
احتلت صورة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واقفا امام كنيسة وهو يحمل الإنجيل، مساحة مساوية وموازية لصورة جورج فلويد والمتظاهرين، لتبين، مدى انقسام الشعب الأمريكي لا من ناحية لون البشرة فقط ولكن ما هو ابعد من ذلك، أي الناحيتين الاقتصادية والطبقية، المتداخلتين مع درجات الاستحواذ على مراكز السلطة، وكيفية الوصول اليها ومن ثم المهارة في صناعة الرضا الشعبي.
إن تأثير المظاهرات الامريكية سيبقى، محصورا بما سيفرض من تغيير على الوضع الداخلي، ولن يمس السياسة الخارجية التي هي في المحصلة سياسة دولة
ومن يراجع مسيرة ترامب سيجد أنه منذ ترشيحه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، البلد الأقوى في العالم عسكريا وتكنولوجيا، كممثل للحزب الجمهوري، عمل على استقطاب شرائح مجتمعية يعرف جيدا أنها من ستوفر له فرصة البقاء في منصبه دورة أخرى. وانه، خلافا، لعديد الرؤساء الأمريكيين ممن سبقوه، نفذ فعلا معظم وعوده التي أطلقها اثناء الحملة الانتخابية، بغض النظر عن درجة استهجان نسبة من الشعب الأمريكي لبرنامجه ولا إنسانية أسلوبه في التطبيق البرنامج، بالإضافة الى كراهيتنا، نحن الذين نعيش نتائج عنجهية السياسة الأمريكية الخارجية وحروبها المدمرة.
صحيح أن سلوك الرئيس الأمريكي اتسم بالشعبوية التحريضية، واقترن خطابه بخلق المهاترات والعنصرية بواسطة تغريدات لم يعهدها العالم من قبل أي رئيس سبقه، وصحيح أنه تميز بسرعة إصدار الأحكام وتعيين المستشارين او طردهم أو إقامة علاقات دولية او وضع حد لها بسرعة، خلال ساعات أحيانا، قد جعلته محط سخرية ومصدرا لا ينضب لرسامي الكاريكاتير، الا انه نجح في تحقيق ما أراده جمهوره من الشعب الأمريكي، الذي صّوت له وفق نظام ديمقراطي يُعتبر أساس الوجود الأمريكي، تبعا لدستور يكاد يكون مقدسا. وهذه نقطة بالغة الأهمية، غالبا، ما يتم تجاهلها أو التعامل معها من قبلنا. اذ نُسقط على الديمقراطية الامريكية واختيار الشعب لحكامه عبر الانتخابات مواقفنا نحو الديمقراطية والدساتير في بلداننا في ظل أنظمة استبدادية ـ تابعة ومتوارثة. حيث لم تنم الديمقراطية بشكل عضوي، ونادرا ما كان الدستور مكتوبا من قبل أبناء البلد أنفسهم في معظم البلدان العربية بل والأدهى من ذلك، غالبا ما نجدهما اما مستوردين أو مفروضين من « الخارج» وفي حالة العراق من قبل قوات الاحتلال الأمريكي
هذه الأرضية تستحق الانتباه عند الكتابة عن المظاهرات الامريكية الحالية والدعوة الى مساندتها باعتبارها « ثورة»، وكأنها نبعت من شعب أجبرته قوات الغزو والحكام بالنيابة، على خوض انتخابات مفروضة عليه قسرا. المفارقة (أو لعله الإحساس بالمرارة)، هي اننا لم نقرأ أي نداء من قبل أي حزب أو تنظيم عربي أو عالمي يدعو الى دعم المعتصمين العراقيين في انتفاضة تشرين/ أكتوبر بتكلفتها العالية بحياة 700 شهيد ومئات المختطفين وآلاف الجرحى، خلال أربعة أشهر فقط. ولا يزال الصمت القاتل سائدا على الرغم من استمرار الاحتجاجات في عشر مدن عراقية للمطالبة بمحاسبة قتلة المتظاهرين والتخلص من الاحتلالين الأمريكي والإيراني.
بعيدا عن الصحافة العربية التي يبدو كتابها إما مصدومين لأن «الكلام المنمق الذي تستخدمه الإدارات الأمريكية للحديث عن وجوه المساواة والعدالة المتحققة في المجتمع الأمريكي، ليس حقيقة»، أو كأنهم اكتشفوا العجلة حين يصفون قتل فلويد بأنه يبين « ممارسات التمييز العنصري في دولة تدعي أنها زعيمة المساواة والحرية في العالم»، نجد أن ترامب استطاع، الحصول على رضا المصوتين له، اذ حقق لهم تحسنا اقتصاديا ملموسا وتخفيض نسبة البطالة، وبناء جدار عازل مع المكسيك، ومعاملة المهاجرين بطريقة تثير رعب كل من يحاول اللجوء الى أمريكا، وطرد من لا تحتاجهم، والعمل على تقليل القواعد العسكرية وتكاليف نفقاتها الكبيرة، وإجبار الحكام الراغبين بالحماية الأمريكية ضد شعوبهم، على دفع تكاليف القوات، كما فعل مع المملكة العربية السعودية. كما لم ينكث بوعوده السخية للكيان الصهيوني، بل اُعتبرت « صفقة القرن» إنجازا له، والاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني هو «الشيء الصحيح الذي ينبغي فعله». لتليها الموافقة على مد المستوطنات أينما أراد المحتل. كل هذا بموافقة أو صمت الخانعين من الحكام العرب.
إن تأثير المظاهرات الامريكية سيبقى، محصورا بما سيفرض من تغيير على الوضع الداخلي، ولن يمس السياسة الخارجية التي هي في المحصلة سياسة دولة، كما أن معظم مواطني الولايات المتحدة وأوروبا لا يهتمون كثيرا بالسياسة الخارجية إلا إذا مست وضعهم الاقتصادي بشكل مباشر. ولنتذكر أن معظم الشعب الأمريكي والبريطاني أنتخب الرئيس جورج بوش ورئيس الوزراء توني بلير على الرغم من المظاهرات المناوئة للحرب على العراق في كلا البلدين وفي أرجاء العالم.
كاتبة من العراق
العراق: داعش
والكاظمي ونلسون مانديلا
هيفاء زنكنة
نشرت وكالة الأنباء العراقية، في 30 أيار/ مايو، بيانا لمديرية الاستخبارات أن القوات الأمنية بناء على معلومات استخبارية دقيقة اعتقلت 11 إرهابيا في مناطق مختلفة من جانبي الموصل الأيمن والأيسر.
يتزامن اصدار البيان مع عدم اصدار أي بيان حول هجوم ميليشيا التيار الصدري على خيام المعتصمين في ساحة التحرير ببغداد، واعتقال وقتل متظاهرين في مدن أخرى.
لماذا؟ كي يتماشى اصدار ومضمون البيان مع ازدياد التصريحات الحكومية الرسمية حول تصاعد عمليات تنظيم الدولة الإسلامية « داعش» وما يصاحبها، بالضرورة، من حملات اعتقال « الإرهابيين» في محافظات معينة، وُسمت بصبغة الإرهاب، منذ احتلال البلد عام 2003، ومنذ انبثاق مقاومة المحتل فيها.
فقد أدى الاستخدام السياسي لمفهوم «محاربة الإرهاب» وتوسيعه ليشمل بنودا قانونية عديدة، ومع الغياب شبه الكلي للقضاء النزيه، باعتراف المنظمات الحقوقية الدولية، الى منح الحكومات المحلية المتعاونة مع الاحتلال القدرة على شرعنة القاء القبض، لأي سبب كان، ورمي المعتقلين في غياهب السجون لسنوات بناء على شبهة أو وشاية أو خلاف، أو إصدار الاحكام السريعة بالإعدام بحيث استحق العراق لقب «المسلخ» من قبل رئيسة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أو تغييب المعتقلين فلا يُسمع لهم خبرا. كما أدى الاستخدام السياسي ـ الدعائي ـ التحريضي الى انعدام الثقة باي اجراء أو تصريح حكومي أو انتصار في عملية أو اعتقال خلية إرهابية. واعتبارها، منفردة او مجتمعة، مجرد تضليل آخر يستهدف المواطنين لتمشية أمور الفئة الحاكمة أو للتغطية على فسادها وجرائمها.
وإذا كان تعيين مصطفى الكاظمي، رئيس المخابرات السابق، رئيسا للوزراء قد دفع البعض الى الإحساس بوجود ومضة أمل في نهاية نفق النظام المظلم أو لأنه، حسب المثل العراقي «اللي يشوف الموت يرضى بالسخونة»، خاصة بعد أن حظي تعيينه بالترحيب من قبل المنظومة السياسية المهيمنة على مؤسسات الحكم والمليشيات على اختلاف أنواعها بالإضافة الى المباركة الامريكية الإيرانية، فان الدلائل تشير الى ان الوعود الجوفاء متجذرة في صميم النظام وان اطلاقها، بعد كل تغيير سطحي، ضروري لمصلحة النظام وليس الشعب.
فالتقدم لتحقيق الوعد بإجراء انتخابات نزيهة، وهو أحد مطالب انتفاضة تشرين/ أكتوبر 2019، يصطدم باللانزاهة في مفوضية الانتخابات، وتبادل أعضائها الاتهامات بالمحاصصة والفساد. وبات كشف فساد الانتخابات السابقة هو الموضوع الأول في أستوديوهات التلفزة، للدلالة على نزاهة المتنافسين على عضوية المفوضية، والنتيجة: الكل فاسد والكل نزيه في آن واحد.
كان الكاظمي قد وعد بحسم «ملف المغيبين، لأن عوائلهم ما زالت تنتظر معرفة هل هم أحياء أم تم الغدر بهم من تلك الميليشيات الإرهابية»، كما طالب رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين البرلمانية
أما فيما يخص المسؤولين عن قتل المتظاهرين فلم يُتخذ أي إجراء تقريباً لمساءلة قوات الأمن العراقية والحشد الشعبي على الرغم من وجود شهود عيان وفيديوهات وصور موثقة من قبل منظمات حقوقية محلية ودولية من بينها «وجود أدلة دامغة تشير إلى نمط تتعمد فيه قوات الأمن العراقية استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الدخانية الثقيلة لقتل المتظاهرين بدلاً من تفريقهم وذلك في انتهاك مباشر للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد كانت قوات الأمن على علم بمدى القدرة الفتاكة لهذه الأسلحة المقيتة، لكنها استمرت في إطلاقها كما يحلو لها». حسب برايان كاستنر، كبير مستشاري برنامج الأزمات المختص بالأسلحة والعمليات العسكرية في منظمة العفو الدولية. وكانت المنظمة قد وثّقت منذ 1 أكتوبر/تشرين الأول 2019 وطيلة فترة الاحتجاجات التي اندلعت في بغداد والمحافظات العراقية الجنوبية ـ استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة، وفي مئات الحالات القوة المميتة لتفريق المحتجين. وأصدرت منظمة «هيومان رايتس ووتش « ومركز جنيف الدولي للعدالة وعشرات المنظمات المحلية تقارير موثقة مماثلة، فاذا كان هذا كله متوفرا فلم لم يقم الكاظمي، كما وعد، عشية تعيينه، بما هو أكثر من تشكيل لجنة تحقيق، يعرف العراقيون جيدا انها تعني، في الواقع، دفن التحقيق؟
وأثار قيام عديد الدول بإطلاق سراح وجبات من السجناء، لتقليل خطر انتشار وباء الكورونا، قضية آلاف المعتقلين والمغيبين الذين لا يعرف مصيرهم وكلهم، تقريبا، من المحافظات التي تواصل الأحزاب الطائفية وميليشياتها وصمها بالإرهاب، ومعاملتها على هذا الاساس. تواصل حكومة الكاظمي تجاهل هذه القضية الحساسة التي تُعتبر مقياسا لمدى جديتها في التعامل مع استمرارية حملة التطهير التي سارت عليها الحكومات الطائفية السابقة. وكان الكاظمي قد وعد بحسم «ملف المغيبين، لأن عوائلهم ما زالت تنتظر معرفة هل هم أحياء أم تم الغدر بهم من تلك الميليشيات الإرهابية»، كما طالب رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين البرلمانية.
ان تحقيق العدالة، لا يتطلب تشكيل لجان جديدة تُضاف الى كومة اللجان النامية في الوزارات، بل يتطلب الاعتراف أولا بجسامة الجرائم المرتكبة ضد عموم الشعب والعمل ثانيا بوطنية صادقة على حلها. اللجان التي بدأ الكاظمي بتشكيلها لن تعيد للمواطنين حقوقهم لأنها استمرارية لسياسة التزوير والتضليل التي يعيشونها منذ 2003. وما تعرض له الناس من عقاب جماعي ونزوح قسري، لايزال مستمرا، ومصير آلاف الرجال والفتيان الذين اختفوا قسرياً على أيدي قوات الأمن أثناء النزاع، والإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان، يحتاج ما هو أكثر من تشكيل لجنة. فالنظام نفسه منخور بالفساد والطائفية والعنصرية مهما كان خطاب ساسته مغايرا على السطح. واستمرار بقاء المحتجين في ساحات المدن وخروجهم الى الشوارع، على الرغم من مخاطر وباء الكورونا، هو تصريح شعبي بعدم الثقة بما يُقال دون تطبيق، كما انه تأكيد على صلاحية المطالبة بوطن. وطن يوفر لأهله، جميعا، حقوقهم كمواطنين. بلا ساسة يدّعون العصمة، بلا مليشيات تمارس القتل بلا مساءلة، بقوات أمنية توفر لهم الحماية ولا تقتلهم وتشوههم. وطن يعيشون فيه بأمان ويتطلعون الى غد خال من الخوف. وطن وليس ساحة حرب تتنازع فيه أمريكا وإيران وما ينتجانه من منظمات ومليشيات إرهابية. وطن لا يحرم أهله من الكرامة وعزة النفس فـ» أي شخص أو مؤسسة تحاول أن تجردني من كرامتي ستخسر»، كما يُذكرنا نلسون مانديلا.
كاتبة من العراق
إحياء «داعش» في العراق
ضروري للمتنازعين عليه
هيفاء زنكنة
ظهرت بوادر تغير في خطاب مصطفى الكاظمي، بعد مرور 12 يوما فقط على تعيينه رئيسا لوزراء العراق، سواء كان خطابه موجها الى الادارة الامريكية ودول الاتحاد الأوروبي أو الشعب العراقي. فبعد أن كان يؤكد في خطبه الأولى، على أن حكومته «تنوي التحضير لإجراء انتخابات مبكرة ونزيهة، والتعهد بمحاربة فيروس كورونا المستجد في البلاد»، تَصدر خطبه، في لقاءاته مع السفير الأمريكي وسفراء دول الإتحاد الأوروبي، أمله في أن «تواصل الدول دعمها للعراق في حربه ضد داعش». وهو تغير كبير يعيد الى الأذهان سيرورة من سبقه من رؤساء الوزراء، مهما كان ادعاؤه مغايرا ومهما كانت مسميات «المنظمات الإرهابية» مختلفا. فمنظمة الدولة الإسلامية «داعش»، لم تكن تحتل المكانة الأولى في خطب التهنئة التي انهالت عليه سواء من قبل مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي أو محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني.
كان هَّم الجميع التوصل الى توازن أمريكي ـ إيراني، يتفاوض من خلاله الطرفان على صيغة توافقية لحل اختلافاتهما، وتقاسم السيطرة على العراق، بشكل يرضيهما، بدون أن يعرضا أمن بلديهما للتهديد. وقد منحهما الاتفاق الاولي على اختيار الكاظمي الإحساس بأن في «مقدوره المساهمة في التخفيض من التوترات بين الولايات المتحدة وإيران»، كما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية. كما عبَّرَ مايك بومبيو، عن حسن نية الإدارة الأمريكية تجاه إيران أكثر منه «الشعب العراقي» باستثناء إيران من العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها لمدة 120 يوما لتصدير الكهرباء الى العراق.
ما هي دلالات تغير خطاب الكاظمي اذن؟ لماذا «داعش» الآن وما هي الجهة المستفيدة من ظهوره في هذا التوقيت بالتحديد؟ هناك جهات عدة تحتاج إعادة نفخ الروح بداعش أو استحداث غيرها إذا استدعت الضرورة. بالنسبة الى البقاء الأمريكي بالعراق، هل من قبيل الصدف قيام «داعش» بعمليات متفرقة في البلد، والنظام مقبل على مناقشة وإعادة النظر في تفاصيل الاتفاقية الأمنية الموقعة بين العراق وأمريكا، بداية الشهر المقبل؟
الأمر الذي دفع الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة أي الكاظمي الى التصريح الفوري بأن « العراق ما زال بحاجة لبقاء قوات التحالف الدولي لتدريب القوات العراقية وتجهيزها لمواجهة التحديات». أما بالنسبة الى إيران، يوفر ظهور داعش أرضية شاسعة لاستمرارية بقاء وسيطرة الميليشيات الموالية لها، على الرغم من تزايد الغضب الشعبي على وجودها، بعد أن ثبت قيامها باستهداف منتفضي تشرين الأول/ اكتوبر وحملات الاختطاف والاغتيال التي طالتهم. ويشكل الظهور الداعشي طوق نجاة للحشد الشعبي، الذي انحدرت شعبيته التي كان قد نالها، عند تأسيسه بناء على فتوى المرجعية الجهادية.
داعش ذات الوجوه والأشكال المتعددة هي عدو جاهز مُهيأ للاستخدام عند الحاجة، ولو لم توجد فعلا لتم اختراعها. فكل الأنظمة، تقريبا، بحاجة إلى « عدو«، يستقطب دعم الشعوب لحكامها مهما كانوا
اذ يعاني «الحشد الشعبي» من كساد في الشعبية حتى بين اتباعه المخلصين وغيرهم من أبناء الشعب بسبب فساد القادة، وطائفيتهم المزمنة، واخلالهم بالوعود الدنيوية التي بُذلت بسخاء للشباب المنخرطين بصفوفه، بالإضافة الى توثيق عديد الجرائم التي ارتكبها افراده في «المناطق المحررة»، والتي ترقى الى مستوى جرائم ضد الإنسانية، حسب تقارير منظمات حقوقية دولية. لذلك، قام الكاظمي، بنفسه، بزيارة رئيس الحشد في مقره الرئيسي وارتدى زي الحشد بتظاهرة إعلامية لم تحظ بها اية جهة أخرى وذلك لطمأنة إيران على عدم المس بأذرعها داخل البلد.
خلال أيام قليلة، عادت «داعش» لتغطي على وباء كورونا، وعلى فشل التعامل معه، وعلى الفساد المكشوف، وكل ما يراد التستر عليه إعلاميا وسياسيا. عادت لتستعيد مكانتها لدى الساسة كأداة جاهزة للترويع وتسويغ الإرهاب بحجة محاربة الإرهاب.
فعودة «داعش» ضرورة حتمية لكل المتنازعين على العراق وهو الخيار الأفضل لاستمرار منظومة الفساد السياسي والميليشيات. فما ان يُذكر اسم «داعش» حتى تُبرر سرقاتها ونهبها مليارات النفط بالإضافة الى استحواذها على أموال المساعدات الخارجية المقدمة لمحاربة «داعش» بحجة الدفاع عن «الشعب العراقي». بينما الحقيقة هي ان الكل، باستثناء «الشعب العراقي»، بأمس الحاجة الى داعش أو أية منظمة إرهابية أخرى. داعش ذات الوجوه والأشكال المتعددة هي عدو جاهز مُهيأ للاستخدام عند الحاجة، ولو لم توجد فعلا لتم اختراعها. فكل الأنظمة، تقريبا، بحاجة الى «عدو«، يستقطب دعم الشعوب لحكامها مهما كانوا. «داعش» الوقت الحالي هو «شيوعية» فترة الحرب الباردة و«مكارثية» الإدارة الامريكية ضد مثقفيها في خمسينيات القرن الماضي. وها هو سيف داعش يُشهر من جديد، بعد غيبة، لتعلن حكومة الكاظمي، كما الحكومات التي سبقتها، شن عمليات ضد داعش، باسم «اسود الجزيرة» في ذات المحافظات التي لم يزل مئات الالاف من سكانها قد هُجروا قسرا ولايزالون يعيشون في الخيام، ولم يكن الناطق الرسمي باسم قائد القوات المسلحة الكاظمي قد أكمل تصريحه بوجوب إبقاء القوات الأمريكية حتى شن طيران «التحالف» غارة على جنوب غربي محافظة نينوى. المحافظة التي لاتزال رائحة جثث ضحايا القصف الأمريكي تتخلل هواء خرائبها.
لم تعد الساحة السياسية، اذن، بعد أسبوع واحد من اعلان الحكومة الجديدة، تقتصر على «النزاع» الأمريكي ـ الإيراني بل أتت أضافة «داعش» وبالحجم الذي يستدعي القيام بعمليات عسكرية أرضا والقصف جوا، كعامل مستجد قد يعمل، على تقوية حضور «المُتنازعين» الأمريكي والإيراني وليس استعادة السيادة العراقية، حسب وعود الكاظمي في خطبه الأولى، فبقائهما وفق تقسيم الجو لأمريكا والأرض لإيران، مُفيد للطرفين خاصة وان استراتيجية أمريكا العسكرية لم تعد تعتمد على إبقاء المعسكرات والقوات على الأرض بل على الطائرات بلا طيار والعمليات الخاصة وكل أنواع التقدم التكنولوجي عن مبعدة بالإضافة الى القوة الناعمة، بجوانبها الثقافية والتعليمية. فالاتفاقية الاستراتيجية المنوي مراجعتها لا تقتصر على الجانب العسكري والأمني فقط كما يُشاع تضليلا.
ولعل التغير الأكبر الذي سيطرأ، جراء إحياء تنظيم داعش، هو مدى نجاح منظومة الفساد السياسية في استخدام الترهيب من داعش للقضاء على انتفاضة تشرين / أكتوبر نهائيا، بعد ان فشلت كل الأساليب القمعية بالإضافة الى فيروس كورونا في ذلك. اذ تشير دلالات تغير خطاب الكاظمي، خلال بضعة أيام من تعيينه، ان من وافقوا على تعيينه من أحزاب وميليشيات ومحتلين سيستعينون، من جديد، بشعار «محاربة الإرهاب» لقمع كل صوت مستقل يطالب باسترجاع الوطن من أيديهم، وسيبقى مدى نجاحهم مرتبطا بعودة المنتفضين إلى الساحات، بذات القوة والوعي الذي فشل الفاسدون باختراقه.
كاتبة من العراق
إنهم لا يعرفون
الشعب العراقي
هيفاء زنكنة
انهالت التهاني على « العراق»، كما الحامض حلو على رأس عروس أو رأس ولد في حفل ختانه. وأخيرا، صار للعراق رئيس وزراء جديد، يدعى مصطفى الكاظمي. صحيح أنه غير منتخب، رشحه رئيس جمهورية غير منتخب، إذ لم تزد نسبة الناخبين، في المرة الاخيرة، عن 18 بالمئة، إلا أن هذا غير مهم، فبعد انقضاء خمسة أشهر على اجبار المنتفضين رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على الاستقالة، وبعد فشل مرشحين اثنين في الوصول الى خط النهاية، لم يعد هناك الكثير من الأمور المهمة بالنسبة الى ساسة « العملية السياسية» ومديريها. المهم أن يتم تعيين رئيس وزراء، أيا كان، وتقديمه باعتباره المنقذ بعد أن تم تعليق كل المساوئ، بضمنها قتل المنتفضين، بمشاركة وعلم الجميع، على شماعة رئيس الوزراء السابق.
حصلت المعجزة اذن، وُلد الطفل الذي يتنازع على أبوته اثنان، في بلد يدعى العراق. حال اعلان الولادة/ تشكيل الحكومة الناقصة، سارع الأبوان المتنازعان للاحتفال. مايك بومبيو، وزير خارجية أمريكا، كان الأول. لم يتحمل الانتظار فأرسل تغريدة ذكر فيها أنه «من الرائع التحدث مع رئيس الوزراء العراقي الجديد». وكاد، لفرط سروره أن ينهي التغريدة لولا تذكره أنه نسى إضافة الكليشيه الجاهزة أي « الشعب العراقي» أو أهل البلد المضَّيف (كما هو متعارف لدى قوات الاحتلال على تسمية أهل البلدان المحتلة)، فأكمل قائلا: «لقد تعهدت بمساعدته على تنفيذ أجندته الجريئة من أجل الشعب العراقي». ونافسه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، باستخدام كليشيه « الشعب العراقي»، مؤكدا « أن إيران ستقف دائما بجانب الشعب العراقي».
كلاهما يدعيان أنهما إنما يقومان بكل ما في وسعهما، وبذل كل التضحيات المادية والبشرية، من أجل « الشعب العراقي»، مما يثير، في خضم تبادل التهاني وتنفس الصعداء بالتصويت على الحكومة الجديدة، تساؤلا جوهريا، قلما يتم التطرق اليه، منذ غزو واحتلال البلد عام 2003، وهو: عن أي شعب يتحدثان؟ وأين هو هذا « الشعب العراقي» الذي يدّعيان الاهتمام به والعمل من أجله في مسار نزاعاتهما واقتتالهما ومفاوضاتهما على أرضه، بعيدا عن أراضيهما، حفاظا على مصالح أمنهما القومي؟ هل هو شعب افتراضي من « مكونات» استحدثت ونُشرت على ارض البلد، كالعشب الضار، آملين ان تكون، بمرور الوقت، الشعب المُراد تفتيته بين ديمقراطية الشيطان الأكبر وولاية فقيه الشيطان الأصغر؟
ماذا عن الشعب الآخر الذي قاطع الانتخابات، بشكل شبه جماعي، والشعب المقيم، بملايينه، في مخيمات النازحين والمدن المهدمة، ومئات الآلاف من المعتقلين والمسجونين والمختفين؟
إنهم «الشعب العراقي» الذي خرج مطالبا باستعادة وطنه وسيادته وهويته الوطنية ورحيل المحتلين الأمريكي والإيراني
ماذا عن الشعب الذي تكاد الاحتجاجات والاعتصامات أن تكون، لاستمراريتها، مطبوعة على جيناته ضد قوات الاحتلال الانكلو أمريكي أولا ثم ضد حكوماته بالنيابة والميليشيات المدعومة إيرانيا ثانيا، وضد كليهما وكل ما يمثلانه في انتفاضته الأخيرة منذ تشرين / أكتوبر 2019؟ الانتفاضة التي أجبرت عادل عبد المهدي على الاستقالة بعد أن تم تقديمه، كما هو مصطفى الكاظمي اليوم، باعتباره السياسي المعتدل، مالك الحل السحري لفض النزاع بين الشيطان الأكبر والأصغر، وخلق التوازن المطلوب بين المُحتَلين وساستهما المحليين. الانتفاضة التي لم تنجح الميليشيات، بتعاون أو تعامي القوات الحكومية في القضاء عليها، بل تأجلت، جزئيا، بعد انتشار وباء كورونا وحرص المنتفضين على سلامة عموم الشعب ليثبتوا بذلك، أنهم «الشعب العراقي»، المُهمل، المستهان به، الذي عمل المحتل على تغييبه، ومع ذلك يواصلون النضال بتكلفة الدم الغالي الذي دفعوه، بآلاف الضحايا ومئات آلاف الجرحى والمختطفين. إنهم « الشعب العراقي» الذي خرج مطالبا باستعادة وطنه وسيادته وهويته الوطنية ورحيل المحتلين الأمريكي والإيراني، وليس، كما يردد يوميا، ومع كل تغيير لأقنعة الوجوه الفاسدة، ان يكون حشية أرض يتبادل عليها المحتلون الأوضاع.
إن الصورة التي رسمها عدد من العراقيين المتعاونين مع الإدارة الامريكية في فترة ما قبل الغزو، وكان مصطفى الكاظمي واحدا منهم، عن شعب سيستقبل قوات الاحتلال بالزهور والحلوى، تمزقت مع قتل أول جندي للاحتلال، كما هي صورة الشعب الراكض للتضحية بنفسه من أجل «الأمام» ، التي فقدت وهجها العقائدي، بعد مرور 17 عاما على الاحتلال، وتأكد الشعب من أن شجرة التضليل سواء كانت مستندة على الديمقراطية أو « الدعوة» الدينية / الطائفية، بقيت هوائية بلا جذور في المجتمع العراقي، على الرغم من كل الجهود التي بذلها رؤساء الوزراء الذين سبقوا الكاظمي بدءا من أياد علاوي والجعفري ونوري المالكي وحيدر العبادي وانتهاء بعادل عبد المهدي، والذين تم تعيينهم، كلهم وفق المحاصصة الطائفية وإن بتعديلات طفيفة على السطح مثل إضافة صفة « المعتدل» أو « المستقل»، وكلهم، كما الكاظمي، كان الشرط الثاني لتعيينهم هو الحصول على رضى أمريكا وإيران معا، بحجة تحقيق ما يسمى بالتوازن السياسي داخل العراق.
طوال هذه الفترة، تعامل المحتل وساسته المحليون مع الشعب باعتباره هامشا في صفحة يكتبونها هم، الى أن رجرجت انتفاضة تشرين الأوضاع بقوة وكان بالإمكان أن تؤدي الى تغييرات حقيقية تمس جوهر العملية السياسية والفساد المستشري لولا انتشار وباء كورونا الذي وفّر للنظام فرصة تمديد البقاء. الأمر الذي يعيد الى الأذهان ذات التساؤلات التي واجهها رؤساء الوزراء السابقين وأهمها مدى معرفتهم بالشعب العراقي الحضاري، الأبي، المعتز بكرامته وحقوقه، ومدى ولائهم وتمثيلهم لهذا الشعب والوطن، بعيدا عن الرطانة الخطابية. وبالنسبة الى الكاظمي، هل سينفذ مطالب المنتفضين، ومن بينها تقديم المسؤولين عن قتل المتظاهرين الذين زاد عددهم عن 600 شخص وجرح أكثر من 24 ألف آخرين، الى القضاء، خاصة وأنها خطوة ستتطلب التحقيق معه، أيضا، بحكم كونه رئيسا للمخابرات، يفترض فيه، معرفة الفاعلين، أكثر من أي شخص آخر في حكومة تتحمل المسؤوليّة المباشرة عن الكثير من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وانتهاكات ترتقي الى جرائم ضدّ الإنسانيّة؟
ثم أليس هذا هو « نفس الطاس ونفس الحمام»، ما دامت الحكومة الجديدة، قد تم اختيار أعضائها وتعيين رئيسها من قبل نفس أشخاص النظام الفاسد وأحزابه وميليشياته؟ يشير نزول المحتجين الى الشوارع، في بغداد وعدة مدن أخرى، حال انعقاد الجلسة الاولى للحكومة الجديدة، أنهم يعرفون الأجوبة مسبقا وأن لعبة التسويف والمناورات، من ذات الوجوه، لم تعد تنطلي على أحد.
كاتبة من العراق
حرية الصحافة في مقياس
القمع الحضاري وغير الحضاري!
هيفاء زنكنة
إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد جعل واحدة من مآثره، مهاجمة الصحافيين المستقلين، بكافة أجهزة الإعلام، وبشكل شبه يومي، حتى في اليوم العالمي لحرية الصحافة (3 مايس)، فأنه انما يمارس، بذلك، تقليدا قديما لا يقتصر، كما قد نتوهم، على الحكومات العربية القمعية، بل ويحتضن الدول الغربية التي ترى نفسها مُصّدِرة للديمقراطية وحرية التعبير.
فمع الإقرار بوجود الاختلاف، بدرجات، حسب طبيعة النظام، وانتقائية سبل التعامل مع من يراد تكميم أفواههم، التي تتراوح ما بين الأساليب «الحضارية الناعمة» كالابتزاز والاغواء المادي والتهديد بجرائم فساد أو تهم أخلاقية والمنع من ممارسة المهنة، كما في الدول الغربية الى الأساليب «غير الحضارية»، كالاعتداء الجسدي والاعتقال والاختطاف والقتل، وهو ما يُطبق في بلداننا.
وإذا كان القتل الوحشي قد غّيب الصحافي السعودي المعارض جمال الخاشقجي فان عملية تغييب الصحافي الاستقصائي جوليان أسانج، تتم بشكل يماثل من يُفصد دمه بشكل بطيء، من خلال العزل الانفرادي ولَّيْ القوانين لتسليمه الى أمريكا حيث سيواجه الحكم بالسجن لمدة 75 عاما. وهي عملية تنفذها الحكومة البريطانية لصالح الإدارة الامريكية التي لا تغفر للصحافي ان يمس مصالحها أو أن يكون مستقلا بشكل حقيقي. فكان العمل على تحطيم حياة أسانج وفريق « ويكليكس» الذي كشف عن مئات الآلاف من الوثائق الأمريكية وغيرها الفاضحة لمعلومات عن جرائم بحق مواطني البلدان الديمقراطية نفسها كما البلدان المستهدفة بالغزو او الحصار او الابتزاز.
إنها المعلومات التي أريد لها أن تبقى طي النسيان لما تحويه من مساس بحرية الفرد والرأي ومساحة التآمر عليه والجرائم التي ترتكب باسمه، بذريعة «الأمن القومي».
يشكل ادعاء الحفاظ على « الأمن القومي» واحدا من أكثر الذرائع التي تستخدمها الأنظمة القمعية للسيطرة على الشعوب، وغالبا ما يكون الصحافيون من أوائل الضحايا.
ففي إيران، ثلثا أعداد المعتقلين هم من الصحافيين الذين يدفعون ثمنا مكلفا بسبب محاولتهم التحقيق في ملفات فساد مالي ترتبط بأشخاص نافذين في هيكل النظام، حسب منظمة « مراسلون بلا حدود»، في تقريرها الصادر حديثا، وتبوأت فيه إيران المرتبة 170 من أصل 180 دولة حول العالم في 2019. وتعتبر سلطات الاحتلال الصهيوني استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين وقتلهم أمرا يدعو للاحتفال وتبا لكل القوانين باستثناء قوانين الاحتلال العنصرية. من بين الشهداء، سقط في العام الماضي صحافيان، وفقد ثلاثة صحافيين على الأقل أعينهم بشكل نهائي. ولم تتوقف حملة الاعتقالات والاستجواب والاعتقال الإداري بالإضافة الى اغلاق وسائل إعلام فلسطينية بحجة التحريض على العنف.
يتعرض الصحافيون في العراق لكل أنواع المخاطر بدءا من الاعتداء الجسدي والتهديد إلى الاختطاف والقتل على أيدي الميليشيات، بينما يقف المسؤول الحكومي متفرجا أو مشاركا في جرائم الميليشيات
المفارقة الموجعة أن تتماهى سلطات دول عربية في القمع وتكميم الأفواه مع كيان الاحتلال الصهيوني والمنظمات الإرهابية المدعومة محليا وعالميا. وتمثل ممارسات الحكومات العراقية المتعاقبة منذ غزو البلد واحتلاله عام 2003، نموذجا صارخا لنظام يدّعي مسؤوليه، كما في الكيان الصهيوني، الديمقراطية واحترام حق الرأي والتعبير.
«سلامة الصحافيين في خطر أكثر من أي وقت مضى»، هو أحد عناوين تقارير دولية عدة تتناول وضع الصحافيين بالعراق. وهو وضع يشي باللامسوؤلية القانونية والإنسانية والأخلاقية لنظام فاسد يستهين بحياة مواطنيه، ويصوب رصاصه على كل صحافي مستقل يحاول الكشف عن الفساد ومرتكبي الجرائم، أو فضح حملات الاعتقال والتعذيب المنهجي أو تغطية الاحتجاجات، كما في الأشهر الأخيرة، ومنذ اندلاع انتفاضة تشرين الأول/ أكتوبر 2019. اذ يتعرض الصحافيون لكل أنواع المخاطر بدءا من الاعتداء الجسدي والتهديد إلى الاختطاف والقتل على أيدي الميليشيات، ومن يطلق عليهم تسمية « مسلحون مجهولون»، بينما يقف المسؤول الحكومي متفرجا أو مشاركا في جرائم الميليشيات.
وإذا كانت « مراسلون بلا حدود» قد وثقت اختطاف 48 إعلاميا واعدام 13 صحافيا من قبل منظمة الدولة الإسلامية « داعش»، اثناء سيطرتها على مدينة الموصل، فإنها تواصل توثيقها لخطورة ما يتعرضون له « في ظل تعنت الشخصيات السياسية والدينية التي تعتبر نفسها مقدسة وغير قابلة للانتقاد»، وأي نشر عنها يعرض الصحافيين للملاحقات بتهمة «إهانة رموز وطنية أو دينية».
ولا تدخر الحكومة، عبر هيئة تنظيم الإعلام، جهدا في منع أي بث مباشر وتعطيل خدمة الإنترنت وسحب التراخيص الإعلامية ورفع الدعاوى والغرامات. وعلى الرغم من ازدياد حالات الخطف والاغتيال وتوثيق العديد منها ووجود شهود العيان، لم يحدث وتم اعتقال أو معاقبة أي شخص واقصى ما تفعله الحكومة هو الإعلان عن تشكيل لجان تحقيق تزويقية.
تعكس آلية التعامل مع أجهزة الإعلام ذكاء الأنظمة وقدرتها على احتواء الأصوات الممثلة لشرائح معينة من الشعب، في الأوقات العادية، أو غالبية الشعب، عند الحاجة، في ظروف معينة، كالأزمات الاقتصادية والحروب والنزاعات المحلية والفترات السابقة للانتخابات. فالرئيس ترامب، مثلا، يختار التهجم على أجهزة إعلام معينة، مهما كانت حرفية إعلاميها، لأنه متأكد من استقطاب أجهزة إعلام أخرى ترتبط معه، ومع الطبقة التي تجد فيه ممثلا لها، بمصالح مشتركة.
تتبدى هذه القدرة في الجمع بين إطلاق الأكاذيب واتهام أجهزة الإعلام بالكذب، في ذات الوقت، بدرجات أقل حدة في أنظمة بلداننا، لأنها تجد في التغييب العنيف والمباشر للصحافيين والأصوات المعارضة، كالاختطاف والقتل، حلا سريعا يساعدها، أيضا، على ترويع بقية أبناء الشعب وتجذير الإرهاب الحكومي، مع الانتباه الى عامل مشترك يكاد يجمع ما بين كافة أجهزة الإعلام، في العالم، وهو قدرة الأحزاب السياسية الحاكمة أو المتنفذة على ركوب أجهزة إعلام معروضة للاستئجار أو البيع ، بكل العاملين فيها، من صحافيين وغيرهم، أو تأسيس شبكات إعلام كذراع لها، وتسييرها وفق ايديولوجيتها ومصلحتها سواء كانت سياسية او دينية او اقتصادية او كلها معا. تُبرر هذه التداخلات بانها علاقة مصالح متبادلة، وحين تؤدي، كما رأينا في تسويغ احتلال العراق، الى أضرار جسيمة بحق البلد وأهله، فأنها تُروج باعتبارها « وجهة نظر».
بعيدا عن قمع الأنظمة، أينما كانت، وجهودها في تصنيع الرضا الشعبوي المبتذل، يبقى صوت الصحافي المستقل مخيفا للطغاة والمحتلين، وتبقى القوانين الوطنية والدولية، التي توجب حماية الناس، واعتبار الاستهداف المتعمد للمدنيين، بمن فيهم الصحافيون وأجهزة الإعلام، في عداد جرائم الحرب، السلاح الأقوى لتحقيق العدالة للجميع، ومع تنامي دور صحافة المواطن التي غيّرت دور المواطن من مجرد متلق إلى فاعل لنقل المعلومة والحدث والتوثيق في عصر، نأمل أن يساهم في إزاحة كابوس السلطة وأنظمة الاستبداد عنها.
كاتبة من العراق
الحقيقة ـ الضحية الأولى
بين رويترز والنظام العراقي
هيفاء زنكنة
سحبت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية ترخيص عمل وكالة الأنباء الدولية « رويترز»، لمدة ثلاثة أشهر وتغريمها 21 ألف دولار، لأنها نشرت تقريرا في الثاني من نيسان/ أبريل، نقلت فيه عن ثلاثة أطباء من المشاركين، بشكل وثيق في عملية إجراء الاختبارات لرصد الإصابات بفايروس كورونا، وعن مسؤول في وزارة الصحة، تأكديهم أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفايروس في البلاد، يفوق الرقم المعلن من قبل الوزارة بآلاف، وان المصادر فضلت عدم الإفصاح عن اسمائها لأن السلطات أمرت الطواقم الطبية بعدم الحديث لوسائل الإعلام. أكدت «رويترز»، يوم 14 نيسان/ أبريل، صحة التقرير الذي، حسبما ذكرت، استندت فيه على « مصادر طبية وسياسية مؤهلة ومتعددة وإن رأي وزارة الصحة كان ممثلا فيه بصورة كاملة».
من الذي نصدقه عند قراءة تقرير عن مدى انتشار الإصابات بالفايروس، الناطق الرسمي العراقي أو وكالة الأنباء الأجنبية؟ أليس من الطبيعي أن نصدق التصريحات العراقية باعتبارها الأدرى بأحوال المواطنين؟ فلِم اذن يختار الكثيرون، التشكيك بالتصريحات الرسمية والميل نحو تصديق وكالات الأنباء الأجنبية؟
السبب الرئيسي هو تجذر الإحساس بعدم الثقة تجاه كل ما يقوم به النظام ويُصرح به، في عديد المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية، وانعكس سلبا على الجانب الصحي والتعليمي. وهو إحساس قديم تنامى بشكل متسارع بعد غزو واحتلال البلد في 2003. اذ ازدادت الهوة ما بين ما هو منجز وما يُصرح به بشكل هائل. وباتت منصات التصريحات الحكومية أماكن لإطلاق الأكاذيب المفضوحة. خاصة بعد ان أصبح الساسة ينطقون بأصوات سيدهم المحتل واختلطت التصريحات « الحكومية» بتصريحات متحدثي قوات الاحتلال. فمن الناحية الإعلامية: تم تسخير صحافيين عراقيين لنشر مقالات تحمل أسماءهم إلا انها مكتوبة من قبل الجهاز الدعائي لقوات الاحتلال.
هدفت المقالات الى تشويه المقاومة وتقديمها باعتبارها «سنية ـ إرهابية» والى تعزيز موقع قوات الاحتلال كطرف إنساني محايد في «الاقتتال» بين العراقيين أنفسهم. 30 دولارا كانت مكافأة الصحافي لقاء المقالة الواحدة، بينما كانت الخسارة جسيمة لا تعوض وهي ثقة المواطن بنزاهة ومصداقية الصحافة وانعكاس عدم التصديق على ما تقدمه من معلومات حتى لو كانت حقيقية ولصالح المواطن فعلا.
من الناحيتين الأمنية والعسكرية، يعيش المواطن، غالبا، على اخبار الوكالات والصحافيين الأجانب ليعرف ماذا يحدث في بلده، بل وعلى الرغم من أكاذيب قوات الاحتلال المنهجية، كُشفت بعض الجرائم المروعة من قبل جنود للاحتلال، أصيبوا بنوبة صحو ضمير، وليس من قبل مسؤولين أو ساسة عراقيين.
ينشغل مسؤولو وزارة الصحة، بمناصبهم الموزعة ضمن المحاصصة الطائفية ـ السياسية، بتوقيع عقود مستشفيات لا تكتمل، واستيراد أدوية ومعدات وهمية
ولنأخذ الأمثلة التي خضّت العالم أخلاقيا. طقوس التعذيب والقتل في أبو غريب، عام 2004، من الذي كشفها؟ استخدام اليورانيوم المنضب والفسفور الأبيض ضد المقاومة في مدينة الفلوجة في 2004، من الذي كشفه؟ مجزرة حديثة في 2005، وحرق الطفلة عبير الجنابي وعائلتها بعد اغتصابها، عام 2006، من الذي كشفهما؟ مجرم الحرب إدوارد غالاغر، ضابط الصفّ في وحدة القوات الخاصة بالبحرية الأمريكية، من الذي كشفه؟ لم يكشف هذه الجرائم، التي تشكل قمة الجبل الجليدي المطمور، ساسة أو مسؤولون عراقيون، ولم يشر أي منهم اليها الا من باب اتهام الضحايا بالإرهاب مما يعني الحكم عليهم انهم بالموت.
تستدعي هذه المراجعة التساؤل عن ماهية المقياس الأخلاقي الذي يستند اليه المتحدثون الرسميون، وكيف التحقق من صحة تصريحاتهم، والوثوق بهم، عند مقارنتها بسجل صمتهم أو تواطئهم المستدام، إزاء جرائم يدينها العالم الإنساني، منذ عام 2003 وحتى اليوم؟ آخذين بنظر الاعتبار ان ما يمر به العراق ليس تاريخا سحيقا ليس بالإمكان التحقق من صحة وقائعه تاركا الناس متأرجحين بين هذه السردية وتلك. بمعنى أنها وقائع معاشة، يعرفها المواطن كل المعرفة. وفي عصر الصورة والفيديو والتواصل الاجتماعي والتوثيق والأرشفة اليومية من الصعب جدا إخفاء حقيقة الأحداث إلا إذا أراد المرء باختياره ولمصلحته الا يرى. ولعل أكاذيب مسؤولي النظام ومتحدثيه الرسميين عن الجرائم التي ارتكبت بحق المنتفضين في ساحات التحرير منذ تشرين/ أكتوبر 2019 وحتى الأيام الأخيرة، أفضل مثال عن الذين يختارون الا يروا، وإذا رأوا فبعين واحدة. ألم يقفوا اليوم بعد الآخر مصرحين بان قتل وجرح واختطاف آلاف المنتفضين، والموثقة بالصور والفيديوهات والفضائيات، مرتكبة من قبل «طرف ثالث» او «مجهولين»؟
ما ساعد على انخفاض الثقة بصدق وأخلاقية المتحدثين الرسميين، أيضا، سياسة تكميم أفواه الصحافيين إذا ما حدث ومس أحدهم عصبا حيا في جسد أحد المسؤولين الحكوميين أو قادة الميليشيات او من يتمتعون بالعصمة الدينية. فكان التخلص من الصحافيين الأجانب، واحدا من الخطوات الاولى لمنع اطلاع العالم الخارجي على ما يجري بالعراق، ثم تم التركيز على الإعلام العراقي المستقل ليحتل البلد، على مدى سنوات، أعلى قائمة الدول الأكثر خطرا للعمل الصحافي. وحين ظهرت صحافة المواطن ومارسها ناشطون، معظمهم من الشباب، امتدت إليهم ايادي ميليشيات الاختطاف والقتل، خاصة منذ انبثاق انتفاضة تشرين التي لاتزال مستمرة، وان بشكل محدود، بناء على قرار اتخذه المنتفضون حفاظا على حياة عموم المواطنين من انتشار وباء كورونا. وهو موقف ناضج يؤكد حرصهم على حياة الجميع، كما هو موقف العاملين في الجهاز الطبي، الذين يقومون بجهود جبارة لرعاية المصابين وعموم المواطنين، ضمن حدود الإمكانيات الفقيرة وظروف الإهمال التي يعيشها الجانب الصحي بانحدار متسارع منذ الاحتلال، والتي يتحمل مسؤوليتها ساسة العقود الوهمية، الى حد باتت فيه مستشفيات واحد من بلدان العالم الغنية، متهالكة تستجدي الأدوية والأجهزة والمعدات من المحسنين، بينما ينشغل مسؤولو وزارة الصحة، بمناصبهم الموزعة ضمن المحاصصة الطائفية ـ السياسية، بتوقيع عقود مستشفيات لا تكتمل، واستيراد أدوية ومعدات وهمية، معلنة بين الحين والآخر، عن انجاز «ضخم» لصالح المواطنين، كما فعلت منذ أيام، حين تباهت بتجهيز مركز للتبرع بالدم بكراسي عدد أربعة، مما دفع احد المواطنين الى ارسال تهنئة الى الوزارة، داعيا الله عز وجل ان تتمكن الوزارة من شراء مناضد شاي لتوضع امام الكراسي.
تفاصيل الفساد المعلب بالتضليل والاكاذيب، هي التي تدفع المواطن الى الشك بما يقدمه « الناطق الرسمي» من اهل بلده، ويفضل هضم وتداول الاخبار المقدمة اليه من خارج البلد. وهو موقف قد يبدو بسيطا الا انه بترجرجه خطر جدا ما لم يكن المواطن نفسه واعيا، وقادرا على الفصل بين العمل الحقيقي الذي تؤديه الهياكل الطبية مثلا والتضليل الإعلامي لنظام فاسد خاصة وان منع وكالة مثل «رويترز» سيؤدي الى تعزيز مصداقيتها وليس العكس.
كاتبة من العراق
هل يفهم العالم الآن
محنة الأسير الفلسطيني؟
هيفاء زنكنة
إذا كان فايروس كورونا قد فاجأ حكومات وسكان الدول الغربية بغزوه لبلدانهم، وما سببه من حصد للأرواح وخسارة اقتصادية وتفكيك التقارب المجتمعي، بالإضافة الى زرع القلق والخوف وعدم الاستقرار، جراء عدم معرفة ما سيجلبه الغد، والحرمان من الحياة اليومية العادية المألوفة لديهم، فان غزوه بلداننا لم يأت كمفاجأة بل كإضافة تراكمية الى ما يعيشه أهلنا من صنوف الغزو والاحتلال الأجنبي والاستبداد المحلي، وانعكاساتها حتى على الهواء والماء والتربة. توليفة الهيمنة على حياة المواطن باتت جزءا لا يتجزأ من وجوده في معظم البلدان العربية، فجاء الفايروس ليزيد من حجم المأساة واختزال حياة الانسان فيها الى صراع لا هوادة فيه من اجل البقاء.
وإذا كان فايروس كورونا قد مس كل البلدان العربية، مسببا الموت أينما حّلَ، بأعداد متفاوتة، وحسب قدرة كل بلد على الدفاع عن نفسه، فإن فلسطين المحتلة، بأسراها وغَزَتها (غزة السجن الأكبر في العالم)، تبقى الأكثر هشاشة بين كل البلدان، وان بدا ظاهريا غير ذلك، في ظل الترويج الدعائي الصهيوني، وتهافت عدد من الحكومات العربية على طمس القضية الفلسطينية.
في فلسطين المحتلة، يتعاون فايروس كورونا مع سلطة الاحتلال العنصرية على حرمان الفلسطينيين مما يمدهم بقوة الصمود والتضحية والبقاء، بعد محاولاتها في تدميره عبر الاستيطان والتهويد والضمّ والحصار. ويتزايد تأثير الفايروس بشكل مضاعف على الأسرى الذين وصل عددهم، نهاية شهر آذار 2020، إلى ما يقارب 5000 أسير ومعتقل، من بينهم 432 معتقلاً إدارياً، و41 أسيرة، و7 نواب في المجلس التشريعي، و183 طفلاً منهم 20 تحت 16 عاما، حسب «منظمة الضمير». ولا تزال سلطات الاحتلال مستمرة في اعتقال الفلسطينيين وزجّهم في مراكز التوقيف والتحقيق والسجون، التي تفتقر للحد الأدنى من متطلبات الحياة الإنسانية. حيث اعتقلت منذ بداية انتشار الوباء ما يقارب 357 معتقلاً ومعتقلة منهم 48 طفلا و4 نساء، في ذات الوقت الذي تقوم فيه عديد الدول بأطلاق سراح السجناء تفاديا لانتشار الفايروس بينهم.
وكأن انعكاس معاناة الأسرى والأسيرات وظروفهم المعيشية والصحية القاسية، خاصة المرضى منهم، على أسرهم ليس كافيا، قامت سلطات الاحتلال، بعد تفشي الفايروس، باتخاذ اجراءاتٍ تمس الأسرى والمعتقلين بحجة مواجهة الفايروس، حيث أعلنت العمل بنظام الطوارئ، الذي يتضمن إلغاء زيارات عائلات الأسرى وزيارات المحامين.
عن هذه القيود الإضافية كتبت المحامية فدوى البرغوثي، زوجة الأسير القيادي مروان البرغوثي، الذي يقضي عامه الـ(19) في سجون الاحتلال: «بعد زيارتي التي انتظرتها ثلاث سنوات، وسُعدت باللقاء الذي ساعدني على تجميع الصورة والملامح من جديد، بدأت أُحضر نفسي للزيارة الثانية. قبلها بأيام قليلة بلغنا الصليب الاحمر بوقف كافة الزيارات للسجون، لأعود أحسب الأيام من جديد لزيارة قادمة حين تسمح لنا كورونا».
في فلسطين المحتلة، يتعاون فايروس كورونا مع سلطة الاحتلال العنصرية على حرمان الفلسطينيين مما يمدهم بقوة الصمود والتضحية والبقاء، بعد محاولاتها في تدميره عبر الاستيطان والتهويد والضمّ والحصار
وفي ندائها الموجه الى العالم الذي ترى انه ذاق، أخيرا، طعم الحجر ومعنى العزل لعدة أسابيع، بسبب الفايروس، كتبت الاسيرة المحررة أمان نافع، زوجة الأسير نائل البرغوثي، الذي أمضى في الأسر 40 عاما « الآن أصبح العالم كله يستطيع ان يتخيل كيف يعيش الأسير الفلسطيني… ولكن من المستحيل ان يتخيل كيف استطاع أن يتحمل نائل البرغوثي 40 عاما داخل السجن؟» وكان نائل قد اعتقل للمرة الأولى عام 1978، وعمره 19 عاما، وحُكم عليه بالسجن المؤبد و18 عاما. وأفرج عنه عام 2011، ضمن صفقة «وفاء الأحرار» وتزوج من المحررة أمان نافع، إلى أن أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله مجدداً في 2014، وأعادت حُكمه السابق، إلى جانب العشرات من محرري الصفقة الذين أُعيدوا إلى أحكامهم السابقة وغالبيتهم يقضون أحكامًا بالسّجن المؤبد.
يمنحنا الأسيران مروان ونائل البرغوثي، مع كل الأسرى والأسيرات، نموذجا لنضال شعب مستمر، على الرغم من التكلفة العالية، لإنهاء أشكال هيمنة تاريخية كالاحتلال والاستعمار الاستيطاني والعنصرية والتمييز، باتت تُقدم الى الأجيال الجديدة بأسماء تمّوه مضمونها لاختراق الشعوب وتضليلها. ليبقى صوت الأسرى جامعا موحدا لقضايا تعني البلدان العربية والعالم كله. صوت يحمل ردا لمن يبرر الصمت حول فلسطين بأن كثرة المصائب وتعددها في البلدان العربية من العراق الى سوريا واليمن وليبيا، خففت من اهتمامهم ومتابعتهم الهّم الفلسطيني.
ردا على ذلك أقول، انني حين تحدثت مع الأسير نائل البرغوثي، خفية، في مكالمة سريعة، عام 2015، لم يتحدث عن وضعه الخاص داخل السجن قرابة الأربعين عاما، أو عما تعرضت له عائلته من تنكيل واعتقالات وتهديم منزلين للعائلة أو حتى فلسطين، بل كان سؤاله الأول عن العراق. كمن يسأل عن صديق طفولة طال غيابه، قال: كيف العراق؟
وإذا كان الأسيران مروان ونائل محكومين بقيود الاحتلال حول التواصل مع العالم الخارجي، فان فدوى البرغوثي وأمان نافع، كما بقية ذوي الأسرى والاسيرات، لم تتوقفا يوما عن محاولة إيصال أصوات الأسرى، كلهم، الى العالم الخارجي. تقول فدوى «إن التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني وحقوقه ونضاله هو ضرورة في سياق المعركة الكبرى ضد مختلف أشكال الاستعمار»، بينما تنشط أمان، في ظل المخاوف من الفايروس الوبائي، ضمن حملة «الحرية لكل الأسرى»، قائلة: «لا يوجد أسير صغير أو كبير، على الاحتلال أن يطلق سراح كل الأسرى، لأن حياتهم أصبحت معرضه للخطر بسبب نسبة الإصابة العالية في صفوفهم في أراضينا المحتلة وأكثر السجون موجودة في أراضي 48.
نطالب حكومتنا الضغط بهذا الاتجاه والتواصل مع العالم للضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عنهم جميعا.
فكيف بأسير لا يأكل طعاما صحيا او لا يرى الشمس ولا الهواء ان يقاوم هذا المرض؟ كل الأسرى الفلسطينيين في خطر. أنقذوهم قبل ان يقتلوهم».
يواجه الأسير اليوم خطر السجان/ الجلاد والوباء، وتعيش كل عائلات الأسرى التي ينتظر بعضها حرية أبنائهم منذ عقود، معاناة صعبة وتجارب قاسية، كما تؤكد فدوى برغوثي أن الشعب الفلسطيني وفيّ لمناضليه وأسراه وشهدائه وتضحيات أبنائه، وأن نضاله مستمر مهما بلغت المعاناة والتضحيات حتى نيل كامل حقوقه والعيش بكرامة وحرية، وهي غاية ستكون احتمالات تحقيقها أكبر ، لو شارك العالم ، في نزع فتيل استهتار وعنجهية نظام الاحتلال العنصري ، لا حماية للفلسطينيين فقط بل حفظا للسلام العالمي، وكما قال مروان البرغوثي اثناء محاكمته «إن اليوم الأخير في عمر الاحتلال هو اليوم الأول للسلام».
كاتبة من العراق
المثقف والاحتلال:
من النازية إلى «العراق الجديد»
هيفاء زنكنة
لايزال هناك من يعتبر احتلال بلده وجهة نظر تستحق النقاش. ولايزال النقاش دائرا بين أوساط المثقفين، بعد مرور 17عاما على غزو العراق واحتلاله، وما سببه من خراب مباشر وغير مباشر، حول استخدام او اختيار مصطلح أو نعت ملائم يصفون به ذلك الحدث الجلل. بهذا التيه يقف المثقفون لوحدهم، منعزلين عن بقية أبناء الشعب، وحتى عن ساسة النظام الذين جلبهم الاحتلال معه وقام بتنصيبهم كحكام بالنيابة، الذين باتوا يستخدمون مفردة «الاحتلال». بل ويذهبون، أحيانا، ابعد من ذلك، متغنين، بالمقاومة، أما بعد انتفاء الحاجة إليهم أو بعد عثورهم على « رب عمل» آخر، يتكفل بحمايتهم، ويمدهم بالعقيدة اللازمة لتبرير الاحتلال وتعاونهم معه فيما يُعرف قانونيا وأخلاقيا بالجريمة الأكبر.
احتلت الكتابات عن ذكرى الغزو في عام 2003، مساحات نافست ما يُكتب عن فايروس كورونا على صفحات التواصل الاجتماعي خاصة من قبل المثقفين. يُلاحظ عند مراجعة ما كتب، وجود انقسام حقيقي بين مؤيدي الاحتلال ومناهضيه. لم تخفت حدته على الرغم من مرور 17 عاما مثقلة بالخسارة البشرية والخراب والفساد والطائفية وخطر تقسيم البلد المسلط على الرؤوس مثل السيف. يمتد الانقسام عميقا ويطفو على السطح، بمفردات ومصطلحات، حسب الانتماء الحزبي، أكثر من غيره. الا ان ما يجمع الكل، في مرحلة التخبط السياسي، وتحول البلد الى ساحة اقتتال بين احتلالين، وانهيار الساسة الأخلاقي والديني المنعكس على شرائح مستفيدة من الاتباع، هو إصرار المثقفين على كونهم يمثلون وعي الامة، وان امتلاكهم عصا «الحقيقة»، يمنحهم عصمة اللاخطأ، و القدرة على الرؤية أبعد من بقية الناس. اذ قلما نرى مثقفا يعتذر عن مواقف سياسية له أدت الى ارتكاب جرائم ضد أبناء شعبه. فهو محق دائما وهو قادر على التبرير والمحاججة، وإذا ما باتت الحقيقة واضحة وضوح الشمس بالتوثيق والشهادات الحية ووجد نفسه محاطا بآخرين يمتلكون شجاعة الاعتراف بالخطأ او الجريمة، يلتفت حينئذ ليلقي اللوم على الشعب « الجاهل والمتخلف». الأمثلة كثيرة في هذا المجال، لعل أكثرها وضوحا هو قيام مثقف بإقناع إدارة بوش بان الشعب سيستقبل قوات الاحتلال بالأزهار والحلوى، كما منح المحتل الانطباع بانه، وحفنة عملت معه، يمثلون صوت الشعب، وان الشعب سيلتذ بالاستماع الى قصف عاصمته بغداد، كما يلتذ بسماع الموسيقى.
من هنا، من شيزوفرينيا المظلومية والرغبة المرضية بالانتقام، ومن الخلط الانتقائي (الانتقائي الممنهج وليس الغبي) ما بين القضايا وأدعياء القضايا، حّشَد بعض المثقفين أنفسهم (ولايزالون) لتسويق الغزو بمصطلحات تتماشى مع حاجة السوق، مهما كانت متناقضة المعنى، مثل ان الحل الوحيد لإنقاذ البلد من النظام الدكتاتوري هو القوات الأمريكية ـ البريطانية، أو التساؤل ببراءة مصطنعة: ما هو الحل اذن، لقد حاولنا وفشلنا… ما هو الحل؟
لايزال المثقف العراقي، يُنشد « التغيير والتحرير»، عاجزا عن لفظ كلمة الاحتلال، بعد مرور 17 عاما عليه. فهل اختلف مفهوم «الاحتلال» حقا أم أن دور المثقف في مجتمع يعيش حالة حرب وحشية مع احتلالين متصارعين، هو صراع مع نفسه؟
ومع الغزو ولترسيخ الاحتلال ومؤسساته، استحدثت أجهزة الإعلام الدعائي ـ العسكري ـ السيكولوجي، المصطلحات المطلوبة للتعميم وغسل أدمغة المواطنين عن طريق التكرار المستدام، مع مراعاة الاختلاف في الجمهور المتلقي وكيفية السيطرة على طريقة تفكيره وجعله يصدق ما يقال له. فما استحدثته الإدارة الامريكية لتحشيد الرأي العام الأمريكي مختلف عما أستحدث للتأثير على الشعب العراقي. ففي أمريكا وبريطانيا، انصب التحشيد الدعائي الإعلامي على اثارة الخوف والاحساس بالتهديد من النظام العراقي الذي يمتلك « أسلحة دمار شامل» وبإمكانها افناء بريطانيا، مثلا، خلال 45 دقيقة فقط، حسب خطب رئيس الوزراء البريطاني توني بلير.
وتطلبت مخاطبة الشعب العراقي مفردات تحمل مضامين مختلفة عن تلك الموجهة الى الأمريكيين. صارت اللغة محّملة برسائل أخرى معدة للاستهلاك المحلي: «التحرير» أو «التغيير» أو «الاستبدال» أو «حرب العراق». أما احتلال العاصمة التاريخية بغداد، فقد استبدل الاسم/ الرمز المرتبط بأذهان العرب والمسلمين بالعلم والثقافة والحضارة وكل ما يمثل عزة وكبرياء واعتداد الشعب، ب» سقوط بغداد». تدريجيا، لم يعد التأثر بهذه المصطلحات يقتصر على عموم الناس، بل تتسلل حتى الى عقول بعض المثقفين المناهضين للاحتلال، ليقوموا بتكرارها، بالنيابة، بلا تفكير، وبالإمكان ملاحظته في الكتابات عن ذكرى الغزو.
ان انقسام المثقفين العراقيين حول احتلال بلدهم ليس فريدا من نوعه. فالمثقفون الفرنسيون لايزالون يراجعون الوثائق والشهادات حول الاحتلال النازي لفرنسا ودور المقاومة والمتعاونين مع الاحتلال، حتى اليوم وعلى الرغم من مرور 100 سنة على الاحتلال وتقسيم البلد الى ثلاثة أجزاء وتنصيب حكومة فيشي « الفرنسية الوطنية» المتعاونة مع الاحتلال النازي ضد المقاومة.
وتمنحنا مراجعة دور المثقف الفرنسي، في جمهورية فيشي، مقاربة لفهم أفضل حول نقاط مهمة من بينها: كيفية التعامل مع مسؤولي النظام الحاكم الخاضع بدوره لسلطة احتلال أو متعاونا معها، ضد قوى الشعب المقاومة، وما هي طبيعة هذه القوى ونسبتها بالمقارنة مع نسبة « المتعاونين» مع المحتل؟ فقد كان في جمهورية فيشي مستويات تشابه متعددة وبدرجات مختلفة مع ما يجري في العراق منذ احتلاله. فكما فرضت أمريكا سياستها على الحكومات العراقية المتعاقبة وفق الاتفاقية الأمنية والاتفاقية الاستراتيجية تعاونت حكومة فيشي، برئاسة المارشال بيتان، مع الألمان في كافة المجالات وعلى رأسها الأمنية وتوفير الأيدي العاملة. وإذا كانت الطائفية قد أثبتت فائدتها للساسة العراقيين خاصة حول ظهور المهدي المنتظر لإحلال العدل، فان جمهورية فيشي وجدت في الدين المسيحي أداة لأقناع الناس بان المعاناة، كما المسيح، ستجلب العظمة للامة.
بالنسبة الى المثقفين، ارتبط البعض، بدرجات متفاوتة، بمؤسسات فيشي والمتعاونين مع المحتلين النازيين في باريس، لأسباب عديدة كالعنصرية والانتهازية والكراهية للشيوعية. كان من بينهم المعماري المشهور لو كوربوزييه، ومدير المسرح جان فيلار، والروائي لويس فرديناند سيلين.
ولعل نقطة الاختلاف الجوهرية التي تستحق الوقوف عندها في مجال المقارنة بين مواقف المثقفين الفرنسيين والعراقيين تحت الاحتلال، هي ان عديد المثقفين الفرنسيين الذين ارتبطوا بحكومة فيشي وتعاونوا مع الاحتلال النازي غّيروا مواقفهم بل وانضم عدد منهم للقتال ضمن صفوف المقاومة، على الرغم من ان عمر الاحتلال والجمهورية لم يتجاوز الأربع سنوات، بينما لايزال المثقف العراقي، يُنشد « التغيير والتحرير»، عاجزا عن لفظ كلمة الاحتلال، بعد مرور 17 عاما عليه. فهل اختلف مفهوم « الاحتلال» حقا أم ان دور المثقف في مجتمع يعيش حالة حرب وحشية مع احتلالين متصارعين، هو صراع مع نفسه؟
كاتبة من العراق
فلوجة المقاومة…
لماذا يخشون ذكراها؟
هيفاء زنكنة
في الرابع من نيسان/ ابريل 2004، مرت ذكرى الهجوم الوحشي الذي شنه المحتل الأمريكي على مدينة الفلوجة، الواقعة على نهر الفرات، اقل من 60 كيلومترا غرب بغداد، على موقع «هاشمية الانبار»، عاصمة العباسيين الأولى في القرن الثامن، قبل بناء بغداد. أُطلق على الهجوم اسم «معركة الفلوجة الأولى ». شارك فيها خمسة آلاف جندي من المارينز والمرتزقة. استخدمت فيها قوات الاحتلال أسلحة محرّمة دوليًا ضد أبناء المدينة، والتي انتهت بفشل الهجوم وانسحاب قوات الاحتلال. كان انسحابا مؤقتا. لتشهد الفلوجة هجوما آخر، في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام نفسه، وصفه أحد قادة جيش الاحتلال الأمريكي بانه «الأكبر منذ حرب فيتنام». تم الهجوم بموافقة رئيس الوزراء أياد علاوي، الذي كان الحاكم العسكري الأمريكي بول بريمر قد عينه يوم قرر مغادرة العراق.
تم خلال الهجومين، تهديم 70 بالمئة من مدينة الفلوجة، وقتل آلاف المدنيين، الى حد عجز فيه الأحياء عن دفن القتلى، فبقيت الجثث في الشوارع عدة أيام، وتم تحويل ملعب لكرة القدم، فيما بعد، الى مقبرة، ودفن البعض، في لحظات الأسى المطلق، احباءهم في حديقة الدار. احدى هذه اللحظات سجلتها الكاتبة نسرين ملك في قصيدة « الأب الذي دفن ابنه في حديقة الدار»، مخاطبة فيها الاب بوجع ينغرز عميقا في القلب: ارفع جسد ابنك الدافئ واصرخ كما لم تصرخ من قبل واسألهم ما الذي فعله ابنك؟… اجلس يوميا بجانب القبر، ابكِ لخسارتك وخسارتنا وأسالهم ما الذي فعله ابنك؟».
وإذا كانت قيادة الاحتلال، يومها، قد أصدرت اوامرها الى الجنود، ملخصة سياستها بجملة واحدة هي « اقتلوا كل ما يتحرك»، حسب شهادة عديدين منهم فيما بعد، وكان من جرائها قتل آلاف المدنيين، فإن جريمتها الأكبر، هي حين استخدمت اليورانيوم المنضب والفسفور الأبيض اللذين تم تشبيه آثارهما بما يعاني منه سكان مدينة هيروشيما اليابانية، حتى اليوم، منذ أن القى الجيش الأمريكي القنبلة الذرية عليهم. واثبتت دراسات علمية عديدة تأثير اليورانيوم المنضب والفسفور الأبيض الموثق بارتفاع ملحوظ في مستويات التشوهات الخلقية عند الولادة، جنبا إلى جنب مع ارتفاع معدلات الاصابة بالسرطان وظهور أمراض وتغيرات غير عادية في نسبة الجنس عند الولادة.
لماذا لا يراد من العراقيين والعالم تذكر الفلوجة؟ حاليا، تتعاون عدة جهات، تبدو مختلفة او متنازعة ظاهريا، وهي الاحتلال الأمريكي والمتعاونون معه وساسة الولاء الإيراني وميليشياتهم، على طمس ذكرى مقاومة الفلوجة وما لحق بها من تدمير بشري وتخريب عمراني، بعيد المدى. بالنسبة الى المحتل الأمريكي، ليس من مصلحته الإشارة الى ما حدث بالفلوجة، اذ لا تزال قواته موجودة في عدة قواعد عسكرية متناثرة في ارجاء الوطن من شماله الى جنوبه «بناء على طلب الحكومة العراقية لمحاربة الإرهاب»، وكان ولا يزال من المستحيل على قوات الاحتلال الاعتراف بمقاومة المدينة ضدها لئلا تكون مثالا يحتذى، عراقيا وعربيا. فقد يحطم المثال السردية التي بناها الغزاة، على مدى عقود، حول حاجة العراقيين إليهم كمحررين، والوعود التي قُدمت إليهم من قبل عراقيين متعاونين معهم، بأنهم سيتم استقبالهم بالزهور والحلوى بالإضافة الى استقتال قوات الاحتلال في احراز نصر يمحو من ذاكرة الشعوب هزيمة القوات الامريكية في حربها ضد فيتنام. هناك، أيضا، السقوط المهين لما يُسمى « ديمقراطية « العراق الجديد حسب الوصفة الامريكية.
صمت المثقف إزاء فاجعة أو حدث يمس الشعب، مهما كان، يعكس وجوده هو وكينونته ودوره ومدى استحقاقه لحمل سمة المثقف. وانتقائية الموقف الإنساني والنضالي سيؤدي، حتما، الى كسر بوصلته الأخلاقية
أما ساسة النظام، فانهم يتعامون عن الذكرى، بقوة، لأنهم كانوا ولايزالون يستنشقون هواء وجودهم عبر المحتل الأمريكي وهم مستعدون لاتهام الشعب كله بالإرهاب إرضاء لسادتهم، كما انهم يرغبون بمحو ذكرى المقاومة التي تستحضر عار تعاونهم واستخذائهم، اذ قلما يوجد من يرغب ببقاء من يذكره بحقيقته. لذلك يفضلون الهاء الشعب بإقامة مناسبات واحتفالات وطقوس تتماشى مع مصالحهم وسياستهم وتعمل، في الوقت نفسه، على تخدير الناس. مع المتعاونين مع المحتل الأمريكي، يقف الساسة من أتباع إيران. متفقين في اتهامهم المقاومة بالإرهاب لتبرير وحشية الميليشيات، متمثلة بالحشد الشعبي، وممارساتها اللا إنسانية ضد كل من يمثل المقاومة وعلى رأسهم اهل الفلوجة، الامر الذي دفع الكثيرين منهم، في شهادات موثقة لمنظمات حقوقية دولية، الى القول بأن « الحشد الشعبي هو الوجه الآخر لداعش، انهما وجهان لعملة واحدة».
بالمقابل، في ذاكرة العالم، لدى المؤمنين بحق الشعوب في المقاومة، في الحياة والحرية والكرامة، أصبحت الفلوجة رديف الغورنيكا، كمكان ولوحة. المكان هو عاصمة الباسك التي قاومت الديكتاتور الإسباني فرانكو، وحين فشل بإخضاعها طلب من المانيا النازية قصفها، فقُصفت يوم 26 نيسان/ ابريل، عام 1937. اللوحة هي «غورنيكا» للفنان الاسباني بيكاسو الذي كتب عنها مذكرا الالمان بجريمتهم: « عندما كان الجنود الألمان يأتون إلى الاستوديو الخاص بي، بباريس، وينظرون إلى لوحاتي الأولية عن الغورنيكا، كانوا يسألون «هل فعلت ذلك؟». كنت أجيب « كلا، أنتم من فعل ذلك».
موضحا فيما بعد سبب رسمه الغورنيكا « ليس الرسم ديكورا لتزيين الشقق. انه سلاح هجوم ودفاع ضد العدو«. لذلك، ساهم فنانون عالميون وكتاب ومسرحيون ومفكرون، من فنلندا الى أمريكا اللاتينية الى البلدان الاستعمارية تاريخيا كبريطانيا وفرنسا وإيطاليا الى مركز الامبريالية أمريكا، في تسخير ادواتهم الإبداعية والفكرية لفضح ما أطلقوا عليه « جريمة أمريكا» و«أمريكا تتصرف كالنازيين»، دفاعا عن “الفلوجة غورنيكا الجديدة» و«الفلوجة غورنيكا القرن الواحد والعشرين». آلاف القصائد كتبت (هناك موقع الكتروني متخصص بذلك) واللوحات رُسمت تستنكر وتصرخ وتحتج. متظاهرون في بلدان الاحتلال يعتصمون وينامون في الشوارع احتجاجا.
في العراق، بعيدا عن المحتل والساسة الفاسدين والمليشيات الاجرامية، تمر ذكرى غورنيكا القرن الواحد والعشرين، في العراق، بين المثقفين والإعلاميين، باستثناء قلة، بصمت مخيف. وهم جلوس يرثون أنفسهم، يكتبون حكايات ماضيهم البطولي، أو يتصفحون سيرة «الأئمة الصالحين»، لئلا يروا ما يمر أمامهم. لئلا يروا مسيرة أجنة محكوم عليها بالإعدام قبل ولادتها، وأطفال محكوم عليهم بالتشوه مدى الحياة، وأمهات شابات حُكم عليهن بارتداء السواد مدى الحياة. ان صمت المثقف إزاء فاجعة أو حدث يمس الشعب، مهما كان، يعكس وجوده هو وكينونته ودوره ومدى استحقاقه لحمل سمة المثقف. وانتقائية الموقف الإنساني والنضالي سيؤدي، حتما، الى كسر بوصلته الأخلاقية. فلا غرابة ان يكون صمت المثقف، إزاء جرائم الاحتلال، مخيفا أكثر من نازية المحتل.
كاتبة من العراق
لمكافحة الفايروس… حجر
حسابات الفاسدين في العراق!
هيفاء زنكنة
إذا ما توقف العالم، الآن، عن متابعة أخبار فايروس الكورونا وانتشاره وجداول أعداد المصابين به واحتمالات الإصابة به، أينما يكون المرء على وجه الأرض، ما الذي سيراه؟ ما الذي سيراه العراقيون، مثلا، بعد ان بشّر أدعياء الدين المواطنين بالحصول على مكان في الجنة، بجانب الأئمة الصالحين، حين يواصلون زيارة مراقد الأئمة وأداء الطقوس الجماعية، بل وأشاعوا بين الناس ان زيارة الامام الكاظم هي الأفضل للمرضى المصابين بفايروس كورونا لأن زيارة الامام، هي في الحقيقة، لم تعد مجرد زيارة دينية بل باتت تُسمى « زيارة الطبيب»؟
أذا ما توقف العالم عن النظر في مرآة الكورونا، المضببة بالخوف والترويع، ورؤية نفسه فقط، سيرى ان هناك عالما آخر لاتزال أحداثه المأساوية، سارية المفعول، كما هي قبل مجيء الفايروس، وستصبح أسوأ بكثير أثناء انتشاره، والاحتمال كبير بانها ستستمر، بعد التخلص منه.
ففي فلسطين، لا تزال الحياة كما كانت، سجينة الاحتلال العنصري، وتعاني غزة من انقطاع التيار الكهربائي، ومياه الشرب غير الآمنة، ولا يوجد فيها سوى 60 سريراً للعناية المركزة في الإقليم، 70 بالمائة منها قيد الاستخدام.
في سوريا التي بات من الصعب تبين ملامحها، ينتشر الخراب و11 مليون نازح ومهجر، وفي اليمن، نزح ما يقرب من 3.6 مليون شخص، يعيش أغلبهم في مخيمات مؤقتة، وفي ليبيا، يعيش 900 ألف ليبي في الملاجئ والمراكز المؤقتة وهم بحاجة إلى المساعدة الإنسانية.
في العراق، أيضا، الزمن متوقف، بالنسبة الى عموم الشعب بمنتفضيه المستمرين بمطالبتهم بالوطن، وسُذَجِه المتباكين على الماضي السحيق، ولكن بشكل خاص بالنسبة الى النازحين والمُهَجّرين والمعتقلين. انهم المَنسّيون المهددون أكثر من غيرهم قبل انتشار الكورونا وأثنائها.
حيث سُجلت أول حالة إصابة بالفيروس في مخيم للنازحين بدهوك، في كردستان، وتتزايد المخاوف بصدد النازحين المعرضة حياتهم للخطر أصلاً بسبب نقص الغذاء والمياه النظيفة ومتطلبات السلامة الصحية والتعرض للطقس البارد، وإصابة الأطفال والنساء بأمراض جلدية ومزمنة.
فبعد مرور عامين على اعلان النظام الانتصار على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، لايزال مليون ونصف مواطن، في مدينة الموصل، الواقعة شمال العراق، لوحدها، غير قادرين على العودة الى بيوتهم، وذلك لعدم قيام الحكومة بإعادة الاعمار وتهيئة المساكن التي هُدمت اثناء الاقتتال مع قوات داعش والقصف الجوي من قبل قوات التحالف بقيادة أمريكا، وغالبًا ما يكون استئجار أو شراء ممتلكات جديدة باهظ الثمن، بالإضافة الى انعدام فرص العمل، والخوف من الانتقام بسبب الاتهام بالإرهاب. هذه الأسباب دفعت سكان المنازل المدمرة وعددها 138000، الى البقاء في مخيمات نينوى الخمسة.
بإمكان المجتمع الدولي أن يفرض الحجر الاقتصادي على الحسابات المالية واستثمارات ساسة الأنظمة الفاسدة ، كالعراق، الموجودة خارج البلد، وتوفيرها لمجالس طبية تمثل شعوب العالم، تستخدمها لشراء الأجهزة الطبية الضرورية لشفاء المواطنين المصابين المعرضين للموت، في ظل ادعاء الساسة الفاسدين عدم توفر الإمكانات المادية
وإذا كان النظام يتحجج، حاليا، بانشغاله بحماية المواطنين من الفايروس، فانه لم يفعل الكثير لمساعدة وحماية المواطنين قبله، بل اتبع سياسة جعلتهم يفضلون العودة الى المخيمات بعد اجلائهم قسريا منها، وفق «القرار 16» الذي لم ينشر ولم يمرر عبر البرلمان. وحدث واطلعت عليه منظمة « هيومان رايتس ووتش» الحقوقية.
شملت « إعادة التهجير»، ما يزيد على 37 ألف شخص خلال ستة أشهر في العام الماضي، معظمهم من النساء والأطفال، مما يعني أنهم حاولوا العودة إلى مناطقهم لكنهم غادروها، مرة أخرى، لأنهم وجدوا أن الحياة هناك غير ممكنة اطلاقا، على الرغم من ان حياة المخيمات نفسها تفتقر الى الخدمات الأساسية وتزيد من التعرض للمخاطر الأمنية، وتفاقم الوصمة الاجتماعية وتبادل الاتهامات زورا بدعم أو الانضمام إلى داعش لتسوية الحسابات أو الانتقام من الأعداء والمنافسين الشخصيين.
وتعاني النساء، بشكل خاص، من مشاكل التحرش الجنسي وعدم الحصول على الأوراق والوثائق الرسمية للأطفال، حسب المجلس النرويجي للاجئين، الذي وثّق وجود حوالي 45000 طفل في المخيمات، في جميع أنحاء العراق، بلا شهادات ميلاد أو وثائق مدنية أخرى، مما يعرضهم لخطر أن يُحكم عليهم بالسجن مدى الحياة على هامش المجتمع، اذ لا يمكنهم الزواج أو العمل مستقبلا، وقد يحصلون على علاج طبي بسيط، ولكن ليس اجراء عملية جراحية.
أما بالنسبة الى السجناء والمعتقلين، فقد أطلق « مركز جنيف الدولي للعدالة» نداء الى المجتمع الدولي للعمل من أجل حماية المعتقلين، والإفراج عن السجناء الذين يستند سجنهم على اعتباراتٍ سياسية أو طائفية. اذ أدت الاعتقالات التعسفية، والتطبيق التمييزي لقانون العقوبات، دون محاكمة عادلة، إلى اكتظاظ السجون والظروف اللاإنسانية، وعدم وجود رعاية طبية، مما يوّفر البيئة المثالية التي يزدهر فيها الفايروس ويُسهل انتشاره بين السجناء من ناحية، وبين السجناء والحرّاس من جهة أخرى. وأوضح المركز انّه يتلقى بانتظام أدلّة تُظهر أن العديد من السجناء يموتون بسبب هذه الظروف.
وأوضح انّه من آلاف حالات الاختطاف التي راجعها المركز، فانّ اختطاف معظم الضحايا يجري أثناء طريقهم إلى العمل، أو المدرسة، أو إلى مراكز التسوّق. وتشترك الشرطة أو قوات الأمن، مع الميليشيات بتلك الاعتقالات. وقد حذر المركز من نفاد الوقت ووجوب حماية سكّان العراق، مناشدا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عموماً للضغط على الحكومة العراقية من أجل إطلاق سراح السجناء السياسيين والمعتقلين لأسباب طائفية، وأولئك المحكومين احكاماً خفيفة.
ان مسؤولية حماية حياة المواطنين، جميعا بلا استثناء، تقع على عاتق الحكومة، مهما كانت الظروف. وتمتد المسؤولية في حالات معينة كالتي يعيشها العالم، حاليا، الى كل الحكومات والأنظمة.
بإمكان المجتمع الدولي، على الرغم من مواقفه المسيئة أو عدم جدواه بالنسبة الى شعوبنا، أن يتخذ مسارا آخر جراء عمله على حماية مواطنيه عبر حماية لمواطني دول أخرى، عن طريق تبادل المعطيات والتجارب وآخر المستجدات العلمية بالإضافة الى ارسال الأطباء والمواد والأجهزة الضرورية لأنقاذ الحياة الى البلدان التي تعاني من الشحة.
بإمكان المجتمع الدولي أن يفرض الحجر الاقتصادي على الحسابات المالية واستثمارات ساسة الأنظمة الفاسدة ، كالعراق، الموجودة خارج البلد، وتوفيرها لمجالس طبية تمثل شعوب العالم، تستخدمها لشراء الأجهزة الطبية الضرورية لشفاء المواطنين المصابين المعرضين للموت، في ظل ادعاء الساسة الفاسدين عدم توفر الإمكانات المادية.
كاتبة من العراق
إعادة انتشار الانتفاضة
العراقية وأشكال المقاومة الجديدة
هيفاء زنكنة
ونحن نشاهد غزو فيروس كورونا متناهي الصغر وسرعة انتشاره في أرجاء الكرة الأرضية، وهشاشة مقاومة الدول العظمى أمام اجتياحه المتسارع، ومع ازدياد أعراض الخوف، في بلداننا، من عدم إمكانية احتوائه، وفرض أيام العزلة الاجبارية وما تلاه من حجر على مستوى وطني، يجد العالم نفسه محاصراً إزاء أسئلة يصب بعضها في محيط الشائعات والتضخيم، بينما يمس البعض الآخر أمورا أعمق بكثير، لم يجد المرء نفسه مجبرا على مواجهتها أو حتى التفكير بها، سابقا، ما لم يكن معنيا بجوهر الحياة والإنسان أو مضطرا لمواجهة وباء عالمي.
تثير جائحة كورونا تساؤلات كثيرة لدى الجميع في أرجاء العالم، لعل أهمها خاصة في بلداننا، عن علاقة الدين بالعلم، حيث ينمو الفرد وهو يحمل في وعيه الداخلي، أي اللاوعي، مهما ادعى غير ذلك، درجات من القدرية والإيمان بتوليفة المعتقدات الدينية غير القابلة للنقاش، المعجونة، غالبا، بالأساطير والخرافات، حتى لم يعد، لفرط تداخلها، بالإمكان التمييز بينها. ولهذا الوعي اللاواعي للأفراد انعكاسات على مستوى الوعي الثقافي المجتمعي، والسلوك العام، والاحساس بالمسؤولية الاجتماعية، عموما، في ظل ضعف المستوى العلمي والاعتماد على الخارج في مجالات البحوث والتكنولوجيا. وتمتد التساؤلات لتشمل دور الفرد المتضائل أكثر فأكثر في مواقع اتخاذ القرار والمستوى العقلي للمسؤولين الحكوميين، وقدرتهم على خدمة عموم الشعب وليس الاتباع فقط، بالإضافة إلى مدى إمكانية غير الفاسدين القيام بمبادرات فردية ومجتمعية في جو يسوده القمع السلطوي والذعر من انتشار الوباء في آن واحد.
يشكل الوضع العراقي الحالي، باستمراريته منذ غزوه عام 2003، وبعد مرور 17 عاما على تسويقه كنموذج شرق أوسطي للديمقراطية الانجلو أمريكية، نموذجا مذهلا في تخبط نظامه الفاسد وسياسته الطائفية التي جعلت المواطن، مثل محكوم بزنزانة، فيها كوة واحدة، تطل على جدار عال، وينام ويصحو على وقع خطاب يخبره بأن الزنزانة والجدار هما لحمايته من « الآخر»، أي ابن بلده وأهله. انعكاسات هذه العزلة العقلية نراها بوضوح مخيف والبلد بمواجهة عدو حقيقي يستهدف كل الشعب.
ففي خضم التخويف وإشاعة الترويع من المواطن «الآخر»، رعى النظام نمو شرائح مجتمعية، استفاد من سذاجتها حينا وحاجتها إليه وضمان امتيازاتها حينا آخر، في علاقة تجذرت لتبرز على السطح بشكل طقوس وبُدع، تستمر على مدى العام، مسّوغة أعلى درجات النهب والفساد وانعدام الخدمات الأساسية وأهمها التعليم والصحة. طقوس تشغل الناس وتلتهم الأيام والسنين، ومعها القدرة على التفكير السليم، فازداد عدد الأتباع المنصاعين لأوامر أو توجيهات أو إرشادات، وفي الآونة الأخيرة، تغريدات رجال (كلهم بالمناسبة رجال) يرتدون زيا موحدا، ويتحدثون بلغة موحدة، هدفها الأول والأخير أن تضع حدا لأي تقدم وتطور فكري وعلمي، قد يهدد وجودهم والنظام المرتكز عليهم.
ما يقوم به المنتفضون من حملات توعية هو مسألة حياة أو موت بالنسبة لهم ولبقية أبناء الشعب، وفي تبنيهم مستوى آخر من مستويات النضال إنما يحافظون على سلامة بلدهم وأخذه إلى بر الأمان
وإذا كان هدف المُحتل هو الهيمنة على الشعوب المُستعمَرة عسكريا فإنه لن يكون قادرا على تحقيق هدفه بدون تعاون الحكومات المحلية الفاسدة، وأدعياء الدين المتعاونين معها على تخدير عقول العامة والتمثيل الذاتي لتخدير عقولهم هم أنفسهم، أيضا، كما يؤكد مسؤول ميليشيا بدر والحشد الشعبي، هادي العامري: «نحن مع رأي الإمام، الإمام إذا يقول حرب حرب، وإذا يقول صلح صلح»، وهو يتحدث عن إمامه هو وليس إمام الشعب كله.
من المؤكد قدرة المحتل على مسخ شريحة من الشعب، لفترة قصيرة، إلا أن من المستحيل تحقيقه النجاح في مسخ الشعب كله لفترة طويلة، فالشعب غني بتنوعه ووشائجه العميقة. إذ لابد وأن تواجه قوات الاحتلال، مهما كان مصدرها وتبريرها، المقاومة. وهذا ما أكدته المقاومة العراقية ضد الاحتلال أولا ومن ثم التظاهرات والاعتصامات المستمرة على مدى سنوات الاحتلال ثانيا والتي بلغت ذروتها في صحوة الشباب التي وصلت إلى أوجها في انتفاضة تشرين / أكتوبر 2019.
«علينا مواجهة فيروس كورونا وفيروس النظام الفاسد معا». هذه هي رسالة المنتفضين بعد مرور ستة أشهر على بدء الانتفاضة، وهم يعيشون يوميات نضال استثنائي يجعلهم متميزين بانتفاضتهم عن بقية العالم، ومتوحدين معه في خوفهم على شعبهم من انتشار الوباء. ينبع تميزهم من إصرارهم وصمودهم أمام أساليب القمع الوحشية التي أودت بحوالي 700 شهيد و25 ألف جريح، وإعاقة 3000 شخص فضلاً عن 54 محاولة اغتيال قتل فيها 26 شخصاً وأصيب 16 آخرون. هذه التكلفة البشرية الفادحة تدفع الكثيرين إلى المقارنة بما سببه فيروس كورونا في بلدان أخرى، حتى الآن، وما يثيره من ضجة مقابل الصمت العالمي المحيط بالانتفاضة وانعكاساتها الإنسانية. فكم من بلد دفع هذه التكلفة ثمنا للاحتجاج على نظام طائفي فاسد متعاون مع الاحتلال، خلال فترة وجيزة نسبيا؟
أما توحد المنتفضين مع بقية العالم لمكافحة الفيروس، فقد تبدى باتخاذهم قرارا واعيا بالانسحاب من ساحات التحرير، إلى حين، حرصا على حياة الجميع مع إبقاء عدد من الخيم، يواصل عدد من المنتفضين البقاء فيها، بمعدل أربعة لكل خيمة، للتذكير بمبادئ الانتفاضة وإبقاء جذوتها مشتعلة وفاء للوطن وللشهداء.
كما اختار المنتفضون مستوى آخر للعمل، تم تبنيه لمقاومة أو، على الأقل، تقليل عدد الإصابات بالفيروس، من خلال التوعية بمخاطره وحث أبناء الشعب على تطبيق الشروط الصحية، وأهمها الالتزام بحظر التجوال وتجنب الأماكن المزدحمة، خاصة فيما يتعلق بأداء الصلاة الجماعية وزيارة المراقد الدينية، وممارسة طقوس الزيارة من التشبث بشبابيك الأضرحة وتقبيلها، أي كل ما يعمل على نشر الفيروس بأسرع طريقة ممكنة، خاصة وأن عددا من أدعياء الدين لايزالون يروجون أن فيروس كورونا لن يمس الزوار المخلصين المواظبين على أداء الطقوس، لأن زيارة الأئمة والقيام بطقوسها سيحميهم.
ما يقوم به المنتفضون الآن من حملات توعية هو مسألة حياة أو موت بالنسبة إليهم وإلى بقية أبناء الشعب، وفي تبنيهم مستوى آخر من مستويات النضال إنما يحافظون على سلامة بلدهم وأخذه إلى بر الأمان. إنها خطوة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في الوضع الكارثي الناتج عن غياب الحكومة، وعدم توفر الخدمات الصحية العادية ناهيك عن إمكانية مقاومة الوباء، وخشية كل الساسة والسلطات الأمنية، إصدار أمر وتطبيقه بالقوة لو اقتضى الأمر، بمنع الحشود من زيارات المراقد وإقامة الطقوس الجماعية، لئلا يتم اتهامهم بموالاة «الآخر» أو تلويث «المعتقد» الذي جعلوه، مع فسادهم وزيفهم واستغلالهم، المغذي الذي يبقيهم على قيد الحياة.
كاتبة من العراق
أمريكا أم إيران… من الذي
يعلم العراقيين ركوب الدراجة؟
هيفاء زنكنة
تمر هذه الأيام ذكرى الغزو والاحتلال الأنكلو أمريكي للعراق عام 2003. يأتي مرورها، على الرغم مما سببته من كوارث، بشكل يكاد يكون تسللا في ظل انتشار وباء فايروس كورونا. قد يكون التسلل او حتى النسيان ممكنا بالنسبة الى العالم، الا أنه يوم حُفر بأزميل من دماء الضحايا وخراب البلد في ذاكرة العراقيين على مدى 17 عاما. اذ لم يمر يوم دون ان يعيش المواطن انعكاساته الهائلة على حياته وعلى بلده وعلى المنطقة كلها.
حصدت سنوات الاحتلال من الأرواح ما يعادل او ينافس الجزائر، بلد المليون شهيد، الذي تربينا على اعتباره مثلنا الأعلى في النضال والتضحية، كما يكاد يقترب من ضحايا المحتل الصهيوني بشهدائه ولاجئيه واستمرارية محاولات اخضاعه لكل ضروب الإبادة الجماعية. هذا من الناحية البشرية، وإذا ما راجعنا قائمة الخسائر المادية وخراب البنية التحتية، لوجدنا البلد الذي يزيد عدد شبابه على نصف السكان، ينوء بأثقال تحد من طموحاته واحلام مستقبله، تاركة إياه مثل عجوز يجد صعوبة قصوى في التنفس والحركة والتفكير.
وإذا كانت سنوات الاحتلال قد شابها زيادة وتقليل عدد القوات الأمريكية أو قوات التحالف بقيادة أمريكا، على أرض البلد وسمائها، تحت مسميات متنوعة تراوح ما بين التدريب والاستشارة ومحاربة الإرهاب (المتمردين السنة، القاعدة، داعش) أو قوات التحالف كجزء من قوات حلف الناتو، فان ما أسست له سنوات الاحتلال، من طائفية وفساد ونهب للثروات، أعمق من مجرد تواجد القوات العسكرية أو عدم تواجدها. حيث اعتمدت لديمومة هيمنتها (المباشرة والناعمة) على نظام المحاصصة السياسية/ الطائفية الذي ما كان لقوات الاحتلال أن تبقى في العراق الى يومنا هذا لولا اعتمادها عليه، متمثلا بأولئك الذين تحالفت معهم من العراقيين، المستعدين لبيع ولائهم للشيطان، وأقرب ما يكونون الى المرتزقة في تأجير خدماتهم، بعيدا عن الوطن والوطنية، ما دام سيساعدهم على التخلص من عدوهم، ولأن للرغبة بالانتقام مذاق يماثل مذاق الدم للحيوانات الشرسة، الا أنه غير مستساغ من قبل عموم البشر، تم تغليف تحالفاتهم بالديمقراطية وحقوق الانسان.
وفرت سياسة المحتل الأمريكي المنهجية في القضاء على الدولة العراقية ومقوماتها الأرضية لتأسيس الأحزاب ذات الولاء الخارجي وللنمو السريع، كما الأعشاب الضارة، للميليشيات ذات الولاء الإيراني والمدعومة بأموال النفط العراقي، بينما يعيش شباب البلد وخريجوه في مستنقع الفقر المدقع والتهجير وغياب الخدمات الأساسية، من الماء الصالح للشرب الى الصحة والسكن، التي تتمتع بها بلدان أقل ثراء من العراق بكثير، بشرط وجود حكومة وطنية تمثل الشعب.
وفرت سياسة المحتل الأمريكي المنهجية في القضاء على الدولة العراقية ومقوماتها الأرضية لتأسيس الأحزاب ذات الولاء الخارجي وللنمو السريع، كما الأعشاب الضارة، للميليشيات ذات الولاء الإيراني والمدعومة بأموال النفط العراقي، بينما يعيش شباب البلد وخريجوه في مستنقع الفقر المدقع والتهجير وغياب الخدمات الأساسية
على مدى 17 عاما، عمل تحالف الشيطان الأكبر والاصغر غير المعلن، بكل الطرق المختلفة، على اقناع الشعب العراقي أنه عدو نفسه، وأنه يحمل بداخله خطيئة العنف الأزلية، وان الحل الوحيد لإنقاذه هو اما قبول مشروع المخلص الحضاري (أمريكا) او مشروع آية الله (إيران). صراع ومفاوضات أصحاب هذين المشروعين العلني داخل العراق حينا والسري حينا آخر، حسب مقتضيات مصلحتيهما منفردة او مزدوجة، يقودان العراق الى سيرورة هلاك لا مفر منه. وما عملية اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني، في العراق، ومن ثم تبادل حملات القصف الجوي والصواريخ بين أمريكا وإيران، في العراق أيضا، بالإضافة الى زيادة عدد قوات الاحتلال الأمريكي، فضلا عن تمتع الميليشيات الموالية لإيران بحرية الحركة والفعل، غير استهانة بكرامة وحياة الشعب العراقي. سيرورة تحقيق أي نجاح من قبل المُحتَلَين يعتمد على مدى نجاح أي منهما بغسل أدمغة الناس، مسح الذاكرة وغرز البدائل. وهي سياسة قديمة قدم الاستعمار، أثبت التاريخ انها قد تنجح لفترة قصيرة، الا من الصعب او المستحيل نجاحها على المدى البعيد. والمدى البعيد هو الذي تراهن عليه الشعوب الُمحتَلة لمقاومة الُمحتَل الذي يفوقها عسكريا وماديا وبشريا.
كان التشبيه المفضل لدونالد رامسفيلد، وزير الدفاع الأمريكي اثناء الغزو، هو الإشارة إلى العراقيين على أنهم أطفال يتعلمون ركوب الدراجة « كانت مهمتنا هي خلع عجلات التدريب والسماح لهم بتعلم الركوب بأنفسهم. المشكلة هي أننا ظللنا نأخذ عجلات التدريب في وقت مبكر جدًا واستمرت الدراجة في التحطم». هذا المفهوم الاستعماري المتضمن ان العراقيين لن يتمكنوا من الدفاع عن المكاسب التي يحققها لهم الجيش الأمريكي، وبالتالي هم في حاجة الى الوجود العسكري الأمريكي للدفاع عنهم، لا يختلف عن الموقف الإيراني الذي يرى أن إيران، من خلال ميليشياتها وفيلق القدس وقادته، هي منقذة العراق من الإرهاب الداعشي ـ الأمريكي ـ السعودي ـ الصهيوني، ولولا آيات الله وولاية الفقيه لما قامت للعراق قائمة.
هذه النظرة الدونية الى الشعب العراقي، متشابهة في جوهرها، حتى لو كانت أمريكا هي الهر الأكبر وممارسات إيران داخل العراق هي مجرد خرمشات قط صغير، حسب ادعاء البعض.
بعد مرور 17 عاما على غزو واحتلال العراق، تتنافس أمريكا وإيران على الهيمنة عليه جوا وأرضا، عسكريا وثقافيا، جاذبة اليها أعضاء الحكومة والبرلمان، كل حسب مصلحته وولائه ودرجة فساده. خارج لعبة شد الحبل هذه وما يتمخض عنها، بين الحين والآخر، من سقوط قتلى بين الطرفين وضحايا عراقيين، يعيش الشعب، في ذكرى احتلال بلده، ولأول مرة، يوميات انتفاضة جماهيرية، بدأت في الأول من تشرين 2019 وحققت، حتى الآن، من المنجزات ما لا يمكن القضاء عليه، مهما حاولت قوى الاحتلال بشقيه الأمريكي والإيراني.
«لا أمريكا ولا إيران.. ولاؤنا للعراق»، الشعار الذي رفعه المنتفضون إثر القصف الأمريكي، منذ أيام على مواقع لحزب الله العراقي، هو معنى السيادة للوطن الذي يريده المنتفضون.
هو المكان الذي تشارك فيه المرأة الرجل على قدم المساواة في الواجبات والحقوق، حيث تتم مقاضاة القتلة والإرهابيين المسؤولين عن سقوط الشهداء، كل الشهداء، على مدى سنوات الاحتلال، بلا حصانة أو تمييز. وطن حيث تُفتح أبواب العمل للشباب، ويستعيد الناس ثروتهم المنهوبة، وحيث يعيش المواطنون المنهكون لكثرة ما مروا به من فواجع، على مدى عقود، أياما يتمتعون فيها بحقهم: الكرامة والحرية والعدالة التي يستحقونها.
كاتبة من العراق
فلنحتفل… كل عام
وأنتِ والوطن بخير
هيفاء زنكنة
للمرة الأولى منذ غزو العراق واحتلاله عام 2003، تحتفل المرأة العراقية، ابنة اليوم، بعيد المرأة، بشكل أعادت فيه الى الأذهان ذكرى الاحتفالات التي كانت تعيشها أمها سابقا. عادت المرأة، أخيرا، للمشاركة في صنع الحياة، بعد غياب أريد له أن يدوم.
«نازلة آخذ حقي» و«أريد وطن»، شعاران رفعتهما مع شقيقها الرجل، وهي تناضل لاستعادة الفضاء العام، حقها الطبيعي في ساحات وشوارع بلادها التي ساهمت أمها وجدتها في بنائها وتنميتها على مدى سنوات الدولة الحديثة منذ عشرينيات القرن الماضي. وكما هو وضعها الحالي، منذ انتفاضة تشرين 2019، لتحرير وطنها من الاحتلال الأمريكي ـ الإيراني سواء تحت غطاء الديمقراطية أو الدين، لم تكن وحيدة. فوجودها وحضورها وقدرتها على البناء يتحدد، حاليا، كما في الماضي، بنضالها وتنمية قدراتها الذاتية سوية مع الرجل. ألم يكن الشاعر جميل صدقي الزهاوي من أوائل المنبهين الى حالها في مقالته «المرأة والدفاع عنها» المنشورة في آب/ أغسطس 1910، وفي شعره الذي هاجم فيه التخلف المجتمعي المسوغ باسم الدين، داعيا إياها الى الكفاح لتأخذ حقها في الحرية؟ والا تعبأ بالغربان الذين يواصلون النعيق، قائلا: «وذري من الدين القشور/ جميعها وخذي اللبابا. عزوا الحجاب الى الكتاب/ فليتهم قرأوا الكتابا».
فلا عجب أن تخرج ابنة العراق، بعد أكثر من مائة عام، من نداء التحرر من «بيت أُريد / بضيقه ليكون لحدا»، لتواصل ثورتها على ساسة، تجمعهم توليفة طالما عاشتها الشعوب المُستعمَرة، ما بين خدمة المحتل والفساد وارتداء الدين زورا استزادة بالتجهيل، لمنعها من المشاركة، مع شقيقها الرجل، بانتفاضة تطالب بالاستقلال والحرية والكرامة، خرجت متحدية كل من يرميها بالتهم الجاهزة المهترئة، كما فعل «السيد» أخيرا، حين رأى في نشاطها العام: «التحرّر والتعرّي والاختلاط والثمالة والفسق والفجور، بل والكفر والتعدّي على الذات الإلهيّة وإسقاط الأسس الشرعيّة والأديان السماويّة والتعدّي على الأنبياء والمرسلين والمعصومين». كل هذا بعد أن درست الفتاة وتخرجت وتفوقت في عصر تُسيره قدرة الجميع على العمل المشترك، بلا تمييز، من أجل التطور وبناء المستقبل بكل المستويات العلمية والتكنولوجية والثقافية.
خرجت الفتيات، وهن يرتدين العلم العراقي الجامع، ليحتفلن بوحدة الوطن، ضد الطائفية والنهب وخدعة «ديمقراطية» السياسة المبنية على تزوير الانتخابات وسرقة الأصوات. ضد أن تكون المرأة مجرد مقعد يجلس عليه الآخرون في البرلمان، وأن تستباح كرامتها كلما توجهت الى مؤسسة حكومية، وأن تعتقل وتعذب وتتهم بالدعارة وتهدد بالاغتصاب ما إن ترفع صوتها محتجة. ضد أن يكون الحل الرسمي لمليون أرملة بحاجة الى المساعدة هو إعطاء الرجل منحة لاتخاذ زوجة ثانية بدلا من تمكين المرأة وتوفير الرعاية الاجتماعية وفرصة العمل في واحد من دول العالم الغنية.
للمرة الأولى منذ غزو العراق واحتلاله عام 2003، تحتفل المرأة العراقية، ابنة اليوم، بعيد المرأة، بشكل أعادت فيه الى الأذهان ذكرى الاحتفالات التي كانت تعيشها أمها سابقا. عادت المرأة، أخيرا، للمشاركة في صنع الحياة، بعد غياب أريد له أن يدوم
فلنحتفل مع كل النساء في جميع أرجاء العالم، تقول المرأة في البلاد العربية. لنشارك العالم يوما من فرح نحن بأمس الحاجة اليه. ليس تغريبا أو تخليا عن الدين والموروث الاجتماعي بل رغبة في أن تكون المرأة، في البلدان العربية، بذات المستوى الحضاري للمرأة، أينما كانت، ما دامت تؤمن بالعدالة والمساواة والكرامة الإنسانية. فنساء البلدان العربية، من فلسطين الى اليمن والعراق وسوريا مرورا بتونس ولبنان، الى آخر القائمة، بحاجة، في خضم نضالها وصراعها سواء من أجل البقاء أو من أجل الحصول على ما هو أكثر من الأساسيات، أن تتاح لها فرصة تجر فيها أنفاسها وتشحن طاقتها المستنفدة في المعاش اليومي، في الصراع مع الماضوية، في الحروب المفروضة، في النضال ضد الاحتلال بأنواعه، وأحيانا من أجل ألا تخسر ما حققته الأمهات والجدات عبر أجيال. فهي تستحق أن تُكَرَم ويحتفى بها هي التي تواصل العيش والكفاح في منطقة تتحكم بها 40 بالمئة من الحروب والنزاعات الدائرة في العالم اليوم.
فلنحتفل بصمود المرأة الفلسطينية التي تمدنا جميعا، أينما كنا، بالأمل. إنها المرأة العربية/ امرأة كل النضال مجتمعة. تحمل في وجودها ومقاومتها، في جمال أسيراتها، في بقائها في وطنها، في عروقها، عنفوان الحياة. معها، لا حاجة لنا، بذكر الانتماء والهوية والعنوان. فهي الأصل، هي مانحة الحياة.
فلنحتفل، تقول الأسيرة كما المعتقلة السياسية، تحديا للاحتلال أو السلطات المحلية القمعية أو كليهما معا. الاثنان يريدان كتم صوتها وطمر رأيها، مهمشا أو منكرا وجودها، محولا إياها الى آلة خرساء تستجيب لما يراد منها بلا صوت، بلا حضور.
«أليس اليوم عيدا؟»، تتساءل المناضلة التونسية عواطف المزغني، وهي في السجن، الذي جعله نظام بن علي محل إقامة لمن يعارض نظامه الاستبدادي. تخبرنا في نصها المنشور في «دفاتر الملح.. كتابات تونسيات عن تجربة السجن السياسي»، كيف أنها قررت، بعد أن مسحت دموعها بظهر كفها، مستعيدة صوتها وعنادها، أن تحتفل وبقية السجينات بالعيد الكبير. قررت ذلك لئلا يرحل العيد الكبير دون أن تشارك فيه، تاركا إياها والبقية ضحايا للألم. أرادت ان يتمتعن ولو لساعات بمشاركة أولادهن وعوائلهن فرحة العيد بتكبيراته وفرحة أطفاله. فكان لهن ما أردن، دقائق وانفجرت ردهة السجن بالعيد.
فليكن الاحتفال تذكير بملايين النساء اللواتي أجبرن على مغادرة بيوتهن، جراء غزو أو قصف أو همجية ميليشيات. في سوريا واليمن والعراق ومن قبلهن فلسطين. هُجرن قسرا وهن لا يعرفن ما الذي ستجلبه الأيام المقبلة لهن ولعوائلهن، ليصبحن بين ليلة وضحاها نازحات في بلدان، توفر لهن الخيام حينا وتتاجر بحياتهن حينا آخر. هربا من الخطر في اوطانهن يواجهن الخطر في أماكن لا تقل قسوة عن الأوطان. بلا حقوق، تُنفى جسدا فتكافح يوميا لتحافظ على انسانيتها.
«كل عام وأنت والوطن بخير»، هذا ما تلقيته من مناضلة فلسطينية، بمناسبة يوم المرأة، إشارة الى مطالبة الجيل الجديد من المنتفضات العراقيات بالوطن. هكذا تتبادل نساء العالم العربي التمنيات بمناسبة يوم المرأة العالمي. وهو أسلوب فريد من نوعه بين نساء العالم اللواتي يكتفين، عادة، بتمني أن يكون اليوم سعيدا. إنهن يلخصن بذلك التأكيد على التلاحم ما بين التمنيات الشخصية والعامة، ومعنى الوجود المرتبط بوجود الوطن.
كاتبة من العراق
الانتفاضة العراقية:
قفزة نوعية في الوعي الجماعي
هيفاء زنكنة
منذ أن تم تعيين محمد علاوي كرئيس وزراء للحكومة العراقية الانتقالية، وحمى مزاد المقايضة على المناصب الحكومية في تسارع لا يختلف عن مزادات الحكومات السابقة، التي خرج الشباب منتفضين ضدها منذ الأول من تشرين / أكتوبر العام الماضي، ولايزالون يدفعون الثمن غاليا من دمائهم لوضع حد لها. ما لا يريد الساسة الحاليون فهمه أو يتعامون عنه، انتقائيا، هو ان إعادة تدويرهم، في مناصبهم أو اختيار أقاربهم أو من احتل منصبا في حكومات اللصوصية السابقة، انما هو ما تعتبره الانتفاضة السرطان الذي بات ينخر المنظومة السياسية وما بقي من الدولة من أعلى مسؤول فيها الى أصغر موظف، بضمنها كل المستويات الاقتصادية والأمنية. والأخطر من ذلك كله أنه بات جزءا لا يتجزأ من حياة المواطنين. صار أمرا عاديا أما حماية لأنفسهم او ابتغاء منفعة أو مجرد تسيير امورهم. بمعنى آخر، ان الفساد، بأشكاله، لم يعد حكرا على الطبقة الحاكمة، بل تسلل الى بنية المجتمع في دوائر الدولة وموظفيها والى المدارس والمستشفيات كما في الشوارع والمطارات والموانئ والأسواق، وحتى للعائلة والمحلة، مما يهدد بقاءه وجعله لقمة سهلة للإرهاب والتفتت. وهذا هو ما عاشه البلد في سنوات الاحتلال وما افرزه من ميليشيات مسلحة وإرهاب يتغذى على الفساد، خاصة، مع توفر أموال النفط الهائلة، وهو ما ترمي الانتفاضة لاستئصاله.
لذلك، يصر المنتفضون على رفض إعادة تدوير الساسة الحاليين، ليس حبا بالرفض فحسب، ولا لأن شكل الساسة لا يعجبهم او لأنهم مغرمون بالنوم في الساحات بعيدا عن بيوتهم وعوائلهم أو طمعا بالمناصب لأنفسهم، ولكن لأنهم يدركون جيدا حجم الكارثة التي سببها حكم الفاسدين والسراق وما سيجره إبقاءهم في مناصبهم على الوطن.
إن وعي المنتفضين بهذه الحقيقة وجعله أولوية ضرورة واستمرار لما توصلت إليه شعوب بلدان أخرى تعيش مرحلة الانتقال من نظام الى آخر، مع وجود بعض الاختلافات. ففي تونس، مثلا، التي تشكل نموذجا ناجحا للانتقال من نظام استبدادي الى ديمقراطي، لم يعد خافيا ان سيرورة الثورة لن تتم بالشكل الذي يحقق طموحات الشباب في مستقبل مغاير واستقلالية بناء الدولة وحمايتها، ما لم يتم القضاء على منظومة الفساد التي أسسها النظام السابق ولايزال المجتمع، على الرغم من التغير السياسي، وهنا مكمن الخطورة، يعيش يوميات استشرائه.
واذا كانت سيرورة العدالة الانتقالية قد فشلت في العراق بعد محاولاتها في سنوات الاحتلال الأولى، ولأسباب عديدة من بينها عدم القدرة على العمل تحت مظلة الاحتلال، وسياسة حكوماته المحلية الطائفية العنصرية، وغياب الاستقرار السياسي والأمني، فان مسار تحقيق العدالة الانتقالية، بأوجهه المتضمنة المساءلة والحقيقة والكرامة وجبر الضرر، بتونس، لم يؤد النجاح المتوقع وتعثر لكونه، كما يتبين من آخر تصريح أصدره المركز الدولي للعدالة الانتقالية، منذ أيام، بمناسبة عقد مؤتمر دولي بتونس، عنوانه « الحقيقة والمساءلة واسترداد الأموال المنهوبة وكيف يمكن للعدالة الانتقالية مكافحة الفساد «.
إن تشابه ممارسات الأنظمة الاستبدادية القمعية وحصرها الثروة الوطنية بأيدي قلة فاسدة، يجعل لتجربة الشعوب بمواجهة هذا النوع من الأنظمة وتوحيد جهودها للتخلص منها، قيمة تتجاوز حدود البلد الواحد، لتفرض أشكالا من النضال والتضامن
يعزو التصريح سبب التعثر الى «اقتصار ميدان العدالة الانتقالية طيلة سنوات، على العناية بقضايا الحرمة الجسديّة وانتهاكات الحقوق المدنية والسياسيّة»، مبيّنا أنّ بعض البلدان، كالأرجنتين وتشيلي وجنوب افريقيا، ركّزت على جرائم التعذيب والقتل والاختفاء القسري والاحتجاز المطوّل، « دون النظر في الفساد الذي تمّ ارتكابه من طرف المسؤولين «. وقد تم تسجيل استثناءات ملحوظة في عدد من البلدان، فقط، حين يكون بإمكان العدالة الانتقالية أن تضطلع بما يتعيّن عليها وذلك بمتابعة المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان والفساد على حدّ السواء.
يختلف الوضع في العراق عن بقية الدول التي تعيش تجربة العدالة الانتقالية من نواح عدة لعل أهمها انعدام السيادة، وعدم وجود حكومة تمثل الشعب، وانتهاكات حقوق الانسان المستدامة، واحتلال العراق أعلى قائمة الدول الأكثر فسادا إداريا وماليا، وقد بلغ حجم السرقات في العقود وتهريب العملة مئات مليارات الدولارات، أي أرقاماً لا يمكن للمواطن استيعابها الا اذا تم تقريبها الى 15 ألف دولار للفرد الواحد (اذا كان الهدر نصف الدخل من النفط منذ الاحتلال فقط)، أي مائة الف دولار للعائلة العراقية الواحدة. الا ان متابعة تجارب الشعوب في تطبيق العدالة الانتقالية، كما في تونس وجنوب افريقيا، والاطلاع على خبرتها في مكافحة الفساد واستعادة الأصول المنهوبة والمكتسبة بصورة غير مشروعة، فضلا عن مساءلة الفاسدين، واصلاح القضاء وغيره من مؤسسات الدولة ضروري للاستفادة من نجاحاتها وتجنب اخفاقاتها.
ان تشابه ممارسات الأنظمة الاستبدادية القمعية وحصرها الثروة الوطنية بأيدي قلة فاسدة، يجعل لتجربة الشعوب بمواجهة هذا النوع من الأنظمة وتوحيد جهودها للتخلص منها، قيمة تتجاوز حدود البلد الواحد، لتفرض أشكالا من النضال والتضامن، لن تكون بالضرورة جديدة بل تعيدنا، في بعض ملامحها، الى حقب التحرر الوطني.
وهذا ما نلاحظ تطوره بين الشباب في ساحات التحرير بالعراق وفي الجزائر ولبنان. اذ استعادت المفاهيم التي حاربت الشعوب طويلا لامتلاكها، لأنها حق من حقوقها، كالوطن والحرية والكرامة ومعاقبة الظالمين والفاسدين، الى الواجهة في حيز الوعي المتنامي. وهي ذات القيم التي أراد المستعمر طمرها واستطاع بمرور الوقت، بالتعاون مع طبقة الفاسدين المحليين، أن يحقق نجاحات تبرعمت بشكل حكومات استبدادية وطائفية بالإضافة الى الخنوع امام المحتل.
اتضح عمق مطالبة المنتفضين بالوطن، مع استمرار الانتفاضة واستشهاد الشباب بشكل يومي تقريبا، لتصبح الدعوة الى اسقاط النظام ومحاسبة القتلة و « لا محسوبية ولا منسوبيه»، أساسية لتحديد تركيبة الحكومة المقبلة، وان كانت انتقالية، ولترسخ أسس اية حكومة وطنية مستقبلا. وهي قفزة نوعية تجمع ما بين الطموح بتنظيف السياسة والقضاء والاقتصاد والممارسات التي تخللت بنية المجتمع على مدى عقود. هذه المهام الضرورية إذا ما أُريد للعراق ان ينهض من كبوته، وقد منحت الانتفاضة بشجاعة شبابها وتضحياتهم، بقية أبناء الشعب، الأمل بإمكانية التغيير الحقيقي وليس فقط تدوير الفاسدين وهو ما كان يجري سابقا، كما رفعت من مستوى الوعي بالظلم والإهانة والحرمان من الحقوق من كونه استهدافا فرديا الى كونه جماعيا ووطنيا. وهذا ما لن يتمكن النظام الحالي بكل أسلحته المحرمة، المستخدمة ضد المنتفضين يوميا، وبكل وحشيته ولا اخلاقيته، من القضاء عليه، كما يريد، الى الأبد.
كاتبة من العراق
هل من قضية
يفوز بها العراقيون؟
هيفاء زنكنة
شهدت الأسابيع الأخيرة، ومع استمرار الانتفاضة في العراق، عودة عدد من وجوه «العملية السياسية» الأصليين، الذين دخلوا البلد مع الاحتلال، للظهور في الفضائيات الإخبارية، بعد انقطاع. من بين الوجوه البارزة أياد علاوي، أول رئيس وزراء عيّنه حاكم الاحتلال بول بريمر، والذي تم ارتكاب مجازر الفلوجة وتهديم مدينة المقاومة في ظل حكومته. في مقابلاته التلفزيونية الطويلة، هذه الأيام، يؤكد علاوي وقوفه إلى جانب المنتفضين وحرصه عليهم مستغربا قبول ابن عمه محمد علاوي، الذي يحبه كثيراً وهو إنسان طيب ونزيه، حسب تعبيره، منصب رئيس وزراء الحكومة الانتقالية. وفي مقابلة بعد أخرى يُقسم أياد علاوي بشرفه بأنه سيقف أمام المحاكم الدولية ليدلي بشهادته ضد الحكومة الحالية وأن لديه ملفات خطيرة سيقدمها في المحاكم ليفضحها. هل هي صحوة ضمير من أياد علاوي؟ وإذا كان جاداً بقسمه لماذا لا ينشر هذه الملفات والوثائق أو لم لا يقدمها الآن الى أية جهة قانونية دولية كخطوة أولى لوقف اغتيالات المحتجين السلميين، ولإظهار الحقيقة وكشف الوجه القميء البشع لحكومة المليشيات الفاسدة التي لا تتورع عن قتل أي شخص يعارضها، وربما لكسب ثقة أبناء الشعب وانه فعلاً سيقدم على فعل شيء بعيداً عن الظهور الإعلامي وتكرار ذات التصريحات الشعبوية؟
في المقابل، وبينما تواصل الحكومة العراقية استهداف المنتفضين بأكثر الوسائل وحشية اختطافاً وتعذيباً وقتلاً، الذين تجاوزت أعداد الضحايا المئات والجرحى والمقعدين والمعتقلين عشرات الآلاف وعدم تقديم أي من المسؤولين عن الجرائم الموثقة بالشهود والفيديوهات الى القضاء، تقوم منظمة محلية تدعى « الغد» بعمل حقيقي يمس حياة الناس فعلاً، وبلا تصريحات هوائية، إذ تستعد حاليا، لمقاضاة الحكومة الهولندية ومطالبتها بتعويضات لأنها تسببت بقتل 70 شخصا على الأقل، بينهم 22 امرأة و26 طفلا، في 2 حزيران 2015، في غارة جوية ألقت فيها طائرات أف 16 الهولندية، القنابل على مدينة الحويجة، الواقعة جنوب غرب كركوك. من بين المتضررين، امرأة قتل وجرح افراد عائلتها المكونة من 35 شخصا. هناك أيضا ضحايا أمراض من بينها السرطان والاصابة بالجنون، جراء المواد الكيمياوية المتصاعدة من القنبلة، والتي أثبت الإعلام الهولندي أن طائرة هولندية أسقطتها كجزء من عملية التحالف الدولي ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» الإرهابي (داعش).
ولأن الحكومة العراقية لم تتخذ أي خطوة لمساعدة الضحايا، ولأن ساستها منشغلون بالنهب والصراعات واتهام وابتزاز بعضهم البعض، ولا أمل في ان يطالبوا، يوماً، أية جهة معتدية بدفع التعويضات للضحايا، أخذت المنظمة على عاتقها إعداد ملف يشمل حتى الآن قضايا 50 ضحية.
إن مواجهة إنكار الجرائم المرتكبة ضد الضحايا المدنيين من قبل حكومات تتطلب وجود حكومة وطنية تؤمن بحقوق مواطنيها وأولها حق الحياة
تكمن صعوبة إعداد الملف، وهي صعوبة يلاقيها كل من يفكر برفع قضية ضد أي حكومة، في التوثيق الدقيق لئلا يتم التشكيك بمصداقية القضايا وبالتالي خسارتها، كما حدث في قضية العراقيين الذين قامت القوات البريطانية بتعذيبهم، بين عامي 2003 و2004. وانتهت القضية، بعد سنوات، بالخسارة حيث نجح الادعاء العام البريطاني بتفنيد الأدلة وإثارة الشكوك حولها. ويشكل التأخر في تقديم القضايا صعوبة في الحصول على الأدلة، كما أن عدم تسجيل الحوادث والجرائم في حينها بشكل قانوني صحيح يزيد من تعقيدها، إلا أن هذه العوائق كلها لم تمنع المنظمة من تقديم الملفات وتكليف محام بتبني القضية.
العائق الأهم هو تحديد من هو المسؤول قانونيا وكيفية التعامل معه، خاصة إذا كانت الجهة المسؤولة حكومة أجنبية وليست شخصا أو جهة فاعلة داخل البلد. فأثناء مناقشة القضية في البرلمان الهولندي، في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2019، أصرت وزيرة الدفاع آنك بيليفيلد على أن العراق مسؤول عن معالجة الأضرار الناجمة عن التحالف الدولي المناهض لداعش، لأن الحكومة العراقية هي التي دعت قوات التحالف للدفاع عنها. وهي نقطة مهمة جداً من ناحية تفادي المسؤولية القانونية والذي إذا ما تم تقبلها ستفتح أبواب التعويضات ضد كل دول التحالف التي سببت مقتل آلاف الضحايا من المدنيين، جراء قصفها لعديد المدن العراقية، وسقوط الضحايا تحت ما سمّته « أخطاء ثانوية». تفاديا لذلك، وعدت الوزيرة الهولندية، بأنها ستتخذ قراراً في وقت قريب بشأن ما إذا كان سيتم فتح صندوق مساعدات خاصة لضحايا انفجار الحويجة «كبادرة حسن نية». وعادت بعد ذلك للتصريح بأنه وفقاً لقوات التحالف، فإن جميع الأعضاء يتحملون المسؤولية نفسها عن الإصابات الناجمة عن العمليات. فما هو عدد « الإصابات» التي تتحدث عنها الوزيرة؟ ليست هناك أرقام دقيقة. فحسب قوات التحالف في 26 أيلول/ سبتمبر أنها أجرت 34573 غارة جوية بين أغسطس/آب 2014 وأغسطس 2019، وأن ما لا يقل عن 1335 مدنياً قد قُتلوا من دون قصد في سوريا والعراق. بينما تؤكد منظمة « الحروب الجوية» الراصدة لأعداد الضحايا تراوح العدد بين 8214 و13125 من غير المقاتلين من المرجح أن يكونوا قد قتلوا نتيجة لأعمال التحالف خلال نفس الفترة.
وبالنسبة الى التعويضات، ترفض الحكومة البريطانية الاعتراف بوجود ضحايا مدعية بأنه لم يصب أي مدنيين في أكثر من 1300 غارة جوية تابعة للقوات الجوية الملكية في العراق، بينما تخلت الإدارة الأمريكية حتى عن نظام تسديد مدفوعات «التعازي» التقديرية الذي كانت تدفعه سابقاً في أفغانستان والعراق، مبينة في تقرير وزارة الدفاع السنوي عن الخسائر المدنية: «… في الحالات التي تطلب فيها دولة مضيفة أو حكومة دعماً عسكرياً أمريكياً للقوات العسكرية المحلية، قد يكون من الأنسب أن تستجيب الدولة المضيفة أو جيشها للاحتياجات وطلبات السكان المدنيين المحليين من خلال تقديم التعازي بنفسها».
ان مواجهة إنكار الجرائم المرتكبة ضد الضحايا المدنيين من قبل حكومات تتطلب وجود حكومة وطنية تؤمن بحقوق مواطنيها وأولها حق الحياة، أما مواجهة إنكار الجرائم ضد المواطنين من قبل حكومتهم، كما يحدث الآن في العراق، فيتطلب مواصلة النضال ضد هذه الحكومة من قبل كل أبناء الشعب، وأن تستمر صرخة المنتفضين: كفى استهانة بعقول الناس، فتغيير الأقنعة لا يعني تغيير الوجوه.
كاتبة من العراق
توجيهات
«السيد» للثائرة العراقية
هيفاء زنكنة
لم تكن تظاهرة النساء العراقيات يوم 13 شباط/ فبراير، مليونية بلغة الأرقام والاحصائيات، التي تستهوي زعيم التيار الصدري السيد مقتدى، كلما خطر على باله إطلاق أتباعه في شوارع المدن العراقية. كانت التظاهرة أكبر وأهم من ذلك بكثير. هتفت المتظاهرات بصوت يتحدى كل من يحاول إسكاتهن «صوت المرأة ثورة»، وهو صوت من تطالب بحقها « نازلة آخذ حقي»، وهو مقاومة « الحق سلاحي وأقاوم، أنا فوق جراحي سأقاوم، أنا لن أستسلم لن أرضخ، وعليك بلدي لا أساوم».
في مسيرة سلمية، غير رسمية، لم يشهدها العراق منذ عقود، تعالت أصوات النساء مرددة «هايه بناتك يا وطن هايه»، لتجسد ما هو أعمق من مجرد التحدي المؤقت لرجل دين يرى في مشاركة المرأة في الاحتجاج ضد الفساد والطائفية والاحتلال، وفي مطالبتها مع شقيقها الرجل باستعادة الوطن، دعوة الى « التحرّر والتعرّي والاختلاط والثمالة والفسق والفجور، بل والكفر والتعدّي على الذات الإلهيّة وإسقاط الأسس الشرعيّة والأديان السماويّة والتعدّي على الأنبياء والمرسلين والمعصومين»، حسب تغريدة له بلغت درجة الفتوى بين أتباعه «أفتى» فيها بأن «على المتظاهرين مراعاة القواعد الشرعيّة والاجتماعيّة للبلد قدر الإمكان وعدم اختلاط الجنسين في خيام الاعتصام».
تعامل البعض مع موقف المرأة هذا باعتباره مفاجئا واستثنائيا بينما سيجد من يتابع نضال المرأة العراقية ان صمتها هو الاستثناء، وان هذه التظاهرة وما سبقها من مشاركة يومية في مقاومة الاحتلال الأنجلو – أمريكي والتظاهرات والاعتصامات التي سبقت انتفاضة تشرينالأول / أكتوبر، امتداد طبيعي لنضالها المتميز، كما شقيقاتها في فلسطين والجزائر وتونس ولبنان والسودان وبقية البلدان العربية، في مراحل التحرر الوطني ومحاربة الاحتلال، وما تبعها من مناهضة الحكومات المستبدة وحكومات الاحتلال بالنيابة. ويشكل سكوتها، في السنوات الأخيرة، قطيعة فرضتها وحشية الاحتلال وعملائه، الذين كان واحداً من أكبر أهدافهم اخضاع كل من يفهم معنى الحرية والوطن.
فالفتاة الحاضرة في ساحات التحرير، اليوم، هي إبنة تلك الجدة التي قاومت الاحتلال البريطاني في أربعينيات القرن الماضي، وظن الكثيرون انها استكانت لعبودية الاحتلال والطائفية ونهب الوطن، غير انها خيبت آمال من أرادوها خانعة مستكينة لتثبت أن جذورها تمتد عميقاً في أرض البلد وأهله.
هزت الانتفاضة، عبر صمود المشاركة وبناء الثقة بالنفس وديناميكية الوعي، مفاهيم اجتماعية غالباً ما تبرز خلال التظاهرات والاعتصامات حول دور المرأة ووجوب حمايتها
أثبتت شهور الانتفاضة، أن سيرورة خروج المرأة الى الشارع، ومشاركتها على كل المستويات، ساعدت على تقوية مناعتها ضد الخنوع وعلى تطوير نفسها، ونفض غبار الأوهام التي فرضت عليها لتعيدها عقوداً الى الوراء، من هنا جاءت إضافتها النوعية الى الحراك الذي اختارت المشاركة فيه. فبمساهمتها مع أشقائها ارتقت بالحراك من مستوى الاحتجاج الى التظاهرة الى الاعتصام ثم الى الانتفاضة. وها هي تُبلغ العالم الصامت، بذكوره وإناثه، أنها شريكة في صنع ثورة. ثورة ستعيد للوطن، للعراق، ألقه. العراق الذي كان العالم يعرفه، قبل أن يدخله البرابرة بقناعين: الأول هو قناع الديمقراطية وحقوق المرأة، متمثلاً بالاحتلال الأمريكي، والثاني هو قناع الدين السياسي والطائفة متمثلاً بإيران. بعد 17 عاما من الاحتلال بقناعيه، المعجون ببقايا ما ناضلت ضده منذ بناء العراق الحديث، تمكنت المرأة من الانسلال خارج الجدران الكونكريتية التي نصبها الاثنان حولها، لتنطلق حرة أبية متحدية الخوف والترويع والإرهاب.
من الصعب التنبؤ بما سيجلبه الغد، في ظل الإرهاب الحكومي والمليشياوي المستمر ضد المنتفضين اختطافاً وقتلاً، ومع استمرار فرض الحصار على الساحات وحرق الخيم، والهجوم طعنا بالسكاكين، ومع استمرار التسويف والتحايل السياسي، ولعبة المفاوضات والممانعة بين أمريكا وإيران، إلا أن هناك تغيرات سياسية وثقافية ومجتمعية عاشها العراق منذ خمسة شهور لا يتطرق اليها الشك. جوهرها هو أن عراق الامس لن يتكرر، ودوام القمع وَهم، وأن المرأة العراقية التي استعادت كرامتها بفعل الثورة لن تعود الى ما كانت عليه. فقد هزت الانتفاضة، عبر صمود المشاركة وبناء الثقة بالنفس وديناميكية الوعي، مفاهيم اجتماعية، غالباً ما تبرز، بشكل قوي، خلال التظاهرات والاعتصامات والثورة والمقاومة، حول دور المرأة ووجوب حمايتها.
تستغل السلطات القمعية هذه المفاهيم لتحرم الثورة من نصف قوتها وذخيرتها الحية، تحت ستار القيم والدين والشرف، واستغلال خوف الآباء والامهات على حياة أبنائهم، خاصة البنات لما قد يتعرضن اليه من انتهاكات تمس الشرف، بينما تقوم ذات السلطات بالاعتداء على المرأة وانتهاك كل الاخلاق والقيم، بأشكال متعددة، تصل الى التحرش والمساومة الجنسية أو اعتقالها كرهينة، حين تحاول المرأة، مثلاً، الحصول على أي معلومات عن أحبائها المعتقلين. هذه الشيزوفرينيا المجتمعية ـ الدينية، بصدد المرأة، لا تقتصر على بيانات رجل الدين مقتدى الصدر بل تتعداه الى المنظومة السياسية، بمجملها، لما تشكله من فائدة كأداة قمعية. وما تغريدات الصدر غير الظاهر المعلن، في أساليب تبين ذعر الساسة الحاليين من استرداد المجتمع عافيته، وإعادته النظر في أساليب تفكيره وسلوكه وطقوسه التي أصبحت، خلافا لما هو متعارف عليه، مُسَخَرة للتفرقة بين فئات المجتمع، وخاصة بين الرجل والمرأة.
ان اتهامات السيد مقتدى الصدر المستهدفة لدور شباب الانتفاضة، والمرأة خصوصا، مكملة لمحاولات المحتل الأمريكي الذي أراد تبييض وجهه، متقرباً من المرأة، بمبادرات تراوح ما بين « تمكين المرأة» و « ورشات الديمقراطية»، في الوقت ذاته الذي دمر فيه البلد وسبب قتل ما يزيد على المليون مواطن. الامر المشابه لسياسة المستعمر الفرنسي بالجزائر، حين شنّ حملة «تحرير» موجهة للنساء تحت الاحتلال، تهدف إلى جذبهن بعيداً عن جبهة التحرير الوطني، من خلال مراسيم كان من بينها حق كشف النقاب للنساء في الأماكن العامة، والتعيين الرمزي للنساء المسلمات في المناصب العامة. فشلت حملة المُستعمر الفرنسي في إيقاف مسيرة التحرير، وها هم شباب الانتفاضة، إناثاً وذكوراً، يطالبون بوطنهم، ويدفعون ثمناً غالياً جداً، لإدراكهم أن هيمنة المستعمر، الاقتصادية والثقافية والمجتمعية، مهما كانت دولته أو قوميته أو دينه، تبدأ بواسطة العنف وتخريب البلد وحرمانه من سيادته وموارده، ولا تنتهي بتعيين مستخدمين مأجورين بل تستمر بأشكال تتجدد حسب مقتضيات الهيمنة، بينما تبدأ وتنتهي استعادة الانسان لوطنه باستقلاله وكرامته.
كاتبة من العراق
هل بإمكان أمريكا
تنظيف نفسها في العراق؟
هيفاء زنكنة
كما في سنوات الحصار على العراق والتهيئة للغزو والاحتلال (1990 ـ 2003)، ترتفع أصوات بعض العراقيين، حاليا، وأكثريتها من المقيمين خارج العراق، مطالبة بالتدخل الأمريكي. ينتشر النداء على مواقع التواصل الاجتماعي وضمن المجاميع الخاصة، تحت ذرائع لا ينقصها حسن النية، وبأشكال متعددة من بينها ارسال عريضة موجهة الى البيت الأبيض لتحمل مسؤولية الغزو وإنقاذ المواطنين من حكومتهم المستبدة.
ليس هذا النداء جديدا، اذ سبقه نداء مماثل وجهه مفكر عربي، منذ ثلاثة أعوام تقريبا، بعنوان « اللي شبكنا يخلصنا». تم إطلاق المناشدة الأخيرة بالتزامن مع تعرض الشباب المنتفضين في ساحات التحرير، منذ تشرين / أكتوبر الماضي، للقتل والاختطاف والتعذيب، بلا تمييز بين ذكر أو أنثى، وبعد أن مست آلة القمع الوحشية حتى الأطفال المستخدمين لابتزاز ذويهم المتظاهرين واجبارهم على العودة الى بيوتهم. جاءت المناشدة، أيضا، في وقت لم تعد فيه الأحزاب والقيادات الشعبوية المستندة الى الدين او الطائفة قادرة على التضليل، وتمرير الخدع فترة أطول، خاصة مع تزايد عدد الشهداء والجرحى والمعوقين والمعتقلين، بينما يقف العالم الخارجي، بضمنه الدول العربية والاسلامية، أما متفرجا، متحالفا مع النظام، في انتظاره أن يتعب المنتفضون ويعودون الى بيوتهم، أو مراهنا على اضعاف إيران في مفاوضات جارية بين الطرفين، ضمن مجريات صراعهما على الأرض العراقية، ولا يتحمل فيها أي من الطرفين خسارة مباشرة، بل يدفع ثمنها أبناء الشعب العراقي.
تشكل هذه الأرضية محاججة المتوجهين الى أمريكا بمناشدتهم «ليس استجداء ولكن طلبا من أمريكا تصحيح خطئها التاريخي باحتلال العراق تحت مسمى الديمقراطية»، متسائلين بلوعة وحرقة قلب « ما هو الحل؟ هل نستسلم للميليشيات لتقتل كل شباب الشعب العراقي أم نطلب ممن وضع هؤلاء على رأس هرم السلطة ليحذفوهم من المعادلة السياسية الراهنة «؟
يعيدنا سؤال: ما هو الحل؟ الى سنين ما قبل الغزو. فالشعب محاصر وجائع جراء تدهور الوضع الاقتصادي بحيث صار راتب الموظف يساوي دولارين شهريا، ومعارضة الخارج، بأنواعها، كانت تساهم برسم صورة مضخمة عن أسلحة دمار النظام، وجيشه الأقوى المُهدد للعالم، ومفرمة اللحم التي أبكت بواسطتها آن كلويد، النائبة في البرلمان البريطاني، بقية النواب، عشية التصويت على وقوف بريطانيا بجانب أمريكا، لإنقاذ العراقيين من المفرمة، وبناء عراق الديمقراطية وحقوق الإنسان. وانتهينا بكارثة بشرية وبنى تحتية، ورثها ويعيش نتائجها شباب الوطن الان. ولا نزال نسمع أصوات من تعاونوا مع المحتل مبررين: « لم يكن هناك حل آخر»، أو « كان ذلك الحل الوحيد لإنقاذ العراق».
الحل هو وحدة المنتفضين وصمودهم وانضمام بقية أفراد الشعب إليهم، مع مواصلة ناشطي الخارج حملات التضامن والدعم وايصال صوت المنتفضين الى العالم الخارجي. على المدى البعيد: لا بديل عن النهوض التدريجي للقوى الذاتية
نحن، الآن، امام تاريخ يعيد نفسه. فاليوم، كما يكرر الكثير من اهلنا داخل العراق، أسوأ من الامس، ولا ندري ما الذي سيجلبه الغد. بعد تجاوز الانقسام الطائفي الذي أثبت تجاوزه، خلال أربعة أشهر فقط من الانتفاضة، كم كان واهيا وبلا جذور في المجتمع، طفت على السطح أصوات منقسمة حول الاستجارة/ الاستنجاد/ المناشدة أو المطالبة (سمها ما تشاء) إما بإيران او أمريكا. مع أن كليهما يحتلان العراق وفق صفقات تتجدد منذ الغزو عام 2003 بتوزيع المنافع والمناصب لزبائن كل منهما، و«قواعد اشتباك « و«خطوط حمر» في التجاذب والتنافس قبل التوافق، ويعرفان جيدا، ربما أكثر من النظام العراقي نفسه، تفاصيل ما يجري يوميا من جرائم يساهمان إما بارتكابها مباشرة، بواسطة الميليشيات والمرتزقة وقوات العمليات الخاصة، او بشكل غير مباشر عن طريق أتباعهما المحليين، ثم يتبادلون التهم والإدانات والاستنكار بشأنها.
ان إدراك المنتفضين لطبيعة وتشابك العلاقة بين الشيطان الأكبر والأصغر، بعد أن ذاقوا مرارة العيش، بلا كرامة، في ظليهما على مدى 17 عاما، هو الذي يجعلهم يرفعون شعار « ألعن أبو أمريكا وأبو إيران»، وهو الذي يميز انتفاضتهم ويحصنها ضد السقوط في مستنقع الاستجارة بهذا النظام أو ذاك. إن المنتفضين، بحكم معايشتهم اليومية للأحداث بتفاصيلها المفرحة والدامية معا، وفهمهم لمتطلبات النضال السلمي المشترك، بمواجهة قوى تتربص بهم، يعرفون أفضل منا نحن المقيمين على مبعدة، خارج الوطن، ونرى ونتفاعل مع ما يجري عبر شاشات التلفاز وأيديولوجيات أجهزة الاعلام واشرطة الفيديو (على أهميتها). يفرض علينا، هذا الاختلاف مستوى من النشاط التضامني، يتماشى مع مطالب المنتفضين، لا يزايد عليهم ولا يختطف أصواتهم ليجيرها لمصالح حزبية او شخصية، تفاديا لما حدث في الماضي، حين باع معارضو الخارج صوت الشعب العراقي المضطهد الى الإدارة الأمريكية مصورين إياه بانه سيستقبل قوات الاحتلال بالزهور والحلوى. إن هتاف المتظاهرين في مدينة النجف « مقتدى الصدر قاتل»، بعد أن تعرضوا لمجزرة دامية، اتهم بارتكابها اتباع الصدر، لا يعني أن يطالب المتضامنون معهم، خارج العراق، أن « تتحمل أمريكا مسؤولية خطئها وتنظف العراق ممن نصبتهم». هذه المطالبة، مهما كان حسن نية المطالبين بها او حرقة قلوبهم على شباب الانتفاضة، بحاجة الى التوضيح إذا ما أريد عدم تكرار الماضي وتجربته المريرة بكل تفاصيلها البشعة، بضمنها المجازر الحالية. هل من الصحيح استبدال مجرم بآخر؟ ماهي تفاصيل عملية التنظيف المُطالب بها؟ ماذا عن جرائمها هي (فساد، مجازر، اعتقالات وتعذيب، قصف المدن، يورانيوم منضب)؟ ثم من الذي سيحل محل الساسة الحاليين؟ إذا افترضنا صحة موقف مطالبي أمريكا بالتدخل، ما هو الثمن الذي يتوجب على العراق دفعه بالإضافة الى ما يدفعه الآن، خاصة بعد ان أكد الرئيس الأمريكي ترامب أن على الدول التي ترغب بالحماية الأمريكية أن تدفع الثمن، لأن أمريكا ليست منظمة خيرية؟ هل سيكون الثمن شن الحرب ضد إيران؟
ولننتبه جيدا الى حقيقة أن الاحتلال الأمريكي هو الذي أدى الى زرع ونمو الميليشيات الإيرانية وإرهاب داعش، وأن ما ارتكبته أمريكا ليس خطأ، كما يدعي ساستها، بل جريمة منهجية استهدفت تحطيم العراق بشعبه ودولته. ما هو الحل اذن؟ هناك بعض الاستشراف الآني: وحدة المنتفضين وصمودهم وانضمام بقية افراد الشعب إليهم، مع مواصلة ناشطي الخارج حملات التضامن والدعم وايصال صوت المنتفضين الى العالم الخارجي. على المدى البعيد: لا بديل عن النهوض التدريجي للقوى الذاتية، ومنها الحركات السياسية الجديدة، عبر رفض سياسات الاستعانة بالأجنبي والتعويل على القوى الخارجية، أيا كانت.
كاتبة من العراق
هل يستحق رئيس الوزراء
العراقي الجديد منحه الفرصة؟
هيفاء زنكنة
يحمل كل يوم يمر على المنتفضين، في ساحات التحرير، في العراق، تحديات جديدة بشكل حواجز كونكريتية. يواجهونها كما يفعل عدَاء الحواجز ولكن ليس على مسافة مائة متر المتعارف عليها، بل مسافة الماراثون، أي بالكيلومترات. ففي الاسبوع الماضي، تمكنوا من تجاوز أحد الحواجز التي تعوَد مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري وميليشيا سرايا السلام، على نصبها كلما بانت في الأفق ملامح تغيير حقيقي في منظومة الفساد والطائفية والقتل التي تسمى « حكومة». فعلى مدى عمر الانتفاضة التي بدأت في الاول من تشرين / اكتوبر الماضي، كان أتباع الصدر يتناوبون على البقاء في الساحات حينا، مدعين توفير الحماية للمنتفضين، والخروج منها حينا آخر بناء على أوامر «السيد» المتقلبة بسرعة تنافس سرعة المروحيات في قيظ تموز العراق. هناك قائمة طويلة من تقلبات المواقف التي اتخذها الصدر، منذ احتلال البلد عام 2003، وصارت سمة عجنت بها شخصية «السيد» وتصريحاته التي باتت أضحوكة كارتونية، إلى حد دفع عددا من المنتفضين الى رفع شعار «ما نريد وطنا… نريد نعرف ماذا يريد الصدر».
ركز الصدر وأتباعه، في الاسابيع الاخيرة، على تهيئة الأرضية لهجوم ميليشياوي تحت أنظار الحكومة والبرلمان والقوات الأمنية التي، غالبا، ما نراها في الفيديوهات، التي تصلنا لتوثيق يوميات الانتفاضة، وهي تقف متفرجة على مسلحي الميليشيات وهم يطلقون النار على المنتفضين، كما يقومون باعتقالهم واختطافهم ترويعا للآخرين. واذا كان رئيس الجمهورية برهم صالح قد تحول، فجأة، الى بطل وطني يتحدث، بأسى عن خلافات الأحزاب الشيعية التي تمنعها من ترشيح رئيس وزراء نزيه، فان أعضاء البرلمان لم يكلفوا انفسهم عناء الدوام، متمتعين بالإجازة باستثناء اليوم الذي نفذت فيه القوات الأمريكية عملية اغتيال « الضيف الإيراني»، قاسم سليماني، يومها وقفوا مرددين هوسة «كلا كلا أمريكا»، فكانت ردة فعل المنتفضين «ألعن أبو إيران لأبو أمريكا»، فالاحتلال، حسب منظورهم واحد حتى لو ردد البعض أن خرمشة أمريكا أكثر ألما من خرمشة إيران. بهذا أثبت المنتفضون وعيهم الذي تجاوز الأحزاب التاريخية المهترئة، والجديدة الطائفية، حول مفاهيم التلاعب السياسي، والقبول بالأمر الواقع، وتقاطع المصالح الذي قاد العراق من مصيبة الى كارثة.
أدى الهجوم على خيم المنتفضين وحرقها، في الاسبوع الماضي، الى ازدياد عدد المتظاهرين بدلا من ترويعهم واجبارهم على الانسحاب، مما دفع أتباع « السيد» الى العودة الى الساحات ومحاولة السيطرة عليها بالقوة، تحت مسمى «ذوي القبعات الزرق» في ذات الوقت الذي كانت فيه ماكنة أحزاب النظام تتهيأ لاحتواء الانتفاضة، سياسيا، بعد أن صمد المنتفضون، حتى الآن، أمام الاختطاف والتعذيب القتل والرش بالغاز القاتل.
لم لا يحاول محمد توفيق علاوي، وهو في المنصب الذي رضي بتسنمه، ولديه الدعم من تحالفين يملكان أشرس الميليشيات، وبمباركة إيران وأمريكا وحتى ترحيب الأمم المتحدة، أن يكسب ثقة الشعب بإجراء خطوات يمكن تنفيذها خلال أيام، على غرار اطلاق سراح المحتجين المعتقلين، ومحاسبة القتلة والجلادين؟
جاء التحرك السياسي تحت غطاء الحرص على الوطن والمتظاهرين وشعار « كلا، كلا، أمريكا»، لمقتدى الصدر، الذي بات مثل الطعام البائت غير المستساغ. اذ اتفقت كتلتا «الفتح» بزعامة هادي العامري، و«سائرون» بزعامة الصدر، بعد محادثات سرية بين الأحزاب المتصارعة، وبالتوافق مع إيران وأمريكا، على تعيين محمد توفيق علاوي، رئيسا للوزراء يحل محل عادل عبد المهدي الذي أجبره المنتفضون على الاستقالة. من المفارقات التي أثارت غضب المنتفضين السلميين كونه ذات التحالف الذي أوصل عبد المهدي الى المنصب. وإن سيرة حياة علاوي، تكاد تطابق سيرة عبد المهدي، في تذبذبه السياسي من تابع لآل الصدر إلى حزب الدعوة الشيعي، ومن قائمة « العراقية» العلمانية إلى تقديم نفسه كمستقل. عاد علاوي إلى البلد مع الاحتلال الأمريكي، انتخب نائبا، ثم تم تعيينه في حكومتي نوري المالكي (2006 ـ 2014) التي ساهمت بتحويل العراق إلى حقل قتل طائفي، تخلله قصف مدن المقاومة بالبراميل الحارقة، ومشاركة المحتل الأمريكي الاحتفالات بذريعة محاربة الإرهاب. أين هو علاوي من مطالب المتظاهرين وشروطهم لاختيار رئيس وزراء لتشكيل حكومة المرحلة الانتقالية؟ لا تدل سيرة علاوي وتاريخه القريب، على أنه يحمل أيا من المواصفات المطلوبة التي ستضمن عودة المنتفضين الى بيوتهم، ومنحه فترة زمنية يتم فيها تحقيق بقية المطالب حسب أولويتها من إجراء انتخابات بإشراف أممي، وتنظيف البلاد من الفساد، ومحاكمة المسؤولين عن قتل 700حوالي متظاهر وجرح 25 ألف واطلاق سراح المعتقلين المتعرضين، حسب كل التقارير الحقوقية المحلية والدولية، إلى أبشع أنواع التعذيب. فهو ابن العملية السياسية التي أسسها الاحتلال، واعتاشت عليها الأحزاب الممثلة بمجلس الحكم اولا وحكومات الاحتلال، بميليشياتها، ثانيا. واذا كان قد استقال من حكومة المالكي، عام 2012، لأن المالكي «لا يتخذ أي إجراء ضد المقربين منه بتهمة الفساد»، فقد جاءت الاستقالة بعد حوالي عشر سنوات من الصمت كبرلماني ووزير في حكومة أبدعت بخطف وقتل وتعذيب المعارضين بالإضافة الى مأسسة الفساد. ما يستحق الذكر أن علاوي صرح حينئذ، وبعد اتهامه هو نفسه بالفساد، واصدار حكم عليه، أنه « يملك وثائق تؤكد وجود عمليات كسب غير مشروع داخل الحكومة، وأنه سيكشف عنها في الوقت المناسب». وها هي قد مرت 8 سنوات على استقالته، وفرخ الفساد الإرهاب، وهو مقيم ببلد يستطيع فيه، كمواطن بريطاني، أن يقيم الدعاوى على الفاسدين، اذا اراد وهو آمن على نفسه وعائلته، فمتى هو الوقت المناسب؟
ماذا عن الآن، ولنفترض انه (أو غيره من مرشحي النظام)، يستحق اعطاء فرصة للعمل خاصة بعد أن بين في خطابه الأول اتفاقه مع المنتفضين في كل طلباتهم حاثا إياهم على البقاء في الساحات (كأن المنتفضين يتمتعون بالبقاء في الساحات، ليلا نهارا، وهم يحملون حياتهم على أكفهم) ؟ لم لا يحاول، وهو في المنصب الذي رضي بتسنمه، ولديه الدعم من تحالفين يملكان أشرس الميليشيات، وبمباركة إيران وأمريكا وحتى ترحيب الأمم المتحدة، أن يكسب ثقة الشعب بإجراء خطوات يمكن تنفيذها خلال ايام، على غرار اطلاق سراح المحتجين المعتقلين، ومحاسبة القتلة والجلادين؟ واذا كان فعلا يريد القضاء على الفساد، كما اعلن، فلم لا يكشف وثائق الاختلاسات والفساد التي يملكها؟ أم أن على المنتفضين أن يعيشوا، في وطنهم، رهائن لتدوير سلسلة الأكاذيب مرة أخرى!
كاتبة من العراق
الجيش الأمريكي
لن يكتب حاضر العراق
هيفاء زنكنة
بعد شهر واحد من بدء انتفاضة تشرين الأول/أكتوبر، أصدر معهد الدراسات الاستراتيجية ومطبعة كلية الحرب للجيش الأمريكي، الجزء الثاني ( 670 صفحة) من الدراسة التي خطط لها الجنرال الأمريكي ريموند اوديرنو، في أيلول/سبتمبر 2013، وأنجزها باحثو «مجموعة دراسة عملية حرية العراق»، بعنوان «الجيش الأمريكي في حرب العراق»، وكان الجزء الاول ( 700 صفحة) قد أصدر بداية العام المنصرم.
السؤال الذي يتبادر الى الذهن عند رؤية هذه المئات من الصفحات هو: ما الذي يجعل هذه الدراسة تستحق القراءة، بالنسبة إلينا؟ ما الفائدة منها وهي، كما يدل العنوان، قد لا تزيد عن كونها سردا لتاريخ احتلال يتم تسويقه باعتباره تاريخ حرب عادلة وأن نتائجها البشرية الكارثية مجرد أخطاء؟ تعتمد الاجوبة على كيفية قراءة الدراسة، واي منظور ينطلق منه القارئ.
يرى الباحثون المساهمون بإعداد الدراسة، ومعظمهم برتب عسكرية عالية، إن هذه الدراسة موجهة الى نوعين من القراء، الاول هم قادة الجيش الأمريكي الحالي وجيش المستقبل، لفهم طبيعة العمليات العسكرية وتحليلها وتقييمها، والثاني هو المدنيون في أمريكا وبلدان التحالف، لمساعدتهم على فهم تجربة الجيش في الحرب تفاديا لخلق فجوة بين الاثنين. كتبه الباحثون على غرار «الجيش الأخضر» عن تاريخ الحرب العالمية الثانية، حيث التركيز على العمليات العسكرية، من وجهة نظر القيادة العسكرية، مع محاولة تقديم وجهة نظر «العدو» وظروف البلد والمحتوى السياسي والاجتماعي لـ«الصراع».
إذا ما وضعنا جانبا، عدم التطرق الى الأسباب الحقيقية للغزو وتكرار القاء اللوم، بشكل مباشر وغير مباشر، على العراقيين أنفسهم للخراب الذي أصاب البلد وخسارة الأرواح، وتذكر أن هذه الدراسة، في جوهرها، سرد لتاريخ احتلال العراق، كما يراه قادة قوات الاحتلال، لوجدنا أن أهمية الكتابين تكمن في كيفية قراءة وتحليل المقابلات العسكرية التي أجريت خصيصا للدراسة، والسجلات والوثائق السرية البالغ عددها 30 ألف وثيقة تم رفع حجر السرية عنها للباحثين. مما يعني توفرها لكل من يمتلك الرغبة بفهم وقائع ونتائج العمليات العسكرية، خاصة اذا ما تم الرجوع، أيضا، الى وثائق ويكيلكس العراق، التي تشكل بحد ذاتها مخزونا لإدانة القوات الأمريكية والشركات الأمنية والمرتزقة، وكل من سبب قتل العراقيين، في المستقبل.
ما لم يتم التطرق إليه في الدراسة، باعتراف الباحثين هو أولا : دور قوات العمليات الخاصة، التي كانت فاعلة طوال فترة الحرب، لأن « قيادة العمليات غير مستعدة للسماح بالاطلاع على وثائقها» وترى أن الوقت لم يحن لذلك، وثانيا : دور قوات الأمن العراقية ودور «العدو». وتستخدم مفردة «العدو» للإشارة الى المقاومة التي اختار الباحثون تسميتها، أيضا، حينا بالتمرد واخرى بالإرهاب.
من التفاصيل الموثقة كيفية تعامل قوات الاحتلال ومجلس الحكم مع الميليشيات وأكثرها نفوذا فيلق بدر، الذي أسسته ايران، بقيادة هادي العامري
يبحث الكتاب الاول، بالتفصيل، قرارات بول بريمر والقوانين المعنية باجتثاث البعث وحل الجيش العراقي وتأسيس مجلس الحكم، بمحاصصته الطائفية التي يتحمل مسؤوليتها، حسب الباحثين، العراقيون السبعة، من معارضة نظام البعث التي كانت ناشطة خارج العراق وهم: احمد الجلبي، أياد علاوي، ابراهيم الجعفري، نصير الجادرجي، باقر الحكيم، مسعود بارزاني وجلال طالباني. إذ طلب منهم بريمر انتقاء بقية أعضاء مجلس الحكم من منظور «غير طائفي». فكانت النتيجة مجلس حكم طائفي، هيأ لمأسسة المحاصصة الطائفية في كل مؤسسات الدولة والحكومة ومجلس النواب، حتى اليوم.
من التفاصيل الموثقة الأخرى، التي تسترعي الانتباه لكونها اساسا لما يجري في البلد، حتى اليوم، ولعلاقتها المباشرة، بحالات الاختطاف والقتل التي يتعرض لها المنتفضون في ساحات التحرير، هي كيفية تعامل قوات الاحتلال ومجلس الحكم مع الميليشيات وأكثرها نفوذا فيلق بدر، الذي أسسته ايران، بقيادة هادي العامري. وقد كتب الباحث باتريك بتلر مقالة طويلة بعنوان « ماذا تكشف تصريحات اوديرنو عن حرب العراق؟»، ترجمها طارق العاني، عن خصوصية تعامل القوات الأمريكية مع فيلق بدر. لهذه المقالة أهميتها ازاء ندرة التغطية الإعلامية حول دراسة الجيش الأمريكي، عربيا أولا، ومحاولة الكاتب الجادة لإثبات أن العلاقة بين القوات الأمريكية وفيلق بدر، منهجية، بدءا من قول الجنرال أوديرنو، الذي كان حينها قائد فرقة المشاة الرابعة، عن احباطه حين علم بإطلاق سراح مجموعة من أفراد فيلق بدر اعتقلوا، لارتكابهم جريمة قتل في أيار/ مايو 2003، وتصريح ديريك هارفي، الذي خدم لاحقاً في مجلس الأمن القومي في حكومة ترامب، لوكالة رويترز في كانون الأول/ ديسمبر 2015 أكد فيه أن القوات الأمريكية أطلقت سراح قتلة من فيلق بدر، الذين تم إلقاء القبض عليهم وبحوزتهم قوائم لاستهداف بعثيين. وتشير احدى برقيات ويكيليكس – العراق الى أن عشرة آلاف عضو في بدر شكلوا فرق موت استهدفت أعضاء البعث من السنة والشيعة في البصرة والعمارة وديالى وبغداد، وأن «العامري قد يكون قد أمر شخصياً بشن هجمات على ما يصل إلى 2000 من السنة» وأن «إحدى طرقه المفضلة في القتل يزعم أنها تتم باستخدام المثقب لاختراق جماجم الخصوم «، في فترة التفاخر باستخدام المثقب لإثارة الرعب عندما أطلق الاحتلال العنان للميليشيات لارتكاب جرائم القتل الجماعي، في مناطق الحواضن الشعبية للمقاومة. وجرى تلويث المقاومة بالطائفية، بعمليات إضافية لفرق العمليات الخاصة الأمريكية بين 2005-2007، وسلسلة الجرائم المرعبة التي تلتها والموصوفة، في الدراسة غالبا، بأنها تمت عن طريق الخطأ.
ولاتزال حوادث القتل اللاإنسانية، تتكرر اليوم، في استهداف المنتفضين السلميين اختطافا وقتلا، واستخدام عبوات الغاز المسيل للدموع المخصصة للاستخدام الحربي التي تخترق، يا للمفارقة، جماجم « الخصوم»، من قبل المليشيات برعاية أمريكية. كما لانزال نقرأ تاريخنا وحاضرنا مكتوبا من قبل آخرين.
كاتبة من العراق
العراق: اغتيال الصحافة
ولعبة تدوير الساسة
هيفاء زنكنة
الى قائمة الشهداء العراقيين، نساء ورجالا، أضيف منذ ثلاثة أيام، الصحافي أحمد عبد الصمد وزميله المصور غالي التميمي، اغتيلا، كما بات متعارفا عليه، رسميا بالعراق «برصاص مسلحين مجهولين» فروا الى «جهات مجهولة». تؤكد هذه الصيغة الجاهزة المبتذلة، الاستهانة بأهم حقوق الإنسان وهو حق الحياة، بالإضافة الى حرية الرأي. وتهدد، بالنسبة إلى الصحافيين، جوهر عملهم، فضلا عن حياتهم. فمن من الصحافيين يجرؤ، في أجواء الترويع والتهديد على ذكر حقيقة ما يجري؟ كيف سيتمكن الصحافي، المستقل، من المحافظة على حياته، إذا ما قدم خبرا مغايرا للتصريحات الرسمية الجاهزة؟ ماذا حدث لـ «العملية السياسية» المُغلفة بورق حقوق الإنسان الصقيل؟ أم أن هناك تعريفا جديدا للصحافي وعمله لا يعرفه غير ساسة «العراق الجديد»؟
يدل استخدام الناطقين الرسميين باسم الحكومة هذه الصيغة على وجود توليفة من ساسة فاسدين وميليشيات ومرتزقة يستهدفون من يشاؤون، بحرية كبيرة، ولعلهم من القلة التي تتمتع بحرية الحركة والتعبير عن رأيها، عن طريق اغتيال من يتجاوز الخطوط الحمراء التي رسموها، خارج حدود القانون والدولة. وهي قلة تتمتع بالحصانة من العقاب بحكم كونها «مجهولة»، ولم يحدث وتم تقديم أي من أفرادها الى القضاء في ظل حكومات ودولة ما بعد الاحتلال. دولة بُنيت على « المجهولين» و»الأطراف» وأهمهم « الطرف الثالث». حيث اُستحدث مصطلح « الطرف الثالث»، منذ انتفاضة تشرين/أكتوبر، ليكون مشجبا تُعلق عليه مسؤولية جرائم الاغتيالات «المجهولة»، المتزايدة، خاصة بين العاملين في أجهزة الإعلام. فخلال شهرين، فقط، من بدء الانتفاضة وثقت « الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحافيين» تعرض نحو مئة صحافي للاعتداء والضرب، مع تحجيم ومهاجمة المؤسسات الإعلامية، وما تلاه من اختطاف واغتيالات تجاوزت الأربعين.
لقي الصحافي عبد الصمد والمصور غالي حتفهما عقب انتهائهما من تغطية الاحتجاجات وسط مدينة البصرة، جنوب العراق. وكان عبد الصمد قد فَنَد، في آخر تقرير له، « مجهولية» الاغتيالات وحالات الخطف واعتقال المتظاهرين، مُحملا الحكومة المسؤولية، مبينا أن هوية «المجهولين» معروفة لدى الحكومة. رشحته تغطيته للاحتجاجات الشعبية ووقوفه بجانب المتظاهرين، للتصفية السريعة على أيدي «المجهولين» من «الطرف الثالث»، لأنه تجاوز خطوطها الحمراء. «الخطوط الحمراء» التي رسمت للصحافيين والعاملين بأجهزة الاعلام، على اختلافها، لكيلا يتجاوزها أحدهم مؤكدا استقلاليته وقدرته على تقديم الحقيقة.
يستحق مصطلح «الخطوط الحمراء»، كما «المجهولين» والطرف الثالث»، أن يضاف الى إنجازات حكومات الاحتلال المتعاقبة. ففي تشرين الثاني/نوفمبر 2009، مثلا، حاول «مجهولون» اغتيال الصحافي عماد العبادي. شفى العبادي بعد أن تمكن أطباء في ميونيخ من إخراج ثلاث رصاصات من دماغه. عند عودته الى الناصرية، مدينته الواقعة جنوب العراق، رحب به الأصدقاء. كان من بينهم، ابن مدينته المطرب المعروف حسين نعمة، الذي صرح قائلا «نبهته أن يخفف من الكلام. هناك خطوط حمراء». لم يُعلق العبادي، يومها، بل فضل عدم الكلام. ولم يكن الصحافي جواد سعدون الدعمي من قناة البغدادية الفضائية، محظوظا مثل زميله، حيث اغتاله «مسلحون مجهولون»، وهو داخل سيارته في حي القادسية جنوب غربي بغداد، في 24 أيلول/ سبتمبر 2007.
إن رفض المنتفضين لكل من ساهم في الحكومات السابقة والحالية و»العملية السياسية» ليس دعوة إلى الانتقام بل إلى طموحهم في تحقيق تغيير حقيقي وبناء وطن دفع الشعب، ولايزال، ثمنه غاليا
يكاد لا يخلو عام من تقرير دولي يوصي « الحكومة» بحماية الصحافيين وتوفير الأجواء لممارسة عملهم. ففي عام 2013، أشار تقرير، أصدرته «لجنة حماية الصحافيين الدولية»، إلى تصدر العراق، قائمة الدول التي يفلت فيها قتلة الصحافيين من العقاب. وأكد التقرير إن المنظمات الإرهابية ليست المسؤولة الوحيدة عن قتل الصحافيين بل هناك «مسؤولون حكوميون وعصابات منظمة تقوم بقتل الصحافيين أيضاً انتقاماً منهم على عملهم، ودون أن يواجهوا العدالة».
وفي 2016، قُتل 13 صحافيا، معظمهم أثناء تغطية المعارك مع تنظيم الدولة الإسلامية، حسب الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحافيين، إلا أن 179 صحافيا تعرضوا لأنواع مختلفة من الاعتداءات من ضرب وتهديد بالقتل من «جهات مجهولة» على خلفية نشر تقارير صحافية عن الفساد في بعض مؤسسات الدولة. أما «إحصائية شهداء الصحافة العراقية» التي وثقت استهداف الصحافيين، منذ عام 2003 حتى 2016، فقد بينت أن عدد الضحايا الكلي هو 277 صحافياً ومساعداً إعلاميا منهم 22 صحافياً أجنبيا، و»أن الصحافي العراقي مستهدف من كل الأطراف المتنازعة دون استثناء».
إن أجواء الترويع المحيطة بعمل الصحافيين وتقييد حرية حركتهم، والتعبير عن آرائهم، وملاحقتهم بالإضافة إلى التصفية الجسدية، وإفلات مرتكبي الجرائم من العقاب، يزيد من اللجوء إلى القتل كأداة سهلة ومضمونة لكتم الأصوات المستقلة، وتحديد المعلومات المتوفرة للجمهور، ودفن الحقيقة مقابل إشاعة الأكاذيب وتضليل الناس.
وإذا كانت هذه هي معالم الصورة العامة منذ 16 عاما، فإن حملة القمع والاغتيالات ازدادت، بقوة، منذ انبثاق انتفاضة تشرين، بموازاة ازدياد الوعي لدى المنتفضين، بأن الحقوق لا يمكن نيلها لفرد دون غيره ولا لفئة دون غيرها، وإذا ما حدث ونالتها الفئة فأنها لن تكون صالحة، على المدى البعيد، لبناء وطن يتسع للجميع، مهما كانت أساليب الإغواء والابتزاز وشعبوية الخطاب. ان وصول المنتفضين الى هذه الحقيقة وتمسكهم بها، يُخيف أعضاء الحكومة والبرلمان والميليشيات الى أقصى حد، فهو يهدد مصالحهم الشخصية التي بنوها على حساب الوطن، كما يهدد كل أوهام الطائفية وصناعة الهويات الفرعية المزيفة، التي عملوا بجد على إشاعتها، لإبقاء المواطن جاهلا بحقوقه ووطنه وبناء مستقبله.
سيرورة الانتهاكات ومنهجية كتم الأصوات وحرمان المواطن من حقوقه، هي التي تدفع المنتفضين الى رفض إعادة تدوير الساسة، حتى من قدم استقالته من البرلمان، أيام الانتفاضة، بعد المشاركة في غنائم الاحتلال وجرائمه أو مسايرته مدة 16 عاما، شكاً بدوافعهم، مثل قصي السهيل (القيادي في حزب الدعوة الشيعي الذي «استقال» من ليرشحوه لرئاسة الوزراء كمستقل)، ورائد فهمي (سكرتير عام الحزب الشيوعي ، ومنذ ثلاثة أيام، أياد علاوي، رئيس وزراء أول حكومة عينها حاكم الاحتلال بول بريمر، اللذان لم يبدر منهما ما يدل على انتقالهما الى صف الشعب شهوداً، بما لديهم من وثائق ومعلومات. إن رفض المنتفضين لكل من ساهم في الحكومات السابقة والحالية و»العملية السياسية» ليس دعوة إلى الانتقام بل إلى طموحهم في تحقيق تغيير حقيقي وبناء وطن دفع الشعب، ولايزال، ثمنه غاليا.
كاتبة من العراق
المنتفضون العراقيون بين
الشيطان الأكبر والأصغر
هيفاء زنكنة
وأخيرا، حدث ما كان العراقيون يتوقعون حدوثه. طفت على السطح همجية طرفين يقتتلان على أرض العراق، بعيدا عن أراضيهم ومواطنيهم. في بلاد استبيحت، تدريجيا، بالتعاون مع من فتح لهم أبوابها. يمنحون فيها حق «الشهادة» والقدسية لمن يريدون والتلويث بـ«الإرهاب» لمن لا يريدون. بين «شهادتهم» و «إرهابهم»، ساحات يقطنها منتفضون، لا يريدون الطرفين، الشيطان الأكبر والشيطان الأصغر، بل يطالبون منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بوطن يتمتعون فيه بحقوق المواطنة، وسيادة الوطن عن طريق وضع حد للقواعد العسكرية لـ «الشيطان الأكبر» وميليشيات وساسة» الشيطان الأصغر».
جاء رد فعل النظام المنقسم ولاء أفراده بين الشيطانين، وحشيا وإجراميا. سالت على أرض الوطن دماء ما يزيد على الخمسمئة مواطن وعشرات الآلاف من الجرحى وآلاف المعوقين والمعتقلين. أُختطف ناشطون وناشطات وعُذب أطفال لاستخلاص اعترافات تدين آباءهم. شكك البرلمان والمرجعية بمطالب المنتفضين بداية وحين أُجبرا على الاعتراف بصحتها، شرع البرلمان بالتسويف والمماطلة بانتظار يأس المنتفضين وتخليهم عن ساحات بلادهم.
وعندما أُجبر رئيس الوزراء على الاستقالة بأمر من الشعب، وبانت دلائل اقتراب المنتفضين من تحقيق انتصارهم في التخلص من الشيطانين، كُتبت سيناريوهات جديدة للمناوشات واستعراض العضلات علنا، وتهيئة الأرضية لجولة جديدة للمفاوضات بين الطرفين سرا، بشرط القضاء على الانتفاضة. فقام الشيطان الأكبر بقتل الابن المفضل للشيطان الأصغر، أثناء زيارة سرية له « كضيف»، كما قيل لنا نحن السذج، ففاجأه الشيطان الأكبر بعدم الترحيب به ومن معه. إذ يرى الشيطان الأكبر نفسه أنه الأحق بالضيافة في العراق، أو كما يطلق عليه في قاموس الاستعمار الجديد «البلد المُضيف» وفق اتفاقيات موقعة مع أهل البيت.
مع تزايد التهديدات بتصعيد الاقتتال، في العراق، (لاحظوا ليس في طهران أو واشنطن)، ونجاح الشيطانين في تحويل الأنظار عن غضب الشعب ومطالبته بالوطن، خطب رئيس الوزراء المقال عادل عبد المهدي، في البرلمان، تضمنت من التناقضات ما يكاد يثير الشفقة عليه، لولا كونه مسؤولا، عن جرائم لا تغتفر بحق المنتفضين. ختم الخطبة بتقديم «خيار» انهاء الوجود الأمريكي بالعراق، واصفا إياه بأنه وجود أجنبي، وهو وصف يعيد إلى الأذهان خطابا لوزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد عام 2004، قال فيه إن مشكلة العراق الأولى هي وجود الأجانب فيه، مستثنيا طبعا قوات الاحتلال الأمريكي، ربما لأنه اعتبرها من «أهل البيت»، كما يفعل عادل عبد المهدي، الآن، حين ينصح بإخراج الأجانب، كأن سليماني وبقية القيادة الإيرانية الفاعلة داخل العراق بالإضافة الى الميليشيات هم مواطنون عراقيون أبا عن جد.
إن المعنى العميق لمطلب المنتفضين حين ينادون باستعادة الوطن هو التخلص من المحتلين الأمريكي والإيراني، وتواجدهما المباشر وغير المباشر، وما أنجباه من المشوهين المتنافسين
ولا أدرى كيف لم ينتب عبد المهدي الخجل وهو يتحدث عن ضرورة الحفاظ على السيادة، وهو يعرف، جيدا، أن قوات الاحتلال الأمريكي والميليشيات الإيرانية والقصف التركي، لم يفتأوا ينتهكون سيادة العراق بشكل دوري وجماعي منذ 16 عاما! فهل كان النظام العراقي بحاجة الى اغتيال سليماني ليدرك أنه محتل من قبل أمريكا؟ ليطالب بالانتقام والثأر والقصاص العاجل وإعلان الحداد ثلاثة أيام لارتكاب أمريكا جريمة اغتيال ستة افراد، بينما مرر جريمة اغتيال أكثر من 500 شاب بصمت لا يضاهيه صمت؟
إن طلب انسحاب القوات الأمريكية وإلغاء تواجد القوات الأجنبية ردا على اغتيال مواطن عراقي هو ما يجب أن يكون لو كانت هناك دولة ذات سيادة تحترم وتقدر حياة مواطنيها، ولو كان المستهدف مواطنا واحدا، وما كان يجب أن يحدث منذ سنوات حين سبب الاحتلال الأمريكي زرع الإرهاب بأنواعه، وفتح الأبواب مشرعة للشيطان الأصغر ليتعاونا سوية، عبر عملائهما، على زرع الطائفية والفساد والتجهيل المنهجي بديلا للتوعية والتعليم، والاحباط بدلا من الأمل والموت بديلا للحياة، حتى تجاوز عدد الضحايا المليون منذ عام 2003، وها هو، الآن، رئيس وزراء مستقيل، يواصل الاستهانة بالمنتفضين والتكلفة الغالية التي يدفعونها ، يوميا، ليقدم مهزلة دحضها أعضاء البرلمان، حين وقفوا في البرلمان، هاتفين بغوغائية مبتذلة أمام الشعب المنتفض في الساحات منذ شهور، وأمام تضحيات الآلاف من المواطنين دما واعتقالا وتعذيبا: «نعم نعم… سليماني، كلا كلا… أمريكا». كيف يمكن لهذه المجموعة، بتاريخها وحاضرها المخزي، أن تعمل على تحرير البلد من قيوده، وعلى تحرير الأمة من الأسر الذي أوقعوها، هم أنفسهم، فيه؟
إن المعنى العميق لمطلب المنتفضين حين ينادون باستعادة الوطن هو التخلص من المحتلين الأمريكي والإيراني، وتواجدهما المباشر وغير المباشر، وما أنجباه من المشوهين المتنافسين، فسادا وطائفية وخنوعا، ما يضاهي أكبر صراع مافيوزي في أي مكان بالعالم. وهو ما لن يتمكن النظام الحالي من تحقيقه، حيث بلغت درجة انغماسه في الفساد المادي والإداري والأخلاقي، وتوفر ملفات الابتزاز المعدة ضد بعضهم البعض، حدا يمنعهم، وإن ارادوا، من تطهير أنفسهم.
إن مطالبة المنتفضين بحقوقهم سببت صدمة كبيرة للشيطانين الكبير والصغير، كما هو فشل المماطلات ومحاولات مد المواطنين بالأوهام ليتقبلوا واقعهم البائس. وقد حاول الطرفان، بمعاونة الساسة المحليين، مسخ الشعب ليحقق كل طرف منهما انتصاره على الآخر، ليحققا مصالحهما في التوسع والاستغلال والمحافظة على سلامة وأمن مواطنيهما والسيادة الوطنية. يتبادلان الأدوار، يهدد أحدهما الآخر، أو يتغازلان، يكمل أحدهما الآخر، على خشبة مسرح يدعى العراق. في 7 كانون الأول/ديسمبر الماضي، تفاوضا لإجراء صفقة، تبعها تغريدة من ترامب قال فيها «شكراً لإيران على مفاوضات عادلة للغاية. هل رأيتم، يمكننا عقد صفقة معا». اليوم يُشهر تغريداته مهددا. وكان من الممكن أن تستمر المسرحية، لصالح الطرفين، لولا انتفاضة تشرين، وهي حصيلة سيرورة كل المظاهرات والاعتصامات، السابقة، ضد من نخروا الأحلام بوطن. ونواة الأمل التي ستحقق النصر، حتما، إذا ما واصل المنتفضون امتلاكهم للساحات، على الرغم من المخاطر الجسيمة التي يتعرضون لها. تتطلب لتجاوزها انضمام بقية أبناء الشعب إليهم بحركة اعتصام مدني، خاصة من قبل عمال النفط، لإيقاف مد الغزاة، أيا كانوا، بما يطيل بقاءهم. وليقوم شباب البلد ببناء وطن بحجم آمالهم وطموحاتهم، مستقلا ليتعاملوا مع بقية بلدان العالم، على قدم المساواة لا كالعبيد.
كاتبة من العراق
عراق الانتفاضة…
أين نحن ذاهبون؟
هيفاء زنكنة
من الصعب، ونحن على قرب يوم من بداية العام الجديد، التهرب من مراجعة أحداث العام الماضي واستشراف ما ستحمله الأيام المقبلة، بالنسبة الى الانتفاضة العراقية، الموشكة على دخول شهرها الرابع، خاصة بعد أن تحقق، فعليا، ما كان الجميع يتوقعه في تحويل مواقع في البلد، الى ساحات مناوشات واقتتال بين أمريكا وإيران. من ناحية المراجعة والتقييم الموضوعي، لا يختلف اثنان في أن الانتفاضة السلمية، حققت تغييرات، ذات أهمية كبرى، محليا وإقليميا، على الرغم من القمع الوحشي الذي تواجهه، يوميا.
محليا، أطلق الشباب الخريجون، والعاطلون عن العمل، والمهمشون صرخة احتجاجهم الأولى مطالبين بحقوقهم واستعادة وطنهم، بعد أن أدركوا أن المطالبة الجزئية المحصورة بمصلحة هذه الفئة أو الطائفة أو الشريحة المعينة دون غيرها لم تعد تجدي، وأنهم وصلوا قاع الطموحات والآمال التي يعيشها الشباب في معظم البلدان، فكيف ببلد غني كالعراق؟ وأدركوا أن انتماءهم الى حزب طائفي أو ميليشيا مسلحة أو الجلوس بانتظار تحقيق وعود العمل، بات مهزلة المهازل، واستهانة بعقولهم من قبل أحزاب فاسدة وحكومة تتحكم بها الميليشيات.
جاء هذا الإدراك بعد 16 عاما من بضاعة «الديمقراطية» والتخلص من المظلومية، فلا غرابة أن يختار المنتفضون الوقوف بعيدا (كالخائف من عدوى الإصابة بمرض خبيث) عن الأحزاب التي ساهمت بالعملية السياسية التي أسسها حاكم الاحتلال الأمريكي بول بريمر. رافضين تعيين أي شخص، كرئيس وزراء للحكومة الانتقالية، إذا كان ينتمي الى أي حزب، مهما كان، عمل ضمن إحدى حكومات الاحتلال منذ عام 2003 وحتى إجبار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على الاستقالة في الشهر الماضي. يبين اتخاذ المنتفضين قرارا كهذا، انعدام الثقة بالأحزاب مجتمعة، مما يجردها من شرعية وجودها كممثلة للشعب، بكل مواطنيه، يتوجب عليها أن تلعب دورا فعليا في نيابة الشعب، وأن تكون عوامل فاعلة ذات أهمية مركزية في نظام ديمقراطي.
محليا، أيضا، تمكن المنتفضون، ذكورا واناثا، من تقديم الإجابة على سؤال طالما طرح، على مدى سنوات الاحتلال الأمريكي والحكومات الميليشياوية، المُلفعة بالسواد، وهو: أين هي المرأة العراقية؟ خلال الانتفاضة، وفي فترة وجيزة نسبيا، استعادت المرأة مكانتها المعتادة، جنبا الى جنب مع الرجل، مطالبة بالوطن والحقوق المهضومة، منادية: نازلة آخذ حقي وعراق… عراق، كلنا عراقية.
إقليميا ودوليا، هتف المنتفضون ضد التدخل الإيراني بميليشياته وأمريكا بقواعدها العسكرية ومرتزقتها. أدرك المنتفضون أنهم لن يستعيدوا الوطن إذا لم يكن مستقلا ويتمتع بالسيادة. وأن تحقيق مطلب الوطن يقتضي التخلص من الاستبداد الداخلي والتدخل الخارجي معا.
هناك نقاط أساسية يواصل المنتفضون التركيز عليها، وهي: اصرارهم على البقاء في الساحات والشوارع، مؤكدين في تصريحاتهم « حتى ننال حقوقنا» و«وفاء لدم الشهداء»
لم تمر هذه المنجزات بسهولة. دفع المنتفضون ثمنا غاليا جدا لتحقيق جزء من حملة التنظيف الداخلية والخارجية. بالمقابل تكاتفت قوى الفساد والاستبداد الداخلي والخارجي، متشبثة بمصالحها وما تعتبره غنيمة حرب من جهة، وساحة لتسوية النزاع والمفاوضات السرية، خاصة، بين أمريكا وإيران، من جهة أخرى. فشهدت ساحات التحرير استماتة متلازمة المستبد – المحتل في الدفاع عن وجودها ومصالحها المهددة. قتلت مئات الشهداء وجرحت عشرات الآلاف واعتقلت وعذبت آلاف المتظاهرين. استخدمت كل ما يتوفر لديها من قتلة وأسلحة محرمة ضد متظاهرين سلميين. وحين رأت اصرارهم وصمودهم على مواصلة الطريق الذي شرعوا بالسير فيه، لجأت الى حملة الاختطاف أولا والذي استهدف النساء لمنعهن من المساهمة بأي نشاط كان، ثم القتل بواسطة كاتم الصوت ثانيا. وقد فاقت أعداد ضحايانا ما سقط في أي بلد آخر في العالم شهد الانتفاضة في العقد الأخير من السنين، سواء بالعدد أو بالنسبة لعدد السكان.
إلى جانب الاستهداف الجسدي للمنتفضين، تستعين متلازمة المستبد – المحتل بمواقع التواصل الاجتماعي، لترويع المنتفضين واستهدافهم نفسيا، عبر حملات تشويه منهجية تتهمهم بالعمالة لقوى خارجية، الكيان الصهيوني وأمريكا، مثلا. يساهم في حملات التشويه والتشكيك بطبيعة الانتفاضة عدد من الأكاديميين والمحللين، إضافة، الى عدد من المؤسسات البحثية التي تدعي الموضوعية. يقوم السذج بتدوير ومشاركة هذه المقالات والبحوث، بدون التأكد من صحة مصدرها وتوثيقها. تُنشر هذه الرسائل لترويع وتخويف ومنع الناس من الانضمام الى المنتفضين، او دفع الموجودين على المغادرة. ولا تخلو مواقع التواصل من قنوات بث (يوتيوب)، تبث رسائل تتضمن « فضح» هذا المحتل ضد ذاك، ينفذها أشخاص يرون في أمريكا الخلاص من « الظلامية الإسلاموية»، أو يرون في إيران الخلاص من « الشيطان الأكبر». كلا الطرفين يدعيان الوطنية وانقاذ العراق.
إزاء هذا كله، ما الذي يُعَول عليه المنتفضون، خاصة، مع توقع زيادة الضغط السياسي عليهم للوقوف بجانب « الحكومة» وإلا اُتهمت بالخيانة؟ «الحكومة» التي صارت تُقدم نفسها باعتبارها «العراق» بعد أن استهدف طيران الاحتلال الأمريكي مواقع ميليشيا حزب الله التابع للمحتل الإيراني قبل يومين. فهل «الحكومة» أو مليشيا حزب الله، هي العراق حقا؟
هناك نقاط أساسية يواصل المنتفضون التركيز عليها، وهي: اصرارهم على البقاء في الساحات والشوارع، مؤكدين في تصريحاتهم « حتى ننال حقوقنا» و «وفاء لدم الشهداء». نيل الحقوق يعني في حكومة انتقالية، نزيهة، لم يخدم أفرادها أي احتلال، أمريكيا كان أو إيرانيا أو مُنزلا من المريخ (حسب تعبيرهم)، واجبها الأول هو تمثيل الشعب العراقي، كله، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم القتل، الذين يعرفهم المنتفضون ويُنكر النظام معرفتهم. أن شروط المنتفضين غير مستحيلة، وممكنة التحقيق، إذا ما توفرت الإرادة السياسية الوطنية، وتم وضع حد لمنظومة المحاصصة الطائفية والفساد، التي نخرت الدولة بكل مؤسساتها وتسربت، تدريجيا، الى بنية المجتمع، لتؤسس طبقة ساسة الأحزاب الحالية. كما شَرعت الأبواب للإرهاب، وكل من يرغب بقضم جزء من بلد، أصبح مفهوم السيادة فيه نكتة سمجة، أو قطعة قماش مهلهلة، تُستخدم، كما هو الدستور، لمسح الأوساخ السياسية. وأصبح كل مواطن مطالبا بإثبات وطنيته، عن طريق أما ان يكون مع أمريكا اذن هو ضد إيران، أو مع إيران اذن هو ضد أمريكا، متعامين عن حقيقة أن الاثنين مُحتلان للوطن، وإن بنسب متفاوتة.
في روايته الأخيرة، المعنونة «الأصل»، يحاول الكاتب الأمريكي المعروف دان براون، الإجابة على اثنين من أهم الأسئلة التي يواجهها الانسان عن الحياة: «من أين أتينا؟» و «أين نحن ذاهبون؟». يحيلنا السؤال الأول الى ضرورة معرفة أسباب الانتفاضة لأن «أولئك الذين لا يعرفون الماضي محكوم عليهم بتكراره»، كما يذكرنا الكاتب والفيلسوف الاسباني جورج سانتايانا، أما الإجابة على السؤال الثاني، فإنه محكوم بالأمل الذي يراهن عليه المنتفضون، ونحن معهم.
كاتبة من العراق
الفضائيات العراقية بين
الانتفاضة والابتذال الإعلامي
هيفاء زنكنة
أصبحت المقابلات التلفزيونية التي تجريها الفضائيات العراقية وعدد من القنوات العربية، مع شباب الانتفاضة، مرتعا خصبا أما لتمرير أجندة القنوات السياسية والربحية، وهي مسألة مفهومة، اذ ليست هناك أجهزة إعلام، تعمل كجمعيات احسان لصالح الشعوب، أو ساحة لاستعراض وتذاكي مقدمات ومقدمي البرامج ونشرات الأخبار، بذريعة « أن الشارع العراقي يتساءل»، وحين يدرك مقدم البرنامج، متأخرا، عادة، أن من يتحدث اليه هو الذي يمثل الشارع، يستدرك موجها سؤاله بصيغة تعميمية أكثر، على مستوى « هناك من يتساءل».
معظم هذه القنوات، تواصل تسويق نفسها، على الرغم من كل ما يدل على العكس، باعتبارها محايدة وموضوعية وتمثل صوت الشارع، فيستمرئ مذيعوها ومقدمو برامجها أداء أدوارهم، عن طريق الاستهانة بضيوف البرامج وبالتالي، ولطول ساعات البث، بعقول الناس. حيث برز، في الأسبوعين الأخيرين، إثر اقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ومع تحقيق المنتفضين خطوتهم الأولى نحو التغيير واستعادة الوطن، الوجه الحقيقي للإعلام المخاتل، إزاء المنتفضين، عندما تتم استضافتهم من ساحات التحرير من مختلف أرجاء البلاد. فبدلا من الحديث عن مجريات الحياة اليومية للمنتفضين، وكيف يواصلون البقاء في الساحات والطرق، وتفاصيل التحكم بالمشاعر الإنسانية من غضب وخوف وتحد وهم يواجهون ويتعرضون لاستهداف وحشي، ورمي بالرصاص الحي، ورشهم بالغاز المسيل للدموع والذي يستخدم في مناطق الحروب، فقط، بالإضافة إلى رؤيتهم لزملائهم وأصدقائهم، وفي بعض الحالات أقربائهم، وهم يقتلون أمامهم أو يتم العثور على جثثهم بعد اختطافهم، بدلا من ذلك ، بتنا نرى عملية اخضاعهم، من قبل مقدمي البرامج ، لاستنطاق يذكرنا ببرامج أجهزة الإعلام الرسمية، التي يتم فيها استنطاق عضو عصابة أو إرهابي، بعد تعذيبه وتوقيعه على الاعتراف بطبيعة الحال.
معظم الفضائيات، تواصل تسويق نفسها، على الرغم من كل ما يدل على العكس، باعتبارها محايدة وموضوعية وتمثل صوت الشارع، فيستمرئ مذيعوها ومقدمو برامجها أداء أدوارهم، عن طريق الاستهانة بضيوف البرامج
شاهدنا، قبل أيام، نموذجا لأحد هذه المقابلات في فضائية، تواصل البث على مدى 24 ساعة يوميا. قدم البرنامج، ومدته ساعة، مذيع، أراد أن يثبت أنه صاحب سلطة على الضيف والجمهور، وأنه، وهذا هو الأهم سيحصل، شاء الضيف ام أبى، على الجواب الذي يريده، بالتحديد، لا أكثر ولا أقل. على مدى ساعة، دار المذيع، حول سؤال واحد بتنويعات استنطاقية متفاوتة، بمثابرة يحسد عليها. وهو ليس الوحيد بل بالإمكان اعتباره نموذجا لكثيرين غيره، من مقدمي البرامج العربية. أراد ان يعرف، بالضبط، بأسلوب استعراضي يجمع بين التهكم والجلوس بأوضاع مختلفة، لماذا لم يختر المتظاهرون، حتى الآن، متحدثا رسميا ناطقا باسمهم، يقوم بالتفاوض مع «الحكومة» لتحقيق مطالبهم، و… لماذا لا يخفف المتظاهرون من اصرارهم على المطالب؟
كان الناشط صبورا على الرغم من ملامح التعب البادية على وجهه. وكيف لا يتعب من قضى عدة اسابيع معتصما في ساحة مهددة بالموت، في كل لحظة، على أيدي الميليشيات والقوات الحكومية؟ كرر، المرة تلو المرة، مطالب المنتفضين وكيف أنها أساسية، يرتبط بعضها بالبعض الآخر، ولا يمكن المساومة عليها، خاصة بعد أن ختمت بدماء الشهداء. إنها حقوق غير مطروحة للمقايضة مع نظام فاسد استنفد مدة صلاحيته منذ سنوات، وصبر عليه أبناء الشعب حفاظا على السلم، وأملا في ان يستيقظ الفاسدون، يوما، ليدركوا مدى الخراب الذي جروا اليه العراق وأهله. كرر الناشط، أيضا، رفض المنتفضين لترشيح أي شخص ساهم، بطريقة أو أخرى، في العملية السياسية منذ عام 2003 أو ينتمي الى أحد الأحزاب المشاركة. فالخراب الذي أصاب البلد ليس مسؤولية فرد واحد بل مسؤولية نظام، وترشيح أحد أبناء النظام كرئيس للوزراء لإدارة الحكومة الانتقالية، هو ضحك على الناس، واستهانة واحتقار لا مثيل لهما للشهداء الذين دفعوا حياتهم ثمنا لاستعادة الوطن من أيدي الفاسدين. وكان الناشط موفقا، تماما، في استخدامه وصف النظام بالفساد باعتباره أساس القمع والاستبداد والطائفية والإرهاب. فالفساد، حسب ميثاق الأمم المتحدة، وقد تذوقه الشعب العراقي على مدى 16 عاما، هو الأخطر على استقرار المجتمعات وأمنها، والأسس الأخلاقية والعدالة وسيادة القانون. وذلك للصلات القائمة بين الفساد وسائر أشكال الجريمة، وخصوصا الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية، بما فيها غسل الأموال، وتزوير العقود والتلاعب بموارد البلد، والتعيينات الوهمية وابعاد الاكفاء النزيهين المؤهلين لشغل الوظائف العامة، مما يهدد الاستقرار السياسي والاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.
مر مقدم البرنامج مرورا عابرا على تشخيص الناشط عن الفساد والفاسدين، ليركز على السؤال الذي بات قبلة أجهزة الإعلام، ومحط استنطاق يثير الشك، هو الكشف عن ممثلي المنتفضين. حاول الناشط أن يبين خطورة مثل هذه الخطوة، وكيف أن المنتفضين مهددون بالاختطاف والقتل اليومي لمجرد تواجدهم في الساحة فكيف إذا ما تم الإعلان عن أسماء متحدثين او مفاوضين باسمهم؟ الا يكفي عدد المختطفين والقتلى حتى الآن؟ وإذا كانت الحكومة جادة بالاستماع للمنتفضين فلم لم تقم بأي خطوة سريعة لكسب ثقة الناس حتى الآن؟ لماذا يواصلون التأجيل وإقامة الاجتماعات في فنادق فخمة، يَدَعون فيها، تمثيل المنتفضين، ويتصرفون وكأن الحياة المشلولة تسير بشكل طبيعي في البلد؟ قوبلت توضيحات الناشط الهادئة المنطقية، بإصرار مقدم البرنامج على تكرار السؤال، مما دفع الناشط الى تذكيره بانه جالس في استديو خارج العراق، متمتعا بالأمان، حيث لا يمكن أن تطاله الميليشيات أو يد الغدر، مضيفا «أما أنا، فموجود مع الآخرين في ساحة نخاطر فيها بحياتنا، ولا ندري ما الذي سيحدث في الدقائق المقبلة، ومن منا سيكون القربان المقبل، مع هذا نحن مصرون على البقاء، وفاء للشهداء ولأنها الطريقة السلمية الوحيدة التي ستجعلنا نسترجع العراق من الفاسدين ونعيد بنائه».
من بين الإنجازات التي تحسب للانتفاضة، بالإضافة الى توحيد الناس بعيدا عن الطائفية، ونشر الوعي السياسي والاقتصادي، وتقوية الروابط المجتمعية والثقافية، مساهمتها بشكل يومي في تعرية الأحزاب وفضح زيف أجهزة الإعلام المستند، خلافا لما يشاع، ليس على الأجندة السياسية والتجارية لمالكيها فقط، بل على ابتذال العاملين فيها، ممن يقدمون أنفسهم كإعلاميين.
٭ كاتبة من العراق
من الذي يريد عراقا قويا؟
هيفاء زنكنة
ما الذي ينتظره رئيس الجمهورية والبرلمان العراقي بعد اقالة رئيس الوزراء وحكومته، لترشيح بديل مؤقت يليق بمطالب وتضحيات المحتجين ودماء الشهداء؟ ما الذي سينفذه البرلمان، وهو المنتخب من قبل 18 بالمئة من المؤهلين للانتخاب، بينما يتواجد الـ 82 بالمئة منهم، حاليا، في ساحات المدن والمحافظات، احتجاجا على الطائفية والفساد والعمالة، التي غلفت حياة الشباب، الخريجين خاصة، خلال 16 عاما الأخيرة، في بلد يُعد واحدا من أغنى دول النفط المصدرة بالعالم، حيث يصدر 4 ملايين برميل يوميا، وتبلغ ميزانية حكومته 112 مليار دولار (ميزانية إيران للعام المقبل هي 35 مليار وسكانها ضعف سكان العراق) بينما لا يحمل خريج الجامعة، الذي يستشهد في ساحات الاعتصام، وفي جيبه اقل من الدولار يوميا؟
لنترك، جانبا، تاريخ الساسة العتيد في التعاون مع المحتل ومأسسة الطائفية ونهب ثروة البلاد. لنترك جانبا 16 عاما من تجريد المواطنين من الاحساس بالانتماء الى الوطن، وتصنيع الهويات الزبائنية، حيث الولاء لمن ينعم بالعمل او المال من أمراء الميليشيات ومافيات الفساد، ولنراجع سجلهم خلال الستة أسابيع الأخيرة، فقط، أي منذ اندلاع الانتفاضة في الأول من تشرين/ أكتوبر. ولنتبع مقولة « عفا الله عما سلف»، التي طالما كررها الزعيم الراحل عبد الكريم قاسم.
عند مراجعة سجل إنجازات رئيس الجمهورية والبرلمان والحكومة المُقالة (لاتزال سارية المفعول بانتظار تحقيق معجزة اختيار رئيس وزراء جديد)، خلال الستة أسابيع، تقريبا، من المظاهرات والاعتصامات السلمية (باعتراف العالم كله)، اقترفت منظومة « العملية السياسية»، أو «النظام الفاشي»، حسب المنتفضين، بشكل مباشر أو غير مباشر، أفعالا تجاوزت حدود الوصف بمفردات «الجرائم» و«الانتهاكات» التي توصف بها أفعال الأنظمة القمعية، عادة.
يضم سجل النظام، حتى اليوم، قتل ما يقارب 475 مواطنا وعشرين ألف جريح وآلاف المعتقلين، بالإضافة الى المختطفين الذين لا يُعرف مصيرهم. وهي أرقام تضمن الفوز الساحق للنظام العراقي على نظام الدكتاتور زين العابدين بن علي، بتونس، مثلا، والذي بلغ عدد ضحاياه، في الأيام السابقة للإطاحة به، 67 شهيدا. وتمت محاكمة الأمنيين الذين ارتكبوا الجرائم، بعد هربه، وهنا وجه التشابه مع بعض ما يجري حاليا في العراق «لأن القتلى الذين سقطوا برصاص الأمن خلال الثورة أصيبوا في أماكن قاتلة مثل الرأس والرقبة، وهذا يعني أن فعل القتل كان متعمدا وليس على وجه الخطأ»، حسب محامية عوائل الشهداء.
مهما كانت مسميات «الطرف الثالث» أو «المندسين»، والتي ترتب عليها استشهاد مئات الشباب في مجازر وحشية ارتكبت خلال وجود هذا النظام، وفشله في حماية المواطنين هو مسؤولية النظام. وأن أفراده، في ظل نظام وطني، سيحاكمون، بتهم القتل العمد والجرائم ضد الإنسانية
من بين «إنجازات» النظام، التي انغرزت عميقا بذاكرة الشعب، هي ارتكاب المجازر. اذ لم يعد معدل القتل اليومي، التدريجي، للمتظاهرين، يُشبع من تعودوا على شرب الدماء. فكانت مجزرة الناصرية، جنوب العراق، التي ذهب ضحيتها زهاء 32 قتيلاوأكثر من 225 جريحًا في 28 تشرين الثاني/نوفمبر، بينما قُتِل 15 متظاهرًا وجُرِح 157 آخرين في 30 تشرين الثاني/نوفمبر. تخللتها يوم 29 حملة تصفية المتظاهرين في مدينة كربلاء، استشهد خلالها 13 شخصا على الأقل وإصابة 865 آخرين. وأدى هجوم مسلحين على المتظاهرين، في ساحة الخلاني ومنطقة السنك، وسط بغداد، ليلة الجمعة 6 كانون الأول/ ديسمبر، الى مجزرة استشهد جرائها 25 شابا وجُرح نحو 130.
أدى استشراء القتل والاستهداف المنهجي للمتظاهرين الى استنكار عالمي بدءا من الأمين العام للأمم المتحدة الى فرنسا وكندا والولايات المتحدة، بالإضافة الى اصدار المنظمات الحقوقية الدولية، التقرير تلو التقرير، ادانة لاستمرار استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين مما أدى إلى ارتفاع عدد الوفيات والإصابات. ووصل الأمر بالبابا فرنسيس الى مناشدة « السلطات إلى الاستماع إلى صرخة الناس الذين يطلبون حياة كريمة وسلمية».
فمن هو المسؤول، اذن، عن ارتكاب هذه المجازر؟ يؤكد شهود عيان من بين المتظاهرين أنها ميليشيات مسلحة مدعومة إيرانيا، وأنها ميليشيا عصائب الحق وكتائب حزب الله. وتبين أشرطة فيديو عديدة مسيرة مؤيدي الحشد الشعبي، في ساحة التحرير، وهم يحملون السلاح وشعارات تأييد المرجعية مقابل المتظاهرين السلميين حاملي العلم. بينما يتهم الناطقون باسم النظام وكل ساسته، الطرف الثالث، او المندسين. ويقول المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أنهم «مضمرو سوء يريدون تخريب العلاقة بين العراق وإيران». أما المتحدثون باسم البيت الابيض الأمريكي فالمسؤول الأول هو إيران. أما وكالة انباء «ارنا» الإيرانية الرسمية فقد ذهبت أبعد من ذلك متهمة المتظاهرين أنفسهم بكونهم قد تم تحريكهم من قبل أمريكا والسعودية وإسرائيل «بهدف تخريب علاقات إيران مع العراق وسوريا».
في غياب وجود أي تحقيق عراقي مستقل حول الجرائم، وحملات التشويه والتضليل والتلفيق المستمرة، وعدم تحميل المسؤولية لأي جهة كانت، تبقى كل الاحتمالات حول هوية مرتكبي الجرائم، واردة. فأبواب العراق مشرعة أمام كل من هب ودب، وأرضه مسرحا لصراع يكاد لا يهدأ يوما بين إيران وأمريكا منذ احتلاله عام 2003 وتأسيس «العملية السياسية». فإيران ممثلة بالميليشيات المسلحة المحصنة من العقاب، وأمريكا بقواعدها العسكرية ومخابراتها وقدرتها على تنفيذ العمليات الخاصة بواسطة «الشركات الأمنية». كلا البلدين يدافعان عن مصالحهما وأمنهما، بعيدا عن أراضيها. كلا البلدين مستعدين وقادرين على تنفيذ «العمليات القذرة»، بأشكالها، على حساب حياة العراقيين، لإثارة الفتنة وديمومة ضعف البلد. فالعراق الضعيف، المستهلكة ثروته البشرية والنفطية، في نزاع مستمر، منخفض الدرجة، مفيد لكلا الطرفين. فمن الذي يريد عراقا قويا؟
يلعب ساسة النظام، نفسه، أدوارهم بمهارة عالية. فهم لايزالون يجتمعون سوية، يتبادلون الابتسامات، ولا ينسون أن يستنكروا «استخدام العنف» ضد المتظاهرين، بعد أن يتأكدوا من وجود الكاميرات لالتقاط صورهم. آملين بالبقاء، على الرغم من تآكل وجودهم المنخور بالفساد ودماء الشهداء، وهم يعولون على كسب الوقت وتخدير المنتفضين بالوعود المهدئة. متعامين عن أن الحقيقة الوحيدة الثابتة هي ان ما يجري، مهما كانت مسميات وتوصيفات «الطرف الثالث» أو «المندسين»، والتي ترتب عليها استشهاد مئات الشباب وحتى الأطفال في مجازر وحشية ارتكبت خلال وجود هذا النظام، وفشله في حماية المواطنين هو مسؤولية النظام. وأن أفراده، في ظل نظام وطني مستقل، سيحاكمون، ان آجلا ام عاجلا، بتهم القتل العمد والجرائم ضد الإنسانية.
كاتبة من العراق
«المندس» الناعم والمسلح
في الانتفاضة العراقية
هيفاء زنكنة
يكثر الحديث الإعلامي والسياسي، فيما يخص انتفاضة تشرين/ أكتوبر العراقية، في الأيام الاخيرة، أثر إقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، عن «المندسين». لا يضاهيه في كثرة الترداد، حتى على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنواعها، غير نعت «الذيول» المستخدم لتوصيف أتباع الاحتلالين الأمريكي والإيراني، وهو تعبير أجدى وأوضح لوصف التبعية الفكرية والعملية. وعلى الرغم من كثرة الترداد، ليس هناك تعريف محدد ومتفق عليه للمندسين، بل يتم استخدام التوصيف وفق ما يراه الفرد او المجموعة أو الحكومة، إزاء فرد او مجموعة أو حكومة أخرى، كل حسب انتمائه ومشاعره المتأججة، في حالة الافراد والمجموعات، والأجندة السياسية، المنهجية المتشابهة، في حالة الحكومات والدول. حيث تفتخر أجهزة المخابرات المركزية، في كل بلد، بقدرتها على اختراق او الاندساس بين صفوف المعارضين والثوار ومنظمات المجتمع المدني، أحيانا، ناهيك عن المنظمات الإرهابية، للدلالة على حفظها للأمن وحماية المواطنين.
وتتمثل ظاهرة الاندساس بين المتظاهرين السلميين بأكثر صورها وضوحا في ممارسات الكيان الصهيوني تجاه الفلسطينيين، اذ تثبت عدة فيديوهات موثقة، كيف يندس ملثمون بين المتظاهرين وهم يرشقون قوات الاحتلال بالحجارة، ثم يطلقون النار على المتظاهرين بينما تنشغل مجموعة منهم بعزل أحد المتظاهرين عن رفاقه وضربه بقسوة قبل اعتقاله. هؤلاء المندسون يسمون «المستعربين». أما في مصر، فقد رصد فيلم «المندس»، الوثائقي، قضية الاعتداء على المظاهرات من قبل من يُطلق عليهم «المواطنون الشرفاء»، لتتم اضافتهم الى المندسين المتعارف عليهم من بين قوات الأمن.
شغلت ظاهرة الاندساس حيزا كبيرا من مساحة التغطية الإعلامية للانتفاضة ومتابعة التغيرات الجوهرية التي تمكنت من تحقيقها خلال فترة قصيرة، وبتكلفة بشرية عالية، دفعت الرأي العالمي، الى الانتباه اليها، رغم اختيارها الاولي بالتعامي عنها. فمنذ اليوم الأول للانتفاضة والتصريحات الرسمية تخلط بتعمد بين المتظاهرين السلميين الذين لم يحملوا غير العلم العراقي سلاحا و«المندسين»، سواء كانوا وهميين أو من الميليشيات أو قوات الأمن. يكاد لا يخلو أي تصريح رسمي سواء من قبل رئيس الجمهورية والوزراء الى أصغر عسكري أو أمني في الحكومة من اتهام «المندسين»، بحيث أصبحت السردية العامة الجامعة بين الترهيب وتبرير القتل متشابكة الى حد كبير. وبات تناقض السردية من مسؤول الى آخر، وهم يعيشون حالة التخبط ووحشية رد الفعل إزاء الانتفاضة غير المتوقعة، يوقعهم بمسؤوليات قانونية لا يدركون هم أنفسهم مدى تورطهم فيها. ومن المتوقع، فيما لو نجح الشعب في تشكيل حكومة وطنية مستقلة، أن تستخدم التصريحات والأوامر والأفعال التي يتم توثيقها كأدلة في محاكمتهم كمجرمي حرب مسؤولين عن قتل مئات المتظاهرين وجرح الآلاف وإعاقة المئات بشكل دائم.
لقد أثبت المنتفضون، حتى اليوم، أنهم حملة الوعي الوطني، وأنهم، هم أنفسهم، المرجعية الحقيقية الناشطة لتحرير وبناء الوطن، مهما كانت محاولات الاندساس والتشويه وتدوير الوجوه القديمة
حسب التصريحات الحكومية، يظهر «المندسون» بين المتظاهرين بمسميات وأشكال متعددة، مما يمنح النظام حق اعتقالهم وخطفهم وقتلهم. حيث تحدث عادل عبد المهدي عن وجود «الخارجين على القانون»، أما المتحدث باسمه فقد وصفهم بأنهم «مخربون» وأصدر الأوامر باعتقالهم. وأعلن الناطق باسم مركز الإعلام الأمني « أن المندسين بين المتظاهرين استخدموا الحجارة وأطلقوا النيران ضد القوات الأمنية». ويأتي التناقض الأكبر في تصريح وزير الدفاع الذي اتهم «جهة ثالثة» في استهداف المتظاهرين بالأسلحة القاتلة، مما وسع من مفهوم الاندساس ليشمل، للمرة الأولى، الإشارة الى الميليشيات أو قوى خارجية «مجهولة الهوية» وسرعان ما تبنى رئيس الوزراء، الذي بات يوزع التهم يمينا ويسارا، كمحاولة لإنقاذ نفسه من المستنقع الذي حفره لنفسه، بإلقاء مسؤولية حملة اختطاف الناشطين من رجال ونساء بالإضافة الى لواء في الجيش، على «طرف ثالث»، في ذات الوقت الذي يُكذب الناطق باسم وزارة الدفاع تحسين الخفاجي التصريحات التي تدعي وجود أطراف مجهولة، أو عدم معرفة المندسين، لأن» مشاهدة التظاهرات من خلال أجهزتنا وطائرات المراقبة والكاميرات الممتدة في كل أنحاء بغداد تعطينا حركة كاملة للمتظاهرين والمندسين ومن يسيء الى القوات الأمنية والتظاهرات». فاذا كانت أجهزة وطائرات المراقبة والكاميرات توفر الحركة الكاملة للمتظاهرين والمندسين فلم لم تميز القوات الأمنية بينهم وبين المتظاهرين؟ وكيف صار هم قوات النظام قتل المتظاهرين بدلا من اعتقال المندسين؟
في خضم التصريحات الرسمية المفضوحة في بث الاشاعات لتشويه الانتفاضة السلمية، وللتغطية على جرائم النظام، برز نوع آخر من «الاندساس»، الذي يمكن وصفه بالناعم لأنه أكثر قدرة على الاندماج بالمنتفضين. وهو سلاح ذو حدين. حيث نزلت الى ساحات الانتفاضة وجوه كانت معروفة، قبل الغزو والاحتلال عام 2003، بتعاونها، على مستويات مختلفة، مع الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية، اما بشكل حزبي أو شخصي، لإضفاء الوجه العراقي على غزو البلد. وقد تمت مكافئة العديد منهم بمناصب استشارية، أما لرئيس الجمهورية او رئيس الوزراء. هذا على المستوى الشخصي أما على المستوى الحزبي، فقد كانت المكافأة بشكل مشاركة برلمانية، عبر تحالفات تَدَعي تمثيل الشعب. تتواجد هذه الوجوه في ساحات الانتفاضة، أحيانا، لوهلة قصيرة تكفيها لالتقاط الصور، لأثبات نظافة مواقفهم، وصدى لشعار «نحن مع مطالب المحتجين» الذي يردده كل ساسة « العملية السياسية»، بينما يتزايد سقوط الشهداء. ولا تخلو الساحات من وجوه حزبية تريد ركوب موجة التحرير، بعد اقصائها من «العملية السياسية»، التي كانت من أشد المؤيدين والمنظرين لديمقراطيتها عمليا وفلسفيا، وبعد ان فشلت في الحصول على مكاسب ترى نفسها جديرة بها.
ما هو الدور الذي سيلعبه «المندسون»، على اختلاف تسمياتهم، وتنوع طرق استغلالهم، سواء كانوا من مستخدمي السلاح او أصحاب الخطب الناعمة، بعد اقالة عادل عبد المهدي وحكومته بقوة المنتفضين المباركة بدماء الشهداء؟ لقد أثبت المنتفضون، حتى اليوم، أنهم حملة الوعي الوطني، وأنهم، هم أنفسهم، المرجعية الحقيقية الناشطة لتحرير وبناء الوطن، مهما كانت محاولات الاندساس والتشويه وتدوير الوجوه القديمة.
كاتبة من العراق
تهديدات الحاكم بأمره
ومسار الانتفاضة في العراق
هيفاء زنكنة
إذا ما حدث ولجأ أحدنا إلى «غوغل»، بحثا عن الأنظمة التي تستهدف المتظاهرين السلميين بالرصاص الحي والقناصة، لوجدنا أن الكيان الصهيوني يحتل مركزا متقدما في استهدافه أبناء الشعب الفلسطيني، ولوجدنا، أيضا، أن النظام العراقي، بات منافسا حقيقيا في استهدافه المتظاهرين السلميين، مما يؤكد، بما لا يقبل الشك، ما نعرفه جميعا، وهو أن أنظمة الاحتلال والقمع، تستنسخ الإرهاب والممارسات الاجرامية.
فالمنتفضون في العراق المحتل أمريكيا وإيرانيا، كما في فلسطين المحتلة من قبل الكيان الصهيوني، ومنذ الأول من تشرين/ أكتوبر، يواجهون وهم يحملون حياتهم على أكفهم، الموت الذي يزرعه القتلة خشية امتداد الحياة.
وإذا كانت المقاومة الفلسطينية قد علمتنا أنها الحياة، فإن مقاومة المحتل الأمريكي، في الأعوام التالية لغزو العرق، قد علمتنا أن المقاومة تعني أن تكون موجودا، أن تكون إنسانا. وها هي انتفاضة تشرين/ اكتوبر، تبين انها، بوحدة تمثيلها للشعب، ومطالبتها بإسقاط النظام الطائفي الفاسد، وإنهاء الاحتلالين الأمريكي والإيراني، قد وصلت مرحلة التغيير النوعي لتراكم ما سبقها من مقاومة وحراك شعبي.
لئلا ننسى: كيف أثبتت التظاهرات، عراقيتها ووطنيتها، منذ الشهر الأول للاحتلال، عام 2003، حين تظاهر عدد من سكان مدينة الفلوجة أمام مدرسة ابتدائية مطالبين قوات الاحتلال بمغادرتها، رافعين شعار «أيها المحتلون القتلة سنخرجكم إن آجلا أم عاجلا». فتعاون المحتل مع الحاكم المحلي على إبادة المدينة واتهام أهلها بالإرهاب. أثمرت المقاومة المسلحة، البطولية، الدامية، رغم تشويهها بالطائفية بـ«العمليات السوداء» المدارة من الاحتلال، بسحب المحتل أغلب قواته وإبقاء وجوه محلية بالنيابة مشاركاً هذه المرة خصمه إيران. واستمرت التظاهرات، بشكل متقطع في كافة أرجاء البلاد بمطالب مختلفة لتعود، بقوة في 25 شباط (فبراير) 2011، تزامنا مع ثورات الحرية في تونس ومصر. جوبهت التظاهرات بالرصاص الحي فاستشهد 27 متظاهرا وتم اعتقال وتعذيب عشرات المتظاهرين. لئلا ننسى، كانون الثاني/يناير 2013، كيف وصف نوري المالكي، رئيس وزراء نظام «حزب الدعوة»، التظاهرات الشعبية والاعتصامات التي ساهم فيها ما يزيد على المئة ألف مواطن، على مدى أسابيع، بأنها «نتنة» وطائفية وأنها «فقاعة»، وهي «عملية تواصل مع جهات أجنبية» وأن المحتجين هم «أصحاب أجندات خارجية» متوعدا إياهم، وهو يزم شفتيه، بقوله: ‘انتهوا قبل أن تنهوا».
وهي اتهامات أطلقها أمين عام حزب مذهبي دينيا / طائفي سياسيا، بامتياز. أما بالنسبة إلى تهمة «التواصل مع جهات اجنبية» أو وفق «أجندات أجنبية»، فليس هناك، في العالم كله، من لا يعرف أن حكام « العملية السياسية»، وصلوا الى سدة مناصبهم بدبابات الاحتلال الانكلو أمريكي؟ فاذا لم يكن هذا تواصلا مع جهات أجنبية فما هو معنى التواصل والأجندة الاجنبية؟
الانتفاضة الحالية ليست وليدة شهر تشرين/ أكتوبر بل استمرارية المقاومة ضد المحتل والنضال الذي دفع آلاف المواطنين حياتهم ثمنا للوصول إليها اليوم، وأن ادعاء النظام الحالي أنه ليس مسؤولا عن خراب 16 عاما، استهانة أخرى بعقول الناس وبحياة الشهداء. وهذا ما أثبت المنتفضون انهم لن يسكتوا عليه هذه المرة
ولنتذكر أن الشعارات التي وصفها المالكي بأنها « نتنة» تضمنت المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين ووضع حد للتعذيب والإهانات اليومية واحتقار الناس، والترويع بتهم الإرهاب الجاهزة، ومعاقبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان المنهجية التي فاقت كل تصور، بحيث بات العراق على رأس قائمة الدول المنفذة لأحكام الإعدام في غياب نظام قضائي نزيه، حسب تقارير الأمم المتحدة.
ولنتذكر، كما أثبتت، تظاهرات الأنبار، أنها كانت منظمة من قبل لجان شعبية، أشرفت كل لجنة منها على أحد الجوانب العملية كالمحافظة على أمن وسلامة المتظاهرين، وتحديد مداخل التظاهرة، ومراجعة الشعارات والكلمات الخطابية لئلا تتعارض مع الروح الوطنية، بالإضافة الى الاشراف على توفير اماكن التواصل الاجتماعي ووجبات الطعام والمحافظة على نظافة المكان، وعلى الندوات التثقيفية في خيم الاعتصام. أي انها كانت وسابقاتها، على مدى 16 عاما، الأرضية الخصبة التي مهدت للانتفاضة الحالية، بتنظيمها الرائع، وروحها العراقية الأصيلة، وجرأة شبابها ودماء شهدائها.
واجهت الاعتصامات السابقة محاولات اختطاف واحتواء وتشويه متعددة، يكررها المتشبثون بغنيمة السلطة حاليا تجاه المنتفضين. مقابل حيوية المنتفضين وتنظيمهم « مدن الساحات»، المزودة بالأساسيات التي فشل النظام بتزويد البلد بها على مدى 16 عاما وبميزانية سنوية بحدود 120 مليار دولار، يقوم النظام بالدفاع عن وجوده ومصالح أفراده، مسخرا مختلف الأساليب الجامعة بين القمع الوحشي ونعومة الخطاب. يشمل القمع الوحشي الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي والقناصة، بالإضافة الى اغتيال الناشطين واختطافهم، خاصة الشابات. دعائيا، لجأوا الى توليفة خطر المنتفضين على البلد ونشر الفوضى وحرق الممتلكات العامة وتعطيل الحياة اليومية والعمالة لقوى خارجية.
أما الشكل الناعم للاحتواء، فقد تبدى بظهور عادل عبد المهدي، محاطا بساسة النظام، وهو يعلن « تفهمه» لمطالب المتظاهرين في ذات الوقت الذي « يحذرهم» من الفراغ السياسي وإحداث الفوضى وتعطيل ميزانية الدولة، ومحملا إياهم حرمان الأطفال من التعليم بسبب مشاركة المدارس في المظاهرات. هكذا ألقى مسؤولية الخراب على عاتق المتظاهرين، وبالتالي وباعتباره القائد العام للقوات المسلحة أفسح المجال لشرعنة قتلهم. معه، احتل بقية الساسة من نواب ورؤساء أحزاب وقادة ميليشيات، شاشات الفضائيات ليعلنوا، جميعا، «تضامنهم» مع المنتفضين، و«حرصهم» على حياتهم، في ذات الوقت الذي تواصل فيه قوات الأمن والمليشيات استهدافها لهم، وسقوط الشهداء من الشباب بشكل يومي. ولا تخلو الساحة الدعائية الإعلامية من وجوه مسؤولين سابقين، يعاد تدويرهم، حاليا، كمحاولة لاستبدال وجه بآخر، تحايلا على المتظاهرين، وانعكاسا، في الوقت نفسه لمدى تمزق النظام وخوف قادة أحزاب «العملية السياسية»، مما سيحمله المستقبل. انطلاقا من هذا، أعلنوا ما أطلقوا عليه «وثيقة الشرف» التي قابلها المنتفضون بالتهكم والسخرية. كما سخروا من دعوات النظام، سواء بلسان رئيس مجلس النواب أو « مثقفي» النظام، الى ترتيب لقاء لعرض طلباتهم وتوجيه «النصائح» لهم بانتخاب من يمثلهم ويتحدث باسمهم بشكل علني. وهي «النصيحة» التي لا يكف مقدمو البرامج التلفزيونية العراقية، عن تكرارها ببلادة ببغائية، ويرفضها المنتفضون جملة وتفصيلا لأنهم يعرفون جيدا ما الذي سيكون عليه مصير من سيتم الإعلان عن أسمائهم وأن الوضع الحالي يقتضي العمل التنسيقي الجماعي خاصة بعد أن أدركت النقابات والاتحادات الوطنية أن عليها المشاركة بالانتفاضة قبل أن يفوت الأوان. ومن يتابع مسار الثورة التونسية، سيجد أن وقوف اتحاد الشغل الى جانب الشباب، على تأخره، بالإضافة الى عدم تدخل الجيش، أحدث تحولا كبيرا في انتصار الثورة.
ان مراجعة مسارات التظاهرات في العراق، على مدى حقبة الاحتلال ومواصلة ذات الوجوه والأحزاب الهيمنة على السلطة، وموارد النفط، وتخريب التعليم، والصحة، والصناعات المحلية، وإفراغ البلد من عقوله، سيبين بوضوح أن الانتفاضة الحالية ليست وليدة شهر تشرين/ أكتوبر بل استمرارية المقاومة ضد المحتل والنضال الذي دفع آلاف المواطنين حياتهم ثمنا للوصول اليها اليوم، وأن ادعاء النظام الحالي أنه ليس مسؤولا عن خراب 16 عاما، استهانة أخرى بعقول الناس وبحياة الشهداء. وهذا ما أثبت المنتفضون انهم لن يسكتوا عليه هذه المرة.
كاتبة من العراق
المرأة العراقية: «نازلة آخذ حقي»
هيفاء زنكنة
بعد سنوات من التغييب القسري، خرجت المرأة العراقية الى الشارع منتفضة بجانب الرجل. أجاب خروجها على سؤال ملح طالما طرحه متابعو المظاهرات والاعتصامات التي تغطي شوارع المدن وساحاتها منذ الغزو الانكلو – أمريكي وما تلاه من انتهاكات وجرائم. كان السؤال: اين هي المرأة العراقية؟ متضمنا سردية إنجازاتها، وهي المعروفة بنضالاتها التاريخية والمعاصرة؟ لماذا الغياب والبلد المحتل بأمس الحاجة الى صوتها؟ كيف تسكت من ساهمت ببناء العراق منذ عشرينيات القرن الماضي، وهي الرائدة في مجال التعليم، والأدب، والنشاط السياسي، والدفاع عن الوطن ضد الاستعمار والظلم والقمع؟
أثار خروج المرأة الى ساحات مدنها وهي تصدح «نازلة آخذ حقي»، اهتماما بالغ الأهمية في داخل العراق وخارجه. فالمرأة التي تتمتع بحرية الحركة في الفضاء العام هي المؤشر الحضاري لأهل البلد، بعيدا عن المتاجرة بحضورها من قبل الأنظمة القمعية.
نساء وفتيات من مختلف الأعمار، من مختلف المهن، خريجات وطالبات، ربات بيوت وعاملات، يشاركن، يوميا، في مظاهرات واعتصامات بشكل لم يشهدها العراق المحتل سابقا. في كل المظاهرات السابقة، منذ الاحتلال ثم في أعوام 2011 و2015 و2018، كان هناك، دائما، عدد لا يزيد على أصابع اليد الواحدة، من ناشطات المجتمع المدني، أو أمهات وزوجات المعتقلين، يقفن أمام معسكرات الاعتقال او المراكز الأمنية، أملا في أن يسمعن خبرا عن أحبائهن، مخاطرات بتعريض أنفسهن للامتهان والاذلال.
أما الآن وخاصة منذ 25 تشرين/ أكتوبر، فقد بات حضور المرأة جزءا لا يتجزأ من المطالبة باستعادة الوطن، بديمومة الانتفاضة، ونسغها المتصاعد في ساحات صارت مدنا بفضل مساهماتها. فهي التي ترسم، وتحاجج مقدمي البرامج التلفزيونية المشككين بأهمية الاحتجاجات وماهية المطالب، وتعالج الجرحى، وتعزف الموسيقى، وتشارك في أعداد الطعام وحملات تنظيف أماكن الاعتصامات. نراها بعينيها المحمرتين جراء الغازات المسيلة للدموع والقنابل الدخانية، وهي توزع قناني الماء لغسل عيون الآخرين المستهدفين مثلها.
تثير مشاركة المرأة في انتفاضة تشرين، تساؤلا آخر عن سبب عدم خروجها سابقا؟ أين كانت، بهذه الاعداد الكبيرة في حراك التظاهرات المتواصلة منذ عام الغزو؟ لقد استهدفت المرأة، بشكل خاص، بحملات الترهيب والترويع، المتبدية بالاختطاف والتعذيب ناهيك عن التحرش الجنسي والاغتصاب. وقائمة المعتقلات وتعرضهن لأبشع أنواع التعذيب منذ اليوم الأول للغزو، تحت مختلف الأسباب، طويلة. صار الحرص على سلامة المرأة، الى حد منعها من مغادرة البيت، أولوية المجتمع الذي يحمل، أساسا، الموروث المجتمعي لمفهوم الشرف، المجسد بالمرأة، والذي تستغله السلطات القمعية والاحتلال، كسلاح ضد المرأة وعائلتها وعشيرتها.
وجاء استهداف المرأة العاملات في المجال العام، خطفا وقاتلا، سواء من قبل أفراد أو ميليشيات أو جهات حكومية، ومع انتشار التفاصيل، بدون إلقاء القبض على الجناة أو تقديم توضيح من الجهات المسؤولة، ليرسخ حالة الخوف بين النساء، ومنعها من ممارسة أي نشاط عام.
لم تعد المرأة، كما بقية الشباب، مخدوعة بخطاب الأحزاب المنمق ووعود الحكومات الفاسدة. تعبت من التهجير القسري من بلاد هي ملكها ووطن استحوذ عليه الحرامية. فخرجت مع أشقائها الشباب الى الشوارع، ليعيدوا للعراق كرامته المتمثلة بهم
ولأن المرأة هي المسؤولة عن العائلة عند غياب الرجل قتلا او اعتقالا، لم تعد أولوية المرأة، كما السابق، المساهمة بالشأن العام، بل باتت أولوياتها متعلقة برعاية العائلة، وتوفير بعض الأساسيات الضرورية لمواصلة الحياة. ولايزال لحملات التهجير القسري وسياسة العقاب الجماعي، والعيش في المعسكرات تأثيرا يماثل الإصابة بالشلل وتفتيت القدرة على التفكير ابعد من اللحظة. ينطبق هذا الحال المأساوي على عموم النساء مما أدى الى انكفائهن بعيدا عن الفضاء العام.
بالمقابل، لعبت الطائفية ومحاصصاتها، دورا في استقطاب مجموعات نسوية، وكان لفساد الأحزاب السياسية تأثيره اختيار البرلمانيات اللواتي اقتصرت أدوارهن، غالبا، على ترديد سياسة أحزابهن وان كانت ضد المرأة، وامتد التأثير على الحراك النسوي العام، عبر المنظمات النسوية وتحديد أولوياتها، وفقا لأجندات الجهات الداعمة، سواء كانت داخلية أو خارجية.
ففي الفترة التي تلت ما بعد الغزو مباشرة، نشطت ضمن «العملية السياسية» التي صاغها المحتل، نسوة استعماريات اخترن أن يكن وجها للاحتلال واداة لتسويغ الغزو والحرب وبخطاب غالبا ما يستبدل أو يعارض القضايا الوطنية والاجتماعية والطبقية الأساسية بقضايا التمايزات الثقافية الأخرى الجنسوية أوالجندرية، مع أهميتها كجوانب على المجتمع الانتباه اليها في سياق تطوره لكنها تصبح بحال «كلمات حق أريد بها باطل» مقابل الصراع الوطني والاجتماعي الدموي العاتي.
اختفى هذا النوع من الناشطات، تدريجيا الواحدة بعد الأخرى، معلنات بان المجتمع العراقي ذكوري، ابوي، بعد أن تضاءلت حصتهن في الاستيزار الى الصفر، وأصبحت نسبتهن في البرلمان أداة تبييض وجه أمام الدول الغربية أكثر منها تمثيلا حقيقيا للمرأة وحافزا لتنشيطها وتوفير فرص العمل والانتاج.
ومع تبني قوات الاحتلال الأمريكي سياسة تفعيل تعاون المرأة العراقية التي قادها قائد قوات الاحتلال الجنرال دافيد بترياس، متبعا بذلك نصيحة مستشاره في مكافحة التمرد دافيد كيلكولان، القائل: «احصل على دعم المرأة فتفوز بدعم العائلة كلها. أملك العائلة، حينئذ تخطو خطوة كبيرة إلى الأمام في تعبئة السكان»، ومع استحداث «مبادرة دعم المرأة العراقية» التي أطلقها فيلق مهندسي قوات الاحتلال ويرتبط معظمها بالقواعد العسكرية، تحت شعارات «تمكين المرأة» و «مشاركة المرأة في بناء الاقتصاد». ومنح النساء المتعاونات عقودا بقيمة 180 مليون دولار، أدى هذا كله، خاصة في فترة تزايد عمليات المقاومة ضد المحتل، الى الحاق الضرر وتلويث سمعة عمل المرأة في المجال العام. وإذا اضفنا الى ذلك فرض رجال الدين السياسي (وكلهم رجال) تفسيراتهم الطائفية المتماشية لا مع التدين كمعتقد شخصي، بل مع سياسة الأحزاب المتبنية لهم، وغالبا ميليشياتها، على المرأة بكل تفاصيل حياتها منذ طفولتها وكيفية تزويجها الى تصويتها للانتخابات وتغسيلها عند وفاتها، لوجدنا أن كاهل المرأة كان ينوء بالكثير مما لا يحتمل، فبدت وكأنها تخلت عن ذاتها المقاومة.
إلا أنها عادت، مع بقية الشباب لتعيد إلينا الأمل. متألقة بشبابها لتكون، كما كانت، قوية، أبية، رافعة الرأس، وهي ترفض العودة الى البيت ما لم يتم تحقيق مطالب المنتفضين وهي منهم. في لحظات التعب والضعف الإنساني، تقف وهي ملتفة بعلم بلادها، لتقسم مع بقية الشباب بأنهم لن يكونوا للعِــدَى كالعبيد، مرددين « موطني»، بكلماته المتجذرة عميقا في الوعي العربي الجماعي، من فلسطين الى العراق. لم تعد، كما بقية الشباب، مخدوعة بخطاب الأحزاب المنمق ووعود الحكومات الفاسدة. تعبت من التهجير القسري من بلاد هي ملكها ووطن استحوذ عليه الحرامية. فخرجت مع أشقائها الشباب الى الشوارع، ليعيدوا للعراق كرامته المتمثلة بهم. العراق الذي لم يعودوا قادرين على تحمل رؤيته محتلا، مهانا، مستباحا.
كاتبة من العراق
على المغول الجدد
الرحيل فالعراق يسير بأهله
هيفاء زنكنة
لو أتيحت للرحالة المغربي ابن بطوطة أن يزور بغداد التحرير هذه الايام، قادما من القرن الرابع عشر، لوجد نفسه، كما نجد أنفسنا، إزاء لحظة إنسانية تاريخية، ستجعله يغير ما أمـلاه عـلى ابـن جُـزَي في «تـحـفـة الـنّـظّـار في غـرائـب الأمـصـار وعـجـائـب الأمـصـار». حين وصف رحلته الى العراق، قائلا عن بغداد «وهذه المدينة العتيقة وإن لم تزل حضرة الخلافة العباسية، ومثابة الدعوة الإمامية القرشية، فقد ذهب رسمها. ولم يبق إلا اسمها. وهي بالإضافة إلى ما كانت عليه قبل إنحاء الحوادث عليها والتفات أعين النوائب إليها كالطلل الدارس، أو تمثال الخيال الشاخص، فلا حسن فيها يستوقف البصر، ويستدعي من المستوفز الغفلة والنظر، إلا دجلتها التي هي بين شرقيها وغربيها كالمرآة المجلوة بين صفحتين، أو العقد المنتظم بين لبتين. فهي تردها ولا تظمأ ونتطلع منها في مرآة صقيلة لا تصدأ، والحسن الحريمي بين هوائها ومائها ينشأ».
ما لم يذكره ابن بطوطة ومن قبله الرحالة الاندلسي ابن جبير ان «مدينة دار السلام، وحضرة الإسلام، ذات القدر الشريف، والفضل المنيف، مثوى الخلفاء، ومقر العلماء»، التي اعتبر الإمام الشافعي أن مَن لم يدخلها «ما رأى دنيا، ولا رأى ناسا»، لم يبق الا اسمها، لأنها تعرضت الى أقسى حدث في تاريخها وهو غزو المغول عام 1258. حيث «وضعوا السيف في أهلها» كما ذكر المؤرخ ابن الفوطي ووجدها أحد المؤرخين «وقد رحل عنها سكانها، وبان عنها قطانها، وتمزّقوا في البلاد، ونزلوا بكل واد».
في تشابه مؤلم، سبب الغزو الأمريكي، عام 2003، الذي أسس للاحتلال المشترك مع إيران، لبغداد وبقية العراق، ذات الخراب البشري والعمراني الذي خلفه المغول. انها ذات البغداد. جعلها المغول الجدد على وشك التمزق طائفية وفسادا. مدارسها طينية ومستشفياتها مقابر للمرضى. نساؤها يخشين السير في الشوارع ورجالها معرضون للاعتقال والتعذيب والتغييب. يرحل عنها سكانها خوفا من القمع والقهر والموت. أغنياؤها يتمتعون بالملايين وفقراؤها من النساء والأطفال يتسابقون على التقاط ما يمكن التقاطه من القمامة. الخريجون عاطلون عن العمل. ثروة البلد يتشارك في نهبها الحاكم الفاسد وسادته. مظاهراته واحتجاجاته خلال 16 عاما، تقمع خطفا وقتلا لأنها «بعثية، إرهابية، داعشية، تخريبية». وتجاوز عدد ضحاياه أما قتلا بشكل مباشر أو نتيجة انعدام الخدمات الصحية المليون مواطن.
إنها ذات البغداد، عاصمة البلد الغني الذي يريد الغزاة، كما جيران السوء جميعاً، شرقا وغربا، شمالاً وجنوباً، ابقاءه مريضا، ضعيفا، جائعا، مستخذيا، بلا كرامة، عاجزا عن التفكير أبعد من يومه، ينخره عنف زرعوه وهم يحاولون اقناعه بانه هو السبب لأنه يحمل جينات العنف. الى أن نهض الشباب في الاول من تشرين/ اكتوبر.
نزل المزيد من المتظاهرين، نساء ورجالا، إلى ساحات المدن وجسورها، متعهدين باستمرار الاعتصامات، مهما كان الثمن، مطالبين باستعادة الوطن من أيدي من تصرفوا على مدى 16 عاما، بشكل يماثل المغول في دمويتهم
ليكون يوما سيؤرخ حدثا لم يشهده البلد منذ عاش العراق وبقية الدول العربية فرحة التحرر من الاستعمار. انتفض الشباب على الحكومة والأحزاب وقدسية المرجعيات ومليشيات الاحتلال. مدركين بان صمتهم ان استمر سينتهي بتدمير انفسهم، تدمير الانسان وحضارته التي صنعها عبر التاريخ. انتفضوا على الحاضر المرير، المتمثل لا بالنظام فحسب، بل وحتى أهاليهم الذين خدعتهم أوهام الطائفة، وصمتوا إزاء الخراب والموت البطيء بانتظار تحقيق الوعود. بانتظار غودو. انتظروا ولم يأت الموعود.
باستمرار الانتفاضة، سقطت الجدران الكونكريتية التي أسسها وبناها ويرعاها المحتل والحكام بالنيابة. معها سقطت قائمة التهم الجاهزة. باتت مجرد هراء. إلا أن هذا لا يعني أن النظام وشريكيه سيتنازلون بسهولة امام المتظاهرين، مهما كانت انتفاضتهم سلمية. وإذا كانت قائمة الشهداء قد بلغت 325 والجرحى عشرة آلاف، فان استمرار الاستهداف الوحشي للمعتصمين، بينما يتحدث ساسته عن الاصلاحات، يبين أنهم استساغوا طعم الدم ولن يتوقفوا عن شرب المزيد. ومن يقرأ بيانات وتصريحات رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بعد إزالة العبارات المنمقة، الفضفاضة، وتجريدها من « سوف» وعود الاصلاح سيجد أن نية القضاء على الانتفاضة هي التي يريد النظام ومستشاروه وميليشياته الإيرانية، تنفيذه. بينما يقف «المستشارون» الأمريكيون، في معسكراتهم المتناثرة كالبثور على وجه العراق، بانتظار مشاركة الغنيمة.
فبعد أن وزع النظام وميليشياته قناصين عراقيين وإيرانيين على سطوح البنايات، واستخدم الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع المصنعة خصيصا للمعارك الحربية، انتقل الى مرحلة المراوغة اللفظية، والتهديد المبطن، والتستر بعباءة المرجعية وعدد من المثقفي قراط الطائفيين. كلهم يدعون، سوية مع عبد المهدي، انهم حريصون على سلامة المتظاهرين، وعلى الممتلكات العامة، والتعليم، والمستشفيات. في الوقت الذي يعرفون فيه جيدا انهم لم يكملوا أثناء حكمهم مشروعا حقيقيا واحدا (هناك طبعا آلاف المشاريع الوهمية)، وانحدر مستوى التعليم والصحة الى أسوأ المستويات في العالم (حسب المؤشرات الدولية)، وان حرصهم على حياة المتظاهرين تم تطبيقه على الارض بقتلهم. اما قطع الانترنت الذي يعني بان بإمكان النظام أن يقتل الناس كما يشاء بدون أن يطلع العالم الخارجي على جرائمه، فان عبد المهدي يبرره بقوله « لأنه يستخدم للترويج للعنف والكراهية والتآمر على الوطن وتعطيل الحياة العامة». كما يشرعن قتل المتظاهرين بذريعة ان النظام « في وضع دفاعي كامل» وانه «لا يستخدم النار بل أبسط الوسائل»، مستهجنا بحرقة المتهم البريء «ومع ذلك نُلام»! وليصب الملح على جروح المتظاهرين وذوي الشهداء وليقتل الشهداء مرة ثانية وثالثة، أطلق النظام عددا من المثقفي قراط ليجلسوا في استديوهات الفضائيات (عزت الشابندر، الشرقية، 8 تشرين الثاني/نوفمبر) مدافعين، عن جرائمه، بحجة ان القوة الخفيفة للدولة تحمي المؤسسات، والى حد لوم الضحايا (وهو نهج شائع لدى المحتل الصهيوني) في ذات الوقت الذي تم فيه قتل ستة متظاهرين، ونزل المزيد من المتظاهرين، نساء ورجالا، الى ساحات المدن وجسورها، متعهدين باستمرار الاعتصامات، مهما كان الثمن، مطالبين باستعادة الوطن من أيدى من تصرفوا على مدى 16 عاما، بشكل يماثل المغول في دمويتهم، وأطلقوا من وعود الاصلاح الكاذبة ما يجعل حتى ملابس الامبراطور العاري حقيقة بالمقارنة.
كاتبة من العراق
هل لمتظاهري العراق برنامج محدد؟
هيفاء زنكنة
ما هي مطالب المنتفضين في ساحات التحرير في العراق؟ منذ انبثاق انتفاضة الشباب في الأول من تشرين الأول/ اكتوبر، في عديد المدن، ويكاد لا يخلو برنامج تلفزيوني، محلي أو عالمي، أو مقال صحافي من طرح هذا السؤال ومحاولة الإجابة عليه. وإذا كانت الإجابة، في أيام الانتفاضة الأولى، محصورة بأصوات المسؤولين الحكوميين وقادة الأحزاب والميليشيات (يقدمون أنفسهم كساسة)، فإنها لم تعد تقتصر على وجوه النظام أو حتى البرلمانيين الذين كانوا يقدمون أنفسهم باعتبارهم ممثلي الشعب. غاب النواب، اختفوا عن أنظار المشاهدين والجمهور عموما. سقطت أقنعة التجارة بمحنة «المظلومين» من داخل منظومة تجد أن بقاءها في السلطة هو الأولوية وأن الشعب لا يزيد عن كونه « فائض قيمة»، في بلد ريعي، ومن الأفضل التخلص منه، مهما كانت همجية الطرق المستخدمة.
بهذا المنطق، تمت شرعنة شراسة قمع المتظاهرين، المصرين على استعادة وطنهم وملكية شوارعهم بطرق سلمية، وأساليب إبداعية، قلما شهدها العراق سابقا. في المقابل «أبدع» النظام في استهدافه المتظاهرين، بدون تمييز بين الرجال والنساء والأطفال ما أدى إلى قتل 250 مواطنا وجرح عشرة آلاف، حتى الآن. وحين قام «فريق التحقق الرقمي»، التابع لمنظمة العفو الدولية، في 31 تشرين الأول/ أكتوبر «بتحديد الموقع الجغرافي وتحليل أدلة في مقاطع فيديو، صورت بالقرب من ساحة التحرير في بغداد، توثّق الوفيات والإصابات بما في ذلك اللحم المتفحم، والجروح التي انبعث منها «الدخان»، تبين أن أنواع قنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقتها شرطة مكافحة الشغب وقوات الأمن الأخرى، على المتظاهرين مباشرة، هي من نوعين مختلفين من بلغاريا وصربيا. ويبلغ وزنها 10 أضعاف ثقل عبوات الغاز المسيل للدموع. وعلى عكس معظم قنابل الغاز المسيل للدموع التي تستخدمها قوات الشرطة في جميع أنحاء العالم يتم تصميم هذين النوعين على غرار القنابل العسكرية الهجومية المصممة للقتال مما أدى إلى إصابات مروعة، وموت متظاهرين بعد أن أغرست القنابل داخل رؤوسهم. كما قال العديد من الشهود إن ما يصل إلى 10 قنابل – والتي يشير إليها المحتجون باسم « الدخانية» – يتم إطلاقها في الوقت نفسه على المناطق المزدحمة، وينبعث منها نوع من الدخان رائحته مختلفة عن أي قنابل غاز مسيل للدموع سبق أن شاهدوها. وقد وجد بحث أجرته المنظمة أنه نظرًا لوزنها وتركيبها، فإنها أكثر خطورة بكثير على المحتجين. وأكد خبير الطب الشرعي للمنظمة أنهم «لم يروا مثل هذه الإصابات الشديدة بسبب هذا من قبل».
يعيدنا استخدام هذه الأسلحة المخيفة والسموم وما تسببه من إصابات مروعة في صفوف المتظاهرين، إلى يوم 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، حين بارك رئيس الوزراء، آنذاك، أياد علاوي هجوم قوات الاحتلال الانجلو أمريكي على مدينة المقاومة الفلوجة بحجة تحريرها، مستخدمين اليورانيوم المنضب وجيلا جديدا من الفسفور الأبيض الذي يذيب أجساد الضحايا.
الساسة والمحللون الذين يحاولون الحط من قيمة التظاهرات وتشويه المطالبة بالسيادة والحرية والكرامة صاروا يتحدثون عن عدم وجود قيادة واضحة لها
ولايزال أهل الفلوجة، وبقية المدن التي تناثر فيها غبار الموت البطيء، يعانون من الارتفاع الملحوظ في مستويات التشوهات الخلقية عند الولادة، جنبا إلى جنب مع ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان وظهور أمراض وتغيرات غير عادية في نسبة الجنس عند الولادة، حسب تقارير علمية معروفة.
ولأن القتلة يتشابهون واصل رئيس الوزراء السابق نوري المالكي سياسة سلفه فأمر بقصف المدينة بالبراميل المتفجرة، بحجة تخليصها من «الإرهاب»، ولكن مع بعض الاختلاف. لم يعد المحتل الأمريكي هو «السيد» الوحيد، بل بات «آية الله»، الجالس في طهران شريكا يمثله قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، الذي صار وجوده على الأرض العراقية ملحوظا أكثر من دوام النواب في البرلمان العراقي. ولأن سليماني يعرف جيدا أن خونة أوطانهم لايؤتمنون، حضر إلى بغداد، هذه الأيام، ليشرف بنفسه على أداء أتباعه من الميليشيات إلى الوزراء وقادة الأحزاب والنواب، عسكريا ودعائيا.
الملاحظ أن الساسة والمحللين الذين يحاولون الحط من قيمة التظاهرات، وتشويه المطالبة بالسيادة والحرية والكرامة، صاروا يتحدثون عن عدم وجود قيادة واضحة وانعدام البرنامج، بعد أن فشلت اتهاماتهم التي وأدت المظاهرات السابقة، وبعد أن بات للمظاهرات شعار موحد هو «نريد وطن»، يتفيأ في ظله الطلاب والعمال والأكاديميون والمهمشون وعدد من النقابات، وبات الحضور النسائي، ملمحا متميزا، متجاهلين حقيقة أن للانتفاضات ديناميكية تجعل النكوص إلى الوراء مستحيلا وأن التغيير حاصل لامحالة.
إن عدم وجود قيادة واضحة أمام عدسات الكاميرات وفي الاستديوهات ضروري إزاء القمع والإرهاب الرسمي. أما بالنسبة إلى المطالب والبرنامج، فقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، في الأيام الأخيرة، ما الذي يعنيه المتظاهرون بـ «نريد وطن» ويتضمن برنامجا، من أهم نقاطه: استقالة الحكومة الحالية، تشكيل حكومة انتقاليّة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر فقط، وتتألف من شخصيات تتوفر فيهم أربعة شروط هي: أن يكونوا مستقلين ولم يسبق لهم العمل في أي حزب سياسي سابقاً. لم يسبق لهم العمل في أي حكومة أو مجلس نواب سابق، ولا في أي حكومة محلية أو مجلس محافظة، أن لا يتقدموا للترشيح في الانتخابات المقبلة ولا يشاركوا في الرعاية أو الترويج لانتخاب أي مرشّح، وأن يكونوا من المشهود لهم بالنزاهة والشجاعة والوطنيّة، وأن يتم تعديل قانون الانتخابات وتشكيل مفوضية مستقلة جديدة للانتخابات بنفس شروط أعضاء الحكومة الانتقاليّة، إجراء انتخابات جديدة ويكون موعدها قبل نهاية فترة الحكومة الانتقاليّة، أن يقوم مجلس النوّاب الجديد بتعديل الدستور بفترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، أن تتعهّد الحكومتان الانتقالية والدائمة بإجراء تحقيق عاجل حول الجهات والأشخاص الذين تسببوا بقتل المتظاهرين، وإنزال حكم القضاء العادل بهم، وتعويض أسر الشهداء والتكفل بعلاج الجرحى وتعويضهم، وأن يتعهّد مجلس القضاء الأعلى أن يتم فوراً إطلاق تحقيق «من أين لك هذا؟» بحق المسؤولين الحاليين والسابقين، وسائر موظفي الدولة، واسترداد الأموال من السرّاق مهما كانت الجهة التي تقف خلفهم.
تمنحنا هذه المطالب، ملامح وليس بالضرورة كل ما يمكن أن يعيد البلاد إلى أهلها، ليتمتعوا بكل حقوق المواطنين بلا استثناء، بالإضافة إلى السلام، إقليميا ودوليا. هل هذه أضغاث أحلام ونحن نرى أصبع كل من هب ودب مغروزة في غنيمة العراق؟ لا أظن ذلك. وبإمكان المتظاهرين تحقيقه إذا ما استمروا رافضين لحالة اللا كرامة والإهانة المفروضة عليهم. إنه ليس مشروعا من المستحيل تحقيقه من قبل المتظاهرين الذين نجحوا، خلال شهر واحد، من إسقاط المشروع الاستعماري الطائفي بمحو الهوية الوطنية، ومنظومة التمييز، وهيمنة الأحزاب الفاسدة، والخوف من الميليشيات وأوهام القدسية التي لا تمس.
كاتبة من العراق
شعراء الشوارع يستعيدون عراقهم
هيفاء زنكنة
مع استمرار المظاهرات في عديد المدن العراقية، وإشهار النظام أدوات قتله بوجوه المتظاهرين، ومع سقوط المزيد من الشهداء، بشكل يومي، ومع حالة الخرس العربية المزمنة، برزت من صميم الانتفاضة، مستويات إبداعية متعددة لتتحدى نظام اللانظام، وعمليته السياسية الطائفية، الفاسدة، التي أسسها المحتل.
تنوعت مستويات الإبداع، التي طالما تميز بها الشعب العراقي، لتساهم في كسر حواجز الخوف والتقسيمات الطائفية والدينية والعرقية المفبركة. فمن الفن التشكيلي والكاريكاتير إلى الموسيقى والشعر والغناء إلى رفع شعارات تخطها الأيدي بحرقة قلب وغضب بات من المستحيل كبته. توحدت، هذه الأوجه المتعددة، جميعا، معبرة بالألوان، والمفردات، والصور عن الظلم والأمل والأحلام وحب الحياة. انضم الفنانون إلى المتظاهرين الشباب ليصرخوا بوجوه من استهانوا بكرامتهم بأن الشوارع ملكهم، والمدن ملكهم، وسيبقون فيها حتى يستعيدون الوطن. فالطغاة مهما تحصنوا بأسلحتهم، وأجهزة إعلامهم، وأموال فسادهم، ودعم سادتهم، يخشون الكلمة واللون وصوت المغني، خاصة إذا ما خضبتها دماء الشهداء.
وإذ ترحب الانتفاضة الجماهيرية بانضمام الطلاب والجامعات والأكاديميين ونقابة المحامين والمدرسين إليها، للتضامن مع من نزلوا إلى الشوارع يوم الأول من تشرين الأول/ اكتوبر وحتى اليوم، يقف أبناء الشعب متسائلين: هل نعيد اجترار الدموع ونلطم حتى إسالة الدم من صدورنا، وتحويل الشهداء إلى صور جامدة بلا حياة، ننساها بعد حين؟ رافضين للحلول الكاذبة ومقايضة الشهداء وتضحياتهم، يقول المتظاهرون: سنبقى وفاء لآمال الشهداء الذين سقطوا مطالبين بحق الكرامة وان يعيشوا سنوات تحقيق طموحاتهم في وطنهم. في شوارع مدنهم. أن يكتبوا قصائد أحلامهم بأنفسهم، لأنفسهم، ولأبناء شعبهم.
يقول المتظاهرون، في لحظات قتل زملائهم، وأجسادهم محروقة بالغاز: نحن أخوة الشهداء، وأهلنا في أرجاء الدول العربية يعرفون معنى ذلك جيدا، وهم يرفعون أجساد أبنائهم العارية إلا من دماء رصاص القناصين والغارات الجوية والغازات الخانقة لأنفاس شباب كل ما يريدونه هو بناء الأمل. هذه صباحات بلداننا ومساءاتها. نراها عبر شاشات التلفاز أو نعيشها ونحن نتساءل أي بلد عربي سيعيش الغدر والتنكيل اليوم؟ فلسطين؟ العراق؟ سوريا؟ أي البلدان هو؟ الشهداء متشابهون وخراب المدن متشابه. وآه… كم يتشابه الطغاة في أكاذيبهم وخنوعهم أمام أسيادهم الأجانب، واستئسادهم تجاه شعوبهم المقاومة الحية. ألم يكن شاعرنا الرصافي محقا بقوله «عبيد للأجانب هم ولكن على أبناء جلدتهم أسودُ»!
منذ الأيام الأولى للمظاهرات اختفى معظم الساسة وقادة الأحزاب وأعضاء البرلمان، باستثناء الخطاب الفضائي الذي ألقاه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وملهاة رئيس البرلمان الحلبوسي حول تحقيقه مطالب الشباب، ارتدى بقية الساسة طاقية الإخفاء، ليصبح المجال مفتوحا أمام الشعب من جهة وأجهزة النظام القمعية والقتلة من الميليشيات الإرهابية من جهة أخرى.
منذ عام 2003، عام الغزو والاحتلال، والعراق ينتفض ويثور كالبركان الذي ما أن يهدأ لفترة حتى يستعيد توهجه وغليان نيرانه
إزاء صمت أجهزة الإعلام أو شراء سكوتها، سيطر الشباب المتظاهرون، داخل العراق، على الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي ليتبادلوا وينشروا أخبارهم وما يحيط بهم، والتحليل والتعليق والصور والفيديوهات الناقلة للحدث الآني المباشر، التي غالبا ما ترفض أجهزة الإعلام الرسمية نشرها أو تقوم بنشرها بشكل انتقائي دقيق.
خارج العراق، في أمريكا وأوروبا، استحدث الشباب المتضامن مع المتظاهرين مجموعات «واتساب» تتابع وتتفاعل وتنظم التظاهرات أمام السفارات العراقية وأجهزة الإعلام الرئيسية كالبي بي سي ومقرات الحكومات ورؤساء الوزراء والأمم المتحدة. أبدعوا أساليب جديدة لجذب الانتباه إلى الإبادة التي يتعرض لها المتظاهرون داخل العراق، وإدانة الصمت الدولي، وتهرب الدول الغربية، وأمريكا خاصة من مسؤوليتها في غزو واحتلال العراق وتهيئة الأرضية للتقسيم والفساد والأرهاب.
مع الشباب المتظاهرالمستقل الذي لم يعد يطالب بالخدمات الأساسية باعتبارها أحلاما وطموحا بل حقا على الحكومة توفيرها، وقف عدد من فنانينا الكبار. لم تعد البلدان التي يقطنونها جدارا عازلا بينهم وبين المتظاهرين كما لم يعد اختلاف العمر فاصلا بين النشاط الإبداعي وانخراط الشباب في عملية التغيير، التغيير الضروري للتطوير المستمر في ديناميكية تعكس حب العراق.
خلال ايام قليلة أنتج الفنانون، ورثة الفن المعروف بمقاومته للاحتلال والقمع، عددا كبيرا من الاعمال الفنية، وفروها للجميع على صفحات الفيسبوك والانستغرام وكل مكان يجدون فيه متنفسا للحرية والتواصل مع المتظاهرين. رأينا فنانين يشاركون في المظاهرات، ورأينا آخرين عبر تخطيطاتهم ولوحاتهم ومنحوتاتهم. باتت أصوات المتظاهرين جزءا من الأعمال الفنية في لحظات اقتراب المخيلة والأحلام من الواقع. حملت أعمال الفنانين عناوين الشارع: لا لاغتيال المتظاهرين، نريد الوطن، قوات مكافحة الشغب وهي تداهم المتظاهرين، كلهم حرامية، نازل آخذ حقي، ولنا كلام آخر. وقد اختار منظمو المهرجان السنوي العالمي في مدينة ردينغ البريطانية، عشرين عملاً فنيا جديدا عن الانتفاضة لتعرض متزامناً مع ورشة حاشدة يوم الجمعة الماضي عن رحلة لتاريخ موسيقى العود العراقي كان مخططا لها منذ أشهر.
ضمن مجموعات الواتساب الشبابية باتت اللغة، بالتعليقات التغريدية القصيرة وأخطائها النحوية، سلاحا للتهكم من أعضاء الحكومة ومجلس النواب والأحزاب، وحتى المراجع الدينية التي تحاط عادة بالقدسية، مسها رشاش السخرية والتهكم. ولا تخلو صفحات التواصل من نقل دقائق ما يجري في الساحات والشوارع بأسلوب سردي يجمع بين المعلومة والتحدي والسخرية، بات منتشرا أثناء الانتفاضة. كتب أحد الشباب ناقلا إلينا خبر انضمام التلاميذ والطلاب إلى المتظاهرين:
«حدث تغيير كبير في العراق، خرج عشرات الآلاف من الطلاب من جميع مستويات التعليم في شوارع بغداد في احتجاج عام ينضم إلى المحتجين. حيث استيقظت الحكومة النايمة على صداع كبير، لا يمكنهم إطلاق النار على طلاب الصف الخامس الابتدائي بحقائب مدرسية من الرجل الحديدي!»
يهدد ساسة النظام العراقيين بالفوضى إذا ما استمرت المظاهرات وتم انضمام بقية شرائح الشعب إلى العصيان المدني، متعامين عن حقيقة أن وجودهم، بأحزابهم وميليشياتهم وولائهم لغير الشعب، هو الفوضى بعينها.
«إنه الوطن»… يقول شباب العراق
هيفاء زنكنة
في الأسبوع الرابع من المظاهرات في العراق، التي شملت عديد المدن في أرجاء البلاد، وبعد استشهاد 200 متظاهر وجرح حوالي ثمانية آلاف، لم يعد المتظاهرون الشباب يطالبون، فقط، بتحسين الخدمات. تكلفة الحياة الثمينة دفعتهم إلى إعادة ترتيب الأولويات. تعافوا من المطالب الخدماتية منذ تصنيع «العملية السياسية» وليدة الاحتلال الانكلو أمريكي عام 2003. تراجعت مطالب الماء الصالح للشرب والكهرباء والخدمات الصحية، على أهميتها القصوى، وهي ليست منة حزبية أو حكومية، بل من أساسيات حقوق الإنسان، وقاعدة هرم الاحتياجات الإنسانية التي ترتقي بالشعوب، ليعود إلى الواجهة أحد المطالب التي برزت أثناء مظاهرات تموز/ يوليو 2018، مع اختلاف مهم. اذ عاد المطلب، أساسيا وبشكل جماعي أقوى وأعمق هذه المرة، وبالتزامن مع المطالبة بحرية الرأي والمساواة بين المواطنين. صارت الهمسة صرخة تنادي «نريد الوطن».
بعد أن أثبت المتظاهرون أنهم خارج الأحزاب، بأنواعها، والمرجعيات الدينية بأنواعها، وتجار الفساد والتبعية للمحتل بأنواعه، لم يعودوا بحاجة إلى إثبات نقائهم الديني والمذهبي ودفع تهم الاندساس والإرهاب والبعث، وبعد أن نفضوا عن أنفسهم الخوف من التهم الجاهزة، المانعة لخروجهم إلى شوارع مدنهم واستعادة ملكيتها (الشوارع ملك للناس، للشعب… أليس كذلك؟)، صار الشعار المختلف الذي شهد ولادة طبيعية، من صميم حراكهم ومبارك بقدسية دمائهم هو «نريد الوطن». مطلب تبناه الشباب في داخل وخارج العراق، لاستعادة ما سلب منهم، وامتد كما لاحظنا من مظاهرات لبنان، في الأيام الأخيرة، إلى بلدان أخرى، بينما تستمر تصريحات الساسة ورجال الدين في إدانة العنف والفساد، كأنهم ليسوا غارقين فيهما، وكأن الشهداء يتساقطون نتيجة تغير مفاجئ في درجات الحرارة وليس قناصة النظام.
«نريد الوطن»، مطلب عضوي يماثل بانتشاره «الشعب يريد اسقاط النظام»، متضمنا، في الوقت نفسه، ما هو أبعد من مجرد اسقاط النظام، ومأسسة المحاصة الطائفية وتوزيع أسهم الفساد. حيث يطمح المتظاهرون إلى البناء، إلى التوحيد بديلا لسياسة التفكيك الاستعمارية المنفذة بالنيابة. إلى العيش في وطن لا مقاطعات القرون المظلمة. إنهم، يعملون من أجل هدف، تم تغييبه عمدا، خلال سنوات الاحتلال وحكامه بالنيابة، ممن ساهموا، ولايزالون، في تفتيت مفهوم الوطن، والترويج للهوية «السائلة»، والولاء لمن يقدم «العرض الأفضل»، ما دام الوطن، حسب منظورهم، سينمحي، تدريجيا، إزاء القبول بالواقع الجديد.
بعد أن أثبت المتظاهرون انهم خارج الاحزاب، بأنواعها، والمرجعيات الدينية بأنواعها، وتجار الفساد والتبعية للمحتل بأنواعه، لم يعودوا بحاجة الى اثبات نقائهم الديني والمذهبي ودفع تهم الاندساس والإرهاب
سواء كان الواقع مضمخا بوعود ديمقراطية المحتل الأمريكي أو دكتاتورية ولاية الفقيه. كلاهما يريدان، بشكل أو آخر، اختزال الوطن ـ العراق بطبقات معانيه، المتعددة، العميقة في ثرائها، إلى ايديولوجيا السرير الحديدي المعد سلفا، كما صنعه الحداد وقاطع الطريق اليوناني بروكرست، الذي كان يهاجم الناس ويقوم أما بمط أجسادهم أو قطع أرجلهم ليتناسب طول أجسامهم مع سريره الحديدي. فالسياسة الاستعمارية الجديدة، لم يطرأ تغير كبير على فحواها: إنها تعتاش وترتزق على مغذي الحاكم المحلي، العبد الذي يحصل على ترقية، فيُسمح له بالخدمة في بيت السيد بدلا من الحقل، إذا كان يخدمه بإخلاص، كما وصف المغني الأمريكي الأسود هاري بيلافونتي رجلاً أسود آخر هو كولن باول، وزير الخارجية الأمريكي أثناء غزو العراق.
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دعوة المتظاهرين للمطالبة بحق لا ينص عليه ميثاق حقوق الإنسان، بهذا الشكل المباشر، الصريح : نريد الوطن. وهي خطوة أذهلت كل أحزاب «العملية السياسية»، من الإسلامية إلى العلمانية، ومن القومية إلى الشيوعية، والتي تاجرت جميعا بتحالفاتها، من انتخاب «ديمقراطي» إلى آخر، تحت شعارات ظاهرها محاربة الفساد والمحاصصة، وباطنها «معا من أجل المحاصصة والفساد». لم تعد التظاهرات مرهونة بخدعة نحن ضد الفساد، نحن نزهاء. نحن مع سيادة العراق، نحن وطنيون.
ولعل أكبر خدع الاحتواء التي عاشها المتظاهرون على مدى سنوات الاحتلال هي التي يطلقها «سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد مقتدى الصدر دام عزه»، الذي يروج له، بعد تحالف الحزب الشيوعي معه في الانتخابات والبرلمان، أنه «مدني». فالمعروف، ومن مراجعة بسيطة، لمجريات المظاهرات السابقة، أنه من يتدخل دائما، بالتعاون مع المرجعية الدينية، على انقاذ النظام، في لحظات اقتراب المتظاهرين من تحقيق التغيير. فهو الذي منح نظام نوري المالكي مهلة ستة أشهر لإجراء الاصلاحات الخدمية التي طالب بها المتظاهرون عام 2011 بعد أن كان رئيس الوزراء نوري المالكي نفسه قد طلب مهلة شهر واحد. ثم عاد ومنح المالكي مهلة أخرى بعد أن خرج المتظاهرون لمطالبة حكومة نوري المالكي بتقديم استقالتها، وكانت النتيجة احتواء المتظاهرين ووضع حد للمظاهرات عبر استخدام أجهزة النظام القمعية واختيار مقتدى الصدر الانزواء في إيران. وكرر التكتيك نفسه مع متظاهري البصرة وغيرها في سنوات تالية مغادرا العراق في لحظات الأزمات الحادة بذريعة الدراسة حينا وكتابة الشعر في حين آخر. وها هو يعود اليوم، بعد صمت لا يضاهيه غير صمت مرجعية النجف على قتل المتظاهرين وتزايد أعداد المختطفين والمعتقلين، واستنكار المنظمات الحقوقية الدولية، واصرار المتظاهرين على الاستمرار، محاولا أن يمدد بقاء ساسة العملية السياسية الفاسدين، وهو وتحالفه جزء لا يتجزأ منها، عبر تخدير الانتفاضة بشعاراته المعتادة «كلا كلا أمريكا» و «كلا كلا للفساد… نعم نعم للإصلاح».
يعلمنا التاريخ أن عمر مغازلة الأوهام وشعبوية الخطاب السياسي، ونشر سياسة القبول بالأمر الواقع، وتخويف المطالبين بتغييره بالفوضى، خدعة قد تنطلي على الشعوب لفترة إلا أنها لن تطول. وخدعة الاصلاح، بعد مرور 16 عاما من فقدان السيادة الوطنية وبؤس الحياة اليومية، والمشاريع الوهمية، لم تعد تنطلي على أحد مهما حاول الساسة تعليبها بشكل جذاب. وحين يخرج الشباب متظاهرين، مطالبين باستعادة ملكيتهم للوطن، فلأنهم يدركون أن دماء الشهداء لا تغسلها وعود القتلة، وأن التعويضات المادية لا تعيد للأمهات أبناءهم، ومنح الشهداء «منزلة الشهيد» من قبل القتلة هو امتهان لكرامة المنتفضين. وهو مخدر سيوفر للفاسدين المستغلين ديمومة بقائهم. وإبقاء المواطن في غيبوبة، مربوطا بآلة تنفس اصطناعي. إنه الميت الحي وهو المطلوب.
كاتبة من العراق
جينات العائلة العراقية
تنتفض في تشرين
هيفاء زنكنة
باستثناء المشاركة الرمزية في المظاهرات المليونية التي شهدها العالم في شباط/ فبراير 2003، معلنا بصوت واضح الرفض الشعبي، لشن الحرب على العراق، لم يساهم عراقيو الخارج، باستثناء قلة، وفي حالات نادرة، في مظاهرات او اعتصامات تساند وتدعم اي فعل شعبي، ينفذ داخل العراق، مهما كانت شرعيته القانونية والاخلاقية، وخاصة اذا كان يدعو الى اجراء تغيير حقيقي في هيكلية « العملية السياسية» أو اسقاط النظام. أسباب الصمت العلني كثيرة، أهمها ان معظم العراقيين المقيمين في اوروبا وأمريكا وصلوها لأسباب سياسية، وفق درجة القمع في حقب مختلفة، وليست اقتصادية كما في عديد البلدان العربية.
وقد نقل العراقيون معهم في رحيلهم الى بلدان الاقامة الجديدة حقائب ثقيلة من العقد والخلافات بالاضافة الى الولاء الايديولوجي الضيق والمحدود للأحزاب التي ينتمون اليها. ومع صعوبة التأقلم مع المجتمعات الجديدة، خلق كل حزب لأعضائه منظمات مجتمع مدني، جمعيات او منتديات او حسينيات او نواد، مهدت الأرضية منذ انشائها، لمأسسة غيتوات الطائفية سواء كانت علمانية أو دينية، خارج البلد استعدادا للعودة اليه بعد «التحرير».
حصلت معظم هذه المنظمات والمنتديات، منذ تسعينيات القرن الماضي، على التمويل من بلدان الاقامة. فكان من الطبيعي، ان يتعاملوا مع قضايا العراق، غالبا، وفق سياسة البلد وجهة التمويل. وازداد التحكم «الناعم» بهذه المنظمات والمنتديات، بعد اعلان أمريكا سياسة «الحرب على الإرهاب» وفرض السياسة على دول اخرى. فمن يتم تمويله من قبل مؤسسة بريطانية، مثلا، ليس من مصلحته وضع الاحتجاج على سياسة الحكومة البريطانية في العراق، واستفادتها من عقود النفط والسلاح الشركات الأمنية ضمن برنامجه. المنفعة الاقتصادية لصالح بريطانيا أرض محظور مسها. وتوجيه الاتهام الى استخدام التعذيب من قبل القوات البريطانية وهي ذاتها التي تدرب القوات العراقية على «حقوق الانسان»، ارض محظورة هي الأخرى، ومفهومة ضمنيا بدون الحاجة الى وضعها على الورق ضمن البرنامج المعلن لمنظمة المجتمع المدني. فبات معظم نشاط هذه المنظمات/ الجمعيات/ المنتديات يقتصر على تنظيم السفرات والحفلات وعروض الازياء ومناسبات الاعياد وذكرى تأسيس الحزب صاحب الجمعية، واستشهاد الامام الحسين، ومجالس العزاء. ولا تخلو البرامج من محاضرات تمس، بحذر، ما يجري في العراق وبشرط ألا تؤثر، بأي شكل من الاشكال، على «طمأنينة ورضا» عقول الحاضرين. واذا كان هناك ما يثير الغضب والحزن حول ما يدور في بلدهم الام فهو وجود «الإرهابيين» وانقياد «المتخلفين»، من ابناء الشعب، لهم.
الشباب العراقي قرر أن يأخذ زمام الأمور بيده، وألا يعتمد على الساسة والبرلمان والأحزاب، وأن ينزع عن رجال الدين، من أصغرهم إلى أكبرهم، رداء القدسية المذهبية
وكان لظهور تنظيم الدولة الاسلامية «داعش» واعلانه مدينة الموصل، شمال العراق، عاصمة له، الحد الفاصل لدى الكثيرين، لتناسي او التعامي أو غسل جرائم المحتل الانكلو أمريكي، بدءا من الاعتقال والتعذيب الى القتل المنهجي البطيء باليورانيوم المنضب وابادة مدن المقاومة. وفر تنظيم داعش الاداة الأفضل لمسح كل ما تم ارتكابه قبله، لتقتصر المطالبة بتحميل المسؤولية والعقاب عليه. ومع تشغيل الماكنة الاعلامية المحلية والاقليمية والدولية، بات تنظيم «داعش» التيزاب السائل لإذابة او غسل الذاكرة من كل ما حدث قبل حزيران 2014، واعادة تركيبها حسب المطلوب. انعكس ذلك على عراقيي الخارج سواء كانوا في البلاد العربية، المكممة لأفواه مواطنيها، اساسا، أو في اوروبا وأمريكا.
الا أن هذه الصورة، تغيرت تماما منذ الاول من تشرين/ اكتوبر، العام الحالي. اذ شهدت العواصم الاوربية وأمريكا عديد المظاهرات والاعتصامات المساندة لانتفاضة الشباب العراقي، الذي قرر أن يأخذ زمام الامور بيده، وألا يعتمد على الساسة والبرلمان والاحزاب، وان ينزع عن رجال الدين، من أصغرهم الى أكبرهم، رداء القدسية المذهبية. مطالبا بصوت واحد «نريد وطن»، مشخصا، بعيدا عن الولاءات الحزبية التقليدية، وبحكمة، توصل اليها عبر سنوات الصبر على الفاسدين، وانتظار صحوة ضمير المستحوذين على ثروة العراق باسم الدين ووجهه الطائفي البشع، ان من ينحني بخنوع امام «السادة» يستحق الركل.
فمن لندن الى جنيف الى موسكو وبرلين ومن باريس الى أثينا ومدريد وواشنطن ومن كندا الى استراليا وجميع بلدان اللجوء والهجرة، نظم شباب الخارج، المولود معظمهم خارج العراق، ولأول مرة، عديد المظاهرات المساندة لأخوتهم بالعراق. وقفوا أمام السفارات العراقية وفي الساحات العامة ومقرات الحكومات احتجاجا وتنديدا بسياسة النظام الفاسد، مطالبين بالتغيير، وبجرأة تجاوزت مخاوف آبائهم، مؤسسي جمعيات ومنتديات احزاب الخارج، باسقاط النظام. انبثقت المظاهرات، أكثر من كونها نظمت، بشكل عفوي، مشحون بالعواطف، اختلط فيها الغضب بالأسى، من قبل شباب بأعمار تماثل اخوتهم المتظاهرين بالعراق، ولم يحدث ان انخرطوا بأي حزب أو شاركوا باية مظاهرة سابقا.
خرجوا، اليوم بعد الآخر، مؤكدين تضامنهم، بشعارات أعدوها على عجل، وسهروا الليل لطباعة صور شهداء الانتفاضة بأنفسهم، تصرفوا وكأنهم يسابقون الزمن، في صياغة هتافات واعداد منشورات بعدة لغات، ليوصلوا اصواتهم الى مواطني اوروبا وأمريكا، ويتواصلون، في الوقت نفسه، مع اخوتهم المعرضين لخطر الموت قنصا، وهم يحملون راية الحرية لعراق خال من الاحتلال الأمريكي ـ الإيراني. كسروا حاجز الخوف من الاتهامات الجاهزة بالبعثية والداعشية والطائفية والإرهاب.
وهذا، بحد ذاته، انجاز كبير سيبقى رمزا لانتفاضة الشباب وان تمكن النظام الفاسد من دفعها جانبا الى حين. الانجاز الآخر هو نجاحهم في دفع منظمات وجمعيات الاحزاب التقليدية على الخروج من قوقعة مواقفهم الخجولة أو الانتهازية لئلا يفوتهم قطار الحرية.
فشباب الانتفاضة، سواء كانوا داخل أو خارج العراق، هم حاملو جينات العائلة العراقية، المعتادة، المكونة من كل القوميات والاديان والمذاهب في آن واحد. أراد الاستعمار الجديد وحكامه بالنيابة، تفكيكها، بذرائع مختلفة، ليتقاتل افرادها فيما بينهم، بينما يقف جانبا ملتذا بانتصاره، ففشل. وانتفاضة تشرين، سواء استمرت أم تأجلت الى حين، هي افضل دليل.
كاتبة من العراق
انتفاضة الشباب
تعيد للعراق عافيته
هيفاء زنكنة
اذا كان خروج شباب البلاد العربية الى الشوارع احتجاجا وثورة، قد فاجأ العالم في عام 2011، وتكاتفت لإعادة تشكيله وصياغته، وفق المطلوب، الحكومات المحلية المستبدة والقوى الاقليمية والعالمية، فان انتفاضة الشباب العراقي، الحالية، في يومها الثامن، لم تفاجئ احدا، وها هي محاولات اجهاضها جارية، كما سابقاتها، من قبل عدة جهات متداخلة بتوليفة ميليشياوية – سياسية – دينية محلية واقليمية، وحجج معجونة بالفساد المحلي والدولي.
ففي كل مرة يخرج فيها المتظاهرون الى الشوارع احتجاجا، لأسباب تبقى في جوهرها واحدة، على اختلاف المدن والمناطق العراقية، مطالبين بالخدمات الاساسية الضرورية لإدامة الحياة والكرامة، في بلد غني تبلغ ميزانيته السنوية 120 مليار دولار، ويتم فيه استيراد المهندسين والعمال أما من الخارج أو تعيين غير المؤهلين نتيجة الفساد، تقوم قوات الحكومة «الديمقراطية» وميليشيات الاحزاب المدعومة إيرانيا، بإطلاق النار على المتظاهرين، بينما يقف سادة «الديمقراطية» من الحكومة البريطانية الى الادارة الامريكية، جانبا، وهم يحصدون غنيمة الحرب والخراب الذي زرعوه عقودا وأسلحة.
قائمة المظاهرات السابقة طويلة وتمتد من شمال العراق الى جنوبه منذ غزوه واحتلاله عام 2003. وفي كل مرة يسقط فيها الشهداء، تتستر الحكومة وقادة الاحزاب المستفيدة باتهامات جاهزة. احتجاجات واعتصامات أعوام 2011 ـ 2013، في الفلوجة والحويجة والرمادي والموصل، تم وصفها بالإرهاب وانها بتنفيذ « القاعدة». متظاهرو البصرة في العام الماضي، وصفهم حزب الدعوة الإسلامي الشيعي، بأنهم «مجرمون، آثمون، داعشيون، بعثيون… ويجب ان يعاقبوا». واتهم رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي المتظاهرين، في أيلول/سبتمبر 2015، بالعمالة لـ «قوى خارجية» تريد «استهداف الدولة»، كما ساهمت قنوات إعلامية، يمولها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، بنشر خبرا مفاده ان مخطط التظاهرات «يهودي صهيوني ماسوني» من أصل عراقي. أما متظاهرو النجف، المدينة المعروفة بأنها مركز المرجعية الدينية الشيعية، المطالبين بالكهرباء والماء الصالح للشرب، عام 2018، فقد تم اطلاق النار عليهم، فاستشهد اثنان وجرح 15 آخرين، تلاها قتيلان و40 جريحا في مدينة كربلاء. برر المسؤولون جريمتهم بأن الضحايا كانوا «إرهابيين، مخربين».
على مدى السنوات، أثبتت حكومات «العملية السياسية»، انها لا تكتفي بإهمال مطالب المتظاهرين واطلاق النار عليهم أو رمي مدنهم بالبراميل الحارقة، بل تواصل تكميم اصواتهم عبر اعتقال وإغتيال الناشطين والعقاب الجماعي. ولجأت، في العام الماضي، الى قطع الانترنت، عدة ايام، منعا للتواصل الاجتماعي وايصال اخبار الانتهاكات والجرائم الى العالم الخارجي. هذه الآلية، بمستوياتها المتعددة، يتم تطبيقها، كلها، على المتظاهرين، حاليا، بعد تطعيمها بتقنية ارهابية جديدة لم تستخدم سابقا، وهي استخدام القناصين لاغتيال المتظاهرين بالإضافة الى رجال الشرطة والجيش، اذا ما حدث، ورفض أحدهم اطلاق النار على المتظاهرين، خاصة وهم يرون بأم اعينهم عدم حمل المتظاهرين لأي سلاح كان، واكتفائهم بالهتافات واعلان الغضب سلاحا.
ان العراق الذي أريد لشعبه الخنوع، ولثروته النهب، ولأرضه التقسيم، بذريعة الطائفية والعرقية، حي يرزق، بشبابه، ورثة تاريخه العريق وحضارته الممتدة عميقا في جذور الانسانية
ان استهداف المتظاهرين بالرصاص الحي ونشر القناصين ليس انتهاكا لحق الحياة الحياة فحسب بل جريمة ضد الإنسانية تتحمل السلطات مسؤوليتها.
ومن يتابع هتافات المتظاهرين سيجدها، كما كانت منذ تظاهرات بدء الاحتلال، تقريبا، باستثناء شعار «ارحلوا»، برمزيته الخاصة التي تبدت بتونس ومصر. فمن «باسم الدين باكونا (سرقونا) الحرامية» و«ما نريد واحد ملتحي، نريد واحد مستحي» للدلالة على زيف ادعياء الدين، و«طلعت ريحتكم» و« كل النواب حرامية»، للدلالة على استشراء الفساد بين الحكومة والنواب معا، الى «ايران برة برة بغداد تبقى حرة»، للدلالة على تبعية الحكومة للمليشيات المدعومة ايرانيا، وعدم الرضا العام عن سياسة التبعية والخنوع لأية قوة خارجية.
واذا كانت كثرة ترداد الشعار الاخير، في التظاهرات الحالية، هو الذي أوحى للساسة بأن يركزوا حملة تشويههم للمتظاهرين، وبالتالي تبرير قتلهم، على اتهامهم بانهم عملاء لامريكا والسعودية، فانهم يتعامون عن حقيقة هي ان ليس كل من ينتقد احتلال ايران للعراق هو مؤيد لأمريكا والسعودية، بالضرورة، وليس كل من ينتقد أمريكا هو مؤيد لإيران، وليس كل مناهض للكيان الصهيوني معاديا للسامية. لم تعد هذه الوصفات الجاهزة للتشويه سارية المفعول. فالشاب العراقي الذي يجد نفسه عاطلا عن العمل او يفتقد سبل العيش الكريم، وقد بلغت نسبة البطالة 40 بالمئة، بينما يتمتع ساسته، مهما كانت طائفتهم او عرقهم، بسرقة أو تمكين سرقة مليارات الدولارات، أمام ناظريه، وتحويل البلد الى ساحة صراع بين أمريكا وايران، لا يحتاج ان يكون عميلا لأحد ليفهم ويدرك وينتفض. أنه تجسيد لشعاره: «نازل آخذ حقي».
بالإضافة الى الاتهامات، حاول الساسة ورجال الدين، ولايزالون، تخدير المتظاهرين بالوعود الزائفة في سيناريوهات جاهزة الى حد اثارة التقزز. من بين رجال الدين، يحتل مقتدى الصدر المركز الاول في حرباوية المواقف والتي انضم اليها الحزب الشيوعي في تحالف غير مقدس، للفوز بالانتخابات الاخيرة التي ساهم فيها 18 بالمئة من السكان فقط، للدلالة على فقدان الثقة بكل سلة الاحزاب. واحتل رئيس البرلمان الحلبوسي، بجدارة، قمة الابتذال السياسي، قبل يومين، حين وجه دعوة للمتظاهرين لزيارته واخباره بمطالبهم، متظاهرا، في كوميديا من الدرجة العاشرة، بانه لا يعرفها، وكأن المظاهرات الحالية هي الاولى من نوعها في البلد، وكأن شهداء الاحتجاجات منذ 16 عاما، كانوا يتسلون بالموت.
ان العراق الذي أريد لشعبه الخنوع، ولثروته النهب، ولأرضه التقسيم، بذريعة الطائفية والعرقية، حي يرزق، بشبابه، ورثة تاريخه العريق وحضارته الممتدة عميقا في جذور الانسانية، ولم يتم لصقه بالغراء «الانكليزي»، خلافا لادعاءات الغزاة والمحتلين. الثمن غال، وصلت فاتورة الحرية خلال الاسبوع الاخير ما لا يقلّ عن 100 شهيد برصاص القوات الحكومية وميليشياتها، وجرح اكثر من 6000 واعتقال بحدود 650 شخصاً.
مع ذلك، ينهض العراق، في كل مرة من رماد القمع والارهاب، لينتفض، ويدفع في كل مرة دماء ابنائه قربانا من اجل عراق حر موحد، ليتخلص من نظام فاسد مبني على طائفية أسسها المحتل الانكلو أمريكي. الطائفية التي أرادوا بواسطتها تقسيم الاهل والارض، وها هم المتظاهرون يغسلونها بدمائهم من على وجه العراق المحتفي دوما بكل اهله.
كاتبة من العراق
مقارنة «شرعنة العنف»
بين بريطانيا والعراق
هيفاء زنكنة
«شرعنة العنف»، كان هو التعليق الأهم الذي أستخدم لوصف تبادل الاتهامات، بلغة لا تليق، بين نواب مجلس العموم البريطاني، في الأسبوع الماضي. كان الاجتماع الذي تراشق فيه النواب، والوزراء وعلى رأسهم رئيس الوزراء، مفردات، لم تستخدم، سابقا، هو الاول للمجلس بعد ان قضت المحكمة العليا، في بريطانيا، بعدم قانونية قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون، بتعليق عمل البرلمان لمدة خمسة أسابيع. من بين المفردات التي تم التلفظ بها، وأعتبرت سابقة في تاريخ المجلس، « خيانة» و«متعاونين» و«الاستسلام» و«هراء»، عبر فيها رئيس الوزراء عن موقفه ازاء اعضاء البرلمان الآخرين، وخاصة ضد أعضاء تحدثوا عن مخاوفهم من تهديدات تلقوها بأشكال متعددة. دفع احتدام النقاش واسلوب الشجار حول «البريكست»، جون بيركو رئيس مجلس العموم الى القول في اليوم التالي أنّ الجدال حول البريكست قد هبط إلى مستوى متدنٍ لم يشهد له مثيلا طوال وجوده في البرلمان.
شهدت بريطانيا، في الثلاث سنوات الأخيرة، استقطابا سياسيا، وصل الى مرحلة العنف حتى بين افراد العائلة الواحدة، وهو حدث نادر في تاريخها المعاصر. يدفعنا هذا التصاعد الحاد في مشاعر البريطانيين تجاه قضية واحدة لا غير هي البريكست، والانقسام الشعبي ووصوله مرحلة التهديد والعنف الجسدي، خلال فترة زمنية قصيرة هي ثلاث سنوات فقط، الى النظر في الوضع العراقي، خاصة من نواحي التحريض على الانقسام وإثارة الكراهية، في الخطاب السياسي للنخبة، المفترض فيها تمثيل الشعب، ومدى نجاح التحريض في إشعال حرائق الفتنة وتجييرها لصالح هذا الحزب او ذاك.
علينا الاقرار بأن التحريض الدعائي / الطائفي/ العرقي المؤسس لتركيبة الأحزاب الحالية، يشهد نجاحا في تجييش العواطف الفجة المرتبطة بالطائفة والدين والعرق، من خلال شعبوية الخطاب، وتحويله الى تجارة يتم التعامل فيها مع المواطن باعتباره مستهلكا لبضاعة الحماية من كراهية «الآخر». وفق هذا المنظور، يوفر الحزب السياسي المهيمن على ثروة البلد، الحماية والعمل وسبل العيش للمواطن الذي ينتمي الى طائفته او دينه او قوميته، تأسيسا لقاعدته الشعبية وضمانا لرضوخ المواطن لإرادة قيادة الحزب. أحد العوامل الرئيسية في تسهيل نجاح الهيمنة الحزبية، خاصة اذا ماتوفر لها «التعاون» الخارجي، كون العراق بلدا ريعيا يعتمد في ميزانيته على النفط. فمن الذي يجرؤ على انتقاد حزب ساعد على منحه راتبا لقاء وظيفة وهمية، أو تعيينه وأقاربه في وظائف على حساب غيره، أو منحه منصبا يعرف جيدا انه لايستحقه من ناحية الكفاءة، ناهيك عن الأخلاق؟
التحريض الدعائي / الطائفي/ العرقي المؤسس لتركيبة الأحزاب الحالية، يشهد نجاحا في تجييش العواطف الفجة المرتبطة بالطائفة والدين والعرق، من خلال شعبوية الخطاب، وتحويله الى تجارة يتم التعامل فيها مع المواطن باعتباره مستهلكا لبضاعة الحماية من كراهية «الآخر»
أثبتت سياسة حكومات الاحتلال المتعاقبة منذ 16 عاما، ان خلق ونشر الكراهية ضرورة، لا يمكن الاستغناء عنها، بالنسبة الى السياسي حين يدرك عدم قدرته على تمثيل عموم الجماهير، وشكلت الرطانة السياسية – الطائفية جزءا لا يتجزأ من سيرورة التطويع والترويع والابتزاز لإنجاح الاستقطاب المفتت للبنية الاجتماعية، كطريقة للفوز على خصومه، وهي بالتأكيد الطريقة الامثل لخلق أجواء عنف تتيح له الوقوف، ضاربا بقبضة يده على صدره، دلالة تحقيق النصر. ويمثل نوري المالكي، الامين العام لحزب الدعوة الشيعي، حاليا، ورئيس الوزراء لدورتين سابقتين، نموذجا يستحق ان يوضع بجانب اهم مجرمي الحرب في العالم، لما زرعه من إرهاب نتيجة لغة التحريض التي مارسها، معتمدا على الشعارات التي أطلقها وحزبه لشحن وتأجيج العواطف. وكلها مصاغة لتعكس احساسه العميق بنقاء طائفته وسردية استحقاقها التاريخي للحكم. حيث ساهم أما شخصيا او من خلال أتباعه، بالنيابة، بطرح مقولات لاستفزاز بقية الشعب، ودفعهم الى الاحساس بهامشيتهم وما يصاحب ذلك، عادة، من الرغبة بالانتقام. كان استخدامه للرطانة الشعبية أداة جعلته يحتل المنصب الاعلى في الدفاع عن طائفته، وبطلا يطمأن مادحيه بانهم باقون في الحكم الى الأبد، وتبا للديمقراطية، ولا خوف عليهم ما دام هو موجودا، مكررا «هو يكدر واحد ياخذها حتى ننطيها»، أي هل هناك من يجرؤ على أخذ الحكم منا لكي نتخلى عنه، مؤكدا بأنه «شيعي» قبل أن يكون عراقيا، وداعيا الى تنفيذ احكام الاعدام، مباشرة، في الساحات، حال القاء القبض على «الإرهابيين». ومهددا باندلاع حرب أهلية في حال يتم «التلاعب بنتائج الانتخابات»، أي عدم فوز حزبه.
ولكن، أين الشعب العراقي في هذه الفوضى التي تنخر البلد نخرا؟ ليس بالامكان القبول بالجواب المغري، المتداول، حاليا، حتى بين المثقفين والسياسيين اليساريين، وهو لوم «الشعب المتخلف». وهو لوم يخفي، في أعماقه، الاحساس بالاحباط والغضب وفي نفس الوقت، تمنح اللائم أو موجه الاتهام، فرصة الوقوف على منصة أخلاقية أعلى من بقية الشعب، وتمكينه من الاستحواذ على صك عدم المسؤولية. لقد مرت أجيال من الشعب العراقي، بحروب لا يعفى من مسؤوليتها أحد، سواء من القوى العالمية اللاهثة خلف الثروات أو حماقات الحكام واستعدادهم لارتكاب الجرائم بشعارات وطنية او قومية. حفرت الحروب وما تلاها من حصار اختزل المواطن الى مستجد للطعام والدواء، جروحا لم تتح لها فرصة الاندمال بل الحفر أعمق مع الغزو وما جلبه من ساسة، يمكن تلخيص كل برامجهم السياسية بكلمة واحدة هي «الانتقام». لم يقتصر استخدام الرطانة السياسية – الطائفية – العرقية على نوري المالكي، ولم تنته بانتهاء فترة حكمه، اذ يكتظ البرلمان، اليوم، بهذا المالكي أو ذاك، حسب ما تجسده هيكيلية «المحاصصة الديمقراطية». فاذا كانت قضية البريكست قد قسمت البرلمان والشعب البريطاني الى مع وضد، خلال ثلاث سنوات، فان نواب البرلمان العراقي المقسم، وفق المحاصصة التي مأسسها المحتل الأمريكي مع نظيره البريطاني، يبنون حضورهم وتأهلهم لـ «تمثيل الشعب» على ادعاءات أحقية تاريخية سحيقة، واحاسيس تختلط فيها المشاعر القومية والدينية، وهي مشاعر لا خلاف حولها، لولا ارتباطها بالمصالح الفردية الفاسدة والمظلومية المزمنة، على حساب الوطن الجامع لكل مواطنيه، والتلاحم المجتمعي الصميم المبني على التزاوج والتاريخ المشترك. ان حالة «شرعنة العنف» التي تتم مناقشتها في بريطانيا كنتيجة لخلاف سياسي عمره ثلاث سنوات، وسط المطالبة باستقالة الحكومة المسؤولة بل وحتى معاقبة رئيس الوزراء، يعيشها العراق بمعنى أوسع وأشمل هو «شرعنة الإرهاب»، ولن تنتهي ما لم يتم التحرر من قبضة الطبقة المسؤولة سواء في الحكومة أو البرلمان.
كاتبة من العراق
ماذا لا تساعد الحكومةالبريطانية المسيحيين العراقيين؟
هيفاء زنكنة
في مقابلة مع «راديو 4 ـ البي بي سي»، بلندن، صباح يوم الاحد الماضي، تحدث القس العراقي جرجيس، ضمن الفترة المكرسة للبرنامج الديني، عن مأساة المسيحيين في العراق، تعرضهم لشتى الضغوط، ومعاملتهم كأقلية من المستحسن التخلص منها، بأي طريقة كانت، بضمنها التهجير القسري والاغتيال. وكان حديثه مؤثرا حين أكد اختياره البقاء في العراق، لمساعدة الناس، على الرغم من كل التهديدات التي يتلقاها، متسائلا بأسى يعصر القلب بما معناه: أليس العراق وطن المسيحيين منذ العصور السحيقة؟
تحدث القس، ساردا قصته الشخصية، متجنبا الأرقام والاحصائيات، على أهميتها، لأنه من الصعب فهم معنى الأرقام والاحصائيات حين تتعلق بجوانب الحياة اليومية. وتزداد الصعوبة، حتى تكاد تكون مستحيلة، عندما ترتبط بالحياة الانسانية نفسها، وترتفع الأرقام لتتجاوز الآلاف، ما لم يتم ربطها بقصة، يمكن للمرء التماهي معها، بدرجة من الدرجات، لتقترب الأرقام من الأذهان. ولكن، كيف يمكن التقريب بين أعداد ضحايا الحروب وقصصهم، لاستيعاب محنتهم، وقد تجاوزت أعدادهم الملايين، وهي في نمو يزداد تسارعا بمرور الايام، لتشمل، بدرجة أو أخرى، في حصيلة الأمر، كل الناس على اختلاف قومياتهم وأديانهم؟ وكيف يمكن تلافي استخدام القصص الانسانية لاستغلال تعاطف الناس وتجييشهم لصالح أجندة سياسية محددة أو مشروع كولونيالي؟
يمنحنا تاريخ الكولونيالية وحاضرها الاستعماري الجديد، عديد الامثلة على استغلال ظلم الأقليات لتفتيت القضايا وجعل حتى أكثر القضايا إنسانية «غيتو» لما يطلق عليه «تنافس الضحايا»، للفوز بالحماية من ذات الجهة او القوة المسببة للمأساة أو من ترتكب ذات الجرائم ضد آخرين. فمن من الناس لم يتعاطف مع الشابة اليزيدية نادية مراد، التي مرت، بابشع الظروف على يد مقاتلي «الدولة الإسلامية»، وكيف باتت رمزا وصوتا للضحايا من أهلها وأتباع دينها؟ وكان من المفترض ان تكون صوتا للضحايا في جميع انحاء العالم، بعد تعيينها سفيرة للنوايا الحسنة من قبل الأمم المتحدة، وفوزها بجائزة نوبل، الا انها قبلت بتسخير مأساتها لصالح الكيان الصهيوني (تعمدا أم سذاجة؟) حالما دعيت لزيارته، بدعوة من نائبة صهيونية، لتتحدث في الكنيست عن مأساة «شعبها» والعمل مع « «الإسرائيليين» على انهاء الظلم ضده، متجاهلة بذلك الظلم المستمر الذي توقعه حكومات الكيان الصهيوني، الاستيطاني، العنصري، المتعاقبة ضد الشعب الفلسطيني، بمن فيه النساء الفلسطينيات. هكذا تتم تجزئة معنى «الظلم» ومفاهيم تحقيق العدالة وانهاء الاحتلال، وفق انتقائية منهجية تماثل حماية الغيتو العرقي أو الديني.
إذا كان النظام العراقي قد بذل أقصى جهده، منذ الاحتلال الذي لعبت فيه بريطانيا دورا رئيسيا، عام 2003، لمأسسة مجتمع تسود فيه طائفة واحدة، وأعداد المهجرين قسرا الكبيرة، فانها اختارت التعامي عن مسؤوليتها في الانتهاكات
يأخذنا نموذج نادية مراد، وهي ليست الوحيدة من نوعها، الى البناء الإعلامي حول القصة الشخصية، لجذب الانتباه الى قضية انسانية، واضاءة أحداث قلما يتم الانتباه اليها، اعلاميا، على الاقل، في خضم تسارع الاحداث اليومية المتأججة، فعلا، خاصة في بلداننا، أو المسيرة وفق أجندات سياسية واقتصادية، في جميع انحاء العالم. يقابل الجانب الإنساني الايجابي، فيها جانبا آخر يمنحها امكانية الاستخدام للتضخيم والمبالغة، وتعمل على الغاء قصص الآخرين، او التغطية على جوانب قد تكون اكثر اهمية من غيرها.
خلافا للكثيرين ممن يتم استدراجهم، إعلاميا، للتفوه وفق اجندات جاهزة، تحدث القس جرجيس، بعاطفة عن العراق وعن اسباب اختياره مواصلة العيش فيه، لافتا، في الوقت نفسه، الانظار الى مأساة تفريغ البلد من أهله. وهي نقطة مهمة جدا للدلالة على سياسة نظام يدعي الديمقراطية وتمثيل المواطنين، بينما يقمع معظم المواطنين، وتتنافى سياسته وفساده وممارساته الطائفية، مع أبسط مظاهر الديمقراطية وحقوق الانسان، بضمنها حرية المعتقد الديني. وهي النقطة الجوهرية التي تجاهلها البرنامج الديني الذي فضل إعلاميوه التمشي على سطح مأساة المسيحيين بالعراق بدون التعمق في الاسباب التي أدت الى التحول المذهل تجاههم، في بلد هم جزء لايتجزأ من تركيبته التاريخية. بالاضافة الى ذلك، تم، بعد مقابلة القس العراقي، تقديم موجز لتقرير أعده أسقف كنيسة تورورو فيليب ماونستيفن، بناء على تكليف وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، بعد أن سادت حالة من الغضب حيال المعاملة السيئة والتهديدات بالقتل التي تلقتها الباكستانية آسيا بيبي بعد اتهامها بالتجديف في باكستان. يكشف التقرير، الذي تشكك جهات علمية بصحة طريقة التوصل الى نتائجه وإحصائياته، الى ان 80 بالمئة من المسيحيين يتعرضون للاضطهاد، وان «المسيحيين هم أكثر الجماعات تعرضا للاضطهاد الديني»، وأضاف جيريمي هانت، قائلا: «في بعض المناطق، يقترب مستوى وطبيعة الاضطهاد من التعريف الدولي للإبادة الجماعية». مبينا ان سبب الامتناع عن مواجهة هذه المشكلة هو «وجود قلق في غير موضعه حيال أن يكون الخطاب في هذه القضية صادرا من استعماريين عن دين يرتبط بقوى استعمارية أكثر من ارتباطه بالدول التي دخلناها كمستعمرين».
وهو محق طبعا فيما يخص ارتباط الدين، اي دين كان بالقوى الاستعمارية وسياسة الدول القمعية، فضلا عن الاستغلال الاقتصادي، حيث تشكل الحملة العسكرية التي شنها جيش ميانمار وأدت إلى مقتل الآلاف وتهجير أكثر من 700 ألف شخص من الروهينجا، الأقلية المسلمة، في ظل نظام «ديمقراطي»، أحد الامثلة الحية. كما هو العراق الذي اختاره وزير الخارجية للاستشهاد باحصائياته قائلا» تراجع عدد المسيحيين، في العراق، إلى 120 ألف مسيحي مقابل 1.5 مليون مسيحي قبل 2003». وكان المطران بشار متى وردة، رئيس أساقفة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، في زيارة له الى لندن، في 25 أيار/مايو، قد أكد «انه منذ الغزو الأمريكي للعراق الذي أطاح بنظام صدام حسين في عام 2003، تضاءل عدد المسيحيين بنسبة 83 في المئة»، مطالبا الحكومة البريطانية، في لقاء له مع وزير الخارجية، أن توفر مساعدة عاجلة للأقلية المسيحية.
ما هو نوع المساعدة التي قدمتها الحكومة البريطانية، حتى الآن، للمسيحيين العراقيين وغيرهم ممن يعانون من الاضطهاد والتمييز ومصادرة الحقوق بانواعها، باستثناء منح اللجوء لقلة منهم؟ والسبب؟ اذا كان النظام العراقي قد بذل أقصى جهده، منذ الاحتلال الذي لعبت فيه بريطانيا دورا رئيسيا، عام 2003، لمأسسة مجتمع تسود فيه طائفة واحدة، حسب كل التقارير الحقوقية المحلية والدولية، واعداد المهجرين قسرا الكبيرة، فانها اختارت التعامي عن مسؤوليتها في الانتهاكات والجرائم المرتكبة تحت الاحتلال بل واستمرت في بيع السلاح وتقديم الدعم المعنوي، والاكثر من ذلك الصمت على ممارسات النظام، في اجواء هيأت الارضية للإرهاب، وعدم اتخاذ اية خطوة رادعة بحق المسؤولين وعدد منهم من حاملي الجوازات البريطانية. وهذا ما لم يتطرق اليه مقدمو البرنامج البريطاني أو وزير الخارجية، عند الحديث عن مأساة المسيحيين، متجاهلين مأساة الشعب الذي يعيش آثار جريمة الاحتلال، بشكل يومي من إرهاب واغتيال واحكام اعدام وهدم للبنية المجتمعية، لبلد هو ملك لكل اهله وليس لطائفة أو دين أو عرق «مختار».
كاتبة من العراق
دموع أيام عاشوراء
و«هيهات منا الذلة»
هيفاء زنكنة
حفل الاسبوع العراقي السابق، على هامش أيام عاشوراء واحياء ذكرى استشهاد الحسين، بلقطات تجمع، مثل كل تظاهرة حاشدة، بالعواطف المتأرجحة ما بين النبل والاستغلال. هناك اولا لقطات الحشود، على اختلاف الجنس، المرتدية للزي الأسود من اعلى الرأس الى اخمص القدمين، السائرة مسافات طويلة متوجهة الى مدينة كربلاء، للمشاركة الجماعية بالطقوس المألوفة، وترداد «قراءات» ترشها المايكروفونات الضخمة، على المشاركين، بأصوات رجال يتنافسون فيما بينهم، على استعراض قدرتهم، على اعادة صياغة الحدث التاريخي، استدرارا لدموع المعزين. ويتجاوب معهم المعزون بكاء، فالدموع تخفيف عن الذنوب وكل دمعة تقربهم أكثر من نيل الثواب. ثواب المغفرة. ويتنافس «الرادود»، أي السارد، الفلاني مع العلاني على إيصال الجمهور الى ذروة الحزن المتبدي لا بالبكاء، فقط، بل حثه على المشاركة الجسدية، الفعلية، بأساليب مختلفة تراوح بين اللطم على الصدور وكفخ الرأس، في الايام الاولى، حرصا على طاقة جمهور المعزين، ثم التدرج الى ضرب الكتفين والظهر بالسلاسل وتطبير الرأس، حتى اسالة الدم، بعد ارتداء الكفن الابيض، في اليوم الاخير. يشكل الدم السائل بلونه القاني على الكفن الابيض، التماهي الاكبر مع مفهوم الشهادة كما تتجسد بتضحية الحسين بنفسه وأهله من اجل المبادئ. المفهوم الذي بات، عبر التكرار السنوي وتغذيته بالأساطير والطقوس، الاقتراب الأكبر من قدسية الحسين الشهيد واهل بيته ممن استشهدوا معه.
لا يقتصر اداء هذه الطقوس على العراق، فقط، بل يمتد الى دول اخرى، يوجد فيها اتباع المذهب الشيعي، بالدرجة الاولى، وان يصر اتباع المذهب السني على رمزية الحسين للجميع. يتسع الامتداد من إيران الى تركيا وباكستان وغيرها، مع اختلاف درجة الحاق الاذى الجسدي للمعزين بأنفسهم على وقع أصوات «الردادة» وانتشار البدع، وهي كثيرة، كنوع من المنافسة، في ابداء درجة التفاني بطاعة الأولياء، وتشكل رؤية احد المعزين للحسين في نومه، وأمره اياه باطلاق الرصاص على نفسه ثلاث مرات مع التأكيد له بانه سيبقى حيا، اللقطة الثانية التي خلفتها ايام عاشوراء لهذا العام، وهي النموذج الافضل للايمان الطقسي الغيبي وكيفية المساهمة في تصنيع المقدس، عبر العصور. انتشر فيديو الرجل الموعود بالحياة بعد اطلاق الرصاص على نفسه على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ أيام، حيث شوهد وهو محاط بحشود تشجعه تكبيرا، الى ان اطلق النار على نفسه، فعلا، ومات.
يزداد العبء أطنانا على المثقف والمفكر المتدين، الباحث عن الحقيقة حول الحدث التاريخي ومعانيه، وسط ركام الطقوس والتشويه والاستغلال السياسي وصمت الفاسدين، خاصة، في بلد يتعثر تحت اقدام المحتلين
لا يكاد بلد في العالم يخلو من اقامة الطقوس الدينية، تأكيدا، ربما، لحاجة الانسان الى ممارسة الطقوس الجماعية، أيا كانت، سواء كانت ارتداء الملابس زاهية الالوان للتوجه الى الكنيسة صباح كل يوم أحد، او الى الجامع للصلاة الجماعية يوم الجمعة، او اصرار اليهود على عدم مغادرة البيت، واطفاء الكهرباء، والامتناع عن الطبخ او القيام باي عمل كان، كل يوم سبت، بالاضافة الى حلق شعر المرأة وارتداء الباروكة. هذه نماذج بسيطة للدلالة على ان العراق ليس شاذا أو متميزا، بشكل عام، بطقوسه وممارساته المذهبية أو الدينية. فلكل شعب، مهما كان عدد مواطنيه صغيرا، تنوعه الثقافي المتبدي بالشعائر والطقوس التاريخية أو حتى ما قبل التاريخية، بل وليس من المستبعد اعتبار الانتماء السياسي، في حقبة زمنية معينة، «دينا»، حسب قوة الاعتقاد به والاستعداد للتضحية بالحياة من أجله. ولاتزال صورة الحشود في الشوارع، بعد ثورة الرابع عشر من تموز، عام 1958، حية باذهان ابناء جيلنا، حين كان مصطلح المظاهرات المليونية يطلق على جماهير العراق الشيوعي، ايامها، ثم استخدم المصطلح لوصف المظاهرات المليونية ايام كان العراق «بعثيا»، وها هي الحشود المليونية تسير وتركض وتموت دوسا تحت الاقدام، في العراق «الشيعي».
الا ان الاختلاف نابع من تميز هذه الحقب كلها، ونحن لا نتحدث عن الماضي السحيق، بل عن العراق المعاصر الذي نعرفه حق المعرفة، بممارسة القمع. فما ان يستولي حامل قومية أو معتقد سياسي على السلطة، حتى تصبح اهم منجزاته قمع «الآخر»، والعمل، على اجتثاثه، بأبشع الطرق. وبدلا من توفير المجال لممارسة الحق الاساسي في حرية التعبير عن الرأي، للجميع، بلا استثناء، يصبح هذا الحق، بقوة السلطة القمعية، انتقائيا للصفوة الحاكمة وعوائلها ومريديها. وما يجعل انتقائية، عراق اليوم، منذ الاحتلال، الأكثر خطورة، هو توليفة مزج العقيدة المذهبية بالتمييز الطائفي وتغييب الآخر والفساد السياسي. واذا كان عدد من المفكرين والمثقفين المتدينين قد سخروا حياتهم لتنقية المذهب مما اصابه عبر العصور من تراكمات طقوسية وتنقيته من عوامل الفتنة، وتحويل الماضي الى حاضر، والوهم الى حقيقة، وهو ما يلجأ اليه الضعفاء في فترات الظلم انتظارا لتحقيق العدالة، فانهم يواجهون وبعد مرور 16 عاما على وصول «المظلومين» الى السلطة، مأزقا فكريا حقيقا يضعهم بمواجهة تحول الضحية الى جلاد، وتعريض حياتهم، انفسهم، للخطر بعد التخوين والتكفير العلني، وسط اجواء ترويع لا تقل إرهابا عن المكارثية الأمريكية ضد المتهمين بالشيوعية اثناء الحرب الباردة، مع اختلاف جوهري يجمع ما بين الدراما والكوميديا في آن واحد. فبينما يعاني كل من يدعو الى التعقل وتحكيم العقل في ممارسات واستغلال أيام عاشوراء، طقوسيا وسياسيا وتحويلها الى دجاجة تبيض الذهب، من التكفير، نرى سباقا من نوع آخر، يضم ادباء وشعراء وفنانين يتزاحمون على كتابة القصائد والنصوص ورسم اللوحات «اقترابا من شعاع عاشوراء» و«للتعبير عن الحزن للمأساة التي تعرض لها الإمام الحسين (ع) وأصحابه والولاء والاستفادة من معانيها الخلاقة في الحياة ومواجهة الطغاة من السلاطين والحكام على مدى التاريخ». ولم يخل حشد الادباء المبايعين من أديب شيوعي متقدم في مركزه الحزبي، مناديا بحرقة قلب «نحن أيتامك يا حسين». يحدث هذا والحزب متحالف سياسيا، مع تيار الصدر، الذي ارتكب من الجرائم، أعدادا لا تحصى، متمتعا بالحصانة الدينية. ليزداد العبء أطنانا على المثقف والمفكر المتدين، الباحث عن الحقيقة حول الحدث التاريخي ومعانيه، وسط ركام الطقوس والتشويه والاستغلال السياسي وصمت الفاسدين، خاصة، في بلد يتعثر تحت اقدام المحتلين، بينما يلطم قادته وينشجون بالبكاء هاتفين «هيهات منا الذلة».
كاتبة من العراق
تاجر سلاح أمريكي
يساوي مليون عراقي
هيفاء زنكنة
بينما يتبادل النواب العراقيون اتهامات الفساد بأصوات عالية، إما داخل البرلمان او خارجه، في استديوهات الفضائيات العراقية والعربية، بدون ان يخشى أحدهم المساءلة، وبأساليب وصلت، أخيرا، حد اتهام أحد النواب، بتغريدات وألفاظ نابية، زميلة له بممارسة الدعارة، نجدهم، في غمرة انشغالاتهم اليومية هذه، يتلقون بصمت أسطوري، أخبارا لها انعكاسات خطيرة على سيادة وتنمية العراق، ومن المفترض ان تكون من صلب وظيفتهم، التي يتلقون رواتبهم للقيام بها.
فمن جهة، تواصل تركيا قصف مناطق حدودية بحجة مطاردة مقاتلي حزب العمال الكردستاني (البي كي كي)، ومن جهة أخرى تواصل إيران استخدام العراق كممر وسوق لبيع المخدرات وكسر الحصار الأمريكي المفروض عليها، بشتى الطرق، التي تراوح بين التدخل السياسي، ودعم المليشيات، والتفجيرات، والاغتيالات الإرهابية، في ذات الوقت الذي تتنعم فيه أمريكا والشركات الاحتكارية بالنفط بأرخص الاسعار، وسمسرة عقود السلاح، و ما يسمى بمشاريع اعادة الاعمار، بلا اعمار، منذ 16 عاما.
يأخذنا مصطلح «اعادة الاعمار» الى خبر تجاهله الساسة ومعظم أجهزة الاعلام العراقية، أخيرا، وتابعه الزميل العالم عماد خدوري، على موقعه الالكتروني. يشير الخبر الى خسارة العراق دعوى قضائية، بقيمة 140 مليون دولار، أقيمت ضده في الولايات المتحدة الأمريكية، قبل عشر سنوات. أقامت الدعوى شركة تدعى «واي اوك» للتكنولوجيا وأرملة ديل ستوفيل، وهو تاجر سلاح و«رجل أعمال» يملك مع شقيق له الشركة المذكورة، وكانت له علاقة وثيقة بأحمد الجلبي، أهم الأدوات العراقية للاحتلال الأمريكي. حصل ستوفيل على عقد، بقيمة 25 مليون دولار، من الحكومة العراقية لاعادة تأهيل عدد من الدبابات الروسية القديمة، كما كانت له علاقاته المتشابكة مع الادارة الأمريكية، ضمن مشروع اعادة اعمار العراق، الذي بلغت قيمته 125 مليار دولار، وتخلله الفساد الذي شمل كبار ضباط الجيش الأمريكي بالاضافة الى مسؤولين عراقيين. في احدى جولاته، داخل العراق، محاولا التشبه برامبو، وهو يحمل على كتفه رشاشة لا تفارقه، ويدخن سيجارا يضفي على شخصيته جانب التأمل فيما حوله، تم اغتياله، عام 2004، ولم يتم القاء القبض على قاتليه، وان اصدرت جهة أدعت انها من المجاهدين بيانا حول تنفيذها العملية. حينئذ، أصبح حاله حال آلاف العراقيين الذين تم اغتيالهم منذ الغزو الانكلو أمريكي للبلد عام 2003، من قبل «مجهولين»، وتقدر اعداد الضحايا بما يزيد على المليون شخص.
كان من أولى خطوات مجلس الحكم الانتقالي، إثر الاحتلال، تصريح عبد العزيز الحكيم، رئيس المجلس حينئذ، عام 2003، بأنه يجب على العراق دفع تعويضات الحرب لإيران البالغة قيمتها 100 مليار دولار عن خسائرها وضحايا الحرب العراقية الإيرانية
قبل إطلاق النار عليه، بعد خروجه من معسكر التاجي، شمال بغداد، وهو أحد أربع معسكرات منح رئيس الوزراء السابق نوري المالكي عقود خدماتها الكلية، عبر شركة يديرها وزوج ابنته باسم «آفاق»، الى شركة يديرها جنرال أمريكي متقاعد يدعى فرانك هلمك، كان ستوفيل قد تعاون مع لجنة التحقيق الفيدرالية، في أموال وعقود اعادة الاعمار، مقابل منحه الحصانة ضد المساءلة القانونية. فرسم ستوفيل للجنة، صورة تليق برواية ابطالها من المافيا، كما ذكر الصحافي الاستقصائي جيمس غلانز، في صحيفة « نيويورك تايمز»، في 15 شباط/فبراير 2009. تحدث ستوفيل بالتفصيل عن مئات الآلاف من الدولارات المحشوة بصناديق البيتزا، يتم تسليمها خلسة إلى مكاتب المقاولات الأمريكية في بغداد، وعشرات الالاف من الدولارات الموضوعة في أكياس ورقية التي يتم تسليمها كمكافآت الى مسؤولين في مناطق مختلفة من المنطقة الخضراء، حيث المركز الرئيسي للادارة الأمريكية بالعراق. وقام ستوفيل بتسليم اللجنة وثائق وملفات عن قادة أمريكيين كبار مسؤولين في مشروع اعادة الاعمار الأمريكي بالاضافة الى العراقيين، فتم اغتياله بعد شهر من ذلك، وتحولت القضية، تدريجيا، الى مطالبة الحكومة العراقية بالتعويضات التي تشمل ثمن عقد الدبابات الروسية والمحاماة وخسارة الشركة والقضاء على مدى عشر سنوات.
مما يضعنا امام مهزلة لا تضاهيها غير مهزلة انحطاط المهاترات والاتهامات الشخصية بين المسؤولين والنواب الى مستوى يمكن تسميته بـ«سياسة المجاري»، وانعكاس ذلك على الحكومة الحالية، وما تثيره أخبار على غرار فوز شركة وعائلة ستوفيل بالتعويضات من تساؤلات حول وجود حكومة اساسا بالمقارنة مع بقية الحكومات بالعالم، على اختلاف مستواها السيادي والتمثيلي للشعب. فاذا كان حال ستوفيل كضحية مماثلا لبقية الضحايا من العراقيين، على مدى 16 عاما الاخيرة، فان المطالبة بالتعويض عن مقتله بالاضافة الى قيمة العقد الذي لم تستوفه الشركة، وتحميل الحكومة العراقية المسؤولية، وقبول الحكومة المسؤولية وابعاد الشبهة عن الجنرالات وتجار الحروب الأمريكيين، يشكل اهانة لا تغتفر بحق الضحايا العراقيين الذين لم يحدث وطالبت الحكومة بحق، ولو مواطنا واحدا منهم، اغتالته قوات الاحتلال على الرغم من توفر الوثائق والشهود. وهذا ما شاهدناه في ملهاة دفع التعويضات الى كل فرد وشركة ومبنى تقدم بطلب التعويضات من العراق جراء احتلال الكويت. ولا تزال قائمة المطالبات مفتوحة على الرغم من مرور عقود عليها، و«تحرير» البلد من النظام الذي كان مسؤولا عنه، ودفع العراق مبلغ 52.4 مليار دولار حسب قرار الأمم المتحدة. وعلى نفس الخطى، كان من أولى خطوات مجلس الحكم الانتقالي، إثر الاحتلال، تصريح عبد العزيز الحكيم، رئيس المجلس حينئذ، في 2003، بأنه يجب على العراق دفع تعويضات الحرب لإيران البالغة قيمتها 100 مليار دولار عن خسائرها وضحايا الحرب العراقية الإيرانية. ولم يتوقف عبد العزيز الحكيم، وان كان هذا مفهوما باعتباره رئيس المجلس الاسلامي الاعلى المشكل بإيران، لحظة ليتساءل عمن سيدفع التعويضات للضحايا العراقيين، مؤسسا بذلك عقيدة، يستمرئ النظام الحالي ممارستها، وهي الاستهانة بحياة المواطن العراقي واحساسهم الداخلي بالدونية تجاه الآخرين. وهي السيرورة التي أدت الى تجاهل حياة مليون مواطن عراقي من قبل حكومته المنتخبة، افتراضا، مقابل دفع التعويضات لتاجر سلاح ومرتزق، ميزته ان حكومته لم تتخل عنه، مهما كانت الاسباب.
كاتبة من العراق
العراق: في بيتنا شخص مفقود
هيفاء زنكنة
في لقاء صحافي مع راديو «البي بي سي»، صباح الاول من ايلول/ سبتمبر، بمناسبة مرور 80 عاما على احتلال ألمانيا النازية لبولندا وإشعال فتيل الحرب العالمية الثانية، أكد السفير البولندي بلندن، على ضرورة مواصلة بلده المطالبة بتعويض ضحايا الغزو، عام 1939. ويشمل مصطلح الضحايا القتلى، والمختطفين، ومن اقتيدوا الى معسكرات العمل الاجباري، والمهجرين قسرا، وكل من اختفى ولم يسمع منه ذووه أو لم يعثر على جثته. يلخص هذا الموقف مفهوم العدالة والمثابرة على المطالبة به. فللضحايا وذويهم حقوق لا تسقط بمرور الزمن ومن واجب حكوماتهم المطالبة بها والعمل على تحقيقها.
في ظل الاحتفال بذكرى نشوب الحرب العالمية، وتعهد الدول العظمى على ألا تتكرر للمرة الثالثة، والعمل على تحقيق العدالة كشرط اساسي للاستقرار الأمني والسلام العام، مرت، خلال الاسبوع الماضي ذكرى يوم من نوع آخر. يوم التذكير بنكبة المفقودين. وهي ظاهرة تتميز بها، بشكل خاص، دول الشرق الأوسط (حيث يدور 40 بالمئة من الحروب والنزاعات بالعالم) وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. بهذه المناسبة رشح تقريران صادران عن منظمتين دوليتين هما «الصليب الاحمر الدولي» و«هيومان رايتس ووتش»، العراق باعتباره البلد الذي يضم أعلى رقم من المفقودين بالعالم، ففي كل بيت هناك شخص مفقود، جراء عقود من الحروب والصراعات.
وحسب تقرير منظمة « هيومان رايتس ووتش»، تقدر «اللجنة الدولية لشؤون المفقودين»، التي تعمل بالشراكة مع الحكومة العراقية لتحديد المفقودين وإعادتهم، أن عدد المفقودين في العراق يتراوح بين 250 ألف شخص ومليون شخص. منذ 2014، أخفى الجيش العراقي والقوى الأمنية العراقية قسرا رجالا عربا سُنة في إطار عمليات مكافحة الإرهاب بالإضافة إلى حالات أخرى. تقع مسؤولية الاختفاءات القسرية على عاتق مجموعة من عناصر الجيش والقوى الأمنية، حيث أن العديد منها حصل عند نقاط التفتيش أو في منازل المخفيين. لم تقدم السلطات العراقية أي معلومات حولهم بالرغم من طلب أُسرهم. كما لم تستجب السلطات لطلبات هيومن رايتس ووتش حول القنوات المتاحة للأسر للبحث عن أقاربهم. كما أوقف البرلمان مبادرتين لإصدار قانون جديد يحظر الاختفاء القسري كجريمة بعينها في 2015، ومرة أخرى في 2017.
واذا كانت تنظيم «الدولة الاسلامية» قد ارتكب عديد الجرائم ضد المدنيين والتي تم تصنيفها، دوليا، كجرائم ضد الانسانية، فان الحكومة العراقية، تمارس ومنذ انتهاء القتال ضد التنظيم، اشكالا ومستويات متعددة من العقاب الجماعي لأُسر المشتبه بانتمائهم إلى التنظيم. حيث تتسع مظلة الاتهامات والاعتقالات والاعدامات، حسب اهواء ورغبات الانتقام الفردية والمسيسة للميليشيات والأحزاب، في غياب النظام القضائي النزيه، وهي حقيقة لم تعد بحاجة الى النقاش.
اذ يتم منع «عائلات عراقية يُتصور بأن لها صلات مع داعش، بسبب الاسم أو الانتماء القبلي أو الجغرافي، من الحصول على التصريحات الأمنية المطلوبة للحصول على بطاقات هوية ووثائق رسمية أخرى».
في العراق، يُمارس التعذيب على أوسع نطاق، ويطبّق فيه حكم الاعدام على الشبهات بعد محاكماتٍ سريعة غير عادلة، ويوضع مئات الآلاف من الأبرياء في السجون
ينعكس هذا العقاب الجماعي على حرية الحركة، والحق بالتعلم، والعمل، بالإضافة إلى الحق بالاستفادة من استحقاقات الرعاية الاجتماعية والحصول على وثائق الميلاد والوفاة الضرورية للإرث والزواج. مما يعني انهم، يعيشون في سجن يفتقرون فيه حتى الى الحقوق التي تكفلها القوانين للسجناء والمعتقلين.
وحين يصرح المسؤولون الحكوميون بان على العوائل التقدم بالشكوى واقامة الدعاوى القضائية لنيل حقوقهم، تثبت التقارير الحقوقية الموثقة استحالة ذلك، اذ يمنع « الحرمان من التصريحات الأمنية هذه العائلات من تقديم شكاوى للجان الحكومية لتعويض المتأثرين بالإرهاب والعمليات الحربية والأخطاء العسكرية، وتقديم دعاوى قضائية أو الاعتراض على مصادرة أراضيهم من قبل القوى الأمنية العراقية أو عائلات محلية أخرى»، ويصل العقاب حد الحرمان، في بعض الأحيان، من الحصول على المساعدات الإنسانية.
واذا كانت المرأة هي حاملة العبء الاكبر، عند فقدان الزوج وتغييبه، في رعاية العائلة من الابناء الى ذويها وذوي الزوج، فان تعرضها وهي تبحث عن المفقود من افراد عائلتها، عند غياب شخص آخر يقوم بذلك، قد اكتسب بعدا جديدا، منذ الغزو عام 2003، وتبدت ملامحه بشكل، يكاد يكون مألوفا ومقبولا رسميا، أثر اعلان الانتصار على تنظيم «الدولة الاسلامية». حيث باتت المرأة المحتاجة الى المساعدة أو المراجعة الرسمية، مهما كانت درجتها، مستباحة الجسد والكرامة لكل من يرى في نفسه ذرة سلطة. وتتدرج الاستباحة من التعنيف اللفظي الى الابتزاز الجسدي. من المؤسسات التي تسيطر عليها الميليشيات «المسيسة» الى حراس وقوات أمن المعتقلات والسجون، صارت المرأة غنيمة حرب وجسدا يتم من خلال امتهانه تحقيق الانتقام ضد «الآخر». فما نفذه تنظيم « الدولة الاسلامية» ضد المرأة الإيزيدية، لأنها تشكل «الآخر» المنبوذ الذي يستحق الاهانة عبر استباحة الجسد والهيمنة، يستمر ارتكابه، اليوم، ضد نساء المفقودين والمعتقلين والمتهمين بتهمة «الداعشية» الجاهزة، خاصة في «المدن المحررة»، مع فارق غالبا ما يتم تجاهله، وهو ان الفعل الاجرامي الذي نفذه تنظيم «الدولة الاسلامية»، اجمع العالم، كله، على ادانته ومحاربته وقصف مرتكبيه حتى الموت، ووضع أطفاله ونسائه في معسكرات يعاملون فيها كالحيوانات، بالاضافة الى تعويض ضحاياه، أما ضحايا الميليشيات والإرهاب الحكومي المباشر وغير المباشر، فانه يحدث داخل جدران كونكريتية من الصمت والانتقام المنهجي.
لكسر دائرة العنف والانتقام المهدد بالقضاء على العراق ككل، هناك أصوات حقوقية تطرح حلولا، يرون انها ستفتح كوة أمل لأهالي المفقودين والمعتقلين، وقد يتحقق من خلالها، اذا ما طبقت بنية صادقة، ما يساعد على استعادة اللحمة المجتمعية التي أصابتها عثة الطائفية والانتقام والفساد بالتآكل. أحد الحلول المطروحة، ما قدمه مركز جنيف الدولي للعدالة، في الدورة 41 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان ( 24 حزيران/يونيو 2019 )، في كلمة نبه فيها الى حجم وعمق انتهاكات حقوق الانسان، بالعراق، في ظل دولة « يُمارس فيها التعذيب على أوسع نطاق، ويطبّق فيها حكم الاعدام على الشبهات بعد محاكماتٍ سريعة غير عادلة، ويوضع مئات الآلاف من الأبرياء في السجون والمعتقلات لسنوات طويلة دون محاكمة. دولة التي يصل فيها الفساد الى بيع المناصب الوزارية، ومناصب المحافظين، ووكلاء الوزارات، والمدراء العامّين بلّ كل الوظائف العامة… دولة يُشرّع برلمانها قوانين للتمييز بين المواطنين في الرواتب والتقاعد والخدمات على أسس طائفية وسياسية». لهذه الاسباب، طالب المركز مجلس حقوق الانسان بدراسة حالة حقوق الإنسان في العراق، بشكل مفصل، وتعيين مقرّر خاص لها من قبل المجلس. قد لا تكون هذه الخطوة، حلا جذريا لكارثة المفقودين والمعتقلين وانقاذا لحياة القابعين في غياهب السجون بانتظار تنفيذ احكام الاعدام، الا انها خطوة قد تكسر حاجز الصمت المسربل للكارثة وتوثيقا لمحاسبة المسؤولين. قد لا يتشابه مصير العراق والمنطقة مع المصير الاوربي، حيث يستمر توثيق الجرائم وتحصيل التعويضات بعد 80 عاماً من حدوثها في ثلاثينيات القرن الماضي، لكن مبدأ العدالة واحد مهما اختلفت طرق تحقيقه.
كاتبة من العراق
قصف الكيان الصهيوني
للعراق ليس وجهة نظر
هيفاء زنكنة
الكيان الصهيوني يقصف مواقع منتقاة في العراق. ما كان سيشكل جريمة شخصية ووطنية لا تغتفر ضد كل مواطن عراقي، أيامنا، بات اليوم «وجهة نظر»، كما كان الاحتلال لديهم أنفسهم، تناقش على منصة مرفوعة خارج البرلمان للاستهلاك السريع وامتصاص الغضب، بتصريحات سياسية منمقة، سرعان ما تم وضعها في خانات التقسيم الطائفي والعرقي الجاهزة. فهل تجذرت هذه التقسيمات وأصبحت أعمق مما نظن فعلا؟ للتوضيح، لنأخذ نموذجا مصغرا.
من الشائع، على صفحات التواصل الاجتماعي، تبادل التهاني بالأعياد ومناسبات نجاح الابناء، والاحتفاء بما يحققه الاصدقاء وابناء الوطن الواحد عموما. فما ان تفوز فتاة بشهادة رياضيات، مثلا، في بلد أوروبي، أو ان ينجز شاب ورقة بحث، حتى نسارع الى تهنئة بعضنا البعض بالفوز. وهذا أمر طبيعي في مواقع كانت مهمتها، في البداية، تشجيع التواصل ومشاركة الافراح والاتراح. الا ان صيغة التعامل تغيرت حتى فيما يتعلق بتحقيق الانجازات الفردية. اذ برزت، في الآونة الاخيرة، ظاهرة جديدة، بين المتواصلين العرب والعراقيين خاصة. وهي ظاهرة خطيرة، في زمن تقسيم البلدان وتفتيت الهوية، وان بدت بريئة الغاية. إذ لم يعد ناشرو أخبار النجاح والتفوق، حتى لو كان الانجاز تفوقا مدرسيا في مرحلة الطفولة (الابتدائية والمتوسطة)، يكتفون بذكر اسم الشخص ونشر صورته ودرجة نجاحه، بل وإضافة قوميته ودينه ومن ثم الاسترسال في تفصيل مدى تعرض طائفته ومنطقته للعنف. وكيف أنه حقق النجاح على الرغم من ذلك كله. وغالبا، ما يلي نشر الخبر السعيد، بهذه الصيغة، تعليقات تزيد من جرعة التمييز الديني والقومي والطائفي، بلغة يُستدل منها ما هو أبعد من التهنئة بالنجاح. فهل يعكس هذا درجة تغلغل العنصرية الطائفية/ الدينية/ العرقية، في النفوس؟ والى أي حد ستؤثر هذه اللغة وصياغتها في تكوين الهوية الفردية للطفل أو الشاب، صاحب الانجاز، وانعكاسها على الهوية الجماعية للمجتمع، مستقبلا؟
هناك عدة مستويات لقراءة هذه الظاهرة. فالاحتفاء بالنجاح المدرسي حدث مجتمعي تقليدي يعتز به الأهل والاصدقاء يصل الى حد اقامة الحفلات واستقبال المهنئين ومنح الناجح الهدايا. فنشر اسم الناجح ـ المتفوق وصورته، يحملان في داخلهما، مسبقا، النجاح في التواصل مع الآخرين والاستجابة التلقائية، بلا حواجز، للصورة والحدث.
فالقارئ مهيأ، بحكم الموروث المجتمعي، للتعاطف، فهو يعرف جيدا معنى الاحتفاء بالنجاح وبوده المشاركة بفرحة الاهل والاصدقاء. تجعل، هذه الخلفية، من السهل جدا على من يرغب بتمرير رسالة معينة القيام ذلك. وهنا يأتي دور اللغة. ولا أعني تعدد اللغات بين قوميات مختلفة في البلد الواحد، حيث احتمال سوء الفهم موجود، بل استخدام اللغة الواحدة، ولكن بالتمايز في المفردات للدلالة على ذات الحدث. وهنا تكمن خطورة تناقل الاخبار وفق هيكلة لغوية جاهزة، بدون التمعن بدلالة المفردات، وامكانية تسخيرها للتشظي، حتى حين تستخدم لنقل خبر بسيط، هدفه الظاهر والمعلن تجميع الناس. فما هي ضرورة الاشارة الى ان المتفوق في امتحانات الاعدادية هو يزيدي أو كردي أو تركماني، ثم التشعب نحو المذهب بطريقة من الطرق، مع ملاحظة عدم استخدام مفردة «العراقي»؟ قارنوا ذلك بنشر صورة طالبة فلسطينية وقد كتب تحتها «الطالبة الفلسطينية شروق دويات، حكمت 16 سنة في سجن اسرائيلي». فلسطين، هنا، هي الهوية.
ما هي ضرورة الاشارة الى ان المتفوق في امتحانات الاعدادية هو يزيدي أو كردي أو تركماني، ثم التشعب نحو المذهب بطريقة من الطرق، مع ملاحظة عدم استخدام مفردة «العراقي»؟
اليس الأجدى نشر صورة المتفوق واسمه واسم مدرسته، ومدح وتكريم مدرسيه؟
طالما استخدم السياسيون اللغة كسلاح للدعاية والتحريض والتسويغ سواء اثناء الحملات الانتخابية أو أثناء الحروب. وهم الأكثر حرفية ومهارة في الاستخدام الممنهج للغة الاقناع وتمرير المعلومات ذات الاجندة المدروسة «فاللغة السياسية مصممة لتبدو الاكاذيب حقيقة والجريمة محترمة، وما هو هوائي صلب، وينطبق هذا على كل الاحزاب السياسية من المحافظة الى الفوضوية» حسب الكاتب الانكليزي جورج اورويل.
الأمر الذي يضع على كاهل المواطن العادي مسؤولية كيفية تلقي المعلومات واستيعابها، والاكثر من ذلك، مسؤولا عن تدويرها، في عصر شبكات التواصل الاجتماعي المشجعة على التدوير بدون تمحيص أو تدقيق للمعلومات، خاصة عند وجود صورة تستقطب الاهتمام أكثر من اللغة المصاحبة لها.
يساهم التدوير السريع، لأخبار بلغة ذات دلالة معينة، الى تصنيع هوية معينة، تتدرج باستخدام مفردات دالة ثقافيا، بالإمكان تشبيهها بلغة الازياء أو اللحى، وان كانت اللغة أعمق بكثير.
فالمسلم المتدين، مثلا، يكتب عند وفاة شخص ما «الله يرحمه»، أما غير المتدين/ العلماني فيقول «لروحه السلام». ويلاحظ، في اوقات النزاع والصراع الاهلي، أو تسنم فئة معينة للسلطة، تغييرا في المفردات ذات العلاقة بالهوية، لتصبح مفردات وطريقة نطق الجهة الأقوى هي السائدة. بالإضافة الى نمو الفجوة الدلالية الواضحة – الانقسام في معنى الكلمات، مما يؤدي، تدريجيا، الى تفتيت الهوية الموجودة.
قد يكون تقديم صورة المتفوق مصحوبة بتحديد القومية أو الدين أو المذهب، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، عبر رموز تٌصنع هوية – هويات بديلة، تطبيقا لما يعرف بسياسات الهوية، والذي نراه بأوضح صوره في منظمات المجتمع المدني، حيث يتم تحديد الهوية التي يستند عليها عمل المنظمة، حسب العرق أو الدين أو الجنس أو الإثنية أو الأيديولوجية…الخ. ويكمن الخطر الأكبر في الأجندات السياسية المرافقة لتصنيع الهويات، بعيدا عن المحيط الاجتماعي ـ الثقافي، والمؤدية الى تقسيم البلد وتخريب المشترك التاريخي الحضاري وفق « المظلومية» الدينية أو المذهبية أو العرقية.
وتكتسب اللغة خصوصية فارقة عندما ترتبط بايديولوجيا حزب أو تيار سياسي. والامثلة كثيرة في معاناة العراق والمنطقة، خلال حوالي اربعة اجيال، من تيارات ايديولوجية مزقت النسيج الاجتماعي الغني بخلطته التاريخية المتبدية في تركيبة كل عائلة على الإطلاق. فالتيارات القومية العربية، مثلاً، تاجرت بمفاهيم عنصرية واصول قبلية نقية تقصي ولا تجمع، تحت شعارات الوحدة، وجاءت التيارات الإسلامية بالتقسيم الطائفي الاكثر خطورة، بالتكفير المتبادل، وباستدعاء المقدسات المزعومة وغير المزعومة، وفقدت التيارات العلمانية اليسارية، ومنها الحزب الشيوعي مثلا، بعد عقود من تمثيلها الصراع الوطني ضد الاستعمار مع النضال لتحقيق العدالة الاجتماعية والمواطنة البعيدة عن العنصرية والمذهبية، هذا التميز نتيجة فقدانها التدريجي للاستقلالية.
ليست هناك براءة في اللغة. فكل مفردة محملة بالمعاني، وتعتمد على كيفية استخدامها، لا لفهم الماضي والحاضر ولكن، وهذا هو الاخطر، في حال البلدان المهددة بالتقسيم المجتمعي، في تصنيع الذاكرة لمن سيحل محلنا مستقبلا. وقد يكون الطفل المحتفى بنجاحه هو حامل ذاكرة ما يوصف به حاليا من انتماء طائفي او عرقي، ليواصل حمل هوية فرعية مصنعة تنأى به عن الآخرين وان شاركهم بقعة الارض ذاتها. وهنا تكمن مسؤوليتنا، جميعا، في الانتباه الى ما تحمله اللغة من رسائل، وتجنب تدويرها المباشر، لأنها قادرة على تدوير ما هو أكثر من التهنئة البريئة. وقد تكون هذه خطوة بسيطة جدا لاستيعاب «وجهة النظر» حول نجاح الكيان الصهيوني في قصفنا.
كاتبة من العراق
كيف تنجح في اخضاع بلد كالعراق؟
هيفاء زنكنة
من يتابع تصريحات الساسة واجراءات رجال الأمن والشرطة، بالعراق، التي ينثرونها على المواطنين، بين الحين والآخر، حول نوعية الملابس التي يجب على الرجال والنساء ارتداؤها، أو تصنيف المدن كمقدسة أو غير مقدسة وتسميتها وفق ذلك، وعما اذا كان وجود عازفة كمان، في احتفال رسمي، لافتتاح بطولة لكرة القدم، مخل بالآداب العامة وقدسية المكان أم لا، سيظن، حتما، ان البلاد بألف خير اقتصاديا وسياسيا وحضاريا، ولم يبق فيها ما يستحق المتابعة والاصلاح غير هذه الامور. فهم يعملون بجد على اقناع الآخرين، وربما أنفسهم، ان البنـــية التحتــــية للبـــلد، التي ساهموا بتخريبها، عن طريق التعاون مع المحـــتل ومأسسة الفساد، قد أعادوا اصلاحها، كما يرون في الطائفـــية التي ساهموا بغرزها في الجسد العراقي، إلى حد تغيــير شكل الوجه والمظهر واسماء الافراد والاماكن واضفاء «القدسية» على هذا المكان أو «العصــمة» على ذاك الشخص، حلا مثاليا لنقاء وطني ما كان بالامكان تحقيقه لولا وجودهم.
أما التهجير القسري وفق انتقائية الدين والمذهب والقومية، فيرونه، في قرارة أنفسهم، الحل الافضل للنقاء الطائفي الذي لا يقل ابتذالا ووحشية عن النقاء العنصري. واذا ما اتفقنا، افتراضا، مع القائلين بأن التمييز الطائفي والعرقي كان موجودا بالعراق، قبل الاحتلال، وربما، كما يقترح البعض، قبل مئات السنين، فان من المستحيل، لأي مواطن أو راصد للاوضاع، مهما كانت درجة معارضته للنظام السابق، انكار دور النظام الحالي في ايصال البلد المنهك، جراء الحروب والحصار، إلى هوة تهدد الكل بالابتلاع. إذ بات عراق، اليوم، بفضلهم، لايذكر الا بصيغة «الافعل» انحدارا.
فهو الاسوأ في قائمة الفساد العالمية، وهو الاقل أمانا للصحافيين، وهو الاكثر انتهاكا لحقوق الانسان، والادنى بمستوى التعليم والصحة، والاقل سيادة اذ تحتله قوات عدة دول في آن واحد وتقصـــفه دول اخرى، والاكثر تنفيذا لاحكام الاعدام، وسجـــونه ومعتقلاته الاكثر اكتظاظا، وليس هناك ما هو أكـــثر انتشـــارا من التعذيب فيه غير بسملة الساسة وقادة الميليشيات المسلحة، المدعومة داخليا من المرجعية الدينية وخارجيا من دول اقليمية أهمها إيران. وهي توليفة تجعل من رئيس الوزراء و «القائد العام للقوات المسلحة»، مجرد إطار لصورة تتحكم بها الميليشيات، لأنها الاقوى والأكثر هيمنة على الشارع والمؤسسات من قوات الجيش والشرطة والأمن معا. وهذه حقيقة، لم تعد مطروحة للنقاش.
ان انتشار شبكات بيع الاعضاء البشرية واستخدام الاطفال والنساء للتسول والدعارة بالاضافة إلى تحول العراق من بلد خال من المخدرات إلى أكبر ممر تهريب من ايران، يوازي ان لم يفوق تخريب البنية التحتية
لهذا، تلجأ أحزاب الحكومة، بين الفينة والفينة، إلى مناورات لتلهي الناس، وتستقطب الاهتمام الاعلامي. هدفها تغطية عجزها عن النظر في التدهور الكارثي، للبلد ككل، وتعاميها عن ايجاد حلول جذرية . وبما ان المستوى العقلي لأصحاب السلطة محدود ويقتصر على اختلاق الحيل وابتكار طرق للاستزادة من الفساد، سرعان ما تنقلب مناوراتهم لاشغال الناس ضدهم. كما في الضجة الكبيرة التي أثيرت حول ظهور عازفة كمان في حفل افتتاح بطولة كرة القدم، بمدينة كربلاء، التي بات اسمها، منذ الاحتلال، «كربلاء المقدسة». لم تكن المرأة عارية او كاشفة عن مفاتنها، ولم ترقص بمجون أو تغني بصوت شبق، كما الاتهامات الجاهزة، بل كل ما فعلته هو انها عزفت النشيد الوطني. فقامت الدنيا ولم تقعد. وطفت على السطح تعريفات عن القدسية والفضيلة وحرمة الاماكن والاخلاق، بينما يدفن ذات المعترضين، في اعمق الاعماق، استثماراتهم في شبكات تمتهن استغلال الأطفال في التسول، وتجارة الأعضاء البشرية، واستدراج النساء للعمل ضمن شبكات الدعارة.
وكأن التهجم على الموسيقى ليس كافيا، انشغلت شرطة مدينة كركوك، الواقعة شمال بغداد، بملاحقة مرتدي الشورت أو البرمودا، وهو سروال قصير يصل طوله حد الركبة، والذي يميل الشباب، خاصة، إلى ارتدائه، كبقية البشر، في ارجاء الكرة الارضية، عند ارتفاع درجات الحرارة صيفا، والتي تصل بالعراق إلى حد تذويب الاسفلت في الشوارع، وشي البيض عليه. قسوة الطبيعة هذه المتزامنة مع انقطاع التيار الكهربائي وانعدام الماء الصالح للشرب، في الجنوب ، خاصة، لم يمنعا المتحدث باسم وزارة الداخلية من التهديد بان: «إن ارتداء الشورت أو البرمودا ممنوع… وكل من يخالف سوف يحاسب». فكانت رد فعل الناس، شن حملة ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي مع التذكير بـ «فتاوى» ممنوعات ومحرمات تنظيم «داعش»، الذي اجتمعت 56 دولة على محاربته في العراق، بينما يحظى النظام الحالي بدعم ذات الدول، بدون الاشارة إلى أي من ممارساته «الداعشية».
واذ تواصل شرطة كركوك «محاربة الشورت»، واعتقال مرتديه، تعيش المحافظة روتين الجرائم اليومية من سرقات وابتزاز، وتهديد بلا انقطاع، في المدينة المتنازع عليها بسبب نفطها والمتنازع فيها، في الحقيقة، بسبب نفطها أيضا ولكن بعد تعبئته بحاويات القومية الملونة. كما يواصل المجرمون ارتكاب جرائمهم، بلا مساءلة وفي أجواء آمنة، بحماية أحزاب وميليشيات تستفيد، بنسب سمسرة مذهلة. من بين الجرائم التي تم توثيقها هي الاتجار بالاعضاء البشرية. حيث وثَّق المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر وجود وجود 27 شبكة اتجار بالبشر، يتخذ معظمها من إقليم كردستان ملاذاً آمناً، من بينها ثلاث شبكات تستغل مجموعات من الأطفال والنساء، للتسول في أزقة محافظة كركوك وشوارعها.
ان انتشار شبكات بيع الاعضاء البشرية واستخدام الاطفال والنساء للتسول والدعارة بالاضافة إلى تحول العراق من بلد خال من المخدرات إلى أكبر ممر تهريب من ايران، يوازي ان لم يفوق تخريب البنية التحتية التي نفذها المحتل الامريكي كاستراتيجية للحصول على عقود «اعادة الاعمار». وهو يمثل قفزة نوعية في كيفية تحويل العراق من دولة إلى «سوق حرة» للمتاجرة بالانسان جسدا وعقلا. اذ أكتشف المحتل و«خدم المنازل» ان العراق لم يرضخ قصفا واعتقالا وتفجيرا، فوجد في نشر هذه الشبكات امكانية تحقيق التخريب الداخلي من جهة والتظاهر بالانفتاح والاستقرار من جهة أخرى. ولأن كل ما تم تنفيذه من أساليب اخضاع عموم الناس لم تنجح حتى الآن (وان تركت جروحا)، والدليل تجدد استنباط اساليب القهر والاخضاع.
أن الخزين التاريخي الحضاري للبلد أعمق بكثير ولن ينضب حتى بهجرة وتشرد الملايين منذ الاحتلال، وقبله في سنين الحروب والإنقلابات. لكنها مسألة زمن، وأننا سنشهد عاجلا ام آجلاً ما الذي سيفرزه جهاز المناعة العراقي في مقاومته فـ «الجلادون من ورق مقوى»، كما يذكرنا، اذا نسينا، الشاعر الجزائري الفرنسي الراحل جان سيناك.
٭ كاتبة من العراق
العدالة والملح في دفاتر تونسيات
هيفاء زنكنة
لمركز «العدالة الانتقالية الدولي» نشاطات في ست دول عربية، هي: الجزائر ولبنان وتونس والمغرب ومصر وفلسطين. كما قام المركز ببعض النشاط في العراق إثر الاحتلال لفترة لم تطل، إذ بات تطبيق مبادئ العدالة الانتقالية، في ظل الاحتلال والحكومات المتعاقبة، أمراً مستحيلاً. خلافاً لذلك، شهدت تونس استمرارية نشاط المركز، بمستويات متعددة منذ الثورة عام 2011. نشاط تبدى بدعم عمل «هيئة الحقيقة والكرامة»، ومكافحة الفساد، وتعويض ضحايا الاستبداد.
وكان للمرأة حصة. مثال ذلك، مشروع «أصوات الذاكرة» الذي ضم أربعة أوجه، من بينها إقامة ورشة للكتابة الإبداعية، كانت حصيلتها إصدار كتاب «دفاتر الملح: كتابات تونسيات عن تجربة السجن السياسي». بواسطته، تمكنت المشاركات من تسليط الضوء» على كيفية تأثر الحياة العادية لمواطنة ما، بقسوة، عندما يكون أحد أفراد عائلتها هدفاً للقمع أو لأنها تجرّأت هي نفسها على الاختلاف»، حسب سلوى القنطري، مديرة المكتب بتونس، التي شخصت تحديا «لا يزال يشهده التحول الديمقراطي بتونس، وهو الانقسام الإسلامي العلماني» الذي يحدد الهوية بشكل صارم قائم على الأيديولوجية، ما يؤدي في النهاية إلى إنكار أيّ تعاطف أو تضامن محتملين مع «المختلف»، حسب تعبيرها.
عالجت الورشة تساؤلات كثيرة على غرار: هل بالإمكان الكتابة عن وجع الروح بشكل لا يحبط القارئ ويدفعه إلى وضع الكتاب جانباً؟ كيف نكتب تجربتنا إذن؟ كيف يمكن سرد الأحداث المستخلصة من الذاكرة، وغربلة الحقيقة، وتوثيق التجربة المريرة التي أرادتها السلطات القمعيّة عقابا لكلّ من يعارضها، على مدى عقود طويلة، والتواصل مع القارئ في الوقت نفسه؟ كيف الوصول إلى مستوى «الكتابة عن الضجر بدون أن نصيب القارئ بالضجر»، كما ينصح أحد النقاد؟ ولماذا تريد المشاركات الكتابة بهذا الشكل، أساساً، وقد قام معظمهن بتقديم شهاداتهن، رسمياً، سابقاً؟
كان من الواضح أنّهنّ يرغبن في الكتابة لعدّة أسباب، من بينها وبكلماتهن: توثيق التجربة من أجل حفظ الذاكرة الجماعيّة، والتوثيق للأجيال المقبلة، ونكتب لأولادنا، والتعريف بما حدث لنا وبتاريخنا، لإبراز ما جرى لآلاف السجناء من القفّة إلى المراقبة الإداريّة، ووفاء للضحايا ولاستمراريّة النضال بشكل جديد لإظهارالحقيقة، ولنتصالح مع أنفسنا والآخرين ضمن مسار العدالة الانتقالية، لئلا تتكرّر الجرائم، ولئلا يتكرّر التعذيب، ولتحقيق المصالحة والتواصل وقبول الآخر.. هذه الأسباب دفعت المشاركات إلى المواظبة على الكتابة وهن يتوخين تحقيق هدف الورشة العام الذي يطمح إلى تشجيع كل النساء على كتابة قصصهنّ بأنفسهنّ، ولا يُكتفى بما يكُتب عنهن بالنيابة. وأن تكون الكتابة مختلفة عن التدوين السائد لأغراض التوثيق وتسجيل الشهادات التي تستوجب دقة المعلومة لا المشاعر والمعاني. وأن يكتبن قصصهنّ بشكل إبداعيّ، وظلالها وعمقها الإنسانيّ التي غالباً ما يهملها كُتاب التاريخ، باعتبارها تفاصيل جانبية لا تستحقّ التسجيل. فلكلّ مشاركة قصّتها الاستثنائية، وكلّ ما تحتاجه هو تنمية التقنية الفنيّة الضروريّة لتدوين القصّة.
في بلادنا ذاكرة مليئة بالتفاصيل الموجعة تريد أن تُخرج إلى عامّة الناس ما اختزنته من لحظات كانت تبدو عابرة، لكنّها اندست عميقاً في التواريخ الفرديّة والنفوس المعذّبة
الملاحظ في الكتاب، حصيلة الورشة، أن كاتبات النصوص لسن جميعاً من المعتقلات السياسيات، بل شاركتهن الكتابة نساء عشن تجربة اعتقال أحد أفراد عائلتهن، وهن في سن تقل عن العشر سنوات، ما حفر في ذاكرتهن صوراً يختلط فيها الخوف مع الأسى والرغبة بالتغيير في آن واحد. نهى الديماسي، مثلاً، شهدت اعتقال والدتها واقتيادها بعيداً عنها وهي في سن الثالثة. وميلان حامي شهدت مأتم جدها بعد اعتقال والدها بحضور رجال الأمن: «كان من بين الحضور أناس لا يبكون. كانوا الوحيدين الذين يشبهونني. وقتها أحسست تجاههم بالاطمئنان. روعني نحيب من حولي، فخلت أنّ الصامتين سيكونون ملجأً لي. عرفت فيما بعد أنّهم من الأمن وأنّ المفرّ الذي اخترته كان نفسه يدعو إلى الفرار».
وسلافة مبروك استمعت إلى كلام والدها عن الأعين والآذان التي تراقبهم وتسمع كلامهم، بعد اعتقال شقيقها، فـ «تخيّلت جدران الغرف وقد التصقت الآذان بها، وعيون كبيرة وكثيرة فوق أشجار الزيتون تسترق السمع إلى حديثنا، أما أذنا الحارس وعيناه فأكبر بكثير. تخيلت أنّه بالإمكان أن يمدّها فتصل وراء بيتنا، ولا بدّ أنّه سيسمع كلام أمي وأبي عن بورقيبة الذي نهرانا عن ذكره. أحسست بالحيرة والخوف… فكيف لبيتنا الريفي الواقع وسط غابة الزيتون أن تصل إليه وتراقبه كل هذه العيون والآذان؟»
عن هذه التفاصيل والذاكرة، كتب الروائي والأكاديمي شكري المبخوت في تقديمه للكتاب: «فثمّة في بلادنا ذاكرة مليئة بالتفاصيل الموجعة تريد أن تُخرج إلى عامّة الناس ما اختزنته من لحظات كانت تبدو عابرة، لكنّها اندست عميقاً في التواريخ الفرديّة والنفوس المعذّبة. لم تكن هذه التفاصيل في ضمائر القرّاء مثلي موجودة إلاّ على نحو باهت ضبابيّ بين مصدِّق ومكذِّب. ولكنّها إذ تروى تبدو أوضح قليلاً علّها تمنح للمترجرج غير المتشكّل حبكة تكشف وجهاً من الحقيقة. فأن تروي الضحيّة مسارها الفرديّ يعني أنّ الذاكرات التي منعت من إخراج ما اختزنته من ألم ممضّ وأوجاع مبرّحة قد منحت فرصة لتقول وتعبّر عن سخطها وغيظها فتراكم العلامات الدالّة على التعسّف فتدين وتصرخ وتحتجّ وتطالب بنصيبها من الحقيقة الغائبة والمغيّبة».
إنّ ما كتبته النساء في «دفاتر الملح» يقربنا خطوة من فهم ما مررن به من ألم وحيرة وإحساس بالظلم والاضطهاد، من تساؤلات ربّما بقي بعضها بلا أجوبة. إلا أنّهن، وهذا هو الأهمّ، كتبن نصوصهنّ وهنّ مدركات، تماماً، أنّ هدف الكتابة ليس الانتقام أو طلب الغفران، بل وسيط التعافي عبر مشاركة الآخرين الحقيقة. وكشف الحقيقة هو أساس العدالة إذا ما أريد للمجتمع أن يتعافى، آخذين بنظر الاعتبار مسألة في غاية الأهمية، وهي أن الحقيقة «باعتبارها مطلباً أخلاقيّاً وسياسيّاً وقصّة تفتقر دائماً إلى حبكة دقيقة مفصّلة، لا يمكن تجزئتها ولا توظيفها سياسيّاً بالمعنى الحزبيّ للسياسة»، ما يقودنا إلى تساؤل يلخصه المبخوت «فأيّ الوجوه ستغلب وقد بدأت المصارحة؟ وأيّة هويّة جماعيّة جديدة سيبتكرها هذا المشروع السرديّ الجماعيّ وغيره من المشاريع الأدبيّة التي تعتمل هنا وهناك في بلادنا؟». وهو تساؤل عام لا يمكن إهماله إطلاقاً. تساؤل يشمل الجميع وليس النساء وحدهن. وكما هو معروف، إن مقياس نجاح أي كتاب، بعيداً عن الآنية، هو مدى ما سيثيره من تساؤلات تحفز على التفكير والمبادرة. فهل سيكون للملح في دفاتر النساء دور في بناء الحقيقة المشتركة؟
كاتبة من العراق
بين أمريكا والعراق…
الفاسد يعاقب الفاسد!
هيفاء زنكنة
نشر البنك المركزي العراقي تعميماً بتاريخ 24 يوليو/ تموز، أمر فيه المصارف العاملة في العراق بتجميد حسابات أربعة عراقيين «متورطين في قضايا فساد أو انتهاكات لحقوق الإنسان». العراقيون الأربعة هم: محافظ نينوى السابق، ومحافظ صلاح الدين السابق، وآمر كتيبة بابليون التابعة للحشد الشعبي، وآمر لواء 30 الحشد الشعبي.
كان من الممكن الاحتفاء بهذه الخطوة واعتبارها منطلقاً لتأسيس مسار حقيقي للقضاء على الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، لو كان قرار التجميد قد جاء تطبيقاً لقرار قضائي أو قانوني عراقي، إلا أنه صدر وجاء تطبيقه من قبل المصرف المركزي بشكل سريع (لعله الأسرع منذ احتلال البلد عام 2003) ليس نتيجة قرار عراقي، بل استجابة للعقوبات الأمريكية الصادرة بحق الأربعة الذين تتهمهم الإدارة الأمريكية بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان. جاءت هذه الخطوة في أعقاب سلسلة قرارات اتخذتها الإدارة الأمريكية، وأكدتها السفارة الأمريكية، ببغداد، لتبين التزامها « للعمل مع الحكومة العراقية وجميع العراقيين المناهضين للفساد وانتهاكات حقوق الإنسان المُرتكبة من قبل مسؤولين حكوميين.، كما أوضح سيغال ماندلكر، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية. وكان نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، قد أضاف بعداً «إنسانياً» آخر على القرار حين صرح قائلاً: «الولايات المتحدة لن تقف متفرجة بينما تنشر الميليشيات المدعومة من إيران الرعب». ولا تقتصر العقوبات على الأشخاص الأربعة فقط، بل شملت ما فرضته وزارة الخزانة الأمريكية على شخصين آخرين بتهمة تهريب أسلحة إلى ميليشيات عراقية يدعمها الحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى شركة «موارد الثروة الجنوبية» المتهمة بتسهيل «وصول الحرس الثوري الإيراني إلى النظام المالي العراقي من أجل التهرب من العقوبات».
كل هذا تم خارج نطاق القانون والقضاء العراقي وكل ما له علاقة بالسيادة الوطنية، لكنه تم حسب «قانون ماغنتسكي العالمي»، وهو قانون تم تطويره عام 2017 ليخول الرئيس الأمريكي، بالإضافة إلى سلطاته الحالية، سلطة فرض عقوبات على المواطنين غير الأمريكيين، ومعاقبة المسؤولين الحكوميين الأجانب «الفاسدين والمتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان» في أي مكان في العالم.
وقد لاقى تطبيق القانون على عدد من «المارقين»، أشخاصاً وحكومات، ترحيباً من عديد المنظمات الحقوقية الدولية، ما شجع دولاً أخرى على تطبيقه. الأمر الذي يثير تساؤلاً حول عدم ترحيبنا به والتهليل لمنجزاته. فلم لا نحتفي بقرار سيؤدي، عند تطبيقه، إلى إنهاء فيروس الفساد المستشري بالنظام العراقي الحالي، كما يضع حداً لانتهاكات حقوق الإنسان التي طالما طالبنا بمحاسبة مرتكبيها؟
هناك أسباب عديدة لا تدعو إلى التفاؤل بهذا المنجز، تتضح أمامنا حالما نلقي نظرة سريعة على السياسة الأمريكية تجاه العراق في مرحلة ما بعد الاحتلال، وسيرورتها الحالية. هكذا نفهم المستقبل. فمن لا يقرأ الماضي سيبقى أمياً إزاء المستقبل. فجوهر العلاقة هو الاستغلال الإمبريالي (نفط، أمن الكيان الصهيوني، حلبة للمناوشات مع إيران واستنزاف لدول الخليج)، ساعدها في الاستمرار وجود نظام طائفي عنصري فاسد، غير معني بالسيادة الوطنية والوطن.
أحد الجوانب المهمة للعمل التضامني المتكافئ هو التمكن من كشف الاتفاقيات والمساومات الثنائية غير المعلنة، المقيدة، ومن ثم اتخاذ الإجراءات بصددها
نظام يتأرجح ما بين استجداء الحماية الأمريكية والإيرانية، لأنه يرى أن عدوه الأول هو الشعب. يغذي ديمومة هذه العلاقة النهب المنهجي لأموال البلد في سنوات الاحتلال الأولى، ومن ثم الفساد المتمثل بالعقود الضخمة، بقيمة مليارات، في مجالات الإعمار والسلاح والنفط والشركات الأمنية، التي تم منحها إلى شركات أمريكية بعد إعلان انسحاب القوات العسكرية، عام 2011. وتم التوقيع على معظمها في أثناء وجود نوري المالكي، أمين عام حزب الدعوة، رئيساً للوزراء مدة 8 سنوات، أشرف خلالها على تأسيس شبكة فساد منظم يقوم من خلالها رجال أعمال ومسؤولين حكوميين عراقيين حاليين وسابقين مرتبطين به، بالعمل مع شركات أجنبية مقابل دفع حصة معينة. وقد نشر موقع « ديلي بيست» الاستقصائي، المتابع لقضايا الفساد الأمريكية، في 24 يوليو/ تموز، تقريراً بعنوان «العلاقات المشبوهة لجنرال أمريكي متقاعد بالعراق». يضم التقرير تفاصيل دقيقة بأسماء الأشخاص والشركات والتاريخ والأماكن، عن شبكة العلاقات الخفية والعقود العسكرية والتجارية بين الجنرال فرانك هلمك، الذي كان من نجوم الاحتلال وتقاعد في 2011 ليصبح «رجل أعمال»، فتحت له علاقته بنوري المالكي أبواباً واسعة في مختلف الشركات المشبوهة المرتبطة بالنظام السياسي العراقي.
هذا غيض من فيض، يعطينا نموذجاً لنوعية العلاقة الفاسدة بين مسؤولي الإدارة الأمريكية والساسة العراقيين. فمنذ عام 2004، أي بعد عام من الغزو، تلاشى ما مجموعه 218 مليار دولار، أي أكثر من الناتج المحلي الإجمالي للعراق في العام السابق، في جيوب السياسيين ورجال الأعمال من الطرفين، وهو رقم رسمي يعتبره كثيرون ضئيلاً بالنسبة للتقديرات السابقة. وفي كل يوم تطفو على السطح معلومات جديدة، موثقة، عن الفساد المشترك وعلاقته بالإرهاب، وعن انتهاكات حقوق الانسان الصادرة عن منظمات حقوقية عراقية وأمريكية مستقلة، لتواجه جداراً من الصمت من الإدارة الأمريكية بل وإصراراً على مد النظام بالسلاح والحماية.
فهل يلام من لا يحتفي بالإعلان الأمريكي عن فرض العقوبات على أربعة عراقيين وشركتين، بتهمة الفساد والانتهاكات، حين اقتضت مصلحتها في مسار المناوشات مع إيران؟ كيف يمكن الوثوق بدولة غزت البلد وأسست للطائفية والفساد والإرهاب، وجعلته نموذجاً محفوراً بذاكرة العالم، لإجراءات التعذيب التي جعلتها الإدارة الأمريكية قانونية؟ كيف يمكن الوثوق بجلاد؟ بإدارة يقودها رئيس متهم بالفساد والاعتداءات الجنسية، يتباهى بصداقة ودعم وترسيخ الكيان العنصري الصهيوني، على حساب الشعب الفلسطيني، ولم يبق بند من بنود حقوق الإنسان لم ينتهك، داخل وخارج أمريكا، تحت رئاسته؟ رئيس عنصري يشكك حتى بالأمريكي إذا كان لون بشرته مختلفاً، ووالداه من بلد آخر، فكيف إذا كان عراقياً؟
وهل يلام من لا يثق بوعود وتصريحات رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بعد إعلان العقوبات الأمريكية، وبعد أن أوعز المصرف المركزي بتنفيذها، ليصرح بعد ايقاظه، فجأة، من سباته العميق: «أحلنا ملف عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية على المستشارين القانونيين للبت بها»، وأن هناك «قضايا لم تحسم بمختلف مؤسسات الدولة بلغت بمجملها 4117 قضية»، لافتاً إلى وجود «1367 قضية فساد محالة إلى محاكم النزاهة»؟
ليس بالإمكان وضع الثقة بالفاسدين المحليين أو العالميين، والفساد في أدنى مستوياته وأقذرها حين يرتبط بالاحتلال والإرهاب. لذلك نرى تزايد الاعتصامات والمظاهرات، في أرجاء البلد، من قبل مختلف شرائح الشعب.
والحاجة ماسة جداً إلى التنسيق والتكاتف بين الجميع تحت الشعار الواقعي الموحد «الفساد يقتلنا»، بالإضافة إلى التنسيق مع منظمات التضامن والمنظمات الحقوقية خارج العراق، وبضمنها الأمريكية المستقلة، غير المرتبطة بالإدارة، المعنية بالشفافية والنزاهة وحقوق الإنسان. أحد الجوانب المهمة للعمل التضامني المتكافئ هو التمكن من كشف الاتفاقيات والمساومات الثنائية غير المعلنة، المقيدة، ومن ثم اتخاذ الإجراءات بصددها.
مئات المنظمات
الحقوقية في العراق:
الشعب إذن بخير!
هيفاء زنكنة
قد يتبادر إلى الأذهان عند قراءة تقرير منظمة «هيومان رايتس ووتش»، الصادر بداية الشهر الحالي عن حال المعتقلين والسجناء بعنوان «العراق: آلاف المحتجزين، منهم أطفال في أوضاع مهينة» ـ أن العراق خال من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، ما يمنح السلطات المحلية حرية مطلقة في انتهاك حقوق الإنسان، خاصة المعتقلين، بلا مساءلة، وأن هذه المنظمة هي الوحيدة التي ترصد الانتهاكات والخروقات، فيسهل التشكيك بتقاريرها أو تجاهلها، كما يحدث عادة.
التقرير مزود بصور مهولة لأجساد متراصة بأوضاع مشوهة أكروباتيكية، من الأحداث واليافعين، في سجون الرجال، و كما هي أجساد النساء والأطفال في سجون النساء. وهو ليس بالأمر المستغرب إذا ما علمنا أن الطاقة الاستيعابية القصوى لمراكز الحبس الاحتياطي الثلاثة في شمال العراق، مثلاً، هي 2500 شخص، بينما وصل عدد المحتجزين هناك، بحلول يونيو/حزيران، إلى 4500 سجين ومحتجز تقريباً، من بينهم 1300 شخص حُوكموا وأُدينوا وكان ينبغي نقلهم إلى سجون بغداد منذ ستة أشهر على الأقل. ووصل عدد السجينات بسجن النساء في بغداد 602 امرأة، بينما لا يتسع بناء السجن المتهالك لغير 200.
الحقيقة هي أن العراق لا يعاني من قلة المنظمات الحقوقية على الإطلاق، إذ إن هناك مئات المنظمات المحلية، بالإضافة إلى «المفوضية العليا لحقوق الإنسان»، وهي منظمة حكومية تقدم نفسها كهيئة مستقلة شكلت بموجب قانون عام 2008، لتعمل على «ضمان حماية وتعزيز احترام حقوق الإنسان وحماية الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور وفي القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المصادقة عليها من قبل العراق». برلمانياً، هناك «لجنة حقوق الإنسان» المكونة من 12 نائباً (تم تعيينهم وفق نظام المحاصصة)، وتختص هذه اللجنة -حسب موقعها- بثلاث مهمات، من بينها «متابعة شؤون السجناء والمعتقلين في السجون».
دولياً، لدينا فروع 23 منظمة من منظمات الأمم المتحدة التي تغطي كافة جوانب حقوق الإنسان، وعدة منظمات حقوقية دولية تتابع الشأن العراقي، من بينها: منظمة العفو الدولية، وهيومان رايتس ووتش، ومراسلون بلا حدود، ومركز العدالة الانتقالية الدولي، وأطباء بلا حدود.
وأبرز المكاتب، عملياً، وأكثرها نفوذاً هو «مكتب حقوق الإنسان» في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)- الذي تم تأسيسه وفقاً لولاية قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في حزيران 2018، للعمل على «تعزيز المساءلة وحماية حقوق الإنسان والإصلاح القضائي والقانوني من أجل توطيد سيادة القانون»، من خلال العمل «مع حكومتي العراق وإقليم كردستان والحكومات المحلية ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية والمجتمع المدني لتعزيز حقوق الإنسان بطريقةٍ حيادية»، أي وباختصار شديد، إنه يهدف إلى العمل مع كل من يتلفظ أو يدعي أو يمثل حقوق الإنسان من أعلى سلطة في الدولة الى أصغر مؤسسة، مروراً بمنظمات المجتمع المدني والدولي.
هذا كله غيض من فيض من منظمات المجتمع المدني التي يتخصص العشرات منها بشأن المعتقلين والمسجونين. ومن يراجع مواقع هذه المنظمات ويقارنها بما يعرفه تمام المعرفة عن حال المعتقلين اللاإنساني، في عموم البلد، لا بد وأن يتساءل عن جدوى هذا الكم الهائل من المنظمات المحلية والحكومية والدولية، والمواقع الإلكترونية، والمطبوعات الملونة بجداولها وإحصائياتها، والدعم المادي الكبير للمؤتمرات والورشات، والتغطية الإعلامية للوفود وزيارات التفقد لمراكز التأهيل والسجون، وإصدار البلاغات؟
تتراكم المظالم كما حدث في الماضي القريب والبعيد، وتنتقل إلى روح الانتقام، ويختلط العنف مع اللجوء إلى أي داعم خارجي أو إرهابي داخلي مهما كانت أهدافه، فتعود الدورة من جديد، وتسيل الدماء، ويتهدم البلد على رؤوس أهله
هناك، بطبيعة الحال، عدد من المنظمات المستقلة، فعلاً، الجادة في عملها، والتي غالباً ما يجد الناشطون فيها أنفسهم عرضة للتهديد والابتزاز والمضايقات وحتى الاختطاف. منظمات تحاول أن تجد لها حيزاً خارج حدود الفساد والاتهامات الجاهزة بالإرهاب. أما بقية المنظمات، وهي كثر، فإنها تتنافس فيما بينها على الدعم المادي الذي لا يصلها منفصلاً عن تبعية الأجندة السياسية – الطائفية – العرقية. أي أنها تمثل -بحكم التمويل الحزبي والحكومي والفساد- أداة لاستمرارية الخروقات والانتهاكات التي تتظاهر بمحاربتها، ولكن تحت غطاء تمويهي زاه يدعى الديمقراطية وحقوق الإنسان.
من يراجع أعمال هذه المنظمات سيجد صوراً عن لقاءات مع مسؤولين يبتسمون أمام عدسات أجهزة الإعلام وهم يقدمون دروع التقدير إلى ممثلي المنظمات الدولية وهم يؤكدون على «اعتماد السبل القانونية في استقبال الشكاوى والمناشدات ومتابعتها إلى حد إقامة دعاوى قضائية في حال عدم استجابة الجهات المعنية». ويتم تداول هذه التصريحات في القنوات التلفزيونية التي يزيد عددها على 200 قناة تابعة لأحزاب تلتحف بحقوق الإنسان، في الوقت ذاته الذي يستمر فيه التعذيب والاعتقال والموت داخل السجون المكتظة.
كيف يتعامل المواطن، ضحية الانتهاكات، وهو محاط بادعاءات الديمقراطية وحقوق الإنسان؟
النصيحة التي تسديها هذه المنظمات للمعتقلين هي اللجوء إلى القضاء. وهذا ما فعله الطالب علي حاتم السليمان ( 23 عاماً) الذي كان في طريقه من الفلوجة إلى بغداد، عام 2005، لإجراء الامتحانات، وتم اعتقاله في نقطة تفتيش بسبب تشابه اسمه مع شيخ عشيرة متهم بالإرهاب. تم اقتياده إلى مقر للجيش حيث عذب. يقول علي في شهادته التي كتبها مصطفى سعدون، رئيس المرصد العراقي لحقوق الإنسان، بأنه حين تم تسليمه إلى أهله، بعد عشرة أيام من التعذيب، كانت كفاه قد أصيبتا بالغنغرينا، وعظام أصابعه مكسورة ولا يقوى على تحريك يديه، فكان الحل الوحيد هو بتر الكفين. نفد علي النصيحة، فأقام دعوى قضائية في المحاكم. حقق القضاء بما حصل معه، ثم ذهب إلى وزارة الدفاع أكثر من مرة لمقابلة قيادات عسكرية هناك على أمل نيل تعويض. ولا يزال بعد خمسة أعوام من المراجعات بلا تعويض وبلا مستقبل وبلا عقاب للجلادين.
إن وضع حد لهذه الممارسات الوحشية يعتمد، بالأساس، على وجود حكومة تسعى فعلاً لوضع حد لها، قانوناً وممارسة، وبدونها كما بينت تجاربنا وتجارب كل الشعوب، تتراكم المظالم كما حدث في الماضي القريب والبعيد، وتنتقل إلى روح الانتقام، ويختلط العنف مع اللجوء إلى أي داعم خارجي أو إرهابي داخلي مهما كانت أهدافه، فتعود الدورة من جديد، وتسيل الدماء، ويتهدم البلد على رؤوس أهله كلهم مرة أخرى. لن يتم تجنب دورة الانتقام والتخريب إلا بقيام حكومة يرى مسؤولوها أبعد من مصلحتهم الآنية المعجونة بالطائفية والفساد. إلى أن يتحقق ذلك، لعل الضغط على الأمم المتحدة لتعيين مقرر عام لحقوق الإنسان، وإرسال خبراء دوليين مستقلين للقيام بزيارات منتظمة لمواقع الاحتجاز، وإنشاء فريق من مفتشي السجون المستقلين لمراقبة الأوضاع ـ قد يكون خطوة بالاتجاه الصحيح.
العراق: «الشهداء»
لا يقتلون بالقصف الأمريكي!
هيفاء زنكنة
في كل يوم، يقدم لنا مسؤولو النظام العراقي، على اختلاف تدرجاتهم الوظيفية، مثالاً جديداً للاستهانة بالحياة البشرية والكرامة الإنسانية. ففي مقابلة تلفزيونية (قناة التغيير – 7 تموز) مع ناجحة الشمري، مدير عام مؤسسة الشهداء، بدرجة وزير، حول استحقاقات الشهداء وعن إمكانية شمول ضحايا «ملجأ العامرية»، بالاستحقاقات، حالهم حال بقية الضحايا الذين تتبناهم المؤسسة، وبعد أن بين لها الإعلامي أن الضحايا -ومعظمهم من النساء والأطفال- قتلوا جراء القصف الأمريكي المباشر، وهي حقيقة يعرفها الجميع.. قالت السيدة الشمري: لا يمكن اعتبارهم شهداء لأنهم ماتوا اختناقاً. وكان الملجأ قد استهدف بإحدى الغارات الأمريكية على بغداد، يوم 13 فبراير 1991، بواسطة طائرتين من نوع أف-117 تحمل قنابل ذكية، ما أدى إلى مقتل 408 مدنيين. يعيد تصريح السيدة الشمري إلى الأذهان تصريح سيدة أخرى، هي وزيرة الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت، التي قالت عندما سئلت عن وفاة أكثر من نصف مليون طفل جراء الحصار الاقتصادي على العراق.. إنه ثمن مناسب للحصار.
أن تتلفظ وزيرة خارجية دولة فرضت عقوبة الحصار على العراق لأسباب سياسية واقتصادية، أمر قد يفهم، مهما كانت لا إنسانيته، ربما كمؤشر للدلالة على نجاح فرض سياسة القوة. أما أن يصدر من سيدة عراقية تمثل مؤسسة للشهداء العراقيين وتم تعيينها لأنها «ولدت من رحم شريحة ذوي الشهداء»، كما تذكر في سيرتها الذاتية، أي أنها عانت من استلاب حق الحياة، كما تدعي، وتفتخر بدراستها الشريعة الإسلامية وعملها ضمن عديد المؤسسات الدينية والحقوقية، فمن الصعب تقبل التصريح المستهين بحياة 408 ضحية، وحرمان عوائلهم من مستحقات هي من حقهم، خاصة وأن ساسة النظام وذويهم وذوي ذويهم يتمتعون بها، ومن ضمنهم السيدة الشمري التي تذكر في سيرتها أن «قافلة الشهداء في عائلتها تطول».
تم تعريف «الشهيد»، حسب القانون الذي سنه النظام الحالي: هو «ضحية نظام البعث المباد والحشد الشعبي وضحايا جرائم الإرهاب» فقط . ولأهله الحق إما بقطعة أرض أو تعويض مادي قدره 65 ألف دولار، والحصول على تقاعد، وعلاج ذوي الشهداء خارج العراق، ولأولاده أولوية القبول بالجامعات والبعثات الدراسية إلى الخارج، والحج، وأولوية التعيين في الوظائف الحكومية، حيث قامت مؤسسة الشهداء بتعيين (16000) من ذوي الشهداء في وزارات الدولة المختلفة.
يجب ألا يكون رد الاعتبار للضحايا ورعاية ذويهم وتوفير الحياة الكريمة محط استهانة من قبل أية حكومة مهما كان توجهها السياسي. إنه جزء أساسي من سيرورة تحقيق العدالة
على هذا المنوال، وتحت تصنيف لقب «الشهيد»، الموظف طائفياً -بحكم إشاعة فكرة أن نظام البعث كان سنياً والإرهاب سنياً، والضحايا من الشيعة- قامت المؤسسة بالمصادقة على (48894) شهيداً، للفترة من 2/8/2007 ولغاية 01/11/2014، حسب تقرير المؤسسة للفترة المحددة، وسيكون الرقم أعلى بكثير لو ضم التقرير مصادقة المؤسسة على «الشهداء» طوال سنوات حكم البعث. بلغ عدد المستفيدين من عوائل الشهداء الذين تسلموا راتباً تقاعدياً (146475)، وهذا قبل أن تشرع المؤسسة بإضافة «شهداء» الحشد الشعبي، المؤسس بعد فتوى المرجعية بالجهاد عام 2014، بالإضافة إلى عشرات المليشيات المدعومة إيرانياً. بالمقابل، قام النظام الحالي بحرمان الجنود الذين قتلوا أثناء الحرب العراقية الإيرانية (1980 – 1988) من مخصصاتهم كشهداء، بالإضافة إلى عدم الاعتراف بقضايا ضحايا الحصار الجائر (1990 – 2003)، والغزو والاحتلال الإنجلو أمريكي عام 2003، وما ترتب على ذلك من إرهاب حصد الأرواح وزرع الفتنة الطائفية وهدم البنية التحتية.
كان بإمكان السيدة الشمري، وهي المسؤولة برتبة وزير، حسب قانون المؤسسة، والمفترض فيها تحقيق العدالة وتوفير فرص الحياة الكريمة لذوي الشهداء، أن ترد عند سؤالها عن ضحايا الملجأ قائلة إن القانون الحالي لا يعالج كل القضايا، مثلاً، وأملنا أن يتم تصحيح الوضع في المستقبل القريب. هذا، لو حرصت -طبيعة الحال- على مشاعر أهل الضحايا، على الأقل، أو توخت تحقيق العدالة لجميع الضحايا كخطوة أولى في مسار وضع حد للضيم والجور والتصالح مع الذات والمجتمع.
إن موقفاً كهذا، والسيدة الشمري، ليست نموذجاً فريداً من نوعه بين ساسة النظام، هو واحد من مجموعة مواقف تمييزية تدفع إلى تعميق الإحساس بالظلم والتهميش، وبالتالي إشاعة الفتنة الطائفية، يعززها الإحساس بتجيير مؤسسات ذات أهداف إنسانية، على غرار «مؤسسة الشهداء»، إلى وسيلة لمنح الامتيازات وبناء قاعدة اجتماعية طائفية تجسد سياسة النظام المنهجية في الانتقام وإرساء مفهوم انتقائي للعدالة، على كل المستويات. وإلا كيف تبرر مؤسسة تحمل اسماً كالشهداء، يتجذر عميقاً في الموروث الجماعي العربي والإسلامي، بالتضحية والدفاع عن الوطن، بعدم اعتبار من انضم إلى المقاومة ضد الاحتلال الأمريكي – البريطاني شهيداً؟ كيف يمكن تجاهل بطولة من قاوم غزو تسبب بوفاة ما يزيد على المليون مواطن، وتهجير أربعة ملايين، وتخريب مدن بكاملها، وتوفير البيئة لإرهاب الدولة والقاعدة وداعش والميليشيات؟ ماذا عن ضحايا إرهاب مليشيات الأحزاب الحكومية؟ والمفارقة الأكبر، كيف يمكن تبرير أن يجرد من شارك كعسكري في الحرب ضد إيران في الثمانينيات من كونه شهيداً، بينما يمنح اللقب للأسير العراقي « التَواب» الذي أعلن توبته (اختياراً أو تحت التعذيب) وهو في معتقلات إيران، ثم تم إرساله إلى جبهة الحرب للقتال في صفوف القوات الإيرانية ضد العراقية؟ ماذا عن أهالي 1627 عسكرياً أسيراً توفوا في المعتقلات الإيرانية، و1616 ممن وجدت رفاتهم في مقابر على الحدود الإيرانية؟
يجب ألا يكون رد الاعتبار للضحايا ورعاية ذويهم وتوفير الحياة الكريمة محط استهانة من قبل أية حكومة مهما كان توجهها السياسي. إنه جزء أساسي من سيرورة تحقيق العدالة والتأسيس الحقيقي لمجتمع يعمل بجد على التخلص من العلاقات المرضية المشوهة الناتجة عن سياسة حكومات محلية وقوى عالمية تتغذى على تقسيم الناس وانتقائية العدالة حسب مقولة «كل الناس متساوون، لكن بعضهم متساوون أكثر من غيرهم»، للكاتب الإنكليزي جورج أورويل.
٭ كاتبة من العراق
ذوّبوا الليل يا أهل البصرة
هيفاء زنكنة
عاد المتظاهرون، بمدينة البصرة في جنوب العراق، إلى الشوارع من جديد في الشهر ذاته تقريباً، كما في العام الماضي، كما لو كان سكان المدينة الغنية بالنفط، يستعيدون ذكرى تظاهراتهم واعتصاماتهم، التي لم تثمر شيئا في العام الماضي. عادوا، كما في الزيارة السنوية للأماكن المقدسة، وهم يحملون المطالب ذاتها: الخدمات الأساسية، كالتزود بالكهرباء والماء، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة التي قاربت خمسين درجة مئوية، وحق العمل. وأضيف إليها، هذه الأيام، مطلب إنصاف المتضررين من احتجاجات العام الماضي، ومحاسبة المتسببين. لا تخلو المظاهرات من أصوات منفردة تطالب بوضع حد لنفوذ الميليشيات المتحكم بحياة الناس أكثر من الحكومة.
كانت تظاهرات العام الماضي قد تأججت نهاية شهر حزيران/ يونيو، وواجهتها القوات الأمنية باستخدام الذخيرة الحية، وقتل متظاهرين سلميين، بالإضافة إلى تنفيذها حملة اعتقالات تعسفية وتعذيب المعتقلين. وصل عدد ضحايا الاحتجاجات إلى 13 قتيلاً ومئات الجرحى، واكتفى خلالها ساسة الحكومة بإطلاق التصريحات الهوائية والوعود الفارغة بحل المشاكل ووضع آليات عمل، وتشكيل لجان لمتابعة عمل لجان أخرى تم تشكيلها لتهدئة الغضب سابقاً، ورسم مسار إستراتيجي للنهوض بواقع الخدمات!
أصاب الصحافيين، خلال تغطيتهم الاحتجاجات وقضايا الفساد في العام الماضي، رشاش القمع؛ إذ قامت الأجهزة الأمنية، بين 14 تموز/يوليو و6 أيلول/سبتمبر 2018، بالاعتداء على سبعة صحافيين من جميع أنحاء العراق واعتقالهم، وتم إحراق مكاتب اثنين من وسائل الإعلام المحلية. وسجل تقرير للجنة حماية الصحافيين، ومقرها نيويورك، حالات مغادرة أربعة صحافيين محافظة البصرة، بعد أن قامت الميليشيات المسيطرة هناك بتهديدهم بالقتل.
بالنسبة إلى الوضع الحالي لا يبدو، حتى الآن، أن هناك اختلافاً كبيراً، سواء في سيرورة التظاهرات أو الاستجابة الحكومية؛ إذ أعلن المتظاهرون أنهم سيستمرون حتى تحقيق المطالب، ووجهوا النداء إلى مختلف شرائح المجتمع للخروج معهم، في الأيام المقبلة. بينما شرعت القوات الأمنية بإطلاق التهديدات ضدهم وضد الصحافيين في حال تغطيتهم المظاهرات. بل واستبقت الأحداث باعتقال كادر قناة السومرية المكون من مراسلة ومصور أثناء تصويرهم التظاهرات قبل أيام. ولم يتم إطلاق سراحهما إلا بعد تدخل وزير الداخلية شخصياً، مما يثير التساؤلات حول سلامة الصحافيين المستقلين في حال رفض وزير الداخلي التدخل، في بلد معروف بغياب القضاء النزيه، وعمل الصحافي في بيئة مسيّسة تعتبر وسائل الإعلام أدوات سياسية قبل أي شيء آخر. وكانت السلطات قد حذرت، في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وسائل الإعلام من إظهار عدم احترامها «للرموز الوطنية أو الدينية»، ما يجعل الصحافي عرضة للاعتقال والسجن حالما يكتب عن أي سياسي أو معمم «يقدم نفسه» كرمز وطني، الأمر الذي يرسخ، بقوة، مكانة النظام العراقي بين بقية الأنظمة العربية المبدعة في ابتكار أساليب تكميم أفواه أبناء الشعب عموماً والصحافيين خصوصاً. إذ ترى في الصحافي المستقل أداة تخشاها أشد الخشية إن لم تتمكن من شرائه، إما بالمال والتهديد والابتزاز والاعتداء الجسدي، أو الاختطاف والقتل.
من الواضح أن قائد عمليات البصرة ذا الرتبة العسكرية العالية لا يعتمد في عمله أو تصريحاته على احترام الدستور، بل على ترهيب وترويع المواطنين عموماً، ومنهم الصحافيون
ضمن هذا المسار، وقف قائد عمليات البصرة، قاسم نزال، أمام الكاميرات ليحذر وسائل الإعلام، قائلاً: «إن الإعلامي الذي نلزمه بتظاهرة غير مرخصة راح ايكون بالتوقيف موجود إن شاء الله»، ما معناه، باللهجة العراقية، أنه تهديد صريح للصحافيين بالاعتقال وما يترتب عليه، في حال تغطية الصحافيين للتظاهرات في محافظة البصرة، حسب مرصد الحريات الصحافية، الذي دعا «القائد العام للقوات المسلحة» إلى تبيان موقفه من التهديد، الذي يعتبر «مخالفة واضحة لبنود الدستور العراقي» الذي جاء في مادته الـ(38): «تكفل الدولة حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل، وحرية الصحافة، بالإضافة إلى حرية الاجتماع والتظاهر السلمي».
من الواضح أن قائد عمليات البصرة ذا الرتبة العسكرية العالية لا يعتمد في عمله أو تصريحاته على احترام الدستور، بل على ترهيب وترويع المواطنين عموماً، ومنهم الصحافيون. ولا بد أنه -إما لغبائه المنسوج بالعنجهية أو لسذاجته- لم يسمع بوجود بدائل إعلامية بإمكان المتظاهرين اللجوء إليها في حال قيامه باعتقال الصحافيين. وهي بدائل أو أساليب تكمل ما هو موجود، توصلت إليها الشعوب لمناهضة القمع السلطوي المباشر. هناك، مثلاً، «صحافة المواطن» التي باتت منذ ما يزيد على العقد منافسة للصحافة التقليدية، أو مكملة لها، لتمتع ممارسيها بميزات قد لا تتاح للصحافي المحترف، خصوصاً إذا كان الصحافي عرضة للمراقبة والتهديد والمنع من ممارسة مهنته من قبل الأجهزة القمعية، كما هو حال الصحافيين المستقلين بالعراق مثلاً.
وشرعت «صحافة المواطن» الأبواب التي كانت مقتصرة على الإعلام التقليدي في نقل الأخبار وتحليلها. أما الآن فبإمكان كل مواطن يملك كاميرا أو هاتفاً جوالاً مزودا بكاميرا، أن ينقل الخبر إما بنفسه على صفحات التواصل الاجتماعي، «فيسبوك وتويتر وإنستغرام» وغيرها، بالصور والفيديو والمدونات والرسائل السريعة الناقلة للأخبار لحظة بلحظة، أو عبر التواصل المباشر مع أجهزة الإعلام التقليدية، وتزويدها بالصور والتعليقات والتحليل، أو تنبيهها إلى ما يجري من أحداث فور حصولها، كما لو كان المواطن مراسلاً من مكان الحدث. هذه الإمكانية المتوفرة للجميع ساعدت، في السنوات الأخيرة، على تغيير ميزان القوى بين المتظاهرين والقوات الأمنية، وقللت إلى حد ما من وحشية الإجراءات القمعية التي تمارسها هذه القوات، في البلدان العربية، ضد المتظاهرين سلميا. كما ساعدت على استقطاب أفراد جدد إلى الحركات الناشطة المطالبة بالتغيير السلمي لأوضاع لم يعد بالإمكان السكوت عليها.
في العام الماضي، أدركت الحكومة خطر هذا الأسلوب عليها، فعمدت إلى قطع الإنترنت لمنع انتشار الصور والفيديوهات المصورة التي جرى التقاطها، سواء من قبل المواطنين أو الصحافيين، والتي تظهر قمع السلطات للتظاهرات السلمية. وهو تعتيم متعمد منح القوات الحكومية تفويضاً بالقمع دون خشية انتشار الأخبار. إلا أن المتظاهرين يعرفون جيداً أن قطع الإنترنت لا يمكن أن يدوم إلى الأبد، ما يوفر لهم سلاحاً يضاف إلى بقية مستويات مقاومة الظلم والقمع والفساد، بشرط توخي المصداقية وألا يكونوا الوجه الآخر لعملية التزوير الحكومية.
كاتبة من العراق
علاقة الحب والكراهية بين أمريكا وإيران
هيفاء زنكنة
مع تصاعد دقات طبول الحرب الأمريكية ضد إيران، بدأنا نسمع صداها، فرحًا، في قلوب شخصيات وأحزاب عراقية ترى في الحرب «تحريرًا» من الاحتلال الإيراني. بل وبلغت الحماسة بالبعض حدًا جعلهم يغردون ويتبادلون التهاني بقرب الخلاص، مهددين إيران بقوة أمريكا وضربات الرئيس ترامب التي لا ترحم. بيانات ورسائل على «فيسبوك» وصور كاركاتيرية، وهي مشاعر ومواقف قد يكون هناك ما يبررها بحجة إنقاذ البلد والتخلص من «الاحتلال»، لولا أن هذه المجموعات والأحزاب ذاتها وقفت بقوة عام 2003 ضد الاحتلال الأمريكي، الذي تبنته وبررته في الوقت ذاته أحزاب عراقية أخرى (ولا تزال)، بذريعة «التحرير» أيضًا. وهو تبادل سريع للمواقع والتغير في فترة زمنية قصيرة نسبيًا من منظور القيم الأخلاقية على الأقل، ويقدم صورة هلامية عن مبادئ كانت تعتبر، حتى وقت قريب، قيمًا ثابتة المعاني، لا يتطرق إليها الشك، في العلاقة بين الشعوب ومحتليها مهما كانت هوية المحتل.
فكيف تحول الغازي المحتل إلى المنقذ المنتظر؟ ما الذي يدفع هذه الأحزاب التي كانت مناوئة للاحتلال الأمريكي إلى الاستنجاد بأمريكا؟ وهل هناك ما يضمن ثبات السياسة الأمريكية تجاه شعوب المنطقة؟
في شبكة العوامل الداخلية والخارجية المتداخلة والمتصارعة سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا، بالإضافة إلى الصراع الديني-المذهبي الدامي، على غنيمة العراق، تبرز أكثر من غيرها تعقيدات علاقة أشبه ما تكون بعلاقة يتخللها هاجس الحب-الكراهية، بصعوده ونزوله بين الإدارة الأمريكية والنظام الإيراني. مهر المحب هو العراق، الوزة التي تبيض ذهبًا. تختلف هذه العلاقة عن الأمثلة التاريخية المعروفة بين المستعمِر والمستعمَر. إذ لم تتعرض إيران إلى احتلال أمريكي مباشر، كما العراق مثلًا، مما انعكس على نوعية العلاقة بين الطرفين. فتتم المناوشات، حتى عند صعودها إلى أسوأ مستوياتها، مهددة بالعنف والاقتتال في بيوت الجيران وليس في البيت الأمريكي أو الإيراني، كما رأينا في لبنان وسوريا والعراق.
هذا الصعود والنزول في العلاقة، ونقل ساحة الصراع إلى بيوت الجيران، ومن ثم التوصل إلى هدنة، بشكل أو آخر، يوضح عرض النظام الإيراني مساعدة أمريكا في تسهيل شؤون احتلال العراق، «فنحن أدرى بالعراق»، كما صرح مسؤول إيراني، حينئذ، لإغراء الإدارة الأمريكية بقبول النظام كشريك. كان الهدف هو أن يتم تجنب نقل الصراع بأي ثمن كان إلى داخل البيت الإيراني لحين استشراف ملامح وخارطة العلاقة المستقبلية، بعد «تنظيف» بيت الجيران ممن كان يعترض على وجودهما غير المرحب به.
علاقة أشبه ما تكون بعلاقة يتخللها هاجس الحب ـ الكراهية، بصعوده ونزوله بين الإدارة الأمريكية والنظام الإيراني
ما لم يكن حسبان الطرفين هو بروز المقاومة التي وإن لم تنتصر بمعنى التخلص الكلي من الاحتلال بشقيه الأمريكي والإيراني، إلا أنها نبهت الإدارة الأمريكية إلى وجود شعب لم يستقبل الاحتلال بالزهور والحلويات، كما طمأنها عراقيون قبل الغزو. ونبهت إيران إلى وجود أصوات مغايرة لمن راهنت على استقبالهم لها داخل البيت، بل ومنحها عقد ملكية الدار بكامله.
جرت سياسة الإقصاء الطائفي، وانبثاق المقاومة المسلحة، إلى لجوء المحتلين، الأمريكي والإيراني، إلى تقوية أدواتهما للهيمنة أولًا، ومن ثم تهيئة الأرضية للتوافق فيما بينهما على حساب العراق. فاستخدمت، بالإضافة إلى القصف والتفجيرات والعقاب الجماعي وحملات الاغتيال المستهدفة للأصوات المستقلة، أسلحة ذات مفعول أعمق وأكثر ضررًا على المدى البعيد من مجرد القتل المباشر؛ أسلحة تستنزف بنية المجتمع وتآخيه لتتركه منهكًا، غير قادر على المقاومة أو المبادرة، لا يطلب شيئًا في الحصيلة غير البقاء على قيد الحياة، مرددًا وهو يرفع يديه عاليًا باتجاه السماء: «حسبنا الله ونعم الوكيل».
أصبح العراق سوقًا مفتوحة على مدى 24 ساعة يوميًا، لميليشيات ومنظمات طائفية انبثقت كأذرع الأخطبوط، إما كأدوات معدة للتخريب الممنهج، أو كنتيجة حتمية للاحتلالين. فانتشرت الميليشيات المدعومة إيرانيًا، التي سارع بعض الشباب للانضمام إليها؛ لأنها وظيفة مضمونة الراتب في الحياة الدنيا، ومضمونة الفردوس في الحياة الأخرى. بينما سارع آخرون للانضمام إلى منظمات مسلحة؛ لأنها وعدتهم بدولة الخلافة في الحياة الدنيا، والفردوس في الحياة الأخرى. تكشف الوثائق المسربة، سواء من قبل «ويكليكس» أو غيرها، حجم اختراق هذا المحتل أو ذاك في هذه المنظمات، وحجم التسليح المتطور لكل الجهات من قبل مصادر التسليح ذاتها.
إن مرور 16 عامًا على الغزو الأمريكي الذي هيأ للاحتلال الإيراني، جذَّر انقسامًا مجتمعيًا يغذيه الفساد والمصلحة الفردية المرتبطة بهذه الفئة أو تلك، بحثًا عن الحماية الجسدية والمادية، بدون أن تمتد أو تتوسع لتشمل الجميع، قوامها الخوف من الآخر لدى البعض، والنظر إلى الماضي بنوستالجيا مرضية لدى البعض الآخر. وإذا كان مزيج الإحساس بالمظلومية والعجز عن أحداث التغيير وتغليب المصلحة الفردية/الفئوية على مصلحة الوطن، هو الذي دفع البعض إلى التحالف مع المحتل الأمريكي في غزوه لبلدهم، عام 2003، وإلى فتح الأبواب مشرعة للنظام الإيراني، فإنه هو ذاته عمليًا ما يدفع الأحزاب والشخصيات التي ناهضت الاحتلال الأمريكي إلى الترحيب بشن الحرب ضد إيران لإزالتها؛ لأنها-كما يحاججون- مرض الإيدز، أما أمريكا وإسرائيل فإنهما مرض الجدري! ما يعني، ضمنيًا، عرض أنفسهم كبديل للنظام الحالي.
إن الأحزاب التي تعاونت مع المحتل الأمريكي، عام 2003، لم تفكر أو لم تعبأ بما سيجلبه الاحتلال من خراب على الشعب والبلد. كما أن الأحزاب والشخصيات المهللة، حاليًا، لقصف إيران لا تفكر إطلاقًا بما سيجره ذلك من نتائج كارثية على الشعب العراقي أيضًا. فمن ناحية الهجوم الأمريكي، العراقيون أدرى من غيرهم بمعنى ذكاء الصواريخ ودقة الاستهداف واعتبار الضحايا خسائر جانبية. ومن ناحية «الدفاع» الإيراني، العراقيون أدرى من غيرهم بهمجية الميليشيات والسيارات المفخخة والتفجيرات والاغتيالات، فهل فكر مشجعو الإدارة الأمريكية بالفعل الأمريكي، ورد الفعل الإيراني على الشعب العراقي، وهو الرهينة على أرض لن تتوانى كل الأطراف عن استخدامها كساحة لتحقيق النصر؟ وماذا عن الشعب الإيراني؟ إذا كنا نحرص دائمًا على التمييز بين الحكومات العربية المستبدة والشعوب، فلمَ لا نفعل الشيء ذاته مع إيران؟
لحسن الحظ، أوقف الرئيس الأمريكي إطلاق الصواريخ على إيران قبل التنفيذ الفعلي بدقائق. لعل الرئيس الأمريكي، ترامب، أدرك أنه على وشك تجاوز خطوط اللعبة المحددة مع إيران.
مهما تكن الأسباب، هذه هي المرة الأولى التي يتنفس فيها الناس الصعداء، وأنا منهم، ليس إعجابًا بالإدارة الأمريكية؛ إذ إنها أساس البلاء الذي نعيشه، ولا حبًا بنظام الملالي الشمولي الذي لن يتقاعس عن إرسال أطفاله للموت، بعد أن يضع في أعناقهم «مفاتيح الجنة»، ولكن حرصًا على أهلنا في المنطقة كلها.
على شعوب الدول الغربية أن تثور أيضاً
هيفاء زنكنة
عن أعداد اللاجئين جراء الحروب والاحتلال والاضطهاد، بأنواعها، أخبرتنا المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، منذ أيام، بأن إجمالي العدد وصل حوالي 71 مليون وهو أعلى رقم تسجله منذ 70 عاماً. مما يعني، إذا ما حاولنا تقريب الرقم الى الاذهان، أن هناك 37 ألف مشرد جديد، في العالم، يوميا، يلقى الكثير منهم حتفه وهو يحاول الوصول إلى أوروبا، بحثاً عن الأمان. مقابل ذلك، انخفض عدد المسجلين كلاجئين في مختلف الدول، حسب السياسة الحكومية المتبعة تجاه اللاجئين، مما يعني زيادة عدد مخيمات/ مجمعات/ دور القصدير/ كارافانات النازحين وتحولها، وهذه ظاهرة مرعبة، من مخيمات مؤقتة تفي بالحاجات الانسانية المؤقتة، الى أماكن بقاء دائمة، تمتد وتتوسع، عبر الاجيال، حاملة في أسس إنشائها معاني الظلم والتهميش والتمييز بأنواعه. ولأن بعض النازحين يولدون في المخيمات ويقضون معظمم حياتهم هناك، تصبح حياتهم ذاتها موسومة بكل ما هو غير مستقر، من التعليم والرعاية الصحية الى الطموح المستقبلي ومعنى الحياة.
من الحقائق المعروفة أن 40 في المئة من اللاجئين (خارج بلدانهم) والنازحين (داخل بلدانهم) في العالم، أي 28 مليون أنسان، هم من البلدان العربية، وبشكل أساسي من فلسطين (6) وسورية (13)، بالإضافة الى العراق (5) واليمن (2). وتعتبر مخيمات المهجرين الفلسطينيين المتوسعة، مع ولادة كل طفل، منذ النكبة عام 1948 وحتى اليوم، هي النموذج الأوضح لحياة انسان، يجبر على مغادرة بيته قسراً ويعيش حياة محكومة بمنعه من حق العودة جراء الاحتلال الاستيطاني.
أدى تجذر التعاون بين الدول الإمبريالية والأنظمة المستبدة في المنطقة العربية، في العقود الأخيرة، الى انتشار مخيمات النازحين واللاجئين على وجه خارطة المنطقة، مهددة إياها ببناء مدن من نوع جديد وولادة جيل جديد من السكان، سيكون همه الاول، إذا لم يتمكن من العودة إلى بيئته التي حرم منها، هو الهجرة بأي شكل كان وبأي ثمن كان.
ففي مخيم الزعتري، المقام في الأردن، لاستقبال اللاجئين السوريين منذ انتفاضة 2011، يولد يوميا ما بين 12-15 طفلاً، ويعيش فيه أكثر من 90 ألف لاجئ، ثلثهم ولدوا فيه، وحجمه بحجم مدينة في الأردن. ووصل عدد سكان مخيم دوميز 1، من السوريين في إقليم كردستان العراق، المنتصب أساسا لاستقبال ألف شخص فقط، إلى 33,000 نسمة، تبعه إنشاء مخيم دوميز 2، ثم مخيم ديباكة، الذي أنشئ لاستيعاب 5000 شخص، لكنه استقبل أكثر من 36 ألف في أقل من ستة أشهر مع زيادة النزوح من القرى والأقضية القريبة من الموصل.
أدى تجذر التعاون بين الدول الإمبريالية والأنظمة المستبدة في المنطقة العربية، في العقود الأخيرة، إلى انتشار مخيمات النازحين واللاجئين على وجه خارطة المنطقة
وإذا كانت القوى العظمى، بقيادة أمريكا، متفقة حول توفير الحماية للأنظمة العربية الاستبدادية التي تؤدي دورها في الهيمنة والاستغلال بالنيابة، مما يوضح حقيقة أن الغالبية العظمى لحالات اللاجئين طويلة الأمد في العالم موجودة في الدول النامية، فإنها تبدي بعض التفاوت الطفيف في قبولها للاجئين الهاربين من بلدانهم جراء سياستها الخارجية.
فبينما تميل الإدارة الأمريكية نحو تقليد الكيان الصهيوني في بناء جدران العزل العنصري ومنحه معنى أوسع ليشمل حظر حركة الشعوب، تمارس الحكومة البريطانية، الحليف الرئيسي لأمريكا في أوروبا، سياسة لا تقل عنصرية عن أمريكا، في قبولها اللاجئين، ولكن بأسلوب أقل عنجهية. ففي الوقت الذي استقبلت فيه بنغلادش، بميزانيتها القليلة، ما يزيد على المليون لاجىء من المسلمين الروهانجا، تضع الحكومة البريطانية شروطا قاسية لقبول اللاجئين وتخضعهم، لإجراءات تزيد من تدهور أوضاعهم النفسية، في حال قبولهم. من بينها إجراءات معيقة للم شمل الأسرة والذي نوقش قراره يوم 20 حزيران/يونيو الحالي، في البرلمان البريطاني، بعد أن طالب أحد النواب بإعادة النظر فيه وإجراء تعديلات عليه ليتماشى مع قوانين اللجوء الدولية، متسائلاً عما إذا كانت المملكة المتحدة والمجتمع الدولي قد قاما فعلاً بكل ما في وسعهما لحل هذه المشكلة.
هذا النقاش يقودنا الى التساؤل حول امكانية حل أية مشكلة كانت بدون معرفة الاسباب المؤدية اليها ومن ثم معالجتها، وما لم تتغير وجهة النظر الرسمية الأمريكية – الأوربية تجاه اللاجئين لتعترف بأنهم مضطرون لمغادرة بلدانهم لا حبا أو طمعا بأمريكا وأوروبا بل للمحافظة على حياتهم وحياة أبنائهم، من احتلال وحروب ونزاعات، غالباً ما يكون سببها هذه الدول نفسها. وبما أن هذا الاعتراف بعيد المنال، الى حين، ونظراً لتفاقم أعداد وسوء أوضاع اللاجئين، قدمت الأمم المتحدة وعديد المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال برامج تؤكد على الالتزام بالتضامن الدولي وتقاسم المسؤولية، وبدأت بتنفيذ بعض بنودها وإن لا يزال معظمها مجرد حبر على ورق، خاصة بعد أن أصبحت مأساة اللاجئين تجارة رائجة ومصدر ربح لبعض الدول والشركات الكبرى والأفراد بالإضافة الى الفساد المالي الذي يلتهم أموال المعونات والمنح عبر الوسطاء.
تقترح لجان الأمم المتحدة أن الحل الوحيد هو العودة الطوعية، وان تعمل الحكومات الوطنية على احترام مبدأ العودة الطوعية، وضمان أمن العائدين، والحماية الكاملة لحقوقهم. محذرة من أن عودة اللاجئين الى الوطن قبل الأوان نتيجة عوامل الدفع من بلدان لجوئهم سينتهي بهم المطاف، على الارجح، في مجمعات مؤقتة بديلة، أو يعودون الى بلد اللجوء، أو أن يصبحوا مهاجرين غير نظاميين. كما يمكن أن تكون العودة غير الطوعية عاملاً مزعزعاً للاستقرار في بلدان الأصل، مما يعجّل بتجدد التوتر وحتى تجدد العنف. هذه الصورة تنطبق، أيضاً، على عودة النازحين إلى مناطقهم التي أجبروا على مغادرتها بعد تهديم بيوتهم لأسباب طائفية أو دينية أو عرقية.
ان ما تطرحه برامج الأمم المتحدة من حلول ستساعد على حل مأساة اللاجئين والنازحين ولكن فقط حين تتوافر إرادة سياسية حقيقية لمعالجة القضايا التي أدت الى النزوح واللجوء أساسا، من قبل المجتمع الدولي والحكومات الوطنية، وأن تعمل كل الجهات المعنية على وضع حد لمنهجية اعتبار المنطقة العربية سوقا لتصريف السلاح وثمنا لحماية الحكام الفاسدين. وهذا لن يتحقق بانتفاضات شعوبنا فقط، فقد انتفضت وثارت الشعوب العربية بما فيه الكفاية سواء ضد الاستعمار في حقبة ما قبل التحرر الوطني وضد الاستبداد في حقبة ما بعد التحرر. لن يتجسد الحل لإنهاء الظلم وتحقيق العدالة، على كل المستويات، ما لم تنتفض شعوب الدول الغربية، أيضاً، على حكّامها، لتغيير سياستها الخارجية والعمل سوية، مع بقية شعوب العالم، من أجل تغيير حقيقي.
العنف الجنسي
لا يقتصر على المرأة فقط
هيفاء زنكنة
لا يمكن للقوات الأمنية، بأمرة الأنظمة القمعية، إلا أن تلجأ إلى أكثر الأساليب انحطاطا لتكميم الأفواه والهيمنة على الشعب. هذه حقيقة لم يعد بالإمكان التشكيك بها، لأنها من صلب وجود هذه الأنظمة التي تتغذى على العنف، بأنواعه، وأكثره سفالة هو الاغتصاب الذي لم يعد يقتصر على النساء كسلاح لمنعهن من المشاركة بأي نشاط عام بل وامتد بممارساته الكريهة ليشمل الأطفال والرجال، في بلدان عديدة، تمزقها الحروب أو حين تشهد تظاهرات احتجاجية، مهما كانت سلمية مسارها. وما حدث في السودان، في الأسابيع الأخيرة، نموذج لسلوك الأنظمة القمعية حيث ارتكبت وحدة قوات التدخّل السريع «الجنجويد»، المتنفذة ضمن وحدات الأمن، والتابعة لنائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو، عديد الانتهاكات وبضمنها اغتصاب نساء ورجال، أثناء فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش منذ 3 يونيو/حزيران، حسب مصادر متعددة.
يكاد لا يخلو بلد عربي من الجرائم الوحشية ذاتها التي نشهدها، حاليا، في السودان، وإن كان على مستويين هما بسبب المشاركة في التظاهرات أو الاعتقال. فسجل العراق وليبيا وسوريا، حافل، يدل على خوف الأنظمة المزمن من شعوبها وحاجتها الماسة إلى سلب كرامة الشعوب بأي أسلوب كان. وليس هناك ما هو أكثر نجاحا، بالنسبة إليها، من الهيمنة على أجساد الضحايا لسحق الكبرياء وإذلالهم. وقد شهد العقد العربي الأخير، تطور آلية الحد من مشاركة أفراد الشعب، خاصة المرأة، في أي حراك اجتماعي، من التهديد بالضرب أو الاعتقال أو إعاقة الحركة إلى استخدام انواع كانت نادرة، نسبيا، كالاختطاف والقتل والاغتصاب. ففي العراق، أصبح اختطاف المتظاهرين وضربهم ومن ثم إطلاق سراحهم والسماح لهم بالحديث عما عانوه، ليكونوا أمثولة تخيف الآخرين، شائعا. كما، بين الحين والآخر، اختطاف أحد الناشطين وتغييبه، لتصل درجة الترويع حدا أقصى. وإذا كانت المرأة العراقية قد استحوذت على حصة كبيرة من التهديد بالقتل أو الاغتصاب، وتنفيذهما، فعليا، في حالة المعتقلات والسجينات، منذ غزو العراق عام 2003، فإن القتل والاغتصاب طالا الرجال أيضا، في سجون الاحتلال الأمريكي والبريطاني والحكومات العراقية على حد سواء. حيث أصبح التهديد بالاغتصاب أو الاغتصاب الفعلي، ضد الاثنين، معا، ليمس «الشرف» كقيمة اجتماعية وأخلاقية عالية، متناميا بشكل طردي مع ازدياد شراسة الأنظمة في استقتالها للدفاع عن مصالحها، وثقة الجناة بعدم محاسبتهم وتقديمهم للعدالة.
ويتطابق ما ارتكبه الجناة في لسودان ضد المرأة المشاركة في التظاهرات مع المرأة المصرية التي عاشت التجربة نفسها أثناء اعتصامات ميدان التحرير وأماكن أخرى، واحيانا لمجرد وجودها في الأماكن العامة، حيث انتشرت مجموعات التحرش التي تعتدي على الفتيات بطريقة منظمة مما دفع الحكومة إلى سن قانون يجرّم التحرش الجنسي بعد تزايد الضغوط لمكافحتها.
إذا كانت المرأة العراقية استحوذت على حصة كبيرة من التهديد بالقتل أو الاغتصاب وتنفيذهما فعليا، في حالة المعتقلات والسجينات، منذ غزو العراق عام 2003، فإن القتل والاغتصاب طالا الرجال أيضا
ويُعدّ العنف الجنسي ضدّ الرجال والفتية في سوريا من بين انتهاكات حقوق الإنسان التي قام «مشروع جميع الناجين» والأمم المتحدة بتوثيقها، بدءًا من سبتمبر/أيلول 2017 وحتى أغسطس/آب 2018، ليضاف إلى قائمة العنف الجنسي ضد المرأة والفتيات. وهي تفاصيل قلما يتم التطرق إليها من قبل الضحايا والمنظمات الحقوقية معا. حيث يقتصر عمل المنظمات على توثيق حالات العنف ضد الفتيات والنساء باعتبار الجناة رجالا، بالإضافة إلى «الصور النمطية السائدة حول «الرجولة» التي تُعزّز التصورات في أوساط العاملين في المجال الإنساني بأن بإمكان الرجال رعاية أنفسهم وأنهم ليسوا بحاجة إلى المساعدة»، كأن العالم كان بحاجة إلى رؤية صور التعذيب في «أبو غريب» وخاصة المجندة الأمريكية ليندي انجلاند بابتسامتها المنتشية وسط الضحايا العراة، ليعرف أن الجلاد واحد، أيا كان جنسه. ولا فرق في تأثير هذه الانتهاكات الجسيمة على نفسية الضحايا. حيث يعانون، حسب التقرير، من الإحساس بالعار، وفقدان الثقة بالنفس، واضطرابات النوم، والإحساس بقلّة الحيلة، والشعور بالارتباك، والتفكير في الانتحار. وينتاب الناجون من الرجال الإحساس بفقدان الذكورة ولوم الذات. وتُعزى هذه المشاعر إلى الثقافة المجتمعية والتوقعات السائدة من الرجال والفتية، باعتبارهم مسؤولين عن حماية أنفسهم وعوائلهم.
تبين شهادات عديد الضحايا سواء من المشاركين بالتظاهرات أو المعتقلين السياسيين بالإضافة إلى المنظمات الحقوقية المحلية والدولية أن الخطوة الأولى لوضع حد لهذه الانتهاكات البشعة هي كسر حاجز الصمت والعمل على مقاضاة الجناة. قد لا يكون هذا سهلا، لمن يعيش في ظل نظام قمعي أو احتلال، إلا أنه حق إنساني وقانوني وأخلاقي يجب عدم التخلي عنه مهما طالت السنين، إن لم يكن من أجل الضحايا أنفسهم فمن أجل أبنائهم، لئلا تتكرر المأساة. ولدينا في تقدم ثلاثة مواطنين كينيين، يمثلون آلاف الضحايا، بقضية ضد الحكومة البريطانية لأنهم تعرضوا للتعذيب من قبل قوات بريطانية أثناء انتفاضة الماو ماو في خمسينيات القرن الماضي، سابقة تستحق التقليد والتقدير. فقد ارتكبت هذه الجرائم في فترة الاحتلال البريطاني لكينيا قبل أكثر من ستين عاما، لكن الاغتصاب من الجرائم التي لا تسقط بمرور أي زمن، وقد استغرقت القضية سنوات، إلا أن الضحايا رفضوا التخلي عن حقهم، ونجحوا في أجبار الحكومة البريطانية عام 2013 على دفع تعويضات والاعتراف بممارسة التعذيب ضدهم ومن بينهم رجل تعرض للإخصاء وامرأة تعرضت للاغتصاب. وقدمت المحكمة سابقة قانونية من ناحية الإقرار بتجريم التعذيب الذي مورس على الضحايا، ذكورا أو أناثا، باعتباره عنفا جنسيا وليس جسديا فقط. ويوضح مركز العدالة الانتقالية الدولي مصطلح «الانتهاكات الجنسية» بأنه يمكن أن يأخذ أشكالا متعددة، بما في ذلك الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والاستعباد الجنسي والتعرية القسرية والإجبار على القيام بأفعال جنسية مع الآخرين. وهو تعريف ينطبق، بكل بساطة، على ممارسات سلطة الاحتلال الأمريكي ـ البريطاني والحكومات العراقية المتعاقبة، بالإضافة إلى بقية الأنظمة العربية القمعية. وسيبقى انتهاك الجسد أداة لسلب الكرامة الإنسانية، ما لم تتوصل الجماهير إلى التخلص من الأنظمة القمعية، وإقامة حكم يمثلها، تكون واحدة من مهامه الأولى مقاضاة الجناة، وخاصة أفراد قوات الأمن الذين يفترض بهم حماية الناس.
كاتبة من العراق
المظاهرات السلمية
بين لندن والسودان
هيفاء زنكنة
أكد إطلاق النار على المتظاهرين في الخرطوم وسقوط الضحايا ما نعرفه جيدا عن وحشية الأنظمة الاستبدادية المستندة إلى قوة السلاح، وخوفها العميق من أي حراك شعبي قد يستهدف هيمنتها، مهما كان مسالما. أكد، أيضا، أن الشعوب العربية تخوض مواجهة يومية، إزاء أنظمة تخاف مطالبة الشعوب بحقوقها وتتمترس خلف شعارات تسرقها من الشعوب نفسها، لتتفوه بها من على منصات مبنية من أجساد الضحايا. إنها أنظمة تعمل، بشكل منهجي، منذ عقود، على تغيير مفهوم « العدو». لم يعد العدو احتلالا أو استعمارا أو هيمنة أمبريالية، بل العدو هو الشعب، فهي تخاف شعوبها أكثر من الاحتلال والاستعمار وكل ما تربينا عليه من مفاهيم حول الوطن والوطنية. الشعب بمنطق الاستبداد و»الحرب على الإرهاب»، هو من يهدد الأمن وبالتالي يتوجب التخلص منه، بكل الطرق الممكنة.
وباستثناء الحالة الجزائرية الحضارية التي لم يستخدم فيها العنف ضد المتظاهرين قط في أشهر الاحتجاج الأربعة فإن القمع الوحشي، والتهجير القسري والاغتيالات هي ملامح أولية لخارطة انتهاكات مخيفة تعرض ويتعرض لها المواطن العربي في فلسطين والسودان واليمن والعراق والسعودية ومصر وسوريا والبحرين وليبيا. لينضم بذلك إلى الواقفين (بالكاد) تحت مظلة «عولمة العنف» في إيران وتركيا ومنها إلى افريقيا ودول أمريكا اللاتينية، على اختلاف درجات العنف، حسب تنويعات وابتكارات الأجهزة الأمنية المحلية والدولية.
من خراطيم المياه إلى الرصاص المطاطي إلى رش المتظاهرين بالرصاص الحي في العراق، واستهدافهم بواسطة القناصين والطائرات بلا طيار في غزة لتكون النتائج، على الرغم من استمرار الجماهير بالاحتجاج بطرق سلمية، غالبا، أما مخيبة للآمال ومحبطة للتوقعات أو بعيدة المدى، من ناحيتي التراكم الكمي واثارة الانتباه عالميا، ولا تمنح المتظاهرين حلولا تضع حدا لمعاناتهم، إلى حين، ليتمكنوا من استعادة قواهم وتوفر لهم فسحة للتفكير على المدى البعيد.
وإذا كانت التظاهرات مرتبطة بأذهاننا بمحاربة الاستعمار، وحاضرنا بمحاربة متلازمة الأنظمة الاستبدادية والاحتلال، فإن اللجوء إليها لا يقتصر على بلداننا، بل إنها أداة طالما استخدمت، ولا تزال، من قبل شعوب البلدان التي استعمرتنا للاحتجاج والمطالبة والدعوة إلى التغيير، مع فارق جوهري وهو أن هذه الشعوب تنزل إلى شوارع مدنها وهي تشعر بالأمان، وعلى الأغلب بأجواء احتفالية تزخر بالموسيقى والغناء وارتداء الأزياء التنكرية والأقنعة الساخرة وترفع شعارات تجمع ما بين الطرافة والمطالب الجادة. فهي تعلم بأن الشوارع والمدن والساحات العامة والبلاد بما فيها ملك لها، وأن الشرطة ( باستثناء حالات نادرة) موجودة لحمايتها.
شاهد المتظاهرون، عبر شاشات التلفزيون، قصف العراق ونهبه وتخريبه وسقوط ما يزيد على المليون قتيل ليعيش العراقيون حتى اليوم نتائج حرب عدوانية مبنية على الأكاذيب
على الرغم من هذه الفروق الأساسية بيننا و»بينهم»، يشير رصد عدد من المظاهرات الجماهيرية الحاشدة، في بريطانيا وأمريكا، مثلا، إلى بروز سؤال مهم يواجه منظميها المثابرين وهو عن مدى قدرة المظاهرات، كأداة فاعلة، على تغيير السياسات الحكومية؟ هل تؤدي إلى إحداث تغيير حقا؟ أم أنها مجرد طقس من طقوس الديمقراطية التي يجب ممارستها من جهة، ومنبع رضى للناس لأنها تمنحهم الإحساس بالمساهمة بعمل جماعي أو كونه مجرد تنفيس للغضب بحضور آخرين ممن يشاركونهم الرأي والموقف؟
مظاهرتان كبيرتان تستحقان النظر لمعرفة القدرة على التغيير الفوري. تمت الاولى في 15 فبراير/شباط 2003، أي قبل إعلان الحرب على العراق بشهر. وضمت حوالي 35 مليون شخص من جميع أنحاء العالم، خاصة في أوروبا وأمريكا، وكانت أكبر تظاهرة احتجاجية في تاريخ البشرية، تتم قبل نشوب الحرب وليس بعدها. وصفها صحافي نيويورك تايمز باتريك تايلر بأنها أثبتت أن هناك «قوتين عظيمتين في الكون هما الولايات المتحدة، والرأي العام في جميع أنحاء العالم». حينها، شهدت لندن خروج مليوني محتج إلى الشوارع معلنين رفضهم لشن الحرب. «ليس باسمنا»، كان الشعار الاول الذي يدين رغبة الحكومة البريطانية بالوقوف جنبا إلى جنب مع الإدارة الأمريكية في غزوها العراق. فهل حققت المظاهرة هدفها؟ وماذا كان رد فعل الحكومة البريطانية وهي الممثلة للشعب في بلد يعتبر من أمهات الديمقراطية في العالم؟
لم يتم إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين. إلا أن رئيس الوزراء توني بلير فعل ما هو أسوأ من ذلك. أهان المتظاهرين بقوله إن من حقهم التظاهر فبريطانيا بلد ديمقراطي، معتبرا غضب وكراهية الناس له ثمنا للقيادة وتكلفة قناعته بما يفعل. وبعد أيام، نفد ما أراده. شاهد المتظاهرون، عبر شاشات التلفزيون، قصف العراق ونهبه وتخريبه. وسقوط ما يزيد على المليون قتيل، ليعيش العراقيون، حتى اليوم نتائج حرب عدوانية مبنية على الأكاذيب.
المظاهرة الثانية هي التي تمت في الأسبوع الماضي، في لندن ومدن بريطانية أخرى، احتجاجا على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واستقباله الاحتفالي الرسمي الكبير هو وعائلته من قبل الملكة. شارك في المظاهرة آلاف المحتجين الذين ساروا حيث كان ترامب مجتمعا برئيسة الوزراء البريطانية. أراد المتظاهرون أن يبلغوهما بأن وجود ترامب غير مرحب به وأن الدعوة الرسمية وما صاحبها من احتفاء لا يمثلان الشعب. كان الجو احتفاليا، وكان لحضور الشعارات المنددة بسياسة ترامب تجاه فلسطين والاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني مكانته، واختتم رئيس حزب العمال جيريمي كوربن المظاهرة بخطاب ندد فيه بسياسة ترامب العنصرية اللا إنسانية.
حققت المظاهرة نجاحا على مستويين. الأول هو تحديد حركة ترامب في العاصمة ومنعه من التجوال فيها بسيارته المصفحة الفارهة إلا لمسافة قصيرة جدا، واقتصر تنقله على الهليكوبتر خوفا على حياته. مما يذكرنا بهبوطه الليلي، بطائرة مطفأة الأضواء، أثناء زيارته القاعدة الأمريكية، في بغداد، نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2018، وكيف عبر عن امتعاضه وحزنه لطريقة الزيارة السرية. المستوى الثاني لنجاح المظاهرة هو إطلاقه واحدة من أكاذيبه عند سؤاله عن رد فعله تجاه المتظاهرين فأجاب نافيا وجودهم. كان حجم الكذبة كبيرا إلى حد دفع حتى مراسلي أكثر القنوات التلفزيونية تحيزا إلى تقسيم الشاشة، إلى نصفين يبين أحدهما ترامب وهو يكذب والنصف الثاني آلاف المتظاهرين تحت بالون وردي يمثل ترامب وهو يبكي كالطفل. صحيح أن هذه المظاهرات لم تنجح بمنع الزيارة، كما لم تمنع إقامة حفل التكريم إلا أنها نجحت في تحديد حركة رئيس أقوى دولة في العالم وساهمت بتعرية أكاذيبه.
ولأن الحكام الفاسدين يتغذون على الأكاذيب شاهدنا الشاشة ذاتها وقد تم تقسيمها إلى نصفين لنقل أخبار السودان. حيث العصيان المدني الشامل والشوارع الخالية تماما، كاستفتاء سلمي ضد المجلس العسكري، مقابل متحدث ترامبي الهوى باسم المجلس قائلا إن الحياة طبيعية ولا تغيير!
كاتبة من العراق
هل تهيئ أمريكا
ملفات ابتزاز حلفائها؟
هيفاء زنكنة
تختمر في أجواء استعدادات الادارة الأمريكية لشن حرب أخرى بعيدا عن أراضيها، أسئلة ملحة حول مدى وحجم التعاون أو الشراكة التي غالبا ما يتم ادعاؤها من قبل الادارة الأمريكية من جهة والحكام العرب من جهة أخرى. ولعل أكثر التساؤلات أهمية، هو مدى ودرجة التعاون الاستخباراتي بين وكالة الاستخبارات الوطنية الأمريكية واجهزة الاستخبارات العربية، وبالتحديد عما اذا كانت وكالة الأمن القومي الأمريكية (NSA) تتقاسم آلية استخدام المعطيات والبيانات الحديثة المسماة « آر تي – آر جي» مع الدول العربية؟ ثم ما هي هذه الآلية التي باتت تربط الاستخبارات الأمريكية بمعظم الدول الغربية بلا استثناء؟ وما هي أهميتها بالنسبة الى الدول العربية؟ وهل تستخدمها أمريكا للحرب ضد الإرهاب فقط أم لإعداد الملفات لابتزاز حلفائها أيضا؟
ليس سرا قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على مراقبة المكالمات الهاتفية للاشخاص وتجميع المعلومات عنهم ومن ثم اتخاذ اجراء رادع بحقهم تحت ذرائع مختلفة، لعل اكثرها استخداما، منذ الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول هو « الحرب على الإرهاب». ويعود الفضل، بشكل خاص، لاثبات ما كان يعتبر نظرية مؤامرة يتداولها الموسومون بكراهية أمريكا الى أدوارد سنودن، موظف وكالة الاستخبارات الأمريكية ( سي آي أي) السابق الذي سرب تفاصيل برنامج مراقبة الولايات المتحدة للهواتف والإنترنت، والعسكري مانينغ واسانغ مدير ويكيليكس. كل واحد منهم يدفع، منذ سنوات، ثمن إظهار الحقيقة سجنا ونفيا، وفي حالة أسانج مواجهة ما لا يقل عن عشرين تهمة سيحاكم جراءها، اذا ما قامت السلطات البريطانية بتسليمه الى أمريكا.
كان لتسريبات سنودن وقع كبير على الادارة الأمريكية لأنها فضحت وأثبتت دورها في المراقبة اليومية المستمرة للمواطنين الأمريكيين بالإضافة الى المراقبة في فرنسا وايطاليا والمانيا. وتشير اعادة قراءة الوثائق المسربة من قبل موقع « انترسيبت» الاستقصائي المعروف بباحثيه، الى ان أمريكا ليست البلد الوحيد الذي استفاد من هذه الامكانية بل ان ما اهملته القراءة الاولية للوثائق، ويعاد تقييمه الآن، هو جانب التعاون المتبادل بين دول لم يكن معروفا عنها استخدام ذات الآلية مثل النرويج.
أكثر التساؤلات أهمية، هو مدى ودرجة التعاون الاستخباراتي بين وكالة الاستخبارات الوطنية الأمريكية وأجهزة الاستخبارات العربية
فضح سنودن قوة رقمنة تقاسم الاستخبارات، ووجود مركزين افتتحا بقاعدة بوغرام بافغانستان في تشرين الثاني/نوفمبر 2005. حيث بدأت هناك مهمة تطوير ما يعرف بـ « آر تي – آر جي» أي نظام معالجة البيانات التي أدخلت في عام 2007، من قبل وكالة الأمن القومي الأمريكية (NSA)، خلال احتلال العراق وأفغانستان، ومع تزايد قوة المقاومة العراقية. هذا النظام قادر على تخزين البيانات من مصادر عديدة، مثل الهواتف المحمولة والغارات والاستجوابات والإشارات التي يتم جمعها من أجهزة الاستشعار الأرضية، وكذلك بواسطة المنصات المحمولة جواً والطائرات بدون طيار والأقمار الصناعية. بواسطته أصبح لمحللي الاستخبارات، لأول مرة، القدرة على الوصول مباشرة إلى قواعد بيانات وكالة الامن القومي، ودمجها مع المعلومات الجديدة والبحث فيها وتحليلها. ومن ثم، وهذا هو الاهم، تبادلها مع القادة العسكريين المحليين في ذات الوقت الذي يتم فيه حدث ما ( الوقت الفعلي)، ويتطلب اتخاذ اجراء سريع، كالقصف أو قائمة بالأهداف المستهدفة بدون اللجوء الى بيروقراطية الأخذ والرد وانتظار الاوامر المكتوبة. واذا كانت افغانستان هي المختبر الاول لتجربة النظام المستحدث، حيث تفتخر القيادة الأمريكية بانها قتلت 6534 « عدو» في عام واحد، متجاهلة أعداد الضحايا المدنيين، فان العراق هو المكان الذي تم فيه التطبيق الاحدث لما وصفه الجنرال دافيد بترايوس، القائد العسكري للعراق سابقا، ورئيس السي آي أي السابق، بانه « اهم انجاز عسكري تم استخدامه حتى الآن.. وعامل رئيسي في نجاح عمليات « مكافحة التمرد»، متجاهلا هو الآخر مئات الآلاف من الضحايا المدنيين. وجاء النجاح، حسب بترايوس، بعد ان مكّن النظام وكالة الامن القومي ليس على مراقبة الاتصالات من العراق فحسب، ولكن أيضًا للهيمنة على أجهزة الهاتف والكمبيوتر العراقية، لفتح بوابة الوقت الحقيقي لتصبح كل المعلومات المتعلقة بالعراق متوفرة للمحللين والعسكر.
من أجل تغطية بغداد، حسب تقرير « انترسيبت»، كان يجب أن يكون النظام قادرًا على استيعاب 100 مليون «حدث مكالمة» أو سجلات بيانات وصفية، ومليون « صوت» أو تسجيلات للمكالمات الهاتفية، و 100 مليون سجل بيانات وصفية أخرى عبر الإنترنت – يوميًا. كما اقتضى تحولا تدريجيا في تجميع الاشارات التقليدية من جمع وتخزين فقط ما هو مطلوب للعثور على «الإبرة في كومة قش» إلى « تجميع كومة قش». أي جمع كل شيء وخزنه. وحسب الصحافي الاستقصائي غلين غرينوالد (15 تموز/يوليو 2013): « أن وكالة الأمن القومي تحاول جمع ومراقبة وتخزين جميع أشكال التواصل البشري». مما يعني انها تقوم بتحليل « نمط حياة» الاشخاص لا للاستهداف الآني فحسب بل لحين الحاجة. لذلك بلغ عدد المحللين بالعراق خمسة آلاف، يتم تمريرهم كمستشارين وفي افغانستان ثمانية آلاف.
استوقفني، كمثال على العمل الاستخباري، ما جاء ذكره في احد التقارير التي سربها سنودن والمتوفرة الآن على الانترنت، حيث فشل أحد المحللين في تحديد مكان تواجد عراقي « مشكوك بأمره»، لإلقاء القبض عليه، لأنه كان يتعمد تفكيك هاتفه الجوال حالما يقترب من مكان سكنه بحي الشعلة ببغداد، فقام المحلل بمتابعة اشارات هاتف زوجته وتكوين صورة عن تحركاتها وروتين ايامها ومن ثم ربطها بتحركات زوجها، الى ان تم القاء القبض عليه.
يعيدنا المثال الى التساؤل حول استعداد أمريكا لتوفير هذه الانظمة الاستخبارية المتقدمة لأجهزة استخبارات الدول العربية؟ وما هو دور الكيان الصهيوني وموقفه ازاء ذلك؟ وماذا عن الحكام والمسؤولين العرب الذين يرون في أمريكا حليفا لا يمكن الاستغناء عنه، إزاء نظام الهيمنة الجديد نسبيا إزاء مفهوم السيادة الوطنية؟ ما هي الاسرار التي سجلتها انظمة الاستخبارات الذكية عن نمط حياتهم وحياة افراد عوائلهم ربما ليس للتخلص منهم الآن ولكن… ما هي ضمانات عدم استخدام البيانات والمعطيات المحفوظة عنهم ككومة القش مستقبلا؟ وهل نحن هنا أمام مفهوم اوسع للابتزاز الامبريالي السهل بالجملة لكل من هو في موقع سلطة؟
كاتبة من العراق
كيف تشتري صمت
الحكومة البريطانية؟
هيفاء زنكنة
من الصعب، هذه الايام، العثور على خبر رسمي أو غير رسمي في أجهزة الاعلام البريطانية عن العراق. الا ان الشهور الأخيرة شهدت بعض المتابعة من جهات رسمية. فقد طرح أسقف كوفنتري، في الاسبوع الماضي، سؤالا على الحكومة، عن تقييمها للتقارير التي تفيد بأن حوالي 45000 طفل في مخيمات النازحين العراقيين، لا يحملون وثائق هوية مدنية، وما هو الموقف من الحكومة العراقية لضمان عدم استبعاد هؤلاء الأطفال من المواطنة والمجتمع العراقي في المستقبل؟ فكان جواب اللورد أحمد وزير الدولة، مصاغا بعناية دبلوماسية معتادة، بأن الحكومة البريطانية على دراية بالتقارير الإعلامية، وإن لم يتم التحقق من الأرقام المذكورة. وإن الحكومة مدركة لهشاشة وضع هؤلاء الأطفال ومخاطر استبعادهم من الجنسية العراقية والمجتمع في المستقبل. لذلك تستمر الحكومة ببيان قلقها للسلطات العراقية بما في ذلك أهمية الاعتراف الرسمي بجميع الأطفال. والمعروف ان عدد الأيتام، بالعراق، وصل حوالي 800 ألف طفل حتى نهاية 2017.
آخذين بنظر الاعتبار ان الحكومة البريطانية برئاسة توني بلير وقفت جنبا الى جنب مع الادارة الأمريكية برئاسة جورج بوش، مستخدمة «تحرير العراق»، وإرساء حقوق الانسان، من بين ذرائع الحرب، وان معظم الوزراء واعضاء البرلمان، الحاليين، يعترفون بان شن الحرب كان خطأ تاريخيا، سيكون السؤال البديهي: لم لا تتخذ الحكومة اجراءات ردع أكثر فاعلية، بصدد انتهاكات حقوق الانسان التي تمارسها الحكومة العراقية، ضد مواطنيها، والتي تمس بشكل خاص الشرائح الأكثر ضعفا في المجتمع كالاطفال؟ ما الذي يمنع الحكومة البريطانية من اتخاذ موقف واضح صريح، تجاه حكومات ما بعد «التحرير»، على الرغم من كثرة التقارير المحلية والدولية عن انتهاكات حقوق الانسان، وبضمنها تقارير منظمة الأمم المتحدة؟ ثم ما هي آلية الضغط التي تتحدث عنها الحكومة البريطانية فيما يخص الالتزام بحقوق الانسان القانون الدولي؟ وهل هناك سابقة في هذا المجال؟
هناك آليات ضغط عديدة بامكان الحكومة البريطانية اللجوء اليها اذا شاءت. ونعم هناك سابقة تتعلق بالعراق. حيث « شهد عام 2002 نشرًا غير مسبوق لوثيقة عن حالة حقوق الإنسان في بلد واحد. في تشرين الثاني/نوفمبر، نشرت وزارة الخارجية ملفًا عن انتهاكات حقوق الإنسان، بعنوان «صدام حسين: الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان – تقرير عن التكلفة الإنسانية لسياسات صدام». جاء فيه تفاصيل عن التجاهل المنهجي للنظام العراقي لحقوق الإنسان لمواطنيه، بما في ذلك استخدامه للتعذيب واضطهاد الأقليات وعمليات القتل التعسفي المتكررة التي تحدث هناك». اذا كانت الحكومة البريطانية قد وقفت بهذا الشكل «الانساني الرائع» ضد سياسة النظام العراقي السابق في انتهاك حقوق الانسان لمواطنيه، لماذا السكوت الآن، وانتهاكات حقوق الانسان وصلت حدا لا يمكن السكوت عليه؟
هناك عدة أسباب، من بينها:
ما الذي يمنع الحكومة البريطانية من اتخاذ موقف واضح صريح، تجاه حكومات ما بعد «التحرير»، على الرغم من كثرة التقارير المحلية والدولية عن انتهاكات حقوق الانسان
أولا: ان القوات العسكرية البريطانية، نفسها، منغمسة في كثير من الخروقات وبعضها يصل حد ارتكاب جريمة حرب. وتعمل الحكومة جاهدة على تشريع قانون يمنع محاسبة القوات مهما كانت الجرائم التي ارتكبها افرادها في البلدان المحتلة.
ثانيا: عقود النفط الموقعة بين شركات النفط البريطانية ووزارة النفط العراقية لصالح الشركات وفي جو الفساد المستشري بلا محاسبة.
ثالثا: العقود التجارية، اذ تشهد الصادرات من السلع والخدمات البريطانية إلى العراق ارتفاعا مضطردا، بمعدل زيادة عشرة بالمئة سنويا. وكان وزير شؤون الشرق الأوسط، قد زار العراق نهاية كانون الثاني/يناير، مؤكدا: «تجمع بيننا طائفةٌ من الأولويات المشتركة والمتزايدة باطراد، ومن بينها الأمن والتنمية والسياسة الخارجية والتجارة». تبعه وزير التجارة الدولية، معلنا أثناء زيارته العراق في 14 نيسان/ أبريل أن المملكة المتحدة ستوفر دعما إضافيا قدره مليار جنيه إسترليني للشركات البريطانية العاملة في العراق.
رابعا: تصدير السلاح والمعدات العسكرية. هناك زيادة كبيرة في عدد تراخيص التصدير. فخلال أربع سنوات فقط، من 2013-2017، زاد إجمالي عدد التراخيص أكثر من 12 مرة من 46 إلى 559 ترخيصا.
خامسا: تعتبر العقود التي حصلت عليها الشركات الامنية العسكرية البريطانية، بعد الغزو، من غنائم الحرب الكبيرة. هناك 80 شركة عسكرية بريطانية تعمل في العراق، ويقال إن بعض الشركات الكبرى تدين بوجودها للأرباح المكتسبة في الحربين ضد العراق وأفغانستان. ولوجود الشركات الامنية أذرع متعددة تمتد ما بين توفير الحماية والأمن الى القتال كمرتزقة، وان تفضل الشركات والدول التي تستأجرها عدم الاشارة الى ذلك. ما تفضل ذكره للتعريف بنفسها، كما تفعل شركة «أيجز» البريطانية الشهيرة، هو «شركة بريطانية للأمن وإدارة المخاطر مقرها لندن… لدينا خبرة كبيرة وقاعدة عملاء عالمية… نحن مزود أمن رئيسي للحكومة الأمريكية». وتؤكد الشركة انها تعمل في العراق منذ عام 2004 ولديها «مجموعة كبيرة من عملاء قطاع النفط والغاز». تضاهيها بالعمل في حقول نفط البصرة، شركة «جي فور أس» البريطانية ذات التاريخ الطويل في إدارة نقاط التفتيش وسجون الاحتلال الصهيوني، حيث يتواصل التعذيب والمعاملة اللا إنسانية المهينة. وهي ذات الانتهاكات التي تعرض لها المواطن العراقي بالاضافة الى تدمير الممتلكات، وإساءة استخدام السلطة، وقتل المدنيين، كما في ساحة النسور ببغداد. وللشركة بالبصرة لوحدها 500 مسلح بأحدث الاسلحة و200 مصفحة عسكرية. وكان رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي قد منحها عقدا طويلا بعد ان تم الغاء عقود عالمية معها بسبب تاريخها السيئ.
يشير تقرير لموقع «رصد العنف المسلح» الى ان الشركات الأمنية البريطانية تعمل في 17 دولة من بين 30 دولة تدرجها وزارة الخارجية تحت تصنيف دول لا تراعى فيها حقوق الإنسان، وبضمنها العراق. فما الذي تفعله هذه الشركات هناك؟ ما هي الرقابة الموجودة في هذه العمليات، خاصة في بعض الأماكن التي تتورط فيها الحكومة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان؟ ومن الذي يدفع هذه الشركات؟ يجيب التقرير: لا نعرف. والسبب هو انها تمارس اعمالها وحتى عناوينها واسماء الشركات بطرق تضليلية، كما ان تأسيسها، غالبا، من قبل عسكريين سابقين او بالتعاون مع عسكريين بريطانيين، يجعل التوصل الى تشعبات اعمالها ومدى تدخلها بالشؤون الداخلية للبلدان التي تستأجر فيها، صعبا جدا.
أما ما يرش الملح على الجروح فهو اعلان وزير شؤون الشرق الأوسط، اليستر بيرت عن تخصيص 16 مليون جنيه إسترليني لصندوق الإصلاح وإعادة الإعمار في العراق. وهو مبلغ يقل عن واحد بالألف لايزيد عن كونه فتاتا بالمقارنة مع مما غنموه من شن الحرب وتدمير البلد، و ما يغنمونه وهم يعبرون عن «قلقهم» على وضع اطفال بلا وثائق.
كاتبة من العراق
ليس حبا بالنظام الإيراني
هيفاء زنكنة
لا مفر، هذه الأيام، مهما حاولنا، من متابعة أخبار التهيؤ العسكري لإشعال جحيم حرب جديدة بين أمريكا وإيران في العراق، أو استمرارية جحيم حرب دائرة، الآن، في اليمن وليبيا، فضلا عن الاستيطان الصهيوني في فلسطين. أكرر مفردة «جحيم»، فهذا العالم العربي، الذي يتفتت كالخبز البائت أمام أنظارنا، لا يزال متمسكا بإصرار أسطوري على الا تقل الحروب على أرضه عن أربعين بالمائة من حروب العالم. حروب تمطر على أهله قنابل، تزداد وزنا مع كل حرب جديدة وصواريخ غبية، مؤهلة ان تكون ذكية، لفرط استخدامها في دروس القتل.
فمن حقل القتل الأول، بفلسطين، تطايرت بذرة الموت الاستعماري الاستيطاني لتحط في العراق واليمن وسوريا وليبيا، برعاية محلية. قتل الأجنة والأطفال، بغزة، مثلا، تراه الحكومات العربية، خبرا عاديا مألوفا، لا يستحق حتى مقاضاة المجرمين على الرغم من انها، جميعا، تدعي وصولها الحكم عبر انتخابات ديمقراطية تمثل الشعب.
هذه الحكومات العاجزة عن حماية شعوبها، قادرة على تشكيل «تحالف» ضد شعوبها، نتيجته واضحة منذ البداية كما في اليمن: تجويع الناس وسقوط الضحايا من المدنيين أينما كانوا سواء في حفلات الزفاف والجنازات أو المستشفيات والمدارس. أفعال إجرامية متغطرسة، يتماهى خلالها، حاملو السلاح وصانعوه وباعته ومشتروه، وهم يرددون ذات الاعذار التي تجعل، من القتل، الخيار الوحيد، الذي لا حل غيره.
يقول رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، مبررا سقوط الضحايا الفلسطينيين، نتيجة القصف المكثف، بضمنهم الأطفال، انه يستهدف «العناصر الإرهابية في قطاع غزة». ولا يختلف كثيرا عنه، المستشار القانوني لـ«التحالف العربي»، حين يبرر مقتل 22 طفلا في غارة جوية للتحالف على اليمن بأن الغارات تمت استنادا إلى معلومات استخباراتية بأن الحافلة كانت تقل قياديين حوثيين، وهو ما يجعلها «هدفا عسكريا مشروعا». وهما لا يختلفان عن المتحدث باسم القوات الأمريكية حين يبرر مقتل 200 شخص، بمدينة الموصل، جراء غارة لها، في آذار/مارس 2017، قائلا إن ارتفاع أعداد الضحايا متوقع مع دخول الحرب على المتشددين أعنف مراحلها.
وإذا كان حكام المملكة العربية السعودية ودولة الامارات الحاليين يدفعون مليارات الدولارات لشراء الأسلحة الأمريكية، بالإضافة الى «أتاوة» الحماية والرعاية لهذا الجناح من القبيلة دون غيره، فان الإدارة الأمريكية تزود الكيان الصهيوني، بالمقابل، بالمساعدات العسكرية البالغة مليارات الدولارات، والحماية مجانا. مما يوضح بما لا يقبل الشك من هو الحليف الدائم ومن هو المؤقت، وكيف أسقطت هذه التحالفات مفهوم «السياسة فن الممكن»، الذي يلجأ اليه الحكام العرب لتبرير أفعالهم، الى «الاستئثار الممكن بالخنوع».
ما هو موقف الشعوب العربية إزاء استمرارية العقيدة الأمريكية بأن «العالم ساحة معركة» والاعتماد على الصواريخ وغارات الطائرات بدون طيار، بالإضافة الى العمليات السرية الخاصة المحفزة للاقتتال وإثارة الفتن والضغائن حتى بين أبناء الشعب الواحد، ووجود غربان السلاح والحروب الذين يقتاتون على الموت؟
من الواضح، أيضا، ان الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، مهما كانت الأوصاف الدونية التي تُطلق عليه، لا يختلف عن سلفه باراك أوباما، الذي امطرته البشرية بالمديح والثناء، أو سلفه «الصالح» جورج بوش حين يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية وحماية المصالح الأمريكية العسكرية وغيرها في المنطقة. فاذا كان الرئيس ترامب قد طلب، منذ يومين، التحضير الفوري لملفات عديد العسكريين الأمريكيين المتهمين أو المدانين بارتكاب جرائم حرب بما في ذلك العسكري الذي من المقرر محاكمته لقتله مدنيين عزلا أثناء خدمته بالعراق، لأنه يفكر في العفو عن هؤلاء الرجال في «يوم الذكرى» الذي يوافق 27 أيار/مايو والذي تحيي فيه الولايات المتحدة ذكرى جنودها الذين قتلوا في المعارك اذا كان هذا ما سيقوم به ترامب، ليشرعن قتل المدنيين في البلدان المحتلة او يرونها مهددة للمصالح الأمريكية، فان الرئيس أوباما كان قد سبقه الى تشريع برنامجين
للاغتيال بواسطة الطائرات بدون طيار، لصالح وزارة الدفاع والسي آي أي، في باكستان وأفغانستان واليمن والصومال والعراق، تحت ستار الحرب على الإرهاب، وبعد ان تمت تسمية «الاغتيال» بأنه «قتل مستهدف»، حسب وثائق مسربة كشفها جيريمي سكاهل، الصحافي الاستقصائي الأمريكي، في كتابه « الحروب القذرة».
ومن بين التفاصيل التي تم الكشف عنها في الوثائق المسربة أن تسعين بالمائة من الأشخاص الذين قُتلوا في الغارات الجوية بطائرات بدون طيار لم يكونوا هم الأفراد المستهدفين. وكشفت الوثائق، أيضًا، عن الإجراءات التي تم من خلالها تحديد الأفراد للقتل والتحرك من خلال عملية أطلق عليها اسم «سلسلة القتل»، وبترتيب مع الرئيس أوباما نفسه، تم وضع الأفراد في «دورة الاستهداف»، وهي نافذة مدتها شهران يكون للجيش الأمريكي فيها «السلطة» للقيام بعملية الاغتيال. ولن ننسى التشريع الاوبامي الذي منح فيه القوات المسلحة صلاحية توجيه الضربات الجوية ضد أهداف الدولة الإسلامية في العراق وسوريا حتى لو أدت إلى سقوط الضحايا من المدنيين، بمعدل عشر ضحايا لكل غارة، بدون الرجوع إلى القيادة العسكرية المركزية، إذا ما تبين ان هدف الغارة الجوية يستحق ذلك.
ما هو موقف الشعوب العربية إزاء استمرارية العقيدة الأمريكية بأن «العالم ساحة معركة» والاعتماد على الصواريخ وغارات الطائرات بدون طيار، بالإضافة الى العمليات السرية الخاصة المحفزة للاقتتال وإثارة الفتن والضغائن حتى بين أبناء الشعب الواحد، ووجود غربان السلاح والحروب الذين يقتاتون على الموت؟
ان آلية القتل قصفا واستخدام جيل جديد من الطائرات بلا طيار، هي السائدة الآن، وستكون، كما تشير، كل الدلائل، الى انها ستستمر كسلاح مفضل في الحرب / الحروب المقبلة، التي يتم الاستعداد لها، بحماس منقطع النظير، من قبل دعاة الحرب في أمريكا وإيران والسعودية، التي ستكون ساحتها العراق، ولن تكون السعودية او الامارات أو إيران بمنأى عنها. ولن تكفي كل الجدران التي يبنيها ترامب والكيان الصهيوني لحمايتهما.
وإذا كان مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، يعتقد ان الله قد أرسل ترامب لينقذ إسرائيل من إيران والسعودية تعتقد ان أمريكا ستخلصها من إيران أيضا، أليس من الواضح أين ستقع الحرب التالية؟ أليس ما يجري في فلسطين والعراق واليمن كافيا ليدرك غربان الموت من الحكام العرب المستجيرين بأمريكا ان هذه الحرب لو لم تكن ضد إيران لكانت ضد بلد عربي، لأن الإدارة الأمريكية بحاجة ماسة الى عدو يحميها من نفسها ويوفر لمموليها فرصة استثمار ثرواتهم؟
هذه الحرب، إذا حدثت، ستكون المصيبة الأكبر على الشعب العراقي الذي عاش من الحروب ما يجعل ذاكرته مثقوبة بالرصاص، وسينهي أي أمل بالتعاون مع شعب بلد مجاور يعاني هو الآخر من استبداد يماثل ما تعيشه الشعوب العربية. ليس حبا بالنظام الإيراني، فما فعله في العراق وعرضه مساعدة أمريكا على احتلاله وتخريبه، جريمة لا تغتفر، ولكن حرصا على ما تبقى من العراق، علينا الا نتعاون مع أمريكا والكيان الصهيوني، فتاريخهما وحاضرهما أفضل دليل على مخططاتهما مستقبلا.
كاتبة من العراق
للقاتل اسم والضحايا العراقيون بلا أسماء
هيفاء زنكنة
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الأسبوع الماضي، عفوا عن ملازم اول بالجيش الأمريكي، محكوم بخمسة وعشرين عاما، لارتكابه جريمة قتل المواطن العراقي علي منصور، اثناء التحقيق معه كمتهم بالانتماء الى تنظيم القاعدة عام 2009. جاء العفو، حسب البيان، بعد ضغط عسكري وسياسي وشعبي كبير، باعتبار الملازم جنديا أمريكيا نموذجيا. ماذا عن الضحية العراقي علي منصور؟ ما الذي نعرفه عنه باستثناء تبرير القاتل بانه قتله دفاعا عن النفس؟ وفقا لوثائق المحكمة، أقتاد الملازم وفصيله علي منصور إلى منطقة صحراوية نائية، بالعراق، بعد ان قررت القيادة إطلاق سراحه. إدعى الملازم انه يستجوبه حول هجوم سابق على جنود أمريكيين، فأمره بالتعري ثم أطلق عليه النار في الرأس والصدر.
أثار قرار العفو غضب عديد المنظمات الحقوقية والسياسيين، بأمريكا، ولكن… ما هو رد فعل الحكومة العراقية والساسة وأعضاء البرلمان عن العفو، وهم يقرأون سيناريو تبرير القتل التافه، خاصة وان جريمة القتل المتعمد هذه، هي واحدة من قائمة طويلة من جرائم وانتهاكات قوات الاحتلال، التي تمر مرور الكرام، منذ 2003، بلا مساءلة من الجهة العراقية وغالبا ما يتم الالتفاف حولها بشتى الطرق «القانونية» أمريكيا؟
ماذا عن آخر المحاكم؟ فبعد أسبوعين، سيتم تقديم قائد العمليات الخاصة التابعة للبحرية الأمريكية، ادوارد غالاغار، للمحاكمة بتهم قتل مدنيين عراقيين، عام 2017، أثناء وجود القوات، على مقربة من مدينة الموصل، للقيام، كما يطبل رسميا، بمهمات «تدريبية واستشارية»، مساندة للقوات العراقية في الحرب ضد تنظيم «داعش». يعتبر هذا القائد واحدا من ابطال القوات الأمريكية الخاصة، وقناصا ماهرا، ونموذجا يحتذى بجرأته وشجاعته في محاربة أعداء أمريكا في أفغانستان والعراق، حاز جراءها على أوسمة شرف عديدة. الا ان مسار «بطولاته» توقف عندما تقدم سبعة من زملائه، الأقل رتبة منه، بالشكوى ضده لأنهم ما عادوا قادرين على تحمل ارتكابه جرائم قتل المدنيين في الموصل. الا ان القيادة رفضت الاصغاء إليهم حفاظا على سمعة الوحدة العسكرية التي يُفتخر بانها تضم نخبة الجيش الأمريكي. فثابر المشتكون، حتى تم الاستماع إليهم، خاصة بعد ان كشف عدد من الصحافيين تفاصيل جرائمه وحيثيات ارتكابها، فلم يعد أمام قيادة الوحدة من خيار غير اجراء التحقيق واعتقال المتهم وتقديمه الى المحاكمة.
يتبين من الشهادات، انه كان يقضي معظم وقته جاثما في أماكن القنص ليتمتع باصطياد المارة من المدنيين، حيث كان يصوب خمسة أو عشرة أضعاف القناصة الآخرين. أخبر قناصان المحققين أن غالاغار، أطلق في أحد الأيام، النار على فتاة ترتدي حجابًا مزينًا بالأزهار، كانت تسير مع فتيات أخريات على مقربة من ضفة النهر. ثم شاهدا الفتاة وهي تسقط على الأرض، ممسكة ببطنها، فسحبتها الفتيات الأخريات بعيداً. كما قام، مرة أخرى، بأطلاق النار على رجل عجوز كان يرتدي دشداشة بيضاء، وسقط الرجل على الأرض مضرجا بدمائه. سجلوا: نحن في الموصل عام 2017.
هل هي عقلية المُحتَل المبنية على الدونية والحط من قيمة أخيه المواطن، لكي لا يُذكره بما آل اليه من انحطاط، ام هو الخوف من كشف الحقيقة وتحميله مسؤولية المشاركة بجرائم يتكشف وجهها البشع يوما بعد يوم؟
يقول الشهود، كما جاء في تحقيق صحيفة « نيويورك تايمز»، أنهم شعروا بالقلق الشديد إزاء قيامه بإطلاق النار على المدنيين، الى درجة أنهم صاروا يطلقون طلقات تحذيرية، على بعد متر أو اثنين فقط من المدنيين، لإخافتهم حتى لا يتمكن قائدهم من اصابتهم. وفي أيار/مايو، من العام الماضي، حدث أمر لم يعد بإمكانهم السكوت عليه. إذ تم احضار جريح، عمره 14 عاما، الى الوحدة العسكرية اثناء احدى المعارك مع داعش. يقول افراد الوحدة إنهم وضعوه على الأرض وبدأوا بمداواته. اثناء قيامهم بذلك جاء القائد غالاغر وأبرز سكينًا خاصا كان يفضل حمله. وبدون ان يقول شيئا، على الإطلاق، قتل الأسير طعنا في الرقبة والجذع. بعد ذلك، جمع أفراد الفصيل كلهم حول وعلى جسد الصبي الميت وأمر بإقامة حفل تجنيد. وهو احتفال يتعين فيه على الجندي القيام بطقوس خاصة بإعادة التجنيد طوعًا وأن يرفع يده اليمنى ليقسم ولاءه وطاعته للدستور. وقام أحد افراد الفصيل بالتقاط الصور. سجلوا: نحن في الموصل ،2017، وهي الفترة التي شهدت تعاونا شاملا بين القوات الأمريكية مع الجيش والحشد الشعبي، قتالا على الارض وقصفا بآلاف الغارات الجوية في خمس محافظات وتنسيق الهجوم البري والدوريات المشتركة. ونتج عنها هدم بنايات كاملة بما فيها من سكان، ولا تزال جثث الضحايا تُسحب من تحت الأنقاض. كان من السهل، أثناءها، على المسلحين إيجاد الذريعة لارتكاب أي جريمة كانت بدوافع سادية شخصية او عنصرية أوسع.
ولعل ما يحز بالنفس ويحفر عميقا بالقلب، هو موقف الضباط العراقيين الذين عند جلبهم للشهادة نفوا حدوث الجريمة بل وأضافوا بأن جريمة القتل لا تتماشى مع شخصية القائد غالاغار! أي أن الضباط العراقيين كذَّبوا أفراد الفصيل الأمريكي الذين استيقظت ضمائرهم.
هذه، أيضا، ليست المرة الأولى المسجلة التي يتسلى فيها أحد قوات الاحتلال بقتل المدنيين ثم يدعي انه قتل «إرهابيا» أو انه ضحية ثانوية. ففي عام 2006، مثلا، قام العريف لورانس هاتشينز من سلاح مشاة البحرية وجنود آخرون بقتل هاشم إبراهيم عواد (52 عاما) ثم وضعوا بندقية كلاشنيكوف وجاروفا، بجوار الجثة للإيحاء، بأنه كان يخطط لزرع قنبلة. وتم تقديم العريف الى المحكمة التي حكمت بإطلاق سراحه.
يعيدنا تقديم قائد عسكري أمريكي للمحاكمة، هذه الأيام، بقضايا قتل مدنيين عراقيين، الى رد فعل الحكومة العراقية تجاه فضيحة التعذيب في سجن أبو غريب. جاء الرد بلسان رئيس الجمهورية الراحل جلال طالباني، الذي قال، بروحه المرحة، حين جوبه بصور تعذيب المعتقلين من قبل قوات الاحتلال الأمريكي: «عادي ولا يقارن بما كان يحدث في سجون صدام حسين»، مشرعنا بذلك، عمليات التعذيب والقتل، كسلوك رسمي منهجي، وكأنه شارك بـ«تحرير العراق» ليواصل ما هو «عادي» ولا يخرج عليه.
ان ما تقوم به الحكومة والبرلمان، حاليا، وهي متدثرة بالغطاء الديمقراطي ولجان حقوق الانسان، تجاه الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال، أسوأ بكثير من موقف الطالباني المبتذل. لتصبح هوة الانحدار الأخلاقي والوظيفي بلا قاع.
بتنا نصغي، باستثناء قلة من الأصوات، الى مزيج من الصمت حينا ونفي حدوث الجرائم، أساسا، في حين آخر، ليتم التستر على جرائم حرب من واجب أية حكومة وطنية أن تلجأ الى المحاكم الدولية ومجلس الأمن والأمم المتحدة للمطالبة بحقوق الضحايا من مواطنيها. فهل حاول أحد أعضاء لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، مثلا، معرفة أسم الفتاة ذات الحجاب المُوَرد أو العجوز الذي كان يرتدي دشداشة بيضاء، اللذين تسلى القائد الأمريكي بقتلهما؟ هل هما بلا أسماء؟ كيف يكون للقاتل أسما والضحايا بلا اسماء بلا هوية؟ فهل هي عقلية المُحتَل المبنية على الدونية والحط من قيمة أخيه المواطن، لكي لا يُذكره بما آل اليه من انحطاط، ام هو الخوف من كشف الحقيقة وتحميله مسؤولية المشاركة بجرائم يتكشف وجهها البشع يوما بعد يوم؟
كاتبة من العراق
إنهم يخشون الجنين الفلسطيني
هيفاء زنكنة
لم يتغير الكثير: القاذفات الإسرائيلية، الطائرات بلا طيار، القناصون، وحشية التدمير المنهجي، والهدف الرئيسي هو قتل المدنيين. شهداء غزة المقاومة يتزايدون. الزنانة، طائرات الاستطلاع، تغتال شابا في فالوجة غزة. لم تعد آلة الكيان الصهيوني النهمة تشبع من استهداف مقاتلين يدافعون عن ارضهم أو شبانا يطالبون بحقهم بالحياة والكرامة، أو محمد الدرة ابن العاشرة، أو الأطفال الأربعة من عائلة واحدة الذين مزقت جثثهم على رمال شاطئ غزة وهم يلعبون: اسماعيل (9 سنة)، وزكريا (10 سنة)، وعاهد (10 سنة)، ومحمد رامز (11 سنة).
يوما بعد يوم، ازدادت شهية الوحش، بات ينشد دماء الضحايا ممن هم أصغر سنا حتى وصل الرضع والأجنة ببطون أمهاتهم. فكانت الرضيعة صبا محمود أبو عرار (14 شهرا) وأمها فلسطين صالح أبو عرار (37 سنة) وجنينها الذي كانت تريد ان تسميه عبد الله.
في الأسبوع الماضي، شاهدنا، عبر قناة الجزيرة، صبا، وهي موضوعة في ثلاجة الموتى، محتضنة نفسها، في غياب الأم، كأنها نائمة ببراءة لولا معرفتنا المسبقة باغتيالها، ولولا كثرة عدسات التصوير المتحلقة حولها، لتودعها بصورة أخيرة بعد ان زينت أمها شعرها بضفائر صغيرة وورود ملونة. انها وجه غزة تحت 150 غارة خلال 24 ساعة.
في عام 2004، شاهدنا أبا يبكي وهو يحتضن النصف العلوي من جسد طفلته المحروق بجيل جديد من النابالم، رشته قوات الاحتلال الأمريكي على مدينة المقاومة، الفلوجة، غرب العراق.
في عام 2006، شاهدنا على الهواء مباشرة، عبر قناة الجزيرة، أيضا، كيف تمكن عمال الإنقاذ اللبنانيون، في قانا المتعرضة لقصف الكيان الصهيوني، من سحب جثث 27 طفلاً من تحت الأنقاض. شاهدنا رجلاً يحمل فتاة في الرابعة من العمر ترتدي ثوبًا بلا أكمام تزينه زهورا صغيرة. كان وجهها وذراعيها وساقيها العاريتين مغطاة بالتراب.
في ذات العام، أغتصب جنود الاحتلال الأمريكي الطفلة عبير قاسم الجنابي (14 عاما) من بلدة المحمودية، جنوب بغداد، ثم قتلوها وحرقوها سوية مع أمها وأبيها وشقيقتها الصغرى هديل (5 سنوات).
منذ عقود ونحن نرى وجوه الأطفال، يغطيها الموت، الواحد تلو الآخر، من بلد عربي الى آخر وهي جامدة، بعيون مفتوحة على سعتها، تحدق بنا، ذعرا. ضحايا يصبحون، كلهم، بلا استثناء، في لحظات الشهادة، طفلا واحدا، هو طفلنا. كم يتشابه ضحايا الجرائم البشعة! من جنين وغزة في فلسطين إلى الفلوجة وحديثة وإسحاقي في العراق إلى بيروت وقانا في لبنان، من تمكنت عدسات المصورين تخليد لحظاتهم الأخيرة مع من لم يحظ بتلك الثانية المجمدة بالزمن.
وفي كل مرة نغضب ونبكي الشهداء، من الأطفال، ونشعر بالذنب لأننا خذلناهم لأننا لم نحمهم، لأننا لم نوفر لهم فرصة ان يعيشوا سنوات عمرهم. لأننا لانزال أحياء. حتى نكاد والقلب يدمع دما، ان يخامرنا الشك: هل نحن القتلة؟ هل صحيح اننا لا نحب أطفالنا؟ هل يتوجب علينا الوقوف بين الجثامين والانقاض لطلب المغفرة قائلين: «سامحونا»؟
إن تجدد آليات محاربة الشعوب، بكل المستويات قصفا وقمعا وحصارا، يعني شيئا واحدا. إنها، على الرغم من كل الإمكانيات المادية والعسكرية، لم ولن تنجح. وإن روح مقاومة الشعوب الحية، للمستعمر والمستبد، هي الباقية
اثناء قصف بغداد في حملة «الصدمة والترويع» التي شنتها أمريكا ضد الشعب العراقي، عام 2003، وأمام منظر الخراب وحالة الخوف من ان يمحى العراق وأهله، خرجت امرأة أردنية، في أواسط العمر، الى الشارع، مرتلة مثل كاهنة بمعبد تحوك طلب المغفرة، قائلة: «سامحنا يا عراق».
نحن، أهل البلدان المحتلة، المستعمرة، المعرضة للقصف والاغتيالات، نغضب ونبكي ويخامرنا الشك لأننا لسنا غزاة إرهابيين، ننتشي بالموت. الارهابيون لا يتساءلون، لا ينتابهم الشك، لأنهم يتمتعون بالقتل ويطلقون صرخات الابتهاج لحظة سقوط الضحايا مضرجين بدمائهم. يطلق القاتل الصهيوني، ضحكات هستيرية مشتركة مع جنديين آخرين، في فيديو متوفر على اليوتيوب، بعد اصابته شابا فلسطينيا أعزل: «ها… ها… لقد أصبته ابن ال…»..
جنود جيش الاحتلال الاستيطاني، لا يقتلون لأنهم ينفذون الأوامر فقط، بل لأنهم يجدون لذة في القتل، كما تثبت افعالهم، وبتشجيع من المسؤولين. «أفضل الجنود الذين يضحكون وهم يطلقون النار»، يقول عضو الكنيست بيتسالئيل سموتريش. ويصف وزير الأمن صرخات الابتهاج بقتل الفلسطينيين بأنها «ردود فعل إنسانية»، ويؤيده وزير الدفاع قائلا انهم ينتمون الى «الجيش الأخلاقي بالعالم». وبينما تمتد وتتسع مستوطنات الكيان الصهيوني باحتقار كلي للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية، يفتخر المستوطنون بتسجيل فيديو يحتفلون فيه بقتل الرضيع الفلسطيني علي دوابشة حرقا مع والديه وهم أحياء في قرية دوما بالضفة الغربية.
ماذا عن الحكومات والشعوب العربية؟ معظم الحكومات، ترى في زمن انحطاطها، ان فلسطين باتت عبئا عليها وليس احتلالا يجب التخلص منه. بعد ان كانت فلسطين في فترات التحرر الوطني جزءا لا يتجزأ من هوية الأمة والحق الذي لا يساوم عليه. وما كان عارا يتم التستر عليه وانكاره إذا ما كشف بات شرفا يتسابق الحكام على نيله بذريعة القبول بالأمر الواقع. وتبقى صورة السلطان قابوس، الواقف منكمشا، في قصره، في العاصمة مسقط، مع نتنياهو، رئيس «مستوطنة إسرائيل»، هي النموذج الأقوى للذل الذي انحدر اليه الحاكم العربي. في لحظة تماهى فيها الخنوع بالخوف من ان يترك وحيدا أمام شعبه. ماذا عنا؟ كيف تمكن الحاكم الذي نتفق على انه لا يمثلنا من خلع حتى ملابس الامبراطور أمامنا؟
علينا الاعتراف بان تعاون الحاكم العربي مع القوى الاستعمارية أعمق مما نتصور. وهي علاقة تتجدد فيها آليات محاربة الشعوب حسب الحاجة المرحلية. ويتماشى نجاحها مع قدرة الحاكم على استقطاب شرائح مجتمعية يرتبط بقاؤها ومصالحها به أو، وهو ما نراه بوضوح حاليا، تفتيت كل شعب الى عدة شعوب، وكل منها يعيش في غيتو يتم التحكم بحياة افراده الاقتصادية والأمنية، فلا يستطيع التفكير أبعد من الهم المعيشي اليومي. انها السياسة الاستعمارية القديمة « فرق تسد» بمسميات جديدة.
ان تجدد آليات محاربة الشعوب، بكل المستويات قصفا وقمعا وحصارا، يعني شيئا واحدا. إنها، على الرغم من كل الإمكانيات المادية والعسكرية، لم ولن تنجح. وإن روح مقاومة الشعوب الحية، للمستعمر والمستبد، هي الباقية. وإلا كيف يواصل الشعبان السوداني والجزائري الثورة وهم يرفعون العلم الفلسطيني بجانب اعلامهم؟ ولم تخش أكبر قوة عسكرية بالمنطقة الجنين الفلسطيني وهو الذي لم يولد بعد؟
رومانسية زمن القتل في العراق
هيفاء زنكنة
من بين الأسئلة التي أثارتها قيادة «مكافحة التمرد» في العراق وأفغانستان، قبل وبعد غزو البلدين، سؤال بالغ الأهمية، وهو: كيف نكسب قلوب وعقول أهل البلدان «المضيفة»؟ قدمت القيادة العسكرية عديد الخطط، الآنية منها والاستراتيجية، في مؤلفات بات بعضها متوفرا للعامة، كجواب يعالج إشكالية الكراهية الطبيعية أو النامية تدريجيا عند اهل البلد، وان قام البعض بالترحيب بها بداية. وكما ان للعملة وجها آخر، واجهت الإدارة الأمريكية، بشقها السياسي، السؤال نفسه، ولكن بصيغة مختلفة وهي: كيف نكسب قلوب وعقول الشعب الأمريكي ورضاه على شن الحرب؟
اعتمدت الإدارة الأمريكية، لتحقيق مستوى معين من الرضا أو القبول، على مخطط استراتيجي شرعت به منذ التسعينيات. فأسست لذلك لجنة عمليات معلوماتية خاصة، استغلت بواسطتها كل مستويات الاستهداف الدعائي النفسي، من الاعلام الى الجامعات ومراكز الدراسات والبحوث ودور النشر. وكان لدور النشر أثر كبير في تبرير الحرب وان لم يحظ بذات الاهتمام الذي حظيت به أجهزة الاعلام من ناحية الرصد، بحكم سرعة وآنية التأثير الإعلامي السمعي والبصري، بالمقارنة مع بطء وعمق تأثير الكتب. تشكل هذه الجهود جانبا مما شخصه نعوم تشومسكي ونورمان هيرمان في كتابهما «صناعة الرضا»، المنشور عام 1988، عن تلاعب النخب المتحكمة بالعقل الجمعي الأمريكي منذ عشرينيات القرن الماضي.
منذ ان بدأت حملة التهيئة لشن الحرب على العراق، في أعقاب الحادي عشر من سبتمبر، وقائمة الكتب الأمريكية ـ البريطانية عن العراق في تزايد مستمر. وبعد ان كان عامة الأمريكيين والبريطانيين لا يفرقون بين العراق وإيران، إذ حالما تخبرهم أنك من العراق يأتيك التساؤل «إيران؟»، أصبح العراق بلدا يتصدر قائمة الأخبار والمطبوعات، خاصة حين سارع مهندسو الحرب الى تحشيد الأجواء الدعائية النفسية لتقديم صورة للبلد، تسوغ ارسال قواتهم للقتال فيه والتضحية بحياتهم من أجل «تحريره».
تزايد، أيضا، بمرور الوقت، اهتمام دور النشر باستقطاب المؤلفين، من عسكريين ومحللين سياسيين الى «خبراء» في معرفة الشرق الأوسط ونفسية العرب المسلمين، وإن لم ينطق أحدهم باللغة العربية غير كلمة « مرهبا». في تلك الأجواء، المنفتحة على سوق الحرب، باتت هناك فرصة لتسويق كتب كانت تقتصر في موضوعها، حتى ذلك الوقت، على البحوث الأكاديمية التي قلما يقرأها أحد من خارج الحلقة الأكاديمية المغلقة تقريبا. فسارعت دور النشر ومؤسسات الدراسات الاستراتيجية والبحوث والفكر، الى نشر كتب تعريفية بالعراق، تاريخا وحاضرا، واضافة تقارير القمع والاستبداد المناقضة لحقوق الانسان، والخطر المؤكد على العالم من بلد قادر على الوصول بأسلحة دماره الشامل الى الغرب، وبالتحديد بريطانيا، خلال 45 دقيقة، حسب خطب رئيس الوزراء البريطاني توني بلير!
ومع تنوع مستويات التحشيد، دخل عالم النشر بحماس يكاد ينافس الاعلام البصري والسمعي لتأطير صورة بلد بحاجة الى التحرير والديمقراطية، وخلق وعي شعبوي يضاف الى الوعي التاريخي المترسب في الذاكرة الاستعمارية، عن عبء الرجل الأبيض وتحمله مسؤولية رفع مستوى وتمدين الشعوب المتخلفة.
اعتمدت الإدارة الأمريكية، لتحقيق مستوى معين من الرضا أو القبول، على مخطط استراتيجي شرعت به منذ التسعينيات. فأسست لذلك لجنة عمليات معلوماتية خاصة، استغلت بواسطتها كل مستويات الاستهداف الدعائي النفسي، من الإعلام الى الجامعات ومراكز الدراسات والبحوث ودور النشر
أكتسب الكتاب أهمية قصوى في مخاطبة شريحة مجتمعية قد تشكك أو لا تثق بدور الاعلام، الا انها مستعدة نفسيا لتقبل ما هو منشور بالكتب بحكم العلاقة التقليدية بين المثقف والكتاب. لذلك حققت كتب عدد من الباحثين والصحافيين المتخصصين نجاحا في تهيئة أرضية شن الحرب العدوانية والتقبل النفسي باعتبارها جزءا لا يتجزأ من السياسة الأمريكية في «الحرب على الإرهاب»، والمحافظة على الأمن الداخلي واصطياد «الإرهابيين» في بلد ناء بحيث لا يمكن ان يعرض حياة الأمريكي للخطر.
فتم اصدار كتب وتوزيعها بشكل كبير بموضوعات تعكس فكر المحافظين الجدد وخاصة محور دونالد رامسفيلد ـ دك تشيني- بول وولفوتز، الذين تصدروا مراكز صنع القرار في الإدارة الأمريكية.
شكل هذا المحور أساس عديد الكتب المبررة لشن الحرب والاحتلال، كحل وحيد لدمقرطة العراق، متجاهلين ما ستسببه الحرب من خراب بشري وعمراني وانعكاساتها على الاستقرار الاقليمي. كان هذا قبل الغزو أما بعده وتحت الاحتلال، فقد غزت الأسواق كتب من نوع مغاير، احتل عدد منها قوائم الكتب الأكثر مبيعا. اذ انضم الى مؤلفي الكتب اشخاص لم يكونوا يحلمون يوما بالكتابة ناهيك عن النشر. مرتزقة وجنود وضباط. نساء ورجال. سجناء ومدمنو مخدرات ومرضى يعانون من صدمة ما بعد الحرب. اذ أفرزت الحرب على العراق اعلى نسبة من جنود الاحتلال المصابين بصدمات وأمراض نفسية حتى بالمقارنة مع الحرب الأمريكية ضد فيتنام. لجأ معظم الجنود العائدين الى جنس المذكرات للكتابة عن تجربة القتال في العراق، وابراز روح التضحية و«الهوس بإخبار القراء أن الحرب مروعة» مع الإصرار على «ان كل الجنود أشخاص طيبون يبذلون قصارى جهدهم في وضع سيئ»، كما يذكر الصحافي توم بيتر في دراسة له. وكما يذكر الجندي السابق في العراق نيكو ووكر السجين حاليا بتهم ادمان وبيع المخدرات وعدة محاولات نهب للبنوك «مقارنةً بما كنت أفعله في العراق، بدا أن سرقة البنوك بمثابة أفعال أطفال. من الواضح أنه كان خطأ، وأنا أدرك ذلك الآن».
أنها مذكرات يسهب فيها كتابها بإظهار ما تعرضوا له من أخطار، ليكسبوا عطف القارئ الأمريكي حتى ان كانوا مجرمي حرب، متعمدين عدم ذكر العراقيين، أو ذكرهم بطريقة تبين بان موت العراقي محزن ولكن المأساة الحقيقية هي معاناة الجندي الأمريكي.
من بين الكتب التي لاقت نجاحا بعناوين تدل على مضمونها: زمن القتل بالعراق، بوابة قاتل بالعراق، كنا واحدا: جنبا إلى جنب مع مشاة البحرية الذين دخلوا الفلوجة، وفي الرمادي: القصة المباشرة لمشاة البحرية الأمريكية في أكثر مدن العراق دموية. وتمنح دور النشر مساحة كبيرة للجنديات اللواتي يكتبن مذكراتهن. اذ نشر لهن عناوين على غرار: أحب بندقيتي أكثر مما أحبك: شابات في الجيش الأمريكي، وعصبة شقيقات: أمريكيات بالعراق.
المفارقة الكبيرة التي نراها عند اطلاعنا على حمى نشر هذه النوعية من الكتب هي ان نشر الكتب العاطفية ببطولة مقاتلين ومرتزقة بالإضافة الى نشر المذكرات التي تسلط الأضواء على مفهوم البطل/ الجندي الذي يضحي بحياته من اجل نشر «القيم الديمقراطية»، نجح في استقطاب المخيال الشعبي الأمريكي والغربي عموما والفوز بقلوب وعقول الناس العاديين أكثر من كل حملات الترويج الدعائي بكثير. يقول مدير دار نشر «سورسبوكس»: «هناك الكثير من الاهتمام بقواتنا ودعمها. جميع الرومانسيات ذات الطابع العسكري تبيع بشكل جيد للغاية. يصنع الرجال العسكريون أبطالا كبارا، وتصنع النساء العسكريات بطلات رائعات».
الأمر الذي أكده استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث، بأمريكا، مبينا ان 91 بالمئة من الأمريكيين يشعرون بالفخر والاعتزاز بمن خدموا في الجيش، اثناء غزو واحتلال العراق، بينما كانت نسبة من وافقوا على غزو العراق هي 36 بالمئة فقط!
شكرا جوليان أسانج
هيفاء زنكنة
«احرقهم… نعم كلهم!»، يقول الجندي الأمريكي مشجعا زميله وهو يرش العراقيين الذين يتراكضون في الشارع، في بغداد الجديدة، تحت مروحية الاباتشي. يعجبه مرأى الضحايا على الأرض، فيصرخ فرحا «آه، نعم، أنظر إلى هؤلاء الأوغاد الميتين. منظر لطيف». وعندما اكتشفت قوات الاحتلال، فيما بعد، وجود طفلين بين الجرحى، قال المسؤول عن رش الضحايا بالرصاص، مبررا جريمته «حسنًا، إنه خطأهم… جلب أطفالهم إلى المعركة». ليس هذا الحوار واطلاق صرخات الفرح بالقتل المتعمد هو لقطة في فيلم هوليوودي. بل هو واحد من الأفلام والوثائق السرية التي كشفها الصحافي جوليان أسانج عام 2010، في تسريبات، ما بات يعرف بـ«ويكيليكس»، التي أدت إلى القاء القبض عليه من قبل الشرطة البريطانية، يوم الخميس 11 نيسان/ أبريل، بعد إخراجه عنوة من سفارة الاكوادور، في لندن، بعد سبع سنوات ونصف من بقائه لاجئا فيها. تم خلال سنوات لجوئه الكشف عن مئات الآلاف من الوثائق الأمريكية وغيرها الفاضحة لتبادل المعلومات التي طالما أريد لها ان تبقى طي النسيان، والا يطلع عليها المواطنون لما تحويه من مساس بحرية الفرد والرأي ومساحة التآمر عليه، غالبا، بذريعة «الأمن القومي».
كان الفيديو الذي كشف جريمة قتل 12 مواطنا عراقيا، عام 2007، بضمنهم صحافيون عاملون لدى وكالة أنباء رويترز، وهما نمير نور الدين ( 22 عاما) ومساعده سعيد شماغ ( 40 عامًا، متزوج. ترك أرملة وأربعة أطفال)، والذي ساعدت صحيفة «الغارديان» البريطانية، على توزيعه بشكل واسع، ومن ثم تناقلته أجهزة الإعلام، في جميع انحاء العالم، هو الذي سلط الأضواء بقوة على أهمية عمل فريق «ويكيليكس» التحقيقي الصحافي، المستند إلى حق حرية التعبير، وهو الذي جعل الادارة الأمريكية تطالب برأس الفريق أسانج، حسب فرضية إقطع الرأس تتخلص من الجسد، وبعد أن القت القبض على الجندي الأمريكي برادلي ماننغ، الذي قام بتسريب الفيديو، مع 750 ألف وثيقة عسكرية ودبلوماسية أخرى، إلى «ويكيليكس».
احتل الفيديو أهمية خاصة، أيضا، على الرغم من كشفه بعد مرور ثلاث سنوات على ارتكاب المذبحة، لأنه أوضح بالصوت والصورة، زيف الادعاءات عن « التحرير» و«انسانية» المحتل.
اذ بينت صرخات الابتهاج بحصد الأرواح من طائرة مروحية من طراز أباتشي (المرتبطة بالاذهان بالمجازر الأمريكية بفيتنام)، وبآلات القتل المتطورة، كيف تعتبر قوات الاحتلال نفسها: إنها فوق البشر. وكيف ترى العراقيين كأوغاد مجهولي الهوية، يحاولون الحاق الضرر بهم وهم الذين جاؤوا لـ« تحريرهم».
كان الفيديو الذي كشف جريمة قتل 12 مواطنا عراقيا، عام 2007، بضمنهم صحافيون عاملون لدى وكالة أنباء رويترز، هو الذي سلط الأضواء بقوة على أهمية عمل فريق «ويكيليكس» التحقيقي الصحافي، المستند إلى حق حرية التعبير
العراقيون، إذن، أوغاد، بلا اسماء، بدون إنسانية – وتجريدهم من إنسانيتهم، كفعل منهجي متعمد، يجعل قتلهم سهلاً. هكذا، مارس المحتل الأمريكي والبريطاني التعذيب، بأبشع صوره، في سجن أبو غريب ومعسكر «بريد باسكت»، وارتكب المجازر في مدينة حديثة (التي تمت مقارنتها بمذبحة ماي لاي خلال حرب فيتنام) ؛ والاسحاقي (حيث قتل 11 مدنيا عراقيا في يونيو 2006) ؛ والفلوجة التي تم هدم 70 بالمئة منها، بالاضافة إلى اغتصاب وحرق الطفلة عبير الجنابي وعائلتها، ومن ثم اتهام « المتمردين السنة» ليغطي الغزاة جريمتهم. وغالبا ما يأتي أحدهم ليبرر جرائم قتل الاطفال بأن الخطأ هو «خطأهم»، أي اهل البلاد، لأنهم يجلبون الاطفال إلى أرض المعركة. ولأن جوهر المحتل واحد أينما كان، استمعنا إلى ذات التبرير من قبل ناطق باسم الكيان الصهيوني عندما وثقت كاميرا (قناة فرانس2) في 30 أيلول/سبتمبر 2000، جريمة قتل الطفل الفلسطيني محمد الدرة ( 11 سنة)، وهو بحضن والده جمال، وسط قطاع غزة، لحظة بلحظة. حيث واصل جنود الاحتلال رشهما بالرصاص بعد أن اختبأ خلف برميل إسمنتي طلبا للحماية من عمليات إطلاق النار. إدعى متحدث الكيان الصهيوني، للتبرؤ من قتل محمد الدرة، بعد أن هزت صورته ضمير العالم «أن الفلسطينيين يضحون بأطفالهم لتشويه صورة إسرائيل»!
بالاضافة إلى الفيديو، نشرت منظمة «ويكيليكس» الاعلامية، يوم 22 أكتوبر 2010، أكبر تسريب عسكري سري في التاريخ، وهو نشر 391،832 من «سجلات حرب العراق»، التي توثق الحرب واحتلال العراق، من 1 يناير 2004 إلى 31 ديسمبر 2009 (باستثناء شهري مايو 2004 ومارس 2009) كما سجلها جنود الأحتلال في التقارير الرسمية، ووصفوا فيها الاحداث، كما رأوها وسمعوا عنها، دقيقة دقيقة. وهي أول لمحة حقيقية عن التاريخ السري للحرب التي كانت حكومة الولايات المتحدة مطلعة عليه طوال الوقت، حسب تعبير ويكيليكس.
توثق السجلات المنشورة في موقع Iraq War Logs ))، بالتفصيل، وفاة 109،032 شخص في العراق، تتألف من 66،081 ‘مدني’ ؛ 23984 «عدو» (من يطلق عليهم اسم المتمردين) ؛ 15،196 «دولة مضيفة» (قوات الحكومة العراقية) و 3،771 «صديقة» (قوات التحالف). غالبية القتلى أي 60 بالمئة من 66 ألف هم من المدنيين. بلغ معدل القتلى 31 مدنيا في اليوم خلال فترة السنوات الست. للمقارنة، توضح «مذكرات الحرب الأفغانية»، التي أصدرتها ويكيليكس سابقا، والتي تغطي نفس الفترة، مقتل حوالي 20 ألف شخص. مما يجعل ضحايا العراق الموثقين لدى قوات الاحتلال خلال نفس الفترة، خمسة أضعاف العدد في أفغانستان لنفس النسبة السكانية. وغني عن القول ان أعداد الضحايا أكبر بكثير اذا ما حسبنا وفيات الجرحى بعد حين، وكذلك الوفيات نتيجة دمار المستشفيات وانتفاء الخدمات الطبية وسوء المواصلات.
هذه الأعداد المسماة بـ«الوفيات الإضافية» هي التي تم التعامل معها عالميا لتقدير نتائج الحروب السابقة، والتي استخدمت في تقديرات مجلة لانسيت الطبية المعروفة عالميا، عام 2006 عن وفيات العراق الإضافية، وهي 654 الف عراقي في السنين الثلاث الاولى للاحتلال.
بالنسبة الينا كعراقيين، للسجلات الأمريكية العسكرية التي كشفها جوليان اسانج، مهما كانت نسبة تسجيلها، أهمية قصوى، خاصة في مجال محاسبة المسؤولين عن شن الحرب ضد العراق كمجرمي حرب، والى ان يبادر عدد من الباحثين العراقيين بتفكيك الرموز المتعارف عليها عسكريا، التي استخدمت بكتابتها، ومن ثم ربطها بمجريات الاحداث والجرائم التي غطتها الصحافة، وتقديم ولو جريمة واحدة إلى المحاكم الدولية، إلى ان يتم ذلك اقول شكرا جوليان اسانج فلولا ما سربته لنا أنت وفريق منظمة «ويكيليكس» من سجلات جرائم بحق شعبنا، من حقائق عن الحرب الامبريالية القذرة، لما كان بامكاننا حتى ان نحلم بذلك.
حملات التضامن العالمي…
هل بامكانها تغيير العالم؟
هيفاء زنكنة
شهد الأسبوع الماضي، في لندن، ومدن عربية وغربية أخرى، مظاهرات لدعم مسيرة «العودة الكبرى» وذكرى «يوم الأرض» الفلسطيني الذي يرمز إلى مقاومة الاحتلال الإسرائيلي. كانت هناك وقفة احتجاجية، أمام سفارة الكيان الصهيوني نظمتها «حملة التضامن مع فلسطين» في بريطانيا، ودعت منظمة «أوقفوا الحرب» البريطانية بالمشاركة مع عدة منظمات تضامنية بريطانية ـ فلسطينية، الى مظاهرة ونشاطات، يوم 11 أيار/مايو، تقام في جميع ارجاء بريطانيا، بعنوان «موجود… أقاوم… أعود»، وهو عنوان يجمع بين الوجود الانساني وحق المقاومة وحق العودة الى الوطن. وهو شعار أطلقته المنظمة الاسبانية للتضامن مع الشعب العراقي، ومقاومته للاحتلال الانكلو ـ أمريكي عام 2003. كان الشعار «أنا أقاوم… انا موجود»، المقتبس بتصرف من مقولة للكاتب الفرنسي البير كامو، حيث يصبح الوجود وحب الحياة شكلين من أشكال المقاومة. واذا كانت حملات التضامن تقتصر، حتى وقت قريب، على التظاهرات والاعتصامات واقامة الندوات، فانها تطورت، أخيرا، لتمتد على مدى اسابيع وشهور، بهدف تجذيرها بالذاكرة، ومقارعة النسيان، كما في «اسبوع التضامن مع الشعب الفلسطيني» و«شهر التضامن مع العراق» الذي يمتد في شهري آذار/ مارس ونيسان/ أبريل، سنويا، للتذكير بجريمة الحرب العدوانية ضد العراق وأحتلاله، وللتعريف بنتائج الاحتلال من خراب بشري ومادي.
تتزايد هذه النشاطات التضامنية، الجامعة احيانا بين عديد القضايا العربية في آن واحد، وعلى رأسها الاحتلال الصهيوني لفلسطين، بشكل طردي مع تصاعد حمى الاستسلام والاستخذاء الرسمي العربي. ومن يراجع يوميات الخنوع الرسمي، الذي كان مستورا في الماضي وبات مكشوفا بلا خجل الآن، سيظن ان هناك مسابقة (أو لعلها صفقة العصر!) تتنافس على الفوز بها أنظمة الاستبداد والفساد.
في هذه الاجواء ومع التغطية الإعلامية المتصهينة، العربية والغربية معا، وتسويق «ديمقراطية» الانتخابات بالغزو والاحتلال، تبرز أسئلة على مستوى: ما هي اهمية هذه التظاهرات؟ ما هو جدوى الوقوف أمام سفارة كيان مستهتر بالقوانين الدولية، يحظى بدعم أمريكي، مع وجود حكام عرب يرون ان مهمتهم الأولى هي قمع شعوبهم، وجعلهم مستعدين لقبول الاستعمار؟ ثم ما هو معنى «التضامن»، وآلة القتل الامبريالية تتغذى على الضحايا بشكل يومي؟
يقدم تحالف «أوقفوا الحرب»، الذي يضم عدة منظمات بريطانية ـ فلسطينية، في دعوته الى اقامة نشاطات تضامنية متعددة، بعض الاجوبة عما يهدف اليه الفعل التضامني: « يحتاج الشعب الفلسطيني إلى تضامننا أكثر من أي وقت مضى، ويدعو إلى احتجاجات عالمية لحماية حقوقه الجماعية. مع استمرار (إسرائيل) في انتهاك القانون الدولي وانتهاك حقوق الإنسان، هناك مسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي في مساءلتها والضغط من أجل وضع حد لقمع الشعب الفلسطيني». كما يبين منظمو «شهر التضامن مع العراق»، وجها آخر لتنظيم الشهر، فأن يبقى العراق في الذاكرة، قضية في غاية الأهمية لملايين الضحايا الذين يستحقون العدالة، وهو ضروري للتذكير بجرائم الاحتلال في تهديم دولة وتفكيك مجتمع واستهداف ثقافة شعب، ولكي لا تتكرر الجريمة أبدا.
إن العمل التضامني، بمستوياته المتعددة، فعل أخلاقي، لا يستند الى المصالح الفردية، بل يستمد قوته من القيم الإنسانية المشتركة المناهضة للظلم والقمع والطغيان
على مستوى آخر، أنه مناسبة للاحتفاء بتاريخ ومقاومة الشعب العراقي، وطموح العراقيين في تحقيق السلام المبني على المساواة والعدالة. وهي مناسبة يشترك بها كل ناشط بمبادرته وتنظيمه ومن زاويته، ولا تسجل الا لمصلحة العراق كبلد في وعي ابنائه ووعي الانسانية ككل.
يربط التضامن بين ما هو اجتماعي، وسياسي، وأخلاقي، معا، في نهج سياسي متميز يعترف بمصادر القوة الاجتماعية من ناحية ومصادر الدافع الأخلاقي من ناحية أخرى.
هذه الأهداف الواضحة ذات اهمية قصوى لحث الجماهير على التفاعل الايجابي، والعمل على انجاز تغيير محدد من قبل مجموعة توحدت لهذا التغيير. مع مراعاة التأكيد على ان حملات التضامن العالمية سواء كانت سياسية أو إجتماعية، قلما تؤدي الى إحداث تغيير فوري، ونادرا ما تكون فاعلة لوحدها. والوعي بهذه النقطة يجنب الناشطين وعموم الناس خيبة الامل والاحباط المرتبطين بالرغبة برؤية نتيجة مثمرة فورية. ان حركات التضامن العالمي تهيئ الارضية للتغيير، لكنها نفسها لا تغير. ولانها تنبع من القاعدة الجماهيرية، وليس من قمة الهرم السلطوي، فانها تتوخى التوعية فضلا عن ممارسة الضغط السياسي. وتكمن قوتها، بعيدة المدى، في تمتين العلاقة والنضال المشترك بين شعوب الدول حتى الامبريالية منها. فلمدة أربع سنوات، في أواخر ثمانينيات القرن العشرين، واصل المتظاهرون المناهضون للفصل العنصري احتجاجهم المستمر، ليلا ونهارا، خارج سفارة جنوب إفريقيا في لندن. ولا يمكن لأحد ان يدعي ان انهاء النظام العنصري أو اطلاق سراح نلسون مانديلا كان نتيجة الاعتصام، الا انه لايمكن لأحد ان ينكر أهمية تذكير الحكومة البريطانية المتواطئة مع النظام العنصري بأنها لا تمثل الشعب البريطاني كله، ولا ينكر أهمية احساس ضحايا التمييز العنصري بأن هناك من يتضامن معهم، فضلا عن تطوير أساليب التضامن من خلال استمرارية الاعتصام وسيرورته. وهذا هو ما يهدف اليه منظمو «شهر التضامن مع العراق»، في عامه الاول، ونراه، بشكل واضح، في نجاح حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (بي دي أس)، التي تأسست عام 2005، وشرعت بتوجيه نداء الى شعوب العالم، يطالبهم بدعمها كشكل رئيسي من أشكال المقاومة الشعبية السلمية الفلسطينية، وكأهم شكل للتضامن العالمي مع نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه. صحيح ان حملة المقاطعة لم تنجح بانهاء الاحتلال الا انها حققت نجاحا ملحوظا في قيادة حملة مقاطعة الكيان الصهيوني، على مختلف المستويات الاقتصادية والثقافية والفنية، الى حد دفع الكيان الصهيوني الى اعتبارها خطرا أمنيا يهدد بقائه.
يكمن نجاح حملة التضامن في وضوح الهدف وامكانية تحقيقه من قبل كل من لا يريد الوقوف بجانب المحتلين/ الطغاة/ الجلادين. هذه الامكانية تمنح الفرصة للاستمرارية وبالتالي خلق ديناميكية الأمل وعدم الاصابة بالاحباط واليأس ازاء جسامة المهمة. إن العمل التضامني، بمستوياته المتعددة، فعل أخلاقي، لا يستند الى المصالح الفردية، بل يستمد قوته من القيم الإنسانية المشتركة المناهضة للظلم والقمع والطغيان. ولكي نساهم جميعا في هذا الفعل الاخلاقي النبيل «لا يتعين علينا الانخراط في أعمال بطولية كبرى للمشاركة في عملية التغيير. الأعمال الصغيرة، عندما تضرب بملايين الناس، يمكن أن تغير العالم «، كما يذكرنا المؤرخ الاشتراكي الأمريكي الراحل هوارد زن.
كاتبة من العراق
هدية أمريكا إلى العراقيين…
كوكتيل الملوثات السامة
هيفاء زنكنة
احتل خبر علمي، في الاسبوع الماضي الموقع الثاني بعد « البريكست» في اجهزة الاعلام البريطانية. وتناول خبر ثان موضوعا مماثلا ولكن في أمريكا. وللخبرين علاقة وثيقة بالعراق والدول المحيطة به. تناول الخبر الأول نتائج الابحاث التي أجرتها جامعة « سنترال لانكشاير»، ببريطانيا، على مقربة من «غرينفيل تاور»، بلندن، الذي تعرض لحريق هائل أودى بحياة 72 من سكانه في حزيران/يونيو 2017.
أجريت الابحاث بعد ان اشتكى عدد من السكان المقيمين على مقربة من المبنى من مشاكل صحية تراوح أعراضها بين السعال المصحوب بالدم والامراض الجلدية وصعوبة التنفس. بعد مرور ستة أشهر على الحريق، تم تجميع عينات من التربة، فتبين إن مستويات المواد الكيميائية السامة التي أطلقها الحريق عالية وأن كثيرا منها سامة بشكل حاد أو مزمن، مما سيزيد من احتمال الاصابة بأمراض الربو والسرطان. وحين قام فريق من جامعة كاليفورنيا، في لوس أنجلوس، بتحليل عينات من التربة والحطام مأخوذة من ستة مواقع على بعد 1.2 كم من المبنى، كشفت الدراسة عن «تلوث بيئي كبير» في المنطقة المحيطة، بما في ذلك الرواسب الزيتية التي جمعت بعد 17 شهرًا. بناءً على مستوى المواد الكيميائية التي تم اكتشافها، خلص العلماء إلى زيادة خطر حدوث عدد من المشكلات الصحية لتلك الموجودة في المنطقة. وأوصوا باجراء فحص صحي، طويل الأجل، لتقييم أي آثار صحية ضارة للحريق وما أفرزه من مواد، على المدى البعيد، على السكان المحليين وحتى فرق الانقاذ وعمال التنظيف.
أما الخبر الثاني فمفاده تبنى الكونغرس الأمريكي مطالبات الجنود بالتعويضات المادية والرعاية الصحية، وهم الذين قاتلوا بالعراق وأفغانستان واصيبوا بالامراض جراء التلوث الناتج عن حرق النفايات في القواعد الأمريكية. وصفت السناتور آمي كلوبوشار، من الحزب الديمقراطي، حرق النفايات قائلة «هذا هو عامل جيلنا البرتقالي»، في إشارة إلى مبيد الأعشاب السام الذي رشته أمريكا على غابات فيتنام بين 1955 و 1975، للقضاء على المقاومة الفيتنامية، وأصاب رذاذه الجنود الأمريكيين ايضا، مسببا لهم أمراضا مستعصية.
لهذين الخبرين، علاقة وثيقة بالتلوث البيئي الهائل، المسكوت عنه رسميا، الذي يعيش في ظله المواطن العراقي. وقد يصلحان، بالاضافة الى ما هو متوفر من بحوث عراقية ودولية، كنقطة انطلاق لمحاكمة الدول التي استخدمت أنواع الاسلحة (وبعضها محرم دوليا) وما نتج عنها من تفجيرات واطلاق لملوثات سامة على مدى عقود بدءا منذ التسعينيات. ان ما توصل اليه العلماء من تأثير السموم الكيمياوية على السكان المقيمين على مبعدة كيلومترات من غرينفيل تاور نتيجة حريق تم حصره بشكل سريع بالمبنى نفسه ولم يمتد الى أماكن أخرى (وهذا ما يجب ان يكون حرصا على حياة المواطنين)، يشكل مقارنة مرعبة بما تعرض له العراقيون، في عديد الأماكن والمدن، على مدى عقود وليس أياما.
إن السموم الموجودة في الدخان الناتجة عن حرق النفايات في المنشآت العسكرية الأمريكية في العراق، يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في التسبب في سرطان قدامى المحاربين». وإن «نسبة الإصابة بالسرطان الأعلى بكثير تأتي من العراق الآن ومن أفغانستان أكثر من الحروب الأخرى
تشكل أصناف الاسلحة ونوعية القنابل والمواد الكيميائية التي تم استخدامها ضد العراقيين، من قبل قوات التحالف بقيادة أمريكا وبريطانيا، قائمة لا تساويها بطولها غير قائمة الامراض التي تغزو أجسادهم، وتتجذر في حالة النساء الحوامل وصولا الى الأجنة حيث أثبتت البحوث المستقلة قدرتها على التغيير الجيني.
من بين الأسلحة التي تم استخدامها، بالاضافة الى التجريبية، اليورانيوم المنضب، القنابل العنقودية والنيوترنية والحرارية، الفسفور الابيض (نوعه المحرم)، النابالم، وبحدود 19 ألف قنبلة « ذكية» و حوالي 9 آلاف «غبية». هذا جزء بسيط مما رصدته. د سعاد ناجي العزاوي، الاستاذ المشارك في الهندسة البيئية، في بحوثها وأوراقها العلمية العديدة. ومن أهم هذه البحوث 12 بحثا، حول التلوث الإشعاعي باليورانيوم المنضب في العراق، بعد حرب الخليج الأولى، واختيار أفضل المواقع لردم والتخلص من النفايات الصناعية والمشعة. توصلت في آخر ورقة علمية لها، بعنوان «نمذجة انتقال ملوثات اليورانيوم المنضب جنوب العراق»، الى استنتاجات مهمة من بينها ان التربة الملوثة بتركيز عال ومتوسط هي مصدر مستمر لانبعاث غاز الرادون الذي يستنشقه المواطنون بشكل مستمر. وان المناطق الملوثة بأكاسيد ونويدات انحلال اليورانيوم المنضّب بتراكيز عالية تعتبر مصادر تلوث مستمرة لأنها تصبح عالقة في الجو مع كل عاصفة رملية في المنطقة، مما يعرض السكان والبيئة الاحيائية لجرعات اشعاعية اضافية ترفع من مستويات معاملات الخطورة، للاصابة بالأمراض الناجمة عن مثل هذا النوع من التلوث.
واذا كان ما أطلقه حريق «غرينفيل تاور» من سموم، قد سبب أعراضا مرضية للسكان وهو مبنى واحد، فماذا عن قصف المدن (الفلوجة والموصل مثلا) و حرق قوات الاحتلال لمخلفاتها في حفر مكشوفة في 52 قاعدة عسكرية (بضمنها كردستان وكربلاء)؟ لم يعر المحتل اية اهمية للسموم التي نثرها الى ان ظهرت نتائجها على قواته. وكان لوفاة ابن جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق، الذي كان ضمن قوات الاحتلال بالعراق، واصيب فيما بعد بسرطان دماغ من النوع النادر، تأثير اعلام، خاصة حين قال جو بايدن في مقابلة تلفزيونية مع «بي بي أس نيوز أوار» الأمريكية، بانه يعتقد «أن السموم الموجودة في الدخان الناتجة عن حرق النفايات في المنشآت العسكرية الأمريكية في العراق، يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في التسبب في سرطان قدامى المحاربين». وان «نسبة الإصابة بالسرطان الأعلى بكثير تأتي من العراق الآن ومن أفغانستان أكثر من الحروب الأخرى».
ومن يزور الموقع الحكومي للمحاربين القدامى الأمريكيين، سيجد معلومات مخيفة عن نوعية النفايات التي يحرقها المقاولون والجيش في حفر مفتوحة. من ضمنها: «المواد الكيميائية والطلاء والنفايات الطبية والبشرية وصناديق المعادن / الألومنيوم والذخائر وغيرها من الذخائر غير المنفجرة ومنتجات البترول ومواد التشحيم والبلاستيك والمطاط والخشب والأغذية الفاسدة. ويضاف الوقود النفاث كمعجل»، ويعتمد مدى انتشار الدخان على مواقع الحرق والرياح السائدة.
في أواخر صيف 2008، تم حرق 147 طنا من النفايات في اليوم، في قاعدة بلد لوحدها. وحسب الموقع الحكومي الأمريكي ان السموم المتصاعدة من الحرق تؤثر على الجلد والعينين والجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية والجهاز الهضمي والأعضاء الداخلية. وفي نوفمبر 2018 نشرت قناة « فوكس نيوز»، نتيجة دراسة علمية، عنوانها «قدامى المحاربين يعانون من وفيات عالية بسبب السرطان نتيجة التعرض لحرق النفايات في الهواء الطلق»، أعدها باحثون في جامعة أوغوستا في جورجيا، خلصت الدراسة الى ازدياد احتمال وتطور سرطانات خطيرة وأمراض أخرى.
مقابل ذلك، ماذا عن ضحايا السموم والتلوث من العراقيين؟ هناك تعتيم حكومي شامل يتغذى على الفساد الأمريكي – العراقي المشترك، ويبقى الأمل الوحيد، حاليا، هو بعض المبادرات الفردية المعنية بتجميع المعلومات ونتائج البحوث واعداد الملفات لمقاضاة المسؤولين، على أمل النجاح، كما في فيتنام، مستقبلا.
كاتبة من العراق
في الموصل… جريمة وليست فاجعة
هيفاء زنكنة
انها المرة الأولى، منذ غزو العراق عام 2003، التي يقوم فيها محتجون بمطاردة رئيس الجمهورية، يخترقون حاجز حمايته وحرسه المسلح الخاص، ويجبرونه على الفرار، وهو على وشك الاختناق من صرخات الغضب، وموجة الأجساد التي انهكها الحزن. أجبروه على نزع ابتسامته، المستهينة بالناس عادة، ليرتسم على وجهه ذعر، صورته أجهزة الموبايل المرتفعة على الرؤوس. سجلت العدسات كيف بات همه الاول في تلك اللحظات، هو الهرب ممن افترض انه جاء ليكذب عليهم. زحف الى السيارة المصفحة التي تحمل أسم «حماية القائد». تجاذبته الايدي، وسُحبت سترته عدة مرات حين اراد الجلوس فيها. أراد المحتجون ان يعرف ان غرق الضحايا، بالموصل، جريمة وليس فاجعة، وانه، يجب ان يحاسب كما كل مسؤول، أيا كان منصبه، فالفساد معروف، والإرهاب معروف، والاستهانة بحياة المواطنين وحقوقهم لم تعد سرا خفيا، وان السمكة فاسدة من رأسها.
المحتجون هم أهل ضحايا العبٌارة التي أودى غرقها، منذ ايام، بحياة 120 شخصا، بينهم 62 امرأة و18 طفلا، كانوا قد ارتدوا ملابس العيد متوجهين الى جزيرة أم الربيعين، للاحتفال بعيد نوروز، ببدء الربيع، وعيد الأم. المحتجون هم من أهل الموصل، المدينة التي لايزال ضحايا «تحريرها قصفا»، تحت الانقاض، بعد مرور ثلاثة أعوام. المدينة التي يتحكم بحياة أهلها اليوم ميليشيات طائفية، ومحافظ فاسد يمتهن السمسرة، مع آخرين، في عقود «اعادة الاعمار» الوهمية، حاميا نفسه بكل الطرق وبضمنها اعتقال الصحافيين المستقلين وحصر موافقات التصوير والتغطية الإعلامية به شخصياً.
هل كانت زيارة الموت مفاجئة وغير معروفة الأسباب؟ من يراجع يوميات الموصل، منذ الاحتلال، وحتى اليوم، سيجد نفسه ازاء جواب مخيف. فالموت بأشكاله غير المبررة، المبتذلة، والوحشية، مقيم في المدينة. يتجول في أزقتها وغاباتها، قد يغادرها لوهلة الا انه سرعان ما يعود اليها متخفيا أو كاشفا عن أوجهه. فللموت، بالموصل أوجه متعددة. كان المحتل الأمريكي أولها حين أولت قوات الاحتلال للمدينة «رعايتها» وذلك لموقعها الخاص وتنوعها الديني والعرقي. ولأنها، مثل مدينة الفلوجة، رفضت الخضوع للمحتل وقاومته، بكل الطرق الممكنة، كما ينص ميثاق الأمم المتحدة بحق الشعوب بمقاومة الاحتلال. فكانت معركة الموصل في تشرين الثاني/نوفمبر 2004 التي نجحت المقاومة فيها من استعادة ثلثي المدينة، الى ان تم أرسال 20 ألف جندي من الفرقة 101، المحمولة جواً، بقيادة اللواء ديفيد بترايوس، الذي تمت ترقيته فيما بعد الى منصب القائد العام للقوات الأمريكية، ومن ثم رئيس وكالة المخابرات الأمريكية (السي آي أي) مكافأة له على إنجاح سياسة «مكافحة التمرد» في الموصل أولا ثم بقية العراق. وأرسلت قوات الاحتلال، بالتعاون مع نوري المالكي رئيس الوزراء الذي كان يعرف نفسه بأنه «شيعي قبل ان يكون عراقيا» تعزيزات عسكرية لكبح «التمرد» مرة اخرى عام 2007.
عملت أجهزة الاعلام بحمية ومثابرة على التضليل وتخدير العقول، صاحبها فساد القضاء، لتوفير الحماية لساسة «العملية السياسية»، وارتكاب كل الخروقات والجرائم خارج نطاق القانون، بينما صار مصير أي شخص يحاول ولو اثارة التساؤل حول حقيقة ما يجري، الاتهام بالإرهاب
منذ ذلك الحين، وحتى العام الماضي، وعمليات قوات الاحتلال، سواء كانت أرضا أو جوا (بعد احتلال داعش للموصل في 2014) مستمرة تحت عناوين مختلفة ولمحاربة «أعداء» بأسماء تتغير بتغير المتطلبات. فاذا كان «العدو» في بداية الاحتلال هو البعثي والصدامي وضباط الجيش الصدامي المنحل، فأنه تحول تدريجيا الى الإسلامي الإرهابي، عضو تنظيم القاعدة، أولا ثم الدولة الإسلامية (داعش) ثانيا، ولاتزال ماكنة انتاج «العدو» ناشطة لتسويق عدو جديد.
بالتزامن معها، عملت أجهزة الاعلام بحمية ومثابرة على التضليل وتخدير العقول، صاحبها فساد القضاء، لتوفير الحماية لساسة «العملية السياسية»، وارتكاب كل الخروقات والجرائم خارج نطاق القانون، بينما صار مصير أي شخص يحاول ولو اثارة التساؤل حول حقيقة ما يجري، الاتهام بالإرهاب والعمالة بل والتصفية الجسدية.
وفي ظل الحكومات العراقية، ونتيجة للفساد المستشري، حسب التقرير الأخير لمرصد الحريات الصحافية الدولي، باتت «المؤسسات الحكومية تعتم على المعلومات، مما يعرض الصحافيين الى الخطر والملاحقة والتهديد، ولا سيما الساعين الى استحصال معلومات ووثائق متعلقة بالفساد المتعدد الاوجه، فغالباً ما تلجأ تلك المؤسسات إلى حظر نشر المعلومات ومنع تداولها». فتزايد عدد مكاتب «المتحدثين الرسميين» المختصين بتقديم البيانات حول «أنشطة» المسؤولين الايجابية فقط، بالإضافة الى منابر الاعلام الحزبية، بينما أغلقت الابواب امام الصحافيين.
هذه هي خلفية جريمة غرق العبارة. انها ليست « حادثا» مؤسفا أو كارثة بيئية نترحم فيه على أرواح الضحايا، نقيم مجالس العزاء وقد نقبض بعض التعويضات، ثم ننسى. بينما يواصل السراق النهب من جهة والجلوس في استديوهات القنوات الفضائية، متظاهرين بالنزاهة واتهام الآخرين بالنهب، من جهة أخرى. نحن ازاء عصابة تتقن الكذب على الشعب وتزوير الحقائق. إذ من الضروري تزوير التاريخ واضفاء صفة النبل على ما يرتكبونه.
وهذا هو بالضبط ما أعلنوا أنهم «سيقومون» به، إزاء «فاجعة العَبٌارة». أرسل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بعد ان رأى ما لحق برئيس الجمهورية برهم صالح، تغريدة الى رئيس البرلمان طالب فيها بإقالة محافظ نينوى «للاهمال والتقصير الواضحين في أداء الواجب والمسؤولية، ووجود ما يدل من تحقيقات تثبت التسبب بالهدر بالمال العام واستغلال المنصب الوظيفي». ووافق البرلمان على الطلب داعيا الى « تشكيل لجنة تحقيق». يهدف هذا القرار، كما هو واضح، الى القاء اللوم على ثلاثة أشخاص هم المحافظ ونائبيه، بعد ان اكتشف رئيس الوزراء، فجأة، وبقدرة قادر، اهمال وتقصير المحافظ، فأرسل تغريدته للاعلان عن اكتشافه وبيان نبل أخلاقه. غاية القرار الحقيقة هي طمر الفساد الأكبر، المتجذر بعمق المؤسسات الحكومية في كافة ارجاء العراق وليس الموصل لوحدها، بدءا من رأس السمكة حتى ذيلها.
أما الاعلان عن تشكيل لجان التحقيق أو فتح الباب لذوي الضحايا للمطالبة بالتعويضات، فانه مسخرة أخرى واستهانة لا مثيل لها بذكرى الضحايا وذويهم، فكلنا يعلم مصير مئات لجان التحقيق التي تم تشكيلها منذ الغزو وحتى اليوم. أنها لجان فضائية، حسب معجم العملية السياسية، واذا وجدت لغرض دفع مخصصات لأعضائها، فلم يحدث وتم الاعلان عن نتائجها. أما طلب اهل الضحايا بالتعويضات، فكلنا يعرف تكلفة التقدم بأي طلب كان الى أية جهة حكومية والذي من المستحيل انجازه بدون دفع مئات وآلاف الدولارات. إن ما قام به المحتجون، في أعقاب انتشال الضحايا، فعل نابع من فهم لما حدث والظروف التي ادت الى حدوثه، وهو أعمق من المخدر الذي تقدمه الحكومة والبرلمان.
كاتبة من العراق
هل نحن مسؤولون عن مجزرة نيوزيلندا؟
هيفاء زنكنة
قيل وسيقال الكثير حول المجزرة التي ارتكبت اثناء صلاة الجمعة، يوم 15 مارس/ آذار، في مسجدين، في مدينة كرايست تشيرش، في نيوزيلندا. وقد يكون ما لن يقال أكثر. ففي لحظات الفاجعة الانسانية الجماعية، وحتى ما يليها، يصاب العقل بصدمة تعيقه عن رؤية الحدث بجوانبه المتعددة، وغالبا ما تكون الاستجابة العاطفية خليطا من حزن وألم وذعر وغضب واستعادة لذكريات مريرة، في آن واحد. يتبدى هذا بوضوح على المستوى الانساني ـ الفردي وامتداده الجماعي. فتكون ردود الافعال، الآنية والبعيدة في بعض الحالات، نوعا من التشبث الانتمائي بالمجموعة، أيا كانت. خاصة اذا استقطبت الفاجعة الاهتمام سياسيا واعلاميا، وبات مادة خصبة للتداول بين ساكني مواقع التواصل الاجتماعي.
توفرت هذه المواصفات، كلها، في ردود الافعال حول ارتكاب مجزرة الجامعين وما تلاها. فهي المرة الاولى التي يحدث فيها مثل هذا العمل الإرهابي في البلد الذي بدا للعالم، حتى لحظة المجزرة، كأنه يغفو، بسلام، بعيدا عما ينتاب البقية. جاء جرس الاستيقاظ، بشكل شاب ابيض، وصل الى نيوزيلندا من استراليا، مسلحا، سلاحه مجاز قانونيا، وليس لديه أي سجل في دوائر الشرطة او القوات الامنية او الاستخبارات، في كلا البلدين، على الرغم من تنسيق الاجهزة الامنية بينهما. نفذ جريمته بتخطيط دقيق الى حد ترتيب البث الحي، دقيقة بدقيقة، وهو يرتكبها. تكلف نداء التنبيه الى وجود «اليميني المتطرف»، حسب توصيفه محليا وعالميا، دماء ما يزيد على الخمسين ضحية وعشرات الجرحى، من مصلين مسالمين، نساء ورجال وأطفال، كانوا يظنون أنفسهم آمنين في المسجدين، يوم الجمعة.
تبين مراجعة سردية ظهور «الإرهاب»، المفاجئ في نيوزيلندا واستراليا، التي انتشرت بعد ارتكاب المجزرة، وجود ثقوب عميقة، أو فراغات واسعة في الفكر الغربي السائد. لعل أهمها هو تغاضي اجهزة الامن والاستخبارات الغربية، عموما، عن وجود وممارسات اليمين الابيض المتطرف، المركزة على نشر خطاب الكراهية ضد اللاجئين و«الاجانب» من غير البيض. فهي لا تتعرض لهم، مهما فعلوا تقريبا، بينما تتجه ملاحقتها ومراقبتها وتركيزها الأمني المكثف على المسلمين. حيث بات الإرهاب، سمة ملتصقة بالمسلم مهما كانت قوميته أو خلفيته العرقية. انه متهم بشكل أو آخر، حتى لو كان، قد ولد أو ترعرع في بلد اوروبي. انعكس هذا الوضع، تدريجيا، على عامة الناس، الذين يتشكل وعيهم عبر الخطاب الاعلامي والسياسي، لتسود شيطنة المسلمين ويصبح تصنيفهم كإرهابيين مقبولا ومألوفا بلا تمحيص.
للإرهاب منظمات وحكومات تمارسه. وأن تصبح المطالبة بالبحث عن جذوره وإيجاد الحلول هو الهدف، إذا ما أردنا ترسيخ ما يجمع الناس بعيدا عن «نحن» و«هم»
ولدينا أمثلة على توجيه اصبع الاتهام، اعلاميا، الى مسلمين، حال وقوع حادث يستهدف مدنيين في اية مدينة اوروبية، والى ان تظهر الحقيقة تكون صورة المسلم كإرهابي قد رسخت بالاذهان. أدى هذا الامر، ومع ظهور منظمات تستخدم الإسلام لستر جرائمها، والتشويه المنهجي المتعمد والاختراق المخابراتي أو «العمليات السوداء» المنسوبة الى حركات مقاومة الغزو والاحتلال، الى تحشيد قوى الامن لمراقبة المسلمين وملاحقة البعض، وتزايد حملات الضغط والمراقبة ضدهم، مما وفر للأبيض اليميني المتطرف حرية الحركة وعدم الملاحقة. لذلك، من الطبيعي، ألا يوجد سجل لمرتكب المجزرة الاسترالي (مع آخرين لابد قد تعامل معهم في رحلاته الى بلغاريا واسرائيل وتركيا وغيرها في مجرى اختيار موقع جريمته) وهو الذي قضى عامين في شراء السلاح والاعداد الدقيق لجريمته.
ان مجزرة المسجدين ليست حصيلة فعل فردي مختل، أو «تفاحة فاسدة»، كما قيل عن تعذيب المعتقلين من قبل قوات الاحتلال الامريكي، بسجن ابو غريب. انها حصيلة تغذية منهجية، سياسيا واعلاميا لـ «الإسلاموفوبيا»، على مدى عقود، من قبل جهات متعددة تراوح بين المحتل الاستيطاني، والغازي الامبريالي، وتجار السلاح والهيمنة على النفط مرورا بالحكام العرب المستبدين. أنه واقع بتنا نعيشه، تتخلله أصوات مستقلة انتبهت منذ وقت مبكر الى تأثير هذه السياسة، وتداعياتها الوخيمة، ومسؤولية أجهزة الاعلام في تناولها. وهذا ما أكد عليه الاعلامي البريطاني جيمس أوبراين، في حديثه عن المجزرة، قائلا في برنامجه الاذاعي في «أل بي سي»: «إن وسائل الإعلام تتحمل بعض المسؤولية عن إطلاق النار على المسجدين في نيوزيلندا… من خلال نشر مقالات تثير الكراهية ضد المسلمين». كمثال على ذلك، حدد جيمس مقالين، نشر الأول في صحيفة «الصن ـ The Sun»، وهي الصحيفة الأوسع انتشارا في بريطانيا. إدعى كاتب المقال: «إذا كنا نريد السلام، فنحن بحاجة إلى قدر أقل من الإسلام»، أما المقال الآخر فنشر في مجلة The Spectator، الناطقة تقريبا باسم حزب المحافظين البريطاني، وحث فيه كاتب المقال على الخوف من المسلمين، قائلا: «لا يوجد ما يكفي من الخوف من الإسلام في حزب المحافظين». ويخلص جيمس أوبراين أن «مثل هذه المقالات ساعدت على خلق ثقافة يدخل فيها رجل إلى المسجد حاملا بندقية ويبدأ إطلاق النار».
ولكن، هل هناك تمييز ضد المسلمين، في بلد ديمقرطي، مثل بريطانيا؟ خلص تقرير صدر عن لجنة الحراك الاجتماعي في أيلول/سبتمبر 2017 إلى أن المسلمين يعانون على نطاق واسع من التمييز والعنصرية في مكان العمل، بسبب الخوف من الإسلام، على الرغم من تفوقهم على نظرائهم من غير المسلمين في التعليم. وما يقرب 50٪ من الأسر المسلمة في حالة فقر، مقارنة مع أقل من 20٪ من إجمالي السكان. سرد التقرير العوائق التي تحول دون النجاح، بما في ذلك الصور النمطية السلبية عن المسلمين. كشف التقرير أن النساء اللاتي يرتدين الحجاب يواجهن تمييزا خاصا بمجرد دخولهن مكان العمل. صرحت الأستاذة جاكلين ستيفنسون، من جامعة شيفيلد هالام، التي قادت البحث، أن «المسلمين يتم استبعادهم أو التمييز ضدهم أو خذلانهم في جميع مراحل انتقالهم من التعليم إلى العمل».
جمع رد فعل رئيسة الوزراء النيوزيلندية بين التأثر الكبير والاحساس بالصدمة جراء حدوث فعل «إرهابي»، في بلد كنيوزيلندا، واستنكار ان يكون مرتكب الجريمة «منا»، مخاطبة السكان المسلمين قائلة «انتم نحن». وهذا هو الموقف الانساني والسياسي السليم لمن يؤمن، حقا، بالتنوع البشري وحق العيش بأمان. وهذا هو بالضبط الموقف الذي يجب تبنيه عند إدانة الإرهاب، بأنواعه. وألا تقتصر الادانة على فئة أو مجموعة بشرية دون غيرها، فللإرهاب منظمات وحكومات تمارسه. وان تصبح المطالبة بالبحث عن جذوره وإيجاد الحلول هو الهدف، اذا ما أردنا ترسيخ ما يجمع الناس بعيدا عن «نحن» و«هم».
تاثيرات « عام العدس» على الشعب العراقي!
هيفاء زنكنة
لا أظن أن هناك مواطنا، خارج حدود العراق، سيحظى بهدية من حكومته، تماثل ما حظي به المواطن العراقي. ولأن يوم المرأة لايزال طريا في الذاكرة، بعد مرور ثلاثة أيام،، يمكن اعتبار «الهدية»، بعد تغليفها بورق ملون، هدية خاصة للمرأة العراقية، تثمينا لدورها في المحافظة على بنية المجتمع. انها هدية صالحة لكل المناسبات والفصول والأعياد الدينية والتقليدية، ومنها شهر رمضان الكريم، كما أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء. الهدية الثمينة التي تناقلت أجهزة الاعلام تفاصيلها هي باقة عدس، عفوا، نصف كيلو عدس. ستقدمه الحكومة العراقية «دعماً للعائلة العراقية في الشهر المبارك»، حسب بيانها الرسمي.
وبما ان منجزات الحكومات، منذ غزو العراق عام 2003 حتى اليوم، تحمل في جوهرها، الاستهانة وازدراء المواطنين من جهة، وابتذال اللامنطق من جهة ثانية، تطورت عند المواطنين، بالمقابل، وكنوع من الدفاع عن سلامة البقية الباقية من العقل، موهبة جديدة، هي روح النكتة والتهكم والسخرية السياسية، والتي لم يكن المجتمع العراقي مشهورا بها، كما الشعب المصري، مثلا. فانتشرت النكات والكتابات السياسية الساخرة بالإضافة الى الكاريكاتير، بسرعة مذهلة، مستهدفة المحتل الأمريكي، بداية، لينضم اليه الإيراني لاحقا. تلاه التهكم اللاذع ضد الساسة الفاسدين وخاصة مستخدمي الدين الإسلامي، من الطائفتين، لستر سرقاتهم وفضائحهم «الدنيوية»، فضلا عن منظمة الدولة الإسلامية «داعش» التي واجهها المواطنون بنكات، اختلط فيها التهكم بالتقزز، من ممارساتها الهمجية. ولم يسلم المواطنون، أنفسهم، من استهداف أنفسهم أو بعضهم البعض، بروح السخرية المعجونة بالألم والحسرة، متجاوزين حدود اللياقة، أحيانا. صار البعض يمنح نفسه صفة المراقب، المستهجن لما يراه، غير المنتمي الى «الحشود». ليتمكن بذلك من تبرئة نفسه من المسؤولية، وامتطاء صهوة القيم الاخلاقية، متسائلا باستغراب اتهامي: كيف يسكتون على الضيم الذي يزداد وقعا عليهم كل يوم؟
وإذا كانت السخرية، السياسية خاصة، تهدف الى فضح الزيف والنفاق والفساد، فأنها، على الاغلب، لا تطرح حلولا، على الرغم من تعدد أشكالها ومستوياتها، مما يدفع الى التساؤل عن جدوى ممارستها؟
تشير متابعة انتشار روح التهكم والسخرية السياسية، في العراق اليوم، إلى ازدياد متابعيها، نتيجة تطورها بأشكال جديدة، مثل تصوير الفيديوهات القصيرة جدا، وتناقلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. مما جعل ملكيتها عامة للجميع. لم تعد تقتصر، كما في الماضي، على «النخبة».
حيث باتت، بالإضافة الى كونها سلاحا لفضح تداعيات مواقف سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، مثيرة للجدل، أو فساد مالي أو أخلاقي أو خيانة للوطن، أداة فاعلة يواجه بها أبناء الشعب التدهور السريع، غير المعقول، للقيم التي تربوا عليها، ومفارقات الواقع المرير، بتناقضاته وتشوهاته.
بما أن منجزات الحكومات، منذ غزو العراق عام 2003 حتى اليوم، تحمل في جوهرها، الاستهانة وازدراء المواطنين من جهة، وابتذال اللامنطق من جهة ثانية، تطورت عند المواطنين، بالمقابل، وكنوع من الدفاع عن سلامة البقية الباقية من العقل، موهبة جديدة، هي روح النكتة.
واقع ان يكون المرء ابن ثاني أكبر بلد منتج للنفط، بالمنطقة، بلغت ميزانيته للعام الحالي 88 مليار دولار، بينما يعيش ربع السكان و50 بالمئة من أطفال المحافظات الجنوبية تحت خط الفقر. بلد «لايزال 1.8 مليون من مواطنيه، يسكنون الخيام، بعد مرور أكثر من سنة على انتهاء العمليات القتالية» حسب منظمة الصليب الاحمر الدولي، في الشهر الماضي. وهي العمليات التي طالما استخدمت لتبرير الفساد الذي بلغ حدا بات فيه المسؤولون، أنفسهم، يحذرون من نتائجه وهم يتراشقون التهم. آخر المسؤولين «النزهاء» هو ملا بختيار، مسؤول الهيئةِ العاملة في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، الذي صرح، يوم 21 شباط، ان «حجمَ الفساد، وصلَ الى أكثر من 800 مليار دولار، منذ الاحتلال، وان عددَ المدارس المبنيةِ من طين فيهِ يبلُغ 60 الفَ مدرسة». بينما يتمتع الساسة وحواريهم بالغنى الفاحش. الغنى الذي بلغ حد أن يوزع احدهم على المدعوين لعرس ابنته، ليرات ذهبية بدلا من «الحامض حلو».
هذا الواقع المنسوج بالظلم، والتمييز الطبقي والعنصري العرقي والديني والطائفي، وتمكن المتورطين بقضايا الفساد الفاحش من الهرب إلى خارج البلاد أو بقائهم مطلقي السراح بموجب «قانون العفو العام»، مهد الأرضية لنمو روح السخرية والتهكم لابلاغ رسالة محددة مهما كان تأثيرها صغيرا. وتشكل ردة الفعل الساخرة على اضافة نصف كيلو العدس، الى الحصة التموينية، للتوزيع خلال شهر رمضان، وبعد ان نقصت مفرداتها تدريجيا، بعد الاحتلال، مثالا يثير الضحك، كاشفا، في الوقت نفسه، زيف الادعاءات الرسمية وعدم تطابقها مع الواقع.
بدأت حملة السخرية بنش بعض الناشطين وسم «عدس الحكومة يجمعنا». ليليه «حملة التبرع بالعدس للحكومة». كلاهما تصدرا قائمة انتشار التغريدات في العراق. وأدت منحة العدس الى النظر، من جديد، في كيفية تطبيق بعض القوانين الحكومية على المواطنين، فكتب أحدهم: «كل مواطن له الحق في استلام مادة العدس مالم يكون مشمولا بإجراءات المساءلة والعدالة». وتم إيضاح الشروط أكثر، بتعليق آخر: «من شروط استلام العدس في شهر رمضان المقبل، ان يكون المستلم من أبوين عراقيين بالولادة، وأن لا يكون قد استلم عدس في زمن النظام السابق».
لم يفًوت عدد من فناني الكاريكاتير العراقيين المشهورين، فرصة معالجة ثيمة العدس، فرسم الفنان أحمد المندلاوي عائلة مكونة من أربعة أفراد: أب وأم وصبي وفتاة، واقفون، كأنهم ينظرون الى المجهول، وهم ينشدون نشيدا حماسيا، يرتبط لحنه الشائع بالذاكرة الجماعية العربية، بعد استبدال كلماته المعروفة بمفردة العدس، ليصبح «العدس الساطع آت وانا بطني جوعان… العدس الساطع آت بحلول شهر رمضان». ونشرت صورة تمثل عادل مهدي، رئيس الوزراء، وهو جالس على الارض، مرتديا الدشداشة، متسائلا «والله دايخ بالعدس نطي ربع كيلو لو ميت (مئة) غرام… حيرة!»
وبينما اقترح أحد المؤرخين تسمية العام الحالي «عام العدس» موضحا « في أزمنة شيوع الأمية، كان الناس يؤرخون بالوقائع.. فيقولون «سنة الجراد». واليوم لشيوع الأمية بنسبة مرعبة اقترح ان يؤرخ للعام الذي نحن فيه بعام العدس». إرتأت الكاتبة بثينة الناصري ان يمتد الاقتراح ليشمل « ومن يولد له مولود ذكر في هذا العام سوف يسميه : عدس (إذا كان سنيا) وعداس (إذا كان شيعيا) و(عوديسو) إذا كان كلدانيا، وإذا كانت انثى فسوف تشيع اسماء : عدسة /عديسة/عدوس». كما صار البعض يتبادل التحيات التقليدية مطعمة بالعدس على غرار يا صباح أو يا مساء العدس.
أما على مستوى التضامن الدولي، فقد أخبرنا أحد النشطاء بأن شركة أديداس، المشهورة، متعددة الجنسيات، قررت أن تحذف حرفين (يد) من علامتها التجارية ليصبح أسمها «أداس» تضامنا مع شعب العراق. مما يستدعي، حتما، إطلاق هوسة عشائرية شعبية، يتم أداؤها ترحيبا اذا ما زار أحد مدراء الشركة البلد،: «ها…أخوتي… ها، أفرح يا شعبنا، البرلمان أنطاك أداس». يقودنا استعراض هذه النماذج الساخرة الى تساؤل يستحق التوقف عنده حول تأثيرها: هل هي مجرد تنفيس آني عن الغضب أم إنها نوع من المقاومة السلمية؟
عن يوم المرأة وجيل عراقي بلا عُقد حزبية
هيفاء زنكنة
كما جرت العادة، ستقام بمناسبة يوم المرأة العالمي، احتفالات رسمية في معظم البلدان العربية. حيث سيقوم أولياء الامر من الحكام والساسة ورؤساء الأحزاب وأصحاب منظمات المجتمع المدني، بتلاوة المديح النسائي والتسبيح عليها وطليها بالثناء، وكيف انها تشكل نصف المجتمع ولولاها لما قامت للمجتمع قائمة… وأنها…. الى آخر الأسطوانة المشروخة، وهم ذات الحكام والساسة الذين يمارسون كل أساليب القمع والاضطهاد والتمييز ضدها، أما بشكل مباشر أو غير مباشر. فخطاب الوقوف بجانب المرأة والدفاع عنها كليشيه، تزويقية، ضرورية للأنظمة العربية للظهور بمظهر حضاري ومتمدن ونفي سمات التخلف والرجعية.
ولا يقتصر استغلال « قضايا» المرأة على الأنظمة، بل استنسختها، في ظل « الديمقراطية» منظمات المجتمع المدني، المتلقية للدعم بحجة «تمكين» المرأة والدفاع عن حقوقها. وكما جرت العادة، ما ان تشارف ساعات « يوم المرأة» على الانتهاء حتى يكرر المسؤول والسياسي وعوده بتحسين الأوضاع وإصدار القرارات بين يديه ويرميها بأقرب سلة مهملات. أما منظمات المجتمع المدني فإنها ستواصل خطاب التمكين الى أن ينتهي الدعم المالي المكرس للتسويق والذي وفر لأصحابها ما لم يكونوا يحلمون به لولا المتاجرة بقضايا المرأة.
هذا، بطبيعة الحال، لا ينطبق على كل منظمات المجتمع المدني، اذ يخوض عدد منها صراعا قد يستهلكها، أحيانا، من اجل الحفاظ على استقلاليتها المادية والعملية. كما تبرز، بين الآونة والأخرى، مجموعات مكونة من ناشطين، يجمعهم هدف الحراك من أجل الكل، بلا استثناء، وبلا تمييز بين المرأة والرجل، مما يعيدنا الى حقب حركات التحرر الوطني، التي شارك في خوضها ودفع ثمن التحرر من الاستعمار وهيمنته واستغلاله للشعوب، كل أبناء الشعب من الرجال والنساء معا. مثل هذه النشاطات، بآليتها وسيرورتها، المستقلة، تساعد على التشبث بالأمل، وابعاد شبح الأسى والإحباط العام، بعيدا عن « الأيام» المُختطفة من قبل الأنظمة والساسة.
من بين النشاطات التي نثرت حماسا، غير معهود، في الأسابيع الأخيرة، في الاوساط العربية، والعراقية خاصة، بلندن، وهي المنشغلة عادة بمراكمة المآسي، قيام مجموعة من الناشطين، بنشاط نوعي جديد، استحوذ على تغطية إعلامية متميزة، نسبيا، من قبل أجهزة الاعلام الغربية.
تضمن النشاط أوجها عدة. اعتصامات وأفلام وملصقات ومعرض وورشة فنية. فخلال شهر كامل، سبق افتتاح المتحف البريطاني معرضا بعنوان «أنا آشور بانيبال ملك العالم ملك آشور» عن الامبراطورية الآشورية، ومركزها نينوى عملت المجموعة (لا يزيد عدد أفراد نواتها على أصابع اليد الواحدة) على الاعتصام المتكرر داخل وخارج المتحف، بحضور مئات المشاركين، وتصوير كل ما يحدث ومن ثم نشر الأفلام والتصريحات والمقابلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي باستهداف مكثف. احتج الناشطون على تمويل شركة النفط البريطانية «بريتيش بتروليوم» للمعرض. وهي الشركة التي تركت آثار استغلالها البشع على كل البلدان التي عملت فيها، ومنها العراق «ووفقاً لوثائق الحكومة البريطانية الصادرة في عام 2011، كانت شركة بريتش بتروليوم مستقتلة للدخول إلى العراق قبل غزو عام 2003، حيث «مجال النفط الكبير». مما يجعل الشركة، متواطئة في حرب أسفرت عن مقتل مئات الآلاف من العراقيين وتشريد الملايين، حسب تصريح الناشطين.
خطاب الوقوف بجانب المرأة والدفاع عنها «كليشيه» تزويقية، ضرورية للأنظمة العربية للظهور بمظهر حضاري ومتمدن ونفي سمات التخلف والرجعية.
عند مراجعة تفاصيل نجاح المجموعة، والتغطية الإعلامية التي حظيت بها، من قبل صحف معروفة مثل « الغارديان» و«الاندبندنت»، وعدد من المواقع الفنية، نتوقف لنتساءل: ما الذي جعلها تحقق ما لم تتمكن نشاطات أخرى للجالية العراقية وغيرها من تحقيقه؟
هناك أسباب عديدة.
أولا: قامت المجموعة بعدة نشاطات متنوعة لتستقطب بذلك جمهورا متعدد الاهتمامات. ثانيا: تمت الاعتصامات داخل وخارج حيز غير سياسي، بل معروف، عالميا، باحتضانه للحضارات من جميع ارجاء العالم، بحيث ان « استعمارية» المكان، من ناحية الاستيلاء على كنوز وآثار البلدان المستَعمرة، مختلف عليها حتى بين الكثير من المثقفين الذين تعيش بلدانهم حروبا ونزاعات «أهلية». إذ يرون في المُستعمِر من يحافظ على الآثار في مكان واحد بينما يقوم أبناء البلدان، أنفسهم، بتهريب آثارهم لتباع في الأسواق العالمية وتُركن، الى الابد، في خزانات لا يمكن حتى القاء النظر عليها. ولم تستهدف الاعتصامات «حضارية» المكان بل تمويل المعرض لتضيء جانبا يحمل أقسى التناقضات.
ثالثا: لم يقتصر النشاط، بأوجهه المتعددة، الاحتجاجية والفنية، على تأثير سياسة الشركة على العراق، لوحده، بل فضح سياستها في بلدان مختلفة من العالم. هذه المعالجة أنقذت المجموعة من السقوط في «غيتو» الصراع بين الضحايا وتنظيم نشاطات تفتقد الى التواصل التضامني. وهو مطب كبير، بات سائدا في العقدين الأخيرين، حيث يتم جلب الانتباه الى مأساة بلد ما أو مجموعة بشرية أو أقلية أو جندر، دون ربطها بما يجري للآخرين في البلد نفسه أو في بقية ارجاء العالم، فتكون النتيجة تفتيت القضايا الإنسانية واستهلاك جهد الناشطين.
رابعا: رأينا في النشاط المتنوع عودة الى التضامن، بمفهومه الحقيقي، بين مجموعة من الناشطين الذين ينتمون الى بلدان مختلفة ويجمعهم الوعي بعولمة الاستغلال من قبل شركات احتكارية عابرة للأوطان، يهيمن عدد منها على الثروات الوطنية، بينما تقوم أخرى ببيع السلاح.
وتراعي كلها تبييض الوجوه بـ«المساعدة الإنسانية» وتوفير الدعم لنشاطات ثقافية وحضارية. ازدواجية هذه الأدوار، تطرق اليها منظمو الاعتصامات والمعرض بشعارات ذكية واعمال فنية رائعة، ساعدت الجمهور على النظر أبعد من الاعراض السطحية.
خامسا: ينتمي أفراد المجموعة التي قامت بالتنظيم، كونهم شبابا، الى جيل عراقي لا يحمل حقائب العُقد السياسية، وموروث صراعات الماضي، وانعكاساته على نشاطات المنتمين الى الأحزاب السياسية التقليدية. ما يحملونه هو حب العراق والاعتزاز بحضارته وعدالة قضيته، وهذا هو الأهم. وهم يماثلون، بذلك، الجيل الفلسطيني الذي وُلد وعاش، بعيدا عن الوطن، ولم يزر افراده فلسطين الا ان فلسطين، بالنسبة اليه، قضية عادلة، تمس جوهر الوجود الإنساني، ولا يمكن التخلي عنها الا إذا تجرد الفرد من انسانيته.
كاتبة من العراق
الإعدامات ودورات الانتقام في العراق
هيفاء زنكنة
يتم بين الحين والآخر إطلاق نداءات استغاثة من داخل أحد السجون العراقية لجذب الانتباه الى ما يعانيه السجناء من أوضاع مزرية لا تليق «حتى بالحيوانات» حسب تعبير أحد السجناء الذي تمكن، أخيرا، من ابلاغ رسالته الى مصدر موثوق به، منبها الى نقل اعداد من الاحداث المعتقلين بتهمة الإرهاب، من مدينة الموصل، الى سجن الناصرية سيئ الصيت، لكثرة تنفيذ احكام الإعدام. طالب صاحب الرسالة «ذوي الضمائر الحية» والمجتمع الدولي بالتدخل لإنقاذ حياة الفتيان. يحيلنا هذا النداء وتهمة «الإرهاب» التي وسمت الفتيان، وعلى الاغلب اعترافاتهم، الى تصديق ناقل النداء حسب المعطيات المتوفرة حتى اليوم حول واقع المحاكمات الجائرة التي تتم في العراق، في ظل نظام قضائي يتسم بالعيوب العميقة، حسب تقرير لمنظمة «هيومان رايتس ووتش»، الحقوقية، حيث «يُحرم المتهمون، ولاسيما المشتبه في علاقتهم «بالإرهاب»، من حقهم في الحصول على الوقت الكافي والتسهيلات الكافية لإعداد الدفاع، وفي عدم تجريم النفس أو الاعتراف بالذنب، واستجواب شهود الادعاء. وتستمر المحاكم في قبول «الاعترافات» التي تُنتزع تحت وطأة التعذيب كأدلة. وحُكم بالإعدام على العديد من المتهمين الذين أُدينوا إثر محاكمات جائرة».
ولا تكتفي السلطات العراقية بإصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بحق المعتقلين بتهمة «الإرهاب»، خاصة، بعد ان شرعنت المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) كل أنواع الانتهاكات بحجة محاربة الإرهاب، بل غالبا ما تشمل الاعتقالات المحامين الذين يدافعون عن المتهمين واتهامهم بأنهم أعضاء في التنظيم. ومع حرمان المعتقلين من التواصل مع ذويهم أو العالم الخارجي، عموما، صار من السهل على السلطات العراقية، تنفيذ الإعدامات دون نشر أي أرقام رسمية حول هوية المعتقلين أو جرائمهم أو مشاركة هذه المعلومات مع الجهات الفاعلة الدولية، مكتفية، أحيانا، بإصدار تصريح مقتضب ينص على «تنفيذ حكم الإعدام بعدد من الإرهابيين»، في حال تعرضها لضغط دولي يطالبها باحترام حقوق الانسان، مستهينة بذلك بواحد من أهم حقوق الانسان على الاطلاق وهو حق الحياة الذي تواصل انتهاكه، يوميا، بإعداماتها التي جعلتها تحتل المرتبة الرابعة في اعلى معدلات الإعدام في العالم، بعد إيران، والصين، والسعودية.
يشير فوز العراق بهذه المرتبة «العربية»، الى وجود هوس مرضي يدعى عقوبة الإعدام، ينتشر كما الطفيليات والاعشاب الضارة، بين حكام وساسة البلدان العربية، ولا يوجد في الأفق ما يدل على التخلص منه، إذا ما استمرت حالة الاستبداد السلطوي، واعتبار الشعوب أعداء غير جديرين بالحياة، على وضعها الحالي، ومع ازدياد تنفيذ أحكام الإعدام بأعداد متزايدة من الرجال ولا يستثني النساء، ويمتد، بلا استثناء أيضا، من مصر الى العراق الى المملكة العربية السعودية مرورا بسوريا، ليمنح خارطة الدول العربية لونا قانيا يُزيد من محنة شعوبها وتصاعد الإحساس بالظلم.
أمر رئيس الوزراء حيدر العبادي بتنفيذ أحكام الإعدام بشكل فوري في السجون بعد ثلاث ساعات فقط من تفجير الكرادة… وتم اعدام 65 محكوما، كانوا موجودين في السجن عندما تم التفجير الإرهابي
الاعدامات، اذن مستمرة وإصدار الاحكام بالإعدام يتزايد، في البلدان العربية وما يجاورها، بسرعة مخيفة تدفع العديد من الناشطين الحقوقيين والقانونيين، الى استخدام مفردات ادانة لم تكن واردة، في قاموسهم اللغوي سابقا، تجاه الحكومات التي حولت العقوبة من حكم نادر الإصدار الى فعل عادي قد يتعرض له أيا كان ولأي سبب كان. اذ يوفر القضاء العراقي، مثلا، للمسؤولين فرصة، لا مثيل لها، لانتقاء التهمة التي يراد منها إنزال عقوبة الإعدام، حيث يسمح بعقوبة الإعدام في نحو 50 جريمة.
فبات من المتعارف عليه في تصريحات ناطقين باسم مجلس حقوق الانسان، بالأمم المتحدة، مثلا، استخدام مفردات على غرار «الإقدام على إعدام الناس بالجملة هو امر بغيض وقذر، وكأنه مسلخ لصناعة اللحوم في مجزرة للحيوانات»، لوصف سلسلة الاعدامات بالعراق و«مسلخ بشري» لوصف التصفيات الجماعية في السجون السورية.
إن اختيار 140 بلدا، من أصل 192 بلدا، عضوا في الأمم المتحدة، التخلي عن عقوبة الإعدام، ليس عبثا، بل ناتج عن دراية واقتناع بأن عقوبة الإعدام هي العقوبة النهائية القاسية واللاإنسانية والمهينة ـ في جميع الحالات بلا استثناء، باعتبارها تشكل انتهاكاً للحق في الحياة نفسه، وان تاريخ البشرية والبحوث ذات العلاقة، أثبتت بما لا يقبل الشك، بان الإعدام ليس رادعا لارتكاب الجرائم بل، غالبا، ما يؤدي الى ولادة جيل يحمل في داخله بذور الانتقام، في حال، اعدام الأبرياء. وهذا ليس مستبعدا إذا ما تم تنفيذ حكم الإعدام، بسبب خلفيات إيديولوجية أو سياسية أكثر من كونه حكمًا للردع. وهو ما نراه بوضوح في العراق. فالقضاء مُسير سياسيا، ينتهشه الفساد، وخاضع كالعبد لمزايدات هستيريا شعبوية الخطاب السياسي مما يساعد على استخدام أحكام الإعدام للترويع والترهيب وكوسيلةٌ لتصفيةٍ وتطهيرٍ عرقيّ تحت مظلة القانون. ففي تموز/ يوليو، مثلا، وفي اعقاب تفجير الكرادة، ببغداد، مثلا، أمر رئيس الوزراء حيدر العبادي بتنفيذ أحكام الإعدام بشكل فوري في السجون بعد ثلاث ساعات فقط من تفجير الكرادة، وتم اعدام 65 محكوما، كانوا موجودين في السجن عندما تم التفجير الإرهابي.
وبينما يواصل القضاء غير النزيه تنفيذ احكام الإعدام، تقوم السلطات بتغطية الانتهاكات التي ترتكبها أو تتعامى عن ارتكابها، من التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري، ضد المواطنين، بالإعلان عن تشكيل لجان تحقيق. ولم يحدث ونشرت أيا من تلك اللجان، التي يتجاوز عددها المئات، النتائج التي توصلت إليها. وبدلا من ان تقوم السلطة ولجانها بالبحث عن الحقيقة والعثور على الجناة ومحاسبتهم قضائيا، يسارع المسؤولون، تخديرا لمشاعر الغضب الشعبي وتغطية لفشلهم، بتنفيذ احكام اعدام جماعية بمعتقلين، بعضهم موجود في السجن منذ سنوات، بعد أيام من كل تفجير إرهابي.
إذا كان هناك من درس علمنا إياه تاريخ العراق، خاصة، فهو ان تنفيذ أحكام الإعدام لن تحل مشاكل العراق ولن تضع حدا للإرهاب، مهما كان نوعه، بل انه أحد عوائق استعادة اللحمة الاجتماعية والمصالحة، بعد سنوات من تأجج المشاعر وبذر روح الانتقام المستغل سياسيا. أحد الأسئلة التي تستوقفنا عند البحث في عقوبة الإعدام وتعذيب المعتقلين، هو: كيف سيساعد اختطاف فتيان ونقلهم الى سجون، بعيدا، عن ذويهم، تحت طائلة قضاء غير نزيه، معروف بأحكامه الجائرة، الى المصالحة؟
يقول بيتر ماورير، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر (شباط/فبراير 2019) على وجوب اتباع الإجراءات القضائية وتوفير ظروف احتجاز لائقة تطبق بشكل منصف على جميع المحتجزين بصرف النظر عن الاتهامات الموجهة إليهم أو بلدانهم الأصلية. وإذا كانت السلطات جادة في مكافحة الإرهاب، فيتوجب عليها « الكشف عن مصير العدد الهائل من الأشخاص الذين لا يزالون في عداد المفقودين» الذين تصل أعدادهم مئات الآلاف.
«لقد التقيت في الموصل بعائلاتٍ تبحث عن أحبائهم المفقودين. أخبروني بما يعتصر قلوبهم من آلام يومية بسبب عدم معرفة مصير ذويهم. ولا بد للمجتمع ـ والسلطات العراقية ـ التصدي بشكلٍ مباشر لهذه المشكلات التي تؤجج العواطف».
كاتبة من العراق
من شباط إلى شباط… أحزاب عراقية تحتضر!
هيفاء زنكنة
إذا كان شهر آذار/ مارس المقبل، هو شهر استحضار ذكرى الغزو الانكلو أمريكي والعدوان الاجرامي على العراق، فان لشهر شباط / فبراير، حيزا خاصا في الذاكرة الجماعية العراقية، لا ينافسه فيها غير شهر تموز/ يوليو. فشهر تموز يرتبط بتاريخنا السحيق بالإله تموز (الراعي)، الذي عاقبته عشتار آلهة الحب والحرب، عندما اكتشفت خيانته، بإنزاله الى العالم السفلي/ عالم الأموات ثم ندمت فأنقذته لتعيده الى الحياة ستة أشهر سنويا. والأول من تموز هو عيد ميلاد كل العراقيين، الذين لا يعرفون تاريخ ميلادهم. والرابع عشر من تموز، عام 1958، هو ميلاد الثورة (يسميها البعض انقلابا) ضد النظام الملكي، التي صاحبها قتل وسحل رموز العهد الملكي، بطريقة بشعة، غطت على جوانبها المشرقة.
والسابع عشر من تموز/يوليو، عام 1968، هو الانقلاب (يسميه البعض ثورة بيضاء) الذي جاء بحزب البعث العربي الاشتراكي الى السلطة بصحبة اعتقالات وتصفيات، وفي الثلاثين من تموز، بذات السنة، جرى انقلاب أخرى (يسميه البعض تصحيحا) صاحبته اعتقالات وتصفيات لقادة الانقلاب / الثورة الذي تم قبله بأسبوعين.
قد يتبادر الى الاذهان ان سلسلة هذه الاحداث (الدامية أو المشرقة حسب الانتماء الأيديولوجي لمن عايشها او منظور من يكتب عنها)، تُمكن شهر تموز من احتلال قمة الشهور التراجيدية في التاريخ العراقي المعاصر، وبلا منافس، الا ان أحداث شهر شباط الدامية، منذ عام 1949 وحتى اليوم، تثبت أنه ينافس شهر تموز، في مآسيه. كما تثبت أنه لايزال هناك متسع، في الذاكرة الجماعية العراقية، لتراجيديا الأسى والحزن والاحساس بالظلم الناثر للانتقام، على الرغم من اكتظاظها بعقدة الذنب وجلد الذات، للمساهمة أو السكوت (لا فرق) على مقتل الامام الحسين، منذ 1400 عاما. ومنذ ذلك اليوم، واجيال العراقيين تدفع «فوائد» دَيونِ لم يقترضوها.
في شهر شباط/فبراير، من كل عام تزورنا، الذكرى بعد الأخرى، وهي مخضبة بالموت. ففي 14 شباط، 1949، أعدم النظام الملكي تحت الوصاية البريطانية، مؤسس وقائد الحزب الشيوعي يوسف سلمان يوسف (فهد)، ورفيقيه زكي محمد بسيم وحسين محمد الشبيبي. وتم تعليق جثثهم في بغداد. وكان قد شنق قبلهم في الشوارع صلاح الدين الصباغ ورفاقه زعماء حركة مايو 1941 من قادة الجيش العراقي المتمرد على بريطانيا والوصي عبد الاله، وهم اول شهداء الحركة القومية العربية في العراق.
ووصل حزب البعث الى الحكم في 8 شباط/فبراير من سنة 1963، بشكل لا يقل عنفا. اذ استهل بإعدام رئيس الوزراء الزعيم عبد الكريم قاسم، بعد محاكمة صورية عاجلة في دار الإذاعة ببغداد، مع اثنين من مرافقيه، وعرض جثثهم، بطريقة مهينة، على شاشة التلفاز، في نفس اليوم. تلت ذلك حملة اعتقالات وتعذيب وتصفيات، طالت أعضاء ومؤيدي الحزب الشيوعي خاصة. وإذا كان الحزب الشيوعي يستعيد ذكرى « يوما لا يقارن ما ارتكب فيه من جرائم الا بما اقترفه الفاشيون والنازيون، وقد يكون فاقهم فيها… ويصعب تصور حجم الدماء الشيوعية الغالية التي سفحها الانقلابيون الفاشيون، وكم الارواح العزيزة التي ازهقوها»، ببيانات وتصريحات نارية، لا يذكر فيها تحالفه ومشاركته الحكم مع أولئك « الانقلابيين الفاشيين» بعدها ببضع سنوات وتصفية جميع القوى الأخرى هذه المرة.
قسمت الصراعات الدموية الضحايا الى « شهداء» يحملون ختما خاصا بأحد الأحزاب دون غيره. بات الشهيد ملكا خاصا خاضعا للتغييب أو المزايدات السياسية والاستغلال المادي. وبدت الصورة بأوضح صورها في فترة ما بعد الغزو. فصار «الشهيد»، في الأحزاب الطائفية، ورقة مقايضة للحصول على المناصب والعقود والابتزاز
يستعيد حزب البعث ذكراه، هو الآخر، ولكن كيوم ثورة “قوضت الحكم الديكتاتوري القاسمي بعد ان انحرف بثورة 14تموز 1958، عن مسارها الوطني والقومي». نُشرت تأكيدا لهذه النقطة، على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا وُصفت بأنها « نادرة جدا لشهداء ثورة الشواف قبل وبعد إعدامهم. الثورة التي انتفض فيها اهل الموصل ضد الطاغية الدكتاتور عبد الكريم قاسم ودموية الحزب الشيوعي الذي قتل عشرات الآلاف من اهالي الموصل وكركوك ومناطق أخرى من العراق».
وذكر بيان أصدره حزب البعث، الأسبوع الماضي، بأن “الحزب قدم من اجل الثورة كوكبة من الشهداء الابطال»، كما تطرق الى ما اسماه «ردة 18-11- 1963 واصفا إياها بأنها» اقترنت بشن حملات قمعية ضد مناضلي حزب البعث العربي الاشتراكي الابطال من اجل اجتثاثه والقضاء عليه واعتقل آلاف البعثيين وتعرضوا للتعذيب والاعدامات والحرمان الوظيفي».
قسمت الصراعات الدموية الضحايا الى « شهداء» يحملون ختما خاصا بأحد الأحزاب دون غيره. بات الشهيد ملكا خاصا خاضعا للتغييب أو المزايدات السياسية والاستغلال المادي. وبدت الصورة بأوضح صورها في فترة ما بعد الغزو. فصار «الشهيد»، في الأحزاب الطائفية، ورقة مقايضة للحصول على المناصب والعقود والابتزاز.
ولم يقتصر شهر شباط على صراعات وتقاتل الأحزاب الرئيسية فحسب بل تعداها الى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أصدر الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب، يوم 13 شباط/فبراير، عام 1991، أمره بقصف ملجأ العامرية المدني، ببغداد، بقنابل (ذكية) حرقت 800 طفل وامرأة اتخذوا من الملجأ ملاذا، من القصف اليومي المستمر، على بغداد، خلال التسعينيات. فأصبحت اجساد الضحايا المتفحمة شهادة حية على جريمة لم يحاسب عليها أحد. جريمة ستبقى «عارا على الإدارات الأمريكية المتعاقبة طالما انها لم تعتذر لذوي الضحايا، وطالما انّها لم تتخذ الاجراءات القانونيّة لمحاسبة المخطّطين والمنفذين لجريمة الحرب هذه»، حسب مركز جنيف الدولي للعدالة.
ان مسؤولية الحرب العدوانية ضد العراق، وهي الجريمة الدولية العليا كما عَرفٌتها المحكمة العسكرية الدولية في نورمبرغ، في أعقاب الحرب العالمية الثانية، تقع على عاتق الولايات المتحدة الأمريكية وشريكتها الأولى بريطانيا. وإذا كان الاحتلال قد قرر محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين، كما صرح بنيامين ب. فيرينكز، أستاذ القانون، وأحد المدعين العامين للولايات المتحدة في المحاكمات العسكرية للمسؤولين الألمان في أعقاب الحرب العالمية الثانية، في مقابلة أُجريت في 25 آب/أغسطس 2006 فانه « كان يجب محاكمة جورج دبليو بوش، أيضاً، لأن حرب العراق كانت قد بدأت من قبل الولايات المتحدة بدون إذن من مجلس الأمن الدولي». وعن إمكانية تحقيق العدالة قانونيا، قال: «يمكن أن تكون هناك دعوى مقنعة بأن الولايات المتحدة مذنبة بارتكاب الجريمة العليا ضد الإنسانية، لكونها حربا عدوانية غير شرعية ضد دولة ذات سيادة».
هذه الجريمة الدولية الأعلى، التي يصر البعض على اعتبارها «تغييرا»، شرذمت الأحزاب العراقية، المؤسسة قبل وبعد الاحتلال، وجردتها من آخر رابط يمنحها شرعية الوجود، وهو الوطنية وتمثيل العراقيين بشكل حقيقي. ليصبح شهر شباط، بتصريحاته الجوفاء وانتقائيته الشعبوية في النظر الى احداث تاريخية تتطلب تشخيص الحقيقة، نموذجا لاحتضار حزبي دام أمده. وستبقى مسؤولية اجبار الدول المعتدية على الاعتذار وتحمل مسؤولية الاضرار التي الحقتها بالبلد بشريا وعمرانيا، مؤجلة بانتظار استعادة الدولة وحكومة وطنية لا تحمل تابوت شهر شباط الثقيل على كتفيها.
كاتبة من العراق
)سيلفي( مثقفين عراقيين مع رئيس الجمهورية
هيفاء زنكنة
كيف يمكن ألا نفتخر ونتباهى برئيس جمهورية يزور معرضا للكتاب ببغداد صحبة «السيدة الأولى» وهو يقف بين كُتاب وناشري وموزعي اهم أداة لنشر الثقافة والمعرفة، في بلد متعطش للنشر والكتابة والقراءة، بعد تحقيق «الانتصار» على الإرهاب؟ لماذا لا ننضم الى جموع المصفقين والمرحبين وملتقطي الصور و«السيلفي»، مع رئيس جمهورية أنيق، بوجه حليق، ولباس غربي (خلافا لمرتدي العمامة والدشداشة والشروال)، يتحدث اللغة العربية بطلاقة (وهو الكردي)، ويحضر صحبة زوجته (بينما يخفي بقية الساسة زوجاتهم أما في البيت أو خارج العراق)؟ كيف لا نؤيده، وهو يخاطب الوسط الثقافي العراقي والعربي والعالمي، بكلمات نبيلة هي جوهر ما يصبو اليه أي مثقف كان، خاصة، في بلداننا، مؤكدا: «ان حريةُ التفكيرِ والتعبير عن الرأي مكفولةُ دستورياً في العراقِ الديمقراطي تعززها حريةُ حركةِ الكتاب وتجاوزُ أيِّ رقابةٍ على الفكرِ»؟
كيف لا نهز رؤوسنا اعجابا بجرأته، وهو يقف مستنكرا بأسف شديد جريمة اغتيال الكاتب علاء مشذوب، في الأسبوع الماضي، الجريمة التي رأى انها تفرض عليه والمسؤولين والمجتمع « العملَ بجهد استثنائي لكشف الجناة والقبض عليهم وإحالتهم للعدالة، والعمل أيضا بجهد فاعل، أمنياً واستخبارياً وسياسياً واجتماعياً، لأن تكون هذه الجريمة دافعاً آخر لاجتثاث العنف والإرهاب وأي تهديد لحياة وأمن وكرامة المواطن»؟
أليس الأجدر بنا كمثقفين، اذن، الاحتفاء ببرهم صالح كرئيس جمهورية لا مثيل له، ونسارع لالتقاط الصور معه، لنمسك بلحظة تاريخية نادرة، استنادا الى هذه التصريحات الجامعة لمواقف سياسية مسؤولة وفكرية وثقافية، يؤكد فيها على «حريةُ التفكيرِ والتعبير عن الرأي… وحرية حركة الكتاب وتجاوزُ أيِّ رقابةٍ على الفكرِ»؟
ما الذي يمنعنا من ذلك؟ هل هو موقفنا منه كسياسي ساهم بشكل فاعل، على مدى عقود، في تسويق غزو واحتلال «بلده»، متعاونا مع محتل مسؤول، بالدرجة الأولى، عن الخراب البشري والعمراني، عن مأسسة التمييز الطائفي العنصري، وما تلاه من إرهاب لا يكاد يخلو خطاب له من ذكره؟ أما حان الوقت لأن نتخلص من اوهامنا، حول المفاهيم الديناصورية التي نحملها، كالوطن والوطنية والخيانة والعمالة، وأن نرضى بالأمر الواقع، كما يفعل آخرون، وان نؤمن، بما تم تصنيعه من هويات مستحدثة، وان الاحتلال لا يزيد عن كونه مجرد اختلاف في وجهات النظر؟
ما الذي يقف حائلا بيننا وبين القبول بـ«الأمر الواقع»، كما يجسده شخص رئيس الجمهورية، وتصريحاته التي تغطي كافة الأصعدة، من حرية التعبير والرأي الى توفير الحماية والأمن لمن يمارسها؟
ان قائمة ترهيب وقتل الصحافيين والكُتاب والناشطين طويلة، وأحدثها (ولن تكون الأخيرة) جريمة قتل الروائي والباحث علاء مشذوب التي سبقها اختطاف واختفاء الناشط المدني الشاب جلال الشحماني، وقتل الشاعر بكر علي، وسوران مامه حمه، وسردشت عثمان، ولسنا بحاجة الى ذكرها بالتفصيل للدلالة على قمع حرية الرأي والتعبير
الحائل الأول والأخير الذي لا يمكننا التعامي عنه حتى لو رضينا، كما يراد منا جميعا، بالأمر الواقع، هو ما يدحضه الواقع نفسه، المتبدي بالفجوة الصارخة بين الرطانة والتطبيق. بين الادعاء والممارسة، وبين الحقيقة والتظاهر بالحقيقة تبعا لمنطلقات نفعية انتهازية. والقاء نظرة سريعة على واقع «حرية التعبير»، في العراق، منذ شهر واحد فقط (ولن أقول منذ عام 2003)، وموقف المسؤولين السابقين واللاحقين، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية، يُكذّب بما لا يقبل الشك، تصريحات برهم صالح في معرض الكتاب، لتتكشف، كما هي عارية، مبتذلة، بابتسامة واسعة تحسده عليها جوليا روبرتس، مستهينا، بالكتب ومؤلفيها وناشريها، وحرية الفكر والتعبير.
فخلال الشهر الماضي فقط، سجل المركز العراقي لدعم حرية التعبير (حقوق)، مقتل صحافي، بالإضافة الى 15 انتهاكاً بحق الصحافيين، والمتظاهرين. أبرزها اعتقالات متكررة لصحافيين يعملون في قناة NRT، بإقليم كردستان، بناء على شكوى مقدمة من المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، وفصل طلبة جامعيين بسبب التعبير عن آرائهم في الفيسبوك، بالإضافة الى ممارسة تحرشات من قبل قوات امنية، وتهديدات مبطنة على خلفية اعداد تقارير صحافية او تصوير مواد مرئية، واعتقال ستة متظاهرين في البصرة من قبل مفرزة تابعة لشرطة النفط، لمجرد طلبهم الموافقة على إقامة تظاهرة. وقدم مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحافيين، تقريره السنوي يوم 17 كانون الثاني/يناير، في مدينة أربيل، موثقا 349 انتهاكاً ضد الحريات الإعلامية في الإقليم فقط، بضمنها ضرب الصحافيين والهجوم المسلح من قبل قوات أمنية على بيوتهم وحرق مقار إعلامية، وإيقاف بث قنوات محلية.
وقام النظام في تموز/يوليو من العام الماضي، بقطع الانترنت، تبعها تقييد مقصود للوصول إلى منصات وسائل التواصل والإعلام الاجتماعية، في ارجاء العراق، عدة أيام، ردا على الاحتجاجات المطالبة بالخدمات الأساسية، ومنها الماء الصالح للشرب، في البصرة. وكان الهدف من هذه الخطوة هو كبح الاحتجاجات ووقف انتقادات الحكومة عبر الإنترنت.
ان قائمة ترهيب وقتل الصحافيين والكُتاب والناشطين طويلة، وأحدثها (ولن تكون الأخيرة) جريمة قتل الروائي والباحث علاء مشذوب التي سبقها اختطاف واختفاء الناشط المدني الشاب جلال الشحماني، وقتل الشاعر بكر علي، وسوران مامه حمه، وسردشت عثمان، ولسنا بحاجة الى ذكرها بالتفصيل للدلالة على قمع حرية الرأي والتعبير، فجريمة اختطاف او قتل واحدة في البلدان التي تتمتع بالحرية كافية لاستقالة مسؤولين وملاحقة المجرمين. أما في العراق، فأقصى ما يقوم به المسؤولون هو تحويل الجريمة الى خطاب «أسف واستنكار» تخديرا لمشاعر الناس الى ان يتم نسيان الجريمة في زحمة المآسي اليومية. فما هي مسؤولية المثقف المتميز بوعيه النقدي في هذه الحالة؟ هل هو ابداء الأسف والاستنكار كما يفعل الساسة، فيكون المثقف تابعا للسياسي، أو في أحسن الأحوال، واقفا بجانبه ليلتقط «سيلفي» كما حدث في معرض الكتاب، لنترك القيم الأخلاقية جانبا، لنترك «الوطن للجحيم والموت والعصابات والمخابرات»، كما يُذكرنا الروائي حمزة الحسن في نصه «من قتل علاء مشذوب؟»
كاتبة من العراق
العراقيون يرحبون بعودة الأمريكان!
هيفاء زنكنة
جاء انتشار صور وفيديوهات القوات الأمريكية وهي تتجول متمتعة باسترخائها ببغداد، وبالتحديد في شارع المتنبي، قلب العراق الثقافي، إعلانا رسميا بأن الإدارة الأمريكية، لم تعد ترضى بفكرة التواجد المستور وأنها تصرخ بأعلى صوتها، معلنة عن حضورها العسكري المباشر بالإضافة إلى مرتزقة الشركات الأمنية.
وكانت زيارة الرئيس الأمريكي ترامب إلى بغداد، نهاية العام الماضي، بدون الاتصال أو التواصل أو لقاء أي مسؤول عراقي، هي خطوة رسمية بحرق ذريعة المساعدة والتواجد» كمستشارين ومدربين»، والانتقال إلى مرحلة مطالبة المسؤولين العراقيين بالإقرار بفضل أمريكا في « التحرير» سواء عام 2003 أو 2017، خاصة وأن أمريكا، بمنظور الإدارة الأمريكية، سابقا وحاليا، تدفع الثمن غاليا بأرواح جنودها وأموال دافعي الضرائب. وتأتي المطالبة بدفع التكلفة وإلا… الموجهة إلى النظام العراقي مماثلة لمطالبة أو إنذار السعودية بدفع تكلفة حمايتها وإلا… الرسالة الموجهة إلى عديد دول العالم، تشمل النظام العراقي ومفادها أن هذه الخدمات ليست مجانية والولايات المتحدة الأمريكية ليست جمعية خيرية مسجلة عند هذا النظام أو ذاك.
هذه الشروط الواضحة وأهمها القبول بالحضور العسكري العلني وإعادة فتح المعسكرات وزيادة عدد القوات، وتصريح الرئيس ترامب، منذ يومين، بأننا لن نغادر العراق، يشكل نقلة نوعية في سياسة الولايات المتحدة الخارجية وهي مختلفة عن سياستها أثناء رئاسة باراك أوباما، التي ركزت على استثمار «القوة الناعمة» والعمليات الخاصة والقصف الجوي، والاكتفاء بأكبر سفارة في العالم ومستخدمي الشركات الأمنية الخاصة (المرتزقة) وعدد محدود من القوات العسكرية، كما كانت مسترخية في نظرتها إلى الواقع العراقي كساحة للنزاع أو الاقتتال مع إيران نتيجة توقيعها الاتفاق النووي، الذي قام الرئيس ترامب بإلغائه وإعادة فرض العقوبات عليها، وها هو يقول للعالم (متجاهلا الساسة العراقيين)، إنه يريد مراقبة إيران من القاعدة الأمريكية، باهظة الثمن، من العراق.
فما هو موقف الساسة العراقيين؟ إن إعلان الإدارة الأمريكية عن الحاجة إلى إقامة معسكرات إضافية وشروعها بذلك فضلا عن نشر أو تسريب صور وأفلام العسكريين الأمريكيين في أرجاء مختلفة من العراق، بالإضافة إلى بغداد، أخذ الساسة العراقيين وقادة الميليشيات على حين غرة وأحرجهم لأنه مزق الغشاء الذي طالما تستروا به حول السيادة والنفي المطلق حول وجود القوات الأمريكية. فمن منا لا يتذكر تصريح رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، مؤكدا: «لا يوجد أي جندي أمريكي مكلف بمهمة قتالية في العراق»، في الوقت الذي كانت القوات موجودة في قاعدة القيارة العسكرية الجوية، جنوب مدينة الموصل، ومن منا لا يتذكر تصريح معظم المسؤولين وقادة ميليشيا الحشد بأن الانتصار على مقاتلي «الدولة الإسلامية» (داعش) تم بأيدي قوات الحشد بينما تجاوز عدد غارات التحالف الجوية، بقيادة أمريكا، على مدينة الموصل لوحدها 12 ألف غارة بين يونيو/حزيران 2014 إلى 2017، فقط، وسببت مقتل آلاف المدنيين.
اليوم تتعالى أصوات السياسيين، من شيعة وسنة، وبقومياتهم، مشاركين في إطلاق صيحات الوطنية والحرص على «السيادة» والنزاهة
اليوم، تتعالى أصوات السياسيين، بقضهم وقضيضهم، من شيعة وسنة، وبقومياتهم، مشاركين في إطلاق صيحات الوطنية والحرص على «السيادة» والنزاهة.
وبينما تتصاعد حمى الخطاب الشعبوي إلى أقصى درجات التهديد والوعيد عند قادة الميليشيات المدعومة، إيرانيا، والتي باعتراف أبو مهدي المهندس، نائب رئيس ميليشيا الحشد الشعبي، لم تمس قوات الاحتلال الأمريكي سابقا، يسارع الساسة السنة، بمساعدة أجهزة إعلامهم، إلى الترويج بأن العراقيين يرحبون بعودة الأمريكان. ولا يكتفون بذلك، بل هناك من بات يروج لتصريحات «مسؤولين» أو «مصادر مطلعة» أن «الشارع السنّي يرحب تمامًا بالقوات الأمريكية وانتشارها في مختلف المدن والمحافظات السنية».
وإذا كانت ميليشيا الحشد (حسب ادعائها) قد هادنت قوات الاحتلال وسكتت على وجودها بذريعة محاربة الإرهاب أي «داعش»، وانتظر قادتها إلى أن قامت أمريكا بوضع عدد منهم ضمن قائمة الإرهاب، كما حدث للمهندس، فانقلبوا عليها، أو إلى أن بلغتهم الجهة الداعمة ـ إيران، بوجوب تغيير دفة المسار، فإن الساسة «السنة» المشاركين بالعملية السياسية، ومن يدعون تمثيل «الشارع السني»، كما ساسة الأديان والقوميات الأخرى، من أدعياء التمثيل للشعب بعد تفتيته، وجدوا ملاذهم في أحضان التفاوض السري مع المسؤولين الأمريكيين، بذريعة التخلص من النفوذ الإيراني، ليسقطوا أبناء الشعب في هوة «أما… أو» متناسين بانتقائية لا مثيل لها جرائم المحتل الأمريكي ومسؤوليته في مأسسة التمزيق الطائفي والفساد.
إن الاستنجاد بقوات الاحتلال الأمريكي، أو قوات ولاية الفقيه، بعد أن أثبتت الـ 16 سنة الأخيرة، بما لا يقبل الشك، رغبة كل منهما بالدفاع عن مصالحه وحل نزاعاته، على أرض العراق، جريمة لا تغتفر يرتكبها ساسة العملية السياسية على اختلاف أديانهم ومذاهبهم وقومياتهم ضد العراق، ونتيجتها الحتمية تقديم أهله قربانا لصراع ابتلع حتى الآن، حياة ما يقارب المليون مواطن. كما أن النداءات والحركات الاحتجاجية المطالبة بالإصلاح لم تعد ذات فاعلية بل وباتت أداة يتم تسخيرها لصالح النظام وتخفيف الضغط عليه، بحكم توجهها نحو الاحزاب ذاتها المنغمسة بالفساد، خاصة مع هيمنة ميليشياتها على الشارع واختطاف أو قتل كل من يجاهر بالاحتجاج. وإذا كان دعاة «الاحتجاج المطلبي» المشاركين في اللعبة السياسية نفسها قد نسوا اختطاف الناشط جلال الشحماوي، وعدم العثور عليه حتى اليوم، من بين آخرين، ها هم يعاد تذكيرهم بجريمة اغتيال الروائي والباحث د.علاء مشذوب، عصر السبت، في مدينة كربلاء، حيث اخترقت جسده 13 طلقة. والجريمة التي ارتكبها: التذكير بمصاب العراقيين، وأهل مدينته التي عشقها، جراء الطائفية والفساد المستشري.
كاتبة من العراق
انهم يقتلون المجتمع المدني في العراق!
هيفاء زنكنة
على مدى ثلاثة أيام تلقى عدد من رجال الدين من محافظة نينوى، شمال العراق «تدريبات مركزة على كيفية بناء السلام والتعايش والحد من الكراهية»، في ورشة أدارها « مشرف على عمليات بناء السلام» من منظمة مجتمع مدني تدعى «سند لبناء السلام». وتهدف المنظمة من خلال الورشة الى»بناء السلام» و«خلق فرص السلام»، بالإضافة الى «التسامح والتآلف والتعايش المجتمعي وفضاء الإنسانية». مما يعني ان المنظمة تفترض، إما بحسن نية أو لأن التمويل المتوافر يتطلب برنامجا كهذا، إن أهل الموصل، خاصة، ونينوى عموما، لم يحدث وأن عاشوا سوية بسلام وان المنظمة قادرة على تحقيق ذلك بقدرة مديرها ولقبه الرسمي «مشرف على عمليات بناء السلام». وهو لقب، ظننته قد استخدم، في البداية، من باب المزاح، في مجال مسميات نشاطات المجتمع المدني المستحدثة، إلا أن مواصلة القراءة أكدت ان المسألة جدية. ويستحق عمل المنظمة الذكر عند رصد مصادر تمويل المجتمع المدني بالإضافة الى النظر في ماهية المشاريع ومدى استجابتها للحاجة الفعلية للمجتمع، منذ الاحتلال عام 2003 وحتى اليوم.
الملاحظ ان منظمة «سند لبناء السلام» تأسست عام 2013 بدعم من «معهد الولايات المتحدة للسلام». وهو مؤسسة يتمتع أعضاء مجلسها بعلاقات وثيقة مع أجهزة الاستخبارات الأمريكية. مما يضع علامة استفهام حول دور المعهد وماهية توفيره التمويل والدعم لمنظمات مجتمع مدني في بلد قامت أمريكا بغزوه، وهي المسؤولة الأولى عن تخريبه، بشريا وعمرانيا، بشكل مباشر وغير مباشر. وتصبح علامة الأستفهام أكبر حين يتم تمويل منظمات المجتمع المدني في البلد المحتل تحت شعار رنان هو «بناء السلام»، فعن أي سلام يتحدثون؟ هل هو ذات « السلام» الذي يحاول الكيان الصهيوني تسويقه، يوميا، بينما يدير آلة القتل المنهجي ضد الفلسطينيين؟ ألم يتم تفريغ السلام من فحواه النبيل بعد؟
مشروع آخر يستحق الاشارة، أنجزته منظمة مجتمع مدني تدعى «مؤسسة تجديد عراق لتنمية وتطوير الاقتصاد» تقدم نفسها باعتبارها « جادة في تطوير الوضع الاقتصادي والعلمي في العراق كمساهمة في بناء العراق الجديد». أما المشروع الذي أنجز نهاية العام الماضي، فهو «حملة تشجيع البدء المبكر للرضاعة الطبيعية»، حيث تدرب خلال يومين 20 شخصا من ملاكات الصحة على «تشجيع الأمهات العراقيات على ترضيع الأطفال حديثي الولادة». ويؤكد موقع المؤسسة على ان الحملة تمت بدعم «من الشعب الأمريكي» و«المؤسسات الإنسانية» ووزارة الصحة وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف). هذه المعلومات، تثير التساؤل حول ماهية المشاريع: فمتى توقفت الأمهات العراقيات عن إرضاع اطفالهن حديثي الولادة؟ حسب علمي، أنه إذا كانت هناك مشكلة فهي ان الأمهات يواصلن الارضاع لسنوات ما لم يكن هناك سبب صحي مانع وليس العكس. بالإمكان اعتبار هذه المشاريع نموذجاً مصغراً لمشاريع «إعادة الاعمار» على مدى أعوام الاحتلال.
لم تكن ولادة «المجتمع المدني» الذي برز بمنظماته وشبكة اتصالاته، في العراق المحتل منذ عام 2003، طبيعية
وفي كتابه «كانت نيتنا حسنة»، يكشف الدبلوماسي الأمريكي بيتر فان بورن، قائد فريق إعادة الإعمار التابع لوزارة الخارجية الأمريكية في العراق، عن قائمة طويلة من المشاريع الخيالية أو الوهمية التي قام بها فريق الإعمار وفي كلا الحالتين لم تكن ذات فائدة إطلاقاً للمجتمع العراقي بينما «كلفت دافع الضرائب الأمريكي أموالاً طائلة»، حسب تعبيره، وان كانت الأموال، في الحقيقة، مستخلصة من العراق نفسه.
يتساءل فان بورن أثناء تمحيصه طبيعة المشاريع: «إذا ما تم تعيينك مسؤولا عن «إعمار العراق»، هل ستنفق أموال دافعي الضرائب على لوحة جدارية في أخطر أحياء بغداد لتشجيع المصالحة من خلال الفن؟ ماذا عن إنشاء «مصنع الحليب» النائي المعزول الذي لا يستطيع العاملون فيه نقل الحليب إلى السوق؟ أو إدارة صف لتدريب العراقيات على صنع المعجنات وفتح المقاهي في شوارع قصفت وتفتقر إلى الماء والكهرباء؟».
وإذا كانت مئات المشاريع قد تم تجميدها بعد الانسحاب الجزئي لقوات الاحتلال عام 2011، فإن ما أسس له من فساد مالي بقي متغلغلاً، في بنية الحكومات العراقية ومؤسساتها، من أعلى المناصب القيادية الى أصغرها، ومقبولاً، عملياً، من قبل كل المنخرطين في العملية السياسية، وبات، وهنا الخطر الأكبر، مؤثراً، أيضاً، على طبيعة وعمل «المجتمع المدني»، بذات المواصفات وبدرجات قبول متفاوتة، محليا وعالميا.
لم تكن ولادة «المجتمع المدني» الذي برز بمنظماته وشبكات اتصالاته، في العراق المحتل منذ عام 2003، طبيعية. فباستثناء قلة من المنظمات المستقلة، فعلاً، جاءت ولادة معظم البقية مشوهة، بعدما أعلن ديك تشيني، وزير الخارجية، أن أي عمل مدني تدعمه جزء من سياستها الرسمية وليس كما تشاء المنظمات أو الناشطون. عدد منها كان جزءاً من القوة الناعمة لبلدان أخرى ساهمت بالغزو وكانت قد أسست في الخارج لتسويق الخطاب الدعائي لشن الحرب، ومن ثم تم تصديرها الى داخل البلد لترويج خطاب «بناء الديمقراطية». العدد الآخر، تم تأسيسه داخليا، في فترات تطلبت نشاطا دعائيا ترويجيا معينا، مثل تأسيس مئات المنظمات قبل الانتخابات لتصويرها بأنها «نزيهة وشفافة». هذه المنظمات تتلاشى حالما تنتفي الحاجة اليها وينتهي التمويل. وإذا كانت من أبرز مصادر الدعم والتمويل لمنظمات « المجتمع المدني» الناشطة داخل العراق هي وكالة الاستخبارات الأمريكية (سي آي أي) ووزارة الدفاع (البنتاغون) ووزارة الخارجية الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في فترة الاحتلال الأولى فإن مسؤولية التمويل تقاسمتها منظمات أمريكية، مدعومة حكوميا، باشرت ذات المهمة وهي: المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية، والمعهد الجمهوري الدولي، ومركز المشروعات الخاصة المستقلة، والمركز الأمريكي للتضامن الدولي من أجل العمل («مركز التضامن»)، وعدة منظمات أصغر مثل معهد الولايات المتحدة للسلام. مهمتها، على اختلاف أسمائها، تصدير السياسة الأمريكية تحت أغطية ملونة ومزركشة بالديمقراطية والمصالحة والسلام.
ولم يقتصر هوس تأسيس المنظمات على بلدان الاحتلال فقط، إذ سرعان ما اكتشف ساسة الحكومة العراقية أهميتها كأداة للتظاهر بالديمقراطية وحقوق الانسان أمام المجتمع الدولي والدول المانحة من جهة، ولإجهاض عمل المنظمات المستقلة من جهة أخرى. فباتت المنظمات الكبيرة المهيمنة على الساحة امتداداً طبيعياً للحكومة، اذ يحتل رؤساء عدد من أكبر منظمات المجتمع المدني المهيمنة على الساحة مناصب حكومية عليا، بالإضافة الى الأحزاب الفاسدة القادرة على التمويل، وتم تحويل «المجتمع المدني» من مجموعة من المنظمات التطوعية التي تنشأ وتعمل باستقلالية عن الدولة إلى واجهات لمن يدفع ناهيك عن تمثيل السياسة الخارجية لدول أخرى، والأدهى من ذلك حين تكون الدولة الممولة هي محتلة للبلد وعملت بمثابرة على تهديم بنيته التحتية وسببت مقتل مليون مواطن.
ان تدخل الأحزاب ووصاية الحكومة يعني موت المجتمع المدني فما بالك بالتدخل الأجنبي؟ ما بالك إذا كان الأجنبي هو المحتل الذي هدم البلد وعاد متظاهراً ببناء السلام من خلال منظمات ومشاريع تغذي قلة من المستفيدين أو السذج، وتمنع قيام مجتمع مدني فاعل يعمل على تشكيل الوعي ورفع المستوى الثقافي والتفكير المستقل والانجاز الحقيقي.
كاتبة من العراق
.
